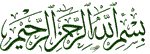
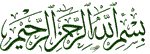
دعوة إلى
سبيل المؤمنين
(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)
النساء 115
الإهداء
إلى من هنى الثرى به ضجيعا أمجدا
إلى من أضاءت وجناته الليل الأسودا
إلى ضجيع تمرغت حبيبات الثرى عليه تبركا
وتنعمت به خيرا أقام عندها سرمدا
إلى ضجيع مطرت به أرض الخريف القاحل
وازدانت به الأيام في عيش أرغدا
إلى من غطاه تراب الأرض ولا عجب
فمن تحت الثرى دوما نروم العسجدا
إلى زين العابدين المهدلي أبي
أهدي أشواق القلوب توجدا
المقدمة
الحمد لله الذي علا بحوله، ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفضل، وكاشف كل عظيمة وأزل، أحمده على عواطف كرمه، وسوابغ نعمه، وأومن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قادرا قاهرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا.
وأشهد أن محمد (ص) عبده ورسوله، أرسله لإنقاذ أمره، وإنهاء عذره، وتقديم نذره (1).
إن ما ستطالعه، إن شاء الله، بين دفتي هذا الكتاب هو طائفة من التحقيقات التي قمت بها خلال مدة دراستي في كليه الإلهيات والمعارف الإسلامية في إيران، حول مسألتين مهمتين هما:
1 - عدالة الصحابة بقضهم وقضيضهم.
2 - مسألة الخلافة بعد النبي (ص)، وما تمخضت عنه أحداث السقيفة وخلاف السنة والشيعة حول هذه المسألة، معتمدا في ذلك على ما جاء حولها في المراجع المعتبرة لأهل السنة والجماعة.
وأنا بدوري أعرض ما توصلت إليه من قناعات على من تهمه المسألة من أفراد المسلمين كافة، من خلال مفهوم (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) (2)، ومن
____________
(1) نهج البلاغة: من الخطبة 83 (الغراء).
(2) البقرة: 256.
لقد كان هذا التحقيق مما لا بد منه ولا مفر، إذ القضية ترتبط بالاعتقاد والمصير الأبدي، فلم يكن المجال ليسمح بالمساومة أو المماطلة أو الترضيات.
إن الدين الإسلامي لما كان هو نظام الحياة الذي يجب أن يؤسس كل مؤمن حياته عليه ويبني عليه مصيرة، كان لا بد أن يقوم اعتقاد كهذا على أساس يبعث اليقين والطمأنينة. ولا يصح أن تنال المصائر بالظنون والتوهم، أو تنال بالتقليد الأعمى الذي لا يعرف صاحبه الدليل والحجة غير ما كان عليه الآباء والأولون، فإذا سئل: لماذا أنت مسلم؟ فإنه لا يجيب إلا بالصمت والحيرة. وإذا قيل له: لماذا أنت شيعي أو سني أو مالكي أو...؟ تراه يخطرف (1) في الإجابة. كل ذلك لأنه لم يفكر في اعتقاده ومصيره من قبل بحرية، بل قام كل ما عنده من اعتقاد على التقليد الأبوي والاجتماعي، فصار على هذا مسلما: شيعيا أو سنيا.
ولما كان هذا الأمر خاصا للغاية بالفرد نفسه، سواء في هذه الحياة أو في الحياة الأخرى، فمن الجهل أن يعارضه أحد فيما ذهب إليه واطمأنت له نفسه، فلا يجوز إملاء الاعتقاد أو إكراه الناس على نهج يسيرون عليه، ولكن يجوز إقناعهم بالدليل والحجة المقنعة بالروح العلمية الرياضية العصرية، في إطار حرية الاعتقاد التي سار عليها دين محمد (ص) في تعامله مع الفرق والأديان والاعتقادات المخالفة في كل زمان ومكان.
ولقد كنت أتعجب جدا من أولئك الذين عارضوني وخاصموني بشدة، عندما اخترت لنفسي مذهب أهل بيت النبي (ص)، اطمئنانا مني لهذا المذهب الذي هو عندي أكمل المذاهب وأفضلها بال منازع، بل هو ما كان عليه النبي وأصحابه العدول. ويتعبد به اليوم عدد كبير من أمة محمد (ص) في كثير من بلدان العالم الإسلامي.
____________
(1) تخطرف الشئ: جاوزه وتعداه. لسان العرب 9: 79.
غير أنني لم أغلق الباب أمام من يرى خلاف ما رأيت، ويملك من الأدلة ما لم أملك، على أنه سيظل الباب مفتوحا له، ما دام ينتهج في حواره قوله تعالى: (وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) (1)، وإلا فالباب موصد.
المؤلف
1416 هـ / 1995 م
أم درمان
____________
(1) النحل: 125.
تمهيد
أولا: الفتن والاختلافات الحادة.
ثانيا: تعدد الفرق الإسلامية.
ثالثا: بعد المسافة الزمنية بين زماننا وزمان النبي (ص).
رابعا: حصار أهل البيت وتكميم أفواههم.
الإنسان بين الواجب الدنيوي والمصير الأخروي
يأتي الإنسان إلى هذه الحياة الدنيا، مبتدئا، إياها بيوم مولده، ثم ينشأ ويترعرع.
وتترعرع في جنبيه آماله وأحلامه، ويقوى تعلقه بهذه الحياة، فلا يسعه فراقها ولا يرضى بغيرها بدلا، فيطوي على هذا الحال سنين طويلة، ويبلغ من عمره ما يبلغ، فتأكل الأيام قواه ويثقل الزمان ظهره بحمل من السنين، فيقعد مرغما عن السعي إلى الآمال والركود خلف الأحلام. وعندها تحين الالتفاتة، وهو ما يفتأ يرى أنه قد بلغ النهاية في عراكه مع أحداث الحياة من أجل الوصول إلى ما كان يرجوه من أسفاره. وها هو الآن يضع عصا الترحال مستسلما لأمر الواقع، إذا قد حانت أشراط الفراق، وقد ازدادت الشقة بينه وبين هذه الحياة، ثم يلفظ آخر أنفاسه خاتما تلك الحياة في لحظة من سكرات الموت.
فهل ينتهي إلى هنا كل شئ؟ وهل تنتهي الحياة بموت الإنسان وتحوله إلى جثة هامدة وعظام نخرة، ثم لا شئ بعد ذلك؟ فإن كان الأمر كذلك، فما هو الفرق إذا بين الإنسان والحيوان، وبين إنسان وآخر من جنسه من حيث المصير؟ ما الفرق بين الناس:
الناجح منهم والفاشل في حياته، وبين الخير والشرير، وبين العادل والظالم؟ أم أن خالق الكون والإنسان لا يهدف إلى شئ من خلقه إياه؟ أم أن وجود الإنسان محدود بهذه الحياة الدنيا فحسب، فلماذا الموت والفناء إذا، ولم لا يترك الإنسان مخلدا باقيا في حياته، ما دام لا شئ بعد الموت، أم أن الخالق عاجز عن إبقائه فيها أبدا؟
إن الحياة لا تنتهي بالموت، وإنما الموت انتقال إلى الحياة الثانية التي تبدأ بما يسمى بالحياة البرزخية. وفي الواقع أنه بالموت يبدأ كل شئ، فالحياة الدنيا ليست سوى تلك الأعمال التي يتصدى لها الإنسان فيها منذ ولادته إلى يوم ارتحاله، والحياة الأخرى ليست سوى حضور تلك الأعمال التي تصدى لها الإنسان في حياته الدنيا بذواتها منذ بلوغه التكليف ثم حصحصتها بلا تجاوز لصغيرة ولا كبيرة. وعلى هذا الأساس - فالناس - وهم في حياتهم الدنيا - سواسية من حيث إن لهم اكتساب هذه الفرصة للتحصيل والتزود كل على قدر ارتباطه بخالقه والتزامه بتكاليفه. وهم بذلك على قدر وافر من الاختيار، بل دون جبر يحول بينهم وبين اكتساب هذه الفرصة السانحة التي لا تتكرر. وطبقا لذلك فهم سواسية أيضا من حيث الثواب والعقاب في الحياة الأخرى، كل طبقا لما اكتسبه في حياته الأولى وما انتخبه من نهج فيها.
إذا فالحياة الأولى مرحلة الاكتساب والتزود، والموت هو لحظة الانتقال إلى الحياة الثانية التي هي حياة الاستقرار الأبدي لما اكتسبه وتزود به سابقا (ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب) (1).
إن الحياة التي يحرزها الإنسان في آخرته بلا شك هي حياة أبدية ويمكن للفرد أن يتصور ويمعن الفكر بعمق في معنى تلك الحياة الأبدية، مع العلم بأن الأبدية تعني إلى جانب عدم الانقطاع والانصرام اللاعودة واللارجعة لترتيب الأمور وإصلاح ما فسد منها، إذا أن ذلك أمر ممنوع ولا مجال له قط. فليتصور الإنسان ذلك، وليضع نفسه مرة في موضع من حالفه التوفيق في تلك الحياة الأبدية، ومرة في موضع الذي جانبه التوفيق وحدث على أقل تقدير تقصير في أعماله فأصابه نوع من الشقاء فيها، وليذوق طعم الحياتين في الحالتين معا، حتى يتبين له الفرق الشاسع وخطورة الموقف، حتى تتبين
____________
(1) إبراهيم: 51.
فالحياة الدنيا - وهي مجال لأداء هذا الواجب ومنطلق لذاك المصير - ليست مجالا لاكتساب أعمال قد أحيطت بالظنون وطوقت بالأوهام، إذا أنها حياة - وهي تؤدي إلى مصير كهذا قطعا - لا تحتمل ذلك لمحدوديتها وقصرها، فلا بد إذا أن يكون كل فعل يكتسب فيها مؤسسا على اليقين والحق، والفعل الذي يبعث الاطمئنان على النتائج فتأسيس هذه الحياة على الظن والأوهام لا ينتهي إلا إلى هذين. إن أهمية الحياة الدنيا من هذا الحيث لا تقل شيئا عن أهمية الحياة الأخرى، إذ لا بد للإنسان أن يبعد عن حياته هذه كل ما من شأنه أن يباعد بينه وبين السعادة الأبدية في تلك الحياة التي تقوم على أساس اليقين، بل عين اليقين. وهذا هو أصل السعادة وأساس الفوز في الحياة الآخرة.
والسنخية بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة واضحة، فما يفعله الإنسان في هذه الحياة يحضر بعينه وبصورته النوعية الحقة ليجده الفرد هناك أمامه، بل كل فعل وكل شئ آنذاك يتجلى في صورته الواقعية التي لا نستطيع ونحن في حياتنا هذه - ما دمنا قد بنيناها على الظن - أن ندركها كما هي في الواقع الحقيقي، وهذا هو اليقين المطلوب في هذه الحياة، الذي تكون علائمه التي تشير إليه هي اليقين المطلوب في هذه الحياة في أدنى درجاته.
وجوب التحقيق في أمر العقيدة
والحصول على هذا اليقين أولى ما يكون في العقيدة، إذ أنها أصل لكل فرع، وفساده في فسادها الذي هو موجب لكل فساد لا محالة، إذ العقيدة هي التي نعنيها بالتحقيق والتصحيح حتى تبدو وقد تأسست على الحقيقة واليقين، فلا بد إذا من التحقيق من سلامتها بالفحص وإعادة النظر وتقليب البصر وإعمال الفكر والتدبر في أحوالها.
والعقيدة لا تورث حتى ندعها للفطرة وحدها، والاتكاء على اعتقاد الأسلاف والآباء والأجداد ممنوع: (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون) (1)؟
وأرجو أن يظن أحد أن هذا منحصر بنقض عقائد المشركين التي ورثوها عن أسلافهم فحسب، بل يمتد ليشمل العقيدة التي ورثها أصحابها عن الأسلاف، ظنا منهم أنها من الإسلام في شئ. والسبب في ذلك أن عقائد المسلمين قد تلونت وتقسمت وتعددت وتفرعت بسبب الاختلافات والفتن التي عصفت بالرعيل الأول من المسلمين، وما ورد على عقائدهم من عقائد الأمم والوافدين. ولو لم يكن غير هذا لكان كافيا في إيجاب النظر والبحث في ما بلغنا من اعتقاد السابقين، ولكن الرسول (ص) قد صرح محذرا أمته إذ يقول (ص) (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة). إذا فالاختلاف الذي وقع
____________
(1) المائدة: 104.
وما يجدر الإشارة إليه أن الذي يفجعون بالمصير السئ والنهاية والمشؤومة في تلك الحياة الأخرى هم الذين سكنت نفوسهم للموروث من العقائد، ظنا منهم أنه الحق، وتلذذت أنفسهم بنشوة الغفلة وهدأة النفس لها، ولما أصابوه من هذه الحياة.
وهؤلاء إما أنهم قد أطلقوا للنفس زمامها وحبلها على غاربها بالتهاون والتساهل في أمر الدين ونسيان الحياة الآخرة وعدم مراعاة أمرها بتصحيح اعتقاد أو أداء تكليف، أو أنهم ركنوا إلى الأوهام في اعتقادهم وغاصوا في بحار التوهم بحثا عن اللؤلؤ، دون أن يتفطنوا إلى أن اعتقادا كهذا لا وجود له حتى يأتي باللؤلؤ النفيس، فليس الوهم إلا عدم محض لا يوجد إلا في الخيال.
أو أن هؤلاء قد استلقوا في أحضان الظن في أمر العقيدة. وذاقوا بهذا يسيرا من مذاق الحقيقة بعد اختلاطها بقدر جم من الباطل، وهم في غمرة هذا المذاق الحلو الذي يتلمظونه بين كم من المرارة ركنوا لمذاق الباطل الذي خلطوه به ظنا منهم أن للحق مذاقا كهذا إذ أنهم خطوا عملا صالحا بآخر سيئا (إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) (1).
والذين يمحصون اعتقادهم الديني ليبلغ حد اليقين أو قدرا من اليقين تضعف نسبة الشك والظن فيه بصورة تجعل مقدار الشك لا يؤدي وجوده إلى زوال الطمأنينة في الاعتقاد، فهؤلاء أقرب من غيرهم إلى النهج الذي رسمه النبي الأكرم (ص) لكي يسير عليه الناس، بل هؤلاء لا يعجزون عن التماس الأدلة والحجج القوية على اعتقادهم هذا من حيث موافقته لآيات القرآن وأحاديث النبي (ص) ومسلمات العقل وفطرياته، فهم في
____________
(1) النجم: 28.
متطلبات التحقيق في أمر العقيدة
إن من حزم الأمر على التحقيق والبحث في اعتقاده فهو لا يستطيع إحراز شئ من تحقيقه إن كان مفعما بالتعصب والتقليد اللذين لا يتيحان الفرصة للتحقيق الحر، فلا بد له لكي يكون حر الحركة والتفكير أن يفرغ نفسه من كل ما يكون أن يتسبب في إفساد التحقيق عليه والحيلولة بينه بين ما يصبو إليه من بحثه، وأن يهيئ نفسه جيدا لتقبل الحقيقة التي يصل إليها، بعد نجاز التحقيق والاطمئنان إلى سلامته من حيث المنهج السليم والأدلة المقنعة بلا شك، لأن الخوف من خوض التحقيق أو الخوف من تقبل النتيجة عدو المحقق النزيه، فالنتيجة تحتم عليه رحابة الصدر لتقبلها باعتبار أنها الحق، بل تحتم عليه الدفاع عنها وعرضها على الآخرين. ومن لا يهدف إلى هذا من تحقيقه وبحثه فعليه ألا يشرع في شئ من التحقيق لأنه يكون عندئذ مضيعة لوقته، بل يكون عبثا ولعبا، ولماذا يحتمل المشاق ويقطع الحجة على نفسه ثم لا يقبل نتيجة بحثه وتحقيقه ولا يدافع عنها؟
ثم إن المحقق والباحث في مسألة الاعتقاد الديني له ثوابت أساسية ينطلق منها باديا بحقه وتحقيقه، فهو لا يستغني عنها أبدا، ولا يتجافى عنها في بحثه عن الاعتقاد الكامل السليم. وهذه الثوابت الأساسية تتمثل في:
فالقرآن هو الدليل على نبوة محمد (صلى الله عليه وآله)، وهو - من ثم - الدليل على وجود الله وخالقيته وربوبيته ووحدانيته إضافة إلى الدلائل الأخرى المبثوثة في الأنفس والآفاق، وذلك لأن طبيعة القرآن الإعجازية تفرض على البشر ذلك الاعتقاد، إذ أنهم - بإزاء القرآن - قد عجزوا عن:
1 - الإتيان بمثله. يقول الله في كتابه الكريم: (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) (1).
2 - الإتيان بسورة من مثله. يقول تعالى: (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين) (2).
وهذا تحد صريح يثبت صدق النبي (صلى الله عليه وآله) في ادعائه النبوة، الأمر الذي يثبت وجود الله وهيمنته على الوجود.
3 - العجز عن تحريف القرآن. ولو بإبدال حرف واحد بحرف آخر، وهذا من إعجاز القرآن الواضح في بقائه - منذ نزوله إلى هذا اليوم عبر القرون - على ألفاظه، ولا غرو فقد تكفله الله بالحفظ (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (3). وهذا دليل قاطع يؤكد صدوره من عند الله تعالى إلى نبيه (صلى الله عليه وآله).
____________
(1) الإسراء: 88.
(2) البقرة: 23.
(3) الحجر: 9.
فالإيمان بالله وبرسوله وكتابه هي السمة المشتركة بين كل الفرق المختلفة والمتخالفة، ولا نجد فرقة تدعي الانتساب إلى الإسلام تؤمن بالله وتكفر برسوله أو تطعن في كتابه الكريم، ورغم ذلك فالناجية واحدة. فما هي إذا تلك السمة التي انفردت بها هذه الفرقة عن سائر الفرق ونالت بها الفوز والنجاة؟ وبالتأكيد أن هذه السمة لا تتوفر إلا في هذه الفرقة دون غيرها، وإلا لما كان اختلاف، ولكانت كل الفرق في الواقع فرقة واحدة، فما هذه الصفة يا ترى؟! وهذا هو أساس البحث والتحقيق الذي نحن بصدده..
إذا لا بد من التعرف على هذه الفرقة بهذه الصفة التي تميزت بها عن سائر الفرق.
يقول الإمام الرازي: (إن النهي عن الاختلاف والأمر بالاتفاق يدل على أن الحق لا يكون إلا واحدا. وإذا كان كذلك كان الناجي واحدا [ أي الناجي فرقة واحدة من بين الفرق المتخالفة ] (1).
____________
(1) التفسير الكبير للإمام الرازي 8: 174 - آل عمران 103 قوله تعالى: (واعتصموا...).
الأسباب الموجبة للتحقيق في أمر العقيدة
لا شك أن ما ندين من عقائد يحتوي على قدر جيد من الحقيقة، بل بالنظر إلى وجود القرآن بيننا يجعلنا نستطيع أن نجزم بأن ما بين أيدينا هو كل الحقيقة، ولكن وجود الحقيقة بيننا شئ والعمل على أساس هذه الحقيقة شئ آخر، فالنبي (صلى الله عليه وآله) لم يأمر باتباع القرآن أو العمل به فحسب بل قرن به ما قرن، وهذا المقرون بالقرآن ليس فيه حقيقة تنفصل عن القرآن وتخالفه، بل يبين ما اشتمل عليه القرآن من الحق. إذا فالمقرون بالقرآن هذا لا نستطيع أن نقف من دونه على ما جاء به القرآن من الحق. وهذا هو السبب الذي لا نستطيع معه أن نقطع بأن ما ندين به يشتمل بلا ريب على اليقين دون الظن، وكثير من الأسباب أدت إلى عدم القطع هذا فكان دافعا للتحقيق والبحث، ومن هذه الأسباب:
أولا: الفتن والاختلافات الحادة
وهي الفتن والاختلافات عصفت بالمجتمعات والأفراد المسلمين، منذ نعومة أظافر الإسلام. وقد بدأت هذه الاختلافات والنبي (صلى الله عليه وآله) لما يرتحل من بين الناس آنذاك، فلقد اختلفوا في أهم مسألة ترتبط بمصير المسلمين وهم جلوس في حضور نبيهم (صلى الله عليه وآله)، وهو الاختلاف الذي عرف فيما بعد ب " رزية يوم الخميس ". ولا تخلو من حكايته كتب السير والأحاديث. ولا شك أن هذا الاختلاف قد ألقى بظلاله على زماننا، وأحيطت الحقيقة
ثانيا: تعدد الفرق الإسلامية
ذلك أن اختلافا كهذا حدث بين الرعيل الأول - ولا سيما بعد الركون إلى عدالتهم كافة - قد أدى إلى بروز فرق لا تحصى ولا تعد في المجتمع الإسلامي. والعجيب أن أعضاء هذه الفرق - وهم لا يجوزون بحث الخلاف بين الصحابة - تراهم يبحثون حول ما حدث بينهم من اختلاف، وقد غفلوا عن أن اختلافهم هذا كثير منه معلول الاختلافات الأول، فإثبات الحق لفرقة وسلبه عن فرقة أخرى، هو في الواقع نسبة ذلك الحق إلى رأي من آراء بعض الصحابة في المسألة المختلف فيها، وسلبه عن الفرقة الأخرى هو سلب هذا الحق عن البعض الآخر منهم في نفس مسألة الاختلاف، وقد طعنوا بذلك في عدالة كافة الصحابة من مكان بعيد.
ثالثا: بعد المسافة الزمنية بين زماننا وزمان النبي (صلى الله عليه وآله)
وهذا من الأسباب القوية التي تؤدي بلا شك إلى بعث غريزة التحقيق والبحث في أمور الدين، لأن ما صدر من النبي (صلى الله عليه وآله) لا بد له أن يطوي كل تلك المسافة متنقلا بين أنواع أفراد البشر والمجموعات المتخالفة التي لا تعتمد إلا ما وافق الرأي منها ولا تحتفظ إلا بما تراه صوابا.
وهي في تحديدها الصواب من الخطأ تتنازعها أمور وتتناوشها أشياء، فالنسيان
فالذين ينقون ما يمر عبرهم من أقوال وأفعال صدرت عن النبي (صلى الله عليه وآله).. على أي معيار يعتمدون في هذه التنقية؟ ومن يجرح غيره ويتهمه بالنسيان وكثرة الخطأ يجرحه بأمور هو نفسه عرضة لها وإن كان ثقة عادلا، هذا فضلا عن الذين شمروا عن سواعدهم لوضع ما لم يكن عن النبي (صلى الله عليه وآله) صدوره ونسبته إليه بعد ذلك، وهم أكثر وأشد نشاطا وفعالية.
وعملهم أسهل وأهون من عمل الإصلاح.
رابعا: حصار أهل البيت وتكميم أفواههم
لقد كان الخليفة الأول وكذلك الخليفة الثاني يرجعان في كثير من الأمور إلى أهل البيت، فأبو حفص كان مفزعه في أمور الدين الإمام علي، ولهذا صدر منه مرارا قوله: " لولا علي لهلك عمر "، وقوله: " الله أعوذ بك من معضلة ليس لها أبو الحسن "، وهكذا كان دأبهما.
وأعلمية أهل البيت - وعلى رأسهم الإمام علي (عليه السلام) - من الحقائق التي لا مراء فيها ولا جدال، وقد اعترف بذلك أبو بكر الصديق وخليفته أبو حفص. واستمر الحال إلى زمان عثمان حيث استولى بنو أمية على مقاليد الأمور في الدولة الإسلامية، وتصرفوا في كل شئ حتى هيمنوا على السلطة تماما، فتغير الحال وحورب أهل البيت، وحوصرت أقوالهم، وسلب حقهم في المرجعية الدينية فضلا عن الخلافة. واستمر الحال هكذا إلى آخر يوم في الدولة العباسية، فنشأ الناس على ترك أهل البيت. ثم إن الحصار في دولة بني أمية لم يقف على إبعاد أهل البيت النبوي عن المرجعية فحسب، بل تعدى إلى ابرازهم بنحو يؤدي إلى نفور الناس منهم، ولهذا الغرض استنوا سب الإمام علي (عليه السلام) أكثر من خمسين عاما.
وضرب الحصار على من يرجع إليهم في أمور دينه، وقتل من لم يطلق لسانه فيهم بالسباب والشتم، وهيئت الفرص لمن يسبهم ويجافيهم. وأمر معاوية الناس في بقاع
كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة أن برئت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته! فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليا ويبرؤون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته. وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة، لكثرة من بها من شيعة علي عليه السلام (1).
والسؤال الذي يطرح ببراءة: لماذا حارب الأمويون طيلة حكمهم هذا علماء أهل البيت؟ ولأي شئ قتلوهم؟ ولماذا نسج على منوالهم العباسيون؟
وقد يجيب أحد بأنهم نافسوهم في الحكم والسلطة.. ولكن، هل كان أهل البيت يعارضون حكم الأمويين لو كان قائما على ما جاء به الوحي وقضى به النبي (صلى الله عليه وآله)؟! وهل كان من الوحي سب الإمام علي أو قتل الإمام الحسين بالصورة الوحشية التي عرفها التاريخ؟! أو كان من الوحي إطعامهم السم الزعاف؟! وهل كان أبناء الرسول يحبون السلطة من أجل السلطة والحكم؟ وما ذا تضرر العباسيون من عترة النبي (صلى الله عليه وآله) حتى انتهجوا معهم ما انتهجه الأمويون؟!
إن أهل البيت بعد الضربات الأموية لم تبق لهم تلك الخطورة السياسية التي تعتمد على قوة الجيش والسلاح، فقد انفض الناس من حولهم إما خوفا من القتل والسبي، وإما انجذابا نحو الأصفر والأبيض من أموال السلطة. وصار أهل البيت تحت المراقبة الأموية في منازلهم وبين أهليهم، أو في المحابس وفي سجون الحكومة العباسية، وهذا يكفي الحكام لتوطيد حكمهم. إذا.. لماذا القتل؟! وهل كان لأهل البيت خطر غير الجيوش والسلاح لا يزول إلا بقتلهم؟! وما ذاك الخطر؟ وهل كان السبيل إلى الصلح والتوافق معهم قد أغلق تماما؟!
لقد كانت المسألة بين الحكام من الأمويين والعباسيين، وبين أهل البيت مسألة الدين والشرع، فالحكام في نظر أهل البيت قد خالفوا الشرع والنهج المحمدي، وأهل
____________
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 11: 44، الباب 23.
وهذا الإمام الحسين يصور حقيقة النزاع بين الحكام وأهل البيت، يقول الطبري: " وقام الحسين في كربلاء مخاطبا أصحابه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن رسول الله (ص) قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفئ، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غيري " (1).
فإذا كان النبي (صلى الله عليه وآله) قد ربى أبناء الناس على الدين خير تربية، أتراه تاركا أبناءه فإنه على غير تربية الدين؟! لا، بل لهم الأولوية في التربية والنشأة على الوحي، وإلا فإنه يكون كالآمر بالبر والناسي لنفسه.
ولما كان هدف أهل البيت إقامة الدين وإجراء الشرع الذي تربوا عليه وهم أولى بذلك، كان الحكام في زمانهم يهدفون إلى السلطة فحسب، لأن الذي لا يهدف إلى شئ إلا أن يرى الدنيا قائما، لا يضيره شئ إن قام الدين بغيره من الناس على الوجه المطلوب.
وهكذا حوصر أهل بيت النبوة من كل صوب، ومنعوا من الكلام في أي أمر في مجال الدين سياسيا وعباديا. فإن كان هذا حال أهل البيت فمن من أتباعهم تكون له جرأة الكلام والتفوه بما يرضي العترة النبوية؟! فلو استهان أمر أهل البيت عند الحكام فلأمر أتباعهم أشد هوانا. ومع ذلك ظهر على سطح الساحة الدينية علماء صار حق الفتيا لهم، وارتضاهم الحكام، وقصدوا إلى فرض ما أفتوا به على الناس ونشره بينهم، فقربوهم إليهم وأجزلوا لهم العطاء. فلم كان ما أفتى به هؤلاء يرضي سريرة أهل البيت ويوافق ما هو عليه من أمر، فلماذا لم يترك الحكام أهل البيت لأن يفتوا أو يقولوا بهذا ما دام لا يضيرهم منه شئ؟! أم أن هؤلاء كانوا أعلم من أهل البيت بأمور الدين والوحي؟! ولكن أهل
____________
(1) تاريخ الطبري 4: 304 - حوادث سنة إحدى وستين.
ولهذا أبعد أهل البيت، وقرب من خالفهم من العلماء والناس. واستمر الحال هكذا وطارت فتواهم كل مطير وانتشرت في البلاد وسار الناس على مذاهبهم، ولم يلتفت أحد إلى بيت النبوة ومهبط الوحي، فأخذ الناس الدين عن غيرهم. وها نحن نرى الخلاف بين أتباع المذهب الجعفري (1) من شيعة أهل البيت وبين المذاهب السنية.
أفلا يدعو هذا إلى البحث والتحقيق؟!
____________
(1) نسبة إلى الإمام جعفر الصادق (عليه السلام).
اختلاف المسلمين حول ولي الأمر بعد النبي (صلى الله عليه وآله)
ثم إن من المسائل التي تفرض علينا التحقيق البحث حولها باعتبارها من أهم مسائل الدين، هي معرفة ولي الأمر.
الاعتقاد السائد بين كافة المسلمين أن النبي (صلى الله عليه وآله) هو خاتم الأنبياء والرسل، أي هو نبي لا نبي من بعده، وأي اعتقاد بخلاف ذلك يستوجب الكفر بلا شك. وفرض عدم خاتمية الرسالة يفرض نبيا آخر يأتي بعد محمد (صلى الله عليه وآله) لهداية الناس بعد انقضاء فترة الإسلام، ولما لم يكن كذلك.. فهم الإسلام على ضوء ختم الرسالة بأنه دين كل زمان ومكان، وهذا منطق بلا شك يتفق وختم الرسالة، وعلى هذا تصافق وتوحد اعتقاد المسلمين باعتباره أمرا قرآنيا مسلما (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) (1)، وعلى هذا فإننا نستخلص من هذا الاعتقاد المسائل التالية:
1 - ليس هناك نبي يأتي بعد محمد (صلى الله عليه وآله)، فهو خاتم وآخر الأنبياء والرسل.
2 - إن الإسلام خاتم الأديان، وهو قد جاء إذا لكافة الناس إلى يوم القيامة.
3 - ولكي يفي الإسلام بهذه العمومية لكل البشر، وحتى يفي بمتطلبات عموم الناس على اختلافهم وتنوعهم زمانا ومكانا، لا بد أن يكون على درجة من القوة والكمال حتى ينهض بالناس دينيا واجتماعيا وسياسيا وخلقيا واقتصاديا، ولهذا يقول تعالى: (اليوم
____________
(1) الأحزاب: 40.
بكل هذه الخصائص لا بد لهذا الدين أن يشق طريقه نحو المجتمعات، ماضيها وحاضرها والناشئة مستقبلا، لإرشاد الناس إلى سبيل المؤمنين، وإبطال كل فكر واعتقاد يباعد بينهم وهذه السبيل. فهذه مهمة لا تنجز منحصرة في عصر واحد، بل تقتضي الحضور الدائم في كل عصر، فكما كان النبي (صلى الله عليه وآله) هو المتصدي لهذه المهمة يكون ولي الأمر من بعده هو المتكفل بذلك، وهكذا أولو الأمر إلى آخرهم.
وأهمية ولي الأمر تنحصر في أمور:
أولا: فهو من ناحية أنه رئيس وقائد ومدير لشؤون الدولة الإسلامية، فله الأهمية السياسية بكل جوانبها.
ثانيا: ومن ناحية أنه المرجع الديني للمسلمين في نواحي الدولة الإسلامية كافة، فله الأهمية الدينية التي لا تنفصل عن حياة الناس.
ثالثا: ومن ناحية أنه واجب الطاعة فهو يمثل مسألة من أهم مسائل أصول الدين، إذ أن طاعته أمر إلهي تعبدي لا بد من أدائه، وذلك لقوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (2)، فهذا أمر مطلق قطعي، وواجب يلزم أداؤه لولي الأمر.
إذا، فالأمر الصادر من الله تعالى بإطاعة أولي الأمر يحتم علينا التعرف على ولي الأمر هذا، لأداء واجب الطاعة له، تنفيذا لأمر الله تعالى. والطاعة هذه تكون لولي الأمر في كل ما يقول ويأمر به وينهى عنه، فمخالفته في شئ بعد تعيينه معصية صريحة، ومخالفته في أمر بسبب الجهل به ليس فيه عذر، لأن تصريح القرآن بالأمر بطاعته هو إشارة إلى وجوده وتعيينه، وإلا يكون تكليفا فوق الطاقة.
فمن هو ولي الأمر من بعد النبي (صلى الله عليه وآله)؟
لقد اختلف المسلمون في ذلك، وانحصر الاختلاف بينهم في ولي الأمر بين أبي
____________
(1) المائدة: 3.
(2) النساء: 59.
ونحن مسؤولون عن معرفة الولي المطاع، طبقا للآية الكريمة، ومن هنا تظهر أهمية التحقيق والبحث بل وجوبه حول هذه المسألة المصيرية.
____________
(1) نهج البلاغة: من الخطبة رقم 3 (الشقشقية).
الفصل الأول: عدالة الصحابة
مقدمة في عدالة الصحابة.
تعريف الصحابي.
تعريف العدالة.
الفرار من الزحف وشماتة البعض.
كتمان الشهادة! شهادة الزور.
سب الإمام علي (عليه السلام).
اختفاء المنافقين بين الصحابة.
إشكالات على الحديث.
إختلاف علي وعثمان.
إخبار النبي (صلى الله عليه وآله) لأبي بكر بالإحداث.
محدثات أبي حفص.
مخالفة الصحابة للخلفاء الأربعة.
مخالفة سعد بن عبادة لأبي بكر وعمر.
خلاف بعض الصحابة للخليفة الرابع.
مخالفة عائشة لعثمان وعلي.
عدالة الصحابة
مقدمة في عدالة الصحابة
إن مسألة عدالة الصحابة لهي من المسائل التي وضعت بصماتها بصورة جلية في حياة المسلمين الاعتقادية والعبادية، ذلك لأن قول الصحابي وفعله أضحى من الأمور التي أولاها الفقهاء وعلماء الحديث والأصول أهمية أدرجتها في مصاف مصادر التشريع الإسلامي، وصارت من المقدسات الدينية عند المسلمين. فكثير من المسائل الفقهية ترجع إلى قول الصحابي وفعله وما سنه من سنن، حتى وإن كانت هذه السنن تخالف تماما السنة النبوية أو صريح القرآن، كغسل الرجل عند الوضوء دون مسحها (1)، وسن صلاة التراويح في جماعة (2)، وقول: " الصلاة خير من النوم " (3) في آذان الفجر، وإلغاء زواج المتعة وتحريمه (4)، وسن الآذان الثاني في صلاة الجمعة (5). وغير ذلك كثير سن من قبل بعض الصحابة، دون أن يوافق ما كان عليه النبي (صلى الله عليه وآله). على أن من المسائل التي تدعو إلى التعجب وتبعث على الحيرة، إدراج كافة الصحابة في صحيفة العدالة دون مراعاة
____________
(1) تفسير الإمام الرازي 3: 370 - تفسير سورة المائدة.
(2) إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري 5: 4.
(3) الموطأ، شرح الزرقاني 1: 25 - باب ما جاء في النداء للصلاة.
(4) شرح التجريد للقوشجي: مبحث الإمامة.
(5) تفسير القرطبي 18: 100 الكواكب الدراري 6: 127، إرشاد الساري 6: 210، عارضة الأحوذي 2: 305.
