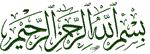
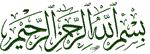
مقدمة المركز
تعتبر الإمامة أصلا من أصول مذهب أهل البيت(عليهم السلام) وركناً هاماً من أركانه الأساسية، ولهذا يعدّ مبحث الإمامة من أهم المباحث التي دوّن حوله الكثير من العلماء والمفكّرين، بحيث أدّى ذلك إلى إغناء رصيد المكتبة الإسلامية بالكثير من الكتب المدوّنة في هذا المجال.
وهذا الكتاب ـ الماثل بين يدي القارىء الكريم ـ يعتبر من تلكم الكتب التي اهتمت بهذا الجانب، ولكنّها اختلفت عن أمثالها من ناحية الزاوية التي نظر من خلالها المؤلف إلى هذا الموضوع، وهي زاوية قلّ من نظر من خلالها إلى هذا المبحث، وذلك، لأن المؤلف حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة وعلم النفس، وحاول خلال بحثه لموضوع الإمامة أن ينظر إليه من زاوية اختصاصه في علم النفس، ولهذا وصل المؤلف عن طريق المنهج العلمي والتحليلي المعمّق الذي اتبعه في دراسته هذا المبحث إلى نتائج جديدة حول مفهوم الإمامة.
ويفتخر "مركز الأبحاث العقائدية" أنّه يقوم بتشجيع النخبة من المستبصرين على تدوين حصيلة جهودهم في البحوث التي قادتهم إلى التخلي عن معتقداتهم السابقة ودفعتهم إلى الالتحاق بركب أهل
ويعتبر هذا الكتاب اصداراً آخر ضمن "سلسلة الرحلة إلى الثقلين" التي جعلها المركز وسيلة لنشر كتب المستبصرين وأملنا أن يكون هذا الكتاب عن طريق مساهمته في توسيع آفاق ذهنية القارىء حول مكانة أهل البيت(عليهم السلام) وعظمة شأنهم خطوة في طريق خدمة هذه العترة الطاهرة التي جعل البارىء التمسك بها ـ كما ورد في حديث الثقلين ـ ضماناً لعدم الانحدار في أودية الضلال.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل
مركز الأبحاث العقائدية
فارس الحسون
دعاء:
ربّ ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا.
ربّ اجعلني أتقرب في هذا العمل إليك واجعل طريق الإمام علي(عليه السلام) طريقي فهو طريق الرشد ومعراج الهداية وسفينة الوصول إلى الله تعالى والرسول(صلى الله عليه وآله).
رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
مقدمة
الكتب التي انصرف مؤلفوها نحو تناول شخصية الإمام علي بن أبي طالب بالدرس والتحليل كثيرة جداً، والكتب التي ذهبت تتفحّص ما كتب حوله في التاريخ، ليست فقط لدى المسلمين، بل وعند سواهم من الديانات الأخرى أيضاً كثيرة، كما أنّ الكتب التي اكتفت بالحديث عن فضائله ومنزلته وما قدمته للإسلام وللإنسانية جمعاء كثيرة.
وهذا لا يعني أنّ خزائن معرفته قد امتلأت، ولا يعني أيضاً أن العالم لم يعدّ بحاجة إلى المزيد مما يكتب عنه، بل على العكس، إن الذي كتب عن الإمام عليّ(عليه السلام) على كثرته وأهميته، ما يزال يعاني من مساحات شاسعة من الفراغ الذي يبحث عمّن يشغله.
وإذا كانت الكتابات تصبو نحو الإحاطة الكلّية بهذا الرجل العظيم; فإنها لم تتمكّن من ذلك لا لأنها قاصرة، بل لأنه أمضى عمره الشريف مهتماً بالشؤون الدنيوية والأخروية في آن معاً، وهذا ما لا يتوفر لكاتب أو باحث أو مؤرخ أن يحيط به أو يفعله! وإنما يأخذ
ولا نظن أننا سنبلغ أكثر مما وصل إليه غيرنا بكثير، وإنما نرغب في دخول غمار البحث، راجين من وراء ذلك الفائدة والبركة من جهة، وساعين نحو إثارة فكرة نراها جوهرية في فهم ماهية الإمامة من جهة ثانية.
وسيكون لنا في مسيرتنا البحثية مواطن متعددة نقف عليها واحدة تلو الاخرى، وتدور البحوث هنا حول ثلاثة محاور رئيسية هي:
المحور الأول: يدور حول إظهار ماهية الإمامة، في تناول يعتني بالجانب النفسي والاجتماعي من حياة الإنسان، وهذا الجانب هو الذي قادنا إلى تفصيل معنى الإمامة من الناحية اللغوية ومن ناحية الاصطلاح.
ولهذا المحور اتجاه نحو فهم شامل للإمامة، لا على أنها قيادة سياسية أو زعامة اجتماعية، أو على أنها نهج متقدم في شؤون الحياة، وإنما بما هي مصداق للنزوع الإنساني نحو الغاية من الوجود، ونحو الملاذ الذي يحتمى بكنفه، ويسعى من أجل بلوغه.
المحور الثاني: يدور حول انطباق هذه الماهية في النتيجة على شخصيات محدودة، تمارس مع تتابع الأزمنة أدواراً رسالية من
وهنا سوف نتوسّع في استعراض النصوص المقدسة التي تؤيد ما ذكرناه، ونجلو بعد ذلك الصورة التي بلغناها في معرفة هذا الانطباق.
المحور الثالث: وهو المحور الذي يكون لنا فيه سياحة مع الكيفية التي مارسها الإمام عليّ(عليه السلام) في إرساء دعائم خطاب الإسلام الإنساني، وهو هذا الخطاب الذي باشره النبيّ الكريم محمد(صلى الله عليه وآله)، وكانت البشرية جميعها هي المقصودة من ورائه، وليس فقط فئة من الناس، ولا أمة من الأمم.
ولمّا كانت الإمامة مسألة من المسائل التي لا يمكن فصلها عن الإسلام بحال من الأحوال، لما تشكله من دور في حياة المسلمين، كان تناولها من أكثر الأمور حيوية وإثارة، وذلك لأسباب عديدة: منها أنّ فريقاً من المسلمين عدّها فرعاً من فروع الدين، وعمل على إخراجها عن دائرة الأُصول، مع ما تستحوذ عليه من جدل يخرجها عن الفروع ويجعلها من الأصول!
وعند النظر في ما سجّل وقيل عنها، يلاحظ المهتم أنها دخلت مجالاً من التعصب كما سنشير إلى رأي الغزالي خلال البحث، وفي الواقع ليس للغزالي وحده هذا النمط من الرأي وإنّما سلك هذا المسلك أكثر أهل السنّة، وسنجد تفصيل ذلك بحول الله في مكانه من
والحقّ أنّ عملنا هنا ينصبّ بالدرجة الأُولى على مفهوم الإمامة، وليس على وظيفة الإمام، مع ما سيكون من فروع تتفرع عن هذا الفهم، لأنّ الانطلاق من المفهوم إلى المصداق هو الذي يعين على تلمّس معرفة أسباب الاختلاف الذي نشب بين الآراء التي بحثت موضوع الإمامة في الإسلام، ونحن نعلم المدى الذي شغله هذا الموضوع من الفكر الإسلامي، لكن الأمر أوسع من ذلك، فهو موضوع في الواقع يشغل مساحة كبرى من الفكر البشري عموماً ومنذ أقدم الأزمنة، بمعنى أنه ليس بدعة خاصة جاء بها الإسلام، بل وفق المنهج الذي تبنّيته، يتبيّن أنّها في عمق الحقيقة البشرية وعمق النفس الإنسانية، أيّ أنّ الإمامة ضرورة إنسانية وليست ضرورة مذهبية أو دينية مع ما يمثله الدين من ضرورات في حياة الناس.
وقد أخذ الجدل في التراث الإسلامي حول هذا الموضوع بعداً متميزاً، بحيث نجد من يعتبر الحديث في الإمامة من غير المسموحات، وأنّ الخطر كل الخطر في الاقتراب منه! ونجد أيضاً نقيض هذه الفكرة لدى أطراف أُخرى، كما نجد من وقف في المنطقة الوسطى بين هذين الأمرين، فلهذا رأينا أنّ المجال يتّسع لحمل هذا الأمر محمل البحث الجديد لما فيه من خير وفائدة، مستعينين ـ بالإضافة إلى العلوم المتبعة في هذا المجال ـ بعلم النفس الذي يقدّم
والجانب الآخر الذي رأينا أنه من الضرورة بحثه أيضاً، هو الجانب التطبيقي لما تصل إليه نظرية الإمامة.
ولمّا كان الإمام علي(عليه السلام) هو المثل الأعلى للإمامة عند كافة المسلمين لما حفل به من قدسية، بحيث لو ذكرت كلمة الإمام ككلمة مفردة لتبادر إلى الذهن فوراً الإمام عليّ(عليه السلام)، ولما تمتّع به من صفات الإنسان الكامل، الذي قصدت مجمل الديانات السماوية والفلسفات الكبرى سبيل بناءاً الإنسان بناء يسير به نحو أن يحذو حذو هذا المثال، لذلك فقد اخترنا أن نتحرك داخل أجوائه، ونتعرف على حقيقة الهدف الإلهي من وراء جعله إماماً للناس كافة، وهذا لا يتحقق يقيناً بغير ما ينبغي أن يعرف أولاً عن مفهوم الإمامة، ثم بعد ذلك قد تنكشف الحجب وتظهر للمهتم الصورة العلوية المباركة.
وقد سعينا في الختام أن نربط الإمامة تاريخياً بالبعد الإنساني عامّة، إدراكاً منا أنّها لم تنقطع يوماً من الأيام، ولم تنفصل عن مسيرته البشرية، ولم يتأت هذا الإدراك اعتباطاً، بل جاء متوافقاً مع نتائج علوم جمّة تناولت التاريخ الإنساني بأبعاده الحضارية وما فيه من إرث يسجل تطلع الإنسان إلى هدف يسعى من أجل بلوغه وإلى ملاذ يلجأ إليه وإلى مثال يتطلع نحو كماله ويعدّه الغاية النهائية لحقيقة سعيه.
الحقيقة الأولى: تتمثل في أنّ الإمامة ضرورة فطرية تسعى نحوها النفس البشرية كافة، وهذا متوافق مع المشروع الإسلامي وعالميته، وقد تبيّن لنا أن الناس منذ أقدم أزمنتهم يتمتعون بالتطلع نحوها، والبحث عنها.
والحقيقة الثانية: هي الدور الذي نهض به الإمام عليّ(عليه السلام)، ليس باعتباره فقط إماماً للمسلمين، بل بما هو مصداق واقعي لذلك السعي الفطري الإنساني الباحث عنه.
وختاماً نسأل المولى عزّ وجلّ السداد، ونرجوه القبول.
وهو من وراء القصد
المدخل
لا بد لنا قبل التحدّث عن الإمام عليّ(عليه السلام) ومنهجه وطبيعة خطابه الإنساني، من تسليط الضوء على الحدود اللازمة لمعرفة طريقة تناولنا له(عليه السلام) هنا في هذا الكتاب.
لذلك لا بد من الإشارة إلى أنّنا استخدمنا كلمة (الإمامة) هنا كاصطلاح إجرائي، ينفعنا في تبيين أمر تلمسنا جوانبه من خلال اشتغالنا بالطب النفسي بالدرجة الأولى، وبالدور الذي تمارسه علوم النفس في الكشف عن سرائر الإنسانية وإضاءة جوانبه المظلمة.
وقد كان لنا مع مصطلح الإمامة عمل رأينا أن نقدمه في كتاب يشرح أبعاده، واتضح لنا أن خير من يجسد هذا المصطلح، هو الإمام عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) لما تمتعت به شخصيته من تمكين وتجسيد لمفهوم المثال الذي دأبت الرسالات السماوية والفلسفات الوضعية على إظهاره للناس كما ذكرنا.
لذلك قد نحتاج أن نوضّح هنا، أنّه رغم اطلاعنا على الطرق التي
ومن البيّن أن المسلمين اتخذوا لأنفسهم مذاهب في شرح وتعريف الإمامة، وهذا أمر علمي وعملي، فهو الذي يساهم دائماً في قدح شرارة التجديد كلما لوحظ أنّ تبلداً ما قد أخذ يطرأ على الأذهان، فالحيوية التي يتمتع بها الفكر الإسلامي هي التي تميّزه عن بقية الأفكار الموجودة على الأرض، ونقصد دائماً ذلك الجانب الجدلي الفعّال في بنية المعتقد الإسلامي، فهو فكر متوثب لا يركن إلى الجمود.
إذن، فالمناهج المتبعة والمذاهب التي يعمل بها الفكر الإسلامي هي ضرورة حيوية، من ضرورات وجوده وبقائه متجدداً باستمرار، ومن الخطأ أن يفهم أنّ الفكر الإسلامي فكر محدّد بأطر لا يمكن تجاوزها، أو الحيد عنها، وإلاّ لكان أُقفل على العقل المسلم منذ نهاية العصر النبوي، وأحكم إغلاقه، فلا يقدر بعدئذ أن يبني لنفسه ما يؤهله لدخول ساحات التقدّم العلمي والتقني، لعدم حيازته على ترخيص من سالف الزمان.
والواقع أنّ العكس هو الصحيح، فالعقل الإسلامي عقل مدقّق فاحص باحث عن المعرفة، سائر إلى تطبيق مناهجه في كل زمان
بهذا الشكل من التفهم والتعقل، نجد أنّ المذاهب التي تناولت الإمامة في الإسلام وبذلت قدراً من الجهد في هذا المجال رأت أنّه يكفيها في حينه، كلّ بحسب تطلعه وعلمه، وهذا لا يمنع الدارس من تناولها بالفحص والعناية، لإظهار منافعها من جهة، ولإبعاد ما يمكن أن يكون غير نافع في هذا العصر من جهة ثانية.
وبذلك يستمر الفكر الإسلامي بالتجدد، وليس ذلك بتقديس القديم بما هو قديم فحسب، لأنّ الأشياء المقدسة وغير القابلة للنقد لم تكن محل نزاع بين المسلمين، بل هي تستحوذ على احترام الجميع بلا اختلاف، وإنّما الذي ينشب حوله النزاع، ذلك الذي تشتق منه فكرة أو يستخلص منه رأي أو تصاغ حوله الموضوعات، أمّا الثابت المقدس كالتوحيد مثلا، والقرآن الذي هو الكتاب الجامع لكلّ مسلم على وجه الأرض، ونبوّة محمد(صلى الله عليه وآله) و...، فهي أُمور لا اختلاف حولها. أمّا باقي المفاهيم المنتزعة من هذه العقيدة بعد ثبوتها فإنها مجال للتناول، ولا نرى غضاضة في إجراء الحوارات، والمناظرات حولها، وهي جارية منذ أرفق سبحانه بنبيّه(صلى الله عليه وآله)وتوفاه إلى جواره، ولا نعتقد أنّ عصراً خلا ولم يتناوب أهلوه فيه المناظرات والمجادلات حول تفاصيل جمّة، منها ما هو عقيدي،
فالخير كلّ الخير في استمرار المباحثات بين المسلمين، والخطأ كلّ الخطأ في إقفال بابها، وإلجام حوارها، فهي معين يروي ظمأ العطشان، وجنّة تورف بظلالها، وتكثر ثمارها، وينبعث النفع منها كالريح الطيبة العطرة.
من هنا نجد أنّ الإسهام في دفع هذه العملية واجب وضرورة، واجب على من تؤهله ملكاته ومعارفه ويملك آلته في دخولها، وضرورة من ضرورات التواصل بين المسلمين وشدّ أواصر القربة، وقطع دابر الفتنة وما ينجم عنها من ويلات وسيئات تحصد الثواب، وتنزل الويل.
ولمّا كانت الإمامة من المسائل ذات الخصوصية العالية في الفكر والمعتقد الإسلامي، كان الاشتغال فيها أمر دائم، وكانت الأقوال فيها تتراوح بين منحيين أو اتجاهين:
الاتجاه الأوّل: يدور حول حقيقتها، دوران الموارب غير الموضح تماماً لما يريد أن يقوله فيها.
الاتجاه الثاني: إحكام دائرة الفصل فيها، والقطع بأنّها منحة تحفل بالعناية الإلهية، لا يصيبها أحد وإنّما تُصطفى، مثلما حدّثنا القرآن الكريم عن الصفوة الأُولى التي اختارها الله سبحانه.
ولهذين الاتجاهين تفرعات متعدّدة، منها من انفتح على
فما هي الإمامة، وما معناها، وما الفائدة من بحثها، وما ضرورتها عند المسلمين وعند سواهم؟ هذا ما تتولى الإجابة عنه الأبحاث القادمة.
ونبدأ باستعراض سريع لعدد من الآراء المعتبرة عند المسلمين حول هذا الأمر مقدمين لذلك الفصول الآتية:
الفصل الأول: الإمامة ماهيتها ومعناها
يجد الباحث في معرض التساؤل عن ماهية الإمامة في التراث الإسلامي إجابات متعدّدة ومتنوّعة:
ـ منها من حملها على أنّها أمر يختص بالزعامة والقيادة أو الرئاسة.
ـ ومنها من تناولها على أنها فكرة وأدخلها حيّز التصورات التي تبحث لها عن تصديق.
ـ ومنها من سار بها نحو التأملات الفلسفية التي تحتمل في تحققها الخطأ مثلما تحتمل الصحة.
ـ ومنها من رآها شأناً إلهياً كالنبوّة، ليس للناس من قرار فيه.
ـ وهناك من نأى بها عن فنّ المعقولات وسار بها نحو الفقهيات، يريد بذلك إدخالها منطقة الاستنباط، وإخراجها عن دائرة الأُصول التي يبحر العقل وراء إدراك كنهها، ويرتفع بها عن مقام المعاملات، ليصير إلى فلسفة المعرفة.
ويرد على سبيل المثال هنا لا الحصر كلام الغزالي في معرض شرحه لموقفه من موضوع الإمامة حيث يقول: "اعلم أن النظر في الإمامة أيضاً ليس من المهمات، وليس أيضاً من فنّ المعقولات، بل من الفقهيات، ثم إنّها مثار للتعصبات والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض فيها وإن أصاب، فكيف إذا أخطأ! ولكن إذا جرى الرسم باختتام المعتقدات بها، أردنا أن نسلك المنهج المعتاد..."(1).
لا يخفى أن المعتقدات شيء والفقهيات شيء آخر، وللغزالي باع في الأُمور الكلامية التي تصب في فلسفة العقائد، وربما داخل هاتين الإشارتين نجد مساحة للتحرك، مفادها أن إقصاء الإمامة عن أُصول العقيدة وإدخالها في باب الفقه ليس في غاية الإحكام، بل هو مجال لاستمرار البحث فيها، ولا تلتزم مفردة "اعلم" التي يستخدمها المعلمون المسلمون قديماً كختام أو تمام للفكرة، وإنّ على المهتم أن لا يعتبر ما جاء هنا هو ذروة الصواب، بل كما أسلفنا
____________
1ـ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: 234، وعنه السبحاني في الملل والنحل 1: 295، والواقع أن الكلام حول هذا الأمر كثير في التراث. ويمكن الرجوع إلى آراء المتكلمين المسلمين للتوسع في مفهومهم للإمامة فهناك عدد كبير منهم لم يخرج عن رأي الغزالي كثيراً.
ولا ندري إنْ كانت تنفع مفردات مثل "المعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض فيها"، أو "إنها مثار للتعصبات"، أو "مثار للفتن والشحناء"(1) يُقصد منها الكفّ عن البحث في الإمامة وإقامتها، أم يقصد فيها إثارة ذهن الباحث نحو جلاء مثل هذه الحقيقة! وأرى ترجيح الثانية، والسير على هذا الترجيح.
ويتضح لي أنّ الإمامة مفهوم جميع ما تقدّم، وعلى هذا المفهوم تترتب النتائج التي تكون أكثر شمولية، وأشد تعبيراً من المناصب الإدارية أو السياسية أو العسكرية أو الاجتماعية، لكن لبلوغ هذا المفهوم يحتاج الراغب لمزيد من العناء، ولا نقصد بالعناء هنا المشقة من أجل الوصول إليه، لأنّ الإمامة والإمام أمر لا ينبغي معه الغموض، مثلما لا يجب أن ينشب حوله خلاف من نوع ذاك الذي يقسّم الناس إلى فرق وأحزاب، إنّما الواجب أو الضروري ـ بمعنى الحتمي ـ أن يكون الإمام هو الجامع والرابط بين الناس، الجاذب لهم والموطد لأواصر التقارب والتلاحم فيما بينهم، هذا هو الأمر الطبيعي والسليم، الذي يرسل الله تعالى الأنبياء عادة ويزودهم بالأوصياء من أجله.
____________
1ـ انظر غاية المرام في علم الكلام للآمدي: 363.
وليس المقصود بضنك العيش هنا: الاحتياج والفقر، أو الشعور بالظلم وما شابه ذلك، إنّما المقصود هو اغتراب النفس وابتعادها عن راحتها وطمأنينتها بالدرجة الأولى! فكم من موسر، وكم من جبار، وكم وكم من أولئك الذين يتصور الناس أنهم بلغوا رتبة السعادة في الحياة الدنيا، تجدهم في حقيقة أمرهم يعانون من آلام القلق والاضطراب، وعدم الاستقرار والسكينة.
ويجد المتابع للمنهج القرآني أنّ ذروة الدعوة لديه منصّبة على إخراج هذا الكائن البشري من مثل هكذا ضنك، والدفع به نحو مدارج السعادة، لكن هذا لا يتحقق بحسب الطرح الديني على أساس حلّ المشكلات الحياتية اليومية كما يتصور البعض، وإن كانت الراحة شي حاسم في هذه الحلول، وإنّما يتحقق على أساس فكّ رموز الوجود والتعرّف على معناه، الأمر الذي يوطّد لمعرفة الغاية من ورائه، وعند هذه المعرفة بالذات تستوي اللذائذ الدنيوية مع الآلام، لتشكّلان بالنسبة للعارف بهذه الحقيقة بُعداً مادياً ليس هو
وهنا عند هذه النقطة تكمن أهمية معرفة الإمام، بحسب ما جاء عن الإمام الرضا(عليه السلام)في معرض وصفه للإمام، انّه "معدن القدس والطهارة"(1).
ولا نخال أمراً أكثر عسراً وأكثر إيغالا في التشويش من ذاك الذي يجرف المرء نحو الشكل وينأى عن المضمون، لذلك وجدنا هذا الجدل وهذا الصراع ـ إن صحت العبارة ـ حاصل بين من يعتبر أنّ الإمامة أمر دنيوي يمكن أن يقوم به ويتكفّل بتنفيذ مهماته شخص يتمتّع بصفات معينة أو قدرات أهّلته أن يتربّع على كرسيها، حتى يدير شؤون الناس ويمارس زعامته وإمكاناته في رئاستهم، وبين من يعتبرها شأناً إلهياً صرفاً يجعله في من يختار من عباده، ولا يكون بعد ذلك من هدى واقعي بمخالفة هذا القانون.
والحديث الآن حول مفهوم الإمامة، ثم نتحدث بعد ذلك عن ماهية الإمامة.
ما هو المفهوم
يرمز المفهوم عند المناطقة إلى ما ينتزعه الإنسان من الخارج من
____________
1ـ انظر: الكافي للكليني 1: 202، كتاب الحجّة.
ونحن عند اختيارنا لهذا التعريف، رمينا إلى ما يقود الفكرة نحو عمقها، للخروج بها عن معطيات الظاهر، بالطبع بعد أن أخذت شكلها وتسميتها بالنسبة للتجربة الحسية التي ندركها كما أدركها من سلف، لأنّ الشيء لا يُعد موجوداً بالنسبة لشعورنا إلاّ عندما يلد فكرة تصبح برهاناً على وجوده في عقلنا، وعندما يتيح ذلك يصبح حضوره وجوداً حقيقياً، وحينئذ تنكشف شخصيته ويوضع بالتالي اسم يطلق عليه، تلك هي عملية الإدراك(3).
فالاسم هو أول تعريف للشيء الذي يدخل نطاق شعورنا، وهو تصديق على وجوده، وهو بهذا الوضع أوّل درجة من درجات المعرفة وأوّل خطوة نخطوها نحو العلم، وإذا كان الاسم بهذا المعنى هو الدرجة الأولية في المعرفة، فإنّ المفهوم هو الدرجة الأوسع
____________
1ـ محيط المحيط، مكتبة لبنان، ص704.
2ـ المعجم الفلسفي المختصر: توفيق سلوم، ط موسكو ص470.
3ـ انظر كتاب الأُصول الفكرية للثقافة الإسلامية، محمود الخالدي، دار الفكر، عمان ط1، 1: 30، وما بعدها.
لذلك عند إطلاق تسمية (الإمام) على الرجل الذي يتزعّم أو يقود نجدها لا تصلح لأن تبلغ مفهوماً! بمعنى أن الأمر هنا هو انطباق المصطلح على من يقوم بتنفيذ أمر ما، وهذا لا يقود نحو تجريد الاسم وبلوغه المعنى الذي يتيح التعمق وبلوغ الحقيقة التي هي شي غير القيام بالفعل، وسوف نجد مثالا على هذا في قول ابن حزم مثلا "إن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله(صلى الله عليه وآله)"(1).
وينبغي علينا أن نفرق تماماً بين القائم بالعمل على أنّ هذا العمل أمر موكل إليه من قبل الناس، لبراعته فيه وتمكنه وفق مؤهلات تملّكها، أو سلطان خوله القيام عليه، وبين الإمام بالمفهوم العميق الذي أورده الإمام الرضا(عليه السلام) عند وصفه للإمام، فهو لا يزجي إليه مهمة تكون ضمن إمكانات العاديين من الناس، وإنْ اشتمل بالعرض عليها، وإنّما هو يتعمق إلى جوهر الإمامة، فيقول(عليه السلام): "الإمام عالمٌ لا يجهل، وراع لا ينكل، معدن القدس والطهارة، والنسك والزهادة، والعلم والعبادة... نامي العلم، كامل الحلم، مضطلع بالإمامة، عالم بالسياسة، مفروض الطاعة، قائم بأمر الله عزّ وجلّ، ناصح لعباد الله..."(2).
____________
1ـ الفصل بين الملل والنحل لابن حزم 4: 87.
2ـ انظر: الكافي للكليني 1: 202، كتاب الحجّة.
الإمام في اللغة
جاء في الصحاح: "هو الذي يقتدى به"(1)، وكما هو واضح هنا فهي تفيد التعميم، ولا تختص بتفصيل يقود إلى معنى دقيق وحقيقي، فالذي يقتدى به يمكن أن يكون شخصاً يتمتع بالفطنة والذكاء، ويمكن أن لا يكون كذلك، ويمكن أن يكون آلة، ويمكن أن يكون مَعلماً من معالم المنفعة، بالطبع نحن نعلم أنّ المقصود هنا إجمالي، لكن حديثنا يجب أن يعطف على الفور على رغبتنا في إظهار المفهوم، لذا تقتضي الدقة أن يحاط بجميع أطراف التعريف، حتى يصار إلى انتزاع المفهوم الذي يتيح التعمق كما سبق.
وجاء في لسان العرب: "أم القوم وأم بهم: تقدّمهم، وهي الإمامة، والإمام: كل من أئتم به"، ويفصّل ابن منظور هنا فيقول: "يكون الإمام رئيساً كقولك إمام المسلمين، ويكون الإمام الطريق الواضح،
____________
1ـ الصحاح للجوهري: 5، مادة إمام.
وأورد من محيط المحيط في إظهار معنى الإمام من الناحية اللغوية قوله: "فالإمام هو قيم الأمر، والمصلح له"(2).
وقال الراغب: "والإمام المؤتم به إنساناً كأن يقتدى بقوله أو فعله، أو كتاباً أو غير ذلك، محقاً كان أو مجملا، وجمعه أئمة"(3).
هذه الطائفة من التعاريف اللغوية تشير بأشكالها هنا إلى عدّة معان، وإن بدت جميعها تبحث عن إجمال المعرّف وتحديده، لكن لكل واحد منها فيما يبدو شكلا مستقلا إلى حدّ ما عن الآخر، وإنّما في عمومها تشير إلى من يحمل صفة التقدّم والإمساك بزمام الأُمور بما فيها الزعامة، أي رئاسة القوم والمرجعية العقائدية، أي المرتكز الفكري والدليل الذي يحدّد الاتجاه.
وكذلك تفيد الإشارة إلى صاحب المقام أو المنزلة الذي يقصد لجلال معين، وتظهر أيضاً أحد معانيها القيام بالأمر الاجتماعي، والمحافظة على أُمور تم التوافق عليها عند ذكر كلمة (قيّم) أو (مصلح).
فقد أخذت هذه التعريفات بمحاولة الإحاطة بالهدف، لكنها كما يلاحظ تخفق في إصابة كبد الحقيقة! وهذا الأمر ليس مستنكراً
____________
1ـ لسان العرب لابن منظور مادة: أم.
2ـ محيط المحيط، بطرس البستاني، دار لبنان، ط 1977، ص161.
3ـ المفردات لألفاظ القرآن الكريم للراغب الاصفهاني: 24.
الإمام في عمق النفس البشرية
إنّ ما تقدّم من البحث في التعريف والمفهوم، يساعدنا على القول، أنّ الإمام المرجو الإفصاح عنه خفي على الظهور، بقدر ما هو واضح وجليّ في عمق النفس الإنسانية.
وسنحاول هنا أن نعمل على نقل هذا الوضوح من العمق إلى السطح بالمقدار الذي يمكننا من إزالة الحجب، حتى تصبح الإشارة فيما بعد إلى حقيقة الإمام إشارة لا يشوبها غموض. وقد أمعنا النظر في الوارد هنا من تعريفات، ولاحظنا أنّها تعطي تقريباً لغوياً للمفردة، وفي عدّة أمكنة نلاحظ سيراً أشد عمقاً نحو إلحاح المفردة على إظهار معنى أكثر عمقاً، وهذه حاجة ضرورية، إذ أن التفسير اللغوي يعتني عادة بالإبلاغ عن الأمر أكثر بكثير من البحث في جوهره ومعناه الحقيقي. وإن الذي يساعد على ذلك فيما يبدو، نسق آخر من أنساق التفتيش خلف هذه الحقيقة وسنجده هناك في عوالم النفس.
فثمة في عمق الإنسان ذلك التطلع نحو هدف تنشده نفسه،
يقول أريك فروم: "لا يوجد إنسان ليس محتاجاً إلى دين ما، ولا يريد تحديداً للاتجاه والموضوع الذي ينبغي له التعلق به"(1)يريد بهذا القول: إن الغرض الدفين في العمق الإنساني هو هدف يسير بالإنسان باتجاه تعلق من نوع ما باتجاه نداء يسحبه من أعماقه، دون أن تكون لديه المقدرة على تجاهله، وإن هو تجاهله لوقت أو لحال من الأحوال فإنه ينقذف ـ في لحظة معينة من داخله ـ شعور يجعله يضطرب متساءلاً عن فحواه، فمتى قاده هذا الشعور إلى عقيدة أو دين أو إيمان من نوع ما فإنه سوف يسعى لأن يعبّر عنه بأيّ طريقة تتناغم معه، وتشعره بانتهاء قلقه، أو انتهاء شي منه.
____________
1ـ البحث النفسي والدين، أريك فروم: ضمن الإنسان والإيمان، مرتضى المطهري، منظمة الإعلام الإسلامي ط2، ص43.
الفطرة
لعلّ المقصود بالفطرة هنا: هي تلك الأهلية المتوفرة داخل النفس والتي تشير إلى أكثر حالاتها صفاءً، قبل دخول وتراكم المعارف عليها، وهي بهذا اللحاظ تعبر بصورة مثلى عن الاحتياجات التي تجذب نحو تعلّق الإنسان.
ومن المستحكم يقيناً أنّ التدين أمر غريزي، أو فطري.
والتدين بأحد المعاني، هو اعتقاد من نوع ما، يستلزم فكراً مجرّداً من جهة، ويستلزم أيضاً تعلّقاً عاطفياً من جهة أخرى.
وهو من هاتين الجهتين يحقق انسجاماً وتناغماً مع الإنسان، بما يشتمل عليه ذهنه من أُمور تعمل وتسير نحو التجريد والبحث عن حقائق الأشياء وانتزاع المفاهيم الخاصة بها، وإقامة البراهين والأدلة العقلية على نظريات تلزمه في حياته، وبين ما تحتاجه النفس من اتساع وخروج خارج الأطر والحدود المادية، بما يساعدها على سدّ بعض الثغرات التي تعتريها، وتسبب لها الاضطراب والقلق.
ونحن إذ نتطلع إلى الإمامة، فإنّنا ننظر في مفهومها وفي ماهيتها باعتبار الحاجة إلى معناها الذي تقوم عليه الدلائل، عندما يصار إلى المفارقات التي تنسجم واقعيتها معها، ورأت فيها أدواراً يؤديها هذا الكائن البشري أو ذاك، لما يتجلّى به من ميزة، أو فضيلة، أو مكرمة، أو ما شابه ذلك.
لذا فالمعرفة الإنسانية من جانب البعد التركيبي النفسي، ومن ميدان السبر والتحليل الذي ينطلق منهما مفتاح الدخول إلى أغوار النفس البشرية، وجدنا في هذا المكان مجالاً لقراءة الدافع أولاً نحو التدين، ثم الغاية التي تتلو آياتها مفردات السير نحو مدرج الكمال.
وهنا نستعير هذا المقتبس من صاحب تفسير الميزان، حيث يقول: "إنّ على الإنسان أن يتجرّد عن جميع معلوماته التي اكتسبها عن طريق التقليد"(2) يريد جلاء الفطرة وإظهار حقيقة النفس بدون شوائب، وهو إذا بلغ ذلك عن دراية وعلم، فإنّه يتحرّك سائراً نحو
____________
1ـ انظر: علي والفلسفة الإلهية، السيد محمد حسين الطباطبائي: 39، وما يليها.
2ـ المصدر نفسه مع بعض التصرّف.