إجراءات وضـوابـط مشبوهـة
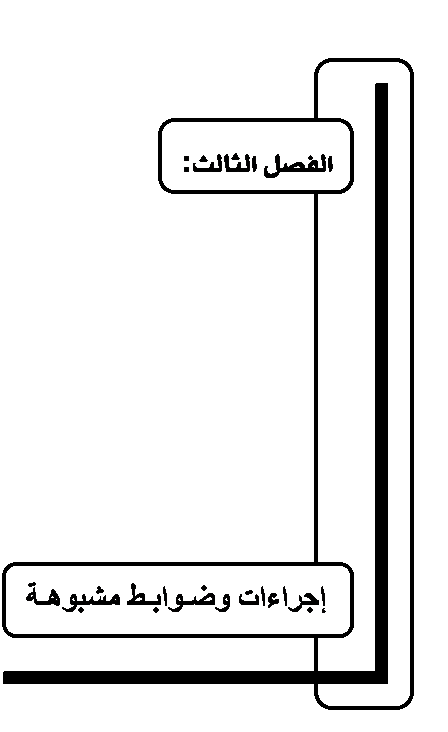
معايير لحفظ الإنحراف:
وبعد، فإن التصدي للفكر الإسرائيلي، وإن أفلح في
حفظ وصيانة الإسلام إلى حد بعيد، ولكن آثار هذا الحفظ إنما ظهرت،
أو فقل:
قد اقتصرت على التيار الذي كان يقوده الأئمة «عليهم
السلام» وشيعتهم، ومن تخرج من مدرستهم، واختار طريقتهم ونهجهم.
أما الآخرون؛ الذين كانوا في الخط الآخر، فقد
استمروا في التحرك في دائرة السياسة المعلنة، والمصرح بها من قبل
الحكام، فأخذوا عن أهل الكتاب الشيء الكثير مما هو محرف ومدسوس،
ونفذوا والتزموا بالإسلام الذي راق للحكام، وروجوا له.
فكان أن شحنوا كتبهم ومجاميعهم الحديثية بالشيء
الكثير من الفتاوى، والمعارف، والعقائد، والسياسات، والسير
والتواريخ، التي تنسجم مع ما يريده أولئك الحكام، مما أتحفهم به
أهل الكتاب، أو غيرهم من المرتزقة والمتزلفين.
نعم، لقد شحنوا بها كتبهم، ومجاميعهم، من دون أي
تحقيق، أو تمحيص، إلا فيما يمس القشر، ولا يتعرض لما دونه في شيء؛
لأنها قد جاءت محكومة لضوابط ومعايير من شأنها أن تكرس الإنحراف،
وتقوي من تياره، وتعمق جذوره، لأنها إنما وضعت لتأكيد تلك الأباطيل
والترهات ومن خلالها، ومن أجل حفظ الإنحراف وتكريسه لا لإزالته
والتخلص منه.
أما المعايير الحقيقية والضوابط الأصيلة، القادرة
على كشف الزيف، وإحقاق الحق، فقد كانت مرفوضة من هؤلاء الناس جملة
وتفصيلاً،
حتى إن ما ورد من الأمر بعرض الحديث على كتاب الله سبحانه قد رفض،
وضرب به عرض الجدار، بل قد اعتبروه من وضع الزنادقة، كما سيأتي في
الفصل التالي إن شاء الله تعالى.
ونحن من أجل جلاء الحقيقة، والتعريف بحقيقة
المؤامرة، نذكر هنا نماذج يسيرة من ضوابط تهدف لحفظ الإنحراف،
ومعايير لتكريس الباطل وترسيخه، بكل ما فيه من فتاوى باطلة،
وروايات مختلقة، أو محرفة، وأساطير وترهات عن أهل الكتاب وغيرهم.
بالإضافة إلى أساليب تبرير المواقف اللاإنسانية
واللاشرعية، التي صدرت وتصدر عمن يهمهم حفظهم، والاحتفاظ بهم بأي
ثمن كان،
والنماذج التي نريد تقديمها إلى القارئ الكريم هي التالية:
لقد كان الكثيرون من الصحابة، ممن تهتم السلطة وبعض
الفئات والإتجاهات
المذهبية والسياسية بإعطائهم دوراً
متميزاً
وأساسياً،
سواء على الصعيد السياسي، أو العقيدي، أو في مجال الحديث،
والرواية، أو الفتيا، أو على صعيد المواقف، تأييداً
وتأكيداً،
أو غير ذلك.
مع أن أولئك الأشخاص لا يملكون تاريخاً
نظيفاً
ولا مشرفاً،
لا في حياتهم السلوكية من حيث الالتزام بأحكام الدين، ولا في مجال
التحلي بمكارم الأخلاق، وحميد الخصال.
فكان أن عملوا من أجل تبرير انحرافاتهم ومخالفاتهم،
وتبرئتهم مما ارتكبوه من جرائم، وموبقات، حتى ما هو مثل الزنى،
وشرب الخمر، وقتل النفوس، وسرقة بيت مال المسلمين، وما إلى ذلك،
على اختراع إكسير يستطيع أن يحول تلك الجرائم والموبقات، والمعاصي،
إلى خيرات، وطاعات ومبرات، وحسنات، يستحقون عليها المثوبة، وينالون
بها رضا الله والجنة.
وكان هذا الأكسير هو دعوى:
أن الصحابة بساطهم مطوي، وإن جرى ما جرى، وإن غلطوا
كما غلط غيرهم من الثقات([1]).
و«الصحابة
كلهم عدول، سواء منهم من لابس الفتن، ومن لم يلابس»
وذلك بإجماع من يعتد به من الأمة([2]).
وعمدة مستندهم في ذلك آيات كريمة ورد فيها ثناء على
الصحابة في ظاهر الأمر، مع أن الثناء ناظر إلى بعض منهم، وهم خصوص
المتصفين بصفة الإيمان، مع مواصفات معينة أخرى أشارت إليها، أو
صرحت بها تلك الآيات بالذات.
وقد تحدثنا عن ذلك باختصار في
كتابنا:
>صراع
الحرية في عصر المفيد<،
فراجع.
أضف إلى ذلك:
أن تلك
الآيات لم تتناول الأفراد بالنصوصية، إنما غايتها عموم، يرد
التخصيص عليه بحسب الموارد،
مع أن دليل شمول الصحبة لمطلق من رأى النبي «صلى الله عليه وآله»
ركيك جداً([3]).
لا أدري إن كان قولهم بعدالة كل صحابي، يشبه القول
بعصمة الحاخامات لدى اليهود([4])،
أو أنه مستوحى منهم، أم لا؟.
وقد يكون من بين من يراد تبرير جرائمه وموبقاته، من
كان حين وفاة النبي «صلى الله عليه وآله» صغيراً جداً، أو لم ير
النبي «صلى الله عليه وآله» سوى مرة واحدة، في ساعة من نهار،
وبصورة عابرة، فجاءت المعالجة من قبل من يهمهم أمر هؤلاء؛ فقررت:
أن الصحابي هو كل من صحب النبي «صلى الله عليه وآله» سنة أو شهراً،
أو يوماً،
أو ساعة، أو رآه([5]).
وعدوا من الصحابة صبياناً
وأطفالاً
رأوا النبي «صلى الله عليه وآله» يوم الفتح، وفي حجة الوداع،
وغيرهما([6]).
وحين يجدون:
أن بعض من يعز عليهم من الصحابة يرتد عن الدين، ويحارب النبي «صلى
الله عليه وآله»، ثم يعود فيظهر الإسلام، كطليحة بن خويلد، وبعضهم
ارتد، وأهدر النبي «صلى الله عليه وآله» دمه، كما هو الحال بالنسبة
لعبد الله بن سعد بن أبي سرح.
وكذا الحال بالنسبة للأشعث بن قيس الذي ارتد عن
الإسلام، ثم لما أسر، وأظهر التوبة في عهد أبي بكر أطلقه الخليفة،
وزوجه أخته في نفس الساعة([7]).
إنهم حين يجدون ذلك، يبادرون إلى ادعاء:
أن الصحابي إذا ارتد ذهبت صحابيته، فإذا عاد إلى الإسلام عادت إليه
صحابيته، من دون حاجة إلى أن يرى النبي «صلى الله عليه وآله» من
جديد([8])،
أي وتعود إليه عدالته أيضاً!!
لقد كان ولا يزال الجهر بما فعله بعض الصحابة محرجاً،
بل مخجلاً
لمن يعتقدون لزوم موالاتهم، والارتباط بهم، ويوجب سلب ثقة الناس
بأناس يراد لهم أن يثقوا بهم، بل يراد لهم أن يقدسوهم.
ولو فرض أنه يمكن إسكات بعض العوام، بواسطة إطلاق
بعض الشعارات البراقة والرنانة، أو بواسطة بعض الفتاوى المختلقة،
أو بشيء من الترغيب أو الترهيب، فإن ذلك لا يتيسر بالنسبة لجميع
الناس، فلا بد من اعتماد أسلوب آخر للخروج من المأزق.
فقالوا عن الصحابة:
«الواجب علينا أن نكف عن ذكرهم إلا بخير»([9]).
وقالوا:
ينبغي للقاص
«أن
يترحم على الصحابة، ويأمر بالكف عما شجر بينهم، ويورد الأحاديث في
فضائلهم»([10]).
وقد أخذوا على أبي عمر بن عبد
البر:
أنه قد شان كتابه
«الاستيعاب»
بذكر ما شجر بين الصحابة([11]).
وحيث لم ينفع الأمر بالسكوت عما شجر بين الصحابة،
فقد لجأوا إلى أسلوب آخر للخروج من المأزق، وهو اتهام من ينتقد
الصحابة بالزندقة، والخروج من الدين، والإلحاد.
قال أبو زرعة:
«إذا
رأيت الرجل ينتقص أحداً
من أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فاعلم أنه زنديق، وذلك
أن الرسول «صلى الله عليه وآله» عندنا حق، والقرآن حق، وما جاء به
حق.
وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله
«صلى الله عليه وآله».
وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، ليبطلوا الكتاب
والسنة، والجرح بهم أولى. وهم زنادقة»([12]).
وقال السرخسي:
«من
طعن فيهم فهو ملحد، منابذ للإسلام، دواؤه السيف، إن لم يتب»([13]).
ومن الواضح:
أن حملة الإسلام وتعاليمه إلى الأمم ليسوا هم الوليد بن عقبة ولا
مروان بن الحكم، ولا ابن أبي سرح ونظراؤهم، وإنما هم علي «عليه
السلام» وأهل البيت «عليهم السلام» وأبو ذر وسلمان وابن مسعود،
وأبي بن كعب ونظراؤهم من أعلام الأمة وعلمائها. وما كلام أبي زرعة
وغيره هنا إلا مغالطة ظاهرة، لا تسمن ولا تغني من جوع.
أما بالنسبة إلى المعاصي التي ارتكبوها، ولا يمكن
دعوى التأويل والاجتهاد فيها، فقد جاء تبريرها بدعوى: أن الصحابي
لا يفسق بما يفسق به غيره([14]).
وإذا ارتكب الصحابي ما يوجب العقاب له أخروياً،
مما توعد الله عباده عليه بالعقاب بالنار، ولم يمكن دفع ذلك عنه،
لا بدعوى الاجتهاد، والتأويل، ولا بغير ذلك.
فإن علاج ذلك هو بالقول:
إن التوبة حتمية الوقوع ممن يعصي منهم([15]).
ولبعض الشخصيات مزيد من الأهمية، فلا يمكن تركها
تعصي الله ثم ننتظر إلى أن تصدر التوبة منها، وهي قد تتأخر بعض
الوقت.
بل لا بد من مغفرة ذنوب هؤلاء فوراً،
ففتشوا عن تاريخ هؤلاء الأشخاص، فوجدوا أنهم ممن حضر بدراً
ـ وإن لم يعلم عنه أنه قاتل ـ فجاءت المعالجة لتقدم معياراً
جديداً
يقول:
إن ما يقع من معاصٍ لا يحتاج إلى التوبة، إذا كان
مرتكب ذلك ممن شهد بدراً
لأن أهل بدر مغفور لهم([16]).
وكان لا بد من تبرير أخطاء وقع فيها بعض الصحابة،
سواء في مواقفهم، أو في فتاواهم، حتى حارب بعضهم بعضاً،
وأزهقت أرواح كثيرة، وسفكت دماء غزيرة، وخرج بعضهم على إمام زمانه،
وقاتلوه،
كما جرى في الجمل، وصفين، والنهروان،
فاخترعوا للصحابة مسألة الإجتهاد،
فكلهم مجتهدون([17])،
ولا اعتراض على المجتهد، بل هو إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ
كان له أجر واحد.
وبهذا أدخلوا معاوية، وطلحة والزبير الجنة، ومنحوهم
المزيد من الثواب على ما فعلوه وما ارتكبوه من جرائم في حق الإمام
والأمة. وأصبح من حلل منهم الربا، وشرب الخمر مأجوراً
ومثاباً،
بل إن خالد بن الوليد، الذي قتل مالك بن نويرة بدون جرم، ثم نزا
على زوجته في نفس الليلة مثاب ومأجور على ذلك أيضاً.
والخلاصة:
أن المصيب منهم له أجران، كعلي «عليه السلام» وأصحابه. والمخطئ
كمعاوية، ومن معه لهم أجر واحد، بل كان ما فعلوه بالاجتهاد، والعمل
به واجب، ولا تفسيق بواجب([18]).
وبتعبير آخر:
«إن
جميع من اشترك في الفتنة من الصحابة عدول، لأنهم اجتهدوا في ذلك»([19]).
وقال الكيا الطبري:
«وأما
ما وقع بينهم من الحروب والفتن، فتلك أمور مبنية على الاجتهاد، وكل
مجتهد مصيب، والمصيب واحد، والمخطئ معذور، بل مأجور»([20]).
والملفت للنظر هنا:
أننا نجد البعض لا تطاوعه نفسه على تخطئة الفئة
الباغية على إمام زمانها، فيقول: إن علياً «عليه السلام» وأصحابه
كانوا أقرب إلى الحق([21]).
وكأنه يريد أن يوحي للقارئ بأن معاوية قريب أيضاً
لكن علياً أقرب، كما أنه بتعبيره هذا يكون قد تجنب التصريح بكون
علي «عليه السلام» مع الحق، والحق معه.
ولا نستغرب على هؤلاء مثل هذا البغي والظلم، فإنما
هي شنشنة أعرفها من أخزم.
وقال المقبلي، ونعم ما قال:
«بعد
أن تم لهم تعريف الصحبة،
ذيلوها باطّراح ما وقع من مسمى الصحابي؛ فمنهم من يتستر بدعوى الإجتهاد،
دعوى تكذبها الضرورة في كثيرة (كذا) من المواضع، ومنهم من يطلق ـ
ويا عجباه من قلة الحياء ـ في ادعائهم الاجتهاد لبسر بن أرطأة،
الذي انفرد بأنواع الشر؛ لأنه مأمور المجتهد معاوية، ناصح الإسلام
في سب علي بن أبي طالب وحزبه. وكذلك مروان، والوليد الفاسق،
وكذلك الإجتهاد
الجامع للشروط في البيعة ليزيد، ومن أشار بها، وسعى فيها، أو رضيها»([22]).
وللعلامة أبي رية تعليقات هامة على كلام المقبلي
هذا، يذكر فيها أفاعيل بعض الصحابة مع رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، وأموراً أخرى، فراجع.
كما أن ابن خلدون قد انتقد دعوى اجتهاد جميع
الصحابة هذه؛ فقال:
«إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا، ولا كان
الدين يؤخذ عن جميعهم، وإنما كـان
ذلـك
مختصـاً
بالحـاملين
للقرآن، العـارفين
بنـاسخه
ومنسوخه الخ..»([23]).
وقال مالك بن أنس:
«سن
رسول الله «صلى الله عليه وآله» وولاة الأمر بعده سنناً،
الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله، وقوة على
دين الله،
من عمل بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل
المؤمنين، وولاه الله ما تولى»([24]).
وعن عمر بن الخطـاب، أنه قـال
لشريح، حين ولاه القضـاء:
«فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، فاقض بما استبان لك من أمر الأئمة المهتدين»([25]).
وقال الخطيب البغدادي، بالنسبة للأمور التي لم يسمع
من النبي «صلى الله عليه وآله» فيها شيء:
إن كانوا
قد قالوا رأياً واجتهاداً ولم يسمع من النبي
«صلى الله
عليه وآله»
فيه شيء فإجماع
الأئمة (الأمة خ ل) على التحليل والتحريم يثبت به
الحكم، كأمر النبي «صلى الله عليه وآله»([26]).
والمراد بالأئمة المهتدين حسب الظاهر هم الخلفاء
الثلاثة الأول، ما عدا علياً «عليه السلام»، كما سنرى.
قد ألمحنا سابقاً إلى قول
الخطيب:
إن كانوا قد قالوا رأياً
واجتهاداً..([27]).
وذكر المقريزي أيضاً:
أن أبا بكر كان يقضي بما كان عنده من الكتاب والسنة، فإن لم يكن
عنده شيء، سأل من بحضرته من الأصحاب، فإن لم يكن عندهم شيء اجتهد
في الحكم([28]).
وذكر بعض آخر:
أن الصحابة كانوا يغيبون عن مجلس النبي «صلى الله عليه وآله»،
فكانوا يجتهدون فيما لم يحضروه من الأحكام([29]).
ومهما يكن من أمر:
فقد ذهب الأكثرون إلى جواز الاجتهاد في عصر النبي «صلى الله عليه
وآله» ووقوعه،
وقد ذكروا في ذلك أقوالاً
كثيرة، وتفصيلات عديدة، فلتراجع في مظانها([30]).
وتجد من العلماء من يقول:
إن الصحابة
«كانوا
مخصوصين بجواز العمل والفتوى بالرأي كرامة لهم،
فيجوز لهم العمل بالرأي في موضع النص، وقد فعلوا ذلك في عهد رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، ولم ينكر «صلى الله عليه وآله» ذلك
عليهم،
وهذا من الأمور الخاصة بهم دون غيرهم»([31]).
وقد رأينا في أحيان كثيرة:
أن بعض الصحابة يصرحون بأن ما يفتون به ما هو إلا رأي رأوه، وقد
ظهر خطأ كثير منهم في فتاواه وآرائه هذه، ومخالفتها للنص القرآني،
ولما ثبت بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله «صلى الله عليه وآله».
فكان لا بد من علاج ذلك، وتلافي سلبياته، فجاءت
النظرية الغريبة عن روح الإسلام لتقرر: أن للصحابة حق التشريع، وأن
فتاواهم سنة، إلا ما أفتى به علي «عليه السلام».
ويتضح ذلك بمراجعة النصوص التالية:
قال أبو زهرة:
«وجدنا
مالكاً
يأخذ بفتواهم على أنها من السنة»([32]).
وقد رأينا أنهم يعقدون في كتب أصولهم باباً لكون
قول الصحابي فيما يمكن فيه الرأي ملحق بالنسبة لغير الصحابي
بالسنة.
وقيل:
«إن
ذلك خاص بقول الشيخين أبي بكر وعمر»([33]).
وخطب عثمان حينما بويع فقال:
إن لكم عليّ بعد كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه «صلى الله عليه وآله»
ثلاثاً:
«اتباع
من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم، وسن سنة أهل الخير فيما لم
تسنوا عن ملأ»([34]).
وقال البعض:
السنة هي:
«ما
سنه رسول الله «صلى الله عليه وآله» والصحابة بعده عندنا»([35]).
وأمثال ذلك كثير، فراجع كتب أصول الفقه، وكتابنا:
الحياة السياسية للإمام الحسن «عليه السلام» ص 86
ـ
90.
ونعود فنذكر بأن اليهود يقولون:
إن أقوال الحاخامات كالشريعة([36]).
قد تقدم:
أنهم يعقدون باباً
في كتب الأصول يذكرون فيه:
أن قول الصحابي فيما يمكن فيه الرأي ملحق بالسنة،
وقيل: إن ذلك خاص بقول الشيخين أبي بكر وعمر.
وقال عمر بن عبد العزيز:
«ألا
إن ما سنه أبو بكر وعمر، فهو دين نأخذ به، وندعو إليه».
وزاد المتقي الهندي:
«وما
سن سواهما فإنا نرجيه»([37]).
ورووا عن النبي «صلى الله عليه
وآله» قوله:
«عليكم
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»([38]).
وبهذا استدل الشافعي على حجية قول أبي بكر وعمر([39]).
مع أننا قد أشرنا إلى:
أن هذا الحديث ـ لو صح ـ فالمقصود بالخلفاء الراشدين هم الأئمة
الاثنا عشر «عليهم السلام»، الذين ذكرهم النبي «صلى الله عليه
وآله» مرات كثيرة، كما في صحاح مسلم والبخاري وأبي داود وغير ذلك([40]).
والمقصود بسنة الخلفاء هو ما تلقوه عن رسول الله،
واستفادوه من كتاب الله من أحكام وسنن وتشريعات.
وأما إخراج عثمان، فلعله لأجـل تسهيل إخراج علي،
ولعله لأجـل ظهور عوار سلوكه، حتى إن الرعية لم تتحمل سياساته،
فقتلته..
ويقول عثمان:
«إن
السنة سنة رسول الله وسنة صاحبيه»([41]).
وفي قضية الشورى يعرض عبد الرحمن بن عوف على أمير
المؤمنين علي «عليه السلام»: أن يبايعه على العمل بسنة النبي «صلى
الله عليه وآله»، وسنة الشيخين: أبي بكر وعمر؛ فأبى «عليه السلام»
ذلك، فحولت البيعة إلى عثمان([42]).
وقد بلغ من تأثير الشيخين على
الناس، ونفوذهما فيهم:
أننا نجد ربيعة بن شداد لا يرضى بأن يبايع علياً أمير المؤمنين
«عليه السلام» على كتاب الله وسنة رسوله.
وقال:
على سنة أبي بكر وعمر.
فقال له «عليه السلام»:
«ويلك،
لو أن أبا بكر وعمر عملا بغير كتاب الله وسنة رسوله لم يكونا على
شيء»([43]).
وهذا الكلام لا يعني أن الشيخين قد عملا بكتاب الله
وسنة رسوله بل معناه تعليم ذلك الجاهل ما ينبغي أن يكون بديهياً
عنده بغض النظر عن حقيقة سلوك الشيخين في هذا المجال..
ومهما يكن من أمر فقد قال ابن
تيمية:
«فأحمد بن حنبل وكثير من العلماء يتبعون علياً فيما
سنه، كما يتبعون عمر وعثمان فيما سناه، وآخرون من العلماء ـ كمالك
وغيره ـ لا يتبعون علياً فيما سنه. وكلهم متفقون على اتباع عمر
وعثمان فيما سناه»([44]).
ثم لما مست الحاجة إلى فتاوى وتبريرات أخرى اقتضتها
سياسات الحكام، وتصدى الحكام لسن بعض السنن، جاء المبرر الآخر
المنسوب إلى ابن عباس، ليكون أكثر قبولاً
لدى أهل العلم، وإن كنا لا نوافق على نسبته له، ليقول:
«السنة
سنتان: من نبي، أو من إمام عادل»([45]).
وحين زاد تدخل الحكام في شرع الله، وفي دينه، واتسع
نطاقه، وتعدى دائرة الخلفاء، وكان لا بد من تبرير ذلك أيضاً،
قالوا:
إنه بعد موت أبي بكر، وفتح سائر البلاد في عصر عمر،
وبعده، تزايد تفرق الصحابة في البلاد. فكان أمير كل بلد يجتهد، لو
لم يكن فيها صحابي([46]).
وكأنهم يريدون بصياغة الأمور على هذا النحو الإيحاء
بأن ذلك قد كان بسبب الضرورة، حيث لم يكن ثمة مخرج إلا ذلك،
مع أن المخرج موجود، بمرأى منهم ومسمع وهو الأخذ بقول النبي
«صلى الله
عليه وآله»
فيما
يرتبط بالتمسك بالعترة.
فإنهم سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق،
وهم أحد الثقلين، اللذين لن يضل من تمسك بهما.
قد عرفنا:
أن بعض الصحابة يصدرون فتاوى لم يستندوا فيها إلى آية ولا إلى
رواية، وإنما هو الرأي منهم، وهو قد يخطئ ويصيب،
وصار يناقض بعضهم بعضاً أحياناً،
بل قد نجد التناقض في آراء الصحابي الواحد.
يقول البعض:
إن الصحابة كانوا يغيبون عن مجلس النبي «صلى الله عليه وآله»،
فكانوا يجتهدون فيما لم يحضروه من الأحكام،
ولعدم تساوي هؤلاء المجتهدين في العلوم والإدراكات، وسائر القوى
والملكات، تختلف ـ طبعاً
ـ الآراء والإجتهادات،
ثم تزايدت تلك الإختلافات،
بعد عصر الصحابة([47]).
فكان لا بد من علاج هذه الحالة، وتلافي سلبياتها،
فكان أن اخترعوا لنا دعوى:
«أن
قول الصحابي إن كان صادراً
عن الرأي؛ فرأيهم أقوى من رأي غيرهم؛ لأنهم شاهدوا طريق رسول الله
«صلى الله عليه وآله» في بيان أحكام الحوادث، وشاهدوا الأحوال التي
نزلت فيها النصوص، والمحال التي تتغير باعتبارها الأحكام..»([48])
ثم قرروا على هذا الأساس لزوم تقديم رأيهم على رأينا، لزيادة قوة
في رأيهم.
وإذا خالفت فتوى الصحابي قولاً صريحاً، وحديثاً
صحيحاً عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فان مالك بن أنس
يعاملهما معاملة المتعارضين.
قال أبو زهرة:
«إن
مالكاً
يوازن بينها وبين الأخبار المروية، إن تعارض الخبر مع فتوى صحابي.
وهذا ينسحب على كل حديث عنه «صلى الله عليه وآله»،
حتى لو كان صحيحاً»([49]).
ونقل عن الشوكاني ما يقرب من ذلك أيضاً([50]).
وقال الأسنوي عن قول الصحابي:
«فهل
يخص به عموم كتاب أو سنة؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي، حكاه الماوردي».
و
«قال
في جمع الجوامع: وفي تخصيصه للعموم قولان.
قال الجلال:
الجواز كغيره من الحجج. والمنع الخ..»([51]).
وقال ابن قيم الجوزية عن أحمد
بن حنبل:
«وكان تحريه لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه، بل أعظم،
حتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل» برجال ثبت([52]).
وقال التهانوي:
«لا
لوم على الحنفية إذا أخذوا في مسألة بقول ابن مسعود وفتواه، وتركوا
الحديث المرفوع؛ لاعترافكم بأن فتوى الصحابي هو الحكم وهو الحجة،
وإذا تعارض الحديثان يعمل بالترجيح؛ فإن رجح القياس أو مرجح آخر
سواه قول الصحابي على الخبر المرفوع، فينبغي أن يجوز عندكم الأخذ
بقول الصحابي».
ولكنه عاد فقال:
«إن غالب أقوال الصحابة وفتاواهم كان على سبيل التبليغ عن قول
النبي «صلى الله عليه وآله»، أو فعله أو أمره، وإذا كان كذلك فيجوز
للمجتهد أن يرجح فتوى الصحابي على المرفوع الصريح أحياناً، إذا
ترجح عنده كون فتوى الصحابي مبنية على جهة التبليغ دون الرأي»([53]).
ولكن مراجعة فتاوى الصحابة توضح
عدم صحة قوله:
إنها كانت على سبيل التبليغ، لكنه أراد تخفيف قبح هذا العمل.
قال التهانوي:
«عمل
الصحابة أو صحابي بخلاف الحديث يوجب الطعن فيه، إذا كان الحديث
ظاهراً
عليهم أو عليه»([54]).
وقال السرخسي:
«أما
ترك العمل بالحديث أصلاً،
فهو بمنزلة العمل بخلاف الحديث، حتى يخرج به عن أن يكون حجة»([55]).
كثيراً ما نجد أنهم قد نسبوا إلى بعض الصحابة أموراً
يُدَّعى
أنهم شهدوها، أو سمعوها من النبي «صلى الله عليه وآله» أو من غيره،
تهدف إلى تأييد اتجاه سياسي، أو مذهبي معين، ثم يظهر البحث العلمي
أن أولئك الصحابة ما كانوا قد ولدوا في تلك الفترة، أو ما كانوا
موجودين في بلد الحدث، أو حين صدور ذلك القول أو الفعل،
فتأتي قاعدة جديدة لتحل المشكل، وتحسم الأمر لصالح ذلك الاتجاه
السياسي أو المذهبي.
حيث تقرر كما ذكره جماعة:
أن مرسلات الصحابة حجة.
ثم يحاولون تبرير هذه القاعدة بدعاوى لا تثبت أمام
النقد العلمي الصحيح فيقولون:
لأن الظاهر:
أن ذلك الصحابي قد سمع ذلك من النبي «صلى الله عليه وآله»، أو من
صحابي آخر سمعه من النبي «صلى الله عليه وآله»، بل لقد قبل بعضهم
مراسيل التابعين، وتابعي التابعين أيضاً([56]).
وكان أحمد بن حنبل يقدم الموقوف عن الصحابة
والتابعين على المرسلات عن النبي «صلى الله عليه وآله»([57]).
قد يقال: إن الاجتهاد معناه:
أن المجتهدين قد يصيبون في اجتهادهم، وقد يخطئون؛
فلا بد لنا نحن من معرفة الصواب من الخطأ في ذلك. فإن الاجتهاد إذا
كان عذراً
لهم إذا أخطأوا فليس عذراً
لنا في متابعتهم على الخطأ، ولاسيما بعد ظهوره لنا.
فجاء العلاج ليقول:
أما بالنسبة لفتاواهم في الأحكام، فإنهم مصيبون جميعاً في
اجتهادهم؛ فقد قال الشهاب الهيثمي في شرح الهمزية على قول البوصيري
عن الصحابة:
«كلهم
في أحكامه ذو اجتهاد ـ أي صواب ـ وكلهم أكفاء»([58]).
وأما بالنسبة لما جرى بين الصحابة من الفتن، فهو
أيضاً اجتهاد منهم؛ وقد يقال بصواب هذا الاجتهاد من الجميع أيضاً،
فقد قال الآمدي:
«وعلى هذا، فإما أن يكون كل مجتهد مصيباً،
أو أن المصيب واحد، والآخر مخطئ في اجتهاده، وعلى كلا التقديرين،
فالشهادة والرواية من الفريقين لا تكون مردودة،
أما بتقدير الإصابة فظاهر، وأما بتقدير الخطأ مع الاجتهاد
فبالإجماع»([59]).
وعن العنبري في أشهر الروايتين
عنه:
«
إنما أصوب كل مجتهد في الذين يجمعهم الله. وأما الكفرة فلا يصوبون»([60]).
وقال الشوكاني:
«ذهب جمع جم إلى أن كل قول من أقوال المجتهدين فيها
(أي في المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها) حق وأن كل واحد منهم
مصيب، وحكاه الماوردي والروياني عن الأكثرين.
قال الماوردي:
وهو قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلة».
إلى أن قال:
«وقال جماعة منهم أبو يوسف:
إن كل مجتهد مصيب، وإن كان الحق مع واحد،
وقد حكى بعض أصحاب الشافعي عن الشافعي مثله».
إلى أن قال:
«فمن قال: كل مجتهد مصيب، وجعل الحق متعدداً
بتعدد المجتهدين فقد أخطأ»([61]).
وقال حول حجية الإجماع:
«فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حقاً،
ولا يلزم من كون الشيء حقاً
وجوب اتباعه؛ كما قالوا: إن كل مجتهد مصيب، ولا يجب على مجتهد آخر
اتباعه في ذلك الاجتهاد بخصوصه»([62]).
وقال الأسنوي حول الاجتهاد وفي الواقعة التي لا نص
عليها: فيها قولان:
«أحدهما: أنه ليس لله تعالى فيها قبل الاجتهاد حكم
معين بل حكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهد.
وهؤلاء هم القائلـون
بـأن
كل مجتهد مصيب، وهم الأشعري، والقاضي، وجمهور المتكلمين من
الأشاعرة والمعتزلة الخ»([63]).
ونقل عن الأئمة الأربعة، ومنهم الشافعي، التخطئة
والتصويب فراجع([64]).
لقد أظهرت الروايات التي زعموها تاريخاً
لرسول الله «صلى الله عليه وآله»: أن النبي «صلى الله عليه وآله»
يجتهد ويخطئ في اجتهاده. ويجتهد عمر فيصيب، فتنزل الآيات لتصوِّب
رأي عمر وتخطِّئ
النبي «صلى الله عليه وآله» كما زعموه في وقعة بدر الكبرى، في قضية
فداء الأسرى([65])
وآية الحجاب وغيرها.
ولأجل ذلك تجدهم يقرون بأن النبي «صلى الله عليه
وآله» يخطئ في اجتهاده، ولكن لا يقرر على الخطأ([66]).
ولكن قولهم:
إنه «صلى الله عليه وآله» لا يقرر على خطئه لا يتلاءم مع ما يروونه
عنه «صلى الله عليه وآله» من أخطاء في اجتهاده، مع عدم صدور رادع
عنه، كما هو الحال في قصة تأبير النخل، حيث لم يرد ما يرفع خطأه،
ووقع الناس نتيجة لذلك في الخسارة والفشل([67])
فراجع.
وأما بالنسبة لسهو النبي «صلى الله عليه وآله»
ونسيانه، واعترافه هو بذلك([68])،
فذلك حدِّث
عنه ولا حرج.
وستأتي قصة ذي الشمالين، وسهو النبي «صلى الله عليه
وآله» في صلاته، بعد غزوة بدر إن شاء الله تعالى. فإذا جاز على
النبي «صلى الله عليه وآله» ذلك، فإن أهدافاً
كثيرة يمكن تحقيقها عن هذا الطريق، ويمكن تصحيح روايات عديدة تخدم
هوى سياسياً
أو مذهبياً
بعينه.
وإذا كان الرسول «صلى الله عليه وآله» يخطئ في
اجتهاده، فإن الأمة معصومة عن الخطأ، بل سيأتي حين الحديث حول صحة
ما في البخاري ومسلم:
أن ظن الأمة لا يخطئ أيضاً،
أي أنه إذا حصل إجماع بعد الخلاف؛ فإن ذلك يلغي أي تشكيك بصحة ما
أجمعوا عليه، بل لا بد من الحكم بصحته وصوابه، لأن الأمة معصومة([69]).
وقد واجه القائلون بعصمة الأمة فكرة أن تكون الأمة
أعلى رتبة من النبي «صلى الله عليه وآله»، فكيف وجب عليها طاعته
واتباعه؟! فأزعجهم ذلك، وحاولوا التخلص منها، فما أفلحوا في ذلك
فراجع([70]).
وقد يحتاج الحاكم أحياناً
من أجل تثبيت سلطانه، وإحكام قبضته على مقدرات الشعوب إلى التصرف
في بعض الشؤون العقائدية، أو الفقهية الثابتة، أو المفاهيم
الدينية، فيواجه اعتراضاً
من علماء الأمة، وأهل الفضل والدين.
فلا بد إذن من إيجاد تبرير لما يقدم عليه من تصرف،
ومن تغيير في الدين وأحكامه، ورسومه وأعلامه؛ فجاءت القاعدة لتقول:
إنه إذا حصل ذلك، واستطاع أن يحصل على موافقة الناس في عصره،
وإجماعهم، فإن هذا الإجماع يصبح تشريعاً
إلهياً،
ولا مجال لنقضه، ولا لمعارضته، والاعتراض عليه، إلا بتحصيل إجماع
مثله وذلك لأن الإجماع نبوة بعد نبوة([71]).
وهو حجة قاطعة للعذر، متى انعقد، وفي أي عصر كان([72]).
وكنموذج من ذلك نشير إلى:
أن هذا ما حدث بالفعل بالنسبة إلى الخلافة
الإسلامية، فقد كان ثمة إجماع على اشتراط القرشية في خليفة
المسلمين، حتى جاء السلطان سليم إلى مصر، وخلع الخليفة القرشي،
وتسمى هو بالخليفة، وألغى عملياً
هذا الشرط، ثم أجمعت الأمة على إلغائه ولا تزال،
وأصبح عدم القرشية من الدين، كما كانت القرشية من الدين في السابق.
وبعد، فإنه إذا كانت الأمة معصومة، وكان أفراد
الصحابة مصيبين في اجتهاداتهم كلها ولا يخطئون،
فإن ضابطة أخرى لا بد من مراعاتها، لأنها تنفع في حل مشكلات كثيرة
تواجههم.
وهي قاعدة:
ظن المعصوم عن الخطأ، لا يخطئ([73]).
وسيأتي استدلالهم بهذه القاعدة في مورد حساس في هذا
البحث بالذات.
وحين ظهر أن كثيراً من اجتهادات أئمة المذاهب تخالف
النص الوارد عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقد أجازوا مخالفة
نص رسول الله «صلى الله عليه وآله»، والالتزام بآراء أئمة مذاهبهم.
فقد قال البعض، وهو يتحدث عن الشافعية:
والعجب منهم من يستجيز مخالفة الشافعي لنص له آخر
في مسألة بخلافه،
ثم لا يرون مخالفته لأجل نص رسول الله «صلى الله عليه وآله»([74]).
ونقول:
إن ملاحظة طريقتهم في التعامل مع الحديث، ومع فتاوى أئمتهم تعطينا:
أن ذلك لا ينحصر بالشافعي وأصحابه، بل هو ينسحب على
غيرهم من أتباع المذاهب الأخرى الأربعة، وغيرها أيضاً.
وقد أحصى ابن القيم في أعلام الموقعين حوالي مئة
حديث لم يأخذ بها مقلدة الفقهاء،
حسبما يتضح من مراجعة الأحاديث المبثوثة في الكتب المعتبرة لدى أهل
السنة.
وذكر سبط ابن الجوزي جملة من أحاديث الصحيحين لا
يأخذ بها الشافعية، لما ترجح عندهم مما يخالفها،
ورد أبو حنيفة على رسول الله أربع مئة حديث أو أكثر.
وفي رواية:
وردّ مئتي حديث.
بل قال حماد بن سلمة:
إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن فردها برأيه([75]).
ثم ومن أجل سد النقص الناتج عن ابتعاد الناس عن
حديث رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
وابتعادهم عن أئمة أهل البيت
«عليهم السلام»،
فقد قرروا إجازة العمل بالقياس، والرأي، والاستحسان، وما إلى ذلك.
وقد كتب الخليفة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري:
«فاعرف الأشباه والأمثال، ثم قس الأمور بعضها ببعض،
أقربها إلى الله، وأشبهها بالحق، فاتبعه، واعمد إليه»([76]).
وقال لشريح:
«فإن لم تعلم كل ما قضت به الأئمة المهتدون، فاجتهد رأيك».
أو قال:
«ولم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك»([77]).
وقد عمل بالرأي كل من أبي بكر،
([78])
وابن مسعود، وعثمان، وعمر([79])
وغيرهم من الصحابة، فراجع.
وقد كان من نتيجة ذلك أن:
«استحالت الشريعة وصار أصحاب القياس أصحاب شريعة جديدة»
على حد تعبير ابن أبي الحديد المعتزلي([80]).
وقد أعلن الأئمة «عليهم السلام» رفضهم لهذا النهج،
وأدانوه بشدة وإصرار، ورفضه غيرهم أيضاً.
وقد قال الشعبي في إشارة إلى رفض العمل بالرأي:
ما حدثوك عن أصحاب محمد «صلى الله عليه وآله» فخذ
به، وما قالوا برأيهم، فبل عليه([81]).
وقال ابن شبرمة:
دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد بن علي، فقال له جعفر:
«اتق الله، ولا تقس الدين برأيك، فإنا نقف غداً نحن
وأنت، ومن خلفنا بين يدي الله تعالى، فنقول: قال الله، قال رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، وتقول أنت وأصحابك:
سمعنا ورأينا، فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء([82]).
وقد أراد العاملون بالقياس إضفاء هالة من القدسية
على آرائهم، وتكريسها كمعيار عملي، ونهج فكري، ثابت ومقبول، فسمحوا
بنسبة ما دل عليه القياس إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وإن
لم يكن النبي «صلى الله عليه وآله» قد قاله.
يقول البعض:
«استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل
عليه القياس الجلي إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» نسبة قولية.
فيقولون في ذلك:
قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: كذا..
ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها
موضوعة؛ لأنها تشبه فتاوى الفقهاء، و لأنهم لا يقيمون لها سنداً»([83]).
ومن أجل تكريس المذاهب الأربعة، ولكي لا يفكر أحد
بالتعدي عنها، وتكون هي المعيار والضابطة دون سواها؛ فقد قرروا:
أنه لا يحق لأحد أن يجتهد في هذه العصور المتأخرة
إلا في حدود المذهب الذي ينتسب إليه، أو في دائرة خصوص مذاهب
الأئمة الأربعة، ووفق أصول محددة لا مجال للتعدي عنها.
ذكر ابن الصلاح:
«أنه
يتعين تقليد الأئمة الأربعة دون غيرهم؛ لأن مذاهب الأربعة قد
انتشرت، وعلم تقييد مطلقها، وتخصيص عامها، ونشرت فروعها؛ بخلاف
مذهب غيرهم»([84]).
وقال الشيخ محمد نجيب المطيعي:
«قد بنى ابن الصلاح على ما قاله إمام الحرمين قوله
بوجوب تقليد واحد من الأئمة الأربعة دون غيرهم..
إلى أن قال:
بل الحق: أنه إنما منع من تقليد غيرهم، لأنه لم تبق
رواية مذاهبهم محفوظة..
إلى أن قال:
امتنع تقليد غير هؤلاء الأئمة الأربعة من الصحابة وغيرهم، لتعذر
نقل حقيقة مذاهبهم، وعدم ثبوته حق الثبوت»([85]).
ونقل محمد فريد وجدي عن بعضهم:
أنه بعد الماءتين كان الواجب على كل من المقلدين
والمجتهدين المنتسبين أن ينتموا لمذهب واحد معين من المجتهدين
المستقلين.
وأما من نشأ من المسلمين بعد المئة الرابعة إلى زمن
صاحب كتاب (الإنصاف في بيان سبب الاختلاف)، فهم إما عامي أو مجتهد
منتسب، فيجب على العامي تقليد المجتهد المنتسب لا غير، لامتناع
وجود المستقل من هذا التاريخ حتى اليوم([86]).
قال التهانوي الحنفي:
«ومن
ترك هذا التقليد، وأنكر اتباع السلف، وجعل نفسه مجتهداً
أو محدثاً،
واستشعر من نفسه أنه يصلح لاستنباط الأحكام، وأجوبة المسائل من
القرآن والحديث في هذا الزمان، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، أو
كاد أن يخلع، فأيم الله لم نر طائفة يمرقون من الدين مروق السهم من
الرمية إلا هذه الطائفة المنكرة لتقليد السلف، الذامة لأهلها الخ..»([87]).
وقال المقريزي:
«ولي
بمصر القاهرة أربعة قضاة، وهم شافعي، ومالكي، وحنفي، وحنبلي؛
فاستمر ذلك من سنة خمس وستين وست مئة، حتى لم يبق في مجموع أمصار
الإسلام مذهب يعرف من مذاهب أهل الإسلام سوى هذه المذاهب الأربعة،
وعقيدة الأشعري،
وعملت لأهلها المدارس، والخوانك، والزوايا، والربط في سائر ممالك
الإسلام،
وعودي من تمذهب بغيرها، وأنكر عليه، ولم يول قاضٍ، ولا قبلت شهادة
أحد، ولا قدم للخطابة والإمامة والتدريس أحد ما لم يكن مقلداً
لأحد هذه المذاهب،
وأفتى فقهاء هذه الأمصار في طول هذه المدة بوجوب اتباع هذه
المذاهب، وتحريم ما عداها، والعمل على هذا إلى اليوم»([88]).
وقد ذكر ابن الفوطي ما يدل على أن رسم التمذهب
بالمذاهب الأربعة في بغداد، والمنع من ذكر آراء غيرهم قد كان قبل
هذا التاريخ بحوالي عشرين سنة أو أكثر،
فراجع كلامه حول افتتاح المدرسة المستنصرية، ثم رسم تعليم المذاهب
الأربعة فيها، والمنع مما عداها([89]).
وقد كان ابن الصلاح المتوفى سنة 643 ه. قد أفتى
بحرمة الخروج على تقليد الأئمة الأربعة، مستدلاً
له بإجماع المحققين([90]).
ونقل البعض:
أن
العباسيين في بغداد طلبوا من أهل المذاهب أموالاً،
فلم يستطع الشيعة تأمين المال المطلوب،
لكن الحنفية، والمالكية، والحنبلية، والشافعية قد دفعوا المال
المطلوب لأجل اتساع حالهم، وتيسر المال لديهم،
وكان ذلك في زمن الشريف المرتضى المتوفى سنة 436 ه. فآل ذلك إلى
تكريس المذاهب في الأربعة، واتفقوا على بطلان ما عداها،
وجوزوا الاجتهاد في المذهب، ولم يجوزوا الاجتهاد عن المذهب([91]).
وقد فصل ابن قيم الجوزية أقوال القائلين بانسداد
باب الاجتهاد، وزمان ذلك الانسداد، وقولهم: لا يجوز الاختيار بعد
الماءتين، وناقش تلك الأقوال، فراجع([92]).
وقد لاحظنا:
أنهم، وهم يحكمون على من مارس الاجتهاد، ولم يقلد من يحبون، أو من
استشعر من نفسه أنه يصلح لاستنباط الأحكام، بالمروق من الدين، وخلع
ربقة الإسلام من عنقه، حسبما تقدم عن التهانوي،
قد مهدوا لسد باب الاجتهاد، ولكن بذكاء حينما ناقشوا أولاً مسألة
خلو العصر من المجتهد،
فلما جوزوه، انتقلوا إلى القول بأن الخلق كالمتفقين على أنه لا
مجتهد اليوم.
فقد
«حكى
الزركشي في البحر عن الأكثرين: أنه يجوز خلو العصر من المجتهد،
وبه جزم صاحب المحصول.
قال الرافعي:
الخلق كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليوم.
قال الزركشي:
ولعله أخذه من كلام الإمام الرازي، أو من قول الغزالي في الوسيط:
قد خلا العصر من المجتهد المستقل»([93]).
وقد ناقشهم الشوكاني، وأبطل هذا الزعم منهم، فراجع
كلامه([94]).
ويقول نص آخر:
«قد
استدل بما صرح به الإمام حجة الإسلام قدس سره، والرافعي، والقفال
بأنه وقع في زماننا هذا الخلو»
(أي من المجتهد).
إلى أن قال:
«من
الناس من حكم بوجوب الخلو من بعد العلامة النسفي، واختتم الاجتهاد
به. وعنوا الاجتهاد في المذهب».
أما الاجتهاد المطلق، فقالوا:
«اختتم
بالأئمة الأربعة، حتى أوجبوا تقليد واحد من هؤلاء على الأمة»([95]).
ومهما يكن من أمر، فإن سد باب الاجتهاد إنما هو لدى
فريق معين غير الشيعة، أما شيعة الأئمة الاثني عشر «عليهم السلام»،
وأتباعهم، فهم في غنى عن كل هذا، فهم يفتحون باب الاجتهاد على
مصراعيه، ويمارسونه بصورة مطردة على مر التاريخ، وإلى يومنا هذا،
وهذه نعمة كبرى، هي نعمة العلم والفهم حباهم الله بها، وحرم
الآخرون أنفسهم منها، وقديماً
قيل: على نفسها جنت براقش.
أما محمد فريد وجدي فقد اعتبر:
أن السبب في دعوى انسداد باب الاجتهاد، هو ما طرأ على المسلمين من
جمود اجتماعي، وقصور عن فهم أسرار الشريعة، فستروا ذلك بالدعوى
المذكورة،
والحقيقة أنه مفتوح بنص الكتاب والسنة إلى يوم القيامة.
([96])
لكن ملاحظتنا التي نريد تسجيلها هنا هي:
أولاً:
لماذا قصرت أفهام المسلمين عن فهم أسرار الشريعة؟!
وهل دعوى هذا القصور صحيحة من أساسها؟!
ثانياً:
ما فائدة فتح باب الاجتهاد، مع وجود ذلك القصور عن الفهم؟!
وماذا يفيد فتح باب لا يجرؤ أحد على الولوج فيه، أو
لا يستطيع الولوج أصلاً؟!.
وقد كنا نحب أن نعرف:
إن كان ثمة ارتباط بين ما يقال عن سد باب الإجتهاد
لدى هؤلاء، وبين ما يقوله الفريسيون من اليهود، من أنه لا اجتهاد([97]).
أما بالنسبة لما تناقلوه على أنه حديث رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، فقد حاولوا إضفاء هالة من التقديس الأعمى
عليه، وكأنه نفس كلامه الصادر عنه «صلى الله عليه وآله» مع أن
أكثره محض اختلاق، وتزوير.
وقد قدست كتب بأكملها على هذا الأساس،
فراجع ما يذكرونه عن صحيح البخاري، وموطأ مالك، وسنن أبي داود،
وغير ذلك.
بل لقد حرصوا على المنع من مناقشة الحديث، حتى ولو
خالف العقل، والوجدان، وضرورة العقل، والتاريخ القطعي؛ لأن السماح
بالمناقشة فيه لسوف يبرر المناقشة ثم التشكيك في أمور هي أكثر
أهمية وحساسية بالنسبة إليهم.
وقد تصدى الحكام لمواجهة ذلك بصورة قوية وصارمة
وحازمة، لاسيما وأن ذلك قد مكنهم من توجيه الناس حيثما يريدون،
وكيفما يشاؤون، من خلال حفنة من وعاظ السلاطين، لا يتورعون عن
الإختلاق والإفتراء، حتى على الله ورسوله، دونما مانع من دين، أو
رادع من وجدان.
وقد روى بعض هؤلاء المرتزقة عن النبي «صلى الله
عليه وآله» محاجة جرت بين آدم وموسى «عليهما السلام»؛ فحج آدم
موسى!! فاعترض البعض بأنه: متى اجتمع آدم وموسى؟ فتدخل الخليفة
ودعا بالنطع والسيف ليقتل ذلك المعترض المستفهم، بحجة أنه زنديق
يكذب بحديث رسول الله «صلى الله عليه وآله»!!([98]).
بل لقد كان الاتهام بالزندقة هو الوسيلة الميسورة
للتخلص حتى ممن لا يرى الصلاة خلف الخليفة العاتي والمتجبر([99]).
وقد يعترض البعض:
بأن في البخاري، ومسلم، وغيرهما من كتب الصحاح أحاديث كثيرة تضمنت
ما يخالف الحقائق الثابتة، وصريح العقل والوجدان.
فجاء الرد:
أن البخاري أجلّ كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله([100]).
وما قرئ في كربة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب
فغرقت. ويستسقى بقراءته الغمام، وأجمع على قبوله، وصحة ما فيه أهل
الإسلام([101]).
وقال أبو نصر السجزى:
«أجمع
أهل العلم والفقهاء، وغيرهم على أن رجلاً
لو حلف بالطلاق: أن جميع ما في كتاب البخاري، مما روي عن النبي
«صلى الله عليه وآله» قد صح عنه، ورسول الله «صلى الله عليه وآله»
قاله، لا شك فيه، لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته»([102]).
وقالوا:
أصح كتب بعد كتاب الله الصحيحان: البخاري،
ومسلم([103]).
بل قال البعض:
«اتفق
علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله أصح من صحيحي
البخاري ومسلم»([104]).
وعن سنن أبي داود يقول ابن
الأعرابي:
«لو
أن رجلاً
لم يكن معه من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله، ثم هذا الكتاب
لم يحتج معهما إلى شيء من العلم بتة»([105]).
ولعلك تقول:
إجماع الأمة على صحة ما في الصحيحين لا يمنع من كون بعض ما فيهما
خطأ،
لأن
حجية الخبر وإن كانت قطعية، ولكن ذلك لا يمنع من كون مضمونه
مظنوناً،
لكنه من الظن الذي هو حجة،
والظن الحجة قد يخطئ الواقع أيضاً.
فيأتيك الرد:
«ظن
المعصوم عن الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة عن الخطأ»([106]).
وحول تلقي الأمة للصحيحين
بالقبول قال ابن كثير:
«لأن
الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته، ووجب عليها العمل به، لا بد
أن يكون صحيحاً في نفس الأمر،
وهذا جيد»([107]).
وتسجل إدانة لكتب الصحاح خصوصاً
البخاري ومسلم، وهي روايتهم عن الخوارج، والمبتدعة،
حتى إن البخاري ومسلماً،
وسائر أصحاب الصحاح قد رووا عن الخوارج والمبتدعة، مثل عمران بن
حطان، وهو من أكبر الدعاة إلى البدعة([108])،
فإنه مادح ابن ملجم على قتله وصي النبي «صلى الله عليه وآله» علياً
«عليه السلام».
ورووا عن كثيرين آخرين من مبغضي علي «عليه السلام»
وشانئيه، مثل:
بهز بن أسد، وعبد الله بن سالم، وحصين بن نمير،
وعكرمة، وقيس بن أبي حازم، والوليد بن كثير، وعروة بن الزبير،
وإسحاق بن سويد، وحريز بن عثمان، وأزهر بن عبيد الله، وزياد بن
أبيه، وميمون بن مهران، وأسد بن وداعة، ومحمد بن هارون، ونعيم بن
أبي هند، ودحيم، وعبد المغيث الحنبلي، وخالد بن مسلمة([109])
وعلي بن الجهم([110])،
ومحمد بن زياد، وعبد الله بن شقيق، والمغيرة بن عبد الله([111])،
وعشرات غيرهم.
وكل هؤلاء، ومن هو على شاكلتهم، قد حكموا لهم
بالوثاقة، ورووا عنهم، وعظموهم، ووصفوهم بكل جميل، مع معروفيتهم
بالنصب والبغض لعلي «عليه السلام»، وآله الأطهار([112]).
ومن جهة ثانية، فقد روى أصحاب الصحاح أيضاً لبعض
الشيعة والرافضة([113])
وقد ذكر الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه طائفة كبيرة
من الشيعة، أو المتهمين بالتشيع، ممن روى لهم أصحاب الصحاح، فراجع.
فروايتهم عن النواصب والخوارج، والمبتدعة، وعن
الشيعة، والرافضة، تتناقض مع قولهم: إن الرواية عن كل هؤلاء لا
تصح.
فهم يقولون:
عن ابن لهيعة:
أنه سمع شيخاً
من الخوارج يقول بعد توبته:
«إن
هذه الأحاديث دين؛ فانظروا عمن تأخذون دينكم؛ فإنا كنا إذا هوينا
أمراً
صيرناه حديثاً»([114]).
أو قال:
«انظروا
هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنَّا
كنا إذا تراءينا رأياً،
جعلنا له حديثاً»([115]).
ويلاحظ هنا:
أن نفس هذا النص مروي عن حماد بن سلمة، ولكن عن شيخ من الرافضة!!
([116]).
ولما حدث إياس بن معاوية الأعمش بحديث عن بعض
الحرورية، قال:
«تريد
أن أكنس الطريق بثوبي، فلا أدع بعرة، ولا خنفساء إلا حملتها؟!»([117]).
وقال الجوزجاني عن الخوارج، الذين تحركوا في الصدر
الأول، بعد الرسول «صلى الله عليه وآله»:
«نبذ
الناس حديثهم اتهاماً لهم»([118]).
قد وردت أحاديث رواها أهل السنة أيضاً تنهى عن
الرواية عن أهل البدع([119])
فلتراجع في مظانها.
إن أدنى مراجعة لكتب الرجال على
مذاق أهل السنة تظهر:
أن أكثر المجروحين عندهم إنما جرحوهم بالتشيع أو الرفض، وقد
اعتبروا ذلك جريمة لا مجال للسكوت عليها، أو التساهل فيها([120]).
وسئل مالك عن الرافضة، فقال:
لا تكلمهم، ولا ترو عنهم، فإنهم يكذبون([121]).
وعن الشافعي:
لم أر أحداً من أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة([122]).
وقال أبو عصمة لأبي حنيفة:
«ممن
تأمرني أن أسمع الآثار؟! قال: من كل عدل في هواه إلا الشيعة، فإن
أصل عقيدتهم تضليل أصحاب محمد «صلى الله عليه وآله»، ومن أتى
السلطان طائعاً الخ..»([123]).
وعن شريك:
إحمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث،
ويتخذونه دينا([124]).
وقال التهانوي:
«نحن
نعلم: أنهم كذبوا في كثير مما يروونه في فضائل أبي بكر، وعمر،
وعثمان.
كما كذبوا في كثير مما يروونه في فضائل علي. وليس
في أهل الأهواء أكثر كذباً
من الرافضة»([125]).
ويقول هارون الرشيد:
«طلبت أربعة فوجدتها في أربعة: طلبت الكفر فوجدته في الجهمية،
وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة، وطلبت الكـذب
فوجدته عنـد
الرافضة، وطلبت الحق فوجدته مـع
أصحاب الحديث»([126]).
وعن يزيد بن هارون:
يكتب عن كل صاحب بدعة، إذا لم يكن داعية إلا الرافضة، فإنهم يكذبون([127]).
كانت تلك بعض أقاويلهم حول هؤلاء وأولئك، وهي تناقض
موقفهم منهم، وروايتهم عنهم، فكان علاجهم لهذا المشكل بتقديم عدة
ضوابط، رأوا أنها تكفي لدفع الخطر، وتجنب الكثير من الضرر.
ونذكر من هذه المعالجات:
34 ـ ردّ
روايات الشيعة في المطاعن والفضائل:
فكل ما فيه تأكيد على الحق، وإظهار له، فيما يرتبط
بفضائل علي «عليه السلام»، وكذا فيما يرتبط بما صدر من خصوم أهل
البيت «عليهم السلام» من أفاعيل تدينهم، وتظهر بعض مساوئهم، فإنهم
لا يقبلونه، ويتهمون الرافضة بالكذب فيه.
إنهم لا يقبلون منهم أي شيء فيه تأييد لمذهب
الشيعة، وتفنيد لمذاهب غيرهم.
ومن أجل استبعاد فقه، ورؤى، ومعارف أهل البيت
«عليهم السلام» الذين هم أحد الثقلين اللذين أمر رسول الله «صلى
الله عليه وآله» بالتمسك بهما إلى يوم القيامة، وهم سفينة نوح التي
ينجو من ركبها.
ولكي تبقى الساحة مفتوحة أمام الآخرين ليأخذوا
بفتاوى أناس عاشوا، أو فقل: ولدوا بعد وفاة النبي «صلى الله عليه
وآله» بعشرات السنين، ليسوا من أهل بيت النبوة، ولا من معدن
الرسالة، ولا من مهبط الوحي والتنزيل.
نعم،
من أجل ذلك، نجدهم يحاولون قطع الصلة بين الرافضة وبين الرسول
بالكلية.
فقد قال التهانوي حول المعرفة
بالإسناد:
«لا ريب أن الرافضة أقل معرفة بهذا الباب، وليس في أهل الأهواء
والبدع أجهل منهم به؛ فإن سائر أهل الأهواء، كالمعتزلة والخوارج
يقصررون
في معرفة هذا، لكن المعتزلة أعلم بكثير من الخوارج، والخوارج أعلم
بكثير من الرافضة، والخوارج أصدق من الرافضة».
إلى أن قال:
«أهل
البدع سلكوا طريقاً
أخرى ابتدعوها واعتمدوها، ولا يذكرون الحديث بل ولا القرآن في
أصولهم إلا للاعتضاد، لا للاعتماد.
والرافضة أقل معرفة بل وعناية بهذا، إذ كانوا لا
ينظرون في الأسناد، ولا في سائر الأدلة الشرعية والعقلية، هل توافق
ذلك أو تخالفه. ولهذا لا يوجد لهم أسانيد متصلة صحيحة قط.
بل كل إسناد متصل لهم؛ فلا بد أن يكون فيه من هو
معروف بالكذب، أو كثرة الغلط، وهم في ذلك شبيه باليهود والنصارى،
فإنه ليس لهم أسناد».
وقال:
والأسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو في
الإسلام من خصائص أهل السنة، والرافضة أقل عناية به، إذ كانوا لا
يصدقون إلا بما يوافق أهواءهم، وعلامة كذبه أنه يخالف هواهم»([128]).
وأما رواية الشيعي، وحتى الرافضي لما يؤيد مذهب أهل
السنة، أو فقل ما لا يضر بنهجهم، ولا بمذهبهم، فهي مقبولة، بل يمكن
أن يصبح الشيعي بل الرافضي من رواة الصحاح
ألست
أيضاً،
وبذلك يكون قد جاز القنطرة، كما سنرى.
وأما بالنسبة للخوارج والنواصب، وحتى الشيعي
والرافضي أحياناً
حين يوافق هواهم، ويخدم اتجاههم بزعمهم، فقد قالوا:
إن صاحب البدعة إذا لم يكن داعية، أو كان وتاب، أو
اعتضدت روايته بمتابع، فإن روايته تقبل،
أما إذا كان داعية، فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته([129]).
وقيل لا تقبل رواية غير الداعية أيضاً([130]).
وبما أن ما تقدم لا يكفي في علاج بعض جهات القضية،
لاسيما وأنهم يردون روايات من يتهم بالتشيع، مع أن صحاحهم تروي عن
الشيعة، فقد اتجهوا نحو الحديث عن حجم البدعة ومقدارها، فقالوا:
إن كانت البدعة صغرى، جازت الرواية عن صاحبها، وإن
كانت كبرى لم تجز؛ فالبدعة الكبرى هي الرفض الكامل، والصغرى كغلو
التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرق([131]).
وبذلك يفسحون المجال أمام الرواية عن بعض علمائهم
الذين ينسبون إليهم التشيع لمجرد:
أنه روى حديثاً في فضل علي «عليه السلام»، أو تكلم
في معاوية، كالنسائي، وعبد الرزاق الصنعاني، والحاكم النيسابوري،
وأضرابهم.
ولكن تبقى مشكلة روايتهم عن بعض المبتدعة، الذين هم
من أشد الدعاة إلى بدعتهم، مثل عمران بن حطان، وغيره من النواصب
والخوارج، فحلوها بطريقة جبرية، وقاطعة، حين قالوا: من روى له
الشيخان، فقد جاز القنطرة([132]).
وقال الذهبي في ترجمة يحيى بن
معين:
«وأما
يحيى فقد جاز القنطرة (يعني برواية الشيخين له) فلا يلتفت إلى ما
قيل فيه،
بل قفز من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي ـ يعني أنه في أعلى
مراتب التعديل والتوثيق»([133]).
وذكر التهانوي:
إن كل من حدث عنه البخاري فهو ثقة، سواء حدث عنه في الصحيح، أم في
غيره،
وكذا كل من ذكره البخاري في تواريخه، ولم يطعن فيه، فهو ثقة،
وكذا كل من حدث عنه مسلم، والنسائي، وأبو داود، أو سكت عنه أبو
داود فهو ثقة أيضاً([134]).
وبعد ما تقدم، فقد حلت مسألة لزوم قبول روايات بعض
علماء أهل السنة الكبار، الذي اتهموا بالتشيع، بسبب روايتهم بعض
فضائل علي وأهل بيته «عليهم السلام»، أو انتقدوا معاوية وأضرابه،
وقبلت أيضاً روايات بعض الشيعة أو الرافضة، التي جاءت منسجمة مع
النهج الفكري الذي يلتزمه غير الشيعة أيضاً،
ثم قبلت أيضاً روايات الصحاح؛ البخاري، ومسلم، والنسائي، وأبي داود،
ولكن ذلك كله لا يكفي أيضاً، بل لا بد من تصحيح رواية كل خارجي
وناصبي، مع أنهم يدّعون: أن هؤلاء أهل بدعة قد ترك أهل السنة
حديثهم([135]).
ومع أن فيهم من يدعو إلى بدعته، ومن كان داعية إلى
بدعته لا تقبل روايته([136]).
ومع أنه قد تقدم:
أن الخوارج معروفون بوضع الحديث، وقد ترك الناس الرواية عنهم في
البداية لذلك.
فعالجوا هذا المشكل بدعوى:
أن
«الخوارج
أعلم بكثير من الرافضة، والخوارج أصدق من الرافضة،
بل الخوارج لا نعلم عنهم أنهم يتعمدون الكذب،
بل هم من أصدق الناس»([137]).
وقال أبو داود:
«ليس
في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج»([138]).
وقال التهانوي:
«الخوارج
لا يكادون يكذبون،
بل هم من أصدق الناس مع بدعتهم وضلالهم»([139]).
وقال ابن تيمية:
«الخوارج
مع مروقهم من الدين فهم أصدق الناس، حتى قيل: إن حديثهم أصح الحديث»([140]).
وعلل بعضهم صدقهم بأنهم يقولون بأن مرتكب الكبيرة
كافر([141]).
ولا ندري كيف صح له هذا التعليل.
وهؤلاء الخوارج أنفسهم قد قتلوا عبد الله بن خباب،
وارتكبوا جرائم الزنى،
وغيرها مما هو مسطور في تواريخهم؟!
وحين طغت مدرسة أهل الحديث، ونشروا في الناس الكثير
من الأمور التي يأباها العقل والوجدان، والفطرة، وتخالف القرآن.
مثل:
نفي عصمة النبي «صلى الله عليه وآله» إلا في التبليغ،
عقيدة الجبر،
التجسيم والتشبيه،
لزوم الخضوع للحاكم الظالم، والمنع من الاعتراض عليه،
وغير
ذلك من أمور أدخلوها في عقائد المسلمين، وفي تاريخهم،
وهي مأخوذة في الأكثر من أهل الكتاب.
ثم واجههم المعتزلة، وغيرهم، ولاسيما الشيعة
بالأحاديث الصحيحة والصريحة، التي رووها هم أنفسهم، فأحرجوهم في
كثير من المواقع، وفندوا مزاعمهم وأقاويلهم،
سواء بالنسبة لكثير من الجهات العقائدية، أم بالنسبة لبعض ما
يزعمون أنه أحداث تاريخية، أو غيرها.
فإنهم التجأوا إلى أسلوب التجريح، والمقاطعة على
الصعيد الفكري، وقرروا بالنسبة إلى الشيعة رد رواية كل من فيه
رائحة التشيع.
وأما بالنسبة للمعتزلة الذين كانوا يتمتعون
بالتأييد من قبل عدد من الحكام، فقد قرروا:
أنه إذا كان الراوي معتزلياً، يناصب أهل الحديث
العداء، فلا يسمع كلامه، ولا يعتد به، لأن كونه معتزلياً، مخالفاً
لأهل الحديث، يوجب ضعفه، وسقوط ما يأتي به!!
([142]).
ومن الذين يسمح لهم بالحديث على نطاق واسع عائشة أم
المؤمنين، التي نشرت في الناس ألوف الأحاديث، التي تصب في اتجاه
معين، لا يتلاءم كثيراً مع خط علي «عليه السلام» وأهل بيته.
إن لم نقل:
إنه يؤيد الاتجاهات المخالفة له في كثير من
الأحيان.
ومنعاً لأي ريب أو اعتراض، فقد جاءت الضابطة على
صورة حديث منسوب إلى النبي «صلى الله عليه وآله» يقول:
«خذوا
نصف دينكم عن هذه الحميراء»([143]).
ومن المعلوم:
أن أبا هريرة الدوسي يستأثر بأكبر رقم من الروايات التي ينسبها إلى
النبي «صلى الله عليه وآله»، حيث إن له منها، حسب إحصائية ذكرها
العلامة أبو رية رحمه الله 5374 حديثاً([144]).
ونحن نجد الطعون تتوجه إلى هذا الرجل، أعني أبا
هريرة من كل حدب وصوب، وقد ألفت في ذلك الكتب([145])،
وكتبت البحوث.
بل إنك تجد في الطاعنين عليه من هو من كبار الصحابة
أيضاً؛ وقد قال إبراهيم بن
سيار النظام: أكذبوه: عمر، وعثمان، وعلي، وعائشة([146]).
ورد سعد على أبي هريرة مرة، فوقع بينهما كلام حتى
ارتجت الأبواب بينهما([147]).
وروي عن عمر بن الخطاب قوله:
أكذب المحدثين أبو هريرة([148]).
وقد ذكر الذهبي نصوصاً عديدة
تفيد:
أنهم كانوا يتجنبون حديث أبي هريرة، ويتكلمون في إكثاره من الحديث([149]).
وإن أدنى مراجعة لكتاب أبو هريرة شيخ المضيرة للشيخ
محمود أبي رية، وكذا كتاب أبو هريرة للإمام السيد عبد الحسين شرف
الدين، تغنينا عن ذكر النصوص الكثيرة لذلك.
وبعد كل ما تقدم نقول:
لقد رأوا: أن هذه الطعون التي تتوجه إلى أبي هريرة من كل حدب وصوب،
قد تؤدي إلى إحداث خلل كبير في البنية الفكرية لتيار كبير من
الناس، فلا بد إذن من مواجهة هذه الهجمة بهجمة مماثلة،
ولا مانع من أجل تثبيت الأصول والقواعد من استعمال أسلوب التخويف،
والتهويل، بل والسباب،
ثم الاتهام بكل عظيمة،
وإن لم ينفع ذلك كله في دفع غائلة تلك التجريحات والطعون،
فبالإمكان الالتجاء إلى أسلوب تحريض الحكام على أولئك الناس، إذا
ما حاولوا التذكير بأقوال السلف ومواقفهم من أبي هريرة راوية
الإسلام.
ولعل خير ما يجسد هذا الاتجاه هي أقوال ابن خزيمة
التي جمعت ذلك كله، حيث قرر:
أن من يطعن في أبي هريرة:
إما معطل جهمي.. وإما خارجي يرى السيف على أمة محمد، ولا يرى طاعة
خليفة، ولا إمام،
أو قدري،
أو جاهل([150]).
هذا كله عدا عن رمي الطاعنين على أبي هريرة
بالانحراف، والضلال، وبكثير من أنحاء التوهين والتهجين، والإخراج
من الدين،
كل ذلك إكراماً
لأبي هريرة، فلأجل عين ألف عين تكرم.
ومن أجل مواجهة الحالة الناشئة من وجود أحاديث
كثيرة،
حتى في الصحيحين تخالف القرآن الكريم وتنافيه، الأمر الذي من شأنه
أن يحرج القائلين بصحة كل ما في الصحيحين، وكذا ما جاء في غيرهما
من أحاديث بأسانيد معتبرة وصحيحة، حسب تقديراتهم،
من أجل ذلك، قرروا:
أن الحديث أصل قـائم
برأسه([151])
ولا يعرض على الكتـاب
العزيز، والأحاديث التي تلزم بعرض الحديث على القرآن هي من وضع
الزنادقة،
والسنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب بقاض على السنة. (وسيأتي ذلك
مع مصادره في الفصل التالي إن شاء الله تعالى).
ولأجل هذا نجد:
«أن
كثيراً من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة؛ لرده كثيراً
من أخبار الآحاد العدول، لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما
اجتمع من الأحاديث، ومعاني القرآن»([152]).
أمـا ما نرى:
أنه قد جاء موافقاً لأهل الكتاب، فهو لا يعني ـ بالضرورة ـ أن أهل
الكتاب قد تلاعبوا بهذا الدين، وأدخلوا فيه ترهاتهم.
وذلك لوجود ضابطة مزعومة تقول:
إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان يحب موافقة أهل الكتاب في
كل ما لم يؤمر به([153]).
رغم أننا قد قدمنا:
أن الأمر كان على عكس ذلك تماماً،
ولسوف يأتي في هذا الكتاب، حين الكلام حول صيام عاشوراء ما يثبت
ذلك أيضاً إن شاء الله تعالى.
أما بالنسبة للرواية عن بني إسرائيل، وإعطاء الفرصة
لأهل الكتاب لبث سمومهم، والعبث بأفكار الناس، وتسريب عقائدهم،
وأفكارهم، وحتى أحكامهم الفقهية إلى المسلمين، فليس الذنب في ذلك
ذنبهم، وإنما كان ذلك انسجاماً
مع الضابطة المقررة، وامتثالاً للمرسوم الذي يقول:
«حدثوا
عن بني إسرائيل ولا حرج».
وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يحدث عن بني
إسرائيل عامة ليله حتى يصبح، كما زعموا،
وكل ذلك قد تقدم.
وتواجههم أحكام شرعية مزعومة، وأقاويل عقائدية،
وأحاديث وأوامر وأمور غير معقولة، ولا مستساغة،
من قبيل ما ذهب إليه جمهور الأشاعرة من أن التكليف بغير المقدور
وما لا يطاق صحيح وجائز،
بل جوز بعضهم التكليف بالمحال أيضاً([154])،
واستدلوا على ذلك بما لا مجال لذكره هنا([155])،
واستدل البعض بروايات بدء نزول الوحي أيضاً، كما سيأتي.
فمن أجل مواجهة الضجة التي ربما تثيرها أقاويل من
هذا القبيل جاؤوا بضابطة عجيبة غريبة تقول:
إنه لا قبيح إلا ما قبحه الشرع، ولا حسن إلا ما
حسنه الشرع. أما العقل فلا دور له في هذا الأمر، لا من قريب ولا من
بعيد،
وهذا ما ذهب إليه الأشعرية، ومن وافقهم([156])
وبذلك تنحل عندهم كثير من العقد العقائدية، والتاريخية، والفقهية
وغيرها،
ولا نريد أن نناقش هذه المزعمة هنا، غير أننا نشير إلى أن الشوكاني
ـ وهو من كبار علمائهم ـ قد اعتبر إنكار إدراك العقل لكون الفعل
حسناً،
أو قبيحاً
مكابرة ومباهتة([157]).
وقد قلنا في فصل سابق:
إنهم من أجل تلافي الإعتراضات
على بعض الفتاوى التي كانت تصدر من بعض الرموز الرئيسية، مما
يخالفون فيها صريح النص القرآني أو النبوي، الأمر الذي قد يزعزع
الثقة بهم، بالإضافة إلى سلبيات أخرى،
إنهم من أجل تلافي ذلك، قرروا حصر الفتوى في القضايا السياسية
والقضائية الهامة، بالأمراء،
وسموها: صوافي الأمراء.
وأما سائر ما تبقى من أمور، فقد أوكلت إلى أناس
بأعيانهم، وحظر على الآخرين ـ الذين لا يُطمأَنّ إلى ميلهم، أو
أهليتهم في مجال تقوية الخط السياسي القائم ـ حظر عليهم أن يتصدوا
للفتوى، أو للرواية،
وقد قدمنا بعض ما يوضح ذلك فلا نعيد،
ثم قرروا ضابطة أخرى وهي:
وكذا ضابطة:
إلى غير ذلك:
من معايير زائفة،
وضوابط تهدف إلى حفظ الإنحراف
والإحتفاظ
به، لا يتسع المقام لذكرها، ولا تسمح الفرصة بتقصيها. ولعل فيما
ذكرناه كفاية لمن أراد الرشد والهداية.
([1])
أضواء على السنة المحمدية ص342 عن الذهبي في رسالته التي ألفها
في الرواة الثقات.
([2])
راجع: الكفاية في علم الرواية ص46 ـ 49 والباعث الحثيث ص182
و181 وتدريب الراوي ج2 ص214 والسنة قبل التدوين ص394 و403
وعنهم وعن فتح المغيث ج4 ص35.
وراجع: علوم الحديث لابن الصلاح ص264 و265 و268 وعلوم الحديث
لصبحي الصالح ص353 الطبعة الثامنة وقواعد في علوم الحديث
للتهانوي ص202 و203 والإصابة ج1 ص9 و10 والإحكام في أصول
الأحكام ج2 = = ص81 و82 وفواتح الرحموت ج2 ص156 وإرشاد الفحول
ص70 و69 و64 و65 والخلاصة في علوم الحديث ص124 و94 و67 وسير
أعلام النبلاء ج2 ص608.
([3])
أضواء على السنة المحمدية ص349 عن العلم الشامخ للمقبلي ص297 ـ
312.
([4])
راجع: مقارنة الأديان (اليهودية) ص222.
([5])
راجع: الكتابة في علم
الرواية ص51 وراجع ص50 والباعث الحثيث ص179 و181 (متناً
وهامشاً) والإصابة ج1 ص5 و7 و4 ونهاية الوصول ج3 ص179 وإرشاد
الفحول ص70 وأضواء على السنة المحمدية ص352 وتدريب الراوي ج2
ص208 و209 و215 ـ
216 والسنة قبل التدوين ص387 ومقدمة في علوم الحديث لابن
الصلاح ص263 والخلاصة في أصول الحديث للطيبي ص124 و125 وعلوم
الحديث لصبحي الصالح ص352 ط 8. وصحيح البخاري (ط دار الفكر) ج4
ص188 وأسد الغابة ج1 ص13، وراجع: الأحكام في أصول الأحكام ج2
ص82 وفواتح الرحموت ج2 ص158 وسلم الوصول ج3 ص180 وعن فتح
المغيث ج4 ص31 و32 وعن تلقيح فهوم أهل الآثار ص27 ب.
([6])
راجع: الباعث الحثيث ص184 والسنة قبل التدوين ص392 ومعرفة علوم
الحديث ص24 وعلوم الحديث لصبحي الصالح ص356 و357 ط 8 وراجع:
سلم الوصول ج3 ص180.
([7])
راجع: الإصابة ج1 ص51.
([8])
راجع الإصابة ج1 ص158 وص 8 وترجمـة طليحة وتـدريـب الراوي ج2
ص209 وراجع فواتح الرحموت ج1 وسلم الوصول ج3 ص180.
([9])
السنة قبل التدوين ص397 عن المنهج الحديث في علوم الحديث ص62
عن شرح مسلم الثبوت.
([10])
القصاص والمذكرين ص115.
([11])
البـاعث الحثيث ص179 وعلوم الحديث لابن الصلاح ص262 وتقريب
النواوي (مطبوع مع تدريب الراوي) ج2 ص207 والخلاصة في أصول
الحديث للطيبي ص124.
([12])
الكفاية في علم الرواية ص49 والسنة قبل التدوين ص405 عنه.
([13])
أصول السرخي ج2 ص134.
([14])
السيرة الحلبية ج2 ص203 و204 عن الخصائص الصغرى، عن شرح جمع
الجوامع وراجع: فتح الباري ج7 ص237.
([15])
راجع: فتح الباري ج7 ص238 والسيرة الحلبية ج2 ص203.
([16])
راجع: الصحيح من سيرة النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» الجزء
الرابع حين الحديث حول غفران ذنب من شهد بدراً.
([17])
راجع: التراتيب الإدارية ج2 ص364 ـ 366.
([18])
راجع: فواتـح الرحموت في شرح مسلم الثبوت ج2 ص158 و156 وسلم
الوصول (مطبوع مع نهاية السؤل) ج3 ص176 و177 والسنة قبل
التدوين هامش ص396 و404 و405.
([19])
السنة قبل التدوين ص404 وراجع: إختصار علوم الحديث (الباعث
الحثيث) ص182.
([21])
إختصار علوم الحديث (الباعث الحثيث) ص182.
([22])
أضواء على السنة المحمدية ص352 عن الأرواح النوافخ (المطبوع مع
العلم الشامخ) ص687 و688.
([23])
المقدمة لابن خلدون ص389.
([24])
تهذيب تاريخ دمشق ج6 ص307.
([25])
شرف أصحاب الحديث ص7.
([26])
الكفاية في علم الرواية ص421 ـ 422.
([27])
الكفاية في علم الرواية ص421 ـ 422.
([28])
راجع: الخطط والآثـار ج2 ص332 وتاريخ حصر الاجتهـاد ص90 ـ 93
وراجع: الغدير ج7 ص119 عن سنن الدارمي ج1 ص58 وعن الصواعق
المحرقة ص10 وعن تاريخ الخلفاء ص71 وعن أعلام الموقعين ص19 وعن
جامع بيان العلم ج2 ص51 وعن ابن سعد في الطبقات.
([30])
راجع: إرشاد الفحول ص256 و257.
([31])
راجع: أصول السرخسي ج2 ص134 و135 ثم إنه ناقش هذه النظرية
وردها.
([32])
ابن حنبل ص251 ـ 252 ومالك لأبي زهرة ص290.
([33])
راجع على سبيل المثال: فواتح الرحموت ج2 ص186 والتراتيب
الإدارية ج2 ص366 ـ 367 وسلم الوصول في شرح نهاية السؤل ج4
ص410 وراجع نهاية السؤل ج4 ص410 وأصول السرخسي ج2 ص114ـ 115.
([34])
حياة الصحابة ج3 ص505 عن تاريخ الأمم والملوك ج3 ص446.
([35])
أصول السرخسي ج2 ص113 وراجع: نهاية السؤل ج4 ص416.
([36])
مقارنة الأديان (اليهودية) ص222 تأليف الدكتور أحمد شلبي.
([37])
كنز العمال ج1 ص332 عن ابن عساكر، وكشف الغمة للشعراني ج1 ص6
والنص له.
([38])
راجع: الثقات لابن حبان ج1 ص4 ونهاية السؤل ج3 ص266 و267 وسلم
الوصول في شرح نهاية السؤل ج4 ص410 وأصول السرخسي ج1 ص116 و114
وإرشاد الفحول ص33 والأحكام في أصول الأحكام للآمدي ج4 ص204
وحياة الصحابة ج1 ص12 وعن كشف الغمة للشعراني ج1 ص6.
([39])
راجع المصادر التي في الهامش السابق.
([40])
راجع كتابنا: الغدير والمعارضون ص61 ـ 70.
([41])
سنن البيهقي ج3 ص144 والغدير ج8 ص100 عنه وراجع: الطبقات
الكبرى لابن سعد ج2 قسم 2 ص135. وراجع رواية صالح بن كيسان
والزهري في تقييد العلم ص106 و107 وفي هامشه عن العديد من
المصادر.
([42])
راجع قصة الشورى في أي كتاب تاريخي شئت. وراجع: أصول السرخسي
ج2 ص114 والأحكام في أصول الأحكام للآمدي ج4 ص133.
([43])
بهج الصباغة ج12 ص203.
([44])
منهاج السنة ج3 ص205 وقواعد في علوم الحديث ص446.
([45])
كنز العمال ج1 ص160 عن الديلمي في الفردوس.
([46])
راجع: الخطط والآثار للمقريزي ج2 ص332 وتاريخ حصر الاجتهاد ص90
و 92 و93.
([47])
راجع: الخطط والآثار للمقريزي ج2 ص332 وتاريخ حصر الإجتهاد ص90
و92.
([48])
أصول السرخسي ج2 ص108.
([49])
ابن حنبل لأبي زهرة ص251 ومالك لأبي زهرة ص290.
([50])
ابن حنبل لأبي زهرة ص254 و255 عن إرشاد الفحول ص214.
([51])
نهاية السؤل، وسلم الوصول بهامشه ج4 ص408.
([52])
أعلام الموقعين ج1 ص29.
([53])
قواعد في علوم الحديث ص460 و461.
([54])
قواعد في علوم الحديث ص202.
([55])
أصول السرخسي ج2 ص7.
([56])
راجع تفصيل ذلك في: إرشاد الفحول ص64 و65 والخلاصة في أصول
الحديث ص67 والكفاية في علم الرواية ص385 و384 وراجع ص404
وقواعد في علوم الحديث للتهانوي ص138.
([57])
الكفاية في علم الرواية ص392 وقواعد في علوم الحديث للتهانوي
ص139 و141.
([58])
التراتيب الإدارية ج2 ص366 وراجع ص364 و365.
([59])
الأحكام في أصول الأحكام ج2 ص82 والسنة قبل التدوين ص404 عنه.
([60])
إرشاد الفحول. ص259.
([61])
إرشاد الفحول ص261.
([63])
نهاية السؤل ج4 ص560 وراجع ص558 وراجع: الأحكام للآمدي ج4
ص159.
([64])
نهاية السؤل ج4 ص567.
([65])
سيأتي تفصيل ذلك، وبيان فساده حين الحديث حول غزوة بدر.
([66])
راجع: أصول السرخسي ج2 ص318 وص 5 و96 و91 وإرشاد الفحول ص35
ونهاية السؤل ج4 ص537 والأحكام في أصول الأحكام ج4 ص187
واجتهاد الرسول ص122 ـ 124 عن العديد من المصادر.
([67])
سيأتي الحديث عن قصة تأبير النخل في هذا الكتاب أيضاً إن شاء
الله تعالى.
([68])
راجع على سبيل المثال: إرشاد الفحول ص35 والأحكام في أصول
الأحكام ج4 ص187 و188 واجتهاد الرسول.
([69])
راجع: تهذيب الأسماء ج1 ص42 وراجع: الإلمام ج6 ص123 والباعث
الحثيث ص35 وشرح صحيح مسلم للنووي (مطبوع بهامش إرشاد الساري)
ج1 ص28.
وراجع: نهاية السؤل ج3 ص325 وسلم الوصول ج3 ص326 وعلوم الحديث
لابن الصلاح ص24، وإرشاد الفحول ص82 و80 والإحكام في أصول
الأحكام للآمدي ج4 ص188 و189.
([70])
راجع: الإحكام في أصول الأحكام ج4 ص188. ففيه ما يستفاد منه
ذلك، وناقشه بما لا يجدي، وكذا في كتاب: اجتهاد الرسول ص141
و142 عن مصادر أخرى.
([71])
راجع: المنتظم ج9 ص210 والإلمام ج6 ص123 والإحكام في أصول
الأحكام ج1 ص204 و205 وبحوث مع أهل السنة والسلفية ص27 عن
المنتظم.
([72])
راجع: الإحكام في أصول الأحكام ج1 ص208 وتهذيب الأسماء ج1 ص42
والنشر في القراءات العشر ج1 ص7 و33 و31. وأي كتاب أصولي، يبحث
حول حجية الإجماع، وفق مذاق أهل السنة.
([73])
الباعث الحثيث ص35 وعلوم الحديث لابن الصلاح ص24 وشرح صحيح
مسلم (بهامش إرشاد الساري) ج1 ص28.
([74])
مجموعة المسائل المنيرية ص32.
([75])
راجع ما تقدم: في أضواء على السنة المحمدية ص370 و371.
([76])
تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص155 والكامل في الأدب ج1 ص13
وأعلام الموقعين ج1 ص86.
وراجع: سنن الدارقطني ج4 ص206 و207 وراجع: المحلى ج1 ص59 وعيون
الأخبار لابن قتيبة ج1 ص66.
([77])
تهذيب تاريخ دمشق ج6 ص307.
([78])
الإحكام في أصول الأحكام ج4 ص162، وقد تقدمت بقية المصادر في
فقرة رقم: 11 رأي الصحابي حيث لا نص، فراجع.
([79])
الإحكام في أصول الأحكام ج4 ص162 والمحلى ج1 ص61.
([80])
شرح النهج ج12 ص84.
([81])
شرف أصحاب الحديث ص74.
([82])
شرف أصحاب الحديث ص76.
([83])
الباعث الحثيث ص85 عن السخاوي في شرح ألفية العراقي ص11
والمتبولي في مقدمة شرحه الجامع الصحيح.
([84])
نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول ج4 ص632.
([85])
سلم الوصول لشرح نهاية السؤل ج4 ص631.
([86])
راجع: دائرة معارف القرن العشرين لوجدي ج3 ص223.
([87])
قواعد في علوم الحديث ص462.
([88])
الخطط والآثار للمقريزي ج2 ص334.
([89])
تاريخ حصر الاجتهاد ص105 ـ 107.
([90])
المصدر السابق ص108.
([91])
راجع: رياض العلماء ج4 ص33 و34.
([92])
أعلام الموقعين ج2 ص275 ـ 278. والاجتهاد في الإسلام ص218 ـ
246.
([93])
إرشاد الفحول ص253.
([94])
إرشاد الفحول ص253 و254.
([95])
فواتح الرحموت ج2 ص399 والاجتهاد في الإسلام ص219.
([96])
دائرة معارف القرن العشرين ج3 ص197.
([97])
راجع: مقارنة الأديان (اليهودية) ص223.
([98])
راجع: تاريخ بغداد ج14 ص7 و8 والبداية والنهاية ج10 ص215
والبصائر والذخائر ج1 ص81 وتاريخ الخلفاء ص285.
([99])
البداية والنهاية ج10 ص153.
([100])
إرشاد الساري ج1 ص29.
([101])
إرشاد الساري ج1 ص29. وراجع: تدريب الراوي ج1 ص96 وفتح الباري
(المقدمة) ص11 وتذكرة السامع والمتكلم ص127 (هامش) عن مفتاح
السعادة ص127 وقال: إن السلف والخلف قد أطبقوا على أنه أصح
كتاب بعد كتاب الله تعالى.
([102])
علوم الحديث، لابن الصلاح ص22.
([103])
راجع: فتح الباري (المقدمة) ص8 وتدريب الراوي ج1 ص91 وعلوم
الحديث لابن الصلاح ص14 والخلاصة في أصول الحديث ص36 وعلوم
الحديث ومصطلحه ص396 و399 والغدير ج9 ص35 عن شرح صحيح مسلم
للنووي.
([104])
عمدة القاري ج1 ص5.
([105])
راجع: تذكرة السامع والمتكلم (هامش) ص128 عن تذكرة الحفاظ
للذهبي ج3 ص210.
([106])
علوم الحديث لابن الصلاح ص24 وشرح صحيح مسلم للنووي (مطبوع
بهامش إرشاد الساري) ج1 ص28.
([107])
الباعث الحثيث ص35.
([108])
الباعث الحثيث ص100.
([109])
راجع في جميع ما تقدم: الغدير ج5 ص293 ـ 295 وج 7 ص273 ومقدمة
فتح الباري ص460 و461 والكفاية في علم الرواية ص125.
([110])
راجع: البداية والنهاية ج11 ص4 والغدير ج5 ص244.
([111])
راجع: الغدير ج11 ص87 وج 3 ص123 وج 6 ص143 و144.
([112])
راجع: فتح الباري (المقدمة) ص460 و461 وتدريب الراوي ج1 ص328 ـ
329.
([113])
راجع: مقدمة فتح الباري ص460 و461 وراجع: الكفاية في علم
الرواية ص125.
([114])
لسان الميزان ج1 ص10 و11 والكفاية للخطيب ص123 و128 وآفة أصحاب
الحديث ص71 و72 واللآلي المصنوعة ج2 ص468 وراجع: العتب الجميل
ص122. وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص29 عن الأولين، وعن
الموضوعات لابن الجوزي ص38 وعن السنة ومكانتها في التشريع
للسباعي ص97.
([115])
اللآلي المصنوعة ج2 ص468.
([116])
راجع: لسان الميزان ج1 ص11.
([117])
الكفاية في علم الرواية ص403 وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص29
عن المحدث الفاضل للرامهرمزي ج1 ص12.
([118])
أحوال الرجال ص34.
([119])
راجع: لسان الميزان ج1 ص10 و12 و7 وميزان الاعتدال ج1 ص3.
([120])
وراجع على سبيل المثال: السنة قبل التدوين ص443 و442 والكفاية
في علم الرواية ص123 و130 و31.
([121])
لسان الميزان ج1 ص10 وميزان الاعتدال ج1 ص27 ـ 28 ومقدمة فتح
الباري ص431 وفتح الباري ج2 ص153 وقواعد في علوم الحديث ص407
و422.
([122])
الكفاية في علم الرواية ص126 وراجع لسان الميزان ج1 ص10.
([123])
الكفاية في علم الرواية ص126.
([124])
لسان الميزان ج1 ص10 وميزان الاعتدال ج1 ص27 و28.
([125])
قواعد في علوم الحديث ص444 وراجع ص443.
([126])
شرف أصحاب الحديث ص55 وراجع ص78.
([127])
لسان الميزان ج1 ص10 وميزان الاعتدال ج1 ص27 و28.
([128])
قواعد في علوم الحديث ص443 و444.
([129])
علوم الحديث لابن الصلاح ص104 و103 والباعث الحثيث ص99 وإرشاد
الفحول ص51 وفتح الباري (المقدمة) ص459 و450 ومعرفة علوم
الحديث ص135 والخلاصة في أصول الحديث ص95 والمجروحون ج1 ص168
والكفاية في علم الرواية ص121 و123 و126 ـ 128 وقواعد في علوم
الحديث للتهانوي ص230 و231 و402 و207 وتقريب النووي وشرحه
للسيوطي المسمى بتدريب الراوي ج1 ص325.
([130])
الخلاصة في أصول الحديث ص95 والكفاية في علم الرواية ص120
وقواعد في علوم الحديث للتهانوي ص227 ـ 230 وتقريب النووي
وشرحه (تدريب الـراوي) ج1 ص324 وبحـوث في تـاريخ السنة المشرفة
ص46 عنه وعـن = = الكامل لابن عدي ج1 ص39: أ وعن: المجروحون
ج2 ص27 ب وعن المحدث الفاضل ج1 ص12.
([131])
لسان الميزان ج1 ص9 و10 وميزان الاعتدال ج1 ص30.
([132])
قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص463 عن أبي الوفاء القرشي في
كتاب الجامع الذي جعله ذيلاً للجواهر المضية ج2 ص428.
([133])
ميزان الاعتدال ج4 ص410.
([134])
لخصنا ذلك من كتاب: قواعد في علوم الحديث للتهانوي ج2 ص428.
([135])
ميزان الاعتدال ج1 ص3 ولسان الميزان ج1 ص7 و12.
([136])
راجع تفصيل ذلك فيما تقدم وفي لسان الميزان ج1 ص10.
([137])
قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص443.
([138])
ميزان الاعتدال ج3 ص236 والعتب الجميل ص121 وفتح الباري
(المقدمة) ص432 وج 2 ص154.
([139])
قواعد في علوم الحديث ص444 ـ 445.
([140])
بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص29.
([141])
المصدر السابق ص28.
([142])
السنة قبل التدوين ص443.
([143])
أضواء على السنة المحمدية ص127.
([144])
راجع: كتابه أضواء على السنة المحمدية
([145])
راجع كتاب: أبو هريرة لشرف الدين، وكتاب: أبو هريرة شيخ
المضيرة، لأبي رية.
([146])
تأويل مختلف الحديث ص132 والسنة قبل التدوين ص455.
([147])
سير أعلام النبلاء ج2 ص603.
([148])
السنة قبل التدوين ص455 عن: رد الدارمي على بشر المريسي ص132.
([149])
راجع: سير أعلام النبلاء ج2 ترجمة أبي هريرة.
([150])
راجع: السنة قبل التدوين ص467 و468.
([151])
مقالات الإسلاميين ج2 ص251.
([152])
أضواء على السنة ص370 عن الانتقاء ص149.
([153])
راجع: صحيح البخاري ط الميمنية ج4 ص67 والسيرة الحلبية ج2 ص132
وزاد المعاد ج1 ص165.
([154])
راجع: نهاية السؤل (شرح منهاج الأصول) ج1 ص315 ـ 321 متناً
وهامشاً، وص 345 و347 و348 و353 وإرشاد الفحول ص9 ([154]).
([155])
راجع: إرشاد الفحول ص9.
([156])
راجع: إرشاد الفحول ص7 ونهاية الأصول ج1 ص314 وص 81 ـ 85.