|
|

عضو مجتهد
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المستوى : 
|
|
|
|
|


|
كاتب الموضوع :
زائر الأربعين
المنتدى :
ميزان الثقلين القرآن الكريم والعترة الطاهرة عليهم السلام
 بتاريخ : 13-Feb-2013 الساعة : 05:03 PM
بتاريخ : 13-Feb-2013 الساعة : 05:03 PM
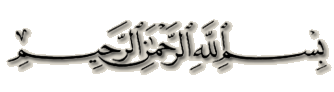
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
-[ 115 ]-
الأمر الثاني
الواقع الجاهلي
وذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد عاش في وسط جاهلي غريب عن جميع المعارف الإلهية، والتعاليم الدينية، بل هو منافر لها في وثنيته وقبليته وغطرسته وسلوكه.
ولم يعرف عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قد اختلف إلى مَن عنده علمٌ بذلك، لأن مراكز الثقافة الدينية كانت في المدينة المنورة عند اليهود، وفي نجران والشام عند النصارى.
ومن المعلوم أنه لم يأخذ من اليهود، لعدم رؤيته المدينة قبل الهجرة، ولِمَا هو المعروف من تعصب اليهود لأنفسهم ومحاولتهم حكر النبوة الخاتمة ومعارفهم الدينية على أنفسهم، وما هم عليه من نظرة الازدراء لولد إسماعيل (عليه السلام) عامة، وبغضهم للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة.
كما أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يذهب لنجران قطعًا،وإنما ذهب للشام في سفرتين محدودتين لا تسمحان له بتعلم شيء من العلوم الإلهية والدينية.
الأولى في صباه بصحبة عمه أبي طالب حينما سافر للتجارة، وكان
-[ 116 ]-
أبو طالب ملازماً له، ظنيناً به، يخشى عليه من كيد الأعداء، لِمَا كان يتوقعه له من مستقبل عظيم. بل روي أن أبا طالب لم يقض وطره من سفرته، وأنه رجع به مسرعاً خوفاً عليه (1).
والثانية في شبابه في تجارة له بمال خديجة (رضي الله عنه) لا تسمح له بالتفرغ لطلب العلم، ولم يذكر عنه أنه اتصل هناك ببعض علماء أهل الكتاب وتردد عليهم.
كما أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يحاول التعلم بتحصيل مقدماته وأسبابه، من جمع الكتب وكتابتها ودراسته. وهذا أمر معلوم من واقعه لا يحتاج إلى إثبات واستدلال.
وكل ما ذكر عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يختلي في غار حراء للتأله وعبادة الله تعالى والتفكر في أمره عزّ وجلّ وعظيم شأنه، والتأمل في خلقه والتدبر فيه.
ومع كل ذلك جاء بالقرآن العظيم الجامع لفنون العلم والمعارف الإلهية في التوحيد الخالص، المبني على تنزيه الله تعالى عن الشريك والنظير والولد والشبيه ((قُل هُوَ اللهُ أحَدٌ* اللهُ الصَّمَدُ* لَـم يَلِد وَلَـم يُولَد* وَلَم يَكُن لَهُ كُفُواً أحَدٌ)) (2).
و ((لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ)) (3).
ـــــــــــــــــــــــ
(1) بحار الأنوار 15: 198، 201.
(2) سورة الإخلاص.
(3) سورة الشورى آية: 11
-[ 117 ]-
و ((لاَ تُدرِكُهُ الأبصَارُ وَهُوَ يُدرِكُ الأبصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ)) (1).
ثم وصفه تعالى بصفات الجلال والجمال ((هُوَ اللهُ الَّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ عَالِمُ الغَيبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحمَنُ الرَّحِيمُ* هُوَ اللهُ الَّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ المَلِكُ القُدُّوسُ السَّلاَمُ المُؤمِنُ المُهَيمِنُ العَزِيزُ الجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ سُبحَانَ اللهِ عَمَّا يُشرِكُونَ* هُوَ اللهُ الخَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ لَهُ الأسمَاءُ الحُسنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ)) (2) مع التأكيد على عظمة الله عزّ وجلّ وكبريائه، وقدرته وإحاطته وهيمنته، وتنزيهه عن كل ما لا يليق بحكمته وكماله المطلق.
والتأكيد على الرسالة الخاتمة وكرامة حاملها (صلى الله عليه وآله وسلم) وحسن الثناء عليه وتعظيم حقه وكرامة المؤمنين المسلمين له المهتدين بهديه.
وتنزيه أنبياء الله تعالى ورسله وملائكته وأوليائه، وبيان كرامتهم ورفعة مقامهم، وذكر رسالاتهم وتعاليمهم وجميل سيرهم، والتنفير من الظلم والظالمين والكافرين والمنافقين، وبدء الخلق والتكوين، وأخبار القرون الماضية والأمم الخالية وما حلّ بها، ووقع عليها من قوارع وقواصم.
والتذكير بالموت وما بعده من البرزخ والبعث والنشر والحشر، والحساب واستعراض مشاهد القيامة، ووصف الجنة والنار، والثواب والعقاب، والتأكيد على البعث والنشأة الآخرة، ثم الاحتجاج على كثير من ذلك بأيسر الطرق وأقربها للفطرة، من دون تكلف وتعقد.
ـــــــــــــــــــــــ
(1) سورة الأنعام آية: 103..
(2) سورة الحشر آية: 22ـ24.
-[ 118 ]-
والتأكيد على آيات الله تعالى البالغة، ونعمه السابغة، ورحمته بعباده، وجميل صنعه بهم، وسطوته بمَن يشاقه ويضاده، ونكاله بهم، وانتقامه منهم.
والتشريع فيما يخص العقائد، وما يخص السلوك العملي، من الفرائض، والمحرمات، والسنن والآداب، والنظم الاجتماعية، ومكارم الأخلاق ومحمود الصفات والفعال.
والتذكير والوعظ والتقريع والتنبيه للعبر وضرب الأمثال، والوعد والوعيد بثواب الله تعالى وعقابه في الدنيا والآخرة... إلى غير ذلك مما يجعله بمجموعه مستوعباً لجميع حدود الدعوة وأصولها، وتثبيت خطوطها العامة، وبيان وجهتها الشريفة وأهدافها النبيلة.
مع تأكيد جميع ذلك وتركيزه بتكرار عرضه بمختلف الأساليب والصور، كل ذلك على أكمل وجه وأرفعه، وبأجمل بيان وأروعه، بنحو يوحي بتعالي قائله ورفعته، وغناه عمن سواه مهما بلغ شأنه.
وكل ذلك غريب عن مجتمع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومحيطه الذي عاش فيه، ويمتنع في العادة أن يهتدي لذلك بنفسه من دون مرشد ومعلم. وحيث سبق أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يتعرف على مَن عنده شيء مِن ذلك، ولم يختلط به، ليكتسبه منه، فلابد أن يكون ذلك من الله تعالى، العالم بكل شيء على حقيقته، والمحيط به، وقد أنزله عليه وعضده به، ليكون دليلاً لدعوته، وشاهداً على رسالته، ومعجزاً لنبوته.
-[ 119 ]-
ولو كابر المكابر، وأصرّ على احتمال تعلمه (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك ممن عاصره، أو اطلع على بعض كتبهم، فقد ردّ الله سبحانه عليه بقوله عزّ من قائل: ((وَلَقَد نَعلَمُ أنَّهُم يَقُولُونَ إنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلحِدُونَ إلَيهِ أعجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ)) (1).
وهو يبتني على الوجه السابق للإعجاز، وهو تميز القرآن بأسلوبه، لأن الأعجمي لا يحسن الكلام العربي، فضلاً عن أن يصوغه بذلك الأسلوب المتميز.
وقد سبق أن ذلك الوجه في الإعجاز هو أهمّ الوجوه، لأنه الذي يدركه عامة الناس، وكان خطابه تعالى بهذا الرد معهم.
تميُّز القرآن عن ثقافة عصرة شاهِدٌ بأصالته
ولنا أن نرد عليه بوجه آخر يتناسب مع الوجه الذي نحن بصدده في إعجاز القرآن الشريف.
وحاصله: أنّ مَن يكتسب العلم بالتعلم مِن الناس..
تارة: ينشأ في جوّ علمي ويتمرس فيه مِن صغره، ويتدرج فيه حتى يبلغ النهاية المطلوبة، كما هو الحال فيمن ينتسب للمراكز العلمية - كالحوزات، والمعاهد، والجامعات - ويعيش فيها.
وأخرى: يأخذ العلم تلقِّياً في مدة قليلة، من أجل أن يتحمله لا غير،
ـــــــــــــــــــــــ
(1) سورة النحل آية: 103.
-[ 120 ]-
مع كونه غريباً عليه غير متمرس فيه.
والأول كثيراً ما يُتقن العلم، ويتمكن فيه، بل قد يحظى بشيء من النبوغ، فيطور العلم ويرتفع بمستواه.
أما الثاني فهو يتحمله عادة بسطحية ورتابة، دون تركيز وأصالة، وبذلك يكون معرضاً للتحوير والتشويه، وضعف الأداء وسوء العرض. وذلك أمر ظاهر يستوضحه كل ممارس.
ومن المعلوم من حال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ليس من القسم الأول، لأنه قضى عمره الشريف في مكة المكرمة بعيداً عن مراكز أهل الكتاب، كما سبق. وغاية ما قد يدعى أنه اطلع على بعض كتبهم أو تعرَّف على بعض مَن يحمل ثقافتهم.
ولكن القرآن الكريم حينما طرح العلوم الإلهية والمعارف الدينية لم يطرحها بالوجه المطروح في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي يتبناه أهل الكتاب، مع سطحية وتشويه، بل ولا مع الحفاظ على ما عندهم بجمود وتقليد، وإنما طرحها طرحاً متميزاً على ما عندهم، أصالة وكمالاً، وسمواً واعتدالاً، ورونقاً وجمالاً، وأفاض في جهات كثيرة لم يطرقوها، مثل قصص أنبياء الله تعالى هود وصالح وشعيب، وكثير من التعاليم الحقة.
بل حتى فيما طرقوه وتحدثوا عنه لم يتحدث عنه حديثاً تابعًا لهم، بل حديثاً مستقلًّا عنهم مهيمنًا على ما عندهم، حيث يتميز عنه بأمور..
الأول: تهذيبه من التناقضات والخرافات والمناكير والمخزيات، التي
-[ 121 ]-
لا تتناسب مع جلال الله وكماله وقدسية رسله وملائكته وأوليائه، ولا مع تعاليمهم الحقة، المطابقة للفطرة.
الثاني: التعديل في بعض ما ذكروه استثناءً أو إضافةً أو تحويرًا، وإن لم يكن ما ذكروه منكرًا، كاستثناء بعض أهل نوح من دخول الفلك، وإضافة بعض المؤمنين غيرهم فيمن دخله، مع أنهم اقتصروا فيمن دخله على نوح وامرأته وأولاده ونسائهم (1). ومثل خيانة امرأة لوط له، وبقائها من دون أن تخرج معه، مع أن المذكور عندهم هو إخراجه لها معه بعد أمره بذلك، المناسب لعدم خيانتها له، إلا إنها التفتت إلى جهة المدينة، فصارت عمود ملح (2). ومثل الاختلاف الكثير في قصة يوسف (عليه السلام) (3).
الثالث: إهمال كثير مما ذكروه من تفاصيل الموضوع ومتعلقاته.
الرابع: تتميم بعض ما ذكروه بإضافة تناسبه وتزيده روعة وتناسقًا، مثل ما تضمَّنه في أمر نبيِّه عيسى وأمه (عليهم السلام)، فإنه أسهب في أمر مريم (عليه السلام)، ونبَّه إلى رفعة شأنها من بدء نشوئها، حيث وُلدت في بيت اصطفاه الله عزوجل، وكفلها نبيًّا من أعاظم أنبيائه، وبلغت طهارتها وعبادتها وقدسيتها حدّاً استحقت به أن ينزل الله سبحانه عليها رزقاً من السماء، ويحدثها ملائكته المقربون، بنحو يناسب تهيئتها لكرامة الله تعالى لها بحملها بعيسى (عليه السلام) - ذي المقام الرفيع في الأنبياء (عليهم السلام) ومن أولي العزم منهم - ودعم عيسى لها
ـــــــــــــــــــــــ
(1) سفر التكوين: الإصحاح السادس والسابع.
(2) سفر التكوين: الإصحاح التاسع.
(3) سفر التكوين: الإصحاح السابع والثلاثون والإصحاح التاسع والثلاثون إلى الإصحاح السادس والأربعين.
-[ 122 ]-
بعد ولادته بكلامه معهم وهي تحمله، بنحو إعجازي يشهد ببراءتها، مع أنه لا إشارة لشيء من ذلك في تعاليم أهل الكتاب.
بل يظهر مما عندهم إنها امرأة عادية كانت خطيبة ليوسف النجار، فحملت بعيسى (عليه السلام) قبل أن يدخل بها، وأن يوسف بعد أن اتهمها في نفسها، وأراد أن يطّلقها من دون أن يشهر بها خوطب في منامه ببراءتها وبحقيقة الأمر (1)، فأبقاها عنده وأولدها أولاداً آخرين ذكوراً وإناثاً صاروا أخوة لعيسى (2)... إلى غير ذلك.
هذا مضافاً إلى الاختلاف الشاسع في المنهج والتبويب، حيث تنهج كتبهم في تعاليمها - نوعاً - إلى التبويب وإشغال كل باب بما يناسبه مستوعباً له،أما القرآن المجيد، فيشيع فيه أسلوب التضمين والجمع في مقام واحد بين أمور مختلفة، من تمجيد الله تعالى والثناء عليه، والتذكير بآياته ونعمه، وسطواته ونقمه، وتكريم ملائكته ورسله وخاصّة المؤمنين وعامّتهم، وذم أعدائه من الشياطين والكافرين والمنافقين، والقصص والتاريخ، والأحكام والآداب، والاحتجاج، والأمثال والحكم والعبر، والترغيب والترهيب وغيرها، والانتقال من موضوع لآخر بأدنى مناسبة، بإيجاز أو تفصيل حسب اختلاف الموارد.
وذلك كله لا يناسب أخذ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) القرآن الكريم ممن سبقه من أهل الكتاب، أو مما سبقه من كتبهم التي هي في المتناول، بل يناسب
ـــــــــــــــــــــــ
(1) إنجيل متّى: الإصحاح الأول: 18ـ21.
(2) إنجيل متّى: الإصحاح الثالث عشر: 55، 56.
-[ 123 ]-
تباين المدرستين وإن اتفقتا في بعض الأمور، مع أصالة الثانية وتكاملها ورفعتها وهيمنتها على الأولى، بحيث جاءت لتصحيح أخطائها واستدراك نواقصها وحذف فضولها، كما صرح به القرآن الكريم.
وإن نظرة عابرة في العهدين القديم والجديد يكفي لاستيضاح هبوط مستواهما حدّ التفاهة بحيث لا يكونان طرفاً للمقارنة والموازنة مع القرآن المجيد في عظمة مضامينه ورفعة مستواه.
وبذلك يتعين عادةً كوْن القرآن الكريم وحياً من الله تعالى، لتتم به الحجة على الناس بعد ضياع معالم الأديان السابقة عليهم، بسبب الكتمان والتحريف والتشويه.
-[ 124 ]-
| |
|

|
|
|