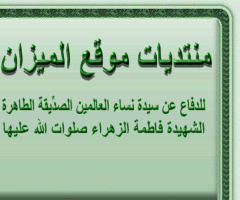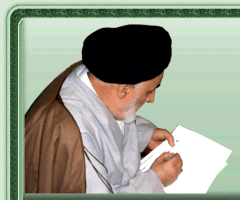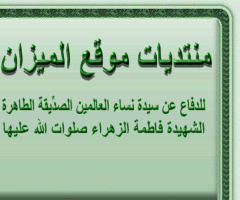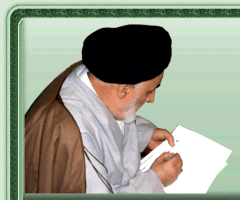(يقول المرجع السيد الحكيم حفظه الله):
-[ 57 ]-
المقصد الأول
في التوحيد
والمُراد به تَفَرُّدُ اللهِ عزّ وجلّ بالأُلُوهِيَّة والخَلْق والتدْبير، وعليه يَتَفَرَّع اسْتِحْقاقُه تعالى للعبادة، وتَفَرُّدُه بذلك.
التوحيد أمْرٌ فِطْرِي ارْتِكَازِي
وهو أمْرٌ قد فُطِر الإنسان عليه مهما كابَر وغالَط، وقد تَرَكَّز في أعماق نفسه وانطوى عليه ضميرُه بطَبْعه مِن دُون تَكَلُّف، ولا حاجةٍ للاستدلال.
ويبدو إذْعَان الجاحِد به المُكابِر فيه عندما تُحِيط به المشاكلُ والمخاطر ويضيق بها، فينهار أَمامَها، ويفقد السيطرة على نفسه، فلا يقوى على كتمان ما انطوت عليه، وينسى مكابرتَه وجحودَه، ويتّجه لا إرادياً لهذا المُدبِّر القادر، ويلجأ إليه في محْنته - وكأنه حاضر عنده لا يغيب عنه - مُخاطباً له طالباً نجْدتَه..
قال الله تعالى: ((وَمَا بِكُم مِن نِعمَةٍ فَمِن الله ثُمَّ إذَا مَسَّكُم الضُّرُّ فَإلَيهِ
-[ 58 ]-
تَجْأرُونَ* ثُمَّ إذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُم إذَا فَرِيقٌ مِنكُم بِرَبِّهِم يُشرِكُونَ)) (1).
وقال سبحانه: ((وَإذَا مَسَّ الإنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أو قَاعِداً أو قَائِماً فَلَمَّا كَشَفنَا عَنهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأن لَم يَدعُنَا إلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلمُسرِفِينَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ)) (2).
وقال عزّ وجلّ: ((هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنهَا زَوجَهَا لِيَسكُنَ إلَيهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَت حَملاً خَفِيفاً فَمَرَّت بِهِ فَلَمَّا أثقَلَت دَعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِن آتَيتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِن الشَّاكِرِينَ* فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشرِكُونَ)) (3).
وقال عزّ من قائل: ((هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُم فِي البَرِّ وَالبَحرِ حَتَّى إذَا كُنتُم فِي الفُلكِ وَجَرَينَ بِهِم بِرِيح طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُم المَوجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أنَّهُم أُحِيطَ بِهِم دَعَوا اللهَ مُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِن أنجَيتَنَا مِن هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِن الشَّاكِرِينَ)) (4).
وفي الحديث: "قال رجل للصادق (عليه السلام) :
يا ابن رسول الله دُلَّنِي على الله ما هو؟ فقد أكثر عليّ المُجادِلُون وحيَّرُوني.
فقال له: يا عبد الله هل ركبْتَ سفينةً قَطّ؟
قال: نعم.
قال: فهل كُسِرَت بك حيث لا سفينة تنْجيك ولا سباحة تغْنيك؟
قال: نعم.
قال: فهل تَعَلَّق قلبُك هناك أنّ شيئاً مِن الأشياء
ـــــــــــــــــــــــ
(1) سورة النحل آية: 53ـ54.
(2) سورة يونس آية: 12.
(3) سورة الأعراف آية: 189ـ190.
(4) سورة يونس آية: 22.
-[ 59 ]-
قادِر على أنْ يخلّصك مِن ورطتك؟
قال: نعم.
قال الصادق (عليه السلام) :
فذلك الشيء هو الله القادر على الإنْجاء حيث لا مُنْجي، وعلى الإغاثة حيث لا مُغيث" (1).
صِدْق النبي في دعْوى النبوة دالٌّ على التوحيد
أضف إلى ذلك أنّ التوحيد قد تَبَنّاه بإصرارٍ دِينُ الإسلام العظيم الذي جاء به نبيُّنا الأمين (صلى الله عليه وآله وسلم)، فكلما دلّ على صدق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في نبوته وفيما بلّغ به - مما يأتي في محله إن شاء الله تعالى – (فهو)يَدُلّ على التوحيد، لأنه أساسُ دينِ الإسلام، وأولُ أمرٍ ادّعاه (صلى الله عليه وآله وسلم) ودعا الناس إلى الإقرار به، وعليه أكّد القرآن المجيد الذي هو معجزته الخالدة، كما لا يخفى.
بل هو مما تَبَنَّته الأديان السماوية جميعًا، وحتى بعض الأديان الأخرى.
وأما ما اعْتَنَقَته بعضُ الطوائف المسيحية مِن التَّثْلِيث، فمِن البعيد جدّاً رُجُوعُه إلى تعدُّد الخالق المدبِّر للكون، بل الظاهِر رُجوعُه إلى أنّ الخالق الواحد قد اتّحَد مع الأقانيم، فاستحق الكلُّ العبادةَ. وإنْ كان تحديد مرادهم في غاية الإشكال. على أنّ الظاهِر(والمَعْلُوم) أنّ عقيدة التثليث طارِئة على المسيحية (2)، والأمْرُ ليس بمهمٍّ بعد ما سبق(مِن أنّ التوحيد فِطْرِيّ،ويدلّ عليه كلُّ ما دَلَّ على نبوة النبي صلى الله عليه وآله).
ومع كل ذلك فيَحْسُن بنا الاستدلال على التوحيد تَأْكِيداً للحجّة،
ـــــــــــــــــــــــ
(1) بحار الأنوار 3: 41.
(2) دائرة معارف القرن العشرين 2: 759 في مادة: الثالوث.
-[ 60 ]-
وقطْعاً للمعاذير، ولسَدّ الطريق على المكابر والمعاند. وينحصر الدليل عليه - بعد ما سبق - بالعَقْل، الذي تقدم في التمهيد التنبيهُ لأهميته، وأنّ عليه المَدار، وأنه الحجة الباطنة، كما تضمنته الأخبار.
ومِن الظاهر أنّ التوحيد يرجع إلى أمرين:
إثْبَات الخالق، وأنه واحِدٌ لا شريك له، فالكلام فيه يقع في فصلين..
-[ 61 ]-
الفصل الأول
في إثبات الخالق
وتمهيداً للاستدلال على ذلك نقول:
تَقْسِيم الأشْيَاء إلى مُمْتَنِع ومُمْكِن وواجِب
كُلّ أمْرٍ يُفْرَض، إذا عُرِض على العَقْل فهو بِفِطْرَتِه..
تارَةً: يَمْنَع مِن وُجوده لِذَاتِه، بحيْث يَرَاه العقلُ مُمتنِعاً بِنَفْسه، بلا حاجة إلى أمْرٍ خارجيٍّ يَمْنَع منه.
وأخرى: لا يَمْنَع مِن وُجوده لذاته، وإنْ أمْكَن أنْ يَمْتَنِع لأَمْرٍ طارئ خارِج عن الذات.
فالأوّلُ(المُمتنع لذاته) كاجْتِمَاع النَّقِيضَيْن - وهما الوجود والعَدَم - وكارْتِفَاعهما بالإضافة لشيءٍ واحدٍ في زمانٍ واحد، حيث لابدّ في كلّ شيءٍ إمّا أنْ يكون موجوداً أو مَعْدُومًا، ولا يُعْقَل أنْ يكون موجوداً ومعدوماً في زمان واحد، كما لا يُعْقَل أنْ لا يكون موجوداً ولا معدومًا.
وكذا اجتماع الضِّدَّيْن - كالسواد والبياض، والحركة والسُّكُون - في
-[ 62 ]-
مَحَلٍّ واحد في آنٍ واحد.
وكَصَيْرُورَة الأربعةِ فرْدًا، والخمسةِ زوْجًا، بمَعْنَى أنْ لا تَنْقَسِم الأربعةُ إلى عددين متساويين مِن دُون كَسْر، وأنْ تنقسم الخمسة إلى عددين متساويين مِن دُون كسْر.
فإنّ هذه الأمور ونحوها إذا عُرِضَت على العقل مَنَع بفطرته مِن تَحَقُّقِها، وحَكَم حُكْماً قاطعاً بامْتناعها لذاتها.
والحكم المذكور بَدِيهِيٌّ يُدْرِكُه الإنسانُ بفطرته، بِلا تَكَلُّفِ استدلالٍ. ومَن يُنكره مكابرٌ لا يَحْسُن الحديث معه، بل يتعيّن ترْكه وما اختار لنفسه، حتى يرجع عن خطئه إنْ حالفه حظّه.
وأما الثاني - وهو الذي لا يَمْنَع العقلُ عن وُجوده - فيُمْكن فَرْضُه بأحد وجهين:
أولهما: أنْ يكون لازِمَ الوُجُود لِذَاتِه، بأنْ تكون ذاتُه مُسْتَلْزِمَةً لِوُجُوده. وهو المُعَبَّر عنْه بِوَاجِب الوُجُود، في قِبَال القسم الأول الممتنع الوجود.
واجِب الوُجُود أَزَلِيٌّ خَالِد
ولازِمُ ذلك..
أولاً: أنْ يكون مُسْتَغْنِياً في وجوده عن غيره، ولا يَحْتاج إلى عِلَّةٍ تُوجِدُه.
وثانياً: أنْ يكون وُجودُه قَدِيماً أزليّاً لا مَبْدَأَ له، وخالِداً سَرْمَدِيّاً لا مُنْتَهَى له.
-[ 63 ]-
إذ لو لم يَكُن قديماً أزليًّا، أو لم يَكُن خالداً سرمديًّا، لكان عَدَمُه ممكنًا، بل حاصِلاً، أو يَحْصَل لاحِقًا، وهو(عَدَمُه) خِلاف فَرْضِ كَوْنِه واجبَ الوجود(ونحن افترضنا أنه واجب الوجود).
وعَكْسُه في الأمْرَينِ معاً القسم الأول، وهو ممتنع الوجود، فإنّ امْتِنَاعَ وجودِه يَسْتَلْزِم كَوْنَ عَدَمِه قديماً وخالدًا، كما هو ظاهِر.
لابدّ في وُجودِ مُمْكِنِ الوُجودِ مِن عِلَّةٍ مُوجِدَةٍ له
ثانيهما: أنْ لا يَكُون بِذَاتِه لازِمَ الوجود، بل كما يمكن وجودُه يمكن عَدَمُه.
ومثل هذا لابدّ أنْ يكون حادِثاً مُفْتَقِراً في وجوده إلى غيْره، بأنْ يَسْتَنِد وجودُه للغيْر، ويكون ذلك الغيْرُ هو العِلَّة له والسبَب في وجوده. ويمتنع وجوده مِن دُون علةٍ، لِعَدَم المُرَجِّح لوجوده على عدمِه بَعْد إمْكَانِ كلٍّ منهما في ذاته.
وإلى هذا يَرْجِع ما اشْتَهَر مِنْ أنّ كلَّ أثَرٍ لابدّ له مِن مُؤَثِّر، وأنه يَسْتَحِيل وجود الشيء مِن غير علةٍ، فإنّ مُرَادهم بذلك هو الأَثَر الحادِث الذي يمكن كلٌّ مِن وجوده وعدمه، دُونَ واجب الوجود لذاته، أو ممتنع الوجود لذاته.
بَدَاهَة احْتِياجِ الأثر للمُؤَثِّر
هذا، وقَضِيَّةُ أنّ كلّ أَثَرٍ حَادِثٍ لابدّ له مِن علّة مُؤثِّرة، وأنه يَمْتَنِع تَحَقُّقُه بِنَفْسِه مِن دُون علّة، مِن القضايا البديهية التي فُطِر الإنسانُ على
-[ 64 ]-
إدْرَاكها والإقْرَار بها قَلْباً ولِسَانًا، والجَرْيِ عليها عَمَلاً. كما نراه مِن حال كلِّ إنسان ذي شُعُورٍ بالإضافة إلى كلِّ حَدَثٍ كبير وصغير جليل وحقير.
فنرى أهْلَ العلم والمعرفة على اختلاف معارفهم - مِن طب وكيمياء وفيزياء وغيرها - عندما يَرَوْن أيَّ شيءٍ يَتَعَلَّق بمعارفهم (فإنّهم)يبْحثون عن أسبابه ومناشئه ومؤثراته، ويتدرّجون في التعرُّف عليها وضبطها، ثم التعرف على عِلَل تلك الأسباب وهكذا. وبذلك تزداد معارفهم وترتفع مستوياتهم في مختلف العلوم والفنون.
ولا يَضَعُون في حِسَابهم فَرَضِيَّةَ حُصُول الحَدَث مِن دُون سَبَب.
وشَأْنهم في ذلك شأن عامة الناس حينما يُدْركون المؤثِّرات مِن طريق آثارها، جليلةً كانت - كاحْتراق الدُّور، وفيضان الأنهار - أو حقيرةً - كاختلاج العين، وتصدُّع الإناء - حيث لا يَرْتابون في أنّ وراء جميع ذلك أسباباً وعللاً ظاهرة أو خفيّة.
ومَن كابر وأنكر ذلك هنا فقد كذّب نفسَه في سائر الموارد مما يعرض له، كإنسان عادي، أو كصاحب اختصاص في جهة من جهات المعرفة.
وذلك شاهِدٌ بأنّ هذه القضية مِن الضَّرُورِيَّات العَقْلِيَّة البديهية، التي يَحْتَجّ بها الله تعالى على عباده، ولا ينكرها إلا معاند مكابر، لا يحسن الحديث معه، ولا ينفعه إنكاره بعد قيام الحجة ووضوحها.
-[ 65 ]-
لابد مِن استناد العالَم إلى عِلّةِ العِلَل
وإذا عرفت ذلك فنقول:
هذا العالَـم الذي نتعرّف عليه - على اختلافنا في مقدار التعرف ومراتب المعرفة - مَلِيءٌ بالحركة الدائبة، والحوادث المتعاقبة، مِن ليل، ونهار، وزوابع، وأمطار، ومرض، وشفاء، وراحة، وعناء، وحياةِ مولودٍ، وموتِ مفقودٍ... إلى غير ذلك مما لا يُحصى كثرةً، ويدركه عامّة الناس، أو خاصّتهم مِن ذوي العلم والمعرفة.
ولا مَجَالَ لِكَوْنِه بحَوَادثه مُسْتَغْنِياً عن المُؤَثِّر، لِمَا سبق مِن أنّ الاسْتِغْنَاء عن المؤثر خاصٌّ بواجب الوجود الذي لو كان (لو وُجِد) لكان أزليّاً خالدًا، والحوادثُ المذكورة ليست كذلك، فلابد مِن كوْنها مُمْكنةً، وقد سبق أنّ الممكن محتاجٌ إلى العلة المؤثرة، بل هي(الحوادث) بالوجدان مستندةٌ إلى أسبابها وعللها التي نُدْرِكُها، فالإحراق والنور مُسَبَّبان عن النار، والمطر مُسَبَّبٌ عن احتكاك الغيوم في الجوّ، والولد مسبب عن اتصال أبويه جنسيًّا... إلى غير ذلك مما لا يسعه الإحصاء.
ثم نَنْقُل الحديثَ إلى تلك الأسباب والعِلَلِ، التي هي حادِثةٌ أيضًا، تَبَعاً لأسبابها وعللها... وهكذا نَجْرِي صُعُوداً في سلسلة العلل والأسباب، ولابد بالآخِرَة مِن أنْ نَنْتَهِي إلى علّةٍ قديمة، وسبَبٍ أزليٍّ مُسْتَغْنٍ بنفسه عن العلة والسبب، لكوْنه واجبَ الوجود لذاته.
وذلك هو الله تعالى شأنه الخالق المدبر لهذا الكون. وبذلك يتم الاستدلال على وجوده تعالى لو كان خفيًّا.
-[ 66 ]-