|
حـتـى بــيــعـــة الــعــقــبــة
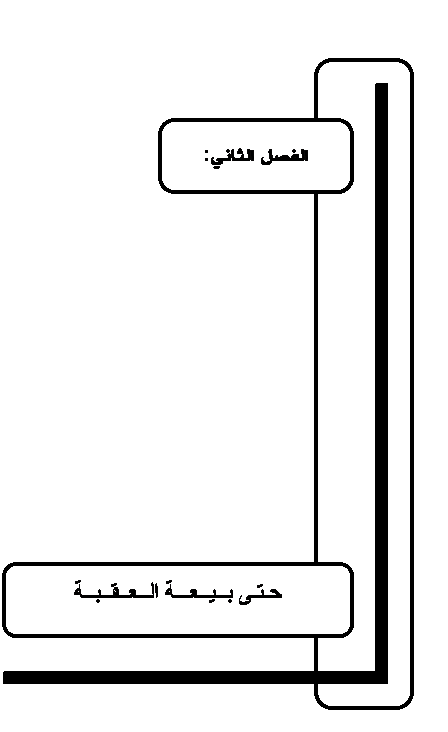
بيعة
العقبة الأولى:
يقول المؤرخون:
إنه حينما عاد أولئك النفر المدنيون الذين أسلموا إلى
المدينة ذكروا لأهلها رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»،
ودعوهم إلى الإسلام، حتى فشا فيهم، فلم يبق دار من دور الأنصار إلا
وفيها ذكر من رسول الله «صلى
الله عليه وآله».
حتى إذا كان العام المقبل أي في السنة الثانية عشرة من
البعثة، وافى الموسم اثنا عشر رجلاً اثنان منهم أوسيان، والباقون من
الخزرج، فالتقوا مع الرسول
«صلى
الله عليه وآله»
في العقبة، وبايعوه على بيعة النساء، أي البيعة التي لا تشتمل على حرب،
أي:
«على
أن لا يشركوا بالله شيئاً، ولا يسرقون، ولا يزنون، ولا يقتلون أولادهم،
ولا يأتون ببهتان يفترونه من بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصونه في معروف،
فإن وفوا فلهم الجنة وإن غشوا من ذلك شيئاً فأمرهم إلى الله عز وجل، إن
شاء عذب، وإن شاء غفر».
ولما رجعوا إلى المدينة أرسل النبي
«صلى
الله عليه وآله»
معهم
مصعب بن عمير ليقرئهم القرآن، ويعلمهم الإسلام، ويفقههم في الدين، فكان
يسمى المقري،
وألحقه بابن أم مكتوم([1])
كما قيل.
وأقام مصعب أول صلاة جمعة في المدينة!!. وقد نجح مصعب،
ومن معه ممن أسلم في الدعوة إلى الله تعالى، وأسلم سعد بن معاذ، الذي
كان السبب في إسلام قومه بني عمير بن عبد الأشهل، حيث إنه حين أسلم على
يد مصعب رجع إلى قومه، فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف
تعرفون أمري فيكم؟
قالوا:
سيدنا وأفضلنا
رأياً، وأيمننا نفساً وأمراً.
قال:
فإن كلام
رجالكم ونسائكم عليَّ
حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله.
قال:
فوالله، ما
أمسى في دار قبيلة بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً، أو مسلمة([2])،
فأسلموا كلهم في يوم واحد، (إلا عمرو بن ثابت، فإنه تأخر إسلامه إلى
أحد، فأسلم، ثم استشهد قبل أن يسجد لله سجدة واحدة، كما قيل).
وأقام مصعب بن عمير يدعو الناس إلى الإسلام، حتى أسلم
الرجال والنساء من الأنصار باستثناء جماعة من الأوس، اتبعوا في ذلك أحد
زعمائهم، الذي تأخر إسلامه إلى ما بعد هجرة الرسول الأعظم
«صلى
الله عليه وآله»([3]).
ولنا هنا وقفات، فلنقف أولاً مع:
إن الدعوة إلى الله ليست مختصة بالأنبياء والأوصياء بل
هي شاملة لكل مكلف بحسب ما يملك من طاقات وقدرات.
وهي من الأمور التي يلزم بها العقل الفطري السليم،
ويوجبها على كل إنسان، ولا تحتاج إلى جعل شرعي؛ فإن العقل يدرك أن في
ارتكاب المنكرات، وترك الواجبات، والانحراف في الفكر والعقيدة والسلوك
ضرراً جسيماً على المجتمعات وعلى الأجيال ولذلك فهو يحكم بلزوم الدعوة
إلى الالتزام بالخط الفكري الصحيح، وترك المنكر، وفعل المعروف.
وهذا هو ـ بالذات ـ ما يفسر لنا اندفاع سعد بن معاذ في
الدعوة إلى الله تعالى، حتى إنه على استعداد لقطع كل علاقة مع قومه إذا
كانوا ضالين منحرفين.
وإن عظمة هذا الموقف لتتضح أكثر إذا عرفنا مدى ارتباط
سعادة ومصير الإنسان العربي في تلك الفترة بقبيلته ومدى ارتباطه بها
فهو حين يضحي بعلاقاته القبلية، فإنه يكون قد ضحى بأمر عظيم وأساسي في
حياته وفي مصيره، ومستقبله، في سبيل دينه.
وقد جاء القرآن مؤيداً
لحكم العقل والفطرة هذا؛ ففرض على كل من كان له بصيرة في أمر الدين
أن
يدعو إلى الله،
قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي
أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾([4]).
كما أننا لا بد أن نشير أيضاً:
إلى أن من عرف الحق، وذاق حلاوة الإيمان، فإنه لا يملك نفسه من
الاندفاع في محاولة لجلب الآخرين نحو هذا الحق، وجعلهم يؤمنون به،
ويستفيدون منه، ويلتذون به ويشعرون بحلاوته.
ولذلك نجد الإمام علي بن الحسين
«عليه
السلام»،
الذي كان يخشى على شيعته، الذين هم الصفوة في الأمة الإسلامية، والذين
كانوا يتعرضون لمختلف أنواع الاضطهاد، والبلايا في الدولة الأموية،
وبعدها في الدولة العباسية كان يظهر تذمره من عدم مراعاة الشيعة للظروف
والمناسبات، وهو يرى حدة اندفاعهم نحو إظهار أمرهم، بسبب شعورهم بحلاوة
الإيمان، وضرورة إبلاغ كلمة الحق، قال الإمام السجاد
«عليه
السلام»:
«وددت
أني افتديت خصلتين في الشيعة ببعض لحم ساعديّ: النزق وقلة الكتمان»([5]).
أضف إلى ذلك:
أن التراحم
فيما بين المؤمنين، والشدة على الكافرين يصبح أمراً طبيعياً، كما قال
تعالى: ﴿أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاء بَيْنَهُمْ﴾([6]).
ونجد:
أن نص البيعة
قد تضمن الخطوط العريضة، وأهم المبادئ التي يقوم عليها المجتمع
الإسلامي، وهي تتضمن جانباً عقائدياً، وآخر عملياً،
وقد حملهم «صلى
الله عليه وآله»
مسؤوليات معينة في علاقاتهم مع بعضهم بعضاً.
وجعل التزامهم هذا قائماً على إعطاء تعهد من قبلهم،
يرون مخالفته تتنافى مع شرف الكلمة وقدسيتها؛ وذلك تحت عنوان:
«البيعة»
التي تعني إعطاء كلمة الشرف بالالتزام بتلك المبادئ.
ولكنه لم يقرر عقاباً عنيفاً لمن ينقض هذا العهد،
ويتجاوز ويغش فيه؛ فإن الوقت حينئذٍ لم يكن مناسباً لقرار كهذا.
بل أوكل ذلك إلى الوجدان والضمير الشخصي لكل منهم، مع
ربطه بالمبدأ العقيدي،
ومع إعطاء الفرصة له للعودة لإصلاح الخطأ إن كان؛
حيث أبقى الأمل حياً لدى ذلك الذي يمكن أن يغش، وأوكل أمره إلى الله،
إن شاء عذب، وإن شاء غفر.
وقد تقدم في الحديث:
أن مصعب بن
عمير قد جمع بالمسلمين في المدينة قبل الهجرة([7]).
وربما يشكل على ذلك:
بأن سورة
الجمعة قد نزلت بعد هجرته «صلى
الله عليه وآله»
إلى المدينة؛ فكيف صلى مصعب الجمعة قبل تشريعها؟
والجواب:
أننا لو سلمنا أن المراد بجمع، صلى الجمعة.
إذ من المحتمل:
أن يكون
المراد صلى جماعة ـ لو سلمنا ذلك ـ فإن قوله تعالى في سورة الجمعة:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ
الله﴾
ليس المقصود به تشريع إقامة الجمعة، وإنما هو يوجب السعي إلى الجمعة
التي تقام، فلعل وجوب إقامتها كان قبل ذلك قد جاء على لسانه
«صلى
الله عليه وآله»
في مكة، ولكن لم يكن يمكن إقامتها، أو كان يقيمها سراً
ولم يصل ذلك إلينا.
ويؤيد ذلك قوله تعـالى:
﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لهَواً
انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِندَ الله خَيْرٌ
مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ﴾([8])؛
فإن ذلك يشير إلى أن الجمعة كانت قد شرعت قبل ذلك، وأن هذا كان سلوكهم
معه «صلى
الله عليه وآله».
ويؤيد ذلك:
ما أخرجه
الدارقطني، عن ابن عباس، قال: أذن النبي
«صلى
الله عليه وآله»
الجمعة قبل أن يهاجر، ولم يستطع أن يجمع بمكة؛ فكتب إلى
مصعب بن عمير: أما بعد، فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور،
فاجمعوا نساءكم وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم
الجمعة، فتقربوا إلى الله بركعتين.
قال:
فهو أول من
جمع، حتى قدم النبي «صلى
الله عليه وآله»
المدينة، فجمع بعد الزوال من الظهر، وأظهر ذلك([9]).
وثمة روايات تفيد:
أن أول من جمع
بهم هو أسعد بن زرارة([10])
وسيأتي بعض الكلام أيضاً حول صلاة الجمعة في آخر هذا الجزء إن شاء الله
تعالى.
وعاد مصعب بن عمير من المدينة إلى مكة، فعرض على النبي
«صلى
الله عليه وآله»
نتائج عمله؛ فسر بذلك نبي الإسلام سروراً عظيماً([11]).
وفي موسم حج السنة الثالثة عشرة من البعثة أتى من أهل
المدينة جماعة كبيرة بقصد الحج، ربما تقدر عدتهم بخمس مئة([12])،
فيهم المشركون، وفيهم المسلمون المستخفون من حجاج المشركين من قومهم،
تقية منهم.
والتقى بعض مسلميهم بالرسول
«صلى
الله عليه وآله»
ووعدهم
اللقاء في العقبة في أواسط أيام التشريق ليلاً، إذا هدأت الرجل،
وأمرهم أن لا ينبهواً نائماً، ولا ينتظروا غايباً.
ويلاحظ هنا:
ما لهذا التوقيت من أهمية، فلو انكشف أمرهم، فسيكون ذلك
بعد تمام حجهم، ومفارقتهم للبلد، ولا يبقى من ثم مجال للضغط عليهم بشكل
فعال.
ويلاحظ كذلك:
أمره
«صلى
الله عليه وآله»
لهم بأن لا ينبهوا نائماً، ولا ينتظروا غائباً، وذلك كي لا ينكشف أمرهم
إذا لاحظ غيرهم عدم طبيعية تصرفاتهم.
وفي تلك الليلة بالذات ناموا مع قومهم في رحالهم، حتى
إذا مضى ثلث الليل بدؤوا يتسللون إلى مكان الموعد، واحداً بعد الآخر،
ولا يشعر بهم أحد حتى اجتمعوا في الشعب عند العقبة، وهم سبعون أو ثلاثة
وسبعون رجلاً، وامرأتان.
والتقوا بالرسول
«صلى
الله عليه وآله»
هناك
في الدار التي كان «صلى
الله عليه وآله»
نازلاً
فيها، وهي دار عبد المطلب، وكان معه حمزة وعلي، والعباس([13]).
وبايعوه على أن يمنعوه وأهله مما يمنعون منه أنفسهم،
وأهليهم وأولادهم، وأن يؤووهم، وينصروهم، وعلى السمع والطاعة في النشاط
والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف، والنهي عن
المنكر وأن يقولـوا
في الله، ولا يخافـوا
لـومة
لائم، وتدين لهم العجم، ويكونون ملوكاً،
وعند آخرين ـ والنص لمالك ـ عن عبادة بن الصامت:
«بايعنا
رسول الله «صلى
الله عليه وآله»
على
السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر
أهله وأن نقول (أو نقوم) بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم»([14]).
قال السيوطي:
«يريد
الملك والإمارة»([15]).
وقد أدرك العباس بن نضلة خطورة الموقف، ولا سيما من
قوله «صلى
الله عليه وآله»:
«وتدين
لكم العجم، وتكونون ملوكاً»،
وأنهم مقدمون على مواجهة ومقاومة، ليس فقط مشركي مكة أو الجزيرة
العربية، وإنما العالم بأسره،
فأحب أن يستوثق من الأمر، ويفتح عيون المبايعين ليكونوا على بصيرة من
أمرهم، حتى لا يقولوا في يوم ما: لو كنا نعلم أن الأمر ينتهي إلى هذا
لم نقدم.
فقال لهم:
يا معشر الأوس والخزرج، تعلمون على ما تقدمون عليه؟
إنما تقدمون على حرب الأحمر والأبيض، وعلى حرب ملوك الدنيا؛ فإن علمتم
أنه إذا أصابتكم المصيبة في أنفسكم خذلتموه وتركتموه، فلا تغروه فإن
رسول الله، وإن كان قومه خالفوه، فهو في عز ومنعة.
فقال عبد الله بن حزام، والد جابر، وأسعد بن زرارة،
وأبو الهيثم بن التيهان: مالك وللكلام؟!
يا رسول الله، بل دمنا بدمك، وأنفسنا بنفسك، فاشترط
لنفسك، ولربك ما شئت([16]).
ويذكر أيضاً:
أن أسعد بن زرارة قد قال في بيعة العقبة: يا رسول الله،
إن لكل دعوة سبيلاً، إن لين، وإن شدة، وقد دعوت اليوم إلى دعوة متجهمة
للناس، متوعرة عليهم: دعوتنا إلى ترك ديننا واتباعك على دينك، وتلك
رتبة صعبة، فأجبناك إلى ذلك.
ودعوتنا إلى قطع ما بيننا وبين الناس من الجوار
والأرحام، القريب والبعيد، وتلك رتبة صعبة؛ فأجبناك إلى ذلك.
ودعوتنا، ونحن جماعة في دار عز ومنعة، لا يطمع فيها
أحد: أن يرأس علينا رجل من غيرنا، أفرده قومه، وأسلمه أعمامه، وتلك
رتبة صعبة، فأجبناك إلى ذلك
الخ..([17]).
ويذكر المؤرخون هنا أيضاً:
أن العباس بن عبد المطلب قد حضر بيعة العقبة وأنه أراد
أن يستوثق لابن أخيه فبدأ هو الكلام، فقال: يا معشر الخزرج، إن محمداً
منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا، ممن هو على مثل رأينا، فهو في
عز من قومه، ومنعة في بلده، وقد أبى إلا الانحياز إليكم، واللحوق بكم،
فإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه، ومانعوه ممن خالفه، فأنتم
وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به
إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده.
وفي رواية، أنه قال لهم:
قد أبى محمد الناس كلهم غيركم، فإن كنتم أهل قوة وجلد، وبصر في الحرب،
واستقلال بعداوة العرب قاطبة، ترميكم عن قوس واحدة فروا رأيكم،
وائتمروا بينكم إلخ..
وبعد أن استمع إلى إجابتهم، طلب
«صلى
الله عليه وآله»
منهم:
أن يخرجوا له اثني عشر نقبياً، أي كفيلاً يكفل قومه، فأخرجوا له تسعة
من الخزرج، وثلاثة من الأوس؛ فكانوا نقباء وكفلاء قومهم،
وعرفت قريش بالاجتماع؛ فهاجت، وأقبلوا بالسلاح،
وسمع الرسول «صلى
الله عليه وآله»
النداء؛ فأمر الأنصار بالتفرق، فقالوا: يا رسول الله، إن أمرتنا أن
نميل عليهم بأسيافنا،
فعلنا.
فقال:
لم أؤمر بذلك، ولم يأذن الله لي في محاربتهم، فقالوا:
يا رسول الله، فتخرج معنا؟
قال:
أنتظر أمر الله..
فجاءت قريش على بكرة أبيها، قد حملوا السلاح،
وخرج حمزة، ومعه السيف، هو وعلي بن أبي طالب
«عليه
السلام».
فلما نظروا إلى حمزة قالوا:
ما هذا الذي اجتمعتم له؟.
فعمل حمزة بالتقية من أجل الحفاظ على النبي
«صلى
الله عليه وآله»
والمسلمين والإسلام، فقال: ما اجتمعنا، وما ههنا أحد، والله لا يجوز
أحد هذه العقبة إلا ضربته بسيفي،
فرجعوا، وغدوا إلى عبد الله بن أبي، فقالوا له: قد بلغنا أن قومك
بايعوا محمداً على حربنا،
والله، ما من حي أبغض من أن ينشب الحرب بيننا وبينه منكم.
فحلف لهم عبد الله:
أنهم لم يفعلوا، ولا علم له بذلك، وأنهم لم يطلعوه على أمرهم؛ وتفرقت
الأنصار، ورجع رسول الله إلى مكة.
ولكن قريشاً قد تأكدت بعد ذلك من صحة الخبر؛ فخرجت في
طلب الأنصار؛ فأدركوا سعد بن عبادة، والمنذر بن عمير،
فأما المنذر فأعجزهم.
وأما سعد فأخذوه، وعذبوه.
فبلغ خبره جبير بن مطعم، والحارث بن حرب بن أمية،
فأتياه وخلصاه؛ لأنه كان يجير لهما تجارتهما، ويمنع الناس من التعدي
عليها([18]).
ولنا قبل المضي في الحديث ههنا وقفات.
فنشير أولاً: إلى دور العباس في
بيعة العقبة:
تذكر بعض الروايات:
أن العباس كان في بيعة العقبة مع النبي، ولم يكن أحد
غيره معه، ويقولون: إنه وإن كان حينئذٍ مشركاً، إلا أنه أحب أن يحضر
أمر ابن أخيه، ويتوثق له. وقد قدمنا ما ينسب إليه من قول في هذه
المناسبة.
ولكننا نشك في صحة ذلك.
أولاً:
إن في الكلام المنسوب إلى العباس تخذيلاً واضحاً عن النبي
«صلى
الله عليه وآله»،
وليس توثيقاً لأمره كما يقولون، ولا سيما قوله:
«واستقلال
بعداوة العرب قاطبة، ترميكم عن قوس واحدة إلخ»
إلا أن يقال: إن هذا الكلام من العباس، إنما هو لبيان الحقيقة، ليكون
الأنصار على بصيرة من أمرهم، حتى لا يكون منهم أي تعلل في المستقبل.
ثانياً:
إن في كلامه ما يخالف الحقيقة، ولا سيما قوله:
«قد
أبى محمد الناس كلهم غيركم»؛
فإن معناه: أن الناس كلهم غير الأنصار قد وافقوا النبي
«صلى
الله عليه وآله»،
وقبلوا مناصرته، ولكنه هو رفضهم.
مع أن الأمر على عكس ذلك تماماً، باستثناء قبيلة شيبان
بن ثعلبة التي رضيت بحمايته مما يلي مياه العرب، دون ما يلي مياه كسرى([19])
وقبيلة شيبان ليست هي «الناس
كلهم».
واحتمال إرادة خصوص عشيرته لا يتلاءم مع التعبير بـ
«الناس
كلهم».
واحتمال أن تكون العبارة: «أبى
محمداً الناس»
ليس له ما يؤيده، لأن النص الموجود بين أيدينا خلافه.
ثالثاً:
إن موضوع
الهجرة إلى المدينة لم يكن قد طرح بعد، ولم يكن النبي
«صلى
الله عليه وآله»
قد
أُري دار هجرتهم ولا أخبرهم برؤياه تلك، فمن أين علم العباس أن النبي
«صلى
الله عليه وآله»
سوف يهاجر إلى المدينة؟
فهل نزل عليه الوحي في ذلك؟!
لست أدري!! ولكننا نقرأ في كلامه قوله:
«وقد
أبى إلا الانحياز لكم، واللحوق بكم.
إلى أن قال:
وإن كنتم ترون
أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه إلخ..».
إلا أن يكونوا قد طلبوا منه «صلى
الله عليه وآله»
أن
يخرج إليهم، فظهر منه «صلى
الله عليه وآله»
الميل إلى إجابة طلبهم، وإن كان قد جاء ذلك بصيغة: لم
أؤمر بذلك، أي بالهجرة، ولكنه احتمال بعيد ولا شاهد له.
رابعاً:
إن ما ينسب إلى العباس لا يصدر إلا عن مسلم مؤمن تام الإيمان.
ولم يكن العباس قد أسلم بعد بل بقي على شركه إلى وقعة
بدر،
وخرج لحرب النبي «صلى
الله عليه وآله»
فيها
مكرهاً، وأسلم كما سيأتي،
بل سوف يأتي أنه لم يسلم إلى فتح مكة.
إلا أن يكون قد قال ذلك محاماة عن رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»
بدافع
الحمية والعصبية، ولكننا لم نر لهذه الحمية كبير أثر في مواقف العباس
قبل وبعد ذلك،
وهذا أمر يثير العجب حقاً.
والذي نرجحه:
هو أن الذي
كان حاضراً وتكلم بكلام يهدف منه إلى شد العقدة له
«صلى
الله عليه وآله»
هو العباس بن نضلة الأنصاري([20])
وليس العباس بن عبد المطلب.
ولذا يلاحظ مدى التشابه بين كلاميهما المنقول والمنسوب
إليهما،
فلعل الأمر قد اشتبه على الراوي بين العباسين؛ لتشابه الاسمين، أو لعل
العباسيين أرادوا إثبات فضيلة جليلة لجدهم، بهدف الحصول على مكاسب من
نوع معين، ولعل، ولعل.
وتذكر بعض الروايات الشاذة:
أن أبا بكر قد حضر العقبة، وقد جعله العباس على فم الشعب.
ونحن لا نطيل في بيان بطلان هذا، بعد أن كانت سائر
الروايات تنص على أنه لم يكن إلا حمزة، وعلي، والعباس.
مع الشك في هذا الأخير أيضاً، وأن حمزة وعلياً قد خرجا
إلى فم الشعب حينما علمت قريش بالأمر، وهاجت بالسلاح وذلك في أواخر
لحظات الاجتماع، حسبما تقدم.
إن كون الاجتماع في دار عبد المطلب ليقرب صحة ما ورد من
أن حمزة وعلياً قد حضرا بيعة العقبة، خصوصاً وأنه كان ثمة حاجة إليهما،
ليقفا ذلك الموقف البطولي الرائع في وجه قريش وخيلائها وجبروتها؛
ليمنعاها من دخول الشعب،
ويعطيا الفرصة للمجتمعين للتفرق([21]).
حتى إذا دخلت قريش الشعب لم تجد أحداً؛ فترفع الأمر إلى
ابن أبي؛ فينكر ذلك.
ولولا موقفهما ذاك لكانت قد جرت الأمور على غير ذلك
النهج، ولوقع المسلمون في مأزق حرج وخطير جداً.
والغريب في الأمر:
أننا نجد عدداً من الروايات لا تذكر حضور أمير المؤمنين
«عليه
السلام»،
وأسد الله وأسد رسوله،
مع أنها هي نفسها تذكر قضية تجمهر وهياج قريش، وغضبها من الاجتماع!!
وإن كانت تسكت عن هجومها على الشعب، ودفع حمزة وعلي
لها، بل تكتفي بذكر لقائها مع ابن أبي، ثم تتبعها للمسلمين، وظفرها
بابن عبادة إلى آخر ما تقدم،
وقد فات هؤلاء: أن قريشاً التي عرفت بالاجتماع بعد انفضاضه فغضبت،
وهاجت، ثم اتصلت بابن أبي، فأنكر ذلك، ثم بعد انصراف الحاج لحقت
بالمسلمين، وآذت سعد بن عبادة إلخ، لا يمكن أن تسكت عن الهجوم على محل
الاجتماع، وأخذ الأنصار والنبي «صلى
الله عليه وآله»
بالجرم المشهود، وتكون حينئذٍ معذورة أمام من تريد الاعتذار منهم،
فلماذا سكتت هنا،
وغضبت وتصرفت بعنف هناك؟
وعلى كل حال،
فقد عودنا
هؤلاء أن نرى منهم كثيراً من أمثال هذه الخيانات للحق وللدين؛ لأهداف
دنيوية رخيصة، وصدق المثل الذي يقول: «لأمر
ما جدع قصير أنفه».
ولعلك تقول:
كيف يمكن لرجلين: أن يقفا في وجه قريش ويرداها على
أعقابها؟! وهي في إبان غضبها، وأعلى درجات تحمسها.
والجواب:
أن الرجل
الواحد أيضاً كان يكفي لرد كيد قريش، وذلك
لأن
هذا الرجل أو هذين الرجلين يقف أو يقفان على فم الشعب، حيث لا يمكن أن
يعبر إلا أفراد أو جماعات صغيرة يمكن ردها على أعقابها برد الفئة
الأولى منها.
وقد كان يقال:
إن عمرو بن
عبد ود ـ الذي قتله أمير المؤمنين «عليه
السلام»
ـ يعد بألف فارس، وذلك لأنه وقف على فم الوادي، ومنع
ألف فارس من ورودها، ولم يمكن دخول الألف إلا متفرقين بسبب ضيق المكان.
إن المحافظة على سرية الاجتماع، التي بلغت الحد الذي لم
يستطع حتى من كانوا ينامون مع المسلمين: أن يشعروا بشيء، ولا عرفوا
بغيبة رفقائهم، وكذلك الحال في موعد الاجتماع ومكانه، والطريقة التي تم
بها، رغم ضخامته، واتساع نطاقه ـ إن كل ذلك ـ ليعتبر مثلاً رائعاً،
ودليلاً قوياً على مدى وعي أولئك المسلمين ويقظتهم، وحسن تدبيرهم.
كما أنه برهان آخر على أن اللجوء إلى عنصر السرية لا
يعتبر تخاذلاً، إذا كان المسلمون لا يملكون مقومات الدفاع عن أنفسهم في
مقابل قوى الظلم والطغيان.
وهو دليل آخر على أن التقية التي يقول بها الشيعة وأهل
البيت، ونزل بها القرآن وتحكم بها الفطرة والعقل السليم هي الأسلوب
الصحيح في التعامل مع الواقع بمرونة، ووعي، حينما يكون الباطل هو القوي
مادياً ولا يملك أهل الحق ما يدفع عنهم أو يمنع.
وقد تحدثنا عن موضوع التقية فيما سبق فلا نعيد.
ونجد هنا:
أن النبي
الأعظم «صلى
الله عليه وآله»
قد أخبرهم بما سوف يعترض طريقهم من مشاكل وصعوبات في سبيل نشر الدعوة،
والدفاع عنها،
ليكونوا على علم مسبق بذلك، وعلى بصيرة من أمرهم، ومن دون أي إبهام أو
غموض،
حتى لا يترك لهم في المستقبل مجالاً للاعتذار بأنهم ما كانوا يعرفون:
أن الأمر سوف ينتهي بهم إلى ما انتهى إليه من مصاعب ومتاعب.
بل هو لا يريد أن يشعروا في أنفسهم بالغبن، أو حتى أن
يمر ذلك في وهمهم وخيالهم على الإطلاق.
وهو بذلك يدلل لكل أحد على أنه لا يريد أن يخدع أحداً
بالوعود الخلابة، ولا أن يجعلهم يعيشون الآمال والأحلام الفارغة لأن
الوسيلة عنده جزء من الهدف، رغم أنه في أمس الحاجة إلى نصرتهم، بل هو
لم يجد طيلة فترة دعوته غيرهم.
وإن من طبيعة العربي الالتزام بالعهد، والوفاء بالذمار
وتعتبر كل قبيلة: أنها مسؤولة عن الوفاء بما يلتزم به أحد أفرادها، أو
حلفائها عليها.
وعندما بايع الأنصار النبي على الإيمان والنصرة
ـ
حسبما تقدم ـ أراد أن يلزمهم ذلك بشكل محدد، بحيث
يستطيع أن يجد في المستقبل من يطالبه بالوفاء بالالتزامات والعهود،
وكان أولئك النقباء هم الذين يتحملون مسؤولية الوفاء بتلك الالتزامات.
وهم الذين يمكن مطالبتهم بذلك، لأنهم هم الكفلاء
لقومهم، برضى منهم ومن قومهم على حد سواء.
أما إذا ترك الأمور في مجاريها العامة، فلربما يمكن لكل
فرد أن يتملص ويتخلص من التزاماته، ويلقي التبعة على غيره، ويعتبر أن
ذلك غير مطلوب منه، ولا يمكن بحسب تصوره أن يكون هو كفردٍ مسؤولاً عنه،
وأما بعد أن التزم ذلك أفراد معينون، كل واحد منهم من قبيلة.
فإن المسؤولية قد أصبحت محدودة، ويمكن مطـالبتهم
بالوفاء بالتزاماتهم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك،
لا سيما في مواقف الحرب والدفاع.
وبذلك تبتعد القضية عن الأهواء الشخصية، والأهم من ذلك
عن الفوضى في المواقف العامة، وتدخل مراحل التنظيم والبناء الاجتماعي
على مستوى الفرد والجماعة.
يلاحظ:
أن المشركين قد اهتموا لأمر هذه البيعة جداً، حتى إنهم
تهددوا أهل المدينة بالحرب، مستغلين بذلك ضعف المجتمع المدني، وتفككه
بسبب الحروب الداخلية بين الأوس والخزرج.
نعم، إنهم يهددونهم بالحرب، رغم أن حرباً كهذه لسوف تجر
عليهم أخطاراً جسيمة من وجهة نظر اقتصادية، لأن قوافلهم إلى الشام، محل
تجارتهم المفضل،
كان طريقها على المدينة.
مما يعني:
أن المشركين كانوا يرون في هذه البيعة خطورة قصوى،
تجعلهم يضطرون إلى التضحية بعلاقاتهم الحسنة مع كل من يتقبل هذه الدعوة
ويناصرها، حتى ولو كانوا أهل المدينة، الذين كانوا يكرهون جداً أن تنشب
الحرب فيما بينهم وبينهم، كما تقدم قولهم ذلك لابن أبي.
كما أن ذلك يدلنا على مدى ما كان يتعرض له المسلمون في
مكة من ظلم واضطهاد.
قد تقدم أن من جملة ما اشترطه الرسول الأعظم
«صلى
الله عليه وآله»
على أهل المدينة في ضمن نص البيعة، هو أن لا ينازعوا
الأمر أهله.
وإن
اشتراط ذلك في نص بيعةٍ حساسة جداً في تاريخ الإسلام، ويتقرر مصير
الإسلام على نجاحها وعدمه،
وتعريض هذه البيعة لخطر الرفض والانفصام، فيما لو رفضوا الالتزام بذلك
ـ كما كان الحال بالنسبة لبني عامر، حسبما تقدم ـ
إن
ذلك لمما يدل على أن هذا الأمر كان له أهمية قصوى بالنسبة للرسول
«صلى
الله عليه وآله»
الذي كان رأيه يمثل رأي الإسلام الواقعي.
ويوضح أنه لن يتنازل عنه ولو تعرض لأعظم الأخطار،
مما يعني: أن هذا الأمر ليس له، وإنما هو لله يضعه حيث يشاء،
وأن هذا هو الأمر الذي إذا لم يبلِّغه
فما بلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى.
ويمكن أن نفهم من ذلك أيضاً:
أن الرسول
الأعظم «صلى
الله عليه وآله»
كان من
أول الأمر يمهد السبيل لجهة معينة وإلا، فكيف ينهى الناس عن منازعة
الأمر أولئك الأهل المخصوصين والمؤهلين للملك والخلافة، ثم ينسى أن يعيّن
شخص ذلك الخليفة منهم وليعطف ذلك على ما تقدم من تعيينه ذلك الشخص حين
إنذار عشيرته الأقربين؟!.
ثم على ما يأتي بعد من مواقف وتصريحات وكنايات له
«صلى
الله عليه وآله»،
ولا سيما في قضية الغدير.
كما أننا نجده
«صلى
الله عليه وآله»
لا يأذن للمجتمعين في العقبة بأن يميلوا على قريش
بأسيافهم؛ لأن معنى ذلك هو القضاء على هذا الدين، وعلى حماته الأبرار،
ولا سيما مع قلتهم، وكونهم في الموسم، الذي تجتمع فيه الناس من كل حدب
وصوب، وكلهم على نهج وطريقة ومذاق قريش، ويدورون في فلكها دينياً
وعقائدياً وفكرياً، وحتى مصلحياً أيضاً.
ولن تكون هناك أية فرصة لانتصار الأنصار على عدوهم في
بلاده، وقريش التي ترى في المـدينـة أهمية خاصـة لأنهـا على طريق
قوافلهـا إلى الشـام ـ ولأجل ذلك أطلقت سعد بن عبادة ـ، لن تسكت على
موقف الأنصار هذا.
ويكون لها كل الحق أمام أهل الموسم، وحتى أمام المدنيين
المشركين في أن تضربهم الضربة القاصمة والقاضية، لأنهم في موقف
المعتدي، وعلى قريش أن ترد هذا الاعتداء بالكيفية وبالحجم الذي تراه
مناسباً.
([1])
السيرة النبوية لدحلان ج1 ص151 و 152 والسيرة الحلبية ج2 ص9
وفيه أن الواقدي ذكر أن ابن أم مكتوم إنما قدم المدينة بعد بدر
بقليل، وفي كلام ابن قتيبة أنه قدم المدينة مهاجراً بعد بدر
بسنتين. ثم جمع الحلبي بين الأقوال باحتمال: أن يكون قد علَّم
أهل المدينة ثم عاد إلى مكة، ثم عاد فهاجر بعد بدر.. وهو
احتمال وجيه لا بأس به.
([2])
راجع ما تقدم: في سيرة ابن هشام ج2 ص79 ـ 80 والسيرة الحلبية
ج2 ص14 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص90 والسيرة النبوية لابن كثير
ج2 ص184.
([3])
السيرة النبوية لابن كثير ج2 ص184 وراجع تاريخ الأمم والملوك
ج2 ص90 والسيرة لابن هشام ج2 ص79 ـ 80 والسيرة الحلبية ج2 ص14.
([4])
الآية 108 من سورة يوسف.
([5])
سفينة البحار ج1 ص733 والبحار ج75 ص69 و 72 عن الخصال ج1ص24
والكافي ج2 ص221.
([6])
الآية 29 من سورة الحج.
([7])
راجع: السيرة الحلبية ج2 ص9 والتعليق المغني (مطبوع بهامش سنن
الدار قطني) ج2 ص5 عن الطبراني في الكبير والأوسط.
([8])
الآية 11 من سورة الجمعة.
([9])
الدر المنثور ج6 ص218 عن الدارقطني. والسيرة الحلبية: ج2 ص12.
([10])
الدر المنثور ج6 ص218 عن أبي داود، وابن ماجة وابن حبان،
والبيهقي، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر ووفاء
الوفاء ج1 ص226، والسيرة الحلبية ج2 ص59 وص9 وسنن الدار قطني
ج2 ص5 و 6 وفي التعليق المغني على الدار قطني (مطبوع بهامش
السنن) ص5 قال: الحديث أخرجه أبوداود، وابن ماجة وابن حبان
والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم والبيهقي في سننه.
([11])
وفي البحار ج19 ص12: أن مصعباً قد كتب إلى النبي
«صلى
الله عليه وآله»
بذلك وكذا في إعلام الورى ص59.
([12])
طبقات ابن سعد ج1 قسم 1 ص149.
([13])
إعلام الورى ص59، وتفسير القمي ج1 ص273، والبحار ج19 ص12 ـ 13
و 47 عنهما، وعن قصص الأنبياء، وراجع: السيرة الحلبية ج2 ص16،
والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص152.
([14])
الموطأ المطبوع مع تنوير الحوالك ج2 ص4 وراجع سير أعلام
النبلاء ج2 ص7 ومسند أحمد ج5 ص314 و 316 وسنن النسائي ج7 ص138
و 139 وصحيح البخاري ج4 ص156 والبداية والنهاية ج3 ص164
والسيرة النبوية لابن هشام ج2 ص97 ودلائل النبوة للبيهقي ج2
ص452 ط دار الكتب العلمية والسيرة النبوية لابن كثير ج2 ص204
وصحيح مسلم ج6 ص16 و 17.
([15])
تنوير الحوالك: ج2 ص4.
([16])
راجع ما تقدم في البحار ج19 ص12 و 13 عن إعلام الورى، وراجع:
دلائل النبوة للبيهقي ج2 ص450 ط دار الكتب العلمية وتاريخ
الخميس ج1 ص318 والسيرة النبوية لابن هشام ج2 ص88 والبداية
والنهاية ج3 ص162 والسيرة النبوية لابن كثير ج2 ص201 والسيرة
الحلبية ج2 ص17.
([17])
حياة الصحابة: ج1 ص88 ودلائل النبوة لأبي نعيم: ص105.
([18])
راجع فيما تقدم أي كتاب تاريخي أو حديثي شئت مثل: البحار ج19
ص12 و 13 وإعلام الورى ص57 وتفسير القمي ج1 ص272 و 273 وتاريخ
الخميس ج1 ص318 و 319 ودلائل النبوة للبيهقي (ط دار الكتب
العلمية) ج2 ص450 والبداية والنهاية ج3 ص158 والسيرة النبوية
لابن كثير ج2 ص193 و210 والسيرة الحلبية ج2 ص17 وما قبلها وما
بعدها والسيرة النبوية لابن هشام ج2 ص88 وقبلها وبعدها، وغير
ذلك كثير.
([19])
السيرة الحلبية ج2 ص5 و 16 وراجع السيرة النبوية لابن كثير ج2
ص168.
([20])
الإصابة: ج2 ص271، والبحار: ج19، والسيرة الحلبية: ج2 ص17،
والسيرة النبوية لدحلان: ج1 ص153.
([21])
ويحتمل البعض: أن بعض سفهاء قريش ـ وليس كل قريش ـ قد حاولوا
دخول الشعب فصدهم علي وحمزة ولكننا نقول لا مانع من تجمهر
قريش.. ولكن علياً وحمزة أعاقا وصولها إلى مكان الاجتماع إلى
حين تفرق المجتمعين.
|