|
الخمس بين السياسة والتشريع
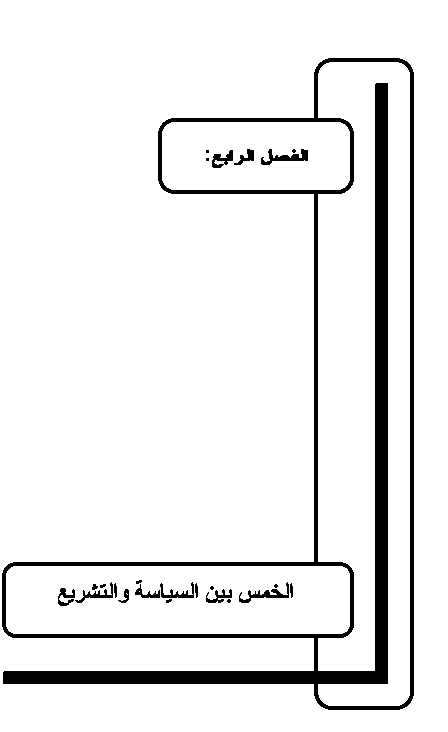
الخمس:
كنت قد وعدت القارئ الكريم بإيراد بعض التوضيحات حول
تشريع الخمس في عهد الرسول «صلى الله عليه وآله»، وحيث إن العلامة
البحاثة الشيخ علي الأحمدي دام تأييده قد تصدى لبحث هذا الموضوع، فنحن
سوف نستفيد قدر الإمكان مما أورده ومع زيادات، وإضافات في المتون
والمصادر، والمراجع بحسب ما رأينا أنه يناسب المقام، فنقول:
قال تعالى:
{وَاعْلَمُواْ
أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}([1]).
يرى علماء بعض فرق المسلمين:
أن الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار في ميدان الحرب
والقتال.
ويرى الشيعة تبعاً لأئمتهم
>عليهم
السلام<:
أنها ـ كما فسرها اللغويون ـ هي مطلق المال المأخوذ بلا
بدل.
قال اللغويون:
الغنم: الفوز بالشيء من دون مشقة. وغنم الشيء، فاز به.
والاغتنام: إنتهاز الفرصة. وغنم الشيء غنماً:
فاز به بلا مشقة، وناله بلا بدل.
وعند الراغب:
أن الغنم إصابة الشيء والظفر به؛ ثم استعمل في كل مظفور
به([2]).
هذا ما ذكره اللغويون في المقام.
وإذا راجعنا استعمالات كلمة «غنم»
في الأحاديث، والخطب، فسوف نجد: أنها تستعمل في مطلق الحصول على الشيء.
وحسبك شاهداً
على ذلك قول علي «عليه
السلام»:
«من أخذ بها لحق وغَنِم»([3]).
و «يرى الغُنم مَغْرَماً والغُرم مَغْنَمَاً»([4])
و «اغْتَنِم مَن استَقْرَضَكَ»([5])
و «الطاعة غَنِيمَة الأكياس»([6]).
وفي الحديث:
«الرهن لمن رهنه له غُنمه
وعليه غُرمه»([7])
و«الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة»([8]).
وقال تعالى:
{فَعِندَ
الله مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ}([9]).
وفي الدعاء عند إعطاء الزكاة عنه «صلى الله عليه وآله»:
«اللهم اجعلها مَغْنَمَاً
ولا تجعلها مَغْرَمَاً»([10])
و «غنيمة مجالس الذكر الجنة»([11])
وفي وصف الصوم: «هو غُنْمُ
المؤمن»([12]).
إلى كثير مما
لا
يمكن حصره واستقصاؤه.
وعليه فالغُنم في اللغة:
هو مطلق الحصول على الشيء.
وأما قيد «بلا مشقة»، الذي أضافه البعض؛ فهو يخالف
موارد الاستعمال السابقة وغيرها. والتزام المجاز فيها يلزم منه أن تكون
أكثر استعمالات هذه الكلمة في الموارد المجازية.
بل إن نفس آية الخمس في القرآن الكريم قد أطلقت على كل
ما يُغْنَم،
ومن جملته ما يحصل في الحرب بعد مشقة.
وأما ما ذكره البعض([13])
من أن هذه الكلمة كانت في الأصل لمطلق الغنيمة، ثم اختصت بغنائم الحرب.
فلا يصح أيضاً؛ لأننا نجد أن استعمالات هذه الكلمة في الحديث الشريف لا
تختص في ذلك، بل هي في غيره أكثر، وعليه أدل. ومع فرض الشك فلا بد من
الحمل على المعنى اللغوي.
إذاً فالآية الشريفة تدل على وجوب الخمس في مطلق ما
يحصل عليه الإنسان، ويظفر به، ولو لم يكن من ميدان الحرب مع الكفار.
وقد اعترف القرطبي: بأن اللغة لا تقتضي تخصيص الآية بغنائم الحرب.
ولكنه قال: إن العلماء قد اتفقوا على هذا التخصيص([14]).
ومعنى كلامه:
أنهم قد اتفقوا على خلاف ظاهر الآية، وخلاف المتبادر
منها.
كما أن كتب النبي «صلى الله عليه وآله» ورسائله إلى
القبائل لتؤكد وتؤيد: أن الخمس كما يجب في غنائم الحرب يجب في غيرها،
وأن المراد من الغنيمة هو المعنى الأعم
؛ فلاحظ ما يلي:
1 ـ
وصية النبي «صلى الله عليه وآله» لبني عبد القيس، الذين
قالوا له «صلى الله عليه وآله»: «إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في أشهر
حرم وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل، نخبر به من
وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة.
فأمرهم «صلى الله عليه وآله» بأربع، ونهاهم عن أربع:
أمرهم بالإيمان بالله وحده.
قال:
أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟
قالوا:
الله ورسوله أعلم.
قال:
شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام
الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس،
ونهاهم إلخ»([15]).
وواضح:
أن عبد القيس كانت قبيلة ضعيفة لا تجرؤ على الخروج من
ديارها إلا في الشهر الحرام؛ ولا تستطيع حرباً
ولا قتالاً.
ويؤيد ذلك أيضاً:
أن المغنم إنما يكون تحت اختيار القائد والأمير، وهو
المسؤول عنه؛ فيأخذ منه الخمس ويرسله، ويقسم الباقي على الأفراد،
وليس له ارتباط بالأفراد
أنفسهم. وظاهر كلامه «صلى الله عليه وآله» المتقدم: أنه «صلى الله عليه
وآله» قد أمرهم بأوامر تختص بالفرد وتكون من وظائفه التي لا بد أن
يمارسها باستمرار أو بكثرة، كالإيمان، والصلاة، والزكاة. وكذلك الخمس؛
فإنه أيضاً على حدها، ولا يختلف عنها.
2 ـ
وكتب «صلى الله عليه وآله» لعمرو بن حزم، حينما أرسله
إلى اليمن، كتاباً
مطولاً
جاء فيه: «وأمره أن يأخذ من المَغَانِمِ
خمس الله»([16])
والكلام في هذه الفقره لا يختلف عن الكلام في سابقتها.
3 ـ
وكتب «صلى الله عليه وآله» لبني عبد كلال اليمانيين، مع
عمرو بن حزم، يشكرهم على امتثالهم ما أمرهم به فيما سبق بواسطة عمرو بن
حزم نفسه، ويقول: «فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خمس الله عز
وجل»([17]).
وواضح:
أننا لم نجد في التاريخ: أن حروباً
قد جرت بينهم وبين غيرهم بعد إسلامهم، وأنهم قد غنموا من تلك الحروب
غنائم، وخمسوها، وأرسلوها مع عمرو بن حزم.
4 ـ
وكتب «صلى الله عليه وآله» لقبيلتي سعد هذيم من قضاعة،
وجذام: «وأمرهم: أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه: أبيّ،
وعنبسة، أو من أرسلاه»([18]).
مع أن هذه القبيلة قد أسلمت جديداً
ولم تخض حرباً
بعد، ليكون المراد خمس المغانم.
5 ـ
وقد أوجب «صلى الله عليه وآله» الخمس في ست عشرة رسالة
أخرى، بل أكثر، كان قد أرسلها إلى القبائل ورؤسائها، وهي: قبيلة بكاء،
وقبيلة بني زهير، وحدس، ولخم، وبني جديس، وللأسبذيين،
وبني معاوية، وبني حرقة، وبني قيل، وبني قيس، وبني جرمز، ولأجنادة
وقومه، وقيس وقومه، ولمالك بن أحمر، ولصيفي بن عامر شيخ بني ثعلبة،
والفجيع ومن تبعه، ونهشل بن مالك رئيس بني عامر، ولجهينة بن زيد، وذكر
أيضاً في رسالة لليمن، ولملوك حمير، ولملوك عمان([19]).
وربما يقال:
إن المراد بكلمة: «مغنم وغنائم، ومغانم» الواردة في تلك
الرسائل هو خصوص غنائم الحرب. ولكن ذلك لا يصح؛ وذلك لما يلي:
1 ـ
إن إعلان الحرب وقيادتها وتدبيرها كان آنئذٍ من شؤون
الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله»، أو من نصبه. ثم من تولى الأمر
بعده من الخلفاء، أو من نصبوه؛ ولم يكن لأي من القبائل أن تتخذ قرار
الحرب من عند نفسها؛ ولا يحدثنا التاريخ عن نشاط حربي مستقل لهم؛ ولو
كان، فالمناسب أن يكتب «صلى الله عليه وآله» بذلك إلى أمرائهم وقوادهم،
الذين يتولون إخراج خمس الغنيمة، وإرساله إليه، ثم تقسيم الباقي على
أهله.
2 ـ
لقد كانت تلك القبائل تعيش في الحجاز، والشام،
والبحرين، وعمان، وأكثرها كان من القبائل الصغيرة، التي لا تقوى على
حرب أحد، ليطلب منها إعطاء خمس غنائم حروبها.
3 ـ
لو كان المراد خمس غنائم الحرب، لكان معنى ذلك هو
السماح لكل أحد بأن يشن حرباً
على العدو، في أي زمان أو مكان شاء، وهذا من شأنه أن يحدث الفوضى،
ويتسبب بمشاكل كبيرة وخطيرة على الدولة الإسلامية. ولا يصدر مثل هذا
التشريع عن عاقل، مدبر وحكيم. مضافاً
إلى أننا لا نجد في التاريخ شيئاً من هذه الفوضى الناشئة عن ممارسة
تشريع كهذا.
4 ـ
قد تقدم: أن هذه الرسائل تتعرض لجملة من الأحكام التي
ترتبط بالأفراد، كالإيمان بالله، وبالنبي، وإعطاء الزكاة، والخمس،
الأمر الذي يجعلنا نكاد نطمئن إلى أن الخمس لا يختلف عن تلك الأحكام في
ماهيته؛
وأنه مما تعم البلوى به
للأفراد؛
لا أنه حكم نادر، لا يرتبط بهم فعلاً،
ولا يتفق لهم ربما في عقود بل قرون كثيرة من الزمن.
وكتب «صلى الله عليه وآله» رسالة لوائل بن حجر، وفيها:
«في السيوب الخمس»([20]).
قال الزيلعي:
«السيب العطاء، والسيوب الركاز»([21]).
وتجد تفسير السيوب بالعطاء في مختلف كتب اللغة.
ولنا أن نتساءل:
لماذا خصوا السيوب بالركاز الذي هو أحد أفراد السيب،
والسيب عام ومطلق؟! وهل ذلك سوى الاجتهاد في اللغة، والتحوير والتزوير
الباطل؟!. من أجل أن يتحاشوا تشريع الخمس في مطلق المغانم!.
كما أنهم قد خصوه بالمال المدفون بالجاهلية. ولا ندري
سر ذلك أيضاً، فإن لفظ سيوب لا اختصاص له في ذلك قطعاً. كما أنه قد كان
مستعملاً
في الجاهلية أيضاً، ولا يعقل أن يعتبره أهل الجاهلية: أنه المال
المدفون في الجاهلية!!.
والظاهر:
أنهم أرادوا أن يوهمونا بأنه بذلك يصير غنيمة من
الكفار، الذين يجب حربهم، ليوافق مذهبهم في الخمس.
ونحن نقول:
إن كتب اللغة تنص على أن السيب هو المهمل، والسائبة هي
الحيوان بلا صاحب ومراقب. وقد كانت الناقة تسيب في الجاهلية أي تهمل.
وفي الحديث:
كل عتيق سائبة.
وهذا يقرب:
أن يكون المراد بالسيوب: كل متروك ومهمل، لا يدخل في
حاجة الإنسان فيجب فيه الخمس.
وكتب «صلى الله عليه وآله» إلى بعض
قبائل العرب:
«إن لكم بطون الأرض وسهولها، وتلاع الأودية، وظهورها،
على أن ترعوا نباتها، وتشربوا ماءها، على أن تؤدوا الخمس»([22]).
وسياق الكلام ظاهر ظهوراً
تاماً
في أن المراد ليس خمس غنائم الحرب، إذ لا مناسبة بين ذلك وبين جعل بطون
الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها لهم، ثم بين رعي نباتها، وشرب
مائها، وبين الخمس، إلا أن يكون خمس ما يحصلون عليه من ذلك الذي جعله
لهم.
ويؤيد ذلك ويؤكده:
أنه قد ذكر بعد الخمس هنا زكاة الغنم أيضاً، وأنهم إذا
زرعوا فلسوف يعفون من زكاة الغنم. والظاهر أن ذلك ترغيب لهم بالزراعة.
ثم إن من الثابت عندهم:
أن «في الركاز الخمس» وكذا في المعادن([23]).
ويذكر الأصطخري:
أنهم كانوا يأخذون خمس المعادن([24]).
وقد عد غير مالك وأهل المدينة المعدن من الركاز الذي
يجب فيه الخمس، واعتبروه كالغنيمة([25]).
ويقول أبو عبيد:
إنه بالركاز أشبه([26]).
وقد كتب عمر بن العزيز لعروة، يسأله عن رأي السابقين في
الخمس، فأجابه عروة: بأن العنبر بمنزلة الغنيمة، يجب أن يؤخذ منه الخمس([27]).
ويقول الشيباني:
إن الركاز والمعدن يجب فيهما الخمس، وهما من المغنم([28]).
وقد خمس علي «عليه السلام» الركاز في اليمن كما سنرى.
وعن جابر:
«ما وجد من غنيمة ففيها الخمس» ويقرب منه ما عن ابن
جريج([29]).
وأخيراً، فقد جاء:
أن من أخذ شيئاً من أرض العدو، فباعه بذهب أو فضة أو
غيره، فإنه يخمس([30]).
وكل ما تقدم ليس من غنائم الحرب كما هو معلوم، وقد حكم
بثبوت الخمس فيه، فما معنى تخصيص الآية بغنائم الحرب؟!!
وحسبنا ما ذكرناه هنا، فإن فيه مقنعاً
وكفاية لمن أراد الرشد والهداية.
ومن الطريف أن نذكر هنا:
أن أبا بكر قد أوصى بخمس ماله، وقال: «أوصي بما رضي
الله به لنفسه، ثم تلا:
{وَاعْلَمُواْ
أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ}»([31]).
ويظهر:
أنه كان للنبي «صلى الله عليه وآله» جباة للخمس، كما
كان له جباة للصدقات، وقد أرسل عمرو بن حزم إلى اليمن، وقدم عليه
بأخماس بني عبد كلال اليمنيين، وأرسل إليهم يشكرهم على ذلك.
وأرسل علياً «عليه السلام» ليأخذ خمس غنائم الحرب من
خالد بن الوليد([32]).
بل ويقول ابن القيم إنه «صلى الله
عليه وآله»:
«ولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن، والقضاء بها»([33]).
ومعلوم:
أن أهل اليمن قد أسلموا طوعاً، ولم يكن بينهم وبين
غيرهم حرب.
وقد خمس علي «عليه السلام» الركاز في اليمن([34]).
وكان محمية بن جزء رجلاً من بني زبيد استعمله رسول الله
«صلى الله عليه وآله» على الأخماس([35]).
والقول بأن المراد:
أنه أرسل علياً «عليه السلام» على الصدقات إلى اليمن.
يدفعه:
أنه «صلى الله عليه وآله» لم يكن يولي بني هاشم
الصدقات. وقصة عبد المطلب بن ربيعة، والفضل بن العباس مشهورة([36]).
بل كان يمنع حتى مواليه من تولي ذلك، فقد منع أبا رافع
من ذلك، وقال له: «مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة»([37]).
لقد نصت آية الخمس في الكتاب العزيز على أن الخمس لله
ولرسوله، ولذوي قرباه، ولليتامى، وللمساكين، وأبناء السبيل. وكان رسول
الله «صلى الله عليه وآله» يعطي ذوي قرباه من الخمس إلى أن قبض([38]).
وأما اليتامى والمساكين في الرواية؛ فقد روي عن علي بن
الحسين «عليه
السلام»
أنه قيل له: إن الله تعالى قال:
{وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينُ}؟([39]).
فقال:
أيتامنا ومساكيننا([40]).
وفي روايات أئمة أهل البيت «عليهم
السلام»:
أن سهم الله ورسوله وسهم ذي القربى للإمام «عليه
السلام»،
وسهم اليتامى لبني هاشم، والمساكين وأبناء السبيل منهم([41])،
وبنو هاشم هم بنو عبد المطلب([42]).
ويشترك في الخمس الذكر منهم والأنثى؛ فيقسم نصف الخمس
على الطوائف الثلاث إذا كانوا فقراء، لقرابتهم من رسول الله،
ولافتقارهم إلى ذلك في مؤنتهم.
ولا يكفي انتسابهم إلى عبد المطلب بالأمومة ويكفي
الانتساب بالأبوة.
هناك رواية واردة في الصحاح، تبين موضع الخمس في عصر
الرسول «صلى الله عليه وآله»، وهي:
عن جبير بن مطعم، قال:
لما كان يوم خيبر ـ وفي رواية: حنين ـ وضع الرسول «صلى
الله عليه وآله» سهم ذي القربى في بني هاشم، وبني المطلب، وترك بني
نوفل، وبني عبد شمس. فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي «صلى
الله عليه وآله» فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم، لا ننكر فضلهم؛
للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم
وتركتنا، وقرابتنا واحدة؟
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
إنا وبني المطلب لا نفترق ـ وفي رواية النسائي: إن بني
المطلب لم يفارقوني ـ في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد،
وشبك بين أصابعه([43]).
وبعدما تقدم، فإننا نذكر هنا ملخصاً
لما ذكره بعض الباحثين([44])
مع بعض التقليم والتطعيم، فنقول:
الخمس
في عهد أبي بكر:
إذا لاحظنا طبيعة العصر الذي عاش
فيه أبو بكر، فإننا نجد:
أن السياسة قد اتجهت نحو إرسال جيوش لإخضاع الفئات
المعارضة للحكم الجديد، والتي لم تقبل بيعة أبي بكر. فوضع الخمس حينئذٍ
وسهم ذوي القربى في السلاح والكراع.
فقد ذكر المؤلفون:
أن الصحابة بعد وفاته «صلى الله عليه وآله» قد اختلفوا؛
فقالت طائفة سهم الرسول للخليفة بعده، وقالت طائفة: سهم ذوي القربى،
لقرابة الرسول، وقال آخرون: سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة. فأجمعوا
على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع والسلاح.
وفي
سنن النسائي، والأموال لأبي عبيد:
فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمر.
وفي رواية:
فلما قبض الله رسوله رد أبو بكر نصيب القرابة في
المسلمين فجعل في سبيل الله.
وقريب منه رواية أخرى تضيف عمر إلى أبي بكر. إلى غير
ذلك من الروايات([45]).
ويوضح ذلك ما روي عن جبير بن مطعم:
«أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لم يقسم لبني عبد
شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب.
وأن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله «صلى الله عليه وآله» كما كان رسول
الله «صلى الله عليه وآله» يعطيهم»
الخ..([46]).
الخمس
في عهد عمر:
وفي زمن عمر اتسعت الفتوح، فازدادت الثروات، ووزعوا
الخمس على المسلمين، وأراد عمر أن يعطي بني هاشم شيئاً من الخمس، فأبوا
أن يأخذوا إلا كل سهمهم؛ فأبوا عليهم ذلك، وحرموهم منه؛ فقد جاء في
جواب ابن عباس لنجدة الحروري حين سأله عن سهم ذوي القربى لمن هو؟.
قوله:
«هو لنا أهل البيت، وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه
أيمنا، ويخدم منه عائلنا، ويقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه
لنا. وأبى ذلك فتركناه عليه».
ومثل ذلك روي عن علي أيضاً، وأن عمر عرض عليهم البعض،
وقال: إنه لم يبلغ علمه: أنه إذا كثر يكون كله لهم، فأبوا إلا الكل([47]).
الخمس
في عهد عثمان:
وأعطى عثمان خمس فتوح أفريقيا مرة لعبد الله بن سعد بن
أبي سرح([48])
وفي الغزوة الثانية أعطاه لمروان بن الحكم. وقال في ذلك أسلم بن أوس
الساعدي، الذي منع من دفن عثمان في البقيع.
وأعــطـيـت مـروان خمس العبـاد
ظـلـمــاً لهم وحمـيـت الحـمـى([49])
وقد نقم الناس عليه لأمرين:
أولهما:
أن الخليفتين قبله وإن كانا قد أخذا ذلك من مستحقيه،
إلا أنهما كانا يضعان تلك الأموال في النفقات العامة، وقد خصصها عثمان
لأقربائه.
الثاني:
أن سيرة هؤلاء الذين كان يعطيهم هذه العطايا الهائلة من
مال لا يستحقونه كانت سيئة جداً، وكانوا معروفين بالانحراف، وعدم
الاستقامة.
وقد سئل أبو جعفر الباقر «عليه
السلام» عن علي «عليه السلام»:
كيف صنع في سهم ذوي القربى حين ولي أمر الناس؟!
قال:
سلك به سبيل أبي بكر وعمر.
قلت:
وكيف، وأنتم تقولون ما تقولون؟
فقال:
ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه.
قلت:
فما منعه؟
قال:
كره والله أن يدعى عليه خلاف أبي بكر وعمر([50]).
وفي سنن البيهقي:
أن حسناً،
وحسيناً،
وابن عباس، وعبد الله بن جعفر (رض) سألوا علياً (رض) نصيبهم من الخمس،
فقال: هو لكم حق، ولكني محارب معاوية، فإن شئتم تركتم حقكم منه([51]).
فعلي «عليه السلام» إذاً لم يغير شيئاً مما فعله أبو
بكر وعمر في الخمس، لأن ذلك يؤلب الناس عليه، ويدعون عليه خلاف أبي بكر
وعمر. وإذا كان يريد حرب معاوية؛ فإن الأمر يستوجب هذا الأمر الأهم،
وتأجيل المهم إلى وقت لا يكون فيه العمل به ذا مضاعفات خطيرة.
لقد حرم بنو هاشم من الخمس منذ زمن معاوية، الذي صار
يصطفي لنفسه الصفراء والبيضاء، ولا يقسم بين المسلمين منه ذهباً
ولا فضة.
فعن علي بن عبد الله بن عباس، وأبي جعفر محمد بن علي «عليهما
السلام»،
قالا: «ما قسم علينا خمس منذ زمن معاوية إلى اليوم»([52]).
ولما أمر عمر بن عبد العزيز بدفع شيء من الخمس إلى بني
هاشم،
اجتمع
نفر منهم، وكتبوا إليه
يشكره،
لصلته رحمه وفيه: إنهم لم يزالوا مجفوين منذ كان معاوية([53]).
كما أن زياداً
كتب إلى والي خراسان من قبله، الحكم بن عمرو الغفاري، يقول له عن
الغنائم الكثيرة التي أصابوها: «أما بعد، فإن أمير المؤمنين كتب أن
يصطفى له الصفراء والبيضاء، ولا تقسم بين المسلمين ذهباً
ولا فضة».
وزاد الطبري:
«الروائع»([54])
على الصفراء والبيضاء.
ولكن الحكم رفض ذلك، وقسم الغنائم، فأرسل إليه معاوية
من قيده، وحبسه، فمات في قيوده، ودفن فيها، وقال: إني مخاصم([55]).
وبقي الخمس في أيدي الأمويين يتصرفون فيه تصرف المالك،
حتى كان عهد عمر بن عبد العزيز، فحاول أن يعيد للهاشميين بعض حقوقهم
لمصلحة يراها، فقسم فيهم بعض ذلك، ووعدهم: أنه إن بقي لهم أعطاهم جميع
حقوقهم([56]).
لكن هذه المحاولة ـ كعهد عمر بن عبد العزيز نفسه ـ
سرعان ما انتهت وبطل مفعولها، وعادت الأمور لتسير في نفس الاتجاه الذي
رسمه لها أعداء علي «عليه السلام» وأعداء أهل بيته، كما يعلم بأدنى
مراجعة لكتب السير والتاريخ.
ولقد تضاربت آراء فقهاء أهل السنة تبعاً لما فعله
الخلفاء:
قال ابن رشد:
واختلفوا في الخمس على أربعة مذاهب مشهورة.
إحداها:
أن الخمس يقسم على خمسة أقسام على نص الآية، وبه قال
الشافعي.
والقول الثاني:
إنه يقسم على أربعة أقسام.
والقول الثالث:
إنه يقسم اليوم ثلاثة أقسام، وإن سهم النبي «صلى الله
عليه وآله»، وذي القربى سقط بموت النبي «صلى الله عليه وآله».
والقول الرابع:
إن
الخمس بمنزلة الفيء يعطى منه الغني والفقير.
والذين قالوا يقسم أربعة أقسام أو خمسة اختلفوا في ما
يفعل بسهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» وسهم القرابة بعد موته، فقال
قوم: يرد على سائر الأصناف الذين لهم الخمس.
وقال قوم:
بل يرد على باقي الجيش.
وقال قوم:
بل سهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» للإمام، وسهم ذي
القربى لقرابة الإمام.
وقال قوم:
بل يجعلان في السلاح والعدة، واختلفوا في القرابة من هم([57]).
أما ابن قدامة فقد ذكر:
أن أبا بكر قسم الخمس على ثلاثة أسهم، وذكر أن هذا هو
قول أصحاب الرأي، أبي حنيفة وجماعته، فإنهم قالوا: يقسم الخمس على
ثلاثة أقسام: اليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل وأسقطوا سهم رسول الله
«صلى الله عليه وآله» بموته، وسهم قرابته أيضاً.
وقال مالك:
الخمس والفيء واحد، يجعلان في بيت المال.
ثم قال ابن قدامة:
«وما قاله أبو حنيفة فمخالف لظاهر الآية؛ فإن الله
تعالى سمى لرسوله وقرابته شيئاً، وجعل لهما في الخمس حقاً،
كما سمى الثلاثة الأصناف الباقية، فمن خالف ذلك فقد خالف نص الكتاب.
وأما حمل أبي بكر وعمر (رض) على سهم ذي القربى في سبيل الله، فقد ذكر
لأحمد فسكت، وحرك رأسه، ولم يذهب إليه. ورأى أن قول ابن عباس ومن وافقه
أولى؛ لموافقته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله»([58]).
ورأى أبو يعلى، والماوردي:
أن تعيين مصرف الخمس منوط باجتهاد الخلفاء([59]).
أهل البيت
 وشيعتهم وقضية الخمس:
وشيعتهم وقضية الخمس:
يقسم الخمس عند أهل البيت «عليهم
السلام»
وشيعتهم إلى ستة أقسام، ثلاثة منها لله ولرسوله، ولذوي قرباه، يقبض
النبي «صلى الله عليه وآله» هذه الأسهم في حياته، ويعود أمرها إلى
الأئمة الاثني عشر من أهل بيته بعد وفاته «صلى الله عليه وآله».
والأسهم الأخرى هي لفقراء بني هاشم، وأبناء سبيلهم، ويتاماهم، مع وصف
الفقر.
وقالوا أيضاً:
يجب إخراج الخمس من كل مال فاز به المسلم من جهة العدى
أو غيرهم. ولا يتوقف شيعة أهل البيت عند هذا، بل يستدلون أيضاً
بالأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك، الواردة عن أئمة أهل البيت «عليهم
السلام»،
الذين هم أحد الثقلين الذين أمرنا بالتمسك بهم، وهم سفينة نوح، وباب
حطة، هدانا الله جميعاً إلى المزيد من محبتهم والتمسك بهم ومتابعتهم في
أقوالهم وأفعالهم وما ذلك على الله بعزيز.
([1])
الآية 41 من سورة الأنفال.
([2])
راجع: لسان العرب، وأقرب الموارد، ومفردات الراغب، والقاموس،
ونهاية ابن الأثير، ومعجم مقاييس اللغة، وتفسير الرازي، وغير
ذلك من كتب اللغة.
([3])
نهج البلاغة الخطبة رقم118.
([4])
المصدر، الحكمة رقم150.
([5])
المصدر، الكتاب رقم31.
([6])
المصدر، الحكمة رقم331.
([7])
نهاية ابن الأثير مادة
>غنم<.
([9])
الآية 94 من سورة النساء.
([10])
سنن ابن ماجة (كتاب الزكاة) الحديث رقم1797.
([11])
مسند أحمد ج2 ص177.
([12])
راجع: مقدمة مرآة العقول ج1 ص84 و 85.
([13])
هو العلامة السيد مرتضى العسكري في مقدمة مرآة العقول.
([14])
تفسير القرطبي ج8 ص1.
([15])
البخاري ط مشكول ج1 ص22 و 32 و 139، وج2 ص131 وج5 ص213، وج9
ص112، وصحيح مسلم ج1 ص36، وسنن النسائي ج2 ص333، ومسند أحمد ج1
ص228 و361، وج3 ص318، وج5 ص36، والأموال لأبي عبيد ص20،
والترمذي باب الإيمان، وسنن أبي داود ج3 ص330، وج4 ص219، وفتح
الباري ج1 ص120، وكنز العمال ج1 ص20 وص19 رقم6.
([16])
تاريخ ابن خلدون ج2، وتنوير الحوالك ج1 ص157، والبداية
والنهاية ج5 ص76، وسيرة ابن هشام ج4 ص242، وكنز العمال ج3
ص186، والإستيعاب هامش الإصابة ج2 ص517، والخراج لأبي يوسف
ص77، ومسند أحمد ج2 ص14 و15، وابن ماجة ج1 ص573 و 575 و 577،
وسنن الدارمي ج1 ص281 و 385، وج2 ص161 ـ 195، الإصابـة ج2
ص532، وسـنـن أبي = = داود ج2 ص98 و99، والدر المنثور ج2 ص253،
والتراتيب الإدارية ج1 ص248 و249، والترمذي ج3 ص17. وعن:
رسالات نبوية ص204، والطبري ج2 ص388، وفتوح البلدان للبلاذري
ص80، وأعلام السائلين ص45، ومجموعة الوثائق السياسية ص175،
وفريدون ج1 ص34، وإهدلي ص68، والإمتاع للمقريزي ص139.
([17])
الأموال لأبي عبيد ص21، وسنن البيهقي ج4 ص89، وكنز العمال ج3
ص186 و252 و253 عن الطبراني وغيره، ومستدرك الحاكم ج1 ص395،
والدر المنثور ج1 ص343، ومجمع الزوائد ج3، وعن تهذيب ابن عساكر
ج6 ص273 و274، وجمهرة رسائل العرب ج1 ص89، ومجموعة الوثائق
السياسية ص185 عن إهدل ص67 و68 عن ابن حبان، والمبعث ص141.
([18])
طبقات ابن سعد ج1 قسم2 ص23 و24، ومجموعة الوثائق السياسية
ص224، ومقدمة مرآة العقول ج1 ص102 و103.
([19])
راجع هذه النصوص في المصادر التالية: أسد الغابة ج4 ص175 و 271
و 328، وج5 ص40 و 389 وج1 ص300، والإصابة ج3 ص338 و 199 و 573،
وج1 ص53 و 247 و278، وج2 ص197، وطبقات ابن سعد ج1 ص274 و 279 و
66 و 269 و 271 و 268 و 270 و 284، وج7 قسم1 ص26، وج5 ص385،
ورسالات نبوية ص237 و 102 و 103 و 131 و 253 و 138 و 188 و
134، ومجموعة الوثائق السياسية ص121 و 264 و 273 عن أعلام
السائلين و 98 و 99 و 252 و 250 و 216 و 196 و 138 و 232 و 245
و 180، وكنز العمال ج2 ص271 وج5 ص320، وج7 ص64 عن الروياني
وابن عساكر وأبي داود، كتاب الخراج وطبقات الشعراء للجمحي ص38،
وسنن البيهقي ج6 ص303، وج7 ص58، وج9 ص13، ومسنـد = = أحمد ج4
ص77 و 78 و 363، وسنن النسائي ج7 ص134، والأموال لأبي عبيد ص12
و 19 و 20 و 30، والإستيعاب ترجمة عمر بن تولب، وج3 ص38،
وجمهرة رسائل العرب ج1 ص55 و 68 عن شرح المواهب للزرقاني ج3
ص382، وصبح الأعشى ج13 ص329، ومجموعة الوثائق عن إعلام
السائلين ونصب الراية، ومغازي ابن إسحاق، ومصنف ابن أبي شيبة،
ومعجم الصحابة، والمنتقى، وميزان الاعتدال، ولسان الميزان،
واليعقوبي، وأموال ابن زنجويه. وتاريخ اليعقوبي ج2 ص64،
والبداية والنهاية ج5 ص46 و 75، وج2 ص351 عن أبي نعيم، وتاريخ
الطبري ج2 ص384، وفتوح البلدان للبلاذري ص82، والسيرة الحلبية
ج3 ص258، وسيرة ابن هشام ج4 ص258 و 260، وسيرة زيني دحلان ج3
ص30، والمصنف ج4 ص300، وطبقات الشعراء لابن سلام ص38، ومجمع
الزوائد ج8 ص244.
([20])
أسد الغابة ج3 ص38، والإصابة ج2 ص208، وج3 ص413، والبحار ج96
ص83 و190 والإستيعاب هامش الإصابة ج3 ص643، وجامع أحاديث
الشيعة ج8 ص73، والعقد الفريد ج1 باب الوفود، والبيان
والتبيين، والوسائل= =
كتاب الزكاة باب تقدير نصاب الغنم، ومعاني الأخبار ص275، وشرح
الشفا للقاري ج1 ص18، وتاريخ ابن خلدون ج2، والسيرة النبوية
لدحلان هامش الحلبية ج3 ص94، والفائق للزمخشري ج1 ص14، وعن:
المعجم الصغير ص243، ورسالات نبوية ص67 و297، وجمهرة رسائل
العرب ج1 ص58 و59، ومجموعة الوثائق السياسية ص205 و206 عن
المواهب اللدنية، والزرقاني، ومادة سيب في نهاية ابن الأثير،
ولسان العرب، وتاج العروس، ونهاية الإرب وغريب الحديث لأبي
عبيد في مادة: قيل وسيب، وطبقات ابن سعد ج1 ص287.
([21])
تبيين الحقائق ج1 ص288 (الركاز: ما ركزه الله أي أحدثه ودفنه
في المعادن من ذهب أو فضة أو غيرها.
([22])
طبقات ابن سعد ج4 قسم2 ص167، وعن مجموعة الوثائق السياسية
ص219، ورسالات نبوية ص228، وكنز العمال ج7 ص65، وجمع الجوامع
مسند عمرو بن مرة ونقله في مقدمة مرآة العقول ج1 عن نهاية ابن
الأثير، وعن ابن منظور في لسان العرب في كلمة: صرم.
([23])
الأموال لأبي عبيد ج33 ص337 و473 و477 و476 و468 و467، ونصب
الراية ج2 ص382 و381 و380، ومسند أحمد ج2 ص228 و239 و254 و274
و314 و186 و202 و207 و285 و319 و382 و386 و406 و411 و415 و454
و456 و467 و475 و482 و493 و495 و499 و501 و507، وج3 ص354 و353
و336 و356 و335 و128، وج5 ص326، وكنز العمال ج4 ص227 و228،
وج19 ص8 و9، وج5 ص311، ومستدرك الحاكم ج2 ص56 ومجمع الزوائد ج3
ص77 و78، وعن الطبراني في الكبير والأوسط، وعن أحمد والبزار،
ومصنف عبد الرزاق ج10 ص128 و66، وج4 ص117 و64 و65 و116 و300،
وج6 ص98 عن خمس العنبر، ومقدمة مرآة العقول ج1 ص97 و96، ومغازي
الواقدي ص682، وسنن البيهقي ج4 ص157 و156 و155، وج8 ص110،
والمعجم الصغير ج1 ص120 و121 و153، والطحاوي ج1 ص180، وسنن
النسائي ج5 ص44 و45، والبخاري ط مشكول ج2 ص159 و160 في باب في
الركاز الخمس، وفي باب من حفر بئراً في ملكه وط سنة1309 ه. ج4
ص124، والهداية شرح البداية ج1 ص108، وخراج أبي يوسف ص26، وسنن
ابن ماجة ج2 ص839 و803، وسنن أبي داود ج3 ص181، وج4 ص196، وشرح
الموطأ للزرقاني ج2 ص321، وكتاب الأصل للشيباني ج2 ص138، وسنن
الدارمي ج1 ص393 وج2 ص196، ونيل الأوطار ج4 ص210، والموطأ ج1
ص244 وج3 ص71 (مطبوع مع تنوير الحوالك)، ومنحة المعبود ج1
ص175، والترمذي ج1 ص219 وج3 ص138، وصحيح مسلم ج5 ص127 و11
و225، والعقد = = الفريـد ونهـاية الارب، والإستيعـاب، وتهـذيب
تـاريـخ دمشق ج6 ص207، وتاريخ بغداد ج5 ص53 و54، ومصابيح السنة
ط دار المعرفة ج2 ص17، والمسند للحميدي ج2 ص462، ومسند أبي
يعلى ج10 ص437 و461 و459، وج11 ص202 وفي هامشه عن مصادر كثيرة
جداً.
([24])
مسالك الممالك ص158.
([25])
راجع: الأموال لأبي عبيد ص472.
([27])
مصنف الحافظ عبد الرزاق ج4 ص64/65.
([28])
كتاب الأصل للشيباني ج2 ص138.
([29])
مصنف الحافظ عبد الرزاق ج4 ص116.
([30])
مصنف عبد الرزاق ج5 ص179 و181، وج9 ص67 وتحف العقول ص260.
([31])
مصنف الحافظ عبد الرزاق ج9 ص66.
([32])
نصب الراية ج2 ص382، ومصنف عبد الرزاق ج4 ص116، ومجمع الزوائد
ج3 ص78، وراجع: البحار ج21 ص360 عن إعلام الورى.
([33])
راجع: البداية والنهاية.
([34])
زاد المعاد ج1 ص32، وراجع: سنن أبي داود ج3 ص127 باب كيف
القضاء.
([35])
الأموال لأبي عبيد ص461.
([36])
مجمع الزوائد ج3 ص91، وأسد
الغابة ترجمة: عبد المطلب بن ربيعة، ونوفل بن الحارث، ومحمية،
صحيح مسلم ج3 ص118 باب تحريم الزكاة على آل النبي
>صلى
الله عليه وآله<،
وسنن النسائي ج1 ص365، وسنن أبي داود، والأموال لأبي عبيد
ص329، ومغازي الواقدي ص696 و697، وتفسير العياشي ج2 ص93.
([37])
سنن أبي داود كتـاب الزكـاة ج2 ص212، والترمـذي كتـاب الـزكـاة
ج3 = = ص159، والنسائي كتاب الزكاة ج1 ص366، ومجمع الزوائد
ج3 ص90 و91، وكنز العمال ج6 ص252 ـ 256، وأمالي الطوسي ج2 ص17،
والبحار ج96 ص57، وسنن البيهقي ج7 ص32.
([38])
راجع: تفسير الطبري ج15 ص504 و 506 وبهامشه تفسير النيسابوري
ج15، وأحكام القرآن للجصاص ج3 ص65 و61، والأموال لأبي عبيد ص22
و 447 و 453 و 454.
([39])
الآية 7 من سورة الحشر.
([40])
تفسير النيسابوري بهامش الطبري، وتفسير الطبري ج15 ص7.
([41])
راجع: الوسائل ج9 ص356 و358 و359 و361 و362.
([42])
الوسائل ج9 ص358 و359،
ومقدمة مرآة العقول للعسكري ج1 ص116 و 117.
([43])
صحيح البخاري باب غزوة خيبر ج3 ص36 وط سنة1311 ج4 ص111 وج6
ص174، وسنن أبي داود ج3 ص145 و146، وتفسير الطبري ج15 ص5،
ومسند أحمد ج4 ص81 و85 و83، وسنن النسائي ج7 ص130 و131، وسنن
ابن ماجة ص961، ومغازي الواقدي ج2 ص696، وأموال أبي عبيد ص461
و 462، وسنن البيهقي ج6 ص340 ـ 342، والسيرة الحلبية ج2 = =
ص209، والمحلى ج7 ص328، والبداية والنهاية ج4 ص200، وشرح النهج
ج15 ص284، ومجمع الزوائد ج5 ص341، ونيل الأوطار ج8 ص228 عن
البرقاني والبخاري وغيرهما، والإصابة ج1 ص226، وبداية المجتهد
ج1 ص402، والخراج لأبي يوسف ص21، وتشييد المطاعن ج2 ص818 و 819
عن زاد المعاد، والدر المنثور ج3 ص186 عن ابن أبي شيبة، والبحر
الرائق ج5 ص98، وتبيين الحقائق ج3 ص257، ونصب الراية ج3 ص425 و
426 عن كثيرين. ومصابيح السنة ج2 ص70، وتفسير القرآن العظيم ج2
ص312، وفتح القدير ج2 ص310، ولباب التأويل ج2 ص185، ومدارك
التنزيل (مطبوع بهامش الخازن) ج2 ص186، والكشاف ج2 ص221. ونقل
ذلك عن المصادر التالية: الجامع لأحكام القرآن ج7 ص12، وفتح
الباري ج7 ص174، وج6 ص150، وتفسير المنار ج10 ص7، وترتيب مسند
الشافعي ج2 ص125 و 126، وإرشاد الساري ج5 ص202.
([44])
هو العلامة السيد مرتضى العسكري حفظه الله.
([45])
راجع في ذلك كله وغيره مما يرتبط بالموضوع سنن النسائي ج2
ص179، وكتاب الخراج ص24 و 25، والأموال لأبي عبيد ص463، وجامع
البيان للطبري ج15 ص6، وأحكام القرآن للجصاص ج3 ص62 و 60، وسنن
البيهقي ج6 ص342 ـ 343، وسنن أبي داود بيان مواضع الخمس، ومسند
أحمد ج4 ص83، ومجمع الزوائد ج5 ص341.
([47])
راجع الحديث في: الخراج لأبي يوسف ص21 و 24، ومغازي الواقدي
ص697، والأموال لأبي عبيد ص465 و 467، وسنن النسائي ج2 ص178
و177، وج7 ص129 و 128، وشرح معاني الآثار ج3 ص235 و 220، ومسند
الحميدي رقم532، والجامع الصحيح (السير) رقم1556، وأحكام
القرآن للجصاص ج3 ص63، ولسان الميزان ج6 ص148، وصحيح مسلم ج5
ص198 باب النساء الغازيات يرضخ لهن، ومسند أحمد ج10 ص225، وج1
ص320 و 308 و 248 و 249 و 294 و 224، ومشكل الآثار ج2 ص136 و
179، ومسند الشافعي ص183 و 187، وحلية أبي نعيم ج3 ص205،
وتفسير الطبري ج10 ص5، وسنن أبي داود ج3 ص146 كتاب الخراج،
وسنن البيهقي ج6 ص344 و 345 و 332، وكنز العمال ج2 ص305،
والمصنف ج5 ص228 وراجع ص238، والمحاسن والمساوئ ج1 ص264، ووفاء
الوفاء ص995، والروض الأنف ج3 ص80، ومسند أبي يعلى ج4 ص424،
وج5 ص41 و 42.
([48])
راجع تاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص79 و 80، وتاريخ ابن الأثير ط
أوربا ج3 ص71، وشرح النهج ج1 ص67.
([49])
راجع في ذلك الكامل ج3 ص71، والطبري ط أوربا قسم1 ص2818، وابن
كثير ج7 ص152، وفتوح أفريقيا لابن عبد الحكم ص58 و60،
والبلاذري ج5 ص25 و27 و28، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص156
والأغاني ج6 ص57.
([50])
الأموال لأبي عبيد ص463، والخراج ص23، وأحكام القرآن للجصاص ج3
ص63، وسنن البيهقي ج6 ص323، وأنساب الأشراف ج1 ص517، وتاريخ
المدينة لابن شبة ج1 ص217، وكنز العمال ج4 ص330 عن أبي عبيد،
وعن ابن الأنباري في المصاحف.
([51])
سنن البيهقي ج6 ص363.
([52])
طبقات ابن سعد ج5 ص288 ط أوربا.
([54])
مستدرك الحاكم وتلخيصه للذهبي بهامشه ج3 ص442، وطبقات ابن سعد
ط أوربا ج7 ص18، والإستيعاب ج1 ص118، وأسد الغابة ج2 ص36،
والطبري ط أوربا ج2 ص111، وابن الأثير ط أوربا ج3 ص391،
والذهبي ج2 ص220، وابن كثير ج8 ص47.
([55])
تهذيب التهذيب ج2 ص437، ومستدرك الحاكم ج3 ص442.
([56])
راجع ذلك في طبقات ابن سعد ج5 ص281، 285، 287، 289، والخراج
ص25، وسنن النسائي باب قسم الفيء ج2 ص178.
([57])
بداية المجتهد حكم الخمس ج1 ص401.
([58])
المغني لابن قدامة ج7 ص351 باب قسمة الفيء والغنيمة.
([59])
الأحكام السلطانية للماوردي باب قسم الفيء ص126، والأحكام
السلطانية لأبي يعلى ص125.
|