|
قـبـل نـشــوب الـحـــرب
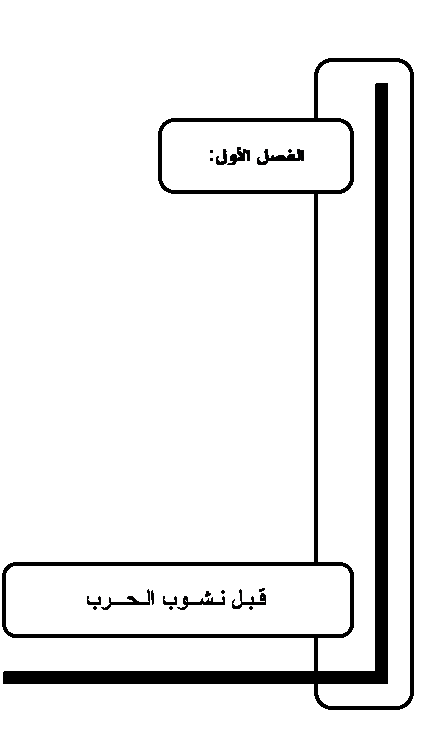
أجواء ومواقف:
وفي سنة ثلاث
ـ وشذ من قال في سنة أربع([1])
في
شهر
شوال، يوم
السبت على الأشهر ـ كانت غزوة أحد([2])،
وهو جبل يبعد عن المدينة حوالي فرسخ. وذلك أن نتائج حرب بدر كانت قاسية
على مشركي مكة، ومفاجأة لليهود والمنافقين في المدينة.
فقريش لا يمكن أن تهدأ بعد الآن حتى تثأر لكرامتها،
ولمن قتل من أشرافها. حتى لقد أعلنوا المنع عن بكاء قتلاهم؛ لأن ذلك
يذهب الحزن، ويطفئ لهيب الأسى من جهة. ولأنه يدخل السرور على قلوب
المسلمين من الجهة الأخرى.
ولكنهم عادوا فتراجعوا عن هذا القرار؛ فسمحوا للنساء
بالبكاء، لأن ذلك ـ بزعمهم ـ يثير المشاعر، ويذكر الرجال بالعار الذي
لحق بهم.
ومضت قريش تستعد لقتال النبي محمد «صلى الله عليه
وآله»، وتعبئ النفوس، وتجهز القوى الحربية لأخذ الثأر، ومحو العار.
ومضى اليهود الذين أصبحوا يخافون على مركزهم السياسي، والاقتصادي في
المنطقة، وعلى هيمنتهم الثقافية أيضاً يحرضون المشركين على الثأر ممن
وترهم، وأعلنوا بالحقد، ونقض العهد، حتى كال لهم المسلمون ضربات صاعقة،
هدت كيانهم، وجرحت وأذلت كبرياءهم وغرورهم.
ومن جهة النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله»، ومن معه من
المسلمين؛ فإنهم لن يتخلوا عن قبلتهم، الكعبة، ولن يتركوا قريشاً
وغطرستها وغرورها، لا سيما بعد تعدِّيها عليهم، وظلمها القبيح لهم، حتى
اضطرهم ظلمها وتعدِّيها إلى الهجرة من ديارهم، تاركين لها أوطانهم، وكل
ما يملكون.
وكذلك، فإن النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» قد حاصر
قريشاً بمعاهداته للقبائل التي في المنطقة، وموادعاته لها، وأصبح يسيطر
على طريق تجارتها، ولم يعد هذا الطريق آمناً
لها، وأصبحت ترى نفسها بين فكي (كماشة)، فلا بد لها إذاً من كسر هذا
الطوق، وتجاوز هذا المأزق.
وهذا ما عبَّر
عنه ذلك الزعيم القرشي ـ كما تقدم في سرية القردة ـ بقوله لقريش:
«إن محمداً وأصحابه قد عوروا علينا متجرنا، فما ندري
كيف نصنع بأصحابه؟ لا يبرحون الساحل.
وأهل الساحل
قد وادعهم، ودخل عامتهم معه، فما ندري أين نسلك، وإن أقمنا نأكل رؤوس
أموالنا، ونحن في دارنا هذه فلم يكن لنا بقاء. إنما نزلناها على
التجارة إلى الشام في الصيف، وفي الشتاء إلى أرض الحبشة»([3]).
وكانت العير التي كانت وقعة بدر من أجلها ـ وهي ألف
بعير كما قالوا ـ قد بقيت سالمة ومحتبسة في دار الندوة. واتفقوا مع
أصحابها على أن يعطوهم رؤوس أموالهم، وهي خمسة وعشرون أو خمسون ألف
دينار ـ على اختلاف النقل ـ على أن يصرف الربح في قتال المسلمين. وكان
كل دينار يربح ديناراً،
وهو مبلغ هائل في وقت كانت للمال فيه قيمة كبيرة، والقليل منه يكفي
للشيء الكثير.
وبعثوا الرسل إلى القبائل يستنصرونهم، وحركوا من أطاعهم
من قبائل كنانة، وأهل تهامة، واشترك الشاعر أبو عزة الجمحي في تحريض
القبائل على المسلمين، وكان قد أسر في بدر، ومنّ عليه النبي «صلى الله
عليه وآله» بشرط أن لا يظاهر عليه.
وقد شارك في ذلك بعد أن ألح عليه صفوان بن أمية، وضمن
له إن رجع من أحد أن يغنيه، وإن أصابه شيء أن يكفل بناته.
وخرجت قريش بحدها وجدها، وأحابيشها ومن تابعها.
وأخرجوا معهم بالظعن خمس عشرة امرأة، فيهن هند بنت
عتبة، لئلا يفروا، وليذكرنهم قتلى بدر. يغنين ويضربن بالدفوف، ليكون
أجد لهم في القتال.
وخرج معهم الفتيان بالمعازف، والغلمان بالخمور، وكان
جيش المشركين ثلاثة آلاف مقاتل.
وقيل:
خمسة آلاف.
ونحن نرجح الأول؛ لقول كعب بن مالك:
ثـلاثــة آلاف ونـحـن
نـصـيـبـه ثـلاث مـئـين إن كـثـرنا وأربـع([4])
أي:
وأربع مئين.
وكان في جيش المشركين سبعمائة دارع، ومئتا فارس على
المشهور.
وقيل:
مئة، ومئة رام، ومعهم ألف ـ وقيل ثلاثة آلاف ـ بعير.
ولا يبعد
صحته([5])
كلهم بقيادة أبي سفيان الذي صار زعيم قريش بعد قتل أشرافها في بدر.
وكان معهم أبو عامر الفاسق، الذي كان قد ترك المدينة
إلى مكة مع خمسين رجلاً من أتباعه من الأوس كراهية لمحمد، خرج إلى مكة
يحرض على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ويقول لهم: إنهم على الحق،
وما
جاء به محمد باطل.
فسارت قريش إلى بدر، ولم يسر معهم، وسار معهم إلى أحد.
وكان يزعم لهم:
أنه لو قدم على قومه لم يختلف عليه اثنان منهم، فصدقوه،
وطمعوا في نصره، ولكن الأمر كان على عكس ذلك كما سنرى.
وكان مع المشركين أيضاً:
وحشي غلام
جبير بن مطعم، الذي وعده سيده بالحرية، إن هو قتل محمداً، أو علياً، أو
حمزة بعمه طعيمة بن عدي؛ فإنه لا يدري في القوم كفؤاً له غيرهم([6]).
فقال وحشي له ـ أو لهند ـ :
أما محمد؛ فلن يسلمه أصحابه، وأما حمزة فلـو
وجـده
نائماً
لمـا
أيقظه من هيبته، وأما علي فـإنه
حـذر
مرس، كـثير
الالتفات([7]).
وسيأتي:
أنه تمكن من الغدر بحمزة، أسد الله وأسد رسوله.
ويرد هنا سؤال:
وهو أنهم إذا كانوا قد أخرجوا معهم النساء لئلا يفروا،
فلماذا فروا حين حميت الحرب، وتركوا النساء؟!.
والجواب عن ذلك سيأتي حين الكلام عن هذا الموضوع، إن
شاء الله تعالى.
ويقولون:
إن العباس بن
عبد المطلب كتب إلى النبي «صلى الله عليه وآله» يخبره بمسير قريش،
وبكيفية أحوالهم، وبعددهم، مع رجل غفاري، على أن يصل إلى المدينة في
ثلاثة أيام، فقدم الغفاري المدينة، وسلم الكتاب إلى النبي «صلى الله
عليه وآله»، وهو على باب مسجد قباء، فقرأه له أبي بن كعب، فأمره «صلى
الله عليه وآله» بالكتمان([8]).
ووقعت الأراجيف بالمدينة، وقال
اليهود:
إن الغفاري ما جاء بخبر يسر محمداً. وفشا الخبر بخروج
المشركين قاصدين المدينة بعدتهم وعددهم، هكذا قالوا.
ولكننا في مقابل ذلك:
نجد الواقدي يذكر: أن نفراً
من خزاعة فيهم عمرو بن سالم سروا من مكة أربعاً،
فوافوا قريشاً، وقد عسكروا بذي طوى، فلما وصلوا المدينة أخبروا رسول
الله «صلى الله عليه وآله» الخبر، ثم انصرفوا، فلقوا قريشاً ببطن رابغ
على أربع ليال من المدينة.
فقال أبو سفيان:
أحلف بالله، إنهم جاؤوا محمداً فخبروه بمسيرنا، وعددنا،
وحذروه منا، فهم الآن يلزمون صياصيهم، فما أرانا نصيب منهم شيئاً
في وجهنا.
فقال صفوان بن أمية:
إن لم يصحروا
لنا عمدنا إلى نخل الأوس والخزرج فقطعناه، فتركناهم ولا أموال لهم؛ فلا
يختارونها أبداً. وإن أصحروا لنا فعددنا أكثر من عددهم وسلاحنا أكثر من
سلاحهم، ولنا خيل، ولا خيل معهم، ونحن نقاتل على وتر لنا عندهم، ولا
وتر لهم عندنا([9]).
وقد يقال:
لا مانع من أن يكون الخبر قد وصل إلى النبي «صلى الله
عليه وآله» من قبل الغفاري، ومن قبل هـؤلاء
معـاً.
وقبل أن نمضي في الحديث نشير في ما يلي إلى بعض النقاط، وهي التالية:
ويرد هنا سؤال وهو:
كيف قبلت قريش بـإقامـة
العباس في مكة مسلماً
ـ إذا صح أنه أسلم في بدر ـ وقريش لم تكن لترحم أحباءها وأبناءها إذا
علمت بإسلامهم، ولا سيما بعد تلك النكبة الكبرى التي أصابتها على يد
ابن أخيه في بدر، حيث قتل أبناءها وآباءها وأشرافها؟
إلا أن يقال:
إنه كان مسلماً
سراً،
وقد أمره «صلى الله عليه وآله» بالبقاء في مكة؛ ليكون عيناً
له، ولازم ذلك هو أن يتظاهر بالشرك، وأنه معهم، وعلى دينهم.
وقد تقدمت بعض تساؤلات حول وضع العباس في مكة في غزوة
بدر، فلا نعيد.
ويلاحظ هنا:
أن أبا سفيان لم يكن يثق بمن هم على دينه، ولا يستطيع
أن يعتمد عليهم، ولذلك نراه يبادر إلى اتهامهم بأنهم قد أخبروا محمداً
بمسيرهم، وعددهم، وحذروه منهم.
وقد أشير إلى هذه الحالة في حديث
سدير، قال:
قلت لأبي عبد الله: إني لألقى الرجل لم أره ولم يرني
فيما مضى قبل يومه ذلك؛ فأحبه حباً
شديداً،
فإذا كلمته وجدته لي مثلما أنا عليه له، ويخبرني: أنه يجد لي مثل الذي
أجد له.
فقال:
صدقت يا سدير،
إن ائتلاف قلوب الأبرار إذا التقوا ـ وإن لم يظهروا التودد بألسنتهم ـ
كسرعة اختلاط قطر السماء مع مياه الأنهار، وإن بُعد ائتلاف قلوب الفجار
إذا التقوا ـ وإن أظهروا التودد بألسنتهم ـ كبُعد البهائم عن التعاطف،
وإن طال اعتلافها على مذود واحد([10]).
ويمكن
أن
يستفاد هذا المعنى أيضاً من بعض الآيات القرآنية، قال تعالى: ﴿وَلاَ
يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ
خَلَقَهُمْ﴾([11]).
وقال تعالى: ﴿وَأَلَّفَ
بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا
أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ الله أَلَّفَ بَيْنَهُمْ
إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾([12]).
وقال: ﴿وَاذْكُرُواْ
نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً﴾([13]).
وموجز القول في سر ذلك:
وهو ما أشار إليه الطباطبائي أيضاً، الذي سنكتفي بتلخيص
كلامه لما فيه من الخصوصيات، وإن كان أصل الكلام قد كان محط نظرنا
أيضاً: أن الكفار إنما يلتقون على مصالحهم الدنيوية الشخصية، ويتفقون
ويختلفون على أساسها؛ وذلك لأن الإنسان يحب بطبعه أن يخص نفسه باللذائذ
والنعم، وعلى هذا الأساس يحب هذا ويبغض ذاك.
وحيث
إنه
لا يستطيع أن يلبي كل ما يحتاج إليه من ضروريات حياته؛ فإنه لا بد له
من حياة اجتماعية تعينه على ذلك، ويتبادل مع الآخرين ثمرات الأتعاب،
حيث إن كل شخص له مؤهلات تجعله يختص ببعض الامتيازات لنفسه: من مال، أو
جمال، أو طاقات فكرية، أو نفسية، أو غريزية، أو غير ذلك.
هذه الامتيازات التي تطمح إليها النفوس، ويتنافس فيها
البشر عموماً.
وبسبب الاحتكاكات المتوالية، وما يصاحبها من وجوه الحرمان، والبغي،
والظلم، والشح، والكرم في هذه الأمور التي يتنافسون فيها، فإن العداوات
والصداقات تنتج عن ذلك.
وأما محاولات بذل النعم لفاقديها، فإنهـا
لا ترفع هذه النزاعـات
والعداوات وغيرها إلا في موارد جزئية. أما الحالة العامة فتبقى على
حالها؛ لأن هذا البذل لا يبطل غريزة الاستزادة، والشح الملتهب، على أن
بعض النعم لا تقبل إلا الاختصاص والانفراد، كالملك، والرئاسة، فالشرور
والأحقاد التي تتولد عن ذلك باقية على حالها. هذه حالة المجتمع الكافر
بالله، الذي لا يؤمن إلا بالمصلحة الدنيوية الشخصية، واللذات الحاضرة.
ولكن الله قد منَّ
على المسلمين، وأزال الشحَّ
من نفوسهم: ﴿وَمَن
يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾([14])
وألَّف
بين قلوبهم، وذلك لأنه عرَّفهم:
أن الحياة الإنسانية حياة خالدة، وأن الحياة الدنيا زائلة لا قيمة لها،
وأن اللذة المادية لا قيمة لها، واللذة الواقعية هي أن يعيش الإنسان في
كرامة عبودية الله سبحانه، ورضوانه، والقرب والزلفى منه تعالى، مع
النبيين والصديقين، وهناك اللذة الحقيقية الدائمة، قال تعالى: ﴿وَمَا
هَذِهِ الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ
الْآخِرَةَ لَهِيَ الحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾([15]).
كما أنه لا يملك أحد لنفسه نفعاً
ولاضرراً، ولا موتاً ولا حياة، بل هو في تصرف الله الذي بيده الخير
والشر، والنفع والضر، والغنى والفقر. وكل نعمة هي هبة من ربه، وما حرم
منه احتسب عند ربه أجره، وما عند الله خير وأبقى. وإذ لم يعد للمادة
قيمة عند المؤمنين؛ فإن أسباب الضغن والحقد تزول، ويصبحون بنعمته
إخواناً، ولا يبقى في نفوسهم غل، وحسد، ورين([16]).
وهكذا يتضح:
أن موقف الخزاعيين، وعدم التزامهم بنصر قومهم، والحفاظ
على أسرارهم أمر طبيعي.
كما أن سوء ظن أبي سفيان، وعدم ثقته بهم هو أيضاً نتيجة
طبيعية للشرك، وعدم الإيمان.
ومن كل ذلك نعرف أيضاً سر عدم تأثير تشجيع النساء في
ثبات المشركين، ولم يمنعهم عار أسر نسائهم من الهزيمة، وتركوهن في معرض
السبي، مع أنهم أخرجوهن لهدف هو عكس ذلك تماماً.
ولكن الأمر بالنسبة للمسلمين (الحقيقيين) كان على عكس
ذلك تماماً
كما سنرى.
قد رأينا:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» يأمر أُبياً
بكتمان خبر مسير قريش، ويستفيد من عنصر السرية، كي لا يفسح المجال أمام
الحرب النفسية، التي لا بد أن يمارسها اليهود والمنافقون ضد المسلمين؛
وليفوت الفرصة عليهم، ويحبط مؤامراتهم المحتملة؛ لأنهم في الحقيقة ـ
وهم العدو الواقعي ـ هم العدو الأخطر، والمطلع على مواطن الضعف والقوة
لدى المسلمين. أي أن إعلان الأمر في وقت مبكر لسوف يستدعي إصراراً
على معرفة خطة المواجهة مع العدو، وهذا يسهل على المتآمرين والخونة وضع
الخطط اللازمة لإفشال خطة المسلمين في الدفاع عن أنفسهم.
كـما
أنـه
يعطي أعداءهـم
الفـرصة
لإعـلام
قـريـش
بـالأمـر،
وبكـل
الخصوصيات اللازمة لمواجهة خطة المسلمين وإفشالها، أو على الأقل تكبيد
المسلمين أكبر عدد ممكن من الخسائر. وعنصر السرية هذا قد اعتمده النبي
«صلى الله عليه وآله» في أكثر من موقف في معركة أحد هذه وفي غيرها، كما
سنرى.
ولما انتهت قريش إلى الأبواء، ائتمروا في أن ينبشوا قبر
أم محمد «صلى الله عليه وآله»، وقالوا: «فإن النساء عورة؛ فإن يصب من
نسائكم أحداً،
قلتم: هذه رمة أمك. فإن كان براً
بأمه ـ كما يزعم ـ فلعمري لنفادينهم برمة أمه، وإن لم يظفر بأحد من
نسائكم، فلعمري ليفدين رمة أمه بمال كثير، إن كان بها براً»([17]).
وكانت زعيمة هذا الرأي هند زوجة أبي سفيان، فاستشار أبو
سفيان أهل الرأي من قريش، فقالوا: لا تذكر من هذا شيئاً؛ فلو فعلنا
نبشت بنو بكر وخزاعة موتانا.
وسارت قريش حتى نزلت بذي الحليفة، وسرَّحوا
إبلهم في زروع المدينة، التي كان المسلمون قد أخلوها من آلة الزرع قبل
ذلك، وأرسل النبي «صلى الله عليه وآله» بعض العيون لمراقبتهم، وأرسل
أيضاً الحباب بن المنذر سرَّاً
لمعرفة عددهم وعدتهم، وقال له: إذا رجعت فلا تخبرني بين أحد من
المسلمين، إلا أن ترى في القوم قلة، فرجع إليه فأخبره خالياً،
وأمره الرسول «صلى الله عليه وآله» بالكتمان([18]).
ونشير نحن هنا إلى أمرين:
إن سبب أمره «صلى الله عليه وآله» عينه الذي أرسله
إليهم بذلك واضح، فإن معرفة المسلمين بعددهم وعدتهم سوف يثبط من عزائم
بعضهم، ممن اعتادوا أن يقيسوا الأمـور بالمقاييس المـادية، ولم
يتفاعلـوا بعد مع دينهـم وعقيدتهم، بشكل كامل، ولا اطلعوا على تعاليم
الإسلام وأهدافه، وارتبطوا بها عقلياً، ووجدانياً، وعاطفياً، وسلوكياً،
بنحو أعمق وأقوى، وإنما دخلوا في الإسلام، إما عن طريق الإعجاب، أو
القناعة العقلية. ولم تمض على دخولهم فيه إلا فترة قصيرة جداً.
إن ما فكر به القرشيون من نبش قبر أمه «صلى الله عليه
وآله»، إنما يعبر عن مدى الإسفاف الفكري لدى قريش، حتى إنها لتفكر
باتباع أبشع أسلوب وأدناه في حربها مع المسلمين. وهذا إن دل على شيء،
فإنما يدل على أمور:
أحدها:
إفلاسهم على صعيد المنطق والفكر، وحتى على صعيد الخلق
الإنساني، بل والعلاقات والضوابط المعقولة، في المواجهة مع المسلمين
الذين هم القمة في كل ذلك.
الثاني:
مدى حقدهم الدفين على الإسلام والمسلمين.
الثالث:
مدى عمق الجرح، وعنف الصدمة الساحقة التي تلقتها قريش
في بدر، ولا تزال تتلقاها على صعيد طرق قوافل تجارتها إلى الشام،
ويحتمل إلى الحبشة أيضاً.
النبي
 يستشير أصحابه:
يستشير أصحابه:
ويقول المؤرخون:
إنه لما نزل المشركون قرب المدينة، وبثَّ
المسلمون الحرس عليها، وخصوصاً
على
مسجد الرسول، وأراد «صلى الله عليه وآله» الشخوص،
فجمع
أصحابه للتشاور في أمر جيش لم يواجه المسلمون مثله من قبل، عدة وعدداً.
ويذكرون أيضاً:
أنه «صلى الله عليه وآله» أخبرهم برؤيا رآها، رأى بقراً
يُذبح،
وأن في سيفه ثلمة، وأنه في درع حصينة، فأول البقر: بناس من أصحابه
يقتلون.
والثلمة:
برجل من أهل بيته يقتل.
والدرع:
بالمدينة.
وللرواية نصوص أخرى لا مجال لها.
وإذا كانت رؤيا النبي «صلى الله عليه وآله» من الوحي،
وكانت هذه الرواية صحيحة؛ فإن ذلك يكون توطئة لإعلامهم بالموقف الصحيح،
وأن عليهم أن يلتزموا بتوجيهات رسول الله «صلى الله عليه وآله» فيما
يرتبط بالتخطيط والتنفيذ في المواجهة مع العدو.
ولكنهم اتجهوا في مواقفهم وقراراتهم نحو العكس من ذلك،
حيث يقولون: إن ابن أبي قد أشار بالبقاء في المدينة، فإذا أقبل العدو
رماه الأطفال والنسوة بالحجارة، وقاتله الرجال بالسكك. وإن أقام في
خارج المدينة أقام في شر موضع.
وكان «صلى الله عليه وآله» ـ كما يقولون ـ كارهاً
للخروج من المدينة أيضاً. ولكن من لم يشهد بدراً،
وطائفة من الشباب المتحمسين الذين ذاقوا حلاوة النصر في بدر، ومعهم
حمزة بن عبد المطلب، وأهل السن، قد رغبوا بالخروج وأصروا عليه، لأنهم ـ
كما يقول البعض ـ يرون خيل قريش وإبلها ترعى زروعهم، وتعيث فيها فساداً.
واحتجوا لذلك:
بأن إقامتهم في المدينة ستجعل عدوهم يظن فيهم الجبن،
فيجرؤ عليهم.
وقالوا:
(وقد كنت يوم بدر في ثلاثمائة رجل؛ فأظفرك الله بهم،
ونحن اليوم بشر كثير).
بعد أن ذكروا:
أن هذا أمر قد ساقه الله إليهم في ساحتهم.
قال نعيم بن مالك:
يا نبي الله، لا تحرمنا الجنة؛ فوالذي نفسي بيده
لأدخلنها.
فقال له
«صلى
الله عليه وآله»:
بم؟
قال:
بأني أحب الله ورسوله، ولا أفر من الزحف.
فقال له «صلى الله عليه وآله»:
صدقت.
وقال له أنصاري:
متى نقاتلهم يا رسول الله، إن لم نقاتلهم عند شعبنا؟
وقال آخر:
إني لا أحب أن ترجع قريش إلى قومها لتقول: حصرنا محمداً
في صياصي يثرب وآطامها؛ فتكون هذه جرأة لقريش، وها هم قد وطأوا سعفنا،
فإذا لم نذبَّ
عن عرضنا فلم ندرع؟!.
وقال آخر:
إن قريشاً مكثت حولاً
تجمع الجموع، وتستجلب العرب في بواديها، ومن اتبعها من أحابيشها، ثم
جاؤونا قد قادوا الخيل، واعتلوا الإبل، حتى نزلوا ساحتنا؛ فيحصروننا في
بيوتنا وصياصينا؟ ثم يرجعون وافرين لم يكلموا؟! فيجرؤهم ذلك علينا، حتى
يشنوا الغارات علينا، ويصيبوا أطلالنا، ويضعوا العيون والأرصاد علينا.
مع ما قد صنعوا بحروثنا، ويجترئ علينا العرب حولنا الخ..
وثمة كلام آخر هنا يروى عن حمزة وغيره لا مجال له هنا،
فمن أراد المزيد فعليه بمراجعة المصادر.
وأبى كثير من الناس إلا الخروج، فنزل «صلى الله عليه
وآله» على رأي غالبية الناس، ثم دخل بيته ليلبس لامة الحرب. ففي هذه
الأثناء أدركهم الندم على إصرارهم على النبي «صلى الله عليه وآله»
واستكراههم له، وهو أعلم بالله وما يريد، ويأتيه الوحي من السماء.
فلما خرج النبي «صلى الله عليه وآله» عليهم وقد لبس
لامته، ليتوجه مع أصحابه إلى حرب قريش، قالوا: يا رسول الله، امكث كما
أمرتنا.
فقال
«صلى
الله عليه وآله»:
ما ينبغي لنبي
إذا أخذ لامة الحرب أن يرجع حتى يقاتل([19]).
ثم وعظهم وعقد الألوية، وخرج بجيشه لحرب قريش وجمعها.
وفي رواية:
أنهم لما صاروا على الطريق قالوا: نرجع.
قال
«صلى
الله عليه وآله»:
ما كان ينبغي لنبي إذا قصد قوماً
أن يرجع عنهم.
وههنا أمور هامة لا بد من التنبيه عليها:
قد تقدم في
أوائل
هذا الكتاب في فصل «سرايا وغزوات قبل بدر»،
وفي نفس موقعة بدر بعض الكلام حول استشارة الرسول الأكرم «صلى الله
عليه وآله» لأصحابه في أمر الحرب.
ونعود هنا للإشارة إلى هذا الأمر من جديد، على أمل أن
يضم القارئ ما كتبناه هنا وهناك، وهنالك، بعضه إلى بعض، ويستخلص
النتيجة المتوخاة من طرح هذا الموضوع، والإشارة إلى جوانبه المختلفة
فنقول: إنه لا ريب في حسن المشاورة وصلاحها.
وقد ورد الحث عليها في الأخبار الكثيرة.
ويقولون:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد شاور أصحابه في أكثر
من مرة ومناسبة، حتى نزل في مناسبة حرب أحد قوله تعالى: ﴿فَبِمَا
رَحْمَةٍ مِّنَ الله لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ
الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى
الله إِنَّ الله يُحِبُّ المُتَوَكِّلِينَ، إِن يَنصُرْكُمُ الله فَلاَ
غَالِبَ لَكُمْ ..﴾([20]).
وعن ابن عباس بسند حسن:
لما نزلت: ﴿وَشَاوِرْهُمْ
فِي الأَمْرِ﴾،
قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: أما إن الله ورسوله لغنيان عنها،
ولكن جعلها الله رحمة لأمتي؛ فمن استشار منهم لم يعدم رشداً،
ومن تركها لم يعدم غياً([21]).
والسؤال هنا هو:
إنه إذا كان الله ورسوله غنيين عنها، فلماذا يأمر الله
تعالى نبيه بأن يشاور أصحابه في الأمر؟!.
وسؤال آخر، وهو:
هل يمكن بضم الآية التي في سورة الشورى: ﴿وَأَمْرُهُمْ
شُورَى بَيْنَهُمْ﴾([22])،
وبضم سـائر
الروايـات
التي تحث على الاستشارة ـ هل يمكن ـ أن نفهم من ذلك: ضرورة اتخاذ
الشورى كمبدأ في الحكم والسياسة، وفي الإدارة، وفي سائر الموارد
والمواقف، حسبما تريد بعض الفئات أن تتبناه، وتوحي به على أنه أصل
إسلامي أصيل ومطرد؟!.
أما الجواب عن السؤال الأول:
فنحسب أن ما تقدم في الجزء السابق من هذا الكتاب في فصل سرايا وغزوات
قبل بدر، وكذا ما تقدم من الكلام حول الشورى في بدر([23])
كاف فيه، ونزيد هنا تأييداً
لما ذكرناه هناك ما يلي:
1 ـ
قد يقال: إن بعض الروايات تفيد: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يكن
يستشير أصحابه إلا في أمر الحرب.
فقد روي بسند رجاله ثقات، عن عبد
الله بن عمرو، قال:
كتب أبو بكر إلى عمرو بن العاص: إن رسول الله شاور في الحرب، فعليك به([24]).
وإن كنا نرى:
أن هذا لا يفيد نفي استشارته «صلى الله عليه وآله» في
غير الحرب.
2 ـ
إن قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿وَشَاوِرْهُمْ
فِي الأَمْرِ﴾
خاص بالمشاورة في الحرب، لأن اللام في الآية ليست للجنس بحيث تشمل كل
أمر، بل هي للعهد، أي شاورهم في هذا الأمر الذي يجري الحديث عنه، وهو
أمر الحرب، كما هو واضح من الآيات السابقة واللاحقة؛ فالتعدي إلى غير
الحرب يحتاج إلى دليل.
3 ـ
إن الآية تنص على أن استشارة النبي «صلى الله عليه
وآله» لأصحابه لا تعني أن يأخذ برأيهم حتى ولو اجتمعوا عليه؛ لأنها تنص
على أن اتخاذ القرار النهائي يرجع إلى النبي «صلى الله عليه وآله»
نفسه، حيث قال تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ
فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله﴾.
4 ـ
لقد ذكر العلامة السيد عبد المحسن فضل الله «رحمه
الله»:
أن الأمر في الآية ليس للوجوب؛ وإلا لكانت بقية الأوامر في الآية كذلك،
ويلزم منه وجوب العفو عن كبائرهم حتى الشرك. وإذا كان الضمير في الآية
يرجع إلى الفارين فهو يعني: أن الشورى تكون لأهل الكبائر من أمته، مع
أن الله قد نهى رسوله عن إطاعة الآثم، والكفور، ومن أغفل الله قلبه([25]).
فالحق:
أن الأمر وارد
عقيب توهم الحظر عن مشاورة هؤلاء، ليبيح مشاورتهم، ومعاملتهم معاملة
طبيعية ([26]).
5 ـ
إن رواية ابن عباس المتقدمة تفيد: أن استشارته «صلى
الله عليه وآله» أصحابه لا قيمة لها على صعيد اتخاذ القرار؛ لأن الله
ورسوله غنيان عنها، لأنهما
يعرفان صواب الآراء من خطئها، فلا تزيدهما الاستشارة علماً،
ولا ترفع جهلاً،
وإنما هي أمر تعليمي أخلاقي للأمة؛ بملاحظة فوائد المشورة لهم؛ لأنها
تهدف إلى الإمعان في استخراج صواب الرأي بمراجعة العقول المختلفة. فعن
علي أمير المؤمنين «عليه السلام»: من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال
شاركها في عقولها([27]).
وعنه أيضاً:
الاستشارة عين
الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه([28]).
وعن أنس عن النبي
«صلى
الله عليه وآله»:
ما خاب من استخار، وما ندم من استشار([29]).
إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه.
وإذا كانت الاستشارة أمراً
تعليمياً
أخلاقياً،
فلا محذور على الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» فيها.
يقول الشهيد السعيد، الشيخ مرتضى مطهري، قدس الله نفسه
الزكية:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» وهو في مقام النبوة، وفي
حين كان أصحابه يتفانون في سبيله، حتى ليقولون له: إنه لو أمرهم بأن
يلقوا أنفسهم في البحر لفعلوا، فإنه لا يريد أن ينفرد في اتخاذ القرار،
لأن أقل مضار ذلك هو أن لا يشعر أتباعه بأن لهم شخصيتهم وفكرهم
المتميز، فهو حين يتجاهلهم كأنه يقول لهم: إنهم لا يملكون الفكر والفهم
والشعور الكافي، وإنما هم مجرد آلة تنفيذ لا أكثر ولا أقل، وهو فقط
يملك حرية إصدار القرار، والتفكير فيه دونهم.
وطبيعي أن ينعكس ذلك على الأجيال بعده «صلى الله عليه
وآله»، فكل حاكم يأتي سوف يستبد بالقرار، وسيقهر الناس على الانصياع
لإرادته، مهما كانت، وذلك بحجة أن له في رسول الله «صلى الله عليه
وآله» أسوة حسنة. مع أنه ليس من لوازم الحكم،
الاستبداد بالرأي، فقد استشار النبي «صلى الله عليه وآله» ـ وهو معصوم
ـ أصحابه في بدر وأحد([30])
انتهى.
ونزيد نحن هنا:
أن ظروف وأجواء آية: ﴿وَشَاوِرْهُمْ
فِي الأَمْرِ﴾
تشعر بأنه قد كان ثمة حاجة لتأليف الناس حينئذٍ، وجلب محبتهم وثقتهم،
وإظهار العطف والليونة معهم، وأن لا يفرض الرأي عليهم فرضاً،
رحمة لهم، وحفاظاً
على وحدتهم واجتماعهم، ولمّ شعثهم، وجمع كلمتهم، وكبح جماحهم؟!
فالآية تقول: ﴿فَبِمَا
رَحْمَةٍ مِّنَ الله لِنتَ لهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ
الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
لهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾([31]).
فكأنه كان قد بدر من أصحابه أمر سيء يستدعي العفو عنهم
واللين معهم، وإرجاع الاعتبار إليهم، ليطمئنوا إلى أن ما بدر منهم لم
يؤثر على مكانتهم عنده، فلا داعي لنفورهم منه.
يضاف إلى ذلك:
أنه حين يكون الأمر مرتبطاً بالحرب، فإن الأمر يحتاج
إلى قناعة تامة بهـا، واستعداد لتحمل نتائجها، وإقـدام عليها بمحض
الإدارة والإختبار من دون ممارسة أي إكراه أو إجبار في ذلك..
هذا كله،
عدا عما قدمناه حين الكلام على بدر، وعلى السرايا التي
سبقتها، في الجزء السابق من هذا الكتاب، فليراجع.
نشير إلى ما يلي:
1 ـ
ما قدمناه: من أن قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ
شُورَى بَيْنَهُمْ﴾([32])
ليس إلا أمراً
تعليمياً
أخلاقياً،
وليس إلزامياً
يوجب التخلف عنه العقاب، وإنما يمكن أن يوجب وقوع الإنسان في بعض
الأخطاء، فيكون عليه أن يتحمل آثارها، ويعاني من نتائجها.
2 ـ
إن الضمير في ﴿أَمْرُهُمْ﴾
يرجع إلى المؤمنين، والمراد به الأمر الذي يرتبط بهم؛ فالشورى إنما هي
في الأمور التي ترجع إلى المؤمنين وشؤونهم الخاصة بهم، وليس للشرع فيها
إلزام أو مدخلية، كما في أمور معاشهم ونحوها، مما يفترض في الإنسان أن
يقوم به. أما إذا كان ثمة الزام شرعي فـ
﴿مَا
كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ
أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾([33])
﴿وَأَطِيعُواْ
اللهَ وَالرَّسُولَ﴾([34]).
فمورد الحكم، والسياسة، والإدارة، وغير ذلك، لا يمكن أن يكون شورائياً
إلا إذا ثبت أن الشارع ليس له فيه حكم، ونظر خاص.
وقد قال العلامة الطباطبائي
«رحمه
الله»:
«والروايات في المشاورة كثيرة جداً، وموردها ما يجوز
للمستشير فعله وتركه بحسب المرجحات.
وأما الأحكام الإلهية الثابتة، فلا مورد للاستشارة
فيها، كما لا رخصة فيها لأحد، وإلا كان اختلاف الحوادث الجارية ناسخاً
لكلام الله تعالى»([35]).
3 ـ
قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ
فِي الأَمْر﴾([36])
ظاهر في كون ذلك في ظرف كونه حاكماً
ووالياً
عليهم؛ فإن عليه أن يستشيرهم في هذا الظرف. وهذا لا يعني أبداً أن يكون
نفس الحكم شورائياً
وانتخابياً،
بأي وجه.
هذا كله، عدا عن احتمال أن يكون هذا الأمر وارداً
في مقام توهم الحظر، فلا يدل على أكثر من إباحة المشاورة، ولا يدل على
الإلزام بها. وهو احتمال قوي كما أوضحناه في ما سبق.
4 ـ
إن القرار النهائي يتخذه المستشير نفسه، ولربما وافق رأي الأكثر،
ولربما خالفهم.
ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله﴾([37]).
وليس في الآية إلزام برأي الأكثرية، بل ولا برأي الكل
لو حصل إجماعهم على رأي واحد.
5 ـ
إن هذه الشورى التي دل عليها قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ
شُورَى بَيْنَهُمْ﴾([38])
ليست لكل أحد، وإنما هي خاصة بأولئك المؤمنين الذين لهم تلك الصفات
المذكورة في الآيات قبل وبعد هذه العبارة، وليس ثمة ما يدل على تعميمها
لغيرهم، بل ربما يقال بعدم التعميم قطعاً،
فقد قال تعالى: ﴿فَمَا
أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ
اللهَ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ، وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ
وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، وَالَّذِينَ
اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، وَالَّذِينَ إِذَا
أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ﴾([39]).
فهؤلاء
الذين صرحت الآيات بإيمانهم وبحيازتهم لهذه الصفات،
هم أهل الشورى
دون أحد سواهم([40])،
وليس لغيرهم الحق في أن يشاركهم فيها، لأن ذلك الغير، لا يؤمن على نفسه،
فكيف يؤمن على مصالح العباد، ودمائهم، وأموالهم، وأعراضهم؟!.
واللافت:
أننا لا نجد لعلي «عليه السلام» أي حضور في مواقع
الاعتراض أو الاقتراح على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، لأنه كان
دائماً في موقع التسليم لرسول الله، والرضا بما يرضاه صلوات الله
وسلامه عليهما.
ويقول الشهيد السعيد، السيد محمد
باقر الصدر، قدس الله نفسه الزكية، ما ملخصه:
إن الله عز وجل قد جعل الخلافة لآدم «عليه
السلام»،
لا بما أنه آدم، بل بما أنه ممثل لكل البشرية، فخلافة الله في الحقيقة
هي للأمة وللبشر أنفسهم، فقد قال تعالى: ﴿وَإِذْ
قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ
مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾([41]).
كما أن المراد بالأمانة في قوله تعالى: ﴿إِنَّا
عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾([42])هذه
الخلافة بالذات، وهي التي تعني الإدارة والحكم في الكون.
واستشهد على ذلك أيضاً بقوله تعالى: ﴿يَا
دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ
النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾([43]).
وبقوله تعالى: ﴿إِذْ
جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ﴾([44]).
وبقوله تعالى: ﴿ثُمَّ
جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ﴾([45]).
ورتب على ذلك:
أنه بعد وفاة النبي «صلى الله عليه وآله»، وفقد الإمام،
وتحرر الأمة من الطاغوت، تمارس الأمة دورها في الخلافة الزمنية، ويكون
دور المجتهد المرجع هو الشهادة والرقابة على الأمة.
وقال ما ملخصه:
إن الله هو رب الأرض وخيراتها، ورب الإنسان والحيوان،
فالإنسان مستخلف على كل ذلك. ومن هنا كانت الخلافة في القرآن أساساً
للحكم.
وقد فرع الله الحكم بين النـاس
على جعل داود خليفة. ولمـا
كـانت
الجماعة البشرية هي التي منحت ـ ممثلة بآدم ـ هذه الخلافة، فهي إذاً
المكلفة برعاية الكون، وتدبير أمر الإنسان، والسير بالبشرية في الطريق
المرسوم للخلافة الربانية.
وهذا يعطي مفهوم الإسلام الأساسي عن الخلافة، وهو أن
الله تعالى قد أناب الجماعة البشرية في الحكم، وقيادة الكون وإعماره،
اجتماعياً
وطبيعياً.
وعلى هذا الأساس تقوم نظرية حكم الناس لأنفسهم، وشرعية
ممارسة الجماعة البشرية حكم نفسها بوصفها خليفة عن الله. وفي عملية
إعداد وتربية الأمة يتولى النبي والإمام مسؤولية الرقابة والشهادة على
الأمة، ومسؤولية الخلافة؛ ليهيئ الأمة لتحمل مسؤولياتها في الوقت
المناسب.
وبعد أن فقد الإمام «عليه
السلام»،
بسبب ظروف معينة عرضت لها الأمة؛ فإن المرجع ـ غير المعصوم ـ لا بد أن
يتولى أمر الخلافة والشهادة ما دامت الأمة محكومة للطاغوت، ومقصاة عن
حقها في الخلافة العامة.
«وأما إذا حررت الأمة نفسها، فخط الخلافة ينتقل إليها؛
فهي التي تمارس الخلافة السياسية والاجتماعية في الأمة، بتطبيق أحكام
الله، وعلى أساس الركائز المتقدمة للاستخلاف الرباني.
وتمارس الأمة دورها في الخلافة في الإطار التشريعي
للقاعدتين القرآنيتين التاليتين: ﴿وَأَمْرُهُمْ
شُورَى بَيْنَهُمْ﴾،
﴿وَالمُؤْمِنُونَ
وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ﴾([46]).
فإن النص الأول:
يعطي للأمة
صلاحية ممارسة أمورها عن طريق الشورى، ما لم يرد نص خاص على خلاف ذلك.
والنص الثاني:
يتحدث عن الولاية، وأن كل مؤمن ولي الآخرين. ويريد
بالولاية تولي أموره، بقرينة تفريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
عليه.
والنص ظـاهر
في سريان الولايـة
بين كـل
المؤمنين والمؤمنـات
بصورة متساوية.
وينتج عن ذلك:
الأخذ بمبدأ الشورى، وبرأي الأكثرية عند الاختلاف.
وهكذا، وزع الإسلام في عصر الغيبة
مسؤوليات الخطين بين المرجع والأمة، وبين الاجتهاد الشرعي والخلافة
الزمنية»([47])
إلى آخر كلامه قدس الله نفسه الزكية.
ونحن نسجل هنا النقاط التالية:
أولاً:
إن الآية القرآنية التي استدل بها رحمه الله تقول: ﴿وَالمُؤْمِنُونَ
وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾([48]).
فإذا كان تفريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليلاً
على أن المراد بالولاية هو تولي أمور بعضهم البعض، كما ذكره قدس الله
نفسه الزكية،
فما هو وجه تفريع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على
ذلك؟!.
ولم لا يُفهم من الآية:
أنها ـ فقط ـ في مقام إعطاء حق الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر للمؤمنين جميعاً؛ فهي تجعل لهم الولاية بهذا المقدار، لا
أكثر؟!.
بل لم لا يُفهم منها:
أنها في مقام إعطائهم حق الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر، بسبب محبة بعضهم بعضاً،
أو بسبب كون بعضهم تابعاً
لبعض، ومطيعاً
له، أو بسبب نصرته له، ونحو ذلك.
فقد وردت للولي معان كثيرة، ومنها:
المحب، والصديق، والنصير، والولي: فعيل، بمعنى فاعل، من
وليه إذا قام به، قال تعالى: ﴿الله
وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ
يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾([49]).
بل إن من يلاحظ آيات إعطاء الولاية للمؤمنين وسواها من
الآيات، يخرج بحقيقة: أن الله سبحانه يريد للناس المؤمنين أن يكونوا
أمة واحدة، وبمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر
الأعضاء.
وكل
هذه
الأعضاء للجسد الواحد إنما تحافظ على ذلك الواحد بكل ما تقدر عليه،
وذلك بالدفاع عنه؛ وبالنصيحة لجماعة ولأئمة المسلمين.
فالله ولي الذين آمنوا بالتشريع، وحفظ المصالح والحكم،
ولله الأمر من قبل ومن بعد، وللنبي «صلى الله عليه وآله» وللإمام «عليه
السلام»
الولاية أيضاً بجعل من الله، بهدف تدبير أمورهم وقيادتهم.
والمؤمنون المرؤوسون للنبي «صلى الله عليه وآله»
وللإمام «عليه السلام» بعضهم أولياء بعض في النصيحة وحفظ الغيب،
والاهتمام بأمور بعضهم بعضاً، والنصرة، والمعونة، فليس معنى الولاية هو
الحكومة لكل واحد منهم على الآخر أو على المجتمع، بل ولي المجتمع
والحاكم فيه هو الله سبحانه.
وكخلاصة لما تقدم نقول:
إن كل هذه المعاني محتملة في الآية المشار إليها ـ إن
لم يكن من بينها (وهو الأخير) ما هو الأظهر ـ وليس فيها ما يوجب تعين
كون الولي فيها بمعنى الحاكم، والمتولي للأمر.
ثانياً:
لو كانت هذه الآية تعطي حقاً
للمؤمنين في أن يحكم بعضهم بعضاً؛
فاللازم أن تعطي الآيات الأخرى هذا الحق بالذات للكفار، وتصير حكومتهم
على بعضهم البعض شرعية!!
فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ
الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الله وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ
أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ
يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى
يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ
النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ
وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾([50]).
فبقرينة المقابلة في الآية هنا بين ولاية المؤمنين التي
نشأت عنها مسؤوليات النصر وغير ذلك من أمور، تدل على أن المراد
بالولاية تولي الأمور، وبين الآية الدالة على ولاية الكفار بعضهم لبعض،
تكون النتيجة هي: جعل الحاكمية للكفار أيضاً بالنسبة لبعضهم فيما
بينهم، لو كان المراد بالولاية هو تولي الأمور كما يريد المستدل أن
يقول.
ويؤيد ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ﴾([51]).
وقوله
تعالى: ﴿إِنَّا
جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾([52]).
وقوله
تعالى: ﴿إِنَّ
الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالله وَلِيُّ
المُتَّقِينَ﴾([53]).
إلى غير ذلك من الآيات التي بهذا المضمون.
حيث إن المقصود هو النهي عن إطاعة الشياطين، وعن
الانصياع لأوامر اليهود والنصارى.
بل إن الآية الأخيرة تنفي الولاية عن المؤمنين، وتخصها
بالله
تعالى
مع أنها إنما تتحدث عن طبيعة الأمور في الواقع الخارجي والعملي من حيث
إن الظالم يهتم بشؤون الظالم، ولا تريد أن تعطي شرعية لولاية الكافر
على الكافر..
كما أنها تريد أن تسلب شرعية ولاية كافر على مؤمن.
فلو كان المراد بالولاية الحكم، لكانت ولاية الكفار شرعية كما قلنا.
وهذا مما لا يمكن القول به ولا المساعدة عليه، فلا بد
من القول بأن الولاية التي يترتب عليها الأمر بالمعروف، والنهي عن
المنكر، ليست بهذا المعنى، بل هي بمعنى النصيحة، وحفظ الغيب، وأنها
ولاية بهذا المقدار لا أكثر.
والقول:
بأن هذه الآيات ونظائرها ناظرة إلى أن من طبيعة الكفار
أن يتولى بعضهم بعضاً،
وليس في مقام جعل ولاية شرعية لهم.
يقابله القول:
بإنه لم لا تكون الآيات التي تتعرض للولاية بين
المؤمنين ناظرة إلى نفس هذا المعنى أيضاً؟!.
وإذا كانت آيات ولاية الكفار يراد منها الولاية بمعنى
النصرة، والمحبة، ونحو ذلك، فلتكن تلك الآيات لها نفس هذا المعنى
أيضاً، فإنها كلها لها سياق واحد، وتريد أن تنفي وتثبت أمراً واحداً.
ثالثاً:
لو سلمنا أن معنى الآية هو: أن كل مؤمن ولي للآخرين.
وسلمنا أن المراد بالولاية:
ليس هو حفظ مصالح الأمة الإسلامية بالنصيحة، والمعونة، وحفظ الغيب،
وغير ذلك، مع أن ذلك هو الظاهر، وقبلنا بأن المراد بالولاية ولاية
الحكومة، فحينئذٍ لنا أن نسأل: هل يعني ذلك: أن الآية تجعل كل مؤمن
حاكماً على الآخرين، ومحكوماً لهم في آن واحد؟
أم أن الآية تريد فقط:
أن تعطي للبعض الحق في أن يحكم ويتسلط على البعض
الآخر؟!. من دون أن يكون للمحكوم حق في ذلك. وبماذا ترجح هذا على ذاك،
دون العكس يا ترى؟!.
ولو سلمنا:
أن الظاهر هو الثاني، فما هي شرائط هذه الحكومة؟ وما هي ظروفها؟ وما
الذي يجب توفره في هذا الحاكم؟!: العلم؟ الاجتهاد؟ العدالة؟ الخ..
ومن الذي يعين هذا الحاكم، ومن يختاره؟ هل هو المعصوم؟
أم غيره؟.
فإن كل ذلك محتمل، ويحتاج الالتزام به إلى دليل غير هذه
الآية المباركة.
رابعاً:
بالنسبة لآيات الاستخلاف في الأرض والشهادة على الناس
نشير إلى:
1 ـ
إنه ليس في آية سورة الأحزاب: أن المراد بالأمانة:
الخلافة.
وقد قيل:
إنها التكاليف.
وقيل:
هي العقل.
وقيل:
هي الولاية الإلهية.
وقيل:
هي معرفة الله. إلى غير ذلك من الأقوال([54]).
والجزم بأن المراد هو الخلافة، ثم ترتيب أحكام
واستنتاجات معينة على ذلك، ليس بأولى من الجزم بغيره، فلا بد من ترجيح
أحد هذه الوجوه بالقرائن. وليس ثمة ما يوجب الالتزام بخصوص هذا المعنى
دون سواه مما ذكر.
بل إن في الآية التي تلي تلك الآية ما يؤيد أن المراد
بالآية أمر اعتقادي، أو نحو ذلك، وليس الخلافة، فقد قال تعالى: ﴿إِنَّا
عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً، لِيُعَذِّبَ الله
المُنَافِقِينَ وَالمُنَافِقَاتِ وَالمُشْرِكِينَ وَالمُشْرِكَاتِ
وَيَتُوبَ الله عَلَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ الله
غَفُوراً رَّحِيماً﴾([55]).
2 ـ
بالنسبة لآية استخلاف آدم،
نقول: إنه
ليس فيها ما يشير إلى أن المراد هو استخلاف النوع البشري، إلا قول
الملائكة: ﴿أَتَجْعَلُ
فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء﴾([56])؟!.
وهذا لا يدل على أكثر من أن
الملائكة قد فهموا:
أن هذا المخلوق الجديد (الخليفة) له طبيعة فيها مقتضيات
الشر،
وتقتضي
ما ذكروه، ولا تدل على أن الخلافة قد منحت لكل من له هذه الطبيعة.
3 ـ
بل إن هناك من يرى: أن الآية ناظرة إلى ولاية المعصومين، فإن الملائكة
قد رأوا: أن من يسفك الدماء ويفسد ليس أهلاً للخلافة كما أن الله قد
قرر هذه الخلافة لآدم النبي المعصوم الذي علمه الله الأسماء كلها.
4 ـ
ثم، ما المراد بهذا الاستخلاف؟ هل هو الحكم والإمارة؟ أم هو التسليط
على الكون وما فيه في حدود قدراته، وإعطاؤه حق التصرف في ما خلقه الله،
على قاعدة قوله تعالى: ﴿هُوَ
أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾([57])
ولذلك هو يطلب منهم شكر هذه النعمة، والإيمان بالله تعالى؟
الظاهر هو الثاني:
ويؤيد ذلك:
أن من يطالع آيات الاستخلاف يجد: أن أكثرها ناظر إلى
البشر جميعاً، مؤمنهم وكافرهم، ثم هي تهدد الكافرين، وتتوعدهم.
ومما يؤيد أن يكون المراد بالخلافة في أكثر الآيات، هو
إعمار الكون: أنه إذا كان البشر خلفاء؛ فهم خلفاء على أي شيء؟!
إنهم خلفاء ووكلاء على غير أنفسهم؛ إذ لا يعقل أن يكون
الشيء خليفة على نفسه.
فالبشرية لها خلافة على غيرها مما في الكون. وهذا يؤيد
أن يكون معنى الخلافة ليس هو الإمارة.
5 ـ
وفي مقابل ذلك نجد: أنه تعالى لم يستخلف المؤمنين فعلا،
وإنما وعدهم بالاستخلاف حيث قال: ﴿وَعَدَ
اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ﴾([58]).
فالجمع بين هذه الآية، والآيات الأخرى، يحتم علينا أن
نقول: إن المراد بآيات (خلائف) ونحوها، هو النيابة في إعمار الكون،
والتمكين من التصرف في الطبيعة.
والمراد من هذه الآية الأخيرة هو الحكم والسلطان، فهذه
الآية أدل دليل على أن الخلافة بمعنى الحكم والسلطان لم تمنح للبشر
عامة، وإنما وعد الله المؤمنين بها في الوقت المناسب.
والظاهر:
أن ذلك سيكون في زمن ظهور المهدي عليه الصلاة والسلام.
6 ـ
إن آية استخلاف داود، وتفريع الحكم بين الناس بالحق على
هذه الخلافة، التي لا بد أن يكون معناها الحكم والسلطان، لا تدل على
جعل الخلافة لكل البشر؛ فلعل كونه نبياً
لم يتلبس بشيء من الظلم أبداً
ـ كما قال تعالى: ﴿لاَ
يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾([59])
ـ له
مدخلية في استحقاق هذا المنصب الخطـير؛
لأن نيله درجـة
النبوة، إنما هـو
لأجـل
أنه يحمل خصـائص
معينة ـ كـالعصمة
ونحوهـا
ـ أهلته لـذلـك
الأمـر
الخطير الـذي
يتفرع عـلـيـه
الحكم بالحق.
7 ـ
إننا نلاحظ: أنه ليس في جميع الآيات التي استعملت لفظ:
(خليفة)، ومشتقاته ما يدل على أن هذا المستخلف هو خليفة لله لا لغيره.
بل ذكرت الآيات:
أن الله تعالى قد جعل خلفاء، ولم تبين: أنهم خلفاء لمن.
فلعل المراد:
أن آدم «عليه السلام» قد جاء لإعمار الأرض، وقد خلف من
كان عليها من المخلوقات قبله «عليه السلام». وعلى هذا فلا مجال
للاستدلال بتلك الآيات على ما أراده رحمه الله.
ملاحظة:
إن الاستخلاف في الأرض، ليس معناه جعل جميع المناصب
الإلهية لهذا المستخلف. وليس في هذا اللفظ ما يفيد عموم المنزلة؛ بل هو
ينصرف إلى نوع معين من الأمور.
فمثلاً لو قيل:
فلان استخلف فلاناً
على أهله؛
أو على الناس
فإنه ينصرف إلى الاستخلاف في
أمور
معينة يمكن الاستخلاف فيها.
ولا يمكن أن يعني ذلك ثبوت كل حق كان لذاك لهذا، فإن
الاستخلاف حكم يجري في كل مورد قابل لذلك، أو في الموارد التي ينصرف
إليها الكلام بحسب خصوصيات المورد، وبحسب حالات الخطاب.
ولا يمكن أن يتمسك بإطلاق الاستخلاف لإثبات قابلية ما
يشك في قابليته.
خامساً:
إن قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ
شُورَى بَيْنَهُمْ﴾([60])،
يدل على أن الأمور الراجعة لهم هي التي يمكن أن يمارسوا فيها حق
الشورى؛ فلا بد أولاً من إثبات:
أن مسألة الحكم، والتصرف في أمور الغير حق لهم،
ليمكنهم أن يفصلوا فيها عن طريق مبدأ الشورى، ولا يمكن للحكم أن يثبت
موضوعه ويوجده، كما أشرنا إليه آنفاً.
بل إن لدينا ما يدل على أن الحكومة ليست حقاً
للناس، ولا يرجع البت فيها إليهم. وهو ما تقدم حين الكلام عن عرض النبي
«صلى الله عليه وآله» دعوته على القبائل، حيث قال لبني عامر: الأمر لله
يضعه حيث يشاء.
وسيأتي في غزوة بئر معونة:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد قال ذلك لعامر بن الطفيل
أيضاً.
ثم هناك مقبولة ـ بل صحيحة ـ عمر بن
حنظلة التي تقول:
«ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف
أحكامنا، فليرضوا به حكماً،
فإني قد جعلته عليكم حاكماً»([61]).
وكذا قوله:
العلماء حكام على الناس، وروايات كثيرة أخرى. ولم يعين
في الروايات: أن يكون ذلك في زمن الطاغوت، أو في ما بعد الإطاحة به،
ولا صورة رقي الأمة إيمانياً
وفكرياً،
ولا عدمها.
وسادساً:
إن هذه الشورى لا يفهم منها إلا مبدأ كلي مجمل. ولا تدل
على أنه لو خالف بعض الأمة فيما يراد إجراء مبدأ الشورى فيه: فهل ينفذ
حكم الأكثرية على تلك الأقلية؟ أم لا بد من إرضاء الجميع في أي تصرف،
وأية قضية؟ وأنه لو تساوت الآراء فماذا يكون مصير الشورى؟ إلى غير ذلك
مما يرتبط بشرائط الشورى وحدودها، ومواردها.
وأخيراً:
فلو أنه رحمه الله استدل على ولاية الفقيه بقول أمير
المؤمنين «عليه السلام»: «إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه،
وأعلمهم بأمر الله فيه». وبصحيحة عمر بن حنظلة المشار إليها آنفاً
لكان أولى.
فإنها تقرر:
أن الحكم حق للفقيه الجامع للشرائط فقط، ولا يحق لغيره
أن يتصدى له، حيث قال «عليه السلام»: «فإني
قد جعلته عليكم حاكماً».
د: ماذا
يريد
النبي  في
أحد؟ في
أحد؟
غالب الروايات، بل كلها متفقة على أن النبي «صلى الله
عليه وآله» كان يرجح البقاء في المدينة، ولكن إصرار أصحابه هو الذي
دعاه إلى العدول عن هذا الرأي.
ولكن العلامة السيد الحسني «رحمه
الله» يرى:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يرى الخروج إلى العدو، عكس رأي عبد
الله بن أبي بن سلول، وإنما استشارهم «صلى الله عليه وآله» ليختبر
نواياهم، ويستدل على ذلك بما ملخصه:
أن
ملاقاة جيش مكة داخل المدينة سيمكنهم من احتلالها خلال ساعات معدودة؛
لأن المنافقين، والمرتابين من سكان المدينة ـ وعددهم كثير، وكانوا على
اتصال دائم معهم ـ سيعاونونهم على النبي «صلى الله عليه وآله»
والمسلمين.
ولا يعقل أن يخلص ابن أبي ومن معه من المنافقين
والمرتابين من المهاجرين والأنصار في الدفاع عن محمد «صلى الله عليه
وآله» ورسالته، وهم يلتقون مع الغزاة التقاء كاملاً.
وكان ابن أبي هو المشير على الرسول «صلى الله عليه
وآله» بالبقاء في المدينة، ووافقه على ذلك شيوخ المهاجرين. وأدرك النبي
«صلى الله عليه وآله» الغاية، ولكنه بقي يتظاهر بالموافقة على رأي ابن
أبي؛ ليختبر بقية المسلمين، وإن كان فيمن وافق ابن أبي من لا يشك في
حسن نيته، كما أنه لا شك في أن فيهم المتآمرين.
ولما اختبرهم «صلى الله عليه وآله»، وعرف نواياهم، أعلن
عن رأيه الذي كان قد انطوى عليه من أول الأمر.
ويرجح ذلك:
أنه لما خرج المسلمون إلى أحد رجع ابن أبي في ثلاثمائة
وخمسين من أتباعه المنافقين، وبعض اليهود إلى المدينة بلا سبب.
وفي رواية:
أنه هو نفسه «صلى الله عليه وآله» أمرهم بالرجوع، وقال:
لا نحارب المشركين بالمشركين.
وذلك دليل قاطع على سوء نواياهم، وأنه «صلى الله عليه
وآله» كان يتخوف منهم أن ينضموا إلى المشركين حين احتدام الحرب، وإذا
كان في ريب من أمرهم، وهم خارج المدينة؛ فكيف يوافقهم على مقابلة
الغزاة في داخلها، ويطمئن إليهم في الدفاع عنها؟!.
وإذا كان ابن سلول صادقاً في قوله:
إنه سيدافع عن المدينة في الداخل، فلماذا رجع من الطريق
وهو يعلم: أن جيش النبي «صلى الله عليه وآله» بأمس الحاجة إلى
المساعدة؟!.
إذاً، فالخروج من المدينة هو الأصوب، ولو أنه بقي فيها
لأصبح خلال ساعات معدودات تحت رحمة المشركين. إنتهى ملخصاً([62]).
ويؤيد رأي العلامة الحسني أيضاً:
المبدأ الحربي
الذي أطلقه علي «عليه السلام» حينما قال: ما غزي قوم في عقر دارهم إلا
ذلوا([63]).
ونحن هنا نشير إلى ما يلي:
1 ـ
إن أبا سفيان
ـ كما تقدم ـ كان يخشى أن يلزم أهل يثرب صياصيهم، ولا يخرجوا منها([64]).
وهذا يعني:
أنهم يعتبرون بقاء المسلمين في المدينة معناه: تضييع
الفرصة على قريش، وعدم تمكينها من تحقيق أهدافها. وغاية ما استطاع
صفوان بن أمية أن يقدمه لأبي سفيان، كبديل مرض ومقنع، هو أنهم حينئذٍ
سوف يلحقون بأهل المدينة خسائر مادية كبيرة؛ فإنهم إن لم يصحروا لهم
عمدوا إلى نخلهم فقطعوه؛ فتركوهم ولا أموال لهم.
إذاً، فالموقف الصحيح كان هو البقاء في المدينة، فإن
الخسائر المادية يمكن الصبر عليها وتحملها، أما الخسائر في الأرواح،
فإنها تكون أصعب وأنكى، ورسول الله «صلى الله عليه وآله» لم يكن ليعدل
عن الموقف الصحيح هذا.
2 ـ
إن ضرار بن الخطاب كان يخشى مثل ذلك أيضاً، لأن الأنصار
قتلوا قومه يوم بدر، فخرج إلى أحد، وهو يقول:
«إن قاموا في صياصيهم فهي منيعة، لا سبيل لنا إليهم،
نقيم أياماً،
ثم ننصرف. وإن خرجوا إلينا من صياصيهم أصبنا منهم؛ فإن معنا عدداً
أكثر من عددهم، ونحن قوم موتورون، خرجنا بالظعن يذكرننا قتلى بدر،
ومعنا كراع ولا كراع معهم، وسلاحنا أكثر من سلاحهم، فقضي لهم إن خرجوا
الخ..»([65]).
3 ـ
لقد رأينا: أن صفوان بن أمية لم يذكر لأبي
سفيان شيئاً عن احتمال تعاون المنافقين معهم، وتمكينهم من القضاء على
الإسلام والمسلمين بسهولة، أو على الأقل كان على أبي سفيان أن يدرك
ذلك، ويبتهج له.
4 ـ
إن من الواضح: أن ابن أبي، ومن معه لم يكن باستطاعتهم
الإقدام على مثل تلك الخيانة في تلك الظروف؛ لأن معنى ذلك: أن يذبح من
قومه من الخزرج ومن المهاجرين أعداد هائلة، ولم يكن بإمكانه
أن يسمح بذلك، ولا يوافقه عليه من معه؛ لأنهم قومهم وأبناؤهم،
وإخوانهم، وآباؤهم. ولم يكن التخلي عنهم سهلاً
وميسوراً
إلى هذا الحد.
وإذا أرادوا أن يتخلوا عن مثل هؤلاء، ويسلموهم إلى
القتل، بعد أن يقدموا هم أيضاً العديد من القتلى، فمن يبقى لابن أبي ـ
بعد استئصال هؤلاء ـ لا سيما بملاحظة قلة سكان المدينة آنئذٍ؟!.
وهل تبقى المدينة مدينة؟!.
وهل يمكن لابن أبي أن ينصب نفسه ملكاً
على من يتبقى له في ظروف كهذه؟!
وهل سوف ينال هذا المنصب حقاً؟!
وهل يستطيع بعد هذا أن يعتمد على إخلاص من معه له؟!
وهل باستطاعته أن يحتفظ لهم بمكانتهم وبموقعهم في قبال
اليهود، الذين كانت العداوة بينهم وبين أهل يثرب متأصلة على مر
السنين؟!.
وهل يستطيع أيضاً أن يقاوم أطماع من حوله من قبائل
الغزو والغارة؟! أو حتى أن يستقل في اتخاذ القرار عن قريش؟!
وهل باستطاعته أن يأمن قريشاً، ويطمئن إلى التعامل معها
على المدى البعيد، بعد أن أدركت مدى خطر المدينة على مصالحها
الحيوية؟!.
وهل؟ وهل؟ إلى آخر ما هنالك.
أم أن ذلك ليس في الحقيقة إلا انتحاراً
سياسياً،
لا مبرر له، ولا يقدم عليه أحد،
ولا تساعد عليه أي من الموازين والمقاييس حتى الجاهلية منها، فضلاً
عن العقلائية والاجتماعية؟!.
ولقد كان باستطاعة ابن أبي:
أن ينحاز إلى المشركين في المعركة في خارج المدينة، وذلك ـ وإن كان
أيضاً يحمل في طياته أخطاراً
جمة له ولأصحابه ـ أقرب إلى تحقيق أهدافه، وأسلم له في الوصول إليها،
بملاحظة ما سبق.
ولكن الظاهر:
هو أن دوافعه للإشارة بالبقاء هي حب السلامة، وعدم
التعرض للأخطار المحتملة ما أمكنه، وحتى لا يتكرر انتصار النبي «صلى
الله عليه وآله» في بدر مرة أخرى.
ولا سيما مع ملاحظة زيادة عدد المسلمين، وحسن عدتهم
بالنسبة إلى السابق، كما يفهم من الكلام المتقدم لبعض المشيرين.
يضاف إلى ذلك:
أنهم الآن
يدافعون عن شرفهم وعرضهم، وبلدهم، وعن وجودهم، فلا بد أن يكونوا أكثر
تصميماً
وإقداماً.
كما أن من الممكن أن يكون التزلف إلى النبي «صلى الله
عليه وآله» داخلاً
أيضاً في حسابات ابن أبي في بادئ الأمر.
ونلاحظ:
أن التزلف، والتظاهر الكلامي بالتدين، وبالغيرة على
الإسلام ومصالح المسلمين، يكون لدى المنافقين أكثر من غيرهم.
هذا بالإضافة:
إلى أنه لو كان ثمة احتمال من هذا النوع لأشار إليه أبو
سفيان، أو صفوان بن أمية، أو ضرار بن الخطاب، أو غيرهم، كما قلنا.
5 ـ
بل إن العلامة الحسني نفسه يقول: إن الذين أصروا على البقاء كان من
بينهم المخلص والمنافق.
وهذا ينافي قوله الآخر:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يريد أن يختبر
أصحابه، ويكتشف نواياهم.
وإذاً،
فقد فشل النبي «صلى الله عليه وآله» في محاولاته تلك، فكيف يقول الحسني
بعد ذلك: إنه «صلى الله عليه وآله» وقف على نوايا الجميع، ومحصها
تمحيصاً
دقيقاً؟!.
والحقيقة هي:
أن إصرارهم على الخروج كان ناشئاً
عن الأسباب التي ذكروها أنفسهم في كلامهم.
6 ـ
ثم إننا لا نوافق العلامة الحسني: على أن النبي الأعظم «صلى الله عليه
وآله» كان يتعامل مع أصحابه بهذه الطريقة الماكرة ـ والعياذ بالله ـ
فيظهر لهم خلاف ما يبطن؟! نعوذ بالله من الزلل والخطل في القول والعمل.
إلا أن يكون مقصوده
«رحمه
الله»:
أنه «صلى الله عليه وآله» لم يظهر لهم رأيه، بل تركهم
يظهرون له ما في نفوسهم من دون أي تحفظ أو حياء، وليتحملوا هم
المسؤولية، ثم ليتألفهم بذلك، حتى إذا اختلفوا كان هو الحاسم للخلاف
برأيه الصائب، وموقفه الحكيم.
وأخيراً؛
فـإن
لنا تحفظاً
على ما ذكره من أن ابن أبي قد رجع بمن معه من المنافقين، وبعض اليهود.
فإن ذكر اليهود هنا في غير محله، لأنه «صلى الله عليه
وآله» لم يكن يحبذ الاستعانة باليهود، كما أنهم هم أنفسهم ما كانوا
ليعينوه على قتال عدوه، ولا يرضى قومهم بذلك منهم، إلا إذا كانوا
يريدون أن يكونوا في جيش المسلمين عيوناً للمشركين.
ولم يكن ذلك ليخفى على النبي «صلى الله عليه وآله» ولا
المسلمين، ولعله لأجل ذلك نجده «صلى الله عليه وآله» قد رفض قبولهم في
هذه الغزوة بالذات، وأرجعهم كما سنرى.
ه
: لبس لامة الحرب يعني القتال:
وقد رأينا:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» بعد أن لبس لامة حربه
استجابة لرأي الأكثرية، يرفض الرجوع إلى الرأي الأول، لأن ذلك معناه:
أن ينتزع عنه مفهوم خاطئ، يضر بالمصلحة العليا للإسلام والمسلمين، ولا
ينسجم مع مركزه كقائد، بل ربما تكون له آثار سيئة وخطيرة على المدى
البعيد.
وهذا المفهوم هو أنه رجل ضعيف، تتقاذفه الأهواء
والآراء، ولا يملك اتخاذ القرار؛ بل هو ألعوبة بأيدي أصحابه،
والمنتسبين إليه!
كما أن ذلك من شأنه أن يجعل قراراته في المستقبل عرضة
للصراعات الفكرية بين أصحابه، الذين تختلف مستوياتهم فكرياً،
واجتماعياً،
وسياسياً،
وإيمانياً،
وغير ذلك.
ويفسح المجال أمام أهل الأطماع، وظهور الاختلاف، ثم
التمزق، والفشل الذريع. ولا يعود يملك مجتمعاً
منضبطاً،
قوياً
متماسكاً،
وقادراً
على مواجهة الأخطار والمعضلات الجسام التي تنتظره، والمهمات التي لا بد
أن يضطلع بها؛ فضلاً
عن أن يتحمل هذا المجتمع مسؤولية نشر الإسلام والدفاع عنه في العالم
أجمع.
هذا كله،
عدا عن أن هذا التردد سوف يقلل من قيمة الوحي في نفوسهم، ويضعف ـ من ثم
ـ ارتباطهم بالغيب، وإيمانهم به، مع أن هذا ركن أساسي في الدعوة
الإسلامية، وفي نجاحها، واطِّراد
تقدمها.
فليكن هذا الموقف منه «صلى الله عليه وآله» درساً لهم،
يعلمهم: أنه لا ينبغي لهم أن يعارضوا الوحي الإلهي بعقولهم القاصرة عن
إدراك عواقب الأمور.
ومن الجهة الأخرى، فإن العدو سوف يرى في هذا التردد
ضعفاً،
وفشلاً،
ويزيد ذلك في طمعه بالمسلمين، وجرأته عليهم.
ولسوف يجعله ذلك يعتمد أسلوب الضغط على النبي «صلى الله
عليه وآله» من خلال أصحابه، ويحاول تشويش مواقفه وتمييعها، إن لم يمكن
توجيهها إلى ما يوافق مصالحه وأهدافه عن هذا السبيل.
وأخيراً، فإن المعتزلي يرى:
أن تردد
المسلمين دليل على فشلهم في الحرب، فإن النصر معروف بالعزم والجد،
والبصيرة في الحرب. وأحوالهم هنا كانت ضد أحوالهم في بدر، وأحوال
المشركين في بدر كانت ضد أحوالهم هنا، ولذلك انكسرت قريش في بدر([66]).
ونقول:
إن المسلمين لم ينكسروا في أحد، ولم تنتصر قريش. بل
هزمت هزيمة نكراء، كما سنرى والذي حصل للمسلمين إنما كان سببه أفراد
معدودون كانوا على فتحة جبل أحد.
و
: من الأكاذيب:
ومن الأكاذيب التي رأينا أن نذكر القارئ بها:
أولاً:
ما ورد في
رواية نادرة من أن ابن أبي قد أشار بالخروج([67]).
وذلك لا يصح إذ:
1 ـ
لا يبقى معنى حينئذٍ لاحتجاج ابن أبي لرجوعه من وسط الطريق بأنه «صلى
الله عليه وآله»: خالفه وأطاعهم.
2 ـ
إن القرآن يلمح إلى أن المنافقين كانوا يصرون على
البقاء في المدينة، فإنه بعد رجوع المسلمين من أحد، وقد قتل منهم من
قتل، قال المنافقون: ﴿لَوْ
أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾([68]).
وهؤلاء هم الذين احتجوا لرجوعهم
بقولهم:
لو نعلم قتالاً
لاتبعناكم.
ثانياً:
يقولون: إنه
«صلى الله عليه وآله» خرج إلى أحد من بيت عائشة([69]).
مع أن من الثابت:
أنه «صلى الله
عليه وآله» كان إذا سافر كان آخر عهده بفاطمة، وإذا رجع بدأ ببيت فاطمة
أيضاً([70]).
إلا أن يكون
مقصودهم بيت عائشة الذي كان لفاطمة، واستولت عليه عائشة بعد وفاة
الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله»([71]).
ثالثاً:
قولهم: إنه بعد أن استشار النبي «صلى الله عليه وآله»
أصحابه، دخل بيته، ودخل معه أبو بكر وعمر، فعمماه ولبساه، لا يُعبأ
به،
لضعف مستنده من جهة، ولأن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يكن يحتاج إلى
من يعممه ويلبسه، بل كان باستطاعته أن يمارس ذلك بنفسه من جهة ثانية.
وبعد أن استشار رسول الله «صلى الله عليه وآله» أصحابه،
وخرج عليهم لابساً
لامة حربه، استخلف على المدينة ابن أم مكتوم وعقد الألوية.
فأعطى اللواء
أمير المؤمنين «عليه السلام»، كما نص عليه البعض([72]).
ويقول البعض:
إن لواء المهاجرين كان مع علي.
وقيل:
مع مصعب بن عمير([73]).
ويقال:
إنه اللواء
الأعظم([74]).
وقيل:
إنه «صلى الله
عليه وآله» سأل عمن يحمل لواء المشركين، فقيل له: طلحة بن أبي طلحة،
فأخذ اللواء من علي ودفعه إلى مصعب بن عمير، لأنه من بني عبد الدار،
وهم أصحاب اللواء في الجاهلية([75]).
وكان لواء الأوس مع أسيد بن حضير، ولواء الخزرج مع حباب
بن المنذر.
وقيل:
مع سعد بن عبادة، كذا يقولون.
ونقول:
لا يصح ما ادعوه من أن اللواء كان مع مصعب بن عمير، أو
أنه أخذه من علي، وأعطاه لمصعب.
والصحيح هو:
أنه كان مع علي «عليه السلام» في أحد، وبدر، وفي كل مشهد.
ويدل على ذلك:
1 ـ
ما تقدم في غزوة بدر: من أن علياً «عليه
السلام»
كان صاحب لواء رسول الله «صلى الله عليه وآله» في بدر، وفي كل مشهد.
2 ـ
عن ابن عباس، قال: لعلي بن أبي طالب «عليه
السلام»
أربع ما هن لأحد: هو أول عربي وعجمي صلى مع رسول الله «صلى الله عليه
وآله». وهو صاحب لوائه في كل زحف، وهو الذي ثبت معه يوم المهراس؛ وفر
الناس، وهو الذي أدخله قبره([76]).
3 ـ
عن ابن عباس: كان علي أخذ راية رسول الله يوم بدر.
قال [الحكم] الحاكم:
وفي المشاهد كلها([77]).
4 ـ
وعن مالك بن دينار: سألت سعيد بن جبير وإخوانه من القراء: من كان حامل
راية رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟
قالوا:
كان حاملها علي (رض).
وفي نص آخر:
أنه لما سأل مالك سعيد بن جبير عن ذلك غضب سعيد، فشكاه
مالك إلى إخوانه من القراء، فعرفوه: أنه خائف من الحجاج.
فعاد وسأله، فقال:
كان حاملها علي (رض).
هكذا سمعت من
عبد الله بن عباس([78]).
وفي نص آخر عن مالك بن دينار قال:
قلت لسعيد بن جبير: من كان صاحب راية رسول الله «صلى
الله عليه وآله»؟
قال:
إنك لرخو اللبب.
فقال لي معبد الجهني:
أنا أخبرك:
كان يحملها في المسير ابن ميسرة العبسي، فإذا كان القتال؛ أخذها علي بن
أبي طالب رضي الله عنه([79]).
5 ـ
عن جابر: قالوا: يا رسول الله، من يحمل رايتك يوم القيامة؟
قال:
من عسى أن يحملها يوم القيامة، إلا من كان يحملها في
الدنيا، علي بن أبي طالب؟!
وفي نص آخر:
عبر باللواء
بدل الراية([80]).
6 ـ
وحينما مر سعد بن أبي وقاص برجل يشتم علياً «عليه
السلام»،
والناس حوله في المدينة، وقف عليه، وقال: يا هذا، على ما تشتم علي بن
أبي طالب؟
ألم يكن أول من أسلم؟
ألم يكن أول من صلى مع رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟
ألم يكن أزهد الناس؟
ألم يكن أعلم الناس؟
وذكر حتى قال:
ألم يكن صاحب راية رسول الله «صلى الله عليه وآله» في غزواته؟([81]).
وظاهر كلامه هذا:
أن ذلك كان من مختصاته صلوات الله وسلامه عليه.
7 ـ
عن مقسم:
أن
راية النبي «صلى الله عليه وآله» كانت تكون مع علي بن أبي طالب، وراية
الأنصار مع سعد بن عبادة، وكان إذا استعر
القتال كان النبي «صلى الله عليه وآله» مما يكون تحت راية الأنصار([82]).
8 ـ
عن عامر:
أن
راية النبي «صلى الله عليه وآله» كانت تكون مع علي بن أبي طالب، وكانت
في الأنصار حيثما تولوا([83]).
وقد يقال:
إن هذين النصين الواردين تحت رقم 7 و 8 لا يدلان على أن
الراية كانت دائماً
مع علي «عليه السلام» بصورة أكيدة وصريحة، وإن كان يمكن أن يقال: إن
ظاهرهما هو ذلك.
9 ـ
عن ثعلبة بن أبي مالك، قال: كان سعد بن عبادة صاحب راية رسول الله «صلى
الله عليه وآله» في المواطن كلها؛
فإذا كان وقت القتال أخذها علي بن أبي طالب([84]).
10 ـ
قال ابن حمزة: وهل نقل أحد من أهل العلم: أن علياً كان في جيش إلا وهو
أميره؟([85]).
11 ـ
وفي حديث المناشدة: أن علياً «عليه السلام» قال: نشدتكم الله، هل فيكم
أحد صاحب راية رسول الله «صلى الله عليه وآله» منذ يوم بعثه الله إلى
يوم قبضه، غيري؟!.
قالوا:
اللهم لا([86]).
وبالنسبة لخصوص واقعة أحد نقول:
1 ـ
عن علي قال: كسرت يده يوم أحد، فسقط اللواء من يده؛ فقال رسول الله
«صلى الله عليه وآله»: دعوه في يده اليسرى، فإنه صاحب لوائي في الدنيا
والآخرة([87]).
2 ـ
قد ورد، في احتجاج الإمام الحسن المجتبى صلوات الله
وسلامه عليه بفضائل أمير المؤمنين «عليه
السلام»
على معاوية، وعمرو بن العاص، والوليد الفاسق، ورد قوله: «وأنشدكم الله،
ألستم تعلمون: أنه كان صاحب راية رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوم
بدر، وأن
راية المشركين كانت مع معاوية، ومع أبيه، ثم لقيكم يوم أحد، ويوم
الأحزاب، ومعه راية رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ومعك ومع أبيك
راية الشرك الخ..»؟!([88]).
3 ـ
قال ابن هشام: «لما اشتد القتال يوم أحد، جلس رسول الله «صلى الله عليه
وآله» تحت راية الأنصار، وأرسل إلى علي: أن قدم الراية.
فتقدم علي؛ فقال:
أنا أبو
القصم. فطلب أبو سعيد بن أبي طلحة، وهو صاحب لواء المشركين منه البراز،
فبرز إليه علي، فضربه علي فصرعه([89]).
وهذا معناه:
أنه «عليه السلام» كان صاحب الراية العظمى، فأمره «صلى
الله عليه وآله» بالتقدم، ثم طلب منه صاحب لواء المشركين البراز، لأنه
إذا قطت الراية العظمى انكسر الجيش وانهزم.
4 ـ
وقال
القوشجي: في غزاة أحد جمع له الرسول «صلى الله عليه وآله» بين اللواء
والراية([90]).
5 ـ
عن أبي رافع قال: كانت راية رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوم أحد مع
علي، وراية المشركين مع طلحة بن أبي طلحة([91]).
6 ـ
ويظهر من بعض الروايات الفرق بين اللواء والراية، وقد
قالوا: إن الراية كانت في يد قصي، ثم انتقلت في ولده حتى انتهت إلى
النبي «صلى الله عليه وآله»، فأعطاها رسول الله «صلى الله عليه وآله»
لعلي في غزاة ودان، وهي أول غزاة حمل فيها راية مع النبي «صلى الله
عليه وآله»، ثم لم تزل مع علي في المشاهد، في بدر وأحد.
وكان اللواء
يومئذٍ في بني عبد الدار، فأعطاه رسول الله «صلى الله عليه وآله» لمصعب
بن عمير، فاستشهد، ووقع اللواء من يده، فتشوقته القبائل؛ فأخذه رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، فدفعه إلى علي، فجمع له يومئذٍ الراية
واللواء، فهما إلى اليوم في بني هاشم([92]).
ويظهر أن هذا هو مراد القوشجي من كلامه الآنف.
لا
فرق بين اللواء والراية:
ونقول:
إن هذه الروايات تنافي ما تقدم عن ابن عباس، وجابر،
وقتادة، من أنه «عليه السلام» كان صاحب لوائه «صلى الله عليه وآله» في
كل زحف.
وقد دلت النصوص المتقدمة على أن علياً «عليه
السلام»
هو صاحب لواء
رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، وهو أيضاً صاحب راية رسول الله، لو كان ثمة
فرق بينهما.
ونحن نشك في
ذلك، لأن بعض أهل اللغة ينصون على عدم الفرق([93])،
فإن كلاً
منهما عبارة عما يجعله القائد من الأقمشة في طرف رمح أو نحوه.
ونجد وصف
اللواء بالأعظم تارة([94])،
ووصف الراية بالعظمى أيضاً([95]).
إلا أن يقال:
إن مصعب بن عمير كان صاحب لواء المهاجرين، فلما استشهد في أحد صار
لواؤهم إلى علي، فعلي «عليه السلام» صاحب راية ولواء رسول الله، وهو
أيضاً صاحب لواء المهاجرين. ولعل هذا هو الأظهر.
وقد تقدم بعض الكلام حول هذا الموضوع في غزوة بدر
أيضاً، فلا نعيد.
ثم توجه رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»
إلى أحد ومعه:
ألف رجل،
ويقال: تسعمائة، وزاد بعضهم خمسين. منهم مئة دارع. ليس معهم فرس([96]).
وقيل:
مع النبي «صلى
الله عليه وآله» فرسه، وفرس لأبي بردة بن نيار([97]).
وقيل:
كان معهم فرس
واحد([98]).
ويظهر مما يأتي:
أنه «صلى الله عليه وآله» خرج نحو أحد من ثنية الوداع،
شامي المدينة.
ورجع ابن أُبي
مما بين المدينة وأحد بمن معه من المنافقين، وأهل الريب. وكانوا
ثلاثمائة رجل، وقال: محمد عصاني وأطاع الولدان؟ سيعلم!!
ما ندري علام نقتل أنفسنا وأولادنا ههنا أيها الناس؟
فرجعوا. وتبعهم جابر بن عبد الله الأنصاري يناشدهم الله
في أنفسهم، وفي نبيهم، فقال ابن أُبي:
لو نعلم قتالاً
لاتبعناكم، ولو أطعتنا لرجعت معنا.
وقيل:
إن النبي «صلى
الله عليه وآله» أمرهم بالانصراف، لكفرهم([99]).
فبقي «صلى الله عليه وآله» في سبعمائة من أصحابه، أو
ستمائة.
وبرجوع ابن أبي سقط في أيدي بني حارثة وبني سلمة، ثم
عادوا إلى الموقف الحق، قال تعالى: ﴿إِذْ
هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ﴾([100])
الآية.
وروي بسند رجاله ثقات:
أنه بعد أن جاوز النبي «صلى الله عليه وآله» ثنية
الوداع، إذا هو بكتيبة خشناء، فقال «صلى الله عليه وآله»: من هؤلاء؟
قالوا:
عبد الله بن أبي بن سلول في ستمائة من مواليه اليهود.
فقال:
وقد أسلموا؟
قالوا:
لا يا رسول الله، قال: مروهم فليرجعوا، فإننا لا ننتصر
بأهل الكفر على أهل الشرك.
أو:
فإننا لا نستعين بالمشركين على المشركين([101]).
إن من الطبيعي:
أن يكون لانخذال ابن أبي ورجوعه بمن معه من المنافقين
أثر سيء على نفوس المسلمين ومعنوياتهم، فإن حدوث الخيانة هذه قد كانت
أحد الأسباب الرئيسية لتهيؤ بعض المسلمين نفسياً
للهزيمة في المعركة، وهم بنو حارثة، وبنو سلمة.
وقد حكى الله ذلك بقوله: ﴿إِذْ
هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ﴾([102]).
وقد جاءت هذه الخيانة في لحظات حرجة وحساسة، قد مهدت
الطريق، ومنحت العذر لمن تبقى من المنافقين للفرار في أحرج اللحظات
وأخطرها على الإسلام والمسلمين بصورة عامة.
وهذا يؤيد، ويؤكد سلامة موقفه «صلى الله عليه وآله» في
إرجاعه في غزوة بدر من لم يكن مسلماً،
وعدم قبوله باشتراك بعض اليهود في حرب أحد، حيث أرجع كتيبتهم كما سلف.
ولذلك شواهد كثيرة في حياته «صلى الله عليه وآله» يجدها
المتتبع
في السيرة النبوية.
وقد أشار الله تعالى إلى الأثر السيئ لمواقف المنافقين
في العديد من الآيات، فهو تعالى يقول: ﴿لَوْ
خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً﴾([103]).
ويعطي قاعدة عامة في التعامل مع غير المؤمنين، فيقول: ﴿وَلاَ
تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾([104])
إلى
غير ذلك مما لا مجال لتتبعه.
وبعد هذا،
فإننا نعرف عدم صحة ما روي عن الزهري، قال: «كان يهود يغزون مع النبي
«صلى الله عليه وآله»؛ فيسهم لهم كسهام المسلمين»([105]).
وما ذلك إلا لأنه قد ﴿زُيِّنَ
لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ
الَّذِينَ آمَنُواْ﴾([106])،
ولأن: ﴿الَّذِينَ
آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله وَالَّذِينَ كَفَرُواْ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾([107]).
ومن هذا المنطلق، قال ابن أُبي هنا:
ما ندري علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟.
ومن جهة ثانية،
فإن المنافقين واليهود كانوا يلتقون مع المشركين في
الهدف مرحلياً؛
لأنهم جميعاً لا يستطيعون أن يروا انتصار الإسلام والمسلمين في
المنطقة، لأنهم ـ وهم الذين لا همّ
لهم إلا الدنيا ـ يرون ذلك يضر بمصالحهم، وبموقعهم السياسي،
والاجتماعي، والاقتصادي في المنطقة.
وإذا حارب اليهود والمنافقون إلى جانب المسلمين، فإنما
يفعلون ذلك إما تمهيداً
للخيانة بهم، وإسلامهم إلى أعدائهم، وإما طمعاً
في المال والغنائم. ومن يقاتل من أجل ذلك، فلا يستطيع أن يقدم على
الأخطار، ولا أن يضحي بنفسه، بل إنما يكون مع المسلمين ما دام النصر
حليفهم، حتى إذا
رأى
أنهم في خطر، فإنه لا بد أن يخذلهم في أحرج اللحظـات،
وهذا ما سوف يؤثر تأثيراً
سلبياً
على معنوياتهم، ومن ثم على مستقبلهم ومصيرهم أيضاً.
ويبقى سؤال، وهو:
أنه إذا كان الحال كذلك، فلماذا يقبل النبي «صلى الله
عليه وآله» المنافقين في جيش المسلمين مع أن ذلك يشكل خطراً عليهم؟!
ولماذا لا يفضحهم ويكشفهم للناس؟!
وإذا كان يمنع اليهود وغيرهم من الكفار من المشاركة،
فلماذا لا يتخذ تدبيراً
معيناً
يمنع به المنافقين من الحضور في ساحة الحرب؟!
والجواب يتلخص في النقاط التالية:
1 ـ
لقد كان النبي «صلى الله عليه وآله» واقعاً
بين محذورين، كل منهما صعب وخطير.
أحدهما:
سلبية خروج المنافقين إلى الحرب، وقد حددها الله
سبحانه، حينما قال: ﴿لَوْ
خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ
خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ﴾([108]).
وكان «صلى الله عليه وآله» يستر ذلك عليهم ما داموا لم
يظهروا هم أنفسهم ذلك، من خلال أفعالهم ومواقفهم، وأقوالهم.
الثاني:
سلبية إبقاء المنافقين في المدينة، يسرحون ويمرحون،
وربما يكـون
الخطر في ذلك أعظم مما لو اصطحبهم معه في الحرب، لأن ذلك يفسح المجال
لهم للتآمر، من دون أن يكون ثمة من يستطيع دفع كيدهم، ورد بغيهم.
وما قضية تبوك إلا الدليل القاطع على ما نقول، حيث اضطر
الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» إلى إبقاء خليفته ووصيه، ومن هو
منه بمنزلة هارون من موسى في المدينة، حينما شعر أن تخلف المنافقين عن
الخروج إلى تبوك يحمل في طياته أخطاراً
جساماً،
لا يمكن لأحد مواجهتها إلا النبي «صلى الله عليه وآله»، أو أخوه علي
«عليه السلام».
وقد رجح «صلى الله عليه وآله» هذا على ذاك ليرد كيدهم،
ويفشل مؤامراتهم، ولأجل ذلك كان يخرجهم معه إلى الحرب.
2 ـ
ثم إن النفاق قد لا يتخذ صفة العنف، بل يظهر المنافق الإسلام حفاظاً
على مصالحه، أو لأسباب خاصة أخرى، مع عدم إبائه عن الدخول فيه، وتقبله
طبيعياً
له، فهو لا يهتم بهدم الإسلام والكيد له. فتبرز الحاجة ـ والحالة هذه ـ
إلى إعطائهم الفرصة للتعرف أكثر فأكثر على تعاليم الإسلام وأهدافه،
ولكي يعيشوا أجواءه من الداخل، وليكتشفوا ما أمكنهم من أسرار عظمته
وأصالته، فتلين له قلوبهم، وتخضع له عقولهم. ولا أقل من أن أبناءهم،
ومن يرتبط بهم، يصبح أقدر على ملامسة واقع المسلمين، والتفاعل مع
تعاليم الإسلام ما دام أنه يعيشها بنفسه، وتقع تحت سمعه وبصره.
وهذا بالذات ما كان يهدف إليه الإسلام من التألف على
الإسلام، وإعطاء الأمـوال
والأقطـاع،
وحتى المنـاصب
والقيـادات
لمـن
عرفـوا
بـ
﴿المُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ﴾([109])،
بالإضافة إلى ما كان يهدف إليه من دفع كيدهم وشرهم.
وما تقدم يفسر لنا السبب الذي جعل رسول الله «صلى الله
عليه وآله» كان يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم، يتألفهم بذلك، حتى إن
عمرو بن العاص ظن بنفسه أنه خير القوم.
ثم صار يسأل
النبي «صلى الله عليه وآله» عن المفاضلة بين نفسه وغيره، فلما عرف:
أنهم أفضل منه، قال: «فلوددت أني لم أكن سألته»([110]).
3 ـ
إن سكوته «صلى الله عليه وآله» عن المنافقين، وقبولهم
كأعضاء في المجتمع الإسلامي، إنما يريد به المحافظة على من أسلم من
أبنائهم، وإخوانهم، وآبائهم، وأقاربهم، حتى لا تنشأ المشاكل العائلية
الحادة فيما بينهم؛ ولا يتعرض المسلمون منهم للعقد النفسية، والمشكلات
الاجتماعية، التي ربما تؤثر على صمودهم واستمرارهم.
4 ـ
وكذلك، فإن اتخاذ أي إجراء ضد المنافقين، لربما يكون سبباً
في تقليل إقبال الناس على الإسلام، وعدم وثوقهم بمصيرهم، وما سوف يؤول
إليه أمرهم معه فيه، ولا سيما إذا لم يستطيعوا أن يتفهموا سر ذلك
الإجراء، ولا أن يطلعوا على أبعاده وخلفياته.
ولسوف يأتي:
أن سبب إظهار وحشي للإسلام، هو أنه كان معروفاً
عن النبي «صلى الله عليه وآله»: أنه كان لا يتعرض لمن يظهر الإسلام بشيء
يسوءه.
5 ـ
إن اتخاذ أي إجراء ضد المنافقين،
معناه: فتح جبهة جديدة، كان بالإمكان تجنبها، واضطرار هؤلاء الساكتين
ظاهراً،
انصياعاً
لظروفهم، إلى المجاهرة بالعداء، والإعلان بالتحدي، وهم عدو داخلي كثير
العدد، وخطير جداً، يعرف مواضع الضعف، ومواضع القوة، ويكون بذلك قد
أعطاهم المبرر للانضمام إلى الأعداء، العاملين ضد الإسلام والمسلمين.
وواضح أن تصرفاً
كهذا ليس من الحكمة ولا من الحنكة في شيء، لأنه يأتي في ظرف يحتاج فيه
الإسلام إلى تمزيق أعدائه وتفريقهم؛ حيث لا يستطيع مواجهتهم جميعاً في
آن واحد.
وإذا كان المنافقون قد تمكنوا من توجيه ضربة قاسية
للمسيرة الإيمانية بعد وفاة رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»،
فإنهم لم يتمكنوا من إطفاء نور الله سبحـانه.. وبقي الإسـلام حيـاً
متوهجـاً وسيبقى كذلـك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها..
بقي أمران:
أحدهما:
لقد نزلت آيات قرآنية كثيرة تفضح المنافقين، وتظهر أفاعيلهم، وتنقل
أقاويلهم، وتبين أوصافهم بدقة وبتفصيل.
كما أن النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» نفسه قد حاول
أن يحد من فعالية المنافقين ما أمكنه، وذلك بتنبيه الصحابة إلى خططهم
ومؤامراتهم، والكشف عن حقيقتهم ووجودهم، وتحـذير
الناس منهم، وذكر أفعـالهم
وأوصافهم باستمرار، حتى حينما كان النبي «صلى الله عليه وآله» في مكة.
بل لقد اتخذ «صلى الله عليه وآله» أحياناً إجراءات عملية ضدهم، كهدم
مسجد الضرار، وغير ذلك مما يظهر جلياً
في الآيات القرآنية الكثيرة، والمواقف النبوية المختلفة.
وهذا بطبيعته يمثل حصانة ومناعة للمسلمين ضد النفاق
والمنافقين ومكائدهم.
الثاني:
إنه يظهر مما تقدم: أنه كان ثمة كتيبة لليهود بقيادة
ابن أبي، وقد أرجعها رسول الله «صلى الله عليه وآله» من الطريق. ثم رجع
ابن أبي مع طائفة من المنافقين.
بل يظهر من بعض النصوص:
أن المنافقين
قد رجعوا من نفس أحد([111]).
والذي نخشاه هو أن تكون هذه الرواية مكذوبة بهدف
التغطية على فساد ابن أبي ورجوعه بالمنافقين من وسط الطريق.
وقد رد رسول الله «صلى الله عليه وآله» من استصغرهم،
ومنعهم من الخروج إلى الحرب، مثل: ابن عمرو بن ثابت، وسمرة بن جندب،
ورافع بن خديج ثم سمح «صلى الله عليه وآله» لرافع؛ لأنه رام. وكان
يتطاول من الشغف على الخروج.
فيقال:
إن سمرة قال لزوج أمه: أُذِنَ
لرافع وردَّني،
وأنا أصرعه؟!
فأمرهما «صلى
الله عليه وآله» بالمصارعة؛ فصرعه سمرة بن جندب؛ فأذن له أيضاً([112]).
الريب فيما ينقل عن سمرة:
ونحن نرتاب فيما نقل عن سمرة بن جندب، وذلك لما يلي:
1 ـ
إن ابن الأثير
يذكر: أن صاحب هذه القضية هو جابر بن سمرة حليف بني زهرة([113])
وليس سمرة بن جندب.
2 ـ
إن سمرة لم يكن مستقيماً
ولا مراعياً
للشرع في تصرفاته ومواقفه. فحياة سمرة، وتاريخه، ونفسيته، وروحيته،
سواء في حياة النبي «صلى الله عليه وآله»، أو بعد وفاته، كل ذلك يأبى
عن نسبة مثل ذلك إليه.
أما في حياة النبي
«صلى
الله عليه وآله»،
فإننا نجد:
أنه هو صاحب العذق الذي كان في حائط الأنصاري، وبيت الأنصاري في ذلك
الحائط أيضاً؛ فكان سمرة يمر إلى نخلته، ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري،
فأبى، فشكاه إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، فكلمه النبي «صلى الله
عليه وآله» فأبى أن يستأذن. فساومه النبي «صلى الله عليه وآله»، وبذل
له ما شاء من الثمن فأبى أيضاً. فبذل له نخلة في الجنة في مقابلها،
فأبى أيضاً.
فقال رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»
حينئذٍ للأنصاري:
إذهب فاقلعها،
وارم بها إليه؛ فإنه لاضرر ولا ضرار([114]).
كما أنه هو
نفسه ـ كما في الروضة ـ الذي ضرب رأس ناقة النبي «صلى الله عليه وآله»
فشجها، فشكته إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»([115]).
وأما بعد وفاة
النبي «صلى الله عليه وآله»، فإنه قتل من المسلمين ما لا يحصى، حتى إن
زياد بن أبيه استخلفه على البصرة، وأتى الكوفة مدة وجيزة، فقتل ثمانية
آلاف([116])،
كما عن الطبري. وقتل سبعة وأربعين رجلاً من بني عدي في غداة واحدة،
كلهم قد جمع القرآن([117]).
وكان يقتل من يتشهد الشهادتين، ويبرأ من الحرورية([118]).
وبعد موت زياد أقره معاوية على
البصرة ستة أشهر ثم عزله؛ فقال:
لعن الله معاوية، لو أطعت الله كما أطعت معاوية لما عذبني أبداً([119])
وكان يخرج من داره مع خاصته ركباناً
فلا يمر بطفل، ولا عاجز، ولا حيوان إلا سحقه هو وأصحابه، وهكذا إذا
رجع. فلم يكن يمر عليه يوم إلا وله قتيل أو أكثر([120]).
وبذل معاوية له مئة ألف، ليروي:
أن آية: ﴿وَمِنَ
النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾
إلى قوله: ﴿وَالله
لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ﴾([121])
نزلت في علي «عليه السلام»، وأن آية: ﴿وَمِنَ
النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ الله وَالله
رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾([122])،
نزلت في ابن ملجم؛ فلم يقبل، فبذل له مئتي ألف، ثم ثلاثمائة. فلما بذل
له أربعمائة ألف، قبل، وروى ذلك([123]).
كما أن سمرة
هذا قد حضر مقتل الحسين، وكان من شرطة ابن زياد، وكان يحرض الناس على
الخروج إلى قتال الإمام الحسين «عليه السلام»([124]).
هذا هو سمرة، وهذه هي نفسيته، وأفاعيله، فإن كان حقاً
هو صاحب القضية المتقدمة، وهو بعيد في الغاية، فلا بد أن يكون هدفه هو
الحرب من أجل المال أو الجاه، وغيره من المكاسب الدنيوية، مهما كانت
تافهة وحقيرة.
3 ـ
وإن من الأمور التي شاعت وذاعت، ورواها المحدثون والمؤرخون بشكل واسع
قول رسول الله «صلى الله عليه وآله» في سمرة، وأبي هريرة، وأبي محذورة:
آخركم موتاً في النار. فكان سمرة آخرهم موتاً([125]).
وتأويل ذلك:
بأن سمرة قد مات في قدر مملوءة ماءً حاراً([126])
لا يصح، لأنه خلاف الظاهر، فإن ظاهر الكلام: أن المراد هو النار
الأخروية، كما هو المتبادر، لا أن موتـه
بسبب أن النار تجعل الماء حاراً،
ثم يقع فيه؛ فإن ذلـك
ـ بالإضافة إلى أنه مجاز لا مبرر له إلا إرادة تبرئة ساحة رجل له أمثال
تلك الجنايات والعظائم ـ لا يصح، إذ لو كان هو المراد لكان الأصح هو
التعبير بقوله: (بالنار)، لا (في النار)، أو يقول: في الماء الحار،
ونحو ذلك.
فهذه الكرامة له، والتي تقول:
إنه كان يتشوق للمشاركة في الحرب، رغم صغر سنه، ثم
مصارعته لرافع، لا تناسب كل ما أشرنا إليه آنفاً،
ولا تنسجم مع واقع سمرة ونفسيته.
ولعل سر تكرم محبيه عليه بهذه الفضيلة، هو طاعته
الخارقة لمعاوية، ومعاونته لابن زياد، وتحريضه على قتل الحسين «عليه
السلام»،
وغير ذلك.
ولو أننا قبلنا صدور ذلك منه؛ فإنه ـ ولا شك ـ قد انقلب
على عقبيه بعد ذلك، ولا تنفعه أمثال هذه الأمور، بعد أن كانت عاقبته هي
النار.
ملاحظة:
ولا يخفى: أن هذا الكلام منه «صلى الله عليه وآله» في
حق هؤلاء الثلاثة من شأنه أن يسقطهم عن الاعتبار جميعاً، إذ لو كان
واحد منهم مستقيم الطريقة لم يجز وضعه في دائرة من يحتمل في حقه ذلك.
وهذا أسلوب فذ في إسقاط خطط الذين يريدون تكريس رموز، وأشخاص
يريدون أن يقوموا بدور غير مسؤول ويمس مستقبل الأمة، ويؤثر على دينها،
وعلى كل وجودها ولو عن طريق تزوير نصوص الدين وأحكامه، والعبث برسومه
وأعلامه.
ونزل «صلى الله عليه وآله» في مكان في الطريق، وعين
محمد بن مسلمة في خمسين آخرين لحراسة الجيش.
ويقولون:
ثم قال: من يحرسنا الليلة؟
فقام رجل، فقال:
أنا.
فسأله عن اسمه، فقال:
ذكوان. فأجلسه.
ثم سأل الثانية:
فقام رجل، فقال: أنا.
فسأله عن اسمه فقال:
أبو سبع. فأجلسه.
وفي الثالثة:
قام رجل وتسمى بابن عبد القيس، فأجلسه.
ثم أمر بقيام الثلاثة. فقام ذكوان وحده. فسأله عن
الباقين.
فأخبره أنه هو
صاحب الأسماء الثلاثة، فكان هو الذي حرسه([127]).
قال المعتزلي:
قلت: قد تقدم هذا الحديث في غزوة بدر، وظاهر الحال أنه
مكرر، وأنه إنما كان في غزاة واحدة.
ويجوز أن يكون
قد وقع الغزاتين، ولكن على بعد([128]).
ونحن نستبعد قصة ذكوان هذه وذلك لما يلي:
1 ـ
إننا لا نستطيع أن نصدق: أن النبي «صلى الله عليه وآله»
كان ساذجاً
إلى حد أنه لا يستطيع أن يدرك: أن الذي أجابه في المرات الثلاث، بل
الأربع، هو شخص واحد، حتى سأله عن الباقين!!.
2 ـ
ثم
إننا
لم نفهم المبرر لعدم إجابة غير ذكوان من المسلمين الذين يبلغ عددهم
حوالي سبعمائة رجل، وفيهم أعظم المؤمنين، وكثيرون من الغيارى على حياة
الرسول «صلى الله عليه وآله» وأصحابه، ويفدونه بأرواحهم، وبكل غال
ونفيس.
ولم تكن الحراسة
تشكل خطراً عظيماً وحاسماً كما كان الحال بالنسبة
لمنازلة عمرو بن ود، بل هي أخفُّ مؤونة من ذلك، لأن الخطر فيها يبقى في
حدود الإحتمال.
وأين كان علي «عليه السلام» عنه في تلك الليلة، مع أنه هو الذي كان
يتولى حراسته عادة.
3 ـ
إننا لا نفهم المبرر لأمره «صلى الله عليه وآله» إياه
بالجلوس في المرات الثلاث!! ولم لم يوافق على طلبه من المرة الأولى؟!
فإن الخطر منها ليس في مستوى خطر مواجهة عمرو بن عبد ود
العامري..
4 ـ
إن النزول في الطريق، وبيات ليلة فيه موضع شك أيضاً إذ
لم تكن المسافة بين المدينة وبين جبل أحد كبيرة إلى حد يحتاج معها إلى
أن يبيت في الطريق إليه.
([1])
السيرة الحلبية ج2 ص216، وراجع: تاريخ الخميس ج1 ص419.
([2])
راجع: البداية والنهاية ج4 ص9، ودلائل النبوة للبيهقي ط دار
الكتب العلمية ج3 ص201، وأنساب الأشراف ج1 ص311، والمغازي
للواقدي ج1 ص199، والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص18، والكامل
في التاريخ ج2 ص148، وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص186، والسيرة
الحلبية ج2 ص216، والسيرة النبوية لدحلان (المطبوع بهامش
الحلبية) ج2 ص19 وتاريخ الخميس ج1 ص419.
([3])
المغازي للواقدي ج1 ص197، وسيرة المصطفى ص385.
([4])
البدء والتاريخ ج4 ص207. نعم يمكن أن يكون عمدة الجيش ثلاثة
آلاف، ومعهم من العبيد والخدم ـ وهم مقاتلون أيضاً ـ ألفان بل
في البحار ج20 ص117: أن أبا سفيان قد استأجر ألفين من الأحابيش.
([5])
راجع: تاريخ الخميس ج1 ص419 ـ 422، والسيرة الحلبية ج2 ص217 و
218، والسيرة النبوية لدحلان (مطبوع بهامش الحلبية) ج2 ص19 ـ
21 و 26، وراجع: الوفاء بأحوال المصطفى ص684، والمغازي للواقدي
ج1 ص200 ـ 204 و 206، وأنساب الاشراف ج1 ص312 و 313، وتاريخ
الأمم والملوك ج2 ص187 ـ 190 و 197، والبداية والنهاية ج4 ص10
ـ 16، والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص20 و 25 و 26 و 30 و 32،
والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص64 و 65 و 70 و 71، والكامل في
التاريخ ج2 ص149 ـ 151، ودلائل النبوة للبيهقي ج3 ص221 و 209،
و البحار ج2 ص48، وحياة محمد لهيكل ص254، وسيرة المصطفى ص391.
([6])
السيرة الحلبية ج2 ص217، والسيرة النبوية لدحلان (مطبوع بهامش
الحلبية) ج2 ص20.
([7])
المغازي للواقدي ج2 ص285.
([8])
راجع: تاريخ الخميس ج1 ص430، والمغازي للواقدي ج1 ص204، وأنساب
الاشراف ج1 ص314، والسيرة الحلبية ج2 ص172، والسيرة النبوية
لدحلان ج2 ص20، وسيرة المصطفى ص393، وحياة محمد لهيكل ص255.
([9])
مغازي الواقدي ج1 ص205، وشرح النهج للمعتزلي ج14 ص218 و 219.
([10])
سفينة البحار ج1 ص204.
([11])
الآيتان 118 و 119 من سورة هود.
([12])
الآية 63 من سورة الأنفال.
([13])
الآية 103 من سورة آل عمران.
([14])
الآية 9 من سورة الحشر.
([15])
الآية 64 من سورة العنكبوت.
([16])
راجع: تفسير الميزان ج9 ص119 ـ 121.
([17])
المغازي للواقدي ج1 ص206.
([18])
المغازي للواقدي ج1 ص207 و 208.
([19])
راجع جميع ما تقدم في: السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص67 و 68،
وتاريخ الخميس ج1 ص421 و 422، والسيرة الحلبية ج2 ص218 و 219،
وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص188 ـ 190 ، والمواهب اللدنية ج1 ص92
و 93، ودلائل النبوة للبيهقي (ط دار الكتب العلمية) ج3 ص208 و
226.
وراجع
أيضاً: السيرة النبوية لابن اسحاق ص324، والكامل في التاريخ ج2
ص150، والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص25 و 26، والبداية
والنهاية ج4 ص12 و 13، وراجع ص11 والمغازي للواقدي ج1 ص208 ـ
211 و 214، والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص21 ـ 23، وسيرة المصطفى
ص395 و 396، ومجمع الزوائد ج6 ص107.
([20])
الآيتان 159 و 160 من سورة آل عمران.
([21])
الدر المنثور ج2 ص80 عن ابن عدي، والبيهقي في شعب الايمان.
([22])
الآية 38 من سورة الشورى.
([24])
مجمع الزوائد ج5 ص319 عن الطبراني، وحياة الصحابة ج2 ص48 عن
كنز العمال ج2 ص163 عن البزار والعقيلي وسنده حسن، والدر
المنثور ج2 ص90 عن الطبراني بسند جيد عن ابن عمرو.
([25])
راجع: سورة الكهف آية 29، والأحزاب آية 56، والدهر آية 34،
وأقول: وتنافي أيضاً الآية التي في سورة الشورى التي خصت
الشورى بالمؤمنين الذين لهم صفات معينة.
([26])
راجع: الإسلام وأسس
التشريع ص111 ـ 113 للعلامة السيد عبد المحسن فضل الله.
([27])
نهج البلاغة ج3 ص192 الحكمة رقم 161.
([28])
نهج البلاغة ج3 ص201 الحكمة رقم 211.
([29])
الدر المنثور ج2 ص90 عن الطبراني في الأوسط، وأمالي الطوسي
ص84.
([30])
جريدة (جمهوري إسلامي) الفارسية عدد 30 ربيع الأول 1400 ه.
([31])
الآية 159 من سورة آل عمران.
([32])
الآية 38 من سورة الشورى.
([33])
الآية 36 من سورة الأحزاب.
([34])
الآية 132 من سورة آل عمران.
([35])
تفسير الميزان ج4 ص70.
([36])
الآية 159 من سورة آل عمران.
([37])
الآية 159 من سورة آل عمران.
([38])
الآية 38 من سورة الشورى.
([39])
الآيات من 36 إلى 39 من سورة الشورى.
([40])
واحتمال: أن يكون المعنى: ما عند الله خير وأبقى لجماعات
مختلفة وهم:
أ ـ الذين آمنوا.
ب ـ الذين يجتنبون كبائر الإثم الخ..
هذا
الاحتمال خلاف الظاهر هنا، فإن المراد أن الذين يجمعون هذه
الصفات هم الذين يكون ما عند الله خير وأبقى لهم. وإلا فلو كان
أحد ينتصر على من بغى عليه ولكنه غير مؤمن مثلاً، فلا شك في أن
ما عند الله ليس خيراً وأبقى له. وكذا لو كان أمرهم شورى بينهم
وهم غير مؤمنين.
([41])
الآية 30 من سورة البقرة.
([42])
الآية 72 من سورة الأحزاب.
([43])
الآية 26 من سورة ص.
([44])
الآية 69 من سورة الأعراف.
([45])
الآية 14 من سورة يونس.
([46])
الآية 71 من سورة التوبة.
([47])
هذا محصل ما جاء في كتاب: خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء
للشهيد الصدر، والفقرات الأخيرة هي في ص53 و 54.
([48])
الآية 71 من سورة التوبة.
([49])
الآية 257 من سورة البقرة.
([50])
الآيتان 72 و 73 من سورة الأنفال.
([51])
الآية 51 من سورة المائدة.
([52])
الآية 27 من سورة الأعراف.
([53])
الآية 19 من سورة الجاثية.
([54])
راجع: تفسير الميزان ج16 ص348 ـ 352 في تفسير الآية.
([55])
الآيتان 72 و 73 من سورة الأحزاب.
([56])
الآية 30 من سورة البقرة.
([57])
الآية 61 من سورة هود.
([58])
الآية 55 من سورة النور.
([59])
الآية 124 من سورة البقرة.
([60])
الآية 38 من سورة الشورى.
([61])
الوسائل ج18 باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث1.
والرواية معتبرة جدا؛ فإن عمر بن حنظلة شيخ كبير روى عنه عدد
كبير من الثقات الكبار والأعيان، بل لم يرو عنه ضعيف إلا رجل
واحد.
ومن
بين من روى عنه ـ وهم كثير ـ من لا يروي إلا عن ثقة ـ كما قيل
ـ كابن بكير وصفوان الجمال.
([62])
سيرة المصطفى ص396 ـ 399 .
([63])
نهج البلاغة بشرح عبده ج1 ص64.
([64])
مغازي الواقدي ج1 ص205، وشرح النهج للمعتزلي ج14 ص218.
([65])
مغازي الواقدي ج1 ص282، وشرح النهج للمعتزلي ج14 ص274.
([66])
شرح النهج للمعتزلي ج14 ص226.
([67])
السيرة الحلبية ج2 ص219.
([68])
الآية 168 من سورة آل عمران.
([69])
مغازي الواقدي ج1 ص213، وشرح النهج للمعتزلي ج14 ص225، ووفاء
الوفاء ج1 ص284، وتاريخ الخميس ج1 ص423 عن ابن الكلبي، ومجاهد،
والواقدي.
([70])
مسند أحمد ج5 ص275، وذخائر العقبى ص37 عن أحمد، وأبي عمر،
وإسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار ص170 عن أحمد، والبيهقي،
وغير ذلك كثير، فإنه لا مجال لتتبعه.
([71])
قد أوضحنا ذلك في مقال لنا بعنوان: (أين دفن النبي «صلى الله
عليه وآله» في بيت عائشة أم في بيت فاطمة؟) فراجع كتابنا:
دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام.
([72])
الأوائل لأبي هلال ج1 ص183. والثقات لابن حبان ج1 ص224 و 225،
وراجع: البحار ج20 ص49، وتفسير القمي ج1 ص112.
([73])
مغازي الواقدي ج1 ص215، وشرح النهج للمعتزلي ج14 ص227، وتاريخ
الخميس ج1 ص422.
([74])
تاريخ الخميس ج1 ص426 عن المنتقى.
([75])
أنساب الاشراف ج1 ص317، وشرح النهج للمعتزلي ج14 ص232، والسيرة
الحلبية ج2 ص220.
([76])
مناقب الخوارزمي ص21 و 22، وإرشاد المفيد ص48، وتيسير المطالب
ص49 وراجع: مستدرك الحاكم ج3 ص111، وتلخيصه للذهبي بهامشه.
([77])
ذخائر العقبى ص75، والرياض النضرة المجلد الثاني، جزء 4 ص156.
([78])
راجع: مستدرك الحاكم ج3 ص137 وصححه وقال: له شاهد من حديث زنفل
العرفي، وفيه طول فلم يخرجه الحاكم، ومناقب الخوارزمي ص258 و
259، وذخائر العقبى ص75 عن أحمد في المناقب.
([79])
الطبقات الكبرى لابن سعد ط ليدن ج3 قسم 1 ص15.
([80])
هامش ص180 من احتجاج الطبرسي، والرياض النضرة المجلد الثاني ج3
ص172 عن نظام الملك في أماليه، وكفاية الطالب ص336 وقال: ذكره
محدث الشام ـ أي ابن عساكر ـ في ترجمة علي «عليه السلام» من
كتابه بطرق شتى عن جابر، وعن أنس، وكنز العمال ج15 ص119، وراجع
ص135 عن الطبراني، ومناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي ص200،
وعمدة القاري ج16 ص216، ومناقب الخوارزمي ص358.
([81])
مستدرك الحاكم ج3 ص500، وصححه على شرط الشيخين هو والذهبي في
تلخيص المستدرك، وحياة الصحابة ج2 ص514 و 515. وأظن أن القضية
كانت مع سعد بن مالك أبي سعيد الخدري، لأن سعد بن أبي وقاص كان
منحرفا عن أمير المؤمنين. ويشير إلى ذلك ما ذكره الحاكم في
مستدركه ج3 ص499 من أن أبا سعيد قد دعا على من كان ينتقص علياً
فاستجاب الله له.
([82])
المصنف لعبد الرزاق ج5 ص288، وراجع: فتح الباري ج6 ص89 عن أحمد
عن ابن عباس بإسناد قوي.
([83])
المصنف لعبد الرزاق ج5 ص288.
([84])
أسد الغابة ج4 ص20، وأنساب الاشراف ج2 ص106 لكن فيه: ميسرة
العبسي بدل سعد بن عبادة.
([85])
الشافي لابن حمزة ج4 ص164.
([86])
المسترشد في إمامة علي «عليه السلام» ص57.
([87])
تاريخ الخميس ج1 ص434، والرياض النضرة المجلد الثاني ج4 ص156
عن ابن الحضرمي، وذخائر العقبى ص75 بلفظ (ضعوه).
([88])
كفاية الطالب ص336، وشرح النهج للمعتزلي ج6 ص289، والغدير ج10
ص168 عنه.
([89])
السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص78، وتاريخ الخميس ج1 ص427..
([90])
شرح التجرية للقوشجي ض 486.
([91])
اللآلي المصنوعة ج1 ص365.
([92])
الإرشاد للشيخ المفيد ص48.
([93])
السيرة الحلبية ج2 ص147.
([94])
راجع حياة الصحابة ج1 ص431، وتاريخ ابن عساكر ترجمة علي «عليه
السلام» بتحقيق المحمودي ج1 ص110 والمنتقى.
([95])
كما في قول ابن أبي الحديد عن هزيمة الشيخين في خيبر:
وللـرايـة العظمى وقـد ذهبــا بهــا مـلابس ذل فـوقـهـا
وجـلابـيـب
([96])
وفاء الوفاء ج1 ص284 و 285 عن ابن عقبة، والسيرة الحلبية ج2
ص221، وفتح الباري.
([97])
تاريخ الطبري ج2 ص190، والسيرة الحلبية ج2 ص221.
([98])
مجمع الزوائد ج6 ص117 عن الطبراني، وحياة الصحابة ج3 ص769 عن
كنز العمال ج3 ص135 عن الطيالسي.
([100])
الآية 122 من سورة آل عمران.
([101])
وفاء الوفاء ج1 ص283، وتاريخ الخميس ج1 ص422 عن الوفاء،
والطبراني في الكبير والأوسط بسند رجاله ثقات، وذكر مثل ذلك عن
الكشاف ومعالم التنزيل والسيرة الحلبية ج2 ص220، وشرح النهج
للمعتزلي ج14 ص227، ومغازي الواقدي ج1 ص215.
([102])
الآية 122 من سورة آل عمران.
([103])
الآية 47 من سورة التوبة.
([104])
الآية 113 من سورة هود.
([105])
مصنف عبد الرزاق ج5 ص188، وسنن البيهقي ج9 ص53، ونقل عن ابن
أبي شيبة.
([106])
الآية 212 من سورة البقرة.
([107])
الآية 76 من سورة النساء.
([108])
الآية 47 من سورة التوبة.
([109])
الآية 60 من سورة التوبة.
([110])
راجع: مجمع الزوائد ج9 ص15 عن الطبراني بإسناد حسن، وفي الصحيح
بعضه بغير سياقه. وحياة الصحابة ج2 ص706 عن الترمذي في الشمائل
ص25 .
([111])
مغازي الواقدي ج1 ص219، وشرح النهج للمعتزلي ج4 ص230.
([112])
تاريخ الطبري ج2 ص191، والسيرة الحلبية ج2 ص220، وتاريخ الخميس
ج1 ص422، ومغازي الواقدي ج1 ص216، وشرح النهج ج4 ص227.
([114])
راجع: شرح النهج للمعتزلي ج4 ص78، والكافي ج5 ص292 و 294، ومن
لا يحضره الفقيه ج3 ص233 و 103، والتهذيب ج7 ص147، والوسائل
ج17 ص340 و 341، والبحار (ط جديد) ج100 ص127 و (ط قديم) ج8
ص675، ومصابيح السنة للبغوي ج2 ص14، والسنن الكبرى ج6 ص157،
وسنن أبي داود ج3 ص315، والدر المنثور ج6 ص357 عن ابن أبي حاتم
وراجع: قاموس الرجال ج5 ص8.
([115])
قاموس الرجال ج5 ص8 عن الروضة.
([116])
تاريخ الأمم والملوك (ط دار المعارف بمصر) ج5 ص237.
([117])
قاموس الرجال ج5 ص8.
([118])
قاموس الرجال ج5 ص9.
([119])
تاريخ الأمم والملوك (ط دار المعارف) ج5 ص291.
([120])
قاموس الرجال ج5 ص9 عن الطبري.
([121])
الآيتان 204 و 205 من سورة البقرة.
([122])
الآية 207 من سورة البقرة.
([123])
شرح النهج للمعتزلي ج4 ص73.
([124])
راجع: قاموس الرجال ج5 ص8
ـ 10 وشرح النهج للمعتزلي ج4 ص77 و 78 و 79.
([125])
راجع: قاموس الرجال،
والاصابة ج2 ص79، وشرح النهج للمعتزلي ج4 ص78.
([126])
راجع: الاصابة ج2 ص79، والإستيعاب بهامشها ج2 ص78.
([127])
تاريخ الخميس ج1 ص422 و 423، والسيرة الحلبية ج2 ص221، ومغازي
الواقدي ج1 ص217، وشرح النهج للمعتزلي ج4 ص228.
([128])
شرح النهج للمعتزلي ج4 ص228 و 229.
|