|
عــبـــرة ومــنــاســـبــــة
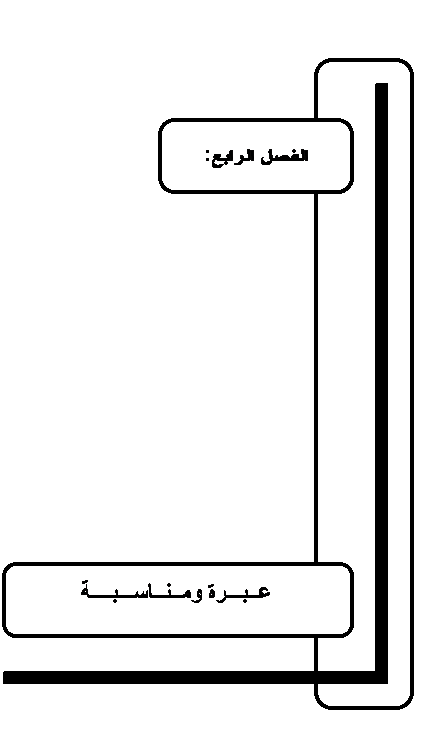
بـدايـة:
نتحدث في هذا الفصل عن وفيات بعض الأشخاص الذين عاشوا
في زمن النبي «صلى الله عليه وآله»، وذلك انطلاقاً
من المبررات التي ألمحنا إليها في بداية الفصل السابق.
ولكننا نشير هنا إلى أننا سوف نجعل ذلك أيضاً ذريعة إلى
التعرض لأمور أخرى ترتبط بهؤلاء الأشخاص من قريب أو من بعيد، من أجل أن
نسجل تحفظاً،
أو ننوه بما ينبغي التنويه به، والتنبيه إليه، فنقول:
فإنهم يقولون:
إن عبد الله
بن عثمان بن عفان، سبط رسول الله، حيث إن أمه هي رقية بنت النبي «صلى
الله عليه وآله»([1])،
قد توفي في جمادى الأولى، من السنة الرابعة([2]).
وكان قد ولد
في الإسلام في الحبشة؛ فبلغ ست سنين؛ فنقره ديك في عينه؛ فمرض فمات([3]).
وحين دفن دخل
رسول الله «صلى الله عليه وآله» قبره([4]).
ونحن نشك في أكثر ما تقدم، ونذكر ذلك ضمن النقاط
التالية:
في قولهم:
إن عبد الله بن عثمان كان سبط رسول الله «صلى الله عليه وآله».
نقول:
قد تقدم في الجزء الثاني من هذا الكتاب شكنا في كون
زوجتي عثمان كانتا بنتي رسول الله «صلى الله عليه وآله» وقلنا: إن
الظاهر هو أنهما كانتا ربيبتيه؛ فراجع.
إننا لا ننكر
أن يكون النبي «صلى الله عليه وآله» كان يؤتى بأولاد الصحابة يسميهم،
ويبرّك عليهم حين ولادتهم، وقد حفظ التاريخ لنا وقائع كثيرة من هذا
القبيل([5]).
ولكن قولهم:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» هو الذي سمى ابن عثمان
ب
«عبد
الله»([6])
غير ظاهر الوجه، بعد أن كان قد ولد في الحبشة، فهل يعقل أن يبقى طفل
هذه المدة الطويلة، التي تصل إلى سنوات من دون تسمية!!
أضف إلى ذلك:
أن ظاهر بل صريح كلام مصعب الزبيري، والزهري، وأم عباس
«أو
عياش»
التي يقال: إنها مولاة رقية هو: أن عثمان نفسه هو الذي سمى ولده([7]).
إلا أن يدَّعى:
أنهم قد سموه أولاً، ثم لما قدموا المدينة، ورآه رسول الله «صلى الله
عليه وآله» جدد له التسمية.
ولكن ذلك يبقى مجرد احتمال لا دليل عليه، وليس ثمة ما
يؤيده.
ولعل الهدف هو جعله في مستوى سيدي شباب أهل الجنة،
اللذين سماهما النبي «صلى الله عليه وآله»، ولا أقل من أن لا يكون ذلك
مختصاً
بهما
«عليهما
السلام».
قولهم:
إن عبد الله
قد توفي في السنة الرابعة، يقابله قول أبي سعد النيسابوري في كتاب شرف
المصطفى: أنه مات قبل أمه بسنة، فيكون قد مات في أول سني الهجرة([8]).
وذكر الدولابي:
«أنه
مات وهو رضيع»([9]).
قولهم:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد دخل قبره ينافيه قولهم: إن عثمان هو
الذي دخل قبره([10]).
إلا أن يقال:
يمكن أن يكون النبي «صلى الله عليه وآله» وعثمان أيضاً قد دخلا حفرته.
ولكنه احتمال بعيد، إذ قد كان على ناقل دخول عثمان أن
ينبه على دخول النبي أيضاً، لأن ذلك شرف عظيم لا يهمل ذكره ليذكر ما لا
شرف فيه، مع توفر الدواعي على تكريس الفضائل والكرامات لعثمان، وكل من
يلوذ به.
بل قولهم:
«صلى
عليه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ونزل في حفرته أبوه عثمان»([11])
يأبى عن هذا التوجيه إن لم يكن ظاهراً
في ضده ونقيضه.
وأخيراً،
فنحن نشك في أصل وجود هذا الطفل، فضلاً
عن كل تلك الادعاءات.
قال قتادة:
«لم
تلد رقية لعثمان»([12]).
وعلقوا على ذلك بقولهم:
«وهو
غلط، والأصح ما تقدم وإنما أختها أم كلثوم لم تلد له»([13]).
لكن الحقيقة هي:
أن قتادة التابعي القريب العهد من عصر النبوة، والذي يأخذ علمه عن
الصحابة الشاهدين للأحداث مباشرة، قتادة هذا لا بد أن يكون أعرف بهذا
الأمر من الدياربكري وغيره.
ويكفي أن يكون قول قتادة هذا موجباً
للشك والشبهة في هذا الأمر الخطير، لا سيما ونحن نعلم: أن هناك من يهتم
بصياغة الفضائل والمناقب لعثمان، كما أشرنا إليه غير مرة.
هذا كله، بالإضافة إلى ما تقدم من الاختلاف الفاحش في
المدة التي عاشها بين أن تكون ست سنين، ثم مات، أو أنه مات وهو رضيع.
قد أشرنا فيما سبق:
إلى وفاة زينب بنت خزيمة، وذلك حين الكلام عن زواج
النبي «صلى الله عليه وآله» بها، ولكنها كانت إشارة عابرة وسريعة، فآثرنا
هنا أن نذكر ذلك بنحو أكمل وأتم،
فنقول:
إنهم يقولون:
إن زينب بنت خزيمة، بنت الحارث الهلالية، قد تزوجها
النبي «صلى الله عليه وآله» في سنة ثلاث، فلبثت عنده «صلى الله عليه
وآله» شهرين، أو ثلاثة، ثم توفيت، ودفنت في البقيع، ذكره الفضائلي،
والذهبي.
وعند الدياربكري:
أنها مكثت عنده «صلى الله عليه وآله» ثمانية أشهر، ذكره
الفضائلي.
وقال البلاذري:
أقامت عند النبي «صلى الله عليه وآله» ثمانية أشهر،
تزوجها في شهر رمضان سنة ثلاث، وماتت في آخر ربيع الأول سنة أربع:
ودفنها في البقيع.
وكانت أولاً تحت عبد الله بن جحش، قتل عنها يوم أُحد،
كما قال ابن شهاب، قال في المواهب: وهو أصح.
وقال قتادة:
كانت قبله «صلى الله عليه وآله» عند الطفيل بن الحارث.
وقال أبو الحسن علي بن محمد
الجرجاني النسابة:
كانت عند الطفيل بن الحارث، ثم خلف عليها عبيدة بن الحارث.
قال:
وكانت زينب أخت ميمونة، لأمها.
قال أبو عمر:
ولم أر ذلك لغيره.
ويقال:
إنها كانت تدعى في الجاهلية بأم المساكين، ونزل في
قبرها إخوتها.
وكان سنها يوم
ماتت ثلاثين سنة، أو نحوها([14]).
ونقول:
إن الظاهر: أن
الصحيح هو قول الجرجاني النسابة، ويؤيده ما ذكره ابن سعد وغيره، من أن
الطفيل بن الحارث طلقها، فخلف عليها أخوه عبيدة بن الحارث بن عبد
المطلب فقتل عنها يوم بدر([15]).
وأما ما قاله الزهري، وتبعه غيره، من أنها كانت تحت عبد
الله بن جحش، فقد قال التستري:
«لعل
الأصل في قول كونها عند عبد الله بن جحش، خلطها بأم حبيبة، فإنها كانت
قبل النبي «صلى الله عليه وآله» عند عبد الله بن جحش، والله العالم»([16]).
ولكننا لم نفهم المبرر لهذا الخلط، ولا سيما من الزهري،
فهل هو اشتباه نسخ الكتاب الذي قرأ ذلك فيه، أم أن الرواة خلطوا في
سماعهم لفظ: أم حبيبة، فسمعوه: بنت خزيمة!!.
كل ذلك بعيد عن الاحتمال المقبول، والمرضي، ولعل دعوى
الخلط بين عبد الله بن جحش، وعبد الله بن الحارث أقرب إلى الاعتبار،
بملاحظة ما بينهما من الاتفاق والتقارب في اللفظ لو كان ثمة خلط حقيقة.
قال ابن الأثير:
«ذكر
ابن مندة في ترجمتها قول النبي «صلى الله عليه وآله»:
«أسرعكن
لحوقاً
بي أطولكن يداً»
فكان نساء النبي «صلى الله عليه وآله» يتذارعن، أيتهن أطول يداً،
فلما توفيت زينب علمن أنها كانت أطولهن يداً
في الخير».
قال:
«وهذا
عندي وهم، فإنه «صلى الله عليه وآله» قال: أسرعكن لحوقاً
بي، وهذه سبقته، إنما أراد: أول نسائه تموت بعد وفاته، وقد تقدم في
زينب بنت جحش، وهو بها أشبه، لأنها كانت أيضاً كثيرة الصدقة من عمل
يدها، وهي أول نسائه توفيت بعده»([17]).
ونضيف نحن إلى ذلك:
أن من غير المعقول أن يقول النبي الأعظم «صلى الله عليه
وآله» كلاماً
مبهماً
لا يفهم المقصود منه، حتى لقد صدر منهن ما يوجب الضحك والسخرية، وهو
أنهن صرن يتذارعن ليرين أيهن أطول يداً؛
لأنه «صلى الله عليه وآله» حين قال لهن ذلك، إنما أراد
به حثهن على المسابقة في الصدقات وعمل الخير، وهذا هو اللائق بشأنه
«صلى الله عليه وآله»، والمتوافق مع أهدافه ومراميه.
فالحق هو أنها زينب بنت جحش، كما قالوا.
ولا نرى أن قولهم:
كان نساء النبي «صلى الله عليه وآله» يتذارعن،
يصح بوجه، ولا مبرر له.
وقد كانت
فاطمة بنت أسد امرأة صالحة، وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله»
يزورها، ويقيل في بيتها([18]).
وهي أول امرأة
بايعت النبي «صلى الله عليه وآله» بمكة بعد خديجة([19]).
قال ابن عباس:
«وفيها
نزلت:
﴿يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾»([20]).
وأول امرأة
هاجرت إلى النبي «صلى الله عليه وآله» من مكة إلى المدينة على قدميها
ماشية حافية([21]).
وكانت حادية عشرة، يعني في السابقة إلى الإسلام،
وكانت بدرية([22]).
وحينما حضرتها
الوفاة أوصت إلى النبي «صلى الله عليه وآله» فقبل وصيتها([23]).
وتوفيت في السنة الرابعة من الهجرة، وصلى عليها رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، وتولى دفنها، ونزع قميصه وألبسها إياه،
واضطجع معها في قبرها، وقرأ فيه القرآن، وأحسن الثناء عليها.
فلما سوى عليها التراب سئل عن سبب فعله ذلك، فقال:
ألبستها لتلبس من ثياب الجنة، واضطجعت معها في قبرها لأخفف عنها ضغطة
القبر، إنها كانت أحسن خلق الله صنعاً
بي بعد أبي طالب.
وعند السمهودي أنه «صلى الله عليه وآله» نزع قميصه وأمر
أن تكفن فيه، وأنه «صلى الله عليه وآله» صلى عليها عند قبرها وكبر
عليها تسعاً
وأنه «صلى الله عليه وآله» حفر اللحد بيده وأخرج ترابه بيده.
وأضاف السلفي:
أنه «صلى الله عليه وآله» تمرغ في قبرها وبكى، وقال:
جزاك الله من أم خيراً،
لقد كانت خير أم، وكانت ربت النبي «صلى الله عليه وآله»([24]).
وأضاف الكليني:
أنه «صلى الله عليه وآله» حمل جنازتها على عاتقه، فلم
يزل حتى أوردها قبرها، وأخذها على يديه، ووضعها فيه، وانكب عليها طويلاً
يناجيها ولقنها ما تسأل عنه، حتى إمامة ولدها علي
«عليه
السلام».
وحينما سئل عن ذلك قال:
«اليوم
فقدت بر أبي طالب، إن كانت لتكون عندها الشيء؛ فتؤثرني به على نفسها
وولدها إلى آخر ما قال
«صلى
الله عليه وآله وسلم»([25]).
وعند الكليني:
أنه هو نفسه «صلى الله عليه وآله» قد قال للمسلمين:
«إذا
رأيتموني قد فعلت شيئاً لم أفعله قبل ذلك؛ فسلوني: لم فعلته»([26]).
وعند السمهودي:
أن قبرها حفر
في موضع المسجد الذي يقال له اليوم قبر فاطمة([27]).
ودفنت رحمها
الله تعالى في البقيع، ودفن الحسن عندها كما نص عليه المفيد وغيره([28]).
ولكن أبا الفرج يقول:
إنها دفنت في
الروحاء مقابل حمام أبي قطيفة([29])،
ولم نفهم المبرر لدفنها هناك، لو صح ذلك.
ووصية الإمام الحسن
«عليه
السلام»
بدفنه عندها، ثم دفنه في البقيع تدل على خلاف ذلك،
والحسنان «عليهما السلام» أعرف بقبر جدتهما من غيرهما.
وأخيراً، فقد قيل:
إنها توفيت في
مكة قبل الهجرة، قالوا: وليس بشيء، واستدلوا على ذلك بأن علياً «عليه
السلام» قال لها: إكف فاطمة بنت رسول الله «صلى الله عليه وآله» سقاية
الماء و تكفيك الداخل والطحن والعجن([30]).
ونضيف نحن إلى ذلك:
ما روي عن علي «عليه السلام» أنه
قال:
إنه أهدي إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» حلة استبرق، فقال: اجعلها
خُمراً
بين الفواطم، فشققتها أربعة أخمرة، خماراً
لفاطمة بنت رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وخماراً
لفاطمة بنت أسد، وخماراً
لفاطمة بنت حمزة، ولم يذكر الرابعة، قال ابن حجر
«قلت»
ولعلها امرأة عقيل الآتية([31]).
وقد تقدم:
أنه «صلى الله عليه وآله» حينما أراد أن يقوم ببعض
الأعمال، ويتخذ بعض المواقف تجاه فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه
الصلاة والسلام، يقول للمسلمين:
«إذا
رأيتموني قد فعلت شيئاً لم أفعله قبل ذلك؛ فسلوني: لم فعلته»؟.
ونرى:
أنه «صلى الله عليه وآله» يهدف من وراء ذلك إلى تركيز
أمرين اثنين لهما أهمية فائقة:
أولهما:
الإشارة إلى أن أهم شيء تقوم عليه التربية الإلهية لهذا الإنسان هو:
إقرار حالة من التوازن بين ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المسلم من
لزوم التعبد والتسليم والانقياد لله وللرسول «صلى الله عليه وآله» ولكل
ما هو شرع ودين، عملاً
بقوله تعالى:
﴿وَمَا
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾([32]).
وقوله تعالى:
﴿أَطِيعُواْ
اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾([33]).
والآيات الآمرة بهذه الإطاعة كثيرة.
وبين أن يبقى العقل والفكر طليقاً
يمارس حقه الطبيعي في التأمل، والتدبر والاستنتاج، وإصدار الأحكام،
وفقاً
للمعايير الصحيحة والسليمة، التي يقبلها العقل وأقرها الشرع حتى إذا ما
واجه هذا الإنسان أحياناً
مشكلة على مستوى الفهم والنظر والتأمل، فإن عليه أن يبحث، ومن حقه أن
يسأل ويستوضح.
ذلك:
أن التسليم والتعبد والانقياد لا يتنافى مع هذا الفكر والعقل والفهم،
والإدراك الوجداني.
وإنما هو ملازم له، وبحاجة إليه في نظر الإسلام.
فالإسلام لا يريد لهذا الإنسان أن يعيش حالة الكبت
والقهر، وسلب الاختيار ثم الجمود، ليكون ـ من ثم ـ آلة بلهاء، لا حياة
فيها، ولا حركة. وإنما يريده حراً،
مختاراً
طليقاً،
يزخر بالحيوية، ويجيش بالحركة والتطلع والتوثب، يتفاعل مع ما يحيط به،
ويعي ما يدور حوله، ويفهمه، ويعيشه بروحه، وعقله، وبوجدانه، وعاطفته،
وبكل وجوده.
وذلك من أجل أن يجد السبيل إلى أن يتكامل به ومعه،
ويستوعب خصائصه الإنسانية ولينسجم ـ من ثم ـ مع نفسه، وفكره، ومع
وجدانه وفطرته.
والإسلام يرى في الفكر والعقل، وفي الفطرة أيضاً خير
نصير ومعين له في مجال تحقيق أهدافه، حيث إن ذلك يسهم في تجلي عظمته،
ويظهر مزاياه الفريدة، وخصائصه الكريمة والمجيدة.
وقد اهتم القرآن والحديث عن النبي «صلى الله عليه وآله»
وعن المعصومين من أهل بيته الطاهرين «صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين»
كثيراً
في التركيز على الدور الطليعي والرائد للعقل وللفكر، وللنظر وللتدبر،
وذم التقليد والانقياد الأعمى، ولا نرى حاجة لإيراد الشواهد على ذلك؛
فإن ذلك أظهر من النار على المنار، وأجلى من الشمس في رابعة النهار.
والعبارة المتقدمة عنه «صلى الله عليه وآله» ليست إلا
واحداً
من الشواهد الكثيرة على اهتمام النبي «صلى الله عليه وآله» بإثارة
دفائن العقول، وتحريكها نحو الفهم والفكر، والتعقل والتدبر، ليصبح
التعبد والانقياد مرتكزاً على أساسه القوي المتين، ومستنداً
إلى ركنه الشديد الوثيق.
ويشبه ما نقرؤه عن النبي
«صلى
الله عليه وآله»
هنا ما نقرؤه عن سبطه ووصيه ووارثه الإمام الرضا «عليه السلام»، حينما
سأله الحسين بن خالد عن نقش خاتم جده أمير المؤمنين علي «عليه السلام»
فقال له:
«ولم
لم تسألني عما كان قبله»؟!
ثم يذكر له خواتيم الأنبياء السابقين «عليهم الصلاة
والسلام»([34]).
وفي مورد آخر، نجد الأصبغ بن نباتة يروي عن علي أمير
المؤمنين «عليه السلام»، أنه قال:
«ما
من شيء تطلبونه إلا وهو في القرآن؛ فمن أراد ذلك؛ فليسألني عنه»([35]).
نعم،
وقد أثرت هذه التربية الإلهية في شيعة أهل البيت «عليهم السلام» وبلغت
حداً
فريداً
من نوعه،
حتى لنجد زرارة ذلك الرجل العالم التقي يواجه إمامه الإمام الباقر
«عليه السلام» الذي يعتقد عصمته، وأن قوله قول رسول الله «صلى الله
عليه وآله» يواجهه بسؤال:
«من
أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس، وبعض الرجلين؟ فضحك، ثم قال: يا
زرارة، قاله رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ونزل به الكتاب من الله
(ثم يذكر له آية الوضوء وغير ذلك من استدلالات لا مجال لذكرها هنا)»([36]).
وكتاب علل الشرايع للشيخ الصدوق لخير دليل على مدى
اهتمامهم «عليهم السلام» بإيراد علل الأحكام للسائلين عنها، وتفهيمهم
إياها بالصورة المقبولة والمعقولة، وذلك لما أشرنا إليه.
أضف إلى ذلك:
أنهم «عليهم السلام» كانوا يعلمون شيعتهم كيفية استنباط المعاني
والأحكام من أدلتها ومصادرها، وذكر شواهد ذلك له مجال آخر([37]).
ثانيهما:
إنه «صلى الله عليه وآله» قد أراد بوصيته للمسلمين
بسؤاله عما يفعل في هذه المناسبة أن يفهمهم، وكل من يصل إليه نبأ هذه
الواقعة: أن الإسلام يحفظ للمحسن إحسانه، ولا يبخسه منه شيئاً، حيث لا
يضيع عند الله عمل عامل من ذكر أو أنثى.
ولكنه في حين يريد:
أن يعلن أن هذه المرأة الصالحة قد أعطت وقدمت من
التضحيات في سبيل الله سبحانه وتعالى ما يجعلها مؤهلة للتكريم
والتقدير، والمعاملة المتميزة وعلى المستوى الأعلى، وبالذات من قبل
أفضل الخلق، وخاتم الأنبياء محمد «صلى الله عليه وآله»،
إنه في حين يريد أن يعلن ذلك لسبب أو لآخر نجده يختار
لهذا التكريم والتقدير، ولهذه المعاملة المتميزة اتجاهاً
لم نعهده من غيره في مجالات كهذه على الإطلاق.
فلقد كان هذا التكريم لا يهدف إلى المكافأة الدنيوية،
التي ليس فقط يكون مصيرها ـ كسائر حالات الدنيا وشؤونها ـ إلى الزوال
والفناء.
وإنما هي قد تضر بحال من تكون له أو لأجله، نفسياً
وروحياً ـ على الأقل، حينما يأخذ العجب والغرور، والإحساس بالتميز
بالنسبة لغيره من إخوانه وأقرانه ـ وأقل ما يقال في ذلك: إنه من
الأدواء الخطيرة والمرعبة، ولا أخطر من ذلك ولا أدهى.
وإنما اتخذت تلك المكافأة وذلك التكريم منحى أكثر
واقعية، وأعظم نفعاً،
وأبعد عن مزالق الخطر، ومخاطر الأدواء، حيث ألبسها قميصه لتكسى من حلل
الجنة، واضطجع في قبرها لتهون عليها ضغطة القبر.
وهذا في الحقيقة هو محض الخير، ومنتهى الإحسان، وغاية
النعمة حيث تحس به الروح الإنسانية إحساساً
حقيقياً
وواقعياً،
وعميقاً،
حينما يمكن للروح أن تتلقاه عن طريق العقل بكل ما له من شفافية وطهر
وصفاء لم يتكدر صفاؤه، ولا تأثر طهره بأعراض الحياة الدنيا وزخارفها،
ولا خفف من درجة الإحساس به حجب الشهوات والأهواء، ولا الانصراف ولا
الانشغال بشواغل وصوارف اللهو واللعب. كما قال تعالى:
﴿اعْلَمُوا
أَنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلهَوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ
بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ
أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً
ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ
مِّنَ اللهَ وَرِضْوَانٌ وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ
الْغُرُورِ﴾([38]).
وما ذلك إلا لأن الدار الأخرة هي
التي يتاح للإنسان فيها:
أن يعيشها بكل خصائصه الإنسانية، وبكامل قدراته الحياتية، وهي التي يجد
الإنسان فيها حقيقته، ويدرك واقعه كإنسان، وكإنسان فقط.
﴿وَإِنَّ
الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾([39]).
وفي السنة الخامسة في ربيع الأول منها، في غياب النبي
«صلى الله عليه وآله» إلى غزوة دومة الجندل توفيت عمرة بنت مسعود، أم
سعد بن عبادة، وكان ولدها سعد غائباً
مع النبي «صلى الله عليه وآله» أيضاً وكانت من المبايعات.
وقالوا:
إنه لما رجع النبي «صلى الله عليه وآله» إلى المدينة أتى قبرها، فصلى
عليها وذلك بعد أشهر من موتها([40]).
و قد تقدم
الحديث عن ذلك
فلا نعيد.
ويقال:
إن أبا سلمة،
عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، ابن عمة رسول الله «صلى الله عليه
وآله» ـ لأن أمه هي: برة بنت عبد المطلب([41])
ـ إن أبا سلمة هذا ـ قد توفي في السنة الرابعة كما سيأتي.
وكان قد أسلم
«رحمه
الله»، بعد عشرة أنفس، وكان الحادي عشر، قاله ابن إسحاق([42]).
وكان قد شهد
«بدراً،
وأحداً،
وجرح فيها، جرحه أبو أسامة الجشمي، رماه بمعبلة([43])
في عضده؛ فمكث شهراً
يداوي جرحه فبرئ فيما يرى، وقد اندمل الجرح على بغي لا يعرفه؛ فبعثه
رسول الله «صلى الله عليه وآله» على رأس خمسة وثلاثين شهراً
من الهجرة في سرية إلى بني أسد، بقطن،
فغاب بضع عشرة ليلة، ثم قدم المدينة، فانتقض به الجرح، فاشتكى ثم مات
لثلاث ليال بقين من جمادى الآخرة»([44]).
وإذاً..
فقد كانت وفاته في أوائل السنة الرابعة([45])،
ونسب ذلك إلى الجمهور.
وقيل:
توفي
«رحمه
الله» في سنة ثلاث، في جمادى الآخرة ونقل هذا عن أبي عمر أيضاً([46]).
وفي نقل آخر عن أبي عمر، وابن مندة:
أنه توفي سنة
اثنتين([47]).
فيقع التنافي بين كلامي أبي عمر في نفس الكتاب.
وقد قدمنا في الجزء السادس:
أن الأقرب هو أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد تزوج
بأم سلمة في السنة الثانية، ومعنى ذلك أن زوجها الأول، وهو أبو سلمة
كان قد مات قبل ذلك.
وذلك يدل على:
أن سرية قطن قد كانت في السنة الثانية أيضاً.
ومهما يكن من
أمر، فقد حضر النبي «صلى الله عليه وآله» موت أبي سلمة، وأغمضه بيده([48])،
كان قد أتاه ليعوده، فصادف خروج نفسه([49])
فضج ناس من أهله، فقال «صلى الله عليه وآله»: لا تدعوا على أنفسكم إلا
بخير، فإن الملائكة يؤمّنون.
ثم قال:
اللهم اغفر
لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين،
واغفر لنا، وله يا رب العالمين([50]).
«فغسل
من
(اليسيرة)،
بئر بني أمية بن زيد بالعالية،
وكان ينزل هناك حين تحول من قباء،
غسل بين قرني البئر. وكان اسمها في الجاهلية
«العبير»
فسماها رسول الله «صلى الله عليه وآله»:
(اليسيرة)
ثم حمل من بني أمية بن زيد، فدفن في المدينة»([51]).
وأخيراً.. فإنهم يقولون:
إن رسول الله
«صلى الله عليه وآله» كان قد آخى بين أبي سلمة وبين سعد بن خيثمة([52]).
ولما أقطع
رسول الله «صلى الله عليه وآله» الدور في المدينة، جعل لأبي سلمة موضع
داره، عند دار بني عبد العزيز الزهريين اليوم، وكانت معه أم سلمة،
فباعوه بعد ذلك، وتحولوا إلى بني كعب([53]).
واستخلف رسول
الله «صلى الله عليه وآله» أبا سلمة على المدينة، لما سار إلى غزوة
العشيرة، سنة اثنتين من الهجرة([54]).
وسيأتي حين الكلام على سرية قطن بعض ما يذكرونه عنه:
أنه فعله في هذه السرية.
ورغم:
أن الكثير مما تقدم يحتاج إلى بحث وتحقيق، ولكننا سوف
نعتبره من الأمور التي لا نجد ضرورة ملحة لمعالجتها في الوقت الحاضر،
ولأجل ذلك، فنحن نرجئ الحديث عنها إلى فرصة أخرى، ووقت آخر، ونكتفي
بتسجيل ملاحظات يسيرة، رأينا في الاشارة إليها بعض الفائدة، أو هكذا
خيل لنا،
والملاحظات هي التالية.
ويقولون:
إن أبا سلمة كان قد:
«هاجر
إلى الحبشة، وكان أول من هاجر إليها.
وقال ابن مندة:
هو أول من هاجر بظعينته إلى الحبشة، وإلى المدينة»([55])
فهو إذاً قد كان الأول في الهجرتين معاً.
وكان أبو سلمة
قد التجأ ـ في أول الأمر ـ إلى خاله أبي طالب، شيخ الأبطح «رحمه الله»
حينما اشتد البلاء على المسلمين؛ فمنعه أبو طالب، ورفض تسليمه إلى بني
مخزوم([56])
ثم كانت الهجرة إلى الحبشة، فكان أول من هاجر إليها.
وأما بالنسبة
إلى هجرته إلى المدينة، فإنه حينما قدم من الحبشة إلى مكة وآذته قريش،
وقد بلغه إسلام من أسلم من الأنصار، خرج إليها، وذلك قبل بيعة العقبة([57]).
وكان قدومه
إلى المدينة لعشر خلون من المحرم، ونزل على مبشر بن عبد المنذر([58]).
ومما تقدم يظهر:
أن قولهم: إن عثمان كان أول من هاجر إلى الحبشة بأهله
لا يصح؛ ولا أقل من أنه يصير محل شك وريب، وقد ألمحنا إلى ذلك في الجزء
الثالث من هذا الكتاب في فصل: الهجرة إلى الحبشة.
قال ابن مندة:
شهد أبو سلمة بدراً، وأحداً،
وحنيناً
والمشاهد ومات بالمدينة، لما رجع من بدر([59]).
ونقول:
أولاً:
إن غزوة حنين قد كانت سنة ثمان، فمن مات بعد رجوعه من
بدر، التي كانت في شهر رمضان المبارك، في السنة الثانية كيف يشهد حرب
حنين؟!
ثانياً([60]):
قد تقدم أنه مات في السنة الرابعة على ما قاله الجمهور، أو في الثالثة،
ونحن قد قوينا: أن وفاته كانت في الثانية،
ونسب ذلك إلى أبي عمر، ولكن في كلام أبي عمر تناقض حسبما ألمحنا إليه.
ويقولون:
إن قوله تعالى:
﴿فَأَمَّا
مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا
كِتَابِيهْ﴾([61]).
قد نزل في أبي سلمة «رحمه الله» تعالى([62]).
ولكن قد ورد
أن هذه الآية قد نزلت في أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، روي ذلك
عن أبي جعفر الباقر، وأبي عبد الله الصادق، وابن عباس، فراجع([63]).
([1])
الإصابة ج3 ص67و راجع: تاريخ الخميس ج1 ص464، وأسد الغابة ج3
ص244 والبداية والنهاية ج4 ص89 وأنساب الأشراف ج1 ص401 والسيرة
النبوية لابن كثير ج3 ص172 والكامل لابن الأثير ج2 ص176 وتاريخ
الأمم والملوك ج2 ص555.
([2])
تاريخ الخميس ج1 ص464 وأسد الغابة ج5 ص456 والإستيعاب بهامش
الإصابة ج4 ص300 والبداية والنهاية ج4 ص89 والسيرة النبوية
لابن كثير ج3 ص172 وراجع: تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص206
والكامل في التاريخ ج2 ص176.
([3])
تاريخ الخميس ج1 ص464 و275 وأسد الغابة ج5 ص456 والإصابة ج4
ص304 والإستيعاب بهامشه ج4 ص300 وبهجة المحافل ج1 ص231.
([4])
أسد الغابة ج3 ص224 عن ابن مندة وأبي نعيم.
([5])
راجع كتاب: تبرك الصحابة والتابعين للعلامة الشيخ علي الأحمدي.
([6])
أسد الغابة ج3 ص224 عن ابن مندة وأبي نعيم.
([7])
راجع: الإصابة ج3 ص67 والإستيعاب بهامشه ج4 ص299 وتاريخ الخميس
ج1 ص275 وأسد الغابة ج3 ص224 وج 5 ص456.
([9])
تاريخ الخميس ج1 ص275 والإصابة ج4 ص304.
([10])
تاريخ الخميس ج1 ص464.
([11])
الإصابة ج4 ص304 والإستيعاب بهامشها ج4 ص400 وأسد الغابة ج5
ص456 وتاريخ الخميس ج1 ص275 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص226 ط
الإستقامة وأنساب الأشراف(قسم حياة النبي «صلى الله عليه
وآله») ص401 والبداية والنهاية ج4 ص89 والسيرة النبوية لابن
كثير ج3 ص172.
([12])
تاريخ الخميس ج1 ص275 والإصابة ج4 ص304 وأسد الغابة ج5 ص256
والإستيعاب بهامش الإصابة ج4 ص300.
([13])
تاريخ الخميس ج1 ص275 والإصابة ج4 ص304 وأسد الغابة ج5 ص256
والإستيعاب بهامش الإصابة ج4 ص300.
([14])
راجع في ما تقدم كلاً أو بعضاً: الإصابة ج4 ص315 و316
والإستيعاب بهامشه ج4 ص312 والبداية والنهاية ج4 ص90 والسيرة
النبوية لابن كثير ج3 ص173 و174 وقاموس الرجال ج10 ص445 وأسد
الغابة ج5 ص466 و467 وتاريخ الخميس ج1 ص463 و417 وطبقات ابن
سعد ج8 ص82 والدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص232 وأنساب
الأشراف قسم حياة النبي «صلى الله عليه وآله» ص429، والسيرة
الحلبية ج3 ص318 و319 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص208
ومرآة الجنان ج1 ص7 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص545.
([15])
طبقات ابن سعد ج8 ص82 وقاموس الرجال ج10 ص445 عن البلاذري
والسيرة الحلبية ج3 ص319 وأنساب الأشراف (قسم حياة النبي «صلى
الله عليه وآله») ص429 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص173
والبداية والنهاية ج4 ص90 وتاريخ الخميس ج1 ص417 وتاريخ
الإسلام للذهبي (المغازي) ص208.
([16])
قاموس الرجال ج10 ص445.
([17])
أسد الغابة ج5 ص466 و 467 والإصابة ج4 ص415 و 416 والدر
المنثور في طبقات ربات الخدور ص232.
([18])
طبقات ابن سعد ج8 ص161 والإصابة ج4 ص380.
([19])
تذكرة الخواص ص10 وقاموس الرجال ج11 ص7 عنه وراجع: تفسير
البرهان ج4 ص326 و 327 ومقاتل الطالبيين ص10.
([21])
راجع: تفسير البرهان ج4 ص326 و 327 وتذكرة الخواص ص10 والكافي
ج1 ص377.
([22])
مقاتل الطالبيين ص9 وتفسير البرهان ج4 ص327 وشرح النهج
للمعتزلي ج1 ص14.
([23])
مقاتل الطالبيين ص8 والكافي ج1 ص377.
([24])
راجع ما تقدم في المصادر التالية: مقاتل الطالبيين ص8 و9
وقاموس الرجال ج11 ص6 و7 والإستيعاب بهامش الإصابة ج4 ص382
والإصابة ج4 ص380 والدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص358،
359 وأسد الغابة ج5 ص517 وتذكرة الخواص ص10 والكافي ج1 ص377
والإرشاد للمفيد ص10 وإعلام الورى ص153 وتاريخ الخميس ج1 ص468
ووفاء الوفاء المجلد الثاني ص897 و 898 و 899 وبهجة المحافل ج1
ص231 و 232 وراجع: الفصول المهمة للمالكي ص13 و14.
([25])
راجع: الكافي ج1 ص377 وقاموس الرجال ج11 ص6 عنه وراجع: وفاء
الوفاء المجلد الثاني ص898.
([26])
المصدران السابقان.
([27])
وفاء الوفاء المجلد الثاني ص897.
([28])
الإرشاد ص211 وراجع: ص213 وإعلام الورى ص206 وراجع: ص212.
([29])
مقاتل الطالبيين ص10 والبرهان ج4 ص327 عنه.
([30])
راجع: أسد الغابة ج5 ص517 والإصابة ج4 ص380 وراجع الإستيعاب
بهامشها ج4 ص382 وتاريخ الخميس ج1 ص468 والدر المنثور في طبقات
ربات الخدور ص358.
([31])
الإصابة ج4 ص481 وأسد الغابة ص519.
([32])
الآية 7 من سورة الحشر.
([33])
الآية 59 من سورة النساء.
([34])
راجع: نقش الخواتيم لدى الأئمة الاثني عشر ص10 و 11 للمؤلف.
([35])
الكافي ج2 ص457 والوسائل ج18 ص135.
([36])
علل الشرايع ص279 ومن لا يحضره الفقيه ج1 ص103 والإستبصار ج1
ص62، 63 والتهذيب ج1 ص61 والكافي ج1 ص30 والوسائل ج1 ص391 وج 2
ص980.
([37])
راجع: الكافي ج1 ص33 والتهذيب ج1 ص363 والإستبصار ج1 ص77، 78
وأطائب الكلم في بيان صلة الرحم للكركي ص20 والوسائل ج1 ص327.
([38])
الآية 20 من سورة الحديد.
([39])
الآية 64 من سورة العنكبوت.
([40])
راجع: طبقات ابن سعد ج8 ص330 و 331 والإصابة ج4 ص367 وتاريخ
الخميس ج1 ص469 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص210.
([41])
راجع: أسد الغابة ج3 ص195 والإصابة ج2 ص335 والإستيعاب بهامشها
ج2 ص338 والبداية والنهاية ج4 ص90 والسيرة النبوية لابن كثير
ج3 ص172 وذخائر العقبى وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص209.
([42])
الإصابة ج2 ص335 والإستيعاب بهامشها ج2 ص138، 338 وأسد الغابة
ج3 ص196 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص209.
([43])
المعبلة بكسر الميم: نصل طويل عريض.
([44])
طبقات ابن سعد ج3 قسم 1 ص171 وراجع: تاريخ الخميس ج1 ص450
وتهذيب الأسماء واللغات قسم اللغات ج2 ص240 وذخائر العقبى
ص253، 254 والإصابة ج2 ص335 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص174
والبداية والنهاية ج4 ص62 و90 وراجع: تاريخ الإسلام للذهبي
(المغازي) ص209.
([45])
راجع: تاريخ الخميس ج1 ص350 عن المنتقى، والمواهب اللدنية وأسد
الغابة ج3 ص196 عن مصعب الزبيري وأنساب الأشراف ج1 (سيرة النبي
«صلى الله عليه وآله») ص429 والبداية والنهاية ج4 ص90 و 62
والسيرة النبوية لابن كثيرة ج3 ص174 و 122 والمغازي للواقدي ج1
ص343 والإصابة ج2 ص335 عن ابن سعد وأبي بكر، زنجويه، ثم قال:
«..وبه قـال الجمهور، كابن أبي خيثمة، ويعقوب بن سفيان، وابن
البرقي، والطبري وآخرون».
([46])
أسد الغابة ج3 ص196 وتاريخ الخميس ج1 ص450 عن الصفوة، والإصابة
ج2 ص335 عن أبي عمر، والإستيعاب بهامشه ج4 ص82 وج 2 ص338.
([47])
أسد الغابة ج3 ص196 و 197 والإصابة ج2 ص335 والإستيعاب بهامشه
ج4 ص421 و 422 ذكر زواج النبي «صلى الله عليه وآله» بأم سلمة
في شوال في السنة الثانية.
([48])
طبقات ابن سعد ج3 قسم1 ص172 وتاريخ الخميس ج1 ص450 وأسد الغابة
ج3 ص196 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص209.
([49])
طبقات ابن سعد ج3 قسم 1 ص172.
([50])
أسد الغابة ج3 ص196 وراجع: ذخائر العقبى ص254 وطبقات ابن سعد
ج3 قسم 1 ص172.
([51])
طبقات ابن سعد ج3 قسم 1 ص172 والمغازي للواقدي ج1 ص343.
([52])
طبقات ابن سعد ج3 قسم 1 ص171.
([53])
طبقات ابن سعد ج3 قسم 1 ص171.
([54])
أسد الغابة ج3 ص196 والإستيعاب بهامش الإصابة ج2 ص338.
([55])
ذخائر العقبى ص253 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص209 وثمة
مصادر كثيرة أخرى تقدمت طائفة منها في الجزء الثالث من هذا
الكتاب.
([56])
أسد الغابة ج3 ص196.
([57])
ذخائر العقبى ص253.
([58])
طبقات ابن سعد ج3 قسم 1 ص171.
([59])
أسد الغابة ج3 ص196 و 197.
([60])
أشار إلى هذين الإيرادين على ابن مندة في أسد الغابة ج3 ص197.
([61])
الآية 19 من سورة الحاقة.
([62])
راجع: أسد الغابة ج3 ص196، والتبيان ج10 ص100 وفيه: أبو سلمة
بن عبد الأسود، وروى ذلك عن الفراء، والجامع لأحكام القرآن ج18
ص270، عن الضحاك، ومقاتل، والإصابة ج2 ص335 عن الأوائل لابن
أبي عاصم، عن ابن عباس.
([63])
تفسير البرهان ج4 ص377 و 378 وراجع: تفسير الميزان ج19 ص402.
|