|
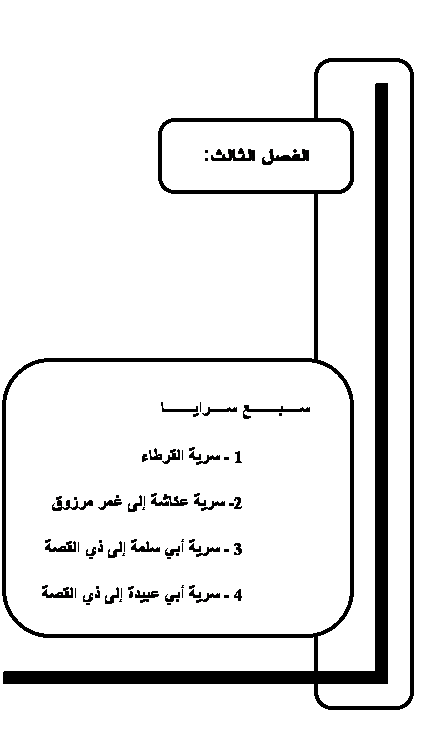
1 ـ سرية القرطاء:
في محرم على رأس تسعة وخمسين شهراً من الهجرة كانت سرية
القرطاء. وهم بطن من بكر بن كلاب، في موضع يقال له: «الضريَّة» وهي على
سبع مراحل على الطريق بين البصرة ومكة.
حيث يقال:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» بعث إليهم محمد بن مسلمة
في ثلاثين راكباً، وأمره أن يغير عليهم بغتة، فسار إليهم، وكان يكمن
بالنهار، ويسير بالليل، حتى أغار عليهم، فقتل نفراً منهم، وهرب سائرهم
وأصاب منهم خمسين بعيراً (أو مائة وخمسين بعيراً)، وثلاثة آلاف شاة.
وقدم المدينة لليلة بقيت من المحرم، فخمسها، ثم قسمها
بين أصحابه.
وكانت غيبته في تلك السرية تسع عشرة ليلة([1]).
وفي نص آخر:
أنه حين سار محمد بن مسلمة إليهم صادف في طريقه ركباناً
نازلين، فأرسل إليهم رجلاً من أصحابه، يسأل: من هم؟
ثم رجع إليه
فقال:
قوم من محارب.
فنزل قريباً منهم، ثم أمهلهم حتى عطَّنوا الإبل (أي
برَّكوها) حول الماء، فأغار عليهم، فقتل نفراً منهم، أي عشرة، وهرب
سائرهم، وساق نعماً وشاء، ولم يتعرض للنساء([2]).
ونقول:
أولاً:
إن لنا تحفظاً على كثير مما يقال في هذه السرايا،
خصوصاً حين تعطي صورة غير واقعية عن سياسات رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، حيث يتخيل القارئ لرواياتها: أن النبي «صلى الله عليه وآله»
بمثابة رئيس عصابة، أو جماعة (والعياذ بالله) ليس له ولهم شغل إلا أن
يترصدوا الناس الآمنين ليغيروا عليهم، فيقتل رجالهم، ويأسر ويسبي
ذراريهم، ونساءهم، ويغنم أموالهم. من دون أي مبرر ظاهر، أو مقبول وفق
ما توحي به سرية القرطاء وأمثالها..
ومن الواضح:
أن طريقة النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله»، وكذلك
طبيعة تعاليم الدين الحنيف إنما كانت تقضي بالرفق، والسماحة، والاهتمام
بهداية الناس والحرص على سعادتهم، بل كانت نفس النبي «صلى الله عليه
وآله» تكاد تذهب حسرات على أناس نصبوا له الحرب، وبغوا له الغوائل،
لشدة حرصه على هدايتهم، ونجاتهم مما هم فيه من الجهل والشرك..
ولم يكن «صلى الله عليه وآله» بالذي يهتم بشن الغارات
على الناس الآمنين، رغبة في قتلهم، والحصول على أموالهم، وأسر واستعباد
من يتمكن من أسرهم واستعبادهم.
لقد كان النبي «صلى الله عليه وآله» أنبل في نفسه،
والله تعالى أرحم وأرأف وأجل وأعدل من أن يكون ذلك داخلاً في أهدافه،
وجزءاً من سياساته، فحاشا، ثم حاشا أن ينسب أحد أمثال هذه الترهات
والأباطيل إلى الله ورسوله.
من أجل ذلك نقول:
إن جميع الحروب التي خاضها رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، وكذلك أمير المؤمنين «عليه السلام» من بعده قد كانت لرد
العدوان القائم، أو من أجل إحباط تدبير لعدوان خطير..
بعد أن تكون قد استنفذت جميع الوسائل المتاحة لهدايتهم
وإرشادهم، والعمل على نصحهم، وكشف غشاوات الجهل والعمى عن بصائرهم،
بحيث يصبح استمرارهم في خط الكفر لا يعدو كونه نتيجة جحود وعناد، وتمرد
وفساد، على قاعدة ﴿وَجَحَدُوا
بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ..﴾.
فإن صح ما يقال عن سرية القرطاء، فلا بد أن يكون بعد
إقامة الحجة، وظهور المحجة، ثم إصرارهم وعنادهم، وسعيهم في إطفاء نور
الله تعالى، والإفساد منهم في الأرض، وصداً منهم عن سبيل الله تبارك
وتعالى.
ثانياً:
إننا نتمنى أن تكون هذه البطولات والإنجازات، التي
ينسبونها إلى محمد بن مسلمة، صحيحة ودقيقة المضامين، فقد تعودنا من
هؤلاء الناس ممارستهم الكثير من الخيانة والتزوير للحقائق، لمجرد منح
هذا أو ذاك أوسمة، وبطولات، ليس لها نصيب من الواقعية والصدق، وذلك في
ضمن كيد إعلامي رخيص، يهدف إلى إطراء من هم معهم، وفي خطهم، ومن اختار
طريق الخصومة لعلي «عليه السلام» ومناوأته، وتعظيم مناوئيه، وكان محمد
بن مسلمة من هؤلاء بلا ريب..
فإنه كان ممن امتنع عن البيعة لعلي «عليه السلام»([3])
رغم أنه كان من الناقمين على عثمان، والشامتين به، فقد قال في يوم قتل
عثمان: «ما رأيت يوماً أقر للعيون، ولا أشبه بيوم بدر من هذا اليوم»([4]).
ومحمد بن مسلمة كان أيضاً من الذين هاجموا بيت فاطمة
الزهراء «عليها السلام» بعد وفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله»
ودخلوه، بل يدَّعون: أنه هو الذي كسر سيف الزبير([5]).
وحين جاءه عمار ليدعوه إلى بيعة علي
«عليه السلام» قال له:
«مرحباً بك يا أبا اليقظان على فرقة ما بيني وبينك..».
ثم كلَّمه في أمر البيعة فرفضها، فلما أبلغ علياً «عليه
السلام» بما جرى قال «عليه السلام»: «..وذنبي إلى محمد بن مسلمة أني
قتلت أخاه يوم خيبر، مرحب اليهودي»([6]).
وكان صاحب العمال أيام عمر إذا اشتكي إليه عامل أرسله
ليتكشف الحال. وهو الذي أرسله عمر إلى عماله ليأخذ شطر أموالهم لثقته
به([7]).
وبعثه إلى الشام أيضاً مع خالد بن الوليد لقتل سعد بن
عبادة، وأشاعوا: أن الجن قتلته([8]).
رغم ذلك كله، فإنه زعم:
أن خلافة علي «عليه السلام» فتنة، وأنه اعتزلها من أجل ذلك([9]).
ولكن ليت شعري ألم يكن كل ما سبقها فتنة؟ وهل بعد بيعة
الغدير، وسواها من الدلائل ما يصلح عذراً لهذا الرجل أو لغيره؟!.
وقد ذكروا:
أن ابن مسلمة حين رجع من تلك الغزوة، جاء بثمامة بن
أثال الحنفي ـ سيد أهل اليمامة ـ أسيراً ـ ولكن آسريه لم يعرفوا أسيرهم
ـ فأمرهم النبي «صلى الله عليه وآله»: بأن يحسنوا إساره، بعد أن
عرَّفهم «صلى الله عليه وآله» به.
ولما رجع «صلى الله عليه وآله» إلى
أهله قال:
اجمعوا ما عندكم من طعام، فابعثوا به إليه، وأمر بلقحته،
أن يغدى عليه بها ويراح، فجعل لا يقع من ثمامة موقعاً. ويأتيه رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، ويقول له: أسلم يا ثمامة، (أو ما تقول يا
ثمامة)، أو ما عند ك يا ثمامة؟
فقال:
عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا
دم، وإن تنعم
تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال، فسل منه ما شئت.
فتركه «صلى الله عليه وآله»، ثم سأله في اليوم الثاني،
ثم في اليوم الثالث، ثم أمر بإطلاقه. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد،
فاغتسل، ثم عاد إليه، فأسلم، وبايعه.
فلما أمسى جاؤوه بما كانوا يأتونه به من الطعام، فلم
ينل منه إلا قليلاً، وباللقحة، فلم يصب من حلابها إلا يسيراً، فتعجب
المسلمون من ذلك!!
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
مِمَّ تعجبون؟! من رجل أكل أول النهار في معي كافر وأكل آخر النهار في
معي مسلم، إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وإن المسلم يأكل في معي واحد([10]).
تقدم:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» عرفهم بأسيرهم، وأنه سيد
أهل اليمامة، وقال لهم: أحسنوا إساره.
ولكن الروايات ذكرت أيضاً:
أنه «ربط بسارية من سواري المسجد»([11]).
فهل ربط الأسير بسارية من سواري المسجد بحيث يراه الخاص
والعام يعدُّ إحساناً لإساره؟! خصوصاً إذا كان من سادات العرب، ومن أهل
الشرف والرياسة!! ألا يعدُّ ذلك بالنسبة لهذا النوع من الناس غاية
الإذلال، وأبلغ المهانة؟!
والتأمل في قصة ثمامة يثير أمامنا أكثر من سؤال، يحتاج
إلى إجابة مقنعة ودقيقة.
فهناك سؤال عن تاريخ أسره، فإن ابن
هشام وغيره يذكرون:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كتب إلى ثمامة بن أثال، وهوذة بن
علي، ملكي اليمامة ـ حين كتب إلى الملوك ـ
([12]).
والمعلوم:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد كتب إلى الملوك بعد
الحديبية كما سيأتي في موضعه، أي في سنة ست أو سبع([13]).
بل لقد ورد:
أن ثمامة عزم على قتل رسول الله «صلى الله عليه وآله»
فأسر على قول، أو خرج معتمراً ودخل المدينة فتحير فيها حتى أخذ وجيء به
إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»([14]).
ويؤيد ذلك:
ما رواه الكليني من أن رسول الله «صلى الله عليه وآله»
قد قال: اللهم مكني من ثمامة، فأسرته خيل النبي «صلى الله عليه وآله»([15]).
والظاهر:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد قال ذلك بعد أن أساء
ثمامة إلى رسوله «صلى الله عليه وآله». وإلا فلماذا يخص ثمامة بهذا
الدعاء؟!
ويدل على تأخر إسلام ثمامة وتأخر
قضية أسره:
أن أبا هريرة يروي القضية، ويقول في آخرها: «فجعلنا
المساكين تقول بيننا: ما نصنع بدم ثمامة؟! لأكلة من جزور سمينة من
فدائه أحب إلينا من دم ثمامة»([16]).
ومن ذلك:
السؤال عن مكان أسر ثمامة.. فإن الروايات التي ذكرناها
آنفاً لم تبين ذلك، بل ربما يكون فيها إلماح إلى أنه قد أسر في المناطق
التي وصلت إليها السرية المذكورة..
مع أن ثمة ما يدل:
على أنه قد أسر في داخل المدينة نفسها، حيث يقول النص:
إنه قد «دخل المدينة وهو يريد مكة للعمرة، فتحير في المدينة، فقبض،
وأتي به إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، ثم أسلم، ومنع حمل الحب من
اليمامة إلى مكة إلا بإذن النبي «صلى الله عليه وآله»..»([17]).
وفي نص آخر:
أنه «كان قد جاء إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» رسولاً من عند
مسيلمة، وأراد اغتياله «صلى الله عليه وآله». فدعا ربه أن يمكنه منه،
فأُخذ وجيء به إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فربط بسارية من
سواري المسجد الخ..»([18]).
ولنا تحفظ على هذا النص الأخير.
فإن سيد أهل اليمامة لا يرضى عادةً بأن يكون هو الرسول
لاغتيال أحد، بل هو يقود الجيوش، ويتزعم الكراديس في الحروب، ويرسل من
قبله أفراداً مغمورين، لا يعرفهم الناس إذا رأوهم، بل يظنونهم أعراباً،
أو تجاراً، أو ما إلى ذلك.
وقد صرح النص الذي نقلناه فيما سبق:
بأن الذين أسروا ثمامة لم يعرفوه، حتى كان النبي «صلى الله عليه وآله»
هو الذي دلهم عليه، وأمرهم بالإحسان إليه..
ونقول:
إن هذا لو صح، فلا بد أن يكون
مؤيداً للنص الذي يقول:
إنه قد قُبِضَ على ثمامة في المدينة، حيث لم يستغرق أسرهم له سوى
دقائق، هي مسافة الطريق من موضع القبض عليه حتى وصوله إلى المسجد، حيث
عرض أمره على النبي «صلى الله عليه وآله»..
ولو كان قد أسر قبل ذلك، فلا يعقل أن يبقى في يد آسريه
ساعات أو أياماً، دون أن يسألوه عن نفسه، وعن أهله وبلده، ويبقى
مجهولاً لهم إلى أن يعرفه النبي «صلى الله عليه وآله» ويخبرهم بأمره.
إلا أن يقال:
إنهم سألوه، فلم يجبهم، أو أجابهم ولم يصدقوه.. وكلاهما
احتمال لا شاهد له.
وقد زعموا أيضاً:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» انصرف من عند ثمامة وهو
يقول: اللهم أكلة لحم من جزور أحب إلي من دم ثمامة، ثم أمر به فأطلق([19]).
ونحن نجل رسول الله «صلى الله عليه وآله» عن هذه
التفاهات، فإنه «صلى الله عليه وآله» لم يكن يهتم بأكلة من لحم جزور،
ولا يجعل هذا الأمر طرفاً في المقايسة مع دم أحد..
والصحيح هو:
أن هذا من أقوال أبي هريرة، ومن معه من أصحاب الصفة،
الذين صاروا يقولون:
نبينا «صلى الله عليه وآله» ما يصنع بدم ثمامة؟! والله لأكلة جزور
سمينة من فدائه أحب إلينا من دم ثمامة([20]).
وقد ذكرت الروايات المتقدمة:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد أحسن إلى ثمامة، وخصه
بلقاحه فكان يغدى بها عليه ويراح. وصار «صلى الله عليه وآله» يطلب منه
أن يسلم..
ونقول:
إن من الواضح:
أن الإسلام حين خص المؤلفة قلوبهم بنصيب من المال، فلا
بد أن يكون قد لاحظ:
أولاً:
إنه بذلك يكون قد أعطاهم الفرصة ليعيشوا أجواء الإسلام،
عن كثب، ليتلمسوا حقائقه وقيمه، ومفاهيمه، وليعيشوا الأمن والسلام
الداخلي، والاجتماعي، والسياسي، بكل ما لهذه الكلمات من معنى.
ثانياً:
إنه يكون بذلك قد طمأنهم إلى أن الإسلام لا يريد أن
يحرمهم من لذائذ الحياة الدنيا، ولا يريد أن يسلبهم الامتيازات
المشروعة فيها، بل هو يريد أن يحفظ لهم ذلك، وأن يوجههم باتجاه إنتاج
المزيد من الخير والسعادة لهم، وإبعاد أي نوع من أنواع الخلل في حياتهم
وفي سعادتهم..
ثالثاً:
إنه يريد منهم أن يكفوا عن ممارسة أساليب الضغط على
الناس وعن العمل على مصادرة حريات الآخرين، والتأثير على قرارهم فيما
يرتبط بالفكر والاعتقاد، وأن يبقى الباب مفتوحاً والمجال مفسوحاً أمام
أبنائهم، وسائر أرحامهم وأصدقائهم، وكل من يرتبط بهم، ليعيشوا أجواء
الإسلام، من دون أي حرج أو تردد، وأن يتفهموا حقائقه، ومفاهيمه،
ومعانيه، من منابعه الأصلية، بكل سلامة وصفاء، بعيداً عن أي تشويه، ومن
دون تأثر بالشائعات المغرضة، أو الكاذبة.
رابعاً:
إن ذلك ليس شراء لذممهم، ولا هو شراء لضمائرهم، ولدينهم
بالمال. بل ذلك من أجل رفع الحواجز النفسية، وطمأنتهم إلى أن الهدف هو
مجرد الحصول على حرية التفكير والقرار، إذ لو كان الأمر على خلاف ذلك
لكان اللازم هو فرض قرار الإسلام والإيمان عليهم مقابل المال. وهذا ما
لم يكن، بل الذي كان هو مجرد رفع حالة العداء، وحصول درجة من الثقة
والإلفة، ورفع الوحشة وإزالة الخشية من نفوسهم، ولذلك سماهم الإسلام
بالمؤلفة قلوبهم، وسمي سهمهم أيضاً بسهم المؤلفة قلوبهم..
خامساً:
وأخيراً، فإن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت وتفرغت
للعبادة، وأيس منها الوسواس، حسبما قاله الصحابي الجليل سلمان الفارسي
(المحمدي) رضوان الله تعالى عليه([21]).
وعلى هذا الأساس نقول:
إنه إذا وجد المؤلفة قلوبهم مقاصدهم المالية، فإن الباب
يصبح أمامهم مفتوحاً للتفكير بأمور الاعتقاد والسياسة، والأخلاق
والقيم، وما إلى ذلك.
وأما الحديث عن كثرة أكل ثمامة، وقلته، قبل الكفر
وبعده، وادِّعاء أن سبب قلة أكله بعد أن أسلم هو أن المؤمن يأكل بمعي
واحد.. فهو حديث غريب وعجيب.
فأولاً:
لماذا عجب المسلمون من ثمامة حينما قلَّ أكله بعد
إسلامه؟ ألم يجر هذا الأمر على كل واحد منهم قبله، حين خرجوا من الكفر
إلى الإيمان؟! أم أن ذلك قد حدث لأول مرة مع خصوص ثمامة دون سواه؟!
وها نحن لا زلنا نشاهد مشركين وكفاراً يسلمون، فهل
يقلُّ أكلهم بعد إسلامهم، بحيث يلفت ذلك النظر، ويثير العجب؟!
ثانياً:
قيل: إن هذا الحديث قد ورد في رجل بعينه، وهو عمرو بن
معد يكرب الزبيدي، الذي كان يأكل في حال كفره فيكثر، فلما أسلم قل
طِعمه..
وقال أبو عبيد في تاريخه:
هو أبو بصرة الغفاري واسمه حُمَيْل([22]).
وقيل:
المراد به أبو غزوان([23]).
غير أننا نقول:
إن سياق الحديث يأبى هذا الاختصاص، لأن كثرة الأكل
وقلته، قد علقتا على الكفر والإيمان..
إلا أن يقال:
إن اللام في كلمتي المؤمن والكافر عهدية لا جنسية([24]).
ولكنه توجيه لا يصح، لأن ظاهر
الكلام:
أنه «صلى الله عليه وآله» بصدد ضرب القاعدة، وإعطاء
الضابطة.
وخير ما يوجه به هذا الكلام هو:
ما ذكره علماؤنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، من
أنه جار على طريقة المجاز لحث الناس على القناعة، وعلى أن لا تكون
همتهم في طعامهم «كالبهيمة المربوطة همها علفها، وشغلها تقممها»، فإن
الذي يبحث عن اللذة، وينساق وراء إشباع دواعي الشهوة هو الكافر.. أما
المؤمن فهمه مجرد التبلغ لحفظ خيط الحياة.
أو يقال:
إن الكافر لا يبالي من أين أكل، ولا كيف أكل، بل هو لا
يشبع من جمع الأموال، ويريد أن يأكل الدنيا بأسرها، بأي سبب كان، فكأن
له سبعة أمعاء، على سبيل المبالغة.
أما المؤمن، فلا يأكل إلا الحلال بالسبب الحلال، فيقتصر
ما يتناوله أو يصل إليه على أقل القليل..
وقالوا أيضاً:
إن ثمامة قال للنبي «صلى الله عليه وآله»: إن خيلك
أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟! فبشره النبي «صلى الله عليه
وآله» وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟
فقال:
لا، ولكني أسلمت مع رسول الله «صلى الله عليه وآله».
ولا والله لما تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن النبي «صلى الله
عليه وآله».
ثم خرج إلى اليمامة، فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاً.
حتى أضر بهم الجوع وأكلت قريش العلهز([25]).
فكتبوا إلى النبي «صلى الله عليه
وآله»:
إنك تأمر بصلة الرحم، وإنك قد قطعت أرحامنا.
فكتب رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
أن خل بين قومي وبين ميرتهم. ففعل، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ
أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا
يَتَضَرَّعُونَ﴾([26]).
ويقال:
إنه لما كان ببطن مكة في عمرته لبى، فكان أول من دخل
مكة يلبي، فأخذته قريش، فقالوا: لقد اجترأت علينا. وهموا بقتله، ثم
خلوه لمكان حاجتهم إليه وإلى بلده([27]).
وحول ما ذكرته رواية قطع النبي «صلى الله عليه وآله»
أرحام قومه، نقول:
أولاً:
هل يحق لأهل مكة، الذين حصروه هو والهاشميين في شعب أبي
طـالب سنوات، ومنعوا عنهم كل شيء حتى كادوا يهلكون جوعاً، ثم أخرجوا
النبي «صلى الله عليه وآله» ومن معه من ديارهم، وحاربوه، وقتلوا عمه
حمزة، وابن عمه عبيدة بن الحارث وكذلك غيرهما من الأخيار، وتآمروا على
حياته، ولا يزالون يعملون جاهدين لإطفاء نور الله.. ويشنون عليه
الغارات.. و.. و..
هل يحق لهم:
أن يتهموه بأنه قطع أرحامهم؟!..
ولماذا لم يتهموه بذلك وهو لم يزل يعترض قوافلهم التي
تحمل أموالهم وتجاراتهم، وقد عور عليهم متجرهم؟!..
وإذا كانوا قد قالوا ذلك له فعلاً، فلماذا لم يستجب
لهم، ويتوقف عن اعتراض قوافلهم وتجاراتهم؟!
وإذا كان قد استجاب لهم، فما هو الداعي لحرب بدر؟
ألم يكن بإمكانهم أن يطالبوه بصلة أرحامهم، ليكف عن
اعتراض تجاراتهم؟!
ثانياً:
إذا كان ثمامة هو الذي منع عن قريش أي شيء من نتاج
اليمامة، فما هو ذنب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ليتهموه بأنه قد
قطع رحمهم؟! ولماذا لا يطالبون ثمامة نفسه بهذا الأمر؟..
ثالثاً:
والأهم من ذلك: هل كانت اليمامة هي المصدر الوحيد
للحنطة، ولغيرها مما تحتاجه مكة؟! ألم يكن في سائر بلاد الله الواسعة
ما يلبي حاجات مكة وسواها من ذلك؟!
رابعاً:
وعلينا أن لا نغفل أخيراً عن هذا التعبير الذي ينسب إلى
رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وهو قوله: «خلِّ بين قومي وبين
ميرتهم»، فهل كان «صلى الله عليه وآله» على استعداد لإمداد قريش
بالميرة في غير حالات المجاعة القصوى، حيث يتطلب الأمر إنقاذ الأطفال
والنساء، وغيرهم من المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة؟!
وما معنى التعبير بكلمة «قومي»
بياء المتكلم؟
فهل نسبتهم إلى نفسه «صلى الله عليه وآله» تهدف إلى
تشريفهم بذلك وتكريمهم؟!
أم أنه «صلى الله عليه وآله» واقع تحت المشاعر العنصرية
بصورة عفوية؟!
أم أنه قال ذلك في حالة غضب، لم يتمكن من السيطرة
عليه.. وكلا هذين الخيارين لا يمكن صدورهما منه «صلى الله عليه وآله».
ثم لماذا ينسب الميرة إلى قومه، فيقول:
«ميرتهم»؟!
وهل لهم حق مفروض بهذه الميرة، لا يجوز لأحد منعه عنهم،
ومنعهم عنه؟!
وفي ربيع الأول من سنة ست كانت سرية عكاشة بن محصن إلى
غمر مرزوق ـ ماء لبني أسد على ليلتين من فيد، في أربعين رجلاً([28]).
وقيل:
بل كان أميرهم ثابت بن أرقم، فأخبر به القوم فهربوا،
فنزلوا عليا بلادهم، وانتهى المسلمون إلى ديارهم فلم يجدوا أحداً.
فبعثوا شجاع بن وهب في جملة جماعة إلى بعض النواحي
طليعة يطلبون خبراً، ويجدون أثراً، فرجع شجاع بن وهب، فأخبرهم أنه وجد
أثر نعمٍ قريباً، فذهبوا إلى هناك، فأخذوا رجلاً من بني أسد كان
نائماً، فدلهم على نعمهم بالمرعى.
وفي نص آخر:
أطلعهم على نعم لبني عم له لم يعلموا بمسيرهم، فساقوا
مائة بعير، أو مائتين، وقدموا على رسول الله «صلى الله عليه وآله»([29]).
وفي ربيع الأول بعث محمد بن مسلمة في عشرة معه إلى بني
ثعلبة في ذي القَصَّة ـ بفتح القاف ـ موضع بينه وبين المدينة أربعة
وعشرون ميلاً ـ وقيل غير ذلك ـ فورد عليه ليلاً، فكمن له القوم، وهم
مائة رجل، وأمهلوهم حتى ناموا، فتراموا ساعة من الليل، ثم حملت الأعراب
عليهم بالرماح فقتلوهم، وجرح محمد بن مسلمة، وظنوه قد مات، وجردوهم من
ثيابهم([30]).
ومر رجل من المسلمين، فحمل ابن مسلمة حتى ورد به
المدينة.
ثم بلغ رسول الله «صلى الله عليه وآله» أنهم يريدون أن
يغيروا على سرح المدينة، الذي كان يرعى بعيداً عنها بسبعة أميال ببطن
هيفاء، فسار إليهم في ربيع الآخر من سنة ست أبو عبيدة بن الجراح في
أربعين رجلاً إلى مصارعهم، فأغاروا عليهم في عماية الصبح، فأعجزوهم
هرباً في الجبال، وأسروا رجلاً واحداً، فأسلم وتركه، وأخذوا نعماً من
نعمهم فاستاقوها، ورِثَّةً من متاعهم، وقدموا المدينة، فخمسه رسول الله
«صلى الله عليه وآله» وقسم ما بقي عليهم([31]).
وفي ربيع الآخر من سنة ست كانت سرية زيد بن حارثة إلى
بني سليم بالجموم أو الجموح: (وهي ناحية من بطن نخل على أربعة أميال من
المدينة)، فأصابوا امرأة من مزينة يقال لها: حليمة، فدلتهم على محلة من
محال بني سليم، فأصابوا نعماً، وشاء، وأسرى. فكان فيهم زوج حليمة
المزنية.
فلما قفل زيد بما أصاب وهب رسول الله «صلى الله عليه
وآله» للمزنية زوجها ونفسها([32]).
ويستوقفنا في السرايا الثلاث عدة أمور هي:
أولاً:
ما أشرنا إليه فيما سبق من أن سياق هذه السرايا من شأنه
أن يعطي انطباعاً غير صحيح بأن هذا النبي الكريم
«صلى الله عليه وآله»
ليس له همٌّ إلا الإغارة على الناس الآمنين، وسلب أموالهم، وقتل رجالهم
و.. وهؤلاء هم أصحابه يفعلون الأفاعيل بالناس، حتى إنهم ليضربون الرجل
الأسدي ليدلهم على النعم في مراعيها، وهي لأناس لم يعلموا بمسيرهم([33]).
ولكن الحقيقة مغايرة لهذا تماماً، فإن هم النبي
«صلى الله عليه وآله»
هو هداية الناس وإسعادهم، وليس قتلهم، وسلب أموالهم. وقد كان «صلى الله
عليه وآله» شديد التثبت في أمر الذين يدبرون ويسعون للعدوان على
المسلمين، كما يظهر من كثير من الموارد، مثل سرية ابن رواحة إلى أسير
بن رزام الآتية وغيرها.
ثانياً:
إنه إذا صحت الروايات عن حدوث هذه السرايا فعلاً، فلا
بد أن تكون قد هدفت إلى رد عدوان أناسٍ كانوا معلنين للحرب على أهل
الإيمان، أو إبطال كيدهم، وتفريق جموعهم، وإضعاف قدرتهم على تنفيذ ما
يخططون له.. وليس للمحارب أن يغفل أو أن يتغافل فإنما الحرب خدعة
تبتدر، وفرصة تنتهز.
وقد صرحت الروايات:
بأن الذين أغار عليهم أبو عبيدة كانوا بصدد الإغارة على
سرح المدينة لاستياقه..
ثالثاً:
إن الظاهر هو: أن سرية محمد بن مسلمة ـ لو صحت ـ فإنما
كانت لأجل الاستطلاع، وتقصي الأخبار عما يخطط له بنو ثعلبة، فوقعوا في
كمين أعدائهم، وجرى عليهم ما جرى.
رابعاً:
ذكر ابن عائذ: أن أمير السرية هو ثابت بن أقرم، وليس
عكاشة بن محصن..([34]).
وقد ذكروا:
أن جميع من انتظم في سرية ابن مسلمة قد قتل، ونجا ابن
مسلمة وحده جريحاً..
وقد ذكر الواقدي:
أن هؤلاء العشرة هم:
1 ـ
أبو نائلة.
2 ـ
والحارث بن أوس.
3 ـ
وأبو عبس بن جبر.
4 ـ
ونعمان بن عصر.
5 ـ
ومحيصة بن مسعود.
6 ـ
وحويصة بن مسعود.
7 ـ
وأبو بردة بن نيار.
8 و 9 ـ
ورجلان من مزينة.
10 ـ
ورجل من غطفان.
ونقول:
قد نص العلماء:
على أن
أكثر هؤلاء
قد عاش سنوات طويلة بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فلاحظ ما يلي:
1 ـ النعمان بن عصر:
قتله طليحة بن خويلد بعد استشهاد رسول الله «صلى الله عليه وآله» فيما
يعرف بحروب الردة، أو اليمامة([35]).
2 ـ أبو بردة بن نيار:
مات في خلافة معاوية، بعد أن شهد مع علي «عليه السلام» حروبه كلها
وقيل: إنه مات سنة إحدى، وقيل: اثنتين، وقيل: خمس وأربعين([36]).
3 ـ أبو عبيس (أو عبس) بن جابر (أو
جبر):
كان قد عمي في عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأعطاه «صلى الله
عليه وآله» عصاً، وقال: تنور بهذه، فكانت تضيء له ما بين كذا وكذا([37]).
ومات سنة أربع وثلاثين، وصلى عليه عثمان([38]).
4 ـ حويصة يقولون:
إنه شهد أحداً، والخندق، وسائر المشاهد([39])،
فمن حضر سائر المشاهد، فإنه يكون قد عاش إلى ما بعد وفاة رسول الله
«صلى الله عليه وآله»..
وهناك ثلاثة رجال
لا يعلم عنهم شيء.
وعلى هذه فقس ما سواها..
على أن ما ذكرناه آنفاً ليس هو كل شيء، فهناك شكوك
أخرى، لا بد من التصريح بها، والبحث عما يزيلها، إن كان هناك ما يمكن
أن يكون مفيداً في معرفة الحق والحقيقة فيها.
ونذكر مما يدخل في هذا المجال ما يلي:
بالنسبة إلى الذين قتلوا مع ابن مسلمة نقول:
1 ـ
إنهم إذا كانوا قد ناموا فهجم عليهم الأعداء حتى خالطوهم، فما معنى أن
يتراموا بالنبل، الذي يحتاج إلى مسافة، فإن المفروض في الذين خالطوهم
ألا يلجأوا إلى الرمي بالنبال، بل أن يضربوهم بسيوفهم، أو أن يشجروهم
برماحهم؟!
2 ـ
ما معنى أن ينام جميع رجال السرية، حتى لم يبق أحد منهم
يحرس ويراقب؟! مع أنهم كما صرحت الروايات قد أصبحوا في بلاد عدوهم،
وحيث أصبح الخطر داهماً؟!
3 ـ
قد صرحت الروايات: بأن محمد بن مسلمة وقع جريحاً
«فضربوا كعبه، فلم يتحرك، فظنوا موته، فجردوه من الثياب».
والسؤال هو:
لماذا اختاروا أن يضربوا كعب محمد بن مسلمة، ولم يغمدوا
سيوفهم في صدره أو نحره، أو بطنه، أو ما إلى ذلك،
ليتأكدوا من موته؟!
وكيف أبصروا حركته وعدمها في ظلمة ذلك الليل؟!
وكيف استطاع هو أن يتحمل هذا الألم، ولا يتحرك؟!
وحين قتل المشركون المسلمين، هل تمكن المسلمون من قتل
أحد من المشركين؟! أم أنهم سلموا جميعاً، فلا قتل ولا جراح فيهم؟!
ولماذا لم يحدثنا التاريخ عن شيء من ذلك؟!
إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة التي تحتاج إلى إجابات
مقنعة ومقبولة. وأين وأنَّى؟!.
وفي جمادى الأولى من سنة ست كانت سرية زيد بن حارثة إلى
العيص (موضع على أربعة ليال من المدينة)([40])،
ومعه سبعون راكباً، أو في سبعين ومائة راكب([41])،
لما بلغه «صلى الله عليه وآله»: أن عيراً لقريش قد أقبلت من الشام.
فتعرضوا لها، فأخذوها وما فيها، فأخذوا يومئذٍ فضة كثيرة لصفوان بن
أمية، وأسروا منهم أناساً، منهم أبو العاص بن الربيع زوج زينب ابنة
(والصحيح: ربيبة([42]))
رسول الله «صلى الله عليه وآله»([43]).
فنادت زينب في الناس، حين صلى النبي «صلى الله عليه
وآله» الفجر: إني قد أجرت أبا العاص.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
ما علمت بشيء من هذا. وقد أجرنا من أجرت. ورد عليه ما
أخذ([44]).
وقد ذكر ابن عقبة:
أن أسره كان على يد أبي بصير وأبي جندل بعد الحديبية.
وكانت هاجرت قبله، وتركته على شركه..
وردها النبي «صلى الله عليه وآله» عليه بالنكاح الأول.
قيل:
بعد سنتين، وقيل: بعد ست سنين، وقيل: قبل انقضاء العدة.
وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
جده:
ردها بنكاح جديد سنة سبع([45]).
ولنا هنا وقفات، هي التالية:
قد ذكرنا في أول الجزء السادس من
هذا الكتاب:
أنهم يدَّعون أنه قد كانت هناك سرية إلى ماء يقال له: القردة، وأن
أميرها زيد بن حارثة أيضاً، وقد أرسله «صلى الله عليه وآله» إلى قافلة
لقريش فيها صفوان بن أمية، وأبو سفيان، وكان أكثرها من الفضة، فأصاب
العير وما فيها، وأعجزه الرجال، ورجع بالغنيمة إلى رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، فخمَّسها، فبلغ الخمس عشرين ألفاً.
وقد لاحظنا:
أن ثمة تشابهاً عجيباً بين تلك السرية وبين هذه التي
نحن بصدد الحديث عنها، فإن هذه السرية أيضاً: أميرها زيد بن حارثة،
وكانت إلى ماء يقال له: القردة، وأخذ المسلمون منها فضة كثيرة، وكانت
الفضة أيضاً لصفوان بن أمية..
فهل تراهما سرية واحدة؟ اختلف الرواة في تاريخها، وفي
بعض خصوصياتها، كما يختلفون في غيرها، فظنهما البعض سريتين. فدوَّنهما
مرتين؟!
وفي سياق آخر نقول:
إن قريشاً هي التي جنت على نفسها حين واجهت المسلمين
بالبغي، والعدوان، والاضطهاد، والاستيلاء على أملاكهم، وإخراجهم من
أوطانهم وديارهم، بغير جرم أتوه.
إلا أن يقولوا: ربنا الله، ويريدون أن يكونوا أحراراً فيما يفكرون،
وفيما يعتقدون..
فكان لا بد من أن تواجه عاقبة ذلك، حين يريد المظلومون
أن يسترجعوا بعض ما أخذ منهم، ولو كان نزراً يسيراً.. وسوف يكون
استرداد هذا القليل عظيم الأثر على روح أولئك الطغاة الجبارين، الذين
يرون الحياة الدنيا كل شيء بالنسبة إليهم، ويرون في ارتفاع آهات
المظلومين والمعذبين فضلاً عن مطالباتهم، وسعيهم للتخلص من الظلم
والبغي، مساساً بكبريائهم، وانتقاصاً من جبروتهم، فإذا تمكن أولئك
المستضعفون من استرجاع شيء من حقوقهم، فسيكون في ذلك أعظم الخزي لأولئك
الطغاة، وأبلغ الخذلان، وتلك هي أعظم مصائبهم، وفيها أشد آلامهم.
وأما إذا بلغ الأمر حد إرباك هؤلاء الطغاة، وإشغالهم
بالحفاظ على لقمة عيشهم، وسلامة تجارتهم، فإن ذلك يكون غاية ذلهم،
وصغارهم وهوانهم..
وعن دعواهم:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» أثنى على صهره أبي العاص
بن الربيع، نقول:
إن ذلك لا يصح:
فقد روي عن أبي جعفر «عليه السلام»، أن رسول الله «صلى
الله عليه وآله» زوج أبا العاص بن الربيع مع كونه منافقاً([46]).
كما أننا لم نجد له موقفاً جهادياً مميزاً، ولا عرف عنه
شيء من الزهد والتقوى، والبذل في سبيل الله، ونحو ذلك.
النبي
’
لا يتصرف بما ليس له:
وقالوا:
«إن زينب دخلت على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فسألته أن يرد على
أبي العاص ما أخذ منه، فأجابها إلى ذلك»([47]).
ونقول:
إننا نشك في صحة ذلك:
لأن ما أخذه المسلمون إنما هو غنائم حرب وهي ملك لهم..
فإن كان قد وعدها النبي
«صلى الله عليه وآله»
بشيء، فلا بد أن يكون ذلك بأن يطلب من المسلمين التنازل له عن شيء من
حقهم، فإن رضوا أعاد إليه ما يرضون بإعادته..
ويدل على ذلك:
أنهم يذكرون: أنه «صلى الله عليه وآله» بعث للسرية،
فقال لهم: «إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم. وقد أصبتم له مالاً، فإن
تحسنوا وتردوا عليه الذي له، فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله
الذي أفاء عليكم، فأنتم أحق به»([48]).
وزعموا:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال لزينب عن أبي العاص:
«لا يخلص إليك، فإنك لا تحلين له»([49]).
والظاهر:
أن ذلك كان قبل أن يسلم أبو العاص..
ويقولون:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد رد زينب على زوجها بالنكاح الأول..
وهذا معناه:
أن ذلك قد حصل
قبل غزوة الحديبية، أي قبل تحريم نكاح المشرك للمؤمنة؛ لأن هذا
التحريم إنما كان في الحديبية([50])
كما يزعمون..
ولو كان ذلك قد حصل بعد الحديبية، فلا بد أن يكون زوجها
قد أسلم قبل أن تنقضي عدتها، أي أنه أسلم بعد إسلامها بيسير؛ لأن شرط
عودتها إليه بالنكاح الأول هو ذلك، أي أن يكون قبل انقضاء العدة.
ولو قيل:
إن قوله «صلى الله عليه وآله» لزينب: لا يخلص إليك يدل
على أن إرجاعها إليه كان بعد الحديبية،؛ لأن تحريم نكاح المشرك للمسلمة
قد نزل بعدها،
لأجيب:
بأن سرايا رسول الله «صلى الله عليه وآله» لم تتعرض
لقوافل قريش بعد الحديبية. فأبو العاص لم يؤسر بعدها.
إلا أن يقال:
إن السرية التي اعترضت عير قريش، وأسرت أبا العاص، تعود
لأبي جندل، وأبي بصير وأصحابهما الذين كانوا يعترضون عير قريش..
وقد قيل:
إنهم أخذوا أبا العاص، فهرب منهم، ودخل إلى المدينة،
واستجار بزينب.
وقيل:
بل هم الذين أطلقوه، لمكانه من رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، فخطب النبي «صلى الله عليه وآله» الناس، وأعلمهم أن زينب
قد أجارته، فلما علم أبو جندل وأصحابه بذلك أطلقوا الأسرى، وردوا عليهم
كل شيء. وكان ذلك في سنة ثمان([51]).
وقد يقال:
كيف يمكن ادِّعاء:
أن أبا العاص قد أسلم بعد زينب بيسير، أي قبل انقضاء عدتها، وهم
يقولون: إنها أسلمت قبله بست سنين، وقيل: بسنة واحدة، وقيل: بعد سنتين
من إسلامه؟!([52]).
ويمكن أن يجاب:
بأن الثابت هو:
أنها قد أتت إلى المدينة قبل زوجها بهذه المدة الطويلة، ولكن ذلك لا
يدل على: أنها قد أسلمت قبله، فلعل انتقالها إلى المدينة كان للتخلص من
مضايقات قريش لها، لمجرد صلتها برسول الله «صلى الله عليه وآله»، وإن
لم تكن قد دخلت في دينه. كما هو ظاهر لا يخفى.
7 ـ
سرية زيد إلى الطرف:
وفي جمادى الآخرة سنة ست كانت سرية زيد بن حارثة إلى
الطرف، وهو ماء على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة، فخرج إلى بني ثعلبة
في خمسة عشر رجلاً، فأصاب نعماً وشاء، وهربت الأعراب.
وصبح زيد بالنعم المدينة، وهي عشرون بعيراً، ولم يلق
كيداً، وغاب أربع ليال، وكان شعارهم الذي يتعارفون به في ظلمة الليل:
أمت أمت([53]).
وقد قلنا:
اكثر من مرة بأننا نشك في وقوع هذه السرايا، التي تظهر
أن همَّة النبي
«صلى
الله عليه وآله»
كانت منصرفة إلى الغنائم والسبايا، ولو بقيمة قتل الناس وإبادة
خضرائهم، أو إذلالهم.
([1])
راجع: تاريخ الخميس ج2 ص2 و 3 والطبقات الكبرى ج2 ص78 وعيون
الأثر ج2 ص63.
([2])
السيرة الحلبية ج3 ص174.
([3])
أسد الغابة ج4 ص330 و 331 والإمامة والسياسة ج1 ص53 وشرح نهج
البلاغة للمعتزلي ج4 ص9.
([4])
قاموس الرجال ج8 ص388 و 389 والبحار ج301 ص291.
([5])
شرح نهج البلاغة للمعتزلي
ج2 ص51 وج6 ص48 وقاموس الرجال ج8 ص388 وكتاب سليم بن قيس ص411
والسقيفة وفدك للجوهري ص48 و 73 والبحار ج28 ص315 والغدير ج5
ص356 والسنن الكبرى ج8 ص152 وكنز العمال ج5 ص597 وتاريخ مدينة
دمشق ج30 ص287 والبداية والنهاية ج5 ص270 وج6 ص333 والسيرة
النبوية لابن كثير ج4 ص496.
([6])
الإمامة والسياسة ج1 ص54 وقاموس الرجال ج8 ص388.
([7])
أسد الغابة ج4 ص330، وراجع: قاموس الرجال ج8 ص388 والإصابة ج3
ص384 والزهد والرقائق ص179 والتراتيب الإدارية ج1 ص267.
([8])
البحار ج30 ص494 والإستغاثة ج1 ص8 ومجالس المؤمنين ج1 ص335
وقاموس الرجال ج8 ص388 ومعجم رجال الحديث ج9 ص76 وإكمال الكمال
ج3 ص141 وتاريخ مدينة دمشق ج20 ص243 وتهذيب التهذيب ج3 ص412.
([9])
راجع ترجمته في: الإصابة، والإستيعاب، وأسد الغابة وغير ذلك
وراجع: فيض القدير ج1 ص388 وسير أعلام النبلاء ج2 ص369
والبداية والنهاية ج5 ص376 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص695.
([10])
تاريخ الخميس ج2 ص3 والسيرة الحلبية ج3 ص174 و 175 وقاموس
الرجال (ط مؤسسة النشر الإسلامي) ج2 ص494 و 495 والطرائف لابن طاووس ص505 عن
الحميدي، وعن مسلم في صحيحه، ومصباح الشريعة ص27 و 28 والبحار
ج36 ص337 وج63 ص325 و 337 وج81 ص204 عن الخصال ص351 وعن
المحاسن ص447 وفيه: ستكون بعدي سنة، يأكل (في بعض الروايات:
يشرب) المؤمن في معاً واحد، ويأكل الكافر في سبعة أمعاء. =
= وراجع: مستدرك سفينة البحار ج9 ص408 والصراط المستقيم ج3 ص47
وغوالي اللآلي ج1 ص144 ومجمع البيان ج9 ص166 وتفسير غريب
القرآن ص70 والكافي ج6 ص268 والمجازات النبوية ص376 والوسائل
(الإسلامية) ج16 ص406 ومستدرك الوسائل ج16 ص211 ومصباح الشريعة
ص78 والطرائف ص505 وكتاب الأربعين للشيرازي ص632 والبحار ج60
ص325 وج78 ص204 وميزان الحكمة ج1 ص89 و 208 ومسند أحمد ج2 ص21
و 43 و 318 و 375 و 415 و 145 و 275 وج3 ص333 و 357 وج4 ص336
وج6 ص397 وسنن الدارمي ج2 ص99 وصحيح البخاري ج6 ص200 و 201
وصحيح مسلم ج6 ص132 وسنن ابن ماجة ج2 ص1084 والجامع الصحيح
للترمذي ج3 ص173 وج5 ص415 وشرح مسلم للنووي ج14 ص23 ومجمع
الزوائد ج5 ص31 وفتح الباري ج8 ص69 وج9 ص442 والديباج على صحيح
مسلم ج5 ص108 وتحفة الأحوذي ج5 ص440 وصحيفة همام بن منبّة ص40
ومسند الطيالسي ص251 والمصنف للصنعاني ج10 ص419 ومسند الحميدي
ج2 ص295 والمصنف لابن أبي شيبة ج5 ص569 ومسند ابن راهويه ج1
ص247 وإكرام الضيف للحربي ص40 والآحاد والمثاني ج2 ص244 وج5
ص57 وسنن النسائي ج4 ص178 والمغاريد عن رسول الله ص95 ومسند
أبي يعلي ج2 ص218 وج3 ص159 وج4 ص113 وصحيح ابن حبان ج1 ص378
وج12 ص39 والمعجم الأوسط ج1 ص276 وج2 ص168 والمعجم الكبير ج2
ص274 وج7 ص230 وج23 ص433 ومسند الشاميين ج2 ص398 وج4 ص295
ومسند الشهاب ج1 ص114 والفائق ج3 ص248 والجامع الصغير ج2 ص660
والعهود المحمدية ص776 وكنز العمال ج1 ص141 وشرح مسند أبي
حنيفة ص197 وفيض القدير ج6 ص326 وكشف الخفاء =
= ج2 ص295 وضعيف سنن
الترمذي ص571 ومجمع البيان ج9 ص166 وغريب القرآن ص70 ونور
الثقلين ج2 ص20 وتفسير القرطبي ج7 ص192 وتفسير القرآن العظيم
لابن كثير ج4 ص189 والتاريخ الكبير للبخاري ج8 ص119 وعلل
الترمذي ص415 والثقات ج3 ص61 والكامل ج1 ص379 وج2 ص63 وتاريخ
بغداد ج2 ص186 وتاريخ مدينة دمشق ج56 ص18 وأسد الغابة ج1 ص309
وميزان الإعتدال ج4 ص214 وسير أعلام النبلاء ج16 ص238 وتاريخ
المدينة ج2 ص437 وذكر أخبار إصبهان ج1 ص112 وج2 ص153 والبداية
والنهاية ج5 ص241 وج6 ص131 وعن السيرة النبوية لابن هشام ج4
ص1051 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص439 وسبل الهدى والرشاد
ج5 ص454 وج6 ص72 و 75 وج9 ص466 وج12 ص103.
([11])
السيرة الحلبية ج3 ص174
وقاموس الرجال (ط
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين)
ج2 ص494 ومستدرك الوسائل ج2 ص514 وغوالي اللآلي ج1 ص227
ومكاتيب الرسول ج2 ص349 ومسند أحمد ج2 ص452 وعن صحيح البخاري
ج1 ص119 و 120 وج3 ص91 وج5 ص117 وصحيح مسلم ج5 ص158 وسنن أبي
داود ج1 ص605 وسنن النسائي ج2 ص46 وج1 ص262 والسنن الكبرى
للبيهقي ج1 ص171 وج2 ص244 وج6 ص319 وج9 ص65 و 88 وشرح مسـلم
للنـووي ج12 ص87 وصحيح ابن خزيمـة ج1 ص125 وصحيح ابن حبان ج4
ص42 ونصب الراية ج4 ص243 و 244 وإرواء الغليل= = ج5 ص42
والثقات ج1 ص281 وتاريخ مدينة دمشق ج21 ص279 وتاريخ المدينة ج2
ص434 والبداية والنهاية ج5 ص59 وعيون الأثر ج2 ص63 والسيرة
النبوية لابن كثير ج4 ص92 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص71.
([12])
راجع: السيرة النبوية لابن هشام ج4 ص254 وأسد الغابة ج2 ص344.
([13])
راجع: السيرة النبوية لابن هشام ج4 ص254 و 255 وأسد الغابة ج3
ص344 وراجع: مكاتيب الرسول (ط دار صعب) ج1 ص113 عن تاريخ الأمم
والملوك ج2 ص288 وعن الكامل في التاريخ ج2 ص80 وعن الطبقات
لابن سعد ج1 ص258 و 259 وتاريخ أبي الفداء ج1 ص148 والتنبيه
والإشراف ص225.
([14])
مكاتيب الرسول للأحمدي (ط دار صعب) ج1 ص140 وأسد الغابة ج1
ص246 و 247.
([15])
راجع: الكافي ج8 ص499.
([16])
أسد الغابة ج1 ص247 وتاريخ المدينة لابن شيبة ج2 ص439 والسنن
الكبرى ج9 ص66 والسيرة الحلبية ج3 ص174 والكافي ج8 ص299.
([17])
السيرة الحلبية ج3 ص174 وأسد الغابة ج1 ص246 و 247 وراجع
المصادر المتقدمة في الهامش السابق.
([18])
السيرة الحلبية ج3 ص174.
([19])
السيرة الحلبية ج3 ص174 عن الإستيعاب (بهامش الإصابة) وتاريخ
المدينة لابن أبي شبة النميري ج2 ص439.
([20])
السيرة الحلبية ج3 ص174 والكافي ج8 ص299 والسنن الكبرى للبيهقي
ج9 ص66 وأسد الغابة ج1 ص247 وتاريخ المدينة لابن شبة ج2 ص439.
([21])
المعجم الكبير ج6 ص219 ومجمع الزوائد ج5 ص35 والعلل لأحمد بن
حنبل ص402 وحلية الأولياء ج1 ص207 والإمامة وأهل البيت (لمحمد
بيومي مهران) ج1 ص31.
([22])
البحار ج63 ص226 وتقريب التهذيب ج2 ص362 وأسد الغابة ج1 ص295
وإكمال الكمال ج2 ص126 وضعيف سنن الترمذي ص51 والمعجم الكبير
ج2 ص276 وعون المعبود ج4 ص64.
([23])
البحار ج63 ص227 عن فتح الباري، ومجمع الزوائد ج5 ص32 وعن فتح
الباري ج9 ص443 وتحفة الأحوذي ج5 ص440 وأسد الغابة ج5 ص268.
([24])
راجع: البحار ج63 ص325 ـ 327.
([25])
العلهز: هو الدم يخلط بأوبار الإبل، فيشوى على النار.
([26])
الآية 76 من سورة المؤمنون.
([27])
راجع: تاريخ الخميس ج2 ص3 عن البخاري، والإكتفاء، والسيرة
الحلبية ج3 ص145 وعن فتح الباري ج8 ص69 وعن السيرة النبوية
لابن هشام ج4 ص1054 وراجع: سبل الهدى والرشاد ج6 ص72.
([28])
البحار ج20 ص291 والطبقات الكبرى ج2 ص84 وتاريخ مدينة دمشق
ج11 ص110 والبداية والنهاية ج4 ص202 وموسوعة التاريخ الإسلامي
ج2 ص559.
([29])
تاريخ الخميس ج2 ص9 والسيرة الحلبية ج3 ص176 وسبل الهدى
والرشاد ج6 ص77 والطبقات الكبرى ج2 ص85 وموسوعة التاريخ
الإسلامي ج2 ص560 وعن عيون الأثر ج2 ص95.
([30])
المسترشد ص225 والطبقات الكبرى ج2 ص85 والثقات ج1 ص283
والتنبيه والإشراف ص219 وعن عيون الأثر ج2 ص96 والبحار ج20
ص291 وج30 ص136 وتـاريـخ مـدينـة دمشـق ج16 ص285 وج30 ص316 =
= وج65 ص125 وسير أعلام النبلاء ج4 ص518 ومعجم البلدان ج4 ص366
وشرح النهج للمعتزلي ج14 ص157 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص86
وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص286.
([31])
تاريخ الخميس ج2 ص9 والسيرة الحلبية ج3 ص176 وسبل الهدى
والرشاد ج6 ص79 وعن عيون الأثر ج2 ص97 والثقات ج1 ص283
والطبقات الكبرى ج2 ص86.
([32])
السيرة الحلبية ج3 ص176 وتاريخ الخميس ج2 ص9 والطبقات الكبرى
ج2 ص86 وعن تاريخ الأمم والملوك ج2 ص286 وعن عيون الأثر ج2 ص98
وتاريخ اليعقوبي ج2 ص71 والبحار ج20 ص291.
([33])
السيرة الحلبية ج3 ص176 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص77.
([34])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص77 ومجمع الزوائد ج6 ص210 والمعجم
الكبير ج2 ص77 وتاريخ مدينة دمشق ج11 ص110 وج6 ص77 وأسد الغابة
ج1 ص220 وعن الإصابة ج1 ص501 وعن عيون الأثر ج2 ص95.
([35])
الإصابة ج3 ص563 والإستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج3 ص543 عن
الطبري، وإكمال الكمال ج7 ص26 و 385 والأنساب للسمعاني ج4 ص202
وج5 ص569 والطبقات الكبرى ج3 ص470 وأسد الغابة ج5 ص27.
([36])
الإصابة ج4 ص19 والإستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج4 ص18
والطبقات الكبرى ج2 ص452 وأسد الغابة ج5 ص146 والجرح والتعديل
ج9 ص100 وتهذيب الكمال ج33 ص72 وسير أعلام النبلاء ج2 ص35
وتهذيب التهذيب ج12 ص18 وتقريب التهذيب ج2 ص360 وإسعاف المبطأ
برجال الموطأ ص113.
([38])
الإصابة ج4 ص30 والإستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج4 ص122
والطبقات الكبرى ج3 ص451 و 507 والثقات ج3 ص255 وأسد الغابة ج3
ص283 وج5 ص248 وتهذيب الكمال ج38 ص46 والمستدرك للحاكم ج3 ص350
و 351 والآحاد والمثاني ج4 ص31 وسير أعلام النبلاء ج1 ص189
وتهذيب التهذيب ج12 ص140 وتاريخ المدينة لابن شبة ج2 ص457
وتقريب التهذيب ج2 ص431.
([39])
الإصابة ج4 ص30 والإستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج1 ص394
وتهذيب الكمال ج27 ص313 وتهذيب التهذيب ج10 ص60 وسبل الهدى
والرشاد ج1 هامش ص123.
([40])
الإمتاع للمقريزي ص265 والطبقات الكبرى ج2 ص87 وعيون الأثر ج2
ص99 وتاريخ مدينة دمشق ج67 ص15 والبحار ج20 هامش ص292 عن
الإمتاع، وسبل الهدى والرشاد ج6 ص30 والبداية والنهاية ج4 ص203
وعن عيون الأثر ج2 ص99.
([41])
السيرة الحلبية ج3 ص177 وتاريخ مدينة دمشق ج55 ص296 وج67 ص15
والطبقات الكبرى ج2 ص85 و 87 وج8 ص33 وسبل الهدى والرشاد ج6
ص83 وج11 ص31 والبحار ج20 ص292 وعن عيون الأثر ج2 ص99 وسير
أعلام النبلاء ج2 ص249 وعن الإصابة ج8 ص152.
([42])
راجع: أسد الغابة ج5 ص469 وكتابنا «بنات النبي «صلى الله عليه
وآله» أم ربائبه»، وكتابنا «القول الصائب في إثبات الربائب».
([43])
الثقات ج1 ص284 والطبقات
الكبرى ج2 ص87 وتاريخ مدينة دمشق ج67 ص12 وراجع: أسد الغابة ج5
ص237 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص82 وذخائر العقبى ص158 والمنتخب
من ذيل المذيل ص7 وراجع: تحف العقول ص455.
([44])
تاريخ الخميس ج2 ص9 والسيرة الحلبية ج3 ص177 وسبل الهدى
والرشاد ج6 ص83 والمستدرك للحاكم ج4 ص45 والطبقات الكبرى ج2
ص87 وج8 ص33 وتاريخ مدينة دمشق ج67 ص16 وعن عيون الأثر ج2 ص99
وعن الإصابة ج8 ص152 والآحاد والمثاني ج1 ص398 وسير أعلام
النبلاء ج2 ص248.
([45])
تاريخ الخميس ج2 ص9 والسيرة الحلبية ج3 ص177 و 178 وسبل الهدى
والرشاد ج6 ص84 وجواهر العقود للأسيوطي ج2 ص27 ونصب الراية ج3
ص399 والفصول في الأصول للجصاص ج3 ص163 والعلل لأحمد بن حنبل
ص313 وسير أعلام النبلاء ج2 ص249 والطبقات الكبرى ج8 ص33 وحلية
الأبرار ج1 ص84 والبحار ج19 ص354 وراجع سنن ابن ماجة ج1 = =
ص647 والمستدرك للحاكم ج3 ص639 والمصنف للصنعاني ج7 ص171
وراجع: شرح معاني الأخبار ج3 ص256 والمعجم الكبير ج19 ص202
وسنن الدارقطني ج3 ص177 وأسد الغابة ج4 ص266 وج5 ص237 و 468
وتاريخ مدينة دمشق ج67 ص19 والبداية والنهاية ج6 ص390 والشفا
بتعريف حقوق المصطفى ج1 ص127 والجوهر النقي ج7 ص189 وإرواء
الغليل ج6 ص341.
([46])
راجع: البحار ج22 ص159 والسرائر ص471 والوسائل (ط دار
الإسلامية) ج14 ص435 ومستطرفات السرائر ص565.
([47])
السيرة الحلبية ج3 ص177 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص83 وج11 ص31
والطبقات الكبرى ج8 ص33 وتاريخ مدينة دمشق ج67 ص16 وموسوعة
التاريخ الإسلامي ج2 ص570.
([48])
السيرة الحلبية ج3 ص177 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص83 وذخائر
العقبى ص159 والمعجم الكبير ج22 ص430 وتاريخ مدينة دمشق ج67
ص12 وعن السيرة النبوية لابن هشام ج2 ص483 ومجمع الزوائد ج9
ص216 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص166 وشرح النهج للمعتزلي ج14
ص196.
([49])
السيرة الحلبية ج3 ص177 و 178 وعن تحف العقول ص455 والبحار ج19
ص353 وشجرة طوبى ج2 ص241 ومستدرك سفينة البحار ج4 ص345 وسنن
النسائي ج7 ص185 والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص185 وج9 ص95 ومجمع
الزوائد ج9 ص216 والمعجم الكبير ج22 ص430 وشرح النهج للمعتزلي
ج14 ص196 ونصب الراية ج3 ص401 وأسد الغابة ج5 ص237 وعن تاريخ
الأمم والملوك ج2 ص166 والمنتخب من ذيل المذيل ص7 والبداية
والنهاية ج3 ص401 وعن السيرة النبوية لابن هشام ج2 ص482
والسيرة النبوية لابن كثير ج2 ص520 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص83
و 85.
([50])
السيرة الحلبية ج3 ص177 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص85 وعن فتح
الباري ج9 ص349 وتاريخ مدينة دمشق ج67 ص7 وسير أعلام النبلاء
ج1 ص331 وعن الإصابة ج7 ص208.
([51])
السيرة الحلبية ج3 ص177 وراجع: سبل الهدى والرشاد ج6 ص83 و 85
وتاريخ مدينة دمشق ج67 ص15.
([52])
السيرة الحلبية ج3 ص178 وراجع: تفسير القرآن العظيم ج4 ص375
وسير أعلام النبلاء ج1 ص332 وج2 ص246 ومسند أحمد ج1 ص261
والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص187 وفتح الباري ج9 ص348 وتاريخ
مدينة دمشق ج67 ص20 والبداية والنهاية ج3 ص402 وسبل الهدى
والرشاد ج6 ص84.
([53])
راجع: تاريخ الخميس ج2 ص9 والسيرة الحلبية ج3 ص178 وسبل الهدى
والرشاد ج6 ص87 وعن عيون الأثر ج2 ص99 والطبقات الكبرى ج2 ص87
وراجع: تاريخ الأمم والملوك ج2 ص286 وتاريخ مدينة دمشق ج67
ص15.
|