الـلمســـــات الأخـــــيرة
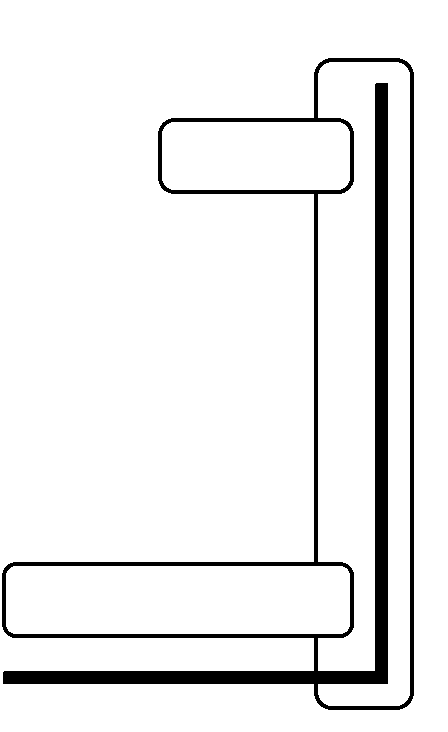
وقد روى مسلم عن سلمة بن الأكوع، والبيهقي عن ابن عباس،
وابن سعد، والبيهقي، والحاكم عن أبي عمرة الأنصاري، والبزار،
والطبراني، والبيهقي عن أبي خنيس الغفاري، ومحمد بن عمر عن شيوخه، يزيد
بعضهم على بعض:
أن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
لما انصرف من
«الحديبية»
نزل بمر
«الظهران»،
ثم نزل بـ
«عسفان»،
وأرملوا من الزاد، فشكا الناس إلى رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
أنهم قد بلغوا من الجوع الجهد، وفي الناس ظهر، فقالوا: ننحره يا رسول
الله، وندهن من شحومه، ونتخذ من جلوده أحذية، فأذن رسول الله
«صلى الله عليه وآله».
فأُخبر بذلك عمر بن الخطاب فجاء إلى رسول الله «صلى
الله عليه وآله» فقال: يا رسول الله، لا تفعل، فإن يكن في الناس بقية
ظهر يكن أمثل، كيف بنا إذا نحن لقينا العدو غداً جياعاً رجالاً؟! ولكن
إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعها، ثم تدعو فيها بالبركة،
فإن الله سيبلغنا بدعوتك.
ودعا رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
الناس ببقايا أزوادهم، وبسط نطعاً، فجعل الناس يجيئون بالحفنة من
الطعام وفوق ذلك، فكان أعلاهم من جاء بصاع تمر، فاجتمع زاد القوم على
النطع، قال سلمة: فتطاولت لأحرر، كم هو؟ فحررته كربضة عنز، ونحن أربع
عشرة مائة.
فقام رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
فدعا بما شاء الله أن يدعو، فأكلوا حتى شبعوا، ثم حشوا أوعيتهم، وبقي
مثله، فضحك رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
حتى بدت نواجذه، وقال:
«أشهد
أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، والله لا يلقى الله تعالى عبد
مؤمن بهما إلا حجب من النار».
ثم أذن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
في الرحيل، فلما ارتحلوا أمطروا ما شاؤوا وهم صائفون، فنزل رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
ونزلوا، فشربوا من ماء السماء. ثم قام رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
فخطبهم، فجاء ثلاثة نفر، فجلس اثنان مع النبي
«صلى الله عليه وآله»،
وذهب واحد معرضاً، فقال رسول الله:
«ألا
أخبركم عن الثلاثة؟
قالوا:
بلى يا رسول الله.
قال:
أما واحد فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فتاب
فتاب الله عليه، أما الثالث فأعرض. فأعرض الله عنه»([1]).
ونلاحظ على ما تقدم ما يلي:
ألف:
إن الناس لم يبادروا إلى نحر الإبل التي معهم، رغم
حاجتهم إلى الطعام، إلا بعد استئذان رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
بذلك. وهذا يعطينا درساً في ضرورة الانضباط والمراجعة للقائد في كل أمر
له ارتباط بالحالة العامة..
ب:
إن قول عمر: كيف بنا إذا نحن لقينا العدو غداً جياعاً
رجالاً؟! غير مفهوم لنا، فإن نحر بعض
الإبل لا يلزم منه أن يلقى العدو رجالاً، فإن الحرب لا
تكون على الإبل، وإنما تكون على الخيل أو بدونها..
ج:
إذا نحروا الإبل، واستفادوا من لحومها، فإنهم
لا يبقون جياعاً..
د:
إن
ما يحتاجونه في كل يوم للنحر
والأكل
لا يزيد على أربعة عشر جملاً، وهو مقدار يسير في
جملة ما
يفي
بحاجات
ألف
وأربع مائة
رجل..
فلو أنهم نحروا خلال ثلاثة أيام، أو
أربعة:
ستين من الإبل
ثم يكونون بقرب المدينة،
فذلك
معناه:
أن يصبح مائتا
رجل ـ على أقل تقدير ـ بلا ظهر يركبونه
في سفرهم.
إذا كان كل ثلاثة، أو أربعة يعتقبون بعيراً
ويبقى مع النبي «صلى الله عليه وآله» ألف ومائتا
مقاتل، لم يتأثر وضعهم بشيء مما يجري، وهؤلاء قادرون على مواجهة العدو،
ومعهم
الظهر الكافي، ولا يعانون من جوع، ولا من غيره..
هـ:
وكيف عرف عمر بن الخطاب هذا الأمر، وجهله النبي الأعظم
«صلى الله عليه وآله»؟!..
و:
وإذا كان النبي
«صلى الله عليه وآله»
عارفاً بهذا الرأي الصالح فلماذا
لم يبادر من عند نفسه إلى ذلك الحل
وصبر حتى
اقترحه
عليه
عمر بن الخطاب؟!
ألم يكن
«صلى الله عليه وآله»
هو الذي
بادر إلى إثارة
آبار الحديبية بالسهم الذي ألقاه فيها،
ثم
صنع
لهم
الكثير من المعجزات في سفر الحديبية
بالذات؟!..
أم يعقل:
أنه كان يرعاهم في سفر الذهاب، ثم تخلى عنهم في
حال
الإياب؟!
ولماذا يتخلى عنهم؟!
وروى البيهقي من طريق المسعودي، عن جامع بن شداد، عن
عبد الرحمن بن أبي علقمة، عن ابن مسعود قال: لما أقبل رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
من
«الحديبية»
جعلت ناقته تثقل، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّا
فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً﴾
فأدركنا رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
من السرور ما شاء، فأخبرنا أنها أنزلت عليه، فبينا نحن ذات ليلة إذ عرس
بنا، فقال رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
«من
يحرسنا»؟
فقلت:
أنا يا رسول الله.
فقال:
«إنك
تنام».
ثم قال:
«من
يحرسنا»؟
فقلت:
أنا.
فقال:
أنت.
فحرستهم، حتى إذا كان وجه الصبح أدركني قول رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
إنك تنام، فما استيقظت إلا بالشمس، فلما استيقظنا قال رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
«إن
الله لو شاء أن لا تناموا عنها لا تناموا، ولكنه أراد أن يكون ذلك لمن
بعدكم».
ثم قام فصنع كما كان يصنع، ثم قال:
«هكذا
لمن نام أو نسي من أمتي».
ثم ذهب القوم في طلب رواحلهم، فجاؤوا بهن غير راحلة
رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
قال: فقال لي رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
«اذهب
ههنا»،
ووجهني وجهاً، فذهبت حيث وجهني، فوجدت زمامها قد التوى بشجرة ما كانت
تحلها الأيدي.
قال البيهقي:
كذا قال المسعودي عن جامع بن شداد: إن ذلك كان حين
أقبلوا من الحديبية([2]).
ثم روى من طريق شعبة ـ وناهيك به ـ عن جامع بن شداد، عن
عبد الرحمن بن أبي علقمة، عن ابن مسعود قال: أقبلنا مع رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
من غزوة تبوك.
قال البيهقي:
يحتمل أن يكون مراد المسعودي بذكر الحديبية: تاريخ نزول
السورة حين أقبلوا من الحديبية فقط، ثم ذكر معه حديث النوم عن الصلاة،
وحديث الراحلة، وكانا في غزوة تبوك.
قلت:
لم ينفرد المسعودي بذلك، قال ابن أبي شيبة في المصنف:
حدثنا منذر، عن شعبة، عن جامع بن شداد به، ولا مانع من التعدد([3]).
ونقول:
إن من الواضح:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا ينام عن
صلاته، وليس في هذا النص ما يدل على ذلك.
بل
هو صريح:
بنوم أصحابه «صلى الله عليه وآله» عن صلاتهم، فعلَّمهم
كيف يصنعون إذا اتفق لهم ذلك..
وسيأتي إن شاء الله المزيد من الحديث عن هذا الأمر في
غزوة تبوك.
قالوا: روى البيهقي عن عروة، قال:
قفل رسول الله «صلى الله عليه وآله» راجعاً، فقال رجل
من أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»: ما هذا بفتح، لقد صددنا عن
البيت، وصُدَّ هَدْيُنَا. وَرَدَّ رسول الله «صلى الله عليه وآله»
رجلين من المؤمنين كانا خرجا إليه.
فبلغ ذلك رسول الله «صلى الله عليه
وآله», فقال:
«بئس
الكلام، بل هو أعظم الفتح، قد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن
بلادهم.
ويسألوكم القضية.
ويرغبون إليكم في الأمان.
ولقد رأوا منكم ما كرهوا.
وأظفركم الله تعالى عليهم، وردكم سالمين مأجورين، فهو
أعظم الفتح.
أنسيتم يوم أحد؟؟
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، وأنا أدعوكم في أخراكم؟!
أنسيتم يوم الأحزاب؟
{إِذْ
جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ
الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِالله
الظُّنُونَا}؟!
فقال المسلمون:
صدق الله ورسوله، فهو أعظم الفتوح، والله يا نبي الله
ما فكرنا فيما فكرت فيه، ولأنت أعلم بالله وبالأمور منا([4]).
وكان الناس قصر رأيهم عما كان.
وكان أبو بكر يقول:
ما كان فتح في الإسلام أعظم من صلح الحديبية، وكان الناس قصر رأيهم عما
كان بين رسول الله «صلى الله عليه وآله» وبين ربه.
والعباد يعجلون، والله تعالى لا يعجل لعجلة العبد حتى
يبلغ الأمور ما أراد، لقد رأيت سهيل بن عمرو في حجة الوداع قائماً عند
المنحر يقرب لرسول الله
«صلى الله عليه وآله»
بُدْنَه، ورسول الله
«صلى الله عليه وآله»
ينحرها بيده، ودعا الحلاق فحلق رأسه، فأنظر إلى سهيل
يلقط من شعره، وأراه يضعه على عينيه، وأذكر امتناعه أن يقر يوم
الحديبية بأن يكتب: ﴿بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
فحمدت الله تعالى الذي هداه للإسلام([5]).
وروى الإمام أحمد، والبخاري، والترمذي، والنسائي، وابن
حبان، وابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال: كنا مع رسول الله «صلى الله
عليه وآله» في سفر ـ يعني: «الحديبية» ـ فسألته عن شيء ثلاث مرات، فلم
يرد عليَّ.
فقلت في نفسي:
ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، نزرت رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
ثلاث مرات فلم يرد عليك، فحركت بعيري، ثم تقدمت أمام الناس، وخشيت أن
ينزل فيَّ القرآن، فما نشبت أن سمعت صارخاً يصرخ بي، فرجعت وأنا أظن
أنه نزل فيَّ شيء، فقال النبي
«صلى الله عليه وآله»:
«لقد
أنزلت عليَّ الليلة سورة هي أحب إليَّ من الدنيا وما فيها: ﴿إِنَّا
فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً، لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا
تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ..﴾([6]).
وروى ابن أبي شيبة، والإمام أحمد، وابن سعد، وأبو داود،
وابن جرير، وابن المنذر، والحاكم ـ وصححه ـ وابن مردويه، والبيهقي في
الدلائل، عن مجمع بن جارية الأنصاري قال: شهدنا
«الحديبية»
مع رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
فلما انصرفنا عنها إلى كراع الغميم إذا الناس يوجفون الأباعر، فقال
الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟
قالوا:
أوحي إلى رسول الله «صلى الله عليه
وآله» فخرجنا مع الناس نوجف، فإذا رسول الله «صلى الله عليه وآله» على
راحلته عند «كراع الغميم»، فاجتمع الناس إليه فقرأ عليهم: ﴿إِنَّا
فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً﴾ الفتح.
فقال رجل من أصحاب النبي «صلى الله
عليه وآله»:
أو هو فتح؟
فقال:
«أي
والذي نفسي بيده إنه فتح».
زاد ابن سعد:
فلما نزل بها جبريل قال: ليهنئك يا رسول الله، فلما
هناه جبريل هناه الناس([7]).
وروى عبد الرزاق والإمام أحمد، وابن أبي شيبة، وعبد بن
حميد، والشيخان والترمذي، وابن جرير، وابن المنذر، والحاكم، عن أنس
قال:
«لما
رجعنا من
«الحديبية»
قال رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
«أنزلت
علي ضحى آية هي أحب إلي من الدنيا جميعاً»
ثلاثاً.
قلنا ـ وفي لفظ قالوا ـ:
هنيئاً مريئاً لك يا رسول الله، قد بين الله لك ماذا
يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟
فنزلت، ـ وفي لفظ، فنزلت عليه ـ: ﴿لِيُدْخِلَ
المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ﴾،
حتى بلغ ﴿فَوْزاً
عَظِيماً﴾»([8]).
وروى ابن أبي شيبة، والإمام أحمد، والبخاري في تاريخه،
وأبو داود والنسائي، وابن جرير، وغيرهم عن ابن مسعود قال:
«أقبلنا
من الحديبية مع رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحي، وكان إذا أتاه اشتد عليه، فسري عنه، وبه
من السرور ما شاء الله، فأخبرنا أنه أنزل عليه: ﴿إِنَّا
فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً﴾»
([9]).
ونقول:
إن لنا مع ما تقدم وقفات نوجزها على
النحو التالي:
قد رأينا:
أن النبي
«صلى الله عليه وآله»،
حين أنكر البعض أن يكون ما جرى في الحديبية فتحاً، صار يذكِّرهم بما
كان منهم في أحد، حيث هاجمهم المشركون في عقر دارهم، فانهزموا فيها شر
هزيمة، ولم يذكِّرهم بما فعله علي
«عليه
السلام»
في أصحاب الألوية، حيث دحر قوى الشرك.
ثم ذكَّرهم بما كان في وقعة الخندق، حيث هاجمهم
المشركون أيضاً في دارهم ولم يستطيعوا أن يبرزوا لمقاومتهم، وكان منهم
ما كان، ولم يشر إلى قتل علي
«عليه
السلام»
لعمرو بن عبد ود في الخندق، وهزيمة الأحزاب بسبب ذلك..
وذلك من أجل أن يقارنوا بين ما جرى لهم هناك وما جرى
لهم في الحديبية، فإن المسلمين في الحديبية هم الذين حضروا إلى بلاد
المشركين، حتى بلغوا مشارف عاصمتهم، ولم يجرؤ المشركون على مواجهتهم،
بل رضوا بأن يدفعوهم عن بلادهم بالراح.
ثم هم يرضون بدخول المسلمين بلدهم بعد عام، ومعهم
سيوفهم في القرب.
وبعقد معاهدة معهم تضمنت شروطاً لم يكن المسلمون يحلمون
بأن يعطيها لهم أهل الشرك..
والذي يقرأ أحداث صلح الحديبية في الروايات المزعومة
يجد:
أن ثمة تشابهاً فيما بين حركات وكلمات، ومواقف كل من أبي بكر، ورسول
الله «صلى الله عليه وآله»..
ونحن نرى:
أن ثمة تعمداً لإظهار هذا الانسجام والتوافق، لكي ينال
أبو بكر فضيلة ترتفع به إلى مستوى الرسول
«صلى الله عليه وآله»
في الوعي للقضايا، وفي الحكمة، والتدبير، والرصانة والاتزان..
وينال عمر بن الخطاب في المقابل فضيلة الغيرة الفائقة،
والحماسة المنقطعة النظير، والشدة في الحفاظ على العزة والكرامة
الإسلامية..
ولينقلب من ثم الخطأ إلى صواب، والرذيلة إلى فضيلة!!
ويصبح الشك في النبوة والرسالة صريح الإيمان، وعصارة التقوى!! فتبارك
الله أحسن الخالقين!!
وقد أظهرت الروايات:
أن سهيل بن عمرو كان يتبرك بشعر رسول الله
«صلى الله عليه وآله».
وقد قلنا مرات كثيرة:
إن التبرك من بديهيات هذا الدين، وإن النصوص المثبتة له
قد تصل إلى المئات. فراجع كتاب التبرك للعلامة الأحمدي «رحمه الله».
([1])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص58 عن مسلم, والبيهقي, وابن سعد,
والحاكم, والبزار, والطبراني, والواقدي, وعن صحيح البخاري ج1
ص24 وعن صحيح مسلم ج7 ص9 وسنن الترمذي ج4 ص171 والسنن الكبرى
للبيهقي ج3 ص232 ومجمع الزوائد ج8 ص304 والسنن الكبرى للنسائي
ج3 ص453 وصحيح ابن حبان ج1 ص287 وكتاب الدعاء ص534 والمعجم
الأوسط ج4 ص29 وعن المعجم الكبير ج3 ص249 ورياض الصالحين ص571
وكنز العمال ج10 ص239 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص348 والبداية
والنهاية ج6 ص125.
([2])
دلائل النبوة للبيهقي ج4 ص155.
([3])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص59 و 60.
([4])
راجع المصادر التالية: سبل الهدى والرشاد ج5 ص58 و 59 وفي
هامشه عن: شرح المواهب اللدنية ج2 ص211 والدر المنثور ج6 ص68
والسيرة الحلبية ج3 ص24 والسنن الكبرى ج6 ص325 ومكاتيب الرسول
ج3 ص96 عن إعلام الورى ص61 وعن الطبقات الكبرى لابن سعد ج2
ص105 وعن شرح الشفاء للقاري ج1 ص121 وعن السيرة النبوية لدحلان
ج2 ص وعن السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص469 وعن المصنف لابن
أبي شيبة ج4 ص429 و 458 و 501 و ج15 ص318 والنص والإجتهاد ص182
وعن عيون الأثر ج2 ص125.
([5])
سبل الهدى والرشاد ج 5 ص63 و 64.
([6])
الآيتان 1 و 2 من سورة الفتح.
([7])
أخرجه أحمد في المسند ج3 ص420 وأخرجه أبو داود في الجهاد باب:
(فيمن أسهم له سهماً) وذكره الحافظ بن كثير في التفسير ج4 ص197
والبيهقي في الدلائل ج4 ص155
وراجع: صحيح مسلم ج5 ص176 والمعجم الكبير ج19 ص445 وموسوعة
التاريخ الإسلامي ج2 ص635 والبحار ج21 ص8 وعن سنن أبي داود ج1
ص622 والمستدرك للحاكم ج2 ص131 و 459 والسنن الكبرى للبيهقي ج6
ص325 وعن فتح الباري ج7 ص340 وعن المصنف لابن أبي شيبة ج8 ص509
والمعجم الأوسط ج4 ص121 وسنن الدارقطني ج4 ص60 ونصب الراية ج4
ص278 وعن تفسير مجمع البيان ج9 ص184 ونور الثقلين ج5 ص48 وجامع
البيان ج26 ص93 والجامع لأحكام القرآن ج16 ص261 والدر المنثور
ج6 ص68 وفتح القدير ج5 ص46 والطبقات الكبرى ج2 ص105 وتهذيب
الكمال ج32 ص364.
([8])
أخرجه: ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص (436) (1760)
والبيهقي ج5 ص217 وأحمد ج4 ص152 والحاكم ج4 ص460 وذكره السيوطي
في الدر المنثور ج6 ص71 والخطيب في التاريخ ج3 ص319 والبيهقي
في الدلائل ج4 ص155 وراجع: مسند أبي يعلى ج6 ص20 وصحيح ابن
حبان ج2 ص94 والمعجم الأوسط ج7 ص100 وجامع البيان ج26 ص92
ومعاني القرآن ج6 ص492 وأسباب نزول الآيات ص256 وتفسير
الجلالين ص712 ولباب النقول ص177 وفتح القدير ج5 ص46 وسبل
الهدى والرشاد ج5 ص60.
([9])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص60 عن البخاري في التفسير ج8 ص582
(4833) والبيهقي في الدلائل ج4 ص155 والدر المنثور ج6 ص68 وفتح
القدير ج5 ص46.
|