وفادات قبل سنة تسع
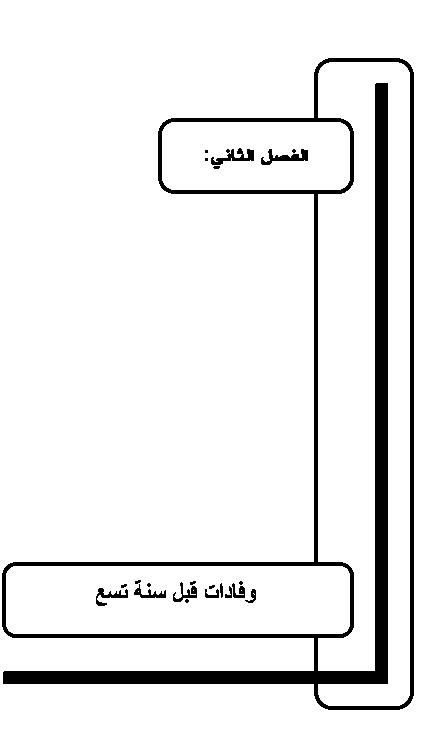
عن رجل من بني ثعلبة [عن أبيه] قال:
لما قدم رسول الله «صلى الله عليه وآله» من الجعرانة
سنة ثمان قدمنا عليه أربعة نفر، وافدين مقرين بالإسلام. فنزلنا دار
رملة بنت الحارث([1])،
فجاءنا بلال، فنظر إلينا فقال: أمعكم غيركم؟
قلنا:
لا.
فانصرف عنا، فلم يلبث إلا يسيراً حتى أتانا بجفنة من
ثريد بلبن وسمن، فأكلنا حتى نهلنا. ثم رحنا الظهر، فإذا رسول الله «صلى
الله عليه وآله» قد خرج من بيته ورأسه يقطر ماء، فرمى ببصره إلينا،
فأسرعنا إليه، وبلال يقيم الصلاة.
فسلمنا عليه وقلنا:
يا رسول الله، نحن رسل من خلفنا من قومنا، ونحن [وهم]
مقرون بالإسلام، وهم في مواشيهم وما يصلحها إلا هم، وقد قيل لنا يا
رسول الله: «لا إسلام لمن لا هجرة له»
فقال
رسول الله «صلى الله عليه وآله»:
«حيثما كنتم واتقيتم الله فلا يضركم».
وفرغ بلال من الأذان، وصلى رسول الله «صلى الله عليه
وآله» بنا الظهر، لم نصل وراء أحد قط أتم صلاة ولا أوجه منه، ثم انصرف
إلى بيته، فدخل، فلم يلبث أن خرج إلينا فقيل لنا: صلى في بيته ركعتين.
فدعا بنا، فقال:
«أين أهلكم»؟
فقلنا:
قريباً يا رسول الله، هم بهذه السرية.
فقال:
«كيف بلادكم»؟
فقلنا:
مخصبون.
فقال:
«الحمد لله».
فأقمنا أياماً، وتعلمنا القرآن والسنن، وضيافته «صلى
الله عليه وآله» تجري علينا، ثم جئنا نودعه منصرفين، فقال لبلال:
«أجزهم كما تجيز الوفود».
فجاء بنقر من فضة، فأعطى كل رجل منا
خمس أواق وقال:
ليس عندنا دراهم، فانصرفنا إلى بلادنا([2]).
ونقول:
إن هذه الرواية قد تضمنت قولهم:
إنه بلغهم أنه لا إسلام لمن لا هجرة له، وقد لاحظنا: أن
النبي «صلى الله عليه وآله» لم يقل لهم: إنه لا هجرة بعد الفتح، بل
قرر: أن عدم هجرتهم لا تضرهم إن اتقوا الله..
ومعنى هذا أنه «صلى الله عليه وآله»
قد قرر:
أن الهجرة باقية بعد الفتح كما كانت قبله.
وقد تحدثنا عن هذا الموضوع حين الكلام عن هجرة العباس،
وذلك حين سار النبي «صلى الله عليه وآله» لفتح مكة فراجع.
قالوا:
قدم مطرف بن الكاهن الباهلي على رسول الله «صلى الله
عليه وآله» بعد الفتح وافداً لقومه. فقال: يا رسول الله، أسلمنا
للإسلام، وشهدنا دين الله في سماواته، وأنه لا إله غيره، وصدقناك وآمنا
بكل ما قلت، فاكتب لنا كتابا.
فكتب له:
«من محمد رسول الله لمطرف بن الكاهن، ولمن سكن بيشة من
باهلة. إن من أحيا أرضاً مواتاً فيها مراح الأنعام فهي له، وعليه في كل
ثلاثين من البقر فارض، وفي كل أربعين من الغنم عتود، وفي كل خمسين من
الإبل مسنة، [وليس للمصدق أن يصدقها إلا في مراعيها، وهم آمنون بأمان
الله] ([3])
الحديث..
وفيه:
فانصرف مطرف وهو يقول:
حلـفـت برب
الراقصـات عشـية على كـل حرف من سديس وبازل
قال ابن سعد:
ثم قدم نهشل بن مالك الوائلي من باهلة على رسول الله
«صلى الله عليه وآله» وافداً لقومه فأسلم، وكتب له رسول الله «صلى الله
عليه وآله» ولمن أسلم من قومه كتاباً فيه شرائع الإسلام. وكتبه عثمان
بن عفان([4]).
ونقول:
بيشة:
قرية باليمن على خمس مراحل من مكة.
فظهر أن لبني باهلة وفدين:
أحدهما:
وفد باهلة، وهم من قيس عيلان.. ومنهم: نهشل بن مالك([5]).
والآخر:
وفد بني قراص أو قراض وهم بنو شيبان، وقد دخلوا في بني
باهلة، وكان على بني شيبان مطرف بن الكاهن([6]).
قالوا:
قدم عبد الله بن علس الثُّمالي، ومسلمة بن هاران
الحدَّاني على رسول الله «صلى الله عليه وآله» في رهط من قومهما بعد
فتح مكة، فأسلموا وبايعوا رسول الله «صلى الله عليه وآله» على قومهم.
وكتب لهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» كتاباً بما فرض عليهم من
الصدقة في أموالهم، كتبه ثابت بن قيس بن شماس، وشهد فيه سعد بن عبادة،
ومحمد بن مسلمة([7]).
ونقول:
1 ـ
بنو حدَّان بطن من أزد شنوءة يسكنون عُمان.
وهناك بنو حدَّان أيضاً بطن من همدان من القحطانية، وقد
وفد هؤلاء أيضاً على رسول الله «صلى الله عليه وآله» سنة تسع مرجعه من
تبوك، وعليهم مقطعات الحبرات، والعمائم المدنية، على الرواحل المهرية،
والأرحبية ومالك بن نمط يرتجز ويقول:
همـدان خــير
ســوقــة وإقبـال لـيـس لهــا في الـعـالمـين أمـثــال
2 ـ
ما ذكره النص المتقدم من أن الوفد أسلموا، وبايعوا رسول
الله «صلى الله عليه وآله» على قومهم يحتمل أحد أمور، هي:
ألف:
أن تكون قبيلتهم هي قد قررت الدخول في الإسلام،
فأرسلتهم إلى النبي «صلى الله عليه وآله» لإنجاز هذا الأمر بالصورة
التي رأوا أنها مفيدة وسديدة..
ب:
أن يكون لأعضاء هذا الوفد من النفوذ والتأثير على من
وراءهم، بحيث يطمئنون إلى أنهم يطيعونهم فيما يطلبونه منهم.
ج:
أن يكونوا قد أخطأوا التقدير، وتخيلوا أنهم قادرون على
أمر.. ثم جاءت الأحداث لتوافق ما تخيلوه، لأسباب لعلها لم تخطر لهم على
بال.
روى ابن سعد عن علي بن محمد القرشي، ورجل من بني عقيل،
قالا: وفد على رسول الله «صلى الله عليه وآله» نفر من بني قشير فيهم
ثور بن عزرة بن عبد الله بن سلمة بن قشير، فأسلم، فأقطعه رسول الله
«صلى الله عليه وآله» قطيعة وكتب له كتاباً.
ومنهم حيدة بن معاوية بن قشير، وذلك قبل حجة الوداع
وبعد حنين.
ومنهم قرة بن هبيرة بن سلمة الخير بن قشير، فأسلم،
فأعطاه رسول الله «صلى الله عليه وآله» وكساه برداً، وأمره أن يتصدق
على قومه، أي يلي الصدقة، فقال قرة حين رجع:
حبـاهـا رسـول الله إذ نـزلـت بـه وأمـكـنـهـا من نائـل
غـير منـفـد
فأضحت بروض الخضر وهي حثيثة وقـد أنـجـحت حاجاتها من
محمد
عليـهـا فـتى لا يـردف الذم رحله تــروك لأمــر
العـاجــز المـتردد([8])
قالوا:
وقدم على رسول الله «صلى الله عليه وآله» رجل من بني
سُليم، يقال له: قيس بن نسيبة، فسمع كلامه وسأله عن أشياء، فأجابه،
ووعى ذلك كله، ودعاه رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى الإسلام،
فأسلم ورجع إلى قومه بني سليم، فقال: قد سمعت برجمة الروم، وهينمة
فارس، وأشعار العرب، وكهانة الكاهن، وكلام مقاول حمير، فما يشبه كلام
محمد شيئاً من كلامهم، فأطيعوني وخذوا نصيبكم منه.
فلما كان عام الفتح خرجت بنو سليم إلى رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، فلقوه بقديد وهم سبعمائة.
ويقال:
كانوا ألفاً وفيهم العباس بن مرداس، وأنس بن عباس (عياض)
بن رعل، وراشد بن عبد ربه، فأسلموا وقالوا: اجعلنا في مقدمتك، واجعل
لواءنا أحمر، وشعارنا مقدماً.
ففعل ذلك بهم، فشهدوا معه الفتح،
والطائف، وحنيناً، وأعطى رسول الله «صلى الله عليه وآله» راشد بن عبد
ربه رهاطاً، وفيها عين يقال لها: عين الرسول([9]).
وكان راشد يَسْدُن صنماً لبني سُليم، فرأى يوماً ثعلبين
يبولان عليه، فقال:
أرب يـبـول الـثـعـلـبـان برأسه
لقـد ذل من بالـت عليه الثعالب([10])
ثم شد عليه فكسره.
ثم أتى النبي «صلى الله عليه وآله»
فقال له:
«ما اسمك»؟
قال:
غاوي بن عبد العزى.
قال:
«أنت راشد بن عبد ربه».
فأسلم وحسن إسلامه، وشهد الفتح مع النبي «صلى الله عليه
وآله».
وقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«خير قرى عربية خيبر، وخير بني سُليم راشد»([11]).
وعقد له على قومه.
وروى ابن سعد عن رجل من بني سُليم
من بني الشريد قالوا:
وفد رجل منا يقال له: قدد بن عمار على النبي «صلى الله
عليه وآله» بالمدينة، فأسلم وعاهده على أن يأتيه بألف من قومه على
الخيل.
ثم أتى قومه فأخبرهم الخبر، فخرج معه تسعمائة، وخلَّف
في الحي مائة، فأقبل بهم يريد النبي «صلى الله عليه وآله»، فنزل به
الموت، فأوصى إلى ثلاثة رهط من قومه: إلى عباس بن مرداس وأمَّره على
ثلاثمائة، وإلى جبار بن الحكم، وهو الفرار الشريدي وأمَّره على
ثلاثمائة، وإلى الأخنس بن يزيد وأمَّره على ثلاثمائة، وقال: ائتوا هذا
الرجل حتى تقضوا العهد الذي في عنقي، ثم مات.
فمضوا حتى قدموا على النبي «صلى
الله عليه وآله»، فقال:
«أين الرجل الحسن الوجه، الطويل اللسان، الصادق
الإيمان»؟
قالوا:
يا رسول الله، دعاه الله فأجابه، وأخبروه خبره.
فقال «صلى الله عليه وآله»:
«أين تكملة الألف الذي عاهدني عليهم»؟
قالوا:
قد خلَّف مائة بالحي مخافة حرب كانت بيننا وبين كنانة.
قال:
«ابعثوا إليها، فإنه لا يأتيكم في عامكم هذا شيء
تكرهونه».
فبعثوا إليها، فأتته بالهدة، وهي مائة، عليها المقنع بن
مالك بن أمية، فلما سمعوا وئيد الخيل قالوا: يا رسول الله، أتينا.
قال:
«لا، بل لكم لا عليكم، هذه سُليم بن منصور قد جاءت».
فشهدوا مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» الفتح
وحنيناً([12]).
ونقول:
قد تضمنت النصوص المتقدمة أموراً يمكن أن تكون موضع
نقاش من قبل الباحثين، ولكننا نؤثر الإضراب عنها، لأننا لا نجد جدوى
كبيرة من صرف الوقت فيها.. وبعضها تقدمت الإشارة منا إليه، ومنه موضوع
تغيير الأسماء..
ولذلك فإننا سوف نقتصر منها على ما يلي:
ولسنا بحاجة إلى التذكير بتكسير نفس سادن الصنم للصنم
الذي كان في خدمته حين رأى الثعلب يبول عليه، ولم لا يدفع عن نفسه ولا
يمنع، وذلك في صحوة وجدانية هيّأت لها الأجواء التي تعيشها المنطقة في
ظل تنامي المد الإيماني، المعتمد على قوة المنطق، والمنسجم مع ما يحكم
به العقل، وتقضي به الفطرة، وقد تعزَّز ذلك بالإنتصارات التي كان
يحققها أهل الإيمان على من لجأوا إلى منطق العدوان، والتحدي، بعد أن
ظهر عجزهم عن مقارعة الحجة بالحجة، فاختاروا أن يكونوا في موقع المحارب
والمعادي للحق، وللصدق، وللقيم الإنسانية والأخلاقية، ومسلمات العقل
الصحيح والسليم.
ولأجل ذلك استحق راشد الوسام النبوي الكريم، الذي أشار
إلى أن راشداً خير بني سليم، ولكنهم قد أضافوا إلى النص كلمة لا معنى
ولا مبرر لها، وهي قولهم: «خير قرى عربية خيبر» رغم أن خيبراً كانت بيد
اليهود، الذين لم يكونوا من العرب.
بل يكفي أن نقول في رد ذلك:
إن أم القرى هي مكة، ولا شك في انها عربية، وانها خير
قرية عربية، كما أن المدينة هي من القرى العربية، وهي خير من خيبر
أيضاً..
على أننا لا نجد أية مناسبة بين الثناء على راشد، وبين
الثناء على خيبر..
ويستوقفنا تعبير منسوب للنبي «صلى الله عليه وآله» أنه
قال في الثناء على قدد بن عمّار: «الحسن الوجه، الطويل اللسان» فإن
عبارة الطويل اللسان إنما تستعمل في مقام الذم، لإفادة أنه كثير
الكلام، أو أنه يتطاول بكلامه على الآخرين. فما معنى أن تُجعل من
مفردات المدح والثناء.؟!
تقدم:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد أعطى رهاطاً لراشد بن عبد
ربه.
ورُهاط ـ بضم الراء ـ:
موضع على ثلاث ليال من مكة.
وقيل:
وادي رهاط ببلاد هذيل.
وقال السمهودي:
إنه موضع بأرض ينبع اتخذت به هذيل سواعاً([13]).
وهو الصنم الذي ورد اسمه في القرآن.
والسؤال هنا هو:
ما هو المبرر لإعطاء شخص واحد هذا العطاء الكبير،
وتخصيصه بهذه المساحات الشاسعة، مع أنه كان من الممكن توزيع هذه
المساحات على مجموعة من الأفراد الذين يعانون من الحاجة الملحة، وليكن
منهم أصحاب الصفة المعروفون بالفقر، وكان «صلى الله عليه وآله» ينفق
عليهم بحسب ما يتيسر له.
وإذا كانت هذه الأراضي قد أصبحت تحت اختيار السلطة،
فذلك لا يبرر التصرف فيها، لتكريس يسيء إلى سمعة الدين، ويسقط منطق
العدل والدين فيه. من خلال إعطاء تلك الأراضي لفئة صغيرة قد تكون في
غنى عنها، بل يجب أن يستفيد منها أكبر عدد من الناس، وخصوصاً الفقراء
منهم.
وقد حاول البعض أن يجيب:
بأن من الجائز: أن تكون بعض هذه المناطق الممنوحة لم
تكن منحاً جديداً، وإنما كان إعطاؤها لهم مجرد تأكيد لملكية سابقة،
وهذا الإقطاع معناه: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أقرها في يد
صاحبها، فقد كان النبي «صلى الله عليه وآله» يضمِّن كتب الأمان التي
يصدرها للأفراد والجماعات ما يملكون من أراضي. وقد يرد في بعض الحالات
اسم زعيم القبيلة أو الوفد وحده على رأس الوثيقة.
ولكن ليس معنى ذلك:
أن كل ما يرد في الوثيقة يخص ذلك الزعيم شخصياً، بل إن
سائر أفراد القبيلة تكون لهم عين الحقوق المعطاة في الوثيقة المعنية،
وما الزعيم، الذي ورد اسمه إلا الممثل لمصالحهم([14]).
غير أننا نقول:
إن هذه الإجابة غير دقيقة، ولا تناسب كثيراً من النصوص
الواردة في كتب الإقطاعات، وإذا كان أولئك الناس قد أسلموا طواعية، فإن
الشرع يحكم بأن من أسلم على أرض فهي له. فأي داع للتصريح بمالكيتهم
لأراضيهم؟!
على أن هذا لو صح لاقتضى أن تشمل الكتابة بذلك جميع
الناس، وأن لا تختص ببعض الناس دون بعض.
والإجابة الصحيحة على هذا السؤال تحتاج إلى الحديث في
جهات عدة، ولو بصورة موجزة وذلك كما يلي:
إن الإسلام لا يريد أن يرى الفقر يعشعش في داخل المجتمع
الإنساني، لأن الفقر ليس فضيلة، كما أن الغنى ليس عيباً، أو نقصاً، بل
الإسلام يريد أن يرى المجتمع طموحاً وفاعلاً، وغنياً وقوياً..
ومتكافلاً ومتعاوناً على البِر والتقوى لا على الإثم والعدوان.
فإن كان ثمة من فقير، فلابد أن يكون سبب فقره ظروفاً
قاهرة، أو إتكالية وكسلاً مرفوضاً وممقوتاً، أو سوء تصرف، أو غير ذلك.
ولذلك جاءت تشريعات الإسلام حاسمة في معالجة مسألة
الفقر، باقتلاعه من جذوره، وقد روي عن أمير المؤمنين «عليه السلام»:
الفقر الموت الأكبر([15]).
وعن الإمام الصادق «عليه السلام»:
كاد الفقر أن يكون كفراً، وكاد الحسد أن يغلب القدر([16]).
هذا..
وقد قال تعالى على لسان يوسف «عليه السلام» مخاطباً
أباه: {..وَقَدْ
أَحْسَنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاء بِكُم مِّنَ
الْبَدْوِ..}([17]).
ما يعني أن الخروج من حياة البدو كان نعمة عظيمة توازي
خروجه من السجن.
وقال تعالى أيضاً:
{يَحْسَبُونَ
الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا
لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ
أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلاً}([18]).
فهو تعالى يذم هؤلاء الناس على أن الأمر قد بلغ بهم
حداً فقدوا معه الموازين، واختلت فيه المعايير لديهم، بسبب حبهم للدنيا
وزخارفها، فكانوا يهربون من الجهاد الذي هو من أشرف الأعمال وأعظمها،
لما فيه من حماية لحياة المسلمين، وحفظٍ لعزتهم ودولتهم، والدفع عن
منجزاتهم الحضارية، ويفضلون عليه أحط الخيارات وأرخصها، وأتفهها. ألا
وهو أن يكونوا بادين في الأعراب، ولا يكونوا في ساحات الشرف والجهاد
والكرامة.
وبالرجوع إلى التاريخ نلاحظ:
أن الإنسان العربي كان آنئذٍ يعيش البداوة بأجلى
مظاهرها، وربما لم تكن له علاقة بالأرض، ولا يراوده حنين إليها إلا
بقدر ما تحمله له من ذكريات، مُرّة تارة، وحلوة أخرى، ولا شيء أكثر من
ذلك..
وكان همه مصروفاً إلى تحصيل لقمة عيشه بطرق سهلة، مثل
رعي الإبل والمواشي، وإلا فالسلب والنهب والغارة، ولو بقيمة إتلاف
النفوس، وإزهاق الأرواح..
فكان من نتائج ذلك:
أن قويت عصبية الإنسان العربي للعشيرة، واشتدت نفرته،
وخوفه من كل من عداها.. فكان أن حرم من تعاون بني جنسه معه على حل
مشكلات الحياة، ومن فرص إرساء أسس لحضارة ذات قيمة..
وبذلك يكون العرب قد حرموا أنفسهم أيضاً من علوم كثيرة
كان من الممكن أن تساعدهم على اقتحام مجالات حياتية مهمة ورائعة، فلم
يمارسوا شيئاً من الصنائع، ولا استخرجوا من كنوز الأرض ومعادنها
وخيراتها ما يفتح أمامهم أبواباً من المعرفة، تفيدهم في تنويع
الإستفادة منها. ولا مارسوا حِرَفَاً تفيدهم في تيسير سبل العيش لهم،
كما أنهم لم يجدوا أنفسهم ملزمين ولو بالإلمام بشيء من العلوم
الإنسانية، على كثرتها وتنوعها واختلافها.
وغني عن القول:
إنه إذا أريد بناء دولة قوية ومجتمع إنساني فاعل،
ومتماسك، وقادر على إنشاء الحضارات وتحمل المسؤوليات التاريخية فلا بد
من توفر العناصر الضرورية لذلك، ومنها يتوفر لديه الأمل والطموح،
والشعور بالأمن والسلام، ثم التفرغ للتأمل والتفكير، والتعرف على
المشكلات وقهر الموانع وتجاوز العقبات، والتخطيط، واستنباط وسائل
التغلب عليها بالتسلح بالعلم والمعرفة، ثم السعي للحصول على القدرات
اللازمة لذلك كله.
وبديهي:
أن يكون ذلك كله مرهوناً بالإستقرار المؤدي لإعمار
الأرض، من خلال الإرتباط بها، وبذل الجهد في استخراج خيراتها، ومعادنها
وكل ما فيها، ووضع ثمرات هذا الجهد في التداول، والإهتمام بتطوير
الحياة به ومن خلاله. ولا يكون ذلك كله ممكناً إلا بالتعاون والتعاضد،
والعمل على إنتاج رؤية سليمة تؤدي إلى تطويع وإخضاع قوانين الطبيعة
لإرادة الإنسان، لتكون في خدمته..
ولا مجال للنجاح في ذلك كله، إلا في ظل الأطروحة
الصحيحة، التي تحدد الأهداف القصوى، وتحفظ مسيرة الوصول إليها
وسلامتها. وتهيمن على المسار والمسير، وتمنح الثقة بالنجاح والفلاح، من
خلال تضافر الجهود، واستنفار العقول.
وقد كان لا بد من الخروج من حياة البداوة، والعمل على
بناء مجتمع مدني قوي وفاعل، وقد عمل الرسول الكريم «صلى الله عليه
وآله» على تحقيق هذا الغرض النبيل، من خلال إجراءات عديدة ومتنوعة،
فأوجب على الإنسان نفقات، وحمّله مسؤوليات مالية، ثم حثّه على العمل
واعتبره كالجهاد في سبيل الله، وحث على الهجرة من البدو، وعلى السعي في
سبيل بناء حياة كريمة، وأوجب على كل فردٍ فردٍ تحصيل كل علم يحتاج
الناس إليه.. وحث على تعلم الحرف والصناعات وشجع على التجارة والزراعة
وإثارة الأرض وعمارتها، ثم إنه من جهة أخرى ذم الكسل والتواكل، ومنع من
أكل المال بالباطل، ومن الظلم والحيف، واغتصاب الأموال، والتعدي على
أراضي الغير، ولو بمقدار شبر واحد، ومنعه من الربا والقمار، والإحتكار..
و.. و.. ثم كانت سياسة إقطاع الأراضي كما سنرى..
ومما يشير إلى اهتمام الإسلام بالحرف، وبإحياء الأرض،
وبالإعمار وغير ذلك ما روي من أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان
إذا نظر إلى الرجل فأعجبه قال: هل له حرفة؟! فإن قالوا: لا.
قال:
سقط من عيني([19])..
وفي مجال الزراعة روي:
أنه «صلى الله عليه وآله» أوصى علياً «عليه السلام» عند
وفاته بقوله: «يا علي، لا يظلم الفلاحون بحضرتك»([20]).
وقال «صلى الله عليه وآله»:
إن الله أهبط آدم إلى الأرض، وأمره أن يحرث بيده ليأكل
من كدّه([21]).
وقد حث أمير المؤمنين «عليه السلام» في وصيته للإما م
الحسن «عليه السلام» على أن لا يقلع شجرة حتى يغرس عوضاً عنها ودية،
حتى تشكل أرضها غراساً([22]).
أي لا تمتاز الأرض عن الشجر.
وعنه «عليه السلام»:
من وجد ماءً وتراباً ثم افتقر فأبعده الله([23]).
وقال «عليه السلام» في عهده للأشتر:
ليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب
الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة. ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب
البلاد، ولم يستقم أمره إلا قليلاً([24]).
وقال الواسطي:
سألت جعفر بن محمد «عليه السلام» عن الفلاحين، فقال: هم
الزارعون كنوز الله. وما في الأعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة. وما
بعث الله نبياً إلا زارعاً إلا إدريس «عليه السلام»، فإنه كان خياطاً([25]).
وقد علَّم الله تعالى نبيه داوود «عليه السلام» صناعة
الدروع، وألان له الحديد.. كما صرح به القرآن الكريم.
ومن المفردات المفيدة جداً في هذا
المجال هو:
إقطاع الأراضي، فإن إقطاع الأراضي لشخصٍ ما، معناه: أن
تصبح تلك الأرض تحت اختياره، ومنع الآخرين من مزاحمته أو الحد من
فاعليته فيها، فيستفيد من هذه الفرصة التي منحت له ليعمل على إحياء تلك
الأرض إما بالزراعة، أو بالإستفادة منها في أي مجال إنتاجي تجاري، أو
صناعي، أو تعليمي، أو تربوي، أو غيره.. واستخراج خيراتها، ومعادنها،
وتطويرها.. ورفد السوق بها، ووضعها في دائرة التداول، لينعش الحالة
الإقتصادية، من حيث إنه يضخ في عروق اقتصاد المجتمع دماً جديداً،
ويزيده قوة وصلابة، ويحفزه لمواصلة نموه، ويمكِّن من ثمّ من تهيئة
الظروف والقدرات للتحرك نحو مراحل ومستويات حياتية أعلى وأرقى، وأرحب
وأوسع، لها طبيعتها ووسائلها، وحاجاتها، ولا بد من مواجهة مسؤولياتها،
وحل مشاكلها.
إن من الطبيعي أن يستفيد ذلك الذي وضعت الأرض بتصرفه،
من طاقات الآخرين لإنجاز مهمة الإحياء، وإيصالها إلى أهدافها، لكي تؤتي
ثمارها في ظل نظام قائم على العدل، يضع الأمور في نصابها، ويعطي كل ذي
حق حقه..
وهذا يقتضي وضع ضوابط ومعايير ترتكز إلى منظومة من
المثل والقيم تحدد طبيعة العلاقة، وتحكم طريقة التعامل، وربما يحتاج
ذلك إلى رصد ميزات نفسية وأخلاقية معينة تفرضها صحة وسلامة هذا التعامل
الممتد عبر الأعصار والأزمان.
وبذلك يصبح إقطاع الأراضي الموات بهدف إحيائها، وإنعاش
الحالة الإقتصادية، وإيجاد فرص عمل لفئات من الناس، ثم دفع المجتمع
ليتعلق بأرضه، ويستخرج خيراتها، وليعيش حالة السلام والأمن ـ يصبح ـ
ضرورة لا بد منها، ولا غنى عنها لبناء المجتمع الإنساني وبناء الدولة،
ثم إرساء قواعد الحضارة القائمة على أساس صحيح ومتين من القيم
الإنسانية والإلهية، ليمكن الإنطلاق بالمجتمع الإنساني إلى آفاق السلام
والسلامة، لينعم بالعيش الرغيد والسعيد..
ثم إن هذه الإقطاعات التي حصلت في زمن رسول الله «صلى
الله عليه وآله» قد كانت في الأكثر لأناس يحتاجون إليها، وليسوا من
الأغنياء، إلا في موارد نادرة جداً، أريد بها تأليف بعض الناس، وكف
أذاهم، مع عدم الإضرار أو الإجحاف في حق أي كان. ويظهر هذا الأمر من
مراجعة قائمة الذين أقطعهم الرسول «صلى الله عليه وآله»، ممن وصلت
أسماؤهم إلينا..
ومما يشير إلى أن إقطاع هؤلاء كان من موجبات القوة، ولم
الشعث، وإنعاش الإقتصاد بصورة أو بأخرى، ومن دون حيف وإجحاف أننا لم
نجد أحداً شكى، أو تساءل عن أي أمر له علاقة بهذا الموضوع، أو أبدى أية
ملاحظة حول الأشخاص الذين أقطعهم «صلى الله عليه وآله». مع أن بعض
الأنصار اعترضوا على إعطاء غنائم حنين للمؤلفة قلوبهم، حتى أوضح لهم
النبي «صلى الله عليه وآله» ما أزال موجبات الإعتراض من نفوسهم..
هذا..
وقد يكون الفقير أو الغني أحياناً لا يريد أو غير قادر
على الإحياء، فيصبح إعطاؤه الأرض لكي يحييها بلا مبرر، ولا يقدم عليه
رسول الله «صلى الله عليه وآله»، لأن المهم هو: إحياء الأرض بيد من
يقدر على إحيائها، وفقاً لأحكام الشرع..
وليس المقصود:
مجرد تمليك الأراضي للناس، وينتهي الأمر عند هذا..
وقد ذم الإسلام الكسالى، والإتكاليين، الذين يريدون أن
يعيشوا كَلّاً على الناس، وأعلن عن شديد مقته لهم، ولم يرض لهم بمدّ يد
العون، وعليه فلا حق لهم لكي تصح المطالبة به، لأنهم هم الذين جنوا على
أنفسهم..
إن الأراضي التي كان «صلى الله عليه وآله» يُقطعها على
أقسام هي:
ألف:
أراضِ موات هي لله ولرسوله، وقد جعلها الله ورسوله لمن
أحياها وفقاً لقوله «صلى الله عليه وآله»: «من غرس شجراً، أو حفر
وادياً بدياً، لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضاً ميتة فهي له، قضاء من
الله ورسوله»([26]).
وثمة أحاديث أخرى أيضاً تشير إلى ذلك، فلتراجع في
مظانها([27]).
ب:
الأنفال: وهي الزيادات، وتكون في الأموال، مثل الديار
الخالية، والقرى البائدة، وتركة من لا وارث له، وتكون في الأرضين
أيضاً. وهي على ما ذكره الفقهاء، ودلت عليه الأحاديث، تشمل الأرض
المحياة التي تُملك من الكفار من غير قتال، سواء انجلى عنها أهلها، أو
سلموها للمسلمين طوعاً.
وتشمل الأرض الموات عرفاً، سواء أكانت معمورة، ثم انجلى
عنها أهلها، أو لم يجر عليها ملك، كالمغاور، وسيف البحار، ورؤوس
الجبال، وبطون الأودية([28])..
ج:
الفيء: هو ما يُرجع أو يُرد من أموال الكفار وأراضيهم
إلى مالكه الأصلي من دون إيجاف خيل ولا ركاب.
والفيء لله ولرسوله، وليس لأحد فيه حق. وللرسول أن
يملِّك منه ما شاء لمن شاء..
وهناك كلام في تداخل هذين القسمين الأخيرين، فإن ما
سلموه للمسلمين طوعاً هو الفيء، وقد تقدم: أنه قسم من الأنفال أيضاً.
ولسنا بصدد البحث والمناقشة في ذلك.
إن الإقطاعات التي كانت من رسول الله «صلى الله عليه
وآله» إنما كانت من هذه الأقسام المتقدمة، ولم يكن ليقطع أحداً من مال
حاضر النفع، ظاهر العين، لأن هذا لا مجال لإقطاعه، إلا على سبيل
التأليف على الإسلام، وهذا إنما كان بالنسبة لأفراد قليلين جداً أكثرهم
من أهل مكة، وكان الهدف إنهاء شغبهم على الدين وأهله، وإبعاد أذاهم،
ولم تكن الإقطاعات في أكثرها تدخل في هذا السياق..
وقد يسجل على هذه الإجابة إعتراضات:
الأول:
قد ورد: أن النبي «صلى الله عليه وآله» حين ورد المدينة
أقطع الناس الدور.
وهذا معناه:
أنه قد أقطع من مال ظاهر العين، حاضر النفع.
والجواب:
أنه إنما أقطعهم مساحات من الأرض، ليبنوا عليها دورهم([29])،
وذلك بعد أن وهبت الأنصار كل فضل كان في خططها([30]).
وقد ذكر ياقوت الحموي:
أنه «صلى الله عليه وآله» كان يقطع أصحابه هذه القطائع
فما كان في عفا الأرض فإنه أقطعهم إياه، وما كان في الخطط المسكونة
العامرة فإن الأنصار وهبوه له، فكان يقطع من ذلك([31]).
وقال الحلبي الشافعي:
«خط للمهاجرين في كل أرض ليست لأحد، وفيما وهبته
الأنصار من خططها»([32]).
الثاني:
قد يعترض على ذلك أيضاً بما ورد من أنه «صلى الله عليه
وآله» أقطع أرضاً ذات نخل وشجر([33]).
وهذا معناه:
أنه كان يقطع الناس من مال حاضر النفع ظاهر العين.
والجواب:
أولاً:
قال ياقوت: أقطع الزبير بن العوام بقيعاً واسعاً([34]).
والبقيع:
هو الموضع الذي فيه أروم الشجر،
يعني أصوله من ضروب شتى([35]).
وهذا يشير إلى أنها كانت أرضاً متروكة، حتى لم يبق من النخيل إلا أصوله.
ثانياً:
عن ابن سيرين قال: أقطع رسول الله رجلاً من الأنصار
يقال له: سليط، فانطلق إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إن هذه الأرض
التي أقطعتنيها شغلتني عنك، فاقبلها مني، فلا حاجة لي في شيء يشغلني
عنك.
فقبلها النبي «صلى الله عليه وآله»
منه، فقال الزبير:
يا رسول الله، اقطعنيها.
قال:
فأقطعها أياه([36])،
فهو قد اشتغل في إحيائها، واهتم بها حتى أشغلته عنه، ثم انصرف عنها،
واستقال منها، فأعطاها «صلى الله عليه وآله» لغيره.
ثالثاً:
إن ذلك يفسر لنا قولهم: إنه «صلى الله عليه وآله» قد
أعطى بني عقيل العقيق ما أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وسمعوا وأطاعوا([37]).
والعقيق:
موضع فيه قرى ونخل كثير([38]).
فإن من الجائز أن يكون المقصود
بالنخل هو:
أصولها، أو أنها مما تركه أهله، لم يكن لها من يهتم بها.
وربما يكون بنو عقيل هم الأقرب إليها، أو الأقدر على
إحيائها من غيرهم.
إنه لا شك في أن الأرض التي كان يقطعها النبي «صلى الله
عليه وآله» لم يكن فيها أي حق لأحد من المسلمين، وقد صرح بهذا الأمر في
الكتاب الذي كتبه لبلال بن الحارث بالأرض التي أقطعه إياها، حيث قال:
«ولم يعطه حقَّ مسلم»([39]).
وكذا في كتابه «صلى الله عليه وآله» لبني عقيل([40]).
وقدم وفد عبد قيس ـ وهي قبيلة، تسكن البحرين وما والاها
من أطراف العراق([41])
ـ إلى النبي «صلى الله عليه وآله» سنة تسع([42]).
ورووا([43]):
أنه بينما رسول الله «صلى الله عليه وآله» يحدث أصحابه إذ قال لهم:
«سيطلع عليكم من هاهنا ركب هم خير أهل المشرق».
فقام عمر، فتوجه نحوهم، فلقي ثلاثة
عشر راكباً، فقال:
«من القوم»؟
فقالوا:
من بني عبد القيس.
قال:
«فما أقدمكم، التجارة»؟
قالوا:
لا.
قال:
أما إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد ذكركم آنفاً فقال
خيراً.
ثم مشوا معه حتى أتوا النبي «صلى الله عليه وآله».
فقال عمر للقوم:
هذا صاحبكم الذي تريدون، فرمى القوم بأنفسهم عن ركائبهم، فمنهم من مشى،
ومنهم من هرول، ومنهم من سعى حتى أتوا النبي «صلى الله عليه وآله»،
فابتدره القوم، ولم يلبسوا إلا ثياب سفرهم، فأخذوا بيده فقبلوها، وتخلف
الأشجّ، وهو أصغر القوم في الركاب حتى أناخها، وجمع متاع القوم، وذلك
بعين رسول الله «صلى الله عليه وآله».
وفي حديث الزارع بن عامر العبدي عند
البيهقي:
فجعلنا نتبادر من رواحلنا، فنقبِّل يد رسول الله ورجله،
وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه.
وفي حديث عند الإمام أحمد:
فأخرج ثوبين أبيضين من ثيابه فلبسهما، ثم جاء يمشي حتى
أخذ بيد رسول الله «صلى الله عليه وآله» فقبَّلها، وكان رجلاً دميماً،
فلما نظر «صلى الله عليه وآله» إلى دمامته قال: يا رسول الله، إنه لا
يُسْتَقَى في مُسُوك الرجال، إنما يُحتاج من الرجل إلى أصغريه: لسانه
وقلبه.
فقال له رسول ل الله «صلى الله عليه
وآله»:
«إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة»([44]).
قال:
يا رسول الله، أنا أتخلق بهما، أم الله جبلني عليهما؟
قال:
«بل الله تعالى جبلك عليهما».
قال:
الحمد لله الذي جبلني على خَلَّتين يحبهما الله تعالى
ورسوله([45]).
قال:
«يا معشر عبد القيس ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت»؟
قالوا:
يا نبي الله، نحن بأرض وخمة، وكنا نتخذ من هذه الأنبذة
ما يقطع من بطونها، فلما نهيتنا عن الظروف، فذلك الذي ترى في وجوهنا([46]).
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«إن الظروف لا تحلّ ولا تحرم، ولكن كل مسكر حرام، وليس
أن تجلسوا فتشربوا، حتى إذا ثملت العروق تفاخرتم، فوثب الرجل على ابن
عمه بالسيف فتركه أعرج».
قال:
وهو يومئذ في القوم الأعرج الذي أصابه ذلك.
وأقبل القوم على تمرا ت لهم يأكلونها، فجعل رسول الله
«صلى الله عليه وآله» يسمي لهم هذا كذا وهذا كذا.
قالوا:
أجل يا رسول الله، ما نحن بأعلم بأسمائها منك. وقالوا
لرجل منهم: أطعمنا من بقية الذي بقي في نوطك، فقام وجاءه بالبرني.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«هذا البرني أمسى من خير ثمراتكم»([47]).
وروى ابن سعد([48])
عن عروة بن الزبير قال:
وحدثني عبد الحميد بن جعفر عن أبيه، قالا: كتب رسول
الله «صلى الله عليه وآله» إلى أهل البحرين أن يقدم عليه عشرون رجلاً
منهم، فقدم عليه عشرون رجلاً رأسهم عبد الله بن عوف الأشج، وفيهم
الجارود، ومنقذ بن حيان، وهو ابن أخت الأشج، وكان قدومهم عام الفتح،
فقيل: يا رسول الله، هؤلاء وفد عبد القيس.
قال:
«مرحباً بهم، نعم القوم عبد القيس».
قال:
ونظر رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى الأفق صبيحة
ليلة قدموا وقال: «ليأتين ركب من المشرق، لم يُكرهوا على الإسلام، قد
أنضوا الركاب، وأفنوا الزاد، بصاحبهم علامة، اللهم اغفر لعبد القيس،
أتوني لا يسألوني مالاً، هم خير أهل المشرق».
قال:
فجاؤوا عشرين رجلاً ورأسهم عبد الله بن عوف الأشج،
ورسول الله «صلى الله عليه وآله» في المسجد، فسلموا عليه، وسألهم رسول
الله «صلى الله عليه وآله»: «أيكم عبد الله الأشج»؟
فقال:
أنا يا رسول الله، وكان رجلاً دميماً.
فنظر إليه رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، فقال:
«إنه لا يُسْتَقَى في مُسُوك الرجال، إنما يُحتاج من
الرجل إلى أصغريه: لسانه وقلبه». وذكر نحو ما سبق.
وعن الزارع بن عامر أنه قال:
يا رسول الله، إن معي رجلاً خالاً لي، مصاباً فادع الله
تعالى له.
فقال:
«أين هو؟ ائتني به».
قال:
فصنعت مثل ما صنع الأشج، ألبسته ثوبيه وأتيته به، فأخذ
طائفة من ردائه، فرفعها حتى بان بياض إبطه، ثم ضرب ظهره وقال: «أخرج
عدو الله».
فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الأول، ثم أقعده بين
يديه فدعا له، وشج وجهه، فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله «صلى
الله عليه وآله» يَفضُل عليه.
وروى الشيخان([49])
عن ابن عباس قال:
قدم وفد عبد القيس على رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
فقال: «من القوم»؟
قالوا:
من ربيعة.
قال:
«مرحباً بالقوم غير خزايا ولا ندامى».
فقالوا:
يا رسول الله، إنَّا نأتيك من شقة بعيدة، وإنه يحول
بيننا وبينك هذا الحي من كُفار مُضر، وإنَّا لا نصل إليك إلا في شهر
حرام.
فمرنا بأمر فصل، إن عملنا به دخلنا الجنة.
قال:
«آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع».
قال:
أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال: «هل تدرون ما الايمان
بالله»؟
[قالوا:
«الله ورسوله أعلم».
قال:]
«شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء
الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم.
وأنهاكم عن أربع:
عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير ـ وربما قال
المقير ـ فاحفظوهن، وادعوا إليهن من وراءكم».
قالوا:
يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟
قال:
«بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء» ـ أو قال:
«من التمر ـ ثم تصبون فيه من الماء، حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى
إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف».
قال:
وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك.
قال:
وكنت أخبأها حياء من رسول الله «صلى الله عليه وآله».
قالوا:
ففيم نشرب يا رسول الله؟
قال:
«في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها».
فقالوا:
يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان، ولا تبقى بها
أسقية الأدم.
[فقال نبي الله «صلى الله عليه وآله»]:
«وإن أكلتها الجرذان»، مرتين أو ثلاثاً.
ثم قال رسول الله «صلى الله عليه
وآله» لأشج عبد القيس:
«إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة»([50]).
وعن شهاب بن عباد
([51]):
أنه سمع بعض وفد عبد القيس يقول: قال الأشج: يا رسول
الله، إن أرضنا ثقيلة وخمة وإنَّا إذا لم نشرب هذه الأشربة هيجت
ألواننا، وعظمت بطوننا، فرخِّص لنا في هذه. وأومأ بكفيه.
فقال:
«يا أشج، إني إن رخصت لك في مثل هذه» ـ وقال بكفيه هكذا
ـ «شربته في مثل هذه» ـ وفرَّج يديه وبسطهما. يعني أعظم منها ـ «حتى
إذا ثمل أحدكم من شرابه قام إلى ابن عمه فهزر ساقه بالسيف».
وكان في القوم رجل يقال له:
الحارث قد هزرت ساقه في شراب لهم، في بيت من الشعر تمثل
به في امرأة منهم، فقال الحارث: لما سمعتها من رسول الله «صلى الله
عليه وآله» جعلت أسدل ثوبي فأغطي الضربة بساقي، وقد أبداها الله تعالى
لنبيه «صلى الله عليه وآله».
وعن أنس:
أن وفد عبد القيس من أهل هجر قدموا على رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، فبينما هم عنده إذ أقبل عليهم، فقال: «لكم تمرة
تدعونها كذا، وتمرة تدعونها كذا». حتى عد ألوان تمرهم أجمع.
فقال له رجل من القوم:
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو كنت ولدت في هجر ما كنت
بأعلم منك الساعة، أشهد أنك رسول الله.
فقال «صلى الله عليه وآله»:
«إن أرضكم رفعت لي منذ قعدتم
إليَّ، فنظرت من أدناها إلى أقصاها، فخير تمركم البرني الذي يذهبُ
بالداء ولا داء معه»([52]).
عن ابن عباس([53])
قال:
«إن أول جُمعة جُمعت بعد جُمعة في مسجد رسول الله «صلى
الله عليه وآله» في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين».
وعن أم سلمة:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أخّر الركعتين بعد
الظهر بسبب اشتغاله بوفد عبد القيس حتى صلاهما بعد الظهر في بيتها.
وعن ابن عباس وأبي هريرة:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال: «خير أهل
المشرق عبد القيس»([54]).
وعن نوح بن مخلد:
أنه أتى رسول الله «صلى الله عليه وآله» وهو بمكة
فسأله: «ممن أنت»؟
فقال:
أنا من بني ضبيعة بن ربيعة.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«خير ربيعة عبد القيس، ثم الحي الذي أنت منهم». رواه
الطبراني.
وعن ابن عباس:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال: «أنا حجيج من
ظلم عبد القيس»([55]).
ونقول:
قد تضمنت النصوص المتقدمة أموراً عديدة تحتاج إلى شيء
من التصحيح أو التوضيح. وفيما يلي بعض من ذلك:
ذكرت الروايات:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» وصف عبد القيس بأنهم خير
أهل المشرق. وأنه «صلى الله عليه وآله» حجيج من ظلم عبد القيس، وأن عبد
القيس خير ربيعة..
ونحن لا نستطيع أن نؤكد أو ننفي صحة هذه الروايات، غير
أننا نقول:
1 ـ
لو صحت هذه الروايات، فقد يكون المقصود بها هم خصوص
الذين كانوا موجودين في تلك البرهة من الزمان. ولا شيء يؤكد لنا شمولها
لمن بعدهم.
2 ـ
إن روايات فضائل القبائل، والبلدان، وكذلك روايات ذمها
كانت موضوع أخذ وردّ، وربما يكون الكثير منها موضوعاً، كما أظهرت
الدراسات في بعض مواردها.
3 ـ
لعل المقصود بخيريّتهم هو حسن نظرتهم للأمور، وصحة
معالجتهم لها، ولا يتصرفون بانفعال وطيش ورعونة. ولأجل ذلك فإن مواقفهم
تكون أقرب إلى الإتزان من مواقف غيرهم.
4 ـ
إن خيريتهم وتقدمهم على غيرهم نسبية، فإذا كانت هناك
نسبة من الخير في أهل المشرق فإنها تكون في عبد القيس أكثر من غيرهم..
لعل ما يشهد لصحة تفكير عبد القيس، واتزانهم في
مواقفهم، هو: أنهم ـ كما ذكر العلامة الأحمدي ـ صاروا مع أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب «عليه السلام»، ونصروه في حروبه. ولسراتهم يد بيضاء في
نصرة ولي الله تعالى، لا سيما أبناء صوحان: صعصعة، وزيد، وسيحان، وعمرو
بن المرجوم و..([56]).
وقد اشتهر بنو عبد القيس بالخطابة والشعر، والفصاحة([57]).
ويبدو أنهم كانوا على درجة عالية من
الثقافة أيضاً، فقد قيل:
إن صحار بن العباس العبدي له كتاب: «الأمثال»([58]).
ويستوقفنا هنا قول عمر للوفد حين
وصلوا معه إلى النبي «صلى الله عليه وآله»:
هذا صاحبكم الذي تريدون.. فإنه ليس مما يليق، ولا مما ينبغي.. بل هو قد
يستبطن إساءة وإهانة يستحق معها القتل عند خالد بن الوليد فقط، فإن
خالداً كان يعتذر عن قتل مالك بأنه كان يقول، وهو يراجع الكلام: ما
أخال صاحبكم إلا قال([59]).
وقد حكى القاضي عبد الجبار عن أبي
علي الجبائي:
أن خالداً قد قتل مالكاً لأنه أوهم بقوله ذلك: أن رسول
الله «صلى الله عليه وآله» ليس صاحباً له([60]).
ونقول:
لو كان هذا هو ما جرى لكان خالد اعتذر به لأبي بكر،
ولكان تأول فأصاب، لأن مالكاً يكون بذلك مرتداً، يجب قتله، فما معنى أن
يقول أبو بكر لعمر: إن خالداً تأول فأخطأ؟!([61]).
والذي يظهر لنا هو:
أنه قصد بقوله: «صاحبك» أبا بكر وليس النبي «صلى الله
عليه وآله»، ففهم خالد أن مالكاً لا يرى أبا بكر صاحباً له.
وهذا معناه:
أنه ينكر خلافته.
ويشير إلى ذلك:
أن خالداً قال لمالك: إني قاتلك.
قال مالك:
أوبذلك أمرك صاحبك ـ يعني أبا بكر ـ.
قال:
والله لأقتلنك. وكان ابن عمر،وأبو قتادة حاضرين، فكلما
خالداً الخ..([62]).
ثم تذكر الرواية:
أن مالكاً طلب من خالد أن يرسله إلى أبي بكر ليحكم في
أمره، فرفض وقتله، فلو كان قد ظهر من مالك ما فيه إساءة للرسول «صلى
الله عليه وآله» لم يتوسط له ابن عمر، وأبو قتادة الخ..
وسواء أكان مالك قد قصد النبي «صلى الله عليه وآله» أو
قصد أبا بكر، فإن جرأة عمر قد كانت بحق النبي «صلى الله عليه وآله» دون
سواه، فلماذا جرَّت باء خالد ولم تجرَّ باء غيره؟!
وقد ذكرت الروايات المتقدمة:
أنه «صلى الله عليه وآله» صار يعد للوفد أنواع التمر،
حتى عد ألوان تمرهم أجمع، حتى قالوا له: ما نحن بأعلم بأسمائها منك.
وقال بعضهم:
لو كنت ولدت بهجر ما كنت بأعلم منك الساعة.
ونستفيد من ذلك:
1 ـ
عدم صحة ما تقدم في بعض الوفود، من نصوص تظهره «صلى
الله عليه وآله» كرجل لا يعرف عن التمور، وأنواعها ما يحسن السكوت
عليه..
2 ـ
إن هذا الأمر قد بهر ذلك الوفد، إلى حد أن قائل ذلك عقب
كلامه بقوله: أشهد أنك رسول الله..
3 ـ
إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أخبرهم بما هم أعلم
الناس به، ويعرفون صحته ودقة ما يقوله. فإذا أظهر أنه أعلم منهم بما
يدَّعون لأنفسهم التقدم فيه، فسوف يكون له أثر عميق على وجدانهم،
وإيمانهم، بخلاف ما إذا حدَّثهم بما لايعرفون عنه قليلاً ولا كثيراً،
فإنه سيكون حديثاً غير ظاهر النتائج، ولا يستطيعون حسم الأمر فيه، لأنه
سيكون خاضعاً لجميع الإحتمالات.
النبي
 يرى ما
في البحرين: يرى ما
في البحرين:
وقد ذكرت الرواية أيضاً:
أنه «صلى الله عليه وآله» بعد أن ذكر لهم أنواع التمور
حتى كأنه مولود في هجر قال: إن أرضكم رفعت لي منذ قعدتم إلي، فنظرت من
أدناها إلى أقصاها الخ..
وإنما قال لهم ذلك، بعد أن بين لهم أنه أعلم منهم بما
هم أعرف الناس به. وبذلك يكون قد صدق الخَبَرَ الخُبْرُ..
وهذا أدعى لرسوخ الإيمان، وانقياد النفوس.. ثم إنه يكون
بذلك قد نقلهم نقلة نوعية وكبيرة في مجال الإعتقاد، والوقوف على بعض
خصائص النبوة حين يخبرهم: بان الله قد رفع له جميع أرضهم، من أدناها
إلى أقصاها، وأصبح يراها كأنها حاضرة لديه، تماماً كما جرى حين مات ملك
الحبشة، حيث رفع الله له كل خفض، وخفض كل رفع. حتى رأى جسد النجاشي
وصار أمامه، وصلى عليه صلاة الميت كما قدمناه..
وقد
ذكرت الرواية:
أن الله قد جبل الأشج على خصلتين، هما: الحلم والأناة..
ونقول:
إنه إن كان المقصود بذلك معنى ينتهي إلى ما يعتقد به
الجبريون، فذلك غير صحيح، كما اثبته علماؤنا الأبرار فراجع([63]).
بالإضافة إلى أن هذا يؤدي إلى القول بعدم استحقاق الأشج
أية مثوبة على أي فعل تدعوه إليه تانك الخلتان..
وإن كان المقصود:
أن الله تعالى قد أودع في الأشج استعداداً ينتهي به إلى
العمل بهاتين الخلتين، دون أن يكون مسلوب الإختيار، فهو قصد صحيح ولا
ضير فيه..
وثمة سؤال عن قول رسول الله «صلى
الله عليه وآله»:
سيطلع عليكم من ها هنا ركب الخ.. هل هو إخبار عن أمر
غيبي؟! أم أنه ليس كذلك؟
قد يقال:
نعم. فإن هذا هو ظاهر الكلام.
وقد يقال:
لا، لأن ثمة نصاً يقول: إنه «صلى الله عليه وآله» كان
قد أرسل إلى البحرين يطلب قدوم وفد عبد القيس إليه([64]).
ويمكن ان يؤيد ذلك:
أنه قد كانت لعبد القيس وفادتان، فلعل إحداهما كانت
بطلب منه «صلى الله عليه وآله»، وهي التي حصلت سنة تسع أو بعدها، وكان
عدد الوفد أربعين رجلاً..
وكانت الأخرى قبل الفتح، أو سنة خمس، أو قبلها، وتكون
هي التي أخبر النبي «صلى الله عليه وآله» عن طلوع وفدها عليهم.
بل يحتمل:
أن يكون قد أخبر بالغيب، حتى بالنسبة للوفادة التي
طلبها النبي «صلى الله عليه وآله» منهم، فإن طلب قدوم الوفد لا يعني:
المعرفة الدقيقة بوقت حركته، وبوقت وصوله، ولحظة طلوعه عليهم..
إلا أن يقال:
بأن من المحتمل أن يكون قد جاء إلى النبي «صلى الله
عليه وآله» من أخبره بموعد وصول الوفد.. فلا يكون ما حصل من قبيل
الإخبار بالغيب أصلاً.
والصحيح هو:
أن هذا من الإخبارات الغيبية، لأن حديث استقدام النبي
«صلى الله عليه وآله» لوفدهم يقول: ليأتين ركب من المشرق.. إلى أن قال:
بصاحبهم علامة ـ والمقصود بصاحبهم ـ الأشج.. وهذا التعبير يشير إلى أنه
«صلى الله عليه وآله» بصدد إخبارهم بأمر غيبي لم يكن قد علمه بالطرق
العادية.
وقد ذكرنا آنفاً:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد طلب من العلاء بن الحضرمي:
أن يوفد إليه من عبد القيس. أو أنه طلب من نفس بني عبد القيس إيفاد من
يختارونه إليه. وذلك يدل على أنه «صلى الله عليه وآله» كان يطلب
وفادتهم من أجل أن يسهِّل عليهم من أجل الإندماج في المجتمع الجديد، ثم
من أجل أن يسمعوا كلامه، ويروا بأم أعينهم سلوكه، وحالاته، فلعل ذلك
يدعوهم إلى تلمس الفرق بين سلوكهم ومواقفهم، وحالهم، وبين سلوك ومواقف
وحالات رسول الله «صلى الله عليه وآله» والمجتمع الإيماني بصورة عامة.
فإن من شأن ذلك:
أن يسهل عليهم اتخاذ القرار بالتعاون والتلاقي،
والتفاهم، والإسلام والإندماج..
كما أن هذه السياسة لهم من شأنها:
أن تطمئنهم إلى أنه «صلى الله عليه وآله» ليس راغباً في
إذلالهم، ولا في التسلط الظالم عليهم، ولا في الإستيلاء على ثرواتهم،
وبلادهم.
ثم إن هذه الوفود ستجد الفرصة للتأمل فيما يلقيه إليها،
وعليها، أو يطلبه منها، ويجدون فرصة تقييمه بصورة صحيحة في أجواء
هادئة. بعيداً عن التشنج والإنفعال، إذ ليست الأجواء أجواء مواجهة،
وتهديدات.
وقد صرحت بعض النصوص المتقدمة:
بأن الأشج كان أصغر من في الوفد، وبأنه تخلف في الركاب
حتى أناخها، وجمع متاع القوم، وذلك بعين رسول الله «صلى الله عليه
وآله»([65]).
لكن ذلك غير دقيق، فقد صرحت روايات
أخرى:
بأن الأشج كان رئيس الوفد([66])،
فلا يعقل أن يتأخر عنه، بل لابد أن يكون في مقدمته، ويتولى هو الكلام
في حضرته «صلى الله عليه وآله»..
إلا أن يقال:
ربما يكون تخلفه في الركاب، وجمعه متاع القوم، وكان
أصغر الوافدين، إنما كان في وفادتهم الأولى، ثم نتج عن اهتمام النبي
«صلى الله عليه وآله» به، وظهور حصافة رأيه وعقله أن أصبح رئيساً
مقدماً، فجاء في وفادتهم الثانية، وله صفة الرئيس.
وفي الروايات الآتية تحت عنوان:
متى قدم وفد عبد القيس: دلائل ظاهرة على تقدم الأشج في
السن، وقد أضربنا عن ذكرها هنا استغناء بما ذكرناه هناك.
وقد جاءت النصوص التي ذكروها عن وفد عبد القيس مضطربة،
ومشوشة، فتارة يقول بعضها: فلما نظر «صلى الله عليه وآله» إلى دمامته
قال: إنه لا يُسْتَقَى في مُسُوك([67])
الرجال، إنما يحتاج من الرجل إلى أصغريه، لسانه، وقلبه([68]).
فيظهر من هذا النص:
أن قائل هذه الكلمات هو الأشج نفسه.
لكنّ نصاً آخر يقول:
فنظر إليه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقال: «إنه
لا يُسْتَقَى في مُسُوك الرجال، إنما يُحتاج من الرجل إلى أصغريه:
لسانه وقلبه»([69]).
حيث إنه صريح في: أن قائل ذلك هو رسول الله «صلى الله عليه وآله»..
وهذا هو الموافق لما هو معروف من نسبة عبارة: «المرء بأصغريه: قلبه
ولسانه» إلى النبي «صلى الله عليه وآله».
والظاهر:
أن ثمة غلطاً في ذلك منشؤه رواية الطبقات.. رغم أن
الطبقات نفسه قد روى الرواية الصحيحة أيضاً.
وقد نستفيد من قوله «صلى الله عليه
وآله» عن وفد عبد القيس:
«أتوني لا يسألوني مالاً»: أن الكثيرين ممن كانوا
يأتونه كانوا طامعين بالحصول على الأموال، على سبيل الجشع والطمع، لا
لمجرد رفع الحاجة، التي لا سبيل لهم إلى رفعها بغير مساعدته «صلى الله
عليه وآله»..
تقدم:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد عالج خال الزارع بن عامر،
وأخرج منه (الجنّي) اللعين الذي كان سبب بلائه.. وإن كنا لم نستطع أن
نفهم السبب في أنه قد شج وجه ذلك المصاب، رغم أن أمارات الشفاء قد ظهرت
عليه، وجعل ينظر نظر الصحيح، ليس بنظره الأول..
وقد ذكرنا أكثر من مرة:
أن الناس كانوا يتوقعون من النبي «صلى الله عليه وآله»
أن يكون عارفاً بكل ما يحتاجون إلى علمه، وأنه قادر على إيصالهم إلى كل
ما يريدون، من خلال صلته بالله تعالى..
وقلنا أيضاً:
إنه «صلى الله عليه وآله» لم يكن يظهر أي اعتراض على
طلباتهم هذه، بل كان يبادر إلى تلبيتها، وبذلك يكون قد كرس لديهم هذا
الفهم لمقام النبوة. وقد جاءت النتائج لترسخ لديهم اليقين بصحة فهمهم
هذا، وضرورة الإستقامة، والإستمرار على الالتزام بمقتضياته.
النبي
 يؤخر
الركعتين بعد الظهر: يؤخر
الركعتين بعد الظهر:
وأما تأخير النبي «صلى الله عليه وآله» الركعتين بعد
الظهر بسبب انشغاله بوفد عبد القيس، فليس فيه ما يوجب الإشكال، فإنه ـ
لو فرض صحة الرواية بذلك ـ فإنما أخر صلاة مستحبة، ولعلها نافلة العصر،
التي قد يكون من عادة النبي «صلى الله عليه وآله» الإتيان بها فور
الإنتهاء من صلاة الظهر، فأخرها عن الوقت الذي جرت عادته على الإتيان
بها فيه، من دون أن يتجاوز في ذلك وقت فضيلة العصر.. فأخرها لأمر رأى
أن ثوابه أعظم، كما أنه لم يؤخرها عن وقتها، بل أخرها عما اعتاده من
الإتيان بها في وقت بعينه..
وقد ذكرت الرواية المتقدمة:
أنه «صلى الله عليه وآله» أمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع،
فلماذا اقتصر على هذه الأربع.
ويجاب:
بأنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر، لكونهم سألوه أن يخبرهم
بما يدخلون بفعله الجنة، فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال، ولم
يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلاً وتركاً.
ويدل على ذلك:
إقتصاره في المناهي على الإنتباذ في الأوعية، مع أن في
المناهي ما هو أشد في التحريم من الإنتباذ، لكن اقتصر منها على هذه
الأمور لكثرة تعاطيهم لها([70]).
ونقول:
إنه لا ريب في أنهم يعرفون حكم ما
هو من قبيل:
الصدق، والكذب، وقتل النفس المحترمة، وقطيعة الرحم، أو
صلتها، وغير ذلك كثير، ولكنه «صلى الله عليه وآله» أراد أن يؤكد عليهم
في الأمور التي يعرف أنهم لا ينشطون إليها، بل لديهم الصوارف الكثيرة
عنها.
وأما بالنسبة لقولهم:
إنه لا يصلون إليه إلا في شهر حرام.
فالظاهر:
أن المراد به: شهر رجب.
ولذا أضيف إليهم في حديث أبي بكرة،
حيث قال:
رجب مضر.
والظاهر:
أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم، مع تحريمهم القتال في
الأشهر الثلاثة الأخر، إلا أنهم ربما أنسأوها، ولذا ورد في بعض
الروايات: الأشهر الحرم، وفي بعضها: إلا في كل شهر حرام([71]).
ثم إن من دلائل عقل الأشج:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال له: تبايعون على
أنفسكم وقومكم؟!
فقالوا:
نعم.
فقال الأشج:
يا رسول الله، إنك لن تزاول الرجل على شيء أشد عليه من
ديته، نبايعك على أنفسنا، ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا، ومن
أبى قتلناه.
قال:
صدقت.. إن فيك خصلتين: الحلم والأناة([72]).
وعن تاريخ قدوم وفد عبد القيس إلى المدينة نقول:
ذكر العلامة الأحمدي «رحمه الله»:
وجوه الإختلاف في تاريخ قدوم وفد عبد القيس، فقيل: سنة
خمس.
وقيل:
تسع.
وقيل:
قبل فتح مكة.
وقيل:
بعده.
وقيل:
سنة عشر([73]).
وقال أيضاً:
إنه «صلى الله عليه وآله» كتب إلى العلاء ابن الحضرمي
في البحرين: أن يقدم عليه عشرون رجلاً، فقدموا عليه ورأسهم عبد الله بن
عوف الأشج (ثم ذكر أسماءهم). فشكى الوفد العلاء بن الحضرمي، فعزله «صلى
الله عليه وآله» وولى أبان بن سعيد، وأوصى بعبد القيس خيراً([74]).
وهذا يدل على:
أن وفودهم كان في سنة تسع، لأن بعث العلاء إلى البحرين
كان بعد فتح مكة.
غير أننا نقول:
إن
ذلك لا يمنع من أن يكونوا قد وفدوا قبل ذلك، فقد قيل:
إنه «صلى الله عليه وآله» بعث ابن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى في
البحرين في السنة الثامنة.
وقيل:
في السابعة.
وقيل:
قبل فتح مكة.
وقيل:
في العاشرة كما في الطبري([75]).
وهذه الأقوال تفسح المجال أمام احتمالات الأقوال في وقت
مجيء الوفد إلى المدينة.
ولكنّ نصاً آخر يصرح:
بأن راهباً أخبر صديقه المنذر بن عائذ، بأن نبياً يخرج
بمكة يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه علامة، فأخبر المنذر
الأشج بذلك، ثم مات الراهب.
فبعث الأشج ابن أخته وصهره، اسمه عمرو بن عبد القيس إلى
مكة، ومعه تمر ليبيعه، وملاحف. وكان ذلك عام الهجرة، فلقي النبي «صلى
الله عليه وآله»، ورأى صحة العلامات، وأسلم، وعلمه النبي «صلى الله
عليه وآله» سورة الحمد وسورة إقرأ. وقال له: ادع خالك إلى الإسلام،
فرجع وأسلم المنذر، ثم خرج في ستة عشر رجلاً من أهل هجر، وافداً إلى
المدينة. وذلك عام الفتح، ثم شخص «صلى الله عليه وآله» إلى مكة، ففتحها([76]).
وقيل:
إنه أتى النبي «صلى الله عليه وآله» في مكة([77]).
وربما يكون قد اتاه في مكة يوم فتحها، لا قبل الهجرة.
وقد رجح الزرقاني:
أنه كانت لعبد القيس وفادتان: إحداهما: قبل الفتح،
بدليل: أنهم قالوا لرسول الله «صلى الله عليه وآله»: إن كفار مضر قد
حالوا بينهم وبين رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فإن حيلولتهم هذه
إنما كانت سنة خمس أو قبلها.
ويوضح ذلك نص آخر، فيقول:
إن منقذ بن حيان كان متجره إلى المدينة في الجاهلية،
فشخص إلى المدينة بملاحف، وتمر من هجر بعد هجرة النبي «صلى الله عليه
وآله» إليها، فبينما منقذ قاعد إذ مرّ به «صلى الله عليه وآله»، فنهض
إليه منقذ، فقال له «صلى الله عليه وآله»: كيف قومك؟ ثم سأله عن
أشرافهم، رجل رجل يسميهم بأسمائهم، فأسلم منقذ، وتعلم سورة الفاتحة،
وسورة إقرأ، ثم رحل قِبل هجر، وكتب «صلى الله عليه وآله» معه لجماعة
عبد القيس كتاباً، فلما وصل إليهم كتمه أياماً، وكان يصلي ويقرأ، فذكرت
ذلك زوجته لأبيها المنذر بن عائذ، (وهو الأشج)([78])،
وقالت له: أنكرت بعلي منذ قدم يثرب، إنه يغسل أطرافه، ويستقبل الجهة ـ
تعني القبلة ـ فيحني ظهره مرة، ويضع جبينه مرة.
وذكرت:
أنه قد صبأ.
فاجتمعا، وتجاريا ذلك، فأسلم المنذر، ثم أخذ الكتاب
وذهب إلى قومه، فقرأه عليهم، فأسلموا، واجمعوا المسير إلى رسول الله
«صلى الله عليه وآله»([79]).
استدلوا على تعدد وفادة عبد القيس
بقوله «صلى الله عليه وآله» لهم:
«ما لي أرى ألوانكم تغيرت»، ففيه إشعار بأنه رآهم قبل
التغير([80]).
ولكنه استدلال غير كاف، فإن من الممكن أن تكون الآثار
قد ظهرت على وجوههم، فإن كل إنسان يستطيع أن يدرك أن ثمة تغيراً طرأ
على الوجوه، التي يفترض أن تكون على صفة معينة، تشابه فيها ما يعرفه
الناس من ألوان وجوه الذين يعيشون معهم في نفس المحيط.
ولعل مما يدل على تعدد وفادتهم،
قولهم:
«الله ورسوله أعلم. وقولهم: يا رسول الله، دليل على
أنهم كانوا حين المقالة مسلمين»([81]).
ونقول:
إننا وإن كنا نرى:
أنهم كانوا مسلمين حقاً في ذلك الوقت غير أن من الجائز
أن يكون قولهم هذا قد جاء بعد إسلامهم في نفس هذه الوفادة، ولعل الرواة
اختصروا ما جرى، أو غفلوا عن ذكر بعض فصوله.
ويدل على سبقهم إلى الإسلام:
ما رواه العقدي عن ابن عباس: أن
أول جمعة أقيمت بعد جمعة في مسجد رسول الله، هي تلك التي أقيمت في مسجد
عبد القيس بقرية «جُواثَى» في البحرين. وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم
إليهم. قال العسقلاني: فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام([82]).
وجُواثَى:
بضم الجيم، وبعد الألف مثلثة مفتوحة.
غير أننا نقول:
إن ذلك يدل على تمكنهم من إظهار دينهم، وممارسة
شعائرهم، ولعل غيرهم كان أسبق منهم إلى الإسلام، لكن لا يستطيع إقامة
الجمعة، بسبب ما يخشاه من أذى يناله من المحيط الذي يعيشون فيه.
غير أننا بالنسبة لتقدم إسلام عبد القيس على مضر نقول:
إن قولهم:
وبيننا وبينك هذا الحي من مضر، ولا نصل إليك إلا في شهر
حرام. يدل على: تقدم إسلام عبد القيس على إسلام قبائل مضر الذين كانوا
بينهم وبين المدينة، وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والاها من
أطراف العراق([83]).
وقالوا:
إن خلو الرواية من ذكر الحج يدل على: أن هذا الوفد كان
قبل تشريعه، لأن ابن القيم يقول: إن الحج قد فرض في السنة العاشرة([84]).
ورد عليه القسطلاني:
بان فرض الحج كان سنة ست على الأصح([85]).
وقالوا:
إن رواية أحمد قد صرحت: بأن إحدى الوفادتين كانت قبل
فرض الحج، والأخرى كانت بعد ذلك، أي بعد السنة السادسة.
فرد العلامة الأحمدي «رحمه الله»:
بأن الحديث صدر عنه «صلى الله عليه وآله» مرة واحدة،
ولكن الراوي لم يذكر الحج في بعض النصوص، كما لم يذكر الصيام في بعضها
الآخر([86]).
وقد ورد في رواية البيهقي قوله:
«وتحجوا البيت الحرام».
واعتبرها الزرقاني رواية شاذة، لأنها لم ترد في
البخاري، ومسلم، وابن خزيمة، وابن حبان.
إلا أن هذا إنما هو بالنسبة لرواية أبي حمزة عن ابن
عباس، لكن روى أحمد من طريق ابن المسيب وعكرمة عن ابن عباس ذكر الحج في
قصة وفد عبد القيس([87]).
قال العلامة الأحمدي «رحمه الله» ما
ملخصه:
«اختلفوا في عدد الوافدين، فقيل: ثلاثة عشر راكباً.
وقيل:
أربعة عشر.
وقيل:
ستة عشر.
وقيل:
ثمانية عشر.
وقيل:
عشرون.
وقيل:
أربعون».
وقال الزرقاني:
كان هناك وفدتان:
إحداهما:
قبل الفتح، حيث كفار مضر يحولون بينهم وبين النبي «صلى
الله عليه وآله»، وكان ذلك إما في سنة خمس من الهجرة أو قبلها. وعدد
الوفد ثلاثة عشر كما رواه البيهقي. وقيل: أربعة عشر كما جزم به القرطبي
والنووي.
والأخرى:
سنة الوفود. وكان عدد الوفد الثاني أربعين رجلاً.
وقد عدّ العلامة الأحمدي «رحمه
الله» في هامش كتابه أسماء ثمانية وثلاثين رجلاً من الوافدين، مشيراً
إلى المصادر التي صرحت باسم كل منهم([88]).
فلا يلتفت إلى قول النووي:
«إنهم كانوا أربعة عشر راكباً ـ ثم ذكر أسماءهم ـ ولم
نعثر بعد طول التتبع على أكثر من أسماء هؤلاء»([89]).
([1])
الحارث: جد رملة، أما أبوها فاسمه الحدث (بفتح الدال) بن ثعلبة
بن الحرث كما يقول الواقدي. وعند ابن سعد اسمه الحرث: راجع:
الإصابة ج4 ص305.
([2])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص295 عن الواقدي، وابن سعد، وفي هامشه
عن: الطبقات الكبرى لابن سعد (ط ليدن) ج2 ص63، ومكاتيب الرسول
ج3 ص286، والبداية والنهاية لابن كثير ج5 ص104، والسيرة
النبوية لابن كثير ج4 ص172.
([3])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص278 عن ابن شاهين عن ابن إسحاق، وابن
سعد في الطبقات ج2 ص49 وذكر العلامة الأحمدي «رحمه الله» في
كتابه مكاتيب الرسول ج3 ص143 المصادر التالية: الطبقات الكبرى
ج1 ص284 وفي (ط أخرى) ج1 ق2 ص33 ونشأة الدولة الإسلامية ص351
ورسالات نبوية ص262 ومدينة البلاغة ج2 ص233، ونقل شطراً منه في
الإصابة ج3 ص423/8014 في ترجمة مطرف بن خالد بن نضلة، وأوعـز
إليـه في أسد الغابـة ج4 ص372، والبـدايـة = = والنهاية ج5 ص91
والوثائق السياسية ص291/188 عن رسالات نبوية لعبد المنعم خان،
والطبقات، ونثر الدر المكنون للأهدل ص66، ثم قال: قابل الطبقات
وانظر كايتاني ج9 ص7 واشپرنكر ج3 ص322. وذكره ص292 لمطرف بن
خالد بن نضلة الباهلي نقله عن أسد الغابة وهو ابن الكاهن،
وراجع أيضاً ص720 عن سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي (خطية
باريس) 1993 ورقة 9 ـ ألف.
([4])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص278 والطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص307
وذكر العلامة الأحمدي «رحمه الله» في كتابه مكاتيب الرسول ج3
ص141 المصادر التالية: الطبقات الكبرى ج1 ص284 وفي (ط أخرى) ج1
ق2 ص33 و 49 والمصباح المضيء ج2 ص349 ورسالات نبوية ص294 ونشأة
الدولة الإسلامية ص351 ومدينة البلاغة ج2 ص334 والوثائق
السياسية ص292 /189 عن رسالات نبوية، ثم قال: قابل الطبقات 1
وانظر كايتاني ج9 ص8 واشپرنكر ج3 ص323 وراجع أيضاً ص720 من
الوثائق عن سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي خطية پاريس 1993
ورقة 9 ـ ألف ولخص نص الكتاب.
([5])
راجع: مكاتيب الرسول ج3 ص142 عن اللباب ج1 ص116 والأنساب
للسمعاني ج2 ص70 ومعجم قبائل العرب ص60، والطبقات الكبرى لابن
سعد ج1 ص307، وتاريخ مدينة دمشق ج4 ص345، والبداية والنهاية
لابن كثير ج5 ص373، وسبل الهدى والرشاد ج6 ص278.
([6])
نهاية الأرب ص161، ومكاتيب الرسول ج3 ص142، والطبقات الكبرى
لابن سعد ج1 ص307، والإصابة ج6 ص100، والبداية والنهاية ج5
ص106، والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص176، وسبل الهدى والرشاد
ج6 ص278.
([7])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص303 والبداية والنهاية ج5 ص341 و (دار
إحياء التراث العربي) ص363 والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام
ج8 ص135 والطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص353 ومكاتيب الرسول ج1
ص166 و 282 وج3 ص140 وعن الإصابة ج3 ص7993 وتاريخ مدينة دمشق
ج4 ص327 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص672.
([8])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص398 عن ابن سعد في الطبقات (ط ليدن) ج2
ص67، والطبقات الكبرى لابن سعد (ط دار صادر) ج1 ص304، والإصابة
ج5 ص334، وأعيان الشيعة ج1 ص240.
([9])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص346 والطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص307 و
(ط ليدن) ج1 ق2 ص49، ومكاتيب الرسول ج3 ص437، وتاريخ مدينة
دمشق ج9 ص324.
([10])
البيت للعباس بن مرداس انظر ملحق ديوانه 151، ونسب أبي ذر،
وانظر اللسان (ثعلب) وغيرهما انظر الدرر ج4 ص104 وجمهرة اللغة
(1181) والهمع ج2 ص22، والبحار ج3 ص254، والتفسير الصافي ج4
ص17، وتفسير نور الثقلين ج4 ص21، والطبقات الكبرى لابن سعد ج1
ص308، وتاريخ مدينة دمشق ج9 ص325، والبداية والنهاية ج2 ص427
وج5 ص107، وإمتاع الأسماع للمقريزي ج4 ص19، والسيرة النبوية
لابن كثير ج1 ص374 وج4 ص177، وسبل الهدى والرشاد ج2 ص216 وج6
ص346 وج9 ص458، والسيرة الحلبية ج3 ص447، والصحاح للجوهري ج1
ص93.
([11])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص346 وفي هامشه: أخرجه ابن عساكر في
تهذيب تاريخ دمشق ج3 ص141وج9 ص325، والطبقات الكبرى لابن سعد
ج1 ص308.
([12])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص346 و 347 وفي هامشه عن الطبقات الكبرى
لابن سعد ج1 ص234و309.
([13])
وفاء الوفاء ج4 ص1225 وراجع: عمدة الأخبار ص329، ومكاتيب
الرسول ج3 ص437، ومعجم البلدان للحموي ج3 ص107.
([14])
نشأة الدولة الإسلامية ص255 ـ 256، ومكاتيب الرسول ج3 ص533.
([15])
سفينة البحار ج7 ص133، ونهج البلاغة ج4 ص41، وتحف العقول لابن
شعبة الحراني ص111، وخصائص الأئمة للشريف الرضي ص108، وروضة
الواعظين للنيسابوري ص454، ومشكاة الأنوار للطبرسي ص228،
والبحار ج69 ص45 وج75 ص53، وشرح النهج للمعتزلي ج18 ص386،
ومعارج اليقين في أصول الدين للسبزواري ص302.
([16])
سفينة البحار ج7 ص131 و 132 والبحار ج70 ص246 وج110 ص71،
والكافي ج2 ص307، والأمالي للشيخ الصدوق ص371، والخصال ص12،
والوسائل ج15 ص366 و (ط دار الإسلامية) ج11 ص293، وجامع أحاديث
الشيعة ج13 ص551.
([17])
الآية 100 من سورة يوسف.
([18])
الآية 20 من سورة الأحزاب.
([19])
البحار ج100 ص9 وفي هامشه عن جامع الأخبار (ط الحيدرية النجف
الأشرف) ص139، ومكاتيب الرسول ج3 ص537، والفايق في غريب الحديث
للزمخشري ج1 ص240، وميزان الاعتدال للذهبي ج1 ص230، وغريب
الحديث لابن قتيبة ج1 ص321، والنهاية في غريب الحديث لابن
الأثير ج1 ص370، ومعارج اليقين في أصول الدين للسبزواري ص390.
([20])
راجع: الكافي ج5 ص284 وتهذيب الأحكام ج7 ص154 والوسائل (ط
مؤسسة آل البيت) ج19 ص63 و (ط دار الإسلامية) ج13 ص216 وجامع
أحاديث الشيعة ج18 ص460 ومكاتيب الرسول ج3 ص540 والخراجيات
للمحقق الكركي ص90 ورسائل الكركي ج1 ص284.
([21])
راجع: الوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج6 ص382 وج19 ص36 و (ط دار
الإسلامية) ج4 ص981 وج13 ص196 ومكاتيب الرسول ج3 ص540 ومستدرك
الوسائل ج4 ص475 وج13 ص24 و 462 والبحار ج11 ص211 و 212 وجامع
أحاديث الشيعة ج5 ص235 وج17 ص130 وج18 ص434 و 435 وتفسير
العياشي ج1 ص40 وقصص الأنبياء للراوندي ص53 ومنازل الآخرة
للقمي ص41.
([22])
راجع: نهج البلاغة (بشرح عبده) ج3 ص22 ومستدرك الوسائل ج14 ص57
والبحار ج42 ص255 وج100 ص184 وجامع أحاديث الشيعة ج19 ص103
وشرح النهج للمعتزلي ج15 ص147 والنهاية لابن الأثير ج2 ص496
ولسان العرب ج11 ص357.
([23])
قرب الإسناد ص115 وجامع أحاديث الشيعة ج17 ص134 وموسوعة الإمام
علي بن أبي طالب «عليه السلام» في الكتاب والسنة والتاريخ
للريشهري ج4 ص28 و 172 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج17 ص41 و
(ط دار الإسلامية) ج12 ص24 والبحار ج100 ص65.
([24])
راجع: نهج البلاغة وقد ذكرنا شطراً من مصادر هذا العهد في
كتابنا دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام، ومستدرك الوسائل ج13
ص166، والبحار ج33 ص606، وجامع أحاديث الشيعة ج17 ص336، وشرح
نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج17 ص71.
([25])
البحار ج100 ص171 والوسائل (ط دار الإسلامية) ج17 ص42 و (ط
مؤسسة آل البيت) ج12 ص25 وراجع: مستدرك الوسائل ج13 ص459 و (ط
مؤسسة آل البيت) ص26 و 461.
([26])
راجع: الكافي ج5 ص280، ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص151 والوسائل
(ط دار الإسلامية) ج17 ص328 والإستبصار ج3 ص107 وتهذيب الأحكام
ج7 ص151 والمقنع ص132، والمقنع للصدوق ص393، والنهاية للطوسي
ص421، والسرائر لابن إدريس الحلي ج2 ص378، والجامع للشرايع
لابن سعيد الحلي ص374، وتذكرة الفقهاء (ط.ق) للعلامة الحلي ج2
ص400، ومنتهى المطلب (ط.ق) للعلامة الحلي ج2 ص1024، ورسائل
الكركي ج2 ص203، والسراج الوهاج للفاضل القطيفي ص74.
([27])
راجع: الكافي ج5 ص279 والوسائل (ط دار الإسلامية) ج17 ص326
والإستبصار ج3 ص108 وتهذيب الأحكام ج7 ص152 وترتيب مسند
الشافعي ج2 ص133 والأم للشافعي ج3 ص264 و 268 وكنز العمال ج3 =
= ص512 و 513 و 516 و 517 والأموال لأبي عبيد ص386 والسنن
الكبرى للبيهقي ج6 ص142 و 143 وإرشاد الساري ج4 ص184 والخراج
للقرشي ص82 و 84 ومستدرك الوسائل ج2 ص149 وشرح الموطأ للزرقاني
ج4 ص424 و 425 ومجمع الزوائد ج4 ص157 ونصب الراية للزيلعي ج4
ص290 وجامع أحاديث الشيعة وغير ذلك.
([28])
راجع: مصباح الفقاهة، كتاب الخمس، ومسالك الأفهام للشهيد
الثاني ج3 شرح ص58.
([29])
راجع: البحار ج19 ص112.
([30])
راجع: فتوح البلدان للبلاذري ص12، ومكاتيب الرسول ج1 ص351،
وعيون الأثر لابن سيد الناس ج1 ص258.
([31])
معجم البلدان ج5 ص86.
([32])
عن السيرة الحلبية ج2 ص94.
([33])
راجع: الأموال ص394 ومكاتيب الرسول ج1 ص329 عن: فتوح البلدان
ص31 والبخاري ج4 ص116 في فرض الخمس، باب ما يعطي النبي المؤلفة
قلوبهم، ومسند أحمد ج6 ص347 وفتح الباري ج6 ص181 والخراج لأبي
يوسف ص66 والنهاية لابن الأثير في مادة: قطع. وراجع أصول
مالكيت ج2 ص111 والمصنف لابن أبي شيبة ج12 ص354 وصحيح البخاري
ج4 ص116 وصحيح مسلم ج4 ص1716 والقواعد للشهيد ج1 ص 349 وحياة
الصحابة ج2 ص691 وراجع: ترتيب مسند الشافعي ج2 ص133 والكامل
لابن عدي ج4 ص1386 والطبقات الكبرى ج3 ق2 ص72 انتهى.
([34])
معجم البلدان ج5 ص86 والطبقات الكبرى (ط ليدن) ج3 ق1 ص72.
([35])
وفاء الوفاء ج4 ص1154، ومعجم البلدان للحموي ج1 ص473، وراجع:
مجمع البحرين للطريحي ج3 هامش ص308، والمناقب للخوارزمي هامش
ص89، وتفسير جوامع الجامع للطبرسي ج1 هامش ص366، وشرح النهج
للمعتزلي ج10 ص7.
([36])
راجع: الأموال لابن زنجويه ج2 ص613 و 614 وراجع ص627 والأموال
لأبي عبيد ص394.
([37])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص384 ومكاتيب الرسول ج3 ص503 عن: الطبقات
الكبرى ج1 ص302 وفي (ط ليدن) ج1 ق2 ص45 والبداية والنهاية ج5
ص90 ورسالات نبوية ص148 ونشأة الدولة الإسلامية ص365 ومدينة
البلاغة ج2 ص294 والإصابة ج3 ص423 في ترجمة مطرف بن عبد الله
بن الأعلم. والوثائق السياسية ص312 و 216 عن الطبقات، ورسالات
نبوية، وقال: قابل معجم البلدان مادة عقيق، وانظر اشپرنكر ج3
ص513.
([38])
مكاتيب الرسول ج3 ص503 عن معجم البلدان، ومعجم البلدان ج4 ص139.
([39])
المبسوط للشيخ الطوسي ج3 ص274 ونيل الأوطار ج4 ص309 والسنن
الكبرى للبيهقي ج6 ص145 و 151 ورسالات نبوية ص101 و 102 ومسند
أحمد ج2 ص306 وسنن أبي داود ج3 ص174 والأحكام السلطانية ج2
ص198 والنهاية في اللغة، مادة قدس، والسرائر لابن إدريس الحلي
ج1 ص479، والمجموع لمحيى الدين النووي ج15 ص232، ونيل الأوطار
للشوكاني ج6 ص54، ومسند احمد ج1 ص306، وسنن أبي داود ج2 ص47،
والسنن الكبرى للبيهقي ج6 ص145، وأمالي المحاملي ص322،
والتمهيد لابن عبد البر ج3 ص237، وتفسير القرطبي ج3 ص325،
وتاريخ مدينة دمشق ج10 ص425، وإمتاع الأسماع ج9 ص359، والنهاية
في غريب الحديث لابن الأثير ج4 ص24.
([40])
راجع: مكاتيب الرسول ج3 ص503 عن المصادر التالية: الطبقات
الكبرى ج1 ص302 و (ط ليدن) ج1 ق2 ص45 والبداية والنهاية ج5 ص90
ورسالات نبوية ص148 ونشأة الدولة الإسلامية ص365 ومدينة
البلاغة ج2 ص294= = والإصابة ج3 ص423 في ترجمة مطرف بن عبد
الله بن الأعلم. والوثائق السياسية 312/216 عن الطبقات،
ورسالات نبوية، وقال: قابل معجم البلدان مادة عقيق وانظر
اشپرنكر ج3 ص513. أقول: الذي نجده في المعجم ذكره عقيق
اليمامة، وهو عقيق بني عقيل قال: فيه قرى ونخل كثير، ويقال له:
عقيق تمرة، ولم يذكر الإقطاع والكتاب وراجع البداية والنهاية
ج5 ص90.
([41])
المواهب اللدنية وشرحه للزرقاني ج5 ص133.
([42])
المواهب اللدنية وشرحه للزرقاني ج5 ص137.
([43])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص367 عن أبي يعلى، والطبراني، والبيهقي،
وقال في هامشه: أخرجه البيهقي في الدلائل ج5 ص327 وانظر
البداية والنهاية ج5 ص47، وفتح الباري ج1 ص121، والآحاد
والمثاني للضحاك ج3 ص314، والمعجم الكبير للطبراني ج20 ص345،
وتهذيب الكمال ج13 ص354، والبداية والنهاية ج5 ص57، وإمتاع
الأسماع ج14 ص55، والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص90، والسيرة
الحلبية ج3 ص251.
([44])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص367 وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ج5
ص140، والطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص314.
([45])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص367 وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ج5
ص140، والطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص314.
([46])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص367 وراجع: المواهب اللدنية وشرحه
للزرقاني ج5 ص141، ومجمع الزوائد للهيثمي ج5 ص64، وفتح الباري
ج10 ص51، ومسند أبي يعلى ج12 ص244، وصحيح ابن حبان ج16 ص179.
([47])
راجع ما تقدم في سبل الهدى والرشاد ج6 ص367 و 368.
([48])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص368 وفي هامشه عن: ابن سعد في الطبقات
ج1 ق2 ص54، والكامل في التاريخ ج2 ص298.
([49])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص368 وقال في هامشه: أخرجه البخاري
(7266) ومسلم ج1 ص47 (24 ـ 17). وراجع: المواهب اللدنية وشرحه
للزرقاني ج5 ص134 و 135 و 136، ومجلة تراثنا لمؤسسة آل البيت
ج53 ص119 نقلا عن صحيح البخاري، كتاب العلم ج1 ص32، الجامع
لأخلاق الراوي والسامع ص71.
([50])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص368 و 369 عن البيهقي، ومكاتيب الرسول
ج3 ص200 عن المصادر التالية: البخاري ج1ص139 وألفاظ النصوص
مختلفة وفي بعضها بعد ذكر الشهادتين: عقد بيده واحدة، وفي
بعضها كالبخاري ج5 ص213 وج1 ص21 و 32 وصحيح مسلم ج1 ص46 ـ 69
بأسانيد متعددة في روايتين، ومسند أحمد ج1 ص228 وسنن أبي داود
ج4 ص219 والسنن الكبرى ج6 ص294 وكنز العمال ج1ص19 و 20 وتأريخ
المدينة لابن شبة ج1 ص104 والسيرة الحلبية ج3 ص251 والسيرة
النبوية لدحلان (بهامش الحلبية) ج3 ص16 والبداية والنهاية ج5
ص46 وزاد المعاد ج3 ص29 وفي (ط أخرى) ص35 زاد ذكر الصوم، وزاد
في مسند أحمد ج1 ص361: «وأن تحجوا البيت»، وأسقط بعضها ذكر
الصوم والحج كالبخاري ج1 ص139 وج2 ص131 وصحيح مسلم في باقي
الروايات، وسنن أبي داود ج3 ص330 والأموال لأبي عبيد ص20
والأموال لابن زنجويه ج1 ص104. وراجع أيضاً: الروض الأنف ج4
ص221 وفتح الباري ج1 ص120 و 166 وج2 ص136 وج3 ص212 وج8 ص67
وعمدة القاري ج5 ص6 وج8 ص263 وج18 ص20 وموارد الظمآن ص337. كما
أن بعض المصادر أسقط هذا الحديث ولم ينقله كالطبقات الكبرى ج1
ص314 وفي (ط أخرى) ج1 ق2 ص54 والسيرة النبوية لابن هشام ج4
ص242 وفي (ط أخرى) ص222. وراجع أيضاً: شرح المواهب اللدنية
للزرقاني ج4 ص13 وموارد الظمآن ج4 ص367.
([51])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص369 وقال في هامشه: أخرجه أحمد في
المسند ج4 ص207 وذكره البيهقي في الكنز (13252).
([52])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص369 وقال في هامشه: أخرجه الحاكم ج4
ص204 وذكره المتقي الهندي في الكنز (35315).
([53])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص369 وقال في هامشه: أخرجه البخاري في
كتاب الجمعة (892).
([54])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص370 عن البزار، والطبراني.
([55])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص369 و 370 عن الطبراني، وقال في هامشه:
ذكره الهيثمي في المجمع ج10 ص52 وعزاه للطبراني في الكبير
والأوسط وقال: وفيه من لم أعرفهم.
([56])
مكاتيب الرسول ج3 ص203 عن الغارات للثقفي، وصفين للمنقري،
والبحار ج32 في حربي الجمل وصفين، والإصابة ج3 ص15.
([57])
مكاتيب الرسول ج3 ص203، والإصابة (ترجمة صحار) ج2 ص177 والمفصل
في تاريخ العرب قبل الإسلام ج8 ص82 و 781 وج9 ص238 و 430 و 655
و 729 و 784.
([58])
مكاتيب الرسول ج3 ص203 عن الفهرست لابن النديم ص132 وعن المفصل
في تاريخ العرب قبل الإسلام ج4 ص328 و 327.
([59])
البحار ج30 ص491 وفي هامشه عن: تاريخ الأمم والملوك ج3 ص279
وعن الكامل في التاريخ ج2 ص359، و الاحتجاج للطبرسي ج1 هامش
ص125، والغدير ج7 ص164، وشرح النهج للمعتزلي ج17 ص214، وأسد
الغابـة = = ج4 ص296، والإصابة ج5 ص561، والكامل في التاريخ ج2
ص359، وإمتاع الأسماع ج14 ص240.
([60])
المغني للقاضي عبد الجبار ج20 ص355 والبحار ج30 ص491 و 493 و
479، والمواقف للإيجي ج3 ص611.
([61])
البحار ج30 ص379 و 471 وشرح النهج للمعتزلي ج17 ص207، وفوات
الوفيات للكتبي ج2 ص243، والشافي في الامامة للشريف المرتضى ج4
ص161.
([62])
وفيات الأعيان ج6 ص13 ـ 15، والنص والإجتهاد للسيد شرف الدين
ص135نقلاً عن وفيات الأعين.
([63])
راجع: دلائل الصدق، وغيره من كتب الإعتقادات
([64])
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج4 ص360 وراجع ج1 ص314 و ج5
ص557 و (ط ليدن) ج4 ق2 ص77 وج1 ق2 ص44.
([65])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص367، والآحاد والمثاني ج3 ص314، ومسند
أبي يعلى ج12 ص246، والمعجم الكبير للطبراني ج20 ص346، والرخصة
في تقبيل اليد لابن إبراهيم المقرئ ص66، وأسد الغابة ج4 ص352،
وتهذيب الكمال ج13 ص355، والبداية والنهاية ج5 ص57، وإمتاع
الأسماع ج14 ص55.
([66])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص368 عن الطبقات الكبرى (ط ليدن) ج1 ق2
ص54.
([68])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص367 عن أبي يعلى، والطبراني، والبيهقي،
وقال في هامشه: أخرجه البيهقي في الدلائل ج5 ص327 وانظر
البداية والنهاية ج5 ص47 والمواهب اللدنية وشرحه للزرقاني ج5
ص139 و 140 والطبقات الكبرى لابن سعد ج5 ص558.
([69])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص368 والطبقات الكبرى لابن سعد ج5 ص558
وعن البيان والتعريف لحمزة الدمشقي ج1 ص240.
([70])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج6 ص371 و 372 وشرح المواهب اللدنية
للزرقاني ج5 ص138.
([71])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج6 ص371 وشرح المواهب اللدنية
للزرقاني ج5 ص135.
([72])
شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج5 ص139 عن عياض، وصحيح مسلم ج1
ص36، وشرح مسلم للنووي ج1 ص189، وتحفة الأحوذي للمباركفوري ج6
ص129.
([73])
مكاتيب الرسول ج3 ص196.
([74])
الطبقات الكبرى لابن سعد ج4 ص360 وراجع ج1 ص314 و ج5 ص557 و (ط
ليدن) ج4 ق2 ص77 وج1 ق2 ص54، ومكاتيب الرسول ج3 ص202.
([75])
راجع: مكاتيب الرسول «صلى الله عليه وآله» ج3 ص202.
([76])
راجع: الإصابة ج2 ص177 (ترجمة صحار العبدي) وفي (ط دار الكتب
العلمية) ج3 ص330 و، وراجع الطبقات الكبرى لابن سعد ج5 ص411.
([78])
لاحظ الإختلاف بين الروايات في من هو الأشج.
([79])
راجع: مكاتيب الرسول ج3 ص196 عن الكرماني، وسبل الهدى والرشاد
ج6 ص372 وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ج5 ص138
([80])
المواهب اللدنية وشرحه للزرقاني ج5 ص141 عن ابن حبان، وفتح
الباري.
([81])
المواهب اللدنية وشرحه للزرقاني ج5 ص141 و 142 عن فتح الباري.
([82])
المواهب اللدنية وشرحه للزرقاني ج5 ص142 عن فتح الباري، وسبل
الهدى والرشاد ج6 ص370، وفتح الباري ج1 ص122، و عمدة القاري ج1
ص310.
([83])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص370 عن البداية والنهاية، والمواهب
اللدنية وشرحه للزرقاني ج5 ص141، وفتح الباري ج1 ص122، وعمدة
القاري ج1 ص309، والسيرة الحلبية ج3 ص252.
([84])
المواهب اللدنية وشرحه للزرقاني ج5 ص143 وراجع: سبل الهدى
والرشاد ج6 ص371.
([85])
المواهب اللدنية وشرحه للزرقاني ج5 ص142 و 143، وفتح الباري ج1
ص124، والسيرة الحلبية ج3 ص307.
([86])
مكاتيب الرسول ج3 ص201.
([87])
شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج5 ص138، والآحاد والمثاني ج3
ص260، والسنن الكبرى للنسائي ج4 ص188، وصحيح ابن حبان ج1 ص373،
والمعجم الكبير للطبراني ج10 ص289.
([88])
راجع: مكاتيب الرسول ج3 ص197 و 198 و 199 وكلام الزرقاني ورد
في شرحه على المواهب اللدنية ج5 ص138 و 139 و 140 وراجع: سبل
الهدى والرشاد ج6 ص370 و 371.
([89])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص370 و 371، وشرح مسلم للنووي ج1 ص181،
وفتح الباري ج1 ص121.
|