حـجــة الــــــوداع
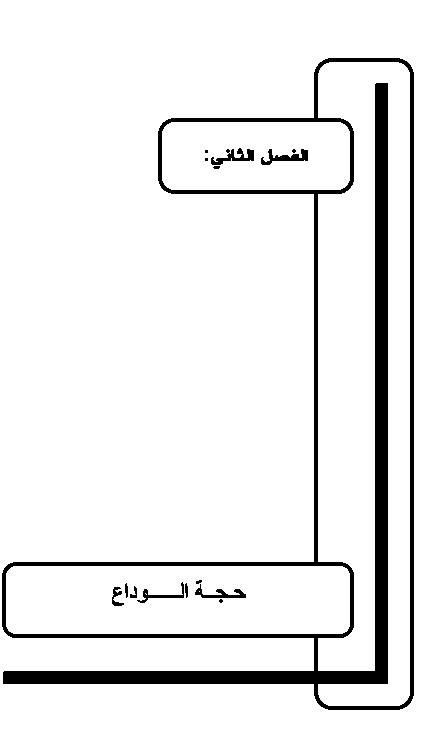
إن من الطبيعي:
أن يهتم المسلمون بما جرى في حجة الوداع، وأن يفردوها
بتصانيفهم، وبحوثهم، لأنها تضمنت التأكيد على أمور أساسية وحساسة جداً،
ومصيرية، أهمها: ما جرى في عرفة، أو في منى من تحد سافر من قبل قريش
ومن هم على رأيها، تجاه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ثم التهديد
الإلهي لهم الذي أدى إلى إنجاز نصب علي «عليه السلام» ولياً وإماماً،
وأخذ البيعة منهم له بذلك يوم غدير خم، في طريق عودة النبي «صلى الله
عليه وآله» من حجته تلك إلى المدينة.
أما دوافع هذا الإهتمام، فلعلها مختلفة إلى حد
التباين.. بين من يريد الإثبات، ومن يريد النفي، أو على الأقل التشكيك
بما حصل، أو بدلالته على ما سيق للدلالة عليه.
ومهما يكن من أمر، فقد قال بعضهم عن حجة الوداع:
أفردها بالتصنيف محمد بن المنذر، وأحمد بن عبد الله
المحب الطبري، وإبراهيم بن عمر البقاعي الشافعيون.
وعلي بن أحمد بن حزم الظاهري.
وبسط الكلام عليها محمد بن أبي بكر الشهير بابن القيم
الحنبلي في «زاد المعاد».
وإسماعيل بن كثير الشافعي في كتاب السيرة في تاريخه
المسمى «البداية والنهاية»، وهو أوسع من الذي قبله.
كل منهم ذكر أشياء لم يذكرها الآخر، وهناك أشياء وظفرت
بأشياء لم لم يذكروها([1]).
قالوا:
أقام رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالمدينة عشر سنين
يضحي كل عام، ولا يحلق، ولا يقصر، ويغزو المغازي ولا يحج، حتى كان في
ذي القعدة سنة عشر أجمع الخروج إلى الحج. فأذَّن في الناس أنه حاج في
هذه السنة.
فسمع بذلك من حول المدينة، فلم يبق
أحد يريد، وفي لفظ:
يقدر أن يأتي راكباً، أو راجلاً إلا قدم، فقدم المدينة
بشر كثير، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، وكانوا من بين يديه، ومن
خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، مد البصر، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله
«صلى الله عليه وآله» ويعمل مثل عمله([2]).
قد جزم في النص الآنف الذكر:
أنه «صلى الله عليه وآله» كان بعد الهجرة يضحي، ولا
يحلق ولا يقصر. في أيام الحج، ويغزو ولا يحج.. وأنه لم يحج من المدينة
سوى حجة الوداع.
مع
أنه قد روي:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد حج عشرين حجة مستسراً([3]).
وفي الكافي:
عشر حجات([4]).
والسبب:
أنه كان يستسر بحجه، إما لأجل النسيء، لأنهم كانوا
يحجون في غير أوان الحج، أو لمخالفة أفعاله لأفعالهم، للبدع التي
أبدعوها في حجهم([5])..
وهناك نصوص أخرى أشرنا إليها في الجزء الرابع عشر من
هذا الكتاب، في فصل: «متفرقات في السنة الخامسة» تحت عنوان: «فرض
الحج».
وفي موضع آخر من هذا الكتاب، ذكرنا عدد حجاته، وهي تدعو
إلى عدم التسرع في إطلاق القول: بأنه «صلى الله عليه وآله» لم يحج سوى
حجة الوداع..
فإن من القريب جداً:
أن تكون بعض هذه العشرين حجة، قد حصلت بعد الهجرة،
وبصورة سرية، بالطريقة التي تناسب حال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»..
ويؤيد ذلك قوله:
إنه «صلى الله عليه وآله» كان يستسر بها جميعاً، فإذا
كان في أيام النسيء، لم يحج مع الناس، وينتظر إلى الوقت الحقيقي، فيحج
سراً..
إن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يكتف بإعلام الناس
بأنه حاج في تلك السنة، بل أمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم: بأن
رسول الله «صلى الله عليه وآله» يحج في عامه هذا([6])،
حتى «بلغت دعوته إلى أقاصي بلاد الإسلام، فتجهز الناس للخروج معه، وحضر
المدينة، من ضواحيها، ومن حولها، ويقرب منها خلق كثير، وتهيأوا للخروج
معه، فخرج بهم»([7])..
وعن الإمام الصادق «عليه السلام»
قال:
ذكر رسول الله «صلى الله عليه وآله» الحج، فكتب إلى من
بلغه كتابه، ممن دخل الإسلام: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» يريد
الحج، يؤذنهم بذلك ليحج من أطاق الحج، فأقبل الناس([8])..
قد ذكر النص المتقدم:
أن الذين قدموا على رسول الله«صلى الله عليه وآله» في
تلك السنة ليحجوا معه كانوا بشراً كثيراً، ووافاه في الطريق خلائق لا
يحصون، وكانوا من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، مدَّ
البصر.
وقد ذكرت الروايات:
أن الذين خرجوا معه «صلى الله عليه وآله» كانوا سبعين
ألفاً([9]).
وقيل:
تسعون ألفاً([10]).
ويقال:
مائة ألف، وأربعة عشر ألفاً([11]).
وقيل:
مائة وعشرون ألفاً([12]).
وقيل:
مائة وأربعة وعشرون ألفاً. ويقال أكثر من ذلك([13]).
قال العلامة الأميني:
«هذه عدة من خرج معه، أما الذين
حجوا معه، فأكثرمن ذلك، كالمقيمين بمكة، والذين أتوا من اليمن مع علي
«عليه السلام» (أمير المؤمنين)، وأبي موسى»([14]).
قالوا:
«وأخرج معه نساءه كلهن في الهوادج،
وسار معه أهل بيته، وعامة المهاجرين والأنصار، ومن شاء الله من قبائل
العرب، وأفناء الناس»([15]).
ونقول:
إن حشد الأمة إلى الحج، وإرسال الكتب إلى أقصى بلاد
الإسلام، وأمر المؤذنين بأن يؤذنوا بأعلى أصواتهم: بأن رسول الله«صلى
الله عليه وآله» يحج في عامه هذا، وإخراج النبي «صلى الله عليه وآله»
نساءه كلهن في الهوادج إلى الحج، واجتماع هذه الأعداد الهائلة، لتسير
معه، سوى من سار إلى مكة من دون أن يمر بالمدينة،
وما والاها، وسوى الذين جاؤوا من اليمن مع ذلك، إن ذلك
لم يكن أمراً عفوياً، ولا مصادفة، ولا كان استجابة لرغبة شخصية تقضي
بجمع النبي «صلى الله عليه وآله» الناس حوله. فحاشاه من ذلك، ولا لغير
ذلك من أمور دنيوية، فإن النبي «صلى الله عليه وآله» لا يفكر ولا يفعل
إلا وفق ما يريده الله تبارك وتعالى.. وحاشاه من أي تفكير أو موقف أو
عمل في غير هذا الإتجاه..
ولعل الهدف من كل هذا الحشد هو تحقيق أمور كلها تعود
بالنفع العميم على الإسلام والمسلمين، ويمكن أن نذكر منها، ما يلي:
1 ـ
إنه أراد للناس المتمردين، بل والمنافقين، والذين
يحلمون بالإرتداد على الإسلام وأهله عند أول فرصة تسنح لهم، يريد لهم
أن يروا عظمة الإسلام، وامتداداته الواسعة، وأنه لم يعد بإمكان أحد
الوقوف في وجهه، أو إيقاف مده، فلييأس الطامحون والطامعون، وليراجع
حساباتهم المتوهمون، وليعد إلى عقولهم المتهورون والمجازفون..
2 ـ
إنه يريد أن يربط على قلوب الضعفاء، ويشد على أيديهم،
ويريهم عياناً ما يحصنهم من خدع أهل الباطل، وكيد أهل الحقد والشنآن..
ومن كل ما يمارسونه معهم من تخويف، أو تضعيف..
3 ـ
أن ينصب علياً «عليه السلام» إماماً وخليفة من بعده
أمام كل هذه الجموع الهائلة، ليكونوا هم الشهداء بالحق على أنفسهم وعلى
جميع الناس، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم..
ثم أن يقطع الطريق على قلة من الناس من أن يتمكنوا من
خداع الآخرين ببعض الإدعاءات أو الإشاعات كما سنرى حين الحديث عما جرى
في عرفات، ومنى، وفي طريق العودة، في غدير خم.
وأما أخذه لجميع نسائه معه فلعله لأن فيهن من يريد أن
يقيم عليها الحجة في ذلك كله، لأنها سيكون لها دور قوي في الإتجاه
الآخر الذي يريد أن يحذر الناس من الإنغماس والمشاركة فيه..
وقالوا:
إن وباء الجدري والحصبة أصابت الناس فمنعت من شاء الله
أن تمنع من الحج الخ..
([16]).
وهذا يؤيد ما قدمناه تحت عنوان:
«نقل الوباء إلى خم»، من أن حديث نقل الوباء من المدينة
إلى خم، أو إلى غيرها، لا يصح، غير أن ما يهم هؤلاء هو أن يوهنوا أمر
غدير خم، وأن يثيروا اشمئزاز الناس ونفرتهم منه، بمجرد سماع اسمه، حتى
لقد قرنوه بالوباء، وبالحمى، وبالجدري، وما إلى ذلك..
قالوا:
وصلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» الظهر بالمدينة
أربعاً، وخطب الناس وعلمهم ما أمامهم من المناسك ثم ترجل وادهن بزيت،
واغتسل قبل ذلك، وتجرد في ثوبين صحاريين: إزار ورداء([17]).
زاد الواقدي:
وأبدلهما بالتنعيم بثوبين من جنسهما، ولبس إزاره،
ورداءه، وركب ـ كما قال أنس ـ على رحل وكانت زاملته، وقال أيضاً: حج
رسول الله «صلى الله عليه وآله» على رحل رث، وقطيفة خلقة.
ثم قال:
«اللهم اجعله حجاً مبروراً، لا رياء فيه، ولا سمعة»([18]).
وخرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» من المدينة نهاراً
بعد الظهر، لخمس بقين من ذي القعدة([19]).
والصحيح:
أنه «صلى الله عليه وآله» خرج لأربع بقين منه([20]).
وقيل:
خرج يوم السبت([21]).
وعند ابن حزم:
يوم الخميس([22]).
وخرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» على طريق الشجرة،
وكان يخرج منها، وصلى في مسجدها([23]).
ولما أراد الخروج جعل على المدينة
أبا دجانة سماك بن خرشة الساعدي([24]).
ويقال:
بل سباع بن عرفطة([25]).
ودخلها لأربع مضين من ذي الحجة([26]).
ودخل مكة من أعلاها، من عقبة المدنيين، وخرج من أسفلها([27]).
النبي
 بذي
الحليفة: بذي
الحليفة:
قالوا:
فسار «صلى الله عليه وآله» حتى أتى ذا الحليفة، وهو من
وادي العقيق فنزل به، تحت سمرة في موضع المسجد، ليجتمع إليه أصحابه،
وصلى بهم العصر ركعتين.
وأمر بالصلاة في ذلك الوادي.
فعن ابن عباس، قال:
سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول بوادي
العقيق: «أتاني آت من ربي»، ولفظ البيهقي: «جبريل» فقال: «صل في هذا
الوادي المبارك».
وقال:
«عمرة في حجة، فقد دخلت العمرة في الحج، إلى يوم
القيامة والله تعالى أعلم»([28]).
ثم بات بذي الحليفة، وصلى المغرب والعشاء، والصبح
والظهر، فصلى بها خمس صلوات، وكان نساؤه معه كلهن في الهودج، وكن تسعة،
وطاف عليهن تلك الليلة، واغتسل.
وعن عائشة:
أنها طيبته قبل طوافه عليهن تلك الليلة، واغتسل([29]).
ونقول:
إن من القبيح جداً أن تتحدث عائشة أو غيرها عن مباشرة
النبي «صلى الله عليه وآله» لزوجاته، ما دام أن ذلك لا يفيد في كشف حكم
شرعي، أو أخلاقي، بل هو مجرد كشف لستر لا يريد الله سبحانه أن يُكشف.
ومن الذي يرضى:
أن تخبر زوجته الناس بمجامعته إياها واغتساله، كلما فعل
ذلك؟!
وعن حديث:
«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» نقول:
سيأتي:
أن ذلك يرتبط بتشريع حج التمتع، الذي بدأ في سنة عشر،
وبهذه الكلمة بالذات. غير أن الظاهر أن قول الرواية: أنه «صلى الله
عليه وآله» قد قال ذلك بوادي العقيق غير دقيق، بل قاله في مكة نفسها،
كما سنرى في الفقرات التاليات إن شاء الله تعالى..
وولدت أسماء بنت عميس ـ زوجة أبي بكر ـ بذي الحليفة (بالبيدا)
محمد بن أبي بكر، فأرسلت أبا بكر إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»
تقول: كيف أصنع؟
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«اغتسلي، واستثفري بثوب، وأهليِّ»، وفي رواية: «وأحرمي»([30]).
وزاد في نص آخر، عن أبي بكر:
وتصنع ما يصنع الناس، إلا أنها لا تطوف بالبيت([31]).
ونقول:
لا معنى لأن يأمرها بالغسل، وهي لا تزال نفساء، إلا إن
كان المراد أن تغسل الدم.
والصواب هو:
ما روي عن أهل البيت «عليهم السلام»، من أنه «صلى الله
عليه وآله» أمرها فاستثفرت، وتنظفت بمنطقة، وأحرمت([32]).
والإستثفار هو:
أن تشد المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي.
فلما قدموا مكة، وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية
عشر يوماً، أمرها رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن تطوف بالبيت،
وتصلي، ولم ينقطع عنها الدم، ففعلت ذلك([33]).
قالوا:
فلما كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالروحاء رأى
حماراً وحشياً عقيراً، قال: «دعوه يوشك أن يأتي صاحبه»، فجاء صاحبه إلى
رسول الله «صلى الله عليه وآله» فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»:
«شأنكم بهذا الحمار»، فأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» أبا بكر
فقسمه بين الرفاق.
ثم مضى «صلى الله عليه وآله» حتى كان بالأثاية، بين
الرويثة والعرج، إذا ظبي حاقف في ظل، وفيه سهم، فأمر رجلاً ـ قالوا: هو
أبو بكر الصديق ـ أن يقف عنده، لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزوه([34]).
قالوا:
والفرق بين قصة الظبي، وقصة الحمار: أن الذي صاد الحمار
كان حلالاً، فلم يمنع من أكله، وهذا لم يعلم أنه حلال، وهم محرمون، فلم
يأذن لهم في أكله، ووكل من يقف عنده لئلا يأخذه أحد حتى يجاوزوه([35]).
ونقول:
أولاً:
لم يظهر لنا من قصة الظبي الحاقف أنه كان ميتاً، فلعله
كان لا يزال جريحاً وحياً..
بالنسبة للحمار العقير، وتوظيف رجل بحراسته، وحفظه
نقول:
1ـ
إنه أراد أن يحفظ حق صاحبه الذي صاده.
2 ـ
إنه أراد أن يفهم من معه أن عليهم أن يراعوا الأحكام
الشرعية، حتى لا يعتدوا على مال الغير، ولكي لا يرتكبوا مخالفة نهي
الشارع المحرمين عنه..
3 ـ
وربما يكون من الصحيح القول أيضاً بأنه فعل ذلك رفقاً
لذلك الحيوان حتى لا يتعرض لأذى المتطفلين والعابثين..
ثانياً:
حتى لو كان ميتاً، فإنه لا يجوز أكله لأحد إذا لم يذَّك
بفري الأوداج، أو كان قد اصطيد بنحو يؤدي إلى ذكاته، وحلية أكله.
ولو جاز أكله لم يجز ذلك للمحرم، حتى لو وصاده المُحِل.
ثالثاً:
إن قصة حمار الوحش إنما كانت بالروحاء، وهي على بعد
أربعين ميلاً أو نحوها من المدينة([36])،
ولا شك في أنها بعد الميقات، وقد كانوا محرمين عندها.
ويدل على ذلك:
أنهم يقولون: إنه «صلى الله عليه وآله» لما صار
بالأبواء أهدى له الصعب بن جثمامة حمار وحش.
وفي رواية:
(عجز حمار وحش).
وفي رواية:
(لحم حمار وحش، يقطر دماً).
أو:
(شق حمار وحشي).
أو:
(رجل حمار وحش، فرده)، وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا
حرم ([37]).
رابعاً:
إنه يظهر أن الذي رمى الظبي بسهم لم يحضر ليرخصهم في
الإستفادة من لحم ذلك الظبي، وليؤكد لهم ذكاته أيضاً.
قالوا:
ومضى «صلى الله عليه وآله» يسير المنازل، ويؤم أصحابه
في الصلوات في مساجد له، بناها الناس، وعرفوا مواضعها([38]).
أي أن الناس كانوا يبنون مساجد في المواضع التي كان
يصلي فيها رسول الله «صلى الله عليه وآله».
وهذا دليل آخر على صحة التبرك والتأسي برسول الله «صلى
الله عليه وآله»، وعلى هذا جرت سيرة المسلمين والمؤمنين، ولم يعترض أحد
من الصحابة على ذلك، بل كان الصحابة أنفسهم يفعلون ما يؤكده، بمرأى من
الناس وبمسمع من النبي نفسه«صلى الله عليه وآله».
فما معنى أن تظهر في آخر الزمان شرذمة تمنع الناس من
التبرك بهذه الآثار المباركة وتسعى في هدمها وإبطالها.
قالوا:
ثم سار «صلى الله عليه وآله» حتى إذا نزل بالعرج، وكانت
زاملته وزاملة أبي بكر واحدة، وكانت مع غلام لأبي بكر، فجلس رسول الله
«صلى الله عليه وآله» وأبو بكر إلى جانبه وعائشة إلى جانبه الآخر،
وأسماء بنت أبي بكر إلى جانبه، وأبو بكر ينتظر الغلام أن يطلع عليه،
فطلع وليس معه البعير، فقال: أين بعيرك؟
فقال:
أضللته البارحة.
فقال أبو بكر ـ وكان فيه حدة ـ:
بعير واحد تضله، فطفق يضرب الغلام بالسوط، ورسول الله
«صلى الله عليه وآله» يتبسم ويقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع»؟
وما يزيد رسول الله «صلى الله عليه وآله» على أن يقول
ذلك ويتبسم؟!([39]).
قال الصالحي الشامي:
سبق أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» حج على رحل،
وكانت زاملة. أي أن الرحل والزاملة شيء واحد، وكان الرحل والزاملة
لرسول الله «صلى الله عليه وآله» وليس لأبي بكر، فقول الرواية هنا: إن
زاد النبي «صلى الله عليه وآله» كان على زاملة أبي بكر ينافي ذلك.
فأجاب عن ذلك بقوله:
قال المحب الطبري: يحتمل أن يكون بعض الزاملة عليها (أي
على رحله «صلى الله عليه وآله»)، وبعض الزاملة مع زاملة أبي بكر.
ولما بلغ آل فضالة الأسلمي، أن زاملة رسول الله «صلى
الله عليه وآله» ضلت، حملوا له جفنة من حيس، فأقبلوا بها حتى وضعوها
بين يدي رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فجعل رسول الله «صلى الله
عليه وآله» يقول: «هلم يا أبا بكر، فقد جاء الله تعالى بغذاء أطيب».
وجعل أبو بكر يغتاظ على الغلام.
فقال له رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«هون عليك يا أبا بكر، فإن الأمر ليس إليك، ولا إلينا
معك، وقد كان الغلام حريصاً على ألا يضل بعيره. وهذا خَلَفٌ مما كان
معه».
ثم أكل رسول الله «صلى الله عليه وآله» وأهله، وأبو
بكر، ومن كان معه يأكل حتى شبعوا.
فأقبل صفوان بن المعطل، وكان على ساقة الناس، والبعير
معه، وعليه الزاملة، فجاء حتى أناخ على باب منزل رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» لأبي بكر: «أنظر هل
تفقد شيئاً من متاعك»؟.
فقال:
ما فقدت شيئاً إلا قعباً كنا نشرب فيه.
فقال الغلام:
هذا القعب معي.
فقال أبو بكر لصفوان:
أدّى الله عنك الأمانة.
وجاء سعد بن عبادة، وابنه قيس ومعهما زاملة تحمل زاداً
يؤمان رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فوجدا رسول الله «صلى الله عليه
وآله» واقفاً بباب منزله، قد رد الله عز وجل عليه زاملته، فقال سعد: يا
رسول الله، بلغنا أن زاملتك ضلت الغداة، وهذه زاملة مكانها.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«قد جاء الله بزاملتنا، فارجعا بزاملتكما بارك الله
فيكما»([40]).
ونقول:
ويعود الحديث هنا من جديد عن ضياع زاملة رسول الله «صلى
الله عليه وآله» وفق ما تعودناه في رواياتهم لأسفار رسول الله «صلى
الله عليه وآله».. ونحن وإن كنا لا نمانع في أن تضيع زاملته أو ناقته
«صلى الله عليه وآله» أكثر من مرة، غير أننا نَلْمَحُ في كثير من
الأحيان أن ثمة رغبة في التسويق لأشخاص هم من فريق واحد، من خلال إظهار
خصوصية، لهم في أنفسهم، أو الإيحاء، بأن لهم نحو اختصاص برسول الله
«صلى الله عليه وآله»..
ولم نجد لأي من الفريق الآخر في رواياتهم أي حضور في
جميع تلكم المواقع والمواضع، ولا في سواها إلا عندما يعجزون عن تغطية
دور ذلك الفريق، أو أحد رموزه الكبار، أو عن تحريفه وتزييفه، أو عن
نسبته إلى مناوئي علي «عليه السلام» وشانئيه..
ومهما يكن من أمر، فإن هناك العديد من النقاط التي
تستوقفنا في حديث ضياع الزاملة هنا، ونذكر منها ما يلي:
وقد ادَّعت الرواية السابقة:
أن زاملة النبي «صلى الله عليه وآله» وزاملة أبي بكر
كانت في حجة الوداع واحدة، وكانت مع غلام لأبي بكر..
وتضمنت الرواية:
أنه «صلى الله عليه وآله» جلس، فجلس أبو بكر إلى جانب
الرسول «صلى الله عليه وآله» وعائشة إلى جانبه الآخر.. وأسماء إلى جانب
أبي بكر الخ..
ونقول:
أولاً:
لماذا كانت أسماء بنت أبي بكر حاضرة معهم في بيت الرسول
«صلى الله عليه وآله»، ولم تكن عند الزبير بن العوام زوجها؟!
ثانياً:
أين كانت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر، فإنها كانت معهم
في ذلك المسير، وقد ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة؟!
ولماذا تركها أبو بكر وحدها، وجاء بابنته أسماء دونها؟!
ولماذا يدخل أبو بكر على رسول الله «صلى الله عليه
وآله» النساء الأجانب اللواتي يتحرج «صلى الله عليه وآله» منهن؟!
وأين كان سائر نساء النبي «صلى الله عليه وآله»، فإنهن
كن جميعاً برفقته؟ وهل كان جميع طعام النبي «صلى الله عليه وآله» وطعام
جميع نسائه محمولاً على جمل واحد بالإضافة إلى طعام أبي بكر وطعام من
معه من العيال والنساء؟!
ثالثاً: بالنسبة للزاملة نقول:
إن ما نعرفه عن النبي «صلى الله عليه وآله» هو أنه لم
يرض بركوب ناقة أبي بكر حين الهجرة إلا بعد أن اشتراها منه بالثمن، فهل
كان أبو بكر قد وضع زاده مع زاد رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
واستفاد من زاملة النبي «صلى الله عليه وآله»؟!
أم أن النبي «صلى الله عليه وآله» هو الذي استفاد من
زاملة أبي بكر، وحين استفاد منها هل أعطاه أجرتها؟!
أم اشتراها منه؟! أم رضي بوضع زاده على زاملة غيره، دون
مقابل؟!
فإن كان الخيار الأخير هو الصحيح، فلماذا رضي في حجة
الوداع بما لم يرضه يوم الهجرة من مكة. وإن كانت الخيارات الأخرى هي
الصحيحة، فلماذا لم يبينها لنا الرواة؟!
وعن ضرب أبي بكر لغلامه بالسوط نقول:
أولاً:
لماذا يضرب أبو بكر غلامه بمحضر رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، دون أن يستأذنه «صلى الله عليه وآله»؟! ألا تعد مبادرته
إلى ضرب الغلام إساءة أدب تجاه رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!
ثانياً:
إذا كان ضرب الغلام مما لا ينبغي للمحرم، كما ظهر من
قول رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع»،
فقد كان ينبغي أن يغضب النبي «صلى الله عليه وآله»، أو أن يظهر
الإنقباض، وأن يزجره عن فعله هذا، لا أن يبتسم!!
ثالثاً:
من أين ثبت لأبي بكر أن الغلام كان مقصراً في مهمته،
وانه يستحق الضرب، وهو لم يسأله عما جرى، ولا عرف منه سبب غفلته عنه؟!
فلعل الغلام سها أو غلبته عيناه فنام، فانسل البعير إلى جهة مجهولة،
فانتبه، فلم يجده.
رابعاً:
إذا كان النبي «صلى الله عليه وآله» يعلم أن الغلام كان
حريصاً على البعير كما صرحت به الرواية، فلماذا ترك أبا بكر يضربه
بالسوط، ويواصل تغيظه عليه، ولماذا لا يدفعه أو يردعه عن ضرب ذلك
الغلام المسكين؟! أو لماذا لم يقل ذلك لأبي بكر من أول الأمر؟!
خامساً:
إذا كان الأمر ليس لأبي بكر، ولا إلى النبي «صلى الله
عليه وآله» ولا إلى غيره معه كما تقول الرواية، فلماذا لم يعاقب أبا
بكر على ظلمه لذلك الغلام المسكين.
سادساً:
من أين عرف صفوان بن المعطل أن الزاملة لرسول الله «صلى
الله عليه وآله»؟! والحال أن الجمل لأبي بكر! إذ ما أكثر الجمال في ذلك
المسير..
قالوا:
فلما مر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بوادي عسفان،
قال: «يا أبا بكر أي واد هذا»؟
قال:
«وادي عسفان».
قال:
«لقد مر به هود، وصالح، (ونوح) على بكرين أحمرين (بكرات
حمر) خطمهما ليف، وأزرهم العباء، وأرديتهم النمار، يلبون، يحجون البيت
العتيق([41]).
ونقول:
إن هذا النص يحتاج إلى ما يؤكده ويقويه، فإن النبي «صلى
الله عليه وآله» لم يكن يجهل ذلك الموضع، فقد مر به عدة مرات، ولا سيما
حين الهجرة، وحين فتح مكة، فلماذا يسأل أبا بكر عنه، في حين أن السائل
أعلم بالأمر من المسؤول؟!
وسؤال آخر وهو:
أنه هل لم يحج البيت ماراً بوادي عسفان سوى هود وصالح؟!
أليس قد حج قبلهما إبراهيم وإسماعيل حسبما جاء في القرآن الكريم؟!
إلا إذا كان «صلى الله عليه وآله» يريد التذكير بما جرى
لهذين النبيين العظيمين مع قومهما، وأنه سيجري من أصحابه على خليفته ما
يشبه ذلك، والله هو العالم بحقيقة الحال.
وما فائدة ذكر البكرين الأحمرين؟! وذكر خطامهما، وأنهما
من ليف؟!
وما فائدة ذكر أزرهما، وأرديتهما؟!
ولماذا؟! ولماذا؟!
ويلاحظ هنا:
أن بعض الروايات تقول عن التمتع بالعمرة إلى الحج:
أمرنا بها رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
أو فعلناها مع رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
أو نحو ذلك، وهو تعبير منسجم مع ما جرى، وليس فيه ما يريب، أو ما يدعو
إلى التساؤل..
لكن هناك تعابير وردت ربما تكون مثاراً للسؤال، كقول
بعض الروايات: تمتع نبي الله وتمتعنا معه([42]).
وفي رواية:
أعلم أن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب، ولم ينهنا
عنهما الخ..
أو قول عمر عن حج التمتع:
قد علمت أن النبي «صلى الله عليه وآله»
قد فعله وأصحابه.
أو قول سعد بن مالك عن المتعة:
قد صنعها رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
وصنعناها معه.
أو قول ابن عمر:
قد فعله رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
وأمر به وغير ذلك([43]).
ويمكن أن يجاب:
بأنه بعد أن ثبت أن النبي «صلى الله عليه وآله»
قد حج قارناً لا متمتعاً، فلا بد أن تحمل هذه الروايات على أن ثمة
تصرفاً تعرض له النص الأصلي، بأن يكون الرواة قد بدلوا الحديث الذي كان
عن متعة النساء ليصبح عن متعة الحج، أو لا بد من طرح النص وإهماله،
والأخذ بما يتوافق مع الثابت عنه
«صلى الله عليه وآله»،
وهو تلك النصوص المتواترة التي صرحت بأنه «صلى الله عليه وآله» قد فرض
عليهم فسخ حجهم إلى عمرة، ليكون حجهم حج تمتع، وأنه
«صلى الله عليه وآله»
بقي على حج القران، لأنه ساق الهدي.
وقد يُحمل بعض النصوص على أن قوله:
جمع بين حجة وعمرة: أنه أمر بذلك، وشرعه، وقرره..
أما النصوص المطلقة، فيمكن حملها على إرادة متعة
النساء، أيضاً..
وبعض نصوص قول ابن عمر قد جاء على صورة القضية
التعليقية، التقديرية، فلا تدل على أنه
«صلى الله عليه وآله»
قد فعل ذلك على الحقيقة..
وقد زعمت الروايات المتقدمة:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» تطيب، وأن عائشة كانت
ترى الطيب في مفرق رسول الله «صلى الله عليه وآله» بعد أيام، أو بعد
ثالثة وهو محرم.
ونقول:
لا ريب في عدم صحة ذلك، قال ابن
قدامة:
«أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب. وقد قال
النبي «صلى الله عليه وآله» في المحرم الذي وقصته راحلته([44]):
«لا تمسوه بطيب» رواه مسلم.
وفي لفظ:
«لا تحنطوه» متفق عليه.
فلما منع الميت من الطيب لإحرامه فالحي أولى. ومتى تطيب
فعليه الفدية»([45])
انتهى.
ولا نرى تناقضاً بين قولهم في النص
المتقدم:
أنه «صلى الله عليه وآله» لما صلى الصبح أخذ في
الإحرام..
وبين قولهم:
إنه «صلى الله عليه وآله» أحرم بعد صلاة الظهر، فإن
المقصود بأخذه في الإحرام هو التهيؤ له، بفعل مقدماته، مثل الغسل
المستحب قبله، وإزالة الشعر ونحو ذلك..
وقد تقدم:
أن أربعة عشر من الصحابة قد رووا عن النبي «صلى الله
عليه وآله» أمره بفسخ الحج إلى العمرة، فحل الناس كلهم إلا النبي «صلى
الله عليه وآله» ومن كان معه هدي، لأنه كان قد ساق الهدي، فصار حجهم حج
قران.
ثم إنه «صلى الله عليه وآله»
أخبرهم:
أن حج التمتع الذي نزل الأمر به بعد أن ساق النبي «صلى
الله عليه وآله» الهدي أفضل من حج القران، وأنه بعد حجه هذا سوف يختار
الأفضل، وأنه لو كان استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدي ولجعلها
عمرة..
وقد ادَّعى ابن القيم حسبما تقدم:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد خير من لم يكن معه
هدي بين حج القران وحج التمتع في سرف، فلما وصل إلى مكة ألزم من ليس
معه هدي بجعلها عمرة، وأن يحج متمتعاً، ومن معه هدي ألزمه بحج القران
في مكة.
وهو كلام غير دقيق..
فإن الذين لم يسوقوا الهدي، وقد احرموا من الميقات لم
يكونوا مخيرين بين القران والتمتع. بل كان فرضهم التمتع حصراً، ولكن
ذلك لم يكن يروق لهم، بل كانوا يعارضونه أشد المعارضة، وقد عارضه عمر
بن الخطاب في مكة. فأحب «صلى الله عليه وآله» أن يتدرج معهم في إبلاغهم
هذا الحكم. فقال لهم أولاً: من أحب. ثم لما وصلوا إلى مكة ألزمهم بما
فرضه الله تعالى عليهم، ولم يلتفت إلى كلام عمر، ولا إلى كلام غيره..
وسيأتي الحديث عن موقف عمر هذا إن شاء الله..
وقد فسر البعض قوله «صلى الله عليه
وآله»:
«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، بأن العمرة جزء
من حج القران، فمن ثم قيل:قرن، أي قرن بين الحج والعمرة وقالوا: إنه
«صلى الله عليه وآله» كان مفرداً أولاً، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك،
وأدخلها على الحج فصار قارناً، واكتفى بطواف الحج وسعيه عنه وعنها، كما
زعم ابن كثير.
ونقول:
إن دعوى وجود عمرة في ضمن حج القران، من دون أن يكون
لها طواف ولا صلاة، ولا سعي، ولا تقصير تحتاج إلى إثبات قاطع للعذر..
وما قولهم: إنه اكتفى بطواف الحج وسعيه عن طواف العمرة وسعيها إلا
اقتراح وافتراض إلا إن لم يقترن بالدليل والحجة..
وكلمة:
«دخلت العمرة في الحج إلى الأبد»، قد قيلت في جواب
سراقة عن حكمة تحويل وفسخ حج الناس الذين لم يسوقوا الهدي إلى العمرة
التي تسبق حج التمتع، فأجابه «صلى الله عليه وآله» بالتأكيد على أن فرض
الذين لا يسكنون داخل المواقيت إلى جهة مكة ما إذا لم يسوقوا الهدي هو
التمتع، ولزوم تقديم العمرة على الحج. وأن هذا الحكم ثابت إلى الأبد.
وتقدم قولهم:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» خرج من المدينة لا يسمى
حجاً ولا عمرة، ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة،
فأمر من لم يكن معه هدي يجعلها عمرة.
ونقول:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» كان عالماً بالحكم، وقد
صرحت النصوص: بأنه «صلى الله عليه وآله» أهلَّ بحج القران كما تقدم،
ولكنه لم يكن يصرح للناس بشيء، لأنه كان يتصرف وفق خطة إلهية تهدف إلى
تكريس حج التمتع الذي كان يلقى معارضة شديدة.. فأشار عليهم بحج التمتع
بسرف، فلم يستجيبوا له، فلما بلغ مكة أمرهم به بصورة جازمة، فاعترض
عليه عمر، فلم يلتفت إليه، وأمضى ذلك عليهم..
وقد ميز نفسه عنهم بحج القران، ليؤكد لهم ولكل أحد
تحديد ما يرمي إليه، ولا يفسح المجال لأي تأويل أو افتئات، فإنه كان
يعرف أن هذا الحكم سيلقى معارضة قوية.
وكان لا بد أن يتخذ الإجراءات المناسبة ليكسر حالة
اللجاج والعناد التي ظهرت آثارها في اعتراض عمر الذي استمر على
المعارضة الشديدة حتى في زمن خلافته..
وعن جوابه «صلى الله عليه وآله» لسراقة بن مالك عن فسخ
الحج إلى العمرة بقوله: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» نقول:
إن فسخ الحج إلى عمرة قد لا يصدق على كثيرين، فقد قالت
عائشة: «خرجنا مع رسول الله «صلى الله عليه وآله»: لا نذكر حجاً ولا
عمرة»([46])..
فإذا كانت عائشة وأمثالها لا يذكرون شيئاً منهما، فما بالك بالآخرين،
الذين كان أكثرهم بعيدين عن التدقيق في مثل هذا الأمر.
ورغم أن الآية القرآنية الكريمة تنص على تشريع التمتع
بالعمرة إلى الحج، في قوله تعالى:
{فَمَنْ
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الهَدْيِ}([47]).
ورغم أن الناس قد فعلوا حج التمتع في عهد رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، وبالذات في السنة العاشرة من الهجرة، وذلك قبل
استشهاد النبي «صلى الله عليه وآله» بقليل، الذي كان في الثامن
والعشرين من شهر صفر..
نعم، رغم ذلك، فإن عمر بن الخطاب قد أصر على مواصلة
إنكاره لحج التمتع، حتى إذا نال ما تمناه من الإمرة على الناس بعد رسول
الله «صلى الله عليه وآله» منعهم عنها بالقوة، وقد تقدم حديث منعه عن
متعة الحج ومتعة النساء، وتوعده بعقوبة من يفعل أية واحدة منهما..
ونشير فيما يلي إلى نصوص أخرى ذكرت منعه عن متعة الحج
بالخصوص، فقد روي عن أبي موسى: أنه سأل عمر عن متعة الحج، فأجابه
بقوله: «قد علمت أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد فعله وأصحابه،
ولكنني كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك، ثم يروحون في الحج تقطر
رؤوسهم»([48]).
وقد فسرت بعض الأحاديث الرجل الذي لم يرضى بحكم الله في
النسك بعمر([49]).
وقد اعترض الضحاك على سعد بن مالك:
بأن عمر قد نهى عن حج التمتع، فقال له سعد: قد صنعها
رسول الله «صلى الله عليه وآله» وصنعناها معه([50]).
وسئل
سعد بن مالك أيضاً عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال:
حسنة جميلة.
فقيل:
قد كان عمر ينهى عنها، فأنت خير من عمر؟!([51]).
قال:
عمر خير مني، وقد فعل ذلك النبي «صلى الله عليه وآله»،
وهو خير من عمر.
وعن سالم قال:
إني لجالس مع ابن عمر في المسجد، إذ جاء رجل من أهل
الشام، فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر: حسن جميل.
قال:
فإن أباك كان ينهى عنها.
فقال:
ويلك! فإن أبي نهى عنها، وقد فعله رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، وأمر به، أفبقول أبي آخذ؟ أم بأمر رسول الله «صلى الله
عليه وآله»؟! قم عني([52]).
وثمة نصوص أخرى تدل على منع عمر من متعة النساء، في
أيام خلافته فلتراجع في مظانها([53]).
وقد صرح في بعضها:
بأنه سوف يعاقب من يحاول أن يخالف أمره الصارم في متعة
النساء ومتعة الحج، ومصادر ذلك تأتي في الفقرة التالية..
وزعمت النصوص المتقدمة:
أن معاوية هو أول من نهى عن حج التمتع بالعمرة إلى الحج([54]).
وفي نصوصٍ أخرى:
أن عثمان هو الذي نهى عنها([55]).
ونقول:
أولاً:
إن هذا الكلام غير صحيح، فإن عمر بن الخطاب هو أول من
نهى عن حج التمتع، وذلك في قوله المشهور:
«متعتان كانتا على عهد رسول «صلى الله عليه وآله» أنا
أحرمهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج»([56]).
ثانياً:
إن معاوية نفسه يقول: إنه هو الذي قصر للنبي «صلى الله
عليه وآله» بمشقص بعد طوافه وسعيه في أيام العشرة([57]).
لكن قيس بن سعد، الراوي عن عطاء
قال:
والناس ينكرون هذا على معاوية([58]).
فإذا كان معاوية يروي:
أنه هو الذي قصر لرسول الله «صلى الله عليه وآله» في
عمرة حج التمتع، فكيف يكون هو نفسه الناهي عن حج التمتع كما نقله لنا
ابن عباس؟!
غير أننا نقول:
إن معاوية كاذب في دعواه:
أنه قصر للنبي «صلى الله عليه وآله» بعد طوافه وسعيه
للعمرة في حجة الوداع.. لأن النبي «صلى الله عليه وآله» قد حج قارناً،
فلا معنى للتقصير بعد الطواف والسعي في أيام العشر.
وعلى فرض كونه صادقاً أو كاذباً، فإنه متجرئ على الله
تعالى ورسوله «صلى الله عليه وآله» عن علم وعمد في منعه الناس عن فعل
ما شرعه الله تعالى لهم.
وحين رأوا:
أن ما فعله عمر قد جاء واضحاً وفاضحاً، ولا مجال
للتسويق له، حاولوا تلطيف الأجواء بطرح بعض التعليلات، ومن هذه
التأويلات:
1 ـ
ما زعم ابن عمر: أن أباه لم يقل: يحرم التمتع بالعمرة
إلى الحج، وإنما قال: أفردوا العمرة من الحج، لكي يزور الناس البيت في
غير أشهر الحج، أي أن العمرة لا تتم في شهر الحج إلا بهدي، قال:
«فجعلتموها أنتم حراماً، وعاقبتم الناس عليها، وقد
أحلها الله عز وجل الخ..»([59]).
وفي نص آخر عن ابن عمر:
أن عمر لم يقل لك: «إن العمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه
قال: إنّ أَتَمّ العمرة أن تفردها من أشهر الحج»([60]).
وعن ابن عمر أيضاً:
أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن
ذلك أتم لحج أحدكم، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج([61]).
ونقول:
إن هذه التأويلات لا تصح ولا تجدي وذلك لما يلي:
أولاً:
إن عمر نفسه كان يتبجح بأنه إنما ينهاهم عن نفس ما أمر
الله به في كتابه، وفعله رسوله «صلى الله عليه وآله».
فعن ابن عباس قال:
سمعت عمر يقول: والله إني لأنهاكم عن المتعة، وإنها لفي
كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله «صلى الله عليه وآله»، يعني العمرة في
الحج([62]).
ثانياً:
عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في
أشهر الحج، وقال: فعلتها مع رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأنا أنهى
عنها.
إلى أن قال:
لو خلينا بينهم وبين ذلك لعانقوهن تحت الأراك، مع أن
أهل البيت ـ يعني أهل مكة ـ ليس لهم ضرع ولا زرع، وإنما ربيعهم في من
يطرأ عليهم([63])..
أي أنه يريد ان يعتمر الناس في غير أشهر الحج لينتفع بهم أهل مكة، إذ
ليس لهم ضرع.
ثالثاً:
إن جعل العمرة في غير أشهر الحج، معناه: إلغاء حج
التمتع، واختلاف التعابير أو التأويلات لا يفيد شيئاً، وهذا يخالف ما
جاء به الكتاب، وأمرهم به الرسول «صلى الله عليه وآله».
ولا ينفع التمسك تارة:
بمقولة أنه يريد لأهل مكة أن ينتفعوا بورود المعتمرين
عليهم.
وأخرى:
بأنه لا يريد للناس أن يذهبوا إلى عرفات ورؤوسهم تقطر
من ماء غسل الجنابة، أو خوفاً من أن يعرسوا بالنساء في أراك عرفات، أو
خوفاً من أن يذهبوا إلى عرفات وذكورهم تقطر منياً، على حد تعابير عمر
بن الخطاب في الموارد المختلفة. فإن ذلك لا يدفع غائله إقدام عمر على
تغيير أحكام الشرع، وعدم الرضا بها..
بل إنه حتى لو أراد إدخال أي تعديل عليها، ولو بمقدار
ترجيح حج القران على حج التمتع، أو ترجيح الفصل بين العمرة وبين الحج،
بفاصل زمني محدَّد، ولو كان يسيراً.. فإن ذلك سيكون أيضاً إدخالاً لما
ليس من الدين في الدين، وهو محرم قطعاً، واستدراك على الله ورسوله «صلى
الله عليه وآله»، وإظهاره وكأن من يفعل ذلك ويصر عليه ويرتأي ويستحسن،
ثم يعاقب من يخالفه ـ إن هذا الشخص ـ يرى نفسه أعرف من الله ورسوله
«صلى الله عليه وآله» بما يصلح الأمة، أو بالأرجح والأولى.. وهذا مرفوض
جملة وتفصيلاً من أي كان من الناس..
وخلاصة الأمر:
لقد حاول عبد الله بن عمر أن يدافع عن أبيه، بادعاء:
أنه لم يحرم حج التمتع، ولم يعاقب عليه، وإنما رجح للناس أن يفصلوا
العمرة عن الحج، ويجعلوها في غير أشهر الحج..
وهي محاولة فاشلة وباطلة، وأما فشلها فلما ذكرناه آنفاً
من أنه لا يحق لأحد أن يتصرف في التشريع برأيه. وأما بطلانها فلما تقدم
من أنه حرم المتعة في الحج، ومتعة النساء بصورة باتة وقاطعة وتوعد
المخالف بالعقوبة.
2 ـ وتأويل آخر قد عكس الدعوى، فقال:
إن عمر لم ينه عن العمرة التي يعقبها الحج، بل نهى عن
الحج الذي يؤتى بالعمرة بعده([64]).
وقد رد ذلك العيني:
أولاً:
بما جاء في رواية مسلم من التصريح بكونها متعة الحج.
ثانياً:
سيأتي: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أعمر بعض
أهله وهي عائشة في العشر، بمجرد فراغه من نفره من منى.
ثالثاً:
في رواية له: جمع بين حج وعمرة، ومراده التمتع المذكور،
وهو الجمع بينهما في عام واحد([65]).
ويمكن مراجعة ما قاله العلامة الأميني في الجواب عن ذلك([66])..
3 ـ
هناك من حاول أن يصحح موقف عمر بن الخطاب بادِّعاء: أن
الحكم بالتمتع بالعمرة إلى الحج خاص بالصحابة، فلعمر الحق في أن يمنع
غيرهم من حج التمتع، ويعاقب فاعله.
وقد ذكر ذلك في رواية رواها رجل اسمه بلال..
ونقول:
أولاً:
قال ابن القيم: إن تلكم الآثار
الدالة على الإختصاص بالصحابة، بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة،
وبين صحيح عن قائل غير معصوم، لا يعارض به نصوص المشرع المعصوم([67]).
ثانياً:
صرحت الرواية: بأن سراقة بن مالك قال لرسول الله «صلى
الله عليه وآله»: متعتنا هذه يا رسول الله، لعامنا هذا، أم للأبد؟.
قال:
لا، بل لأبد الأبد([68])
أو نحو ذلك كما عن سراقة، وابن عباس، وعمر بن الخطاب([69])..
ثالثاً:
قال أحمد عن بلال راوي الحديث لا يعرف هذا الرجل، هذا
حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال عندي بثبت([70]).
وقال ابن القيم:
نحن نشهد بالله أن حديث بلال هذا لا يصح عن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، وهو غلط عليه([71])..
4 ـ
وتأويل رابع تضمنته رواية مزعومة تقول: عن سعيد بن
المسيب: أن صحابياً أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده: أنه سمع رسول الله
«صلى الله عليه وآله» في مرضه الذي توفي فيه ينهى عن العمرة قبل الحج([72])..
ونقول:
أولاً:
قال العيني وغيره: إن هذا الحديث مخالف للكتاب والسنة،
والإجماع([73])..
ثانياً:
وقال أبو سليمان الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال وقد
اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته، وجوز ذلك إجماع أهل
العلم ولم يذكر فيه خلافاً([74]).
أو:
قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرتين قبل حجه،
والأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون وجواز ذلك إجماع من أهل
العلم لم يذكر فيه خلاف([75]).
ثالثاً:
قال الزرقاني: إسناده ضعيف ومنقطع كما بينه الحفاظ([76])..
رابعاً:
لماذا لم يذكر لنا سعيد بن المسيب اسم ذلك الصحابي الذي
أدلى بهذه الشهادة؟!
خامساً:
لماذا لم ينقل هذا الأمر عن رسول الله «صلى الله عليه
وآله» إلا ذلك الصحابي؟! وأين كان سائر الصحابة عن مجلس رسول الله «صلى
الله عليه وآله» في تلك الساعة؟!
وكيف اكتفى النبي «صلى الله عليه وآله» في نسخ حكم ثابت
في الكتاب ـ وقد عمل به عشرات الألوف من الناس بذكره أمام هذا الرجل
الوحيد المجهول؟!!
ولماذا لم ينقل هذه الشهادة أمام عمر بن الخطاب إلا
سعيد بن المسيب، الذي ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر كما ذكره ابن عبد
البر؟!([77])
أو لثلاث سنين بقيت من خلافة عمر كما ذكره غيره([78]).
فعمن نقل ابن المسيب حديثه هذا يا ترى؟!.
سادساً:
لماذا لم يستشهد عمر بن الخطاب بهذا النهي على الصحابة
الذين انتقدوه على تحريمه للمتعتين، ولم يستشهد به عثمان على حرمة حج
التمتع، ليحسم الأمر في احتجاجه على أمير المؤمنين «عليه السلام»، كما
سنرى إن شاء الله تعالى؟!.
سابعاً:
إذا كان ذلك صحيحاً، فلماذا يصر عمر على نسبة النهي عن
المتعتين إلى نفسه، فيقول: أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما؟! ألم يكن
الأولى أن ينسب ذلك إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وينوه بما
ذكره له ذلك الصحابي، لكي يدفع عن نفسه غائلة التهمة بتصديه لإبطال
أحكام الله، وتشريع ما يخالف الله تعالى ورسوله «صلى الله عليه
وآله»؟!.
وحاولوا توجيه اختلافاتهم في طبيعة
حج النبي «صلى الله عليه وآله»:
بأن سببه اختلاف إهلال رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
فتارة: كان يهلُّ بحجة وأخرى: بعمرة، وثالثة: يهلُّ بحجة وعمرة.
ونحن لا نشك في عدم صحة هذا الكلام من أساسه..
فأولاً:
إنه «صلى الله عليه وآله» لم يكن متحيراً فيما يفعل، بل
كان عالماً بأنه يحج حج قران، فما معنى أن يهلَّ بالعمرة؟!
ثانياً:
تقدم: أن عائشة قالت: خرج رسول الله «صلى الله عليه
وآله» من المدينة، لا يسمي حجاً ولا عمرة، ينتظر القضاء، فنزل عليه
القضاء بين الصفا والمروة الخ..
وأعجب من ذلك قول النووي والقسطلاني
المتقدم:
إنه «صلى الله عليه وآله» كان مفرداً بالحج أولاً، ثم
أحرم بالعمرة ثانياً، ثم أدخلها في الحج ثالثاً، فصار قارناً.
فإن هذا كله لا معنى له إذا كان قد ساق الهدي وأشعره،
حسبما أوضحته الروايات..
وزعموا:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد اعتمر أربع عمر.
وسيأتي:
أن هذا غير صحيح.
والصحيح:
هو ما روي عن أهل البيت «عليهم السلام»، من أنه اعتمر
ثلاث مرات فقط، وهي الحديبية، والقضاء، والجعرانة بعد حنين..
وليس في حج القران عمرة، وما زعموه من أن طواف الحج
وسعيه يقوم مقام العمرة كما ذكره ابن كثير في النص المتقدم لا قيمة له
من الناحية العلمية، إلا إذا أثبت ذلك بدليل قاطع، ولم يثبت أن الإنسان
يعنبر معتمراً حتى حيث لا يوجد شيء من أفعال العمرة، فلا طواف ولا سعي
ولا تقصير، ولا غير ذلك..
وعن سبب رفض الناس حج التمتع آنئذٍ نقول:
أولاً:
قال الترمذي والعيني وعيرهما ـ تعليقاً على حديث سراقة
ـ حول ثبوت حكم التمتع إلى الأبد: «معنى هذا الحديث: أن أهل الجاهلية
كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، ولا يرون العمرة في أشهر الحج إلا
فجوراً، فلما جاء الإسلام رخص النبي «صلى الله عليه وآله» في ذلك،
فقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»: يعني: لا بأس بالعمرة في
أشهر الحج.. انتهى([79])..
وهو كلام هام جداً.
غير أننا نلاحظ على تعابير الترمذي وغيره:
1 ـ
قولهم: «رخص» أو «أذن» أو «جوز»، مع أن هذا الحكم مفروض
على الناس، وقد أعلن النبي «صلى الله عليه وآله» أن حج التمتع أفضل من
حج القران، ومن الإفراد.
2 ـ
إنه نسب الترخيص لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، مع
أن هذا الحكم قد نزل به القرآن، وألزم به رسول الله «صلى الله عليه
وآله» كل من لم يسق الهدي..
ثانياً:
عن ابن عباس، قال: والله، ما أعمر رسول الله «صلى الله
عليه وآله» عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك.
وقال:
كانوا يرون: أن العمرة في أشهر
الحج من أفجر الفجور في الأرض([80]).
علي
 لا يدع
السنة لقول أحد: لا يدع
السنة لقول أحد:
وقد رووا:
أن علياً «عليه السلام» حج في زمن عثمان، حج تمتع،
فأحفط ذلك عثمان بن عفان، فقال: لعلي «عليه السلام»: تراني أنهى الناس
عن شيء، وأنت تفعله؟!
فقال «عليه السلام»:
ما كنت لأدع سنة رسول الله «صلى الله عليه وآله» لقول
أحد من الناس([81]).
وفي نص آخر:
ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله «صلى الله
عليه وآله»([82]).
وفي نص ثالث:
أن علياً «عليه السلام» قال لعثمان: عمدت إلى سنة رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، ورخصة رخص للعباد بها في كتابه، تضيق عليهم
فيها، وتنهى عنها؟! وكانت لذي الحاجة، ولنائي الدار!!
ثم أهلَّ بعمرة وحجة معاً.
فأقبل عثمان على الناس، فقال:
وهل نهيت عنها؟! إني لم أنه عنها إنما كان رأياً أشرت
به، فمن شاء أخذ به، ومن شاء تركه([83])..
وحسبنا ما ذكرناه حول هذا الموضوع، فإن الحديث عنه
طويل.. والحر تكفيه الإشارة..
([1])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج8 ص450.
([3])
البحار ج21 ص398 و 399 و 401 وج1 ص280 عن علل الشرائع ص154 وعن
المناقب ج1 ص152 وعن السرائر ص469 وعن الكافي ج1 ص233 و 235
والدروس للشهيد الأول ج1ص474 ومن لا يحضره الفقيه ج2 ص238
والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج13 ص285 و (ط دار الإسلامية) ج9
ص380 وجامع أحاديث الشيعة ج10 ص201 وج11ص504.
([4])
البحار ج21 ص399 عن الكافي في الفروع ج1 ص233 وجامع أحاديث
الشيعة ج10 ص201 والكافي ج4 ص244والوسائل (ط مؤسسة آل البيت)
ج11 ص124و (ط دار الإسلامية) ج8 ص88.
([6])
البحار ج21 ص390 عن الكافي (الفروع) ج1 ص233 و 234 و (ط دار
الكتب الإسلامية) ج4 ص245 والحدائق الناضرة ج14 ص316 والفصول
المهمة ج1 ص649 ومستدرك سفينة البحار ج1 ص98 والتفسير الصافي
ج3 ص374 وتفسير نور الثقلين ج1 ص146 وج3 ص487 وتفسير كنز
الدقائق ج1 ص386.
([7])
البحار ج21 ص383 و 384 عن الإرشاد للمفيد ج1 ص171 وعن إعلام
الورى ص80 ص396 ومستدرك الوسائل ج8 ص84 وجامع أحاديث الشيعة
ج10 ص331 ومكاتيب الرسول ج1 ص283.
([8])
الكافي (الفروع) ج4 ص249 و (ط دار الكتب الإسلامية) ج4 ص249
والبحار ج21 ص396 والحدائق الناضرة ج15 ص58 والوسائل (ط مؤسسة
آل البيت) ج11 ص224و (ط دار الإسلامية) ج8 ص158 وجامع أحاديث
الشيعة ج10 ص359 ومكاتيب الرسول ج1 ص282 وموسوعة أحاديث أهل
البيت «عليهم السلام» ج3 ص45 ومنتقى الجمان ج3 ص163
([9])
البحار ج37 ص202 والتفسير الصافي ج2 ص53 وتفسير نور الثقلين ج2
ص73 والسيرة الحلبية ج3 ص308.
([10])
الغدير ج1 ص9 والسيرة الحلبية ج3 ص308.
([11])
الغدير ج1 ص9 والمجموع للنووي ج7 ص104 ومغني المحتاج ج1 ص345
والسيرة الحلبية ج3 ص308.
([12])
البحار ج37 ص150 والغدير ج1 ص9 و 296 والعدد القوية ص183
والسيرة الحلبية ج3 ص308.
([13])
الغدير ج1 ص9 والسيرة الحلبية ج3 ص308.
([15])
الطبقات الكبرى لابن سعد (ط ليدن) ج3 ص225 وإمتاع الأسماع ص510
وإرشاد الساري ج6 ص429 والغدير ج1 ص9 عنهم.
([16])
راجع: السيرة الحلبية ج3 ص308 وعيون الأثر ج2 ص341 وحجة الوداع
لابن حزم الأندلسي ج1 ص115 وسبل الهدى والرشاد ج8 ص450 والغدير
ج1 ص9.
([17])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص451 عن ابن سعد، والطبقات الكبرى لابن
سعد ج2 ص173 وإمتاع الأسماع ج2 ص102.
([18])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص451 عن البخاري، وابن ماجة، والترمذي في
الشمائل، وأبي يعلى في هامشه عن ابن ماجة ج2 ص965 وحاشية
الدسوقي ج2 ص10 ومجمع الزوائد للهيثمي ج3 ص221 والشمائل
المحمدية للترمذي ص180 والعهود المحمدية للشعراني ص215 وإمتاع
الأسماع ج7 ص237والشفا بتعريف حقوق المصطفى ج1 ص132.
([19])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص451 وسبل السلام ج2 ص188 وراجع: كتاب
الأم ج2 ص138 وموطأ مالك ج1 ص393 ونيل الأوطار ج5 ص191
والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج11 ص235 و (ط دار الإسلامية) ج8
ص168 والإرشاد ج1 ص171 والبحار ج21 ص384 وج30 ص610 وكتاب
المسند للشافعي ص111 ومسند أحمد ج6 ص273 وصحيح البخاري ج2 ص184
وصحيح مسلم ج4 ص32 وسنن ابن ماجة ج2 ص993 والسنن الكبرى
للبيهقي ج5 ص5 ومسند الحميدي ج1 ص104 ومسند ابن = = راهويه ج2
ص425 والسنن الكبرى للنسائي ج2 ص327 و 453 وصحيح ابن حبان ج9
ص238 وراجع: فتح الباري ج3 ص323 وج6 ص81 وج8 ص80.
([20])
البحار ج21 ص389 و 390 عن السرائر ص477 وعن الكافي (الفروع) ج1
ص233 ومنتهى المطلب (ط.ق) للحلي ج2 ص886 والكافي ج4 ص245 و 248
وعلل الشرائع للصدوق ج2 ص412 وتهذيب الأحكام للطوسي ج5 ص454
والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج11 ص214 و 222 وج13 ص199 و (ط
الإسلامية) ج8 ص151 و 157 وج9 ص318 ومستطرفات السرائر لابن
إدريس ص591 والبحار ج21 ص389 و 395 وج96 ص88 وتفسير العياشي ج1
ص89 وتفسير نور الثقلين ج1 ص185 وتفسير كنز الدقائق ج1 ص466
وتفسير الميزان ج2 ص83.
([21])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص451 عن ابن القيم، وابن كثير،
والدمياطي، والحاكم في الإكليل، وابن سعد، وسبل السلام ج2 ص188
وفتح الباري ج3 ص323 وج6 ص 8 وج8 ص80.
([22])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص451 وفتح الباري ج3 ص323 وج6 ص81 وج8
ص80 وعمدة القاري ج9 ص168.
([23])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص451 عن البخاري.
([24])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص450 والدرر لابن عبد البر ص259 والبداية
والنهاية ج5 ص127 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص1020.
([25])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص450 عن ابن هشام، والدرر لابن عبد البر
ص259 والبداية والنهاية ج5 ص127 والسيرة النبوية لابن هشام ج4
ص1020.
([26])
البحار ج21 ص389 و 390 و 395 وج30 ص618 وج96 ص193 والسرائر
ص477 وعن الكافي (الفروع) ج1 ص233 و 234 والمجموع للنووي ج7
ص154 وكشاف القناع للبهوتي ج2 ص482 وتلخيص الحبير ج7 ص108
والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج13 ص199 و (ط دار الإسلامية) ج9
ص318 وجامع أحاديث الشيعة ج11 ص271.
([27])
البحار ج21 ص389 و 390 و 395 والسرائر ص477 وعن الكافي
(الفروع) ج1 ص233 و 234 والبداية والنهاية ج5ص226.
([28])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص451 ورواه أحمد، والبخاري، وأبو داود،
وابن ماجة، والبيهقي، وفي هامشه عن: أحمد ج1 ص257 وابن ماجة ج2
ص991 وراجع: المعتبر للحلي ج2 ص786 والمبسوط للسرخسي ج4 ص4
وبدائع الصنائع ج2 ص144 و 175 وصحيح البخاري ج3 ص71 وسنن ابن
ماجة ج2 ص991.
([29])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص451 عن مسلم، والبيهقي.
([30])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص453 عن مسلم، وفي هامشه عن المصادر
التالية: مسلم ج2 ص886 حديث (147/1218) والشافعي في المسند ج1
ص296 (770) وأبو داود ج2 ص182 (1905) والنسائي ج1 ص654 وابن
ماجة ج2 ص1022 (3074) وأحمد ج3 ص320 وراجع: المغني لابن قدامة
ج3 ص261 و تلخيص الحبير ج7 ص242 ونيل الأوطار ج1 ص301 والبحار
ج21 ص403 وسنن الدارمي ج2 ص45 وصحيح مسلم ج4 ص39 وسنن= = ابن
ماجة ج1 ص204 وسنن النسائي (ط دار الفكر) ج5 ص164 وشرح مسلم
للنووي ج 8 ص 172و منتخب مسند عبد بن حميد ص341 والسنن الكبرى
للنسائي ج 2 ص 356 و مسند أبي يعلى ج4 ص24 و 93 والمنتقى من
السنن المسندة ص123.
([31])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص453 عن النسائي، وابن ماجة، وفي هامشه
عن: النسائي ج5 ص97 وابن ماجة ج2 ص972 وراجع: الآحاد والمثاني
ج1 ص474 والسنن الكبرى للنسائي ج2 ص331 وصحيح ابن خزيمة ج4
ص168 وكنز العمال ج 5 ص 276.
([32])
البحار ج21 ص379 عن الكافي (الفروع) ج1 ص287 و 288 وذخيرة
المعاد (ط.ق) ج1 ق3 ص588 والكافي ج4 ص444 وج5 ص389 و 396
والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج12 ص402 و (ط دار الإسلامية) ج9
ص66 وجامع أحاديث الشيعة ج11 ص29 وج11 ص429 ومنتقى الجمان ج3
ص167.
([33])
البحار ج21 ص379 عن الكافي (الفروع) ج1 ص289 ورسائل الشريف
المرتضى ج1 ص173 والمعتبر للمحقق الحلي ج1 ص254 ومنتهى المطلب
(ط.ج) للعلامة الحلي ج2 ص 438 و (ط.ق) ج1 ص124ومشرق الشمسين
ص326 وكشف اللثام (ط.ج) ج5 ص406 و (ط.ق) ج1 ص333 وذخيرة المعاد
(ط.ق) ج1 ق3 ص644 ومستند الشيعة ج2 ص442 والكافي ج4 ص449 و
تهذيب الأحكام ج1 ص179 وتهذيب الأحكام ج1 ص180 وتهذيب الأحكام
ج5 ص399 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج2 ص384 و 388 و (ط دار
الإسلامية) ج2 ص612 و 616 وعوالي اللآلي ج1 ص307.
([34])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص459 وفي هامشه عن: أحمد ج3 ص452
والنسائي ج5 ص143 وراجع: كتاب الموطأ لمالـك ج1 ص351 والمغني
لابن قدامـة = = ج3 ص291 والشرح الكبير لابن قدامة ج3 ص291
والمحلى لابن حزم ج7 ص251 ومسند أحمد بن حنبل ج3 ص452 وسنن
النسائي ج5 ص183 والمستدرك للحاكم ج3 ص624 والسنن الكبرى
للبيهقي ج 5 ص 188.
([35])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص459.
([36])
وفاء الوفاء ج4 ص9222.
([37])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص460 وفي هامشه عن: البخاري ج4 ص31 (1825
و2573) ومسلم ج2 ص850 (50/1193) وراجع: فتح العزيز ج7 ص496
والمجموع للنووي ج7 ص306 و 325 ومغني المحتاج ج1 ص525 وكتاب
الموطأ لمالك ج1 ص353 و 327 والمغني لابن قدامة ج3 ص290 والشرح
الكبير لابن قدامة ج3 ص290.
([38])
الطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص173 وسبل الهدى والرشاد ج8
ص459 عنه.
([39])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص460 وقال: ترجم أبو داود على هذه القصة
في باب «المحرم يؤدب»، وفقه السنة للسيد سابق ج1 ص670 ومسند
أحمد ج6 ص344 وسنن ابن ماجة ج2 ص978 وسنن أبي داود ج1 ص409
والمعجم الكبير للطبراني ج24 ص90 وتفسير ابن كثير ج1 ص246
والبداية والنهاية ج5 ص130 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص220.
([40])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص460 وإمتاع الأسماع المقريزي ج2 ص106 و
214 وراجع: تاريخ مدينة دمشق ج20 ص258.
([41])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص461 ومسند أحمد ج1 ص232 والعهود
المحمدية للشعراني ص219 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص240 والدر
المنثور ج3 ص97 وتاريخ مدينة دمشق ج62 ص275 والبداية والنهاية
ج1 ص158 وقصص الأنبياء لابن كثير ج1 ص163.
([42])
الغدير ج6 ص199 عن صحيح مسلم ج3 ص71 ح169 ـ 171 وراجع: تلخيص
الحبير ج7 ص113وصحيح مسلم ج4 ص48 وسنن النسائي ج5 ص155 و 179
وشرح مسلم للنووي ج8 ص205 والسنن الكبرى للنسائي ج2 ص350 و 367
والمعجم الكبير للطبراني ج7 ص136 وسبل الهدى والرشاد ج8 ص456.
([43])
راجع النصوص في كتاب الغدير ج6 ص198 وما بعدها.
([44])
أي رمت به فدقت عنقه.
([45])
المغني لابن قدامة (ط دار عالم الكتب سنة 1417 هـ) ج5 ص140 و
(ط دار الكتاب العربي) ج 3 ص 293 عن مسلم، وراجع الشرح الكبير
لابن قدامة ج3 ص279 وكشاف القناع للبهوتي ج2 ص498 و تذكرة
الفقهاء (ط.ج) للعلامة الحلي ج7 ص303.
([46])
صحيح مسلم ج4 ص33 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص6 و 39 وشرح مسلم
للنووي ج8 ص138معرفة السنن والآثار البيهقي ج3 ص512 و 555
وأضواء البيان للشنقيطي ج4 ص371 والبداية والنهاية ج5 ص160
والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص281 و 282 وسبل الهدى والرشاد
ج8 ص457 والسيرة الحلبية ج3 ص311.
([47])
الآية 196 من سورة البقرة.
([48])
الغدير ج6 ص200 عن مسلم في صحيحه ج3 ص67 ح157، وابن ماجة ج2
ص992 ومسند أحمد ج1 ص50 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص20 وسنن
النسائي ج5 ص153 وتيسير الوصول ج1 ص340 وشرح الزرقاني على موطأ
مالك، والبحار ج 30 ص 617.
([49])
الغدير ج6 ص200 وعن صحيح مسلم ج3 ص170 ح165و 166و 167.
([50])
الغدير ج6 ص201 عن كتاب الأم للشافعي ج7 ص199 والموطأ لمالك ج1
ص148 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص7 وسنن النسائي ج5 ص152
والجامع الصحيح للترمذي ج3 ص185 والمواهب اللدنية ج4 ص412 وعن
زاد المعاد لابن القيم ج1 ص84 وعن الجامع لأحكام القرآن ج2
ص258 وأحكام القرآن للجصاص ج1 ص335.
([51])
سنن الدارمي ج2 ص35.
([52])
الغدير ج6 ص201و202 عن الجامع لأحكام القرآن ج2 ص365 عن
الدارقطني، وعن الجامع الصحيح للترمذي ج3 ص185 وزاد المعاد ج1
ص189 وعن هامش شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج2 ص252 والسنن
الكبرى للبيهقي ج5 ص21 ومجمع الزوائد ج1 ص285 والتمهيد لابن
عبد البر ج8 ص209 والجامع لأحكام القرآن ج2 ص388 وإمتاع
الأسماع للمقريزي ج9 ص32.
([53])
مسند أحمد ج1 ص49 وج5 ص143 والغدير ج6 ص202 فما بعدها عن زاد
المعاد ج1 ص214 و 215 و 220 ومجمع الزوائد ج3 ص246 وكنز العمال
= = ج5 ص167 والدر المنثور ج1 ص216 عن أحمد، وعن مسند ابن
راهويه، وراجع: إرشاد الساري ج3 ص204 وعن جامع بيان العلم ج2
ص246 ومختصر جامع بيان العلم ص199 ح180 والآثار لأبي يوسف ص97.
([54])
راجع: بالإضافة إلى ما تقدم: مسند أحمد ج1 ص292 و 313 والجامع
الصحيح للترمذي ج3 ص184.
([55])
راجع: الغدير ج6 ص199 فما بعدها عن شرح مسلم للنووي على صحيح
مسلم ج8 ص205 وإرشاد الساري ج4 ص88 وعن فتح الباري ج3 ص433
وغير ذلك.
([56])
مسند أحمد ج1 ص337 وج3 ص325 و 356 و 363 والغدير ج6 ص208 و 209
و 210 و 211 و 212 ونقل أيضاً عن الجمع بين الصحيحين، وعن زاد=
= المعاد، وجامع بيان العلم ج2 ص239 وعن مختصر جامع بيان العلم
ص226 وكنز العمال (ط الهند) ج22 ص93 و 94 و 95 و (ط مؤسسة
الرسالة) ج16 ص519 و 520 و 521 عن الطبري، وأبي صالح،
والطحاوي، وابن عساكر، وعن ضوء الشمس ج2 ص94. وشرح النهج
للمعتزلي ج1 ص182 وج12 ص251 وج16 ص265 والأم ج7 ص219 وسنن
البيهقي ج7 ص206 ومنتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ج6 ص404
ومرآة العقول ج3 ص481 والأوائل لأبي هلال العسكري ج1 ص238
وتفسير النيسابوري (بهامش الطبري) ج5 ص17 والبيان والتبيين (ط
سنة 1380 هـ) ج4 ص278و (ط دار الفكر) ج2 ص208 و 223 وزاد
المعاد ج1 ص213 وج2 ص184 وفيه (ثبت عن عمر) والتفسير الكبير
للرازي (ط سنة 1357 هـ) ـ مستدلاً به ـ ج10 ص51 وراجع ص52 وفي
(ط أخرى) ج2 ص172 وج3 ص201و202 ووفيات الأعيان، وصحيح مسلم ج4
ص131 وتلخي صالشافي ج3 ص153 وج4 ص29 ومجمع البيان ج3 ص32 وكنز
العرفان ج2 ص156 و 158 عن الطبري في المستنير، والجواهر ج30
ص139 و 140 و 145 و 148 و 149 ونفحات اللاهوت ص98 والإيضاح
ص443 ودلائل الصدق ج3 ص102 و 103 وأحكام القرآن للجصاص ج2 ص270
وبداية المجتهد ج1 ص342 والمحلى ج9 ص107 والتمهيد للقرطبي ج23
ص364 و 365 بسندين، والتفسير الحديث لمحمد عزة دروزة ج9 ص54
والمرأة في القرآن والسنة لدروزة أيضاً ص182 عن المغني لابن
قدامة (ط دار الكتاب العربي) ج7 ص527 وعن شرح معاني الآثار باب
مناسك الحج ص374 وج2 ص144 والمبسوط للسرخسي ج5 ص152 باب القرآن
من كتاب الحج وصححه، والبحار (ط قديم) ج8 ص273 عن جامع الأصول
لابن الأثير، وتحريم نكاح المتعة ص106 و 105 و 72 و 73 و 76
وأخبار القضاة لوكيع = = ج2 ص124 وقد أشار المعلق في هامشه إلى
أن نهي عمر عن المتعة رواه ابن ماجة، والبيهقي، وابن المنذر،
ومحاضرات الراغب ج2 ص214 والمسالك ج1 ص500 والمتعة للفكيكي ص72
وشرح التجريد للقوشجي مبحث الإمامة ص484 والصراط المستقيم ج3
ص277 عن الطبري، وجواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة
البحر الزخار ج2 ص192 عن التفتازاني في حاشيته على شرح العضد،
والتمهيد ج10 ص112و113 والمنتقى للفقي ج2 هامش ص519 والدر
المنثور ج2 ص141 وراجع: الإيضاح ص443 وسنن سعيد بن منصور ج1
ص219.
([57])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج8 ص457 عن البخاري ومسلم، وعن
النسائي، وأبي داود، وقد تقدمت الإشارة إلى مصادر أخرى فراجع.
([58])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج8 ص457 ونيل الأوطار للشوكاني ج5
ص131وسنن النسائي ج5 ص245 والسنن الكبرى للنسائي ج2 ص416.
([59])
السنن الكبرى ج5 ص21 والمجموع للنووي ج7 ص158 والغدير للشيخ ج6
ص202 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص21 والإستذكار لابن عبد البر
ج4 ص61 و 107 والتمهيد لابن عبد البر ج8 ص210 وإمتاع الأسماع
ج9 ص33.
([60])
السنن الكبرى ج5 ص21 ومجمع الزوائد ج1 ص285 والغدير ج6 ص202
وج10 و 66 وشرح معاني الآثار ج2 ص147 ومعرفة السنن والآثار
للبيهقي ج3 ص538 وكنز العمال ج5 ص301.
([61])
الموطَّأ ج1 ص252 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص5 وتيسير الوصول
ج1 ص330 والدر المنثور ج1 ص281 عن ابن أبي شيبة، وكتاب الأم
للشافعي ج7 ص226.
([62])
سنن النسائي ج5 ص153 والشرح الكبير لابن قدامة ج3 ص238 وسنن
النسائي ج5 ص153 والسنن الكبرى للنسائي ج2 ص349 والبداية
والنهاية ج5 ص146.
([63])
حلية الأولياء ج5 ص205 وكنز العمال ج5 ص164 عنه، وعن أحمد،
والبخاري، ومسلم، والنسائي، والبيهقي.
([64])
راجع عمدة القاري ج9 ص205 عن عياض وغيره.
([65])
راجع عمدة القاري ج9 ص205 عن عياض وغيره.
([67])
الغدير ج6 ص214 عن زاد المعاد ج1 ص213.
([68])
الغدير ج6 ص214 عن المصادر التالية: صحيح البخاري ج3 ص148 (باب
عمرة التنعيم) وصحيح مسلم ج1 ص346 والآثار لأبي يوسف ص126 وسنن
ابن ماجة ج2 ص992 ومسند أحمد ج3 ص388 وج4 ص175 وسنن أبي داود
ج2 ص282 وصحيح النسائي ج5 ص178 وسنن البيهقي ج5 ص19. انتهى
وراجع: الخلاف ج1 ص444 وتذكرة الفقهاء (ط.ج) للحلي ج7 ص172 و
(ط.ق) ج1 ص318 ومنتهى المطلب (ط.ق) ج2 ص660 و662 وذخـيرة
المعـاد (ط.ق) ج1 ق3 ص551 والحدائـق النـاضرة ج14 = = ص312
وإعانة الطالبين للدمياطي ج2 ص321 وتحفة الفقهاء للسمرقندي ج1
ص380 وبدائع الصنائع لأبي بكر الكاشاني ج2 ص119 والمغني لابن
قدامة ج3 ص417 والشرح الكبير لابن قدامة ج3 ص247 والمحلى لابن
حزم ج7 ص100 و 120 ونيل الأوطار للشوكاني ج5 ص56 وتهذيب
الأحكام ج5 ص25 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج11 ص240 و (ط دار
الإسلامية) ج8 ص172 ومستطرفات السرائر لابن إدريس الحلي ص552
وعوالي اللآلي ج2 ص235 والبحار ج21 ص404 وج30 ص607 وج96 ص95
وجامع أحاديث الشيعة ج10 ص331 و451 والغدير ج6 ص214 واختلاف
الحديث للشافعي ص567 وكتاب المسند للشافعي ص112 و 196 ومسند
أحمد ج3 ص293 و 320 و 366 و 405 وج4 ص175 وسنن أبي داود ج1
ص402 و 426 والسنن الكبرى للبيهقي ج4 ص326 و 338 وج5 ص6 و 7
وعمدة القاري ج9 ص186 وج10 ص122 وتحفة الأحوذي ج3 ص584 وعون
المعبود ج5 ص258 ومسند أبي داود ص233 والمصنف للصنعاني ج7 ص504
ومسند أبي يعلى ج4 ص26 و 94 وج12 ص108 والمنتقى من السنن
المسندة ص122 وشرح معاني الآثار ج2 ص191 و 192وصحيح ابن حبان
ج9 ص227 و 232 و 235 و 252 و 255 والمعجم الكبير ج7 ص119 و 120
و 121 و 122 و 127 وسنن الدارقطني ج2 ص248 ومعرفة السنن
والآثار ج3 ص488 و 513 والتمهيد لابن عبد البر ج10 ص106 والدرر
لابن عبد البر ص262 و 265 وتخريج الأحاديث والآثار ج1 ص423 و
424 ونصب الراية ج3 ص206 وأحكام القرآن للجصاص ج1 ص321 وتفسير
البغوي ج4 ص492 والجامع لأحكام القرآن ج4 ص143 وتفسير القرآن
العظيم ج1 ص393 وأضواء البيان للشنقيطي ج4 ص359 و 364
والمستصفى للغـزالي ص210 والمحصول للرازي ج2 = = ص103 ومنتقى
الجمان ج3 ص108 وتهذيب الكمال ج10 ص215 وذكر أخبار إصبهان ج1
ص297 وج2 ص12 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص703 والبداية والنهاية
ج5 ص160 و 165 والبداية والنهاية ج7 ص169 وإعلام الورى ج1 ص261
وعيون الأثر ج2 ص344 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص280 و 291
وسبل الهدى والرشاد ج7 ص139 وج8 ص467 والسيرة الحلبية ج3 ص320
والفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص138 والفتوحات المكية لابن
العربي ج1 ص76.
([69])
راجع: الغدير ج6 ص215 عن صحيح البخاري ج2 ص556 وعن مسلم ج3 ص70
وج1 ص355 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص13 وج4 ص344 و 352 والجامع
الصحيح للترمذي ج3 ص271 وسنن ابن ماجة ج2 ص991 وسنن الدارمي ج2
ص51 وسنن أبي داود ج2 ص156 وسنن النسائي ج5 ص181 وعن تفسير
القرآن العظيم لابن كثير ج1 ص230.
([70])
عون المعبود للعظيم آبادي ج5 ص171 وتنقيح التحقيق في أحاديث
التعليق للذهبي ج2 ص19 وأضواء البيان للشنقيطي ج4 ص359.
([71])
الغدير ج6 ص215 عن زاد المعاد ج1 ص207 و 208 ونيل الأوطار
للشوكاني ج5 ص63 وعون المعبود ج5 ص171.
([72])
سنن أبي داود ج2 ص157 والمجموع للنووي ج7 ص157 والمغني لابن
قدامة ج3 ص237 ونيل الأوطار ج5 ص58 وتهذيب الكمال ج15 ص439
والبداية والنهاية ج5 ص159 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص279
والفتوحات المكية لابن العربي ج1 ص748.
([73])
عمدة القاري ج9 ص 199 والمغني لابن قدامة ج3 ص238.
([74])
شرح الموطأ للزرقاني ج2 ص266 ونيل الأوطار للشوكاني ج 5 ص 58.
([75])
عون المعبود ج5 ص152.
([76])
شرح الموطأ للزرقاني ج2 ص266.
([77])
الإستذكار ج7 ص 488 وعمدة القاري ج1 ص186 والتمهيد لابن عبد
البر ج6 ص301 وأضواء البيان للشنقيطي ج5 ص238 والثقات لابن
حبان ج4 ص273 وتهذيب الكمال للمزي ج11 ص67 وتذكرة الحفاظ
للذهبي ج1 ص54 وسير أعلام النبلاء ج4 ص218.
([78])
عون المعبود للعظيم آبادي ج14 ص19 والتمهيد لابن عبد البر ج6
ص301.
([79])
الجامع الصحيح ج3 ص271 وعمدة القاري ج9 ص198 والمجموع لمحيى
الدين النووي ج7 ص8 و 168 والمغني لابن قدامة ج3 ص237 والشرح
الكبير لابن قدامة ج3 ص237 ونيل الأوطار للشوكاني ج5 ص57 وفقه
السنة للشيخ سيد سابق ج1 ص750 والغدير ج6 ص215 و 217 وسنن
الترمذي ج2 ص206.
([80])
الغدير ج6 ص217 عن صحيح البخاري ج2 ص567 ح1489 وعن صحيح مسلم
ج3 ص81 ح198 كتاب الحج، والسنن الكبرى للبيهقي ج4 ص345 وسنن
النسائي ج5 ص180 والمجموع للنووي ج7 ص9 والبحار ج30 ص616
والغدير ج6 ص217 ومسند أحمد ج1 ص261 وسنن أبي داود ج1 ص442
والسنن الكبرى للبيهقي ج4 ص345 وفتح الباري ج3 ص337 وعمدة
القاري ج9 ص199 وصحيح ابن حبان ج9 ص81 والمعجم الكبير للطبراني
ج11 ص18 ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ج3 ص499 والجامع لأحكام
القرآن ج2 ص393 وأضواء البيان للشنقيطي ج4 ص357.
([81])
الغدير ج6 ص219 عن صحيح البخاري (ط سنة 1372هـ) ج3 ص69 وسنن
النسائي ج5 ص148 وسنن البيهقي ج5 ص22 وج4 ص52 ومسند أحمد ج1
ص136 والسنن الكبرى للبيهقي ج4 ص352 وج5 ص22 ومسند سليمان بن
داود الطيالسي ص16 ومسند أبي يعلى ج1 ص342 وكنز العمال ج5 ص160
وسير أعلام النبلاء ج21 ص409 والشفا للقاضي عياض ج2 ص14
والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص279 والبداية والنهاية ج5 ص159.
([82])
الغدير ج6 ص219 وعن صحيح البخاري ج2 ص569 وعن مسلم ج3 ص168
ح159والمجموع للنووي ج7 ص156 والبحار ج30 ص613 و 633 وصحيح
البخاري ج2 ص153 وفتح الباري لابن حجر ج3 ص336 وعمدة القاري ج9
ص198 وتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق للذهبي ج2 ص15 ونصب
الراية للزيلعي ج3 ص199 وأحكام القرآن لإبن العربي ج1 ص181
والدر المنثور ج1 ص216 والبداية والنهاية لابن كثير ج5 ص144
والبداية والنهاية ج5 ص146 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص248
وج4 ص253.
([83])
الغدير ج6 ص219و220 وجامع بيان العلم ج2 ص30 ومختصر جامع بيان
العلم ص198والأحكام لابن حزم ج 6 ص 785.
|