حج النبي
 برواية الإمام الصادق
برواية الإمام الصادق

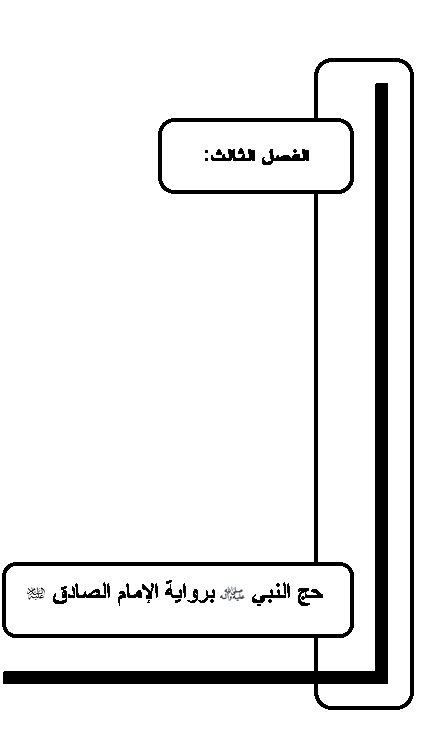
ثم نهض رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى أن نزل بذي
طوى، وهي المعروفة اليوم بآبار الزاهر، فبات بها ليلة الأحد، لأربع
خلون من ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه، ونهض إلى مكة من
أعلاها من الثنية العليا، التي تشرف على الحجون.
وكان في العمرة يدخل من أسفلها، وفي الحج دخل من أعلاها
وخرج من أسفلها.
ثم سار حتى دخل المسجد ضحى.
وعن ابن عمر قال:
دخل رسول الله «صلى الله عليه وآله» ودخلنا معه من باب
عبد مناف، وهو الذي تسميه الناس: «باب بني شيبة»([1]).
وخرج من باب بني مخزوم (إلى الصفا).
فلما نظر إلى البيت، واستقبله ورفع يديه وكبر، وقال:
«اللهم أنت السلام، ومنك السلام،
فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفاً، وتعظيماً، وتكريماً،
ومهابةً، وزد من عظَّمه، ممن حجه أو اعتمره، تكريماً وتشريفاً،
وتعظيماً وبراً»([2]).
ونقول:
إن المروي بسند صحيح عن صادق أهل
البيت «عليهم السلام»:
أنه «صلى الله عليه وآله»: «فلما دخل مكة دخل من أعلاها
من العقبة، وخرج حين خرج من ذي طوى»([3]).
وفي نص آخر:
«دخل من أعلى مكة، من عقبة المدنيين، وخرج من أسفل مكة،
من ذي طوى»([4]).
وحيث إنه قد وردت عن أهل بيت النبي «عليهم السلام»
روايات صحيحة السند تصف لنا حج رسول الله «صلى الله عليه وآله».. نرى
أن عرضها للقارئ الكريم ضروري جداً، ليأخذ الحقيقة من أهل الحقيقة، فإن
أهل البيت أدرى بما فيه..
وقد رأينا تقديم ذكرها على التفاصيل التي يذكرها أتباع
غير أهل البيت، لكي تكون رواياتهم «عليهم السلام» هي المعيار والميزان
للصحيح من الفاسد، والحقيقي من المزيف..
وبما أن هذه الروايات قد تعددت، فقد رأينا أن نأتي
بخلاصة جامعة لما تضمنته من جزئيات وخصوصيات، مقتصرين منها على ما
أورده الكليني «قدس الله نفسه الزكية» في باب «حج النبي «صلى الله عليه
وآله»..» وخصوصاً الروايات التي جاءت مطولة ومفصلة، فنقول:
في صحيحة معاوية بن عمار عن الإمام الصادق «عليه
السلام» قال:
أنزل الله عز
وجل عليه: {وَأَذِّنْ
فِي النَّاسِ بِالحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ
يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ}([5])،
فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم: بأن رسول الله «صلى الله عليه
وآله» يحج في عامه هذا، فعلم به من حضر المدينة، وأهل العوالي
والأعراب، واجتمعوا لحج رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وإنما كانوا
تابعين ينظرون ما يؤمرون ويتبعونه، أو يصنع شيئاً فيصنعونه([6]).
وفي صحيح عبد الله بن سنان عن
الإمام الصادق «عليه السلام» قال:
ذكر رسول الله «صلى الله عليه وآله» الحج، فكتب إلي([7]):
من بلغه كتابه ممن دخل في الإسلام: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله»
يريد الحج، يؤذنهم بذلك، ليحج من أطاق الحج([8]).
وفي صحيح معاوية بن عمار:
فخرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» في أربع بقين من
ذي القعدة، فلما انتهى إلى ذي الحليفة زالت الشمس، فاغتسل ثم خرج حتى
أتى المسجد الذي عند الشجرة، فصلى فيه الظهر، وعزم بالحج مفرداً، وخرج
حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول، فصف له سماطان، فلبى بالحج
مفرداً، وساق الهدي ستاً وستين، أو أربعاً وستين([9])
حتى انتهى إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجة([10]).
وفي صحيح الحلبي عن علي «عليه
السلام»:
خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة، فصلى
بها، ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء، فأحرم منها، وأهل بالحج، وساق
مائة بدنة، وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة، ولا يدرون ما المتعة([11]).
وفي صحيح ابن سنان:
فأقبل الناس، فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط،
وحلق العانة، والغسل، والتجرد في إزار ورداء، أو إزار وعمامة، يضعها
على عاتقه لمن لم يكن له رداء.
وذكر أنه حيث لبى قال:
«لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد
والنعمة لك والملك، لا شريك لك».
وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يكثر من ذي
المعارج، وكان يلبى كلما لقي راكباً، أو علا أكمة، أو هبط وادياً، وفي
آخر الليل، وفي إدبار الصلوات.
فلما دخل مكة دخل من أعلاها من العقبة، وخرج حين خرج من
ذي طوى.
فلما انتهى إلى باب المسجد استقبل الكعبة.
وذكر ابن سنان:
أنه باب شيبة، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على أبيه
إبراهيم، ثم أتى الحجر فاستلمه، فلما طاف بالبيت (وطاف الناس معه) صلى
ركعتين خلف مقام إبراهيم «عليه السلام».
ودخل زمزم فشرب منها، ثم قال:
«اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء
من كل داء وسقم»، فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة.
ثم قال لأصحابه:
ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام
الحجر، فاستلمه([12]).
وفي صحيح معاوية بن عمار:
فطاف بالبيت سبعة أشواط، ثم صلى ركعتين خلف مقام
إبراهيم «عليه السلام»، ثم عاد إلى الحجر فاستلمه، وقد كان استلمه في
أول طوافه، ثم قال:
{إِنَّ
الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَهِ}،
فابدأ بما بدأ الله تعالى.
وإن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة
شيء صنعه المشركون، فأنزل الله عز وجل:
{إِنَّ
الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ
أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا..}([13]).
ثم أتى الصفا فصعد عليه، واستقبل الركن اليماني، فحمد
الله وأثنى عليه، ودعا مقدار ما يقرء سورة البقرة مترسلاً.
ثم انحدر إلى المروة، فوقف عليها كما وقف على الصفا، ثم
انحدر وعاد إلى الصفا فوقف عليها، ثم انحدر إلى المروة حتى فرغ من سعيه([14]).
وفي صحيح الحلبي عن الإمام الصادق
«عليه السلام»:
وهو شيء أمر الله عز وجل به، فأحل الناس، وقال رسول
الله «صلى الله عليه وآله»: «لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت
كما أمرتكم»([15]).
ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي كان معه، إن
الله عز وجل يقول:
{وَلَا
تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ}([16]).
وفي صحيح معاوية بن عمار، عن الإمام الصادق «عليه
السلام»، وكذا في صحيح الحلبي باختصار: فلما فرغ من سعيه وهو على
المروة، أقبل على الناس بوجهه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن هذا
جبرئيل، وأومأ بيده إلى خلفه، يأمرني أن آمر من لم يسق هدياً أن يحل،
ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم، ولكني سقت الهدي،
ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله.
قال:
فقال له رجل من القوم: لنخرجن حجاجاً ورؤوسنا وشعورنا
تقطر؟
وفي بعض الروايات:
«وذكرنا تقطر»؟ أي من ماء المني([17]).
فقال له رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
أما إنك لن تؤمن بهذا أبداً.
فقال له سراقة بن مالك بن جعشم
الكناني:
يا رسول الله، علمنا ديننا كأنا خلقنا اليوم، فهذا الذي
أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل؟
فقال له رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
بل هو للأبد، إلى يوم القيامة، ثم شبك أصابعه وقال:
«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»([18]).
قال:
وقدم علي «عليه السلام» من اليمن على رسول الله «صلى
الله عليه وآله» وهو بمكة، فدخل على فاطمة «سلام الله عليها» وهي قد
أحلت، فوجد ريحاً طيبةً، ووجد عليها ثياباً مصبوغة، فقال: ما هذا يا
فاطمة؟
فقالت:
أمرنا بهذا رسول الله «صلى الله عليه وآله».
فخرج علي «عليه السلام» إلى رسول الله «صلى الله عليه
وآله» مستفتياً، فقال: يا رسول الله، إني رأيت فاطمة قد أحلت وعليها
ثياب مصبوغة؟
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«أنا أمرت الناس بذلك، فأنت يا علي بما أهللت»؟
قال:
يا رسول الله، إهلالاً كإهلال النبي.
فقال له رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«قرّ على إحرامك مثلي، وأنت شريكي في هديي».
قال:
ونزل رسول
الله «صلى الله عليه وآله» بمكة بالبطحاء هو وأصحابه، ولم ينزل الدور،
فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلوا
بالحج، وهو قول الله عز وجل، الذي أنزل على نبيه «صلى الله عليه وآله»:
{فَاتَّبِعُوا
مِلَّةَ
(أبيكم) إِبْرَاهِيمَ}([19]).
فخرج النبي «صلى الله عليه وآله» وأصحابه مهلين بالحج
حتى أتى منى، فصلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة، والفجر.
ثم غدا والناس معه، وكانت قريش تفيض من المزدلفة وهي
جمع، ويمنعون الناس أن يفيضوا منها، فأقبل رسول الله «صلى الله عليه
وآله» وقريش ترجو أن تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون، فأنزل الله
تعالى عليه:
{ثُمَّ
أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَهَ..}([20])،
يعني إبراهيم وإسماعيل، وإسحاق في إفاضتهم منها ومن كان بعدهم.
فلما رأت قريش أن قبة رسول الله «صلى الله عليه وآله»
قد مضت، كأنه دخل في أنفسهم شيء، للذي كانوا يرجون من الإفاضة من
مكانهم، حتى انتهى إلى نمرة، وهي بطن عرنة بحيال الأراك، فضربت قبته،
وضرب الناس أخبيتهم عندها.
فلما زالت الشمس خرج رسول الله «صلى الله عليه وآله»
ومعه قريش وقد اغتسل، وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد، فوعظ الناس وأمرهم
ونهاهم، ثم صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين.
ثم مضى إلى الموقف فوقف به، فجعل الناس يبتدرون أخفاف
ناقته يقفون إلى جانبها، فنحاها، ففعلوا مثل ذلك، فقال: «أيها الناس،
ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف، ولكن هذا كله»، وأومأ بيده إلى الموقف،
فتفرق الناس، وفعل مثل ذلك بالمزدلفة.
فوقف الناس حتى وقع القرص ـ قرص الشمس ـ ثم أفاض، وأمر
الناس بالدعة حتى انتهى إلى المزدلفة، وهو المشعر الحرام، فصلى المغرب
والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين.
ثم أقام حتى صلى فيها الفجر، وعجل ضعفاء بني هاشم بليل،
وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس.
فلما أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى، فرمى جمرة
العقبة([21]).
وفي صحيح إسماعل بن همام، عن الإمام
الحسن «عليه السلام» قال:
أخذ رسول الله «صلى الله عليه وآله» حين غدا من منى في
طريق ضب (جبل عند مسجد الخيف)، ورجع ما بين المأزمين. وكان إذا سلك
طريقاً لم يرجع فيه([22]).
وكان الهدي الذي جاء به رسول الله «صلى الله عليه وآله»
أربعة وستين أو ستة وستين.
وجاء علي «عليه السلام» بأربعة وثلاثين أو ستة وثلاثين،
فنحر رسول الله «صلى الله عليه وآله» ستة وستين، ونحر علي «صلى الله
عليه وآله» أربعة وثلاثين بدنة.
وفي الرواية الأخرى:
نحر رسول الله «صلى الله عليه وآله» ثلاثاً وستين نحرها
بيده، ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر الخ..
([23]).
وأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن يؤخذ من كل
بدنة منها جذوة من لحم، ثم تطرح في برمة، ثم تطبخ، فأكل رسول الله «صلى
الله عليه وآله» وعلي «عليه السلام»، وحسيا من مرقها([24]).
زاد في صحيح الحلبي قوله:
«قد أكلنا منها الآن جميعاً، والمتعة خير من القارن
السائق، وخير من الحاج المفرد»([25]).
وفي صحيح معاوية بن عمار:
ولم يعطيا الجزارين جلودها، ولا جلالها، ولا قلائدها،
وتصدق به، وحلق، وزار البيت ورجع إلى منى، وأقام بها حتى كان اليوم
الثالث من آخر أيام التشريق.
ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى
الأبطح، فقالت له عايشة:
يا رسول الله، ترجع نساؤك بحجة وعمرة معاً، وأرجع بحجة؟
فأقام بالأبطح، وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى
التنعيم.
فأهلت بعمرة، ثم جاءت، وطافت بالبيت وصلت ركعتين عند
مقام إبراهيم «عليه السلام»، وسعت بين الصفا والمروة، ثم أتت النبي
«صلى الله عليه وآله»، فارتحل من يومه، ولم يدخل المسجد الحرام، ولم
يطف بالبيت.
ودخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين، وخرج من أسفل مكة
من ذي طوى([26]).
وفي صحيح معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله «عليه السلام» قال:
الذي كان على بُدن رسول الله «صلى الله عليه وآله»
ناجية بن جندب الخزاعي الأسلمي، والذي حلق رأس النبي «صلى الله عليه
وآله» في حجته معمر بن عبد الله بن حراثة بن نصر بن عوف بن عويج بن عدي
بن كعب.
قال:
ولما كان في حجة رسول الله «صلى الله عليه وآله» وهو
يحلقه، قالت قريش: أي معمر! أُذُنُ رسول الله «صلى الله عليه وآله» في
يدك، وفي يدك الموسى؟!
فقال معمر:
والله، إني لأعده من الله فضلاً عظيماً علي.
قال:
وكان معمر هو الذي يرحل لرسول الله «صلى الله عليه
وآله»، فقال رسول الله: «يا معمر، إن الرحل الليلة لمسترخى».
فقال معمر:
بأبي أنت وأمي، لقد شددته كما كنت أشده، ولكن بعض من
حسدني مكاني منك يا رسول الله أراد أن تستبدل بي.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«ما كنت لأفعل»([27]).
ونقول:
إن النصوص المتقدمة وإن كانت مأخوذة من روايات صحيحة
السند، ولكنها تحتاج أيضاً إلى بعض التوضيح والبيان، فنقول:
جاء في رواية الصدوق للخبر الأخير عن الإمام الصادق
«عليه السلام» فقرة أخرى لم يوردها الكليني، وهي قوله: «والذي حلق رأسه
«عليه السلام» يوم الحديبية خراش بن امية الخزاعي».
وفيه أيضاً:
«كان معمر بن عبد الله يرجل شعره «عليه السلام»..».
قال المجلسي «رحمه الله»:
لعل الأصل يرحل بعيره، فصحفوه بقولهم: يرجل شعره، لعله
لكونه يناسب الحلق.
قال البيضاوي ـ على ما نقله عنه
المجلسي ـ:
«وقوله تعالى:
{ثُمَّ
أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}([28]).
أي من عرفة، لا من المزدلفة، والخطاب مع قريش لما كانوا يقفون بالجمع،
وساير الناس بعرفه، ويرون ذلك ترفعاً عليهم، فأمروا بأن يساووهم.
إلى أن قال:
والمعنى أن الإفاضة من عرفة شرع قديم فلا تغيروه»([29]).
وبذلك يكون الله تعالى، ورسوله قد بينا بصورة عملية أن
لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى.
أحرم
 من المسجد: من المسجد:
تقدم في صحيح الحلبي:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قاد راحلته حتى أتى
البيداء، فأحرم منها.
قال العلامة المجلسي:
«لعل المراد بالإحرام هنا عقد الإحرام بالتلبية، أو
إظهار الإحرام وإعلامه، لئلا ينافي الأخبار المستفيضة الدالة على أنه
«صلى الله عليه وآله» أحرم من مسجد الشجرة»([30]).
وذكرت صحيحة الحلبي أيضاً:
أنه «صلى الله عليه وآله» ساق مائة بدنة.
والمراد ـ كما ذكره العلامة المجلسي
أيضاً ـ:
أنه «صلى الله عليه وآله» ساق مائة، لكن ساق بضعاً
وستين لنفسه، والباقي لأمير المؤمنين «عليه السلام»، لعلمه بأنه «عليه
السلام» يحرم كإحرامه، ويهل كإهلاله الخ..([31]).
أو المراد:
أنه «صلى الله عليه وآله» هو وعلي «عليه السلام» قد
ساقا مائة بدنة، فنسب ما جاء به علي «عليه السلام» إلى النبي «صلى الله
عليه وآله» لأنه أخوه، ولأنه أهلّ بما أهلَّ به رسول الله «صلى الله
عليه وآله» واشتركا في مجموع المائة.
قال الفيض الكاشاني «رحمه الله»
تعليقاً على الرواية الأخيرة:
«كأن قريشاً كنوا بما قالوا عن قدرة معمر على قتل رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، وتمنوا أن لو كانوا مكانه، فقتلوه. وربما
يوجد في بعض نسخ الكافي: «أذى» بدل «أذن».
والمعنى حينئذ:
أن ما يوجب الأذى من شعر الرأس وشعثه منه «صلى الله
عليه وآله» في يدك، كأنه تعيير منهم إياه بهذا الفعل في حسبه ونسبه،
وهذا أوفق للجواب من الأول»
([32]).
حج النبي
 قران!!
أم تمتع؟!: قران!!
أم تمتع؟!:
لقد كان حج النبي «صلى الله عليه وآله» في حجة الوداع
حج قران لا حج تمتع ولا إفراد.. وقد تحير أتباع غير أهل البيت «عليهم
السلام» في هذا الأمر، واختلفوا فيه..
ونحن نذكر ما قالوه مستفيدين من عبارة الصالحي الشامي
أكثر من غيره، ثم نناقش أو نبين بعض ما قالوه وفق ما يتيسر لنا، فنقول:
قالوا:
وساق هديه مع نفسه، و دعا ببدنته، وفي رواية: بناقته
فأشعرها في صفحة سنامها من الشق الأيمن، ثم سلت الدم عنها، وقلدها
نعلين، وتولى إشعار بقية الهدي وتقليده غيره، وكان معه «صلى الله عليه
وآله» هدي كثير.
قال ابن سعد:
وكان على هديه ناجية بن جندب الأسلمي، وكان جميع الهدي
الذي ساقه من المدينة([33]).
«فلما صلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» الصبح أخذ في
الإحرام، فاغتسل غسلاً ثانياً، غير الغسل الأول، وغسل رأسه بخطمي
وأُشنان، ودهن رأسه بشيء من زيت غير كثير»([34]).
وعن ابن عمر قال:
«كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يدّهن بالزيت ـ
وهو محرم ـ غير المقتت»([35]).
وفي حديث أبي أيوب عند الشيخين:
أنه «صلى الله عليه وآله» في غسله حزك رأسه (أي ضغطه)
بيديه جميعاً، فأقبل بهما وأدبر، وطيبته بذريرة وطيب فيه مسك([36])،
وبالغالية الجيدة ـ كما رواه الدارقطني، والبيهقي ـ في بدنه ورأسه حتى
كان وَبِيص المسك يرى من مفارقه، ولحيته الشريفة «صلى الله عليه وآله»([37]).
ثم استدامه، ولم يغسله.
وعن عائشة قالت:
كأني أنظر إلى وَبِيص الطيب في مفرق رسول الله «صلى
الله عليه وآله» بعد أيام وهو محرم([38]).
ولما كان بسرف قال «صلى الله عليه
وآله» لأصحابه:
«من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن
كان معه هدي فلا».
قال ابن القيم:
وهذا رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات، فلما كان
بمكة، أمر أمراً حتماً من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، ويحل من
إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، ولم ينسخ ذلك شيء البتة.
وقد روي عنه «صلى الله عليه وآله» الأمر بفسخ الحج إلى
العمرة أربعة عشر من الصحابة، وأحاديثهم صحاح، وسرد أسماءهم([39]).
ولم يحل هو «صلى الله عليه وآله» من أجل هديه، فحل
الناس كلهم إلا النبي «صلى الله عليه وآله» ومن كان معه هدي، ومنهم أبو
بكر وعمر، وطلحة والزبير، وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما
سقت الهدي، ولجعلتها عمرة».
وهناك سأله سراقة بن مالك بن جشم، وهو في أسفل الوادي،
لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة والإحلال: يا رسول الله، ألعامنا هذا
أم للأبد؟
فشبك رسول الله «صلى الله عليه وآله» أصابعه واحدة في
الأخرى، فقال: «لا»، ثلاث مرات.
ثم قال:
«دخلت العمرة في الحج ـ مرتين أو ثلاثاً ـ إلى الأبد»،
فحل الناس كلهم إلا النبي «صلى الله عليه وآله» ومن كان معه هدي([40]).
وأمر «صلى الله عليه وآله» من لم يسق الهدي بفسخ الحج
إلى العمرة، رواه عنه خلائق من الصحابة.
وقد اختلفوا في ذلك، فقال مالك،
والشافعي:
كان ذلك من خصائص الصحابة، ثم نسخ جواز الفسخ كغيرهم،
وتمسكوا بما رواه مسلم، عن أبي ذر: لم يكن فسخ الحج إلى العمرة إلا إلى
أصحاب محمد «صلى الله عليه وآله»([41]).
وأما أحمد فرد ذلك، وجوّز الفسخ لغير الصحابة.
وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثاً، وللمقصرين مرة.
فأما نساؤه فأحللن، وكن قارنات إلا عائشة، فإنها لم تحل
من أجل تعذر الحل عليها بحيضتها، وفاطمة حلت، لأنها لم يكن معها هدي،
وعلي لم يحل من أجل هديه.
وأمر من أهل بإهلال كإهلاله «صلى الله عليه وآله» أن
يقيم على إحرامه، إن كان معه هدي، وأن يحل من لم يكن معه هدي([42]).
قال الصالحي الشامي:
اختلف في ذلك على أربعة أقوال:
الأول: الإفراد بالحج.
روى الشافعي وأحمد، والشيخان، والنسائي عن عائشة.
وأحمد، ومسلم، وابن ماجة، والبيهقي عن جابر بن عبد
الله.
وأحمد، ومسلم، والبزار، عن عبد الله بن عمر.
ومسلم، والدارقطني، والبيهقي، عن ابن عباس: «أنه - «صلى
الله عليه وآله» أهل بالحج مفرداً»([43]).
الثاني: القران.
روى أحمد، والبخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة
والبيهقي عن عمر بن الخطاب.
وأحمد عن عثمان.
وأحمد والبخاري، وابن حبان، عن علي.
وأحمد، والنسائي، والشيخان، والبزار، والبيهقي، عن أنس.
والترمذي، وابن ماجة، والبزار، والدارقطني، والبيهقي،
عن جابر بن عبد الله.
وأحمد، وابن ماجة، عن أبي طلحة، زيد بن سهل الأنصاري.
وأحمد، عن سراقة بن مالك.
ومالك، وأحمد، والترمذي وصححه، والنسائي عن سعد بن أبي
وقاص.
والطبراني، عن عبد الله بن أبي أوفى.
وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، عن ابن عباس.
وأحمد ومسلم، والنسائي، والدارقطني، عن الهرماس بن
زياد.
وأبو يعلى، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
وأحمد، والشيخان، عن ابن عمرو.
وأحمد، عن عمران بن حصين.
والدارقطني، عن أبي قتادة.
والترمذي ـ وحسنه ـ عن جابر بن عبد الله.
وأحمد، عن حفصة.
والشيخان، والبيهقي، عن عائشة: «أن رسول الله «صلى الله
عليه وآله» كان قارناً»([44]).
الثالث: التمتع.
عن ابن عمر قال:
تمتع رسول الله «صلى الله عليه وآله» في حجة الوداع
بالعمرة، إلى الحج، وأهدى، فساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله
«صلى الله عليه وآله» فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج. الحديث([45]).
وعن
عائشة عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في تمتعه بالعمرة إلى الحج:
وتمتع الناس معه([46]).
وعن ابن عباس قال:
«قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «هذه عمرة
استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحِلَّ كلَّه، فإن العمرة
قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة»([47]).
وعن حفصة أنها قالت:
يا رسول الله، ما شأن الناس حلُّوا بعمرة؟ ولم تحلل أنت
من عمرتك؟
قال:
«إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر»([48]).
وعن ابن عباس قال:
«تمتع رسول الله «صلى الله عليه وآله» وأبو بكر، وعمر،
وعثمان، وأول من نهى عنه معاوية»([49]).
وعن ابن عباس، عن معاوية قال:
«قصرت عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» بمشقص»، زاد
مسلم، فقلت: «لا أعلم هذه إلا حجة عليك»([50]).
وعن عطاء، عن معاوية قال:
«أخذت من أطراف شعر رسول الله «صلى الله عليه وآله»
بمشقص كان معي، بعد ما طاف بالبيت، وبالصفا والمروة، في أيام العشر»([51]).
قال قيس بن سعد الراوي، عن عطاء:
«والناس ينكرون هذا على معاوية»([52]).
وروى البخاري عن ابن عمر قال:
«اعتمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» قبل أن يحج»([53]).
الرابع: الإطلاق.
عن عائشة قالت:
خرجنا مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا نذكر حجاً
ولا عمرة، وفي لفظ: «نلبي لا نذكر حجاً ولا عمرة»، وفي لفظ: «خرجنا مع
رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا نرى إلا الحج. حتى إذا دنونا من
مكة، أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» من لم يكن معه هدي إذا طاف
بين الصفا والمروة، أن يحل»([54]).
وفي نص آخر:
«خرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» من المدينة لا
يسمي حجاً ولا عمرة، ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء بين الصفا
والمروة، فأمر أصحابه من كان منهم أهلَّ ولم يكن معه هدي أن يجعلها
عمرة..»([55])
الحديث.
فهذه أربعة أقوال:
الإفراد، والقران، والتمتع، والإطلاق، ورجحا أنه «صلى
الله عليه وآله» كان قارناً، ورجحه المحب الطبري، والحافظ، وغيرهم.
قال:
أهلَّ في مصلاه، ثم ركب ناقته، فأهل أيضاً، ثم أهلَّ
لما استقلت به على البيداء، وكان يُهِلُّ بالحج والعمرة تارة، وبالعمرة
تارة، وبالحج تارة، لأن العمرة جزء منه، فمن ثم قيل: قرن. وقيل: تمتع،
وقيل: أفرد، وكل ذلك وقع بعد صلاة الظهر، خلافاً لابن حزم، وصاحب
الاطلاع.
قال النووي، والحافظ:
وطريق الجمع بين الأحاديث، وهو الصحيح: أنه «صلى الله
عليه وآله» كان أولاً مفرداً بالحج، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك، وأدخلها
على الحج فصار: قارناً، فمن روى الإفراد هو الأصل، ومن روى القران
اعتمد آخر الأمر، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي، وهو الانتفاع
والإرتفاق([56]).
وذكروا ترجيحات لقول من رأى أنه «صلى الله عليه وآله»
كان قارناً:
وذلك من وجوه، كما قال في زاد الميعاد.
الأول:
أنهم أكثر.
الثاني:
أن طريق الإخبار بذلك تنوعت.
الثالث:
أن فيهم من أخبر عن سماعه لفظه «صلى الله عليه وآله»
صريحاً، وفيهم من أخبر عن نفسه بأنه فعل ذلك، ومنهم من أخبر عن أمر ربه
بذلك، ولم يجئ شيء من ذلك في الإفراد.
الرابع:
تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربعاً، وأوضح ذلك ابن
كثير بأنهم اتفقوا على أنه «صلى الله عليه وآله» اعتمر عام حجة الوداع،
فلم يتحلل بين النسكين، ولا أنشأ إحراماً آخر للحج، ولا اعتمر بعد
الحج، فلزم القران، قال: وهذا مما يفسر الجواب عنه انتهى([57]).
الخامس:
أنها صريحة لا تحتمل التأويل، بخلاف روايات الإفراد،
كما سيأتي.
السادس:
أنها متضمنة زيادة سكت عنها من روى الإفراد، أو نفاها،
والذاكر والزائد مقدم على الساكت، والمثبت مقدم على النافي.
السابع:
روى الإفراد أربعة: عائشة، وابن عمر، وجابر، وابن عباس،
وغيرهم رووا القران، فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت رواية من عداهم
للقران عن معارض، وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب
الرواية عنه ولا اختلفت، كعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأنس،
والبراء، وعمران بن حصين، وأبي طلحة، وسراقة بن مالك، وسعد بن أبي
وقاص، وعبد الله بن أبي أوفى، وهرماس بن زياد.
الثامن:
أنه النسك الذي أُمِرَ به من ربه، كما تقدم فلم يكن
ليعدل عنه.
التاسع:
أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي، فلم يكن
ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي، ثم يسوق هو الهدي ويخالفه.
العاشر:
أنه النسك الذي أمر به له ولأهل بيته، واختاره لهم، ولم
يكن يختار لهم إلا ما اختار لنفسه.
الحادي عشر:
قوله: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، يقتضي
أنها صارت جزءاً منه أو كالجزء الداخل فيه بحيث لا يفصل بينه وبينه،
وإنما يكون كالداخل في الشيء معه.
الثاني عشر:
قول عمر: للصبي بن معبد ـ وقد أهل بحج وعمرة ـ فأنكر
عليه زيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة، فقال له عمر: هديت لسنة نبيك «صلى
الله عليه وآله» وهذا يوافق رواية عمر: أنه الوحي جاء من الله بالإهلال
بهما جميعاً، فدلَّ على أن القران سنة التي فعلها، وامتثل أمر الله
تعالى بها.
قال ابن كثير:
والجمع بين رواية من روى أنه أفرد الحج، وبين رواية من
روى القران، أنه أفرد أفعال الحج، ودخلت فيه العمرة نيةً وفعلاً
وقولاً، واكتفى بطواف الحج وسعيه عنه وعنها، كما في مذهب الجمهور في
القارن خلافاً لأبي حنيفة.
وأما من روى التمتع وصح عنه أنه روى القران، فالتمتع في
كلام السلف أعم من التمتع الخاص، والأوائل يطلقونه على الإعتمار في
أشهر الحج، وإن لم يكن معه حج.
قال سعد بن أبي وقاص:
تمتعنا مع رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وإنما يريد
بهذا إحدى العمرتين المتقدمتين: إما الحديبية، وإما القضاء، فأما عمرة
الجعرانة، فإنها كانت بعد الفتح، وحجة الوداع بعد ذلك سنة عشر.
وأما حديث ابن عمر وعائشة السابقان، فقد رويا التمتع،
فهو مشكل على الأقوال، أما قول الإفراد ففي هذا إثبات عمرة إما قبل
الحج أو معه، وأما على قول التمتع الخاص، فإنه ذكر أنه لم يحل من
إحرامه بعدما طاف بالصفا والمروة، وليس هذا شأن المتمتع([58]).
([1])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص461و462 عن الطبراني، وراجع: المعجم
الأوسط للطبراني ج3 ص238.
([2])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص462 وفي هامشه عن: البيهقي ج5 ص73.
([3])
الكافي (الفروع) ج4 ص250 والبحار ج21 ص 296 و397 والوسائل (ط
مؤسسة آل البيت) ج11 ص224و (ط دار الإسلامية) ج8 ص158 وذخيرة
المعاد (ط.ق) ج1 ق 3 ص579.
([4])
الكافي (الفروع) ج4 ص248 والبحار ج21 ص393 وجامع أحاديث الشيعة
ج10 ص355.
([5])
الآية 77 من سورة الحج.
([6])
الكافي (الفروع) ج4 ص245 والحدائق الناضرة ج 14 ص316 والفصول
المهمة ج1 ص649 والبحار ج21 ص390 والتفسير الصافي ج3 ص374
وتفسير نور الثقلين ج1 ص146 وتفسير كنز الدقائق ج1 ص386.
([7])
كذا في الأصل، ولعل الصحيح «إلى» بالمقصورة، وقد وقع فيها
تصحيف، فلاحظ.
([8])
الكافي (الفروع) ج4 ص249 والحدائق الناضرة ج15 ص58 والوسائل (ط
مؤسسة آل البيت) ج11 ص224 و (ط دار الإسلامية) ج8 ص158
والبحار ج21 ص396 وجامع أحاديث الشيعة ج10 ص359 ومكاتيب الرسول
ج1 ص282 ومنتقى الجمان ج3 ص163.
([10])
الكافي (الفروع) ج4 ص245 والبحار ج21 ص390 و جامع أحاديث
الشيعة ج10 ص454 وتفسير نور الثقلين ج3 ص487 وتفسير كنز
الدقائق ج1 ص387.
([11])
الكافي (الفروع) ج4 ص248و249 وذخيرة المعاد (ط.ق) ج1 ق3 ص551
والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج11 ص222 و (ط دار الإسلامية) ج8
= = ص157 ومستدرك الوسائل ج8 ص76 والبحار ج21 ص395 وج96 ص88
وجامع أحاديث الشيعة ج10 ص356 وج10 ص455 و 499.
([12])
الكافي (الفروع) ج4 ص249و250 وذخيرة المعاد (ط.ق) ج1 ق3 ص579
والحـدائـق النـاضرة ج15 ص58 ومستنـد الشيعـة ج11 ص175 وج11 =
= ص290 ودعائم الإسلام ج1 ص298 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت)
ج11 ص224 و (ط دار الإسلامية) ج8 ص158 والبحار ج21 ص396 وجامع
أحاديث الشيعة ج10 ص359 و 499 وج11 ص14 وجامع أحاديث الشيعة
ج11 ص17 ومنتقى الجمان ج3 ص163.
([13])
الآية 158 من سورة البقرة.
([14])
الكافي (الفروع) ج4 ص245 و 246 وذخيرة المعاد (ط.ق) ج1 ق3 ص632
وج1 ق3 ص644 وكشف اللثام (ط.ق) ج1 ص341 والحدائق الناضرة ج14
ص316 ومستند الشيعة ج12 ص159.
([15])
الكافي ج4 ص249 وعلل الشرائع ج2 ص413 والوسائل (ط مؤسسة آل
البيت) ج11 ص222 و (ط دار الإسلامية) ج8 ص157 والبحار ج21
ص395 وج96 ص89 وتفسير نور الثقلين ج1 ص185 وتفسير كنز الدقائق
ج1 ص466.
([16])
الآية 196 من سورة البقرة.
([17])
راجع المصادر في الهوامش السابقة.
([18])
مرآة العقول ج17 ص113 وجواهر الكلام ج18 ص3 والكافي ج4 ص246 و
ومنتهى المطلب (ط.ق) ج2 ص886 والحدائق الناضرة ج14 ص316 ومستند
الشيعة ج11 ص217 وجامع المدارك ج2 ص568 وتهذيب الأحكام ج5 ص455
والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج11 ص215 و (ط دار الإسلامية) ج8
ص151 والبحار ج21 ص391 وجامع أحاديث الشيعة ج10 ص352 وفقه
القرآن للراوندي ج1 ص266 ومنتقى الجمان ج3 ص123.
([19])
الآية 95 من سورة آل عمران.
([20])
الآية 95 من سورة آل عمران.
([21])
الكافي (الفروع) ج4 ص245 ـ 247 وجامع أحاديث الشيعة ج10 ص350 ـ
354.
([22])
الكافي (الفروع) ج4 ص248 ومن لا يحضره الفقيه ج2 ص237 والوسائل
(ط مؤسسة آل البيت) ج11 ص458 و (ط دار الإسلامية) ج8 ص336
والبحار ج21 ص395 وجامع أحاديث الشيعة ج11 ص463 وسنن النبي
«عليه السلام» للسيد الطباطبائي ص62 ومنتقى الجمان ج3 ص346.
([23])
الكافي (الفروع) ج4 ص249 وذخيرة المعاد (ط.ق) ج1 ق3 ص551 وعلل
الشرائع ج2 ص413 والبحار ج96 ص89.
([24])
الكافي (الفروع) ج4 ص246 ـ 248 ومجمع الفائدة ج7 ص286 وذخيرة
المعاد (ط.ق) ج1 ق3 ص670 وج1 ق3 ص670 والحدائق الناضرة ج14
ص318 وجواهر الكلام ج19 ص159 وجامع المدارك ج2 ص462 وتهذيب
الأحكام ج5 ص457 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج11 ص217 وج14
ص163 و (ط دار الإسلامية) ج8 ص153 وج10 ص144 والبحار ج21 ص393
و 395 وجامع أحاديث الشيعة ج10 ص354 وج12 ص101 وج12 ص104
ومنتقى الجمان ج3 ص125 وج3 ص373 وج3 ص401 وراجع المغني لابن
قدامة ج11 ص109 والشرح الكبير لابن قدامة ج3 ص579 وج3 ص582
والتمهيد لابن عبد البر ج2 ص111 وتفسير البغوي ج3 ص284.
([25])
الكـافي (الفـروع) ج4 ص249 وذخـيرة المعـاد (ط.ق) ج1 ق3
ص551 = = والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج11 ص223 و (ط دار
الإسلامية) ج8 ص158 والبحار ج21 ص396 وجامع أحاديث الشيعة ج10
ص343 و 357 وتفسير الميزان للسيد الطباطبائي ج2 ص84 ومنتقى
الجمان ج3 ص122.
([26])
الكافي (الفروع) ج4 ص248 والحدائق الناضرة ج14 ص319 وجامع
المدارك ج2 ص491 وتهذيب الأحكام ج5 ص457 والبحار ج21 ص389 و
393 وجامع أحاديث الشيعة ج10 ص355 وج11 ص271 و 272 وج12 ص207
وتفسير مجمع البيان ج2 ص42 ومنتقى الجمان ج3 ص254.
([27])
الكافي (الفروع) ج4 ص250 و 251 ومن لا يحضره الفقيه ج2 ص339
وتهذيب الأحكام ج5 ص458 والبحار ج21 ص400 وجامع الرواة ج2 ص253
ومعجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج19 ص 288.
([28])
الآية 95 من سورة آل عمران.
([29])
راجع: مرآة العقول ج17 ص114 وتفسير البيضاوي (ط دار الفكر) ج1
ص487 وتفسير أبي السعود ج1 ص209.
([30])
راجع: مرآة العقول ج17 ص116.
([31])
راجع: مرآة العقول ج17 ص116.
([32])
راجع: مرآة العقول ج17 ص119 وهامش كتاب الكافي ج4 ص251.
([33])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص451 و 452 وراجع: الطبقات الكبرى ج2
ص124.
([34])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص452 عن أحمد، والبزار، والطبراني،
والدراقطني عن عائشة، وفي هامشه عن: مسند أحمد ج6 ص78 والبزار
كما في الكشف ج2 ص11 (1085) والدارقطني ج2 ص226.
([35])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص452 عن الترمذي، وابن ماجة وفي هامشه
عن: الترمذي ج3 ص294 (962) وابن ماجة ج2 ص1030 (3083) وضعفه
البوصيري في الزوائد، وراجع: مسند أحمد ج2 ص25 و 59 وعمدة
القاري ج9 ص154 والمصنف لابن أبي شيبة ج4 ص439.
([36])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص452 عن البخاري، ومسلم وفي هامشه عن:
البخاري ج10 ص384 (5930) ومسلم ج2 ص147 (35/1189) والدارقطني
ج2 ص222 والبيهقي ج5 ص35.
([37])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص452 وفي هامشه عن: البيهقي ج5 ص34.
([38])
سبل الهـدى والرشـاد ج8 ص452 و 453 عن الحميدي، وأحمـد، وأشـار
في = = هامشه إلى: مسند أحمد ج6 ص124 (و 109 و 128 و 130 و 175
و 186 و 212 و 245 و 250 و 254 و 256 و280 ) وهو عند البخاري
ج3 ص463 (1538) ومسلم (39/119) وراجع: المجموع للنووي وج7 ص215
وإعانة الطالبين ج2 ص350 ومغني المحتاج ج1 ص479 والبحر الرائق
ج2 ص562 والمحلى لابن حزم ج7 ص86 وتلخيص الحبير ج1 ص193 ونيل
الأوطار ج5 ص 33 و 76 وفقه السنة ج1 ص655 وصحيح البخاري ج1 ص72
وصحيح مسلم ج4 ص11وسنن ابن ماجة ج2 ص977 وسنن النسائي ج5 ص140
و 141 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص34 و 35 وعمدة القاري ج3 ص221
مسند أبي داود الطيالسي ص197 و 198 و 199 ومسند ابن الجعد ص47
وغير ذلك من مصارد فراجع.
([39])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص461 وراجع: زاد المعاد ج1 ص246.
([40])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص466 و 467.
([41])
البداية والنهاية ج5 ص184 وج5 ص184 والسيرة النبوية لابن كثير
ج4 ص331 وسبل الهدى والرشاد ج8 ص467.
([42])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص467 عن الطبراني برجال ثقات، وراجع:
عيون الأثر ج2 ص344 ومسند أحمد ج6 ص274.
([43])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص455 وقال في هامشه: حديث عائشة عند
الشافعي في المسند ج6 ص104 والبخاري ج3 ص492 (1562) ومسلم ج2
ص875 (122/1211) ومالك ج1 ص335 (37) والنسائي ج5 ص112 وأخرجه
ابن ماجة ج2 ص988 (2966) وحـديـث جـابر أخرجه مسلم (2/881) = =
حديث (136/1213). وراجع: المجموع للنووي ج7 ص153 ونيل الأوطار
ج5 ص44 وصحيح مسلم ج4 ص52 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص4 وشرح
مسلم للنووي ج8 ص216 وفتح الباري ج3 ص342 وأضواء البيان
للشنقيطي ج4 ص345 وتاريخ بغداد ج10 ص297 والبداية والنهاية ج5
ص140 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص240.
([44])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص455 و 456 وقال في هامشه: من حديث عمر:
أحمد في المسند ج1 ص174 والبخاري من حديث عبد الله بن عمر ج3
ص640 (1691). ومن حديث عثمان: أحمد في المسند ج1 ص57. ومن حديث
علي: أحمد ج1 ص57. ومن حديث جابر: الترمذي ج3 ص170 وابن ماجة
ج2 ص990. ومن حديث أبي طلحة: أحمد ج4 ص28. ومن حديث سراقة:
أخرجه أحمد ج4 ص75. ومن حديث سعد: أحمد ج1 ص174 والنسائي ج5
ص118. ومن حديث ابن أبي أوفى البزار كما في الكشف ج2 ص27. ومن
حديث ابن عباس أبو داود ج2 ص159. ومن حديث الهرماس: أحمد ج3
ص485 ومن حديث عمران بن حصين: أحمد ج4 ص427. ومن حديث أبي
قتادة: الدارقطني ج2 ص261. ومن حديث حفصة: أحمد ج6 ص285. ومن
حديث عائشة: البخاري ج3 ص630 حديث (1692).
([45])
سبل الهـدى والرشـاد ج8 ص456 عن والبخـاري، ومسـلـم، وأبي
داود، = = والنسائي، وقال في هامشه: هو عند أبي داود (1805)
والنسائي ج5 ص179 وراجع: المجموع للنووي ج7 ص154 والمغني لابن
قدامة ج3 ص565 والشرح الكبير لابن قدامة ج3 ص580 والمحلى لابن
حزم ج7 ص162 وتلخيص الحبير ج7 ص113 و 165 ونيل الأوطار ج5 ص42
ومسند أحمد ج2 ص139 وصحيح البخاري ج2 ص181 وصحيح مسلم ج4 ص49
وسنن أبي داود ج1 ص405 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص17 وشرح مسلم
للنووي ج8 ص208 وعمدة القاري ج10 ص31 والسنن الكبرى للنسائي ج2
ص348 وشرح معاني الآثار ج2 ص142 وتنقيح التحقيق في أحاديث
التعليق للذهبي ج2 ص16 ونصب الراية للزيلعي ج3 ص199 و 214 و
218 و 219 تفسير البغوي ج1 ص167 وتفسير القرآن العظيم ج1 ص241
و الدر المنثور ج1 ص216 وأضواء البيان للشنقيطي ج4 ص365.
([46])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص456 عن أحمد، والبخاري، ومسلم، وفي
هامشه عن: البخاري ج3 ص630 (1692) وراجع:
المجموع للنووي ج7 ص155 و 157 وتلخيص الحبير ج7 ص165 ومسند
أحمد ج2 ص140 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص18 و 20 وفتح الباري
ج3 ص433 وعمدة القاري ج10 ص34 وشرح معاني الآثار ج2 ص142 و 199
ونصب الراية للزيلعي ج3 ص218 والبداية والنهاية ج5 ص141
والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص243.
([47])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص456 عن مسلم، وفي هامشه قال: أخرجه مسلم
في الحج (303) وأبو داود (1790) وابن أبي شيبة ج4 ص102
والدارمي ج2 ص51 وأحمد ج1 ص236 وراجع: البداية والنهاية ج5
ص144 و 145 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص249 ومسند أحمد ج1
ص236 و 341 وسنن الدارمي ج2 ص51 وسنن أبي داود ج1 ص402 وسنن
النسائي ج5 ص181 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص18 ومسند أبي داود
الطيالسي ص344 والمصنف لابن أبي شيبة ج4 ص544 والسنن الكبرى
للنسائي ج2 ص368 و نصب الراية للزيلعي ج3 ص205 والدراية لابن
حجر ج2 ص34.
([48])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص456 عن البخاري، وفي هامشه قال: أخرجه
البخاري ج3 ص635 (1697) و كتاب الأم للإمام الشافعي ج 7 ص 226
والمجموع لمحيي الدين النووي ج7 ص180 و 221 وموطأ مالك ج1 ص394
والجوهر النقي للمارديني ج5 ص14 والبحر الرائق ج2 ص638 وج3 ص7
والمغني لابن قدامة ج3 ص235 و 303 والشرح الكبير لابن قدامة ج3
ص235 و 248 و 410 وكشاف القناع للبهوتي ج2 ص568 والمحلى لابن
حزم ج7 ص102 ونيل الأوطار للشوكاني ج5 ص130 واختلاف الحديث
للشافعي ص568 والمسند للشافعي ص196
ومسند أحمد ج6
ص284 و 285 وصحيح البخـاري ج2 ص152 و 182 و 188 وج5 = =
ص125 وج7 ص59 وصحيح مسلم ج4 ص50 وسنن ابن ماجة ج2 ص1013 وسنن
أبي داود ج1 ص406 سنن النسائي ج5 ص136 و 172 والسنن الكبرى
للبيهقي ج5 ص12 و 13و 134 وشرح مسلم للنووي ج8 ص211 و 212 و
232 وفتح الباري ج3 ص451 وج10 ص304 وعمدة القاري ج9 ص201 وج10
ص38 و 66 وج18 ص37 وج22 ص55 وعون المعبود للعظيم آبادي ج5 ص168
السنن الكبرى للنسائي ج2 ص337 و 361 ومسند أبي يعلى ج12 ص477 و
481 وشرح معاني الآثار ج2 ص144 و 196 والمعجم الكبير للطبراني
ج 23 ص 190 و 191 و 211 و215 ومسند الشاميين للطبراني ج1 ص413
ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ج3 ص514 و 517 والإستذكار لابن
عبد البر ج4 ص301 و 303 و 364 والتمهيد لابن عبد البر ج8 ص208
وج15 ص297 و 302 و 303 وأحكام القرآن لابن العربي ج1 ص181 و
183 وتفسير القرآن العظيم ج1 ص239 وأضواء البيان الشنقيطي ج4
ص367 و 369 و 370 و 371 وج5 ص149 و 151 و 171 و 173 والبداية
والنهاية ج5 ص155 وإمتاع الأسماع ج9 ص32 والسيرة النبوية لابن
كثير ج4 ص227 و 243 و 271 و 272 وسبل الهدى والرشاد ج 8 ص 456.
([49])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص457 عن أحمد، والترمذي، وفي هامشه عن:
أحمد ج1 ص313 والترمذي ج3 ص85 (822)، وراجع: شرح الأخبار ج2
ص532 وخلاصة عبقات الأنوار ج3 ص224 وسنن الترمذي ج2 ص160
والمصنف لابن أبي شيبة ج8 ص339 وكنز العمال ج5 ص169 وسبل الهدى
والرشاد ج8 ص457 والنصائح الكافية لمحمد بن عقيل ص122.
([50])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص457 عن البخاري، ومسلم، وقال في هامشه:
أخرجه البخاري ج3 ص656 (1730) ومسلم في الحج باب (209) وأبو
داود (1802) والنسائي ج5 ص244 وراجع: المجموع للنووي ج8 ص196
ومسند أحمد ج4 ص96 و 98 وصحيح البخاري ج2 ص189 وصحيح مسلم ج4
ص58 وسنن أبي داود ج1 ص405 وسنن النسائي ج5 ص245 والسنن الكبرى
للبيهقي ج5 ص102 وشرح مسلم للنووي ج8 ص231 وفتح الباري ج3 ص450
و 452 وعمدة القاري ج10 ص66 و 67 ومسند الحميدي ج2 ص275 والسنن
الكبرى للنسائي ج2 ص416 والمعجم الكبير ج19 ص309 ونصب الراية
ج3 ص216 وأضواء البيان للشنقيطي ج4 ص369 و 371 وج5 ص183 وعلل
الدارقطني ج7 ص51 و 52 والإصابة ج6 ص120 والبداية والنهاية ج4
ص422 و السيرة النبوية لابن كثير ج3 ص696.
([51])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص457 وفي هامشه عن: النسائي ج5 ص197
وراجع: سنن النسائي ج5 ص245 و السنن الكبرى للنسائي ج2 ص416.
([52])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص457 ونيل الأوطار ج5 ص131وسنن النسائي
ج5 ص245 والسنن الكبرى للنسائي ج2 ص416.
([53])
كتاب موطأ لمالك ج1 ص343 ومسند أحمد ج2 ص47 وج4 297 وصحيح
البخاري ج2 198 وسنن أبي داود ج1 ص442 والسنن الكبرى للبيهقي
ج4 354 ومجمع الزوائد ج3 ص279 وفتح الباري ج3 ص477 وعمدة
القاري ج10 ص110 وعون المعبود ج5 ص319 ومسند الشاميين للطبراني
ج4 ص136 والإستذكار لابن عبد البر ج4 ص90 و 91 والتمهيد لابن
عبد البر ج20 ص13 وج24 ص411 والكافي لابن عبد البر ص134.
([54])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص457 عن البخاري، ومسلم، وفي هامشه عن:
البخاري ج3 ص492 (1561) وراجع: البحار ج30 ص610 وسنن النسائي
ج5 ص245 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص5 و عمدة القاري ج10 ص46
والسنن الكبرى للنسائي ج2 ص327 والإستذكار لابن عبد البر ج4
ص302 و أضواء البيان للشنقيطي ج5 ص149.
([55])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص457 عن الشافعي، وقال في هامشه: عن مسند
الشافعي ج1 ص372 (960). وراجع: تذكرة الفقهاء (ط.ج) ج7 ص233
ومنتهى المطلب (ط.ق) الحلي 2 ص675 وكشف اللثام (ط.ج) ج5 ص256 و
(ط.ق) ج1 ص313 وجواهر الكلام ج18 ص203 وكتاب الأم للشافعي ج2
ص139 والمجموع للنووي ج7 ص166 وتلخيص الحبير ج7 ص111 واختلاف
الحديث للشافعي ص567 و 568 وكتاب المسند للشافعي ص111 و 196
والسنن الكبرى للبيهقي ج4 ص339 وج5 ص6 ومعرفة السنن والآثار
للبيهقي ج3 ص488 و 513 و 516 و 556 والبداية والنهاية ج5 ص160
والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص280 والسيرة الحلبية ج3 ص311.
([56])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص457و458 وتنوير الحوالك ص317 وشرح مسلم
للنووي ج8 ص135 والديباج على مسلم ج3 ص300.
([57])
البداية والنهاية ج5 ص157 و 171 والسيرة النبوية لابن كثير ج4
ص275.
([58])
البداية والنهاية لابن كثير ج5 ص157و 158 و السيرة النبوية
لابن كثير ج4 ص276وسبل الهدى والرشاد ج8 ص486 و 487 عنه.
|