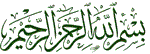
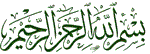
المقدمة
قرآن كريم
الجاثية: 17
حديث شريف
صحيح البخاري
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني
صاحب موسوعة الملل والنحل
الإهداء
إلى كل من يتطلع بشوق إلى إقامة خلافة راشدة وظهور إمامة حق في هذا الزمان.......
أهدي هذا الكتاب
المؤلف
كلمة المركز
يرى الباحث أن الأمة الإسلامية تعيش، في هذه الحقبة من الزمن، أزمة ذات بعدين: أولهما: هوية الذات وتحققها على مستوى الفعالية التاريخية، وثانيهما:
وعي الدين الإسلامي وعياً يتيح هذا الزمان. ويرى أن الخلافات المزمنة، إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية في هذا الزمان. ويرى أن الخلافات المزمنة، بين أهل السنة والشيعة، دليل على وجود تلك الأزمة، وبخاصة أنها تتمثل، في كثير من الأحيان، في اتهامات قائمة على عدم معرفة حقائق الأمور، ما يقتضي بيان هذه الحقائق، في اتهامات قائمة على عدم معرفة حقائق الأمور، ما يقتضي بيان هذه الحقائق بغية تجاوز هذه الأزمة والوصول إلى حوار يفضي إلى الوعي والنهوض.
تعود هذه الخلافات، في أساسها، إلى القضية المركزية، وهي (الإمامة)، وقديماً قال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: (وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام، على قائدة دينية، مثل ما سل على الإمامة في كل زمان).
يخاطب الباحث، في هذا كتاب، كل من يتطلع بشوق إلى تجاوز الأزمة، وإقامة خلافة راشدة وظهور إمامة حق في هذا الزمان، فيبحث (أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة)، فيعود إلى جذور الخلاف، منذ ظهوره، بعد وفاة النبي صلى الله وعليه وآله مباشرة، ويتتبع مساره التاريخي، ما يتيح تبين آثاره المعاصرة وسبل تجاوزه.
يتبع الباحث، في عرضه وتحليله الهادفين إلى معرفة حقائق الأزمة وأدلتها المقنعة، منهجاً تاريخياً نقدياً، موضوعياً، يستند إلى المصادر الأصلية في تقديم الأدلة والبراهين، ويعتمد خطة بحث واضحة متماسكة ولغة سلسة توصل المعاني إلى القارئ بيسر لا يخلو من إمتاع يؤتيه عمق الخطاب ودفته وسهولته.
مركز الغدير للدراسات الإسلامية
بيروت
المقدمة
بدأت تظهر في السنوات الأخيرة، وأكثر من أي وقت مضى بشائر ببداية انحسار أمواج التكفير والتعصب المذهبي الأعمى بين أتباع الفرق الإسلامية، بعد أن لازمتهم هذه الآفات دهوراً طويلة من الزمن.
فمناقشة القضايا الخلافية، والتي يشغل الخلاف السني - الشيعي رأس قائمتها، أصبحنا نراها تدور داخل دائرة الإسلام الواحد والملة الواحدة، ويغلب عليها العقلانية، على عكس ذلك النهج التقليدي المصبوغ بالعاطفة والأحكام المسبقة، والمأسور لحوادث التاريخ والتعصب لرموزه ورجاله، والذي جعل من الإسلام مذاهب متعددة، ومن المسلمين مللاً متباغضة ومعادية لبعضها بعضاً، كما لا زلنا نرى من ذلك شذرات هنا وهناك.
وتزداد أهمية البحث والنظر في مثل هذه القضايا عند كل من يرى جدوى الحل الإسلامي لمشاكل الأمة الإسلامية فضلاً عن مشاكل وأزمات غيرها، ويقول بصلاحية دين الإسلام لكل زمان ومكان. فحري بهؤلاء أن يكونوا على بينة تامة ومعرفة يقينية بتعاليم هذا الدين، وبالدرب الموصل بأمان إلى الشريعة السماوية الحقة كما نزلت نقية ومحكمة.
فبالرغم من كل ما تتمتع به رسالة الإسلام من مقومات ربانية، وتعاليم في غاية اليسر والوضوح والشمول كفيلة بإسعاد البشرية جمعاء، وانتشالها من أوحال الجاهلية والتخلف، فإن أصحاب الرسالة أنفسهم أصبحوا بحاجة لغيرهم لانتشالهم، وطروحات غالبية (الإسلاميين) اليوم أصبحت بعيدة عن الواقع، وعاجزة عن تقديم الحلول العملية والملائمة لطبيعة هذا العصر وظروفه المعقدة والسريعة في التغير، وغاية هذه الطروحات التركيز على شكليات وقشور المفاهيم والأحكام على حساب جوهر الشريعة ومقاصدها الحقيقية.
وللتحقق من هذا الواقع، ما علينا إلا إلقاء نظرة سريعة في حال غالبية التنظيمات والحركات التي تأسست بعد انهيار الخلافة العثمانية عام 1924 م ولغاية أيامنا هذه، ورفعت شعار الحل الإسلامي، حيث سنجد أن ما تطرحه من أفكار وبرامج، وإن. جد أي منها - وما تتبناه من أساليب للوصول إلى غاياتها في إقامة الحكم الإسلامي المنشود يشوبه التخبط والفوضى، لا سيما مع تقوقعها على نفسها، وعدم توفرها على بدائل، مما أوصلها إلى حافة الإفلاس الفكري وخسران التأييد الجماهيري.
وأمام هذا الواقع، لا بد لنا وأن نعترف أن أمتنا تعيش اليوم أزمة فهم لهذا الدين، لفقدانها الرؤية الشمولية والمتكاملة، وأزمة هوية لوجود تناقض صارخ بين واقع المسلمين وواقعية الإسلام، الأمر الذي يعمل على تغذية الشكوك والتساؤلات حول إمكانية تطبيق الشريعة الإلهية في هذا الزمان.
وما وجود تلك الخلافات المزمنة بين أهل السنة والشيعة، وما يدور داخل إطار كل فريق من مجادلات ومشاحنات إلا دليل واضح على وجود مثل هذه الأزمة في الفهم، وتلك الأزمة في تحديد الهوية.
هذا الكتاب
وبحثنا هذا على كل حال لم يأت لحل كل هذه المعضلات، وإنما لتبسيط ما أصبح يعد وكأنه من الألغاز المعقدة أمام الباحثين في الخلاف السني - الشيعي، وقد أعياهم النظر في هذه المسألة، وحاروا فيما ينبغي اعتباره خلافاً في أركان العقيدة لا يمكن التهاون فيه أو صرف النظر عنه، أو خلافاً في الفروع وتشعباتها مما يمكن إغفاله وعدم صرف النظر فيه.
فلمواجهة مسألة شائكة مثل هذه، لا سيما وأن خلافات الفريقين قد أخذت مواقعها الدائمة عشوائياً في عقائدهم وأحكامهم ونفوسهم، فإنه في تقديرنا ينبغي البحث أولاً في جذور الخلاف قبل الانتقال إلى الفروع وتشعباتها الكثيرة. فبتشخيص الخلل في الجذور سيسهل تشخيص خلل الفروع تشعباتها ومعالجتها.
وما نعنيه بجذور الخلاف، فهي تلك المسائل الأساسية التي أدى الخلاف حولها إلى تقسيم المسلمين إلى سنة وشيعة، أو تلك المسائل التي انطلق خلاف الفريقين تاريخياً منها، ثم أدى تطور ونضوج الأفكار حولها مع الأيام إلى إعطاء هذين الفريقين شكلهما الدائمين.
ولا أجد مسألة اختلف عليها بين أهل السنة والشيعة من الممكن أن تنطبق عليها مثل هذه المواصفات كمسألة خلافة النبي صلى الله عليه وسلم أو إمامة المسلمين بعده، ويقول الشهرستاني صاحب موسوعة (الملل والنخل) في هذا الصدد: (وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان).
وأما الفروع، فهي الآثار التي ترتبت على حصول أزمة الخلافة والإمامة، أو مخلفاتها ذات الخطورة على الإسلام والمسلمين. وتشعبات هذه الفروع
وقد اقتصرنا في هذا الكتاب على البحث في جذور هذه الأزمة وآثارها، والمؤيدة ببعض الأمثلة مما اختلف حوله من مفاهيم وأحكام، معتمدين في كل ذلك على أدلة الكتاب والسنة النبوية، ومن خلال النظر في حوادث أهم مرحلة من مراحل تأريخنا الإسلامي، وهي مرحلة صدر الإسلام.
وقد اجتهدنا أن تكون الأدلة مستقاة قدر الامكان من مصادرها الأصلية، ناهجين في ذلك منهجاً علمياً كان همنا الأول والأخير فيه تقصي الحقائق وتثبيت أدلتها، وعرضها بتسلسل منطقي، مع تقديم التحليل اللازم لها والتوفيق الموضوعي فيما بينها، والإضافة عند الضرورة لأقوال العلماء والمفكرين فيها.
وأسلوب البحث عموماً بعيد عن أي تعقيد قد يخطر على بال، ولغته في غاية الوضوح والسلاسة، ولم يكن لنا هم فيها سوى إبراز المعاني والابتعاد عن زخرف القول وبريق العبارات.
خطة البحث
يشمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة أقسام وخاتمة على النحو التالي:
1) المقدمة: وتم فيها تناول مشكلة البحث وخلفيتها، وهدف البحث وأهميته وأسلوبه وخطته.
2) التمهيد: وفيه تعريف عام بالمعاني اللغوية والاصطلاحية للخلافة والإمامة كما وردت في القرآن الكريم.
3) القسم الأول: وتم فيه طرح موقف التشريع الإسلامي من مسألة الخلافة والإمامة من خلال وجهتي نظر أهل السنة والشيعة، وفي ثلاث نقاط رئيسية أعطي لكل منها فصل مستقلا كما يلي:
الفصل الثاني: عرض منهج كل فريق في معرفة هوية الخلفاء والأئمة، واستعراض الأدلة التي احتج بها.
الفصل الثالث: عرض موقف الفريقين بالنسبة للمؤهلات التي ينبغي توفرها في الخلفاء والأئمة، واستعراض الأدلة التي احتجا بها.
4) القسم الثاني: وتم فيه استعراض الواقع التاريخي لدولة الخلافة والإمامة في صدر الإسلام، وهي الفترة التي رسم فيها شكل الخلافة، وحددت فيها معالمها الدائمة لاستناد غالبية المسلمين على منهج وسلوك الخلفاء والأئمة والصحابة دليلاً ومعياراً للخلافة الحقة. وهذا القسم على ثمانية فصول:
الفصل الأول: خلافة أبي بكر
الفصل الثاني: خلافة عمر
الفصل الثالث: خلافة عثمان
الفصل الرابع: خلافة علي
الفصل الخامس: خلافة الحسن بن علي
الفصل السادس: خلافة معاوية بن أبي سفيان
الفصل السابع: خلافة يزيد بن معاوية
الفصل الثامن: خلافة عبد الله بن الزبير.
5) القسم الثالث: ويقدم الكاتب في هذا القسم طريقته الخاصة في الوصول لمعرفة هوية الخلفاء والأئمة الذين أرادهم الله (جل وعلا) لهذا المنصب، وفي هذه الطريقة مزيج من دليل التشريع وشهادة التاريخ من جهة، والعقل والنقل من جهة أخرى، وكان ذلك على فصلين:
الفصل الثاني: لمحات من سيرة الخلفاء والأئمة.
6) القسم الرابع: وتم فيه استعراض آثار أزمة الخلافة والإمامة على شريعة الإسلام وواقع المسلمين على مر العصور، وقد أضيف هذا القسم لإخراج البحث من دائرة الصراع المذهبي الضيقة، وإدخاله إلى دائرة الإسلام الأوسع بمعادلة تشخيص ومعالجة أخطر الأمراض التي عانت ولا تزال تعاني منها الأمة الإسلامية سنة وشيعة على السواء. وقد قسمت هذه الآثار أو المخلفات إلى ثلاثة أنواع أعطي لكل منها فصل مستقل كما يلي:
الفصل الأول: الآثار الأولية أو المخلفات المباشرة للأزمة.
الفصل الثاني: أخطر الآثار التي لازمت الأمة على طول تاريخها.
الفصل الثالث: الآثار اللاحقة أو المخلفات التي ظهرت بعصور متأخرة نتيجة للنوعين الأولين.
7) الخلاصة والخاتمة: وتم فيه استعراض أهم ما يمكن استخلاصه واستنتاجه بشأن الخلاف السني - الشيعي بصورة عامة، وأزمة الخلافة والإمامة بصورة خاصة.
د. أسعد القاسم
رحم الله امرءا أهدى إلي عيوبي
as`ad al-qasem
mcpo box 21987
makati city 1261
philippines
telfax: 63-2-8441635
تعريف عام بالخلافة والإمامة
1 - الخلافة
الخلافة لغة هي ما يجئ من بعد، كأن يقال: هو خلف صدق من أبيه.
وتأتي بمعنى النيابة عن الغير كما في الآية الكريمة: (اخلفني في قومي) [ الأعراف / 142 ].
وأما الخلافة اصطلاحاً فقد ذكرت في القرآن لتعبر عن مفهوم في غاية السمو والرفعة وهو اصطفاء الله سبحانه وتعالى من ينوب عنه، ويقوم مقامه في تحمل مسؤولية إعمار الأرض وتسخير مقدراتها وخيراتها، بل وكل ذرات الكون من أجل السير بالبشرية نحو سعادتها الحقيقية. والخلافة بهذا المعنى على ثلاث درجات:
الدرجة الأولى: استخلاف النوع الإنساني لتميزه عن باقي المخلوقات وعناصر الكون الأخرى من ملائكة، وجن، وحيوانات، ونباتات، وجمادات، كما في قوله تعالى:
(ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) [ الإسراء / 70 ].
(إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً) [ الأحزاب / 72 ].
(هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره) [ فاطر / 39 ].
(ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما تشكرون) [ الأعراف / 10 ].
والاستخلاف في الآية الأخيرة، وكما هو في الآيات التي قبلها ليس لشخص آدم عليه السلام، وإنما للنوع الإنساني (بني آدم)، لأن آدم عليه السلام لم يكن مفسداً في الأرض، ولا سفاكاً للدماء، وكان ذكره في الآية الأخيرة بوصفه الإنسان الأول على هذه الأرض، والذي جعل على عاتقه مسؤولية خلافة الله في الأرض.
الدرجة الثانية: استخلاف قوم أو جماعة بشرية معينة من بين الأقوام أو الجماعات البشرية الأخرى، ولأن الاستخلاف أمانة إلهية، فإن القوم المستخلفين في حالة مخالفتهم لمقتضيات حمل هذه الأمانة، سيتلقون العقاب الإلهي، وتتحول الخلافة عنهم إلى قوم آخرين كما في قوله تعالى:
(إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء) [ الأنعام / 133 ].
(ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون) [ يونس / 14 ].
(وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم) [ محمد / 38 ].
ومن أمثلة هذا الاستبدال قوله تعالى بشأن قوم نوح:
(فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا) [ يونس / 73 ]، وقوله تعالى بشأن قوم عاد: (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح) [ الأعراف / 69 ]، وبشأن قوم ثمود: (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح) [ الأعراف / 69 ]، وبشأن بني إسرائيل: (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين) [ البقرة / 122 ]، وبشأن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس) [ البقرة / 144 ]، وبشأن الباقين الثابتين على الدين الحق: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم) [ النور / 55 ].
(ليكون الرسول شهيداً عليكم) [ الحج / 78 ].
ولأن القوم المستخلفين هم ليسوا المالك الحقيقي لما استأمنوا عليه، وأنما هم خلفاء المالك الأصلي، وهو الله (جل وعلا)، فهم ليسوا مطلقي الحرية والتصرف كما شاؤوا بالإمكانات والسلطات الممنوحة إليهم، ودون قائد رباني، فإنهم سينحرفون تماماً عن الخط الإلهي المرسوم، لما تزخر به النفس الإنسانية من نزوات، وأطماع، وحب التسلط.
وهذه الدرجات الثلاث تمثل بمجموعها مفهوم الإسلام الأساس عن الخلافة، وهو يتلخص بإنابة النوع الإنساني في إعمار الأرض وإصلاحها ولكن بتميز أمة أو قوم يختارون (مع إمكانية استبدالهم) للدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على رأسهم قائد رباني يحكم الناس بالشريعة الإلهية.
وقد اشتهر إطلاق تسمية (الخلافة) عند المسلمين وصفاً للحكومات التي خلفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالحها وفاسدها.
2 - الإمامة
الإمامة لغة هي الانقياد خلف إنسان، والاقتداء بقوله وفعله، وقد وردت كلمة (إمام) في القرآن الكريم لتعبر عن عدة معان، منها:
المعنى الأول: اللوح المحفوظ، كما في قوله تعالى: (وكل شئ أحصيناه في إمام مبين) [ يس / 12 ].
المعنى الثاني: الكتاب السماوي، كما في قوله تعالى: (ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة) [ هود / 17 ].
المعنى الرابع: قادة الهداية، كما في قوله تعالى بشأن إسحاق ويعقوب عليه السلام (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات) [ الأنبياء / 73 ].
المعنى الخامس: قادة الضلال، كما في قوله تعالى بشأن فرعون ومن معه: (وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون) [ القصص / 41 ]، وقوله تعالى: (فقاتلوا أئمة الكفر) [ التوبة / 12 ]، وفي قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيلا * ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً) [ الإسراء / 71 - 72 ]، دلالة على أن لكل قوم إماماً يدعون به يوم القيامة، وهو إما أن يكون إمام هداية، أو إمام ضلال. ولا يمكن أن يكون معنى (بإمامهم) في هذه الآية هو (كتبهم) كما يفسر بعض، المفسرين، لأن أول كتاب سماوي نزل متضمناً لشريعة إلهية هو كتاب نوح، وهذا سيعني خروج جميع الأقوام التي كانت قبل مجئ النبي نوح عليه السلام من مقصود هذه الآية، وهذا غير ممكن لأن جميع الأقوام ستدعى للحساب يوم القيامة.
وعلى ذلك، فإنه وعلى ضوء هذه الاستخدامات المتعددة لكلمة (إمام) في القرآن الكريم، يمكن استخلاص وتوجيه المفهوم الإلهي للإمامة وصفاً للقادة الربانيين الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا هداة الناس إلى شريعته على ضوء الكتب والرسالات التي أنزلها على أنبيائه ورسله، فالكتاب في واقع الحال لا يمكن أن يكون مرشداً للناس من بدون إنسان متخصص بحمله، عارفاً بأمره.
وقد اشتهر بين المسلمين إطلاق لقب الإمام وصفاً لحاكم الدولة الإسلامية، وبصورة أوسع للفقهاء وأصحاب المذاهب، ولمن يأتم الناس به في صلاة الجماعة، وحتى أنه يطلق أحياناً في هذا الزمان على رؤساء بعض الحركات والجماعات الإسلامية.
وإجمالاً: فقد استخدمنا في هذا البحث مصطلحي الخلافة والإمامة مترادفين دائماً، للتعبير عن مفهوم واحد، وهو قيادة الأمة الإسلامية وإدارة شؤونها العامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما دفعنا إلى استخدام هذا الترادف هو غلبة استخدام مصطلح الخلافة عند أهل السنة، ومصطلح الإمامة عند الشيعة على نحو من التخصيص، وكأنهما مفهومان مختلفين، وما هما كذلك.
القسم الأول
الخلافة والإمامة
في
التشريع الإسلامي
تقديم
على الرغم من أن الخلافة والإمامة بمفهومها العام - كما بيناه في التمهيد لهذا البحث - هي محل قبول جميع المسلمين، إلا أنه عند التعرض لدراسة خصوصيات هذا المفهوم عند كل من الفرق والمذاهب الإسلامية، تجد أن مسألة الخلافة والإمامة كانت محور الخلاف الأكبر بين المسلمين على مر العصور، وتسببت في حدوث أزمات لا تزال الأمة تعاني من آثارها وترسباتها لغاية يومنا هذا.
وهذه الخصوصيات هي موضوع بحثنا في القسم الأول وهذا البحث، حيث سنقوم بعرض ما شرعه الإسلام حول هذه المسألة كما فهمه المسلمون، كل حسب مشربه، وتحديداً من خلال وجهتي نظر فرقتي أهل السنة والشيعة بوصفهما الفرقتين اللتين لا زالتا تتمتعان بوجود واقعي ومستمر، ويشكل أتباعهما مجموع أبناء الأمة تقريباً.
وسيتم تناول ثلاث نقاط رئيسية تمثل بمجموعها موقف كل فريق تجاه مسألة الخلافة والإمامة، نعرض كلاً منها في فصل مستقل كما يلي:
الأول: ماهية الخلافة والإمامة.
الثاني: هوية الخلفاء والأئمة.
الثالث: مؤهلات الخلفاء والأئمة.
ولكن قبل ذلك كله، ونظراً لسوء الفهم الشائع بين المسلمين، وغلبة الأحكام المسبقة حول الفرق والمذاهب، نقدم صورة موجزة جداً في تعريف كل من هاتين الفرقتين:
أهل السنة
السنة لغة هي الطريقة أو نمط الحياة. والسنة اصطلاحاً هي كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير أو صفة، خلقية أو خلقية. فيكون المعنى الظاهري أو المفهوم المجرد لكلمتي (أهل السنة) الأتباع الذين يقتدون بالسنة النبوية المطهرة.
وأما (أهل السنة) المصطلح المتداول بين الناس، فهو تسمية لفرقة إسلامية كبيرة يعتقد أتباعها بأركان الإسلام الخمسة وهي: الشهادتان، والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج (ويضيف بعضهم الجهاد ركناً سادساً)، وبأركان الإيمان الستة وهي: الإيمان بالله، وملائكته، ورسله، وكتبه، واليوم الآخر، والقضاء والقدر خيره وشره.
ويرى أهل السنة أن الله (سبحانه وتعالى) اختار واصطفى الصحابة ليكونوا حملة الرسالة وحفظتها ومعلميها بعد رحيل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأجيال اللاحقة، لأنهم - كما يرونهم - كانوا جميعاً في أعلى درجات الصلاح والتقوى، ولا يجوز نقدهم، أو مجرد الشك بصحة أو صدق ما يروونه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ويشكل أهل السنة غالبية أبناء الأمة في وقتنا الحاضر.
الشيعة
التشيع لغة من المشايعة أي المناصرة والموالاة، والشيعة هم الأتباع والأنصار المجتمعون على فكر واحد، وموقف واحد. وقد استخدم هذا اللفظ في القرآن الكريم بمعنى المناصرة والموالاة كما في قوله تعالى: (وإن من شيعته لإبراهيم) [ الصافات / 83 ]، وقوله تعالى: (ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه) [ القصص / 15 ]. وقال الشاعر حسان بن ثابت في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما الشيعة اصطلاحاً فهي الفرقة التي يعتقد أتباعها بأركان إسلام أهل السنة وإيمانهم نفسها، ولكن باختلافات طفيفة في تفاصيل بعضها. ولكن ما ميز الشيعة عن أهل السنة بصورة رئيسية هو نظرتهم للخلافة والإمامة كركن هام من أركان الاعتقاد، وما تضمنه هذا الخلاف من تفاصيل وتفرعات.
ويعتقد الشيعة أن الله (سبحانه وتعالى): اختار أهل البيت عليه السلام واصطفاهم ليكونوا حملة الرسالة الإسلامية وحفظتها ومعلميها إلى الأجيال اللاحقة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم - كما يرونهم - قد خصهم الله بمواصفات استثنائية من التسديد في العلم والتطهير من كل رجس وإثم.
ويشكل الشيعة في عصرنا ما لا يقل عن ربع خمس تعداد المسلمين.
الفصل الأول
ماهية الخلافة والإمامة
عند أهل السنة
يغلب على تعريفات الخلافة أو الإمامة عند علماء أهل السنة قديمهم وحديثهم إعطاء الطابع التنظيمي والتنفيذي لرئاسة الدولة الإسلامية، ولحفظ وتحقيق مصالح الناس على هدى مبادئ الشريعة (1). وهذا يشمل إقامة الحدود، وتدبير أمور الأمة، وتنظيم الجيوش، وسد الثغور، وردع الظالم وحماية المظلوم، وقيادة المسلمين في حجهم وغزوهم وتقسيم الفئ بينهم (2).
وهم بذلك لا يعترفون بفصل الدين عن الدولة وسياستها وشؤونها الإدارية، بل يعتبرون أنهما قائمان على بعضهما بعضا. ومن هذا المبدأ الأساس ينطلق مفهوم الحاجة إلى القيادة الإسلامية. ويقول ابن تيمية في ذلك: (يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لحراسة الدين من رأس) (3).
ويبين الماوردي الدور الخطير الذي يلعبه الإمام بشأن حراسة الدين بقوله: (فليس دين زال سلطانه إلا بدلت أحكامه، وطمست أعلامه، وكان لكل زعيم بدعة، ولكل عصر فيه وهية أثر، وكما أن السلطان إن لم يكن على
____________
(1) محمد سليم العوا: في النظام السياسي للدولة الإسلامية، ص 126 - 127.
(2) الماوردي: الأحكام السلطانية، ص 15 - 16.
(3) ابن تيمية: السياسة الشرعية، ص 165.
ومن هذين الوجهين وجب إقامة إمام يكون سلطان الوقت وزعيم الأمة، فيكون الدين محروساً بسلطانه، والسلطان جارياً على سنن الدين وأحكامه) (1).
وبالرغم من هذا التزاوج الواضح بين الدين والدولة بحيث إن صلاح أحدهما لا يكون إلا بصلاح الآخر، فإن موقع النظر في مسألة ولاية أمر المسلمين المتمثلة بالخلافة والإمامة لا ينسجم مع أهميتها العظمى هذه ويصنفها العلماء القدماء من أهل السنة ليس ضمن فروع الدين وأحكام الفقه فقط، وإنما يحثون على عدم خوض الكلام والبحث فيها أيصاً، لما قد يجلب ذلك من انتقاد بحق الخلفاء لا سيما الأوائل منهم! فيقول الغزالي: (إعلم أن النظر في الإمامة ليس من المهمات، وليس أيضاً من فن المعقولات (بمعنى أنه ليس من العقائد) بل من الفقهيات. بل إنها مثار للتعصبات، والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض فيها وإن أصاب، فكيف إذا أخطأ؟) (3).
وللآمدي رأي مطابق للرأي السابق يقول فيه: (واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات، ولا من الأمور الأبديات بحيث لا يسع المكلف الاعتراض عنها والجهل بها، بل لعمري إن المعرض عنها أرجى من الواغل فيها. فإنها قلما تنفك عن التعصب، والأهواء، وإثارة الفتن، والشحناء، والرجم بالغيب في حق الأئمة والسلف بالازراء، هذا مع كون الخائض فيها سالكاً سبيل التحقيق، فكيف إذا كان خارجاً عن سواء الطريق؟) (3).
وقد انطلق هذا الاعتبار بفرعية الخلافة والإمامة عند أهل السنة وتهميش موقعها ضمن تعاليم الدين من اعتقادهم بعدم تدخل الشريعة من الأساس بتعيين
____________
(1) الماوردي: أدب الدين والدنيا، ص 111.
(2) أبو حامد الغزالي: الإقتصاد في الاعتقاد، ص 234.
(3) الآمدي: غاية المرام في علم الكلام، ص 234.
ويستنتج من كل ذلك، أن الخلافة والإمامة في جوهرها منصب سياسي وتنفيذي لتطبيق حدود الشريعة، وحفظ مصالح العباد ومحاربة الأعداء. ولا تقع على عاتق هذا المنصب مسؤولية حفظ الدين أو تفسير ما غمض من حقائقه، أو تبيان حدوده وتوضيح معالمه وغير ذلك من الأمور المتعلقة بفهم الشريعة وتفهيمها.
وأما قول علماء أهل السنة بتحمل الخليفة مسؤولية حراسة الدين، فإنما يقصد من ذلك الدفاع عن وجود الدين ضد أي تهديد سياسي أو عسكري قد يستهدف اجتثاثه أو الإطاحة بالنظام الحاكم، وهو بذلك دفاع عن المجتمع الإسلامي، أو الحكومة الإسلامية ضد أي خطر داخلي أو خارجي ليس إلا.
عند الشيعة
يعطي الشيعة لمنصب الخلافة أو الإمامة دوراً أكثر - (دينياً) - مما يعطيه أهل السنة، وذلك لأنها تعتبر عندهم الخلافة الإلهية في الأرض، ومهمة الإمام الأساسية استخلاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. فالإمام هو الذي يفسر لهم القرآن، ويبين لهم المعارف والأحكام ويشرح لهم مقاصد الشريعة، ويصون الدين من التحريف والدس، وله الولاية العامة على الناس في تدبير شؤونهم ومصالحهم، وإقامة العدل بينهم وصيانتهم من التفرقة والاختلاف.
فالإمامة بذلك تعد منصباً إلهياً، واستمراراً للنبوة في وظائفها باستثناء كل ما يتعلق بالوحي. وهي بهذا المفهوم أسمى من مجرد القيادة والزعامة في أمور السياسة والحكم، ولا يمكن الوصول إليها عن طريق الشورى أو
ويرى الشيعة أن الشورى حسب الآية (وأمرهم شورى بينهم) [ الشورى / 38 ]. لا تصح إلا في الأمور التي لم يرد فيها حكم من الله ورسوله، وأما مسألة تعيين أو اختيار ولاية أمر المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي مما كان للشريعة الحكم القطعي فيها.
ولذلك، فالشيعة يعتبرون الإمامة أصلاً من أصول الدين لا يكتمل الإيمان إلا بالاعتقاد الصادق بإمامة الأئمة أو الخلفاء المعينين من الله ورسوله، وأن تشريعها كان (لطفاً) من الله بعباده، لأن المسلمين لم يكونوا مؤهلين لسد الفراغات التي خلفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغيابه. فالحقبة الزمنية التي قضاها بينهم تعد قصيرة لإعداد أمة كاملة إعداداً كافياً، يؤهلها لإدارة وتدبير شؤونها الدينية والدنيوية بعده، وخصوصاً إذا كان الأمر متعلقاً بإعداد أمة قد ترسخت فيها عادات المجتمع الجاهلي ووحشيته، والذي كانت تحكمه لا أقل من شريعة الغاب فضلاً من أن الغالبية العظمى ممن أسلموا قد تلفظوا بالشهادتين بعد فتح مكة وأواخر حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإعداد هكذا أمة لا يمكن أن يتم خلال تلك الحقبة الزمنية القصيرة، لا سيما إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أكثر من نصف عمر دعوته في مكة يدعو الناس إلى قول كلمة التوحيد لا غير، ولم يقلها منهم إلا القليل، وقضى ما تبقى من عمر الدعوة في المدينة وكان شغله الشاغل فيها الدفاع عن الإسلام كوجود مهدد بالفناء، وقد أخذت الحروب والغزوات الكثيرة من المسلمين كل مأخذ، والتي محص بعضها - كموقعتي أحد وحنين على سبيل المثال - مدى تغلل الإيمان في نفوسهم!
ولهذه الأسباب يرى الشيعة أن الله (سبحانه وتعالى) لم يطلب من رسوله سوى تبليغ الرسالة للناس، وإقامة الحجة عليهم بها لقوله جل وعلا: (فإن
(فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ) [ الشورى / 48 ].
فالحفيظ المقصود في هذه الآية هو المسؤول عن هداية الناس وتعليمهم، كما في قوله تعالى أيضاً: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) [ الرعد / 7 ].
واعتماداً على هذه الآيات وغيرها يرى الشيعة أن دور الخلافة والإمامة في كل عصر (لكل قوم هاد) هو هداية الإنسان وإصلاح الفرد والمجتمع من خلال حمل الرسالة وحفظها من تحريف المحرفين، وتشكيك المشككين، وإلا فما هي فائدة سلامة تبليغ هذه الرسالة إذا لم تحفظ بعد رحيل مبلغها بأيد أمينة؟ على أن ما حدث للشرائع السابقة فيه الإجابة الوافية على هذا التساؤل، حيث كان أتباعها يأخذون معالم شرائعهم بعد رحيل أنبيائهم عن أي من كان، فحصل التحريف الذي أخبر عنه العلي الحكيم: (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون) [ البقرة / 75 ].
وهكذا يرى الشيعة أيضا أن قوله تعالى: (يوم ندعوا كل أناس بإمامهم) [ الإسراء / 71 ] وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) (1) إنما هو للتأكيد على أن أهداف رسالة الإسلام بعد رحيل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إمامة الخلفاء الهادين المرشدين: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) [ يونس / 35 ].
____________
(1) ستجد مصادر هذا الحديث وتفاصيل بشرحه في الفصل الأول من القسم الثاني.
الفصل الثاني
هوية الخلفاء والأئمة
عند أهل السنة
عند تدخل الشرع بالمسألة
لقد تأسست نظرية الخلافة والإمامة عند أهل السنة على أساس عدم وجود أي نص في تعيين من يخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وترك أمر اختيار الخليفة للناس وبالأسلوب الذي يرونه مناسباً، محتجين بقوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) [ الشورى / 38 ].
ويرى أهل السنة - أيضاً - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أهمل تحديد ذلك لئلا يحرج المسلمين بالتقيد بنمط خاص من أنماط الحكم أو اختيار الحاكم، وذلك يرجع لتطور الزمن وأساليب الحياة التي اختلفت وتعددت مقارنة بما كان عليه الحال في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الكاتب المصري المعاصر الدكتور محمد سليم العوا في هذا الشأن: (من الثابت تاريخياً أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعين للمسلمين من يقوم بأمر الدولة الإسلامية بعد وفاته، بل لم يحدد الطريقة التي تتبع في اختيار الحاكم بعده، وإنما أوضح للمسلمين القواعد العامة التي يجب أن يراعيها الحاكم في سيرته.
وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسيرته وأقواله المثل العليا التي يجب التمسك بها والمحافظة عليها من جانب الحاكم والمحكومين على السواء، دون أن يتضمن ذلك الجانب من سنة الرسول، كما لم تتضمن نصوص القرآن الكريم تفصيلاً لنظام الحكم الذي يجب أن يطبق في الدولة الإسلامية إذ اكتفى في هذا الصدد بالقواعد العامة فحسب) (1).
____________
(1) محمد سليم العوا، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، ص 71.
وبعد قول أهل السنة بعدم وجود نصوص في تعيين من يخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في طريقة اختياره وشروط انعقاد البيعة له، فإنهم ذهبوا للاستدلال بأقوال الصحابة وأفعالهم في تشريع القوانين ووضع النظريات في هذه المسائل. وهم يجمعون على كل حال على الاعتقاد بأن الإمامة الحقة تمثلت بخلافة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، على حسب ترتيب أفضليتهم عندهم، وسموهم بالخلفاء الراشدين. ويعتبرون أيضاً شرعية الخلفاء ممن جاءوا بعدهم كالخلفاء الأمويين، والعباسيين، والعثمانيين، ولم يستثن من هذا الاعتبار سوى قلة نادرة كالخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الذي عد خليفة راشدياً خامساً.
وعلى وبالرغم من إجماع أهل السنة بعدم وجود أي نص باستخلاف أي أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن غالبيتهم قالوا إنه ألمح باستخلاف أبي بكر وشذ بعضهم وقالوا إنه صلى الله عليه وآله وسلم نص على خلافة أبي بكر، فأما القائلون بالتلميح، فهو لاستنادهم على ما روته عائشة عندما سئلت من كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستخلفاً لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر، فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر، ثم قيل لها: من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح، ثم انتهت إلى هذا (2). وروت عائشة أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لها في مرضه الأخير:
(ادع لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) (3).
____________
(1) عبد الملك الجويني، غياث الأمم، ص 75.
(2) صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي بكر، ج 5 ص 247.
(3) المصدر السابق، ص 248.
(إن جئت فلم تجديني فأت أبا بكر الخليفة من بعدي) (1).
ومنها أيضاً: (يكون خلفي اثنا عشر خليفة، أبو بكر لا يلبث إلا قليلاً) (2).
ومنها: (إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) (3).
ومن هذه الروايات المشكوك في صحتها أيضاً ما نسب إلى الإمام علي عليه السلام أنه قال: (لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قدم أبا بكر في الصلاة، فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لديننا، فقدمنا أبا بكر) (4).
طرق انعقاد الخلافة
تنعقد الخلافة أو الإمامة عند أهل السنة بإحدى الطريق التالية:
1 - إختيار أهل الحل والعقد
وأهل الحل والعقد هم بمثابة أعضاء مجلس الشورى الذي يمثل الأمة في عملية اختيار الخليفة، ولم يشترط في ذلك عدد معين منهم، فضلاً عن الإجماع، ويذهب معظم علماء أهل السنة إلى تجويز انعقاد البيعة للخليفة ولو بمبايعة شخص واحد له من أهل الحل والعقد.
____________
(1) ابن حجر الصواعق المحرقة، ص 20.
(2) المصدر نفسه، ص 20.
(3) المصدر نفسه، ص 20. (4) ابن الجوزي: صفوة الصفوة.
وقال عضد الأيجي: (بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لأبي بكر) (3) وقال آخرون: (أقل ما تنعقد به الإمامة منهم خمسة يجتمعون على عقدها، أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالاً بأن عمر جعل الشورى في الستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة) (4).
2 - عهد من الخليفة السابق:
وفي هذه الطريقة يجوز للخليفة أن يعهد بالخلافة لمن شاء ليجعله خليفة بعده، فتنعقد الإمامة بذلك. فيقول التفتازاني على سبيل المثال: أن هذا الاستخلاف يعد بمنزلة الشورى، ودليله على ذلك عهد أبي بكر بالخلافة إلى عمر (5). ويدخل في ذلك أيضا العهد إلى مجموعة من أهل الحل والعقد ليختاروا واحداً منهم إماماً. واستدل على ذلك من فعل عمر عندما عهد بالخلافة إلى ستة.
ويرى بعض العلماء من أهل السنة أن شرعية خلافة يزيد قد اعتبرت انطلاقاً من هذا الأساس (الشرعي) المستنبط من فعل الصحابة لأنها كانت
____________
(1) عبد الملك الجويني، الإرشاد، ص 424.
(2) تفسير القرطبي، ج 1 ص 260.
(3) الأيجي، المواقف، ص 400.
(4) الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 7.