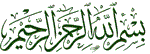
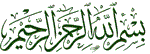
دعاء..
إلى الحبيب المصطفى وآله الكرام
أتم صلاة وأطيب سلام..
وإلى أمي، وأبي
(رب ارحمهما كما ربياني صغيرا)
وإلى من علمني بالحق حرفا
رب آته أحسن الجزاء ضعفا..
وإلى كل أخ جمعته معي ذكريات خاطبتها في هذا الكتاب..
(رب اغفر لي ولأخي
وأدخلنا في رحمتك
وأنت أرحم الراحمين).
هذه الطبعة
الحمد لله حق حمده..
والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله
والتحية والرضوان على صحبه الأخيار والتابعين بإحسان..
وبعد..
فاليوم إذ أقدم لهذه الطبعة - ولعلها تكون الخامسة - بعد علمي بصدور أربع طبعات في ثلاثة بلدان إسلامية في نحو (15000) نسخة صدرت جميعها في سنة 1413 هـ / 1992 - 1993 م.
أوكد بعد الحمد لله بما هو أهله: أني حرصت على المحافظة على هذا الكتاب في صورته الأولى كما كنت أعيشها وأتفاعل معها أيام تدوينها، لذا تجنبت الإضافة والتغيير إلا في نطاق ضيق جدا كان لا بد منه، وقد تضمن:
أ - تصحيح ما وقفت عليه من أخطاء طباعية وهفوات لغوية وهي قليلة جدا والحمد لله.
ب - استدراك موجز على حديث واحد فقط، وقع الاستدراك في صفحة 72 و 74.
ج - تعديل شمل موضعين فقط.
لماذا هذا الكتاب
ليس هو كتابا مذهبيا يراد منه تعميق الخلاف بين المسلمين. فما أحوجنا اليوم إلى كلمة تلم شملنا، وتؤلف بين قلوبنا، وما أحرانا باجتياز الحواجز التي ركزت بيننا.
ثم ما أشوقنا إلى لغة الحوار السليم التي تعيننا على ذلك، إذن لبلغنا المنى ولاستوت مراكبنا، واجتمعت كلمتنا على ما تركه لنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نضل بعده، ولا نفترق، أو نسلك سبلا شتى..
وإذا كانت هناك أسباب ودواع لما حصل بيننا من خلاف، فما أجمل أن نقف عليها بكل حياد، وتعقل مدركين أن المهم في الأمر هو ظهور النهج الإسلامي الأصيل الحنيف، وليس غلبة هذا الاتجاه، أو ذاك.. وأن اتفاقنا على الحق الصريح هو الذي سيضمن اجتماعنا.
وأما تعصب كل منا إلى فرقته - ليس إلا لأنه ورثها عن آبائه. ونشأ عليها، وتشربت بها عروقه - فلا يزيدنا إلا تباعدا عن بعضنا، وابتعادا عن المحجة البيضاء. والشريعة المحمدية السمحاء.
وهذا الكتاب هو تجربة شخصية على هذا الطريق.
تجربة فيها كل ما في التجارب الكبيرة من مشاكل وصعوبات، وفيها ما في أخواتها عند ما تكلل بالنجاح.
وقد لا تكون التجارب في ميدان العقيدة عزيزة، فربما خاضها الكثيرون من أبناء كل
ولست من الذين يرون أن هزيمة اليقين أمام العاطفة هو من أثر العصبية وحدها، فربما يكون ذلك ولكن ربما تكون هذه العاطفة وفاء للذكريات الجميلة التي لا يشك صاحبها في صفائها، وربما يجتمع الأمران معا.
والوفاء لذاته ممدوح، بعكس العصبية..
فكثيرا ما يقف المرء على حقيقة كان يعتقد بخلافها، ولكن لعقيدته هذه في قلبه قدسية أحيانا، فينبعث عن هذه القدسية سؤال يقول: أحقا أن هذا المفهوم الذي عشت أقدسه لا أصل له، وأن الصواب في المفهوم الآخر الذي يأباه قلبي وتنفر منه نفسي؟!
هذه هي العصبية، وكم صدت فحولا عن مواصلة الطريق نحو الحقيقة الثابتة..
إن العصبية تمنح كثيرا من المفاهيم هالة قدسية، لكنها سراب لا حقيقة لها.. وأصعب شئ على من يقدس أمرا أن يقال له: إن الذي تقدسه سراب!!
وثمة نوع آخر من العاطفة يشد المرء إلى الوراء..
إنه الوفاء للذكريات.. فلم لا وقد أمضى أيام شبابه وهو في ذروة الحماس الديني، مع ثلة من إخوانه المؤمنين، تزدان مجالسهم بالذكر والبحث الصادق النقي الذي لا تشوبه شائبة من رياء أو مكابرة؟
إنه ليعشق تلك الذكريات عشقا لا تتخلله سهام الطعن، فإذا ما واجهته الحقيقة بغير ما كان يرى ثار شوقه إلى تلك الذكريات وتأجج عشقه لها، فينبعث من بين الشوق والعشق سؤال يمض الفؤاد: أحقا كانت مجالسنا تلك قد تخللها شئ من الأوهام؟!
إنه لا يريد أن يشك في ذلك الماضي الجميل!!
وهذا هو الوفاء للذكريات..
ولقد كنت للعصبية عدوا حيثما واجهتني، غلبتها أو غلبتني، أما الذكريات فقد آخيتها وأحسنت صحبتها حتى النهاية، وقد جعلتها في فقرات من هذا الكتاب بمثابة صديق لي أحاوره فيستجيب لي ولو همسا.
وقد أعانني على ذلك كونها ذكريات واضحة لم تختلط في ذهني.. وكونها زاخرة
ورأيت أثناء رحلتي أن الوفاء للذكريات لا ينبغي أن يكون عاطفيا، فربما ينعكس أثره فلا يكون عندئذ وفاء.. وإنما المطلوب من الوفاء أن يكون وفاء علميا إن صح التعبير.
من هنا وجدت لزاما علي أن أسجل تجربتي بكل أمانة، لتكون بين الأيدي تجربة جاهزة تختزل الكثير من عناء هذا الطريق الطويل، وتقدم حلولا للكثير من تلك الأسئلة الحائرة..
فوضعت هذا الكتاب..
قد حاولت أن أحفظ فيه أشواط رحلتي مرتبة كما كانت في الواقع، بعيدا عن التكلف..
إثارات أولية، ثم عودة إلى نقاط البدء، فحوار بين حقيقة تهدي إليها الإثارة وموقف مسبق إزاء هذه الحقيقة.. وقد اتخذ هذا الحوار ثلاثة أشكال:
- حوار مع قطب من الأقطاب الذين تبنوا ذلك الموقف ودافعوا عنه، وقد قدمت لهذا دائما بذكر اسم الرجل وكتابه.
- حوار مع الذكريات، فإذا حاورتها سميتها (صديقي)، أو تكلمت بضمير الخطاب.
- حوار مع حدث ثابت من الأحداث، أو مفهوم من المفاهيم.
فتكشف عن كل ذلك أن ثم نسيجا غليظا نسجه التاريخ حول كثير من الحقائق، وهالة مصطنعة أضفاها على كثير من الرجال والمفاهيم، وليس لذلك أساس في الدين ولا واقع في التاريخ.
ووضعت ذلك في فصول اكتفيت فيها بالقليل من شواهد التاريخ، وأغضيت عن كثير منها خشية الإطالة مرة، ولكراهة الغوص في أغوار بعض الأحداث المؤلمة أكثر من القدر الكافي مرة أخرى.
وقد قدمت له بمقدمتين:
الأولى: حول طبيعة الانتماء المذهبي، وأثره في قضية الوحدة بين المسلمين.
وهناك ركائز منهجية اعتمدناها تجدر الإشارة إلى بعضها، فمنها:
1 - تجنب النقل بالواسطة، والاقتصار على ما نقف عليه مباشرة ما تيسر ذلك.
2 - التحقيق في أسانيد الأحاديث المنتخبة، أو اعتماد حكم أرباب هذا الفن فيها. وقد ذكرنا نبذا من ذلك في مواضع الضرورة فقط، وأعرضنا عما سواها تجنبا للإطالة.
3 - لملاحظة اختلاف النسخ المتعددة للمصدر الواحد، ذكرنا تعريفا بالنسخة المعتمدة في فهرس المصادر.
4 - ألحقنا بالكتاب فهارس مفصلة تيسيرا للحصول على المطالب، وقد تضمنت:
الآيات، والأحاديث، والأعلام، والأشعار، والمصادر، ومحتوى الكتاب.
والله ولي التوفيق.
صائب عبد الحميد
الانتماء المذهبي بين الواقع والمسؤولية
أم كيف حصل هذا الانتماء؟
بين هذين السؤالين تدور أشياء كثيرة، منها ما هو بديهي، ومنها ما يتطلب بعض العمليات العقلية، وما لم نمتلك الروح الموضوعية في مواجهة القضايا، فسوف تغيب عنا حتى تلك الأمور البديهية.
ولا بد أن نعترف مقدما بأن هذه الموضوعية ستكون أمرا صعبا للغاية عندما نواجه قضايا تتعلق بالعقائد والتقاليد والموروثات التي تشبعت بها العروق، وألفتها النفوس.
وسوف تكون أشد وأصعب عندما يدور الحديث بين تلك العقائد والموروثات من جهة، وبين ما يقابلها لدى الآخرين من جهة أخرى، فالإنحياز الفوري نحو المألوف هو النتيجة المتوقعة دائما، بينما يبقى الموقف الموضوعي أمرا نادر الحصول.
وما هو أثره في الوجود الاجتماعي لهذه الأمة؟
وكيف ينبغي أن نواجهه؟
سنطرق هذه المواضيع من جوانبها النفسية، بدلا من عواملها التاريخية..
- أذكر يوما أني قد أديت خدمة ما إلى مجموعة من الناس، فيهم السني وفيهم الشيعي، فأراد بعضهم أن يشكر لي جهدي، فقبلني بحرارة، وقال - معبرا عن امتنانه الكبير -: سأدعو لك عند ضريح أمير المؤمنين، وأبي عبد الله الحسين وتلاه آخر، فقبلني بلهفة، وهو يقول: سأدعو لك عند الشيخ عبد القادر الكيلاني، وأبي حنيفة.
لا أشك أن كلا منهما قد كشف عن المعاني التي يقدسها، في لحظات كانت تهيج فيها مشاعره، وتنطق براءته بلا أي تكلف، فهي عبارات تعبر عن شعور بالقرب من المعاني التي تعيش في أعماقه إن لم نقل بالاتحاد النفسي معها والسؤال الذي برز إلى ذهني حينها، هو: من أي شئ حصلت هذه الفوارق في الارتباطات النفسية؟
إنه لا ينبغي أن يثيرنا سؤال واحد يجب أن نضعه أمام أنفسنا لأجل البحث عن سر اختلافنا، وهذا التجافي الحاصل بيننا. ولعلنا سوف نمسك بطرف من أطراف الاتفاق، ونقترب خطوة نحو الموضوعية لو ابتدأنا من هذه الملاحظة البسيطة:
فلو أنك سألت شابا ولد في مدينة (النجف) فقلت له: هل ستكون شيعيا لو حصل أنك ولدت في (حلب) من أبوين سنيين؟
وهكذا لو سألت الحلبي، هل ترى أنك ستكون سنيا بهذه الطريقة، لو أنك ولدت في (النجف)، في أسرة شيعية؟
وهذه الملاحظة وحدها تكفي لأن تضعنا أمام الحقيقة كلها، وتكفي لأن تبعث فينا الاستغراب لهذا التجافي والتنافر الحاصل بيننا، كما تسمح لنا هذه الملاحظة أيضا أن نطرح مزيدا من الأسئلة اللازمة، لنقترب أكثر نحو الموضوعية كلما استطعنا أن نزيح شيئا من دواعي الانحياز الوهمية المتراكمة فينا.
ولنبدأ بالسؤال حول الانحياز نفسه، والعصبية ذاتها:
فهل سيرضى أحدنا لو وجد آخر يتعصب ضده من غير دواع حقيقية، وبدون أن يتعرف على حقيقة مواقفه وآرائه؟
فإذا كان الجواب بالنفي بديهيا لدى هذا الشخص، فماذا نتوقع أن يكون موقف أشخاص محايدين، نفترض أنهم يراقبون هذا المشهد قطعا إنهم سيؤاخذون المتعصب على تعصبه.
إذن، فعند الجميع كان التعصب لذاته شيئا ممقوتا.
أفلا يكون من التناقض إذن أن نحمل بين جوانحنا أشياء نمقتها لدى الآخرين، ونمقتها بالأصل؟!
فلماذا لا نكون إذن على مستوى تقبل الطرح العلمي والموضوعي الذي يتناول شيئا من مواقفنا تجاه الأشياء والقضايا المبدئية، وتجاه بعضنا؟
وماذا في الأمر؟ فما دام الطرح موضوعيا وعلميا، فإنه سيثبتنا على ما نحن عليه، إن وافقنا الأصل والصواب، أو أنه سيرشدنا إلى ما هو أحق وأهدى، إن لم نكن قد وافقناه.
ألسنا جميعا من دعاة الحق، وطلابه؟
ولكن السر كله يمكن ها هنا، فثمة حقيقة نستطيع أن نطلق عليها:
- أفلا ترون أننا لو صدمتنا الحقيقة بشئ يخالف ما ألفناه واعتقدناه، لظهرت ردود الفعل فينا - فورا - على هيئة غضب وثورة، ثم أحكام تلقى جزافا، وربما أعقبتها سخرية، ثم يسدل الستار على الموضوع، حتى لو عاد يواجهنا ثانية لما أحدث فينا أثرا يذكر، ولأصبح كأية مسألة لا تستحق العناية، أو الالتفات!
وبهذه الطريقة يدفعنا اللاشعور للتسلح بالمناعة الكافية ضد أي مفهوم يخالف المألوف، ولو كان أكثر منه ثباتا، وأقوى حجة.
وهذه ظاهرة عامة في بني الإنسان، إلا من تحرر منها بالوعي والمعرفة، وتلك شجاعة ما أعزها!
- وترانا أيضا، حين نواجه الأمر معكوسا نقف منه الموقف المناسب! فلو عرض علينا مذهبنا مفهوما أو اعتقادا لا يستقيم مع الفطرة السليمة، والعقل المستقيم، والبيان الشرعي، فإن رد الفعل هذه المرة سيأتي على هيئة تنازل تلقائي عما نرتضيه حقيقة، لنخضع - بأي مستوى من مستويات الخضوع - لمعان تأباها عقولنا، وتنفر منها فطرتنا، ولكننا ورثناها!
ولو خشينا من أن هذه المعاني الجديدة قد تستولي علينا، فإننا نلجأ - من حيث ندري، أو لا ندري - إلى غض النظر عنها، مؤثرين السكوت، والوقوف عند أي مستوى يمكننا أن نخضع له، مستبعدين إمكان المناقشة والحوار فما الذي يدفعنا إلى كل هذا؟ إنه (الخوف من الهزيمة)!
ذلك الشبح الذي يراود كل من يواجه مثل هذا الموضوع، حيث يرغب،
وعندما تكون تلك الهواجس متفوقة لديه جدا، فإنه سيكتسب قناعات شديدة بكل ما من شأنه قطع السبيل إلى ميادين التفكير الحر، ويجعل أي شئ من هذا القبيل بمثابة الأمر المحرم، الذي يجب إنكاره كليا.
ثم كيف نفسر وجود هذه العقد النفسية المتراكمة فينا تراكما جعل أحدنا يرى أن مجرد اقترابه من الآخر يعد مستوى من مستويات الهزيمة، أو الضعف العقائدي، أو أنه مجاملة على حساب المبادئ!
ومن منا ينكر ظاهرة الانكماش النفسي المفاجئ، والنفور غير الإرادي التي فرضت نفسها حتى على الكثير ممن جاء ليعالج هذا الداء العضال، ويرسم حدود هذه المشكلة المستعصية في الأمة؟
فحتى الكثير من هؤلاء ينزلق من حيث لا يشعر، فيمارس مرة أخرى تجسيد تلك الروحية، وتعميق تلك الحواجز النفسية التي سيكون لها هنا آثار أكثر سلبية حتى من تلك البحوث التي تكرس أصلا لتعميق الخلاف، وإحياء الروح الطائفية، وذلك لأنها ستوحي للقارئ بأن هذه الظاهرة هي بمستوى الحقيقة التي تأصلت في النفوس، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من عقائدنا وعواطفنا، وعند هذا يصبح مجرد مناقشتها أمرا مخالفا للطبع، وليس له موضع بيننا على الاطلاق.
ومن أبرز الأمثلة على هذا النمط، ما نجده عند بعض من كتب في الدفاع عن الوحدة الإسلامية، متحمسا ضد الطائفية ومروجيها، ثم إذا أراد
وهكذا يمارس دوره من جديد في إثارة النزاع بما يثيره من ردود فعل سلبية لدى الأطراف الأخرى، فيضيف حلقة أخرى إلى مسلسل النزاعات!
بينما كان الأجدر به - حين يلجأ إلى مثل هذا الاستشهاد - أن ينتخب نموذجا من حملات أصحابه هو ضد المذاهب الأخرى، فيردها، ويبعدها عن ساحة القبول، وبهذا يكون قد أعطى نموذجا صادقا ورائعا في هذا المضمار، وقدم مثالا لروحية عالية تترفع على الأهواء والعصبيات، وتميل بصدق لتحقيق التآلف بين أبناء هذه الأمة الواحدة.
ذلك بحق إنسان في القمة، وما أحوجنا إليه في كل مكان وزمان.
إن تلك الروحية العالية وحدها هي التي تحقق أثرا إيجابيا يرجى أن يؤتي ثماره على طريق التقارب والتفاهم والحوار العقلاني الواعي، الذي سيزيدنا قوة ويوفر بيننا مستوى من الانسجام والاتحاد لا يقل عن درجة الاحساس الصادق بالارتباط المصيري، والاتحاد العقيدي. وسيعيننا هذا الفهم، بل سيدفعنا إلى التعرف على بعضنا من جديد، بروح أخوية نزيهة، ويزودنا برغبة صادقة في البحث عن الحقائق الناصعة المبرأة من كل ما تراكم من غبار زمن طويل، ملئ بالنزاعات والتخاصم، وتبادل التهم والشتائم و...
وبمثل هذه الصيغة يمكننا أن نتوصل إلى جذور تلك الحواجز النفسية، وخلفيات هذا التشنج، وتلك العصبيات المقيتة.
فلقد بلغت بنا تلك العصبيات حدا بالغ الخطورة، حتى صار تعصبنا لأي شئ ألفناه هو أشد ألف مرة من استعدادنا للتمسك بالحكم الشرعي الثابت.
ومن المهم أن أؤكد هنا أني لا أعني مفهوما بالذات، أو طائفة من المسلمين دون غيرها، ولا فردا دون آخر، بل أريد تلك الظاهرة التي أضحت (مرضا) نفسيا أرسى جذوره في أعماقنا، أفرادا وجماعات، حتى أصبحت معظم التقاليد التي نسبت إلى المذهب، وألصقت به وهي ليست منه، حاكمة حتى على النص الشرعي الثابت لدينا.
فرحنا نلجأ إلى تحوير كل نص لا ينسجم مع هذا التقليد، أو ذلك الرأي وصياغته بحسب قوالب صنعناها نحن بأيدينا، وإن كانت لا تمت إلى الدين بصلة، ولكنها ارتقت في أذهاننا إلى مستوى الشعائر المقدسة، فأصبح مجرد الإشارة إليها أمرا يثير المشاعر، ويؤجج فينا نار الغضب.
ولهذا نجد أن علماء المذهب نفسه لا يجرأون على استنكارها، أو وعظ أصحابهم بتخفيف شدة تمسكهم بها، ولو تجرأ أحدهم على شئ من ذلك، لنبذه أتباعه في الحال، ولأصبح بينهم عرضة لألوان الشتائم والمطاعن، وربما بلغ الأمر إلى رميه بالزندقة والنفاق، ولو كان أتقى الأتقياء!
ولنتذكر مرة أخرى أن من الخطورة بدرجة أن يميل كل منا للاستفادة من هذه الإشارات في توجيه التهم إلى الآخرين، على أنها من مزاياهم وحدهم فإن هذا الأسلوب هو تجسيد كامل للعصبية، كما أنه سوف يبقي على كل معايبنا وأخطائنا، ثم يعود بنا إلى عمق مصيبتنا.
إنما المطلوب منا أن نفتش عن تلك الظواهر في أنفسنا نحن لننتزعها من قلوبنا وعواطفنا، ونتخلص من آثارها.
فلو امتلكنا مثل هذه الروحية، لاقتلعنا كل جذور الخلاف، واكتسحنا كل الآثار السلبية المترتبة عليه.
والآن، لعلي أصبحت قادرا على أن أطرح على نفسي السؤال الآتي:
ما الذي حملني على هذا الإعتقاد، أهو القرآن الكريم؟ أم السنة المطهرة أم العقل السليم؟
أم هي العصبية التي لا تستند إلى شئ؟!
ولماذا لا يمكنني أن أعتقد بأن المذاهب الأخرى هي مثل مذهبي على الأقل؟
ومن يدري! فلعلها تكون جميعا أكثر سلامة وكمالا مما تعلمته أنا!
وما العجب من هذا الافتراض، أليس هكذا يعتقد أبناء المذاهب الأخرى؟
إذن، ما الذي يمنعني من أن أكون أبعد نظرا، لأتقبل فكرة: أن المذاهب الأخرى هي أيضا تحتمل الصحة، على الأقل؟
ثم، ألست مسؤولا غدا عن سبب اعتقادي، وتبعيتي الدينية؟
وهذا هو السؤال الخطير الذي يجب أن أقف عنده موقف الجد..
سيبرز هنا سؤال آخر، وهو: ألا تقودني هذه الفكرة إلى الطائفية مرة أخرى؟
أعني أنني عندما أدخل طريق الدرس والمتابعة، فإن دراستي ستقودني حتما إلى قناعة ما، وعلى أساس هذه القناعة سوف أنتخب المذهب عن وعي وإدراك هذه المرة، كما تقتضي المسؤولية الشرعية، وأصول الدراسة العلمية، أفلا يفهم من هذا أنني سوف أطعن بالمذاهب الأخرى، وسوف أصرح بالفعل وإن لم أصرح بالقول، بأن المذهب الذي انتخبته هو الأكثر كمالا ودقة وعمقا؟
نعم، قد تكون هذه الطريقة مصدرا للإثارة، ولكن إلى أي شئ تعود تلك
هل انبثقت من موقف علمي ورؤية موضوعية، أم أنها نشأت عن غير ذلك؟
وبتعبير آخر، هل هي رؤية تصمد أمام قوله تعالى: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) (1).
أم هي واقعة تحت ظلال قوله تعالى: (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس) (2)؟
فهذا هو ميزان السماء لكل دعوى.
إن شيئا من ردود الفعل هذه، ما هو إلا جزء من إفرازات تلك العقد النفسية المتجذرة فينا، وإلا فمن أين جاء زعمنا: أن الفرد المسلم الذي انطلق من وعيه بمسؤوليته الشرعية، ملتزما قواعد البحث العلمي، والدراسة الموضوعية المجردة، متسلحا بالشجاعة الكافية في اتباع الحق الذي يستقر عليه، ثم انتهى إلى اختيار آخر، خالف فيه أصحابه، أنه سيكون بالضرورة قد ناصبهم العداء، أو حكم عليهم بالضلال والجحيم؟
أليس العكس هو الصحيح، ما دمنا نقر جميعا بأن هذا المنهج هو مسؤولية شرعية في أعناق الجميع دون استثناء؟
نعم لنا أن نقول: إن مثل هذا الفرد لكي يكون متوازنا في، مواقفه، ملتزما علميته، عليه:
أولا: ألا يكون منفعلا بتأثير نشوة الاكتشاف الجديد، فيندفع متحمسا تجاه المذاهب الأخرى، ليشن عليها حملاته بمناسبة أو بلا مناسبة، وكأنه
____________
(1) النمل: 64.
(2) النجم: 23.
وثانيا: ألا يذوب كليا في المجتمع الجديد بكل ما فيه، حتى التقاليد الموروثة التي لم يكن مصدرها الإسلام، وحتى العقد النفسية المتراكمة فيهم تجاه كل من يخالفهم بشئ.
إن منهجا كهذا لو التزمه الواعون منا، لوصلنا إلى أفضل مما نحن عليه الآن بكثير.
وحتى لو لم نصل جميعا إلى نتيجة واحدة، وحتى لو عاد كل واحد منا فانتخب مذهبه الذي نشأ عليه من جديد، فلن يؤدي ذلك إلى خلاف جديد بيننا بالمرة، بل على العكس تماما، سيؤدي إلى احترام كل منا للآخر، لأنه سيعرف عنه الكثير مما كان مخفيا عليه، أو كان مشوها في ذهنه، نتيجة ما ورثه في ذلك الواقع الممزق المخيف.
هذا عن أصل المشكل المثار، وأما عن مضمونه الذي مفاده: (أن مجرد البحث أو التفكير في مثل هذا الموضوع، هو بمثابة نواة للفرقة والتمزق وإثارة الخلافات المذهبية من جديد) فجوابه:
إن قضية الوحدة بين المسلمين هي مسؤولية شرعية لا يمكن التعامي عنها وإغفالها، فقد أمر القرآن الكريم بحفظها أمرا صريحا، فقال: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) (1).
وحذر من تضييعها، وتوعد على ذلك بأشد الوعيد، فقال: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم) (2).
____________
(1) آل عمران: 103.
(2) آل عمران: 105.
فمن المسلم به إذن: أن الشارع المقدس لن يرتضي لأحد أي عمل من شأنه أن يقدح بهذه المسؤولية الشرعية.
ولكن، من المسلم أيضا بين المسلمين، أنه جل جلاله لن يرتضي لعبده المكلف أن تكون حجته في تدينه وانتمائه المذهبي: ما وجد عليه آباءه!
إذن ليس أمام هذا العبد المكلف المسؤول إلا أن يتعاهد مسؤوليته بالبحث والدرس والتحقيق، على قدر استطاعته، ليكون قد اتخذ موقفه، وحدد التزاماته عن وعي وإدراك حقيقيين.
وإذا كان كذلك، فثمة مسألة أخرى لا بد من الإشارة إليها:
ففي منهج البحث العلمي، هل سيكون الباحث ملزما تأييد وموافقة كل ما تتبناه المذاهب الإسلامية، على اختلافها؟
فينبغي له أن يكون - تحت عنوان حفظ الوحدة الإسلامية - مؤيدا لكل الفروع والتفاصيل التي تعترض طريق البحث؟
إن شيئا من هذا الإلزام سوف لا يبقي على أي معنى للبحث والنظر، بل سيبطلهما من الأساس. فالبحث العلمي إنما يتوخى الحقائق المجردة عن أية مواقف مسبقة، وأية اعتبارات أخرى تصرفه عن مساره، وهذا محال مع وجود ذلك الإلزام.
فليس من الصحيح إذن أن نطالبه بموافقة الجميع، حتى فيما اختلفوا فيه، بحجة تجنب الخلاف والفرقة، بل إن فكرة كهذه ستكون مصدر أخطار على الوحدة بين المسلمين قد لا يوازيها خطر يأتي من عمل عدائي مقصود!
لأن هذا الفهم يعني بالنتيجة: أن علينا أن نحتفظ بكل تلك الخلافات وبأسبابها ودواعيها أيضا إلى الأبد، لأنها كلها كانت آراء رجال السلف
ألا يعني هذا أن من حقنا اليوم، وفي كل عصر، أن نجدد تلك النزاعات، وأن يقتل بعضنا بعضا، ولا بأس علينا، لأن كل طرف منا قد تمسك بما نقل إليه عن بعض رجال السلف؟
وفي أحسن الأحوال، فإننا سنبقي على تلك الخلافات، وعلى جذورها حية فينا ما حيينا، وليس هذا مجرد فرض نفترضه، أو دعوى ندعيها، بل هو الواقع الحاصل في هذه الأمة.
فهل تمدد الخلاف فينا، وتوالت الانقسامات، إلا بسبب التمسك بتلك الفكرة التي جعلت من نقاط الخلاف القديم محاور لتجمعنا، وعناوين لانقساماتنا؟
وما زال الكثير منا يدافع عن ذلك المبدأ، معتقدا بأن الدفاع عن الجميع هو السبيل الوحيد لتحقيق التقارب بين المسلمين!
وإنه لأمر غريب حقا، فمتى كان التمسك بأسباب الانشقاق هو الشرط الذي يضمن تحقيق الانسجام؟!
ولنتذكر ثانية أن هذا هو واحد من إيحاءات (الخوف من الهزيمة) الذي نعاني منه، وإلا أفلا يكون من دواعي الاستغراب أن تضيق صدورنا عن تتبع النص الإسلامي الشرعي، والتمسك به؟!
ذلك ونحن نعتقد جميعا إن مسؤوليتنا تتلخص في حفظ هذا الدين الحنيف كما أراده الله ورسوله، بالتزام الموقف الحق الثابت الذي لا غبار عليه، وحمايته سواء وافق ميول الأشخاص، أو خالفها!
هكذا يتبين إذن أنه لا يجوز استغلال شعار " الوحدة الإسلامية " للتخلي عن مسؤوليتنا الشرعية في التفكير الحر، وانتخاب الموقف عن وعي وبصيرة.
إن الوحدة بين المسلمين يجب أن تفهم أنها قضية رسالية أساسية.
فليست هي موضوعا طائفيا يجمع المسلمين أمام الأمم الأخرى، وحسب ولا هي دعوى فوقية يراد منها التزلف والتملق فيما بيننا.
ولم تكن في عرف التشريع السماوي المقدس هدفا دنيويا مصلحيا مؤقتا.
بل هي أكبر من ذلك كله، إنها مسؤولية رسالية بحجم هذه الرسالة، أريد لها أن تسود، كما أريد لها البقاء والخلود.
فما أحوجنا إلى أن ندرك واجباتنا في حفظ مجتمعنا الإسلامي النزيه، وتحقيق الانسجام والتآلف بين أفرادنا وفصائلنا، ومعالجة أسباب (هذه الفرقة، التي لم تؤذ السني في مواجهة الشيعي فقط، ولا الشيعي في مواجهة السني فقط، ولكنها كرست تفتيت السني إلى عدة مذاهب، وكرست تفتيت الشيعي إلى عدة مذاهب) (2).
- إن اتفاق المسلمين في قضاياهم المصيرية ليكونوا أمة واحدة، ويدا واحدة في مواجهة المسؤوليات، وفي البناء الحضاري الإسلامي، وفي حفظ هذا الدين العزيز، والوقوف بوجه المخاطر والتحديات، هي من الأمور التي يجب
____________
(1) الروم: 31 - 32.
(2) من مقالة للدكتور فهمي الشناوي بعنوان (الفتنة الكبرى المعاصرة) نشرتها مجلة العالم في عددها 336 من عام 1990.
وإذا كان هذا الهدف كبيرا وعظيما، فهو ليس مستحيلا ولا مستبعدا.
وحين تتوفر لدينا الرغبة الصادقة في بلوغ هذا الهدف نكون قادرين على تبني المشروع الوحدوي المتكامل الذي يستوعب جميع الخطوات الأساسية على هذا الطريق، والتي يمكن حصرها بما يلي: - أولا: إزاحة الحواجز النفسية المتراكمة فينا، والتي لم ترتكز على دليل علمي، ولا حجة منطقية، ولا أساس من الدين الذي أمرنا الشارع المقدس أن نتدين به.
ثانيا: تحقيق المستوى الكافي من الوعي بمسؤولياتنا تجاه الإسلام، والأمة المسلمة.
ثالثا: التوجه نحو المبادئ المشتركة فيما بيننا - والتي تشكل لوحدها كل العناصر الأساسية اللازمة لتحقيق أفضل مستوى من الاتحاد بين المسلمين -:
كوحدة العقيدة بأركانها، ومصادر التشريع الأساس، وفروع الدين، وما لا يحصى من الأحكام التفصيلية الأخرى، هذا مع إيماننا جميعا بوحدة المصير.
إذ إن وحدة المصير - لوحدها - لو أخذناها مأخذ الجد، لأزاحت الكثير والكثير جدا من العقبات التي تحول دون تفاهمنا.
إن خطوات كتلك ستخلق التآلف الحقيقي، وهو التأليف بين القلوب كما يصفه الله تبارك وتعالى بقوله: (وألف بين قلوبهم) (1).
____________
(1) الأنفال: 63.
والعبارات الخطابية الرنانة، والألفاظ الأدبية الساحرة، التي تصور درجة عظمى من الاتحاد والتماسك، ولكن قد لا تجد لها مصداقا في القلوب.
وفي أبسط لغة، ومع الحد الأدنى من البرهان، نقول: إن كلا منا يشهد للآخرين بأنهم مسلمون..
وبهذه الشهادة وحدها يترتب عليه أن يحفظ تجاههم كل حقوق المسلم على أخيه المسلم، والتي بينها الشارع المقدس في عشرات، بل مئات النصوص من قرآن وسنة:
فدمه، وعرضه، وماله حرام، واغتيابه حرام، وبهتانه من الكبائر، وسبابه فسوق، وقتاله كفر، والغش له والغدر به جفاء مع الدين كله، بل عليه أن يعيش معه كأعضاء الجسد الواحد، وأن يحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لها، ولا يقبل فيه أقوال الوشاة والساعين في بث الفرقة والخلاف.
كل هذا، وكثير غيره، يعد من أوليات الأخلاق الإسلامية، ومما يتعلمه المسلم في أول حياته، وابتداء من أبسط الحقوق: كإفشاء السلام، وعيادة المريض، وانتهاء بأكبرها: كالايثار بالنفس.
فما بالنا ننسى كل هذا، بمجرد أن نختلف في مواردنا الفقهية؟!
ثم نجعل نقطة الخلاف هذه، قبلتنا التي إليها نتوجه في أفكارنا، واهتماماتنا، وأحاديثنا في جلسات سمرنا، لتصبح فيما بعد مواقف سياسية وعقائدية تفصل بيننا؟
ولماذا لا ندرك أن كل ما حصل في هذه الأمة من انقسامات وتشعب في الموارد، إنما هو وليد الخلاف السياسي الذي ظهر مرة، ثم تهيأ له أن ينمو بعدما ظهر، وهو لأجل أن ينمو ويستمر، لا بد أن يعتمد أساسا " شرعيا " وعليه فلا بد أن يشق له مورده الفقهي المناسب، ولو تدريجيا، وعن غير قصد، ولكنه
وهكذا قل مع كل مورد أدخلت فيه السياسية أصابعها، حتى تحصل في الواقع اتجاهات متعددة، تتوغل في البعد عن بعضها كلما أرادت تدعيم حججها وإظهار معالمها.
والحقيقة هي هكذا لو تبصرنا فيها.
ولو لا خشية الخروج عن منهجنا، لفصلنا القول في إيضاح ذلك، ولكنا اكتفينا بما يشير إليه ضمن فصول هذا الكتاب، تاركين التطبيق للقارئ الكريم لأن تكلف التطبيق سيخرج بنا عن منهجنا في هذا البحث، أولا، وسيرغمنا - ثانيا - على الإطالة، التي سعينا جاهدين لتجنبها.
وأمام تلك الحقائق، فلا مفر من كوننا جميعا، على قدم سواء في المسؤولية، مسؤولية البحث، والتحري، والاستكشاف، ثم انتخاب الموقف الواعي، القويم، غير المنحاز، وغير المتطرف.
وكلنا متساوون في الحاجة إلى مراجعة مواقفنا، ثم إعادة بنائها على أساس سليم. وإلى هذا كان سعينا، وفق خطوات نعرضها مرتبة في فصول هذا الكتاب.
والله من وراء القصد (والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) (1):
____________
(1) العنكبوت: 69.
هكذا كانت البداية
مع الحسين - مصباح الهدى - كانت البداية.
ومع الحسين - سفينة النجاة - كان الشروع.
بداية لم أقصدها أنا، وإنما هي التي قصدتني، فوفقني الله لحسن استقبالها، وأخذ بيدي إلى عتباتها..
ذلك كان يوم ملك علي مسامعي صوت شجي، ربما كان قد طرقها من قبل كثيرا فأغضت عنه، ومالت بطرفها، وأسدلت دونه ستائرها، وأعصت عليه.
حتى دعاني هذه المرة، وأنا في خلوة، أو شبهها، فاهتزت له مشاعري ومنحته كل إحساسي وعواطفي، من حيث أدري ولا أدري..
فجذبني إليه.. تتبادلني أمواجه الهادرة.. وألسنة لهيبه المتطايرة..
حتى ذابت كبريائي بين يديه، وانصاع له عتوي عليه..
فرحت معه، أعيش الأحداث، وأذوب فيها.. أسير مع الراحلين، وأحط إذا حطوا، وأتابع الخطى حتى النهاية..
تلك كانت قصة مقتل الإمام الحسين عليه السلام، بصوت الشيخ عبد
فأصغيت عنده أيما إصغاء لنداءات الإمام الحسين..
وترتعد جوارحي، مع الدمعة والعبرة، وشئ في دمي كأنه الثورة..
وهتاف في جوارحي.. لبيك، يا سيدي يا بن رسول الله..
وتنطلق في ذهني أسئلة لا تكاد تنتهي، وكأنه نور كان محجوبا، فانبعث يشق الفضاء الرحيب دفعة واحدة..
إنطلاقة يؤمها الحسين، بقية المصطفى، رأس الأمة، وعلم الدين؟
إنطلاقة الإسلام كله تنبعث من جديد، ورسول الله يقودها من جديد، بشخص ريحانته، وسبطه الحسين؟
وهذه نداءات الإسلام يبثها أينما حل، والجميع يعرفها! ولا يعرف للإسلام معنى في سواها؟
ومصارع أبناء الرسول؟!!
وتيار الانحراف يجرف الحدود، ويقتحم السدود؟!
وأشياء أخرى لا تنتهي...
وتعود بي الأفكار إلى سنين خلت، وأنا أدرج على سلم الدرس، لم أشذ فيها عن معلمي، فقلت: ليتني سمعت إذا ذاك ما يروي ضمأي..
ولكن، ما هو ذنب معلمي! إنه مثلي، كان يسمع ما كنت أسمعه، وليس إلا..
بل ليتها مناهجنا قد نالت شرف الوفاء لهذا العطاء الفريد..
ليتها مرت على فصول تلك الملاحم، ولو مرور العابرين! من غير تعظيم، أو تمجيد، أو ثناء..
فليس ثمة حاجة إلى شئ من هذا القبيل، فقد تألق أولئك الأبطال فوق ذروة المديح والثناء، فكأنني أنظر إلى منابر التبجيل والإطراء مهطعة تحدق
ثم أنت يا حلق الوعظ، ويا خطب الجمع ويا بيوتات الدين، أين أنت من هذا البحر اللامتناهي؟!
لقد صحبتك طويلا، فليتني وجدتك اتخذت من أولئك الأبطال، وتلك المشاهد أمثلة تحتذى في معاني اليقين والجهاد، أو الإقدام والثبات، أو التضحية والفداء، أو النصرة والإباء، أو الحب والعطاء أو غيرها مما يفيض به ميدان العطاء غير المتناهي ذاك، كما عهدتك مع نظائرها، وما هو أدنى منها بكثير!
وأين أنت أيتها الدنيا؟!
وعلى أي فلك تجري أيها التاريخ؟!
ألا تخشى أن يحاكمك الأحرار يوما؟
عتاب لاذع، وأسئلة لا تنتهي، والناس منها على طرق شتى..
فهي تمر على أقوام فلا يكاد يوقظهم صداها، ولا يفزعهم صخبها!!
ورأيتها تمر على آخرين فتكاد تنتزع أفئدتهم، من شدة ما لهم معها من هياج ونحيب، وأدمع تجري فلا تريد أن تكف..
ويلتهبون على الجناة غيظا ونقمة وحنقا..
فتمتلئ صدورهم من هذا وذاك بكل معاني الموالاة والبراءة..
موالاة لله وأوليائه، وبراءة من أعدائه..
ولم لا تنفطر الأكباد لفاجعة كهذه!
وبدلا من أن تهربي من ذكراها - أيتها الدنيا - في العام مرة، أولى بك أن تقفي عندها كل يوم ألف مرة، ولا تستكثري.
أكثير أن يحيا الحسين السبط بيننا على الدوام، وليس كثيرا أن يقتل بين يديك كل يوم ألف مرة؟!
وبين هذا وذاك منازل شتى في القرب والبعد من معالم الحسين..
وأشياء أخرى تطول، فقد استضاءت الدنيا كلها من حولي، وبدت لي شاخصة معالم الطريق..
فرأيت الحكمة في أن أسلك الطريق من أوله، وأبتدئ المسيرة بالخطوة الأولى لتتلوها خطى ثابتة على يقين وبصيرة..
وابتدأت، وإن كانت الأيام تشغلني بين الحين والحين بما يصد المرء عن نفسه وبنيه، إلا أني أعود إذا تنفست فأتابع الخطى.
وقد حملت الصفحات الآتية أهم تلك الخطى، ولم أكن أفقد إحساسي بمدد الله تعالى وتوفيقاته ما دمت أشعر بالقرب منه جل جلاله..
وهو حسبي..
