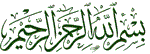
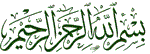
كلمة المركز
في الوقت الذي توحد فيه الأصول الاعتقادية بين المسلمين جميعهم تتيح للعلماء المجتهدين منهم الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية استنادا إلى هذه الأصول الأمر الذي أدى إلى ظهور المذاهب الفقهية وتعدد وجهات النظر.
وإن يكن الاجتهاد هذا يفضي إلى اختلاف في وجهات النظر إلى أمور ليست من الأصول الاعتقادية فينبغي ألا يؤثر هذا الاختلاف على وحدة الأمة الإسلامية فهذه الوحدة يجب أن تبقى مصانة من تأثير أي عامل قد يؤدي إلى الخصومة والتفرق.
فالشريعة الإسلامية إذ تبيح التعدد فإنما تريده أن يكون اجتهادا يحقق مصلحة المسلمين العليا في إطار الوحدة الأمر الذي يمكنهم إن تحقق من مواجهة مختلف التحديات في كل زمان ومكان.
يدرك المؤلف هذه الحقيقة التي تنص عليها غير آية قرآنية وينطلق من هذا الإدراك في تأليف كتابه هذا فيبحث في مسائل فقهية خلافية كانت ولا تزال مثار جدل ونقاش بين الفقهاء السنة والشيعة وهي: الجمع بين الصلاتين، المسح على الأرجل في الوضوء، المسح على الخفين السجود على الأرض الأذان، زواج المتعة. ويسعى إلى أن يكون في بحثه موضوعيا متجردا فيعرض المسألة والآراء المتعددة التي قيلت في شأنها ويتقصى الأدلة التي قدمها كل طرف بغية الوصول مع القارئ إلى رأي يزيل سوء الفهم القائم.
والمؤلف في هذا الكتاب يواصل صنيعا في سبيل الوحدة كان قد بدأه عندما أصدر كتابه: " الوحدة العقائدية عند الشيعة والسنة ".
مركز الغدير للدراسات الإسلامية
بيروت
مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الأطهار الطيبين وصحابته المنتجبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد
إن هذه الشرعة الغراء مثالية في غزارة عطائها وتواصل نمائها ولها من السعة والمرونة ما يجعلها صالحة - على نحو الضرورة - في جميع العصور وفي شتى البقاع.
وقد نشأ عن تلك المرونة والثراء في العطاء أن تعددت وجهات النظر وتفاوتت الأفهام في استنباط الأحكام الشرعية منها. ومن هنا ظهرت المذاهب والاجتهادات الفقهية لكنها لا تختلف في ما بينها حول الأصول الاعتقادية التي تشملهم جميعا، أمة واحدة متميزة منضوية تحت لواء الإسلام العظيم.
وينبغي أن نشير إلى أن الاجتهاد وتعدد النظر أمران لا غضاضة فيهما البتة من حيث المبدأ بيد أنه لا بد أن يكونا في إطارهما الصحيح حتى يؤديا دورهما البناء ولا يخرجا عن جادة الصواب وهذا الإطار تتلخص عناصره في ثلاث نقاط:
اولا: أن يكون مستندا إلى الدليل المنطقي المستنبط من مصادر التشريع المعتمدة.
ثانيا: أن لا يكون عن هوى أو تعصب أو تقليد أعمى بلا بينة واضحة.
ولذلك يجب أن نجعل هذا الإطار نصب أعيننا باعتباره أرضية مناسبة لقيام صرح الوحدة الإسلامية الكبرى بين جميع المذاهب على تعدد آرائها ووجهات نظرها.
ولا نعني بالوحدة الإسلامية أن يتخلى كل ذي مذهب عن فكره واجتهاده الذي يطمئن إليه بل نقصد من وراء ذلك إلى الوحدة في الموقف والتلاحم بين الصفوف والتنسيق في العمل وبذل الجهود في مواجهة التحديات التاريخية والحضارية التي تواجه الأمة وتكتنف مسيرتها وتحيط بها من كل جانب.
ويلزم التمهيد لذلك بعاملين:
الأول: استساغة تعدد النظر وتباين الآراء باعتبارهما أمرين فطريين ناشئين عن تفاوت الأفهام بين البشر ومحاولة إيجاد صيغة للالتقاء بينها.
الثاني: جعل المصلحة العليا للإسلام الهدف الأسمى من وراء كل تحرك ونشاط.
ومن هذا المنطق أردنا أن نسلك هذا الدرب الرسالي في إرساء دعائم التلاحم والتقارب بين المذهبين العريقين والأخوة المتحابين من الشيعة والسنة حتى تسير الأمة في إطارها الوحدوي المرسوم لها من قبل الله عز وجل.
(إن هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) [ الأنبياء / 92 ].
(وإن هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون) [ المؤمنون / 52 ].
قيل لفضيلته: إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية فهل توافقون - فضيلتكم - على هذا الرأي على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية مثلا؟
فأجاب فضيلته:
1 - إن الإسلام لا يوجب على أحد من اتباع مذهب معين بل نقول: إن لكم مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة. ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره - أي مذهب كان - ولا حرج عليه في شئ من ذلك.
2 - إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة.
فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير حق لمذاهب معينة فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب فالجميع مجتهدون مقبولون عند الله تعالى يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات.
ويقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه (الإمام الصادق ص 16): " وأن المسائل التي يتخلف فيها الفقه الإمامي نجد من بينها - حتما - ما يتفق مع رأي الجمهور ونجد ما لا يوافق الجمهور وليس فيه معارضة لكتاب أو سنة نجد له وجهة معقولة يقبلها الدارس الفاحص كقولهم بجواز إنهاء الوقف وتقسيمه بين المستحقين إذا طلبه بعضهم ولو كان الوقف مرتب الطبقات وقد ذكرنا في بعض بحوثنا أن القانون (رقم 180 لسنة 1952)) الذي أنهى الوقف الأهلي يتلاقى مع ذلك الرأي الذي نص عليه في فقه الإمامية وأن الأقوال التي نرى أنها تخالف إجماع جماهير المسلمين ليست كثيرة ولهذا نقرر أن الفقه الاثني عشريا ليس بعيدا كل البعد عن فقه أئمة الأمصار ".
ويقول - أيضا - عند حديثه عن البلاد التي ينتشر فيها التشيع (ص 567): " إن أكثر البلاد الإسلامية وخصوصا النائية عن البلاد العربية فيها تشيع بفئات كبيرة أو أعداد صغيرة ولكنه في مجموعه لا يكون كثرة إسلامية ولا عددا قريبا من الكثرة المطلقة وإن كان عددا كبيرا في جملته فالكثرة الكبيرة سنية بلا ريب وإننا نأمل أن يندمج الجميع في وحدة شاملة لا تكون فيها كثرة وقلة طائفية بل يكون فيها جمع موحد. وإن كانت فيه مذاهب مختلفة وتفسيرات للشريعة في دائرة المقررات الشرعية متعددة فتعدد التفسيرات في دائرة المقررات الإسلامية دليل على الحيوية الفكرية والانقسام إلى طوائف دليل على التفرق والانقسام، والفرق بين الأمرين عظيم ".
ويقول الأستاذ المستشار عبد الحليم الجندي في كتابه (الإمام الصادق ص 3): " فقد تأكد في كتابنا (توحيد الأمة العربية) أن " الوحدة القانونية " هي الطريقة المثلى لربط المسلمين في شتى أقطارهم بتشريع إسلامي شامل تضال دونه التشريعات المعاصرة في الغرب أو في الشرق. والفقه " الشيعي " واحد من النهرين اللذين تسقى منهما حضارة أهل الإسلام وإليه لجأ الشارع
والإمام جعفر الصادق يقف شامخا في قمة فقه أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الفقه إمام وحياته للمسلمين إمام. والمسلمون - اليوم - يلتمسون في كنوزهم الذاتية مصادر أصلية للنهضة مسلمة غير مخلطة ولا مستوردة ".
ويقول في (ص 6): " فالكتاب الحالي يبلغ غرضه إذا كان صوتا يدعو للوحدة والمسلمون تجمعهم أصول فكرية واحدة وإن اختلفت الفروع أو تعددت الآراء، وفي تعدد الآراء ثراء ".
هذا الاتجاه البناء الهادف إلى تقريب وجهات النظر بين المذاهب الفقهية المتعددة إن دل على شئ فإنما هو دليل على سعة الأفق وارتقاء درجة الوعي والفهم الحقيقي لطبيعة هذا الدين.
وخلال هذا البحث نود فحص بعض الأمور الفقهية البارزة التي كانت مثارا للجدال والنقاش لفترات عديدة حتى يومنا هذا وكانت تمثل موضع خلاف لا يرجي له نهاية. مع إننا إذا نظرنا إلى هذه المسائل بتجرد وموضوعية لوجدناها تستند إلى دلائل لا غبار عليها مستنبطة من مصادر التشريع المعتمدة لا سيما من كتب أهل السنة أنفسهم لكن الفجوة القائمة وانغلاق باب الحوار والعزلة الفكرية التي سادت بين الطرفين ردحا طويلا من الزمن أدت إلى طمس معالم هذه الدلائل وجعلتها خافية عن الأذهان.
وهذه المسائل قد تناولتها كثير من الرسائل والمصنفات ومن أهمها أبحاث سماحة الإمام العلامة السيد شرف الدين العاملي (قدس سره) وقد استقينا هذا البحث من عدة مصادر عند إخواننا الشيعة ذكرناها في آخره ولم نخصص موضعا لذكر المصادر السنية نظرا لإدراجها في ثنايا المواضيع مع تعيين كل منها.
وقد توخينا في هذا البحث أن نعرض وجهة نظر إخواننا كاملة وأدلتهم التي ساقوها واستندوا إليها بحذافيرها الواردة في كتب أهل السنة
ونلفت نطر القارئ الكريم إلى أننا قمنا قبل ذلك بتصنيف كتاب آخر بعنوان: (الوحدة العقائدية عند الشيعة والسنة) من أجل خدمة هذا الغرض النبيل نفسه، وهو وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم. فلا يفوتن الباحثين وكلاب الحقيقة مطالعته بالإضافة إلى مطالعة هذا البحث الذي بين يدي القارئ فإن في الإطلاع عليهما بغية الطالب ومنية الراغب في هذا المجال الحيوي، وهو توحيد صفوف المسلمين وطمس معالم الفرقة والتشتت التي دأب المستكبرون وأذنابهم على إشاعتها بينهم.
ونرجو أن نكون قد وفقنا في عرض رأي إخواننا وبيان نظرتهم بلا تزيد أو انتقاص حرصا على الأمانة العلمية التي أناطها الله بأعناق الدعاة إلى سبيله ورعاية لحقوق الأخوة التي أوجبها الله على المسلمين كافة.
والله تعالى من وراء القصد (وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه أنيب).
المؤلف
[ 1 ]
الجمع بين الصلاتين
إن الصلاة هي الركن الأعظم من الدين وعموده المتين وتحتل منه موقعا متميزا لم تشاركها فيه فريضة أخرى. وقد أوجب الله تعالى أداءها بانتظام والمحافظة عليها حتى في أوقات الشدة والخوف مثل الحرب والجهاد قال تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم..) [ النساء / 102 ].
وجاء في الحديث الشريف عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة " (1).
وبالرغم من هذا التشدد في أمر الصلاة والتأكيد على عدم التهاون في شأنها إلا أن الإسلام لم يزل دين اليسر والسهولة وما برح ينأى بأتباعه عن العنت والمشقة بل إنه يأبى التضييق في العبادة، لأن ذلك قد يفضي إلى تعسر أدائها ثم إلى تركها نهائيا.
ولذلك أدخل الإسلام تيسيرات كثيرة في الصلاة من أجل تسهيل القيام بها والمواظبة عليها تستوعب طبيعة أدائها وعدد ركعاتها وأوقاتها.
فأما ما يتعلق بطريقة الأداء فإن الإسلام قد أجاز لمن لا يستطيع أداءها قائما أن يؤديها قاعدا ومن لا يستطيع أن يؤديها قاعدا فلا حرج عليه أن يؤديها مضطجعا.
____________
(1) رواه مسلم وأحمد.
أما في ما يتعلق بعدد ركعاتها فإن الإسلام قد أجاز قصر الصلوات الرباعية بحيث يؤديها المسافر ثنائية وفق الشرائط المقررة لذلك وهذا - أيضا - من باب التيسير والتخفيف أثناء السفر.
أما في ما يخص أوقاتها فإن الإسلام قد أجاز الجمع بين الصلوات سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير تيسيرا لأدائها على المؤمنين ورفعا للضيق والحرج عنهم ولا خلاف بين أهل القبلة من المذاهب الإسلامية كلها في جواز الجمع أثناء الوقوف بعرفة بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم:
أي أداء العصر في وقت الظهر بعد أداء الأخيرة مباشرة كما لا خلاف بينهم في جواز الجمع في المزدلفة بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير: أي أداء صلاة المغرب في وقت العشاء بدءا بصلاة المغرب ثم العشاء على الترتيب وهذا من المستحبات القطعية والسنن النبوية المؤكدة لكن الخلاف قد وقع في جواز الجمع في ما عدا هذين الموطنين.
فأما الحنفية فقد منعوا الجمع بين الصلاتين مطلقا في ما عدا الجمع في عرفة والمزدلفة بالرغم من توفر الأحاديث الصحيحة وتضافرها في جواز الجمع ولا سيما في السفر لكنهم تأولوها على صراحتها في ذلك وحملوها على محامل أخرى مثل الجمع الصوري، الذي هو عبارة عن تأخير الداء الصلاة إلى آخر وقتها ثم أدائها مع الصلاة التي تليها في أول وقتها.
وأما الشافعية والمالكية والحنبلية فقد أجازوا الجمع في السفر لكنهم اختلفوا في جوازه في عدة أعذار أخرى قد تبيحه مثل المطر والطين والمرض والمرأة المرضع أو المستحاضة وكذلك في شروط السفر المبيح له.
أما بالنسبة لأئمة أهل البيت عليهم السلام فإنهم قالوا بجواز الجمع بين الصلاتين مطلقا وتبعهم في ذلك شيعتهم الآخذون بمذهبهم والعاملون
أخرج البخاري (في باب: تأخير الظهر إلى العصر من كتاب مواقيت الصلاة) بسنده عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى " (1).
وأخرج أيضا (في باب: وقت المغرب) عن جابر بن يزيد عن ابن عباس قال: " صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا " (2).
وأخرج الترمذي (في باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر) بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: " جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته " (3).
وأخرج مسلم في صحيحه (باب: الجمع بين الصلاتين):
- بسنده عن أبي زبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لم فعل ذلك؟
____________
(1) صحيح البخاري: ج 1 ص 144.
(2) المصدر نفسه وأخرجه - أيضا - مالك في الموطأ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ص 125.
(3) صحيح الترمذي: ج 1 ص 355.
- بسنده عن حبيب بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
" جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. في حديث وكيع قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟
قال: كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته ".
- بسنده عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: " صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذلك ".
- بسنده عن عبد الله بن شقيق قال: " خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة.. الصلاة قال: فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة... الصلاة فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟! ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بم شقيق: فحاك في صدري من ذلك شئ فأتيت أبا هريرة فصدق مقالته ".
- بسنده - أيضا - عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: " قال رجل لابن عباس: الصلاة فسكت ثم قال: الصلاة فسكت ثم قال: الصلاة فسكت ثم قال: لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! ".
قال النووي في شرحه على (صحيح مسلم): " هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب... " ثم قال: " منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين وهو ضعيف بالرواية الأخرى: " من غير خوف ولا مطر ". ومنهم
قلنا: إن هذا التأويل الأخير مردود من وجوه:
أولا: إن الأحاديث الواردة في الجمع مطلقة وليست مقيدة بمرض أو غيره.
ثانيا: إن الأحاديث جاءت بألفاظ متقاربة منها: " في غير خوف ولا مطر " والخوف يندرج تحته جميع الأسباب التي تدعو إليه من مرض وتعب وإرهاق وإرضاع وانشغال بأمر هام... إلى غير ذلك من الأعذار التي قد تسبب مشقة لصاحبها.
ثالثا: إنه لو فرض أن الجمع كان بعذر المرض ونحوه لكان قد جمع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يتوفر له العذر نفسه أما الباقون فلا يسوغ لهم الجمع.
وهذا يعارض ظاهر الأحاديث الواردة على إطلاقها.
رابعا: إن ابن عباس لم يكن يخطب في مستشفى بحيث يجبر غيره على الجمع بدليل أنه عنف الرجل الذي كان يلح في الصلاة قائلا له: " أتعلمني
____________
(1) مسلم بشرح النووي: ج 5 ص 218.
وهذا يدل بوضوح على أن ابن عباس قد أصاب السنة بعينها بدليل أن أبا هريرة - أيضا - أيده في فعله ولم يذكر عذرا واحدا لتقييد هذا الجمع وبالتالي تنتفي كافة الأعذار التي يمكن أن يتعذر بها المعارضون للجمع على إطلاقه.
ثم قال النووي في تكملة شرحه للأحاديث: " وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين واشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: " أراد أن لا يحرج أمته " فلم يعلله بمرض ولا غيره. والله أعلم ".
قلنا: بالرغم من أن هذا القول يشبه إلى حد كبير ما عليه مذهب أهل البيت عليهم السلام إلا أننا لا ندري ما المقصود بقولهم: " للحاجة لمن لا يتخذه عادة " وبأي دليل جاؤوا بتلك العبارة: " لمن لا يتخذه عادة " وهل كان ابن عباس متكاسلا عن قولها حتى يفسح المجال لغيره كيما يقولها من بعده نيابة عنه؟!
وقال الحافظ في (الفتح) في شرح الحديث الوارد في (صحيح البخاري) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
قال: " وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة.
وممن قال به: ابن سيرين وربيعة واشهب وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال: فقلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج من أمته ". وللنسائي من طريق عمر وبن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما
مما تقدم يتبين لنا أن الجمع بين الصلاتين جائز على إطلاقه وأن الهدف من وراء ذلك هو رفع الحرج عن أفراد الأمة وإدخال اليسر والتوسعة عليهم بحيث يصبح في مقدور كل إنسان أن يؤدي الصلوات بانتظام من دون أدنى عسر أو مشقة.
قال تعالى: (هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم..) [ الحج / 78 ].
ولا ريب أن هذا التيسير يساعد على المواظبة على أداء الصلوات والمحافظة عليها كما أن التشدد في وجوب التفريق على خمسة أوقات منفصلة قد أدى إلى تضييق نطاقها والتكاسل عن أدائها جملة لا سيما عند أهل المشاغل والمصالح وما أكثرهم.
ومما يدل - أيضا - على جواز الجمع مطلقا كتاب الله المجيد إذ يبين أن أوقات الصلوات المفروضة هي ثلاثة أوقات فحسب وهي وقت لفريضتي الظهر والعصر مشتركا بينهما ووقت لفريضتي المغرب والعشاء مشتركا بينهما ووقت ثالث لفريضة الصبح خاصة.
____________
(1) فتح الباري: ج 2 ص 20.
قال الرازي حول تفسيرها: " فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب. وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات: وقت للزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر. وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا - أيضا - بين هاتين الصلاتين فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا إلا أنه دل الدليل على أن الجمع في الحضر لا يجوز من غير عذر فوجب أن يكون الجمع جائزا بعذر السفر وعذر المطر وغيره " (1).
قلنا: لقد بحثنا في ما ذهب إليه بأن الجمع في الحضر لا يجوز من غير عذر فلم نجد له عينا ولا أثرا وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع في حال العذر وفي حال عدمه - أيضا - توسعة على أمته ورفعا للحرج عنها وتلك هي السنة العصماء التي جاء بها خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
____________
(1) التفسير الكبير للرازي: ج 21 ص 27.
[ 2 ]
المسح على الأرجل في الوضوء
إن الله - سبحانه - قد تعبد خلقه بعبادات كثيرة ومتنوعة وكل منها يؤدى بشكل معين وبترتيب محدد والعلة من وراء هذا الترتيب في أداء العبادة فضلا عن الغاية الكامنة في العبادة ذاتها غير معلومة على وجه التحديد ومن ثم تؤدى هذه العبادات بكل خضوع وإذعان وبشكل توقيفي دون البحث في الحكمة من كيفيتها أو الغاية من ورائها. ولا دخل للعقل في استكناه الحكمة من وراء الكيفية بل هو أمر يعتمد على الاستجابة الخالصة لما يمليه الشارع فحسب. ومن هنا اقتبس لفظ العبادة الذي يعبر عن الأمر الصادر من السيد المطلق - سبحانه وتعالى - إلى مخلوقة وما على هذا المخلوق إلا أن ينفذ هذا الأمر بحذافيره بوصفه عبدا خاضعا لسيده ومولاه.
والوضوء يمثل أحد الأعمال التعبدية التي يؤديها المسلم قبل الصلاة في حالة وجود الماء وتوفر القدرة على استعماله وله كيفية معينة قد ذكرها الله - سبحانه - في كتابه المجيد إذ يقول: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين...) [ المائدة / 6 ].
قال الرازي عند بلوغه هذه الآية من (تفسيره الكبير) في المسألة الثامنة والثلاثين: " اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما فنقل القفال في (تفسيره) عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي والإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر: أن الواجب فيهما المسح وهو مذهب الإمامية من الشيعة. وقال جمهور الفقهاء والمفسرين: فرضهما الغسل. وقال الحسن
وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخير بين المسح والغسل " (1). والذي عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام هو مسح الأرجل فرضا على سبيل التعيين وتبعهم في ذلك شيعتهم المتفقون أثرهم ولكن هل لهم من حجة تؤيدهم فيما ذهبوا إليه؟
هذا ما أورده الرازي في (تفسيره) حيث استطرد قائلا: " حجة من قال بوجوب المسح مبنية على القراءتين المشهورتين في (وأرجلكم) فقرا ابن كثير وحمزة وأبو عمر وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه بالنصب.
فنقول: أما القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس فكما وجب المسح في الرأس كذلك وجب في الأرجل.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: هذا الكسر على الجوار كما في قوله:
جحر ضب خرب أو: كبير أناس في بجاد مزمل؟
قلنا: هذا باطل من وجوه:
أولها: إن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يحتمل لأجل الضرورة في الشعر وكلام الله يجب تنزيهه عنه.
وثانيها: إن الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله: جحر ضب خرب فإن المعلوم بالضرورة أن الخرب لا يكون نعتا للضب بل للجحر وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل.
وثالثها: إن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب.
____________
(1) التفسير الكبير للرازي: ج 11 ص 161. وانظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري:
ج 2 ص 254: " واختلفوا في (وأرجلكم) فقرا نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام وقرأ الباقون بالخفض ".
إذا ثبت هذا فنقول: ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله:
(وأرجلكم) هو قوله: (وامسحوا) ويجوز أن يكون هو قوله: (فاغسلوا) لكن العاملين إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى فوجب أن يكون عامل النصب في قوله (وأرجلكم) هو قوله: (وامسحوا) فثبت أن قراءة (وأرجلكم) بنصب اللام توجب المسح أيضا. فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية على وجوب المسح ثم قالوا: ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز ".
نقول: هذه حجة من استدل بالآية المباركة - فحسب - على وجوب المسح على الأرجل في الوضوء.
ثم قال الرازي: " إن الأخبار وردت بإيجاب الغسل والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحها ".
نقول: هذا القول الذي ذهب إليه الرازي بأن الغسل مشتمل على المسح وأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحها لورود الأخبار بذلك هو قول مردود من وجوه:
أولا: القول بأن الغسل مشتمل على المسح يقتضي إدراج الرأس - أيضا - مع الأرجل لاشتراكهما في الحكم وهذا يستلزم غسل الرأس وذلك غير حاصل قط لأن التفريق بينهما يقتضي مصادرة الآية بالأخبار.
ثانيا: إن الله - عز وجل - قد أوجب شيئا اسمه (غسل) يختص بالوجوه
ثالثا: إن الغسل لغة له كيفية معينة وطريقة خاصة به كما هو معروف وكذلك المسح له كيفية مختلفة لغة وعرفا ولا يجوز أن يخلط بينهما أو أن يمتزج بعضهما ببعض.
رابعا: إن الاحتياط لا يتحقق إلا بالجمع بين المسح والغسل لكونهما حقيقتين مختلفتين كما ذهب إلى ذلك داود الأصفهاني والناصر بالحق من أئمة الزيدية حيث التبس الأمر عليهما وأوقعهما في حيرة بسبب التعارض بين الآية والأخبار فأوجبا الجمع بينهما عملا بهما معا. أما القول بأن الغسل مشتمل على المسح فهذه مغالطة واضحة.
خامسا: إذا تعارضت الأخبار مع النص القرآني الصريح فإنه يجب الأخذ بالقرآن قطعا والعمل به وأما الأخبار فإما أن تؤول بنحو من التأويلات ما أمكن لذلك سبيل أو تطرح نهائيا نظرا لتعارضها مع الكتاب القطعي.
ألا ترى أنه إذا جاء القرآن بقوله: (امسحوا) وجاءت الأخبار بقولها (اغسلوا) فبأيهما نأخذ؟
سادسا: ورد بعض الآثار الصحيحة الدالة على أن الواجب في الوضوء هو مسح الأرجل وفقا لكتاب الله تعالى.
قال الإمام الطبري في تفسيره لآية الوضوء:
" وقرأ ذلك آخرون من قراء الحجاز والعراق (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) بخفض (الأرجل) وتأول قارئو ذلك كذلك إن الله إنما أمر عباده بمسح الأرجل في الوضوء دون غسلها وجعلوا (الأرجل) عطفا على (الرؤوس) فخفضوها لذلك.
ثم روى الطبري عدة روايات في ذلك منها:
- عن ابن عباس قال: " الوضوء غسلتان ومسحتان ".
- عن عكرمة قال: " ليس على الرجلين غسل إنما أنزل فيهما المسح ".
- عن جابر عن أبي جعفر قال: " امسح رأسك وقدميك ".
- عن الشعبي قال: " نزل جبريل بالمسح " ثم قال الشعبي: " ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا؟! ".
- عن إسماعيل قال: " قلت لعامر (أي الشعبي): إن ناسا يقولون: إن جبريل نزل بغسل الرجلين؟ فقال: نزل جبريل بالمسح ".
- عن قتادة في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) قال: " افترض الله غسلتين ومسحتين ".
ثم روي بعدة أسانيد عن علقمة ومجاهد والشعبي وأبي جعفر والضحاك أنهم كانوا يقرؤون (وأرجلكم) بالخفض (2).
قلنا: هذه جملة من الآثار الصحيحة تفرق بين الغسل والمسح وتثبت - صراحة - أن الواجب في الأرجل هو المسح لا غير والغريب - بعد هذا كله - أن هناك من يقول بأن الغسل مشتمل على المسح أو أن المقصود بالمسح هو الغسل الخفيف!!
____________
(1) هذا الخبر رواه البيهقي في السنن الكبرى: ج 1 ص 71. ونقول: الحمد لله أن قد علمنا أن الحجاج كان يرى غسل الأرجل ويأمر به!!
(2) تفسير الطبري: ج 10 ص 57.
وأخرج عبد الرزاق الصنعاني في (مصنفه):
- عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا في هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) قالا: " نمسح الرجلين ".
- عن قتادة عن جابر بن يزيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: " افترض الله غسلتين ومسحتين ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين ". وقال رجل لمطر الوراق: من كان يقول المسح على الرجلين؟ فقال: " فقهاء كثيرون ".
- عن ابن جريج قال: " أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول:
قال ابن عباس: الوضوء مسحتان وغسلتان " (2).
نظرة في أخبار الغسل
والآن نلقي نظرة عابرة على بعض الأخبار التي استنبط منها الجمهور وجوب غسل الأرجل وهي تنقسم إلى قسمين:
أولا: منها ما هو غير دال صراحة على وجوب الغسل مثل الحديث الذي أخرجه الشيخان في (صحيحيهما) عن عبد الله بن عمرو وابن العاص
____________
(1) القسم الأول من الإصابة: ج 1 ص 307.
(2) المصنف: ج 1 ص 18.
وهذه الكلمة الأخيرة أي: " ويل للإعقاب من النار " قد وردت - أيضا - في حديث كل من أبي هريرة وعائشة.
وهذا لو صح فإنه يقتضي المسح لأنهم كانوا يعرفون كيفية الوضوء سلفا ومن ثم جعلوا يمسحون على أرجلهم كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكره عليهم بل أقرهم عليه وإنما أنكر عليهم قذارة أعقابهم واختلاطها بالنجاسات ولا عجب من ذلك فإن فيهم أعرابا حفاة جهلة كثيرا ما يتبولون على أعقابهم ولا يلقون لذلك بالا لا سيما في السفر فتوعدهم بالنار لئلا يدخلوا في الصلاة بتلك الأعقاب المتنجسة.
ثانيا: ومنها ما هو دال على الغسل - كما في (الصحيحين) - عن حمران ابن أبان قال: " رأيت عثمان ابن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا... " إلى أن قال: " ثم غسل قدمه اليميني ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ".
ومثله حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري - الوارد في (الصحيحين) - وقد قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا... إلى أن قال: فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم فال: " هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم... " إلى غير ذلك من الأخبار التي وردت في هذا المعنى، وفيها نظر من وجوه:
أولا: إنها جاءت مخالفة للكتاب المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والإجماع أئمة أهل البيت عليهم السلام الموافق للكتاب في وجوب المسح.
وكان يقول: " الوضوء غسلتان ومسحتان ".
ولما بلغه أن الربيع بنت عفراء الأنصارية تزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ عندها فغسل رجليه أتاها يسألها عن ذلك وحين حدثته به قال - متعجبا -: " أن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح " (1).
ثالثا: إنها لو كانت حقا لفاقت حد التواتر ولم يكن ثمة معارض لها لأن الحاجة إلى معرفة طهارة الأرجل في الوضوء حاجة عامة لرجال الأمة ونسائها أحرارها ومماليكها وهي حاجة ضرورية فلو كان الواجب غير المسح المنصوص عليه في الآية لعلمه المكلفون في عهد النبوة وبعده ولكان مسلما بينهم ولتواترت أخباره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل عصر ومصر فلا يبقى مجال لإنكاره ولا للشك فيه ولما لم يكن الأمر كذلك فقد كانت تلك الأخبار موضع نظر وحيث إنها تعارضت مع أخبار أخرى توجب المسح فلا مناص من الرجوع إلى الكتاب الحكيم فهو الفيصل في الأمر وقد علمت أنه أوجب المسح.
نظرة في احتجاج الجمهور بالاستحسان
ربما احتج الجمهور على غسل الأرجل بأنهم رأوه أشد مناسبة للقدمين من المسح كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل حيث إن القدمين لا ينقى دنسهما - غالبا - إلا بالغسل على عكس الرؤوس التي تنقى - غالبا - بالمسح.
____________
(1) أخرجه ابن ماجة في باب: ما جاء في غسل القدمين: ج 1 ص 156.
