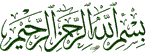
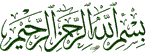
(سورة الزمر: آية/22)
الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)
بحار الأنوار 5/204
الإهداء
إلى وصي الأوصياء، وبقية الله من الصفوة المنتجين، ابن الأنوار الظاهرة، والأعلام الباهرة، والعترة الطاهرة، إلى معدن العلوم النبوية، وباب الله الذي لا يؤتي إلا منه، وسبيله الذي من سلك غيره هلك، ونور الله الذي لا يطفى، وحجة الله التي لا تخفى، صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء..
أهدي هذا المجهود المتواضع.
المقدمة
اللهم صلى على محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطه المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
 إن الجمود الذي تعيشه الأمة الإسلامية لم يكن حالة غريبة، اكتنفت المسلمين في حين غرة من أمرهم، وإنما هي نتيجة حتمية لعواصف الانحراف التي غيرت مسار الرسالة عن مجراها الطبيعي بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، في حين يفترض
إن الجمود الذي تعيشه الأمة الإسلامية لم يكن حالة غريبة، اكتنفت المسلمين في حين غرة من أمرهم، وإنما هي نتيجة حتمية لعواصف الانحراف التي غيرت مسار الرسالة عن مجراها الطبيعي بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، في حين يفترض
 إن حالة التمذهب التي يعيشها المسلمون قديماً وحديثاً، لا يمكن اعتبارها حالة صحيحة نابعة من صميم الدين، وإنما هي حالة سلبية لابد من مواجهتها وتخطيها بكل السبل، لأن الرسالة التي جاءت من إله حكيم لا يمكن أن تكون دعوة للتفرقة والتمذهب، وهو القائل {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي} (الأنبياء/92)، ولا يمكن أن نتصور الأمة الواحدة، إلا من خلال المنهج الواحد، ومن هنا كانت تعاليم الإسلام تعاليم واحدة، منسجمة مع سنن الله الكونية،
إن حالة التمذهب التي يعيشها المسلمون قديماً وحديثاً، لا يمكن اعتبارها حالة صحيحة نابعة من صميم الدين، وإنما هي حالة سلبية لابد من مواجهتها وتخطيها بكل السبل، لأن الرسالة التي جاءت من إله حكيم لا يمكن أن تكون دعوة للتفرقة والتمذهب، وهو القائل {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي} (الأنبياء/92)، ولا يمكن أن نتصور الأمة الواحدة، إلا من خلال المنهج الواحد، ومن هنا كانت تعاليم الإسلام تعاليم واحدة، منسجمة مع سنن الله الكونية،
 إن النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هو أعظم الرسل ورسالته هي آخر الرسالات وهنا تزدوج الأهمية والخطر، فالأهمية فيما يتعلق بالرسالة باعتبار أنها تلخيص كل رسالات السماء، وخطر بلحاظ العنصر البشري الذي تعود نزول رسالات الله عليه بين الحينة والفينة تصوب أخطاءه وترشده إلى الصراط السوي، وإذا اقتضت الضرورة وبلغ بالبشر الكبر والعناد، أرسل الله عليهم أنواع العذاب، ما يدلل على وجود رقابة إلهية على البشر، وهنا نتعرف على عمق الخطر الذي يعيشه المسلمون لعدم وجود تلك العناية التي تصحح مسارهم، إذا فرضنا عدم وجودها كما هو المعروف عند معظم المسلمين، إن الأرض لا يمكن أن تتصل بالسماء بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإذا سلمنا بهذه الفكرة فإنها تخيم اليأس والإحباط واللامبالاة بالواقع الفاسد، فما عسى أن يفعل الإنسان إذا تخلت عنه إرادة السماء، وبما أن عناية الله
إن النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هو أعظم الرسل ورسالته هي آخر الرسالات وهنا تزدوج الأهمية والخطر، فالأهمية فيما يتعلق بالرسالة باعتبار أنها تلخيص كل رسالات السماء، وخطر بلحاظ العنصر البشري الذي تعود نزول رسالات الله عليه بين الحينة والفينة تصوب أخطاءه وترشده إلى الصراط السوي، وإذا اقتضت الضرورة وبلغ بالبشر الكبر والعناد، أرسل الله عليهم أنواع العذاب، ما يدلل على وجود رقابة إلهية على البشر، وهنا نتعرف على عمق الخطر الذي يعيشه المسلمون لعدم وجود تلك العناية التي تصحح مسارهم، إذا فرضنا عدم وجودها كما هو المعروف عند معظم المسلمين، إن الأرض لا يمكن أن تتصل بالسماء بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإذا سلمنا بهذه الفكرة فإنها تخيم اليأس والإحباط واللامبالاة بالواقع الفاسد، فما عسى أن يفعل الإنسان إذا تخلت عنه إرادة السماء، وبما أن عناية الله
 عندما ينظر الإنسان لواقع الأمة الإسلامية تأخذه الحيرة من جراء الاختلافات والتمذهب الذي أصبح الطابع المميز في الوسط المسلم، ترى ماذا يصنع الإنسان؟ وأي الطرق يسلك؟
عندما ينظر الإنسان لواقع الأمة الإسلامية تأخذه الحيرة من جراء الاختلافات والتمذهب الذي أصبح الطابع المميز في الوسط المسلم، ترى ماذا يصنع الإنسان؟ وأي الطرق يسلك؟
في حين تدعي كل الطرق أنها الحق المطلق، مع إن الثابت بالضرورة أن الحق لا يمكن أن يتعدد بخلاف الباطل الذي يمكن أن يتشكل في وجوه مختلفة.
وهنا يتوجه السؤال المصيري.
هل ترك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمته من غير هدى؟ ومن غير ضمانة تتكفل بعصمة الأمة من الاختلاف والخطأ؟.
لا نريد الإجابة على هذا السؤال لأنه يتطلب بحوثاً عديدة وعميقة، ولكن يمكن الإشارة إلى بعض السبل التي إذا وجدت عصمت الأمة من غير شك،
بكلمة جازمة، كان يمثل المرجعية المعصومة الواحدة، ومن الضروريات البديهية أن القيادة الواحدة المعصومة هي الطريق المؤمن والوحيد لعصمة الناس من الاختلاف.
فإذا كان هنالك ضرورة لإيجاد ضمانة فتتعين في تنصيب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إماماً معصوماً يمثل المرجعية لكل المسلمين.
فهل يا ترى نصب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟!.
 إذا نظرنا إلى المذاهب بنظرة شاملة نجدها تنقسم إلى مذهبين كبيرين هما الشيعة والسنة، وأما
إذا نظرنا إلى المذاهب بنظرة شاملة نجدها تنقسم إلى مذهبين كبيرين هما الشيعة والسنة، وأما
 إن عمدة الخلاف بين السنة والشيعة يرجع إلى مسألة الإمامة والخلافة، ويعتمد أهل السنة في نظرية الخلافة على مبدأ الشورى، وبذلك صححوا خلافة أبي بكر لانتخابه في سقيفة بني ساعده، وترى الشيعة ضرورة التعيين والتنصيب الإلهي للخليفة، حيث لا يمكن اختيار الأصلح في النظرية الأولى، كما أن عملية تعيين الإمام خارجة تخصيصاً عن مسؤوليات البشر.
إن عمدة الخلاف بين السنة والشيعة يرجع إلى مسألة الإمامة والخلافة، ويعتمد أهل السنة في نظرية الخلافة على مبدأ الشورى، وبذلك صححوا خلافة أبي بكر لانتخابه في سقيفة بني ساعده، وترى الشيعة ضرورة التعيين والتنصيب الإلهي للخليفة، حيث لا يمكن اختيار الأصلح في النظرية الأولى، كما أن عملية تعيين الإمام خارجة تخصيصاً عن مسؤوليات البشر.
 لا يمكن إعتبار البحث حول الإمامة بحثاُ تاريخياً لا جدوائية فيه لأنه يتعلق بطريقه مباشرة بأمور ديننا ودنيانا، فالبحث فيه يكشف لنا الطريق الذي يجب أن نسلكه، خاصة أن انقسام المسلمين إلى سنة وشيعة كان بداعي الخلاف في هذا الأمر، فعن طريقه نتعرف على أئمتنا الذين يجب علينا تقليدهم ومصادرنا التي نستوحي منها تعاليمنا، وفقهاءنا الذين نتعلم منهم أحكامنا.
لا يمكن إعتبار البحث حول الإمامة بحثاُ تاريخياً لا جدوائية فيه لأنه يتعلق بطريقه مباشرة بأمور ديننا ودنيانا، فالبحث فيه يكشف لنا الطريق الذي يجب أن نسلكه، خاصة أن انقسام المسلمين إلى سنة وشيعة كان بداعي الخلاف في هذا الأمر، فعن طريقه نتعرف على أئمتنا الذين يجب علينا تقليدهم ومصادرنا التي نستوحي منها تعاليمنا، وفقهاءنا الذين نتعلم منهم أحكامنا.
 إن من واجب المسلمين وهم يعيشون في عصر العولمة، أن ينفتحوا على بعضهم البعض، ويتجاوزوا تلك العصور المظلمة من الاختلاف والتعصب الأعمى، لكي تتلا قح أفكارهم وتتشكل قناعتهم بالأدلة والبراهين عن طريق السلم لا العنف، وبالحكمة والإقناع لا بالقوة والإكراه. ومن أهم الوسائل التي تفتح هذا الطريق الحوار الهادف البناء، بشتى أشكاله التي تشمل المناظرات والمطارحات والمراجعات، وقد أكدت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على هذا الأمر حيث فتحت الباب واسعاً أمام الحرية الفكرية، والحوار والتلاقي الثقافي، قال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}(1)، وقوله {وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون}(2)، كما عرض
إن من واجب المسلمين وهم يعيشون في عصر العولمة، أن ينفتحوا على بعضهم البعض، ويتجاوزوا تلك العصور المظلمة من الاختلاف والتعصب الأعمى، لكي تتلا قح أفكارهم وتتشكل قناعتهم بالأدلة والبراهين عن طريق السلم لا العنف، وبالحكمة والإقناع لا بالقوة والإكراه. ومن أهم الوسائل التي تفتح هذا الطريق الحوار الهادف البناء، بشتى أشكاله التي تشمل المناظرات والمطارحات والمراجعات، وقد أكدت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على هذا الأمر حيث فتحت الباب واسعاً أمام الحرية الفكرية، والحوار والتلاقي الثقافي، قال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}(1)، وقوله {وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون}(2)، كما عرض
____________
1- سورة النحل: آية /125.
2- سورة العنكبوت: آية /46.
وقوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنْ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}(2).
وغيرها من الآيات التي تبين إن المناظرة والحوار هي الوسيلة التي اتبعها الأنبياء والرسل، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (نحن المجادلون في دين الله على لسان سبعين نبياً)(3).
 لقد أهتم الشيعة قديماً وحديثاً بالمناظرة والحوار، وهذا مؤشر قوة يشكل إيجابية عند الشيعة، وقد كتب في هذا الجانب كتب عديدة تتبعت
لقد أهتم الشيعة قديماً وحديثاً بالمناظرة والحوار، وهذا مؤشر قوة يشكل إيجابية عند الشيعة، وقد كتب في هذا الجانب كتب عديدة تتبعت
____________
1- سورة يس: آية /78-79.
2- سورة البقرة: آية /258.
3- الاحتجاج للطبرسي ج1 ص15.
 وانطلاقا من مبدأ أهمية الحوار والمناظرة، ومساهمة مني في نشر هذه الثقافة قمت بكتابة هذا الكتاب الذي يعتبر مجهوداً متواضعاً لا يتعدى كونه تجربة شخصية تشوبها كثير من السلبيات، ولكنها تعتبر إنجازاً في عصر قل فيه هذا الفن وانصرفت اهتمامات الناس عنه، هذا بالإضافة إلى أن هذه المناظرات
وانطلاقا من مبدأ أهمية الحوار والمناظرة، ومساهمة مني في نشر هذه الثقافة قمت بكتابة هذا الكتاب الذي يعتبر مجهوداً متواضعاً لا يتعدى كونه تجربة شخصية تشوبها كثير من السلبيات، ولكنها تعتبر إنجازاً في عصر قل فيه هذا الفن وانصرفت اهتمامات الناس عنه، هذا بالإضافة إلى أن هذه المناظرات
معتصم سيد أحمد
سوريا السيدة زينب (ع)
10/جمادى الأول/1419 هـ
بعد رجوعي إلى السودان
بعد عدة أعوام قضيتها بجوار السيدة الطاهرة مولاتي زينب (عليها السلام)، تلقيت فيها معارف أهل البيت(عليهم السلام) وعلومهم عن السادة والمشايخ الكرام، في الحوزات العلمية المتخصصة في هذا المجال، منذ عهد الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام) وما زالت حتى وصلت إلينا في هذا العصر.
والحوزات من الطرق التربوية المتميزة ذات خصائص لا توجد في المعاهد التربوية الأخرى، فأول ما تمتاز به الحرية الفكرية، فتُدرس فيها شتى النظريات في كافة المجالات، من فقه وأصول ولغة وعقائد وتاريخ وعلم اجتماع، مستخدمة في ذلك قوة الدليل والبرهان، لا التعصب المذهبي، كما إنها تحتوي على مكتبة ضخمة فيها كتب جميع المدارس الفكرية الإسلامية وغير الإسلامية، وهذا أوضح مصداق للحرية الفكرية.
وثانياً: العمق في الطرح والتدريس مما يساعد على تخريج المجتهدين القادرين على استنباط الأحكام
ثالثاً: الجو الروحاني الذي يعم أجواء الحوزة من صلوات جماعة وأدعية مأثورة، هذا بالإضافة إلى الترابط القوي والعلاقات الأخوية بين الطلبة.
كل هذا ولدَّ فيَّ روح المسؤولية والالتزام بالحق والدفاع عنه، ونشر رايته لكل محروم يعيش في أودية الظلام، فآليت على نفسي أن أوصل هذه الرسالة، وأن أعمل في ذلك غاية جهدي، وبعد وصولي إلى مدينة الخرطوم وجدت سماحة العلامة السيد علي البدري(رح) يعقد المحاضرات والمناظرات تثبيتاً لمذهب أهل البيت(عليهم السلام)، رغم كبر سنه، وكثرة الأمراض التي تعجزه عن الحركة، ولكنه كان ذو روحٌ عالية تغلبت على آلام المرض وضعف الكبر، فقلت في نفسي مثل هذا السيد وفي بلد غير بلده يقوم بخدمة مذهب أهل البيت(عليهم السلام) أكثر منا نحن الشباب، فقررت تأجيل سفري إلى أهلي الذين هم في شمال السودان، رغم شوقي الذي لا يُحد لرؤيتهم، وأن أقوم بمساعدته.
وبعد أن قضينا يومين توجه السيد مرةً أخرى إلى الخرطوم، وسافرت أنا مع أحد الأخوان المؤمنين إلى مدينة (مدني) التي تقع على النيل الأزرق شرق مدينة كوستي وفي مدني ذهبت إلى جامعة الجزيرة، كلية التربية في منطقة (حنتوب) دارت بيني وبين مجموعة كبيرة من الطلبة نقاشات متعددة وعميقة استمرت إلى يوماً كاملاً، بعدها رجعت إلى الخرطوم وكان لي فيها بعض الحوارات في جامعة الخرطوم كلية التربية وبالخصوص مع طلبة الدراسات العليا، فكان النقاش معهم سلِساً وجميلاً لثقافتهم العالية ومعرفتهم بقيمة الدليل والبرهان وبعد قراءتهم لبعض
وبعد ذلك تجدد شوقي إلى أهلي فقررت السفر إليهم على أمل أن أعيد المسيرة من جديد خاصة إن السيد البدري أصبح طريح الفراش لشدة المرض، وبعد وصولي إلى مدينة عطبرة وقبل أن أصل إلى قريتي كانت لي هذه الجلسة التي دارت بيني وبين الدكتور عمر مسعود.
الجلسة الأولى: نقاش في علم الأصول
الدكتور عمر مسعود من البارزين في الساحة السودانية وخاصة في ولاية نهر النيل في شمال السودان، وهو يحمل مجموعة من الشهادات في الاقتصاد، وعلوم الحديث، ومقارنة الأديان، بالإضافة إلى تتلمذه على يد مجموعة من المشايخ وعلماء الطرق الصوفية، كما أنه يمتاز بإطلاعه الواسع في شتى المجالات فله مكتبة ضخمة تحتوي على (11 ألف كتاب)، وهو يعمل الآن محاضراً في جامعة وادي النيل في كليات متعددة، مثل كلية الدراسات الإسلامية، وكلية التربية وكلية التجارة، فهو مدير لقسم التجارة بهذه الكلية.
هذا الدكتور تربطني به علاقة شخصية، علاوة على أنه أستاذي ثلاث سنوات تقريباً، ودارت بيني وبينه مجموعة من الجلسات والحوارات الإيجابية الهادفة، في شتى المجالات التاريخية والأصولية، والعقائدية، أسفرت عن احترام الطرفين وتقدير وجهات النظر.
بعد أن دخلت الحرم الجامعي رأيت الدكتور يلقي محاضرة لطلاب قسم التجارة، وما إن رآني حتى خرج واستقبلني بحفاوة ثم طلب مني أن أحضر إلى مكتبه بعد المحاضرة.
وبعد المحاضرة ذهبت إليه، وبعد السلام والسؤال عن الأخبار.
قال الدكتور: أين كنت خلال هذه الفترة.
المؤلف: في سوريا عند مقام السيدة زينب (عليها السلام).
الدكتور: ماذا كنت تفعل.
المؤلف: أدرس في الحوزة العلمية.
الدكتور: وماذا تدرس.
المؤلف: فقه، أصول، منطق، عقائد، نحو،
الدكتور: إن أهل السنة أول من ابتدع علم الأصول وتجربتهم أنضج وأكمل، أما تاريخ علم الأصول عند الشيعة فهو حديث مقارنة بالأصول عند السنة.
المؤلف: هذا اشتباه، أولاً إن الأصول هي عبارة عن قواعد وكليات يستنبط منها المجتهد الجزئيات، وهذه الكليات واضحة في روايات أهل البيت، فالإمام الصادق(عليه السلام) كان يقول: "منا الأصول ومنكم الفروع"، هذا من ناحية البعد التاريخي أما إذا قصدت بلورة الأصول بهذه الصورة الحالية والكتابة في هذه المباحث، فإن السنة يختلفون تماماً عن الشيعة ولا وجه هناك للمقارنة فمصادر التشريع عند السنة انقطعت بعد موت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، ولذلك الحاجة التاريخية ألحت لتكوين علم أصول يتكفل باستخراج الأحكام الشرعية،
الدكتور: إن علم الأصول عند السنة يمتاز بأنه أكثر مرونة من الأصول عند الشيعة، فإنها جامدة يصعب على الإنسان أن يستنبط حُكْماً من خلالها، فالأصول عند السنة أبوابها كثيرة ومتعددة من قرآن وسنة وإجماع وقياس وغيرها تساعد المجتهد على تتبع الحوادث في أي زمن واستنباط الحكم الشرعي لأي موضع.
المؤلف: هذا الكلام لا يمكن أن يقبل، أما إنها جامدة فهذا إدعاء لا يمكن أن يصدقه الواقع، فالفقه الشيعي الذي يرتكز على هذه الأصول التي تسميها
أما ثانيا: ً فالأصول التي ذكرتها هي مشتركة بين الشيعة والسنة وإذا كان هناك مرونة لأصول السنة فهي راجعة للقياس، والقياس عندنا لا يعول عليه في استنباط أحكام الشريعة.
ثالثاً: أن الشيعة ليسوا بحاجة لإعمال القياس، وذلك لكثرة النص الفقهي، المروي عن الرسول وأهل بيته، فالوسائل للحر العاملي يتكون من عشرين مجلداً كله أحاديث فقهية، وكتاب مستدرك الوسائل ثمانية عشر مجلداً في نفس الإطار للميرزا النوري، فليس هناك من داعٍ لهذه الظنيات التي اعتمد عليها السنة لقلة النص الديني من روايات وأحاديث في جانب الفقه.
الدكتور: هذا كلام سطحي إن الأصول لم تكن بداعي قلة النص الديني كما زعمت، وما هذه الأصول إلا بمثابة تعليل لهذه النصوص، فالقياس
المؤلف: هذا الكلام بصورته العامة يبدو وجيهاً ولكن عندما نفصل المسألة ونُدقق أكثر يظهر لنا ضعفه، وذلك إن القياس كما تفضلت هو إرجاع الفرع إلى الأصل إذا اشتركت العلة بين الأصل والفرع، وكما هو واضح أن الحكم يدور مدار العلة وجوداً وعدماً، ولكن الإشكال كيف تكشف علة الحكم؟.
فإذا كانت العلة منصوصاً عليها من قبل الشارع نفسه، فمثلاً يقول إن الخمر حرام لأنه مُسكر، فيمكن أن أقيس النبيذ على الخمر إذا كان النبيذ مسكراً، فأقول الخمر حرام لأنه مسكر والنبيذ مسكر إذاً النبيذ حرام. هذا لا إشكال فيه رغم أن هذا نفسه لا يسمى قياساً بمعنى أننا لم نقس حكم النبيذ على حكم الخمر، وإنما اكتشفنا حكم النبيذ من النص مباشرةً، أي أن
أما إذا لم تكن العلة منصوصاً عليها من قبل الشارع فكيف لنا معرفتها، فكل ما نتوقعه لا يخرج عن إطار الظنية ولعل الشارع لم يرتب الحكم على هذه العلة التي اكتشفناها وإنما لعلة أخرى باطنية، مثلاً في حكم الصيام في السفر يقول الشارع {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} فالظاهر من هذه الآية هو عدم الصيام في حالة السفر، فيقول مجتهد أن العلة من عدم الصيام في السفر هو الإرهاق والتعب وخاصة أن السفر في القديم كان عبر الدواب، والآن أختلف الوضع وأصبح السفر مريحاً، فارتفعت العلة التي تمنع الصيام في السفر فيرتفع معها الحكم، وعلى هذا الاجتهاد كثير من المسلمين يصومون في حالة السفر فهذه مخالفة للنص، من الذي يقول إن العلة هي التعب؟ هل الشارع نص على ذلك؟! وإن لم ينص فتكون هذه العلة ظنية لا يعول عليها في استخراج الحكم، وإنما الآية في مقام التشريع فكما أن الله شرع الصيام في
الدكتور: إن البحث عن الحكم القطعي من الصعوبة بمكان، ولو كانت الشريعة تطالبنا بالحكم القطعي لكل واقعة لأصبح الأمر عسيراً، كما أن هذه العلل التي تسميها ظنية هي الطريق الوحيد مع إنني لا أقول ظنية.
المؤلف عفواً أستاذي: إن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ولا يمكن أن تكون الشريعة في زمن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) كل أحكامها قطعية وواقعية والآن تكون أحكامها ظنية، إلا إذا كنت تعتقد أن أحكام الرسول أيضاً ظنية.
وإنما المسألة محلولة داخل الشريعة نفسها، فالأحكام حسب التقسيم الأصولي الشيعي أحكام واقعية وأحكام ظاهرية، فالحكم الواقعي هو الذي يُستنبط من دليل قطعي مثل القرآن والسنة والعقل، والدليل القطعي هو الكاشف للواقعة ولا يحتاج إلى دليل آخر يكشفه إنما تكون حجيته حجية ذاتية، إما إذا
____________
1- الحكم العقلي إذا كان يقيني كاشفاً للواقع، كما يسمى عند الأصوليين القطع والقطع أعم من حكم العقل.