
نتيجة المدخل
نستخلص من هذه المقدمة السريعة أن النفاق ظل موجودا في المجتمع الإسلامي إلى ما بعد وفاة الرسول الأعظم (ص) ويشكل بؤرة المعاناة اليومية للمسلمين. كما نستخلص أن حركة النفاق في المجتمع الإسلامي لم تكن واحدة.
بل كانت عبارة عن فصائل وتيارات تختلف أهواءها ومقاصدها. فهناك من قد دخل الإسلام ليركب متن الصراع. وليكون له الأمر من بعد الرسول (ص) وهذا المنطق كان موجودا يومها في الجزيرة العربية. فعندما عرض النبي (ص) نفسه على بني عامر بن صعصعة فيما ينقله ابن هشام في السيرة، قال: قال له رجل:
" أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك. قال: الأمر لله يضعه حيث يشاء. فقالوا له: أفتهدي نحورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك، فأبوا عليه ".
لقد أدرك الكثير من العرب، إن دعوة الرسول الأعظم (ص) لها شأن عظيم في المستقبل وإنها لا أقل تبقى صفقة مربحة ما دام يمثلها أعظم شخصية هاشمية.
لقد عبر عن ذلك رجل من بني عامر بن صعصعة: " والله لو إنني أخذت هذا الفتى من قريش، لأكلت به العرب " (36) وهذا إغراء كاف لأولئك الذين افتقروا
____________
(36) سيرة ابن هشام ص 73 ج 2 الطبعة الثانية 1409 ه - 1989 م.
- دار الكتاب العربي - بيروت.
لقد حارب أبو سفيان رسولي الله (ص) ردحا طويلا من الزمن وكان الكثير من العرب يفضلون انتشار الرسول (ص) ليس انتصارا للحق الذي جاء به. وإنما انتصارا لقضيتهم.
فمحمد (ص) أولى لهم من أبي سفيان الذي أذلهم ولهذا لم يكن في المصلحة القبلية أبو بكر ولا عمر. أن ينتصر أبو سفيان الذي ينتمي إلى " قصي " سادة قريش، وهما من تيم بن مرة، وعدي وهما أذل حي في قريش.
وهناك حادثة ينقلها بن هشام في السيرة تعكس ذلك الوجه من الحقيقة.. فقد ذكر أن العباس ركب. بغلة النبي ليلة فتح مكة.. وخرج يبحث عن رسول يوفده إلى قريش فيخبرهم بقدوم النبي (ص) ليأتوا إليه فيستأمنوه. فرأى أبا سفيان فقال له: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك. ثم أردفه وأخذه ليستأمن له من النبي (ص) وكلما مر على نار من نيران المسلمين قالوا عم رسول الله (ص) على بغلته حتى مر عمر بن الخطاب. فلما رأى أبا سفيان على عجر الدابة، قال: أبو سفيان!
عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد، ثم خرج يشتد نحو رسول الله (ص) فركض العباس بالبغلة وسبقته، قال العباس: فاقتحمت عن البغلة، فدخلت على رسول الله (ص) فركض العباس بالبغلة وسبقه، قال العباس: فاقتحمت عن البغلة، فدخلت على رسول الله (ص) ودخل عليه عمر، فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بلا عقد ولا عهد. فدعني فلأضرب عنقه، قال: فقلت: يا رسول الله إني قد أجرته، ثم جلست إلى رسول الله، فأخذت برأسه فقلت: والله لا يناجيه الليلة دوني رجل. فلما أكثر عمر بن الخطاب في شأنه، قلت: مهلا يا عمر فوالله إن لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك عرفت إنه من رجال بني عبد مناف ".
وذكر بن عساكر في تهذيبه، إن عمر بن الخطاب قدم مكة، فقالوا له: إن أبا سفيان ابتنى دارا، فألقى الحجارة فحمل علينا السيل، فانطلق معهم عمر، وحمل الحجارة على كتف أبي سفيان، فرفع عمر يده وقال: الحمد لله الذي آمر أبا سفيان ببطن مكة فيطيعني.
أما موقف هؤلاء من بني هاشم الذين كانوا حطب النار في كل صراعات المجد. فقد كرهوا لها الخلافة فيما بعد: حق لا يجتمع لها فضل النبوة والخلافة.
فعندما قال البعض لعمر: " فما يمنعك منه؟ قال: أكره أن أتحملها حيا وميتا، وفي رواية لا أجمع لبني هاشم بين النبوة والخلافة " (37).
ولقد أدرك بعضهم خلفية تيار الاغتصاب، وواجههم بنفس المنطق. فهذا سعد بن عبادة الخزرجي يرفض بيعة أبي بكر، وتحصل بينه وعمر مشادات كلامية، ويقول له: " لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعا غير متبوع ".
وأما أبو سفيان الذي أدرك أن أبا بكر وعمر بن الخطاب ما فعلا ذلك إلا طلبا للرفعة: " ما بال هذا الأمر في أقل حي من قريش، والله لئن شئت لأملأنها خيلا ورجالا " (38).
____________
(37) شرح النهج ابن أبي الحديد / الإمامة والسياسة ابن قتيبة.
(38) الطبري / التاريخ ص 449 ج 2 طبعة 1358 ه 1939 م مطبعة الاستقامة بالقاهرة.
وبذل وسعه في إقصاء بني هاشم. هاهو اليوم يربكه الموقف، ويعز عليه أن يتأمر عليه أهل حي إنما هو أحط حي في قريش. ولإمارة بني هاشم يومها أحب إليه ألف مرة من إمارة بني تيم بن مرة وعدي بن كعب. لقد قالها يومئذ:
" أما والله لئن بقيت لأرفعن من أعقابهما " (39).
وقد طلب البيعة من علي (ع) ورفض هذا الأخير بيعته لما يدركه منه من نوايا خبيثة.
فهو ما أراد ذلك إلا ليحارب بنعرة قبلية جاهلية. وهي النعرة التي يتجنب علي (ع) القتال بها. وهو من سمع أخاه رسول الله (ص) " يقول ليس منا من دعى إلى عصبية "!.
وفي ذلك يقول أمير المؤمنين علي (ع) لمعاوية: " فأبوك كان أعلم بحقي منك، وأن تعرف من حقي ما كان أبوك يعرفه تصب رشدك " (40).
وهو نفس الأسلوب الذي اتبعه معاوية، إذ كثيرا ما رام الحط من الشيخين بطرق مختلفة، ومثال ذلك ما رواه الحمدي في الجمع بين الصحيحين، قال: " قال عبد الله بن عمر: دخلت على حفصة ونسواتها تنظف، قلت: قد كان من أمر الناس ما تبين، فلم يحصل لي من الأمر شئ، فقالت:
الحق لهم، فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون احتباسك عنهم فرقة، فلم تدعه حتى ذهب، فلما تفرق الناس خطب معاوية فقال: " من أراد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق منه ومن أبيه ".
هذا غيض من فيض مما رزح به التاريخ من أدلة قارعة، تكشف عن الواقع
____________
(39) العقد الفريد / شرح ابن عبد ربه ص 257 ج 4 ط 1403 ه 1983 م دار الكتاب العربي - بيروت.
(40) العقد الفريد / شرح ابن أبي الحديد.
ففي الوقت الذي تقدم فيه كل من علي (ع) وحمزة وعبيدة بن الحرث، يبارزون صناديد الكفر، كان أبو بكر خلفهم قرب الرسول (ص) في العريش الذي أقيم له، يتفرج عليهم.
ويا لها من فرجة! وكان أبو بكر وحده مع الرسول (ص) بالعريش! (41).
أما في غزوة أحد، فإن الأمر أشد وأنكر. فلقد انهزم الكثير من المسلمين.
وكان أبو بكر وعمر وعثمان ممن فر في هذه الغزوة. ذكر السدي: لما أصيب النبي (ص) بأحد قال عثمان: لألحقن بالشام، فإن لي به صديقا من اليهود، فلآخذن منه أمانا، فإني أخاف أن يدال علينا اليهود، وقال طلحة بن عبيد الله: لأخرجن إلى الشام، فإن لي به صديقا من النصارى، فلآخذن منه أمانا، فإني أخاف أن يدال علينا النصارى.
وذكر السدي: " فأراد أحدهما أن يتهود، والآخر أن يتنصر. قال: فأقبل طلحة إلى النبي (ص) وعنده علي، فاستأذنه طلحة في المسير إلى الشام، وقال:
إن لي بها مالا آخذه ثم انصرف، فقال النبي (ص): عن مثلها من حال، تخذلنا وتخرج وتدعنا، فأكثر على النبي (ص) من الاستئذان، فغضب علي وقال:
يا رسول الله، إئذن لابن الحضرمية، فوالله لأعز من نصره، ولأذل من خذله، فكف طلحة عن الاستئذان عند ذلك، فأنزل الله تعالى فيهم: " ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم " (42) يعني أولئك يقول: إنه يحلف لكم إنه مؤمن معكم فقد حبط عمله بما دخل فيه
____________
(41) تاريخ ابن خلدون ج 2 ص 416.
(42) المائدة / 53.
يقول بن خلدون في تاريخه: " وغفر الله للمنهزمين من المسلمين ونزل:
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم) الآية " وكان منهم عثمان بن عفان بن أبي عقبة الأنصاري ".
ويوم الخندق لما سكت كل منهم ولم يجب طلب عمرو بن عبد ود العامري، وكانت ستكون هزيمة نكراء لو لم ينهض إليه علي بن أبي طالب (ع) حتى قال الرسول (ص):
(برز الإيمان كله إلى الشرك كله) (44).
وعندما أراد الرسول (ص) فتح خيبر، أعطى أبا بكر الراية فلم يفتح ورجع منهزما، وأعطاها بعد ذلك عمرا فرجع منهزما يجبن أصحابه ويجبنونه حف أعطاها في الثالثة عليا (ع) ففتحت على يده وقال (ص): " لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله له (45)،.
فهذا إن دل فإنما يدل على مدى حرص هذا التيار على الحياة، والابتعاد عن أي موقف يهدد حياتهم. فهم لا يطلبون الشهادة بقدر ما كانوا يطلبون امتيازات المستقبل، وهو ما يفسر فرارهم يوم الزحف.
هذا ما انكشف من سلوك تيار الاغتصاب.
وعليه فإن هذا التيار كان يهدف إلى السلطة، وكان يشكل تيارا مستقلا، لأن همومه، وأهدافه وسلوكه. كانت تختلف كثيرا عن باقي التيارات التي تشكل منها
____________
(43) تفسير الخازن ج 1 ص 503 وتفسير ابن كثير ص 62 ج 2 - بيروت - دار القلم، وكر بلفظ ا لرجلين.
(44) رواه الجمهور.
(45) سنن ابن ماجة ص 520 الحديث 1627 ج 1 دار الكتاب العلمية - بيروت وأيضا أحمد ومسلم والبخاري.
أما التيار الثاني فهو تيار مستقل له شوكته ومقدراته له أهدافه ومقاصده يميزه عن التيار الأول، إنه كان يمثل الامتداد السري لحركة الشرك في الجزيرة العربية.
وكان هذا التيار متمثلا في بني أمية، وعلى رأسهم أبو سفيان وبنيه!.
وحسبنا من ذلك شهادات تاريخية تثبت بقاء أبي سفيان وابنه معاوية على الشرك.
فقد روى ابن الزبير قال: " كنت مع أبي باليرموك وأنا صبي لا أقاتل، فلما اقتتل الناس نظرت إلى ناس على تل لا يقاتلون، فركبت وذهبت إليهم وإذا أبو سفيان بن حرب ومشيخة من قريش من مهاجرة الفتح، فرأوني حدثا، فلم يتقوني، قال:
فجعلوا والله إذا مالت المسلمون وركبتهم الروم يقولون: " إيه بني الأصفر " فلما هزم الله الروم أخبرت أبي، فضحك، فقال " قاتلهم الله أبوا إلا ضغنا، لنحن خير لهم من الروم " (46).
وفي أيام عثمان جاء أبو سفيان إليه وجماعة من أقاربه وقال:
يا معشر بني أمية! إن الخلافة صارت في تيم وعدي حتى طمعت فيها، وقد صارت إليكم فتلقفوها بينكم تلقف الصبي الكرة: فوالله ما من جنة ولا نار " (47).
وذكر صاحب شرح النهج، " إن أبا سفيان مر بقبر حمزة، وضربه برجله وقال: " يا أبا عمارة! إن الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمس صار في يد غلماننا اليوم يتلعبون به ".
____________
(46) ابن الأثير / أسد الغابة ص 149 ج 5 - 1409 ه - 1989 م دار الفكر - بيروت - الطبري ج 4 ص 137.
(47) الأغاني / أبي الفرج الأصفهاني ج 6 ص 355 - 356.
" إذا رأيتموهما اجتمعا ففرقوا بينهما، فإنهما لا يجتمعان على خير أبدا " (48).
وفي رواية أحمد بن حنبل في المسند، رفع الرسول (ص) يديه فقال " اللهم اركسهما في الفتنة ركسا، ودعهما إلى النار دعا ".
وحسبك ما فاضت به كتب الأخبار من أيامهم، يوم حولوها إلى ملك عضوض، وملؤوها ظلما وفجورا. وحسبك أيضا ما مر علينا من قول حفيدهم يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، لما امتثلها صريحة: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل (49).
____________
(48) العقد الفريد / ابن عبد البر.
(49) مسند أحمد بن حنبل ح 4 ص 421.
النفاق والنهاية المفتعلة!
هناك لفتة عجيبة في التاريخ الإسلامي. جديرة بأن تثير عقول الباحثين.
وهي تلك التي تتصل بواقع حركة النفاق في مجتمع الرسول (ص)، وعن تلك النهاية المزعومة، والمفتعلة للنفاق بشكل يدفع إلى طرح السؤال حول ما إذا كانت هناك نهاية فعليه للنفاق أم أن هناك تأسيس جديد لهذه الحركة.
إن النفاق ظل موجودا في حياة الرسول (ص) ويشكل الحدث البارز بعد الفتح الإسلامي، غير أنه سرعان ما اختفى الحديث عن النفاق والمنافقين بعد استتباب الحكم لتيار الاغتصاب.
لم يعد هناك حديث يتناول مشكلة النفاق ولا أنباء تتعرض لأعمال المنافقين.
فهل هذا يعني إن موت الرسول (ص) سينهي تلقائيا حركة النفاق؟!.
أم أن تيار الاغتصاب كان من مصلحته تغييب هذا الاهتمام وبأن يتواضع على توازنات معينة مع باقي الفصائل المنافقة؟!.
إن هذا السكوت المفاجئ عن ظاهرة النفاق وتحويل الأنظار إلى بني هاشم لا دلالة له غير ما حدث من اتصال واتفاق بين فصائل تيار الاغتصاب ومآرب باقي الشرائح المنافقة. فهل يعقل أن المنافقين لم تكن حكمة الرسول الأعظم ونبله وعصمته بالذي يزكي ويربي هؤلاء المنافقين على الإسلام. حتى يأتي أبو بكر وعمر وعثمان فيحسن إسلامهم آنذاك. في حين نجد القرآن ينبئ الرسول (ص) حتى
" والأعراب أشد كفرا ونفاقا " (50) " وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة " (51).
" ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم " (52).
فالنبأ القرآني يخبر عن ظاهرة خطيرة ومنتشرة في المجتمع. كيف تمحى بسرعة فور رحيل النبي (ص) ولأن طبيعة النفاق دائما من التكتم بحيث لا تمكن من ضبط حقيقتها.
أشار القرآن إلى مظاهرها وسلوك أصحابها، وعمل على فضحهم، تمشيا مع أدب الرسالة النبوية التي تحكم على الظاهر وتحتفظ بالعلم في أمور الباطن. لقد عرفهم بسيماهم في لحن القول، والتخلف عن الجهاد، ونشر البلبلة والإشاعة، وموالات المشركين. هذه الصفات لو طبقناها على كثير منهم، لاستطعنا اكتشافهم عن آخرهم وبسهولة يقل لها نظير، فكثير ممن سموا بعدها صحابة، كانوا متخلفين عن الجهاد، وموالين للمشركين ويلحنون في القول.
ومبغضين لعلي بن أبي طالب (ع) الذي قال فيه الرسول (ص) كما تقدم " لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق "!.
____________
(50) 97 - التوبة.
(51) 101 - التوبة.
(52) 101 التوبة.
هل كان هناك ما يجمع بين بني أمية والخلفاء أو الشيخين بشكل خاص؟.
هذا السؤال حيرني كثيرا. وكنت أعتقد بأني برعا في هذه الحيرة المملة. لكن فاجأني أن عثرت عمن يشاركني هذه الحيرة، من دون أن يغمس فيها كل دلاءه.
كان ذلك هو الأستاذ المحترم محمود أبو رية، عندما تسأل فئ طيبة خاطر، وحسن نية، في كتابه " أبو هريرة " عن طبيعة هذه العلاقة وسوف أذكر نصه هنا:
" مما يدعو إلى الملاحظة هنا إننا لم نجد عمر رضي الله عنه إنه قد اتبع هذه السنة مع معاوية بن أبي سفيان، فقد أبقاه عاملا على دمشق سنين طويلة ولم يزعجه بالعزل كغيره - وكان ذلك مما أعان معاوية على طغيانه، وإن يحكم حكما قيصريا طوال أيامه، وبخاصة بعد أن استولى على الشام كله في عهد عثمان، ثم امتد هذا الطغيان الأموي إلى ما بعد معاوية حتى تسلم العباسيون الحكم. وأمر آخر يستوجب الملاحظة، ذلك أن عمر لم يكن هو الذي ولى معاوية على دمشق وإنما الذي ولاه هو أخوه يزيد بن أبي سفيان.
ذلك أنه لما فتحت دمشق في عهد عمر أمر عليها يزيد بن أبي سفيان. ولما احتضر يزيد، استعمل أخاه معاوية مكانه من غير أن يستشير عمر على ذلك ".
هذا ما لا علم لنا به! وإنما الذي يعلمه هو علام الغيوب " (53).
وليس فيما أحدسه من موقف الأستاذ الجليل، سوى تخوفا من الخوض في مثل هذه الموضوعات إذ يصعب على أستاذنا الجليل موضعة عمر بن الخطاب والبحث في أحواله. فهو أحد العمالقة الذين جعل منهم تاريخ العامة، الذات المتعالية التي تند عن التحليل والنقد.
ولقد سبق أن أكدنا في كتاب " الإنتقال " على ذلك لإظهار ما في الأمر من تناسب. لقد ذكرنا ما قام به عمر بن الخطاب من تأمير بني أمية على أصقاع واسعة، واعتبرت ذلك بمثابة حالة من السطحية السياسية " لأن بني أمية لم يكونوا مكتوفي الأيادي بعد أن كانوا طويلبيها في زمن البعثة. وليس بنو أمية عناصر ساذجة، وإنما هم جهاز وحالة قابلة للنشوء في كل لحظة، فتأميرهم لا يعني سوى صب مزيد من النفوذ في جعبتهم، ولقد قووا في زمن عمر بن الخطاب " (54).
ولكني أحببت استدراك ما كنت ذكرته هناك، لأن المسألة ظهر لي فيها مزيدا من الوضوح.
لقد قلت بأن عمر " كان يحاسب الأمويين حسابا عسيرا، لكنه في نفس الوقت يؤمرهم على أصقاع وسيعة " والواقع، إنه لم يكن يحاسبهم حسابا عسيرا على الإمارة وإنما كان يفعل ذلك معهم في قضايا صغيرة مثل ذلك الذي تقدم. يقول الزمخشري في ربيع الأبرار: " وكانت إمارة معاوية عشرين سنة ولاه عمر بن الخطاب الشام، وحاسب عماله إلا معاوية ".
____________
(53) أبو هريرة / محمود أبو رية ص 87 (54) الإنتقال الصعب / ص 163 / المؤلف.
لقد واجه تيار الاغتصاب بعد أن تقلد زمام الأمور كتلتين:
الأولى: كتلة بني هاشم.
والثانية: كتلة التيار الأموي.
فما أن غاب الرسول (ص) حتى نهض بن الخطاب إلى السقيفة يطرح رفيقه على رؤوس الصحابة.
وبعدها عمل على إكراه من كان معتصما ببيت فاطمة بنت الرسول (ص) بعد أن هم بحرق بيتها. وما كان أيضا من أمره في منع فاطمة إرث أبيها حتى ماتت وهي غاضبة عليه وعلى رفيقه أبي بكر. إلى ما هناك من أمثلة سوف نتطرق إليها فيما بعد.
إن هذه العداوة كانت تشكل خطرا على عمر. وهو لا يزال وزيرا لأبي بكر.
كيف يكون له الأمر بعد أن استتب لهما الأمر في السقيفة، على نحو فلتة قال عنها عمر نفسه:
" وقانا الله شرها ".
ومن جانب آخر، تبين بأن التيار الأموي الذي يمثل امتدادا للشرك في الجزيرة العربية كان هو أيضا له نفوذ داخل المجتمع، وحضور قوي.
وأدرك الشيخان أن دخولهما في صراع مع التيار الأموي سوف يثير عليهما مشاكل خطيرة. وهما من يعلم مدى نفوذ هذا الفصيل في المجتمع، وقد سمعا أبا سفيان يقول بعدها: ا أما لو شئت لأملأنها خيلا ورجالا " (55) وقال: " أما والله
____________
(55) سبق ذكره.
ومما يدل على قوة الفصيل الهاشمي والفصيل الأموي. واهتمام الشيخان بهما كعدوين لخلافتهما. ما ذكره البلاذري في الأنساب، قال أبو قحافة عندما بلغه نبأ وفاة الرسول (ص) وهو بمكة: " فمن ولي أمر الناس بعده، قالوا له:
ابنك، فقال أرضي بذلك بنو هاشم وبنو عبد شمس وبنو المغيرة؟.
قالوا: نعم، قال: فإنه لا مانع لما أعطى الله ".
ولقد أحس الشيخان بخطورة هذا الفصيل، وخشيا أن يتم تضامن بين الفصيلين بنو هاشم وبنو أمية للعمومة التي بينهما. خصوصا بعد أن سمعوا من أبي سفيان ما سمعوه من بيعته لعلي وتحريضه لبني هاشم، واستئذانهم في نصرتهم.
وإنه في هذه الفترة لم يكن يقل أبو سفيان عن نفسه وعشيرته بني أمية، وإنما كان يقول " إنما هي بني عبد مناف ".
ليستدرج بذلك بني هاشم إلى القاعدة العشائرية، أنا وابن عمي على الغريب!.
ذكر بن عبد ربه " توفي رسول الله (ص) وأبو سفيان غائب في مسعاه، أخرجه فيها رسول الله (ص) فلما انصرف لقي رجلا في بعض طريقه مقبلا من المدينة.
فقال له: مات محمد؟.
قال: نعم.
قال: فمن قام مقامه.
قال: أبو بكر.
قال أبو سفيان: فماذا فعل المستضعفان علي والعباس.
قال: جالسين.
قال: أما والله لئن بقيت لهما لأرفعن من أعقابهما، ثم قال:
____________
(56) سبق ذكره.
ومن هنا، وخوفا من أن يتم اللقاء والتحالف بين الفصيلين على مواجهة الشيخين، حاول عمر اللعب بكل الأوراق وأن يبادر هو إلى التحالف مع بني أمية من أجل محاصرة بني هاشم. فلذلك عمل فورا على تفويت الإمارة إليهم. ويذكر الطبري في تاريخه، إنه لما استخلف أبو بكر، قال أبو سفيان ما لنا ولأبي فصيل، إنما هي بنو عبد مناف، فقيل له إنه قد ولي ابنك قال: وصلته رحم.
وجاء في تاريخ بن خلدون:
" ثم جاء عمر فرمى بهم الروم، وأرغب قريشا في النفير إلى الشام، فكان معظمهم هنالك، واستعمل يزيد بن أبي سفيان على الشام وطال أمد ولايته إلى أن هلك في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة، فولى مكانه أخاه معاوية وأمره عثمان من بعد عمر، فاتصلت رياستهم على قريش في الإسلام برياستهم قبيل الفتح التي لم تحل صبغتها ولا ينسى عهدها أيام شغل بني هاشم بأمر النبوة " (58).
كما ذكر المسعودي: " ولما أنفذ أبو بكر الأمراء إلى الشام كان فيما أوصى به يزيد بن أبي سفيان وهو مشيع له " (59).
لقد امتدت جسور الخلفاء مع شريحة النفاق... تداخل يوضح مدى تناغم المؤامرة في منعرجاتها كلها بشكل يثير الشك ويوقع في الاستفهام.
وبذلك أسدل الستار على المنافقين، وانتهى الحديث عنهم. وتلك أهم خدمة قدمها الخلفاء لبني أمية الذين كانوا يضيقون ضرعا ويجدون ضغنا لما يروجه المسلمون فيما بينهم من أمر المنافقين! كانوا يتوخون العمل في السر. والعمل على استغفال المسلمين.
من هنا بدأت عملية مد الجسور مع مختلف المنافقين، من أجل دعم
____________
(57) العقد الفريد / ابن عبد ربه.
(58) تاريخ بن خلدون ص 4 ج 3.
(59) مروج الذهب / المسعودي ص 309 ج 2 دار المعرفة - بيروت 1402 ه 1982 م).
لقد غضب الرسول (ص) وهو على فراش الموت، وكان الحزن يعتصر قلبه الشريف طيلة الأيام التي سبقت وفاته (ص) فهو مرة قد يرى رؤية يكتشف منها محنة أهل البيت (ع) واغتصاب الخلافة من أهلها، لقد رأى (ص) بني الحكم يوما ينزلون على منبره فساءه ذلك فما استجمع ضاحكا حتى مات وأنزل الله في ذلك:
" وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس " (60).
لقد أدرك المسلمون منذ البداية، أهمية العداوة بين الإسلام وبني أمية، وكانوا أشد حذرا منهم. ولكن الخلفاء ما فتؤوا يسخون عليهم بالإمارات. ولعمري، إن معاوية لم يكن له من الشأن في بلاد الشام، ولا تلك الشوكة لولا ما مكن له فيه عمر بن الخطاب.
إن معاوية الذي كان مطعونا في دينه - حسب بن أبي الحديد - والذي لم يسلم إلا بعد الفتح خوفا من القتل. يؤمره عمر على الشام، ولم يزحزحه عنها منذ ذلك الوقت.
فهل كان ذلك تأليفا من عمر بن الخطاب لقلوب المنافقين. حتى نعود إلى طرح نفس السؤال السابق؟ إذن، كان أحرى وأجدر أن يؤلف بن الخطاب قلب فاطمة (حاشاها) في حق أبيها.. ويؤلف قلوب الصحابة الكبار بنفس السخاء. ولكان أولى له فأولى أن يؤلف قلب سعد بن عبادة الخزرجي (رض) بدل التآمر على قتله!.
بالإضافة إلى هذين الفصيلين. هناك فصيل غير منظم. مثلته عناصر متفرقة، تحكمها النزعة الفردية، والروح الانتهازية. هؤلاء لم يكن لهم تأثير كبير على المشروع النبوي. نظرا لكونهم غير استراتيجيين. وهم عموم الطلقاء من غير بني أمية أولئك الذين ارتبطوا بمعاوية وغيره طمعا في المناصب والأموال، كعمرو بن العاص، وأبي هريرة، وسمرة بن جندب.
____________
(60) القرطبي للتفسير / ج 15 ص 186.
- السيوطي في تفسيره ج 4 ص 191.
تيار النفاق، وهو التيار الذي يجمع كل الفصائل التي حاربت التوحيد، أو دخلت الإسلام بحثا عن أهداف غير التوحيد. وينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 / فرقة السقيفة.
2 / فصيل بني أمية.
3 / فصيل الانتهازيين، ومنهم أعوان الخلفاء.
تلك هي التيارات التي تشكلت منها حركة النفاق في عصر الرسول. وانقضت على مقاليد الأمور من بعده.
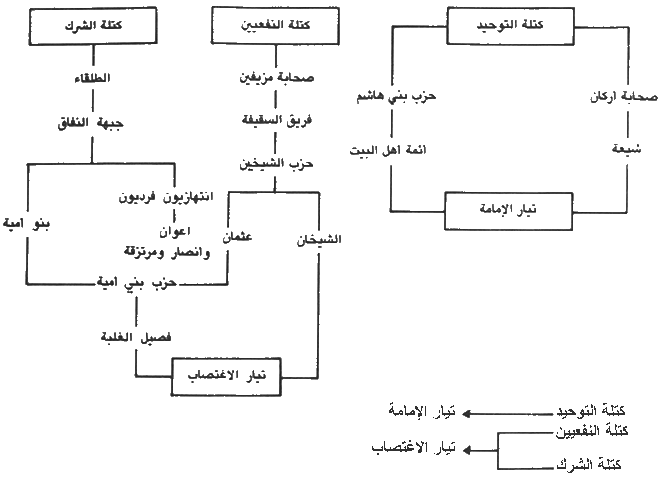
الباب الأول
الخلفاء الراشدون .. حبكة مفتعلة!
الفصل الأول
الاصطلاح والمفهوم
أما لغويا، فإن عبارة: " الخلفاء الراشدون ": إذا فككنا تركيبها، ونظرنا لغويا في المفردتين المكونتين لها، نجد ما يلي:
خلفاء، خليفة من الخلافة.. وهي لغة تعني النيابة.. وخليفة الرجل، من يقوم مقامه.. وفي القرآن. " إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء (1).
" فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب " (2).
" واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح " (3).
" ثم جعلناكم خلائق في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون " (4).
" وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة " (5).
____________
(1) 133 الأنعام.
(2) 169 الأعراف.
(3) 69 الأعراف.
(4) 14 يونس.
(5) 30 البقرة.
أما لفظة " الراشدون " جمع راشد. صفة للنضج والحلم والعقل.
أما في المصطلح فإن الخلفاء جمع خليفة مشتقة عن مصدر خلافة.. وهي النيابة، والقيام مقام الرسول (ص) بعد وفاته، وتمثل كل مهماته كحمل الناس على الطاعات وتنفيذ حكم الشريعة.
والخلفاء الراشدون هم جماعة تلي الأمر بعد الرسول (ص) ويكون هديها من صميم هدي الرسول (ص).
في الاصطلاح الذي تواضع عليه العامة فيما بعد، أصبحت كلمة " الخلفاء الراشدون " تطلق على أشخاص معينين. هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وقد طال الأمد على العامة إلى أن قسى قلبها وتحجر على هذا الاصطلاح، رغم ما يعتريه من تعسف على الواقع التاريخي، ومفاد النص، اللذين تتأكد من خلالهما الخلفية السياسية لهذا الاصطلاح.
فتاريخيا لم يكن اسم خليفة متداولا في عصر الرسول (ص) بمعناه الاصطلاحي إلا في شخص علي (ع) وذلك للأدلة التي ذكرناها آنفا، كحديث يوم الدار (7).
وكان أبو بكر قد سمى نفسه " خليفة رسول الله وكتب بذلك إلى الأطراف " (8).
فكان يكتب من خليفة رسول الله، وكان عمر يكتب: " من خليفة خليفة رسول الله ".
وكان قبل ذلك يقال له: " خليفة خليفة رسول الله، فعدلوا عن تلك العبارة لطولها " (9).
وكان أبو بكر في البداية يتحرج من الجهر بها، ويضطرب من أمرها. فقد جاء
____________
(6) 24 سورة البقرة.
(7) تفسير الطبري / ج 19 ص 74.
(8) الصواعق المحرقة / ص 90 مكتبة القاهرة 1385 ه - 1965 م.
(9) تاريخ السيوطي - مطبعة السعادة بمصر ص 137 - 138 (1371 ه).
فقال: لا.
فقال: فما أنت؟.
قال: أنا الخالفة بعده.
قال ابن الأثير، الخالفة: الذي لا غناء ولا خير فيه. وإنما قال ذلك تواضعا.
ولست أدري على أي وجه اعتبرها ابن الأثير كذلك. وهل من التواضع أن يصف الإنسان نفسه بالحمق والنفاق وهو في مقام الخلافة. وذلك هو ما ذهب إليه العسكري في الأوائل من معنى " خالف " إذ يقول: " وأما الخلافة بالفتح فالحمق وقلة الخير، رجل خالف، وفي القرآن الكريم: " فاقعدوا مع الخالفين " (10).
قال أبو زيد: " يعني من لا خير فيه من المنافقين (11) ".
وكان المفهوم اللغوي لكلمة خلافة هو الجاري به العمل أيام الشيخين، لما تقدم من تسمية عمر لنفسه خليفة خليفة رسول الله، وتركها لاستثقالهم طولها.
ولو أنها كانت تعني المفهوم الاصطلاحي، لكان سمي أبو بكر إماما، وأميرا للمؤمنين نظرا لتداخل معاني هذه الكلمات في الاعتبار الشرعي والاصطلاحي.
فكلمة إمام وأمير المؤمنين لم تكن متداولة اصطلاحيا إلا في شخص علي (ع) سواء في زمن الرسول (ص) أو بعده كما تقدم ويعزز ذلك ما أكده المؤرخون من أن أول من سمى، نفسه أمير المؤمنين من الخلفاء بعد وفاة الرسول (ص) هو عمر بن الخطاب. وكان عدي بن حاتم أول من سماه بها حسب المسعودي، وأول من سلم عليه بها، المغيرة بن شعبة. وأول من دعا له بهذا الاسم على المنبر، أبو موسى الأشعري. فلما قرأها على عمر قال: " إني لعبد الله وإني لعمر وإني لأمير المؤمنين، والحمد لله رب العالمين (12) ".
____________
(10) 83 / سورة التوبة.
(11) الأوائل / أبو هلال العسكري ص 100.
(12) المسعودي / مروج الذهب ص 316 ج 2 دار المعرفة - بيروت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال: ما بدا لكم في هذا لتخرجن مما دخلت فيه فأخبره، وقال: أنت الأمير ونحن المؤمنون، فجرى الكتاب بذلك من يومئذ في كلام هذا معناه ".
وكان من الصعب جدا على فريق السقيفة أن يفوز بهذا اللقب من دون أن يجد حرجا كبيرا.
إذ سبق أن قر في وجدان المسلمين إن الخلافة أمر يقرره النص، لأنها ملازمة للإمارة التي سبق أن أوضحنا رأي الرسول (ص) فيها منذ البداية عندما عرض نفسه على بني عامر بن صعصعة قائلا: الأمر لله يجعله حيث يشاء. ولأن الخلافة ظلت من اختصاص الإمام علي (ع) لما استحقها بمؤازرته. فهي اصطلاحا كانت من اختصاصه منذ واقعة الانذار بيوم الدار. ولغن سرعان ما قست قلوب الذين لا يعلمون، فأصبحوا يستسيغونه. وكثيرا ما كان المتزلفون والمنافقون من أعوان المغتصبين، يساهمون في إطلاق هذه الألقاب مجانا على تيار الاغتصاب، وذلك من أجل تفويت ذلك الامتياز على أهله الحقيقيين.
هذا فيما يرتبط بكلمة خلافة لغويا واصطلاحيا من وجهة نظر التاريخ.
وجاء في أحاديث العامة ما يؤسس لادعاء جديد في أمر الخلفاء الأربعة بعد الرسول (ص) وهو ما أسماه الحديث " الخلفاء الراشدون " معتبرين لفظة " الراشدين " بمثابة ضميمة تخصص الأربعة، وتضعهم في المرتبة التشريعية. وذلك وفق ما جاء في الحديث:
" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها
واعتاد أهل السنة والجماعة أن يعينوا الخلفاء الأربعة، كتخصيص لهذا الحديث، وهو ما ذكره صاحب الموافقات عن النبي (ص) " إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي منهم أربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ":
وقبل الشروع في الرد على هذا الادعاء. أرى من الأولى إثارة نقطة حساسة في هذا المقام. فما ثبت عن الرسول (ص) من طريق آخر، إنه حدد معنى الخلفاء من بعده، وجعل صفتهم رواية الحديث والسنة. قال " اللهم ارحم خلفائي.
اللهم ارحم خلفائي. اللهم ارحم خلفائي. قيل له: يا رسول الله، من خلفاءك؟.
قال: " الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي ".
فهذا التحديد يعرف بصفة خلفاء الرسول (ص) الذين يعملون على نشر سنته. ويستفاد من ذلك أن سنتهم واحدة بهذا الاعتبار الذي تحدده وحدة المصدر، ووحدة الاتجاه في سنتهم جميعا، باعتبارها واقعة في خط سنة الرسول (ص) فلننظر كيف كان موقف الخلفاء ما عدا علي (ع) من السنة والحديث.
جاء في تذكرة الحفاظ، إنه بعد وفاة النبي (ص) جمع أبو بكر الناس، وخطب فيهم قائلا:
" إنكم تحدثون عن رسول الله (ص) أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا تحدثوا عن رسول الله (ص) شيئا، فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه ".
وكان هذا الإجراء تعسفيا لمنع الرواية ومحاصرة السنة. والإبقاء على القرآن، لكونه حمال ذو وجوه، يسهل عليهم التلبيس والتضليل. ولا عليك من دفاع أهل التبرير من خوف أبي بكر على كتاب الله. وهو الذي منع فاطمة من إرث أبيها لحديث انفرد به.
(13) سنن بن ماجة ص 16 ج 1 دار الكتب العلمية بيروت.
فلو كان كما قال: قولوا بيننا كتاب الله، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه، لما رفض نصا قرآنيا، وتمسك لحديث انفرد به يخالف صريح القرآن.
ومن سيرتهم أيضا في تطويق السنة النبوية، ما ذكر ابن ماجة في السنن، إن قرظة بن كعب قال:
" بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا فمشى معنا إلى موضع صرار.
فقال: أتدرون لم مشيت معكم؟ قال: قلنا لحق صحبة رسول الله، ولحق الأنصار. قال: لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم. أنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل. فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم، وقالوا:
أصحاب محمد! فأقلوا الرواية عن رسول الله (ص) ثم أنا شريككم ".
وبلغ من الخوف الشديد من رواية الحديث، أن بعضهم انقطع تماما عن الرواية لما ذكره السائب بن يزيد قال: " صحبت سور بن مالك من المدينة إلى مكة، فما سمعته يحدث عن النبي (ص) بحديث واحد " (16).
وبلغ أيضا بهم أن منعوا كبار الصحابة عن رواية الحديث خوفا من أن تشيع بعض حقائقه، فجمع عمر الرواة وأقامهم عنده حتى يتمكن من الرد عليهم.
كيف لا وهو الذي ألف الرد على الرسول (ص) لقد ذكر عبد الرحمن بن عوف قائلا: ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رسول الله فجمعهم من الآفاق عبد الله بن حذيفة وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة بن عامر، فقال: ما هذه
____________
(14) 16 / سورة النمل.
(15) 9 / سورة مريم.
(16) سنن بن ماجة / ج 1 ص 12.
قالوا: تنهانا؟.
قال: لا، أقيموا عندي، لا والله لا تفارقوني ما عشت " (17).
أما في عهد عثمان فالأمر أشد وأنكر.. إذ قال على المنبر:
" لا يحل لأحد يروي حديثا لم يسمع به في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ".
كان ذلك باختصار هو موقفهم من الحديث والسنة.. فأين حالهم من حال حديث رسول الله (ص) عن خلفائه الراشدين الراوين لأحاديثه الناشرين لسنته، فتأمل يرحمك الله!.
وهناك قرينة أخرى تصرف هذا العنوان عن الخلفاء الأربعة بهذا الترتيب.
وهو ما نقله أهل الصحاح من أن الخلفاء الذين أوصى بهم الرسول (ص) باقتفاء آثارهم.. والذين ربط خير الأمة بإمامتهم. كانوا أكثر من أربعة. لقد ذكر عليه الصلاة والسلام، اثنا عشر منهم بعدد نقباء بني إسرائيل. وتواتر ذلك على النحو التالي:
قال رسول الله (ص) " لا يزال أمر الناس ماضيا، ما وليهم أثنا عشر خليفة، كلهم من قريش (18).
وقال (ص) " لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، ويكون عليهم اثنا عشر خليفة، كلهم من تريش " (19) ويتبين من خلال هذه الأحاديث أن عدد الخلفاء اثنا عشر. بينما مدعى الجمهور هو أربعة. ولعل هذا التناقض هو ما دعى جمعا من العلماء إلى تأويله بشكل يجعل الحديث ينطبق على أكثر من الخلفاء الأربعة وذلك ما رامه بن كثير وابن حجر الهيثمي. إذ اعتبروا الخلفاء الثلاثة وعلي ومعاوية ويزيد ثم عبد الملك وأولاده الأربعة وسليمان، فيزيد، فهشام. والوليد بن يزيد بن عبد الملك. وهذا لعمري هو التكلف. إذ، هب إننا صدقنا قولهم
____________
(17) كنز العمال حديث رقم 48665 الطبعة الأولى ج 5 ص 239.
(18) صحيح البخاري عن جابر، وابن عينه ورد بطريقين.
(19) صحيح مسلم.
أفيستقيم هذا التأويل الفاسد مع ما وصف به الرسول (ص) خلفاؤه الاثنا عشر.
وقد حاول البعض أن يدس بعض الأسماء. كالذي وضعته البكرية. كما جاء في الصواعق المحرقة بإخراج البغوي، بسند حسن، عن عبد الله بن عمر قال:
سمعت رسول الله (ص) يقول: " يكون خلفي اثنا عشر خليفة، أبو بكر لا يلبث إلا قليلا " قال بن حجر في الصواعق، قال الأئمة: صدر هذا الحديث مجمع على صحته. ويكفي في هذا المقام شهادة الناصبي من أن حديث " الاثنا عشر "، مجمع على صحته، وإن كان الاجماع فقط على صدره الأول. أي أن الكلام عن أبي بكر هو من وضع الوضاعين.
ثم إن الحديث - حديث الخلفاء الراشدين - ربط خير الأمة بهم. وهذا مناقض لواقع الخلفاء. فوفاة الرسول (ص) أعقبتها أحداث خطيرة ضد المسلمين وتعاليم الإسلام.
وقد علمنا ما جرى في سقيفة بني ساعدة من مشادات كلامية وما رافقها من تجرؤات على مفاهيم الإسلام ومقدساته من قبل الشيخين كالعزم على قتل علي (ع) وحرق دار فاطمة الزهراء (ع) ومنع تدوين السنة، وحرق المصاحف وما رافقها من أحداث في صفوف القراء. وما شهده عصر عثمان من مفاسد بسبب سوء تدبيره ومخالفته لمبادئ الإسلام مما أدى إلى اضطرابات خطيرة انتهت بمقتله على يد ثوار من الصحابة.
كل هذا يناقض ادعاء الحديث الذي يربط بين خير الأمة وصلاح الحكم ورشد خلفائه.
ومن جانب آخر، ذكر الحديث أن خلفاءه مهديين. ومفاده أن خلفاءه بلغوا
فلو كان كلهم مهديا لما طعن بعضهم في بعض.
إن مقتضى حديث الرسول (مر) إن صح هي مطابقة سنة الراشدين لسنته (ص) مطابقة لا تخالف الشرع في شئ. ولو أن الخلفاء أو من فهم ذلك من أمرهم أدركوا إنهم مهديين جميعا وأن سنة واحدهم كثانيهم فثالثهم. إذا لما جعلوها شرطا لعلي (ع) عند استخلاف عمر بن الخطاب للستة من أصحابه، عندما عرضوا عليه الخلافة على أساس شرط اتباع سنة الرسول (ص) وسيرة الشيخين. فأبى إلا سنة الرسول (ص). وقد رفضوا على الإمام علي (ع) تمسكه بسنة الرسول (ص) وحدها. فهذا إن دل فإنما يدل على أن سنة الشيخين كانت تعني شيئا زائدا على سنة رسول الله. يؤكد ذلك شهادة الإمام علي (ع) وهي شهادة راشدي معاصر لهم.
وقد كان عمر بن الخطاب قد خلف وراءه ستة. منهم طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد. وكان من المحتمل أن يكون أحدهم هو الرابع دون علي أو عثمان. وكان من المحتمل أن لا يكون علي أو عثمان. ويكون طلحة أو سعيد.
فهل هذا بداء في اعتبار الخلفاء الراشدين هم الأربعة المذكورين أم ماذا؟! ولو كان عمر بن الخطاب يعرف أن الراشدين هم هؤلاء الأربعة، إذن لما أزبد شدقاه يوم السقيفة في خبط الناس وإجبارهم على البيعة، ولما ترك الأمر بين الستة، وأخلى الأمر إلى العدد وترتيب حديث الراشدين؟!.
ومما يدل على فقر هذه الرواية في اعتبار المدعى منها، إنها لم تكن على ذات الانتشار والقوة في عهد الرسول (ص) إذ لو أنها كانت كذلك، لما لجأ عمر بن الخطاب إلى غيرها من الشعارات المقوية لجناحه في تنصيب أبي بكر خلفا للرسول (ص). ولو كانت على نفس الوضوح لما حدث صراع بين المسلمين ولا بين الخلفاء الراشدين أنفسهم.
إن هذه القرائن جميعها تدل بما لا يدع مجالا للشك، بأن المروجين لهذه الادعاءات كانوا على اتصال باللعبة السياسية للخلفاء. وجاءوا بعد انتهاء العهد الراشدي بكثير.
وعليه فإن مدعى العامة في ذلك مردود لكون المغزى من ذلك مشروط بخير الأمة وعدم تصارعها وعدم تضارب سنتهم لما كان البناء العقلائي يستبعد تضارب سنة الراشدين. ولأن هذه الخلافة كما تقدم متعلقة بأهل البيت، وأنها اثنا عشر.
وبعد أن تبيين لنا الاضطراب الشديد الذي لف ما ادعوه من أن الراشدية تنطبق على الأربعة. وبأن ذلك تعسف ثقيل على مغزى الحديث ومدعى أضيق من معناه. يجدر بنا التعرف على المغزى الحقيقي له بما ينطبق مع واقع الخلافة.
في البدء، لا بد من الاتفاق على أن الخلافة أمر خاضع للجعل الشرعي.
وخارج عن نطاق الاختيار. وعلى هذا الأساس، فإن الخلافة تبقى خارج نطاق العصبية والغلبة. وإلا أصبح معيار الإمامة هو الغلبة والعصبية. كما فهمها الكثير من السلف.
وهو حال ابن عمر. فقد روى عنه " أنه كان في زمن الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله " (20).
وذكر صاحب الطبقات أيضا عن سيف المازني " كان ابن عمر يقول: لا أقاتل في الفتنة وأصلي وراء من غلب " (21).
إن الخلافة كالإمامة شأن ديني، نابع من صميم الفرد وإمكانياته الذاتية، سواء أمارس الخلافة وتحققت له الغلبة أم لا. إنها شأن يقاس بالنبوة في معنى الاختصاص، من حيث أن النبوة ما دامت إنها اختيار مولوي لا شأن للبشر فيه،
____________
(20) طبقات بن سعد 4 / 149.