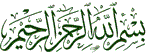
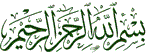
المقدّمة
تطوّر مفهوم التاريخ والتدوين التاريخي عند المسلمين
نبـذة مختصرة
الراجح أنّ لفظـة «التأريخ» عربية الاَصل، فهي من: أَرَخَ، يَـأْرُخُ أَرْخاً، بمعنى بيّن الوقت، أي وَقّت(1).
وبهذا المعنى وحده استخدم العرب هذه المفردة، وهم يعيّنون أوقات الاَحداث لديهم، وقد كانوا يعتمدون حدثاً مهمّاً وكبيراً مبـدأً لتواريخ الاَحداث الاَُخرى اللاحقة، وحتّى السابقة القريبة العهد منه، فيُعرف وقتها قياساً إلى ذلك الحدث الكبير، كحرب البسوس، وعام الفيل، ونحو ذلك، فيقال: حدث كذا قبل حرب البسوس بعامين، وحدث كذا
____________
(1) المعجم الوسيط: «أرخ».
أمّا بعد الاِسلام فقد تعارف المسلمون على التأريخ قياساً إلى أحداث دينية جديدة، كالمبعث النبوي، وعام الحصار في شعب أبي طالب، والهجرة إلى المدينة المنوّرة.. واستمرّ الاَمر هكذا حتّى أحسّوا بالحاجة الماسّة إلى تأريخ ثابت ومحدّد يكون موضع اعتماد الجميع.
فاعتمدوا التقويم الهجري القمري بالفعل منذ سنة 17 للهجرة، في حكومة عمر بن الخطّاب، وجعلوا أوّل محرّم الحرام هو مطلع التاريخ الهجري، وفقاً لِما أشار به الاِمام عليّ عليه السلام لاعتبارات خاصّة ميّزوا بها هذا الشـهر(1).
ولم تظهر لفظة «التاريخ» بمعنى الكتاب الجامع للاَحداث عبر السنين، حتّى النصف الاَوّل من القرن الثاني، في كتاب عوانة بن الحكم، المتوفّى سنة 147 هـ، والذي أسماه: كتاب التاريخ، فهو أوّل كتاب في التاريخ يحمل هذا العنوان، ثمّ اعتُمد بعد ذلك على نحو واسع، فكتب تحت العنوان نفسـه هشام بن محمّـد بن السائب الكلبـي، المتوفّى سنة 204 هـ، كتاب: تاريخ أخبار الخلفاء، وكتب الهيثم بن عديّ، المتوفّى سنة 206 هـ، كتاب: التاريخ على السنين، وكتاب: تاريخ الاَشراف الكبـير(2).
كما اعتُمد لفظ «التاريخ» عنواناً لكتب التراجم كما يوحي به كتاب الهيثم بن عديّ تاريخ الاشراف الكبير، واعتمده أصحاب الحديث في
____________
(1) التنبيه والاِشراف ـ للمسعودي ـ: 252.
(2) انظر: التاريخ العربي والمؤرّخون ـ لشاكر مصطفى ـ 1|51 ـ 52، معجم الاَُدباء 5|597.
أثر الاِسلام في وعي التاريخ وحركة التدوين
لم يكن التاريخ عند العرب قبل الاِسلام أكثر من أخبار الاَحداث المهمّة، تُنقل شفاهاً، وربّما حُدّد وقتها بالقياس إلى حادثة أُخرى، ولم يتجاوز الخبر التاريخي هذين البعدين؛ الرواية، وتعيين الوقت التقريبي.
حتّى إذا نزل القرآن وأخذت العرب تصغي إليه وتحيطه بكلّ ما تدركه من معاني الاِجلال والتقديس، وتتطلّع في معانيه، أصبحت تقف على تفاصيل أحداث أكبر في التاريخ، بدءاً بابتداء الخليقة، وصراع الخير والشرّ في الجنّة، وهبوط البشر إلى الاَرض، ثمّ صراع الخير والشرّ بين هابيل وقابيل، وسلسلة السِيَر ذات الاَثر الحاسم في تاريخ البشرية؛ نوح، إبراهيم، هود، صالح، يونس، يعقوب ويوسف، شعيب، موسى وهارون، داود وسليمان، زكريّا ويحيى وعيسى بن مريم عليهم السلام، نبيّ الاِسلام صلى الله عليه وآله وسلم، وأحوال الاَُمم التي عاش بينها هؤلاء..
فوقفت من خلال ذلك على أنساق تاريخية، تنتظم تحت معادلات واضحة، وسنن محدّدة المعالم، وقف عليها العقل العربي لاَوّل مرّة، ولاَوّل مرّة يقف عليها عقل بشري، فما زال التاريخ عند سائر الاَُمم رهن الاَساطير وطوعاً للحكّام، الآلهة أو أنصاف الآلهة، كما كانوا يدينون.
لاَوّل مرّة يستوقف التاريخ عقل العربي وغير العربي على بطولات وملاحم تصنعها فئات مستضعفة وممتهنة، وليس هو البطل الذي اعتادوا أن يسمعوا باسمه وكأنّه ينحدر عليهم من شاهق، أو يرسل عليهم جنداً من السماء، فيذهب القارئ في أعماق الوعي بالحياة الاجتماعية والقيم
ويرى كيف تصنع الاَُمّة مجدها بالخلود، ليكون ذلك المجد لعنة الاَبد على أُولئك الجبّارين الّذين منحهم التاريخ الآخر ألقاب الآلهة، ذلك حين يقف القارئ على مشاهد من قصّة أصحاب الاَُخدود وموقفهم التاريخي الذي يعزّ أن تجد له بين الاَُمم نظير.
فالتاريخ إذاً تاريخ المجتمعات، تاريخ الثائرين على الظلم والطغيان، تاريخ الضحايا والمستضعفين، تاريخ يقف إلى جانب المعارضة الصامدة المتمرّدة؛ إبراهيم ولوط، وموسى وهارون، وزكريّا، وأصحاب الكهف، وأصحاب الاَُخدود.
وهكذا أصبح التاريخ ليس فقط علماً وفنّاً ومعرفة وميداناً للفكر والاجتهاد، بحثاً عن القوانين والاَنساق والاَُطر الفاعلة في سير حياة الاَُمم والمجتمعات، بل أصبح فوق هذا مدرسة للقيم والمبادئ والتعاليم الراقية.. (لقد كان في قصصهم عبرةٌ لاَُولي الاَلباب ما كان حديثاً يُفترى)(1).
هكذا بعث الاِسلام في العقول الوعي في التاريخ والمعرفة التاريخية، ليكون التاريخ، شيئاً فشيئاً، علماً له خصائصه وأهدافه، وسوف تسهم عوامل متجدّدة في تنفيذه من خلال أعمال متواصلة، تتطوّر مع الزمن حيث
____________
(1) سورة يوسف 12: 111.
ثمّ كانت السيرة النبوية، بما تحتلّه من موقع كبير في قلوب المسلمين، المحفّز الاَوّل لقيام عمل تاريخي، سيبدأ حتماً بأبسط أشكاله، ليتطوّر فيما بعد إلى أكثر أشكاله تكاملاً وتفصيلاً وتعقيداً، وهكذا أصبحت السيرة النبوية هي الميدان التطبيقي الاَوّل لاَوّل الاَعمال التاريخية في عمر الاِسلام، واستمرّت هكذا عقوداً من الزمن، حتّى تطوّر العمل التاريخي، وتراكمت أحداث تاريخية حاسمة في حياة المسلمين بدأت تأخذ طريقها إلى اهتمامات المعنيّـين بالتاريخ، لتتّسع رقعة العمل التاريخي إلى الدوائر السياسية والاجتماعية، والثقافية في الحياة العامّـة.
مراحل التدوين التاريخي عند المسلمين
لا بُـدّ لعِلمٍ تشكّلت معالمه لاَوّل مرّة أن يبدأ بأبسط أشكاله، لتأخذه بعد ذلك الخبرات المتراكمة، والاتّجاهات المتعدّدة، إلى جانب الظروف الخارجية المساعدة، إلى مراتب أكثر تكاملاً، من حيث الاستيعاب ومن حيث العمق، ليطوي طريقه التكاملي في مراحل، تمثّلت بالنسبة للتدوين التاريخي عند المسلمين بمراحل أربع، هي:
المرحلة الاَُولى
بعد أن كانت الرواية التاريخية تنقل شفاهاً في الغالب، شأنها شأن غيرها من السُـنن، دخلت في حيّز التدوين، في وقت مبكّر، ولكن إلى جانب غيرها من السُـنن والآداب، في مدوّنات كان يكتبها بعض الصحابة لاَنفسهم خاصّة لغرض الحفظ والرواية الشفهية للتلاميذ، ولسائر الناس.
ومن رجال هذه المرحلة:
سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي: وقد كتب شيئاً من حياة الرسول الاَكرم صلى الله عليه وآله وسلم، علماً أنّ أباه سعد بن عبادة كان يحتفظ بصحف كتبها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ له نصّ واحد في مسند أحمد(3)، ونصّ واحد في تاريخ الطبري(4)..
سهل بن أبي خيثمة الاَنصاري: وكانت له عناية خاصّة بالسيرة النبوية ومغازي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كان مولده سنة 3 هـ، ووفاته في أيّام معاوية، وصل كتابه إلى حفيدة محمّـد بن يحيى بن سهل، فكان إذا روى منه قال: «وجدت في كتاب آبائي». منه نصوص لدى ابن سعد والبلاذري والطبري(5).
المرحلة الثانية: مرحلة التدوين التاريخي الجزئي المختصّ
بعد انتشار عملية التدوين توزّعت اهتمامات علماء التابعين على أكثر
____________
(1) تذكرة الحفّاظ ـ للذهبي ـ 1|103.
(2) تذكرة الحفّاظ ـ للذهبي ـ 1|103.
(3) مسند أحمد 5|222.
(4) تاريخ الطبري 1|114.
(5) انظر: التاريخ العربي والمؤرّخون ـ لشاكر مصطفى ـ 1|151.
فكتب عروة بن الزبير ـ المتوفّى سنة 93 هـ ـ كتابه المغازي.
وأبو فضـالة عبـدالله بن كـعب بن مـالك الاَنصاري ـ المتوفّى سـنة 97 هـ ـ كتب كتاباً صغيراً في المغازي.
وأبان بن عثمان بن عفّان ـ المتوفّى سنة 105 هـ ـ كتب أيضاً في السيرة والمغازي.
وعاصم بن عمرو بن قتادة الاَنصاري، المتوفّى سنة 120 هـ.
وشرحبيل بن سعد، المتوفّى سنة 123 هـ.
ثمّ ابن شهاب الزهري ـ المتوفّى سنة 124 هـ ـ صاحب كتاب المغازي، وهو أكثر الكتب المتقدّمة أثراً، وقد حفظت أجزاء كثيرة منه في المصنّف لعبـد الرزّاق الصنعاني.
وقد اتّسمت هذه الكتب جميعاً بسمة كتب الحديث، إذ اقتصرت على إيراد الروايات الخاصّة بموضوعها ـ السيرة والمغازي ـ بأسانيدها الكاملة.
ومن طبيعة هذه الاَعمال أنّ الحادثة الواحدة تأتي فيها مجزّأة وغير منتظمة، إذ إنّها كانت غالباً مؤلّفة من عدّة روايات قصار تتحدّث الواحدة منها عن قطعة صغيرة أو جزئية من الحدث، لتأتي أُخرى بقطعة ثانية ربّما لا تكون موصولة بالاَُولى.
المرحلة الثالثة: مرحلة النسق والنظم
بعد مرحلة جمع الاَخبار، تنبّه المؤرّخون اللاحقون إلى ضرورة توحيد صورة الحدث التاريخي، من أجل تقديم نسق دقيق ومترابط للاَحداث، ميّز في النهاية العمل التاريخي عن العمل الحديثي، الذي يعنى بجمع الاَحاديث بأسانيدها، الاَمر الذي دعا المؤرّخين إمّا إلى توحيد الاَسانيد في مقدّمة الحدث المراد نقله، أو إلى إسقاط الاَسانيد، الذي أخذ يظهر في المرحلة اللاحقة.
ومن أبرز مؤرّخي هذه المرحلة:
عوانة بن الحكم، المتوفّى سنة 147 هـ.
محمّـد بن إسحاق، المتوفّى سنة 151 هـ.
لوط بن يحيى، المتوفّى سنة 157 هـ.
أبان بن عثمان بن أحمد البجلي، المتوفّى سنة 170 هـ.
سيف بن عمر التميمي، المتوفّى سنة 170 هـ.
هشام بن محمّـد بن السائب الكلبي، المتوفّى سنة 204 هـ.
الهيثم بن عديّ، المتوفّى سنة 207 هـ.
محمّـد بن عمر الواقدي، المتوفّى سنة 207 هـ.
أبو عبيـدة معمر بن المثنّى، المتوفّى سنة 211 هـ.
نصر بن مزاحم، المتوفّى سنة 212 هـ.
علي بن محمّـد المدائني، المتوفّى سنة 225 هـ.
الزبير بن بكّار، المتوفّى سنة 256 هـ.
أحمد بن يحيى البلاذري، المتوفّى سنة 279 هـ.
وقد غلب على مصنّفات هذه المرحلة أنّها تواريخ مرحلية، أو مقطعية، تخصّص الكتاب الواحد بأخبار مرحلة من مراحل التاريخ أو حادثة مهمّة من حوادثه، ككتب السيرة النبوية والمغازي، وكتب في السقيفة، وأُخرى في الردّة، وأُخرى في مقتل عثمان، ومصنّفات في حرب الجمل، وأُخرى في حرب صفّين، وأُخرى في النهروان، وغيرها في أخبار معاوية، وهكذا، فكان لبعض المؤرّخين عشرات الكتب تناولت عشرات المقاطع التاريخية، فأبو مخنف مثلاً له أكثر من 32 كتاباً، وهشام الكلبي نحو 150 كتاباً، والمدائني 240 كتاباً، وهكذا.
المرحلة الرابعة: مرحلة توحيد التاريخ الاِسلامي، أو العالمي
فظهرت المدوّنات الكبيرة الجامعة التي استوعبت تاريخ الاِسلام بأكمله بترتيب أحداثه، وربّما استوعبت أيضاً تاريخ الاَنبياء والاَُمم السالفة.
وأشهر مؤرّخي هذه المرحلة:
أبو حنيفة الدينوري، المتوفّى سنة 281 هـ.
وأحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي، المتوفّى نحو سنة 292 هـ.
ومحمّد بن جرير الطبري، المتوفّى سنة 310 هـ.
والمسعودي، المتوفّى سنة 346 هـ.
ومسكويه، المتوفّى سنة 421 هـ، الذي قدّم أُنموذجاً جديداً في التاريخ في عمله الكبير الموسوم بـ: تجارب الاَُمم.
لماذا مؤرّخو الشـيعة؟
كانت لي مطالعات ومتابعات في كتاب الدكتور شاكر مصطفى التاريخ العربي والمؤرّخون الذي يمكن عـدّه أهمّ موسوعة اشتملت على تراجم لاَكبر عدد من مؤرّخي الاِسلام، ولا تصحّ نسبته العربية ـ التاريخ العربي ـ إلاّ بلحاظ اللغة التي كتب فيها التاريخ..
لقد استوعبت هذه الموسوعة مراحل التدوين التاريخي، وأنواع التواريخ، لتضيف إلى تراجم المؤرّخين تصنيفاً مهمّاً للمدوّنات التاريخية، لم يخلُ غالباً من تعريف بمنهج المؤرّخ وأُسلوبه في كتابه، مع ذِكر بعض معالم الكتاب، إن لم يكن الكتاب مفقوداً، وإلاّ اكتفى بذِكره مع المتيسّر من ترجمة صاحبه.
وهكذا مثّل هذا الكتاب عملاً موسوعياً مهمّاً هو الاَشمل والاَوسع من سائر ما كتب في هذا الباب، من مثل: علم التاريخ عند المسلمين لفراتنز روزنتشال، و التاريخ والمؤرّخون العرب للدكتور سيّد عبـد العزيز سالم، وغيرهما.
الجولة نفسها قطعتُها مع الاَُستاذ فؤاد سزگين في تاريخ التراث العربي (ج 2: في التدوين التاريخي)، ويأتي هذا الكتاب في المرتبة الثانية بعد الكتاب الاَوّل من حيث الشمول والاستيعاب، مع أنّه يأتي في المرتبة الاَُولى من حيث الدقّة والتوثيق.
وممّا لفت انتباهنا في هذه الاَعمال هو إهمالها لطائفة كبيرة من أصحاب التصانيف في التاريخ، يتوزّع رجالها على سائر الطبقات والقرون، أُولئك هم المؤرّخون الشـيعة!
ولو رجع إليها أُولئك الباحثون لكانت أعمالهم أكثر شمولاً وموضوعيّة.
وإنّما ترجموا للمؤرّخين الشـيعة الّذين وجدوا تراجمهم في مصادر سُـنّية، وإذا وجدوا ذلك ربّما رجعوا إلى تلك المصادر الشـيعية ـ كـ: رجال النجاشي، وفهرست الطوسي ـ لذِكرها في مصادر الترجمة، دون بذل شيء من الجهد في البحث في هذه المصادر نفسها عن مؤرّخين آخرين ومصنّفات تاريخية أُخرى بلغت عدّة مئات من الكتب الصغيرة والكبيرة.
دفعتنا هذه الملاحظة إلى التنقيب في الفهرستات الشـيعية، بحثاً عن مؤرّخين من أصحاب التصنيف في التاريخ، فاستوعب تنقيبنا الفهرستات المعروفة، وهي:
1 ـ الفهرست، للنديم، المتوفّى سنة 380 هـ.
2 ـ الرجال، للنجاشي، المتوفّى سنة 450 هـ.
3 ـ الفهرست، للشيخ الطوسي، المتوفّى سنة 460 هـ.
4 ـ معالم العلماء، لابن شهرآشوب، المتوفّى سنة 588 هـ.
5 ـ الفهرست، لمنتجب الدين، المتوفّى سنة 700 هـ.
فجمعنا ما وقفنا عليه ليكون مكمّلاً لِما أنجزه الباحثون المشار إليهم واستدراكاً على كتاباتهم، وإثراءً لساحة البحث العلمي بشكل عامّ، والبحث التاريخي بشكل خاصّ.
ملاحظات في الكتب الخمسة
هناك نقاط ذات صلة مهمّة بهذا العمل، بعضها يعدّ من المميّزات المنهجية لبعض هذه الكتب، وبعضها الآخر يكشفه البحث والمقارنة، ومن بين الملاحظات العديدة أردنا أن نذكر منها هنا ما له صلة مباشرة بموضوع الدراسة:
1 ـ بعض ما أورده النديم من أسماء المؤرّخين الشيعة هو مثبّت عند النجاشي أو الطوسي غالباً، وقد يذكر من المؤرّخين ما يفوت الشيخين ذكره.
2 ـ تميّز النديم بذِكره تاريخ وفيات الاَعلام الّذين يترجم لهم، غالباً، فيما ندر أن نجد في الكتب الاَربعة الاَُخرى تحديداً لسنة وفاة المترجم له، حتّى بعض ممّن مات على عهد المصنّف نفسه.
وهذه مشكلة علمية لم يتداركها المتأخّر من بين المصنّفين الاَربعة، رغم كون غرض ابن شهرآشوب هو الاستدراك على الشيخ الطوسي، بذِكر
3 ـ تميّز النديم بذكر أسماء الكتب التي ينسبها إلى أصحابها دائماً، فيما اعتمد النجاشي والطوسي طريقة غريبة في ذِكر بعض الكتب؛ إذ يذكران اسم المصنِّف ثمّ يكتفون بالقول: «له كتاب» دون أن نعرف شيئاً عن هذا الكتاب، وقد وقع هذا في كتابيهما كثيراً.
4 ـ أدرج الشيخ الطوسي خاصّة، والنجاشي بدرجة أقلّ، أسماء بعض المصنّفين ـ ومن بينهم مؤرّخين ـ ليسوا من الشيعة؛ لمجرّد أنّهم صنّفوا كتاباً في أهل البيت عليهم السلام، يظهر فيه الحبّ والنصرة، فيما أهملا ذِكر مؤرّخ كبير لا شكّ في تشيّعه، كاليعقوبي مثلاً، وتفرّد النديم بنسبة الواقدي إلى التشيّع، وقد أهمل النجاشي والطوسي ذِكره، والاَرجح أنّ الصواب معهما دون النديم.
5 ـ معظم الكتب التي ذكرها النجاشي والطوسي ومنتجب الدين ذكروا لها أسانيد كاملة تدلّ على روايتهم إيّاها، أو اطّلاعهم عليها، وهذا أثر توثيقي فائق الاَهمّية، فإذا كانت هذه الكتب مفقودة الآن، فهي ـ آنذاك ـ مشهورة عندهم، وقفوا عليها بأنفسهم، أو رووها كاملة.
مؤرّخون لم يدخلوا في هذا المعجم
لمّا اقتصر هذا المعجم على مؤرّخي الشـيعة ممّن له تصنيف في التاريخ، فقد أسقطنا من الاعتبار عدّة أصناف من أصحاب الاَثر التاريخي
أوّلاً
أصحاب الروايات التاريخية الّذين دخلت رواياتهم في مصادر التاريخ المعتبرة لكن لم تُعرف لهم مصنّفات خاصّة في التاريخ، وهم كثير، منهم:
1 ـ حبّة بن جوين العرني:
من أصحاب عليّ عليه السلام، شهد معه المشاهد كلّها، أرّخ وفاته الطبري وابن الاَثير في آخر أحداث سنة 76 هـ، عدّه بعضهم في الصحابة، واستبعد ذلك آخرون(1).
له روايات تاريخية، في تاريخ الطبري وتاريخ الاِسلام للذهبي، وغيرهما(2).
2 ـ إسماعيل بن عبـد الرحمن السدّي القرشي:
وهو السدّي الكبير، رأى الاِمام الحسن عليه السلام وعبـدالله بن عمر وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة، وحدّث عن أنس بن مالك، وخرّج أحاديثه مسلم والترمذي وأبو داود.
جرحه الجوزجاني لتشيّعه، ووثّقه يحيى بن سعيد القطّان، وأحمد بن حنبل، وابن عديّ، والذهبي، توفّي سنة 127 هـ(3).
____________
(1) تاريخ الطبري والكامل في التاريخ: في آخر أحداث سنة 76 هـ.
(2) تاريخ الطبري 5|38، الاِصابة 1|372، تهذيب الكمال 5|351.
(3) تهذيب الكمال 3|132، ميزان الاعتدال 1|236.
3 ـ الحارث بن حصيرة الاَزدي، أبو النعمان الكوفي:
من تابعي التابعين، عدّه الذهبي في الطبقة الخامسة عشرة، الّذين توفّوا بين سنتَي 141 ـ 150 هـ، وله في تاريخ الطبري، والبداية والنهاية لابن كثير، روايات عديدة(2)(3).
ثانياً
مؤرّخون من أصحاب المصنّفات، نُسبوا إلى التشيّع:
ليس يخفى على أهل التحقيق أنّ التشيّع عند المتقدّمين من أهل الجرح والتعديل، وأهل السُـنّة، إنّما هو تفضيل الاِمام عليّ عليه السلام على عثمان، أمّا النَيْل من بني أُميّة فهو عندهم تشدّد في التشيّع.
أمّا تفضيل الاِمام عليّ عليه السلام على أبي بكر وعمر فهو الرفض، حسب تعريفهم، وأمّا النَيْل من أبي بكر وعمر فهو الغلوّ في الرفض، حسب هذا التعريف.
وبناءً على هذا التقسيم أدخلوا الكثير من أهل العلم في التشيّع لمجرّد تفضيلهم الاِمام عليّ عليه السلام، وقدحهم في بني أُميّة، فمن الحفّاظ عدّوا النسائي والحاكم في الشيعة؛ لهذا الاعتبار وحده..
____________
(1) في 84 موضعاً من تاريخ الطبري؛ بواسطة فهارس تاريخ الطبري: 180، وفي 23 موضعاً من البداية والنهاية؛ بواسطة فهارس البداية والنهاية: 528.
(2) تاريخ الطبري في عشرة مواضع، والبداية والنهاية 7|392 ـ طبعة دار إحياء التراث العربي سنة 1408 ـ.
(3) الطبقات الكبرى 6|334، تهذيب الكمال 5|224، الثقات ـ لابن حبّان ـ 6|173.
وصنع مثل هذا مع النسائي(2)، والحاكم النيسابوري(3)، وعبـد الرزّاق ـ صاحب «المصنّف»(4) ـ.
فهؤلاء ومن شاكلهم من المنسوبين إلى التشيّع بهذا الاعتبار لم ندخلهم في هذا المعجم.
ثالثاً
مؤرّخون غلاة انتسبوا إلى التشيّع:
لقد مُنيَ مذهب أهل البيت عليهم السلام بأصناف الغلاة الّذين أسهم الواقع التاريخي كثيراً في تكوين آرائهم الفاسدة، والغلوّ الذي نعنيه هو الغلوّ في الاعتقاد على حقيقته، والذي يتجلّى بادّعاء الاَلوهية للاَئمّة، أو نسبة الصفات الاِلهية إليهم.
وقد ظهر من أتباع الفرق الغالية مؤرّخون كتبوا في الكثير من أبواب التاريخ، ودخلت أسماؤهم في فهارس مصنّفي الشيعة وعلمائهم، منهم:
1 ـ أحمد بن محمّـد بن سيّار:
____________
(1) أثر التشيّع على الروايات التاريخية: 219 ـ 225.
(2) أثر التشيّع على الروايات التاريخية: 217 ـ 219.
(3) أثر التشيّع على الروايات التاريخية: 225 ـ 228.
(4) أثر التشيّع على الروايات التاريخية: 189 ـ 195.
2 ـ جعفر بن محمّـد بن مالك:
أبو عبـدالله، كوفي، كان يضع الحديث وضعاً، ويروي عن المجاهيل، فاسد المذهب والرواية، له في التاريخ: أخبار الاَئمّة ومواليدهم(2).
3 ـ الحسين بن حمدان الخصيبي، المتوفّى سنة 358 هـ أو 346 هـ:
وهو شيخ الغلاة النُصرية في عصره، فاسد المذهب(3)، وهو صاحب كتاب الهداية الكبرى الذي حاول أن يتجنّب فيه العقائد الغالية لاَنّه كتبه لسيف الدولة الحمداني، أيّام الحمدانيّين، وهم من الشيعة الاِمامية، وقد التجأ الخصيبي إلى دولتهم وتقرّب إليهم بهذا الكتاب وبأمثاله.
4 ـ علي بن أحمد الكوفي:
صاحب كتاب البدع المحدَثة، وهو من الغلاة المخمّسة(4).
فهؤلاء وأمثالهم لم ندرجهم في هذا المعجم؛ لاَنّه أُفرد بشكل خاصّ لمن يصدق عليهم لقب التشيّع من المؤرّخين أصحاب التصنيف في التاريخ، في أبوابه المتعدّدة.
____________
(1) رجال النجاشي: 80 رقم 192.
(2) رجال النجاشي: 122 رقم 212.
(3) رجال النجاشي: 67 رقم 159.
(4) رجـال النجـاشي: 265 ـ 266، الرجـال ـ لابـن داود ـ: 259 ـ 260، الخلاصـة ـ للعلاّمة الحلّى ـ: 223 رقم 10، معجم رجال الحديث 11|246 ـ 247 رقم 7876.
1 ـ أبان بن تغلب بن رباح (ت 141 هـ)(1)
أبو سعيد البكري، صحب علي بن الحسين، وأبا جعفر الباقر، وأبا عبـدالله الصادق عليهم السلام، وحدّث عنهم، وكانت له عندهم منزلة وقدم.
وكان من وجوه القرّاء، فقيهاً لغوياً، وله كتاب في تفسير غريب القرآن.
قال له الاِمام الباقر عليه السلام: «اجلس في مسجد المدينة وافتِ الناس، فإنّي أُحبُّ أن يُرى في شيعتي مثلك».
وقال الاِمام الصادق عليه السلام ـ لمّا أتاه نعي أبان ـ: «أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان».
سئل أبان في مجلسه: يا أبا سعيد! كم شهد مع عليٍّ من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ؟
فقال للسائل: كأنّك تريد أن تعرف فضل عليٍّ عليه السلام بمن تبعه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟!
قال: هو ذاك.
قال أبان: والله ما عرفنا فضلهم إلاّ باتّباعهم إيّاه.
وذكر أحدهم الشـيعة في مجلسه، فقال له: أتدري من الشـيعة؟!
الشـيعـة: الّذين إذا اخـتلف الناس عن رسـول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذوا بقـول عليّ عليه السلام، وإذا اختلف الناس عن عليٍّ أخذوا بقول جعفـر بن
____________
(1) رجال النجاشي: 10 ـ 13 رقم 7، الفهرست ـ للطوسي ـ: 51 رقم 17، معالم العلماء: 27 رقم 139، سير أعلام النبلاء 6|308 رقم 131، تهذيب التهذيب 1|81، معجم الاَُدباء 1|108 رقم 2، الذريعة 15|52 رقم 333.
أخرج له أهل السُـنّة في سننهم نحو مئة حديث، وقد وثّقه أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي وابن عديّ وابن حبّان، وقال فيه أبو نعيم: كان غايةً من الغايات.
له في التاريخ:
1 ـ كتاب صِفّـين.
2 ـ كتاب الجَمَل.
3 ـ كتاب النهروان.
2 ـ أبان بن عثمان الاَحمر البجلي (حدود 170 هـ)(1)
كوفي الاَصل، توزّعت حياته بين الكوفة والبصرة، وهو من كبار فقهاء أصحاب الاِمام الصادق عليه السلام، من أصحاب الاِجماع، أدرك الاِمام الكاظم عليه السلام وحدّث عنه قليلاً..
اشتهر مع ذلك بالتاريخ والاَدب، فحدّث عنه بعض مؤرّخي عصره وأُدبائهم، منهم: معمر بن المثنّى.
وألّف في التاريخ كتاباً كبيراً يجمع أخبار المبتدأ ـ بدء الخلق والاَُمم البائدة ـ والمغازي ـ مغازي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والوفاة والردّة ـ.
بهذا التصنيف الواسع يُعدّ أبان فاتحاً لعهد جديد من عهود التدوين التاريخي عند المسلمين، فكتابه هذا يُعدّ أوّل كتاب يستوعب عصور ما
____________
(1) رجال النجاشي: 13 رقم 8، الفهرست ـ للطوسي ـ: 18 رقم 52.
وكتاب أبان المهمّ جدّاً هذا أصله مفقود، لكنّ كثيراً من أخباره محفوظة في المصادر التي أخذت عنه، ابتداءً من تاريخ اليعقوبي و الكافي ثمّ العديد من مؤلّفات الشيخ الصدوق، ثمّ تاريخ الطبرسي الموسوم بـ: إعلام الورى بأعلام الهدى، الذي كان كتاب أبان مصدره الرئيس في السيرة النبوية وأحداثها، لذا يُعدّ الكتاب الاَخير أهمّ المراجع الهادية إلى كتاب أبان.
ولقد أخرج الشيخ رسول جعفريان روايات أبان المبثوثة في هذه المصادر، ممّا يتّصل بالسيرة النبويّة، وجمعها في كتاب يقع ـ مع مقدّمته ـ في 140 صفحة، ولم يجمع فيه ما يتعلّق بقسم (المبتدأ) من أخبار الاَُمم السالفة، ولو جمعه كاملاً لكان عمله أتمّ.
3 ـ إبراهيم بن إسحاق الاَحمري النهاوندي(1)
كان حيّاً سنة 269 هـ، وكان ضعيفاً في حديثه، متّهماً في دينه، صنّف كتباً قريبة من السداد!
له في التاريخ:
1 ـ كتاب مقتل الحسـين.
____________
(1) رجال النجاشي: 19 رقم 21، الفهرست ـ للطوسي ـ: 9 رقم 7، معالم العلماء: 7 رقم 27.
4 ـ إبراهيم بن سليمان بن عبـدالله بن حيّان النِهمي (ق 3)(1)
الهمداني، أبو إسحاق الخزّاز الكوفي، وجاء اسم جده في بعض المصادر «خالد» بدل «حيان» نسبه في نِهم، وقد سكن في بني تميم حيناً فقيل: تميمي، كان ثقة في الحديث، روى عنه حميد بن زياد المتوفّى سنة 310 هـ.
له في التاريخ:
1 ـ كتاب أخبار ذي القرنين.
2 ـ كتاب إرم ذات العماد.
3 ـ كتاب مقتل أمير المؤمنين عليه السلام.
4 ـ كتاب أخبار جُـرهُم.
5 ـ كتاب حديث ابن الحرّ.
5 ـ إبراهيم بن محمّـد بن أبي يحيى المدني (ق 2)(2)
المؤرّخ الكبير، الذي نُسـبت إليه سائر كتب الواقدي.
قال الطوسي: ذكر بعض ثقات العامّة أنّ كتب الواقدي سائرها إنّما هي كتب إبراهيم بن محمّـد بن أبي يحيى، نقلها الواقدي ـ المتوفّى سنة
____________
(1) رجال النجاشي: 20 رقم 18، الفهرست ـ للطوسي ـ: 6 رقم 8، معالم العلماء: 4 رقم 3، معجم الاَُدباء 1|161 رقم 13، قاموس الرجال 1|194 رقم 114.
(2) النجاشي: 14 رقم 12، الفهرست ـ للطوسي ـ: 3 رقم 1.
وله كتاب في الحلال والحرام، مبوّب، عن الاِمام جعفر بن محمّـد الصادق عليه السلام، رواه الطوسي بإسناده إلى إبراهيم.
6 ـ إبراهيم بن محمّـد بن سعيد الثقفي (ت 283 هـ)(1)
كوفي، سكن أصفهان، من ذرّية سعد بن مسعود الثقفي، الذي ولاّه أمير المؤمنين عليه السلام المدائن، وهو الذي لجأ إليه الاِمام الحسن عليه السلام، عدّه النديم من الثقات العلماء المصنّفين.
وإبراهيم المؤرّخ الذي هاجر بتاريخه تحدّياً لمخالفيه، ويقيناً بصحّة كلّ ما أورده فيه!
وقد كتب في التاريخ (32) كتاباً، هي:
1 ـ كتاب المبتدأ.
2 ـ كتاب السيرة.
3 ـ كتاب التاريخ.
4 ـ كتاب معرفة فضل الاَفضل.
5 ـ كتاب أخبار المختار.
6 ـ كتاب المغازي.
7 ـ كتاب السقيفة.
____________
(1) الفهرست ـ للنديم ـ: 279، رجال النجاشي: 16 رقم 19، الفهرست ـ للطوسي ـ: 4 رقم 7، معالم العلماء: 3 رقم 1.
9 ـ كتاب الردّة.
10 ـ كتاب قتل عثمان.
11 ـ كتاب الشورى.
12 ـ كتاب بيعـة عليّ.
13 ـ كتاب الجمل.
14 ـ كتاب صِفّين.
15 ـ كتاب الحَكَمَين.
16 ـ كتاب النهر.
17 ـ كتاب الغارات.
18 ـ كتاب مقتل أمير المؤمنين.
19 ـ كتاب رسائل أمير المؤمنين وأخباره.
20 ـ كتاب أخبار الحسن عليه السلام، أو (قيام الحسن عليه السلام).
21 ـ كتاب مقتل الحسين عليه السلام.
22 ـ كتاب التوابين.
23 ـ كتاب فضل الكوفة ومن نزلها من الصحابة.
24 ـ كتاب أخبار عمر.
25 ـ كتاب أخبار عثمان.
26 ـ كتاب أخبار يزيد.
27 ـ كتاب أخبار ابن الزبير.
28 ـ كتاب أخبار زيد.
29 ـ كتاب أخبار محمّـد النفس الزكية وإبراهيم.
31 ـ كتاب الاَحداث.
أمّا كتابه الذي تحدّى فيه مخالفيه فهو كتاب المعرفـة الذي جمع فيه المناقب المشهورة والمثالب، فاستعظمه الكوفيّون وأشاروا عليه بأن يتركه ولا يخـرجه، فقال: أيّ البـلاد أبعـد من الشـيعة؟ قالوا: أصفهان؛ فحلف لا أروي هذا الكتاب إلاّ بها!
فانتقل إليها ورواه بها ثقة منه بصحّة ما رواه فيه، وقد وفد جماعة من القمّيّـين، منهم: أحمد بن محمّـد بن خالد، وأشاروا عليه بالانتقال إلى قم، فأبى!
والناظر في عناوين كتبه يرى أنّه قد استوعب تاريخ ما قبل الاِسلام في المبتدأ، ومعظم التاريخ الاِسلامي، ابتداءً بالسيرة والمغازي، وانتهاءً بأخبار محمّـد النفس الزكية وأخية إبراهيم ابنا عبد الله بن الحسن المثنّى، المقتولان في زمن المنصور العبّـاسي سنة 145 هـ.
7 ـ أحمد بن أبي طالب الطبرسي (ق 6)(1)
شيخ الحافظ ابن شهرآشوب المازندراني، المتوفّى سنة 588 هـ.
له في التاريخ:
1 ـ تاريخ الاَئمّة.
2 ـ مفاخرة الطالبـية.
____________
(1) معالم العلماء: 25 رقم 125.
8 ـ أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع الصيمري (ق 4)(1)
أبو عبـدالله، من وُلد عبيـد بن عازب، أخي البَراء بن عازب الاَنصاري، الصحابي المعروف.
أصله من الكوفة، وسكن بغداد، ثقة في الحديث، صحيح العقيدة، عاصر الشيخ المفيد رضي الله عنه، المتوفّى سنة 413 هـ ـ، وقال عنه الشيخ المفيد: كنّا نجتمع ونتذاكر، فروى عنّي، ورويت عنه، وأجاز لي جميع رواياته.
ومن خبر الاِجازة يتبادر أنّه كان أسنّ من الشيخ المفيد رضي الله عنه.
له في التاريخ:
1 ـ كتاب الكشف: في ما يتعلّق بالسقيفة.
2 ـ كتاب الضياء: في تاريخ الاَئمّة عليهم السلام، في بعض النسخ (كتاب الصفاء).
3 ـ كتاب الفضائل.
4 ـ كتاب السرائر: في المثالب.
9 ـ أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن المعلّى بن أسد العَمّي (ق4)(2)
أبو بشر، بصري، وكان مستملي أبي أحمد الجلودي، سمع كتبه كلّها
____________
(1) رجال النجاشي: 84 رقم 203، الفهرست ـ للطوسي ـ: 32 رقم 86، معالم العلماء: 19 رقم 87.
(2) رجال النجاشي: 96 رقم 239. الفهرست ـ للطوسي ـ: 30 رقم 80، معالم العلماء: 18 رقم 81، قاموس الرجال 1|368 رقم 265.
له في التاريخ:
1 ـ التاريخ الكبير.
2 ـ التاريـخ الصغير.
3 ـ أخبار صاحب الزنج.
4 ـ أخبار السـيّد الحميري وشعره.
5 ـ عجائب العالم.
6 ـ الاَنبياء والاَوصياء والاَولياء.
7 ـ كتاب المثالب.
8 ـ كتاب القبائل، وقيل: إنّه حسن كبير لم يصنّف مثله.
10 ـ أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الكاتب النديم (ق 3)(1)
شيخ أهل اللغة ووجههم، وهو أُستاذ أبي العبّاس ثعلب، وكان أحمد خصيصاً بالاِمام الحسن العسكري عليه السلام، وبأبيه الاِمام عليّ الهادي عليه السلام قبله.
له مسائل وأخبار وكتب، منها كتاب في الجغرافية، وهو كتاب أسماء
____________
(1) رجـال النجـاشي ـ تحـقيق محمـّد جـواد النائيني ـ 1|238 رقم 228، الفهرست ـ للطوسي ـ: 27 رقم 73، معالم العلماء: 15 رقم 74.
له في التاريخ والاَنساب:
1 ـ كتاب بني النمر بن قاسط: وهو جدّ جاهلي له ذرّيّة كبيرة في المدينة المنوّرة، ترجم له الزركلي في الاَعلام، وقد أورد كتابان: كتاب بنو النمر (أو النمير)، وكتاب بنو قاسط، والراجح أنّهما كتاب واحد، وقد جاء الخطأ من النسّاخ.
2 ـ كتاب طيّ.
3 ـ بنو مرّة بن عوف.
4 ـ بنو عوف.
5 ـ بنو عقيل.
6 ـ بنو عبـدالله بن غطفان.
7 ـ كتاب نوادر الاَعراب.
11 ـ أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح (ت 292 هـ)(1)
اليعقوبي، الكاتب العبّاسي.
كان جدّه واضح من موالي أبي جعفر المنصور، لذلك عرف بالعبّاسي، بالولاء، وقد عمل الجدّ واضح حاكماً على أرمينية وأذربيجان من
____________
(1) معجم الاَُدباء 5|153 رقم 34، النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة 2|10 رقم 40، الاَعلام 1|95، اليعقوبي المؤرّخ والجغرافي ـ لياسين إبراهيم الجعفري ـ، تاريخ اليعقوبي.
كانت ولادة اليعقوبي في بغداد، وبها نشأ، ثمّ رحل في مطلع شبابه إلى أرمينية، وتنقّل في بلدان كثيرة، فألّف كتاب البلدان، وهو من الكتب المتقدّمة في هذا الموضوع، واطّلع على ثقافات مختلفة بشكل مباشر إذ كان يجيد لغات متعدّدة كالفارسية والاَرمنية والاَذربيجانية، بعد العربية.
ويعدّ اليعقوبي من المؤرّخين الكبار، ومن أوّل من صنّف في التاريخ العالمي، فجمع تاريخ الاَُمم إلى تاريخ الاِسلام، كما يعتبر أوّل من صنّف في تاريخ الحضارات من خلال تركيزه الكبير على ثقافات الاَُمم وحركة العلوم المتنوعة فيها، ذلك في الجزء الاَوّل من تاريخه المعروف.
ولقد امتازت كتابته بالاَُسلوب العلمي والمنهج الواضح والمتين، وهو أقرب ما يكون إلى المنهج الاَكاديمي المعاصر.
أمّا كتابه الموسوم بـ: مشاكلة الناس لزمانهم فهو كتاب سابق في بابه؛ إذ عدّت آراؤه فيه بوادر للفكرة الفلسفية للتاريخ.
ولقد نال اليعقوبي إعجاب أهل المعرفة بالتاريخ والمؤرّخين، وموقعاً متقدّماً بين مؤرّخي الاِسلام، كما تعرّض من جانب آخر إلى طعون، لكنّها لا تخلو من تطرف وانحياز ظاهرَين؛ ذلك إنّها تركّزت حول تشيّعه الذي يظهر ـ كما يرى خصومه ـ في ظاهرتين:
والثانية: في فصول الخلافة، كان يقول: «أيّام أبي بكر، أيّام عمر، أيّام عثمان» ثمّ جاء القسم الخاصّ بالاِمام عليّ عليه السلام، فقال: «خلافة عليّ» وبعدها: «خلافة الحسن» ثمّ عاد ليقول: «أيّام معاوية»؛ فجعله بعضهم دليلاً على الغلوّ في التشيّع، وليس هو كذلك؛ لاَنّ اليعقوبي كان موضوعياً، ودقيقاً في كلّ ما نقله، حتّى إنّ هؤلاء الخصوم لم يجدوا في أخباره ما يستدلّون به على دعواهم هذه.
ترك اليعقوبي ثمانية مصنّفات، وتوفّي على الاَرجح في أواخر سنة 292 هـ، وقد كان حيّاً في شوّال من هذه السنة نفسها، إذ كتب بخطّه ملحقاً لكتابه مختصر البلدان مؤرّخاً لزوال الدولة الطولونية، جاء فيه: «لمّا كانت ليلة عيد الفطر من سنة 292 هـ تذكّرت ما كان فيه آل طولون في مثل هذه الليلة».
له في التاريخ:
1 ـ كتاب التاريـخ، المعروف بـ: تاريخ اليعقوبـي: وهو أحد أهمّ كتب التاريخ المعتبرة، جمع فيه بين الدقّة والاختصار، فأخرجه في مجلّدين:
اختصّ الاَوّل:
بتاريخ الاَنبياء والاَُمم السابقة، فامتاز عن غيره من الكتب التي أرّخت لهذه المراحل بقلّة الاَساطير، بل التصريح بتعمّد تركها وعدم العناية بها، لا سيّما الاَساطير التي نُسجت حول ملوك فارس والهند والرومان، فاكتفى بوصف ما نسجته التواريخ منها بأنّه: «ممّا تدفعه العقول،
كما امتاز بعنايته الفائقة بالتاريخ الديني والثقافي والعلمي، اي تاريخ الحضارات، حتّى ليعدّ الجزء الاَوّل من كتابه هذا أوّل كتاب في تاريخ الحضارات يكتبه مؤرّخ مسلم.
وكانت عمدته في تاريخ الاَنبياء والاَديان على الكتب السماوية بالدرجة الاَُولى.
واختص المجلّد الثاني:
بمادّة تاريخ الاِسلام، معتمداً منهجه الاَوّل في الاختصار والدّقة في اختيار الاَخبار من مصادر عرّف بها في مقدّمته على هذا الجزء.
ولقد ظهر اليعقوبي في كتابه هذا ـ بكلا جزئيه ـ مؤرّخاً رفيع المستوى، على درجة متقدّمة من الوعي التاريخي، والحسّ التاريخي، ولم يكن روائياً، أو جمّاعة للروايات يكتفي بسرد الاَخبار دون أن يكون له موقف علمي منها.
2 ـ أسماء الاَُمم السالفة.
3 ـ فتوح المغرب.
4 ـ فتوح إفريقية.
5 ـ تاريخ الطاهرين.
____________
(1) تاريخ اليعقوبي 1| 158.