|
بين الدوافع والأهداف والآثار والنتائج
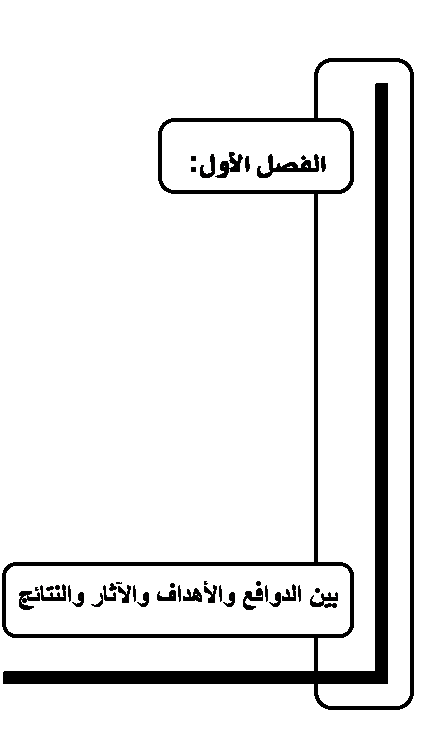
آثـار
ونتائج:
وقد استمر المنع من كتابة الحديث وروايته عشرات السنين،
وأصبح التحاشي عنه هو الصفة المميزة لعلماء الأمة وطليعتها المثقفة.
بل لقد صارت كتابة الحديث عيباً
أيضاً، حتى في أوائل عهد بني مروان([1]).
ومضت السنون والأحقاب، ومات الصحابة الأخيار، بل أوشك
التابعون على الانقراض أيضاً.
ونشأت أجيال وأجيال لم تسمع أحداً
يذكر شيئاً عن نبيها، ولا عن مواقفه، وتعاليمه، وسيرته ومفاهيمه.
وتربت هذه الأجيال على النهج الفكري الذي أراده لها
الحكام والمتسلطون، والموتورون والحاقدون، وتلامذة أهل الكتاب،
المعجبون بهم. وذهب الدين وتلاشى، حتى لم يبق من الإسلام إلا اسمه، ومن
الدين إلا رسمه، حسبما روي عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام([2])،
الذي لم يعش إلا إلى سنة أربعين من الهجرة.
ثم ازداد البلاء بعد ذلك، وبرح الخفاء إلى حد الفضيحة،
فاضطر عمر بن عبد العزيز إلى القيام بعمل رمزي ضعيف وضئيل، لم يكن له
أي أثر يذكر على الصعيد العملي، على مستوى الأجيال والأمة.
ثم بدأت الحركة الحقيقية باتجاه التدوين في أواسط القرن
الثاني للهجرة، حسبما تقدم توضيحه.
وخلاصة الأمر:
أن الحال قد تردت خلال أقل من ثلاثين سنة من وفاة النبي
«صلى الله عليه وآله» إلى ذلك الحد الذي أشار إليه سيد الوصيين «عليه
السلام».
وطمست معظم معالم الدين، ومحقت أحكام الشريعة، كما
أكدته نصوص كثيرة([3]).
وكان ذلك في حين أن الصحابة وعلماءهم كانوا لا يزالون
على قيد الحياة، وكان الناس ينقادون إلى الدين وأحكامه، ويطيعون رموزه
وأعلامه.
فكيف ترى أصبحت الحال بعد أن فتحت الفتوح، ومُصِّرت
الأمصار، ودخلت أقطار كثيرة أو أظهرت الدخول في الإسلام، تحت وطأة
الفتوحات، التي قامت بها السلطة الحاكمة آنذاك؟
وكان أن تضخمت الحالة السكانية، واتسعت رقعة العالم
الإسلامي، في فترة قصيرة جداً،
وبسرعة هائلة.
لقد كان من الطبيعي:
أن يأخذ هؤلاء
الوافدون جديداً
على الإسلام ثقافتهم الدينية من الناس الذين التقوا بهم، وعاشوا معهم،
أو تحت سلطتهم وهيمنتهم.
فإذا كان هؤلاء ضائعين، جاهلين
بأحكام الشريعة، وبحقائق الدين، فما ظنك بالتابعين لهم والآخذين عنهم؟
فإنهم سوف لا يأخذون عنهم إلا ثمرات ذلك الجهل، وآثار ذلك الضياع.
ومن الشواهد على هول ما حدث:
أننا نقرأ عن عدد من الصحابة وغيرهم: أنهم قد تنبهوا
للمأساة، وعبروا عنها بأنحاء مختلفة.
ونذكر من ذلك هنا النصوص التالية:
1 ـ
قد تقدم قول أمير المؤمنين «عليه السلام»: لم يبق من الإسلام إلا اسمه،
ومن الدين إلا رسمه.
2 ـ
روى الإمام مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، أنه قال:
«ما
أعرف شيئاً مما أدركت الناس عليه إلا النداء بالصلاة»([4]).
قال الزرقاني، والباجي:
«يريد
الصحابة، وأن الأذان باق على ما كان عليه، ولم يدخله تغيير، ولا تبديل،
بخلاف الصلاة، فقد أخرت عن أوقاتها، وسائر الأفعال دخلها التغيير الخ..»([5]).
3 ـ
أخرج الشافعي من طريق وهب بن كيسان، قال: رأيت ابن الزبير يبدأ بالصلاة
قبل الخطبة، ثم قال:
«كل
سنن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد غُيرت، حتى الصلاة»([6]).
4 ـ
يقول الزهري: دخلنا على أنس بن مالك بدمشق، وهو وحده يبكي، قلت: ما
يبكيك؟!
قال:
«لا
أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة، وقد ضيعت»([7]).
5 ـ
وقال الحسن البصري: «لو خرج عليكم أصحاب رسول الله «صلى الله عليه
وآله» ما عرفوا منكم إلا قبلتكم»([8]).
ونقول:
حتى القبلة قد غيرت، وجعلوها إلى بيت المقدس، حيث الصخرة قبلة اليهود،
كما تقدم في الفصل الأول من هذا الكتاب.
6 ـ
وقال أبو الدرداء:
«والله
لا أعرف فيهم من أمر محمد «صلى الله عليه وآله» شيئاً
إلا أنهم يصلون جميعاً»([9]).
7 ـ
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أنه قال:
«لو
أن رجلين من أوائل هذه الأمة خلوا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية، لأتيا
الناس اليوم ولا يعرفان شيئاً مما كانا عليه»([10]).
وعن الإمام الصادق «عليه السلام» ـ وقد ذكرت هذه
الأهواء عنده ـ فقال:
«لا
والله، ما هم على شيء مما جاء به رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلا
استقبال الكعبة فقط»([11]).
8 ـ
وحينما صلى عمران بن حصين خلف علي «عليه السلام» أخذ بيد مطرف بن عبد
الله، وقال: لقد صلى صلاة محمد، ولقد ذكرني صلاة محمد.
وكذلك قال أبو موسى حينما صلى خلف علي «عليه السلام»([12]).
9 ـ
وأخيراً،
فقد ذكروا: أن الناس والهاشميين في زمن السجاد «عليه السلام» إلى أن
مضت سبع سنين من إمامة الباقر «عليه السلام» كانوا لا يعرفون كيف
يصلون، ولا كيف يحجون([13]).
فإذا كانت الصلاة التي هي عمود الدين، والركن الأعظم في
الإسلام، ويؤديها كل مسلم خمس مرات يومياً،
كان لا يعرف حدودها وأحكامها
حتى بعض من هم
أقرب
الناس إلى مهبط الوحي والتنزيل،
الذين يفترض فيهم أن يكونوا أعرف من كل أحد بالشريعة وأحكام الدين!،
فكيف تكون حالة غيرهم من أبناء الأمة، الذين هم أبعد عن مصدر العلم
والمعرفة، وما هو مدى اطلاعهم على أحكام الشريعة يا ترى؟!.
وإذا كانت أوضح الواضحات قد أصبحت مجهولة إلى هذا الحد،
فما هو مدى معرفة الناس، وبالأخص البعيدين منهم عن مصدر العلم
والمعرفة، بالأحكام الأخرى، التي يقل الابتلاء بها، والتعرض لها،
والسؤال عنها؟!
وقد يظن القارئ:
أننا نبالغ في تصويرنا لحقيقة ما تمخضت عنه تلك السياسة الخبيثة تجاه
حديث الرسول «صلى الله عليه وآله»، وتجاه القرآن والإسلام.
وقد يظن مثل ذلك بالنسبة للأقوال
الآنفة الذكر التي تقرر:
أنه لم يبق من الإسلام إلا اسمه، ومن الدين إلا رسمه.
أو لم يبق إلا الأذان بالصلاة، أو أن صلاة النبي «صلى
الله عليه وآله» أصبحت منسية حتى من قبل صحابته «صلى الله عليه وآله»،
حتى ذكرهم بها علي أمير المؤمنين «عليه السلام».. إلى آخر ما قدمناه.
ولكننا نأسف حين نقول للقارئ:
إن هذه هي الحقيقة، كل الحقيقة، وليس فيها أي مبالغة، أو تضخيم.
ومن أجل التأكيد على ما سبق نورد للقارئ بعض الشواهد
والوقائع لتكون دليلاً
ملموساً
على ما نقول، مع التزامنا القوي في أن لا نذكر شيئاً
من تلك الشواهد الكثيرة والمتضافرة على جهل الخلفاء ـ باستثناء علي
«عليه
السلام»
ـ بأحكام شرعية هي من أبده البديهيات، وأوضح الواضحات؛
لأننا نخاف أن توجه إلينا أصابع الاتهام بالتعصب على هذا أو ذاك،
وبإرادة تسجيل إدانة لهم من موقع التحامل المذهبي عليهم.
مع أننا نطمئن القارئ الكريم بأن العلامة الأميني رحمه
الله، قد أغنانا في كتابه القيم «الغدير»
عن ذلك، لأنه حشد فيه من الوقائع والشواهد على ذلك الشيء الكثير،
والكثير جداً،
عن مصادر بالغة الكثرة والوثاقة لدى من يتولونهم، ويدافعون عنهم بكل
حيلة ووسيلة.
والشواهد التي نريد أن نوردها هنا، وتصل إلى حد
الفضيحة، هي التالية:
1 ـ
يقول ابن عباس لأهل البصرة، وهو على المنبر: أخرجوا صدقة صومكم. فلم
يفهم الناس مراده؛ فطلب أن يقوم من كان من أهل المدينة حاضراً بتوضيح
ذلك للناس؛ «فإنهم لا يعلمون من زكاة الفطرة الواجبة شيئاً»([14]).
كان هذا هو حال البصرة، التي مُصِّرت في عهد الخليفة
الثاني عمر بن الخطاب، فإن أهلها لا يفهمون حتى لغة الشريعة، ولم
يعرفوا عن زكاة الفطرة شيئاً، رغم أن من المفروض أن يكون ذلك من
البديهيات، فما ظنك بعد هذا بأولئك الذين تفتح بلادهم، ويعلنون
إسلامهم، وهم عشرات الألوف، وليس لديهم من يعلمهم، ولا من يدلهم
ويرشدهم؟
وقد كانت لا تزال تضاف إلى الممالك الإسلامية مناطق
واسعة، وبلاد شاسعة، مملوءة بالسكان، دون أن يتصدى لتعليمهم وتثقيفهم
أحد من الناس.
2 ـ
وقد كان جيش بأكمله من هؤلاء الفاتحين للبلاد، والمفترض أنهم هم حملة
الإسلام إلى سائر الأمم التي تخضع لهم، وتقبل
ببسط سلطتهم ـ إن هذا الجيش ـ لم يكن فيه أحد يعرف: أن الوضوء على من
أحدث، حتى بعث قائدهم، أبو موسى الأشعري من ينادي فيهم بذلك([15]).
مع أن أمر الوضوء من أوضح الواضحات، ويمارسه كل أحد كل
يوم عدة مرات.
فإذا كان هؤلاء يجهلون ذلك، فما ظنك بالناس الذين يفترض
فيهم أن يأخذوا أحكام دينهم وعباداتهم من هؤلاء الجهلة بالذات، وهم
المعلمون والأساتذة، والمربون لهم؟!!.
3 ـ
لقد أشار الخليفة الثاني إلى أن الناس كانوا يعرفون جهل كبار الصحابة
بأحكام الربا، فهو يقول:
«إنكم
تزعمون: أنَّا
لا نعلم أحكام الربا. ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر،
وكوَرِها»([16]).
4 ـ
كما أن ابن مسعود لم يكـن
يدري: أن صرف الفضة بالفضة لا يصلح إلا مثلاً
بمثل([17]).
5 ـ
وأنكر معاوية أيضاً: أن يكون ذلك من الربا([18]).
ونقول:
إنه إذا كان الصحابة، حتى الخليفة الثاني ومعاوية، وحتى
ابن مسعود المشهور بعلمه وفضله، لا يدرون ذلك، فما حال غيرهم من سائر
الناس، فضلاً
عن أولئك الذين لم يروا النبي «صلى الله عليه وآله» ولا عاشوا معه، بل
سمعوا باسمه، لا أكثر ولا أقل؟!.
6 ـ
لقد شكا أهل الكوفة إلى عمر، سعد بن أبي وقاص: أنه لا يحسن يصلي([19]).
7 ـ
إن ابن عمر لا يحسن أن يطلق امرأته، حيث طلقها ثلاثاً
في طهر كان واقعها فيه، فاستحمقوه لأجل ذلك([20]).
8 ـ
إن ابن مسعود قد أفتى رجلاً في الكوفة بجواز أن يتزوج أم زوجته التي
طلقها قبل الدخول، ففعل ذلك، وبعد أن ولدت له أم زوجته ثلاثة أولاد،
وعاد ابن مسعود إلى المدينة، وسأل عن هذه المسألة، فأخبروه بعدم جواز
ذلك، فعاد إلى الكوفة، وأمر ذلك الرجل بفراق تلك المرأة، بعد كل ما حصل([21]).
كما أن مسروقاً
ومعاوية كانا لا يعرفان حكم هذه المسألة أيضاً([22]).
9 ـ
إنهم إنما كانوا يعرفون قراءة رسول الله «صلى الله عليه وآله» في
صلاته؛ باضطراب لحيته([23]).
10 ـ
لقد أفتى عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو([24]):
أن ماء البحر لا يجزي من وضوء ولا جنابة.
وقريب من هذا روي عن سعيد بن المسيب([25])
وروي مثل ذلك عن أبي هريرة أيضاً([26]).
هذا، وقد ذكر لنا الزبير بن بكار وغيره نموذجاً
مخجلاً،
يضحك حتى الثكلى من خطب عدد من سادة القبائل([27])،
ممن كان الخلفاء يولونهم أمور الناس في عنفوان الدولة الأموية. وهي إن
دلت على شيء فإنما تدل على مدى الانحطاط الفكري الذي كان يهيمن على
طبقة الرؤساء وأصحاب النفوذ آنئذ، فكيف يمكننا أن نتصور حالة سائر
الناس ممن كانوا لا يملكون إمكانيات حتى الحصول على لقمة العيش،
والاحتفاظ برمق الحياة؟
قال الزبير بن بكار:
«شكا عبد الله بن عامر إلى زياد بن أبيه ـ وهو كاتبه
على العراق ـ الحصر على المنبر، فقال: أما إنك لو سمعت كلام غيرك في
ذلك الموقف استكثرت ما يكون منك.
قال:
فكيف أسمع ذاك.؟!
قال:
رح يوم الجمعة وكن من المقصورة بالقرب حتى أسمعك خطب الناس.
فلما كان يوم الجمعة قال زياد:
إن الأمير سهر البارحة فليس يمكنه الخروج إلى الصلاة.
والتفت إلى رجل من سادة بني تميم،
فقال له:
قم فاخطب، وصلِّ بالناس.
فلما أوفى على ذروة المنبر قال:
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أشهر.
قالوا:
قبحك الله، جل ثناؤه يقول: في ستة أيام.
وتقول أنت:
في ستة أشهر.
فنزل والتفت إلى شريفٍ لربيعة، فقال
له:
قم فاخطب.
فلما ارتقى المنبر ضرب بطرفه، فوقع على جار له كان
يخاصمه في حد بينهما.
فقال:
الحمد لله. وارتج عليه.
فقال لجاره:
أما بعد فإن نزلت إليك يا أصلع لأفعلن بك، ولأفعلن.
فأنزلوه. فالتفت إلى رئيس من رؤساء الأزد، فقال له:
انهض فأقم للناس صلاتهم، فلما تسنم المنبر قال: الحمد لله، ولم يدر ما
يقول بعد ذلك، فقال: أيها الناس، قد والله هممت أن لا أحضر اليوم،
فقالت لي امرأتي: أنشدتك بالله إن تركت فضل الصلاة في المسجد يوم
الجمعة، فأطعتها، فوقفت هذا الموقف الذي ترون. فاشهدوا جميعاً أنها
طالق.
فأنزلوه إنزالاً
عنيفاً.
وأرسل زياد إلى عبد الله بن عامر، أنه ليس أحد يقيم صلاتهم، ولا بد أن
تحمل على نفسك. فخرج فخطب فتبين فضله في الناس على سائر الناس([28]).
أما بالنسبة إلى حجم التركة التي ورثها الناس عن سلفهم
الصالح (على حد تعبيرهم) فقد ادعوا: أنه قد وصل إليهم من حديث رسول
الله «صلى الله عليه وآله» ـ من غير طريق أهل البيت «عليهم السلام» ـ
نزر قليل، لا يتناسب مع الحاجات التي تواجه الناس، ولا تتوافق مع هذا
التراث الضخم جداً،
الذي سطره علماؤهم عبر القرون المتمادية، فهم يقولون:
1 ـ
إن حديث النبي «صلى الله عليه وآله» أربعة آلاف حديث([29]).
2 ـ
عن أحمد بن حنبـل:
«الأصول
التي يدور عليها العلم عن النبي «صلى الله عليه وآله» ينبغي أن تكون
ألفاً
وماءتين»([30]).
3 ـ
لكن نصاً
آخر يقـول:
إنـه
لم يصل إلى الأمة سوى خمس مئة حديث في أصول الأحكام، ومثلها في أصول
السنة([31]).
ثم إنهم يقولون:
إن هذا الواصل لم يصح منه عندهم إلا أقل القليل، حيث قد بلغت رواية أبي
حنيفة سبعة عشر حديثاً فقط.
أما مالك، فإنما صح عنده ما في كتاب الموطأ،
«وغايتها
ثلاث مئة حديث، أو نحوها»([32]).
فمن أين إذن جاءت هذه الآلاف المؤلفة من الأحاديث التي
وصفوها بالثبوت والصحة، فملأت صحيحي البخاري ومسلم، ومستدرك الحاكم،
وباقي الصحاح الست، وصحيح ابن حبان، وصحيح أبي عوانة. وغير ذلك كثير؟
هذا فضلاً
عن غيرها من مئات الألوف بل الملايين من الأحاديث التي يزعم حفاظ
الحديث أنها عندهم.
بل إن أحمد بن حنبل الذي يقول ما قدمناه هو نفسه قد ألف
المسند الذي يضم أربعين ألف حديث، منها عشرة آلاف مكررة([33]).
ويزعمون:
أنه ليس فيه حديث موضوع عدا ثلاثة أو أربعة أحاديث تكلموا فيها. بل لا
يتأتى الحكم بكون واحد منها موضوعاً
إلا الفرد النادر، مع الاهتمام القوي في دفع ذلك([34]).
نعم، من أين جاءت هذه الأحاديث والروايات، إن ذلك لمريب
حقاً،
وإنه أيضاً لغريب وعجيب!!
قد ظهر مما تقدم:
أن الأحاديث التي كان قد بلغ تداولها إلى درجة الصفر أو كاد، قد بدأت
بعد السماح للناس بالرواية، بعد عشرات السنين تظهر عليها أعراض التضخم
المطرد بصورة غير طبيعية، وبدون أية ضابطة أو رابطة،
إذ إن
مراجعة جامعة لكتب تراجم الحفاظ وأهل الحديث، ومن يسمونهم بالفقهاء مثل
تذكرة الحفاظ للذهبي([35])
وغيره تعطينا أمرين:
أحدهما:
أنها تعظم وتفخم وتخلع مختلف الألفاظ الدالة على الحفظ والعلم، والتبحر
على أشخاص كثيرين، بل تصف بعضهم بأنه وحيد في مصره أو في عصره.
ثم يظهر:
أنه إنما كان يحفظ ثلاث مئة حديث، أو لم يثبت لديه سوى سبعة عشر حديثاً،
أو لا يعرف أنه يحرم الزواج بأم الزوجة، أو ما إلى ذلك مما ألمحنا
إليه.
الثاني:
إن ملاحظة طبقات الحفاظ تعطينا تدرجاً
ملفتاً
للنظر في حجم الأحاديث، فنجد
أن طبقة كبيرة في الصدر الأول يوصف الحافظ منها بأن عنده ثلاثون أو
ستون حديثاً،
أو مئة أو عشرة أحاديث، أو مئتا حديث، ونحو ذلك.
ثم إذا تقدم الزمان قليلاً،
يترقى العدد ليتراوح بين الألف والألفين والثلاثة والخمسة،
ونحو ذلك. ثم في فترة لاحقة يترقى العدد إلى بضع عشرات: عشرين ألفاً،
ثلاثين..
وهكذا.
ثم تأتي فترة فتصل
فيها
الأعداد إلى
مئة ألف أو مئتين أو ثلاث مئة،
ثم يقفز العدد إلى الست والسبع مئة، وإلى المليون حديث،
وأكثر من ذلك حتى ليفوز بعضهم مثل شعبة بلقب أمير المؤمنين في الحديث([36]).
ولا ننسى هنا:
أن نستشهد لهذا الذي ذكرناه
بالمفارقة التالية:
في حين نجد:
أن
القاضي عبد الجبار يصرح: بأن أحاديث التجسيم والتشبيه من أخبار الآحاد([37]).
وأن أحمد بن حنبل قد قال:
إن بعض أهل الحديث أخبره: أن يحيى بن صالح (المتوفى سنة 222 ه.(
([38])
قال:
«لو
ترك أصحاب الحديث عشرة أحاديث، يعني هذه التي في الرؤية».
ثم قال أحمد:
«كأنه
نزع إلى رأي جهم»([39]).
فيحيى بن صالح الذي يروي له البخاري، وأصحاب الصحاح
الست سوى النسائي([40])
يريد أن يقول: إن الاعتقاد برؤية الله قائم على عشرة أحاديث فقط.
بل صرح بعضهم:
بأن أخبار الرؤية لا تزيد على ثمانية أحاديث([41]).
ولكننا بعد حوالي نصف قرن من الزمن نجد ابن خزيمة الذي
يصفونه بأنه «إمام الأئمة» يؤلف كتاباً
بعنوان «التوحيد وإثبات صفات الرب» يبلغ عدد صفحاته حوالي أربع مئة
صفحة، قد شحنه بأحاديث التجسيم، وأحاديث الرؤية من أوله إلى آخره، وفيه
الكثير مما يدل على أن لله تعالى يداً،
ورجلاً،
وعيناً،
وإصبعاً،
وساقاً
و..
و..
الخ..
تعالى الله عما يقوله الجاهلون والمبطلون علواً
كبيراً.
فمن أين جاءت هذه الأحاديث؟
وكيف ومتى لفقت واخترعت؟!
لا ندري، غير أننا وجدنا الإمام الشافعي ينقل عن القاضي
أبي يوسف، الذي عاش في أواخر القرن الثاني قوله:
«والرواية
تزداد كثرة، ويخرج منها ما لا يعرف، ولا يعرفه أهل الفقه، ولا يوافق
الكتاب ولا السنة»([42]).
وذلك يفسر لنا العديد من الظواهر الأخرى الملفتة للنظر،
مما سنشير إلى بعض منه فيما يلي من مطالب.
وبعدما تقدم، فإننا سوف لن نفاجأ إذا سمعناهم يحكمون
على 12 أو 14 أو 35 ألف حديث، بل على مئات الألوف من الأحاديث بالكذب
والوضع والاختلاق؛ وكثير من هذا المختلق والموضوع قد جاء لأهداف
مختلفة، ومنها: لإرضاء الملوك وتأييد سلطانهم، وتحقيق أهدافهم ومآربهم([43]).
وقد ذكر العلامة الأميني في كتابه الغدير ج 5 ص 288 ـ
290 قائمة بالموضوعات بلغت 408684 حديثاً فراجع.
وحتى تلك الأحاديث التي سكتوا عنها أو حكموا بصحتها،
وهي تعد بعشرات الألـوف
والملايين([44])،
وقد زخرت بها كتب صحاحهم ومجاميعهم الحديثية، فإنها تصبح موضع شك وريب،
بل إننا لنطمئن لعدم صحة الكثير منها، من الأساس.
وبعد، فإذا كان كبار الصحابة، وابن مسعود لا يعرفون
أحكام الربا، وابن عمر لا يعرف كيف يطلق امرأته، وجيش بأكمله لا يعرف
أن الوضوء على من أحدث إلى آخر ما تقدم.
فإن من الطبيعي:
أن يرى الناس في من يدعي أنه يحفظ ثلاثين أو أربعين حديثاً،
أو مئة أو ماءتي حديث، أو عرف بعض الأحكام عن رسول الله «صلى الله عليه
وآله»: أنه أعلم العلماء، وأفقه الفقهاء في عصره، أو في مصره، أو بلده.
وأن يصبح هو الملاذ والمرجع والموئل لهم فيما ينوبهم من
أمور دينهم. ويتلمَّذون
عليه، ويأخذون عنه أحكامهم، وشريعة نبيهم، كما يظهر جلياً
من مراجعة كتب التراجم والرجال، التي تمثل التيار العام لبعض الفئات،
التي كانت تنسجم مع سياسات الحكام، وترتبط بها بنحو أو بآخر.
ومن جهة أخرى؛
فإن هذا
العالم الجليل!! إذا وجد نفسه في موقع كهذا، وواجه الواقع، واحتاج إلى
المزيد مما ليس عنده منه أثارة من علم، فلسوف يبحث عما يلبي له حاجته،
ويوصله إلى بغيته، وأين؟ وأنى له أن يجـد
ذلك؟ إلا عند أنـاس،
أخـذ
على نفسه (أو أخـذ
الحكـام
عليه وعلى الناس): أن لا يتصلوا بهم، ولا يأخذوا شيئاً عنهم، وهم أهل
بيت النبوة، ومعدن الرسالة عليهم الصلاة والسلام.
فلا غرو بعد هذا إذا رأينا هذا الرجل الجليل يبادر إلى
ما هو أسهل وأيسر، فيضيف من عند نفسه، وعلى حسابه الخاص ما شاءت له
قريحته، وسمحت له به همته، حيث لا رقيب عليه ولا حسيب، ولا مانع من
ضمير، ولا رادع من وجدان.
أما بالنسبة إلى فقه الفقهاء، ومذاهب العلماء، فقد أصبح
من المفهوم:
أن وراء الأكمة ما وراءها، حين نرى أن فقه أبي حنيفة،
ومالك، والشافعي، وغيرهم يتسع ويتضخم، ويزيد ويتورم، حتى تضيق عنه
المجلدات الكثيرة وآلاف الصفحات،
مع ما نراه من استنادهم إلى المئات والألوف من الروايات التي كانت تلك
حالها، وذاك مآلها!!
فاقرأ واعجب، فما عشت أراك الدهر عجباً!!
أما ما يستندون إليه، ويعتمدون عليه في غير الفقه، فذلك
حدّث عنه ولا حرج؛ وهو يصل إلى الألوف الكثيرة، كما يظهر من تتبع مختلف
المواضع والمواقع.
ومن الطريف أن نذكر هنا:
أنهم في حين يعترفون بأنهم قد وضعوا أحاديث في فضائل
أبي بكر، وعمر، وعثمان، رداً
على من ينتقص منهم([45]).
ويعترفون أيضاً:
بأنه عندما كثر سب الصحابة (وهو أمر لم يحصل،
وما حصل هو مجرد التعريف ببعض ما ارتكبه أشخاص منهم، تحبهم الهيئة
الحاكمة، أو ممن كانوا أحد أركانها، رداً
على الغلو الحاصل فيهم، حتى لتعتبر أقوالهم سنة، وما إلى ذلك) فقد وضعت
أحاديث في فضل الصحابة جميعاً، أو في فضل جمع منهم([46]).
إنهم مع أنهم يعترفون بهذا، لكنهم يتهمون بعض الشيعة
بوضع أحاديث في فضل علي، والطعن في معاوية([47]).
مع أن علياً في غنى عن ذلك، ولا يمكن لأحد أن يضع أكثر
مما قاله رسول الله «صلى الله عليه وآله» في حقه، مما ثبت بالآثار
الصحيحة والمتواترة، والتي تفوق حد الإحصاء.
كما أنه يكفي معاوية التعريف بما ثبتت روايته عن رسول
الله «صلى الله عليه وآله» في حقه مما لا يجهله أحد، حتى إن النسائي قد
نال شرف الشهادة حينما أظهر حديثاً واحداً
منها([48])،
فكيف لو أراد إظهار كل ما يعرفه، مما رواه عن رسول الله «صلى الله عليه
وآله» في حقه؟!
وقد كان العراق موطناً
لعلي «عليه السلام» مدة خلافته، وقد ناصر العراقيون علياً،
ورأوا ورووا بعض فضائله «عليه السلام».
وقاتلوا الناكثين والمارقين والقاسطين معه، فعاداهم
الناس، واتهموهم بالكذب والوضع لأجل ذلك، وفرضوا عليهم حصاراً
ثقافياً
وإعلامياً.
ولعل أول من بادر إلى اتهامهم بذلك هو أم المؤمنين
عائشة([49])
التي لقيت على أيديهم في حرب الجمل شر هزيمة.
واتهمهم بذلك أيضاً عبد الله بن عمرو بن العاص الذي لقي
منهم الأمرين في حرب صفين([50]).
وكذلك الزهري([51])
الذي كان له وجاهة ومكانة خاصة في البلاط الأموي([52]).
أما مالك، الذي لم يرو عن أحد من الكوفيين، سوى عبد
الله بن إدريس، الذي كان على مذهبه، فقد رأى: أن أحاديث أهل العراق،
تنزل منزلة أحاديث أهل الكتاب، أي فلا تصدق ولا تكذب([53]).
وكان يقول:
لم يرو أولونا عن أوليهم، كذلك لا يروي آخرونا عن آخريهم([54]).
وقد كانت هذه السياسة سياسة أموية وشامية، ضد علي «عليه
السلام»، منطلقها التعصب والتجني، وليس تحري الحق، والتزام جانبه.
وقد قالوا عن الجوزجاني:
إنه في كتابه في الرجال
«يتشدد
في جرح الكوفيين من أصحاب علي، من أجل المذهب»،
لذلك قال ابن حجر:
«لا
عبرة بحطه على الكوفيين»([55]).
وقال الأوزاعي:
«كانت
الخلفاء بالشام، فإذا كانت الحادثة سألوا عنها علماء أهل الشام، وأهل
المدينة، وكانت أحاديث العراق لا تجاوز جدر بيوتهم، فمتى كان علماء أهل
الشام يحملون عن خوارج أهل العراق؟!»([56]).
ويقول ابن المبارك:
«ما دخلت الشام إلا لأستغني عن حديث أهل الكوفة»([57]).
بل إن ذلك قد انعكس حتى على علوم العربية، مثل علم
النحو وغيره؛ حيث نجد اهتماماً
ظاهراً
بتكريس نحو البصريين، واستبعاد نحو الكوفيين، مهما عاضدته الدلائل
والشواهد، فراجع ولاحظ. ولهذا البحث مجال آخر.
على أن كل تلك الجهود، وإن تركت بعض الأثر بصورة عامة،
ولكنها لم تؤت كل ثمارها المرجوة، فقد فرض الفقه والحديث العراقي نفسه
على الساحة، ولا يمكنهم الاستغناء عنه بالكلية، فقبلوه على مضض وكره
منهم، حتى ليقول ابن المديني:
«لو
تركت أهل البصرة لحال القدر، وتركت أهل الكوفة لذلك الرأي (يعني
التشيع) خربت الكتب»([58]).
وقال محمد بن يعقوب:
«إن
كتاب أستاذه (يعني صحيح مسلم) ملآن من حديث الشيعة»([59]).
وقد روى البخاري نفسه عن طائفة كبيرة ممن ينسبون إلى
التشيع من العراقيين وغيرهم([60]).
ولمزيد من التأييد والتأكيد على ما نريد أن نقوله، نعود
إلى التذكير ببعض النقاط المفيدة في إيضاح المطلوب، فنقول:
لقد كانت كل تلك السياسات التي
تحدثنا عنها تنفذ في حين:
أن الناس لم يكونوا قادرين على تمييز الغث من السمين، والصحيح من
السقيم، لأنهم كانوا قد فقدوا المعايير والضوابط المعقولة والمقبولة،
التي تمكنهم من ممارسة دور الرقابة الدقيقة والمسؤولة على ما يزعم أنه
شريعة ودين، وأحكام وإسلام.
وبما أن الناس كانوا يريدون معرفة شيء عن دينهم، ويحبون
قرآنهم، وإسلامهم، ونبيهم.
وبما أنه لم يعد ثمة من يستطيع أن يعارض أو أن يعترض،
فقد راجت بضائع الكذابين والوضاعين، وقامت سوقهم على قدم وساق.
وتمكنوا من إشاعة أباطيلهم، وترهاتهم، وأضاليلهم.
ولم يكن كثير من الناس يملكون القدرة على تمييز الصحيح
من السقيم، والحق من الباطل، والأصيل من الدخيل.
وكان أهل الكتاب في طليعة المستفيدين من هذه الأجواء،
حسبما أوضحناه.
حيث إن ذلك قد سهَّل على الذين
أظهروا الإسلام منهم:
أن ينشروا أباطيلهم وترهاتهم، بعد أن خلت لهم الساحة، وأصبحوا هم مصدر
العلم والمعارف الدينية، والثقافة لأكثر الناس،
خصوصاً
مع ما كانوا ينعمون به من حماية وتأييد من قبل الحكام آنئذٍ.
إنما أصبح ذلك ممكنا بعد أن تمكن الحكام من فرض ظروف
منعت الصفوة من أهل البيت «عليهم السلام»، وشيعتهم الأبرار رضوان الله
تعالى عليهم من ممارسة دورهم في التصحيح والتنقيح، والتقليم والتطعيم،
وفضح زيف المزيفين، ودفع كيد الخائنين.
وحرص أكثر الناس ولاسيما الحاقدون والمتزلفون، وضعفاء
النفوس، على الابتعاد عنهم «عليهم السلام»، ولاسيما بعد استشهاد سيد
شباب أهل الجنة، الإمام الحسين «عليه السلام»، وصحبه الأخيار، وأهل
بيته الأطهار في كربلاء الفداء.
وقد أشار الإمام السجاد إلى ذلك،
فقال:
«اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك، ومواضع أمنائك.
في الدرجة الرفيعة، التي اختصصتهم بها، قد ابتزوها حتى عاد صفوتك،
وخلفاؤك مغلوبين، مقهورين، مبتزين. يرون حكمك مبدلاً، وكتابك منبوذاً،
وفرائضك محرفة عن جهات أشراعك، وسنن نبيك متروكة الخ..»([61]).
والملفت للنظر هنا:
أنه «عليه السلام» يقرر هذه الحقيقة ويعلنها في صيغة دعاء، في خصوص يوم
عرفة في موسم الحج، حيث يجتمع الناس من مختلف الأقطار والأمصار،
ليستفيدوا من هذه الشعيرة العظيمة، ويعودوا إلى بلادهم بمزيد من الطهر،
والصفاء، والإخلاص، والوعي لدينهم، ولعقيدتهم.
ثم تكون هذه الفقرات جزءاً من دعاء يدعو به المسلمون كل
يوم جمعة في طول البلاد الإسلامية وعرضها وباستمرار، ليسهم ذلك في
المزيد من إيجاد حالة الوعي الرسالي، وليكون من ثم واحداً من
مسؤولياتهم الإيمانية، والعقيدية.
وقد تعودنا من الإمام السجاد «عليه السلام» هذا الأسلوب
الفذ في أكثر من مجال من مجالات الفكر، والعقيدة، والسلوك، كما يتضح
ذلك بالمراجعة إلى الصحيفة السجادية، وغيرها من الأدعية المنقولة عنه
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين.
وغني
عن القول:
إن استبعاد حديث الرسول «صلى الله عليه وآله»، قد أوقع السلطات الحاكمة
في مأزق حقيقي على صعيد الفتوى، وإصدار الأحكام، ولذلك كان أول من بادر
إلى العمل بالرأي والقياس هم الحكام أنفسهم، الذين كانوا يصرون على
استبعاد أهل البيت «عليهم السلام» ـ قدر الامكان ـ عن دائرة الفتوى،
وعن بث العلوم والمعارف الصحيحة، والصافية في الناس.
ثم تبعهم رعيل كبير ممن تسمى بالفقهاء والمحدثين، الذين
كان الكثيرون منهم من طلاب اللبانات، ومن المتزلفين إلى الحكام، ومن
وعاظ السلاطين. فطغت مدرسة الرأي، وانتشر العمل بالاستحسان وبالقياس([62])
«حتى
استحالت الشريعة، وصار أصحاب القياس أصحاب شريعة جديدة»([63])
كما قاله المعتزلي الشافعي.
وسيأتي([64]):
أن أبا بكر كان أول من عمل برأيه، حينما لا يكون لديه نص عن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، كما زعموا.
ثم جاء عمر بن الخطاب، فأكد ذلك، ورسخه، قولاً
وعملاً.
وستأتي بعض أقواله ورسائله إلى أبي موسى الأشعري([65])،
وشريح القاضي، التي يأمر فيها بالعمل بالرأي والقياس في رقم 28 من هذا
الفصل.
مع أنهم يقولون:
إن عمر بن الخطاب هو الذي انتقد القائلين بالرأي، وروى عن رسول الله
«صلى الله عليه وآله» قوله:
«إن
أصحاب الرأي أعداء السنن، تفلتت منهم أن يعوها، وأعيتهم أن يحفظوها،
وسلبوا أن يقولوا: لا نعلم؛ فعارضوا السنن برأيهم»([66]).
ولعل ذلك قد كان منه قبل أن يواجه المشكلة، ويحتاج إلى
العمل بآرائه، أي قبل أن يتشدد في المنع من رواية حديث النبي «صلى الله
عليه وآله» وكتابته، وقبل أن يمنع الصحابة من الفتوى ويحصر حق الفتوى
بالأمير، أو من يختاره الأمير.
وربما يكون ذلك منه مختصاً
بأولئك الذين يفتون الناس بآرائهم، دون إجازة من الحاكم أو الأمير.
ولعل التوجيه الأول هو الأنسب بسياق كلامه، حيث ينسبهم
إلى الجهل بالسنن، فعارضوا السنن بآرائهم.
إلا أن يدَّعى:
أنه يريد أن غير الأمراء لم يكن لديهم علم بالسنن،
والعلم بها محصور بالأمراء. وهذا كلام لا يمكن قبوله، ولا الموافقة
عليه، لمخالفته الظاهرة للبداهة وللواقع.
وقد أوضح لنا الإمام الصادق «عليه السلام» ـ فيما روي
عنه ـ سبب لجوئهم إلى الرأي، والقياس في دين الله، ثم ما نشأ عن ذلك.
وهي شهادة ممن كان حاضراً
وناظراً،
وقد شاهد وعاين، وخبر الأمور، ووقف على أغوارها، واستكنه أسرارها، فهو
يقول:
«يظن هؤلاء الذين يدعون أنهم فقهاء علماء، قد أثبتوا
جميع الفقه والدين، مما يحتاج إليه الأمة!! وليس كل علم رسول الله «صلى
الله عليه وآله» علموه، ولا صار إليهم من رسول الله «صلى الله عليه
وآله» ولا عرفوه. وذلك أن الشيء من الحلال، والحرام، والأحكام، يرد
عليهم؛ فيسألون عنه، ولا يكون عندهم فيه أثر من رسول الله «صلى الله
عليه وآله».
ويستحيون أن ينسبهم الناس إلى الجهل، ويكرهون أن يسألوا
فلا يجيبون؛ فيطلب الناس العلم من معدنه. فلذلك استعملوا الرأي،
والقياس في دين الله، وتركوا الآثار ودانوا بالبدع الخ..»([67]).
قد قدمنا فيما سبق إيضاحات حول سياسات الحكام تجاه حديث
الرسول، رواية وكتابة، وتجاه السؤال عن معاني القرآن وغير ذلك.
وبقي أن نشير إلى دوافع هذه السياسة وأهدافها، فنحن
نجمل ذلك على النحو التالي:
لقد كان الخليفة الإسلامي ـ بنظر الناس ـ يحتل مقام
رسول الله «صلى الله عليه وآله». وذلك يعني:
أنه لا بد أن يقوم بنفس المهام، ويتحمل نفس المسؤوليات
التي للرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله».
فهو القاضي، والحاكم، والمربي، والقائد العسكري،
والمفتي، والعالم، ووالخ..
وقد كان الناس يرون:
أن لهم الحق في توجيه أي نقد له، ومطالبته بأية مخالفة تصدر منه، وأي
خطأ يقع فيه.
وإذا رجعنا إلى أولئك الذين تسلموا زمام الحكم فور وفاة
رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فإننا نجد:
أنهم ليسوا في مستوى توقعات الناس، لاسيما وأن
التناقضات في فتاواهم وأعمالهم مع ما سمعه الصحابة ورأوه من رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، وعرفوه من مواقفه، كانت كثيرة وخطيرة.
هذا كله عدا عن مخالفاتهم لكثير من النصوص القرآنية،
وأخطائهم، أو عدم اطلاعهم على تفسير كثير من آياته.
بالإضافة إلى تناقضهم في الأحكام والفتاوى باستمرار.
وقد اعترفوا هم أنفسهم بالحقيقة، وقرروها في مناسبات
عدة، حتى وهم يواجهون بعض الاعتراضات من قبل النساء على بعض مخالفاتهم
حيث ظهر أنهم لا يملكون الكثير من المعرفة بالأحكام الشرعية، والدينية،
التي يحتاجها الناس في معاملاتهم وشؤونهم.
بل إن الخليفة الثاني قد سجل كلمة طارت في الآفاق،
وأصبحت لها شهرة متميزة، وذلك حينما طالب أبا موسى الأشعري ببينة على
حديث رواه، وإلا فلسوف ينزل به العقاب.
ثم اتضح صحة الحديث، فقال عمر بن
الخطاب في هذه المناسبة:
إنه ألهاه الصفق بالأسواق([68])
عن الحضور عند النبي «صلى الله عليه وآله» لسماع حديثه، والاستفادة
منه.
وهو الذي يقول أيضاً:
كل الناس أفقه من عمر، حتى ربات الحجال في خدورهن.
وقال عشرات المرات:
لولا علي لهلك عمر. ونحو ذلك([69]).
ومهما يكن من أمر،
فقد كثرت الاعتراضات، وظهر القصور جلياً
واضحاً
في نطاق تطبيق الرواية، والفتوى، والقضاء، والموقف السياسي، وغير ذلك،
على النص القرآني، والسنة النبوية بصورة عامة.
وقد بدا واضحاً:
أن استمرار الوضع على هذا المنوال لسوف يضعف موقع الحاكم، وسيهتز
ويتزعزع، ولن تبقى له تلك المصداقية والفاعلية، ولا الهيمنة القوية
التي يتوخاها.
ومن جهة أخرى، فقد كانت هناك تصريحات كثيرة للرسول
الأعظم «صلى الله عليه وآله»، ومواقف حاسمة وحساسة تجاه بعض القضايا
وبعض الناس، إيجابية هنا، وسلبية هناك.
كان إظهارها وشيوعها بين الناس لا يخدم مصلحة الحكام،
بل هو يضرهم ويجرحهم بصورة كبيرة وخطيرة، فلا بد من معالجة هذا الأمر
وتلافي سلبياته، فكان انتهاج هذه السياسة مفيداً
جداً
لهم في ذلك.
وإليك تفصيل ذلك:
إن مما يدل أو يشير إلى أنه قد كان ثمة مواقف للرسول
«صلى الله عليه وآله»، ونصوص لم يكن إظهارها في مصلحة الحاكم، فكان لا
بد من التعتيم عليها، وطمسها، قول ابن أبي الحديد المعتزلي:
«قد
أطبقت الصحابة إطباقاً
واحداً
على ترك كثير من النصوص لما رأوا المصلحة في ذلك»([70]).
وواضح:
أن
مراده من الصحابة المجمعين من عدا علياً «عليه السلام»، لأن المعتزلي
نفسه يقول:
«إنما
قال أعداؤه: لا رأي له؛ لأنه كان متعبداً بالشريعة، لا يرى خلافها».
إلى أن قال:
«وغيره
من الخلفاء كان يعمل بمقتضى ما يستصلحه، ويستوفقه، سواء أكان مطابقاً
للشرع أم لم يكن. ولا ريب أن من يعمل بما يؤدي إليه اجتهاده، ولا يقف
مع ضوابط وقيود يمتنع لأجلها مما يرى الصلاح فيه، تكون أحواله إلى
الانتظام أقرب»([71]).
وقد قال عثمان للناس على المنبر:
«أيها
الناس، إني كتمتكم حديثاً سمعته من رسول الله «صلى الله عليه وآله»
كراهة تفرقكم عني، ثم بدا لي
الخ..»([72]).
وهناك
مواقف إيجابية لرسول الله «صلى الله عليه وآله» تجاه بعض المخلصين من
صحابته، الذين كانوا يملكون مؤهلات نادرة، وميزات فريدة، تجعل لهم الحق
دون كل من عداهم بالتصدي لإمامة الأمة، وقيادتها. وأعني به علياً أمير
المؤمنين عليه الصلاة والسلام.
وقد ركزت كلمات ومواقف الرسول الأعظم «صلى الله عليه
وآله» على إظهار تلك الميزات الفريدة بالذات،
سواء منها ما يرتبط بفضائله «عليه السلام» الذاتية، أو فيما يرتبط بما
له من جهاد وسوابق.
ثم أوضحت تلك المواقف النبوية، والنصوص عنه «صلى الله
عليه وآله» بالاستناد إلى ذلك: أن الإمامة وقيادة الأمة إنما هي حق له،
وللأئمة من ولده «عليهم السلام»، دون كل أحد سواهم.
وذلك من شأنه:
أن يضع الهيئة التي تصدت للحكم بعد النبي «صلى الله عليه وآله» أمام
إحراجات كبيرة في مسألة
مصيرية، وخطيرة وحساسة، بل وفي منتهى الحساسية،
ويضع علامات استفهام واضحة على مجمل الوضع القائم آنذاك، ومدى شرعيته.
فكان لا بد من محاربة هذا النوع من النصوص، والتعتيم
على تلكم المواقف، تلافياً
لما هو أعظم وأدهى.
فعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، قال:
«جاء علقمة بكتاب من مكة أو اليمن، صحيفة فيها أحاديث
في أهل البيت ـ بيت النبي «صلى الله عليه وآله» ـ فاستأذنا على عبد
الله([73])،
فدخلنا عليه، قال: فدفعنا إليه الصحيفة.
قال:
فدعا الجارية، ثم دعا بطست فيه ماء.
فقلنا له:
يا أبا عبد الرحمن، انظر فيها؛ فإن فيها أحاديث حساناً!
قال:
فجعل يميثها فيها وهو يقول:
{نَحْنُ
نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا
الْقُرْآنَ}([74])،
القلوب أوعية؛ فاشغلوها بالقرآن، ولا تشغلوها بما سواه»([75]).
ويذكرون:
أن ابن عباس
أتي أيضاً بكتاب فيه قضاء علي
«عليه السلام»،
فمحاه إلا قدر ذراع([76]).
وإن كنا نشك في صحة ذلك، ونرى، أن ابن مسعود هو الذي
فعل ذلك،
وسيأتي في مواضع من هذا الكتاب بعض النماذج للحرب الإعلامية التي كانت
تمارس ضد علي وأهل بيته «عليهم السلام» وشيعته الأبرار رضوان الله
تعالى عليهم.
وهناك
أقوال صحيحة، ومواقف صريحة لرسول الله «صلى الله عليه وآله» تبين
انحراف وزيف كثير من الشخصيات والرموز التي كانت تدعم الحكم الجديد،
وتشد من أزره، وتعمل على بسط سلطته، وترسيخ نفوذه،
بل فيهم بعض من أصبح جزءاً
من تكوينه وهيكليته، ومن ركائزه ودعائمه، الأمر الذي جعل الحكم الجديد
يرى نفسه مسؤولاً عن الحفاظ على سمعة هؤلاء الناس،
ورفعة شأنهم، وبسط نفوذهم، وإظهارهم على أنهم شخصيات على درجة من الفضل
والنبل، ولهم من المواقف المشرفة، ومن الكرامات ما ليس لغيرهم،
بل لا
بد أن يُظهروا للناس ـ ولو عن طريق الاختلاق، والتحريف، والتزوير ـ أن
هؤلاء الناس هم الذين شيَّدوا
أركان الدين، وضحُّوا
وجاهدوا حتى قام عموده، واشتد عوده.
أما أقوال النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» في حقهم،
ومواقفه «صلى الله عليه وآله» تجاههم، فلا ضير في أن تكتم وتنستر، ثم
تتلاشى وتندثر، بل لا بد لها من ذلك، وحيث لا يمكن ذلك، فلا أقل من
التأويل والتبديل، والتحريف والتزييف، أو اختلاق ما يناقض ويعارض. وذلك
هو أضعف الإيمان.
وقد روى أحمد بن حنبل:
أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء؛ فسأله أبو قرة الكندي عن ذلك، فقال:
«إن
حذيفة كان يحدث بأشياء يقولها رسول الله «صلى الله عليه وآله»
ـ
في غضبه([77])
ـ
لأقوام، فأُسأل
عنها، فأقول:
حذيفة أعلم بما يقول،
وأكره أن يكون ضغائن بين أقوام،
فأتى حذيفة، فقيل له: إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول.
فجاءني
حذيفة فقال:
يا سلمان ابن أم سلمان.
قلت:
يا حذيفة ابن أم حذيفة، لتنتهين، أو لأكتبن إلى عمر،
فلما خوفته بعمر تركني الخ..
([78]).
إذن، فقد كان حذيفة يحدث الناس بما كان يوقع سلمان الذي
كان أميراً على المدائن من قبل عمر في حرج شديد فكان لا بد لسلمان من
أن يوقف حذيفة عن الإستمرار في ذلك، فاستفاد من هذه الوسيلة لتحقيق هذا
الهدف.
وبعبارة أخرى:
إن السياسة كانت قد فرضت حظراً
على تناقل بعض ما يتعلق بأحوال الأشخاص.
وقد كان حذيفة بنقله تلك الأمور قد أحرج سلمان، فلما
هدده بالكتابة إلى الخليفة كف عن ذلك،
غير أنه قد وردت في آخر الحديث زيادة نحسب أنها لم ترد على لسان سلمان،
وهي أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال: «أيما مؤمن لعنته لعنة، أو
سببته سبة، في غير كنهه، فاجعلها عليه صلاة»([79]).
فإن ذلك لا شك في كونه من الأكاذيب على رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، وعلى سلمان، فراجع ما ذكرناه في غزوة أحد من هذا
الكتاب، ثم ما سنذكره حول موضوع السب واللعن أيضاً.
هناك فرقتان من اليهود:
إحداهما:
«فقهاء الفريسيين»، وهم يؤمنون بكتابة العلم وتدوينه.
ويكتبون كلام علمائهم وأحبارهم. كما هو الحال بالنسبة
إلى التلمود، الذي له أهمية كبيرة عند معظم اليهود، بل إن أهميته لدى
بعض فرقهم لتزيد على أهمية العهد القديم نفسه([80]).
الثانية:
فرقة يقال لها: «القراء»، وهم الذين كثروا ونشطوا بعد ضعف أمر
الفريسيين،
وهم يقولون بعدم جواز كتابة شيء غير التوراة([81]).
وقد صرح البعض:
بأن فرقة الصدوقيين لا تعترف إلا بالعهد القديم، وترفض الأخذ بالأحاديث
الشفوية المنسوبة إلى موسى
«عليه
السلام»([82]).
بل لقد جاء في التلمود نفسه:
«إن
الأمور التي تروى مشافهة ليس لك الحق في إثباتها بالكتابة»([83]).
وقد علق على ذلك بعض العلماء بقوله:
«من العجيب: أن اليهود كتبوا التلمود والمشناة حتى هذا
النهي. وأهل الحديث من المسلمين كتبوا الأحاديث حتى الحديث المكذوب: لا
تكتبوا عني.. الخ»([84]).
غير أننا نقول:
إن المقصود هو المنع من الروايات الشفوية عن الأنبياء، أما أقـوال
العلـماء
فهي الشريعة، تمامـاً
كما يقول البعض الآن: إن آراء الصحابة شريعة وسنة.
والذي يظهر لنا هو:
أن كعب الأحبار قد كان من الفرقة التي لا تجيز كتابة
غير التوراة.
ويشير إلى ذلك:
أنه حينما سأله الخليفة الثاني عن الشعر، أجابه كعب واصفاً
العرب بقوله:
«أجد
في التوراة قوماً
من ولد إسماعيل، أناجيلهم في صدورهم، ينطقون بالحكمة»([85]).
وقد روى مثل ذلك وهب بن منبه أيضاً ـ الذي كان أيضاً في
الأساس من أهل الكتاب ـ فقد جاء في رواية مطولة له قوله:
«يا
رب، إني أجد في التوراة قوماً
أناجيلهم في صدورهم، يقرؤونها،
وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظراً،
ولا يحفظونها، فاجعلهم أمتي، قال: تلك أمة محمد»([86]).
فلعل كعب الأحبار، وغيره ممن كان مقرباً
من السلطة قد استفاد من حسن الظن به من قبل الصحابة والحكام، فألقى هذا
الأمر إليهم، وهم غافلون، فوافق قبولاً
منهم، بسبب ما كانوا يعانونه من مشكلات ألمحنا إليها آنفاً.
ومما يشير إلى أن السلطة كانت تختزن في وعيها شيئاً من
ذلك هو التعليل الذي جاؤوا به حينما أرادوا إحراق ما جمعوه من أحاديث
كتبها الصحابة عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، حيث ذكروا: أن سبب
إقدامهم على هذا الأمر هو الالتفات إلى أن أمماً كانوا قبلهم كان بينهم
كتاب الله، فلما كتبوا أقوال علمائهم أكبوا عليها، وتركوا كتاب الله
(فراجع ما تقدم).
والملفت للنظر هنا:
أن يتخيل هؤلاء المساواة فيما بين أقوال النبي
«صلى الله عليه وآله»
الذي لا ينطق عن الهوى، وبين أقوال علماء أهل الكتاب الذين كانوا
يخلطون الحق بالباطل عن عمد وإصرار في كثير من الأحيان، إن لم يكن في
أكثرها.
هذا، ولا بد من الإشارة هنا:
إلى أن السياسة التي انتهجت تجاه حديث النبي «صلى الله عليه وآله»، وإن
كانت سبباً
مهماً
لما حاق بالإسلام من بلاء، على صعيد تجهيل الناس به، والتلاعب بالدين،
وتغيير أحكام الشريعة.
ولكن ذلك ليس هو كل شيء في هذا المجال، بل إن ثمة سبباً
آخر كان له دوره وتأثيره في ذلك، وهو: بغض علي
«عليه
السلام»، والإصرار على مخالفته في كل شيء.
قال ابن عباس:
«اللهم
العنهم، قد تركوا السنة من بغض علي»([87]).
قال السندي:
«أي
وهو كان يتقيد بها»([88]).
وقال
النيسابوري حول السبب في تركهم الجهر بالبسملة في الصلاة:
«وأيضاً، ففيه تهمة أخرى، وهي: أن علياً رضي الله عنه كان يبالغ في
الجهر بالتسمية؛ فلما كان زمن بني أمية بالغوا في المنع عن الجهر،
سعياً في إبطال آثار علي»([89]).
ورغم اعتراف الحجاج بأن أمير المؤمنين «عليه السلام»
المرء الذي لا يرغب عن قوله، فإنه يصر على مخالفته، والعمل برأي عثمان!!([90]).
وقد عاش الحسنان «عليهما السلام» في الناس دهراً
طويلاً،
وهما إمامان قاما أو قعدا، لكن ما روي عنهما في أحكام الشريعة قليل جداً
لا يكاد يذكر.
ولا يمكن أن يصغي إلى ما اعتذر به ابن شهر آشوب هنا،
حيث قال:
«وأما
من قل منهم الروايات، مثل الحسن والحسين، فلقلة أيامهما»([91]).
والصحيح هو أن الناس أهملوا أقوالهم، ولم يهتموا بنقل
شيء عنهم، بغضاً
منهم لهم، أو خوفاً
من معاقبة الحكام.
([1])
راجع: تقييد العلم ص114 و110 وراجع سنن الدارمي ج1 ص126 وعن
المحدث الفاضل ج4 ص23 وجامع بيان العلم ج1 ص73. كان حكم بني
مروان بعد حكم آل أبي سفيان، الذي انتهى بمعاوية بن يزيد.
([2])
راجع: نهج البلاغة الحكمة رقم 369 والحكمة رقم 190.
([3])
راجع: المصنف للصنعاني ج2 ص63 ومسند أبي عوانة ج2 ص105 والبحر
الزخار ج2 ص254. وكشف الأستار عن مسند البزار ج1 ص260 ومسند
أحمد ج4 ص428 و432 و441 و444 ومروج الذهب ج3 ص85 والغدير ج8
ص166 ومكاتيب الرسول ج1 ص62.
([4])
الموطأ (المطبوع مع تنوير الحوالك) ج1 ص93 وجامع بيان العلم ج2
ص244.
([5])
شرح الموطأ للزرقاني ج1
ص221 وتنوير الحوالك ج1 ص93 ـ 94 عن الباجي.
([6])
كتاب الأم للشافعي ج1 ص208 والغدير ج8 ص166 عنه.
([7])
جامع بيان العلم ج2 ص244 وراجع المصادر التالية: ضحى الإسلام
ج1 ص365 والجامع الصحيح ج4 ص632 والزهد والرقائق ص31 وفي هامشه
عن طبقات ابن سعد ترجمة أنس، وعن الترمذي، وعن البخاري ج1
ص141.
([8])
جامع بيان العلم ج2 ص244.
([9])
مسند أحمد بن حنبل ج6 ص244.
([10])
الزهد والرقائق ص61.
([11])
البحار ج68 ص91 وقصار الجمل ج1 ص366.
([12])
راجع: أنساب الأشراف ج2 ص180 ط الأعلمي وسنن البيهقي ج2 ص68
وكنز العمال ج8 ص143 عن عبد الرزاق وابن أبي شيبة والمصنف
للصنعاني ج2 ص63 ومسند أبي عوانة ج2 ص105 ومسند أحمد ج4 ص428
و429 و441 و444 و400 و415 و392 في موضعين و432 والغدير ج10
ص202 و203 وكشف الأستار عن مسند البزار ج1 ص260 والبحر الزخار
ج2 ص254. وعن المصادر التالية: صحيح البخاري ج2 ص209 وصحيح
مسلم ج1 ص295 وسنن النسائي ج1 ص164 وسنن أبي داود ج5 ص84 وسنن
ابن ماجة ج1 ص296 وفتح الباري ج2 ص209 والمصنف لابن أبي شيبة
ج1 ص241.
([13])
كشف القناع عن حجية الإجماع ص67.
([14])
الإحكام في أصول الأحكام ج2 ص131.
([15])
حياة الصحابة ج1 ص505 عن كنز العمال ج5 ص114 وعن معاني الآثار
للطحاوي ج1 ص27.
([16])
المصنف للصنعاني ج8 ص26 والسنن الكبرى ج3 ص23.
([17])
راجع: المصنف للصنعاني ج8 ص123 و124 والسنن الكبرى ج5 ص282،
ومجمع الزوائد ج4 ص116.
([18])
المصنف للصنعاني ج8 ص34 والسنن الكبرى ج5 ص282 و277 و276 وعن
صحيح مسلم ج2 ص25 و52.
([19])
سيأتي ذلك مع مصادره في غزوة أحد.
([20])
راجـع: صحيح مسلم ج4 ص181 وراجع ص179 و182 والغدير ج10 ص39
وراجع: مسند أحمد ج2 ص51 و61 و64 و74 و80 و128 و145 وعن صحيح
البخاري ج8 ص76 وعن تاريخ الأمم والملوك ج5 ص34 وعن الكامل في
التاريخ ج3 ص27 وعن الصواعق المحرقة ص62 وعن فتح الباري ج7 ص54
وصححه كل ذلك في الغدير.
([21])
راجع: المصنف للصنعاني ج6 ص273 و274 والسنن الكبرى ج7 ص159.
([22])
راجع: المصنف ج6 ص274 و275.
([23])
صحيح البخاري ج1 ص90 و93 ط سنة 1309 ه. ومسند أحمد ج5 ص109
و112، والسنن الكبرى ج2 ص37 و54 عن الصحيحين، والبحر الزخار ج2
ص247 وجواهر الأخبار والآثار (مطبوع بهامش البحر الزخار) ج2
ص247 عن أبي داود والترمذي، والانتصار، والنسائي، والبخاري.
([24])
راجع: المصنف للصنعاني ج1 ص93 والمغنى لابن قدامة ج1 ص8 والشرح
الكبير بهامشه ج1 ص7 وراجع: تحفة الأحوذي ج1 ص231 ط دار الفكر،
والخلاف ط جماعة المدرسين ج1 ص51 والمحلى ج1 ص221 ونيل الأوطار
ج1 ص20 والجامع لأحكام القرآن ج13 ص53 وعن المصنف لابن أبي
شيبة ج1 ص88.
([25])
راجع: الخلاف ج1 ص51 وتحفة الأحوذي ج1 ص231 ونيل الأوطار ج1
ص20.
([26])
نيل الأوطار ج1 ص20 والمحلى ج1 ص221 وتحفة الأحوذي ج1 ص231.
([27])
الموفقيات ص203 ـ 205 وراجع: جمهرة خطب العرب ج3 ص355.
([28])
الأخبار الموفقيات ص203 ـ 204 ح 119.
([29])
علوم الحديث لابن الصلاح ص367 والباعث الحثيث ص85 والسنة قبل
التدوين عن فتح المغيث ج4 ص39 وعن تلقيح فهوم أهل الآثار.
([30])
إرشاد الفحول ص251.
([31])
مناقب الشافعي ج1 ص419 وعن الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا ص243.
([32])
المقدمة لابن خلدون ص444 وأضواء على السنة المحمدية ص388.
([33])
بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص236.
([34])
راجع: تعجيل المنفعة برجال الأربعة ص6. وبحوث في تاريخ السنة
المشرفة ص37 عنه. والقول المسدد في الذب عن المسند للإمام
أحمد، لابن حجر العسقلاني. وذيل القول المسدد للمدراسي.
([35])
شرف أصحاب الحديث ص115 وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لعبد
الجبار ص193.
([36])
راجع: الباعث الحثيث ص186 و187.
([37])
فضل الاعتزال، وطبقات المعتزلة ص193 و158.
([38])
راجع: سير أعلام النبلاء ج1 ص456 والتاريخ الكبير ج8 ص282
وتهذيب التهذيب ج11 ص230.
([39])
سير أعلام النبلاء ج10 ص455 والعلل ومعرفة الرجال ج1 ص187
وتهذيب التهذيب ج11 ص230 والضعفاء الكبير للعقيلي ج4 ص408
وتذكرة الحفاظ ج1 ص408.
([40])
راجع: مقدمة فتح الباري ص452 وتهذيب التهذيب ج11 ص229.
([41])
المغني للقاضي عبد الجبار ج4 ص228 وص 225 و235 و233.
([42])
الأم للشافعي ج7 ص308.
([43])
راجع: على سبيل المثال التراتيب الإدارية ج2 ص208 والكفاية في
علم الرواية ص431 وراجع: المجروحون ج1 ص156 و185 و155 و142 و96
و63 وص 65 حول وضع الحديث للملوك. وراجع: الباعث الحثيث ص84
وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص32 و33 ولسان الميزان ج3 ص405
وج 5 ص228 والفوائد المجموعة ص426 و427 وأي كتاب يتحدث عن
الموضوعات في الأخبار والآثار مثل اللآلئ المصنوعة للسيوطي،
والأسرار المرفوعة للشوكاني والموضوعات للفتني، وغير ذلك.
([44])
راجع عل سبيل المثال: التراتيب الإدارية ج2 ص202 ـ 208 و407
والكنى والألقاب ج1 ص414 ولسان الميزان ج3 ص405 وتذكرة الحفاظ
ج2 ص641 و430 وج 1 ص254 و276 وهذا الكتاب مملوء بهذه الأرقام
العالية والمخيفة، فليراجعه طالب ذلك.
([45])
راجع: اللآلي المصنوعة ج1 ص286 و315 ـ
316
و417 وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص22 عنه وعن تنزيه الشريعة
ج1 ص372 وج 2 ص4.
([46])
اللآلي المصنوعة ج1 ص428 وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص22
عنه.
([47])
اللآلي المصنوعة ج1 ص323 وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص22 عنه
وعن ابن تيمية في المنتقى من منهاج الاعتدال ص313.
([48])
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ج1 ص121 وراجع:
وفيات الأعيان ج1 ص77 ط بيروت والبداية والنهاية ج11 ص124
ومرآة الجنان ج2 ص241 وتذكرة الحفاظ ج2 ص700 وراجع ص699 وشذرات
الذهب ج2 ص240 وراجع: سير أعلام النبلاء ج14 ص132 وتهذيب
الكمال ج1 ص339 وتهذيب التهذيب ج1 ص38 والمنتظم ج6 ص131.
([49])
بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص24 وتهذيب تاريخ ابن عساكر ج1
ص70.
([50])
الطبقات الكبرى لابن سعد ط صادر ج4 ص267.
([51])
بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص24 وتهذيب تاريخ دمشق ج1 ص70.
([52])
ستأتي إشارة إلى ذلك حين الحديث حول روايات بدء الوحي، وقصة
ورقة بن نوفل.
([53])
بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص25 عن ابن تيمية في المنتقى من
منهاج الاعتدال ص88.
([54])
بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص25 عن الكامل لابن عدي ج1 ص3 ـ
أ.
([55])
بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص93 وراجع تهذيب التهذيب ج1 ص93
وج 5 ص46 وج 10 ص158.
([56])
تهذيب تاريخ دمشق ج1 ص70 ـ 71 وبحوث في تاريخ السنة المشرفة
ص25 عنه.
([57])
المصدران السابقان.
([58])
الكفاية في علم الرواية ص129.
([59])
الكفاية في علم الرواية ص129.
([60])
راجع: فتح الباري (المقدمة) ص460 و461 وبحوث في تاريخ السنة
المشرفة ص28.
([61])
الصحيفة السجادية، دعاء 48. وهو الدعاء الخاص بيوم الجمعة
وعرفة.
([62])
حياة الشعر في الكوفة ص253 وكنز العمال ج1 ص332 وغير ذلك.
([63])
شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص84.
([64])
في فصل: معايير لحفظ الانحراف رقم: 11 ـ رأي الصحابي حيث لا
نص.
([65])
سيأتي ذلك إن شاء الله في فصل: معايير لحفظ الانحراف رقم:
28 ـ
القياس، والرأي والاستحسان.
([66])
كنز العمال ج1 ص335 عن ابن أبي نصر والغدير ج7 ص119 و120 عن
جامع بيان العلم ج2 ص134 ومختصره ص185 وعن أعلام الموقعين ص19.
([67])
وسائل الشيعة ج18 ص40 وتفسير العياشي ج2 ص331.
([68])
راجع: صحيح البخاري ج4 ص172 وج 2 ص4 و9 ومسند أحمد ج4 ص400
وسنن أبي داود ج4 ص346 والتراتيب الإدارية ج2 ص7 و4 و25 وحياة
الصحابة ج2 ص569 والغدير ج6 ص158 عن البخاري، وأبي داود وعن
مسلم ج2 ص234 وعن مسند أحمد ج3 ص19 وعن سنن الدارمي ج2 ص274
وعن مشكل الآثار ج1 ص499. وحول تنكيل عمر بمن لا يأتي على
الحديث ببينة راجع: حياة الصحابة ج3 ص360، عن كنز العمال ج7
ص34 وغيره.
([69])
راجع: الغدير للعلامة الأميني رحمه الله تجد تفصيل هذه النصوص،
وطائفة كبيرة من مصادرها.
([70])
شرح النهج للمعتزلي ج12 ص83.
([71])
شرح النهج للمعتزلي ج1 ص28.
([72])
حياة الصحابة ج1 ص455 عن مسند أحمد ج1 ص65 وراجع ص61.
([74])
الآية 3 من سورة يوسف.
([75])
تقييد العلم ص54 والسنة قبل التدوين ص312 وراجع: غريب الحديث
لابن سلام ج4 ص48. وليس فيه: أن الأحاديث في أهل البيت.
([77])
هذه الكلمة لا يمكن أن يقولها سلمان الذي هو من أعرف الناس
بأمر عصمة الرسول في جميع حالاته، بل هي من إقحامات محبي أولئك
المنحرفين الذين لا مانع عندهم من انتقاص شخص الرسول، شرط أن
لا يمس أحداً من أحبائهم.
([78])
مسند أحمد ج5 ص439.
([79])
مسند أحمد ج5 ص439.
([80])
راجع: اليهودية واليهود ص23.
([81])
راجع: التفكير الديني عند اليهود، لمحمد حسن ظاظا وراجع:
مقارنة الأديان (اليهودية) ص227.
([82])
اليهودية واليهود ص86 ومقارنة الأديان (اليهودية) ص226.
([83])
الفكر الديني الإسرائيلي
للدكتور ظاظا ص79 عن التلمود: حيطين 60 ب ـ تمور.
([84])
بحوث مع أهل السنة والسلفية هامش ص97.
([85])
راجع: العمدة لابن رشيق ج1 ص25 وقد صرح بذلك كعب في حديث آخر
في الدر المنثور ج3 ص125 ثم روى ذلك أبو هريرة وقتادة عن النبي
«صلى الله عليه وآله» فراجع الدر المنثور ج3 ص124 و123 و122،
وقد استدل البعض بهذا الحديث على حفظ القرآن عن ظهر قلب، فراجع
مناهل العرفان ج1 ص235 والنشر في القراءات العشر ج1 ص6، وفي
ربيع الأبرار ج2 ص150 ذكر هذا الحديث عن التوراة على لسان راهب
آخر فراجع.
([86])
راجع: البداية والنهاية ج6 ص62 ونزهة المجالس ج2 ص199.
([87])
سنن النسائي ج5 ص253 وسنن البيهقي ج5 ص113 والغدير ج10 ص205
عنهما وعن كنز العمال عن ابن جرير نص آخر.
([88])
تعليقة السندي على سنن النسائي ج5 هامش ص253.
([89])
تفسير النيسابوري (مطبوع بهامش جامع البيان للطبري) ج1 ص79.
([90])
مروج الذهب ج3 ص85 والكامل في الأدب ج1 ص207 و مكاتيب الرسول
ج1 ص62.
([91])
مناقب آل أبي طالب ج1 ص274.
|