|
إلـــى قــبــــــاء
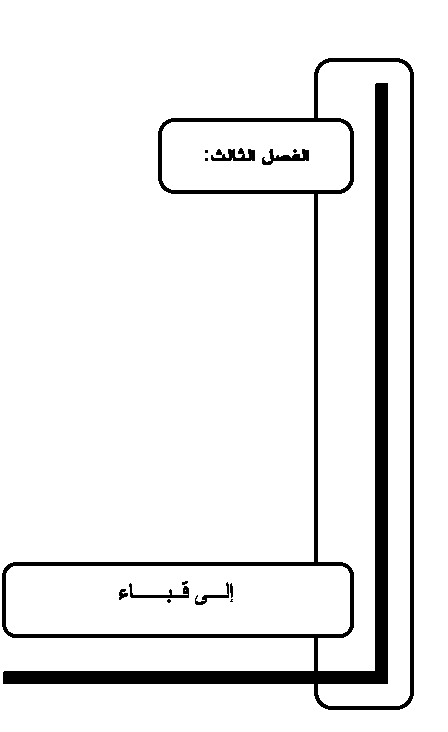
في الطريق إلى المدينة:
عن أبي عبد الله «عليه السلام»:
إن رسول الله «صلى
الله عليه وآله»
لما خرج من الغار متوجهاً
إلى المدينة، وقد كانت قريش جعلت لمن أخذه مئة من الإبل،
خرج سراقة بن جشعم فيمن يطلب، فلحق رسول الله، فقال
«صلى
الله عليه وآله»:
اللهم اكفني سراقة بما شئت،
فساخت قوائم فرسه، فثنى رجله ثم اشتد، فقال: يا محمد إني علمت أن الذي
أصاب قوائم فرسي إنما هو من قبلك، فادع الله
أن
يطلق الي فرسي، فلعمري، إن لم يصبكم خير مني لم يصبكم مني شر.
فدعا رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»:
فأطلق
الله عز وجل فرسه، فعاد في طلب رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»،
حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فلما أطلقت قوائم فرسه في الثالثة، قال: يا
محمد، هذه إبلي بين يديك فيها غلامي، فإن احتجت إلى ظهر أو لبن
فخذ منه، وهذا سهم من كنانتي علامة، وأنا
أرجع
فأرد عنك الطلب.
فقال:
لا حاجة لي فيما عندك.
ولعل رفض النبي
«صلى
الله عليه وآله»
ما عرضه عليه سراقة قد كان من منطلق: أنه لا يريد أن يكون لمشرك يد
عنده.
وقد تقدمت بعض النصوص الدالة على ذلك في فصل أبو طالب
مؤمن قريش، وسيأتي في هذا الكتاب بعض من ذلك أيضاً.
وسار
«صلى
الله عليه وآله»
حتى بلغ خيمة أم معبد، فنزل بها، وطلبوا عندها قرى، فقالت: ما يحضرني
شيء،
فنظر رسول الله «صلى
الله عليه وآله»
إلى شاة في ناحية قد تخلفت من الغنم لضرها، فقال: أتأذنين في حلبها؟
قالت:
نعم، ولا خير فيها.
فمسح يده على ظهرها، فصارت من أسمن ما يكون من الغنم،
ثم مسح يده على ضرعها، فأرخت ضرعاً
عجيباً،
ودرت لبناً
كثيراً، فطلب «صلى
الله عليه وآله»
العس، وحلب لهم فشربوا جميعاً حتى رووا.
ثم عرضت عليه أم معبد ولدها الذي كان كقطعة لحم، لا
يتكلم، ولا يقوم، فأخذ تمرة فمضغها، وجعلها في فيه، فنهض في الحال،
ومشى، وتكلم، وجعل نواها في الأرض فصار نخلة في الحال، وقد تهدل الرطب
منها، وأشار إلى جوانبها فصار مراعي.
ورحل
«صلى
الله عليه وآله»
فلما توفي «صلى
الله عليه وآله»
لم ترطب تلك النخلة، فلما قتل علي «عليه
السلام»
لم تخضر، فلما قتل الحسين «عليه
السلام»
سال منها الدم([1]).
فلما عاد أبو معبد، ورأى ذلك سأل زوجته عن سببه قالت:
مر بي رجل من قريش ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة
(أو نخلة) ولم تزر به صحلة (أو صقلة) وسيم في عينيه دعج، وفي
أشفاره
عطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن،
إن
صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أكمل الناس وأبهاهم من
بعيد، وأحسنه وأعلاه من قريب، حلو المنطق فصل، لا نزر ولا هذر، كأن
منطقه خرزات نظمن يتحدرن، ربعة لا تشنؤه من طول، ولا تقتحمه العين من
قصر غصن بين غصنين وهو أنضر الثلاثة منظراً،
وأحسنهم قدراً.
إلى أن قالت:
محفود محشود
لا عابس ولا مفند. (ووصف أم معبد له «صلى
الله عليه وآله»
معروف ومشهور).
فعرف أبو معبد أنه النبي
«صلى
الله عليه وآله»،
ثم قصد بعد ذلك رسول الله «صلى
الله عليه وآله»
إلى المدينة، فآمن هو وأهله([2]).
وليس ذلك كله بكثير على النبي الأعظم
«صلى
الله عليه وآله»
وكراماته الظاهرة، ومعجزاته الباهرة، فهو أشرف الخلق وأكرمهم على الله
من الأولين والآخرين إلى يوم الدين.
ومن الجهة الثانية:
فإن حصول هذه
الكرامات بعد مصاعب الهجرة مباشرة إنما يؤكد ما أشرنا إليه سابقاً:
من أنه قد كان من الممكن أن تتم الهجرة بتدخل من
العناية الإلهية، ولكن الله تعالى أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها
وليكون هذا الرسول
«صلى
الله عليه وآله»
هو
الاسوة الحسنة، والقدوة لكل أحد، في مواجهة مشاكل الحياة، وتحمل أعباء
الدعوة إلى الله بكل ما فيها من متاعب، ومصاعب وأزمات، فإن للأزمات
التي يمر بها الإنسان دوراً رئيساً في صنع خصائصه، وبلورتها، وتعريفه
بنقاط الضعف التي يعاني منها وهي تبعث فيه حيوية ونشاطاً، وتجعله جدياً
في مواقفه، فإنه إذا كان هدف الله سبحانه هو إعمار هذا الكون بالإنسان،
فإن الإنسان الخامل الذي يعتمد على الخوارق والمعجزات لا يمكنه أن يقوم
بمهمة الإعمار هذه.
إن ذلك لمما يساعد على تربية الإنسان وتكامله في عملية
إعداده ليكون عنصراً
فاعلاً
وبانياً
ومؤثراً، لا منفعلاً
ومتاثراً وحسب،
إلى غير ذلك مما يمكن استفادته من الأحداث الآنفة الذكر.
واستمر رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»
في هجرته المباركة حتى قرب من المدينة، فنزل بادئ ذي بدء في قباء في
بيت عمرو بن عوف، فأراده أبو بكر على دخول المدينة، وألاصه فأبى،
وقال: ما أنا بداخلها حتى يقدم ابن أمي وأخي، وابنتي،
يعني علياً وفاطمة «عليهما
السلام»([3]).
فلما أمسى فارقه أبو بكر، ودخل المدينة، ونزل على بعض
الأنصار، وبقي رسول الله بقباء، نازلاً
على كلثوم بن الهدم([4]).
ثم كتب رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»
إلى أخيه علي «عليه
السلام»
كتاباً
يأمره بالمسير إليه وقلة التلوم، وأرسل الكتاب مع أبي واقد الليثي.
فلما أتاه كتاب النبي «صلى
الله عليه وآله» تهيأ للخروج والهجرة، فأعلم من كان معه من
ضعفاء المؤمنين، وأمرهم أن يتسللوا، ويتخفوا تحت جنح الليل إلى ذي طوى،
وخرج «عليه السلام» بفاطمة بنت الرسول، وأمه فاطمة بنت
أسد بن هاشم، وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب، وتبعهم أيمن ابن أم
أيمن مولى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأبو واقد،
فجعل يسوق بالرواحل فأعنف بهم، فأمره «عليه السلام»
بالرفق فاعتذر بخوفه من الطلب.
فقال أمير المؤمنين «عليه السلام»:
إربع
عليك، فإن رسول الله «صلى
الله عليه وآله»
قال لي: (أي حين سفره من الغار كما تقدم) يا علي أما إنهم لن يصلوا من
الآن
إليك
بأمر
تكرهه.
وأدركه الطلب قرب ضجنان، وهم سبع فوارس متلثمون،
وثامنهم مولى للحارث بن أمية، يدعى جناحاً.
فأنزل
علي «عليه
السلام»
النسوة، وأقبل على القوم منتضياً
السيف، فأمروه بالرجوع، فقال: فإن لم أفعل؟
قالوا:
لترجعن راغماً، أو لنرجعن بأكثرك شعراً، وأهون بك من
هالك.
ودنا الفوارس من المطايا ليثوروها، فحال علي
«عليه
السلام»
بينهم وبينها فاهوى جناح بسيفه، فراغ علي
«عليه
السلام»
عن ضربته، وتختله علي «عليه
السلام»
فضربه على عاتقه، فأسرع السيف مضياً
فيه، حتى مس كاثبة فرسه، وشد عليهم بسيفه، وهو يقول:
خـلــوا سبيل الـجاهـد
المجـاهــد آلـيـت لا أعـبـد غـيـر الـواحــد
فتصدع القوم عنه وقالوا:
أغن عنا نفسك يا ابن أبي طالب.
قال:
فإني منطلق
إلى ابن عمي رسول الله بيثرب، فمن سره أن أفري
لحمه، وأهريق دمه، فليتبعني، أو فليدن مني،
ثم أقبل على صاحبيه، فقال لهما: أطلقا مطاياكما.
ثم سار ظاهراً حتى نزل بضجنان، فتلوم بها قدر يومه
وليلته، ولحق به نفر من المستضعفين من المؤمنين، وفيهم أم أيمن مولاة
الرسول «صلى
الله عليه وآله»
فعبدوا الله تلك الليلة قياماً
وقعوداً
وعلى جنوبهم حتى طلع الفجر، فصلى بهم علي
«عليه
السلام»
صلاة الفجر ثم سار بهم، فجعلوا يصنعون ذلك في كل منزل، حتى قدم
المدينة، وقد نزل الوحي بما كان من شأنهم
قبل قدومهم.
﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ
قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَآ مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً..﴾.
إلى قوله:
﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ
عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أنثَى..﴾([5]).
ولما بلغ النبي
«صلى
الله عليه وآله»
قدومه «عليه
السلام»،
قال: ادعوا
لي علياً.
قيل:
يا رسول الله،
لا يقدر أن يمشي.
فأتاه
«صلى
الله عليه وآله»
بنفسه، فلما رآه اعتنقه، وبكى رحمة لما بقدميه من الورم، وكانتا تقطران
دماً.
وقال «صلى الله عليه وآله» لعلي
«عليه السلام»:
يا علي، أنت
أول هذه الأمة إيماناً بالله ورسوله، وأولهم هجرة إلى الله ورسوله،
وآخرهم عهداً
برسوله،
لا يحبك والذي نفسي بيده إلا مؤمن قد امتحن قلبه للإيمان
ولا يبغضك إلا منافق أو كافر([6]).
إذن،
فالهجرة العلنية، والتهديد بالقتل لمن يعترض سبيل المهاجر قد كانا من
علي «عليه
السلام»،
وليس من عمر بن الخطاب، وقد تقدم في فصل ابتداء الهجرة إلى المدينة بعض
ما يدل على عدم صحة نسبة ذلك إلى عمر، وإنما نسبوا ما كان من أمير
المؤمنين «عليه
السلام»
إلى غيره، شأن الكثير من فضائله ومواقفه
«عليه
السلام».
وبعد.. فإن من الأمور الجديرة
بالملاحظة هنا:
أننا نجد أمير المؤمنين علياً وكذلك أبناءه من بعده
«عليهم
السلام»
يحاولون تفويت الفرصة على مزوري التاريخ من
أعداء
الدين والحق والإيمان، فقد روى عبد الواحد بن أبي عون:
أن رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»
حينما
توفي أمر علي «عليه
السلام»
صائحاً
يصيح: «من
كان له عند رسول الله عدة أو دين فليأتني».
فكان يبعث كل عام عند العقبة يوم النحر من يصيح بذلك،
حتى توفي علي، ثم كان الحسن بن علي يفعل ذلك حتى توفي، ثم كان الحسين
يفعل ذلك، وانقطع ذلك بعده، رضوان الله تعالى عليهم وسلامه.
قال ابن عون:
فلا يأتي أحد
من خلق الله إلى علي بحق ولا باطل إلا أعطاه([7]).
ويذكر البعض:
أن تبعاً
الأول قد آمن بالنبي «صلى
الله عليه وآله»
قبل ولادته «صلى
الله عليه وآله»
بمئات السنين في قصة طويلة، نرغب عن ذكرها،
لأننا
لم نتأكد
من صحتها،
فمن أراد التحقيق حولها، فليراجعها في مصادرها([8]).
قد جاء في بعض المرويات:
أن النبي
«صلى
الله عليه وآله»
أقبل إلى المدينة وكان أبو بكر رديف النبي
«صلى
الله عليه وآله»،
وأبو بكر شيخ يُعرَف، والنبي «صلى
الله عليه وآله»
شاب لا يُعرَف، فيلقى الرجل أبا بكر، فيقول: يا أبا بكر من هذا الذي
بين يديك؟
وفي لفظ أحمد:
من هذا الغلام بين يديك، فيقول: يهديني السبيل، فيحسب
الحاسب أنه يهديه الطريق وإنما يعني سبيل الخير.
وفي التمهيد:
أن الرسول
«صلى
الله عليه وآله»
كان رديف أبي بكر، فكان إذا قيل لأبي بكر: من هذا وراءك؟ الخ.
وصرح القسطلاني:
بأن ذلك كان حين الانتقال من بني عمرو بن عوف، أي من
قباء إلى المدينة.
وفي نص آخر:
أنه
لما قدم «صلى
الله عليه وآله»
المدينة تلقاه المسلمون؛ فقام أبو بكر للناس، وجلس النبي
«صلى
الله عليه وآله»
وأبو بكر شيخ، والنبي «صلى
الله عليه وآله»
شاب،
فكان
من لم ير النبي يجيء أبا بكر زاعماً
أنه هو، فيعرفه النبي «صلى
الله عليه وآله»
حتى أصابت الشمس رسول الله، فجاء أبو بكر فظلل عليه بردائه، فعرفه
الناس حينئذٍ([9]).
ولكن ذلك لا يمكن أن يصح وذلك
للتالي:
أولاً:
إن كون أبي
بكر يُعرَف، والنبي لا يُعرَف، لا يمكن قبوله، فإن النبي
«صلى
الله عليه وآله»
كان يعرض دعوته على مختلف القبائل التي كانت تقدم مكة، طيلة سنوات
عديدة وقد سار ذكره في الآفاق، وبايعه من أهل المدينة أكثر من ثمانين
ورآه حوالي خمسمئة من أهل المدينة قدموا مكة، قبل ثلاثة أشهر فقط كما
تقدم.
فكيف يكون أبو بكر يعرف، والنبي
«صلى الله عليه وآله» لا يعرف؟!([10]).
ومن جهة أخرى:
فلم يكن أحد
يهتم بسفر أبي بكر أو يحس به ولا يجد أي من الناس دافعاً
للتعرف عليه.
هذا كله، عدا عن أن أبا بكر قد فارق الرسول
«صلى
الله عليه وآله»
حينما وصلا إلى قباء، ولم يبق معه إلى حين دخول المدينة.
وأما ما ذكر أخيراً:
من أن من لم
ير النبي «صلى
الله عليه وآله»
كان يجيء أبا بكر زاعماً
أنه هو فهو ينافي قولهم: إن النبي «صلى
الله عليه وآله»
كان شاباً
لا يعرف وأبو بكر شيخ يعرف.
ثانياً:
لقد كان الناس
من أهل المدينة ينتظرون قدومه «صلى
الله عليه وآله»
بفارغ الصبر، وقد استقبله منهم حين قدومه حوالي خمسمئة راكب([11])
بظهر الحرة وكان النساء والصبيان والشبان وغيرهم يهزجون ـ كما قيل ـ
:
طلـع البــدر عـلـيـنـــا
مـــن ثـنـيـات الــــوداع
وجب الشـكر عـلـيـنــا مـــــــا دعـــــــا لله داع
أيهـا المبـعـوث فـيــنـــا جئـت بـالأمـر الـمطــاع
وكان قد مكث في قباء أياماً
يستقبل الناس؛ فهل يمكن أن يكون متنكراً
حين قدومه من قباء إلى المدينة، كما يقول القسطلاني؟!([12]).
أو هل يمكن أن يكون قد دخل المدينة ولم يكن معه أحد من
أهل قباء، ولا من أهل المدينة وأين كان عنه علي حينئذٍ؟!
وألم يكن أهل المدينة قد أتوا زرافات ووحداناً إلى قباء
ليتشرفوا برؤيته؟! ولماذا لم يدل العارفون به أولئك الذين يشتبهون في
أمره عليه؟!
ثالثاً:
لقد كان رسول الله «صلى
الله عليه وآله»
يكبر أبا بكر بسنتين وعدة أشهر؛ لأنه «صلى
الله عليه وآله»
ولد عام الفيل، وأبو بكر استكمل بخلافته سن رسول لله
«صلى
الله عليه وآله»،
حيث توفي ـ كما يدعون ـ بسن النبي «صلى
الله عليه وآله»
عن ثلاث وستين سنة([13]).
إذاً فكيف يصح قولهم:
إنه شيخ والنبي «صلى
الله عليه وآله»
شاب؟
ومما
ذكرناه نعرف:
عدم صحة ما روي عن يزيد بن الأصم ـ المتوفى بعد
المئة عن 73 سنة ـ من أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال
لأبي بكر: أنا أكبر أو أنت؟
قال:
لا، بل أنت
أكبر مني وأكرم، وخير مني، وأنا أسن منك([14]).
وأما
الاعتذار عن ذلك:
بأن الشيب كان في وجه أبي بكر ولحيته كثيراً بخلافه
«صلى
الله عليه وآله»([15])
ـ أو أن أبا بكر كان تاجراً، يعرفه الناس في المدينة عند اختلافه إلى
الشام ـ فلا يصح؛ لأن الشيب وعدمه لا يخفي الشيخوخة والشباب، حتى لقد
ورد التعبير في بعض تلك المرويات بـ
«ما
هذا الغلام بين يديك»؟
فما معنى التعبير بالغلام عن رجل يزيد عمره على خمسين
سنة؟
إلا أن يقال:
الغلام يطلق على الشيخ والشاب فهو من الأضداد.
وأيضاً:
فقد روي عن ابن عباس بسند صحيح: أن أبا بكر قال
للنبي «صلى الله عليه وآله»: يا رسول الله قد شبت؟ قال:
شيبتني هود والواقعة والخ..
وروى الحفاظ مثله عن ابن مسعود، وعن
أبي جحيفة، قالوا:
يا رسول الله،
نراك قد شبت، قال: شيبتني هود وأخواتها([16]).
وإذا كانت السور المذكورة مكية كما هو معلوم،
فيستفاد من ذلك:
أن الشيب قد بان فيه «صلى
الله عليه وآله»
في مكة على خلاف الطبيعة، وأسرع فيه، حتى صار الناس يسألونه عنه، وعما
أثره([17])
ولم يكن مجرد شعرات قليلة لا تلفت النظر، ولا يلتفت إليها.
وأما أن أبا بكر كان تاجراً
يختلف إلى الشام، فقد تقدم: أنه كان في الجاهلية معلماً
للأولاد، وبعد ذلك صار خياطاً،
وكما كان أبو بكر يختلف إلى الشام، فقد كان رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»
أيضاً يختلف إلى الشام، وكان التعرف عليه أدعى وأولى، بملاحظة ما كان
له من الشرف والسؤدد في قريش والعرب، وكان له في أهل المدينة قرابة
أيضاً.
هذا، عدا عما أسلفناه من أن رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»
كان يعرض دعوته على القبائل التي تقدم مكة لعدة سنوات.
وأيضاً:
فإن صفات
النبي «صلى
الله عليه وآله»
كانت تدل عليه، وقد وصفته أم معبد لزوجها فعرفه.
أما أبو بكر، فقد تقدمت صفته عن عائشة وغيرها في بعض
الفصول.
وأخيراً:
فإن ركوب
النبي «صلى
الله عليه وآله»
وأبي بكر على ناقة واحدة لم نجد له ما يبرره، بعد أن كان لدى كل منهما
ناقة تخصه كما تقدم.
ويرى الأميني «قدس سره»:
أن قضية: أنت
أكبر مني وأنا أسن منك تنقل عن النبي «صلى
الله عليه وآله»
مع سعيد بن يربوع المخزومي، الذي توفي سنة أربع وخمسين عن مئة وعشرين
سنة.
ويرى أيضاً:
أن حجة أبي
بكر يوم السقيفة على مخالفيه قد كانت كبر سنه، فحاول محبوه تأييد هذه
الدعوى بما ذكرنا من كونه أسن من النبي «صلى
الله عليه وآله»
والنبي أكبر منه، وأن النبي «صلى
الله عليه وآله»
كان شاباً،
بل غلاماً،
لا يعرف!! وأبو بكر كان شيخاً يعرف!!([18]).
وقبل أن نبدأ الحديث عما بعد الهجرة نرى أن من المناسب
الإشارة إلى أمر يرتبط بالحياة المكية،
والحكم على بعض الظواهر فيها، مع ارتباط له وثيق أيضاً بالحياة في
المدينة بعد الهجرة، وهو موضوع:
هل كان يوجد فيمن أسلم قبل الهجرة من المكيين منافقون
يبطنون خلاف ما يظهرون أم لم يكن؟!
وهل كانت أجواء مكة صالحة لظهور أشخاص من هذا القبيل
يعتنقون الإسلام ويبطنون الكفر، أم لا؟!.
يقول العلامة الطباطبائي «رحمه الله» ما
مفاده:
إنه ربما يقول البعض:
لا، لم يكن في مكة منافقون، إذ لم يكن للنبي
«صلى
الله عليه وآله»
ولا للمسلمين قوة ولا نفوذ، يجعل الناس يهابونهم، ويتقونهم، أو يرجون
منهم نفعاً مادياً، أو معنوياً من نوع ما، فلماذا إذاً يتقربون لهم
ويتزلفون؟
ولماذا يظهرون لهم الإسلام، مع انطوائهم على خلافه؟.
بل كان المسلمون في مكة ضعفاء مضطهدين، معذبين؛
فالمناسب أن يتقي المتقي ـ رغباً
أو رهباً
ـ من صناديد قريش وعظمائها، لا منهم.
وأما في المدينة فقد قوي أمر النبي
«صلى
الله عليه وآله»
وظهر أمر المسلمين، وأصبحوا قوة يمكنها الدفع والمنع، وكان له
«صلى
الله عليه وآله»
في كل بيت أتباع وأنصار يطيعون أوامره، ويفدونه بكل غال ونفيس،
والقلة القليلة الباقية لم يكن يسعهم الإعلان بالخلاف؛ فداروا أمرهم
بإظهار الإسلام، وإبطان الكفر ـ على أن يكيدوا ويمكروا بالمسلمين، كلما
سنحت لهم الفرصة لذلك.
هكذا استدل البعض لإثبات عدم وجود منافقين بين المسلمين
الأولين.
ولكنه كما ترى كلام لا يصح.
وذلك لأن النفاق في مكة كانت له أسبابه، ومبرراته،
ومناخاته، ونذكر هنا ما يلي:
أولاً:
إن أسباب
النفاق لا تنحصر فيما ذكر، من الرغبة والرهبة لذي الشوكة ومنه، إذ أننا
كثيراً ما نجد في المجتمعات فئات من الناس مستعدة لقبول أية دعوة، إذا
كانت ذات شعارات طيبة، تنسجم مع أحلامهم وآمالهم، وتعدهم بتحقيق
رغائبهم، وما تصبو إليه نفوسهم،
فيناصرونها، رغم أنهم في ظل أعتى القوى وأشدها طغياناً،
وهم في غاية الضعف والوهن يعرضون أنفسهم لكثير من الأخطار، ويحملون
المشاق والمصاعب من أجلها وفي سبيلها.
كل ذلك رجاء أن يوفقوا يوماً ما لتحقيق أهدافهم،
والوصول إلى مآربهم، التي يحلمون بها، كالعلو في الأرض، والحصول على
الثروات، والجاه العريض، وغير ذلك.
إنهم يقدمون على كل هذا، مع أنهم ربما كانوا لا يؤمنون
بتلك الدعوة إلا بمقدار إيمانهم بضرورة الحصول على تلك المآرب والأهداف
الآنفة الذكر.
ومن الواضح:
أن المنافق
الطامع الذي من هذا القبيل يكون ـ فيما لو نجحت الدعوة ـ أشد خطراً
على تلك الدعوة من أعتى أعدائها؛ لأنه إذا وجد أن الدعوة لا تستطيع أن
تمنحه كل ما يريد ـ ولو لاقتضاء المصلحة لذلك ـ فإنه سوف يمكر ويغدر([19])،
كما أنه يكون هو الأقدر على الانحراف بهذه الدعوة، وإخراجها عن نهجها
القويم، وصراطها المستقيم إلى المتاهات التي يستطيع في ظلماتها وبهمها
أن يحصل على ما يريد دون رادع أو وازع، وهو الذي يملك كل المبررات لذلك
مهما كانت سقيمة وتافهة.
وأما إذا فشلت الدعوة:
وكان قد أحكم أمره؛ فإنه يستطيع أن يقول لمن هم على
شاكلته: إنا كنا معكم؛ إنما نحن مستهزئون.
فإنه إذا كان النفاق في المدينة قد كان في أكثره لدوافع
أمنية، أو للحفاظ على المصالح والعلاقات المعينة، فإن النفاق المكي
لسوف يكون أعظم خطراً،
وأشد محنة وبلاء على الإسلام والمسلمين، حسبما أوضحنا آنفاً.
وعلى هذا، فإن من القريب جداً.. أن يكون بعض من اتبع
النبي «صلى
الله عليه وآله»
في مكة لم يكن مخلصاً
للدعوة، وإنما كان مخلصاً
لنفسه فقط،
لا
سيما إذا لاحظنا: أن دعوة الرسول قد كانت مقترنة من أول يوم بدئها
بالوعود القاطعة بأن حامليها لسوف يكونون ملوك الأرض، ولسوف يملكون
كنوز كسرى وقيصر([20])،
فقد سأل عفيف الكندي العباس بن عبد المطلب عما يراه من صلاة النبي
«صلى
الله عليه وآله»
وعلي وخديجة «عليهما
السلام»،
فقال له العباس:
هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، زعم أن الله
أرسله، وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح على يديه،
فكان عفيف يتحسر على أن لم يكن أسلم يومئذ، ليكون ثانياً لعلي
«عليه
السلام»
في الإسلام([21]).
وحينما سأله عمه أبو طالب عن سبب شكوى قومه منه، قال
«صلى
الله عليه وآله»:
إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها، تدين لهم بها العرب، وتؤدي إليهم
بها العجم الجزية([22]).
وينقل عنه
«صلى
الله عليه وآله»
أنه قال لبكر بن وائل، حينما كان يعرض دينه على القبائل: فتجعلون لله
عليكم إن هو أبقاكم حتى تنزلوا منازلهم، وتستنكحوا نساءهم، وتستعبدوا
أبناءهم الخ..
وقال قريباً
من هذا لشيبان
بن ثعلبة، ومثل ذلك قال أيضاً حينما أنذر عشيرته الأقربين([23]).
بل إن مما يوضح ذلك بشكل قاطع، ما قاله أحد بني عامر بن
صعصعة لما جاء رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»
يعرض عليهم قبول دعوته: «والله
لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب»،
وقد تقدم بعض المصادر لذلك.
ثم إنه إذا كان هذا النفاق يهدف إلى استخدام الدعوة
لأهداف شخصية، فهو بالتالي مضطر إلى الحفاظ على هذه الدعوة بمقدار
اضطراره إلى الحفاظ على مصالحه وأهدافه تلك، ما دام يرى أو يأمل منها
أن تتمكن من تحقيق ما يتمناه، وتوصله إلى أهدافه التي يرجوها.
وهكذا يتضح:
أنه ليس من
الضروري أن يكون المنافق مهتماً
بالكيد للدعوة التي لا يؤمن بها، والعمل على تحطيمها وإفسادها، بل ربما
يكون حريصاً
عليها كل الحرص، يفديها بالمال والجاه ـ لا بالنفس ـ إذا كان يأمل أن
يحصل على ما هو أعلى وأغلى فيما بعد، ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة في بعض
مسلمي مكة، الذين كانوا يواكبون الدعوة ويعاونونها ما دام لم تصل
النوبة إلى التضحية بالنفس والموت، فإذا كان ذلك فإنهم يفرون، وينهزمون،
ويتركون النبي وشأنه، وقد رأينا ذلك في كثير من المواقف.
نعم،
ربما يتمكن الدين تدريجياً
من نفوس بعضهم، وتحصل لهم قناعة تدريجية به، ولسوف نشير إلى ذلك فيما
يأتي إن شاء الله تعالى، ولربما حين الكلام على غزوة أحد.
وخلاصة الأمر:
أن الميزان
لدى البعض هو أهدافه هو؛ فما دامت الدعوة في خدمتها فهو معها، وأما إذا
وجد أنها سوف تكون عقبة في طريقها، وتشكل خطراً عليها فإنه لا يألو
جهداً
ولا يدع وسيلة في الكيد لها، والعمل على هدمها وتحطيمها.
ثانياً:
ما أشار إليه
العلامة الطباطبائي «رحمه
الله»
أيضاً: أنه لا مانع من أن يسلم أحدهم في أول البعثة، ثم يعرض له ما
يزلزل إيمانه، ويرتاب، ويرتد عن دينه، ولكنه يكتم ذلك، حفاظاً
على بعض المصالح الهامة بنظره كالخوف من شماتة أعدائه، أو حفاظاً على
بعض علاقاته القبلية، أو التجارية، أو للعصبية والحمية، وغيرها مما
يربطه بالمسلمين أو ببعضهم، أو للحفاظ على جاه من نوع معين، أو أي شيء
آخر بالنسبة إليه([24]).
ولربما يشهد لذلك:
أننا قد رأينا
البعض يعترف أنه كان كثيراً ما يشك في هذا الأمر، حتى اعترف في
الحديبية أنه ارتاب ارتياباً لم يرتبه منذ أسلم([25])
وفي غزوة أحد، حينما سمعوا
أنه
«صلى
الله عليه وآله»
قد قتل فروا من المعركة، وقال بعضهم: «نلقي
إليهم بأيدينا، فإنهم قومنا وبنو عمنا»([26]).
ثالثاً:
وقد أشار
العلامة الطباطبائي أيضاً إلى بعض الآيات الدالة على وجود النفاق في
مكة، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَلِيَقُولَ
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ
اللهُ بِهَذَا مَثَلاً﴾([27])
حيث قد وردت هذه الآية في سورة المدثر وهي مكية، وكذا قوله تعالى:
﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا
بِالله فَإِذَا أُوذِيَ فِي الله جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ
اللَّهِ وَلَئِن جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا
مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ
الْعَالَمِينَ﴾([28]).
فإن سورة العنكبوت مكية أيضاً، والآية مشتملة على حديث الإيذاء والفتنة
في الله، وذلك إنما كان في مكة لا في المدينة، وقوله تعالى:
﴿وَلَئِن جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ﴾
لا يدل على نزول الآية في المدينة لأن النصر له مصاديق ومراتب كثيرة.
وأضيف هنا:
أن الله تعالى إنما يحكي حالة المنافقين المستقبلية
بشكل عام.
ثم قال العلامة الطباطبائي:
احتمال أن يكون المراد بالفتنة ما وقع بمكة بعد الهجرة، غير ضائر؛ فإن
هؤلاء المفتونين بمكة بعد الهجرة إنما كانوا من الذين آمنوا بالنبي
«صلى
الله عليه وآله»
قبل الهجرة، وإن أوذوا بعدها([29]).
هذا، ويلاحظ العلامة الطباطبائي
أخيراً:
أننا لم نزل نسمع ذكراً
للمنافقين إلى حين وفاة الرسول الأعظم «صلى
الله عليه وآله»
وقد تخلف عنه «صلى
الله عليه وآله»
في تبوك أكثر من ثمانين منهم، وانخذل ابن أبي في أحد في ثلاثمائة، ثم
انقطعت أخبارهم عنا مباشرة، ولم نعد نسمع عن دسائسهم، ومكرهم، ومكائدهم
للإسلام وللمسلمين شيئاً، فهل انقلبوا بأجمعهم ـ بمجرد وفاته
«صلى
الله عليه وآله»
ـ عدولاً
أتقياء وأبراراً
أوفياء؟!
وإذا كان كذلك، فهل كان وجود النبي
«صلى
الله عليه وآله»
فيما بينهم مانعاً
لهم من الإيمان، وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين؟! نعوذ بالله من
التفوه بالعظائم، وبما يسخط الرب، أم أنهم ماتوا بأجمعهم،
وهم يعدون بالمئات بمجرد موته «صلى
الله عليه وآله»؟
وكيف لم ينقل لنا التاريخ ذلك؟!
أم أنهم وجدوا في الحكم الجديد ما يوافق هوى نفوسهم،
ويتلاءم مع أهوائهم، ومصالحهم؟! أم ماذا؟! ما هي الحقيقة؟!
لست أدري! ولعل الذكي يدري.
([1])
تاريخ الخميس ج1 ص335 عن ربيع الأبرار.
([2])
راجع: تاريخ الخميس ج1 ص334 والبحار ج19 ص41 و 42 ودلائل
النبوة للبيهقي (ط دار الكتب العلمية) ج1 ص279 والسيرة الحلبية
ج2 ص49 و 50 وغير ذلك من المصادر. وحديث أم معبد مشهور بين
المؤرخين، والنص المذكور من أول العنوان إلى هنا هو للبحار ج19
ص75 و 76 عن الخرائج والجرائح.
([3])
راجع: الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص35 من دون ذكر
للاسم، وأمالي الشيخ الطوسي ج2 ص83، وإعلام الورى ص66، والبحار
ج19 ص64 و 106 و 115 و 116 و 75 و 76 وج22 ص366 عن الخرائج
والجرايح.
([4])
إعلام الورى ص66، والبحار ج19 ص106 عنه.
([5])
الآيات 191 ـ 195 من سورة آل عمران.
([6])
راجع فيما ذكرناه: أمالي الشيخ الطوسي ج2 ص83 ـ 86، والبحار
ج19 ص64 ـ 67 و85 وتفسير البرهان ج1 ص332 و 333 عن الشيباني في
نهج البيان، وعن الاختصاص للشيخ المفيد، والمناقب لابن شهر
آشوب ج1 ص183 و 184، وإعلام الورى ص190 وراجع: امتاع الاسماع
للمقريزي ج1 ص48.
([7])
الطبقات الكبرى لابن سعد ج2 قسم 2 ص89 .
([8])
ثمرات الأوراق ص290 و 291 عن القرطبي.
([9])
راجع في ذلك كلاً أو بعضاً: إرشاد الساري ج6 ص214 والسيرة
الحلبية ج2 ص41، وصحيح البخاري ط مشكول باب الهجرة ج6 ص53
وسيرة ابن هشام ج2 ص137، ومسند أحمد ج3 ص287، والمواهب اللدنية
ج1 ص86، وعيون الأخبار لابن قتيبة ج2 ص202، والمعارف له ص75
والندير ج7 ص258 عن كثير ممن تقدم وعن الرياض النضرة ج1 ص78 و
79 و 80، وعن طبقات ابن سعد ج2 ص222.
([10])
راجع: الندير ج7 ص258.
([11])
الثقات لابن حبان ج1 ص131، ودلائل النبوة ج2 ص233، ووفاء
الوفاء ج1 ص255، عن التاريخ الصغير للبخاري، والسيرة الحلبية
ج2 ص52، والسيرة النبوية لدحلان هامش الحلبية ج1 ص325، وتاريخ
الخميس ج1 ص326.
([12])
إرشاد الساري ج6 ص214.
([13])
المعارف لابن قتيبة ص75، مدعياً الاتفاق على ذلك، وأسد الغابة
ج3 ص223، ومرآة الجنان ج1 ص65 و 69 ومجمع الزوائد ج9 ص60
والإصابة ج2 ص341 ـ 344، والغدير ج7 ص271 عمن تقدم وعن المصادر
الآتية: الكامل لابن الأثير ج1 ص185 وج 2 ص176، وعيون الأثر ج1
ص43 والسيرة الحلبية ج3 ص396 والطبري ج2 ص125 وج 4 ص47
والإستيعاب ج1 ص335، وقال: لا يختلفون أن سنه انتهى حين وفاته
ثلاثاً وستين سنة، وسيرة ابن هشام ج1 ص205.
([14])
الغدير ج7 ص270 عن
الإستيعاب ج2 ص226، والرياض النضرة ج1 ص127 وتاريخ الخلفاء ص72
عن خليفة بن خياط، وأحمد بن حنبل وابن عساكر.
([15])
فتح الباري ج7 ص195، وراجع الغدير ج7 ص260 و 261.
([16])
مستدرك الحاكم ج2 ص343
وتلخيصه للذهبي هامش نفس الصفحة واللمع لأبي نصر ص280 وتفسير
ابن كثير ج2 ص435، والغدير ج7 ص261 عنهم وعن تفسير القرطبي ج7
ص1 وتفسير الخازن ج2 ص335 وعن جامع الحافظ الترمذي، ونوادر
الأصول للحكيم الترمذي، وأبي يعلى، والطبراني، وابن أبى شيبة.
([19])
راجع: تفسير الميزان ج19 ص289.
([20])
أشار إلى هذا أيضاً العلامة الطباطبائي في الميزان ج19 ص289.
([21])
ذخائر العقبي ص59، ودلائل النبوة ج1 ص416، ولسان الميزان ج1
ص395 وعن أبي يعلى، وخصائص النسائي، والكامل لابن الأثيرج 2
ص57 ط صادر، وتاريخ الطبري ج2 ص57 وراجع حياة الصحابة ج1 ص33.
([22])
سنن البيهقي ج9 ص88 ومستدرك الحاكم ج2 ص432، وصححه هو والذهبي
في تلخيصه، وتفسير ابن كثيرج 4 ص28، وحياة الصحابة ج1 ص33 عن
الترمذي، وتفسير الطبري، وأحمد، والنسائي، وابن أبي حاتم.
([23])
راجع: الثقات ج1 ص88 والبداية والنهاية ج3 ص140 وراجع ص142 و
145 عن دلائل النبوة لأبي نعيم والحاكم والبيهقي وحياة الصحابة
ج1 ص72 و 80 عن البداية والنهاية وعن كنز العمال ج1 ص277.
([24])
تفسير الميزان ج19 ص289.
([25])
مغازي الواقدي ج2 ص607.
([26])
السيرة الحلبية ج2 ص227، وبقية الكلام على هذا مع مصادره يأتي
إن شاء الله تعالى في غزوة أحد.
([27])
الآية 31 من سورة المدثر.
([28])
الآية 10 من سورة العنكبوت.
([29])
راجع: تفسير الميزان ج20 ص90 و 91.
|