|
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار
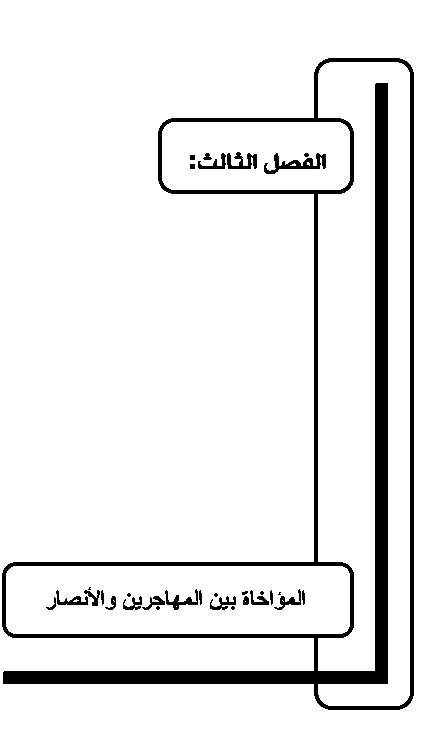
المـؤاخـاة:
وبعد خمسة أو ثمانية أشهر أو أقل، أو أكثر([1])
من مقدمه «صلى الله عليه وآله» المدينة، آخى بين أصحابه من المهاجرين
والأنصار.
وزاد ابن سعد:
أنه «صلى الله عليه وآله» آخى في نفس الوقت بين
المهاجرين والمهاجرين([2]).
آخى بينهم على الحق والمواساة (وقيل: والتوارث) فنزلت
سورة الأنفال التي تجعل الإرث لأولي الأرحام قبل أن يموت أحد من
المتآخيين([3])؛
لأن أول من مات من المهاجرين ـ كما يقولون ـ هو عثمان بن مظعون، مات
بعد بدر([4]).
ونحن نشك في أن يكون «صلى الله عليه وآله» قد آخى بينهم
على التوارث:
أولاً:
لأن رفع هذا الحكم إن كان نسخاً،
فلا معنى للنسخ قبل حضور وقت العمل، كما أنه يلزم أن يكون تشريع
التوارث للمتآخيين عبثاً، وبلا فائدة.
إلا أن يقال:
إن نفس جعل الحكم، وأن يعيش المسلمون هذه الأجواء
الأخوية، والشديدة التلاحم إلى هذا الحد، كان ضرورياً
في تلك الفترة من الزمن.
ولكن الذي تطمئن إليه النفس هو أن نفس المسلمين، أو
بعضهم، هم الذين تخيلوا أن هذه الأخوة ربما تمتد إلى حد توريث بعضهم من
بعض.
ثانياً:
لماذا لم يورث النبي «صلى الله عليه وآله» ممن استشهدوا
في بدر من المهاجرين أو الأنصار، مع أن ذلك قد كان قبل نزول آية
{وَأُوْلُواْ
الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ..}؟([5])،
حيث إن قولهم: إنه لم يمت أحد من المؤمنين قبل عثمان بن مظعون، الذي
مات بعد بدر، لا يصح، إذ قد استشهد في بدر نفسها عدد منهم،
نعم يمكن أن يكون عثمان بن مظعون أول مسلم مات حتف أنفه، أو لعله أول
مسلم مات من المهاجرين.
ثالثاً:
إن كون عثمان بن مظعون مات بعد نزول الآية الرافعة
للحكم السابق غير معلوم،
وإنما ذلك محض اجتهاد من المؤرخين والمؤلفين.
ويقولون:
كان المسلمون حين المؤاخاة تسعين رجلاً، منهم خمسة
وأربعون رجلاً من الأنصار، ومثلهم من المهاجرين،
ويدعي ابن الجوزي: أنه أحصاهم فكانوا جميعاً ستة وثمانين رجلاً.
وقيل:
مئة رجل([6]).
ولربما يكون هذا هو العدد الذي وقعت المؤاخاة بين
أفراده حسبما توفر من عدد المهاجرين،
لا أن عدد المسلمين كان هو ذلك؛ وإلا فإنها تكون صدفة نادرة أن يكون
عدد من أسلم من المهاجرين مساوياً لعدد من أسلم من الأنصار بلا زيادة
ولا نقيصة!!
ومهما يكن من أمر:
فإن النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» استمر يجدد
المؤاخاة، بحسب من يدخل في الإسلام، أو يحضر إلى المدينة من المسلمين([7])
ويدل على ذلك، أنهم يذكرون: أنه «صلى الله عليه وآله» قد آخى بين أبي
ذر والمنذر بن عمرو أو سلمان الفارسي، وأبو ذر إنما قدم المدينة بعد
أحد، كما أنه قد آخى بين الزبير وابن مسعود، وقد وصل ابن مسعود إلى
المدينة والنبي «صلى الله عليه وآله» يتجهز إلى بدر([8]).
ولكن، ربما يشكل على العدد المذكور
في قضية المؤاخاة:
بأن المسلمين كانوا أكثر من ذلك بكثير، فقد بايعه من
أهل المدينة في العقبة الثانية أكثر من ثمانين، كما أنه جهز جيشاً بعد
عشرة أو ثلاثة عشر شهراً إلى بدر قوامه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً.
ويمكن الجواب:
أولاً:
بما ذكره البعض من أن المؤاخاة كانت بين مئة وخمسين من
الأنصار، ومئة وخمسين من المهاجرين([9]).
ثانياً:
لو قلنا بعدم صحة ذلك؛ لأن الذين خرجوا من المهاجرين
إلى بدر كانوا ما بين الستين والثمانين ـ على اختلاف النقل ـ فإننا
نقول: إن المذكور في النص هو العدد المهاجري الذي وقعت المؤاخاة بينه
وبين نظيره من الأنصار،
وقد كان الأنصار أكثر بكثير من المهاجرين، والمهاجرون هم الذين كانوا
خمسة وأربعين، على ما يظهر، فكانت المؤاخاة بين هؤلاء وبين مثلهم من
الأنصار، ثم استمرت المؤاخاة كلما ازداد عدد المهاجرين، حتى بلغوا مئة
وخمسين رجلاً، كما في النص الآنف الذكر.
وذلك لا يعني أن يبقى الآخرون من مسلمي الأنصار من دون
مؤاخاة فيما بينهم.
ولقد كان «صلى الله عليه وآله» يؤاخي بين الرجل ونظيره،
كما يظهر من ملاحظة المؤاخاة قبل الهجرة، وبعدها، فقد آخى قبل الهجرة ـ
على الظاهر ـ بين أبي بكر وعمر، وبين طلحة والزبير، وبين عثمان وعبد
الرحمن بن عوف، وبين نفسه وعلي([10]).
ولكن ابن حبان يذكر:
أن ذلك كان في المؤاخاة الثانية في المدينة، وزاد فيهم:
سعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر([11])
وهؤلاء كلهم من المهاجرين.
وفي المدينة آخى بين أبي بكر وخارجة بن زهير، وبين عمر
وعتبان بن مالك، وهكذا.. ثم أخذ بيد علي فقال: هذا أخي..؟
وآخى أيضاً بين حمزة وزيد بن حارثة، وبين جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن
جبل.
قد أورد على هذا الأخير بأن جعفر كان حينئذٍ في الحبشة([12]).
والجواب عنه:
هو ما تقدم، من أنه «صلى الله عليه وآله» قد استمر
يؤاخي بين المسلمين كلما قدم المدينة منهم أحد.
وقد أجاب البعض:
بأنه أرصده لأخوته حين يقدم([13]).
فيرد سؤال:
ما هو السبب في تخصيص جعفر بهذا الأمر؟!
إلا أن يقال:
إن المقصود هو إظهار الاهتمام بشأن جعفر، والتنبيه على
فضله.
وروى أحمد بن حنبل وغيره:
أنه «صلى الله عليه وآله» آخى بين الناس، وترك علياً
حتى الأخير، حتى لا يرى له أخاً؛ فقال: يا رسول الله، آخيت بين أصحابك
وتركتني؟
فقال:
إنما تركتك لنفسي، أنت أخي، وأنا أخوك، فإن ذكرك أحد،
فقل: أنا عبد الله وأخو رسوله، لا يدعيها بعدك إلا كذاب،
والذي بعثني بالحق، ما أخرتك إلا لنفسي، وأنت مني بمنزلة هارون من
موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وأنت أخي ووارثي([14]).
ومن طريف الأمر:
أنه «عليه السلام» قد قال هذه الكلمة بعد وفاة النبي
«صلى الله عليه وآله»: أنا عبد الله وأخو رسوله، وذلك في خضم الأحداث
التي انتهت بغصب الخلافة من وارث النبي «صلى الله عليه وآله»، فكذبوه؟!
وقالوا له:
أما عبد الله فنعم، وأما أخو رسوله فلا([15])،
فاعجب بعد هذا ما بدا لك!!
وقوله «صلى الله عليه وآله»:
وأنت أخي ووارثي يطرح علينا سؤالاً،
وهو أنه إذا كان المراد: أنه وارث لعلم النبي «صلى الله عليه وآله» دون
غيره، فمن أولى بمقام النبي «صلى الله عليه وآله» منه؟!
وإن كان المراد:
أنه وارثه بقول مطلق، حتى المال، فيرد عليه: أن المال
كان حقاً
لفاطمة «عليها السلام»([16])،
وقد استولى الذين جاؤوا بعد النبي «صلى الله عليه وآله» على أموالها،
ومنها فدك وغيرها كما سنذكره حين الكلام حول غزوة بني النضير في هذا
الكتاب إن شاء الله تعالى.
ومهما يكن من أمر، فإن التأمل في
عملية المؤاخاة يعطينا:
أنه قد لوحظ فيها المسانخة بين الأشخاص، وتشابه وتلاؤم
نفسياتهم، وإلى ذلك أشار الأزري رحمه الله حينما قال مخاطباً
علياً «عليه السلام»:
لـك ذات
كــذاتــه حيـث لــولا أنهــا مــثـلهــا لمـــا آخـــاهـــا
وعلى كل حال،
فإن حديث المؤاخاة متواتر لا يمكن إنكاره، ولا التشكيك
فيه، ولا سيما مؤاخاة النبي «صلى الله عليه وآله» لعلي «عليه
السلام»،
سواء في المؤاخاة الأولى في مكة، أم في الثانية في المدينة، وهو مروي
عن عشرات من الصحابة والتابعين كما يتضح للمراجع([17]).
وقد روي:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال لعلي «عليه
السلام»:
إذا كان يوم القيامة نوديت من بطنان العرش، نعم الأب أبوك إبراهيم،
ونعم الأخ أخوك علي بن أبي طالب([18]).
وعليه فلا يصغى لدعوى أن النبي قد آخى بين علي وعثمان([19])،
أو بين نفسه «صلى الله عليه وآله» وعثمان؛ فإن ذلك لا ريب في بطلانه([20])؛
فإن المقصود من ذلك هو الرفع من شأن عثمان، وتكذيب فضيلة لعلي «عليه
السلام»، بل وجعل عثمان وعلي «عليه السلام» في مستوى واحد، وكيف؟!
وأنى؟!
ويذكر البعض هنا:
أن علياً «عليه
السلام»
لما رأى أنه «صلى الله عليه وآله» لم يؤاخ بينه وبين أحد، خرج كئيباً
إلى المسجد، فنام على التراب؛ فجاءه «صلى الله عليه وآله»، فجعل ينفض
التراب عن ظهره، ويقول: قم يا أبا تراب، ثم آخى بينه وبين نفسه([21]).
ولكن الظاهر هو أن هذه التسمية قد كانت في مناسبة أخرى
غير هذه، ولسوف نتعرض لها حين الحديث عن السرايا في الآتي القريب إن
شاء الله تعالى.
وبعد كل تلك المصادر المتقدمة، والتي هي غيض من فيض،
نجد ابن حزم وابن كثير ينكران صحة سند حديث المؤاخاة([22])،
وأنكره أيضاً ابن تيمية، واعتبره باطلاً، موضوعاً، بحجة أن المؤاخاة
بين المهاجرين والأنصار إنما كانت لإرفاق بعضهم ببعض، ولتأليف قلوب
بعضهم على بعض، فلا معنى لمؤاخاة النبي «صلى الله عليه وآله» لأحد
منهم، ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري([23]).
ونقول:
إن إنكار سند حديث مؤاخاة النبي «صلى الله عليه وآله»
لعلي «عليه
السلام»
لا معنى له، بعد أن صححه كثير من الأعلام، وبعد أن تواتر في كتب سائر
المسلمين عن عشرات الصحابة والتابعين وغيرهم، ولا سيما إذا كان هذا
الإنكار من الأبناء الثلاثة: كثير، وحزم، وتيمية، المعروفين بالنصب،
والتعصب ضد فضائل علي، وأهل بيته الطاهرين «عليهم
السلام».
وأما ما ذكره ابن تيمية تعليلاً
لإنكاره، فنحن نذكر:
أولاً:
ما أجاب به غير واحد: «من أن هذا رد للنص بالقياس،
وغفلة عن حقيقة الحكمة في ذلك.
وبعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة،
والارتفاق ممكن، فآخى بينهم ليعين بعضهم بعضاً، ثم طبقوا هذا الاحتمال
على علي «عليه
السلام»
والنبي، لأنه «صلى الله عليه وآله» كان يقوم بأمر علي «عليه
السلام»
قبل البعثة»([24]).
فمرادهم أن التآلف والمحبة مطلوبان أيضاً بين
المهاجرين؛ لأنهم كانوا من فئات مختلفة، ومستويات متفاوتة: عقائدياً
وفكرياً، واجتماعياً إلخ..
بل لقد صرح نص المؤاخاة بأنها كانت على الحق والمواساة،
ويحتاج المهاجرون إلى أن يواسي بعضهم بعضاً.
كما أنه قد هاجر من قبيلة رجل واحد، ومن أخرى عشرة
مثلاً، فالواحد يحتاج إلى العشرة في معونتهم ورعايتهم،
ثم إنهم يدعون: أن بعض المهاجرين قد حمل ماله معه؛ فيمكن أن يعين بعضهم
بعضاً حتى بالمال إن صحت دعواهم تلك.
ولكننا لا نوافق على قولهم الأخير بالنسبة لعلي «عليه
السلام»
والنبي «صلى الله عليه وآله»، لأن علياً «عليه
السلام»
قد بلغ منزلة يستطيع معها أن يعول نفسه بالعمل، والحصول على ما يحتاج
إليه، أو بالزراعة، أو التجارة بل والغنائم أيضاً.
وإنما الغرض من مؤاخاة الرسول «صلى الله عليه وآله» له،
هو تعريف الناس بمنزلته، وإظهار فضله على غيره، لأنه كان يؤاخي بين
الرجل ونظيره، كما يظهر من دراسة عملية المؤاخاة نفسها، لأن ذلك أقرب
إلى التعاضد والتعاون، وأوجب للتآلف والمحبة([25]).
ثانياً:
قد أخرج الحاكم، وابن عبد البر، بسند حسن: أن النبي
«صلى الله عليه وآله» آخى بين الزبير وابن مسعود، وهما من المهاجرين،
وأخرجه الضياء في المختارة من المعجم الكبير للطبراني.
ويصرح ابن تيمية:
بأن «أحاديث المختارة أصح وأقوى من أحاديث المستدرك»([26]).
ولكن لا بد أن يكون ذلك بعد قدوم ابن مسعود إلى
المدينة، لأنه كان من مهاجري الحبشة، وإنما قدم المدينة بعد قضية
المؤاخاة العامة، وذلك حين كان «صلى الله عليه وآله» يتجهز إلى بدر([27]).
وآخى أيضاً ـ على ما ذكره البعض ـ بعد الهجرة بين أبي
بكر وعمر، وعثمان و عبد الرحمن بن عوف، وطلحة والزبير، وسعد بن أبي
وقاص وعمار بن ياسر، وبينه «صلى الله عليه وآله» وبين علي «عليه
السلام»([28]).
كما وثبتت أيضاً مؤاخاة زيد بن حارثة لحمزة، وهما
مهاجريان، ولذا ـ يقولون ـ إنه قد تنازع زيد وعلي وجعفر في ابنة حمزة،
وكانت حجة زيد: أنها ابنة أخيه([29]).
ونحن نشك في هذه القضية، لأن جعفر لم يكن حين قتل حمزة
حاضراً، فما معنى أن تبقى ابنة حمزة عدة سنوات بلا كفيل،
وإن كانت عند علي فلماذا لم ينازعه زيد؟ وإن كان العكس فلماذا لم
ينازعه علي «عليه
السلام»؟
ومهما يكن من أمر فإن قضية الخلاف حول من يكفل ابنة
حمزة تحتاج إلى تحقيق وتمحيص، نسال الله أن يوفقنا لذلك في فرصة أخرى
إن شاء الله تعالى.
إن من الواضح:
أن هؤلاء الذين أسلموا قد انفصلوا عن قومهم، وعن
إخوانهم، وعن عشائرهم بصورة حقيقية وعميقة،
وقد واجههم حتى أحب الناس إليهم بأنواع التحدي والأذى؛ فأصبحوا وقد
انقطعت علائقهم بذوي رحمهم وصاروا كأنهم لا عصبة لهم،
وقد يشعر بعضهم أنه قد أصبح وحيداً فريداً، وبلا نصير ولا عشيرة، فجاءت
الأخوة الإسلامية لتسد هذا الفراغ بالنسبة إليهم، ولتبعد عنهم الشعور
بالوحدة، وتبعث في نفوسهم الأمل والثقة بالمستقبل،
وقد بلغ عمق تأثير هذه المؤاخاة فيهم أن توهموا: عموم المنزلة حتى في
الارث كما ألمحنا إليه.
لقد أريد للمسلمين المؤمنين أن يكونوا إخوة، وذلك بهدف
السمو بعلاقات هذا الإنسان عن المستوى المصلحي وجعلها علاقة إلهية
خالصة تصل إلى درجة الأخوة، وليكون أثرها في التعامل بين المسلمين أكثر
طبيعية وانسجاماً، وبعيداً عن النوازع النفسية، التي ربما توحي للأخوين
المتعاونين بأمور من شأنها أن تعقد العلاقات بينهما ولو نفسياً على أقل
تقدير.
ورغم أن الإسلام قد قرر ذلك، وأكد على أن المؤمن أخو
المؤمن أحب أم كره، وحمله مسؤولية العمل بمقتضيات هذه الأخوة، إلا أنه
قد كان ثمة حاجة إلى إظهار ذلك عملياً، بهدف توثيق عرى المحبة وترسيخ
أواصر الصداقة والمودة كما هو معلوم، وليكون الهدف السامي قد انطلق من
العمل السامي أيضاً.
لقد كان الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» بصدد بناء
مجتمع جديد، يكون المثل الأعلى للصلاح والفلاح، قادراً على القيام
بأعباء الدعوة إلى الله، ونصرة دينه، في أي من الظروف والأحوال.
وقد تقدمت ـ عند البحث عن عملية بناء المسجد ـ الإشارة
إلى واقع وجود الفوارق الكبيرة بين المهاجرين أنفسهم، والأنصار أنفسهم،
والمهاجرين والأنصار معاً ـ الفوارق ـ الاجتماعية، والقبلية،
والثقافية، والنفسية، والعاطفية، وحتى العمق العقيدي ومستوى الالتزام،
فضلاً عما سوى ذلك، هذا بالإضافة إلى الظروف النفسية والمعيشية التي
كان يعاني منها المهاجرون بالخصوص.
ومع ملاحظة حجم التحدي، الذي كان يواجه هذا المجتمع
الناشئ الجديد، سواء في الداخل: من الخلافات بين الأوس والخزرج، الذين
كان الكثيرون منهم لا يزالون على شركهم، ثم من المنافقين، ومن يهود
المدينة.
ومن الخارج:
من اليهود، والمشركين في جزيرة العرب، بل والعالم
بأسره.
ومع الأخذ بنظر الاعتبار عظم المسؤولية التي يتحملها
هذا المجتمع في صراعه من أجل إقامة هذا الدين الجديد والدفاع عنه.
مع ملاحظة كل ذلك، وحيث أصبح من المفترض بهذا المجتمع
أن يكون بمثابة كتلة واحدة متعاضدة، ومترابطة، بعد أن كانوا أحزاباً
وجماعات وأفراداً فكان
لا بد من إيجاد روابط وثيقة تشد هذا المجتمع بعضه إلى بعض، وبناء عواطف
راسخة، قائمة على أساس عقيدي، تمنع من الإهمال ومن الحيف على أي فرد من
أفراد هذا المجتمع الجديد بحيث يكون الكل مشمولين بالرعاية التامة،
التي تجعلهم يعيشون الحب والحنان بأسمى وأجل معانيه،
كما أنها تمنع من ظهور تلك الرواسب النفسية، والعقد التاريخية ـ بل
وتقضي عليها تدريجاً ـ بين أفراد هذا المجتمع، الذي أصبح أفراده
مأخوذين بالتعامل مع بعضهم البعض، الأمر الذي يجعل خطر ظهورها ـ لأتفه
الأسباب ـ أشد، وتدميرها أعظم وأوسع.
وكانت تلك الرابطة الوثيقة هي:
«المؤاخاة» التي روعيت فيها الدقة، إلى الحد الذي يضمن
معه أن يحفظ في هذا المجتمع الجديد معها التماسك والتعاضد إلى أبعد مدى
ممكن وأقصى غاية تستطاع؛ لا سيما وأنه كان يؤاخي بين الرجل ونظيره، كما
أشرنا إليه.
وسر ذلك يرجع إلى أن هذه المؤاخاة قد أقيمت على أساسين
اثنين:
فالحق هو القاسم المشترك بين الجميع، عليه يبنون
علاقاتهم، وهو الذي يحكم تعاملهم مع بعضهم البعض في مختلف مجالات
الحياة.
نعم،
الحق هو الأساس، وليس الشعور الشخصي النفسي، ولا
المصلحة الشخصية أو القبلية، أو الحزبية!!
وبديهي:
أن الحق إذا جاء عن طريق الأخوة والحنان والعطف، فإن
ذلك يكون ضمانة لبقائه واستمراره، والتعلق به، والدفاع عنه.
أما إذا فرض هذا الحق فرضاً
عن طريق القوة والسلطة، فبمجرد أن تغيب السلطة، والقوة، فلنا أن نتوقع
غياب الحق، لأن ضمانة بقائه ذهبت، فأي مبرر يبقى لوجوده، وبقائه؟!.
بل ربما يكون وجوده وبقاؤه مثاراً للأحقاد والإحن التي
ربما يتولد عنها الظلم والطغيان في أبشع صوره وأخزاها، وأسوأ حالاته
وأقصاها.
فهذه الأخوة إذاً،
ليست مجرد توهج عاطفة، أو شعور نفسي، وإنما هي أخوة مسؤولة ومنتجة،
تترتب عليها آثار عملية بالفعل، يحس الإنسان فعلاً بجدواها وبفعاليتها،
تماماً
كالأخوة التي في قوله تعالى:
{إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}([30]).
حيث جعل مسؤولية الصلح بين المؤمنين متفرعة وناشئة عن
الأخوة الإيمانية.
وإذا كانت أخوة خيرة ومنتجة، فمن الطبيعي أن تبقى، وأن
تستمر،
ومن الطبيعي أيضاً أن يستمر الاحتفاظ بها، والحفاظ عليها إلى أبعد مدى
ممكن. وقد كانت لهذه المؤاخاة نتائج هامة في تاريخ النضال والجهاد.
وقد امتن الله على نبيه في بدر بقوله:
{وَإِن
يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِيَ
أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالمُؤْمِنِينَ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ
قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهُ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ}([31]).
ويروون:
أنه «صلى الله عليه وآله» قال: لو كنت متخذاً خليلاً
لاتخذت أبا بكر خليلاً([32]).
ولكن كيف يصح هذا وهم يروون:
1 ـ
إن خليلي من أمتي أبو بكر([33]).
2 ـ
ويروون: لكل نبي خليل، وخليلي سعد بن معاذ([34])
أو عثمان بن عفان([35]).
والحقيقة هي:
أن حديث خلة عثمان قد وضعه إسحاق بن نجيح الملطي([36])،
وحديث خلة أبي بكر موضوع في مقابل حديث إخاء النبي «صلى الله عليه
وآله» لعلي «عليه
السلام»،
كما نص عليه المعتزلي([37]).
وبعد فإنهم يقولون:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد آخى بين سلمان وبين
أبي الدرداء([38]).
وفي نص آخر:
إنه آخى بينه وبين حذيفة([39]).
وفي رواية ثالثه:
إنه «صلى الله عليه وآله» آخى بينه وبين المقداد([40]).
أما ابن سعد، فقد قال:
«أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني موسى بن محمد بن
إبراهيم بن الحارث، عن أبيه قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: أخبرنا محمد
بن عبد الله، عن الزهري:
أنهما كانا ينكران كل مؤاخاة كانت بعد بدر، ويقولان:
قطعت بدر المواريث.
وسلمان يومئذ في رق وإنما عتق بعد ذلك،
وأول غزوة غزاها: الخندق، سنة خمس من الهجرة»([41]).
ولأجل ذلك:
فقد عبر البلاذري هنا بقوله: «.. وقوم يقولون: آخى بين
أبي الدرداء، وسلمان.
وإنما أسلم سلمان فيما بين أحد والخندق.
قال الواقدي:
والعلماء ينكرون المؤاخاة بعد بدر، ويقولون: قطعت بدر
المواريث»([42]).
وقال ابن أبي الحديد:
«قال أبو عمر: آخى رسول الله «صلى الله عليه وآله» بينه
وبين أبي الدرداء، لما آخى بين المسلمين،
ولا يخفى ضعفه وغرابته»([43]).
ونقول:
إن لنا على ما تقدم ملاحظات نجملها
فيما يلي:
أولاً:
قولهم: إن المؤاخاة قد انقطعت بعد بدر، لا يصح، كما
تقدم، فلا داعي لاستغراب هؤلاء ولا لإنكار ذلك.
ثانياً:
قولهم: إن انقطاع المؤاخاة بعد بدر يلزمه عدم صحة
مؤاخاة سلمان مع أحد من الناس، لا يصح كذلك؛ إذ لماذا لا يؤاخي قبل بدر
بين سلمان وإن كان عبداً، وبين رجل آخر حر؟!. هذا بالإضافة إلى ما
سيأتي من أن سلمان قد أسلم وتحرر في أول سني الهجرة.
ثالثاً:
دعوى البلاذري: أن سلمان قد أسلم بين أحد والخندق، لا
تصح أيضاً، لأنه إنما أسلم في أول الهجرة كما قلنا.
نعم.. هم يقولون:
إن تحرره قد كان قبل الخندق.
فإذا كان مسلماً حين المؤاخاة،
فيمكن أن يؤاخي بينه وبين أحد المسلمين، ولو كان الطرف الآخر حراً؛
لعدم الفرق بين الحر والعبد، في الإيمان والإنسانية، وغير ذلك، بنظر
الإسلام..
هذا.. لو سلم أنه كان لا يزال عبداً..
رابعاً:
إن الذي انقطع بعد بدر إنما هو التوارث بين الإخوة،
وليس نفس المؤاخاة..
مع أننا نقول أيضاً:
إن التوارث لم يكن موجوداً
حتى قبل ذلك، ولعل بعض المسلمين قد توهم التوارث بين المتآخيين، فجاء
الردع عنه، وتصحيح اشتباهه في ذلك، فصادف ذلك زمان حرب بدر..
فنشأ عن ذلك توهمان آخران:
هما: أن التوارث كان ثابتاً..
وأن المؤاخاة تنقطع بانقطاع التوارث، وكلاهما باطل، ولا يصح..
خامساً:
قولهم: إن المؤاخاة قد كانت بين سلمان وبين أبي الدرداء
يقابله:
1 ـ
ما روي عن إمامنا السجاد «عليه
السلام»،
أنه قال: «لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، ولقد آخى رسول الله
«صلى الله عليه وآله» بينهما، فما ظنكم بسائر الخلق»([44]).
2 ـ
عن أبي عبد الله «عليه
السلام»،
أنه قال: «آخى رسول الله «صلى الله عليه وآله» بين سلمان وأبي ذر،
واشترط على أبي ذر: أن لا يعصي سلمان»([45]).
3 ـ
إننا نعتقد: أن مؤاخاة سلمان مع أبي ذر هي الأصح،
والأوفق بما يذكرونه من أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يؤاخي بين
كل رجل ونظيره كما تقدم.
وكان أبو ذر أكثر مشاكلة لسلمان من أبي الدرداء له؛ فإن
سلمان يؤكد على أنه لا بد من الوقوف إلى جانب القرآن، إذا اقتتل القرآن
والسلطان، كما أن أبا ذر قد كان له موقف عنيف من السلطة، حينما وجد
أنها تسير في خط انحرافي خطير، فكان أن اتخذ جانب الحق، وأعلن إدانته
للانحراف بصورة قاطعة، كما أنه هو وسلمان قد كان لهما موقف منسجم من
أحداث السقيفة ونتائجها..([46]).
أما
أبو الدرداء.
فقد أصبح من وعاظ السلاطين، وأعوان الحكام المتسلطين،
حتى لنجد معاوية ـ كرد للجميل ـ يهتم بمدحه وتقريظه والثناء عليه([47]).
كما أن أبا الدرداء ـ حسبما تقدم ـ يكتب لسلمان يدعوه
إلى الأرض المقدسة، وهي الشام بزعمه، وليس مكة، والمدينة! فاقرأ واعجب؛
فإنك ما عشت أراك الدهر عجباً.
ويكفي أن نذكر:
أن يزيد بن معاوية قد مدح أبا الدرداء، وأثنى عليه([48])،
كما أن معاوية قد ولاه دمشق([49]).
بالإضافة إلى أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ـ
حسبما يروى ـ قد ذم أبا الدرداء، وقال له: إن فيك جاهلية.
قال:
جاهلية كفر، أم جاهلية إسلام؟
قال:
جاهلية كفر([50]).
4 ـ
وإذا كان سلمان قد أسلم في أول سني الهجرة، كما سيأتي
الحديث عنه في فصل مستقل، وإذا كان أبو الدرداء قد تأخر إسلامه إلى ما
بعد أحد([51])..
فلماذا ترك النبي «صلى الله عليه وآله» سلمان من دون أن يؤاخي بينه
وبين أحد من الناس، في هذه المدة الطويلة كلها؟!.
5 ـ
وإذا أخذنا بقول الواقدي: «إن العلماء ينكرون المؤاخاة
بعد بدر، ويقولون: قطعت بدر المواريث»([52]).
فإن النتيجة تكون:
أن العلماء ينكرون المؤاخاة بين سلمان وأبي الدرداء،
لأن أبا الدرداء قد تأخر إسلامه عن بدر كثيراً..
6 ـ
وأخيراً.. فقد جاء في بعض النصوص: أنه «صلى الله عليه
وآله» قد آخى بين أبي الدرداء وعوف بن مالك الأشجعي([53])،
ولعل هذا هو الأصح والأولى بالقبول..
وقد روى الكليني عن أبي عبد الله «عليه
السلام»
قال: آخى رسول الله «صلى الله عليه وآله» بين سلمان وأبي ذر، واشترط
على أبي ذر: أن لا يعصي سلمان([54]).
وواضح أن ذلك يعني:
أن طاعة أبي ذر لسلمان لم تكن: إلا لأنها توصل إلى
الحق، وتؤدي إلى الاحتفاظ به، والحفاظ عليه، ولأنه يمثل الوعي الرسالي
الرائد في أعلى مستوياته، ويدعم هذا الوعي ويحميه، ويرفده إيمان ثرٍ،
وعقيدة راسخة، توجه الفكر والرأي والوعي، وكل الحركات نحو الهدف
الأسمى، والمبدأ الأعلى، لتعيش في ظلاله، وتفنى كلها فيه بكل ما لهذه
الكلمة من معنى.
فإن الإيمان عشر درجات، وسلمان كان في العاشرة، وأبو ذر
في التاسعة، والمقداد في الثامنة([55]).
وإن إطاعة أبي ذر لسلمان لتعطينا:
أن الميزان والمقياس في الطاعة ليس إلا ذلك الذي أشرنا
إليه، واعتبره القرآن وسيلة لنيل التقوى واليقين: حين قال تعالى:
{هَلْ
يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ}([56]).
و{إِنَّمَا
يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء}([57]).
و{إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَتْقَاكُمْ}([58]).
إذن، فليس للعرق، ولا للون، ولا للجاه، ولا للمال، ولا
غير ذلك ـ أي دور في التفاضل وإعطاء الامتيازات ـ من أي نوع كانت ولأي
كان، وإنما الميزان والمقياس في كل ذلك هو التقوى والتقوى فقط، التي
يدعمها الإيمان الراسخ، والفكر النير، والوعي الرسالي الرائد، ولأجل
ذلك كان على أبي ذر: أن لا يعصي سلمان، الذي بلغ من العلم والمعرفة
بحيث لو اطلع أبو ذر على ما في قلب سلمان لقتله([59]).
وعن الفضل:
ما نشأ في الإسلام رجل من الناس كافة كان أفقه من سلمان
الفارسي([60]).
ولأجل ذلك بالذات:
كان لا بد من إطاعة أئمة الهدى، الذين هم القمة في
العلم والمعرفة، ومن ثم في التقوى، دون غيرهم من المتغلبين الجهلة
والطواغيت والجبارين.
([1])
راجع البحار ج19 ص122، وهامش ص130 عن مناقب ابن شهرآشوب ج1
ص152، وعن المقريزي، عن المنتقى في مولود المصطفى، والمواهب
اللدنية ج2 ص71، وتاريخ الخميس ج1 ص35، عن أسد الغابة، ووفاء
الوفاء ج1 ص267، وفتح الباري ج7 ص210، والسيرة الحلبية ج2 ص92.
([2])
طبقات ابن سعد (ط ليدن) ج1 قسم2 ص1.
([3])
راجع بحار الأنوار للعلامة المجلسي
>رحمه
الله<
ج19 هامش ص130، والسيرة الحلبية ج2 ص92 و93.
([4])
الإصابة ج2 ص464، والكامل لابن الأثير (ط صادر) ج2 ص141.
([5])
الآية 75 من سورة الأنفال.
([6])
راجع: طبقات ابن سعد ج1 قسم2 ص1، والمواهب اللدنية ج1 ص71،
وفتح الباري ج7 ص210، والسيرة الحلبية ج2 ص90، والبحار ج19
ص130 عن المنتقى، والمقريزي.
([7])
فتح الباري ج7 ص211.
([8])
فتح الباري ج7 ص145.
([9])
راجع: البحار ج19 ص130.
([10])
مستدرك الحاكم ج3 ص14، ووفاء الوفاء ج1 ص267 و268، والسيرة
الحلبية ج2 ص20، والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص155، وفتح الباري
ج7 ص211، والإستيعاب.
([11])
الثقات ج1 ص138 ـ 142.
([12])
سيرة ابن هشام ج2 ص151، والسيرة الحلبية، وغير ذلك.
([13])
البداية والنهاية ج3 ص227، والسيرة الحلبية ج2 ص91.
([14])
راجع: نهج الحق في ضمن
دلائل الصدق ص267، وينابيع المودة ص56، وتذكرة الخواص ص23 عن
أحمد في الفضائل، وصححه، وابن الجوزي، ونقل عن كنز العمال ج6
ص390، والرياض النضرة ج2 ص209، وتاريخ ابن عساكر ج6 ص21،
وكفاية الشنقيطي ص35 و44 والثقات ج1 ص141 و142.
([15])
الإمامة والسياسة ج1 ص13،
وأعلام النساء ج4 ص115، وتفسير البرهان ج2 ص93.
([16])
راجع: الكافي ج1 ص458 بتحقيق الغفاري، والبحار (ط حجرية) ج8
ص231 و(ط جديدة) ج100 ص197، وكشف الغمة ج2 ص132، والأمالي
للطوسي ج1 ص108، والعوالم ج11 ص518، والأمالي للمفيد (ط مؤسسة
النشر الإسلامي) ص283، وراجع: مرآة العقول ج5 ص331، وغير ذلك.
([17])
راجع: تاريخ الخميس ج1 ص353، ووفاء الوفاء ج1 ص267 و268،
وينابيع المودة ص56 و57 عن مسند أحمد، وتذكرة الخواص ص22 ـ 24،
وحكي عن الترمذي أنه صححه، والسيرة الحلبية ج2 ص20 و90،
ومستدرك الحاكم ج3 ص14، والثقات لابن حبان ج1 ص138، وفرائد
السمطين ج1 الباب العشرون، والفصول المهمة لابن الصباغ ص22
و29، والبداية والنهاية ج3 ص226 وج7 ص35، وتاريخ الخلفاء ص170،
ودلائل الصدق ج2 ص268 ـ 270 عن كنز العمال، وعن البيهقي في
سننه، والضياء في المختارة، وعبد الله بن أحمد في زيادات
المسند ثمانية أحاديث، وأبيه في المسند وفي الفضائل، وأبي يعلى
والطبراني، وابن عدي، والجمع بين الصحاح الستة، وأخرج
الخوارزمي اثني عشر حديثا، وابن المغازلي ثمانية أحاديث، وسيرة
ابن هشام ج2 ص150، والغدير ج3 ص112 حتى ص125 عن بعض من تقدم
وعن المصادر التالية: جامع الترمذي ج2 ص13، ومصابيح البغوي ج2
ص199، والإستيعاب ج2 ص460، ترجمة أمير المؤمنين، وعد حديث
المؤاخاة من الآثار الثابتة، وتيسير الوصول ج3 ص271، ومشكاة
المصابيح هامش المرقاة ج5 ص569، والمرقاة ص73 ـ 75، والإصابة
ج2 ص507، والمواقف ج3 ص276، وشرح المواهب ج1 ص373، وطبقات
الشعراني ج2 ص55، وتاريخ القرماني هامش الكامل ج1 ص216، وسيرة
دحلان هامش الحلبية ج1 ص325، وكفاية الشنقيطي ص34، والإمام علي
تأليف محمد رضا ص21، والإمام علي لعبد الفتاح عبد المقصود ص73،
والفتاوى الحديثية ص42، وشرح النهج ج2 ص62، وصححه وعده مما
استفاض من الروايات، وكنز العمال ج6 ص294 و299 و390 و399 و400
و54.
([18])
ربيع الأبرار ج1 ص807 و808.
([19])
تاريخ ابن خلدون ج2 ص397، والغدير ج9 ص94 و95 و318 عن الرياض
النضرة ج1 ص17 وعن الطبري ج6 ص154، وعن كامل ابن الأثير ج3
ص70، وعن المعتزلي ج1 ص165، ولكنه في ج2 ص506 ذكر نفس الحديث
عن الطبري من دون ذكر الموأخاة!!!.
([20])
طبقات ابن سعد ط ليدن ج3 ص47، والغدير ج9 ص16 عنه.
([21])
الفصول المهمة لابن الصباغ
ص22، ومجمع الزوائد ج9 ص111 عن الطبراني في الكبير والأوسط،
ومناقب الخوارزمي ص7، وكفاية الطالب ص193 عن ابن عساكر.
([22])
راجع: البداية والنهاية ج7 ص223 و336.
([23])
راجع: منهاج السنة ج2 ص119، والبداية والنهاية ج3 ص227، وفتح
الباري ج7 ص211، والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص155، والسيرة
الحلبية ج2 ص20، ودلائل الصدق ج2 ص272.
([24])
راجع: وفاء الوفاء ج1 ص268، وفتح الباري ج7 ص211، والسيرة
الحلبية ج2 ص20، والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص155، والغدير ج3
ص174 ـ 175 عن الفتح وعن الزرقاني في المواهب ج1 ص373.
([25])
راجع: دلائل الصدق ج2 ص272 و273.
([26])
فتح البـاري، ووفـاء الوفـاء ج1 ص268، والغديـر ج3 ص174 و175
عـن الفتح، وعن شرح المواهب للزرقاني ج1 ص373.
([27])
فتح الباري ج7 ص145.
([28])
الثقات لابن حبان ج1 ص138 ـ 142 وراجع: الغدير ج10 ص103 ـ 107
فإنه ذكره عن غير واحد، وراجع: مستدرك الحاكم ج3 ص14، ووفاء
الوفاء ج1 ص268، والسيرة الحلبية ج2 ص20، والسيرة النبوية
لدحلان ج1 ص155، وفتح الباري ج7 ص211، والإستيعاب وذكر عثمان،
وقد كان في الحبشة، وكذا عبد الرحمن بن عوف، يؤيد: أن ذلك كان
في المؤاخاة الثانية بعد الهجرة إلى المدينة.
([29])
صحيح البخاري ج3 ص37 ط الميمنية، ومستدرك الحاكم ج2 ص120،
وتلخيصه للذهبي هامش نفس الصفحة، وغير ذلك من المصادر.
([30])
الآية10 من سورة الحجرات.
([31])
الآيتان62 و63 من سورة الأنفال.
([32])
مصنف عبد الرزاق ج10 عن ابن الزبير، وفي هامشه عن سعيد بن
منصور، والغدير ج9 ص347 عن صحيح البخاري ج5 ص243 باب المناقب،
وباب الهجرة ج6 ص44، والطب النبوي لابن القيم ص207.
([33])
إرشاد الساري ج6 ص83 و84، والغدير عنه وعن كنز العمال ج6 ص138
و140، والرياض النضرة ج1 ص83.
([34])
الغدير ج9 ص347 عن كنز العمال ج6 ص83، ومنتخب كنز العمال هامش
المسند ج5 ص231.
([35])
تاريخ بغداد للخطيب ج6 ص321، والغدير ج9 ص346 و347.
([36])
راجع: الغدير ج9 ص347.
([37])
شرح النهج للمعتزلي ج11 ص49.
([38])
الإصابة ج2 ص62،
والإستيعاب بهامشه ج2 ص60 وج4 ص59، والغدير ج10 ص103 و104 وج3
ص174 وقد ناقش في هذه الرواية، والسيرة النبوية لابن هشام ج2
ص152، وأسد الغابة ج2 ص330 و331، وطبقات ابن سعد (ط ليدن) ج4
قسم1 ص60، وتهذيب تاريـخ دمشق ج6 ص203، وشـرح النـهج = =
للمعتزلي ج18 ص37، وتهذيب الأسماء ج1 ص227، وقاموس الرجال ج7
ص256، ونفس الرحمن ص91 و85 عن أبي عمر، وعن المناقب للخوارزمي،
الفصل14 وتهذيب التهذيب ج4 ص138.
([39])
طبقات ابن سعد ط ليدن ج4 قسم1 ص60.
([40])
نفس الرحمن ص85 عن الحسين بن حمدان.
([41])
طبقات ابن سعد ط ليدن ج4 قسم1 ص65.
([42])
أنساب الأشراف (قسم حياة النبي«صلى الله عليه وآله») ج1 ص271.
([43])
نفس الرحمن ص85 عنه.
([44])
بصائر الدرجات ص25، والكافي ج1 ص331، والغدير ج7 ص35 عنهما،
واختيار معرفة الرجال ص17، والبحار ج22 ص343، ومصابيح الأنوار
ج1 ص348، وقاموس الرجال ج4 ص418 و419 والظاهر: أن الرواية
معتبرة.
([45])
الكافي ج8 ص162، والبحار ج22 ص345 عنه، ونفس الرحمن ص91.
([46])
راجع كتابنا: سلمان الفارسي في مواجهة التحدي.
([47])
طبقات ابن سعد ط ليدن ج2 قسم2 ص115.
([48])
تذكرة الحفاظ ج1 ص25.
([49])
الإستيعاب بهامش الإصابة ج3 ص17 وج4 ص60، والإصابة ج3 ص46،
والتراتيب الإدارية ج2 ص426 و427.
([50])
الكشاف ج3 ص537، وقاموس الرجال ج10 ص69 عنه.
([51])
الإستيعاب بهامش الإصابة ج3 ص16، وراجع ج4 ص60.
([52])
قاموس الرجال ج7 ص256،
وج10 ص69 وأنساب الأشراف (قسم حياة النبي «صلى الله عليه
وآله») ج1 ص271، وراجع: طبقات ابن سعدج4 قسم1 ص60.
([53])
طبقات ابن سعد ج4 قسم1 ص22.
([55])
قاموس الرجال ج4 ص423 عن الخصال للصدوق.
([56])
الآية9 من سورة الزمر.
([57])
الآية28 من سورة فاطر.
([58])
الآية13 من سورة الحجرات.
([59])
راجع: قاموس الرجال ج4 ص418 وغيرها.
|