الـغـنــائـــم والأســــــرى
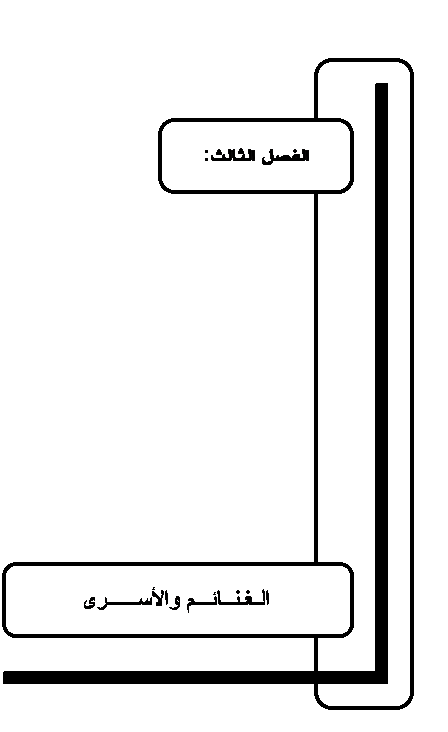
وغنم المسلمون من المشركين مئة وخمسين من الإبل،
وعشرة أفراس، و عند ابن الأثير: ثلاثين فرساً،
ومتاعاً،
وسلاحاً،
وأنطاعاً،
وأدماً
كثيراً([1]).
واختلف المسلمون في هذه
الغنائم:
هل تختص بالمهاجرين، أو تتعداهم إلى من كان خلفهم
من الجيش يقوم بمهمات أخرى. فأرجأ النبي «صلى الله عليه وآله»
تقسيم الغنائم بسبب هذا الخلاف، وجمع الغنائم، وسلمها لعبد الله بن
كعب، وأمرهم بمعاونته في حملها وحفظها، ونزل قوله تعالى ـ كما يقال
ـ :
{يَسْأَلُونَكَ
عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ
اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ
وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}([2]).
ولم يقسم رسول الله «صلى الله عليه وآله» الغنائم
إلا وهو في طريقه إلى المدينة، وذلك من أجل أن تخف حدة الخلاف فيما
بين أصحابه، وتعود إليهم حالتهم الطبيعية، بعيداً
عن نزوات آمالهم الدنيوية.
فقسمها بينهم آنئذٍ، ولم يخرج منها الخمس.
النبي
 لم
يأخذ الخمس في بدر:
لم
يأخذ الخمس في بدر:
وأما لماذا لم يأخذ النبي «صلى الله عليه وآله»
الخمس من غنائم بدر؟
فلعله لأنه أراد ـ بإذن من الله، وسماحة من نفسه،
ومن أولي القربى ـ : أن يعطي المحاربين سهاماً
أوفر، تأليفاً
لهم وترغيباً،
خصوصاً
وأنها أول حرب يخوضونها ضد المشركين، ولا سيما بعد أن رأى حرصهم
على الحصول على المال في هذه المناسبة بالذات، كما أشرنا إليه،
وسيأتي توضيح ذلك أكثر حين الحديث عن الأسرى.
ونظير ذلك ما ورد من أن الحسنين «عليهما السلام» قد
طالبا أباهما أيام خلافته بالخمس، فقال لهما «عليه السلام»: هو لكم
حق، ولكنني محارب معاوية، فإن شئتم تركتم حقكم منه([3]).
كما أن من الممكن أن يكون عدم أخذه للخمس لأجل أن
آية الخمس لم تكن قد نزلت بعد، مما يعني: أن تشريع الخمس قد تأخر
عن غزوة بدر، حتى إننا نجد من يقول: إن أول خمس خمسه كان في غزوة
بني قينقاع([4]).
ولكننا لا نطمئن إلى صحة ذلك،
لأن بعض النصوص تفيد:
أن أول خمس أخذه «صلى الله عليه وآله» كان في سرية
عبد الله بن جحش أي قبل بدر بأشهر.
بل نجد أن ابن عساكر يذكر في حديث مناشدة علي «عليه
السلام» لأصحاب الشورى قوله:
«نشدتكم بالله، أفيكم أحد كان يأخذ الخمس مع النبي
«صلى الله عليه وآله» قبل أن يؤمن أحد من قرابته غيري وغير فاطمة؟
قالوا:
اللهم لا»([5]).
فهذا النص يدل على أن تشريع الخمس كان في مكة في
بدء الدعوة، وحتى قبل أن يسلم أحد من أهل بيته «صلى الله عليه
وآله».
ولكنْ في هذا النص إشكال، وهو أن جعفر «رحمه الله»
قد أسلم في بدء الدعوة أيضاً، وحمزة قد أسلم في حدود السنة الرابعة
أو الخامسة، وكذلك أبو طالب، أي قبل ولادة فاطمة صلوت الله وسلامه
عليها. ويمكن أن يجاب عن ذلك:
أولاً:
إن أبا طالب لم يكن ثمة بحاجة للمال، وكذلك النبي
«صلى الله عليه وآله» وخديجة. وقد كانوا في الشعب ينفقون من أموال
خديجة، وأبي طالب، كما تقدم.
وأما جعفر، فلم يعلم:
أنه كان يستحق من الخمس، فلعله كان ملياً
من المال؛ كما أنه كان يعيش في بلاد الحبشة وكذا حمزة فلعله كان
ملياً
أيضاً.
وثانياً:
يمكن أن يكون الخمس قد شرع في بدء البعثة، وقبل أن
يسلم أحد من أهل بيته «صلى الله عليه وآله»، فخمست خديجة أموالها؛
فنال علياً من ذلك ما ناله، وبعد أن ولدت فاطمة صارت تشاطر علياً
في الخمس.
ولا يلزم من ذلك النص أن تكون فاطمة قد ولدت في أول
البعثة، أو قبلها، كما ربما يتوهم.
النبي
 يرد
الخمس على أصحابه أيضاً:
يرد
الخمس على أصحابه أيضاً:
وكما أنه لم يأخذ الخمس في بدر، فإنه لم يأخذه في
غيرها أيضاً. فقد ورد أنه «صلى الله عليه وآله» قد رد الخمس على
أصحابه في قصة حنين، حيث: «تناول (أي النبي «صلى الله عليه وآله»)
من الأرض وبرة من بعير، أو شيئاً، ثم قال: والذي نفسي بيده، ما لي
مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس، وهو مردود عليكم»([6]).
فهذا كان حال النبي «صلى الله عليه وآله» معهم،
ولكن غير النبي «صلى الله عليه وآله» قد استأثر بالفيء ومنعه أهله،
بل حرم ورثة النبي «صلى الله عليه وآله» من ميراثه، كما هو معلوم.
ولسوف نتكلم حول تشريع الخمس في الأرباح والأموال، في فصل مستقل
يأتي إن شاء الله، بعنوان: «بحوث
ليست غريبة عن
السيرة».
أخرج أبو عبيد، وغيره:
«أن أمير المؤمنين علياً «عليه السلام» أعطى العطاء
في سنة ثلاث مرات. ثم أتاه مال من أصبهان.
فقال:
اغدوا
إلى عطاء رابع، إني لست بخازنكم، فقسم الحبال، فأخذها قوم، وردها
قوم، فأكرههم على أخذها»([7]).
وهذا يعني:
أن الناس قد وصلوا في عهد أمير المؤمنين «عليه
السلام» إلى درجة من الكفاية، حتى إنهم ليردون بعض العطاء.
وكيف لا يصلون إلى هذه الدرجة، وأمير المؤمنين
«عليه السلام» هو الذي يقول: «أنا أهنت الدنيا»؟([8]).
وسيرته في بيت مال المسلمين أشهر من أن تحتاج إلى
بيان؟!.
بينما نجد في عهد غيره:
أن البعض ربما لا يجد ما يستر به نفسه، سوى رقعتين،
يجمع إحداهما على فرجه، والأخرى على دبره، فكان يُدعى:
ذا الرقعتين([9]).
وقد يطرح هنا سؤال، وهو:
هل صحيح أن تشريع الخمس لآل الرسول معناه تبني مبدأ
الطبقية، والالتزام به؟! بل هو قبول بمبدأ التمييز العنصري، كما
يحلو للبعض أن يقول؟.
والجواب:
أن المستفاد من الروايات أن الخمس ملك لله ولرسوله،
وللإمام «عليه
السلام»،
والباقون من الأصناف المذكورة في الآية إنما هم موارد صرفه.
وفي الحقيقة،
فقد اعتبر الله فقراء العترة من عائلة الإمام «عليه
السلام»،
فإن لم تكفهم سهامهم أتمها من عنده، وإن بقي من سهامهم شيء كان
الباقي للإمام «عليه
السلام»،
ويصرف الإمام الخمس فيما ينوبه مما فيه حفظ كيان الدين وحفظ شؤون
المسلمين.
والمال الذي يعطى لهؤلاء لا يعني سوى سد حاجتهم
المادية، بعد أن حرمت عليهم الزكاة، كما كانت الزكاة لسد الحاجة
المادية لغيرهم، من دون أن تعطي لذلك الغير أي إمتياز.
غير أن في إعطاء هذا الخمس لهؤلاء تكريماً للنبي
الأعظم «صلى الله عليه وآله»، وتأكيداً على قدسيته ومكانته في نفوس
الناس، مع عدم الانتقاص من حق ولا من مكانة أحد، الأمر الذي يعطي
للناس زخماً
عقيدياً،
ومن ثم سلوكياً
تحتاج إليه الأمة.
ويلاحظ اهتمام القرآن في هذا الأمر في غير مورد،
كقوله تعالى:
{يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ
صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ}([10]).
ثم إنه تعالى قد أمر الناس بالصلاة والتسليم على
رسوله الأكرم «صلى الله عليه وآله» وليس ذلك إلا لأجل أنه تعالى
يريد أن يستفيد من ذلك في خدمة الدين والإنسان والإنسانية.
أضف إلى ما تقدم:
أن هذا الإعطاء ليس بلا حدود ولا قيود، بحيث يوجب
أن تتكدس الأموال عند طائفة معينة، مع حاجة الآخرين إليها. فلا
يعطى لكل إلا بمقدار مؤونة سنته، وما يرفع حاجته، كما في الروايات
والفتاوى. كما أن أمر سهم الإمام بيد الإمام أو المجتهد، وكذا سهم
السادة على بعض الفتاوى.
أما بالنسبة إلى الزكاة فليس الأمر كذلك، إذ يمكن
إعطاء مبالغ ضخمة منها لمستحقها، بحيث ينتقلون من الفقر إلى الغنى
دفعة واحدة.
ومن جهة ثانية،
فإن الخمس ـ إلى جانب أمور أخرى ـ قد ساهم مساهمة
فعالة في حفظ الدين على مدى التاريخ، فهو الذي حفظ ارتباط الناس
بالمرجعية الدينية، وساهم في بعث الثقة المتبادلة فيما بينهم
وبينها، وساعد الناس على التغلب على آثار إهمال، واضطهاد الحكام
لهم، وسد الكثير من حاجاتهم، وساهم في إنشاء المؤسسات التي تخدم
المجتمع، وترفع من مستواه روحياً، ومادياً وفكرياً، وجعل بإمكان
القيادة الدينية، وكذلك القاعدة الشعبية: أن تعيش حرة في تفكيرها،
وفي مواقفها، من دون ارتباط بالحاكم الجائر، أو خضوع له، ولم يعد
بإمكانه أن يمارس ضدهم أي ضغط يرونه في غير صالح الدين، ولا أن
يستعملهم أداة لتحقيق مآربه، والوصول إلى غاياته. فهم لا يستمدون
مكانتهم واعتبارهم، ولا لقمة عيشهم منه، ولا يفرض عليهم أي ارتباط
به، إلا في حدود الروابط العقيدية والدينية.
ومن هنا نعرف مدى تأثير الخمس في نجاح الثورة
الإسلامية الإيرانية، بقيادة زعيمها آية الله العظمى، والقائد
الديني السيد روح الله الموسوي الخميني (قده)، بالإضافة إلى
العوامل الأخرى، التي ساهمت أيضاً
في هذا النجاح.
ومن جهة ثالثة،
فإن حفظ هذا الدين يتطلب ذلك، إذ إنه يساهم في
إيجاد الشعور بالمسؤولية المباشرة عن حفظ هذا الدين والدفاع عنه
لدى فئة بعينها.
ومن الطبيعي أن تكون أقرب الفئات إلى الشعور بهذه
المسؤولية الكبرى هم أهل بيت النبي «صلى
الله عليه وآله»؛
بدافع من الشعور الطبيعي. ويزيد هذا الشعور ويذكيه، ويجعلهم أكثر
اندفاعاً
إلى التضحية في سبيله جعل هذا الخمس بمثابة ضمانة لهم، ولعوائلهم،
ووسيلة لتلبية حاجاتهم، التي تفرضها مسؤولياتهم تلك.
ومن هنا فإننا نجد حتى العقائد الفاسدة، والدعوات
المريبة، كالوهابية التي هي من أسخف العقائد، قد استطاعت
بالاستفادة من هذا النوع من العصبية أن تفرض وجودها، وتحتفظ
ببقائها؛ حيث وجدت من يعتبرون أن وجودهم مرهون بوجودها،
ورأوا أن العصبية لها والحفاظ عليها مما لا بد منه في بقاء ملكهم
وسلطانهم.
ومن ذلك كله يتضح أن العقيدة الحقة أولى بالاستفادة
من ذلك، ولكن في سبيل الخير والحق، فجاء هذا التدبير الإلهي ليحفظ
لها وجودها، ويساعد على بقائها، ويخفف من الأخطار الجسام التي سوف
تواجهها.
وقد رأينا:
أن المذاهب التي لم يرض عنها الحكام، حينما ووجهت
بأدنى مقاومة أو معارضة، كان مصيرها التلاشي والاندثار، لعدم وجود
ضمانات بقاء لها. أما مذهب أهل البيت، الذي هو رسالة الله الصافية،
فإن فيه الكثير من الضمانات التشريعية والعملية التي تساعد على
استمراره وبقائه في وجه أعتى القوى الظالمة، والحاقدة، حتى ولو
استمر الاضطهاد له ولأتباعه القرون والقرون، كما قد كان ذلك
بالفعل.
وليكن ذلك هو أحد الأدلة
على عظمة هذا الدين، وعلى شمولية وصفاء الإسلام الحنيف.
ألف:
طلحة، وسعيد بن زيد:
ويقولون هنا:
إن طلحة وسعيد بن زيد لم يحضرا بدراً، وذلك لأن
رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد أرسلهما ليتجسسا له خبر العير؛
فرجعا إلى المدينة بعد خروجه «صلى الله عليه وآله» إلى بدر، فخرجا
إليها، فوجداه قد عاد منها؛ فضرب لهما النبي «صلى الله عليه وآله»
بسهميهما من الغنائم([11]).
ولكن ذلك لا يصح، وذلك لما يلي:
1 ـ
إننا نجد نصاً
آخر يقول: إنهما كانا في تجارة إلى الشام، فقدما بعد رجوعه «صلى
الله عليه وآله» من غزوة بدر، فضرب لهما «صلى الله عليه وآله»
بسهميهما بعد رجوعهما([12]).
ولكن الشق الأخير من النص لا يصح، إذ لماذا يضرب
لهما بسهميهما دون سائر من تخلف؟!
وهل لمن لا يحضر غزاة حق في غنائم تلك الغزاة شرعاً؟!
وكيف رضي المسلمون إعطاء هذين الرجلين، دون غيرهما
ممن تخلف عن الحرب لعذر، أو لغيره؟!.
وإذا كان النبي «صلى الله عليه وآله» يتسامح مع
المسلمين في الأموال؛ فإنما كان يتسامح معهم بأمواله هو، لا بأموال
غيره. كما أنه كان يتسامح مع من حضر الحرب، دون من لم يحضر.
2 ـ
إن السيوطي ـ تبعاً
لغيره ـ لا يقر بهذه الفضيلة لهما، بل ينكرها على كل من عدا عثمان،
فهو يقول: وضرب لعثمان يوم بدر، ولم يضرب لأحد غاب غيره، رواه أبو
داود عن ابن عمر، قال الخطابي: هذا خاص بعثمان، لأنه كان يمرض ابنة
رسول الله «صلى الله عليه وآله»
([13]).
وحتى بالنسبة لعثمان فسنرى أن ذلك أيضاً لا يصح.
3 ـ
لقد جاء في حديث مناشدة علي «عليه السلام» لأصحاب
الشورى وفيهم طلحة وعثمان قوله: «أفيكم أحد كان له سهم في الحاضر،
وسهم في الغائب؟
قالوا:
لا»([14]).
ويمكن أن يكون إعطاؤه سهماً
في الغائب من جهة أنه يكون في مهمة قتالية حينئذٍٍ؛ أو أنه أعطاه
«صلى الله عليه وآله» من سهمه الذي كان يرده على المقاتلين. هذا
بالإضافة إلى أنه لم يتخلف إلا في غزوة تبوك.
فقد نص الزمخشري في فضائل العشرة على أنه «صلى الله
عليه وآله» جلس في المسجد يقسم غنائم تبوك، فدفع لكل واحد منهم
سهماً
ودفع لعلي كرم الله وجهه سهمين، ثم ذكر اعتراض زائدة بن الأكوع،
وجواب النبي «صلى الله عليه وآله» له بأن جبرائيل كان يقاتل في
تبوك، وأنه قد أمره بأن يعطي علياً «عليه
السلام»
سهمين([15]).
ونلاحظ هنا:
أن جعفر بن أبي طالب كان له أيضاً سهم في الحاضر،
وسهم في الغائب، فقد روي عن الإمام الباقر «عليه
السلام»
أنه قال: ضرب رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوم بدر لجعفر بن أبي
طالب بسهمه، وأجره([16]).
وذلك لا ينافي ما تقدم بالنسبة لعلي «عليه السلام»، فإن
الذين ناشدهم علي «عليه
السلام»
لم يكن فيهم غير علي له هذه الخصوصية، فلا يمنع أن يكون جعفر أيضاً
ـ الذي لم يكن معهم آنئذٍ، لأنه قد استشهد في مؤتة ـ قد كانت له
هذه الخصوصية أيضاً..
ويقولون:
إن الرسول «صلى الله عليه وآله» قد أسهم لعثمان بن
عفان في غنائم بدر، لأن الرسول «صلى الله عليه وآله» قد أمره
بالتخلف ليُمرِّضَ
زوجته رقية بنت رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فضرب له «صلى الله
عليه وآله» بسهمه وأجره، وعدوه من جملة البدريين([17]).
ونحن لا نصدق ذلك لما يلي:
1 ـ
ما تقدم من مناشدة علي «عليه السلام» لأصحاب
الشورى، وفيهم عثمان.
2 ـ
إن ثمة رواية أخرى تقول: إنه تخلف عن بدر، لأنه كان
مريضاً
بالجدري([18])،
فأي الروايتين نصدق؟!
3 ـ
لماذا يضرب له بسهمه، دون سائر من تخلف لعذر، وكيف
لم يعترض المسلمون المتخلفون على هذا الأمر، ويطالبونه بحقوقهم؛
وكيف رضي المسلمون المحاربون بذلك أيضاً؟ وهل كل من تخلف على مريض
يحق له أن يأخذ من الغنائم التي تحصل في الحرب التي لم يحضرها؟
4 ـ
إن بعض نصوص رواية عثمان تذكر: أن النبي «صلى الله
عليه وآله» قد خلف أسامة بن زيد مع عثمان لأجل رقية. وأنه ـ يعني
أسامة ـ قد كان له دور من نوع ما حينما جاء الخبر بانتصار المسلمين
في بدر، مع أن أسامة لم يكن له من العمر حينئذٍ أكثر من عشر
سنين!!. ولم يضرب له النبي «صلى الله عليه وآله» بسهمه كعثمان!.
5 ـ
إننا نجد: أن عبد الرحمن بن عوف يعيرِّ
عثمان بتخلفه عن بدر، فقد لقي الوليد بن عقبة؛ فقال له الوليد: ما
لي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان؟
فقال له عبد الرحمن:
أبلغه: أني لم أفر يوم عينين ـ قال عاصم: يقول: يوم
أحد ـ ولم أتخلف يوم بدر. ولم أترك سنة عمر.
فخبر الوليد عثمان.
فيقولون:
إنه اعتذر عن تخلفه يوم بدر بتمريضه رقية([19]).
وبمثل ذلك اعتذر ابن عمر ـ كما يقولون ـ لرجل كان
يعترض على عثمان بمثل ذلك([20]).
ولكن ما ذكر من الاعتذار لا يجدي؛ إذ كيف خفي هذا
العذر على صحابي كبير، كعبد الرحمن بن عوف، ثم على ذلك الرجل
الطاعن على عثمان؟!.
وإذ كان قد ضرب له بسهمه وأجره؛ فهذه فضيلة كبرى،
لا يمكن أن تخفى على ابن عوف الذي كان حاضراً
في بدر وأحد، لا سيما وأن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يوم
المؤاخاة قد آخى بين عبد الرحمن وعثمان، فكيف يعيره عبد الرحمن بما
هو فضيلة له، وهو الذي زف له الخلافة، وآثره بها على سيد وخير
الأمة بعد نبيها علي أمير المؤمنين «عليه السلام»؟!.
أم أنهم قد افتروا عليه في ذلك، وطعنوا عليه بما
كان الأجدر بهم أن يمتدحوه عليه؟!.
6 ـ
وحينما أشخص عثمان ابن مسعود من الكوفة، وقدم
المدينة، وعثمان يخطب على منبر رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
فلما رآه عثمان قال: ألا إنه قد قدمت عليكم دويبة سوء، من يمشي على
طعامه، يقيء، ويسلح.
فقال ابن مسعود:
لست كذلك، ولكن صاحب رسول الله «صلى الله عليه
وآله» يوم بدر، ويوم بيعة الرضوان([21])
فهو يعرض بعثمان الذي تغيب عن هذين الموطنين معاً.
7 ـ
وكذلك فقد دخل على سالم بن عبد الله رجل، فطعن على
عثمان بمثل ما تقدم من عبد الرحمن بن عوف، ومن ذلك الرجل مع ابن
عمر([22]).
فكيف خفيت هذه الفضيلة المزعومة لعثمان على هؤلاء
جميعاً يا ترى؟!
8 ـ
وأخيراً، فإننا نستبعد أن يكون «صلى الله عليه
وآله» قد خلفه على ابنته ليمرضها؛ فإن الظاهر: أن عثمان لم يكن
مهتما كثيراً لحال رقية، ولا لمرضها ـ وهو الذي قارف([23])
ليلة وفاتها ـ ومنعه رسول الله «صلى الله عليه وآله» من النزول في
قبرها كما سيأتي في بحث وفاة رقية إن شاء الله تعالى.
ونرجح:
أنه قد تخلف عن بدر في جملة من كرهوا الخروج مع
النبي «صلى الله عليه وآله». كما تقدم في أول الحديث عن بدر.
ثم إن ثمة رواية تقول:
إن أبا أمامة بن ثعلبة كان قد أجمع الخروج إلى بدر،
وكانت أمه مريضة، فأمره النبي «صلى الله عليه وآله» بالمقام على
أمه، وضرب له بأجره وسهمه، فرجع «صلى الله عليه وآله» من بدر، وقد
توفيت، فصلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» على قبرها([24]).
فنلاحظ أنه لا فرق بين هذه الرواية، وبين ما روي
بالنسبة لعثمان. فأي الروايتين قد حرفت وغيرت لصالح الرواية
الأخرى، وأبدلت الشخصيات فيها لصالح الآخرين؟!
وإننا بعد أن قدمنا ما في رواية عثمان من الإشكال؛
وبعد أن كان ثمة جهاز يهتم بوضع الفضائل لشيخ بني أمية، حتى ليكتب
معاوية إلى الآفاق
في ذلك، فإننا نرجح أن رواية أبي أمامة هي التي أغار محترفو
التحريف والتزوير عليها، ليعوضوا عثمان عما فاته من شرف حضور حرب
بدر، وليذهبوا بالسمعة السيئة التي أثارها موقفه من رقية، التي
ماتت من جراء ما صنعه بها. ثم قارف ليلة وفاتها، ولم يرع لها، ولا
لمن رباها ولا لولي نعمتها حرمة، ولا إلاً
ولا ذمة.
ولكن يبقى إشكال إعطاء النبي «صلى الله عليه وآله»
سهماً
من الغنائم لغير علي «عليه
السلام»
كما في حديث المناشدة السابق.
إلا أن يقال:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أعطاه من الخمس
الذي كان رده «صلى الله عليه وآله» عليهم، كما قدمنا.
أو أنه «عليه السلام» قد ناشد الحاضرين ومنهم عثمان
بذلك، فكلامه صحيح بالنسبة إليهم، أما غيرهم، كجعفر رحمه الله،
فليس في كلامه «عليه السلام» ما يثبت ذلك أو ينفيه عنه، كما تقدم.
وقد أُسر من المشركين سبعون رجلاً كما تقدم، وقيل:
واحد وسبعون رجلاً([25])
وتحرك «صلى الله عليه وآله» نحو المدينة، فلما بلغ الصفراء أمر
أمير المؤمنين علياً «عليه السلام» بأن يضرب عنق أسيرين هما: عقبة
بن أبي معيط، ذو السوابق السيئة المعروفة مع المسلمين والنبي «صلى
الله عليه وآله» في مكة، والنضر بن الحارث([26])،
الذي يعذب المسلمين في مكة.
وقيل:
بل قتل «صلى الله عليه وآله» ثلاثة أسرى: هم عقبة،
والنضر، والمطعم بن عدي([27]).
فقال عقبة:
يا محمد، ناشدتك بالله والرحم.
فقال له «صلى الله عليه وآله»:
وهل أنت إلا علج من أهل صفورية؟
وفي نص آخر:
أنه «صلى الله عليه وآله» قال له: وأنت من قريش؟ ما
أنت إلا علج ـ أو يهودي ـ من أهل صفورية، لأنت في الميلاد أكبر من
أبيك الذي تدعى له، حن قدح ليس منها، قدمه يا علي، فاضرب عنقه.
فقدمه علي؛ فضرب عنقه([28]).
وفي رواية:
أن عقبة قال أيضاً: يا محمد، من للصبية؟
قال:
النار([29]).
وعند السهيلي:
أن الذي قال: حن قدح ليس منها، هو عمر بن الخطاب([30]).
وقد كان لعقبة هذا موقف سيئ تجاه رسول الله «صلى
الله عليه وآله» قبل الهجرة؛ فأوعده رسول الله «صلى الله عليه
وآله» إن هو وجده خارجاً
من جبال مكة، أن يضرب عنقه صبراً([31]).
وهكذا كان.
ويلاحظ هنا:
إن سر قول النبي «صلى الله عليه
وآله» له:
إنه علج من أهل صفورية، هو أنهم يقولون: إن أمية جد
أبيه كان في صفورية، فوقع على أمة يهودية لها زوج، فولدت أبا عمرو
ـ وهو ذكوان ـ على فراش اليهودي، لكن أمية استلحقه بنفسه بحكم
الجاهلية.
وقيل:
كان ذكوان عبداً
لأمية، فتبناه؛ فلما مات أمية خلف ذكوان على زوجته.
وعند السهيلي:
يقال: كان أمية قد ساعى أمة، أو بغت له أمة؛ فحملت
بأبي عمرو؛ فاستلحقه بحكم الجاهلية([32]).
وقد قال الفضل بن العباس، مجيباً
الوليد بن عقبة بن أبي معيط على أبيات له:
أتطلب ثـاراً لـست منه ولا لـه
وأين ابن ذكوان الصفوري من عمرو؟
كـما اتصلت بنت الحمار بـأمهـا وتنسى أباهـا إذ
تســامى أولي الفخر([33])
وسأل معاوية دغفلاً
النسابة ـ وكان كبير السن ـ عن أمية جده، فقال: نعم، رأيته أخفش
أزرق دميماً،
يقوده عبده ذكوان.
فقال:
ويحك، كف؛ فقد جاء غير ما ذكرت، ذاك ابنه.
فقال:
أنتم تقولون ذلك([34]).
ولكن ما جاء في تفسير القمي، من قوله «صلى الله
عليه وآله» له: لأنت في الميلاد أكبر من أبيك، يدل على أن عقبة كان
من نطفة رجل آخر، وذلك الرجل من أهل صفورية؛ وأنه كان ينسب إلى أبي
معيط زوراً
وكذباً.
وقد قال الإمام الحسن «عليه
السلام»
للوليد بن عقبة، مثل كلمة الرسول «صلى الله عليه وآله» لأبيه عقبة؛
فراجع([35]).
ويقول الزمخشري:
«إن أبا معيط نفسه كان علجاً
من أهل صفورية، ومن الأردن، قدم به أبو عمرو بن أمية بن عبد شمس؛
فادعاه»([36]).
وحين أراد علي «عليه
السلام»
جلد الوليد في الخمر في عهد عثمان، فسبه الوليد، فقال له عقيل بن
أبي طالب: «يا فاسق، ما تعلم من أنت؟ ألست علجاً
من أهل صفورية؟ قرية بين عكا واللجون أعمال الأردن، كان أبوك
يهودياً
منها»([37]).
ونجد أنه «صلى الله عليه وآله» قد حكم بالنار
للصبية، الذين منهم الوليد الفاسق، الذي كان والياً
لعثمان على الكوفة؛ فشرب الخمر، وزادهم في الصلاة وهو سكران!! وهو
من الصحابة!!. فليتأمل إذاً في دعوى البعض عدالة كل صحابي، وقد
تكلمنا عن هذا الموضوع بصورة موجزة في بعض بحوثنا([38]).
ويعتبر قول النبي «صلى الله عليه وآله» هذا عن
الصبية بمثابة إخبار عن الغيب الذي أطلعه الله عليه، حيث عرفه
تعالى أنه ليس في أولئك الصبية أحد يستحق الكرامة والنعمة. ولكن قد
شاءت السياسة والعصبية تحكيم هؤلاء الصبية في أموال الناس وأعراضهم
ودمائهم، وجعلهم الحكام، والمخططين للسياسة في الخلافة المغتصبة من
أصحابها الشرعيين. ثم احتلوا مكاناً
عظيماً في عقائد الناس؛ حيث فرضوا على الناس لزوم الاعتقاد بعدالة
هؤلاء؛ مهما اجترحوا من السيئات وكانوا من الآثمين!!.
تقدم أن النبي «صلى الله عليه
وآله» قد قال لعقبة بن أبي معيط:
إنما أنت علج من أهل صفورية، أو نحو ذلك ـ مع أنه
«صلى الله عليه وآله» لم يكن سباباً
ولا فاحشاً،
ولا متفحشاً
ـ
، ولعل السبب في ذلك هو
من أجل أن يعلم الناس بعدم صوابية ما يدَّعيه،
وعدم صحة تقريب الهيئة الحاكمة لأبنائه، وقد ولتهم جلائل الأعمال،
على أساس هذه القربى المدعاة، وليجعلوا من ثم مال الله دولاً،
وعباده خولاً،
وليكونوا مصدراً
للفتن والمؤامرات، كما كان الحال بالنسبة للوليد الفاسق، وغيره من
الولاة والمقربين للهيئة الحاكمة باسم الدين والإسلام. على أن
حكمها لم يكن إلا حكم القبيلة والعشيرة، وحكم الجاهلية بالتعبير
الأدق والأوفى.
ويذكر ابن سلام:
أن ابن جعدبة الذي كان ينكر قتل أبي عزة الجمحي
صبراً:
«كان ينكر قتل النضر بن الحارث في يوم بدر صبراً،
فقال: أصابته جراحة؛ فارتث منها، وكان شديد المداوة، فقال: لا أطعم
طعاماً،
ولا أشرب شراباً
ما دمت في أيديهم، فمات.
فأخبرت أبي سلاماً بقول ابن
جعدبة في أبي عزة، فقال:
قد قيل: إن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يقتل
أحداً صبراً إلا عقبة بن أبي معيط يوم بدر»([39])،
ولكن هذا يخالف ما هو ثابت عن المؤرخين، ولا نرى داعياً للوضع
والاختلاق فيه.
ولذا فلا نرى للعدول عن النصوص التاريخية الثابتة
مبرراً
ولا مجالاً.
وأما بالنسبة لأبيات قتيلة أخت النضر بن الحارث
التي قالتها بهذه المناسبة، والتي فيها قولها مخاطبة للنبي «صلى
الله عليه وآله»:
مـا
كـان ضـرك لـو مننت وربــما مـن الـفـتـى وهـو
المغيـظ المحنق
وأن رسول الله «صلى الله عليه وآله» رق لها لما
أنشدته إياها ودمعت عيناه، وقال لأبي بكر: لو كنت سمعت شعرها ما
قتلته.
أما هذا فقد قال الزبير بن
بكار:
سمعت بعض أهل العلم يغمز في أبيات قتيلة بنت
الحارث، ويقول: إنها مصنوعة([40]).
أضف إلى ذلك:
أن ما نقل عن النبي «صلى الله عليه وآله» لا يعقل
أن يصدر منه، فإن هذه الأبيات لم تكن لتغير من تصميمه، وهو يمتثل
أمر الله، ولا يعمل إلا حسب ما يقتضيه التكليف الواجب.
ولعل المقصود هو تلطيف الجو بالنسبة للمنتسبين إلى
عقبة، وإعادة شيء من الاعتبار إليهم عن هذا الطريق.
قالوا:
ولما رأى الأنصار ما جرى للنضر ولعقبة، خافوا أن
يقتل «صلى الله عليه وآله» جميع الأسارى، فقالوا: يا رسول الله،
قتلنا سبعين، وهم قومك وأسرتك أتجذ أصلهم؟ هبهم لنا يا رسول الله،
وخذ منهم الفداء وأطلقهم.
وكان أبو بكر يرجح أخذ الفداء
أيضاً، وقال:
أهلك، وقومك،
استأن
بهم، واستبقهم، وخذ فدية تكون لنا قوة على الكفار.
أو قال:
هؤلاء بنو العم، والعشيرة، والإخوان.
فكره النبي «صلى الله عليه وآله» أخذ الفداء حتى
رأى ذلك سعد بن معاذ في وجهه، فقال: يا رسول الله، هذه أول حرب
لقينا فيها المشركين، والإثخان في القتل أحب إلينا من استبقاء
الرجال.
وقال عمر:
يا رسول الله، كذبوك، وأخرجوك؛ فقدمهم واضرب
أعناقهم، ومكن علياً من عقيل فيضرب عنقه، ومكني من فلان أضرب عنقه،
ومكن حمزة من العباس فيضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر.
ونزل في هذه المناسبة قوله تعالى:
{مَا
كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي
الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ
وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّهِ سَبَقَ
لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}([41]).
ولما رأى النبي «صلى الله عليه وآله» إصرارهم على
أخذ الفداء أخبرهم: أن أخذ الفداء سوف تكون عاقبته هو أن يقتل من
المسلمين بعدد الأسرى، فقبلوا ذلك وتحقق ما أوعدهم به «صلى الله
عليه وآله» في واقعة أحد، كما سنرى([42]).
وتقرر الأمر على الفداء، وجعل فداء كل أسير من ألف
إلى أربعة آلاف، وصارت قريش تبعث بالفداء أولاً بأول. وأعطى «صلى
الله عليه وآله» كل رجل من أصحابه الأسير الذى أسر، فكان هو يفاديه
بنفسه([43]).
وفي بعض النصوص:
أن سهيل بن عمرو جاء بفداء أسرى بدر، فطلب منه «صلى
الله عليه وآله» أن يخبره بما تريد قريش في غزوه([44]).
هذا بعض ما نطمئن إلى صحته من النصوص التاريخية
هنا.
ولكننا نجد روايات أخرى تقرر
عكس ما ذكر آنفاً، وتقول:
إنه «صلى الله عليه وآله» مال إلى رأي أبي بكر، بل
وانزعج من مشورة عمر، فنزل القرآن بمخالفته
وموافقة عمر، فلما كان من الغد، غدا عمر على رسول الله، فإذا هو
وأبو بكر يبكيان؛ فسأل عن سبب ذلك، فقال الرسول «صلى الله عليه
وآله»: إن كاد ليمسنا في خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم، لو نزل عذاب
ما أفلت منه إلا ابن الخطاب.
وعن ابن عباس، عن ابن عمر؛ أنه
«صلى الله عليه وآله» قال:
أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض
علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، وأنزل الله:
{مَا
كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي
الأَرْضِ..}([45]).
ونحن لا نصدق ما ذكر آنفاً، ولدينا من الأدلة ما
يكفي لإثبات بطلانها. ولعل هذه الروايات هي التي جرأت بعض الجهلة
الأفاكين ممن ينتحل الإسلام، ليكتب ويقول: قد أخطأ الرسول في موقفه
من
أسرى
بدر، ونزل الوحي مصححاً
خطأه.
قال تعالى:
{مَا
كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي
الأَرْضِ}([46]).
ومستندنا في تكذيب ذلك كله ما يلي:
أولاً:
لماذا ما نجا من العذاب إلا عمر؟
وما ذنب سعد بن معاذ ليعذب؟
أليس هو من الموافقين لعمر، كما نص عليه غير واحد،
بل كان هو المبتدئ بهذا الرأي على حد تعبير المعتزلي؟([47])
وما ذنب ابن رواحة؟ أليس هو من الموافقين لعمر
أيضاً؟([48]).
ولا يعقل أن يكون قوله تعالى:
{تُرِيدُونَ
عَرَضَ الدُّنْيَا}([49]).
وقوله:
{لَمَسَّكُمْ
فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}([50])
خطاباً
للنبي «صلى الله عليه وآله»؛ إذ لم يكن «صلى الله عليه وآله» طالباً
لعرض الدنيا، ولا مستحقاً
لذلك العذاب العظيم؛ لأن معنى ذلك هو أن الله تعالى قد أمره بأمر،
وبينه له، ثم خالفه، والعياذ بالله، فإن الالتزام بهذا هو من أعظم
العظائم، وجريمة من أكبر الجرائم([51]).
ومما يدل على أن الله تعالى قد
أبلغ نبيه أن اللازم هو قتل الأسرى:
«أن حل الفداء كان قد علم من واقعة عبد الله بن
جحش، التي قتل فيها ابن الحضرمي؛ فإنه أسر فيها عثمان بن المغيرة،
والحكم بن كيسان، ولم ينكره الله تعالى. وذلك قبل بدر بأزيد من
عام»([52]).
ومعنى ذلك أنه قد كانت ثمة أوامر خاصة بالنسبة
لأسرى بدر بينها النبي «صلى الله عليه وآله» لأصحابه، ولكنهم قد
أصروا على مخالفتها، فاستحقوا العذاب العظيم، ثم عفا الله عنهم،
رحمة بهم، وتألفاً
لهم.
ويدل على ذلك أيضاً:
أنه قد جاء في بعض النصوص: «أن جبرائيل نزل على
النبي «صلى الله عليه وآله» يوم بدر، فقال: إن الله قد كره ما صنع
قومك، من أخذ الفداء من الأسارى.
وقد أمرك أن تخيرهم:
بين أن يقدموهم ويضربوا أعناقهم، وبين أن يأخذوا
الفداء على أن يقتل منهم عدتهم.
فذكر ذلك «صلى الله عليه وآله»
لأصحابه، فقالوا:
يا رسول الله، عشائرنا وإخواننا([53]).
بل نأخذ فداءهم، فنتقوى به على عدونا، ويستشهد منا عدتهم»([54]).
فما تقدم يدل على أن تخييرهم هذا إنما كان بعد
تأكيدهم على رغبتهم في أخذ الفداء، وظهور إصرارهم عليه، فأباح لهم
ذلك.
وبعد ما تقدم نقول:
لقد نص البعض على أن النبي «صلى الله عليه وآله»
مال إلى القتل([55]).
وذكر الواقدي أن الأسرى قالوا:
لو بعثنا لأبي بكر، فإنه أوصل قريش لأرحامنا، ولا
نعلم أحداً آثر عند محمد منه؛ فبعثوا إليه فجاءهم فكلموه، فوعدهم
أن لا يألوهم خيراً،
ثم ذهب إلى النبي «صلى الله عليه وآله» فجعل يفثؤه ويلينه، وعاوده
بالأمر ثلاث مرات، كل ذلك والنبي «صلى الله عليه وآله» لا يجيب([56]).
وبعد ما قدمناه فهل يصح قولهم:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد جلس يبكي على
نفسه مع أبي بكر، وأنه لو نزل العذاب لم ينج منه سوى عمر بن
الخطاب؟!.
ثانياً:
لو سلمنا أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يميل
إلى رأي أبي بكر من أول الأمر، وأنه جلس يبكي مع صاحبه ـ كما ذكروه
في مصادرهم ـ فلماذا يقول لعمر: لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه
الشجرة. إذ كيف لا يكون هو مع من استحق العذاب، وهو الذي وافقهم،
وهوي ما هويته نفوسهم؟!
وثالثاً:
إن الالتزام بما ذكروه معناه تكذيب قوله تعالى:
{وَمَا
يَنطِقُ عَنِ الهَوَى، إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى}([57]).
كما أنه لا يبقى معنى ـ والحالة هذه ـ لأمر الله
تعالى للناس بإطاعة الرسول «صلى الله عليه وآله»،
حيث قال:
{أَطِيعُواْ
اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ}([58])
حتى إذا امتثلوا الأمر الإلهي وأطاعوه يؤنبهم، ثم يتهددهم. لقد كان
يجب أن يتوجه التأنيب والتهديد للرسول «صلى الله عليه وآله»،
والمدح والثناء لهم، لأنهم عملوا بوظيفتهم.
ورابعاً:
إن مجرد الإشارة على الرسول بالفداء لا تستوجب
عقاباً،
إذ غاية ما هناك: أنهم قد اختاروا غير الأصلح. وإذاً، فلا بد أن
يكون ثمة أمر آخر قد استحقوا العقاب لمخالفته، وهو أنهم حين أصروا
على أخذ الفداء قد أصروا على مخالفة الرسول، والتعلق بعرض الحياة
الدنيا في مقابل إرادة الله للآخرة ـ كما قال تعالى:
{تُرِيدُونَ
عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ}([59])
ـ بعد بيان النبي «صلى الله عليه وآله» لهم بصورة صريحة، إذ لا
عقاب قبل البيان، ثم المخالفة.
ولكن الله تكرم وتفضل عليهم، وغفر لهم هذه
المخالفة، وأباح لهم أخذ الفداء تأليفاً
لهم، على ما فيه من عواقب وخيمة. وقد بلغ من حبهم لعرض الدنيا أنهم
قبلوا بهذه العواقب أيضاً.
بل يمكن أن يكون إصرار بعض المهاجرين على أخذ
الفداء يرجع إلى أنهم قد صعب عليهم قتل صناديد قريش، حيث كانت
تربطهم بهم صداقات ومصالح ووشائج رحم، وقد استهوى موقفهم هذا جماعة
من البسطاء والسذج من سائر المسلمين الحاضرين.
فهذا التعاطف مع المشركين من قبل البعض، ثم حب
الحصول على المال، قد جعلهم يستحقون العذاب العظيم، الذي إنما
يترتب على سوء النيات، وعلى الإصرار على مخالفة الرسول، والنفاق في
المواقف والأقوال والحركات، لا سيما مع وجود رأي يطالب بقتل بني
هاشم الذين أخرجهم المشركون كرهاً
ونهى الرسول «صلى الله عليه وآله» عن قتلهم.
مع ملاحظة:
أنه لم يشترك من قوم صاحب ذلك الرأي أحد في حرب
بدر.
وأما الخطأ في الرأي مجرداً
عما ذكرناه فلا يوجب عقاباً.
وثمة كلام آخر في تفسير آخر([60])
قد أضربنا عن ذكره لعدم استقامته.
وخامساً:
إنه قد جاء: أنه لما كان يوم بدر تعجل الناس من
المسلمين؛ فأصابوا من الغنائم، فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»: لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم، كان النبي ـ يعني من
السابقين ـ إذا غنم هو وأصحابه جمعوا غنائمهم، فتنزل نار من السماء
على كلها. فأنزل الله عز وجل:
{لَّوْلاَ
كِتَابٌ مِّنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ، فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً}([61])
وقد قوى الطحاوي هذه الرواية في شأن نزول الآية فراجع([62]).
الرسول
 يخطئ
في الاجتهاد.
يخطئ
في الاجتهاد.
وبعد بطلان ما ذكروه ونسبوه إلى النبي «صلى الله
عليه وآله»، وبطلان أن تكون الآية عتاباً
له «صلى الله عليه وآله»، يعلم عدم صحة استدلالهم بهذه الآية على
جواز الاجتهاد والخطأ فيه على النبي «صلى الله عليه وآله»؛ فإن
النبي «صلى الله عليه وآله» لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
وما نسبوه إلى النبي «صلى الله عليه وآله» باطل ولا يصح. هذا عدا
عن الأدلة القاطعة الدالة على أن كل ما يصدر منه «صلى الله عليه
وآله» حق، وموافق للحق والشرع، ووفق أوامر إلهية قاطعة.
لقد روى الطبري عن محمد بن
إسحاق، قال:
لما نزلت هذه الآية:
{مَا
كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى}([63]).
قال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
لو نزل عذاب من السماء لم ينج إلا سعد بن معاذ،
لقوله: يا رسول الله، الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال([64]).
ولعل هذا هو الصحيح؛ ولكن قد حرف لصالح الخليفة
الثاني عمر بن الخطاب، لأهداف لا تخفى.
وإنما قلنا:
إنه هو الصحيح؛ لأنه أسد الآراء، وهو الموافق لمراد
النبي «صلى الله عليه وآله»، أما رأي عمر، فقد كانت تعوزه الدقة
والموضوعية، كما سنرى إن شاء الله، وكذلك سائر الآراء، فإنها لم
تكن صادرة عن نوايا سليمة، ولعلها أو بعضها كانت بإيحاء وطلب من
المشركين أنفسهم، كما تقدم عن الواقدي.
وأما أبو بكر وغيره من الأنصار، فقد تقدم أنهم
أصروا على أخذ الفداء، طمعاً
بالمال، وطمعاً
في أن يخففوا من حدة عداء قريش لهم. وأيضاً
لأن فيهم الإخوان والأهل والعشيرة ـ على حد تعبير أبي بكر ـ ولأن
هذا الأخير قد وعد الأسرى بأن يبذل جهده لصالحهم، كما تقدم عن
الواقدي.
وقد حاولوا أن يقنعوا النبي «صلى الله عليه وآله»
بوجهة نظرهم، ولو بالأساليب العاطفية، كقولهم له: «أهلك، وقومك،
وأسرتك، أتجذ أصلهم». كما أن أبا بكر قد أقام دليلاً مصلحياً
على ذلك، وهو أن يتقوى المسلمون بما يأخذونه من الفداء.
ولكن النبي «صلى الله عليه وآله» ظل يكره ذلك، ولا
تقنعه أقوالهم؛ فإن رأي ابن معاذ هو الصحيح، مضافاً
إلى اعتبارات أخرى، لم تكن لتخفى على النبي الأعظم «صلى
الله عليه وآله».
ونزلت الآية الشريفة لتصوب موقف الرسول «صلى الله
عليه وآله»، ثم ترخص لهم في أخذ الفداء، بعد أن قبلوا بالعواقب
الوخيمة لذلك، حتى بأن يقتل منهم بعدد من يفدى من المشركين.
لا شك في أن الأصوب كان قتل
أسرى المشركين، وذلك للأمور التالية:
1 ـ
إن المأسورين كان فيهم عدد من سادات قريش، ومن هم
رأس الأفعى، وقد حاربوا الرسول «صلى
الله عليه وآله»
والمسلمين، وأخرجوهم من ديارهم، وواجهوهم بشتى أنواع الإهانات
والأذى، وهؤلاء الناس هم المستكبرون الذين لا يرتدعون ولا يرجعون
إلى دين، بل يصرون على استئصال شأفة الإسلام ولا يقبلون بأي خيار
منطقي يعرض عليهم.
وبعد الذي نالهم من ذل الهزيمة، وذل الأسر، قد
أصبحوا أكثر حقداً
على الإسلام والمسلمين. ولسوف يعاني المسلمون منهم ـ لو بقوا أحياء
ـ الأمرين حسبما أشار إليه «صلى الله عليه وآله»، حيث أوعد
المسلمين إن هم فادوهم: أن يقتل منهم بعددهم.
2 ـ
وقد ظهر صحة ذلك، من الدور الهام الذي كان لهم بعد
ذلك في وقعة أحد وغيرها، الأثر البارز في إلحاق الأذى بالمسلمين
باستمرار في المراحل المختلفة. وما أحسن قول سعد بن معاذ: «إنها
أول حرب لقينا فيها المشركين، والإثخان في القتل أحب إليَّ
من استبقاء الرجال».
ويرى البعض:
أن الله تعالى يريد بالتأكيد على قتل الأسرى: «أن
يفهم المسلمين: أن النظرة إلى المال مرفوضة، مهما كانت الظروف، إلا
إذا كانت في خدمة الهدف الأعظم وهو الدين».
3 ـ
إن قتلهم جزاء أعمالهم إن لم يقبلوا الإسلام يكون
أيضاً ضربة عسكرية وروحية موفقة لقريش، وإضعافاً
لشوكة المشركين بصورة عامة، وتشريداً
لمن خلفهم من اليهود ومن مشركي العرب، من غطفان، وهوازن، وثقيف،
وغيرهم.
وقد اتضح للجميع أنه إذا كان النبي «صلى الله عليه
وآله» لا يحابي قومه على حساب دينه وعقيدته، وقد قتلهم؛ لأنهم
أرادوا أن يمنعوه من أداء رسالته، ويطفئوا نور الله؛ فإنه سوف لا
يحابي غيرهم، إذا أرادوا أن يطفئوا نور الله، وأن يقفوا في وجه
دعوته ودينه.
وهذا سوف يؤثر في بث اليأس في قلوب اليهود، وقريش
والمشركين في جزيرة العرب كافة، ولسوف يسهل على النبي «صلى الله
عليه وآله»: أن يقنعهم بأن من الأفضل لهم أن يتركوا محاولاتهم
العدوانية جانباً؛
فإن الوقوف في وجه الدعوة سوف لا يكون حصاده إلا الدمار والفناء
لهم.
4 ـ
ثم إن قتلهم سوف يطمئن الأنصار إلى أن النبي «صلى
الله عليه وآله» سوف لن يصالح قومه، ولن يعود إليهم ما داموا مصرين
على شركهم. وبالتالي
فهو لن يترك الأنصار ولن يتخلى عنهم، لأنه يعتبر ـ
انطلاقاً
من تعاليم دينه ـ أن رابطة الدين هي الأقوى، ولا قرابة فوق قرابة
العقيدة، ولا نسب ولا رحم فوق نسب الإسلام والإيمان.
ولذلك فلا مجال لأن تساور الوساوس والمخاوف نفوس
الأنصار، وهي ما عبروا عنه في بيعة العقبة، وبعد ذلك في فتح مكة،
من أنه ربما يصالح قومه، أو ربما أدركته رغبة في قومه.
إننا نلاحظ:
1 ـ
أن عمر بن
الخطاب
يطلب من النبي «صلى الله عليه وآله»: أن يضرب علي «عليه السلام»
عنق أخيه عقيل، ويضرب حمزة عنق أخيه العباس، ويعتبرهم أئمة الكفر.
وهو طلب غريب حقاً:
كما أن سكوته عن فراعنة وزعماء قريش أغرب وأعجب!!
ولا سيما وهو يسمع الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» يأمر الجيش
ـ وعمر من ومع الجيش ـ بعدم قتل بني هاشم وهؤلاء بالذات، وبعض من
غيرهم، لأنهم خرجوا مكرهين. هذا عدا عن أنه كان يعرف دفاعهم عن
النبي «صلى الله عليه وآله» في مكة، ودخولهم معه الشعب، وتحملهم
المشاق والمتاعب في سبيله.
2 ـ
قد تقدم: أنه لم يشهد معركة بدر أحد من بني عدي([65])
وهم قبيلة عمر، إذاً فلسوف تكون الضربة في جلد غيره؟. وماذا يهم لو
قتل الناس كلهم ما دام هذا الرجل لا يخاف على قومه وأهله.
ومن هنا نعرف:
أن ما أضافه بعضهم، حين ذكره لقول عمر: ومكني من
فلان، فأضاف كلمة: «قريب لعمر»، كما يظهر من مراجعة الروايات التي
تذكر كلام عمر هذا.
لا يصح، إذ لم يكن أحد من أقارب عمر في بدر، إلا
إذا كانت قرابة من ناحية النساء، وهي ليست بذات أهمية لديهم آنئذٍ
لو كانت.
وعلى كل حال، فقد سبقنا العباس بن عبد المطلب رضي
الله عنه إلى إساءة الظن بعمر من هذه الناحية، وذلك حين فتح مكة،
حتى إنه ليقول له ـ حين أكثر في شأن أبي سفيان، وأصر على قتله ـ:
«لا، مهلاً
يا عمر، أما والله، أن لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا،
ولكنك عرفت: أنه من رجال بني عبد مناف»([66]).
3 ـ
إن من الواضح: أن قتل الأقارب أمر مستبشع، تنفر منه
النفوس، ولربما يوجب ذلك ابتعاد الناس عن الإسلام، ومنعهم حتى من
التفكير في الدخول في دين يكلفهم بمباشرة قتل إخوانهم. بل وقد يدفع
ضعفاء النفوس من المسلمين إلى الارتداد، إذا رأوا أنفسهم مكلفين
بقتل أحبائهم وآبائهم بأيديهم، مع إمكان أن يقوم غيرهم بهذا الأمر.
النبي
 لا يقتل أسيراً
هرب:
لا يقتل أسيراً
هرب:
قال الواقدي:
إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لما أقبل من بدر
ومعه أسارى المشركين، كان من بينهم سهيل بن عمرو مقروناً
إلى ناقة النبي «صلى الله عليه وآله»، فلما صار من المدينة على
أميال اجتذب نفسه فأفلت، وهرب، فقال «صلى الله عليه وآله»: من وجد
سهيل بن عمرو فليقتله، وافترق القوم في طلبه، فوجده النبي «صلى
الله عليه وآله» فأعاده إلى الوثاق ولم يقتله.
وقد علل الشريف الرضي رحمه الله ذلك، بأن الآمر لا
يدخل تحت أمر نفسه، لأن الآمر فوق المأمور في الرتبة أو يستحيل أن
يكون فوق نفسه([67]).
ونقول:
إن كلام الرضي صحيح بالنسبة إلى شمول الإنشاء لنفس
الآمر،
ولكن يبقى: أن ملاك الأمر بقتل سهيل إذا كان موجوداً،
فلماذا لم يبادر النبي «صلى الله عليه وآله» إلى قتله، ولو بأن
يأمر بعض أصحابه بذلك؟ إذ إن الرسول «صلى الله عليه وآله» لم يكن
ليقتل أحداً بيده الشريفة، حسبما ستأتي الإشارة إليه.
فلا بد من القول بأن وجدان الرسول «صلى الله عليه
وآله» له دونهم، قد جعل من غير المصلحة أن يقتل ذلك الرجل.
وعلى كل حال،
فقد كان من جملة الأسرى عباس وعقيل. وقد سهر النبي
«صلى الله عليه وآله» ليلة، فقال له بعض أصحابه: ما يسهرك يا نبي
الله؟
قال:
أنين العباس.
فقام رجل من القوم؛ فأرخى من وثاقه، فقال رسول الله
«صلى الله عليه وآله»: ما بالي ما أسمع أنين العباس؟
فقال رجل من القوم:
إني أرخيت من وثاقه شيئاً.
فقال:
«فافعل ذلك بالأسارى كلهم»([68]).
وهذه هي الرواية القريبة والمعقولة، التي تمثل عدل
النبي «صلى الله عليه وآله» ودقته في مراعاة الأحكام الإلهية،
وصلابته في الدين. وهي المناسبة لمقامه الأسمى، وما عرف عنه من
كونه لا تأخذه في الله لومة لائم. لا تلك الروايات التي تمثل النبي
«صلى الله عليه وآله» متحيزاً
إلى أقاربه، وأنه هو الذي طلب منهم أن يرخوا من وثاق العباس فقط؛
فإن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يكن ليرفق بأقاربه، ويعنف
بغيرهم. والرواية التي تقول هذا لم ترد على الوجه الصحيح والكامل.
إلا أن يقال:
إن علم النبي «صلى الله عليه وآله» بأنه قد خرج
مكرهاً،
فكان ذنبه أخف من ذنب غيره، يبرر أن يتصرف تجاهه بهذا النحو.
ونقول:
إن الأمر وإن كان كذلك إلا أن النبي «صلى الله عليه
وآله» وعدله إنما يقتضيان أن يعامل العباس كغيره من الأسرى ولا
يفسح أي مجال للإيراد والإشكال. ولذلك نرى أنه لما قال له العباس
إنه خرج مستكرهاً،
قال له النبي«صلى الله عليه وآله» : «أما ظاهر أمرك فقد كنت علينا»
كما سيأتي عن قريب.
والظاهر:
أن مكان العباس كان قريباً من النبي «صلى الله عليه
وآله»، فمنعه أنينه من الراحة، لا أنه كان يعطف عليه خاصة دون غيره
من الأسرى.
وغنم المسلمون من العباس عشرين أو أربعين أوقية
ذهباً
ـ والأوقية أربعون مثقالاً
ـ فطلب أن تحسب من فدائه. فقال «صلى الله عليه وآله»: فأما بشيء
خرجت تستعين به علينا؛ فلا نتركه لك.
قالوا:
وذلك لأنه خرج بها ليطعم بها المشركين([69]).
وأمره «صلى الله عليه وآله» بمفاداة نفسه، وعقيلاً،
ونوفل ابني أخيه؛ فأنكر أن يكون له مال.
فقال له «صلى الله عليه وآله»:
أعط ما خلفته عند أم الفضل، فقلت لها: إن أصابني
شيء، فأنفقيه على نفسك وولدك. فسأله من أخبره بهذا، فلما عرف أنه
جبرائيل قال: محلوفة([70])،
ما علم بهذا أحد إلا أنا وهي، أشهد أنك رسول الله.
فرجع الأسارى كلهم مشركين، إلا العباس وعقيلاً
ونوفل كرم الله وجوههم، وفيهم نزلت هذه الآية.
{قُل
لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي
قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}([71]).
وفي نص آخر:
أنه «صلى الله عليه وآله» قال للعباس: يا عباس،
إنكم خاصمتم الله فخصمكم([72]).
وفي رواية أخرى:
أنه لما طلب منه الفداء ادعى: أنه كان قد أسلم، لكن
القوم استكرهوه.
فقال له «صلى الله عليه وآله»:
الله أعلم بإسلامك، إن يكن ما تقول حقاً؛
فإن الله يجزيك عليه، فأما ظاهر أمرك فقد كنت علينا([73]).
وهذا يدل على أنه لا مجال
لدعوى:
أن العباس كان قد أسلم قبل بدر سراً،
كما عن البعض([74]).
إلا إذا أراد أن يستند في ذلك إلى دعوى العباس نفسه، وهي دعوى لم
يقبلها منه رسول الله «صلى الله عليه وآله».
ومما يدل على أنه لم يكن في بدر
مسلماً عدا ما تقدم:
أنه لما أسر يوم بدر أقبل المسلمون عليه، يعيرونه
بكفره بالله، وقطيعة الرحم، وأغلظ له علي القول: فقال العباس: ما
لكم تذكرون مساوينا، ولا تذكرون محاسننا؟
فقال له علي:
ألكم محاسن؟
قال:
نعم، إنا لنعمر المسجد الحرام، ونحيي الكعبة، ونسقي
الحاج، ونفك العاني.
فأنزل الله تعالى:
{مَا
كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ
عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ}([75]).
وفي رواية أخرى:
أنه قال: لئن سبقتمونا بالإسلام والجهاد والهجرة،
لقد كنا نعمر المسجد الحرام، ونسقي الحاج؛ فأنزل الله تعالى:
{أَجَعَلْتُمْ
سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ
آمَنَ بِاللّهِ}
الآية([76]).
ولكن هذه الآية، والآية السابقة، في الرواية
المتقدمة هما في سورة التوبة، التي نزلت في أواخر سني حياته «صلى
الله عليه وآله» أي بعد بدر بعدة سنوات.
فلعل ما ذكرته الروايتان لم يكن في بدر، بل كان يوم
فتح مكة، ويكون تصريح الرواية السابقة ببدر من اشتباه الرواة.
لكن يرد على ذلك:
أن العباس لم يؤسر يوم الفتح، فلماذا يغلظ له علي «عليه
السلام»؟
إلا أن يقال:
لعل ذلك قد كان قبل إعلان النبي «صلى الله عليه
وآله» بالكف، وإعطاء الأمان لهم.
وفي نص آخر:
أن الأنصار كانوا يريدون قتل العباس؛ فأخذه الرسول
منهم، «فلما صار في يده: قال له عمر: لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم
الخطاب، وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله يعجبه إسلامك»([77]).
بل لقد جاء أنه لم يظهر للعباس إسلام إلا عام الفتح([78]).
وهذا التعبير هو الأقرب إلى الصواب؛ فإنه إن كان قد
أسلم في بدر: كما يدل عليه ما تقدم، ولا سيما رواية تفسير البرهان
المعتبرة سنداً.
فإنما أسلم سراً،
وكان يتظاهر للمشركين بما يرضيهم، حفاظاً
على مصالحه، وأمواله، وعلاقاته، فإن قريشاً لم تكن تتحمل وجود مسلم
بينها هذه السنوات الطويلة، وحروبها مع محمد قائمة على قدم وساق،
يقتل
أبناءها
وإخوانها، ويعور عليها طريق متجرها، ويذلها بين العرب، ولا سيما
إذا كان ذلك المسلم هو عم ذلك الرجل وقريبه.
وصداقته مع أبي سفيان لم تكن لتسمح له بالبقاء في
مكة، فإن القرشيين قد نكلوا بأحبائهم فكيف يسكتون عن أصدقائهم؟
وشروط قريش على النبي «صلى الله عليه وآله» في الحديبية أدل دليل
على شدتها في هذا الأمر، وعدم تسامحها فيه على الإطلاق.
نعم، ربما يقال:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أمره بالمقام بين
أظهرهم ليكون عيناً
له.
ويقال:
إنه كان يكتب للنبي «صلى الله عليه وآله» بأخبارهم،
وقد أخبره بحرب أحد على ما يظن. ولكن ذلك لا يدل على إسلام العباس،
نعم،
هو يدل على نصحه لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولو بدافع الرحم
والحمية، فلا بد أن يعرف الرسول «صلى الله عليه وآله» ذلك له،
ويكافئه عليه.
إشـارة:
وما دمنا في الحديث عن العباس، فلا بأس بالإشارة
إلى أن من الملاحظ: أنه كان يهتم في المال، ويحب الحصول عليه.
ولقد رأيناه يطالب النبي «صلى الله عليه وآله»
بالمال، لأنه أعطى فداءه وفداء عقيل في بدر. فقد جاء: أنه جاء
النبي «صلى الله عليه وآله» مال من البحرين، وصار يقسمه، فجاء
العباس، فقال: «يا رسول الله، إني أعطيت فدائي، وفداء عقيل (رض)
يوم بدر، ولم يكن لعقيل مال، أعطني هذا المال». فأعطاه «صلى الله
عليه وآله»([79]).
وتضيف بعض الروايات:
أنه «صلى الله عليه وآله» ما زال يتبعه بصره «حتى
خفي علينا عجباً
من حرصه»([80]).
وليلاحظ أسلوبه للحصول على بقية من المال، بقيت بعد
القسم بين الناس في الرواية التالية:
أخرج ابن سعد:
أنه بقي في بيت مال عمر شيء، بعدما قسم بين الناس،
فقال العباس لعمر وللناس: أرأيتم، لو كان فيكم عم موسى «عليه
السلام»
أكنتم تكرمونه؟
قالوا:
نعم.
قال:
فأنا أحق به، أنا عم نبيكم «صلى الله عليه وآله».
فكلم عمر الناس؛ فأعطوه تلك البقية التي بقيت([81]).
وعلى كل حال،
فقد حصل على ما كان يتمناه، حتى لينقلون عنه قوله
حينما أعطاه «صلى الله عليه وآله»: أما أحد ما وعد الله فقد أنجز
لي، ولا أدري الأخرى:
{قُل
لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي
قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ}([82])
هذا خير مما أخذ مني، ولا أدري ما يصنع بالمغفرة([83]).
وكان قد أسر لعمير بن وهب ولد، فاتفق عمير مع صفوان
بن أمية سراً
على أن يقدم عمير المدينة، ويغتال النبي «صلى الله عليه وآله» في
مقابل أن يقضي صفوان دين عمير.
وتكاتما على هذا الأمر، وشحذ عمير سيفه وسمه، وقدم
المدينة؛ فأذن له الرسول بالدخول، فخاف منه عمر؛ فأخذ بحمالة سيفه
في عنقه، ثم دخل به على الرسول.
فلما رآه «صلى الله عليه وآله»
قال لعمر:
أرسله يا عمر. فأرسله، فاستدناه، ثم سأله عما جاء
به؛ فقال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم ـ يعني وهباً
ـ فأحسنوا فيه.
فقال «صلى الله عليه وآله»:
فما بال السيف؟
قال:
قبحها الله من سيوف، وهل أغنت شيئاً؟!
فأخبره «صلى الله عليه وآله» بما جرى بينه وبين
صفوان في الحجر؛ فأسلم عمير.
فقال «صلى الله عليه وآله»:
فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا
أسيره، ففعلوا ذلك.
ثم لحق عمير بمكة يدعو إلى الله، ويؤذي المشركين
بإذن منه «صلى الله عليه وآله»، وحلف صفوان ألا يكلمه، ولا ينفعه
بنافعة([84]).
وبعثت زينب بنت الرسول «صلى الله عليه وآله» ـ بل
ربيبته ـ بفداء زوجها أبي العاص بن الربيع، وكان من جملة ما بعثت
به قلائد كانت خديجة جهزتها بها.
فترحم الرسول «صلى الله عليه وآله» على خديجة، ورق
لزينب رقة شديدة، وطلب من المسلمين أن يطلقوا لها أسيرها؛ ففعلوا.
وأطلقه «صلى الله عليه وآله» مقابل أن يرسل إليه زينب بسرعة. فوفى
بما وعد وأرسلها([85])،
وجرى لها حين هجرتها ما سوف نشير إليه فيما يأتي إن شاء الله
تعالى.
ويرد هنا سؤال:
هل كان النبي «صلى الله عليه وآله» عاطفياً
حقاً
إلى حد تدفعه رقته إلى إطلاق أسير كان يمكن للمسلمين أن يساوموا
عليه، ويحصلوا على ما يقويهم ضد عدوهم؟!
وهل مجرد تربيته لزينب تكفي لهذا الموقف المتميز له
منها؟
وهل كان يرغب في مراعاة جانب من يمت إليه بصلة أكثر
من الآخرين؟
وهل هذا ينسجم مع رسالته وسجاياه وأخلاقه؟!
الجواب:
لا، فإن ثمة مصلحة في هذا الموقف، تعود على الإسلام
والمسلمين بالنفع وبالخير العميم. وإلا لكان موقفه «صلى الله عليه
وآله» من هؤلاء لا يختلف عن موقفه من غيرهم، ممن على شاكلتهم.
وموقفه من عمه أبي لهب لعنه الله ليس بعيداً
عن أذهاننا. وكذا موقفه من عمه العباس.
ونرى:
أن في موقف النبي «صلى الله عليه وآله» هنا تأكيداً
على أن الإسلام يحترم ويقدر مواقف الآخرين وخدماتهم. وخديجة من
هؤلاء الذين استحقوا منه هذا التقدير، فكان منه «صلى الله عليه
وآله» هذا الموقف ممن تحبهم خديجة.
وكان «صلى الله عليه وآله» يهتم بإكرام صديقات
خديجة، فكان «صلى الله عليه وآله» يرسل لهن ما يهدى إليه باستمرار،
حتى إن عائشة أم المؤمنين أسمعته ما يكره في حقها رحمها الله([86])
لأجل ذلك.
ولو أن هذه الخدمات كانت من غير خديجة، لكان للنبي
«صلى الله عليه وآله» نفس هذا الموقف، أي
إنه
سوف يشجع كل ما يكون في هذا الاتجاه، من أي كان، وعلى أي مستوى
كان.
أضف إلى ذلك:
أن هذه مناسبة يستطيع فيها «صلى الله عليه وآله»
إنقاذ نفس من مقاساة العناء والآلام وتخليصها من بين المشركين، ألا
وهي زينب رحمها الله، فلم لا يفعل؟!
هذا كله عدا عن أنه لم يطلق أبا العاص من غير فداء،
فقد أرسلت زينب بالفداء، فما هو المبرر لإمساكه؟
ويقول ابن أبي الحديد المعتزلي عن رقته «صلى الله
عليه وآله» في هذا الموقف: «قرأت على النقيب أبي جعفر يحيى بن أبي
زيد البصري ـ (وقد قرظه المعتزلي في موضع آخر) ـ([87])
رحمه الله هذا الخبر؛ فقال: أترى أبا بكر وعمر لم يشهدا هذا
المشهد؟
أما كان يقتضي الكرم والإحسان أن يطيب قلب فاطمة
بفدك، ويستوهب لها من المسلمين؟!
أتقصر منزلتها عند رسول الله «صلى الله عليه وآله»
عن منزلة زينب أختها، وهي سيدة نساء العالمين؟!!
هذا إن لم يثبت لها حق، لا بالنحلة، ولا بالإرث»([88]).
فداء الأسير
تعليم الكتابة:
قال المقريزي:
«وكان في الأسرى من يكتب، ولم يكن في الأنصار من
يحسن الكتابة، وكان منهم من لا مال له، فيقبل منهم أن يعلم عشرة من
الغلمان، ويخلي سبيله؛ فيومئذٍ تعلم زيد بن ثابت الكتابة في جماعة
من غلمان الأنصار.
أخرج الإمام أحمد، عن عكرمة، عن
ابن عباس، قال:
كان ناس من الأسرى يوم بدر، لم يكن لهم فداء؛ فجعل
رسول الله «صلى الله عليه وآله» فداءهم أن يعلموا
أولاد الأنصار الكتابة.
ثم ذكر المقريزي قصة من ضربه
معلمه، ثم قال:
وقال عامر الشعبي: كان فداء الأسرى من أهل بدر
أربعين أوقية؛ فمن لم يكن عنده علم عشرة من المسلمين؛ فكان زيد بن
ثابت ممن علم»([89]).
ونقول:
إن جعل فداء الأسرى هو تعليم عشرة من أطفال
المسلمين، ليعتبر أول دعوة في التاريخ لمحو الأمية، سبق الإسلام
بها جميع الأمم. وقد أتى الحكم بن سعيد بن العاص النبي؛ فسأله عن
اسمه؛ فأخبره فغير «صلى الله عليه وآله» اسمه إلى عبد الله، وأمره
أن يعلم الكتاب بالمدينة([90]).
وذلك يعبر عن مدى اهتمام الإسلام بالعلم في وقت
كانت فيه أعظم الدول كدولة الأكاسرة تمنع بصورة قاطعة من تعليم
القراءة والكتابة لأحد من غير الهيئة الحاكمة، حتى إن أحد التجار
قد عرض أن يقدم جميع الأموال اللازمة لحرب أنوشيروان مع قيصر الروم
على أن يسمح له بتعليم ولده([91]).
بل لقد كانت بعض الفئات العربية تعد المعرفة
بالكتابة عيباً
كما أشرنا إليه فيما سبق([92])
في المدخل لدراسة السيرة فراجع.
وهذا الإسلام قد جاء ليطلق أعدى أعدائه، في أدق
الظروف، وأخطرها في مقابل تعليمهم لعشرة من غلمان المسلمين، مع أنه
ربما تكون الاستفادة من فداء هؤلاء الأسرى، أو استخدامهم في مهمات
المسلمين، أو جعلهم وسيلة للضغط السياسي على قريش، له أهمية كبيرة
بالنسبة لهذا المجتمع الناشئ، الذي يولد في مجتمع يرفضه، ويحاول
القضاء عليه، وأمامه طريق طويل وشاق من النضال والكفاح من أجل
الحياة والبقاء، وإقامة الدولة الإسلامية، ونشر تعاليم رسالة
السماء.
ويلاحظ:
أن المسلمين الذين ذاقوا الأمرين على أيدي
المشركين، يظفرون الآن بعدوهم، ويصير أولئك الذين عذبوهم بالأمس،
وأخرجوهم من ديارهم، وسلبوهم أموالهم، وقطعوا أرحامهم ـ يصيرون ـ
أذلاء في أيديهم، وتحت رحمتهم.
فماذا تراهم صانعين بهم؟
أو بأي نحو وكيفية سوف يأخذون بثاراتهم منهم؟
التوقعات كثيرة، ولكن ما جرى كان مخالفاً لكل
التوقعات؛ فهم لم يحاولوا أن يأخذوا بثاراتهم، ولا اغتنموا الفرصة
التي أتيحت لهم؛ بل صدر الأمر لهم من القائد الأعظم بكلمة واحدة:
استوصوا بالأسرى خيراً. فأطاعوا الأمر، وشاركوهم في أموالهم حتى
كان أحدهم يؤثر أسيره بطعامه([93]).
هــذه
مــن
عــلاه
إحدى المعــالي
وعـلى
هــذه
فــقـس
مــا
سواهـا
ومما يثير فينا الدهشة والعجب
هنا:
أن نجد سودة بنت زمعة تحرض المشركين على رسول الله
«صلى الله عليه وآله» وعلى المسلمين. فإنها حين جيء بأسارى بدر
ورأت «سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة، مجموعة يداه إلى عنقه بحبل
قالت: فلا والله ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت:
أي
أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم؟ ألا متم كراماً؟!
فوالله ما أنبهني إلا قول رسول الله «صلى الله عليه
وآله» من البيت: «يا سودة، أعلى الله وعلى رسوله تحرضين؟!
قالت:
قلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما ملكت نفسي
حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه: أن قلت ما قلت»([94]).
وتشير بعض النصوص إلى سلبيات في حياتها مع النبي
«صلى الله عليه وآله»، حتى
إن
النبي «صلى الله عليه وآله» قد بعث إليها بطلاقها، فناشدته أن
يراجعها، فجعلت يومها وليلتها لعائشة، التي كانت تثني عليها، حتى
قالت: ما من الناس أحد أحب إلي أن أكون في مسلاخه من سودة
الخ..([95]).
([1])
راجع: مغازي الواقدي ج1 ص102 و103، والسيرة الحلبية ج2 ص183،
والكامل لابن الأثير ج2 ص118.
([2])
الآية1 من سورة الأنفال.
([3])
السنن الكبرى ج6 ص363.
([4])
الثقات لابن حبان ج1 ص211.
([5])
ترجمة الإمام علي
>عليه
السلام<
من تاريخ ابن عساكر بتحقيق المحمودي ج3 ص90، وراجع ص95، وراجع:
مناقب الخوارزمي ص225، وفرائد السمطين ج1 ص322. وفي هامش ترجمة
الإمام علي ج3 ص88/89 مصادر كثيرة لحديث المناشدة.
وراجع
أيضاً: الضعفاء الكبير ج1 ص211 وليس فيه كلمة (قبل أن يؤمن أحد
من قرابته) واللآلي المصنوعة ج1 ص362.
([6])
الموطأ ج2 ص14 المطبوع مع تنوير الحوالك، والأموال لأبي عبيد
ص444 و447، والفتوح لابن أعثم ج2 ص122، ومسند أحمد ج5 ص316
و319 و326، والثقات ج2 ص78.
([7])
الأموال لأبي عبيد ص384، وكنز العمال ج4 ص378 و318، وحياة
الصحابة ج2 ص236، وترجمة الإمام علي
>عليه
السلام<
من تاريخ ابن عساكر بتحقيق المحمودي ج3 ص181، وأنساب الأشراف
بتحقيق المحمودي ج2 ص132.
([8])
البداية والنهاية ج8 ص5 عن البغوي، وحياة الصحابة ج2 ص310.
([9])
مصنف عبد الرزاق ج6 ص267، وراجع268، وسنن البيهقي ج7 ص209.
([10])
الآية2 من سورة الحجرات.
([11])
راجع: السيرة الحلبية ج2 ص147 و185 وغيره.
([12])
سيرة ابن هشام ج2 ص339،340، والتنبيه والأشراف ص205، ولكنه
ذكره بلفظ قيل. والإصابة ج2 ص229، والإستيعاب بهامشها ص219.
([13])
السيرة الحلبية ج2 ص185.
([14])
ترجمة الإمام علي من تاريخ ابن عساكر، بتحقيق المحمودي ج3 ص93،
واللآلي المصنوعة ج1 ص362، والضعفاء الكبير ج1 ص211 و212.
([15])
راجع: السيرة الحلبية ج3 ص142.
([16])
سير أعلام النبلاء ج1 ص216.
([17])
راجع: السيرة الحلبية ج2 ص146 و147 و185 وأي كتاب تاريخي آخر.
([18])
السيرة الحلبية ج2 ص185 و146.
([19])
مسند أحمد ج1 ص68 وراجع ص75، والأوائل1 ص305 و306، ومحاضرات
الأدباء للراغب المجلد الثاني ص184، والدر المنثور ج2 ص89 عن
أحمد، وابن المنذر، والبداية والنهاية ج7 ص207، وشرح النهج
للمعتزلي ج15 ص21 و22، ومغازي الواقدي ج1 ص278، والغدير ج9
ص327، وج10 ص72 عن أحمد وابن كثير وعن الرياض النضرة ج2 ص97.
([20])
مستدرك الحاكم ج3 ص98، والجامع الصحيح للترمذي ج5 ص629، ومسند
أحمد ج2 ص101، والبداية والنهاية ج7 ص207 عن البخاري والغدير
ج10 ص71 عن الحاكم وص70 عن أحمد، وعن صحيح البخاري ج6 ص122.
([21])
أنساب الأشراف ج5 ص36 والغدير ج9 ص3 عنه وص4 عن الواقدي.
([22])
الغدير ج10 ص70 عن الرياض النضرة ج2 ص94.
([23])
قارفَ: قاربَ، وقارفَ الذنب: قاربه.
([24])
السيرة الحلبية ج2 ص147، وراجع: الإصابة ج4 ص9 عن أبي أحمد
الحاكم، والإستيعاب بهامش الإصابة ج4 ص4، وأسد الغابة ج5 ص139.
([25])
العلل ومعرفة الحديث ج1 ص4.
([26])
وقد نص على أن علياً هو الذي ضرب عنق النضر بن الحارث في سيرة
ابن هشام ج2 ص298 عن الزهري وغيره، وراجع: الأغاني ط ساسي ج1
ص10.
([27])
العلل ومعرفة الحديث ج1 ص3.
([28])
راجع: الـروض الأنف ج3 ص65، والسيرة الحـلبية ج2 ص187 و186،
والبحار ج19 ص260 و347، ومصنف عبد الرزاق ج5 ص205، وتفسير
القمي ج1 ص269، والواقدي، وذكر ابن هشام في سيرته ج2 ص298، قتل
علي >عليه
السلام<
له، بلفظ: قيل.
([29])
مصنف عبد الرزاق ج5 ص205 و352 و356، وربيع الأبرار ج1 ص187،
والكامل لابن الأثير ج2 ص131، وسيرة ابن هشام ج2 ص298 والأغاني
ط ساسي ج1 ص10 و11.
([30])
الروض الأنف ج3 ص65.
([31])
راجع: الغدير ج8 ص273 و274 عن ابن مردويه، وأبي نعيم في
الدلائل بإسناد صححه السيوطي.
([32])
السيرة الحلبية ج2 ص87، وراجع: الروض الأنف ج3 ص65.
([33])
الغدير ج9 ص155 عن الطبري ج5 ص151.
([34])
الروض الأنف ج3 ص65، والسيرة الحلبية ج2 ص187.
([35])
شرح النهج للمعتزلي ج6 ص293 عن الزبير بن بكار في كتاب
المفاخرات، وراجع: مقتل الحسين للخوارزمي ج1 ص119.
([36])
ربيع الأبرار ج1 ص178.
([37])
تذكرة الخواص ص206.
([38])
راجع كتابنا: دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام الجزء الثاني.
([39])
طبقات الشعراء لابن سلام ص64 و65.
([40])
زهر الآداب ج1 ص66.
([41])
الآيتين67 و68 من سورة الأنفال.
([42])
راجع هذه النصوص في المصادر التالية، وإن كان كثير منها يذكر
أنه >صلى
الله عليه وآله<
قد مال إلى قول أبي بكر، وبعضها يذكر أنه لم يرد إلا قتلهم
فراجع: الطبري ج1 ص169، والسيرة الحلبية ج2 ص190، وصحيح مسلم
ج5 ص157، والبحار ج19، وأسباب النزول للواحدي ص137، وحياة
الصحابة ج2 ص42، وكنز العمال ج5 ص265 عن أحمد ومسلم، والترمذي،
وأبي داود، وابن أبي شبية، وأبي عوانة، وابن جرير، وابن
المنذر، وابن أبي حاتم، وابن حبان، وأبي الشيخ، وابن مردويه،
وأبي نعيم، والبيهقي. والدر المنثور ج3 ص201 ـ 203، ومشكل
الآثار ج4 ص291 و292، ومغازي الواقدي ج1 ص107 و108، والكامل
لابن الأثير ج2 ص136.
([45])
راجع: المصادر المتقدمة جميعاً، وفواتح الرحموت بهامش المستصفى
للغزالي ج2 ص267، وتاريخ الخميس ج1 ص393، والمستصفى للغزالي ج2
ص365، وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص169.
([46])
قضايا في التاريخ الإسلامي لمحمود إسماعيل ص20.
([47])
شرح النهج للمعتزلي ج14 ص175 و176، والكامل لابن الأثير ج2
ص126، والسيرة الحلبية ج2 ص192، وسيرة ابن هشام ج2 ص281،
وتاريخ الخميس ج1 ص381، ومغازي الواقدي ج1 ص110 و106.
([48])
البداية والنهاية ج3 ص297، وتاريخ الطبري ج2 ص170، والروض
الأنف ج3 ص83، وأسباب النزول للواحدي ص137، وتاريخ الخميس ج1
ص393، والسيرة الحلبية ج2 ص192، وحياة الصحابة ج2 ص43 عن
الحاكم وصححه، وابن مردويه، والترمذي، وأحمد.
([49])
الآية67 من سورة الأنفال.
([50])
الآية68 من سورة الأنفال.
([51])
راجع: دلائل الصدق ج3 قسم1 ص59.
([52])
السيرة الحلبية ج2 ص192.
([53])
هذه الكلمة تشير إلى أن الذين قالوا ذلك هم من المهاجرين.
([54])
تاريخ الخميس ج1 ص393 عن فتح الباري، عن الترمذي، والنسائي،
وابن حبان، والحاكم بإسناد صحيح، ومصنف عبد الرزاق ج5 ص210،
والبداية والنهاية لابن كثير ج3 ص298، وطبقات ابن سعد ج2 ص14
قسم1.
([55])
راجع على سبيل المثال: الكامل لابن الأثير ج2 ص136.
([56])
مغازي الواقدي ج1 ص107 و108.
([57])
الآيتين3 و 4 من سورة النجم.
([58])
الآية 59 من سورة النساء.
([59])
الآية 67 من سورة الأنفال.
([60])
دلائل الصدق ج3 قسم1 ص55 و60.
([61])
الآيتين 68 و 69 من سورة الأنفال.
([62])
مشكل الآثار ج4 ص292 و 293.
([63])
الآية 67 من سورة الأنفال.
([64])
تاريخ الطبري ج2 ص171، وراجع: الثقات ج1 ص169.
([65])
راجع: تاريخ الطبري ج2 ص143، وسيرة ابن هشام ج2 ص271، ومغازي
الواقدي ج1 ص45، والكامل لابن الأثير ج2 ص121، وتفسير ابن كثير
ج2 ص314، وتاريخ الخميس ج1 ص375، وأي كتاب تاريخي شئت، إذا كان
يذكر بدراً ورجوع من رجع عنها قبل نشوب الحرب.
([66])
مجمع الزوائد ج6 ص67، عن الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، وحياة
الصحابة ج1 ص154.
([67])
راجع: حقائق التأويل ج5 ص111.
([68])
تاريخ الخميس ج1 ص390،
وصفة الصفوة ج1 ص510. وعند عبد الرزاق في المصنف ج5 ص353: أن
أنصارياً قال له
>صلى
الله عليه وآله<:
أفلا أذهب فأرخي عنه شيئاً؟ قال: إن شئت فعلت ذلك من قبل نفسك،
فانطلق الأنصاري، فأرخى عن وثاقه، فسكن
>صلى
الله عليه وآله<
ونام ودلائل النبوة للبيهقي ج2 ص410.
([69])
أسباب النزول للواحدي ص138، والسيرة الحلبية ج2 ص198.
([70])
المحلوفة: القَسَم.
([71])
الآية70 في سورة الأنفال، والرواية معتبرة السند في تفسير
البرهان ج2 ص94، وراجع: تفسير الكشاف ج2 ص238، وغير ذلك.
([72])
البحار ج19 ص258، وتفسير القمي ج1 ص268.
([73])
المصدران السابقان، وتاريخ
الخميس ج1 ص390، والسيرة الحلبية ج2 ص198.
([74])
راجع: البداية والنهاية ج3 ص308، والسيرة الحلبية ج2 ص188
و198، وطبقات ابن سعد ج4 ص20 قسم1.
([75])
الآية17 من سورة التوبة. والحديث في: أسباب النزول للواحدي
ص139، وليراجع الدر المنثور ج3 ص219 عن ابن جرير، وأبي الشيخ
عن الضحاك، لكن الآية هي آية سقاية الحاج الآتية.
([76])
الآية19 من سورة التوبة. والحديث في: أسباب النزول للواحدي
ص139، والدر المنثور ج3 ص218 عن ابن جرير، وابن المنذر، وابن
أبي حاتم، وابن مردويه، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وأبي
الشيخ.
([77])
البداية والنهاية ج3 ص298 عن الحاكم، وابن مردويه، وحياة
الصحابة ج2 ص244 و245 عن كنز العمال ج7 ص69 عن ابن عساكر.
([78])
السيرة الحلبية ج2 ص199.
([79])
صحيح البخاري ج1 ص55 و 56، وج2 ص130، ومستدرك الحاكم ج3 ص329
و330، وتلخيصه للذهبي بهامشه، وصححاه، وطبقات ابن سعد ج4 قسم1
ص9، والسيرة الحلبية ج2 ص200، وحياة الصحابة ج2 ص225،
والتراتيب الإدارية ج2 ص88 و 89.
([80])
صحيح البخاري ج1 ص55 و 56،
وج2 ص130، والتراتيب الإدارية ج2 ص89.
([81])
طبقات ابن سعد ج4 قسم1 ص20، وحياة الصحابة ج2 ص234، وتهذيب
تاريخ دمشق ج7 ص251.
([82])
الآية70 من سورة الأنفال.
([83])
مستدرك الحاكم ج3 ص329، وتلخيصه للذهبي وصححاه، وطبقات ابن سعد
ج4 قسم1 ص9، والسيرة الحلبية ج2 ص220، وحياة الصحابة ج2 ص225.
([84])
السيرة النبوية لابن هشام ج2 ص317 و318.
([85])
السيرة النبوية لابن هشام ج2 ص308، وتاريخ الأمم والملوك ط
الإستقامة = = ج2 ص164، والكامل في التاريخ ج2 ص134، والبحار
ج19 ص241، ودلائل النبوة ط دار المكتبة العلمية ج3 ص154،
وتاريخ الإسلام للذهبي (قسم المغازي) ص46.
([86])
تقدمت المصادر لذلك في فصل: بيعة العقبة حين الكلام حول غيرة
عائشة.
([87])
فقد وصفه في شرحه للنهج ج12 ص90 بأنه:
>لم
يكن إمامي المذهب، ولا كان يبرأ من السلف، ولا يرتضي قول
المسرفين من الشيعة<
ووصفه في ج9 ص248 بأنه كان:
>منصفاً،
وافر العقل<.
ونقل في هامش البحار ج19 عنه أنه وصفه بالوثاقة والأمانة،
والبعد عن الهوى والتعصب، والإنصاف في الجدال، مع غزارة العلم،
وسعة الفهم، وكمال العقل.
([88])
شرح النهج للمعتزلي ج14 ص191.
([89])
راجع: التراتيب الإدارية ج1 ص48 و49 عن المطالع النصرية في
الأصول الخطيـة لأبي الـوفـاء نصر الـدين الهـوريني، وعـن
السهيلي ومسند أحمـد ج1 = = ص247، والإمتاع ص101، والروض الأنف
ج3 ص84، وتاريخ الخميس ج1 ص395، والسيرة الحلبية ج2 ص193،
وطبقات ابن سعد ج2 قسم1 ص14، ونظام الحكم في الشريعة والتاريخ
الإسلامي (الحياة الدستورية) ص48.
([90])
نسب قريش لمصعب الزبيري ص174، والإصابة ج1 ص344 عنه.
([91])
خدمات متقابل إسلام وإيران ص283 و 284 و 314، وراجع ص310 عن
شاهنامه فردوسي ج6 ص258 ـ 260.
([92])
الشعر والشعراء ص334، والتراتيب الإدارية ج2 ص248.
([93])
راجع: الطبري ج2 ص159،
والكامل لابن الأثير ج2 ص131، وسيرة ابن هشام ج2 ص299 و300،
ومغازي الواقدي ج1 ص119، وتاريخ الخميس ج1 ص388.
([94])
البداية والنهاية ج3 ص307.
([95])
الإصابة ج4 ص338 وغير ذلك كثير.