|
نـهـــــايــــة الـمــــطــــــاف
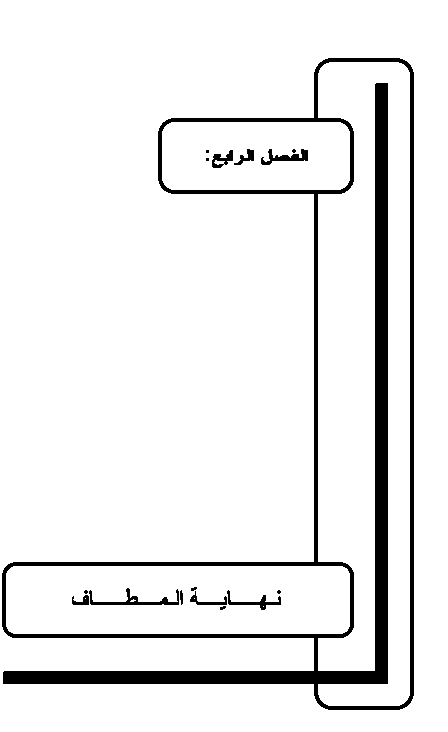
ويذكرون:
أنه حينما كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يتجهز
لفتح مكة، كتب حاطب ابن أبي بلتعة كتاباً
إلى أهل مكة يحذرهم، وأعطاه امرأة لتوصله إليهم.
فأخبر جبرائيل النبي «صلى الله عليه وآله» بالأمر،
فأرسل علياً ونفراً
معه إلى روضة خاخ (موضع بين مكة والمدينة) ليأخذوا الكتاب منها،
فأدركوها في ذلك المكان، وفتشوا متاعها فلم يجدوا شيئاً، فهموا
بالرجوع.
فقال علي «عليه السلام»:
والله ما كَذَبْنَا
ولا كُذِّبْنَا،
وسل سيفه، وقال لها: أخرجي الكتاب وإلا لأضربن عنقك، فلما رأت الجد
أخرجته من ذؤابتها.
فرجعوا بالكتاب إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، فأرسل
إلى حاطب فسأله عنه، فاعترف به، وادَّعى:
أنه إنما فعل ذلك لأنه خشيهم على أهله، فأراد أن يتخذ عندهم يداً
فصدقه رسول الله «صلى الله عليه وآله» وعذره.
لكن عمر بن الخطاب قد رأى:
أن حاطباً
قد خان الله ورسوله، فطلب من النبي «صلى الله عليه وآله» أن يضرب عنق
حاطب، فقال له النبي «صلى الله عليه وآله»:
أليس من أهل بدر؟ لعل ـ أو إن ـ الله اطلع على أهل بدر،
فقال: اعملوا ما شئتم، فقد وجبت لكم الجنة. أو فقد غفرت لكم([1]).
قال الحلبي:
«وهو يفيد: أن ما يقع منهم من الكبائر لا يحتاجون إلى
التوبة عنه؛ لأنه إذا وقع يقع مغفوراً.
وعبر فيه بالماضي مبالغة في تحققه.
وهذا كما لا يخفى بالنسبة للآخرة،
لا بالنسبة لأحكام الدنيا. ومن ثم لما شرب قدامة بن مظعون الخمر في
أيام عمر حد، وكان بدرياً».
وقال الحلبي أيضاً:
«وفي الخصائص الصغرى، نقلاً
عن شرح جمع الجوامع: أن الصحابة كلهم لا يفسقون بارتكاب ما يفسق به
غيرهم»([2]).
ورووا عنه «صلى الله عليه وآله»
أيضاً قوله:
لن يدخل النار أحد شهد بدراً([3]).
ونقول:
إذا كان شرب البدري للخمر لا يضر، ولا يحتاجون للتوبة
من الكبائر، فليكن الزنى حتى بالمحارم غير مضر لهم أيضاً، وكذلك تركهم
الصلاة، وسائر الواجبات وغيرها!. وليكن أيضاً قتل النفوس كذلك. ولقد
قتلوا عشرات الألوف في وقعتي الجمل وصفين، وقتلوا العشرات، سراً
وجهراً، غيلة وصبراً. فإن ذلك كله لا يضر، ولا يوجب لهم فسقاً، ولا
عقاباً!!
أضف إلى ذلك:
أن ابن أُبي
مغفور له، لأنه أيضاً قد شهد بدراً
حسبما روي([4]).
وإذا صح ما ذكروه عن أهل بدر، فلا يبقى معنى لتكليف
البدريين بالشرائع والأحكام، ولماذا يتعبون ويشقون، ما دام أن دخول
الجنة حاصل ومضمون لهم، فليتنعموا في حياتهم الدنيا، وليستفيدوا من
لذائذها حلالاً
أو حراماً!!.
أما دفاع علي «عليه السلام» عن الحق، وإمعانه في قتل
الناكثين والقاسطين والمارقين، بعد أن تناسوا أقوال الرسول «صلى الله
عليه وآله» وإخباراته الصادقة عن هذه الفئات الضالة، فقد اعتبروه جرأة
منه على الدماء، وأن سببه هو ما سمعه من أن الله رخص لأهل بدر في أن
يفعلوا ما شاؤوا!!([5]).
ثم إننا لا ندري لماذا يعاقب البدري في الدنيا، إذا كان
النبي «صلى الله عليه وآله» نفسه قد منع عمر من عقاب حاطب الذي خان
الله ورسوله، وكتب للمشركين بأسرار المسلمين، واحتج الرسول «صلى الله
عليه وآله» لهذا المنع ـ حسبما يدَّعون
ـ ببدرية حاطب؟!
وإذا كان الله قد غفر لهذا البدري، فلماذا يعاقب في
الدنيا؟!
أليس عقابه حينئذٍ يكون بلا ذنب جناه؟
ولا خطيئة اقترفها؟!
والحقيقة هي أن الحلبي:
لما رأى عمر قد أقام الحد على قدامة، اضطر إلى عدم
إسقاط العقاب الدنيوي عن أهل بدر، ولولا ذلك لكنا رأيناه يسقطه أيضاً،
محتجاً
بإسقاط النبي «صلى الله عليه وآله» له عن حاطب. ولكن وبعد أن كان
المعني هو عمر بالذات، فلا بد من بناء الفقه والأحكام على أساس فعله،
وعدم
الالتفات إلى فعل النبي «صلى الله عليه وآله» وقوله وتقريره!!
نعم، لقد استنبط الحلبي كل هذه الأحكام من الحديث
الشريف الذي عبر بكلمة: «(لعل)
فليت شعري: كم كان سوف يستنبط من الأحكام لو أنه ثبت لديه الجزم
بالمغفرة لهم كما ذكرته رواية أخرى»؟!.
ولكن الحقيقة هي أن حديث المغفرة لأهل بدر ـ لو صح ـ
فلم يكن فيه كلمة «اعملوا ما شئتم». والمغفرة إنما هي بالنسبة لما سبق
لهم من ذنب، وإذا كانت هذه الفقرة ثابتة كان المراد بها: فليستأنفوا
العمل، فلسوف يجازون بحسب ما يعملونه فيما يأتي، لا أن المغفرة تكون
بالنسبة لما سوف يقترفونه بعد ذلك أيضاً.
ولو كان قوله:
«اعملوا ما شئتم» ثابتاً
ويراد به المغفرة للذنوب الآتية
أيضاً،
لاحتج به قدامة على عمر، ليدرأ الحد عن نفسه. ولاحتج أيضاً
بموقف النبي «صلى الله عليه وآله» من حاطب، كما أن من الصعب على عمر
نفسه أن يقدم على مخالفة أمر نبوي بهذا الوضوح والمعروفية([6]).
هذا كله بالإضافة إلى أن شيوع هذه الفقرة عن النبي «صلى
الله عليه وآله» بما لها من هذا المعنى الذي يدعيه هؤلاء، يلائم
المصالح السياسية في أحيان كثيرة، الأمر الذي يقوي الظن بأن للسياسة
يداً
في تأكيد ونشر هذا المعنى.
ونسجل هنا:
أننا نجد سعد بن أبي وقاص يكاد يفضل جيشه في حرب
المدائن على أهل بدر، فيقول: «والله، إن الجيش لذو أمانة، ولولا ما سبق
لأهل بدر لقلت وأيم الله: على فضل أهل بدر، لقد تتبعت من أقوام هنات
وهنات فيما أحرزوا، وما أحسبها ولا أسمعها من هؤلاء القوم»([7]).
بل إن كعب بن مالك يفضل ليلة العقبة على بدر، وإن كانت
بدر أذكر في الناس منها([8]).
نعم، هذا هو شأن بدر عندهم، وشأن غيرها. ولكنهم لم
يحكموا لغير البدريين بالجنة، لأنه ليس فيهم من يهتمون بالمغفرة له
وبإدخاله إلى الجنة. أو تفرض السياسة تبرير أعماله ومواقفه المخالفة
للإسلام، والقرآن، والإنسانية! رغم أن سعداً
حسب النص المذكور آنفاً يرى أن في أهل بدر من صدرت منهم هنات وهنات
أنزلت من مقامهم، وخففت من ميزانهم. وهو على حق في ذلك، فإن لكثير من
أهل بدر مواقف وأفاعيل غريبة وعجيبة، لسنا هنا في صدد الحديث عنها.
ويعجبني هنا ما قاله ابن الجوزي، في تعليق له على حديث
المغفرة لأهل بدر، فهو يقول: «نعوذ بالله من سوء الفهم، خصوصاً
من المتسمين بالعلم.
روى أحمد في مسنده:
أنه تنازع أبو عبد الرحمن السلمي، وحيان بن عبد الله،
فقال أبو عبد الرحمن لحيان: قد علمت ما الذي حدا صاحبك ـ يعني علياً ـ
قال: ما هو؟
قال:
قول النبي «صلى الله عليه وآله»: لعل الله اطلع إلى أهل
بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم.
وهذا سوء فهم من أبي عبد الرحمن، حين ظن أن علياً «عليه
السلام»
إنما قاتل وقتل اعتماداً
على أنه قد غفر له.
وينبغي أن يعلم:
أن معنى
الحديث: لتكن أعمالكم المتقدمة ما كانت، فقد غفرت لكم.
فأما غفران ما سيأتي فـلا
يتضمنه ذلـك،
أتـراه
لـو
وقع من أهـل
بـدر
ـ وحاشاهم ـ الشرك؛ إذ ليسوا بمعصومين، أما كانوا يؤاخذون به؟ فكذلك
المعاصي.
ثم
لو قلنا:
إنه يتضمن غفران ما سيأتي، فالمعنى: أن مآلكم إلى
الغفران.
ثم دعنا من معنى الحديث، كيف يحل لمسلم أن يظن في أمير
المؤمنين علي رضي الله عنه فعل ما لا يجوز اعتماداً
على أنه سيغفر له؟! حوشي من هذا. وإنما قاتل بالدليل المضطر له إلى
القتال، فكان على الحق.
ولا
يختلف العلماء:
أن علياً رضي الله عنه لم يقاتل أحداً إلا والحق مع
علي.
كيف وقد قال رسول الله «صلى الله
عليه وآله»:
اللهم أدر الحق معه كيفما دار.
فقد غلط أبو عبد الرحمن غلطاً
قبيحاً،
حمله عليه أنه كان عثمانياً»([9])
إنتهى.
مهما يكن من أمر،
فقد رجع المحاربون المشركون إلى مكة بأسوأ حال من الحنق
والغيظ، فنهاهم أبو سفيان عن النوح على قتلاهم، ومنع الشعراء من ندب
القتلى؛ لئلا يخفف ذلك من غيظهم، ويقلل من عداوتهم للمسلمين. وحتى لا
يبلغ المسلمين حزنهم، فيشمتوا بهم.
وحرم أبو سفيان الطيب والنساء على نفسه، حتى يغزو
محمداً. وكذلك كان موقف زوجته هند، التي اعتزلت فراشه وامتنعت عن
الطيب.
ولما رجع المشركون طلبوا من أصحاب
العير:
أن يواسوهم في تلك العير، فأنزل الله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ
فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً}([10]).
وقيل:
نزلت هذه الآية في المطعمين في غزوة بدر، الذين كانوا
ينحرون الجزر حسبما تقدم، ولعله هو الأنسب والأوفق بمفاد الآية.
وأرسل النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» يبشر أهل
المدينة بالنصر المبين، فلم يصدق البعض ذلك في بادئ الأمر، ثم تأكد
لديهم أنه حق، ففرح المؤمنون، واستقبلوا الرسول «صلى الله عليه وآله»
فرحين مسرورين.
ويقولون:
إن زيد بن حارثة كان هو البشير، فلم يصدقه الناس حتى
اختلى بولده أسامة، وأكد له ذلك.
وهذا لا يصح، لأن أسامة كان حينئذٍ طفلاً،
لا يتجاوز عمره العشر سنوات.
وفي الطريق إلى المدينة فقد المسلمون رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، فوقفوا. فجاء «صلى الله عليه وآله» ومعه علي «عليه
السلام».
فقالوا:
يا رسول الله، فقدناك؟
فقال:
إن أبا الحسن وجد مغصاً
في بطنه، فتخلفت عليه([11]).
ويقال:
«إنه «صلى الله عليه وآله» قدم المدينة حينما كانوا
مشغولين بدفن زوجة عثمان، كما سيأتي الحديث عنه في فصل ما بين بدر وأحد
إن شاء الله.
وقدم الأسارى المدينة بعد قدومه «صلى الله عليه وآله»
بيوم؛ ففرقهم بين المسلمين، وقال: استوصوا بهم خيراً.
إلى أن فداهم أهل مكة.
ثم أرسل «صلى الله عليه وآله» عبد الله بن رواحة مبشراً
إلى أهل العالية ـ ما كان من جهة نجد من المدينة. وفي الطبقات العالية
هم بنو عمرو بن عوف، وخطمة، ووائل ـ بما فتح الله على رسوله وعلى
المسلمين، وبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة ـ ما كان في جهة تهامة»([12]).
لقد تقدم الكثير مما يمكن استخلاصه في هذا المقام. فلا
نرى حاجة إلى الإطالة
فيه، فنحن نكتفي هنا بلمحة خاطفة ضمن النقاط التالية:
1 ـ
إن قريشاً التي كانت تحب الحياة قد واجهت في بدر ضربة روحية قاسية
جداً؛ وأصابها هلع قاتل، وهي ترى أن حياتها مع هؤلاء المسلمين قد أصبحت
في خطر حقيقي. وقد كان لهذا الخوف والهلع أثر لا ينكر على حروبها
اللاحقة مع المسلمين؛ فإن الخائف اللجوج بطبيعته، يتخذ الاحتياطات كافة
لتأمين النصر لنفسه مع احتفاظه بالحياة.
ولذا، فقد حاولت قريش في حملاتها اللاحقة أن تكون أكثر
دقة وتركيزاً،
وأوسع حشداً
واستعداداً،
من أجل القضاء على هذه الحركة التي تراها تهدد مصالحها وامتيازاتها في
المنطقة، إجتماعياً،
وسياسياً،
وإقتصادياً،
وغير ذلك.
2 ـ
ومن الجهة الأخرى فقد قويت نفوس المسلمين بذلك، وعادت
لهم الثقة بأنفسهم بصورة ظاهرة، وشجعهم هذا الانتصار غير المتوقع على
مواجهة ما كان إلى الأمس القريب يرعبهم حتى احتماله، فضلاً
عن التفكير فيه، أو مواجهته. وقد كان هذا الانتصار في المستوى الذي صعب
على بعض أهل المدينة التصديق به.
نعم،
لقد زادهم هذا الانتصار إيماناً، ويقيناً،
وثقة بدينهم و نبيهم. ولا سيما بملاحظة حجم الخسائر التي مني بها
عدوهم.
3 ـ
ولقد أعانتهم تلك الغنائم التي حصلوا عليها إلى حد كبير
على مواجهة مشاكلهم الإقتصادية الملحة، كما أنها فتحت شهية الطامعين،
وجعلتهم على استعداد للمشاركة، بل ويتطلعون إلى نظائرها في المستقبل.
4 ـ
ثم إنه قد أصبح ينظر إلى المسلمين في المنطقة على أنهم
قوة فعالة، لا بد أن يحسب حسابها، وهابتهم القبائل، وبدأت تخطب ودهم،
وتتقرب إليهم، ولم يعد من السهل عليها أن تنقض ما أبرمته معهم من
معاهدات.
بل وأصبحت تتوقع لهم انتصارات أخرى أيضاً، حتى ليقول
اليعقوبي عن وقعة ذي قار، التي كانت بعد بدر بأربعة أشهر:
«وأعز الله نبيه، وقتل من قريش، فأوفدت العرب وفودها
إلى رسول الله، وحاربت ربيعة كسرى. وكانت وقعتهم بذي قار، فقالوا:
عليكم بشعار التهامي، فنادوا: يا محمد، يا محمد. فهزموا جيوش كسرى»([13]).
وبعد هذا، فإن من الطبيعي:
أن يترك ذلك أثراً على محاولات قريش للتحالف مع القبائل
ضد المسلمين، ويخفف من تحمس كثير منها إلى عقد مثل هذه التحالفات معها.
ولما أوقع الله تعالى بالمشركين يوم بدر، واستأصل
وجوههم ورؤساءهم، عرف النجاشي بالأمر من عين له، ففرح فرحاً شديداً،
وجلس على التراب، ولبس ثياباً
خلقة،
لأنه أراد شكر الله لأجل هذه النعمة، وبشر المسلمين بذلك([14]).
ونشير هنا أيضاً:
إلى أن من إعجاز الإسلام: أنه «صلى الله عليه وآله» قد
حارب أعتى القوى بأشواب([15])
من الناس، لا تشدهم ولا تجمعهم أية رابطة سوى رابطة الدين، وأمامهم عدو
تشده إلى بعضه البعض عصبيات وأواصر مختلفة، ومصالح مشتركة، وليس من
الطبيعي أن يتحقق النصر لقوم هم أشواب من الناس على فئة تكون على عكس
ذلك تماماً، ولأجل ذلك قال عروة بن مسعود الثقفي للنبي «صلى الله عليه
وآله» يوم الحديبية: «وإن تكن الأخرى (أي الحرب) فإني لأرى وجوهاً،
وأرى أشواباً
من الناس، خليقاً أن يفروا عنك»([16]).
وهذا النوع من الناس هم الذين اعتبرهم أمير المؤمنين «عليه
السلام»
الغوغاء، الذين إذا اجتمعوا ضروا، وإذا تفرقوا نفعوا([17]).
وإن حربه لأعتى القوى وأكثرها تلاحماً
وتعاضداً
بأشواب من الناس، لم يكن في معركة واحدة، ليقال: إنها ربما تكون صدفة،
خاضعة لبعض العوامل والظروف الاستثنائية، بل استمر ذلك عدة سنوات. ولعل
إلى ذلك يشير قوله تعالى:
{وَأَلَّفَ
بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا
أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ}([18]).
وأخيراً..
فإننا نجد لمعاوية موقفاً
سياسياً
من أهل بدر، وذلك في قضية التحكيم في صفين، حينما رفض أن يحكم رجلاً من
أهل بدر، وقال: «لا أحكم رجلاً من أهل بدر»([19]).
ولعل ذلك يرجع إلى أنه كان يعلم:
أن كثيراً منهم كان ملتزماً
بأحكام الشريعة، صلباً
في ذات الله، ويرفض المساومة والمداهنة في الدين.
وقبل الحديث عن أحداث ما بين بدر وأحد، لا بأس بأن
نتكلم عن بعض الموضوعات التي ترتبط بما تقدم بنحو من الارتباط
والاتصال، وذلك في ضمن الفصل التالي.
([1])
راجع: البخاري ط سنة1309 ج2 ص110، وج3 ص39 و129 وط مشكول كتاب
المغازي، غزوة بدر وج9 ص23، وفتح الباري ج6 ص100، وج8 ص486 وج7
ص237، عن أحمد، وأبي داود، وابن أبي شيبة، والبداية والنهاية
ج4 ص284، وج3 ص328 عن الخمسة، ما عدا ابن ماجة، ومجمع الزوائد
ج8 ص303، وج9 ص303 و304 وج6 ص162 و163 عن أحمد، وأبي يعلى،
والبزار، وحياة الصحابة ج2 ص463 و364 عن بعض من تقدم، والسيرة
الحلبية ج2 ص203 و192، ومجمع البيان ج9 ص269 و270، وتفسير
القمي ج2 ص361، والإرشاد للمفيد ص33 و34 و69، وصحيح مسلم ج4
ص1941 ط دار إحياء التراث العربي، والمغازي ج2 ص797 و798،
وأسباب النزول ص239، وتاريخ اليعقوبي ج2 ص47، وشرح نهج البلاغة
للمعتزلي ج6 ص58، وج17 ص266، وسنن أبي داود ج3 ص44 و45 و48،
والتبيان للطوسي ج9 ص296، وأسد الغابة ج1 ص361 والدر المنثور
للسيوطي ج6 ص203، وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص93 و439
و440، والسنن الكبرى ج9 ص146، والسيرة النبوية لابن هشام ج4
ص39 و41، ودلائل النبوة للبيهقي ج2 ص421 و422، الجامع الصحيح
ج5 ص409 و410، ومسند الشافعي ص316، والطبقات الكبرى ج2 ص97،
وتفسير فرات ص183 و184، ولسان العرب ج4 ص557، والمبسوط للشيخ
الطوسي ج2 ص15، وتاريخ الأمم والملوك ج3 ص48 و49، والمناقب
لابن شهر آشوب ج2 ص143 و144، وكنز العمال ج17 ص59، وتهذيب
تاريخ دمشق ج6 ص371، والبحار ط بيروت ج72 ص388، وج21 ص125 و119
و120 و136 و137 و(ط حجرية) ج8 ص643 عن إرشـاد المفيد، وإعـلام
الورى، = = وتفسير القمي، وتفسير فرات، وعون المعبود ج7 ص310
و313، والدرجات الرفيعة ص336، وزاد المعاد لابن القيم ج3 ص115،
وعمدة القارئ ج14 ص254، وتاريخ الخميس ج2 ص79، وترتيب مسند
الشافعي ج1 ص197، والمحلى ج7 ص333، والجامع لأحكام القرآن ج18
ص50 و 51، وأحكام القرآن للجصاص ج5 ص325، وجامع البيان ج28 ص38
ـ40، والكامل في التاريخ ج2 ص242، وكشف الغمة للأربلي ج1 ص180،
والإصابة ج1 ص300، والبرهان في تفسير القرآن ج4 ص323 والاعتصام
بحبل الله المتين ج5 ص500 و 501، والصافي (تفسير) ج5 ص161،
ونهج السعادة ج4 ص28، ومعجم البلدان ج2 ص335، والمواهب اللدينة
ج1 ص149، وبهجة المحافل ج1 ص188 و 400. وعن المصنف لابن أبي
شيبة ج15 ص69، وعن تفسير الثعالبي ج4 ص289، وعن منهاج البراعة
ج5 ص106.
([2])
السيرة الحلبية ج2 ص203 و 204، وراجع: فتح الباري ج7 ص237 و
238.
([3])
فتح الباري ج7 ص237 وسنده صحيح على شرط مسلم.
([4])
السيرة الحلبية ج1 ص335.
([5])
راجع: البخاري ج9 ص23 ط مشكول، وفتح الباري ج7 ص238، والغارات
ج2 ص568 و 569، وشرح النهج للمعتزلي ج4 ص100.
([6])
راجع حول عدالة الصحابة كتابنا: دراسات وبحوث في التاريخ
والإسلام ج2.
([7])
حياة الصحابة ج3 ص758 عن تاريخ الطبري ج3 ص138.
([8])
البداية والنهاية ج5 ص23 عن البخاري، وأبي داود، والنسائي
ونحوه، مفرقاً ومختصراً، وروى الترمذي بعضه، والبيهقي ج9 ص33،
وحياة الصحابة ج1 ص475 عمن تقدم، وعن الترغيب والترهيب ج4
ص366.
([10])
الآية 36 من سورة الأنفال.
([11])
السيرة الحلبية ج2 ص188.
([12])
راجع: التراتيب الإدارية ج1 ص382.
([13])
تاريخ اليعقوبي ط صادر ج2 ص46.
([14])
السيرة النبوية لابن كثير ج2 ص476 و477.
([17])
نهج البلاغة، الحكم ص199.
([18])
الآية63 من سورة الأنفال.
([19])
أنساب الأشراف ج3 ص23.
|