|
سـريــتـــان نـاجـحـتـــــان
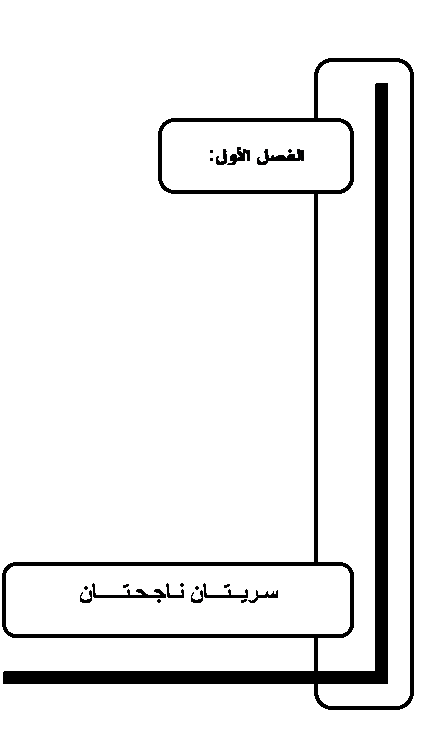
بـدايـة:
هذا..
وقد كانت فيما بين أُحد
والخندق العديد من السرايا والغزوات وكانت لها نتائج إيجابية، على
الصعيد السياسي العام وكذلك على الصعيد الاجتماعي، والعسكري وغير ذلك
كما سنرى.
وحيث إن السرايا لم يكن النبي «صلى الله عليه وآله»
يشارك فيها، وإنما كان يشارك في الغزوات فقط، فلسوف نحاول الفصل فيما
بينهما في الحديث، ولسوف نهتم بالغزوات التي يشارك فيها النبي «صلى
الله عليه وآله» بنفسه أكثر، لنستفيد من أقواله ومواقفه «صلى الله عليه
وآله» الدروس والعظات والعبر، ولتكون لنا نهج حياة، ومنار هداية، ودليل
خير وفلاح.
وليُعلم:
أن كثيراً
مما يذكر في هذه الغزوات والسرايا، يحتاج إلى بحث وتمحيص، وقد لا نرى
ضرورة كبيرة للمبادرة لتحقيقه ومعالجته في هذه العجالة،
توفيراً
للفرصة لما هو أهم وأكثر ضرورة وإلحاحاً.
فما نذكره هنا لا يدل على أننا نقطع بصحته، وإنما نذكره
متابعة للمؤرخين، فليعلم ذلك.
ونذكر هذه السرايا حسب الترتيب الزمني، فيما ظهر لدينا،
أو حسب ما نص عليه المؤرخون فنقول:
ويقولون:
إنه في هلال المحرم، على رأس خمسة وثلاثين شهراً
من الهجرة،
وقيل:
في آخر سنة ثلاث، على رأس أربعة وثلاثين شهراً
كانت سرية أبي سلمة، عبد الله بن عبد الأسد، إلى قطن([1])،
وكان معه مئة وخمسون رجلاً
من الأنصار والمهاجرين،
منهم:
أبو عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، وأسيد بن حضير، وسالم مولى أبي
حذيفة، وغيرهم.
فإن رجـلاً
من طيء، وقيل:
من نفس الـذين
توجـه
أبو سلمة لغزوهم ـ واسمه الوليد بن زهير بن طريف ـ وقيل:
الوليد بن الزيه الطائي،
ولعله تصحيف زهير، أو العكس ـ كان قد قدم المدينة لزيارة زينب الطائية
ابنة أخيه، وزوجة طليب بن عمير ـ فأخبر صهره أن طليحة وسلمة ابني خويلد
قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يريدون أن يدنوا من المدينة لحرب رسول
الله «صلى الله عليه وآله».
وقالوا:
نسير إلى محمد في عقر داره، ونصيب من أطرافه؛ فإن لهم
سرحـاً
يرعى جـوانـب
المدينة، ونخرج على متون الخيـل،
فقد أربعنا خيلنا ـ أي أرعيناها الربيع ـ ونخرج على النجائب المخبورة؛
فإن أصبنا نهباً
لم ندرك، وإن لاقينا جمعهم كنا قد أخذنا للحرب عدتها؛ معنا خيل و لا
خيل معهم، ومعنا نجائب أمثال الخيل، والقوم منكوبون قد أوقعت بهم قريش،
فهم لا يستبلون دهراً
ولا يثوب لهم جمع.
فقال رجل منهم اسمه:
قيس بن الحارث: يا قوم، والله ما هذا برأي، ما لنا
قبلهم وتر، ولا هم نهبة لمنتهب، إن دارنا لبعيدة من يثرب، ما لنا جمع
كجمع قريش، مكثت قريش دهراً
تسير في العرب تستنصرها، ولهم وتر يطلبونه، ثم ساروا وقد امتطوا الإبل،
وقادوا الخيل، وحملوا السلاح، مع العدد الكثير، ثلاثة آلاف مقاتل سوى
أتباعهم، وإنما جهدكم أن تخرجوا في ثلاث مئة رجل، إن كملوا، فتغررون
بأنفسكم، وتخرجون من بلدكم، ولا آمن أن تكون الدائرة عليكم.
فكاد ذلك أن يشككهم في المسير، وهم على ما هم عليه بعد،
فذهب به صهره إلى النبي «صلى الله عليه وآله»؛ فأخبره كما أخبره.
وفي رواية:
أنهم كانوا قد جمعوا، وتوجهوا إلى المدينة، ثم بدا لهم
الرجوع، فرجعوا إلى منازلهم.
وعند البلاذري:
كانوا قد جمعوا جمعاً
عظيماً.
فبعث رسول الله «صلى الله عليه وآله» أبا سلمة، وأرسل
معه نفس ذلك الرجل الذي أخبره بجمعهم، وقال «صلى الله عليه وآله» لأبي
سلمة: سر حتى تنزل أرض بني أسد، فأغر عليهم، قبل أن تلاقى عليك جموعهم.
فخرج، وكان الطائي دليلاً
خريتاً
ـ أي ماهراً
ـ فأغذّ السير فسار بهم أربعاً
إلى قطن، وسلك بهم غير الطريق وعارض الطريق، وسار بهم ليلاً
ونهاراً.
وفي رواية أخرى:
أنهم كان يسيرون في الليل ويكمنون في النهار ليعمي
عليهم الأخبار، فسبقوا الأخبار، وانتهوا إلى أدنى قطن، ماء من مياه بني
أسد.
فتذكر رواية:
أن أبا سلمة أغار على سرحهم ودوابهم وأصابوا ثلاثة
أعبد، كانوا رعاة، وهرب الباقون، وأخبروا قومهم بمجيء أبي سلمة، وكثرة
جيشه ـ وبتعبير الواقدي: وكثروه عندهم ـ .
فخافوا، وهربوا عن منازلهم في كل وجه، ثم ورد أبو سلمة،
فوجد الجمع قد تفرق، وجعل أصحابه ثلاث فرق، فرقة أقامت، وفرقتان أغارتا
في ناحيتين شتى، وأوعز إليهم ألا يمعنوا في طلب أحد، وألا يفترقوا،
وألا يبيتوا إلا عنده، واستعمل على كل فرقة عاملاً
منهم؛ فآبوا إليه جميعاً
سالمين، ولم يلقوا أحداً،
وجمعوا ما قدروا عليه من الأموال ورجعوا إلى المدينة.
وفي رواية أخرى:
أنه لقيهم فقاتلهم، فظفر وغنم، وأنه قتل عروة بن مسعود
(الصحيح: مسعود بن عروة) في هذه الغزوة على ما قاله أبو عبيدة البكري.
وأن أبا سلمة لما ورد قطن، وجدهم قد جمعوا جمعاً،
فأحاط بهم أبو سلمة في عماية الصبح، فوعظ القوم ورغبهم في الجهاد،
وأوعز إليهم في الإمعان في الطلب، وألف بين كل رجلين، فانتبه الحاضر
قبل حملة القوم عليهم، فتهيأوا وأخذوا السلاح، أو أخذه بعضهم، فقتل سعد
بن أبي وقاص رجلاً
منهم، وقتل رجل منهم مسعود بن عروة، فحازه المسلمون إليهم، حتى لا يسلب
من ثيابه، ثم حمل المسلمون فانكشف المشركون، وتفرقوا في كل وجه، ثم أخذ
أبو سلمة ما خف لهم من متاع القوم، ولم يكن في المحلة ذرية، ثم انصرفوا
راجعين إلى المدينة، حتى إذا كانوا من الماء على مسيرة ليلة أخطأوا
الطريق، فهجموا على نعم لهم، فيها رعاؤهم، فاستاقوا النعم والرّعاء،
فكانت غنائمهم سبعة أبعرة.
وفي رواية:
أنهم لما أخطأوا الطريق..
استأجروا دليلاً
فقال لهم: أنا أهجم بكم على نعم؛ فما تجعلون لي منه؟
فقالوا:
الخمس.
قال:
فدلهم على النعم، وأخذ خمسه.
وفي نص آخر:
أن أبا سلمة أعطى الدليل الطائي ما أرضاه، وعزل للنبي
«صلى الله عليه وآله» عبداً،
(صفي المغنم)، ثم خمسها، وقسم الباقي على السرية، فبلغ سهم كل واحد
سبعة أبعرة، وأغناماً.
وكانت مدة غيبتهم عشرة أيام، وقيل:
أكثر من ذلك([2]).
ولنا على ما تقدم ملاحظات، هي:
ألف:
إن النص المتقدم يقول: إن سرية أبي سلمة إلى قطن قد
كانت في هلال المحرم، على رأس خمسة وثلاثين شهراً
من الهجرة.
ونقول:
أولاً:
إن من الواضح:
أن هجرة الرسول الأعظم
والأجلِّ
الأكرم «صلى الله عليه وآله» قد كانت في شهر ربيع
الأول.
وهذا معناه:
أن سرية أبي سلمة كانت على رأس أربعة وثلاثين شهراً،
إلا إذا كان المقصود: أنها كانت في أول الشهر الخامس والثلاثين كما هو
الأولى.
ثانياً:
إنها إذا كانت في أول المحرم، فلا يمكن أن تكون في أول
السنة الرابعة، إلا بنحو من المسامحة، وزيادة شهرين، لأن الهجرة كانت
في ربيع الأول، كما قلنا، وكان هو أول السنة، وتغييره إلى المحرم إنما
كان من قبل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بعد سنوات طويلة.
فمن قال:
إنها كانت في أول الرابعة فقد اعتمد التاريخ الذي وضعه
عمر بن الخطاب، وتسامح بإضافة شهرين.
ومن قال:
إنها كانت في أواخر الثالثة فقد اعتمد التاريخ الأصيل
الذي وضعه النبي «صلى الله عليه وآله» والذي يكون أول السنة فيه هو
ربيع الأول،
ويكون كلامه أكثر دقة وانسجاماً
مع الواقع.
ثالثاً:
إن كون سرية أبي سلمة هذه قد كانت سنة ثلاث في آخرها،
أو في أول سنة أربع، لا يتلاءم مع القول بأن أبا سلمة قد توفي سنة
اثنتين ولا مع القول بأنه قد توفي في جمادى الآخرة سنة ثلاث، حسبما
قدمناه، حين الكلام على وفاته.
رابعاً:
إنه قد تقدم في المجلد الخامس من هذا الكتاب بعض
القرائن التي تفيد أنه توفي سنة اثنتين، وهو ما ذهب إلىه
البعض، حسبما ألمحنا حين الكلام على وفاته.
وقد ذكرنا في الجزء الخامس:
أن أم سلمة قد حضرت زفاف فاطمة كزوجة للنبي، إلا أن
تكون أم سلمة قد حضرت هذا الزفاف كامرأة من النساء ويكون المراد ببيت
أم سلمة: البيت الذي صار لها فيما بعد. وإن كان ذلك خلاف الظاهر. حيث
إن النبي «صلى الله عليه وآله» إنما كان يبني لزوجاته البيوت بعد زواجه
بهن، ولأنه يظهر من الرواية: أنه «صلى الله عليه وآله» كان يتعامل معها
كزوجة، كما ألمحنا إليه فيما تقدم. والله هو العالم بحقيقة الحال.
ب: يلاحظ:
أن الرواية المتقدمة تقول: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد أمر
أبا سلمة بالإغارة عليهم بغتة، قبل أن يعلموا أو يجمعوا الجيش.
ولعل ذلك يرجع إلى أنهم كانوا قد بادروا هم إلى نصب
العداء للمسلمين، وجمع الجموع للإغارة على المدينة، فأصبحوا من
المحاربين، الذين لا بد من كسر شوكتهم، ودفع غائلتهم، ولم يعد لهم
أمان، ولا حرمة، ولا عهد. فلا مانع من تربص غفلتهم، والإغارة عليهم
بغتة، فإنما:
«على
نفسها جنت براقش»،
ولا يعتبر ذلك غدراً
بهم، ولا تجنياً
عليهم، فإن المحارب إذا قصر في الاحتياط لنفسه، لا يكون معذوراً،
ولا يجب على غيره أن ينوب عنه في ذلك.
ومن جهة ثانية:
فإن هذا الأمر من شأنه أن يقلل من حجم الخسائر في
الأرواح في صفوف المسلمين، وحتى في صفوف المشركين أيضاً.
كما أن من شأنه أن يعود بالفائدة الكبيرة على المسلمين
من الناحية الاقتصادية
ـ
كما يتضح من حجم الغنائم التي حصلوا عليها
ـ ويضعف
عدوهم من هذه الناحية
أيضاً،
وبالتالي فإنه يربك خطط العدو وخطواته في مجال التآمر على المسلمين،
وضربهم، ويؤجل كثيراً
من المشاكل، والأخطار إلى أجل مسمى، الأمر الذي ربما يحمل معه الكثير
من المستجدات، التي قد لا يبقى معها مجال للحرب، ولا للخصومة على
الإطلاق.
ولعل ما ذكره
ابن سعد من قول الرسول «صلى الله عليه وآله» لأبي سلمة: سر حتى تنزل
أرض بني أسد فأغر عليهم قبل أن تلاقى عليك جموعهم([3])،
يشير إلى الأمرين السابقين.
ج:
إن ذلك يعطينا: أنه لا مانع من المبادرة إلى أعمال
وقائية، تمنع الأعداء من تسديد الضربات القاسية للمؤمنين، ما دام العدو
بصدد ذلك، ويعد العدة له.
أضف إلى ذلك:
أن غزو المسلمين في عقر دارهم يضعف أمرهم، ويوهن عزمهم،
ويطمع فيهم أعداءهم.
أما إذا بادروا هم إلى مبادءة أعدائهم في عقر دارهم،
فإن ذلك أبعد للسمع، وأنكى للعدو، وأقوى لقلوب المسلمين.
د:
لعل الرواية
الأخيرة أقرب إلى الصواب، إذا ثبت أن مسعود بن عروة أو عروة بن مسعود
قد قتل في هذه الغزوة: كما نص عليه البعض([4]).
كما ويلاحظ:
دقة نصوصها وتفصيلاتها، ولعلها لا تأبى عن الجمع بينها
وبين الرواية الأخرى التي لا تخلو من شيء من الإجمال.
وتعرف بسرية عبد الله بن أنيس.
ويقولون:
إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد بعث عبد الله بن
أنيس ـ وحده ـ إلى قتل سفيان بن خالد، وفي الإكتفاء والمواهب اللدنية:
خالد بن سفيان، حيث بلغ رسول الله «صلى الله عليه وآله» أنه يجمع
الجموع لحرب المسلمين، وضوى إليه بشر كثير من أفناء الناس.
فخرج عبد الله بن أنيس إليه ليقتله،
فرواية تقول:
لقيه وهو في ظعن يرتاد لهن منزلاً،
فسأله عن نفسه، فأخبره بأنه رجل من العرب سمع بجمعه لهذا الرجل أي
النبي فجاءه لذلك، فقال: أجل، أنا في ذلك.
فمشى معه شيئاً، حتى إذا أمكنته الفرصة قتله، وترك
ظعائنه مكبات عليه.
وعند البلاذري:
أنه قتله وهو نائم. ويبدو أنه ناظر إلى ما جاء في
الطبقات وغيره، عن ابن أنيس قال:
«واستأذنت
رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن أقول، فأذن لي، فخرجت، وأخذت سيفي،
وخرجت أعتزي إلى خزاعة ـ وفي السيرة الحلبية والواقدي: أن رسول الله
«صلى الله عليه وآله» أمره بالانتساب إليها ـ حتى إذا كنت ببطن عرنة([5])
لقيته يمشي ووراءه الأحابيش، ومن ضوى إليه».
فمشى معه، وحدثه بما هو قريب مما تقدم، وفيه أنه استحلى
حديث ابن أنيس،
حتى انتهى إلى خبائه؛ وتفرق عنه أصحابه، حتى إذا هدأ الناس وناموا،
اغتررته فقتلته، وأخذت رأسه، ثم دخلت غاراً
في جبل، وضربت العنكبوت عليَّ
الخ..
ثم صار يسير بالليل ويكمن بالنهار حتى قدم بالرأس على
النبي، فوضعه بين يديه، وكانت مدة غيبته ثمانية عشر يوماً.
ويذكر أيضاً:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» أعطاه بهذه المناسبة عصاً
ليتخصر بها في الجنة، فأوصى أهله، حتى لفوها في كفنه ـ أو بين جلده
وكفنه ـ ودفنوها معه.
كما أنه هو نفسه قد ذكر:
أنه حينما رأى خالداً،
وكان قد دخل وقت صلاة العصر، خشي أن يكون له معه ما يشغله عن الصلاة،
فصلى وهو يمشي نحوه، ويومي برأسه.
أما بالنسبة لتاريخ هذه القصة،
فقد ذكرها المؤرخون في السنة الرابعة يوم الإثنين لخمس خلون من المحرم،
على رأس خمسة وثلاثين شهراً
من الهجرة، ورجع يوم السبت لسبع بقين من المحرم.
وعند الواقدي:
في المحرم على رأس أربعة وخمسين شهراً.
وعند البلاذري:
سنة ست، وفي الوفاء: في الخامسة، بعد غزوة بني قريظة
وذكره المسعودي في التنبيه والإشراف بلفظ: قيل.
وبعض أهل السير أوردها بعد سرية
عاصم بن ثابت، وقال:
إنه ـ يعني سفيان بن خالد ـ كان سبباً
لقصة الرجيع التي قتل فيها عاصم وأصحابه. فتكون قصة قتل سفيان بعد سرية
الرجيع([6]).
ولنا هنا ملاحظات:
ألف:
بالنسبة لمدى اعتبار الرواية، نشير إلى:
1 ـ
إن الملاحظ: هو أن المؤرخين والمحدثين إنما يروون هذه
الحادثة الهامة عن خصوص بطلها عبد الله بن أنيس، وذلك أمر ملفت للنظر
حقاً:
فلماذا لم ترو عن غيره يا ترى؟!
هذا مع ملاحظة:
أنه يحاول إعطاء نفسه بعض الأوسمة البراقة، مثل قوله عن نفسه: إنه كان
لا يهاب الرجال.
أو قوله:
فاستحلى حديثي، أو قصة تخصره بالعصا في الجنة، أو نحو
ذلك. مما يظهر من تتبع نصوص الرواية في المصادر المشار إليها في الهامش
آنفاً
وغيرها.
2 ـ
إننا نلاحظ: أنه يدخل غاراً،
ثم يحدث له نفس ما حدث للنبي «صلى الله عليه وآله» حين هجرته، من نسج
العنكبوت عليه؛ ثم يأتي رجل، ومعه إداوة ضخمة، ونعلاه في يده، وكان ابن
أنيس حافياً،
وكان أهم أمره عنده العطش، فوضع إداوته ونعله، وجلس يبول على فم الغار،
ثم قال لأصحابه: ليس في الغار أحد، فانصرفوا راجعين، فخرج عبد الله
وأخذ النعلين، وشرب من الإداوة ولم يره أحد فطلبهما صاحبهما بعد ذلك
فلم يجدهما فرجع إلى قومه، ثم سار عبد الله نحو المدينة([7]).
وهذه هي نفس الأمور التي حدثت للنبي «صلى الله عليه
وآله» في غار ثور حين هجرته،
لا ندري كيف عادت وتكررت لابن أنيس دون سواه!! ومن دون أي تفاوت أو
تغيير تقريباً.
ويلاحظ أيضاً:
أن هذا الرجل يحاول أن ينسب قتل سلام بن أبي الحقيق اليهودي لنفسه
أيضاً: كما سنرى.
3 ـ
إن الرواية ـ رغم أنها عن شخص واحد، وهو نفسه بطلها ـ وردت مختلفة
النصوص إلى حد التنافي، كما يظهر من ملاحظة ما تقدم.
4 ـ
إن هذه الرواية تقول: إن عبد الله بن أنيس قد حمل رأس سفيان إلى النبي
«صلى الله عليه وآله».
ولكن قد جاء عن الزهري قوله:
«لم
يحمل إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» رأس إلى المدينة قط»([8]).
وقد جعل الحلبي قصة حمل رأس سفيان وكعب بن الأشرف إلى
النبي «صلى الله عليه وآله» رداً
على الزهري، وإبطالاً
لقوله([9]).
ونقول:
إن ذلك ليس بأولى من العكس، بل العكس هو الأولى، ما دام
الزهري بصدد تكذيب ما نقل من ذلك. فلولا أنه بحث عن ذلك واستقصاه، وسأل
عنه، لما حكم بهذا الحكم القاطع.
ولا سيما بملاحظة أن ناقل إحدى القصتين رجل واحد، هو
نفس بطلها، إلى آخر ما تقدم من وجوه الوهن في القصة.
ب:
بالنسبة لتاريخ الرواية، وكونها على رأس خمسة وثلاثين
شهراً،
في السنة الرابعة، فقد قلنا بعض ما يرتبط بذلك حين الكلام على سرية أبي
سلمة إلى قطن.
كما أننا قدمنا آنفاً:
أن هذا التاريخ محل نظر، ولا بد أن تكون بعد سرية
الرجيع، وهي بعد التاريخ الآنف الذكر.
ومهما يكن من أمر:
فقد تكلمنا حول الاغتيالات في الجزء السادس من هذا
الكتاب فما بعده،
فلا نعيد.
ج:
ولو أننا أغمضنا النظر عما تقدم، ففي الرواية دلالة على
جواز التبرك بآثاره «صلى الله عليه وآله».
وحتى لو فرضنا:
أن الرواية المتقدمة غير صحيحة من الأساس، فإن قبول المؤرخين القدامى
هذا الأمر
ـ «التبرك»
ـ
وإدراجه في كتبهم، من دون اعتراض عليه، أو تسجيل ملاحظة
حوله يشير إلى أنهم كانوا لا يرون هذا التبرك شركاً
بالله سبحانه، ولا خروجاً
عن الدين.
وقد تحدث العلامة البحاثة الشيخ علي الأحمدي «رحمه
الله»
حول هذا الموضوع بإسهاب في كتابه القيم: التبرك، تبرك الصحابة
والتابعين بآثار الأنبياء والصالحين فليراجعه من أراد.
د: لقد ذكر البعض([10]):
أن قبيلة هذا الرجل وهي هذيل كان لها خصومات دامية مع خزاعة([11]).
فكيف يمكن لابن أنيس أن يدَّعي:
أنه من خزاعة، ثم يثق به سفيان بن خالد؟!
([1])
قطن: جبل بناحية فيد كذا في المواهب اللدنية وفي غيره: ببلاد
بني أسد على يمينك إذا فارقت الحجاز، وأنت صادر من النقرة، قال
إسحاق: قطن: ماء من مياه بني أسد بنجد. راجع: تاريخ الخميس ج1
ص450 وعدداً من المصادر الآتية في الهامش التالي.
([2])
راجع فيما تقدم المصادر التالية: مغازي الواقدي ج1 ص341 ـ 346
وتاريخ الخميس ج1 ص450 والمحبر ص117 والسيرة النبوية لابن كثير
ج3 ص121، 122 والبداية والنهاية ج4 ص61 و 62 وأنساب الأشراف
(قسم حياة النبي «صلى الله عليه وآله») ص374، 375 والمواهب
اللدنية ج1 ص100 وطبقات ابن سعد ج2 قسم 1 ص35 وسيرة مغلطاي ص51
والسيرة الحلبية ج3 ص164 و 165 والسيرة النبوية لدحلان ج1
ص254.
([3])
الطبقات ج2 قسم 1 ص35 ومغازي الواقدي ج1 ص341 والسيرة الحلبية
ج1 ص164.
([4])
راجع: مغازي الواقدي وغيره مما تقدم، وأسد الغابة ج4 ص359 عن
ابن إسحاق، والإستيعاب بهامش الإصابة ج3 ص448.
([5])
بطن عرنة: واد بعرفة، وليس من الموقف.
([6])
راجع قضية سفيان وابن أنيس إجمالاً أو تفصيلاً في المصادر
التالية: تاريخ الخميس ج1 ص450 و 451 ومغازي الواقدي ج2 ص531 ـ
533 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص267 والمحبر ص119 وزاد
المعاد ج2 ص109 وأنساب الأشراف (قسم سيرة النبي «صلى الله عليه
وآله») ص376 والمواهب اللدنية ج1 ص100 والسيرة الحلبية ج3
ص164و 165 وطبقات ابن سعد ج2 قسم 1 ص35 و 36 وتاريخ اليعقوبي
ج2 ص74 وسيرة مغلطاي ص51 و 52 والإصابة ج2 ص279 عن أبي داود
وغيره والإكتفاء ج2 ص417 ـ 419 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص254
و 255.
([7])
مغازي الواقدي ص533 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص254 و 255
والسيرة الحلبية ج3 ص165.
([8])
السيرة الحلبية ج3 ص165.
([10])
محمد في المدينة ص135.
([11])
راجع مغازي الواقدي ج2 ص843 و 844 و 845 و 846.
|