|
دلالات وعــبـــر
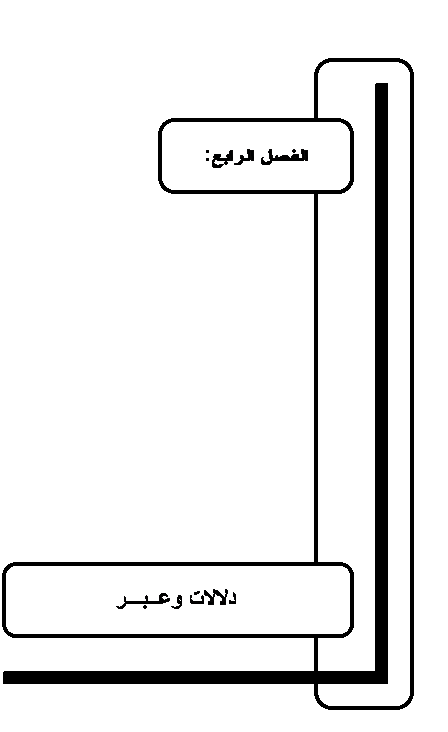
يكفينيك الله، وابنا قيلة:
قد ذكرت الروايات المتقدمة:
أن النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» يجيب على تهديدات عامر بن الطفيل
بقوله:
«يكفينيك
الله، وابنا قيلة».
والمقصود بـ «ابني قيلة»:
الأوس، والخزرج.
وهذه الكلمة تتضمن:
1 ـ
إعزازاً
لجانب الأوس والخزرج.
2 ـ
تحريضاً
لهما على إسداء النصر ضد العدو، الذي لا مبرر لعدوانه، إلا الحمية
الظالمة الخرقاء، حمية الجاهلية، وإلا الانقياد للهوى،
والاستجابة
لنزغ الشيطان.
3 ـ
إن اعتماده «صلى الله عليه وآله» هو على الله أولاً وبالذات، ولكنه في
نفس الوقت يعد العدة، ويعتمد الوسائل المادية في دفع الأخطار المحتملة،
وهذا يدلل على واقعية الإسلام، وعلى أنه لا يتعامل مع الأمور بصورة
تجريدية وذهنية محضة، كما أنه لا يفرط في الاعتماد على القوة المادية،
بل هو يعتمد عليها في صراط اعتماده على الله سبحانه،
فالله هو المصدر الأول للقوة.
بل وحتى القوة المادية، إذا لم تنته إلى الله فإنها
تتحول إلى ركام وحطام لا أثر له، إن لم نقل: إن له الكثير من الآثار
السلبية والهدامة في كثير من الأحيان،
وهذا موضوع حساس وخطير، يحتاج إلى توفر أتم، ووقت أوفى.
النبي
 يُحمِّل
أبا براء المسؤولية: يُحمِّل
أبا براء المسؤولية:
وبعد.. فإننا نجد:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد اعتبر أبا براء هو المسؤول
عما حصل، حينما قال: «هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارهاً متخوفاً».
ونحن نشك في ذلك.
فإن الروايات التي روت لنا ما حصل، لعلها متفقة على أن
أبا براء، لم تكن له أية علاقة بما حدث، لا من قريب، ولا من بعيد،
وقد صرحت بعضها بأنه كان مستاءً جداً مما حصل.
بل إن بعضها يصرح:
بأنه قد مات أسفاً
على ما صنع به عامر ابن أخيه. وعليه فيرد هنا سؤال، وهو:
هل إنه لم تبلغ النبي «صلى الله عليه وآله» الأخبار على
حقيقتها؟
وإذا كان ذلك، فما بال جبرائيل لا يوقفه على حقيقة ما
جرى؟!
أم يعقل أن يكون ما وصل إلينا قد تعمد التعتيم على ما
جرى، أو كان محرفاً
لسبب أو لآخر؟!
ولعل الإجابة الأقرب إلى الواقع هي:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان على علم تام بما حصل،
ولكنه أراد تحريض أبي براء ضد مرتكب الجريمة عامر بن الطفيل؛ بالطريقة
المشروعة، والمقبولة لدى الناس، فلقد كان أبو براء قد قبل ـ مختاراً
ومتبرعاً
ـ بأن يكون مسؤولاً
عن حياة أولئك النفر، وهو الذي بادر إلى إظهار الرغبة بإرسالهم إلى تلك
المنطقة، وحينما عبر النبي «صلى الله عليه وآله» عن مخاوفه من أهل نجد،
نجد أبا براء قد قبل أن يجيرهم، ثم يذهب بنفسه، ويخبر أهل نجد بأنه قد
أجار أصحاب محمد «صلى الله عليه وآله».
ولعل من نتائج موقف النبي «صلى الله عليه وآله» هذا، ثم
مبادرة حسان بن ثابت لتحريض ربيعة بن أبي براء على عامر، أن سأل ربيعة
النبي «صلى الله عليه وآله» أو غيره: إن كانت ضربة أو طعنة لعامر تغسل
عن أبيه هذه الغدرة، فقال «صلى الله عليه وآله»: نعم.
فطعنه ربيعة في حياة أبيه، فقتله،
«كما
في معالم التنزيل»
أو فأشواه، كما في المصادر الأخرى.
وتحدثنا الروايات المتقدمة:
أن عامر بن الطفيل لم يستطع أن يميز النبي «صلى الله
عليه وآله» من بين أصحابه حيث كان جالساً
بينهم كأحدهم حتى يسأل عنه هذا وذاك فيخبرونه.
نعم،
وهذه هي أخلاق الإسلام وتعاليمه، وهذه هي تربيته للإنسان، فهو يربي في
الإنسان إنسانيته أولاً، ويفهمه أن الحكم ليس امتيازاً
وإنما هو مسؤولية وواجب في إطار قاعدة: لا فضل لعربي على عجمي إلا
بالتقوى.
فالإسلام يربي في الإنسان روح الرفض والإدانة لكل
الامتيازات الظالمة، التي يجعلها المتزعمون، وأصحاب الثروات والوجاهات
لأنفسهم، لا لشيء إلا لأنهم أبناء فلان، أو لأنهم يملكون القوة، أو
المال، أو ما أشبه ذلك. من دون أن يقدموا لمجتمعهم أدنى ما توجبه عليهم
القيم والمثل الإنسانية، ولا حتى أن يعترفوا لغيرهم بأبسط الحقوق، حتى
حق الحياة، فضلاً
عن حق الحرية، والعيش بكرامة.
ويلاحظ هنا:
أن عامر بن الطفيل قد ارتكب عملاً
شنيعاً،
يرفضه الخلق الإنساني، ويأنف منه حتى أكثر الناس بعداً
عن المعاني الإنسانية والاخلاقية.
ألا وهو قتل الرسول، (حامل كتاب النبي «صلى الله عليه وآله») وقد جرت
عادة العرب قديماً
«بأن
الرسل لا تُقتَل»([1])
كما أنه يخفر ذمة أبي براء، وما جرت عادة العرب بذلك أيضاً.
وهناك جريمة ثالثة،
وهي أن قتله للرسول كان غدراً
وغيلة وذلك أمر لا يستسيغه حر يحترم نفسه، ويطمح إلى ما كان يطمح إليه
مثل عامر. مع أنه هو نفسه يرسل إلى النبي «صلى الله عليه وآله» يطلب
منه دية الرجلين، اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري في طريقه رغم أن
عمرواً
لم يكن يعلم بالعهد الذي أعطاهما إياه الرسول، ورغم أن ما فعله عامر،
من شأنه أن ينسف كل العهود والمواثيق، ويعطي حق المعاملة بالمثل الذي
تقره جميع الأعراف، ولا تمنع منه الشرائع.
ولكن سماحة الإسلام..
وحرص النبي «صلى الله عليه وآله» على أن يعامل الناس بأخلاقه هو، لا
على حسب أخلاقهم هم، هو الذي جعله لا يتخذ مواقفه من خلال الانفعالات
والمشاعر، التي تنشأ عن إثارات يتعمدها الخصوم في كثير من الأحيان، فإن
الإنسان المسلم لا تزله الرياح العواصف، ولا يفقد توازنه، ولا يتخلى عن
مبادئه ولا يحيد عن هدفه ليصبح أسير مشاعره الثائرة، وانفعالاته
الطاغية ويلبي نداءاتها ويستجيب لإثاراتها.
فنجد النبي «صلى الله عليه وآله» يرسل بدية الرجلين،
ولا يذكّر بشيء مما فعله قومهما، بل هو يظهر استياءه من قتل عمرو بن
أمية لهما، ويصرح بتصميمه على أن يديهما فور علمه بما جرى عليهما، وقبل
أن يرسل إليه عامر بطلب ديتهما.
وبذلك يتميز الإنسان المؤمن عن غيره، يسير كل منهما في
خطه الذي ينبغي له، هذا دليله عقله وحكمته، ورائده رضى ربه، وسلامة
دينه، والفوز بالآخرة، وذاك دليله هواه ورائده شهواته، وهدفه الدنيا،
وزخرفها.
وفي مقابل ذلك نجد عامر بن الطفيل ينقاد لهواه فيقتل
الرسول، والرسل لا تُقتَل، ويخفر الذمة، ويستعمل طريقة الختر والغدر،
وكل ذلك شنيع، وفظيع.
وهو كذلك ينقاد لهواه لأنه يرفض أن يكون موته بغدة كغدة
البعير، ويأنف أن يكون ذلك في بيت سلولية.
أما رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، فهو ينسجم مع أخلاقه، كما أنه ينطلق من مبادئه
السامية في كل مواقفه ولا يخرجه أي شيء عن توازنه ومتانته، لا يزعزع
ثباته، ولا تزله الرياح العواصف مهما كانت هوجاء، وعاتية([2]).
ديَّة
الرجلين لماذا؟!
ومن جهة ثانية نلاحظ:
أن قبيلة عامر قد رفضت الاستجابة لطلب ابن الطفيل بقتل
المسلمين، وذلك وفاء لذمة أبي براء وجواره.
ولا بد أن يكون موقف النبي «صلى الله عليه وآله» هذا
مؤثراً
في إعطاء صورة حسنة للعامريين،
ويفترض البعض أيضاً:
أن ذلك يزيد في حالة عدم الانسجام فيما بين هذه القبيلة وبين عامر بن
الطفيل، الذي ارتكب تلك الجريمة النكراء، فهو «صلى الله عليه وآله»
يريد استمالة بني عامر إلى جانبه، ولهذا قرر التدخل في السياسة
الداخلية للقبيلة.
ولكننا نقول:
إن بعض النصوص تؤكد أن موقف النبي «صلى الله عليه وآله»
هذا قد كان
منطلقاً
من قيمة أخلاقية، ورسالية، فرضها عليه واقع أن هذين الرجلين كانا من
أهل ذمته «صلى الله عليه وآله»، ولم يقتلا من أجل ذنب أتياه، حسبما
أشرنا إليه آنفاً.
ويضيف ذلك البعض:
أنه كان معيباً
في حق بني عامر، ترك الرجال يقتلون، وهم تحت حمايتهم، ولهذا كان الشاعر
المسلم كعب بن مالك واضحاً
في هذا الصدد.
إلى أن قال:
ولم يكن محمد
يستطيع التخلي عن بني عامر قبل التخلي عن كثير من الآمال، ولكن هذا لم
يمنعه من أن يصلي ويطلب من الله معاقبة عامر([3]).
ولكننا نقول:
إنه «صلى الله عليه وآله» قد دعا على رعل وذكوان وعصية، ولم أجد أنه
دعا على بني عامر، بل ذكر الواقدي: أنه «صلى الله عليه وآله» قال:
اللهم اهد بني عامر، واطلب خفرتي من عامر بن الطفيل([4]).
ولعل عدم مشاركة بني عامر في الدفاع عمن أجارهم أبو براء، إنما هو من
أجل أن لا تحدث انشقاقات خطيرة بينهم وبين غيرهم ممن استجاب لابن
الطفيل.
وأما القول بأن تخلي النبي «صلى
الله عليه وآله»
عن بني عامر، معناه التخلي عن كثير من الآمال، فإنه غير واضح، إذ ماذا
يمثل بنو عامر، وما هو الدور الذي قاموا به، أو يمكنهم أن يقوموا به في
نصرته «صلى الله عليه وآله»؟!
وما أقل عقل عامر بن الطفيل، وما أحقر طموحاته وأحطها،
وما أضيق الأفق الذي يفكر فيه، حينما نجده يفعل الأفاعيل انطلاقاً
من حالة انفعالية أثارها أمر تافه، وتافه جداً، جعله يرتكب أبشع جريمة،
ويخالف كل الأعراف والتقاليد، فيغدر، ويخفر الذمم ويقتل الرسول، ويقتل
الكثيرين غيره، ويبادر إلى الزحف نحو المدينة، كل ذلك من أجل أي شيء يا
ترى، وفي سبيل أية قضية؟!
إن ذلك كله..
كما ورد في الروايات قد كان من أجل أن صبياً
عطس، فشمَّته
النبي «صلى الله عليه وآله» لأنه حمد الله، ويعطس عامر فلا يحمد الله،
فلا يشمِّته
رسول الله «صلى الله عليه وآله».
وما كان أحراه بأن يستفيد من هذه القضية درساً
حياتياً
مفيداً،
فيتوجه نحو الله سبحانه ويعتبر أن العز، والشرف، والسؤدد بالقرب منه
تعالى، والعمل بما يرضاه، وأن كل شيء بدون الله فهو حائل زائل، وزخرف
باطل، لا قيمة له، فيربي نفسه على ذكر الله، والتقرب إليه لينال كل ما
يصبو إليه من عز وشرف وحياة وسعادة.
ولكنه يتخلى عن ذلك كله، ليتبع خطوات الشيطان، ويشمخ
بأنفه، وينظر في عطفه، ويصر مستكبراً
صادَّاً
عن ذكر الله سبحانه، يتخيل أن بإمكانه أن يحصل على شيء بدون الله،
وبدون اللجوء إليه سبحانه، فتكون النتيجة هي أنه يجلب لنفسه الوبال،
والدمار، ويخسر الدنيا والآخرة وبئس للظالمين بدلاً.
أما مطالب عامر بن الطفيل التي عرضها على النبي «صلى
الله عليه وآله» فهي تنقسم إلى قسمين:
أحدهما:
يجسد طموحاته وأطماعه الدنيوية وحبه
للتسلط، والاستئثار، فنجده يساوم النبي «صلى الله عليه وآله» ـ كما
فعله مسيلمة الكذاب فيما بعد([5])
ـ ليقاسمه السلطة على الناس، بزعمه، فيقترح عليه أن يكون للنبي «صلى
الله عليه وآله» السهل، ويكون لعامر أهل الوبر، من دون أن يكون لديه أي
مبرر لذلك، سوى الغطرسة والطغيان، والاعتزاز بألف أشقر وألف شقراء
والاعتماد على قوة السيف، الذي يرى فيه المحلل لكل محرم، ويسمح له
بارتكاب أي مأثم،
ومن دون أن يعطي لأولئك الناس الذين يطمح للتسلط عليهم حق الاختيار،
الذي يساوي حق الحياة،
وكأن الناس سلع تشرى، وتباع وتوهب.
هذا عدا عن أنه لا يملك هو نفسه أي امتياز يخوله
الاستئثار بشيء من الامتيازات دون غيره،
فهو لا يملك العلم النافع، ولا يرفع شعار الهداية لسبيل الله والحق،
والخير، ولا غير ذلك من مقومات.
الثاني:
إنه يرشح نفسه لمنصب خطير وهام، ألا وهو خلافة النبوة، وقيادة الأمة
وهدايتها. هذا المنصب الذي لم يكن يملك أي شيء من مقوماته: خلقياً،
وإنسانياً،
وسلوكياً،
فضلاً
عن الامتياز العلمي، وسائر القدرات والمؤهلات الذاتية، التي لا بد من
توفرها في من يتصدى لمنصب كهذا.
ولا أدل على ذلك من أنه تثور ثائرته، لأن الرسول «صلى
الله عليه وآله» يشمِّت
غلامه الذي حمد الله، ولم يشمِّته
هو، حيث لم يحمد الله تعالى.
وبعد هذا..
فكأنه لم يسمع ما أجاب به النبي «صلى الله عليه وآله»
أحد بني عامر بن صعصعة، حينما عرض على النبي «صلى الله عليه وآله» في
مكة نفس ما عرضه هو عليه، فأجابه «صلى الله عليه وآله» بقوله:
«إن
الأمر لله، يضعه حيث يشاء».
فلا مجال لرأي أحد في أمر الإمامة بعده «صلى الله عليه
وآله» ولا يثبت ذلك بالانتخاب، ولا بالشورى، ولا هو من صلاحيات النبي
«صلى
الله عليه وآله»
نفسه، وإنما هو فقط من صلاحيات رب العزة، وخالق الكون دون سواه؛ فهو
الذي يختار ومنه يصدر القرار، وقد قدمنا بعض ما يرتبط بهذه القضية في
الجزء الثالث من هذا الكتاب في فصل: حتى بيعة العقبة، فراجع.
وبعد.. فقد ذكرت الروايات:
أن أبا براء،
ملاعب الأسنة، قد أرسل إلى النبي «صلى الله عليه وآله» يستشفيه من
دبيلة كانت في بطنه، فتناول رسول الله «صلى الله عليه وآله» جبوبة (وهي
المدرة) من تراب، فأمرّها على لسانه ثم دفها بماء، ثم سقاه إياها،
فكأنما أنشط من عقال([6]).
وفي نص آخر:
فتفل فيها
وقال: دفها بماء، ثم أسقاه إياه ففعل؛ فبرئ، ويقال: إنه بعث إليه بعكة
عسل؛ فلم يزل يلعقها حتى برئ([7]).
ويذكرنا هذا النص بما قدمناه عن مشركي مكة أيضاً، الذين
يعلم كل أحد ما لاقاه النبي «صلى الله عليه وآله» منهم، حتى اضطروه إلى
الهجرة، فإنهم مع عدائهم له «صلى الله عليه وآله» يودعون أموالهم عنده
«صلى الله عليه وآله»، حتى ليضطر إلى إبقاء علي أمير المؤمنين «عليه
السلام» في مكة ثلاثة أيام ـ حين الهجرة ـ ليؤدي الودائع والأمانات إلى
أصحابها.
ومعنى ذلك هو:
أنهم يرون في هذا النبي «صلى الله عليه وآله»: أنه متصل
بالغيب، حتى ليرسلون إليه يستشفونه من أمراضهم، كما ويرون فيه أنه في
غاية الأمانة والرعاية لحقوق الناس، وأموالهم.
الأمر الذي لا بد أن يكشف لهم عن ملكات وفضائل أخلاقية
نادرة لديه «صلى الله عليه وآله» وأنه لا مطمع له بمال، ولا بمتاع
دنيا.
إذاً،
فإنهم لا بد أن يتلمسوا التناقض الهائل الذي يجدون
أنفسهم فيه، فهم يكرهونه، ويكذِّبونه،
ويتهمونه، وهم كذلك يرون طهارته، وعفته وصدقه، وأمانته،
حتى لقبوه بالصادق الأمين. فيعيشون حالة الصراع الداخلي مع ذاتهم، ومع
وجدانهم، وما أشده من صراع، وما أعظم البركات التي يحصلون عليها لو
انتصر عقلهم ووجدانهم. وما أخطرها وأشدها دماراً،
لو انتصرت المشاعر والأهواء،
والمصالح الشخصية الرخيصة.
وليراجع الجزء الثاني من هذا الكتاب في بحث: العوامل
المساعدة على انتصار الإسلام وانتشاره ففيه مطالب أخرى ترتبط بهذا
المقام.
ولعل هذا الإحساس الوجداني الصريح، الذي أدركه أبو براء
من خلال مصادقته له «صلى الله عليه وآله» ـ فإنه كان له صديقاً
ـ هو الذي جعل هذا الرجل يتحمس لأن يرسل النبي «صلى الله عليه وآله»
دعاته إلى نجد، ثم يتعهد بأن يكونوا في جواره، وتحت حمايته.
رفضه
 هدية
ملاعب الأسنة منطلقاته ودلالاته: هدية
ملاعب الأسنة منطلقاته ودلالاته:
وتواجهنا في الروايات المتقدمة قضية رفضه «صلى الله
عليه وآلـه»
هدية أبي براء، ملاعب الأسنة، على اعتبار أنه «صلى الله عليه وآله» لا
يقبل هدية مشرك، حتى ولو كان صديقاً
له.
وقد تقدم في فصل:
أبو طالب مؤمن قريش،
موارد أخرى في هذا المجال، وهي تدل على:
أن ذلك كان نهجاً
له «صلى الله عليه وآله» ويصر على الالتزام به، والتعامل على أساسه.
ونحن في مجال فهم الهدى النبوي في هذا الاتجاه، نشير
إلى ما يلي:
ألف:
إن من الواضح أن المشركين لا يقيسون الأمور بمقاييس
صحيحة، ولا يبنون علاقاتهم مع الآخرين
على أساس المثل والقيم والمبادئ عموماً.
وإنما ينطلقون في تقييمهم للأمور من نظرة ضيقة، ومصلحية،
قائمة على أساس الأهواء، والطموحات غير المتزنة ولا المسؤولة.
وعلى هذا،
فقلما تجدهم يبادرون إلى إتحاف بعضهم بالهدايا ونحوها من منطلق منطقي،
أو من شعور إنساني نقي وبريء،
أو من مبادئ إنسانية، ومثل عليا.
وإنما غالباً
ما يكون ذلك تزلفاً،
وتصنعاً؛
بهدف الحصول على ما هو أغلى، وما هو أهم، أو بهدف دفع غائلة من لا
يجدون لدفع غائلته وسيلة، ولا عن التصنع والتزلف إليه مهرباً،
ومحيصاً.
ولأجل ذلك..
فلو فرض أن النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» قد قبل هديتهم. فعدا عن
كون ذلك يدخل في نطاق الموادة لهم، وهو ما ينهى عنه القرآن الكريم
صراحة؛ فإنه لو أراد بعد ذلك أن يتخذ من انحرافاتهم وجرائمهم موقفاً
رافضاً
ومسؤولاً،
فلسوف يعتبرون ذلك، ويعتبره كل من هو على شاكلتهم، نكراناً
للجميل، وكفراناً
للنعمة، الأمر الذي يجعل من هذا الأمر مبرراً لأية سلبية تظهر على
مواقفهم منه فيما يأتي من الأيام.
كما أن رفض النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» لهديتهم
لا يعتبر مقابلة للإكرام بضده، ولا يعد خلقاً
سيئاً،
أو تصرف نابياً.
إذ
إن
النبي «صلى الله عليه وآله» يملك كل الحق في أن يفهمهم أن القضية قضية
مصيرية، لا يمكن الإغضاء عنها، ولا التساهل فيها، ولا تخضع للمساومة،
ولا للمداهنة، ولا يمكن التنازل عن أي شيء فيها في مقابل المال
والنوال.
ولا سيما إذا كان إعطاء المال أو تقديم الهدية يوزن
بميزان جاهلي، مصلحي، حسبما ألمحنا إليه.
ب:
وبعد فإن إهداء أبي براء ملاعب الأسنة للنبي «صلى الله
عليه وآله»، وقول حامل الهدية حينما رد النبي الهدية:
«ما
كنت أرى أن رجلاً
من مضر يرد هدية أبي براء»([8])
يدل على أن أبا براء كان رجلاً
ذا أهمية في مجتمعه الذي يعيش فيه، حتى إن أي مضري لا يجرؤ على رد
هديته احتراماً
وتقديراً
له.
فإهداؤه للنبي «صلى الله عليه وآله» يدل على أن النبي
«صلى الله عليه وآله» كان قد ذاع صيته، وظهرت هيبته في مختلف أرجاء
المنطقة آنئذٍ، وبدأ يتزلف إليه المتزلفون، ويخطب وده الخاطبون.
ج:
كما أن الأمر الذي يثير العجب حقاً
هو: أننا نجد أبا براء ذلك الرجل المعروف والمبجل في محيطه، والذي لا
يرد هديته مضري ليس فقط يتلقى هذه الصدمة الكبيرة، وهي رد هديته من قبل
صديقه، بالإذعان والقبول، وإنما هو يطلب من النبي إرسال دعاته إلى بلاد
نجد، ويقبل أن يتحمل مسؤولية حمايتهم، وكونهم في جواره.
هذا كله..
عدا عن طلبه الاستشفاء بالنبي «صلى الله عليه وآله»
وعمله بما أرسل به إليه.
مع أننا نجد ابن أخيه عامراً
على العكس من ذلك تماماً؛
حيث يثيره تشميت النبي لغلام حمد الله، وعدم تشميته له، وهو لم يحمد
الله. ثم يتنامى به الأمر، ويتعاظم حتى يرتكب تلك الجريمة النكراء،
بأسلوب رخيص ولئيم، أقل ما يقال فيه: إنه مجلبة للعار الدائم، والذل
المقيم.. والمخالف حتى لأعراف الجاهلية، فضلاً
عن مناقضته لكل القيم والمثل والمبادئ الإنسانية.
فإن كان ما فعله أبو براء عن سياسة ودهاء فنعم السياسة
تلك، وحبذا هذا الدهاء، وإن كان عن عقل وحكمة فالمجد والخلود لهذا
العقل، وتلكم الحكمة، وإن كان عن قناعة وجدانية ونفحة إيمانية كانت قد
بدأت تذكو في نفسه، فما علينا إلا أن نقبل بالرواية القائلة: إنه قد
أسلم قبل أن يموت. ونحن نود أن تكون هذه هي عاقبته، وإن كنا لا نملك
الدليل القاطع على ذلك.
وبعد..
فقد رأينا النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» ليس فقط
لا يؤيد ما فعله عمرو بن أمية الضمري، من قتل الرجلين، وإنما يعبر عن
إدانته واستيائه من هذا الأمر.
ثم هو يتعهد بأن يدي الرجلين، ويفعل ذلك.
وإذا أردنا أن لا نقبل بكون الرجلين كانا قد أسلما
حقيقة بقرينة: أنهم يقولون: إنه «صلى الله عليه وآله» أعطى دية حرين
مسلمين.
فإننا لا بد أن نستفيد من موقف النبي «صلى الله عليه
وآله» هذا حتى ولو كانا كافرين إدانة صريحة للمنطق الجاهلي القبلي الذي
يبيح للإنسان أن يقتل أياً
من أفراد القبيلة الأخرى، لو ارتكب واحد منها جريمة تجاه قريب له فرضاً.
فهو «صلى الله عليه وآله» يلوم عمرو بن أمية ويدين
عمله، ويقول له: بئس ما صنعت،
رغم أنه لم يكن يعلم بالعهد، ورغم أن اللذين قتلهما كانا بزعمه مشركين.
ويوضح:
أنه «صلى الله عليه وآله» إنما يدين المنطق القبلي
الجاهلي قوله «صلى الله عليه وآله»: رجلين من أهل ذمتي قتلتهما لا لأجل
دينهما، حسبما روي.
وتذكر الروايات المتقدمة:
أنه بعد أن أراد زيد بن قيس قتل رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، وحبس الله يده، حتى لم يتمكن من سل سيفه،
كانت النتيجة:
أن الله سبحانه وتعالى يرسل على زيد بن قيس صاعقة،
فتحرقه، ثم يموت عامر بن الطفيل من غدة كغدة البعير في بيت سلولية.
وما ذلك إلا لأن هذين الرجلين قد رأيا بأم أعينهما
الآية الظاهرة، والمعجزة القاهرة له «صلى الله عليه وآله»، ولكنهما
يصران على الضلال، والكفر، ولا يعتبران بما رأياه من كرامة إلهية له
«صلى الله عليه وآله»، فكانت النتيجة: أن أصبحا عبرة لمن اعتبر، وخسرا
الدنيا والآخرة، وبئس للظالمين بدلاً.
ونجد في الروايات المتقدمة:
أن جبار بن سلمى، المشرك، حينما طعن
ابن ملحان الأنصاري
سمعه يقول: فزت والله، تحير في فهم مغزى كلامه،
فقال
في نفسه: ما فاز؟ أليس قد قتلت الرجل؟!
ثم يسأل عن هذا الأمر بعد ذلك،
فأخبروه:
أنه الشهادة، فقال: فاز لعمرو الله. وكان ذلك سبب
إسلامه.
ونحن بدورنا
ليس لدينا ما يثبت أو ينفي هذه الرواية، ولكننا نعلم: أن أمير المؤمنين
«عليه السلام» حينما ضربه ابن ملجم على رأسه في مسجد الكوفة، قال: فزت
ورب الكعبة([9]).
ونقول:
إن تحير ذلك المشرك، وقول أمير المؤمنين «عليه السلام» وذلك المسلم
لهذه الكلمة طبيعي جداً.
فإن من يفهم الأمور فهماً
دنيوياً
ومصلحياً
بحتاً،
يقيس الربح والخسران بمقاييس المادة والماديات وحسب. فلا يمكنه أن يفهم
الموت إلا على أنه ضياع وخيبة؛ لأنه يراه عدماً
وفناء، وخسارة وجود، ونهاية حياة.
أما الإنسان المسلم القرآني؛ فهو يرى في الموت أمراً
آخر،
ومعنى يختلف كلياً
عن هذا المعنى، وذلك من خلال التعليم القرآني، الذي هو المصدر الأصفى،
والأدق والأوفى، ثم التربية النبوية الرائدة، وتوجيهات الأئمة
والأوصياء «صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين».
ولا نريد أن نفيض في ذكر الآيات والروايات التي تعرضت
لحقيقة الموت، وبينت موقعه في مسيرة الإنسان ومصيره،
وإنما نكتفي بالإشارة إلى ما يلي:
1 ـ
قال تعالى:
﴿الَّذِي
خَلَقَ المَوْتَ وَالحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ
عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾([10]).
2 ـ
عن الإمام الحسين «عليه السلام»؛ في خطبة له في مكة، قبل أن يخرج إلى
العراق: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني
إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف([11]).
3 ـ
وفي رواية عن الإمام الصادق «عليه السلام» قال:
«ذكر
الموت يميت الشهوات في النفس، ويقلع منابت الغفلة، ويقوي القلب بمواعد
الله، ويرق الطبع، ويكسر أعلام الهوى، ويطفئ نار الحرص»([12]).
4 ـ
عن الصادق «عليه السلام»:
«إن
المؤمن إذا مات لم يكن ميتاً؛
فإن الميت هو الكافر»([13]).
والآيـات
والروايـات
حـول
المـوت
والحياة كثيرة، فيهـا
الإشـارات
والـدلائـل
الجمة إلى كثير من الأمور الهامة والخطيرة،
ونحن نكتفي هنا بالإشارة إلى ما يلي:
ألف:
بالنسبة للآية الكريمة نقول: إننا نلاحظ أنها قدمت ذكر الموت على ذكر
الحياة
«الموت
والحياة».
كما أنها صرحت:
بأن الموت مخلوق لله سبحانه، كما أن الحياة مخلوقة له تعالى.
إذاً فللموت دوره كما هو للحياة،
وليس هو مجرد فناء وعدم، يظهر معناه ومغزاه من خلال ظهور المعنى
المقابل له.
ثم صرحت الآية:
بأن السر في خلق هذين العنصرين هو وضع الإنسان على المحك في سوقه نحو
الأفضل والأحسن، والأكمل، الأمر الذي يفيد: أن لهما دوراً
في بناء شخصية الإنسان وتكامله.
وذلك يعني:
أنهما مرحلتان يتجاوزهما الإنسان، ولا يتوقف عندهما في
مسيرته الظافرة نحو الحياة الحقيقية
﴿وَإِنَّ
الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الحَيَوَانُ﴾([14])،
حيث إن بها يبلغ الإنسان مرحلة كماله،
وفيها تتساقط الحجب المادية المانعة من الإحساس بالأمور إحساساً
واقعياً
وحقيقياً
وعميقاً.
ب:
إن الكلمة المروية عن الإمام الحسين «عليه السلام» قد
اعتبرت أن الموت بمثابة قلادة على جيد الفتاة، ومعنى ذلك هو: أن الموت
هو زينة للحياة ويزيد في بهجتها، ويعطيها رونقاً،
وبهاء وجمالاً،
وبدونه تكون باهتة خافتة تماماً
كما هو الحال بالنسبة للقلادة التي تزيد في بهجة وبهاء وجمال الفتاة،
وتوجب انشداد الأنظار إليها، وتعلق النفوس بها.
ولأجل هذا المعنى جعلها على جيد
«فتاة»
وليس «المرأة».
فإن الفتاة هي التي تميل إليها نفوس الطالبين، وتكون موضعاً
لتنافس المتنافسين.
كما أننا نلاحظ:
أنه لم يستعمل كلمة
«عنق»
هنا وإنما اختار كلمة
«جيد»
الذي هو من الجودة، وهو تعبير مريح للنفس أيضاً، ومثير لكثير من
المعاني اللذيذة في أعماقها.
فالموت زينة الحياة، وبهجتها، حينما يثير في الإنسان
طموحه إلى ما هو أبعد وأوسع وأعلى وأغلى، ويشد روحه وعقله إلى الآفاق
الرحبة، وملاحقة أسرار الكون وخفاياه، وحقائقه ودقائقه ومزاياه، من أجل
أن يسخِّر
كل ما في الوجود ويستفيد من كل ما تصل إليه يده في مجال إبعاد الشفاء
والعناء، ومساعدته على بلوغه مدارج الكمال، ووصوله إلى أهدافه السامية،
وتحقيقه مثله العليا، الأمر الذي يحتم عليه التزام الفضائل، والتعالي
عن الموبقات والرذائل.
بالإضافة إلى أن حقيقة الموت، وإدراكها بعمق يمنح هذا
الإنسان القدرة على الوقوف في وجه شهواته ويهيمن عليها، لأنه يعطي
الحياة الدنيا قيمتها الحقيقية، ويمكِّن
الإنسان من أن يفهمها بعمق، ويعرف مدى واقعيتها.
حتى ليرى الإنسان المؤمن:
أن الموت في بداية الحياة الحقيقية، وأن الخروج من هذه
الدنيا المحفوفة بالمخاطر هو السبيل للسلامة من دواعي وطغيان الشهوات،
والراحة من مكافحة النفس الأمارة بالسوء.
فالموت إذاً،
هو بداية الراحة، والخير، والفوز.
وبه تتساقط الحجب وتزول الموانع عن الإحساس الحقيقي
بالوجود، والوصول إلى كنه الحقائق.
وهو يمكّن الإنسان من أن يملك نفسه، ويستفيد من وجوده
وطاقاته بصورة كاملة.
ولأجل ذلك،
فقد كان الموت للإنسان المؤمن أحلى من العسل([15]).
ووصف الحسين «عليه السلام» أصحابه فقال:
«يستأنسون
بالمنية دوني استئناس الطفل إلى محالب أمه»([16]).
وقال أمير المؤمنين «عليه السلام»:
والله لابن
أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه([17]).
كما أن الموت يصبح خروجاً
من سجن قاس ومرهق، فإن الدنيا سجن المؤمن، والقبر حصنه والجنة مأواه([18]).
وما أحلى أن يحصل الإنسان على حريته، ويكون هو سيد نفسه ويواصل
انطلاقته نحو الله، ويسرح في رحاب ملكوته.
﴿وَإِنَّ
الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾([19]).
أما الكافر فهو يرى الموت فناء وعدماً،
وضياعاً،
فهو كارثة حقيقية بالنسبة إليه، وخسران لنعيم الدنيا، والدنيا هي جنة
الكافر والقبر سجنه، والنار مأواه، حسبما جاء في الحديث الشريف([20]).
وبكلمة..
إن الموت هو سر الحياة، وهو يعطي للحياة معناها
وقيمتها، وهو سرُّ
الطموح، والحركة والبناء، والعمل الهادف المنتج، وهو سر سعي الإنسان
نحو كماله ونحو ربه:
﴿يَا
أَيُّهَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً
فَمُلاقِيهِ﴾([21]).
وبالموت تتساقط الحجب والموانع التي تقلل من قدرة
الإنسان على الإحساس بالواقع، لأنه إنما يتصل بالواقع عن طريق الحواس
المادية، التي لا تسمح بالإحساس بالواقع إلا في مستوى التخيل والتصوير،
ولا توصل إلى كنه الحقائق، والاتصال بأسرار الكون والحياة.
هذا بالإضافة إلى أن المعاصي تزيد من طغيان الجسد، وضعف
القدرات الروحية، فيتضاءل إحساسه بالحقائق، ويتقاصر فهمه عنها، ولا
يعود قادراً
على التعامل معها بعمق ذاته ووجوده، وبكنه مواهبه الإلهية.
وكل ما تقدم يفهمنا بعض ما يرمي إليه الحديث الوارد عن
الإمام الصادق «عليه السلام» والمتقدم برقم
(3)،
ولعل جانباً
مما يرمز إليه الحديث رقم
(4)
اتضح أيضاً.
ج:
ولكننا نزيد في توضيح خلق الموت هنا، فنقول: إنه إذا كان الموت انتقالاً
من نشأة إلى نشأة، وتصرفاً
في الصورة والشكل، مع بقاء المضمون والحقيقة والماهية على ما هي عليه،
فإن خضوع الموت لعملية الخلق يصبح بمثابة من الوضوح، لأن الخلق يختزن
هذا المعنى أيضاً، ويشهد لذلك قوله تعالى:
﴿مِن
مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ﴾
أي وجدت فيها الأشكال والصور البدائية للإنسان،
﴿وَغَيْرِ
مُخَلَّقَةٍ﴾([22])
أي لم يوجد فيها ذلك.
وقال تعالى:
﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أمَّهَاتِكُمْ
خَلْقاً مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ﴾([23]).
د:
بقي أن نشير إلى أن الحكم على الكافر بالموت في الآخرة،
إنما هو بملاحظة: أن نفسه وروحه لن تكون قادرة على نيل درجات القرب،
والسير في رحاب ملكوت الله سبحانه، والإحساس بعظيم جلاله، والقرب من
ساحة قدسه بل يكون الكافر في ظلمات الجحيم، يأتيه الموت من كل مكان،
وما هو بميت، محجوب عن الله، وعن رحمته، مشغول بنفسه وآلامه، عن كل شيء
آخر.
هـ:
وبعد..
فإننا بملاحظة بعض ما تقدم نستطيع أن نفهم كيف يكون المؤمنون شهداء على
الناس، وأن ندرك بعمق معنى الشهيد والشهادة.
فإنها من الشهود، الذي هو الوصول إلى الواقع وملامسته،
مع إدراكٍ
ووعي له، وإحساس واقعي ووجداني به،
ثم معرفة قيمته وحقيقته على ما هو عليه في نفس الأمر.
ومن هنا نعرف:
أن الشهود يزيد عن الحضور، فإن الإنسان قد يكون حاضراً
لحدث ما، ولكنه ليس شاهداً
له إذا لم يدركه بعمق راسخ، تشارك فيه قوى الإدراك الباطنية الظاهرية
في الوصول والحصول.
وبما أن الشهادة هي الوصول إلى الحقيقة، مع إدراك
وإحساس واقعي بها، بسبب تساقط الحجب، وزوال الموانع المادية، فيستطيع
الإنسان حينئذٍ أن يدرك واقع الحياة وسر الوجود، وحقائقه.
فإنها لا يمكن ـ يعني الشهادة ـ أن ينالها الكافر، لأنه
محجوب بذنوبه، وبأعماله، وتكون حياته موتاً،
أما موته فلا يؤهله إلا لمواجهة مصيره الأسود، حيث تحف به ملائكة
العذاب، وتحتوشه زبانية جهنم، ويبقى محجوباً
عن ساحة القدس الإلهية، وعن الانطلاق في رحابها، ونيل بركاتها.
كما أن هذه الشهادة تحتاج إلى تربية إلهية، ورعاية
ملكوتية، تمنحه المعرفة الحقيقية، والرؤية الصادقة، وتربية سلوكياً
وعاطفياً،
وتصفي وتزكي نفسه وروحه، وعمله، وكل وجوده؛ ليكون إنساناً
إلهياً
بكل ما لهذه الكلمة من معنى.
نعم،
وهذا ما يفسر لنا قوله تعالى:
﴿وَيَتَّخِذَ
مِنكُمْ شُهَدَاء﴾([24]).
فإن الله هو
الذي يربيهم، ويزكيهم، ويؤهلهم لتلقي المعارف، ويكشف عن أبصارهم
وبصائرهم ليصلوا إلى درجة الشهود والخلود، في مقعد صدق عند مليك مقتدر([25]).
﴿وَالَّذِينَ
اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ﴾([26]).
أما الكفار، فـ
: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ
يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
أوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾([27]).
و﴿خَتَمَ
اللهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ
غِشَاوَةٌ﴾([28]).
و﴿فَلَمَّا
زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ﴾([29]).
و
:
وعملية الجهاد الأكبر ما هي إلا بذل الجهد من أجل الوصول إلى حالة
الشهود هذه؛ ليكون الجهاد الأصغر انعكاساً
طبيعياً
لدرجة الشهود التي يصل إليها الإنسان، ولمدى إدراكه لحقيقة الكون،
والحياة، وإحساسه بالله سبحانه، وبألطافه، والحصول على بركاته.
ولأجل ذلك، فقد كان الجهاد باباً
من أبواب الجنة، لا يستطيع كل أحد ولوجه والدخول فيه، بل فتحه الله
لخاصة أوليائه وليس كل أوليائه، فهؤلاء الخاصة وحدهم الذين يمكنهم
الجهاد، ويستحقون لقب
«مجاهد»
ويمكنهم أن ينالوا درجة الشهادة، ويكونوا شهداء.
قال علي «عليه السلام»:
الجهاد باب من
أبواب الجنة، فتحه الله لخاصة أوليائه([30]).
ويلاحظ هنا كلمة:
«خاصة
أوليائه»
أي وليس كلهم.
أما الآخرون،
فإنهم لا يستطيعون ذلك، وإن كان يمكن لكل واحد أن
يقاتل، وأن يصبح قتيلاً.
وبعد كل ما قدمناه،
فإننا نفهم بعمق ما جاء على لسان ذلك الرجل
«ما
فاز؟! أليس قد قتلت الرجل».
ثم نفهم بعمق أيضاً قول أمير
المؤمنين «عليه السلام»:
فزت ورب الكعبة.
([1])
السيرة النبوية لدحلان ج1 ص260.
([2])
راجع كتاب: محمد في المدينة ص49.
([4])
المغازي للواقدي ج1 ص351.
([5])
فقد كتب النبي «صلى الله عليه وآله»: أما بعد فإن الأرض لي ولك
نصفان.
([6])
تاريخ اليعقوبي ج2 ص72.
([7])
راجع: مغازي الواقدي ج1 ص350 والإصابة ج3 ص124 والسيرة الحلبية
ج3 ص171.
([8])
راجع: تاريخ اليعقوبي ج2 ص72.
([9])
ترجمة الإمام علي «عليه السلام» من تاريخ دمشق ج3 ص303 تحقيق
المحمودي ومقتل أمير المؤمنين «عليه السلام» لابن أبي الدنيا،
مطبوع في مجلة تراثنا السنة الثالثة عدد 3 ص96.
([10])
الآية 3 من سورة الملك.
([11])
اللهوف ص25 ومقتل الحسين للمقرم ص190 عنه وعن ابن نما ص20.
([12])
البحار ج6 ص133 ومصباح الشريعة ص171 وميزان الحكمة ج9 ص245.
([13])
معاني الأخبار ص276 وميزان الحكمة ج9 ص237.
([14])
الآية 64 من سورة العنكبوت.
([15])
وسيلة الدارين في أنصار الحسين ص253.
([16])
مقتل الحسين للمقرم ص262.
([17])
نهج البلاغة (شرح عبده) ص36.
([18])
البحار ج70 ص91 والخصال ج1 ص108.
([19])
الآية 64 من سورة العنكبوت.
([20])
البحار ج70 ص91 والخصال ج1 ص108.
([21])
الآية 6 من سورة الإنشقاق.
([22])
الآية 5 من سورة الحج.
([23])
الآية 6 من سورة الزمر.
([24])
الآية 140 من سورة آل عمران.
([25])
الآية 55 من سورة القمر.
([26])
الآية 17 من سورة محمد.
([27])
الآية 179 من سورة الأعراف.
([28])
الآية 7 من سورة البقرة.
([29])
الآية 5 من سورة الصف.
([30])
نهج البلاغة (بشرح عبده)، الخطبة رقم 26 أولها: ج1 ص63.
|