حـــدث وتـــشـــريــــــع
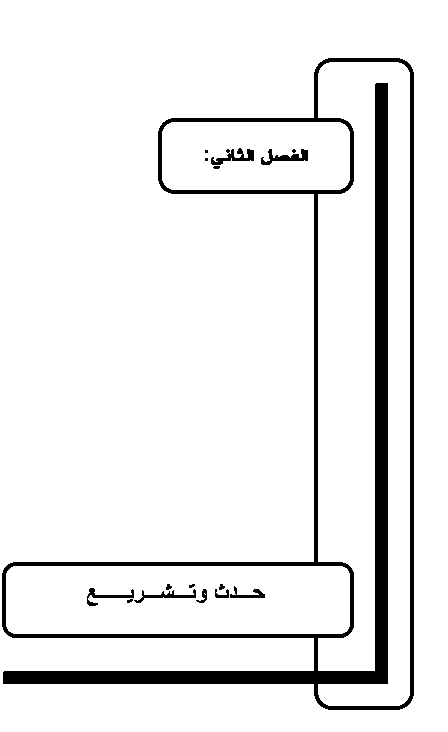
إننا لاستكمال الحديث عن الأمور المرتبطة بغزوة ذات
الرقاع نتحدث في هذا الفصل عن عدة أمور بالترتيب التالي:
1 ـ
إنهم يقولون: إن صلاة الخوف قد شرعت في غزوة ذات الرقاع، وصلاها النبي
«صلى الله عليه وآله» بأصحابه فيها، وهي أول صلاة خوف في الإسلام.
ونحن نرى:
أن ذلك غير سليم، وأن صلاة الخوف قد شرعت في الحديبية، وهي قبل ذات
الرقاع.
بل قد يقال:
إنها قد شرعت قبل الحديبية أيضاً.
2 ـ
ثم نشير إلى الاختلافات الواردة في كيفية صلاة الخوف.
3 ـ
ونتحدث أيضاً بإجمال عما يقال عن عدم صلاة الخوف في غزوة الخندق، لأنها
لم تكن شرعت آنئذٍ..
4 ـ
ثم نعقب ذلك بفلسفة تحليلية لتشريع صلاة الخوف في حدود ما تسمح به
المناسبة.
5 ـ
ثم نتوجه إلى الحديث عن قصر الصلاة، حيث يقال: إن ذلك قد حدث في غزوة
ذات الرقاع أيضاً.
6 ـ
ثم نستطرد في الحديث إلى موضوع آخر يرتبط بقصر الصلاة، وهو ما اشترطته
الآية للقصر، من كونه في مورد خوف الفتنة، وذلك من أجل بيان المراد من
هذا الشرط، ثم المبرر لإدراجه في الآية الشريفة.
7 ـ
ولا ننسى أن نستطرد أيضاً إلى موضوع قصر عثمان للصلاة في منى وعرفات في
أيام الحج، وما نشأ عن ذلك وما انتهى إليه.
ونذكر أيضاً:
أعذاراً
وتوجيهات لهذا الأمر لا يمكن أن تصح، ولا يصح الاعتماد عليها.
8 ـ
ثم نختم الحديث عن هذا الموضوع بالإشارة إلى أن القصر في السفر رخصة أم
عزيمة؟ من أجل أن يتضح المقصود من آية القصر، حيث إن الحديث عن القصر
فيها إنما هو بصيغة: ليس عليكم جناح أن تقصروا.
9 ـ
وأما الحديث عن أن آية التيمم قد نزلت في غزوة ذات الرقاع أيضاً فنرجئه
إلى الحديث عن غزوة المريسيع بعد الخندق، حيث يتم التعرض له هناك إن
شاء الله تعالى..
هذه خلاصة ما سوف نتحدث عنه في هذا الفصل. وأنت ترى:
أنه كله حديث عن تشريعات ادُّعي
أنها قد حصلت في غزوة ذات الرقاع،
ثم استطرادات مفيدة في نطاق الحديث عن هذه التشريعات.
ونحن نرجو أن يكون فصلاً
مفيداً
للقارئ وممتعاً
له في نفس الوقت.. فإلى ما يلي من مطالب، ومن الله نستمد العون والقوة،
وعليه نتوكل..
يقال:
إن صلاة الخوف قد شرعت في غزوة ذات الرقاع،
حيث إنه «صلى الله عليه وآله» في هذه الغزوة واجه جمعاً
من الأعداء
«فتقارب
الجمعان، ولم يكن بينهما حرب. وقد خاف بعضهم بعضاً،
من غير أن يغيروا عليهم، فصلى بهم النبي «صلى الله عليه وآله» صلاة
الخوف، ثم انصرف بالناس»([1]).
وهي أول صلاة
خوف في الإسلام([2]).
ونقول:
إننا نسجل هنا ما يلي:
1 ـ
قولهم: إنها أول صلاة خوف صليت في الإسلام لا تؤيده الروايات على
اختلافها؛ فقد ذكروا ـ وإن كنا قد رددنا ذلك فيما يأتي ـ:
أن صلاة الخوف إنما شرعت في غزوة بني النضير([3])
وهي قبل غزوة ذات الرقاع قطعاً.
2 ـ
ومن جهة أخرى ثمة روايات تقول: إن آيات صلاة الخوف قد نزلت في غزوة
عسفان، فصلى بهم النبي «صلى الله عليه وآله» صلاة الخوف.
وفي رواية الترمذي وابن جرير:
أن جبرئيل هو الذي علَّم
النبي «صلى الله عليه وآله» كيف يصليها، وذلك بين ضجنان، وعسفان.
وعسفان كانت بعد الخندق([4]).
3 ـ
وسأل سليمان اليشكري جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة أي يوم أنزل؟.
فقال جابر بن عبد الله:
وعير قريش آتية من الشام، حتى إذا كنا بنخل..
ثم ذكر ما
جرى، وصلاة النبي «صلى الله عليه وآله» بهم صلاة الخوف، ثم قال: فأنزل
الله في إقصار الصلاة([5]).
ولكن قال ياقوت:
«إن
نخلاً موضع بنجد، من أرض غطفان مذكور في غزاة ذات الرقاع»([6]).
وعن السمهودي، أنه قال:
«حتى
نزل نخلاً، وهي غزوة ذات الرقاع»([7]).
وقال السمهودي أيضاً:
«وكأن
أبا حاتم رأى اتحادهما، فلم يذكر ذات الرقاع،
وهي بنخل عند بعضهم، فلذلك لم يذكرها أيضاً»([8]).
ونقول:
إن هذا اشتباه واضح، فإن نخلاً إذا كانت بنجد لم يكن ثمة مناسبة بينها
وبين عير قريش الآتية من الشام، فالمراد إذن هو
النخل
التي من جهة الشام دون سواها.
4 ـ
وعن مجاهد أنه قال:
بالنسبة لصلاة الخوف في عسفان:
«فلم
يصل رسول الله «صلى الله عليه وآله» صلاة الخوف قبل يومه، ولا بعده»([9]).
5 ـ
عن جابر قال: غزا رسول الله «صلى الله عليه وآله» ست غزوات قبل صلاة
الخوف، وكانت صلاة الخوف في السنة السابعة([10]).
فالقول بأنها في ذات الرقاع، وذات الرقاع في السنة
الرابعة، لا يصح.
والمعتمد عندنا في هذا المجال هو:
الرواية التي رواها علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
الإمام الصادق
«عليه
السلام»:
«فإنها
نزلت لما خرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى الحديبية، يريد مكة،
فلما وقع الخبر إلى قريش بعثوا خالد بن الوليد في ماءتي فارس كميناً
يستقبل رسول الله «صلى الله عليه وآله» [فكان يعارض رسول الله] على
الجبال.
فلما كان في بعض الطريق، وحضرت صلاة الظهر، فأذن بلال،
فصلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالناس.
فقال خالد بن الوليد:
لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة لأصبناهم، فإنهم لا
يقطعون صلاتهم، ولكن تجيء لهم الآن صلاة أخرى هي أحب إليهم من ضياع
أبصارهم، فإذا دخلوا في الصلاة أغرنا عليهم.
فنزل جبرئيل
«عليه
السلام»
على رسول الله «صلى الله عليه وآله» بصلاة الخوف في قوله:
﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ..﴾([11]).
ولا يعارض ذلك ما رواه ابن بابويه في الفقيه بسند صحيح
إلى عبد الرحمن بن أبي عبد الله: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد صلى
بأصحابه صلاة الخوف في ذات الرقاع; فإن هذه الرواية ليس فيها: أن
جبرئيل قد نزل بصلاة الخوف آنئذٍ، ولا أن الآية قد نزلت أيضاً في غزوة
ذات الرقاع. وإن كان الإمام
«عليه
السلام»
بعد أن ذكر كيفية صلاته «صلى الله عليه وآله» بأصحابه صلاة الخوف، قد
أورد الآية، مظهراً
بذلك موافقة فعل النبي «صلى الله عليه وآله» لمضمونها، فراجع([12]).
فتشريع صلاة الخوف قد كان في الحديبية التي كانت في سنة
ست ثم صلاها «صلى الله عليه وآله» مرة أخرى بأصحابه في غزوة ذات
الرقاع، التي كانت في السنة السابعة حسبما قدمنا.
قد اختلفت رواياتهم في كيفية صلاة الخوف التي صلاها
رسول الله «صلى الله عليه وآله» في مغازيه، حتى ليقول البعض:
«قد
رويت صلاة الخوف على ست عشرة صورة كلها سائغ فعله»([13]).
وقال آخر:
«ووراء
ذلك من الكيفيات المتباينات، والخلافات المتعددات بحسب اختلاف
الروايات، ما يطول ذكره، ويعز حصره»([14]).
وقد أغنانا ذلك عن ذكر التناقضات الكثيرة والاختلافات
الفاحشة بين الروايات المختلفة.
والحل الأمثل:
هو الرجوع إلى أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، فإنهم هم أحد الثقلين
اللذين لن يضل من تمسك بهما، وهم سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف
عنها غرق وهوى.
وقد ذكروا:
أن صلاة الخوف في ذات الرقاع كانت قصراً([15]).
وقد زعم البعض:
أن صلاة الخوف لم تكن شرعت في غزوة الخندق، وإلا لكان
صلاها حينئذٍ، لأنهم حبسوه عن صلاة الظهرين والعشاءين فصلاهن جميعاً،
وذلك قبل نزول صلاة الخوف([16]).
ونقول:
إن هذا الاستدلال لا يصح:
إذ لعل العدو
كان في جهة القبلة فصلاها المسلمون إيماء أو كان الوضع الحربي لا يسمح
بالصلاة جماعة بسبب تلاحم المقاتلين، والمناوشة بينهم، حيث يكفي في هذه
الحالة التهليل والتسبيح، والتحميد، والدعاء، كما حدث في صفين ليلة
الهرير([17]).
وسيأتي:
عدم صحة ما يذكرون حول هذا الأمر في موضعه إن شاء الله تعالى..
ولربما يراود ذهن البعض سؤال:
عن السبب في الإصرار على الصلاة جماعة حتى في حال
الحرب، إذ أن
بالإمكان
أن يصلي
المسلمون فرادى متفرقين، مع الاحتفاظ بمواجهة العدو بالكثرة العددية في
ساحة القتال. خصوصاً
مع اتساع الوقت لأداء الصلاة بصورة متوالية من العناصر، بحيث لا يخل
ذلك بالحالة التي يتخذونها تجاه العدو بهدف إرهاقه،
أو دفع شره.
وللإجابة على هذا السؤال:
لا بد لنا من الإشارة إلى أن هذا أمر مقصود لله عز وجل،
لأنه يمثل مطلباً
أساسياً
في أكثر من اتجاه.
فهو من جهة يمثل إصرار المسلمين على الجهر بمعتقداتهم،
وممارسة حقهم بحرية التعبير عنها، وحرية ممارسة شعائرهم الدينية. رضي
الناس ذلك أم
أبوا.
كما أنه يمثل إظهاراً
للالتزام بالقيادة المثلى، والاقتداء بها،
والتلاقي عليها ومعها لتكون رمز وحدة الأمة، من خلال وحدة الهدف، ثم
وحدة الموقف، وانتهاءً بوحدة المصير.
ومن جهة أخرى:
فإن هذا المظهر العبادي الوحدوي التنظيمي ووحدة الشعار،
لا بد أن يثير لدى
الأعداء
أكثر من سؤال يرتبط بالموقف السياسي والعسكري، الذي يتخذه ذلك العدو،
ويتحرك ويتعامل معهم على أساسه ومن خلاله، حتى إذا ما راجع حساباته في
هذا السبيل، فلسوف يجد أنه لم يكن منطقياً،
ولا منصفاً
في عدائه لهم، ولا في مواقفه منهم، التي اتخذها انطلاقاً
من عدم قناعته بما اقتنعوا به، أو فقل: من عدم قبوله بما هم عليه. فهل
عدم اقتناع شخص بأفكار، ومعتقدات، وقناعات، شخص آخر، يعطيه الحق في
تدمير ذلك الشخص واستئصاله من الوجود؟!..
وهل إذا قال هؤلاء:
ربنا الله،
وليس الصنم الفلاني، يستحقون أن يواجهوا بالحرب وبالحرمان وبالقطيعة،
وبجميع أشكال الاضطهاد والتنكيل؟!.
إن صلاة الخوف هذه لسوف تقنع هذا العدو بالذات أن ما
يحاربهم من أجله،
ويصرون هم عليه،
إنما يعنيهم هم أولاً وبالذات،
وليس له هو حق في اتخاذ أي موقف سلبي منهم لأجل أمر يخصهم ويرجع إليهم،
فـ
﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾([18])
فإن الدين يقوم على أساس القناعات وعلى أساس المشاعر، وعقد القلب،
وإحساسه بالأمن،
واستشعاره الإيمان.
ولا يمكن أن يفرض هذا على أحد،
ولا يتحقق الإكراه فيه.
ولا يملك أحد
أن
يصادر حرية الآخرين في أن يعتقدوا ما شاؤوا،
ولا يمكنه
أن يمنعهم من ممارسة كثير مما يريدون ممارسته.
بل إن هذا يخضع للمنطق وللبرهان وللدليل أولاً،
مع إعطاء دور رئيس لتكوّن عامل الثقة،
والصراحة والصدق والإنصاف،
والحرية،
وغير ذلك مما هو ضروري في مجال التحرك الواعي والمسؤول في مجال الدعوة
لتحقيق الاستجابة الحقيقية والواعية والمسؤولة.
فصلاة الخوف شعار،
وموقف،
وبلاغ،
ودعوة،
وتصميم،
ووحدة، وخلوص،
والتفاف حول القيادة،
وتربية،
وتعليم،
وتحد،
ثم هي حرب نفسية وسلاح قاطع.
وليس ثمة
رسالة أبلغ منها للعدو،
ليعرف أن هؤلاء الناس قد بلغوا من إصرارهم على مواقفهم،
وتمسكهم بمبادئهم،
وفنائهم فيها،
حداً
يجعلهم يرون قضيتهم،
ودينهم ودعوتهم،
هي الأهم من كل شيء،
وأن حياتهم،
وكل شيء يملكونه لا بد أن يكون لها ومن أجلها،
وفي سبيلها،
وهم يمارسون ذلك عملاً،
ويقدمون على البذل والعطاء في سبيله،
بكل رضاً ومحبة،
وصفاء وسخاء.
ومن جهة ثانية:
إن ذلك يؤكد للإنسان المسلم مدى أهمية الصلاة،
حتى إنها لا تترك بحال،
حتى للغريق المشرف على التلف،
وحتى للمقاتل الذي يواجه الأخطار الكبرى على حياته ووجوده..
وتأتي الصلاة في هذه الحال بالذات ـ حال الخوف ـ لتربط
الإنسان بمصدر الأمن،
والسلام،
والطمأنينة للقلوب،
وانسجام المشاعر وتلاقيها، ليعيش الإنسان في الآفاق الملكوتية روح
الطهر والخلوص،
ليصبح قادراً
على التخلص مما يربطه بهذه
الدنيا،
ويشده إلى الأرض ليخلد إليها، ويحجبه ذلك عن مصدر القدرة،
وعن الانطلاق في رحابه،
وفي آفاق ملكوته،
ومعاينة آلائه،
وتلمسها،
والتصديق بها.
وقالوا:
إن الصلاة قد
قصرت في غزوة ذات الرقاع([19])
حيث نزل قوله تعالى:
﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي
الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ
إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ
الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً﴾([20]).
ونقول:
إن الكلام هنا في عدة جهات، نذكر منها ما يلي:
إن القول:
بأن ذلك كان في غزوة ذات الرقاع،
تقابله الرواية التي تقول: إن ذلك قد كان في غزوة عسفان.
فقد روي:
«عن
مجاهد،
في قوله:
﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ﴾([21])،
قال: أُنزلت
يوم كان النبي «صلى الله عليه وآله»،
والمشركون بضجنان،
فتوافقوا فصلى النبي «صلى الله عليه وآله» بأصحابه صلاة الظهر أربعاً،
ركوعهم وسجودهم،
وقيامهم معاً
جمعاً.
فهمّ بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم،
وأثقالهم،
فأنزل الله:
﴿فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ﴾([22]).
فصلى العصر،
فصف أصحابه صفين ثم كبر بهم جميعاً،
ثم سجد الأولون لسجوده،
والآخرون قيام لم يسجدوا حتى قام النبي «صلى الله عليه وآله» ثم كبر
بهم وركعوا جميعاً،
فتقدم الصف الآخر،
واستأخر
الصف المتقدم،
فتعاقبوا السجود كما فعلوا أول مرة،
وقصر العصر إلى ركعتين»([23]).
ونقول:
إن هذه الرواية صريحة
في
أن آية قصر الصلاة قد نزلت بعد أو حين تشريع صلاة الخوف،
وثمة روايات أخرى يظهر منها أنهم يتحدثون عن آية القصر ويقصدون منها
صلاة الخوف فقط([24])،
ولعل هذا قد نشأ عن كونهما قد نزلتا في زمان واحد.
وقد تقدم:
أن صلاة الخوف قد شرعت في الحديبية،
ثم صلاها النبي «صلى الله عليه وآله» في ذات الرقاع،
التي كانت بعدها،
فمعنى ذلك: أن قصر الصلاة قد شرع في الحديبية أيضاً،
أو بعدها وذلك واضح لا يحتاج إلى بيان.
لكن ثمة رواية تقول:
إن نزول الآية،
وتشريع صلاة القصر قد كان قبل نزول آية صلاة الخوف بسنة ; فشرع القصر
على لسان رسول الله «صلى الله عليه وآله»، حين سأله تجار يضربون في
الأرض عن كيفية صلاتهم،
فراجع([25]).
فيكون تشريع القصر،
قبل غزوة الحديبية بسنة!
ومن الأمور التي تساءل بعض الناس
عنها هو:
أن آية القصر إنما تتحدث عن إيجاب القصر بشرط خوف
الفتنة من قِبَل الذين كفروا،
مع أن القصر ثابت مع خوف الفتنة وبدونه.
وقد حاول البعض الهروب من هذا
الإشكال بدعوى:
أن القصر لم يذكر في القرآن أصلاً([26]).
وبعض آخر:
كعائشة،
وسعد بن أبي وقاص،
ادعوا: أن الواجب هو القصر في حال الخوف فقط،
أما في حال الأمن،
فكانا يتمان في السفر([27]).
وروي عن عائشة
خلاف ذلك أيضاً([28]).
وقد يحلو للبعض أن يدعي:
أن القرآن قد نسخ بالسنة،
حيث إن القرآن نص على القصر في حالة الخوف،
ثم نسخ ذلك بقول النبي «صلى الله عليه وآله»،
حيث جعله «صلى الله عليه وآله» في مطلق السفر([29]).
إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه.
ونقول:
إن مجرد كون القرآن قد نص على القصر في مورد خوف الفتنة،
ثم جاء تعميم ذلك إلى مطلق
السفر على لسان النبي «صلى الله عليه وآله»،
لا يوجب اعتبار ذلك من قبيل نسخ القرآن بالسنة،
إذ قد يكون القرآن قد ذكر لهم ما كان محلاً لابتلائهم،
أو أورد ذلك مورد الغالب؛
فإذا كان القرآن قد بيَّن
قسماً مما يجب فيه القصر، ثم بينت السنة باقي الموارد، فليس ذلك من
قبيل النسخ، بل هو إما من باب إلقاء الخصوصية، أو من باب التعميم،
والتتميم، إذ ليس فيه إلغاء للحكم الثابت بالقرآن.
وقد أشارت الروايات إلى ذلك أيضاً،
فقد روي:
أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقد أمن الناس.
فقال له عمر:
عجبت مما عجبت
منه، فسألت رسول الله «صلى الله عليه وآله» عن ذلك؛ فقال: صدقة تصدق
الله عليكم، فاقبلوا صدقته([30]).
وعن أبي العالية، قال:
«سافرت
إلى مكة، فكنت أصلي بين مكة والمدينة ركعتين، فلقيني قراء أهل هذه
الناحية، فقالوا: كيف تصلي؟!
قلت:
ركعتين.
قالوا:
أسنة أو قرآن؟!
قلت:
كل
ذلك
سنة وقرآن. صلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» ركعتين.
قالوا:
إنه كان في حرب.
قلت:
قال الله:
﴿لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ
الرُّؤْيَا بِالحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِن شَاء
اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ﴾([31]).
وقال:
﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي
الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ﴾([32])
فقرأ حتى بلغ:
﴿فَإِذَا اطْمَأنَنتُمْ﴾([33])»([34]).
ومن الأمور
التي طعن بها الصحابة والمسلمون على عثمان بن عفان([35]):
أنه أتم الصلاة بمنى وبعرفات، فخالف بذلك رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، الذي قصر الصلاة فيهما،
وكذلك أبو بكر وعمر، وعثمان نفسه عدة سنوات أيام خلافته([36]).
وقد كان ابن
عمر بعد أن يتم خلف عثمان، يعيد صلاته بعد أن يرجع إلى بيته([37])
أما ابن مسعود الذي اعترض على عثمان، لفعله ذاك، فإنه عاد فصار يصلي
أربعاً،
بحجة أن الخلاف شر([38])
وكذلك تماماً
كان من عبد الرحمن بن عوف، فإنه ناقش عثمان أولاً، ثم تابعه وعمل بعمله
أخيراً([39]).
ولكن علياً أمير المؤمنين
«عليه
السلام»
وحده الذي أصر على الرفض، فقد روي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: اعتل
عثمان وهو بمنى، فأتى علي، فقيل له: صل بالناس.
فقال:
إن شئتم صليت لكم صلاة رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
يعني ركعتين.
قالوا:
لا، إلا صلاة أمير المؤمنين ـ يعني عثمان ـ أربعاً.
فأبى([40]).
ولكن معاوية حين قدم حاجاً
صلى الظهر ركعتين، فجاءه مروان بن الحكم، وعمرو بن عثمان فقالا له:
«ما
عاب أحد ابن عمك بأقبح مما عبته به.
فقال لهما:
وما ذاك؟!
قالا:
له: ألم تعلم أنه أتم الصلاة بمكة؟
قال:
فقال لهما: ويحكما، وهل كان غير ما صنعت؟
قد صليتهما مع رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ومع أبي بكر، وعمر.
قالا:
فإن ابن عمك قد أتمها،
وإن خلافك إياه له عيب.
قال:
فخرج معاوية إلى العصر، فصلاها بنا أربعاً»([41]).
وقال ابن عباس، بعد أن ذكر صلاة
عثمان شطراً من خلافته قصراً:
«ثم
صلاها أربعاً،
ثم أخذ بها بنو أمية»([42]).
قد ذكروا أعذاراً
كثيرة للخليفة، ونحن نختار منها نموذجاً،
ونحيل القارئ في الباقي إلى المصادر فنقول:
1 ـ
لقد اعتذر الخليفة نفسه بأنه إنما فعل ذلك لأنه تأهل بمكة لما قدمها([43]).
وقال العسقلاني:
«هذا
الحديث لا يصح لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به، ويرده الخ..»([44]).
ويرده أيضاً:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يسافر بزوجاته، ويقصر([45]).
وقال العلامة الأميني:
«ما
المسوغ له ذلك، وقد دخل مكة محرماً؟
وكيف يشيع المنكر، ويقول: تأهلت بمكة مذ قدمت؟ ولم يكن متمتعاً
بالعمرة ـ لأنه لم يكن يبيح ذلك أخذاً
برأي من حرمها كما يأتي تفصيله ـ حتى يقال: إنه تأهل بين الإحرامين،
بعد قضاء نسك العمرة، فهو لم يزل كان محرماً
من مسجد الشجرة، حتى أحل بعد تمام النسك بمنى»..
إلى أن قال:
«وقد
صح من طريق عثمان نفسه عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» من قوله:
«لا
يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكِحُ، ولا يخطب»([46]).
ثم ذكر «رحمه الله» نصوصاً أخرى:
حول عدم جواز
التزوج حال الإحرام فلتراجع([47]).
هذا بالإضافة:
إلى أنه لا معنى للحكم بالإتمام للمسافر إذا تزوج امرأة
في بلد ما لأن المرأة هي التابعة للرجل وليس العكس.
ولو كان حكم عثمان الإتمام لأنه تزوج امرأة هناك،
فلماذا يتم سائر الناس الذين يأتمون به؟! ولماذا يصر على علي
«عليه
السلام»
بالإتمام حينما أراده على الصلاة مكانه؟!
ولماذا يصرون على معاوية بالعمل بسنة عثمان، ثم يستمر
بنو أمية على ذلك؟!
ولماذا يصلي ابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف بأصحابه
تماماً،
لأن الخلاف شر؟!
ولماذا؟. ولماذا؟!..
2 ـ
وثمة عذر آخر، وهو أنه إنما أتم في منى وعرفة، لأنه كان له مال
بالطائف([48]).
وهو اعتذار لا يصح أيضاً، لأن وجود ملك أو دار في مكة
فضلاً عن الطائف لا يوجب الإتمام.
وقد قصر الصحابة الذين حجوا مع رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولم
يأمرهم النبي «صلى الله عليه وآله» بالإتمام، ولا أتموا بعد رسول الله
«صلى الله عليه وآله»([49]).
هذا بالإضافة إلى أن الذين ائتموا به لم يكن كلهم لهم
أملاك هناك.
ولماذا يصر هو على علي
«عليه السلام»،
ويصر بنو أمية على الإتمام بعد ذلك؟!
ولماذا؟! ولماذا؟!
3 ـ
واعتذر أيضاً بأنه خاف أن يظن أهل اليمن والأعراب المقيمون: أن الصلاة
للمقيم ركعتان([50]).
ولكن هذا العذر غير مقبول أيضاً، إذ قد كان يمكن تعليم
الناس على الحكم الشرعي بأسلوب آخر.
كما أن هذا الفعل قد يوجب أن يظن أهل اليمن، والأعراب:
أن الصلاة في السفر أربع ركعات.
أضف إلى ذلك:
أن رسول الله لم يفكر في تعليم الناس بهذه الطريقة، مع
أنه كان يوجد في زمنه أعراب، وكان أهل اليمن يحجون في عهد أسلاف عثمان
أيضاً.
وقد قال رسول الله «صلى الله عليه وآله» لأهل مكة، بعد
أن صلى ركعتين:
«أتموا
الصلاة يا أهل مكة فإنا سفر أو قال: يا أهل البلد صلوا أربعاً
فإنا سفر»([51]).
وروي أن عمر
أيضاً كان يفعل ويقول ذلك فراجع([52]).
4 ـ
إن منى أصبحت
قرية وصار فيها منازل، فتأول عثمان أن القصر إنما هو في حال السفر([53]).
ونقول:
معنى هذا:
أن عثمان كان لا يعرف حكم القصر، وأنه كان يظن أن القصر
إنما يجب في حال المشي في الصحراء فقط،
فإذا بلغ المسافر قرية ونزل فيها، فإنه يتم حينئذٍ، مع أن النبي «صلى
الله عليه وآله» قد قصر في مكة نفسها، وقد كانت مكة بلداً
كبيراً
ومعموراً
أكثر من منى وعرفات بمراتب.
5 ـ
إنه أقام بها ثلاثاً
والمقيم يتم([54]).
وهو عذر واه إذ
إن
النبي «صلى الله عليه وآله» قد أقام في مكة ما يقرب من عشرة أيام، ولم
يزل يصلي فيها قصراً([55]).
6 ـ
إنه كان قد
نوى الإقامة بعد الحج، والاستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة ثم بدا له
بعد ذلك([56]).
وعلى حسب نص آخر:
أنه قد نوى
الإقامة بعد الحج([57]).
والجواب عن ذلك:
أولاً:
ما قاله العسقلاني من أن سنده مرسل.
ثانياً:
إن الإقامة في
مكة على المهاجرين حرام([58]).
ثالثاً:
ولو صح ذلك أيضاً، فلماذا يتم سائر الناس؟.
ولماذا يقتدي به الأمويون؟
ولماذا يصر هو على علي
«عليه السلام»
بالإتمام؟!
ولماذا كان قصر معاوية عيباً
له، ولماذا؟ ولماذا؟!
7 ـ
إن الإمام حيث
نزل فهو عمله ومحل ولايته، فكأنه وطنه([59]).
والأسئلة الآنفة الذكر آتية هنا. هذا بالإضافة إلى أن النبي «صلى الله
عليه وآله» كان إمام الخلائق، فلماذا لم يتم؟!([60]).
وقد قصر أبو بكر وعمر، وعثمان نفسه شطراً
من ولايته.
8 ـ
إن التقصير في
السفر رخصة لا عزيمة([61])
كما اعتذر به المحب الطبري.
ونقول:
أولاً:
إن ذلك لا يصح، بسبب ورود أحاديث كثيرة دالة على أن
التقصير في السفر حكم إلزامي، ولا يجزي الإتمام عنه، بل لا بد من إعادة
الصلاة لو صلى تماماً
في موضع القصر عمداً([62]).
ثانياً:
لو كان ذلك رخصة فلماذا يصر عثمان على الإتمام، حينما
طلب من علي أمير المؤمنين أن يصلي بالناس؟! ولماذا يصر الأمويون بعد
ذلك على العمل بسنة عثمان، وترك سنة رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!.
ثالثاً:
لماذا يصر عثمان على الإتمام في هذا المورد بالذات، دون سائر الأسفار؟.
ولماذا ينكر عليه الصحابة ذلك، ويعترضون عليه فيه؟!
ولماذا لم يعتذر هو بهذا العذر لهم بالذات ليسكتهم عنه؟!
بل اعتذر عن ذلك بأنه رأي رآه([63]).
قد تخيل البعض أن القصر في السفر رخصة، ولعل منشأ فهمهم
هذا هو أن الآية قد قررت ذلك بعبارة:
﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ﴾([64]).
قال العامري:
«ظاهرها
يدل على أن رخصته مشروطة بالخوف، ودلت السنة على الترخيص مطلقاً..
إلى أن قال:
ثم لا يبعد أن يبيح الله الشيء في كتابه بشرط، ثم يبيحه
على لسان نبيه بانحلال ذلك الشرط، الخ..»([65]).
وقد قال بعض الفقهاء:
بأن التقصير
رخصة، فراجع([66]).
ولكن هذا التخيل مردود.
أولاً:
للأخبار الكثيرة الدالة على أن التقصير في السفر عزيمة
وليس رخصة، وكلام الرسول مفسر للقرآن، ومبين لمعناه، وقد ذكر العلامة
الأميني
«رحمه
الله»
طائفة منها([67]).
ثانياً:
لقد كان من الواضح: أن الكثيرين سوف لن تطيب نفوسهم
بترك ركعتين من الصلاة، ويرون في هذا الأمر تضييعاً للأهداف الإلهية
وتساهلاً
في امتثال أوامره تعالى، فجاء التعبير بلا جناح ليدفع هذا الوهم،
وليطمئنهم إلى أنه لا غضاضة عليهم، لو فعلوا ذلك، ولا نقص ولا حرج فيه.
وقالوا في هذه الغزوة:
نزلت آية
التيمم([68]).
وقيل:
بل شرع التيمم في غزوة بني المصطلق.
وقيل:
في غزوة أخرى([69]).
ونحن نرجئ الحديث عن ذلك إلى غزوة بني المصطلق؛ فإلى
هناك.
([1])
راجع: تاريخ الخميس ج1 ص464 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص264
والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 قسم 2 ص28 و 29 والسيرة
الحلبية ج2 ص271 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص200
والمغازي للواقدي ج1 ص396 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص160
والبداية والنهاية ج4 ص83 وراجع: صحيح البخاري ج3 ص24 و 25
وراجع: الكامل في التاريخ ج2 ص174 وتاريخ الأمم والملوك ج2
ص227 وأنساب الأشراف ج1 ص340 وراجع: طبقات ابن سعد ج2 ص61
وتفسير البرهان ج1 ص411 عن من لا يحضره الفقيه والثقات ج1 ص258
وزاد المعاد ج1 ص110 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص214 وراجع:
نصب الراية ج2 ص246 و 247 وراجع صحيح مسلم (باب صلاة الخوف) ج2
ص214 ونهاية الأرب ج17 ص158 والمواهب اللدنية ج1 ص107 والدر
المنثور ج2 ص212 و 213 عن أبي داود، وابن حبان، والحاكم وصححه
والبيهقي، وعن مالك، والشافعي، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد،
والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني.
([2])
حبيب السير ج1 ص357 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص61 والمواهب
اللدنية ج1 ص107 والجامع ص279 وراجع المصادر المتقدمة أيضاً،
فبعضها قد ذكر ذلك ونصب الراية ج2 ص248 و 249 عن الواقدي
وغيره.
([3])
راجع هذا القول في: تاريخ الخميس ج1 ص464 والسيرة الحلبية ج2
ص271 والتنبيه والإشراف ص214 وحبيب السير ج1 ص357 والسيرة
النبوية لابن هشام ج3 ص215 ونهاية الأرب ج17 ص159 ودلائل
النبوة للبيهقي ج3 ص370 وصحيح البخاري ج3 ص23 وفتح الباري ج7
ص325 وبهجة المحافل ج1 ص232.
([4])
الدر المنثور ج2 ص211 و 213 عن المصادر التالية: عبد الرزاق،
وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وأحمد، وأبي داود، وعبد بن
حميد، والنسائي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والدارقطني،
والطبراني، والحاكم، وصححه، والبيهقي، والترمذي، وابن جرير.
وعن البزار عن ابن عباس، وعن أبي عياش الـزرقي، وأبي هريرة،
ومجاهد وفتح البـاري ج7 ص327 والسيرة الحلبية ج2 ص271 = = ونصب
الراية ج2 ص248 ومسند أحمد ج4 ص59 وفي هامش نصب الراية عن سنن
أبي داود ج2 ص11 و 12 وسنن البيهقي ج3 ص257 وراجع: سنن النسائي
ج3 ص174 والجامع الصحيح ج5 ص243 والمصنف للصنعاني ج2 ص504 و
505 وجامع البيان ج5 ص156 وسنن الدارقطني ج2 ص59 ومستدرك
الحاكم ج1 ص337 وكشف الأستار عن مسند البزار ج1 ص326.
([5])
الدر المنثور ج2 ص211 عن عبد بن حميد، وابن جرير، وجامع البيان
وبغية الألمعي (مطبوع مع نصب الراية) ج2 ص248 وسنن النسائي ج3
ص176.
([6])
معجم البلدان (ط دار الكتب العلمية) ج5 ص320.
([7])
بغية الألمعي (مطبوع بهامش نصب الراية) ج2 ص248 عن وفاء الوفاء
ج1 ص381.
([8])
وفاء الوفاء ج1 ص280.
([9])
الدر المنثور ج2 ص214 عن ابن أبي شيبة، وابن جرير، وراجع جامع
البيان ج5 ص156.
([10])مسند
أحمد ج3 ص348 والدر المنثور ج2 ص214 عنه.
([11])
البرهان في تفسير القرآن ج1 ص411.
([12])
البرهان في تفسير القرآن ج1 ص411 ومن لا يحضره الفقيه (ط مؤسسة
النشر الإسلامي) ج1 ص460.
([13])
سيرة مغلطاي ص53 و 54 وراجع: الروض الأنف ج3 ص253 وشرح بهجة
المحافل ج1 ص234 وراجع: التنبيه والإشراف ص214 وتاريخ الأمم
والملوك ج2 ص227.
([14])
بهجة المحافل ج1 ص233.
([15])
البرهان في تفسير القرآن ج1 ص411.
([16])
راجع: زاد المعاد ج2 ص111 والسيرة الحلبية ج2 ص270 وراجع: فتح
الباري ج7 ص327.
([17])
البرهان ج1 ص411 و 412.
([18])
الآية 256 من سورة البقرة.
([19])
تاريخ الخميس ج1 ص464 واكتفى في السيرة الحلبية ج2 ص278
بالقول: بأن قصر الصلاة كان في الرابعة.
([20])
الآية 101 من سورة النساء.
([21])
الآية 198 من سورة البقرة.
([22])
الآية 102 من سورة النساء.
([23])
الدر المنثور ج2 ص210 عن عبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر،
وابن أبي حاتم، وجامع البيان ج5 ص156 والمصنف ج2 ص504.
([24])
راجع: الدر المنثور ج2 ص210 عن عبد الرزاق عن طاووس، وابن
جرير، وابن أبي حاتم عن السدي والمصنف ج2 ص517 وغيرها وجامع
البيان ج5 ص154.
([25])
الدر المنثور ج2 ص209 وجامع البيان ج5 ص155 عن علي «عليه
السلام»، وبهجة المحافل ج1 ص228.
([26])
سنن النسائي ج3 ص117 وسنن
البيهقي ج3 ص136 وسنن ابن ماجة ج1 ص339 ومجمع البيان ج5 ص136
والدر المنثور ج2 ص209 و 210 عنهم وعن عبد بن حميد، وابن حبان،
وابن أبي حاتم. والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج6 ص444
والمستدرك على الصحيحين ج1 ص258 والموطأ (المطبوع مع تنوير
الحوالك) ج1 ص162 والمصنف للصنعاني ج2 ص518 ومسند أحمد بن حنبل
ج2 ص65 و 66.
([27])
راجع: الدر المنثور ج2 ص110 عن ابن جرير، وابن أبي حاتم، وعبد
الرزاق، ونصب الراية ج2 ص118 و 189 ونيل الأوطار ج3 ص249
وراجع: الجامع الصحيح ج2 ص430 وعن عائشة في المصنف للصنعاني ج2
ص515 وراجع أيضا: الأم ج1 ص159.
([28])
راجع: الأم ج1 ص159 وصحيح مسلم ج2 ص142 و 143 والمصنف للصنعاني
ج2 ص515 والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج6 ص446 و447 والدر
المنثور ج2 ص210 عن بعض من تقدم وعن البخاري، ومالك، وعبد بن
حميد، وأحمد، البيهقي في سننه.
([29])
راجع: بهجة المحافل ج1 ص227 و 228.
([30])
الدر المنثور ج2 ص209 عن ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وأحمد
ومسلم والنسائي وأبي داود، والترمذي، وابن ماجة، وابن الجارود،
وابن خزيمة، والطحاوي، وابن جرير ج5 ص154 وابن المنذر، وابن
أبي حاتم، والنحاس في ناسخه، والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ج6 ص448 و 450 ونصب الراية ج2 ص190 وصحيح مسلم (باب صلاة
المسافر)، ج2 ص143 وسنن أبي داود ج2 ص3 وسنن ابن ماجة ج1 ص176
ومسند أحمد ج1 ص25 و 36 وسنن النسائي ج3 ص116 و117 والجامع
الصحيح (كتاب التفسير) ج5 ص242 و 243 وبهجة المحافل ج1 ص227 و
228 وسنن البيهقي ج3 ص134 و 140 و 141 وسنن الدارمي ج1 ص354
ومصابيح السنة ج1 ص460 وشرح معاني الآثار ج1 ص415 والمصنف ج2
ص517 والأم ج1 ص159.
([31])
الآية 27 من سورة الفتح.
([32])
الآية 198 من سورة البقرة.
([33])
الآية 103 من سورة النساء.
([34])
جامع البيان (ط دار الفكر) ج5 ص330 والدر المنثور ج2 ص209 عنه
والأم ج1 ص159 ونيل الأوطار ج3 ص247.
([35])
تاريخ الأمم والملوك ج3 ص322 وأنساب الأشراف ج5 ص39 وأحكام
القرآن للجصاص ج2 ص254.
([36])
راجع: صحيح البخاري ج1 ص126 و 189 وصحيح مسلم ج2 ص145 و146
والموطأ (مطبوع مع تنوير الحوالك) ج1 ص314 والكامل لابن الأثير
ج3 ص103 ونصب الراية ج2 ص192 و 187 وسنن النسائي ج3 ص120 و 118
ومسند أحمد ج1 ص378 وج2 ص148 والمصنف للصنعاني ج2 ص516 و 518
وسنن البيهقي ج3 ص136 و 126 و 144 و 153 وسنن أبي داود ج2 ص199
والأم ج7 ص175 وج1 ص159 ونيل الأوطار ج3 ص249 والمحلى ج4 ص270.
وراجع: الجامع الصحيح ج2 ص228 و 230 وج3 ص229 وكنز العمال ج8
ص151 و 152 والبداية والنهاية ج7 ص154 وتاريخ الأمم والملوك ج3
ص322 وسنن الدارمي ج1 ص354 وج2 ص55 و 56 وأنساب الأشراف ج5
ص39، والكامل في التاريخ ج3 ص103 والغدير ج8 ص99 فما بعدها.
([37])
المحلى ج4 ص270 والموطأ (مطبوع مع تنوير الحوالك) ج1 ص164.
([38])
الأم ج1 ص159 وج7 ص175 وسنن البيهقي ج3 ص144 والغدير ج8 ص100
عنهم وصحيح البخاري ج1 ص126 والبداية والنهاية ج7 ص154 والمصنف
ج2 ص516 والكامل في التاريخ ج3 ص104.
([39])
تاريخ الأمم والملوك ج3 ص302 وأنساب الأشراف ج5 ص39 والكامل في
التاريخ ج3 ص103 والبداية والنهاية ج7 ص154 وراجع: العبر
وديوان المبتدأ والخبر ج2 قسم 2 ص140 والغدير ج8 ص98 ـ 102
عنهم.
([40])
المحلى ج4 ص270 وحاشية ابن التركماني على سنن البيهقي مطبوعة
بهامش السنن ج3 ص144، والغدير ج8 ص100.
([41])
مسند أحمد ج4 ص94 ومجمع الزوائد ج2 ص156 وعن أحمد والطبراني،
وقال: رجال أحمد موثقون.
([42])
الغدير ج8 ص101 وكنز العمال ج8 ص154 عن عبد الرزاق والدارقطني.
([43])
فتح الباري ج2 ص470 عن أحمد والبيهقي ومسند أحمد ج1 ص62 وأنساب
الأشراف ج5 ص39 ومجمع الزوائد ج2 ص156 وتاريخ الأمم والملوك ج3
ص322 والبداية والنهاية ج7 ص154 والكامل في التاريخ ج3 ص103
وزاد المعاد ج1 ص129 وفيه: أنه كان قد تأهل بمنى، وأحكام
القرآن ج2 ص254.
([44])
فتح الباري ج2 ص470.
([45])
راجع المصدر السابق.
([46])
ذكر في الغدير ج8 ص104، المصادر التالية: الموطأ ج1 ص321 وفي
طبعة أخرى 254 والأم ج5 ص160 ومسند أحمد ج1 ص57 و 64 و 65 و 68
و 73 وصحيح مسلم ج1 ص935 وسنن الدارمي ج2 ص38 وسنن أبي داود ج1
ص290 وسنن ابن ماجة ج1 ص606 وسنن النسائي ج5 ص192 وسنن البيهقي
ج5 ص65 و 66.
([47])
الغدير ج8 ص104 و 105.
([48])
أنساب الأشراف ج5 ص39 وتاريخ الأمم والملوك ج3 ص322 والكامل في
التاريخ ج3 ص103 والبداية والنهاية ج7 ص154 والعبر وديوان
المبتدأ والخبر ج2 قسم 2 ص140 وسنن أبي داود ج2 ص199.
([49])
الأم ج1 ص165 وسنن البيهقي ج3 ص153.
([50])
راجع: أنساب الأشراف ج5 ص39 وتاريخ الأمم والملوك ج3 ص322 وزاد
المعاد ج1 ص129 والبداية والنهاية ج7 ص154 والكامل في التاريخ
ج3 = = ص103 وسنن أبي داود ج2 ص200 وسنن البيهقي ج3 ص144
ونيل الأوطار ج2 ص260 وكنز العمال ج8 ص152 عن البيهقي وابن
عساكر والغدير ج8 ص100 والمصنف ج2 ص518.
([51])
سنن البيهقي ج3 ص136 و157 وأحكام القرآن للجصاص ج2 ص254.
([52])
سنن البيهقي ج3 ص126 والمحلى ج5 ص18 والموطأ ج1 ص164 وفتح
الباري ج2 ص470.
([53])
زاد المعاد ج1 ص129.
([54])
زاد المعاد ج1 ص129.
([55])
راجع: الغدير ج8 ص108 و 109.
([56])
الغدير ج8 ص109 وزاد المعاد ج1 ص129.
([57])
راجع: فتح الباري ج2 ص470 ونيل الأوطار ج3 ص260 وزاد المعاد ج2
ص25 والمصنف ج2 ص516 وسنن أبي داود ج2 ص199.
([58])
راجع المصادر في الهامش الآنف الذكر.
([59])
راجع: الغدير ج8 ص109 وفتح الباري ج2 ص470 وزاد المعاد ج1
ص129.
([60])
فتح الباري ج2 ص479 وزاد المعاد ج1 ص129.
([61])
الرياض النضرة ج3 ص100.
([62])
راجع: الغدير ج8 ص110 ـ 116.
([63])
راجع: تاريخ الأمم والملوك ج3 ص322 والغدير ج8 ص101 والعبر
وديوان المبتدأ والخبر ج2 قسم 2 ص140 والبداية والنهاية ج7
ص154 والكامل في التاريخ ج3 ص103 و 104.
([64])
الآية 101 من سورة النساء.
([65])
بهجة المحافل ج1 ص227.
([66])
راجع كنز العرفان ج1 باب صلاة الخوف، والقصر في السفر، وغير
ذلك من كتب الفقه.
([67])
راجع: كتاب الغدير ج8.
([68])
تاريخ الخميس ج1 ص464 وراجع: السيرة الحلبية ج2 ص275 و 278
وشذرات الذهب ج1 ص11.
([69])
السيرة الحلبية ج2 ص278.
|