جيش المسلمين وجيش المشركين في المواجهة
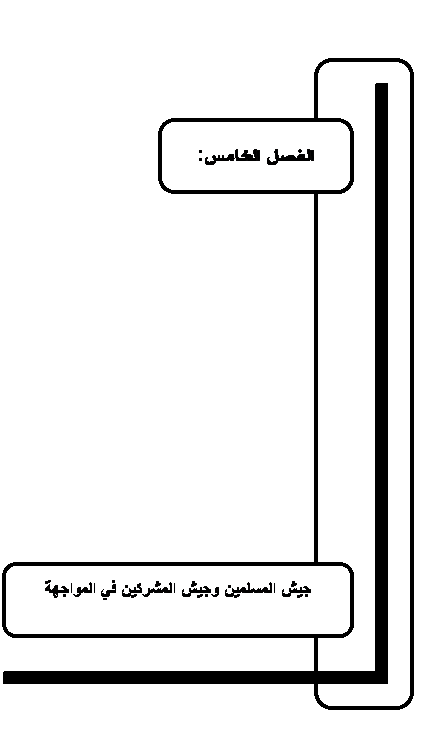
الإعداد
والإستعداد:
قال البلاذري:
«بلغ رسول
الله «صلى الله عليه وآله» الخبر، فندب المسلمين إلى قتال الأحزاب،
وخرج فارتاد لعسكر المسلمين»([1]).
وكان خروجه بعد
أن
استخلف على المدينة ابن أم مكتوم([2]).
وحسب نص الصالحي الشامي:
«ركب فرساً
ومعه عدة من المهاجرين والأنصار فارتاد
موضعاً،
وكان
أعجب
المنازل إليه
أن
يجعل سلعاً
الجبل خلف ظهره، ويخندق الخ..»([3]).
وكان خروجه «صلى الله عليه وآله» لثمان خلون من ذي
القعدة، أو شوال، حسبما
تقدم،
ويقال:
إن
خروجه «صلى الله عليه وآله» كان في يوم الإثنين([4]).
واختار
«صلى الله عليه وآله» ذلك الموضع المكشوف للخندق، وجعل معسكره تحت
جبل سلع([5])
أو سفح سلع، أو سطح سلع، أو جعل سلعاً
وراء ظهره، والخندق بينه وبين القوم([6]).
يقول البعض:
«فلو
أن
العدو عبر الخندق لقدمت سلع للمدافعين نفس
المزايا التي حصلوا عليها في أحد»([7]).
ويستفاد مما تقدم:
أن
موقعهم كان عند سلع من جهة الشام والمغرب([8]).
«وضربت له «صلى الله عليه وآله» قبة من
أديم
أحمر،
على القرن في موضع مسجد الفتح»([9]).
وتقدم في الفصل السابق، حين الكلام عن قصور الروم
وفارس:
أنها
قبة تركية.
وعلى حد تعبير الواقدي:
«وضرب قبة من
أدم،
وكانت القبة عند المسجد الأعلى الذي بأصل
الجبل، جبل الأحزاب»([10]).
ونسجل هنا:
ألف :
إنه
يستفاد من هذا ومما تقدم
ـ
مع
أن
بعض النصوص ذكرت:
أن
النبي
«صلى الله عليه وآله» جعل معسكره سطح (أو سفح) سلع
ـ:
أنه
«صلى الله عليه وآله» قد اختار من السفح موضعاً
مشرفاً،
ومرتفعاً
نسبياً
يمكنه من مراقبة الوضع بدقة، ثم المبادرة إلى اتخاذ
القرار اللازم في الموضع المناسب.
ب:
إنه
إذا كان المشركون إنما يفكرون بالدنيا، ويرون العزة بما يحصلون
عليه من حطامها، فإن
رؤيتهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» في مكان مشرف عليهم، وهو في
قبة ذات لون متميز من أدم أحمر، سيكون مغيظاً
لهم، وسيزيد
من حسرتهم وحنقهم، حين يرغمون على التراجع، وهم يجرون أذيال الخيبة
والخسران،
وقد خلفوا وراءهم قتلى من رؤسائهم وأبطالهم، كما سنرى.
عرض النبي
 الخارجين إلى الحرب:
الخارجين إلى الحرب:
ثم عرض
«صلى
الله عليه وآله»:
الجيش، وهو يحفر الخندق.
فعن أبي واقد الليثي قال:
«رأيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يعرض
الغلمان، وهو يحفر الخندق، فأجاز من أجاز، ورد من رد.
وكان الغلمان يعملون مع الذين لم يبلغوا ولم يجزهم،
ولكن لما لحم الأمر، أمر من لم يبلغ أن يرجع إلى أهله، إلى الآطام
مع الذراري.
إلى أن قال:
فكان ممن
أجاز رسول الله «صلى الله عليه وآله» يومئذٍ ابن عمر وهو ابن خمس
عشرة، وزيد بن ثابت وهو ابن خمس عشرة، والبراء بن عازب وهو ابن خمس
عشرة([11])،
وأبا
سعيد الخدري ولم يردهم.
ويقال:
إنه
أجازهم قبل ذلك»([12]).
قال العسقلاني:
«عرض
الجيش اختبار أحوالهم قبل مباشرة القتال للنظر في هيبتهم وترتيب
منازلهم وغير ذلك»([13]).
ومهما يكن
من أمر فقد أصبحت المدينة بسبب حفر الخندق كالحصن، حسبما تقدم([14]).
ويذكر
المؤرخون كافة تقريباً، وهم يتحدثون عن غزوة الخندق: أن النبي «صلى
الله عليه وآله» قد جعل النساء والصبيان في الآطام([15]).
قال الواقدي:
«ورفع النساء والصبيان في الآطام، ورفعت بنو حارثة
الذراري في أطمهم،
وكان أطماً
منيعاً.
وكانت عائشة يومئذٍ فيه.
ورفع بنو عمرو بن عوف النساء والذرية في الآطام،
وخندق بعضهم حول الآطام بقباء،
وحصن بنو عمرو بن عوف ولفها، وخطمة، وبنو
أمية،
ووائل، وواقف فكان ذراريهم في آطامهم»([16]).
ويذكر المؤرخون:
أنهم بعد
أن حفروا الخندق، وحصنوه «جعل له رسول الله أبواباً([17])
وجعل على الأبواب حرساً،
من كل قبيلة رجلاً،
وعليهم الزبير بن العوام، وأمره إن رأى قتالاً
أن يقاتل»([18]).
وفي نص آخر:
«وجعل على كل باب رجلاً من المهاجرين،
ورجلاً
من الأنصار مع جماعة يحفظونه»([19]).
وتقدم:
أن أبواب الخندق كانت ثمانية.
وأما لماذا
اختار
النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» أن تكون تركيبة الحرس على أبواب
الخندق بهذا الشكل، فربما يكون السر فيه:
هو أنه «صلى الله عليه وآله» قد أراد أن يقطع الطريق على أي تفكير
تآمري، من خلال اتصالات سرية فيما بين المشركين والمنافقين أو
غيرهم، للتواطؤ على المسلمين. ولو عن طريق الإغراء
بالمال، أو الاحتيال، أو التغفيل، حيث يتمكنون من
إحداث
ثغرة أو أكثر، من شأنها أن تعرض المسلمين للخطر الكبير.
وحين يكون الحرس من كل قبيلة رجلاً، فإن الرقابة
على بعضهم البعض تصبح طبيعية، ولن يعود من السهل فتح علاقة مشبوهة
مع أي منهم،
ويصبح احتمال تواطؤهم أبعد،
واتفاقهم على الخيانة يكون أصعب وأعقد.
ويلفت نظرنا هنا:
ذلك النص الذي بُيِّن
فيه اهتمام النبي «صلى الله عليه وآله» بمشاركة الأنصار للمهاجرين
في هذا الأمر.
ونحن نعلم:
أن
إمكانية
اختراق مشركي أهل مكة للمهاجرين
أسهل
وأيسر، لأنهم إخوانهم وأبناؤهم، ولم نزل نجد في المهاجرين من يحابي
قومه ويهتم بعدم
إلحاق
المزيد من الأذى
بهم بدءاً
من حرب بدر، حسبما أوضحناه هناك في قضية فداء الأسرى.
بل لقد وجدنا حتى زوجة النبي «صلى الله عليه وآله»
تخرج عن وقارها، وتندفع لتحرض على رسول الله «صلى الله عليه وآله»
في بدر، فراجع ما ذكرناه هناك
أيضاً
عن سودة بنت زمعة.
وتجد في كتابنا هذا، وفي كتاب «الغدير
والمعارضون»
شواهد كثيرة وغزيرة ومثيرة عن مواقف قريش من النبي «صلى الله عليه
وآله» وأهل بيته. ولا نرى حاجة لإعادة
التذكير بها هنا.
وإن جعل النساء والذراري في مواضع حصينة، وتجميعهم
في
أماكن
معينة يعتبر إجراءً
حكيماً،
لأنه يوفر على المسلمين معاناة حالة التوزع في الاهتمامات،
وانتشارها، ويركزها في نقطة أو نقاط محددة يمكن التركيز عليها في
الرعاية الأمنية،
وتسهيل تقديم المعونة الفاعلة والمؤثرة والسريعة، وفق خطة مرسومة
في الوقت المناسب لو فرض تعرضها لأي
خطر من قبل الأعداء.
ثم هي تمكن هؤلاء الضعفاء من أن يفيدوا من مناعة
تلك الآطام للدفع عن
أنفسهم
بدلاً
من بيوت واهنة لا تساعد على حمايتهم، ولا تدفع عنهم في شيء.
وبذلك لم يعد النساء والأطفال
منتشرين على مساحات واسعة،
بصورة تجعلهم هدفاً
سهلاً
لكل عابث، وعرضة
لأطماع
الأعداء والسفهاء، الأمر الذي يوجب إرباكاً
نفسياً
لدى القوى التي يفترض فيها أن تصب كل اهتماماتها على نقطة واحدة،
وواحدة فقط، وهي دفع العدو، وإبطال
كيده، وإلحاق
الهزيمة المخزية به.
وقد يمكن للعدو ـ لو لم تجعل الذراري والنساء في
الآطام ـ أن يستفيد من الوضع القائم، فيعتدي أو يتظاهر بالاعتداء
على المواقع المختلفة المنتشرة على مساحة المدينة بأكملها،
وذلك بهدف زعزعة حالة الاتحاد والانسجام لدى الجيش الإسلامي،
ليتمكن من إنزال ضربته القاصمة في الوقت المناسب.
وقد كان بنو قريظة يعرفون تفاصيل مسالك المدينة،
لأنهم من أهلها، فقيامهم بأي تسلل إليها سوف يربك الوضع في ساحة
القتال بصورة كبيرة وخطيرة.
وقد كان المسلمون يعرفون ذلك، فكانوا يعيشون حالة
القلق لولا هذا الإجراء الذي اتخذه
النبي
«صلى الله عليه وآله».
ومما زاد في الربط على القلوب، وتهدئة المشاعر،
واستقرار الحالة النفسية:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد جعل حراساً
يطوفون في المدينة، حتى أصبح واضحاً
ليهود بني قريظة ولغيرهم: أن أي تحرك سوف ينتهي بنكسة خطيرة لهم.
وقد كان في التجربة التي قام بها بعضهم للوصول إلى
حصن حسان الذي كانت فيه النساء، وانتهت بقتل ذلك الرجل على يد زينب
بنت جحش عبرة لهم وبلاغ.
أما بالنسبة لعقد ألوية الحرب، فإننا نقول:
ألف:
بالنسبة للمشركين، فالمؤرخون يقولون: إنهم عقدوا لواءهم في دار
الندوة، وحمله عثمان بن أبي طلحة، وقائد القوم أبو سفيان([20]).
ثم وافى
المشركون المدينة، فأنكروا أمر الخندق، وقالوا: ما كانت العرب تعرف
هذا([21]).
ب:
بالنسبة للمسلمين، يقول المؤرخون: «وكان لواء
المهاجرين بيد زيد بن حارثة، ولواء الأنصار بيد سعد بن عبادة، وكان
«صلى الله عليه وآله» يبعث الحرس على المدينة، خوفاً
على الذراري من بني قريظة»([22]).
ونقول:
إننا لا نهتم لتحريفات المؤرخين هذه، حيث نراهم
يتجاهلون الحقيقة الدامغة إرضاء لأسيادهم،
وانسياقاً
مع أهوائهم وعصبياتهم
وتعصباتهم
البغيضة.
فها هم يهملون هنا ذكر صاحب الراية العظمى للجيش
كله وصاحب لواء رسول الله «صلى الله عليه وآله» في كل مشهد، وهو
علي أمير المؤمنين «عليه السلام» مع تصريحهم باسم حامل لواء
المهاجرين، وحامل لواء الأنصار.
ونقول هنا:
1 ـ
إنه قد تقدم في حرب أحد في فصل: قبل نشوب الحرب،
وفي بدر أيضاً،
طائفة من النصوص التي تضافرت وتواترت في كتب السيرة
والتاريخ والحديث بالأسانيد
الصحيحة والموثوقة: أن علياً «عليه السلام» هو صاحب لواء وراية
النبي «صلى الله عليه وآله» في كل مشهد، وتقدم أن ذلك من فضائله
وخصائصه التي اشتهر بها. وهذه حقيقة مؤلمة لمبغضي وشانئي عليٍّ
«عليه السلام» ولأجل ذلك فهم يحاولون تجاهلها، والدس الرخيص
للتشكيك بها، ولو وسعهم الجهر بإنكارها لبادروا إلى ذلك.
2 ـ
وقد ورد في احتجاج الإمام الحسن المجتبى «عليه
السلام» على معاوية وابن العاص، والوليد الفاسق قوله: «ثم لقيكم
يوم أحد، ويوم الأحزاب ومعه راية رسول الله ومعك ومع
أبيك
راية الشرك»([23]).
3 ـ
روى الحكم
بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس، قال: «كانت راية رسول الله «صلى
الله عليه وآله» مع علي «عليه السلام» في المواقف كلها: يوم بدر،
ويوم أحد، ويوم حنين، ويوم الأحزاب، ويوم فتح مكة. وكانت راية
الأنصار مع سعد بن عبادة في المواطن كلها، ويوم فتح مكة، وراية
المهاجرين مع علي «عليه السلام»([24]).
وهذا يدل على أن قولهم:
كانت راية المهاجرين يوم الأحزاب مع زيد بن حارثة غير صحيح.
ويقول المؤرخون:
كان شعار
المهاجرين أيام الخندق: «يا خيل الله»([25]).
وقالوا أيضاً:
كان شعار أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوم الخندق وبني
قريظة: حم،
لا ينصرون([26]).
ونقول:
لقد رأينا:
أن شعار المسلمين في حروبهم مع أعدائهم، سواء في زمن رسول الله
«صلى الله عليه وآله» أو في زمن علي «عليه السلام» في حروبه مع
البغاة هو: «حم، لا ينصرون»،
وكذا عبارة: «يا منصور أمت».
وهاتان الكلمتان لهما دلالاتهما وإيحاءاتهما
في ظرف كهذا حيث
إنهما
تزرعان الطموح إلى النصر في قلب وروح المقاتل المسلم فيزداد جرأة
على القتال وإقداماً
على التضحية، ويتذرع بالصبر الجميل على ما يواجهه من مكاره يترقب
الفرج والفوز بعدها بمزيد من الطمأنينة والثقة ويكون تحركه في ساحة
القتال والحالة هذه تحرك الواثق، الذي يريد من خلال تفعيل طاقاته
القتالية بحكمة وحنكة وتعقل أن يتجاوز هذا الواقع، الذي يرى فيه
وضعاً
إستثنائياً
ونشازاً،
لا تساعد على استمراره عوامل طبيعية ومقبولة.
ثم إن هذا الشعار، حين يبدأ بواحدة من مفردات
الحروف المقطعة التي اختص بها القرآن، فإنه يكون قد أوحى مسبقاً
لهذا الإنسان المؤمن بصدق هذا الوعد الإلهي، الذي يتلفظ به هو نفسه
ويطلقه شعاراً
له في هذا الوقت بالذات الذي يحتاج إليه عملياً.
فهو شعار يتجه نحو الواقع ليتجسد حقيقة ملموسة له، ويساهم هو في
صنعها وفي بلورتها.
والأمر الملفت للنظر هنا:
أن
يكون هذا اليقين قد أيقظته في نفسه كلمة حم، التي هي رمز التحدي
الفكري كما تقدم في الجزء الثاني من هذا الكتاب مفصلاً
وقد اقترن هذا التحدي الفكري بالتحدي بالعنف والقتال، كنتيجة
طبيعية لعجز قوى الشرك، وهزيمتها المخزية والنكراء في مجال الفكر
والمثل والقيم.
وأما بالنسبة للمشركين،
فالأمر سيكون على عكس ذلك تماماً،
فإنهم
حين يسمعون هذه الكلمة (حم، لا ينصرون) لسوف يتمثلون حالة العجز
والسقوط والهزيمة بكل
أنحائها،
وبكل مجالاتها،
ولسوف تزرع هذه الكلمة اليأس والفشل في نفوسهم،
فإنها كانت رمز التحدي القرآني لهم ولكل من هو على شاكلتهم،
بالإضافة إلى إيحاءات أخرى ـ
ألمحنا
إليها فيما سبق ـ كانت إيجابية بالنسبة لقوى الإيمان ولسوف تكون
معكوسة وسلبية بالنسبة لقوى الشرك والطغيان.
فليتأمل المتأمل فيما ذكرناه، وليتدبره كيف يتحول
إلى الضد من ذلك على قوى الشرك، حتى لا نضطر إلى إعادة تفصيلية له.
غير أننا نلمّح هنا إلى نقطة واحدة نضيفها إلى ما
سبق، وهي:
أن هذا الشعار يقول: «لا ينصرون» بصيغة المبني للمجهول ولم يقل:
«لا ينتصرون» ففيه
إلماح
إلى أن المشركين لا يملكون معطيات النصر في أنفسهم فلا بد أن
ينتظروا النصر من غيرهم، وليس ثمة ناصر لهم ولا معين، فهزيمتهم
حتمية لفقدهم مقومات النصر من الجهتين. فالمشرك يرى العجز والفشل
الفكري والعقيدي بكلمة حم. كما
أنه
يتمثل الخواء من أي من القدرات والطاقات التي تخوله
أن
يصنع نصراً.
فهو مهزوم في الحالتين، والمؤمن يأتيه النصر من الله، وهو على يقين
من هذا النصر. فاجتمع على قوى الشرك عاملان من عوامل الضعف ولقوى
الإيمان عاملان من عوامل القوة.
هذا عدا عن أن الصيغة صيغة
إخبار، تعطي:
مزيداً
من الثقة بتحقق ذلك، حتى كأنه أمر واقع وملموس، يصح الإخبار
عنه بهذه الدرجة من الجزم والثبات
والطمأنينة.
ولسوف يتيقن المشركون صدق هذا الوعد، ما دام أنه
هدي قرآني استقر في نفوسهم:
إنهم
أعجز
وأصغر
من أن يشككوا في أي من آياته وحقائقه.
وهذا درس نافع نستفيده من هذا الشعار. نسأل الله
التوفيق للتوفر على دراسة هذا الموضوع بصورة أتم وأوفى، وأوضح
وأجلى وأصفى، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
هذا وقد اختلفت كلمات المؤرخين في عدة وعدد الجيش
الإسلامي الذي واجه الأحزاب في حرب الخندق.
فأما بالنسبة للعدة، فقد ذكر
ابن سعد:
«أنه كان مع المسلمين ستة وثلاثون فرساً»([27])
وأما
بالنسبة إلى العدد فنشير إلى الأقوال التالية:
1 ـ
قيل كان
المسلمون سبع مئة، وهو قول ابن إسحاق([28]).
وقد حكم البعض على ابن إسحاق
بأنه:
«وهم في ذلك» وغلط. وزعم ابن القيم:
أن
منشأ الغلط هو ارتكاز عدد من خرج معه «صلى الله عليه وآله» في أحد([29]).
2 ـ
قيل: كانوا ألفاً
أو نحوها، وهو صريح رواية البخاري ومسلم عن جابر. وصرح به قتادة
أيضاً([30]).
3 ـ
وقيل: تسع مئة أضاف ابن خلدون قوله: «وهو راجل بلا
شك».
وقال ابن حزم:
«وهو
الصحيح الذي لا شك فيه، والأول وهم»([31]).
يريد بالأول: القول بأنهم كانوا ألفاً.
4 ـ
وذهب أكثر المؤرخين إلى أنهم كانوا ثلاثة آلاف أو نحوها([32]).
ونقول:
ألف:
إننا نحتمل قوياً:
أن
يكون القول الثالث هو نفس قول ابن إسحاق، لكن النساخ صحَّفوا
سبعمئة بتسعمئة، لتقارب رسم الخط في الكلمتين، وعدم وجود النقط في
السابق، وما أكثر ما يقع الاشتباه والاختلاف
بين سبع وتسع، من
أجل
ذلك.
ب:
إننا نرجح قول ابن إسحاق، وإن
حكم عليه البعض،
كالحلبي وغيره، بأنه
قد وهم أو غلط في ذلك.
ولو تنزلنا عن ذلك، فإننا
نأخذ بالقول الثاني، أما القول بأنهم كانوا ثلاثة آلاف، فلا مجال
للاعتماد عليه، وذلك للأمور التالية:
1 ـ
ما تقدم في قصة إطعام جابر لأهل الخندق جميعاً وكانوا سبع مئة رجل،
أو
ثمان
مئة، أو
ألف
رجل. فراجع حديث جابر المتقدم في الفصل السابق، وراجع المصادر التي
أشير إليها في الهامش هناك.
2 ـ
روي
عن الإمام الصادق «عليه السلام»:
أنه
«صلى الله عليه وآله» شهد الخندق في تسع مئة رجل([33]).
ويحتمل
أن
تكون كلمة تسع تصحيفاً
لكلمة سبع
أيضاً.
3 ـ
روي: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال: اكتبوا لي من تلفظ
بالإسلام. فكتب حذيفة بن اليمان له
ألفاً
وخمس مئة رجل.
وفي نص آخر:
ونحن ما بين الست مئة إلى السبع مئة.
قال الدماميني:
قيل: كان هذا عام الحديبية([34]).
ويرى البعض:
أن
المسلمين كانوا في أُحد
بعد رجوع المنافقين سبع مئة رجل، وبين أُحد
والخندق سنة أو أكثر بقليل،
ويبعد
أن
يزيد المسلمون خلال سنة واحدة هذه الزيادة الكبيرة، بحيث يصلون إلى
ثلاثة آلاف([35]).
وما جرى في الخندق يوضح:
أن
عدد سكان المدينة لا يصل إلى الخمسة
آلاف نسمة بما في ذلك الأطفال
والنساء.
ووافى
المشركون المدينة، وأحاطوا بها من جميع جهاتها واشتد الحصار على
المسلمين([36]).
وقد اختلفت الأقوال في عدد المشركين،
وذلك على النحو التالي:
1 ـ
قال المسعودي: «سارت إليه قريش،
وغطفان،
وسليم،
وأسد، وأشجع،
وقريظة،
ونضير، وغيرهم من اليهود، فكان عدة الجميع أربعة وعشرين ألفاً،
منها قريش وأتباعها أربعة آلاف»([37]).
2 ـ
وقال ابن شهرآشوب:
«كانوا ثمانية عشر
ألف
رجل»([38]).
3 ـ
وقال ابن الدبيع: كانوا أحد عشر ألفاً([39]).
وذكر في موضع آخر:
أنهم
كانوا عشرة آلاف.
ولعله حين عد معهم بني قريظة ذكر الرقم الأول، وحين غض النظر عنه
عدهم عشرة آلاف.
4 ـ
إن عدد جيش المشركين بجميع فئاته كان عشرة آلاف: قريش وكانوا أربعة
آلاف، ومن
أجابهم
من بني سليم، وأسلم،
وأشجع، وبني مرة، وكنانة، وفزارة، وغطفان([40]).
5 ـ
إنهم كانوا مع يهود بني قريظة والنضير زهاء اثني عشر
ألفاً([41]).
6 ـ
ولكننا نجد آخرين من المؤرخين يتحدثون عن هذا الأمر بطريقة تؤيد
أحد القولين الأولين،
فقد قال ابن الوردي وغيره:
«أقبلت
قريش في أحابيشها، ومن تبعها من كنانة في عشرة آلاف، وأقبلت غطفان
ومن تبعها من أهل نجد» ثم ذكر انضمام بني قريظة إليهم([42]).
7 ـ
ثم هناك من يقول:
إن
عدد جيش الأحزاب كان أربعة آلاف فقط([43]).
ولا نشك في
أن
هذا القول ناظر إلى حشود قريش، أو
أن
بعض المؤرخين رآهم يذكرون
أن
عدد الجمع القريشي كان هذا المقدار فتوهم
أنه
يقصد بيان عدد الجيش كله.
وأما بالنسبة لعدة أهل الشرك،
فقد قال المسعودي:
إنه
كان «معهم ثلاث مئة فرس، وألف وأربع مئة بعير، وقائدهم أبو سفيان
صخر بن حرب»([44]).
وذكر آخرون:
أنه
كان معهم ألف وخمس مئة بعير، وثلاث مئة فرس([45]).
وذكر الدياربكري:
أنهم
كانوا أربعة آلاف معهم ثلاث مئة فرس وألف
بعير، وعند غيره:
ألف
وخمس مئة بعير([46]).
ويظهر من المقريزي:
أنه
كان مع المشركين بالإضافة إلى
ألف
وخمس مئة بعير: ثلاث مئة فرس مع قريش، وثلاث مئة أخرى مع غطفان([47]).
وفي كلام حيي بن أخطب لكعب بن
أسد:
«والخيل
ألف
فرس وسلاح كثير»([48]).
وصرح النويري:
أن
غطفان وفزارة كان معهما
ألف
بعير([49]).
ومن الواضح:
أن
لا مجال لتحديد الرقم الحقيقي لذلك كله ولا لغيره. لكن مما لا شك
فيه:
أن
هذا العرض للنصوص والأقوال يوضح مدى التفاوت فيما بين عدة وعدد
المسلمين، وأعدائهم
من الأحزاب الذين جاؤوا
من كل حدب وصوب.
معنويات
جيش الشرك:
وقد كان من الواضح:
أن
تفوق المشركين في العدد والعدة، ثم ما كان من تحالفهم مع بني قريظة
الذين كانوا في الجهة الأخرى
للمدينة،
أضف إلى ذلك:
هذا الإجماع
الحاصل من مختلف القبائل العربية،
وكذلك بسبب الإعلام المسموم الذي
أعقب
حرب أُحد،
وصوَّر
لأهل
الشرك
أنهم
قد حققوا فيها نصراً
كبيراً،
وبسبب الحقد الذي يتغلغل في نفوس الكثيرين منهم على
الإسلام والمسلمين،
نعم..
إنه
بسبب ذلك كله، وسواه مما لم
نذكره،
كان جيش الشرك يعيش في بدايات حصاره للمسلمين حالة من الانتعاش
الروحي، والشعور بالقوة والتفوق، وبإمكانية تحقيق بعض ما كانوا
يصبون إليه.
ولكن الأمر لم يدم على هذا الحال طويلاً
فقد تبخرت الآمال وحل محلها الشعور بالخيبة، وتلاشت
حالة
الانتعاش، لتخلفها حالة التململ والشعور بالضيق.
حتى إذا جاءت ضربة علي القاصمة لجيش الشرك، تبدل كل
شيء ليواجه هذا الجيش حالة من الرعب والخوف،
وتصبح تلك الكثرة في العدد وفي العدة عبئاً
ثقيلاً،
ومصدر متاعب لذلك الجيش بالذات. فقد
أصبحت
العدة من
أفراس
ومن وسائل نقل ـ أبعرة ـ بسبب طول المدة، وبسبب الجدب أمراً يحسن
التخلص، أو على الأقل
يحسن التخفيف منه وتحجيمه.
كما
إن
إجماع
القبائل لم ينجح في توحيد القيادة لهم، ولا استطاع
أن
يحجب الروح القبلية،
ويمنعها من الهيمنة على مسيرة التحرك، حتى في مواقع القتال.
فكانت
كثرة هذا الجيش تستبطن التمزق، وكان تكثُّر
الانتماءات في الولاء والطاعة، يحمل معه بذور الفساد والإفساد،
والخلاف والشقاق لأتفه
الأسباب.
أضف إلى ما تقدم:
أن
الإعلام المزور والمسموم قد
أوجب
انتفاخاً
كاذباً،
وأذكى
توقعات كبيرة، يعلم قادة الأحزاب
أنفسهم
أنهم
أعجز
عن
أن
ينالوها، أو
أن
يحققوا
أدناها.
وبعد ما تقدم:
فهل يمكن لجيش كهذا
أن
يقوم بتجربة حربية ضد المسلمين، مع
أنه
لا يمكن ضمان نتائجها، لا سيما بعد
أن
عرف ورأى
ميدانياً
أن
الأمور قد
أصبحت
على غاية من التعقيد والخطورة، ولم يكن قد حسب لكل هذه المستجدات
أي حساب؟
وبعد كل ما تقدم:
فإن
علينا
أن
لا ننسى
أن
تلك القبائل كانت تفتقر إلى ترسيخ عامل الثقة فيما بينها. ولم تكن
ثمة ضمانات حقيقية لوفاء بني قريظة للمشركين، ولا العكس، مع علمهم:
أن
الذي يجمع كل هذه المتفرقات هو الخوف من التفرق، وليس شيئاً غير
ذلك..
وأما بالنسبة لجيش أهل الإيمان فإن
الأمر يختلف تماماً،
فهو يرى
أن
وجوده معرض للاستئصال والفناء، ولا بد له من الدفاع، ولن يجد ملجأً
له إلا بذل الجهد، وإلا الجهاد من أجل البقاء.
كما
أن
هذا الجيش ينطلق في حركته وفي جهاده من قاعدة
إيمانية
تجمع بين متفرقاته، وتؤلف بين مختلفاته.
وهو وإن
كان قد تعرض ـ في بادئ الأمر ـ لهزة من نوع ما حين صار المنافقون
وضعفاء الإيمان يتسللون ويتركون مواضعهم بأعذار
مختلفة،
ولكن حزم القيادة، وهيمنتها، وحسن تدبيرها لم يفسح
المجال للتأثر بالشائعات، واستطاعت هذه القيادة، حين فضحت أمر
هؤلاء المنافقين بالوحي القرآني، وحين ظهرت الكرامات الباهرة على
يدها، وأطلقت
البشارات بالنصر الأكيد،
استطاعت
أن
تعيد للجو الإيماني صفاءه ونقاءه، وتحصنه من كل ما من شأنه
أن
يشيع روح التخاذل، ويزرع اليأس والخوف في نفوس المخلصين والمؤمنين،
وقطعت الطريق على أي كان،
من
أن
يتخذ موقفاً،
أو يتصرف تصرفاً
من شأنه
أن
يعطي للعدو أية فرصة من أي نوع كانت.
وعن علي
«عليه
السلام»
قوله:
«فقدمت قريش، فأقامت على الخندق محاصرة لنا، ترى في
أنفسها
القوة وفينا الضعف، ترعد وتبرق، ورسول الله «صلى الله عليه وآله»
يدعوها إلى الله عز وجل، ويناشدها بالقرابة والرحم، فتأبى، ولا
يزيدها ذلك إلا عتواً»([50]).
ونقول:
ليس غريباً
على قريش هذا العتو، وهذه الغطرسة، ما دامت تقيس الأمور بمقاييس
مادية، وترى القوة في أنفسها، والضعف في المسلمين، الذين جاءت
لاستئصالهم، وإبادة خضرائهم،
ولكن هذا العتو وتلك الغطرسة سرعان ما تلاشت، ليحل محلها الضعف
والخنوع، والخيبة القاتلة، كما سنرى.
وليس غريباً أيضاً:
أن نجد النبي «صلى الله عليه وآله» ومن موقع الشعور
بالمسؤولية يعتمد الأسلوب
الإنساني، ويستثير العاطفة الناشئة عن صلات القربى ولحمة النسب،
والتي تكون لها هيمنة حقيقية على الإنسان ولا بد أن تجتاح هزاتها
الجامحة كل كيانه، وكل وجوده. ثم هو «صلى الله عليه وآله» يقرن ذلك
بالدعوة إلى الله عز وجل، الذي هو مصدر الخير والقوة والبركات.
ويقال:
إن أبا سفيان كتب إلى النبي «صلى الله عليه وآله»
مهدداً
إياه بما جمعه من الأحزاب لقتاله، ولعله قد كتب هذا الكتاب بعد
وصوله إلى المدينة وحصول المواجهة، والكتاب هو:
أما بعد..
فإنك قد قتلت أبطالنا، وأيتمت الأطفال،
وأرملت النساء، والآن
قد اجتمعت القبائل والعشائر يطلبون قتالك، وقلع آثارك وقد جئنا
إليك
نريد نصف نخل المدينة، فإن أجبتنا إلى ذلك وإلا أبشر بخراب الديار،
وقلع الآثار.
تجـاوبــت
الـقـبـائـل مـن نــزار لـنـصر الــلات في بـيـت الحــرام
وأقـبـلت الـضـراغم مـن قريش عـلى خـيـل مـسـومــة
ضــــرام
فرد عليه النبي «صلى الله عليه وآله» بالرسالة
التالية:
بسم الله
الرحمن الرحيم، وصل كتاب أهل الشرك والنفاق، والكفر والشقاق، وفهمت
مقالتكم، فوالله، ما لكم عندي إلا أطراف الرماح، وشفار الصفاح.
فارجعوا ويلكم عن عبادة الأصنام، وأبشروا بضرب الحسام، وبفلق
الهام، وخراب الديار، وقلع الآثار، والسلام على من اتبع الهدى»([51]).
قال الشيخ محمد أبي زهرة:
«ونشك في
نسبة هذا الكتاب إلى النبي «صلى الله عليه وآله» لما فيه من
السجع»([52]).
ولا نرى:
أن السجع في الكتاب يبرر الشك فيه، فإن خطب
الزهراء، وخطب علي «عليهما
السلام» لم تخل من ذلك، كما يظهر لمن راجعها.
([1])
أنساب الأشراف ج1 ص343.
([2])
راجع: الثقات ج1 ص266 والتنبيه والإشراف ص216 وزاد المعاد ج2
ص117 وجوامع السيرة النبوية ص149 والسيرة النبوية لابن هشام ج3
ص231 والعبر ج2 ق 2 ص29 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص197
والبداية والنهاية ج4 ص103 و 102 وتاريخ الخميس ج1 ص481
والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص4 والسيرة الحلبية ج2 ص315 و 314
وإمتاع الأسماع ج1 ص216 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص523 ونهاية
الأرب ج17 ص168 والمغازي للواقدي ج2 ص441 وعيون الأثر ج2 ص57.
([3])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص414 و 415.
([4])
راجع: نهاية الأرب ج17 ص170 وغير ذلك من المصادر السابقة
واللاحقة
([5])
تاريخ الخميس ج1 ص481 السيرة الحلبية ج2 ص315.
([6])
راجع المصادر المتقدمة في الهوامش السابقة، وفي: البداء
والتاريخ ج4 ص217 ووفاء الوفاء ج1 ص301 و300 وج 4 ص1204
والمغازي للواقدي ج2 ص454 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق 2
ص29 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص231 وزاد المعاد ج2 ص117
والكامل في التاريخ ج2 ص180 والإكتفاء للكلاعي ج2 ص162 و 163،
وأنساب الأشراف ج1 ص343 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص236
وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص237 وجوامع السيرة النبوية ص149 وفتح
الباري ج7 ص307 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص415 و 514 و 523 وتهذيب
سيرة ابن هشام ص190 ودلائل النبوة للبيهقي ج3 ص428 وبهجة
المحافل ج1 ص264 والمواهب اللدنية ج1 ص112 وإمتاع الأسماع ج1
ص125 والبداية والنهاية ج4 ص102 ومجمع البيان ج8 ص342 وبحار
الأنوار ج20 ص200 ونهاية الأرب ج17 ص168 وسعد السعود ص138.
([7])
محمد في المدينة ص56.
([8])
وفاء الوفاء ج4 ص1200.
([9])
وراجع أيضاً: تاريخ الخميس ج1 ص481.
([10])
المغازي للواقدي ج2 ص454 و 457 وراجع: السيرة الحلبية ج2 ص314
وسبل الهدى والرشاد ج4 ص524.
([11])
راجع: المغازي للواقدي ج2 ص453 وأنساب الأشراف ج1 ص343 و344
وراجع تاريخ الخميس ج1 ص481 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص314 و
315 وإمتاع الأسماع ج1 ص224 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص523.
([12])
أنساب الأشراف ج1 ص344 وراجع: السيرة الحلبية ج2 ص315.
([13])
فتح الباري ج7 ص302.
([14])
إمتاع الأسماع ج1 ص223 وراجع أواخر الفصل الثاني، حين الكلام
عن تشبيك المدينة بالبنيان.
([15])
قد ذكرت ذلك مختلف المصادر التي تقدمت في هذا الفصل، فمن
أرادها فليراجعها.
([17])
راجع: مغازي الواقدي ج2 ص452 و 450 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص515
وتاريخ اليعقوبي ج2 ص50، وراجع: السيرة الحلبية ج2 ص2 ص312
والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص267 ووفاء الوفاء ج4 ص1206.
([18])
تاريخ اليعقوبي ج2 ص50.
([19])
تفسير القمي ج2 ص179 وبحار الأنوار ج20 ص220.
([20])
السيرة النبوية لدحلان ج2 ص2 وراجع: تاريخ الخميس ج1 ص480
والسيرة الحلبية ج2 ص311 والإمتاع ج1 ص218 وعيون الأثر ج2 ص56
وسبل الهدى والرشاد ج4 ص513.
([21])
تاريخ اليعقوبي ج2 ص50 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص5 وراجع:
تاريخ الخميس ج1 ص484 والسيرة الحلبية ج2 ص315 وسبل الهدى
والرشاد ج4 ص530، والمغازي للواقدي ج2 ص470 وتفسير القمي ج2
ص182 وبحار الأنوار ج2 ص224 ونهاية الأرب ج17 ص173 والإرشاد
للمفيد ص52 وكشف الغمة للأربلي ج1 ص202 وإعلام الورى (ط دار
المعرفة) ص100.
([22])
المواهب اللدنية ج1 ص112 وتاريخ الخميس ج1 ص483 وراجع ص481
والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص4 والسيرة الحلبية ج2 ص315 وراجع:
إمتاع الأسماع ج1 ص225 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص524، ونهاية
الأرب ج17 ص170 وعيون الأثر ج2 ص58.
([23])
كفاية الطالب ص336 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج6 ص289 والغدير
ج10 ص168 عنه وجمهرة الخطب ج2 ص23.
([24])
إعلام الورى (ط دار المعرفة) ص191.
([25])
إمتاع الأسماع ج1 ص230 والمغازي للواقدي ج2 ص466 وتاريخ الخميس
ج1 ص485 وراجع: السيرة النبوية لدحلان ج2 ص8 والسيرة الحلبية
ج2 ص321.
([26])
تاريخ الخميس ج1 ص483 عن ابن هشام وص 485 وسبل الهدى والرشاد
ج4 ص524 والكافي ج5 ص47 ونهاية الأرب ج17 ص178 والمغازي
للواقدي ج2 ص474 وعيون الأثر ج2 ص62 عن ابن هشام، والسيرة
النبوية لابن هشام ج3 ص237 وتهذيب سيرة ابن هشام ص194 والسيرة
النبوية لدحلان ج2 ص8 وزاد المعاد ج2 ص118 وبهجة المحافل وشرحه
ج1 ص271 و 272 عن الترمذي، وأبي داود والوسائل ج11 ص105
والكافي ج5 ص46 و 47 وكنز العمال ج10 ص291 وجوامع السيرة
النبوية ص150 والإكتفاء للكلاعي ج2 ص169 والسيرة الحلبية ج2
ص321 وقال: «لعل المراد بالمسلمين الأنصار، فلا يخالف ما في
الإمتاع، وكان شعار المهاجرين: يا خيل الله».
ونقول: إن هذا التوجيه لا يمكن المساعدة عليه.
([27])
المواهب اللدنية ج1 ص110 وتاريخ الخميس ج1 ص480 عن ابن سعد،
والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص2 والمغازي للواقدي ج2 ص457
([28])
تاريخ اليعقوبي ج2 ص50 والسيرة الحلبية ج2 ص314 عن ابن إسحاق.
وراجع: إمتاع الأسماع ج1 ص224 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص524
وراجع ص565 وتفسير القمي ج2 ص177 والبحار ج20 ص218 عنه وزاد
المعاد ج2 ص117.
([29])
السيرة الحلبية ج2 ص314 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص524 وإمتاع
الأسماع ج1 ص224 وزاد المعاد ج2 ص117.
([30])
راجع: وفاء الوفاء ج1 ص301 وفتح الباري ج7 ص301 وتاريخ الخميس
ج1 ص480 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص2 وسبل الهدى والرشاد ج4
ص565 وحدائق الأنوار ج1 ص212 ودلائل النبوة للبيهقي ج3 ص394.
([31])
راجع: العبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 قسم 2 ص29 وراجع: إمتاع
الأسماع ج1 ص225 وجوامع السيرة النبوية ص149.
([32])
إمتاع الأسماع ج1 ص224 و
225 ومجمع البيان ج8 ص342 والبحار ج20 ص200 عنه، وراجع هذا
القول في المصادر التالية: سيرة مغلطاي ص56 والتنبيه والإشراف
ص216 ووفاء الوفاء ج1 ص301 وج 4 ص1204 عن المطري عن ابن إسحاق
والثقات ج1 ص266 والكامل في التاريخ ج2 ص180 والسيرة النبوية
لابن هشام ج3 ص231 والإكتفاء للكلاعي ج2 ص162 والوفاء ص693
ومناقب آل أبي طالب ج1 ص197 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي)
ج2 ص233 و 236 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص236 و 237 والعبر
وديوان المبتدا والخبر ج2 قسم 2 ص29 والسيرة النبوية لابن كثير
ج3 ص197 والبداية والنهاية ج4 ص102 والمواهب اللدنية ج1 ص110 و
112 وتاريخ الخميس ج1 ص480 و 481 و 483 وبهجة المحافل ج1 ص264
والسيرة الحلبية ج2 ص314 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص2 وسبل
الهدى والرشاد ج4 ص524 و565 وكشف الغمة للأربلي ج1 ص197 وشرح
النهج للمعتزلي (منشورات دار مكتبة الحياة) ج4 ص267 والبحار
ج20 ص272 عن المناقب ونهاية الأرب ج17 ص168 وعيون الأثر ج2 ص57
و 58 والتهذيب سيرة ابن هشام ص190 ودلائل النبوة للبيهقي ج3
ص428 والبدء والتاريخ ج4 ص217 ومختصر التاريخ ص43 وحبيب السير
ج1 ص359 وجوامع السيرة النبوية ص149 وفتح الباري ج7 ص301 و 307
وسعد السعود ص138.
([33])
الكافي ج5 ص46 والوسائل ج11 ص105.
([34])
راجع: صحيح البخاري ج2 ص116 وصحيح مسلم ج1 ص91 ومسند أحمد ج5
ص384 وسنن ابن ماجة ج2 ص1337 والتراتيب الإدارية ج1 ص220 و 223
وج 2 ص251 و 252 وعن المصنف لابن أبي شيبة ج15 ص69.
([35])
الرسول العربي وفن الحرب، هامش ص238.
([36])
راجع: حدائق الأنوار ج2 ص587.
([37])
التنبيه والإشراف ص216.
([38])
مناقب آل أبي طالب ج1 ص197 والبحار ج20 ص272 عنه.
([39])
حدائق الأنوار ج1 ص52 ويفهم ذلك من الزمخشري في الكشاف ج3 ص526
وعنه في سعد السعود ص138.
([40])
تاريخ الخميس ج1 ص480 ووفاء الوفاء ج1 ص301 عن ابن إسحاق
والمغازي للواقدي ج2 ص444 و 445 وتفسير القمي ج2 ص177 و 176
وعيون الأثر ج2 ص57 وزاد المعاد ج2 ص117 وبحار الأنوار ج20
ص217 ونهاية الأرب ج17 ص168 والبدء والتاريخ ج4 ص217 وسيرة
مغلطاي ص56.
وراجع: الوفاء ص693 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص233 و
236 ودلائل النبوة للبيهقي ج3 ص428 وراجع: العبر وديوان
المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص29 وفتح الباري ج7 ص301 و 307 والمواهب
اللدنية ج1 ص110 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص2 و 4 وبهجة
المحافل ج1 ص264 والسيرة الحلبية ج2 ص311 وحدائق الأنوار ج2
ص587 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص514 ومنهاج السنة ج4 ص170.
([41])
تاريخ الخميس ج1 ص484.
([42])
تاريخ ابن الوردي ج1 ص161 وكشف الغمة للأربلي ج1 ص197 والكامل
في التاريخ ج2 ص180 والمختصر في أخبار البشر ج1 ص135 وراجع
المصادر التالية: الإكتفاء للكلاعي ج2 ص162 والسيرة النبوية
لابن هشام ج3 ص230 و 231 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص236 و 237
والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص197 والبداية والنهاية ج4 ص102
والبدء والتاريخ ج4 ص217 وتاريخ الخميس ج1 ص483 والمواهب
اللدنية ج1 ص112 ومختصر التاريخ ص43 وجوامع السيرة النبوية
ص149 وفتح الباري ج7 ص307 ومجمع البيان ج8 ص341 و 342 والبحار
ج20 ص200 وتهذيب سيرة ابن هشام ص190 ووفاء الوفاء ج1 ص301.
([43])
راجع هذا القيل في: وفاء الوفاء ج1 ص301 وفتح الباري ج7 ص301
والسيرة الحلبية ج2 ص310 و 311 وتاريخ الخميس ج1 ص480 والسيرة
النبوية لدحلان ج2 ص2 ودلائل النبوة للبيهقي ج2 ص394 عن قتادة.
([44])
التنبيه والإشراف ص216.
([45])
السيرة الحلبية ج2 ص310 و 311 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص2
والإمتاع ج1 ص218 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص513 ونهاية الأرب ج17
ص167 وحبيب السير ج1 ص359.
([46])
تاريخ الخميس ج1 ص480 وعيون الأثر ج2 ص56 وتاريخ الإسلام
للذهبي (المغازي) ص233 ولم يذكر عدد الإبل.
([47])
إمتاع الأسماع ج1 ص218 و 219.
([48])
المغازي للواقدي ج2 ص455.
([49])
نهاية الأرب ج17 ص167.
([50])
الخصال ج2 ص68، باب السبعة، والبحار ج20 ص244.
([51])
خاتم النبيين ج2 ص920 و 921 عن كتاب السيرة لابن جرير الطبري
([52])
خاتم النبيين ص921.