|
معنويات الجيشين والرعب والخوف أيام الحصار
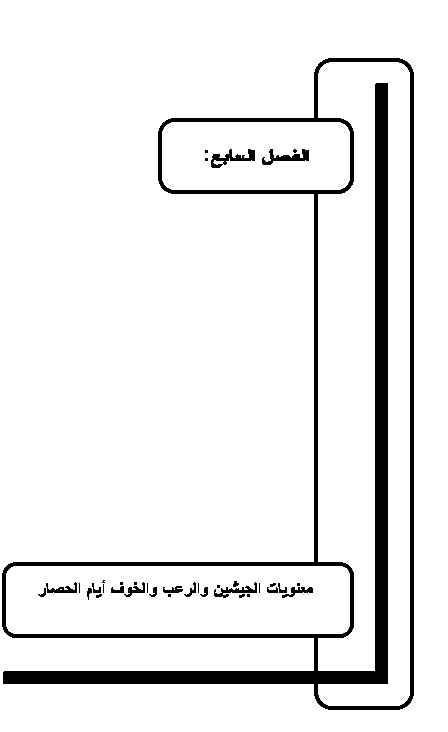
الحالة المعنوية لجيش الأحزاب:
لقد حاصر المشركون المسلمين في المدينة مدة طويلة،
سنتحدث عنها في الفصل التالي. ولا شك في أن جيش الشرك كان مطمئناً
إلى أنه سوف يحقق في مسيره ذاك لحرب المسلمين نتائج طيبة ومثيرة وربما
حاسمة، وذلك استناداً
إلى ذلك الحشد الهائل الذي استطاع أن يوفره، والذي لم يسبق له مثيل.
ثم فوجئ بالخطة الدفاعية التي اعتمدها المسلمون في
المواجهة، ولكنه لم يفقد الأمل، وحرص على متابعة الإعداد
والاستعداد، بحمله بني قريظة على نقض العهد، وذلك على أمل
أن
يجد الوسيلة لتجاوز عقدة الخندق، للتوصل إلى المواجهة الحاسمة التي كان
يأمل.
فكان من
الطبيعي:
أن
نجد جيش الأحزاب يتظاهر بالأنفة
والشموخ والعنجهية، والاستعلاء والفرح.
قال
ابن شهرآشوب:
«كان الكفار على الخمر، والغناء، والمدد، والشوكة»([1]).
وكيف لا يكونون كذلك، وهم يرون أنفسهم في موقع من يحاصر
أعداءه،
ويضيق عليهم الخناق. ويتسبب لهم بالمزيد من الألم
والأذى
والخوف والرعب، مع ما يعانون من جوع وحاجة، وشدة.
وإن
كان فيما بعد ـ وبعد قتل علي لطليعة فرسانهم ـ انقلب السحر على الساحر
كما سنرى.
وما يهمنا هنا هو بيان حالة المسلمين في مواجهة الأحزاب
فنقول:
قد تحدث القرآن عن حالة المسلمين
بصورة عامة في يوم الأحزاب، وتحدث عن حالات المنافقين ومواقفهم
وأساليبهم في هذه المناسبة،
وذكر أيضاً حالة أهل الإيمان والإخلاص،
وميَّزهم
عن غيرهم.
ونحن نذكر هنا:
الآيات التي تعرضت للفرقاء الثلاثة فنقول:
لقد كان ثمة حالة من الخوف والرعب تهيمن على الأجواء
العامة للمسلمين، الذين لم يستحكم الإيمان في نفوسهم وقلوبهم حتى زاغت
الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر،
قال تعالى:
﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن
تَدْخُلُواْ الجَنَّةَ وَلمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الذِينَ خَلوْاْ مِن
قَبْلكُم مَّسَّتْهُمُ البَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلزِلُواْ حَتَّى
يَقُول الرَّسُولُ وَالذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ الله أَلا
إِنَّ نَصْرَ الله قَرِيبٌ﴾([2]).
حيث يذكر المفسرون:
أن هذه الآية
قد نزلت يوم الأحزاب وقيل: نزلت في أحد([3]).
وقد زاد هذا الخوف والرعب باستمرار الحصار، وظهور بعض
المناوشات. وقد أشار الله سبحانه إلى ذلك، فقال:
﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا
اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَليْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ
فَأَرْسَلنَا عَليْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً﴾.
وقال تعالى:
﴿إِذْ جَاؤُوكُم مِن فَوْقِكُمْ
وَمِنْ أَسْفَل مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الأَبْصَارُ وَبَلغَتِ
القُلُوبُ الحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا، هُنَالكَ
ابْتُليَ المُؤْمِنُونَ وَزُلزِلُوا زِلزَالاً شَدِيداً﴾([4]).
أما عن خصوص الثلة المؤمنة الصابرة المجاهدة، فإنهم
كانوا مطمئنين إلى نصر الله تعالى لهم على أعدائهم. دون أدنى شك أو
ريبة منهم، فقد قال تعالى:
﴿وَلمَّا رَأَى المُؤْمِنُونَ
الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ
اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلا إِيمَاناً وَتَسْليماً، مِنَ
المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَليْهِ فَمِنْهُم
مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا
تَبْدِيلاً، ليَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ
المُنَافِقِينَ إِن شَاء أَوْ يَتُوبَ عَليْهِمْ إِنَّ اللهَ كَانَ
غَفُوراً رَّحِيماً﴾([5]).
أما المنافقون:
فإنهم
ما زالوا منذ البداية يشككون في قدرة المسلمين على المواجهة، وقد تقدم
أنهم
حين حفر الخندق
أظهروا
نفاقهم الذي رافق جميع مراحل المواجهة وقد حكى الله تعالى ذلك عنهم،
فقال:
﴿وَإِذْ يَقُولُ المُنَافِقُونَ وَالذِينَ فِي
قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلا غُرُوراً،
وَإِذْ قَالت طَائِفَةٌ مِنهُمْ يَا أَهْل يَثْرِبَ لا مُقَامَ لكُمْ
فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ
إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلا
فِرَاراً، وَلوْ دُخِلتْ عَليْهِم مِن أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا
الفِتْنَةَ لآتَوْهَا وَمَا تَلبَّثُوا بِهَا إِلا يَسِيراً، وَلقَدْ
كَانُوا عَاهَدُوا اللهَ مِن قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الأَدْبَارَ وَكَانَ
عَهْدُ اللهِ مَسْؤُولاً
قُل لن يَنفَعَكُمُ الفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِن
المَوْتِ أَوِ القَتْل وَإِذاً لا تُمَتَّعُونَ إِلا قَليلاً
قُل مَن ذَا الذِي يَعْصِمُكُم مِن اللهِ إِنْ أَرَادَ
بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لهُم مِن
دُونِ اللهِ وَليّاً وَلا نَصِيراً
قَدْ يَعْلمُ اللهُ المُعَوِّقِينَ مِنكُمْ
وَالقَائِلينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِليْنَا وَلا يَأْتُونَ
البَأْسَ إِلا قَليلاً، أَشِحَّةً عَليْكُمْ فَإِذَا جَاء الخَوْفُ
رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِليْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالذِي يُغْشَى
عَليْهِ مِنَ المَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الخَوْفُ سَلقُوكُم بِأَلسِنَةٍ
حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلى الخَيْرِ أُوْلئِكَ لمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ
اللهُ أَعْمَالهُمْ وَكَانَ ذَلكَ عَلى اللهِ يَسِيراً
يَحْسَبُونَ الأَحْزَابَ لمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ
الأَحْزَابُ يَوَدُّوا لوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الأَعْرَابِ
يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ وَلوْ كَانُوا فِيكُم مَا قَاتَلُوا
إِلا قَليلاً﴾([6]).
قد ظهر من الآيات الشريفة:
أن
ما كان يثيره المنافقون من شائعات، وما كانوا يتخذونه من مواقف، قد
أثَّر
على الحالة العامة، وأسهم
في
إثارة
مشاعر الخوف التي كانت متحفزة، بسبب ما يرونه من حشود هائلة، وبسبب
الحصار الذي يعانون منه وترافق مع الحاجة الملحة، الأمر الذي بث روح الإنهزام،
والتخاذل والتردد فيما بين ضعفاء النفوس، وقليلي التدبر.
وقد حملت لنا النصوص التاريخية بعض التفاصيل، التي يحسن
الوقوف عندها، إلى جوانب
أخرى يحسن الإلمام
بها والإطلاق
عليها، والإستفادة
منها.
ونحن نذكر هنا:
بعضاً من ذلك ولا نصرف النظر عن جميع ما لدينا من
ملاحظات وتحفظات، بل نذكر بعضاً من ذلك، حسبما يقتضيه المقام، فنقول:
عن جابر بن عبد الله، قال: كان خوفنا على الذراري
بالمدينة من بني قريظة أشد من خوفنا من قريش، حتى فرَّج
الله ذلك([7]).
وعن أم سلمة، أنها قالت:
إنها
شهدت مع النبي «صلى الله عليه وآله» مشاهد فيها قتال وخوف: المريسيع،
وخيبر، والحديبية، والفتح، وحنين، ولم يكن من ذلك أتعب لرسول الله «صلى
الله عليه وآله» ولا أخوف عندنا من الخندق،
وذلك
أن
المسلمين كانوا في مثل الحرجة، وأن
قريظة لا نأمنها على الذراري الخ..([8]).
«وكانوا
يبيتون بالخندق خائفين، فإذا أصبحوا أمنوا»([9]).
«واشتد البلاء والحصر على المسلمين، وشغلتهم
أنفسهم،
فلا يستريحون ليلاً، ولا نهاراً»([10]).
وقال ابن شهرآشوب:
«وكان الكفار على الخمر، والغناء، والمدد، والشوكة،
والمسلمون كأن على رؤوسهم الطير لمكان عمرو.
والنبي «صلى الله عليه وآله» جاث على ركبتيه، باسط
يديه، باك عيناه، ينادي بأشجى صوت:
«يا صريخ
المكروبين، يا مجيب دعوة المضطرين، اكشف همي، وكربي، فقد ترى حالي»([11]).
ويقولون:
لما صح عند رسول الله «صلى الله عليه وآله» نقض بني
قريظة للعهد ضاق ذرعاً،
وخَشِيَ
أن
يفت ذلك في
أعضاد
المسلمين، فعظم البلاء، واشتد الخوف، وأتاهم
عدوهم من فوقهم، ومن
أسفل
منهم، حتى ظن المؤمنون
كل ظن، ونجم النفاق، وكثر الخوض.
وأقام
رسول الله «صلى الله عليه وآله» وأصحابه فيما وصف من الخوف والشدة
لتظاهر الأعداء عليهم، وإتيانهم
من فوقهم ومن
أسفل
منهم حتى كان ما كان من كيد نعيم بن مسعود الخ..([12]).
وستأتي قصة نعيم، وما فيها من هنات وإشكال.
قال ابن الجوزي:
«قال علماء السِيَر:
كان اشتد الخوف يوم الخندق، وفشل الناس، وخيف على الذراري والأموال»([13]).
وفي نص آخر:
«ولما فشا نقض بني قريظة، واشتد الخوف، وعظم عند ذلك
البلاء، فبينما هم على ذلك إذ جاءتهم جنود ـ يعني الأحزاب ـ وهم قريش
وغطفان، ويهود بني قريظة..
إلى أن قال:
فجاء بنو
أسد،
وغطفان، وفزارة، واليهود من فوقهم، من جهة المدينة، وقائدهم حارث بن
عوف، وعيينة بن حصن،
وجاء قريش وكنانة من جانب أسفل الوادي، وقائدهم أبو سفيان بن حرب»([14]).
وقال ابن عباس:
«كان الذين
جاؤوهم من فوقهم بنو قريظة، ومن أسفل منهم قريش وغطفان، كذا في الوفاء.
ومن هيبة كثرتهم، وشدة شوكتهم رعبت قلوب ضعفاء أهل الإسلام، وزاغت
أبصارهم»([15]).
وقال القيرواني:
«جاءت قريش من ها هنا، واليهود من ها هنا والمجد من ها
هنا،
يريد هوازن»([16]).
ومعنى ذلك هو:
أن
المسلمين كانوا محاصرين من جهات ثلاث
ويقول الطبرسي:
«من فوقكم: من فوق الوادي، من قبل المشرق: قريظة والنضير، وغطفان ومن
أسفل منكم: أي من قبل المغرب، من ناحية مكة: أبو سفيان في قريش ومن
تبعه»([17]).
وقال القمي:
«لما طال على أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»
الأمر واشتد عليهم الحصار،
وكانوا في وقت برد شديد، وأصابتهم
مجاعة وخافوا من اليهود خوفاً
شديداً،
وتكلم المنافقون بما حكى الله عنهم ولم يبق
أحد
من أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلا نافق،
إلا القليل.
وقد كان رسول الله «صلى الله عليه
وآله» أخبر أصحابه:
أن العرب تتحزب ويجيئون من فوق. وتغدر اليهود ونخافهم
من
أسفل،
وإنه ليصيبهم جهد شديد، ولكن تكون العاقبة عليهم.
فلما جاءت قريش، وغدرت اليهود قال المنافقون:
﴿مَا وَعَدَنَا اللهُ
وَرَسُولُهُ إِلا غُرُوراً﴾([18]).
وكان قوم لهم دور في أطراف المدينة،
فقالوا:
يا رسول الله تأذن لنا
أن
نرجع إلى دورنا، فإنها في
أطراف
المدينة، وهي عورة ونخاف اليهود
أن
يغيروا عليها.
وقال قوم:
«هلموا فلنهرب، ونصير في البادية، ونستجير بالأعراب، فإن
الذي كان يعدنا محمد كان باطلاً
كله»([19]).
وقال البيهقي:
إنه
بعد حصار دام قريباً من عشرين ليلة، وبعد حصول قتال دام إلى الليل، شغل
المسلمين عن صلاة العصر: «فلما اشتد البلاء على النبي «صلى الله عليه
وآله» وأصحابه نافق ناس كثير، وتكلموا بكلام قبيح فلما رأى رسول الله
ما فيه الناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول: والذي نفسي بيده
ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة وإني
لأرجو
أن أطوف بالبيت العتيق
آمناً،
وأن
يدفع الله عز وجل
إليَّ
مفاتيح الكعبة، وليهلكن الله كسرى وقيصر، ولتنفقن
كنوزهما في سبيل الله عز وجل.
وقال رجل ممن معه لأصحابه:
ألا
تعجبون من محمد!! يعدنا أن نطوف بالبيت العتيق، وأن
نقسم كنوز فارس والروم، ونحن ها هنا لا يأمن
أحدنا
أن
يذهب إلى الغائط، والله ما يعدنا إلا غروراً.
وقال آخرون ممن معه:
ائذن لنا، فإن
بيوتنا عورة.
وقال آخرون:
«يا أهل يثرب،
لا مقام لكم فارجعوا»([20]).
ويقول نص آخر:
«ونجم النفاق من بعض المنافقين،
وقال معتب بن قشير: كان محمد يعدنا
أن
نأخذ كنوز كسرى وقيصر، وأن
أموالهما تنفق في سبيل الله، واحدنا اليوم لا يأمن على نفسه
أن
يذهب إلى الغائط:
﴿مَّا وَعَدَنَا اللهُ
وَرَسُولُهُ إِلا غُرُوراً﴾([21]).
وقال رجال ممن معه:
«يا أهل يثرب
لا مقام لكم فارجعوا»([22]).
تقدم في النصوص التي أوردناها:
أن هناك من قال: بيوتنا عورة، من
أجل
الحصول على إذن من النبي «صلى الله عليه وآله» لهم بترك مواقعهم
والرجوع إلى بيوتهم، فمن هم هؤلاء الذين قالوا ذلك ياترى؟
إن بعض النصوص التاريخية تقول:
هم:
«عبد الله بن
أبي
وأصحابه.
وقيل:
هم بنو سالم من المنافقين.
وقيل:
إن القائل
لذلك أوس بن قبطي ومن وافقه على رأيه، عن يزيد بن رومان»([23]).
وقال ابن الكلبي:
إن أبا مليل، سليك بن الأزعر
ـ شهد بدراً ـ هو الذي قال يوم الخندق بيوتنا عورة([24]).
وقال الدياربكري:
«وكان جماعة من المنافقين مثل أوس بن القيظي، ومتابعيه
ينفرون جيش الإسلام، ويقولون: ارجعوا إلى منازلكم، واعتلوا بأن
منازلكم عورة، خالية عن المحافظة، فإنها خارج المدينة، ونحن نخاف
أن
يظفر بها جيش العدو»([25]).
ويقول نص آخر:
«عظم الأمر، وأحيط بالمسلمين من كل جهة وهمَّ
بالفشل بنو حارثة، وبنو سلمة، معتذرين بأن
بيوتهم عورة خارج المدينة، ثم ثبتهم الله»([26]).
لكن البعض قال:
إن المستأذنين هم بعض بني حارثة لا كلهم،
فراجع([27]).
ويروي لنا الواقدي هذه القضية بنحو أكثر تفصيلاً،
فيقول:
إن بني حارثة بعثوا بأوس بن قيظي إلى النبي «صلى الله
عليه وآله»،
يقولون: إن بيوتنا عورة، وليس دار من دور الأنصار مثل
دارنا،
ليس بيننا وبين غطفان
أحد
يرد عنا، فأذن
لنا فلنرجع إلى دورنا فنمنع ذرارينا ونساءنا.
فأذن
لهم «صلى الله عليه وآله» ففرحوا بذلك، وتهيأوا للانصراف.
فبلغ سعد بن معاذ ذلك، فقال:
يا رسول الله، لا تأذن لهم، إنَّا
والله، ما
أصابنا
وإياهم
شدة قط إلا صنعوا هكذا، فردهم([28]).
قال دحلان:
«فجعل المنافقون يستأذنون، ويقولون: بيوتنا عورة، أي من
العدو، لأنها خارج المدينة، وحيطانها قصيرة، يخشى عليها السرقة، فأذن
لنا نرجع إلى نسائنا، وأبنائنا،
وذرارينا؛
فيأذن
«صلى الله عليه وآله» لهم.
قيل:
ولم يبقَ
معه تلك الليلة إلا ثلاث مئة»([29]).
وعن حذيفة:
«أن
الناس تفرقوا عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ليلة الأحزاب، فلم يبقَ
معه إلا اثنا عشر رجلاً»([30]).
وقال القاضي النعمان:
«وتسلل عن
رسول الله صلوات الله عليه وآله أكثر أهل المدينة، فدخلوا بيوتهم
كالملقين بأيديهم»([31]).
وتقدم قول القمي:
«ولم يبقَ
أحد من أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلا نافق إلا القليل».
وهذا يؤيد ما سيأتي:
من
أن
سبب النصر هو بطولات علي «عليه السلام»، وما جرى على المشركين من
مكابدة ما تثيره الرياح والأعاصير
من متاعب لهم، وما تزرعه من خوف ورعب في قلوبهم،
بعد أن آتت النشاطات النبوية لزرع الشكوك فيما بينهم ثمارها، كما سنرى.
وقبل أن نمضي في الحديث عن سائر الوقائع نتوقف قليلاً
للإشارة إلى الأمور التالية:
ذكرت بعض الروايات المتقدمة:
الحارث بن عوف في المشاركين في حصار المدينة، وقد تقدم:
أن
قومه ينكرون حضوره حرب الأحزاب، فراجع الفصل الأول من هذا الباب.
وقد ذكرت بعض النصوص المتقدمة:
أن
الليل كان بالنسبة لكثير من المسلمين بمثابة كابوس مخيف لما يتوقعونه
من مفاجئات لم يحسبوا لها حساباً،
ونحن وإن كنا نصدق أن لليل رهبته، ولكن وجود الرسول «صلى الله عليه
وآله» فيما بينهم، وهو الذي لم يزل يطمئنهم إلى نصر الله وعونه، كان
ينبغي أن يطمئنهم، ويذهب حالة الخوف والرعب من نفوسهم لو كانوا راسخي
القدم في الإيمان، والتسليم لله ولرسوله.
وقد تحدثت بعض كلمات المؤرخين:
عن خوف النبي «صلى الله عليه وآله» في حرب الأحزاب.
ونحن لا نشك:
في عدم صحة هذه النصوص، ولا أقل من أنها لم تتحر الدقة
في نقل الوقائع والأحداث،
فإن الرسول «صلى الله عليه وآله»
كان يبشر المؤمنين بنصر الله وعونه، ابتداء من حفر الخندق، ثم حين نقض
بني قريظة لعهدهم، وفي غير ذلك من مناسبات.
فلم يكن هو ليعاني من حالة الرعب والخوف، وهو الذي كان
مصدر السكينة والأمن
والطمأنينة للناس.
بل إننا إذا كنا نرى
أن
القرآن يتحدث عن المؤمنين بأنهم
كانوا على درجة من التسليم والتصديق بوعد الله، وما زادهم مجيء
الأحزاب، ورؤيتهم لهم إلا
إيماناً
وتسليماً؛
فإن النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» لن يكون أقل
إيماناً
منهم.
والذي نراه:
هو
أن
النبي «صلى الله عليه وآله» قد تعب كثيراً
في
إنجاز
المهام حين صار أصحابه يتركونه، حتى بقي في قلة قليلة منهم.
بل
إن
بعضهم حتى طلحة وعمر قد تركوه، واختبأوا في حديقة هناك، وقد كشفت عائشة
أمرهم،
وأحرجتهم
بصورة ظاهرة كما ذكرناه في موضعه فيمكن
أن
يكون بعض المؤرخين خلط بين التعب والمعاناة للنبي «صلى الله عليه وآله»
وبين الخوف، فنسب إليه الخوف، مع
أن
الصحيح هو نسبة التعب كما قالته أم سلمة وغيرها فليلاحظ ذلك.
إتهام
أحد البدريين بالنفاق:
وقد ذكرت النصوص المتقدمة:
أن
متعب بن قشير هو الذي قال: كان محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر الخ..
مع أن ابن هشام يقول: قيل:
لم يكن متعب
من المنافقين، وقد شهد بدراً([32]).
وقال العسقلاني:
«ذكروه في من شهد العقبة. وقيل: إنه كان منافقاً،
وأنه
الذي قال يوم
أحد:
﴿لوْ كَانَ لنَا مِنَ الأَمْرِ
شَيْءٌ مَا قُتِلنَا هَا هُنَا﴾([33]).
وقال:
إنه
تاب،
وقد ذكره ابن إسحاق في من شهد بدراً»([34]).
وقال أبو عمر:
«شهد بدراً وأحداً، وكان قد شهد العقبة.
ويقال:
إنه
الذي قال:
﴿لوْ كَانَ لنَا مِنَ الأَمْرِ
شَيْءٌ مَا قُتِلنَا هَا هُنَا﴾»([35]).
ولا نريد تتبع سائر المصادر التي
أشارت
إلى بدرية متعب بن قشير.
فكيف نـوفـق
بين وصـف
القرآن لـه
بالنفـاق،
وبين بدريته، التي توجـب
ـ حسبما يزعم هؤلاء ـ
أن
يغفر له كل ذنب، ويطهر من كل رجس، وقد تحدثنا عن هذا الأمر في غزوة بدر
فراجع.
قال محمد حسين هيكل:
«لأهل يثرب أبلغ العذر إن كان بلغ منهم الفزع وزلزلت
قلوبهم، ولمن قال منهم العذر في أن يقول: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز
كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه
أن
يذهب إلى الغائط، وللذين بلغت قلوبهم الحناجر العذر في أن تبلغها. أليس
هو الموت الذي يرون آتياً
تقدح بالشرر عينه، مصورة في بريق هذه السيوف تلمع في أيدي قريش، وفي
أيدي غطفان،
وتدب إلى القلب مخافته، متسللة من منازل قريظة الغدرة
الخائنين»؟([36]).
ونقول:
لقد اشتبه هيكل في تصوره وفي تصويره أيما اشتباه، وذلك
لأمور:
الأول:
أن
الله سبحانه قد حكى طائفة مما ذكر آنفاً عن المنافقين، والذين في
قلوبهم مرض، فقال:
﴿وَإِذْ يَقُولُ المُنَافِقُونَ
وَالذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ
إِلا غُرُوراً، وَإِذْ قَالت طَّائِفَةٌ مِنهُمْ يَا أَهْل يَثْرِبَ لا
مُقَامَ لكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنهُمُ النَّبِيَّ
يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن
يُرِيدُونَ إِلا فِرَاراً﴾([37]).
فهل كان المنافقون والذين في قلوبهم مرض على حق في
قولهم هذا؟!
وقد صرح المؤرخون ـ حسبما تقدم
وسيأتي أيضاً ـ :
بأن
المنافقين هم الذين قالوا: يعدنا محمد كنوز كسرى الخ..
الثاني:
إن
هذه الأقوال ـ كما تقدم ـ إنما صدرت بادئ الأمر من المنافقين قبل مجيء
الأحزاب، وقبل نقض بني قريظة للعهد، إذ قد صرحت الروايات بأنهم قد
قالوا ذلك حين حفر الخندق، توقعاً
لمجيء
قريش والأحزاب، ثم قالوا بعد اشتداد الحصار.
فلو سلمنا لهيكل قوله ذاك، نقول له:
ما هو المبرر لرعبهم قبل مجيء الأحزاب ولم يكن ثمة ما
يوجب الخوف إلى هذه الدرجة؟
الثالث:
إننا لا نوافق أن من حقهم أن يقولوا ذلك، حتى لو كان
القائلون هم المؤمنون، وذلك لأنهم قد رأوا من الآيات والخوارق
والكرامات للنبي «صلى الله عليه وآله» وهم يحفرون الخندق الشيء الكثير.
فكان من المفروض فيهم أن يتيقنوا بنصر الله سبحانه لهم، وبصدق ما أخبر
به نبيهم الأكرم «صلى الله عليه وآله».
ولكن لم تكن تلك الكرامات تقتصر على مجرد التصور العقلي
لهم. بل كانت تتعدى ذلك لتكون ممارسة حسية لكل فرد منهم، كما كان الحال
بالنسبة لإطعام
أهل الخندق جميعاً من وليمة جابر.
الرابع:
إن
مراجعة الآيات القرآنية تعطينا: أن الذين زاغت
أبصارهم
وبلغت قلوبهم حناجرهم، وظنوا بالله الظنون هم غير المؤمنين الذين كانوا
ثابتين في حصون الإيمان. لكن هؤلاء المؤمنين قد تأثروا من حالة
إخوانهم، فوقعوا في البلاء والزلزال، فقد قال تعالى مخاطباً
المسلمين:
﴿إِذْ جَاؤُوكُم مِن فَوْقِكُمْ
وَمِنْ أَسْفَل مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الأَبْصَارُ وَبَلغَتِ
القُلُوبُ الحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا، هُنَالكَ
ابْتُليَ المُؤْمِنُونَ وَزُلزِلُوا زِلزَالاً شَدِيداً﴾([38]).
فترى أنه تعالى قد تحدث عن المؤمنين بطريقة الحديث عن
الغائبين، مع
أنه
لو كان المراد جميع المسلمين لكان السياق يقتضي أن يقول: «هنالك
ابتليتم وزلزلتم».
أضف إلى ما تقدم:
أنه لو كان الأمر كذلك لم يقل: «هنالك ابتلي» بل كان
عليه
أن
يقول: وابتليتم. فكلمة «هنالك» تشير إلى أن الابتلاء للمؤمنين قد حصل
حينما ظننتم بالله الظنون، وبلغت قلوبكم حناجركم.
على أن من الواضح:
أن ظن الظنون بالله لا ينسجم مع الإيمان بل هو ينافيه.
وقد تحدث تعالى عن المؤمنين فذكر
أنهم
لم يظنوا الظنون هنا، بل زاد
إيمانهم
عمقاً
ورسوخاً.
فقال تعالى:
﴿وَلمَّا رَأَى المُؤْمِنُونَ
الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ
اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلا إِيمَاناً وَتَسْليماً، مِنَ
المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَليْهِ فَمِنْهُم
مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا
تَبْدِيلاً﴾([39]).
بقي أن نشير هنا:
إلى أن المراد بابتلاء المؤمنين هو أن مسؤولياتهم أصبحت
أكبر وأخطر من ذي قبل، وأصبحت كل المصائب والآلام
الناتجة عن هذا الحصار، من انهزام المسلمين روحياً،
والخوف على الذراري والنساء، وما صاحب ذلك من تحمل مشقات وجهد وسهر ـ
إن
ذلك كله ـ قد انصب على رؤوس ثلة قليلة مجاهدة صابرة، قد لا يتجاوز
عددها عدد
أصابع
اليدين أو حتى اليد الواحدة.
إذ إن من الغني عن البيان:
أن
تحقيق وعد الله ورسوله لهم بالنصر، لا يعني أن لا يتحملوا المشقات
والمصاعب والآلام
الكبيرة وأن
لا يبتليهم بالمواجهات الخطيرة، التي تصل إلى درجة الاستشهاد بالنسبة
إلى بعض الأفراد، لأن الوعد إنما هو للمجموع العام ولأهل
هذه الدعوة بصفتهم العامة، وإن
كان
أفراد
كثيرون يستشهدون، أو يمتحنون بالمصائب والبلايا والرزايا.
([1])
(الشوكة: السلاح) مناقب آل أبي طالب ج1 ص198 وبحار الأنوار ج20
ص272.
([2])
الآية 214 من سورة البقرة.
([3])
بحار الأنوار ج20 ص188 عن مجمع البيان ج2 ص309 وراجع: الدر
المنثور ج1 ص243 عن عبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر، عن
قتادة، وابن أبي حاتم، عن السدي.
([4])
الآيات 9 ـ 11 من سورة الأحزاب.
([5])
الآيات 22 ـ 24 من سورة الأحزاب.
([6])
الآيات 12 ـ 20 من سورة الأحزاب.
([8])
إمتاع الأسماع ج1 ص231 والمغازي للواقدي ج2 ص467 وتاريخ الخميس
ج1 ص485.
([9])
إمتاع الأسماع ج1 ص228.
([10])
دلائل النبوة للبيهقي ج3 ص406.
([11])
مناقب آل أبي طالب ج1 ص198 وراجع ج3 ص134 وبحار الأنوار ج20
ص272 وراجع ج14 ص88.
([12])
تجارب الأمم ج1 ص150 وأشار
إلى ذلك في المصادر التالية: تاريخ ابن الوردي ج1 ص161
والمواهب اللدنية ج1 ص112 و 113 والسيرة الحلبية ج2 ص318 وسبل
الهدى والرشاد ج4 ص528 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص214 و
201 والإكتفاء للكلاعي ج2 ص164 و 165 والكامل في التاريخ ج2
ص180 والبداية والنهاية ج4 ص104 و 111 ومجمع البيان ج8 ص342
وبحار الأنوار ج20 ص202 والمغازي للواقدي ج2 ص459 وتاريخ
الخميس ج1 ص484 والمختصر في أخبار البشر ج1 ص135 وعيون الأثر
ج2 ص60 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص233 وتهذيب سيرة ابن
هشام ص192 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص5 وبهجة المحافل ج1 ص264
وإمتاع الأسماع ج1 ص227 و 228 و 281.
([13])
الوفا ص693 وراجع: سبل الهدى والرشاد ج4 ص528 ونهاية الأرب ج17
ص171.
([14])
العبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق 2 ص30 وراجع: السيرة النبوية
لدحلان ج2 ص5 والسيرة الحلبية ج2 ص317 و 318.
([15])
تاريخ الخميس ج1 ص484 وراجع: السيرة النبوية لدحلان ج2 ص5.
([17])
مجمع البيان ج8 ص339 وبحار الأنوار ج20 ص192 عنه.
([18])
الآية 12 من سورة الأحزاب.
([19])
تفسير القمي ج2 ص186 وبحار الأنوار ج20 ص229 و 230.
([20])
دلائل النبوة للبيهقي ج3 ص402 وراجع: المغازي للواقدي ج2 ص460
والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص5.
([21])
الآية 12 من سورة الأحزاب.
([22])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص528 وراجع المصادر التالية: حدائق
الأنوار ج2 ص587 ووفاء الوفاء ج1 ص303 والسيرة النبوية لابن
كثير ج3 ص201 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص238 وتاريخ
الأمم والملوك ج2 ص238 والبداية والنهاية ج4 ص104 والسيرة
النبوية لابن هشام ج3 ص233 وإمتاع الأسماع ج1 ص288 وعيون الأثر
ج2 ص60 والمختصر في أخبار البشر ج1 ص135 والسيرة الحلبية ج2
ص318 وفتح البـاري ج7 ص307 وتـاريخ = = اليعقوبي ج2 ص51
ومجمع البيان ج8 ص347 وتهذيب سيرة ابن هشام ص192 والسيرة
النبوية لدحلان ج2 ص5 والإكتفاء للكلاعي ج2 ص164 و 165
والمغازي للواقدي ج2 ص459 و 450 وبحار الأنوار ج20 ص193 وتاريخ
الخميس ج1 ص484 وراجع: سعد السعود ص138.
([23])
مجمع البيان ج3 ص347 والبحار ج20 ص193 عنه وراجع: نهاية الأرب
ج7 ص181.
([24])
راجع: إمتاع الأسماع ج1 ص229.
([25])
تاريخ الخميس ج1 ص484 وراجع: المواهب اللدنية ج1 ص133 والسيرة
النبوية لدحلان ج2 ص5.
([26])
العبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق 2 ص30 وراجع المصادر
التالية: السيرة النبوية لدحلان ج2 ص5 وإمتاع الأسماع ج1 ص227
و 228 وزاد المعاد ج2 ص118 ومجمع البيان ج2 ص347 وبحار الأنوار
ج20 ص193.
([27])
راجع: جوامع السيرة النبوية ص149.
([28])
المغازي للواقدي ج2 ص463 وراجع المصادر التالية: سبل الهدى
والرشاد ج4 ص529 وراجـع: إمتـاع الأسـماع ج1 ص229 وتـاريـخ
الأمم والملوك ج2 = = ص238 والبداية والنهاية ج4 ص104 وليس فيه
موقف ابن معاذ: وراجع المصادر التالية: وإن لم تشر لموقف ابن
معاذ: عيون الأثر ج2 ص60 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص233
وتهذيب سيرة ابن هشام ص192 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص201
ودلائل النبوة للبيهقي ج3 ص435 و 436.
([29])
السيرة النبوية لدحلان ج2 ص10 وستأتي بقية المصادر في الفصل
الأخير من هذا الباب تحت عنوان: مهمة حذيفة بن اليمان.
([30])
دلائل النبوة للبيهقي ج3 ص450 و 451 وراجع: تاريخ الإسلام
للذهبي (المغازي) ص249 و 250 ومستدرك الحاكم ج3 ص31.
([31])
شرح الأخبار ج1 ص294.
([32])
عيون الأثر ج2 ص60.
([33])
الآية 154 من سورة آل عمران.
([35])
الإستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج3 ص462.
([36])
حياة محمد (الطبعة الثانية سنة 1354 ه. ق دار الكتب المصرية)
ص325.
([37])
الآيتان 12 و 13 من سورة الأحزاب.
([38])
الآيتان 10 و 11 من سورة الأحزاب.
([39])
الآيتان 22 و 23 من سورة الأحزاب.
|