|
الـحـصــار والـقــتــــــال
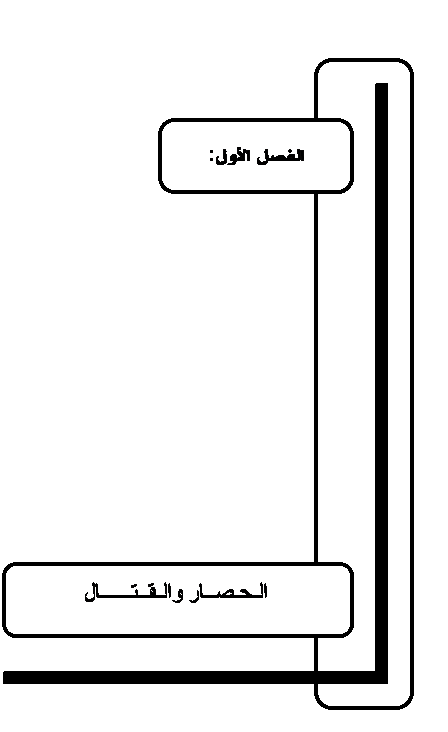
بداية الحديث:
من الواضح:
أن
وجود الخندق قد أفشل خطة الأحزاب، وشل حركتهم، ولكنهم لم يفقدوا الأمل،
فقد كان الأمل لا يزال يراودهم بإمكانية
أن
يجدوا فرصة، ويحدثوا ثغرة تمكنهم من توجيه ضربة قاسية للوجود الإسلامي،
ولو بالتعاون مع يهود بني قريظة، الذين يتواجدون في مؤخرة الجيش
الإسلامي، مع علم المشركين بالحالة الصعبة التي كان يعاني منها
المسلمون خصوصاً من حيث التموين ووسائل الدفاع والصمود، مع وجود
المنافقين الذين يمكن التعاون مع بعضهم أيضاً لإحداث
إرباكات خطيرة داخل الجيش الإسلامي.
وقد تحدثنا في الفصل السابق عن معنويات كلا الجيشين
بالإضافة إلى موضوعات أخرى، ونتحدث الآن عن الحصار، وعن بعض الأحداث
التي حصلت فيه، فنقول، وعلى الله نتوكل، ومنه نستمد العون والقوة:
قد تقدم:
أن
المشركين
أحاطوا
بالمسلمين حتى جعلوهم في مثل الحصن من كتائبه،
وأخذوا
بكل ناحية([1]).
وقد استمر هذا الحصار مدة طويلة. اختلف فيها المؤرخون وهل كانت خمسة
عشر يوماً([2])
أو عشرين
يوماً([3]).
أو أكثر من
عشرين يوماً([4]).
أو شهراً([5]).
أو قريباً من
شهر([6]).
أو تسعة
وعشرين ليلة([7]).
وقيل:
سبعة وعشرين([8]).
ولعل أحدهما:
(السبعة، والتسعة) تصحيف للآخر،
فلا يخالفه.
وبعض آخر يقول:
أربعة وعشرين
يوماً([9]).
ونذكر أخيراً قول من قال:
بضع عشرة ليلة
أو يوماً([10]).
ونقول:
الصحيح هو:
أن
الحصار قد دام شهراً كاملاً
بل أكثر، فقد قال ضرار بن الخطاب يوم الخندق في جملة
أبيات
له:
فـأحـجرنـاهـم([11])
شـهراً كـريـتـاً([12]) وكـنــا
فـوقـهـم كـالـقـاهـريـنا
نـراوحـهـم ونــغــدو كـل يــوم عـلـيـهم في السـلاح مـدججينا([13])
بل لقد ذكر
عبد الله بن الزبعرى:
أن
مدة الحصار قد دامت أكثر من شهر، وبلغت أربعين يوماً،
فهو يقول:
حتى إذا وردوا المـديـنـة
وارتـدوا لـلـمـوت كــل مجـرب قـضـاب
شـهـراً وعشـراً قـاهـريـن محمداً وصحابه في الحرب خير
صحاب([14])
إذن، فلا يمكن قبول قولهم:
إن
الحصار دام مدة خمسة عشر يوماً،
أو عشرين أو بضع عشرة
ليلة، أو ما إلى ذلك.
وقد كانت الحراسة المستمرة واليقظة الدائمة من الأمور
الضرورية،
وكان المسلمون يقومون بها باستمرار،
وكانت حراستهم تتركز على الأمور الرئيسية بالدرجة الأولى، وهي:
1 ـ
مركز القيادة:
النبي «صلى الله عليه وآله».
2 ـ
العسكر.
3 ـ
الخندق.
4 ـ
المدينة.
5 ـ
الرصد لتحركات العدو.
6 ـ
النساء والذراري وتعاهدهم في الآطام.
7 ـ
أبواب الخندق.
وقد ذكرت هذه الأمور وغيرها من تفاصيل في النصوص
التاريخية، والحديثية، التي نختار منها ما يلي:
ألف:
قال النويري وغيره: «كان رسول الله «صلى الله عليه
وآله» يبعث سلمة بن أسلم في ماءتي رجل، وزيد بن حارثة في ثلاث مئة
يحرسون المدينة ويظهرون التكبير. وذلك
أنه
كان يخاف على الذراري من بني قريظة وكان عباد بن بشر على حرس قبة رسول
الله «صلى الله عليه وآله» مع غيره من الأنصار، يحرسونه كل ليلة»([15]).
وكانت المدينة تحرس حتى الصباح، يسمع فيها التكبير حتى
يصبحوا خوفاً([16]).
ب:
وفي بعض
المصادر: «وجعل المسلمون يتحارسون في عسكرهم»([17])
ج:
وقال النويري: «ورسول الله «صلى الله عليه وآله» والمسلمون وجاه العدو،
لا يزولون، يعتقبون خندقهم ويحرسونه،
والمشركون يتناوبون الخ..»([18]).
ويفصل لنا الواقدي ذلك، فيقول:
إن
المسلمين كانوا «على خندقهم يتناوبون، معهم بضعة وثلاثون فرساً،
والفرسان يطوفون على الخندق ما بين طرفيه، يتعاهدون رجالاً وضعوهم في
مواضع منه إلى
أن
جاء عمر (رض) فقال: يا رسول الله، بلغني
أن
بني قريظة قد نقضت الخ..»([19]).
وتقدم:
أنه
«صلى الله عليه وآله» كان قد جعل للخندق أبواباً، وجعل على الأبواب
حرساً.
وقال الواقدي:
«كانوا يطيفون
بالليل حتى الصباح يتناوبون. وكذلك يفعل المشركون أيضاً، يطيفون
بالخندق حتى يصبحوا»([20]).
«ورسول الله
«صلى الله عليه وآله» والمسلمون قبالة عدوهم، لا يستطيعون الزوال عن
مكانهم، يعتقبون خندقهم يحرسونه»([21]).
وأسيد
بن حضير
كان يحرس في جماعة على الخندق أيضاً([22]).
د:
وتقول عائشة: «كان في الخندق موضع لم يحسنوا ضبطه إذ
أعجلهم الحال،
وكان يخاف عليه عبور الأعداء منه،
وكان النبي «صلى الله عليه وآله» يختلف ويحرسه بنفسه. ثم تذكر قصة
حراسة سعد بن
أبي
وقاص لذلك الموضع في تلك الليلة([23]).
وكان النبي
«صلى الله عليه وآله» بنفسه في الليالي يحرس بعض مواضع الخندق([24]).
وسيأتي حديث أم سلمة في ذلك في موضع آخر إن شاء الله
تعالى.
ه :
وكان عباد بن بشر ـ كما يدَّعون
ـ ألزم الناس لقبة رسول الله «صلى الله عليه وآله» يحرسها([25]).
وذكروا الزبير
بن العوام في جملة من حرس النبي «صلى الله عليه وآله» يوم الخندق([26]).
بل جاء
أن
عباد بن بشر، والزبير بن العوام كانا على حرس رسول الله «صلى الله عليه
وآله»([27]).
وقد ظهر من بعض النصوص المتقدمة:
أن
المسلمين كانوا يتناوبون الحراسة([28])
أو حراسة نبيِّهم([29]).
و:
كان بنو واقف قد جعلوا ذراريهم ونساءهم في أطمهم وكانوا
يتعاهدون
أهليهم
بأنصاف
النهار، فينهاهم النبي «صلى الله عليه وآله» فإذا ألحُّوا
أمرهم «صلى الله عليه وآله» أن يأخذوا السلاح، خوفاً
عليهم من بني قريظة فإنهم على طريقهم»([30]).
وكان كل من
يذهب منهم إنما يسلكون على سلع، حتى يدخلوا المدينة، ثم يذهبون إلى
العالية([31]).
وقال «صلى الله عليه وآله» للنساء
حين جعلهن في أطم بني حارثة:
«إن لم يكن
أحد فالمعن بالسيف»([32]).
ز:
حراسة العسكر ورصد العدو: أما بالنسبة لحراسة العسكر
ورصد تحركات العدو، فإن
القمي يقول: «كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» أمر أصحابه
أن
يحرسوا المدينة بالليل،
وكان
أمير
المؤمنين «عليه السلام» على العسكر كله بالليل
يحرسهم، فإن
تحرك
أحد
من قريش نابذهم،
وكان
أمير
المؤمنين «عليه السلام» يجوز الخندق، ويصير إلى قرب قريش، حيث يراهم،
فلا يزال الليل
كله، قائماً
وحده يصلي، فإذا
أصبح
رجع إلى مركزه.
ومسجد
أمير
المؤمنين «عليه
السلام»
هناك معروف، يأتيه من يعرفه، فيصلى فيه، وهو من مسجد الفتح إلى العقيق
أكثر من غلوة نشابة([33])»([34]).
ونقول:
إن الحذر من العدو، وسد المنافذ في وجهه، وحرمانه من
فرصة تسديد ضربة هنا وضربة هناك، بهدف إرباك صفوف الجيش الإسلامي، أو
إحداث ثغرات خطيرة فيه، وهو الذي كان بأمس الحاجة إلى التماسك والتقوي
ببعضه البعض ـ إن ذاك ـ هو أولى مهمات القيادة الحكيمة والواعية، التي
تريد أن تصل إلى أهدافها بأقل قدر ممكن من الخسائر، وأعلى درجة من
الانضباطية والانسجام.
ومن الواضح:
أن
الأساليب
الأمنية
التي كان النبي «صلى الله عليه وآله» ينتهجها كانت ولا تزال كسائر
أفعاله،
وأقواله،
ومواقفه مصدر إلهام لكل المؤمنين والواعين، الذين رأوا في هذا النبي
الكريم
أسوة
وقدوة لهم. في كل الحالات والظروف.
وقد تمثل النشاط الأمني
للمسلمين في غزوة
الأحزاب
ـ بعد
إيجاد
المـوانـع
الطبيعية، التي يصعب على العـدو
اختراقهـا
مثل حفر الخندق،
وتشبيك سائر المنافذ بالبنيان ـ في الأمور التالية:
1 ـ
جعل الحرس على أبواب الخندق، بطريقة يصعب على العدو
إيجاد
مواضع نفوذ فيها، حين جعل الحرس من فئات شتى، ومتنافسة يرقب بعضهم
بعضاً، حيث اختار من كل قبيلة رجلاً لهذه المهمة، كما تقدم بيانه.
2 ـ
إن
من الواضح:
أن
جعل الحرس في نقاط ثابتة ربما يهيئ
للعدو فرصة للتخطيط للنفوذ
إلى
الداخل، بطريقة يتحاشى معها الصدام بنقاط الحراسـة،
أو حتى
إمكانية
التفاتهـا
إلى حقيقة مـا
يجري فكانت الطريقة الأفضل
والأمثل
هي
أن
تنضم إليها دوريات للحراسة غير خاضعة لقيد الـزمـان
ولا المكان. الأمر الذي يضيع على العـدو
الإحساس
بالأمن
والنجاح والفلاح في أية محاولة يبادر إليها، ويقدم عليها. فكان «صلى
الله عليه وآله» يبعث بالحرس على المدينة خوفاً
من بني قريظة، وكانوا
يتجولون فيها، ويظهرون فيها التكبير.
3 ـ
بديهي
أن
التعرض للنساء يمثل ضربة روحية قاسية للمسلمين والمقاتلين، الذي قد يصل
إلى درجة الإحباط
لدى البعض، ويدفع البعض الآخر
إلى التحرك بصورة غير واعية، ولا مسؤولة، الأمر الذي يؤثر على درجة
الانضباط والتماسك. والنبي «صلى الله عليه وآله» يعرف:
أن
العدو لن يتأخر
عن تسديد ضربة في هذا الاتجاه لو سنحت
له الفرصة، ويعتبر ذلك من الأهداف الإستراتيجية
والهامة له. فكان تجميع النساء والأطفال
في الآطام
من شأنه
أن
يسهل أمر حمايتهم من أي اعتداء، مع كونه يهيئ للمسلمين جواً
من الطمأنينة وتمركزاً
في مواضع الاهتمام والتحرك لو دهم أمر.
كـما
أنه
لا بد من الاحتياط لـلأمر،
وعدم الاكتفاء
بالحراسة الثابتة والمتنقلة،
فوضع فيما بينه وبين النساء رمزاً
يمكن الاستفادة منه لإفشال
أية محاولة تستهدفهن وحين يرين
أن
الحالة الأمنية
غير مؤايتة، مع عدم وجود
أحد
يمكن الاعتماد عليه في المواجهة ودفع غائلة العدو.
قال «صلى الله عليه وآله» لهن:
«إن
لم يكن أحد فالمعن بالسيف».
ويلاحظ هنا:
أنه
«صلى الله عليه وآله» قد اعتمد
هذا
الأسلوب،
ولم يطلب منهن الصراخ والاستغاثة ونحوها مما يمثل
إثارة
عاطفية للمقاتلين والمسلمين، وقد
ينشأ
عنها حالة من التضعضع والإرباك
وانشغال الخواطر إلى درجة الإخلال
بالنشاط الحربي المطلوب، في مواجهة
أحزاب
الشرك في الجهة الأخرى.
4 ـ
وغني عن القول أخيراً:
أن
بني واقف كانوا يخطئون في ترددهم إلى
أهليهم
بأنصاف
النهار بلا سلاح، وقد يطمع ذلك العدو فيهم، وقد يفاجئهم العدو وهم على
غير استعداد
فتقع الكارثة.
أضف
إلى ذلك:
أنه
لا بد من الابتعاد عن النساء والأطفال
في أيام الحرب، لأن ذلك يثبط من عزائم المقاتلين ويشدهم إلى الأرض
ويمنعهم من السمو في تفكيرهم وفي طموحاتهم وتصبح التضحيات واقتحام
الأهوال، والصبر على المكاره أكثر صعوبة
عليهم، وأشد
وقعاً
على نفوسهم، ويهيئهم نفسياً
للابتعاد عن مواطن الخطر، أو التعب والضرر، ولو كان ذلك بتوطين
أنفسهم
على مواجهة عار الهزيمة، وخزي عصيان أمر النبي «صلى الله عليه وآله».
5 ـ
ونلمح في النص المتقدم
إصراراً
من بني واقف على زيارة نسائهم وعوائلهم في الأطم
الذي كانوا فيه رغم نهي النبي «صلى الله عليه وآله» لهم وربما يكون أمر
النبي «صلى الله عليه وآله» لهم بحمل السلاح يرمي إلى الإيحاء
غير المباشر لهم بأجواء
الحرب، والاحتفاظ بدرجة من الاستعداد الروحي والنفسي لها، بالإضافة إلى
أن
ذلك هو مقتضى العمل بالحيطة والحذر،
وهما الأمران المطلوبان في ظروف كهذه بصورة
أكيدة
وقاطعة،
ولا
أقل
من
أن
ذلك يفيد في نطاق التعليم والتأسي لكل من يأتي بعده «صلى الله عليه
وآله».
6 ـ
والأهم من ذلك هو حراسة العسكر، الذي كان يتولاه علي
«عليه السلام»، هذا العسكر الذي كان بأمس
الحاجة إلى بعض الشعور بالامن والراحة في هذه الأجواء
المثقلة بالهموم والشدائد، والمشحونة بالخوف الذي يصل لدى الكثيرين إلى
حد الرعب. حتى لقد بلغت القلوب الحناجر، وظنوا بالله الظنون الباطلة
والسيئة.
ولقد كانت
أدنى
حركة في أي موضع في
أطراف
ذلك العسكر كفيلة بإحداث
إرباك
خطير في ذلك العسكر كله.
فكانت هذه الحراسة ضرورية لهذا الجيش، الذي يطمئن إلى
أنه
لن يؤخذ والحال هذه على حين غرة، بل هناك من يبصر له وينذره في الوقت
المناسب.
7 ـ
وكان لا بد من رصد جيش الأعداء أيضاً، لأن حراسة
المعسكر، وإن
كانت تعطي قدرة إلى حد ما على التصدي، إلا
أن
معرفة تحركات العدو، وحجمها، واتجاهها في وقت مبكر يعطي هو الآخر،
فرصة
أكبر
من مواجهته
بالأساليب
وبالمستوى الملائم، ويمنع من العجلة والتشويش في اتخاذ الإجراءات
المؤثرة في دفع غائلة هذا العدو.
وكان علي «عليه السلام»، يقوم بدور الراصد لكل تحركات
الأعداء، وكان هو العين الساهرة في المواقع المتقدمة في خط المواجهة،
التي لم يكن يجرؤ عليها
أحد
سواه، كما ظهر من تجربة المسلمين مع عمرو بن عبد ود.
8 ـ
وبعد، فرغم
أن
الله قد وفق لبقاء المسجد الذي يشهد لجهاد وتضحيـات
علي «عليه السـلام»،
وكـان
هـذا
المسجد معروفـاً،
ويقصده المؤمنون للصلاة فيه، فإننا
لا نكاد نجد لعلي «عليه السلام» ذكراً
في هذا المجال.
ولا ندري
إن
كان هذا المسجد قد استطاع
أن
يصمد طويلاً
أمام
حقد الحاقدين على كل ما يمت لعلي وأهل
بيته «عليهم
السلام»
بصلة، حتى انتهى ميراث هذا التجلي الوقح والغبي إلى من يطلق عليهم اسم:
الوهابيين الذين لا تزال تظهر في كلماتهم وفي
أفعالهم
بوادر
كثيرة تدل على حقد وكراهية وامتهان، ليس فقط لقدسية علي وأهل
البيت «عليهم السلام»، بل وحتى لمقام النبوة
الأقدس بالذات.
وقد أسلفنا بعضاً مما يشير إلى ذلك:
في الجزء الأول من هذا الكتاب،
ولا بأس
بمراجعة الجزء الثالث من كتابنا:
«دراسات
وبحوث في التاريخ والإسلام»،
وبحث: «إدارة
الحرمين الشريفين في القرآن الكريم».
رووا عن عائشة مـا ملخصه:
أنه
كـان
في الخندق موضـع
لم يحسنـوا
ضبطه،
إذ أعجلهم الحال، وكان «صلى الله عليه وآله» يختلف إليه ويحرسه بنفسه،
خوفاً
من عبور المشركين منه.
ورجع مرة من الخندق،
وكانت تدفئه عائشة في حضنها، فإذا دفئ خرج إلى تلك الثلمة.
قالت:
فبينا رسول الله في حضني قد دفئ، وهو يقول: ليت رجلاً
صالحاً
يحرس الليلة هذا الموضع (أو قال: يحرسني،
أو: يحرس هذه الثلمة الليلة)، إذ سمع قعقعة السلاح، فقال: من هذا؟!
قال:
سعد بن أبي وقاص.
فأمره أن يحرس هذا الموضع:
فذهب سعد يحرسه، فنام النبي «صلى الله عليه وآله» حتى
نفخ،
وكان إذا نام نفخ([35]).
ونقول:
إننا نشك في صحة هذه القصة، ونعتقد أن المقصود بها هو
تسجيل فضيلة لسعد، ولعائشة على حد سواء،
وسبب شكنا هو ما يلي:
أولاً:
إذا كان في الخندق موضع لم يحسنوا ضبطه، فلماذا لا
يبادرون إلى ضبطه، وما المبرر لأن يترك ليكون مصدر خـوف
للمسلمين من عبـور
المشركين منه؟!
مع أن سلمان حين رأى مكاناً
يمكن أن تطفره الخيل، قال لأسيد بن حضير، بعد أن ردوا عمرو بن العاص
الذي كان في حوالي مئة رجل يريدون العبور من ذلك الموضع، قال سلمان لأسيد:
«إن هذا مكان من الخندق متقارب، ونحن نخاف تطفره خيلهم، وكـان
الناس عجلوا في حفره،
وبادروا فباتوا يوسعونه، حتى صار كهيئة الخندق،
وأمنوا
أن تطفره خيلهم»([36]).
فلماذا يبادر سلمان للأمر
بإصلاح
ذلك الموضع، فيتم ما أراده في ليلة، ولا يبادر النبي «صلى الله عليه
وآله» إلى مثل ذلك؟!.
ثانياً:
لماذا يتمنى «صلى الله عليه وآله»: «أن يأتي رجل صالح
ليحرس ذلك الموضع في تلك الليلة»؟ ألم يكن بإمكانه أن يأمر جماعته
بحراسة ذلك الموضع؟! والناس كلهم تحت
أمره،
ورهن إشارته؟!.
ثالثاً:
حين كان يرجع إلى عائشة لتدفئه في حضنها!! من الذي كان
يحرس تلك الثلمة؟! فلو أن العدو استطاع أن يتسلل منها في ذلك الوقت ألم
يكن النبي «صلى الله عليه وآله» هو الذي فرَّط
في هذا الأمر،
وتسبب
به؟!.
ولا نريد أن نسجل تحفظنا على دعوى:
أن عائشة كانت تدفئ النبي «صلى الله عليه وآله» في
حضنها!!.
ولا
على حديث:
أنه «صلى الله عليه وآله» نام حتى نفخ،
وكان إذا نام نفخ!!
يقول البعض:
«كان النبي يعقب بين نسائه، فتكون عائشة أياماً،
ثم تكون أم سلمة،
ثم تكون زينب بنت جحش. فكان هؤلاء الثلاث اللاتي يعقب بينهن في الخندق.
وسائر نسائه في أطم بني حارثة، ويقال: كن في «المسير» (النسر) أطم في
بني زريق، وكان حصناً،
ويقال: كان بعضهن في فارع، وكل هذا قد سمعنا»([37]).
ونقول:
إننا نشك في صحة ذلك:
أولاً:
لقد صرحت أم سلمة بقولها: «كنت مع رسول الله «صلى الله
عليه وآله» في الخندق فلم أفارق مقامه كله،
وكان يحرس الخ..»([38]).
ثانياً:
لا يمكننا أن نقبل بـأن
يصدر من النبي «صلى الله عليه وآلـه»
ترجيح وميل لبعض زوجاته على حساب البعض الآخر،
إذ لماذا يعقب بين خصوص هؤلاء: دون سائر زوجاته،
ولم نسمع أن
إحداهن
تنازلت عن حقها لرفيقاتها في غزوة الخندق، وإن كان ذلك محتملاً
في حد ذاته.
والذي نظنه:
أنه لو صح حديث ذلك البعض، فالسبب في ذلك هو أنه «صلى
الله عليه وآله» لم يكن عنده سوى هؤلاء الثلاث، بالإضافة إلى سودة بنت
زمعة، التي كانت مسنة، وكانت قد وهبت ليلتها إلى عائشة. فلا بد من
مراجعة تاريخ زواجه «صلى الله عليه وآله» بزوجاته.
ونظن أن النتيجة ستكون هي ما ذكرناه،
فمن أراد التوسع فعليه أن يقوم بذلك.
«وأمر رسول الله صلوات الله عليه وآله المسلمين بالثبات
في مكانهم، ولزوم خندقهم.. ونظر المشركون إلى الخندق فتهيبوا القدوم
عليه، فجعلوا يدورون حوله بعساكرهم، وخيلهم، ورجلهم،
ويدعون المسلمين: ألا هلم للقتال والمبارزة.
فلا يجيبهم أحد إلى ذلك، ولا يرد عليهم فيه شيئاً.
ولزموا مواضعهم كما أمرهم رسول الله «صلوات
الله عليه وآله»، قد عسكروا في الخندق، وأظهروا العدة، ولبسوا السلاح،
ووقفوا في مواقفهم. وتهيَّب
المشركون أن يلجوا الخندق عليهم. فلما طال ذلك، ونفذت أكثر أزوادهم،
اجتمعوا الخ..([39]).
ثم يذكر ما جرى لعمرو بن عبد ود.
تقول النصوص التاريخية:
«وصار المشركون يتناوبون، فيغدو أبو سفيان في أصحابه
يوماً، ويغدو خالد بن الوليد يوماً، ويغدو عمرو بن العاص يوماً، ويغدو
هبيرة بن أبي وهب يوماً، ويغدو عكرمة بن أبي جهل يوماً، ويغدو ضرار بن
الخطاب يـومـاً،
فـلا
يزالون يجيلون خيلهم، ويفترقـون
مـرة،
ويجتمعون أخـرى،
ويناوشون أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، أي يقربون منهم،
ويقدمون رجالهم فيرمون.
ومكثوا على ذلك المدة المتقدمة،
ولم يكن بينهم
حرب إلا الرمي بالنبل والحصا»([40]).
وذكر البعض:
أن ذلك كان في
أكثر الأيام([41]).
«وكان المشركون يتناوبون الحرب، لكن الله تعالى لم
يمكنهم من عبور الخندق، فإن شجعان الصحابة كانوا يمنعونهم بالنبال والأحجار»([42]).
واستمر الأمر على ذلك «حتى عظم البلاء، وخاف الناس خوفاً
شديداً»([43]).
لكن البعض يذكر:
أن الحرب كانت
«ثلاثة أيام بالرمي بغير مجالدة ولا مبارزة»([44])
سوى ما كان من قتل الفرسان الذين عبروا
الخندق.
وكان أبو سفيان في خيل يطيفون بمضيق من الخندق، فراماهم
المسلمون حتى رجعوا([45]).
وفي مرة أخرى:
كان عمرو بن العاص في نحو الماءة يريدون العبور من
الخندق من مكان تطفره الخيل، فراماهم أسيد بن حضير، ومن معه من الحرس
بالنبل والحجارة حتى ولوا.
وكان مع المسلمين في تلك الليلة
سلمان، فقال لأسيد:
إن هذا مكان من الخندق متقارب، ونحن نخاف تطفره خيلهم.
وكـان
النـاس
عجلوا في حفره،
وبادروا
فباتوا يوسعونه، حتى صار كهيئة الخندق، وأمنوا أن تطفره خيلهم([46]).
«وكان عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد كثيراً
ما يطلبان غرَّة
ومضيقاً،
من الخندق يقتحمانه، فكان للمسلمين معهما وقائع في تلك الليالي»([47]).
وقال ضرار بن الخطاب:
نـراوحـهـم ونـغـدو كـل
يــــوم عـلـيـهـم في السـلاح مدججينا([48])
«ثم إن خالد بن الوليد كرَّ
بطائفة من المشركين يطلب غرَّة
للمسلمين، أي غفلتهم، فصادف أسيد بن حضير على الخندق في ماءتين من
المسلمين، فناوشوهم،
أي تقاربوا منهم ساعة، وكان في أولئك المشركين وحشي، قاتل حمزة رضي
الله عنه، فزرق([49])
الطفيل بن النعمان، فقتله.
ثم بعد ذلك صاروا يرسلون الطلائع بالليل، يطمعون في
الغارة، أي في الإغارة،
فأقام المسلمون في شدة من الخوف»([50]).
لكن صاحب تجارب الأمم يقول:
تفرق ذلك الجمع من غير قتال إلا ما كان من عدة يسيرة
اتفقوا على الهجوم على الخندق، يحكى:
أن
فيهم عمرو بن عبد ود فقتلوا([51]).
إلا أن يكون المراد:
أنه لم يكن قتال بالسيوف والرماح، أما الرمي بالنبل
والحصا فليس محط نظره.
وقبل أن نمضي في الحديث:
نلفت نظر القارئ إلى هذا الاهتمام الظاهر بإبراز دور
أسيد بن حضير، الذي قلنا: إن السياسة كانت تهتم بشأنه، وتعمل على تكريس
وتكديس الفضائل له، مكافأة له على هجومه على بيت فاطمة «عليها
السلام»،
وقيامه بدور فاعل في تشييد خلافة قريبه أبي بكر.
وذكر العلامة الحسني:
أن المشركين
ألفوا
ثلاث كتائب لمحاربة المسلمين، فأتت كتيبة أبي الأعور السلمي من فوق
الوادي، وكتيبة عيينة بن حصن من الجنب، ووقف أبو سفيان ومن معه في
الناحية الثانية من الخندق([52]).
لكننا قدمنا في فصل:
الأحزاب إلى المدينة: أن أبا الأعور لم يكن له أي دور
في الخندق،
وأن أباه هو الذي شارك فيها.
عن محمد بن مسلمة قال:
كنا حول قبة رسول الله «صلى الله عليه وآله» نحرسه،
ورسول الله «صلى الله عليه وآله» نائم نسمع غطيطه إذ وافت أفراس على
سلع، فبصر بهم عباد بن بشر، فأخبرنا بهم.
قال:
فامضِ
إلى الخيل.
وقام عباد على باب قبة النبي «صلى الله عليه وآله» آخذاً
بقائم السيف ينظرني،
فرجعت فقلت: خيل المسلمين أشرفت عليها سلمة بن
أسلم
بن حريش، فرجعت إلى موضعنا.
ثم يقول محمد بن مسلمة:
كان ليلنا بالخندق نهاراً
حتى فرجه الله([53]).
وعن محمد بن مسلمة:
أن خالد بن الوليد تلك الليلة أقبل في مئة فارس، من جهة
العقيق حتى وقفوا بالمذاد وجاه قبة النبي «صلى الله عليه وآله» فنذرت
بالقوم، فقلت لعباد بن بشر ـ وكان على حرس قبة النبي
«صلى الله عليه وآله» وكان قائماً
يصلي ـ أتيت، فركع، ثم سجد،
وأقبل خالد في ثلاثة نفر هو رابعهم، فأسمعهم يقولون: هذه قبة محمد،
إرموا.
فرموا، فناهضناهم حتى وقفنا على شفير الخندق، وهم بشفير
الخندق من الجانب الآخر.
فترامينا، وثاب
إلينا
أصحابنا، وثاب إليهم أصحابهم، وكثرت الجراحة بيننا وبينهم.
ثم اتبعوا الخندق على حافتيه وتبعناهم، والمسلمون على
محارسهم،
فكلما نمر بمحرس نهض معنا طائفة، وثبت طائفة، حتى انتهينا إلى راتج،
فوقفوا وقفة طويلة، وهم ينتطرون قريظة، يريدون أن يغيروا على بيضة
المدينة، فما شعرنا إلا بخيل سلمة بن
أسلم
يحرس،
قد أتت من خلف راتج.
فلاقوا خالداً،
فاقتتلوا واختلطوا، فما كان إلا حلب شاة حتى نظرت إلى خيل خالد مولية.
وتبعه سلمة بن
أسلم
حتى رده من حيث جاء.
فأصبح خالد، وقريش، وغطفان، تزري
عليه وتقول:
ما صنعت شيئاً فيمن في الخندق، ولا فيمن أصحر لك.
فقال خالد:
أنا أقعد الليلة، وابعثوا خيلاً حتى
أنظر
أي شيء تصنع»([54]).
ونقول:
إن هذه الرواية موضع ريب وشك، لأن إصحار سلمة بن
أسلم
ومن معه لخـالد
ومن معه واختلاطهم بهم يصعب تصديقه، لأن عبور سلمة وأصحابه إلى الجانب
الآخر
من الخندق أو مجيئهم من خلف راتج، من طرف الخندق، إلى جهة المشركين
ينطوي على مخاطرة كبرى لما فيه من تعريض أنفسهم للإبادة
الحتمية على يد ألوف المقاتلين من المشركين الذين كانت تعج بهم
المنطقة.
ويلفت نظرنا هنا:
أن الروايـة
لم تشر إلى مبادرة خالـد
لمطاولة هذه الجماعة القليلة، ثم طلب المدد من الجيش الذي هو أحد
قواده. وقد كان عليه أن ينتهزها فرصة ذهبية نادرة ليلحق بالمسلمين نكبة
هائلة ومروعة.
ثم إن تلك الرواية قد تحدثت:
عن أن خالداً
كان في مئة فارس، ولكنه حين أراد أن يرمي قبة النبي «صلى الله عليه
وآله» كان في ثلاثة نفر هو رابعهم.
وحين ترامى خالد وأصحابه، ومحمد بن مسلمة وأصحابه
أين
كان عنه أصحابه، حتى يقول الراوي ـ وهو محمد بن مسلمة ـ وثاب
إلينا
أصحابنا، وثاب إليهم أصحابهم؟!
ومـا معنى قوله:
ثم اتبعوا
الخندق على حافتيه وتبعنـاهم.
فهـل
كـان
خالد وأصحابه على حافتي الخندق؟!
الأمر الذي يعني أن خالداً
ومن معه قد عبروا
الخندق إلى جهة المسلمين، أو العكس.
ثم إننا لا ندري مدى صحة هذه الرواية التي لم يروها لنا
إلا محمد بن مسلمة، الرجل الذي كانت تهتم السلطة في
إعطائه
الأدوار
الحساسة، لأنه كان من أعوانها.
ولكن الغريب في الأمر:
أننا نجد المؤرخين لم يعيروا هذه الرواية أي اهتمام رغم
أهمية وحساسية المعلومات التي تدَّعيها
فيما يرتبط بحرب الخندق.
وعن مالك بن وهب الخزاعي:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» بعث سليطاً
وسفيان بن عوف الأسلمي
طليعة يوم الأحزاب، فخرجا حتى إذا كانا بالبيداء التفت عليهما خيل لأبي
سفيان، فقاتلا حتى قتلا، فأتي بهما رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
فدفنا في قبر واحد. فهما الشهيدان القرينان([55]).
ونحن نشك في صحة ذلك، لما يلي:
أولاً:
بالنسبة
لسنده، قال البزار: «لا نعلم روى مالك إلا هذه»([56]).
وقال:
الهيثمي:
«فيه جماعة لم أعرفهم»،
وقريب من ذلك عند العسقلاني([57]).
وثانياً:
إن من الواضح: أن سفيان بن عوف الأسلمي
وهو الغامدي، هو الذي كان يغير على
أطراف علي «عليه
السلام»،
ويرتكب الجرائم، ويهتك الحرمات، وقد ذكره أمير المؤمنين «عليه السلام»
بقوله: «وإن
أخا
غامد
الخ..»
وكان من قواد معاوية الأساسيين، وكان يعظمه. وقد مات سنة اثنتين أو
ثلاث، أو أربع وخمسين([58]).
ولنا أن نحتمل:
أن تكون دعوى صحابية سفيان هذا قد جاءت لأجل
إعطائه
بعض المصونية والشأن الرفيع، حفاظاً
على سيده
معاوية من جهة، وإضعافاً
لموقف علي «عليه
السلام»
من جهة ثانية، وتبريراً
لمواقفه المخزية، وجرائمه الخطيرة التي ارتكبها بحق المسلمين الذين
أغار
عليهم وقتلهم، وهتك حرماتهم من جهة ثالثة.
عن أم سلمة قالت:
كنت مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» في الخندق، فلم
أفارقه مقامه كله،
وكان يحرس بنفسه في الخندق،
وكنا في قرٍّ
شديد. فإني لأنظر
إليه قام فصلى ما شاء الله أن يصلي في قبته، ثم خرج فنظر ساعة، ثم قال:
هذه خيل المشركين تطيف بالخندق، من لهم؟.
ثم نادى:
يا عباد بن بشر!
قال:
لبيك.
قال:
أمعك أحد؟.
قال:
نعم، أنا في نفر
من
أصحابي حول قبتك.
قال:
فانطلق في أصحابك، فأطف بالخندق، فهذه خيل المشركين
تطيف بكم، يطمعون أن يصيبوا منكم غرة،
اللهم ادفع عنا شرهم، وانصرنا عليهم،
واغلبهم، لا يغلبهم غيرك.
فخرج عبَّاد
في أصحابه، فإذا هو بأبي سفيان في خيل المشركين يطيفون بمضيق الخندق،
فرماهم المسلمون بالحجارة والنبل، فرجعوا منهزمين.
ثم جاء عبَّاد
إلى النبي «صلى الله عليه وآله» فوجده يصلي، فأخبره،
قالت أم سلمة: فنام حتى سمعت غطيطه([59]).
ويستوقفنا في هذا الحديث:
1 ـ
قول أم سلمة أنها كانت مع رسول الله في غزوة الخندق.
وأنها لم تفارقه فيها أصلاً.
وهذا يكذِّب
ما يقوله البعض: من أنه «صلى الله عليه وآله» كان يعقب بينها وبين
عائشة وزينب بنت جحش.
2 ـ
عبارة أم سلمة: فنام حتى سمعت غطيطه. لا ندري مدى صحة
حصول الغطيط
منه «صلى الله عليه وآله»، ونحن نتوقع منه خلاف ذلك. فإن
الغطيظ من المنفرات التي يتنزه عنها النبي «صلى الله عليه وآله».
3 ـ
قولها: وكنا في قرٍّ
شديد. قد تقدم في الفصل الأول ما يوجب الشك في هذا الأمر.
4 ـ
لا ندري كيف لم يلتفت عبَّاد
بن بشر ومن معه إلى خيل المشركين وهي تطيف بالخندق، وكيف رآها النبي
«صلى الله عليه وآله» دونهم؟ فهل علم «صلى الله عليه وآله» ذلك عن طريق
الوحي؟! إن ظاهر الرواية:
هو أنه «صلى الله عليه وآله» علم ذلك بواسطة عينه الباصرة.
5 ـ
أين كان سائر المسلمين عن حراسة خندقهم، ألم يكونوا
يتناوبون عليه يحرسونه، ويطوفون به؟
لكن ذلك لا يعني أن تكون الرواية كاذبة من أساسها، فلعل
النبي «صلى الله عليه وآله» قد نبه المسلمين لمحاولة تسلل من المشركين
لم يكونوا قد التفتوا إليها، لانشغالهم بحديث فيما بينهم.
عن أم سلمة قالت:
والله، إني
لفي جوف الليل في قبة النبي «صلى الله عليه وآله»، وهو نائم إلى أن
سمعت الهيعة([60])،
وقائل يقول: يا خيل الله (وكان رسول الله قد جعل شعار المهاجرين: يا
خيل الله) ففزع «صلى الله عليه وآله» بصوته، وخرج من القبة، فإذا نفر
من الصحابة عند قبته يحرسونها منهم عباد بن بشر،
فقال «صلى الله عليه وآله»: ما بال الناس؟
قال عباد:
يا رسول الله هذا صوت عمر بن الخطاب، الليلة نوبته،
ينادي: يا خيل الله، والناس يثوبون إليه، وهو من ناحية حسيكة، ما بين
ذباب ومسجد الفتح.
فأمر «صلى الله عليه وآله» عباداً
أن يأتيه بالخبر،
فذهب ثم رجع إلى النبي «صلى الله عليه وآله» فقال: يا رسول الله، هذا
عمرو بن عبد في خيل المشركين، معه مسعود بن رخيلة في خيل غطفان،
والمسلمون يرامونهم بالنبل والحجارة.
قالت:
فدخل «صلى الله عليه وآله» فلبس درعه ومغفره وركب فرسه،
وخرج معه أصحابه، حتى أتى تلك الثغرة، فلم يلبث
أن
رجع وهو مسرور، فقال: صرفهم الله، وقد كثرت فيهم الجراحة.
ثم دخل «صلى الله عليه وآله» فنام، فسمعوا هائعة أخرى،
فانتبه «صلى الله عليه وآله» فأخبروه أنه ضرار بن الخطاب،
فلبس «صلى الله عليه وآله» درعه ومغفره وركب فرسه إلى تلك الثغرة، وعاد
في وقت السحر، وهو يقول: رجعوا مفلولين قد كثرت فيهم الجراحة([61]).
ونقول:
قد يمكن للبعض أن يشكك في صحة هذه
الرواية، على اعتبار:
أن الروايات الأخرى قد تحدثت عن هزيمة عمر بن الخطاب
أمام ضرار، وأنه كاد أن يقتله، ثم كف عنه، لأنه كان لا يقتل قرشياً
قدر عليه، كما سيأتي.
كما أن الطبري وغيره يذكرون:
أنه قد اختبأ هو وطلحة وغيرهما في بستان إبان حرب
الخندق،
كما سيأتي عن قريب.
ولكن هذا التشكيك يمكن دفعه:
بأن عمر لم يواجه حرباً
بنفسه هنا، بل واجهها بغيره، أي بواسطة المسلمين الذين تصدوا للمشركين،
وليس بالضروة أن يصل به الرعب والخوف إلى حد الهزيمة من ساحة الحرب،
حتى حين يكون المتحاربون هم الآخرون.
غير أن ما يلفت نظرنا هنا:
هو ما نراه بوضوح من محاولات جادة لإيجاد
دور ما لأشخاص
بأعيانهم، كان لهم دور سلطوي بعد وفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
أو دور في تركيز دعائم السلطة بعده «صلى الله عليه وآله» أو مناوأة آل
أبي طالب بشكل أو بآخر،
فنجد الاهتمام بإبراز دور ما لأبي
بكر، ولعمر، وللزبير، ولمحمد بن مسلمة، ولسلمة بن
أسلم،
وعباد بن بشر، وسعد بن أبي وقاص، وأسيد بن حضير.
والمطلع على تاريخ هؤلاء يجد:
أنهم كانوا على العموم من المناوئين لعلي وأهل البيت
عليهم الصلاة والسلام، ومنهم من هو من أركان الحكم وأعوانه، أو من
المشاركين في الاعتداء على الزهراء «عليها
السلام»
حين قيامهم بعدة هجمات على بيتها صلوات الله وسلامه عليها.
ويذكر المؤرخون:
أنه كان للمشركين رماة يقدمونهم إذا غدوا متفرقين، أو
مجتمعين بين أيديهم وهم حبان بن العرقة، وأبو أسامة الجشمي في آخرين.
فتناوشوا يومـاً
بالنبل سـاعة،
وهم جمعيـاً
في وجـه
واحـد،
وجـاه
قبة رسول الله،
ورسول الله «صلى الله عليه وآله» قائم بسلاحه على فرسه، فرمى حبان بن
العرقة سعد بن
معاذ
بسهم، فأصاب أكحله.
وقال:
خذها وأنا ابن العرقعة.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
عرق الله([62])
وجهك بالنار،
(أو قال له سعد نفسه ذلك).
ويقال:
بل رماه أبو
أسامة الجشمي، وقيل: خفاجة بن عاصم([63]).
وقال سعد:
اللهم إن
أبقيت
من حرب قريش شيئاً فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إليَّ
أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك، وأخرجوه وكذبوه.
اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم، فاجعلها لي شهادة، ولا تمتني
حتى تقر عيني من بني قريظة،
وكانوا حلفاءه
ومواليه في الجاهلية([64]).
أضاف البعض هنا قوله:
فلما قال سعد
ما قال إنقطع الدم([65]).
وتقول عائشة
ـ كما روي ـ :
إن ابن معاذ
مر عليها، وهي
في الحصن، حصن بني حارثة، وكان من أحرز حصون المدينة ـ وذلك قبل أن
يفرض علينا الحجاب([66])
ـ وعليه درع مقلصة قد خرجت منها أذرعه كلها،
وفي يده حربة يرقد (يرقل) بها، وهو يقول:
لـبـثـت قـلـيـلاً يشهد الهيجا
حمل مـا أحسن المـوت إذا حـان الأجل
فقالت له أمه:
الحق
بني فقد ـ ولله ـ أخرت.
فقالت لها عائشة:
والله لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي عليه،
قالت: وخفت عليه حيث أصاب السهم منه.
فقالت أم سعد:
يقضي الله ما هو قاض.
فقضى
الله أن أصيب يومئذٍ([67]).
ونقول:
إننا نرجح أن يكون أبو أسامة الجشمي هو الذي قتل ابن
معاذ، وذلك:
أولاً:
لأن بعض المصادر تذكر لأبي
أسامة
الجمشي أبياتاً
فيها أنه هو الذي رمى سعداً فأصابه، فقد قال مخاطباً
عكرمة، ومشيراً
إلى قتله سعداً:
أعـكــرم هـلا
لمـتـنـي إذ تقول لي فـداك بـآطــام المـديـنـة خــالــد
ألـست الذي ألزمت سعداً مريشة لهـــا بـيــن أثـنـاء
المـرافـق عاند
قـضى نحبـه منهـا سعيداً فاعولت عليه مع الشمط العذارى
النواهـد
الأبيات([68]).
ثانياً:
ذكرت الروايات: أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يوم أحد حبان
بن العرقة بسهم فوقع في ثغرة نحره (أو في نحره) فوقع على ظهره وبدت
عورته، فضحك «صلى الله عليه وآله» حتى بدت نواجذه.
فهل عاش حبان من جديد؟ أو لم يمت من سهم أصابه في
نحره!! ـ وعاش ـ حتى رمى سعد بن
معاذ
في
أكحله
في الخندق؟([69]).
إلا أن تكون قصة أُحد:
قد صنعها محبو سعد بن أبي وقاص لإثبات
فضيلة له، وذلك عن هؤلاء غير بعيد، فقد رأيناهم يفعلون ذلك في كثير من
المواضع،
ثم سرعان ما ينسيهم الله ذلك، فتظهر الحقيقة على ألسنتهم من جديد،
ويكذبون أنفسهم من حيث لا يشعرون.
وأما الاختلاف في قاتل سعد بن
معاذ،
فهو يعود ـ فيما يظهر لنا ـ إلى
أن
الذين كانوا يرمون باتجاه سعد والمسلمين كانوا أكثر من واحد، فاختلطت
السهام، واستطاع كل منهم أن يدَّعي
لنفسه أنه تمكن من قتل سيد قبيلة الأوس في المدينة وهو ـ باعتقادهم ـ
شرف عظيم أراد كل منهم أن يخص نفسه به،
مع أنه في الحقيقة غاية الخزي والعار، لو كانوا يعلمون.
وأمر «صلى الله عليه وآله» بنقل سعد حينما جرح إلى خيمة
رفيدة التي كانت أقامتها في مسجد النبي «صلى الله عليه وآله» لمداواة
الجرحى.
زاد القمي قوله:
وكان يتعاهده
بنفسه([70]).
ونستفيد من ذلك:
إمكانية أن تتولى المرأة مداواة الجرحى. وقد تحدثنا عن
ذلك بشيء من التفصيل في كتابنا: الآداب
الطبية في الإسلام، فنحن نرجع القارئ الذي يريد التوسع إليه.
إصابة
أُبي
بن كعب في
أكحله:
وتذكر بعض الروايات عن جابر:
أن أُبي
بن كعب، رمي يوم الأحزاب على
أكحله،
فكواه رسول الله «صلى الله عليه وآله».
وعنه أي عن جابر:
بعث رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى أُبي
بن كعب طبيباً
فقطع منه عرقاً،
ثم كواه عليه([71]).
ونحن نتساءل عن السبب الذي لم يقدم لأجله
النبي «صلى الله عليه وآله» على معالجة سعد بن
معاذ
بهذه الطريقة حتى يشفى،
أم أنه عالجه، لكن لم يفده العلاج لأن جراحته تختلف عن جراحة أُبي؟!
والذي يثير فينا العجب هنا:
أننا نجد عائشة تروي لنا ما يدل على فرار جماعة من
الصحابة في حرب الخندق، واختبائهم في حديقة هناك.
قال الطبري:
«حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن بشر، قال
حدثنا محمد بن عمرو،
قال: حدثني أبي عن علقمة، عن عائشة قالت:
خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس، فوالله إني لأمشي
إذ سمعت وئيد الأرض خلفي ـ يعني حس الأرض ـ فالتفت فإذا أنا بسعد،
فجلست إلى الأرض، ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس ـ شهد بدراً
مع رسول الله «صلى الله عليه وآله»، حدثنا بذلك محمد بن عمرو ـ يحمل
مجنه، وعلى سعد درع من
حديد،
قد خرجت أطرافه منها، قالت: وكان من أعظم الناس وأطولهم.
قالت:
فأنا أتخوف على أطراف سعد، فمر بي، يرتجز ويقول:
لـبـث قـلـيـلاً يـدرك الهيجا حمل مـا أحسن
المـوت إذا حـان الأجل
قالت:
فلما جاوزني قمت، فاقتحمت حديقة فيها نفر من المسلمين، فيهم عمر بن
الخطاب، وفيهم رجل عليه تَسْبِغَة
له ـ قال محمد: والتسبغة: المغفر لا ترى إلا عيناه ـ فقال عمر: إنك
لجرية، ما جاء بك؟ ما يدريك؟ لعله يكون تحوّز،
(تحرف) أو بلاء.
فوالله ما زال يلومني حتى وددت أن الأرض تنشق لي فأدخل
فيها، فكشف الرجل التَسْبِغَة
عن وجهه: فإذا هو طلحة.
فقال:
إنك قد أكثرت،
أين الفرار، وأين التحوّز
(التحرف) إلا إلى الله عز وجل([72]).
نقول:
إن طلحة يتضايق من جهر عمر بالفرار أمام عائشة،
ثم لما رأى أنه يكرر ذلك لها،
يستنكر أن يكون هذا فراراً،
ويعتبره فراراً
إلى الله عز وجل.
ونلفت النظر هنا:
إلى تجاهل جل المؤرخين لهذه الرواية، رغم أنهم يرون في
الطبري المثل الأعلى لهم، وهم ينقلون عنه ويعتمدون عليه،
ولعله هو بالإضافة إلى سيرة ابن هشام، يأتي على رأس القائمة في أي
مراجعة للسيرة، أو تسجيل أي حدث، أو موقف منها.
كما أننا لا نستبعد:
أن تكون هذه هي القضية الصحيحة، لا قضية عائشة مع أم
سعد.
ثم إننا لا ننسى أن نسجل هنا تساؤلاً
يبقى حائراً،
وهو أنه كيف سوَّغت
عائشة لنفسها أن تخرج من الحصن الذي وضعها النبي «صلى الله عليه وآله»
فيه، مع خطورة الموقف وحساسيته المتناهية، ومع عدم إذن النبي «صلى الله
عليه وآله» لها بذلك، إذ لو كانت مأذونة منه «صلى الله عليه وآله»
لاحتجت به على عمر، ولم تصبر على هذا التقريع
المر الذي واجهها به، حتى إنها لتود أن تنشق لها الأرض، فتدخل فيها.
ولعل مما يؤيد فرار الكثيرين يوم
الخندق:
ما سيأتي في حديث حذيفة حينما
أرسله
النبي «صلى الله عليه وآله» لكشف خبر قريش، حيث ذكر أنه لم يبق مع
النبي سوى اثني عشر رجلاً فقط([73]).
والرواية الأخرى تقول:
إن الناس
تفرقوا ولم يبق من العسكر غير ثلاثة مئة([74]).
ويقولون:
«كان يوم الخندق رجل من الكفار معه ترس، وكان سعد رامياً.
وكان الرجل يقول كذا بالترس، يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع
رأسه رماه سعد لم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، فانقلب وأشال برجله، فضحك
النبي «صلى الله عليه وآله» حتى بدت نواجذه، يعني من فعله بالرجل»([75]).
ونقول:
إننا نشك في صحة ذلك:
ألف:
إن الذين قتلوا من المشركين معروفون،
وستأتي أسماؤهم، وأسماء
الذين قتلوهم،
وهم:
1 ـ
عمرو بن عبد ود،
وقد قتله علي أمير المؤمنين «عليه السلام».
2 ـ
حسل بن عمرو بن عبد ود،
قتله علي «عليه السلام» أيضاً.
3 ـ
نوفل بن عبد الله، قتله علي «عليه السلام»، وقيل:
بل قتله الزبير، وسيأتي أنه غير صحيح.
4 ـ
منبه بن عثمان، أو عثمان بن أمية بن منبه،
أصابه سهم غرب فمات منه بمكة،
وسيأتي ذلك مع مصادره في الفصل الأخير من هذا الباب.
فأين ذلك الرجل الذي قتله سعد بسهم؟!.
إلا أن يقال:
إنه
أصابه
في جبهته، وانقلب وأشال برجله، لكنه لم يمت.
ب:
إن هذه الرواية هي ـ تقريباً ـ نفس الحكاية التي تحكى
لسعد مع حبان بن العرقة في غزوة أحد.
إلا أنها ذكرت:
أن هذا كان يتلاعب بترسه، فرماه سعد في جبهته،
وقد أشرنا غير مرة إلى أننا نجد اهتماماً
خاصاً
بتسطير الفضائل لسعد لتعويضه عن فراره في المواطن،
ولرد الجميل له على مواقفه المؤيدة للسلطة التي اغتصبت مقام الخلافة
بعد الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله».
وقد أشرنا إلى ذلك:
في غزوة أحد حين الكلام عن بطولات سعد الموهومة، فراجع.
روى البيهقي من طريق حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن
أبيه، عن عبد الله بن الزبير، قال: جعلت يوم الخندق مع النساء والصبيان
في الأطم
(يعني حصناً)
ومعي عمر بن أبي سلمة، فجعل يطأطئ لي، فأصعد على ظهره، فأنظر إليهم كيف
يقتّلوا،
وأطأطئ
له فيصعد فوق ظهري، فينظر.
قال:
فنظرت إلى أبي، وهو يحمل مرة ها هنا، ومرة ها هنا، فما
يرتفع له شيء إلا أتاه.
فلما أمسى جاءنا إلى الأطم، قلت:
يا أبه، رأيتك اليوم وما تصنع.
قال:
ورأيتني يا بني؟!.
قلت:
نعم.
قال:
أما إن رسول الله قد جمع لي أبويه.
قال:
فداً
لك أبي وأمي([76]).
ونقول:
قد قدمنا في فصل:
غدر بني قريظة: أن عبد الله بن الزبير كان آنئذٍ طفلاً
صغيراً جداً، ولم يكن بحيث يمكن أن يصدر منه ذلك فقد كان عمره أقل من
سنتين على ما يظهر، فراجع ما قدمناه.
هذا بالإضافة إلى أننا:
لم نفهم معنى لما يدَّعيه
ابن الزبير من حملات لأبيه
هنا، وحملات هناك، ونحن نعلم أن ذلك لم يحدث في الخندق، بل الذي كان هو
المراماة بالنبل والحصا في بعض الأحيان.
أما قضية المبازرة فإنما
كانت بين علي «عليه
السلام»
وعمرو بن عبد ود، كما سيأتي.
هذا بالإضافة إلى:
أن هذا الحديث زبيري سنداً
ومتناً،
ولم نجد من روى لنا هذه المواقف البطولية للزبير في حرب الأحزاب.
عن نافع، عن ابن عمر، قال:
«بعثني خالي عثمان بن مظعون لآتيه
بلحاف،
فأتيت النبي «صلى الله عليه وآله»، فاستأذنته
ـ وهو بالخندق ـ فأذن لي، وقال لي: من لقيت منهم،
فقل لهم: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» يأمركم أن ترجعوا.
قال:
فلقيت الناس،
فقلت لهم..
إلى أن قال ابن عمر:
والله ما عطف عليَّ
منهم اثنان أو واحد»([77]).
ونقول:
ألف:
إن هذه الرواية موضع ريب، لأن عثمان بن مظعون قد توفي
قبل الخندق بزمان، فإنه أول من مات بالمدينة من المهاجرين. وذلك بعد
بدر في السنة الثانية من الهجرة الشريفة.
وقد احتمل البعض:
أن يكون المقصود هو قدامة بن مظعون فراجع([78]).
ب:
قد يقال: إن هذه الرواية تدل على أن طائفة من الناس قد
فروا يوم الخندق، وفقاً لما تقدم من فرار جماعة فيهم عمر وطلحة، وقد
اختبأوا في حديقة هناك، فاكتشفتهم عائشة.
وسيأتي أيضاً:
أن الناس قد تفرقوا عن النبي «صلى الله عليه وآله» حتى
بقي في ثلاث مئة. بل في اثني عشر رجلاً
كما في رواية القمي،
والحاكم في المستدرك بسند صححه هو والذهبي.
لكن قد يجاب عن ذلك:
بأن من الممكن أن تكون الرواية ناظرة
إلى
حالة المسلمين لما بلغهم فرار المشركين، فإنهم تركوا النبي وقصدوا
المدينة لا يلوون على شيء،
وسيأتي ذلك في آخر فصل: نهاية حرب الخندق.
إلا أن هذا الجواب لا يكفي:
إذ لا معنى لطلب النبي من الناس الرجوع إلى مواقعهم،
بعد ذهاب الأحزاب.
ج:
إن هذه الرواية تشير إلى أنه قد كان ثمة دقة في
التنظيم، وهيمنة قيادية، قد فرضت عدم تغيب أي عنصر مشارك في الحرب
إلا
بإذن من الرسول «صلى الله عليه وآله» مباشرة، الأمر الذي يتيح للقيادة
أن تبقى على اطلاع تام على حجم وفعالية القوة التي تعمل تحت قيادتها،
فتتمكن من التخطيط الدقيق والسليم وفي نطاق وحدود القدرات المتوفرة
لديها،
والإستئذان هذا كان من الجميع حتى من المنافقين لأعذار
مختلفة.
قد ذكرت النصوص التاريخية عـدة
مـوارد يقـال:
إنها حصلت فيها مناوشات فردية بين المسلمين واليهود،
وذكرت أيضاً حوادث محدودة في نطاق التدبير العسكري فيما بين الفريقين.
بالإضافة إلى:
تحركات عامة في دائرة التفاهم لشن هجوم مشترك على
المسلمين،
ونذكر هذه الأمور في ضمن النقاط التالية:
قال الدياربكري:
«واستعان بنو قريظة من قريش ليبيتوا المدينة فعلم به
النبي «صلى الله عليه وآله»، فبعث سلمة بن الأسلم
في ماءتي رجل، وزيد بن حارثة في ثلاث مئة رجل حتى حرسوا حصون المدينة
ومحلاتها»([79]).
ويفصّل ذلك البعض، فيقول:
همت بنو قريظة أن يغيروا على بيضة المدينة ليلاً،
فأرسلوا حيي بن أخطب إلى قريش أن يأتيهم منهم
ألف
رجل، ومن غطفان
ألف
فيغيروا
بهم.
فجاء الخبر بذلك رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فعظم
البلاء،
وبعث
سلمة بن
أسلم
في مئتي رجل، وزيد بن حارثة في ثلاث مئة يحرسون المدينة، ويظهرون
التكبير،
ومعهم خيل المسلمين، فإذا أصبحوا أمنوا.
فكان أبو بكر يقول:
لقد خفنا على الذراري بالمدينة من بني قريظة أشد من
خوفنا من قريش وغطفان.
ولقد كنت أوفي على سلع، فأنظر إلى بيوت المدينة، فإذا رأيتهم هادين
حمدت الله عز وجل، فكان مما رد الله به بني قريظة عما أرادوا: أن
المدينة كانت تحرس»([80]).
ونقول:
إنه ربما يستفاد من قوله تعالى:
﴿إِذْ جَاؤُوكُم مِن فَوْقِكُمْ
وَمِنْ أَسْفَل مِنكُمْ﴾
أن بني قريظة قد تحركوا لقتال المسلمين، أو لمحاصرتهم،
أو عملوا على ذلك بطريقة أو بأخرى.
هذا..
ولم تذكر لنا الرواية سبب عدم استجابة قريش وغطفان لطلب
بني قريظة، ولا الطريقة التي علم بها رسول الله بإرسال بني قريظة تلك
الرسالة إلى الأحزاب.
كما أننا لا نكاد نطمئن:
إلى
أن
النبي «صلى الله عليه وآله» لم يبادر إلى حراسة المدينة إلا بعد أن علم
بعزمهم على تبييتها. فإن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يكن ليغفل عن
حراسة المدينة من أول يوم خرج فيه لحفر الخندق ومواجهة الأحزاب،
بل من أول ساعة.
أضف إلى ذلك كله:
أن تخصيص خمس مئة مقاتل لحراسة المدينة، أي ما ربما
يزيد على نصف جيش المسلمين، ثم الإكتفاء بالنصف أو بأقل من ذلك ـ حسبما
تقدم عن عـدة
المسلمين ـ ليواجهـوا
جيش الأحزاب ـ
إن
هذا ـ قد يكون أمراً مبالغاً
فيه،
فلعله
كان يرسل مئتين على التناوب، فتارة
يرسل سلمة،
وتارة يرسل زيداً،
وهكذا.
وبعث «صلى الله عليه وآله» خوات بن جبير
لينظر غرة لبني قريظة، أو خللاً
من موضع، فكمن لهم، فنام، فحمله رجل منهم وقد أخذه النوم،
فأفاق، فعرف أن حامله طليعة لبني قريظة، فأمكنه الله من الرجل وقتله،
ولحق بالنبي «صلى الله عليه وآله» وأخبره، بعد أن كان «صلى الله عليه
وآله» قد عرف بالقضية من جهة جبرئيل([81]).
ونقول:
إننا لا ندري لماذا يفضل ذلك اليهودي حمل عدوه على
ظهره؟! ولا يبادر إلى قتله، والتخلص منه.
والذي نعلمه في حالات كهذه هو أن يكون نوم من ينام قلقاً
وغير مستقر، حتى إن النائم ليتنبه لأدنى
حركة أو لمسة له، ونجد أن هذا اليهودي يحمل هذا النائم ويرفعه إلى كتفه
ولا يشعر به.
ثم كيف عرف خوات بن جبير أن حامله طليعة لبني قريظة؟!
هذا ما لم تصرح لنا الرواية به.
وإذا أغمضنا النظر عن ذلك:
فإن اهتمام النبي «صلى الله عليه وآله» بالعمل الإستخباري
في حروبه ظاهر للعيان.
ولكن طلب الغرة لبني قريظة والخلل من موضع، إنما يتناسب
مع التخليط لمهاجمتهم، وذلك لم يكن متيسراً،
أو فقل:
لم يكن مطروحاً
للتداول به والتخطيط له في غزوة الخندق.
فلعل رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان يمهد لغزوهم
حين فراغه من الأحزاب، فكان
إرسال
الطلائع تمهيداً
لذلك.
وخرج نباش (ولعل الصحيح: شاس) بن قيس في عشرة من اليهود
يريد المدينة، ففطن بهم نفر من أصحاب سلمة بن
أسلم،
فرموهم حتى هزموهم([82]).
ومر سلمة في من معه، فأطاف بحصون يهود، فخافوه، وظنوا:
أنه البيات.
ومن الواضح:
أن هؤلاء اليهود لا يشكلون خطراً
جدياً
على المسلمين، إلا من حيث أنهم طليعة للعدو،
وتريد أن تحصل على معلومات تفيد في توجيه ضربة عسكرية للمسلمين، أو من
حيث
أنهم
يريدون الحصول على مكاسب مادية، لظنهم أن المسلمين في غفلة عن بعض
المواقع التي يمكنهم التسلل إليها للحصول على ما يمكن الحصول عليه
منها.
أو من حيث إحداث بلبلة في صفوف المسلمين، حين يشعرون أن
نساءهم في معرض خطر أكيد من قبل الأعداء.
ومن الملفت للنظر أيضاً:
هذا الرعب من قبل اليهود لمجرد رؤيتهم سلمة بن
أسلم
يطيف بحصونهم، مع أنهم يظنون أنهم مانعتهم حصونهم.
روى الطبراني بسند رجاله ثقات عن
رافع بن خديج، قال:
لم يكن حصن أحصن من حصن بني حارثة، فجعل النبي «صلى
الله عليه وآله» النساء والصبيان والذراري فيه.
وقال لهن:
إن لم يكن أحد فالمعن بالسيف. فجاءهن رجل من بني
(ثعلبة) حارثة بن سعد، يقال له:
نجدان،
أحد بني جحاش على فرس، حتى كان في أصل الحصن، ثم جعل يقول لهن: انزلن
إلي
خير لكن.
فحركن السيف، فأبصره أصحاب رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، فابتدر الحصن قوم فيهم رجل من بني حارثة،
يقال له: ظفر بن رافع،
فقال: يا نجدان
ابرز.
فبرز إليه، فقتله، وأخذ رأسه
فذهب به
إلى
النبي «صلى الله عليه وآله»([83]).
ولنا ملاحظة على هذا النص، وعلى نص
سابق شبيه به:
وهو أنه «صلى الله عليه وآله» قد قال لهن: إن لم يكن
أحد فالمعن بالسيف، فهل هذا يعني: أن يلمعن بالسيف لإيهام
الأعداء
وجود
أسلحة
معهن؟!
الجواب:
قد يكون لا، لأن هذا لو صح لكان الأنسب
أن
يقول لهن، فالمعن بالسيوف، إلا أن يكون المقصود هو جنس السيف، لا السيف
الواحد.
والظاهر:
أنه «صلى الله عليه وآله» يريد أن يلمعن بالسيف لو
تعرضن لأي
هجوم من الأعداء ليعرف المسلمون بالأمر، لينجدوهن بالرجال.
ومعنى ذلك:
هو أن موضع النساء كان قريباً من جيش المسلمين، وفي
مقابلهم. كما أن هذه الطريقة لن تنفعهم إلا في وقت النهار، وحيث تكون
السماء صافية والشمس طالعة لا مطلقاً.
إذ في الليل وحيث لا شمس لا يلمع السيف.
روى الزبير بن العوام:
أن صفية كانت في حصن فارع.
وفي نص آخر:
«في حصن حسان بن ثابت» مع نساء النبي «صلى الله عليه
وآله»،
وكان معهن حسان بن ثابت، فرقى يهودي الحصن حتى أشرف عليهن، فقالت صفية:
يا حسان قم إليه حتى تقتله.
وفي نص آخر:
أن
اليهودي جعل يطوف بذلك الحصن،
فخافت صفية أن يدل على عورة الحصن.
قال:
لا والله، ما ذاك فيَّ،
ولو كان فيَّ
لخرجت مع رسول الله «صلى الله عليه وآله».
قالت صفية:
فاربط السيف على ذراعي. ثم تقدمت إليه حتى قتلته، وقطعت
رأسه، فقالت له: خذ الرأس وارم به على اليهود.
قال:
وما ذاك فيَّ.
فأخذت الرأس فرمت به على اليهود.
فقالت اليهود:
قد علمنا:
أنه
لم يك يترك أهله خلوفاً،
ليس معهم أحد.
ويذكر نص آخر:
أنها طلبت منه أن يسلبه فرفض.
ونص آخر يذكر:
أنها قتلته بواسطة عمود.
وفي غيره:
قتلته بفهر.
وتذكر رفض حسان لسلبه، ولا تذكر حديث قطع رأسه([84]).
وقد زاد أبو يعلى:
«فأخبر بذلك
رسول الله «صلى الله عليه وآله» فضرب لصفية بسهم، كما يضرب للرجل»([85]).
لكن نصاً آخر يقول:
إن غزال بن سموأل أقبل مع عشرة من اليهود نهاراً
فجعلوا يستترون ويرمون الحصن. «وقد حاربت قريظة، ورسول الله «صلى الله
عليه وآله» في نحر العدو، لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم
إلينا
إذا أتاهم آت»([86]).
ونقول:
يلفت نظرنا في هذه الرواية أمور عدة، نذكر منها:
قال البلاذري والوقداي:
«كان حسان رجلاً جباناً»([87]).
وقال ابن الأثير:
«كان حسان من أجبن الناس حتى إن النبي «صلى الله عليه
وآله» جعله مع النساء في الآطام
يوم الخندق»([88]).
وقال الحلبي:
«وهذا يدل على
ما قيل: إن حسان بن ثابت كان من أجبن الناس كما تقدم»([89]).
وقد صرحوا:
بأن حساناً
لم يشهد مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» مشهداً
قط لأنه كان جباناً([90]).
وكان حسان ضارباً
وتداً
في ناحية الأطم،
فإذا حمل أصحاب النبي «صلى الله عليه وآله» على المشركين حمل على الوتد
فضربه بالسيف، وإذا أقبل المشركون ترك الوتد كأنه يقاتل قرناً.
كان يرى
أنه
يجاهد جبناً
عن القتال([91]).
وقال الإسكافي:
«لو كان الضعيف
والجبان يستحقان الرياسة بقلة بسط الكف، وترك الحرب وأن
ذلك يشاكل فعل النبي، لكان أوفر الناس في الرياسة، وأشدهم
لها استحقاقاً
حسان بن ثابت»([92]).
وقال ابن الكلبي:
«كان حسان بن ثابت لسناً،
شجاعاً،
فأصابته علة، أحدثت فيه الجبن، فكان لا ينظر إلى قتال ولا يشهده»([93]).
وقالت صفية:
«كنت أعرف انكشاف المسلمين وأنا
على الأطم
برجوع حسان إلى
أقصى
الأطم»([94]).
وكلام ابن الكلبي هذا:
يدل على عدم صحة ما رد به السهيلي وغيره على هذا بحجة
أنه لو صح أنه كان جباناً
لهجاه به الشعراء، لأنه
كان يهاجيهم كضرار وابن الزبعري.
فلعل حساناً ـ لو صح أنه كان مع النساء في الأطم
ـ كان معتلاً
بعلة منعته من شهود القتال([95]).
أضف إلى ذلك:
أن المؤرخين قد حكموا على حسان بالجبن
بصورة مطلقة معللين
إبقاءه
مع النساء بذلك، الأمر الذي يظهر منه أن جبنه كان معروفاً
لديهم، لا أنهم استندوا في ذلك إلى خصوص هذه الرواية.
وأما لماذا لم يعيِّر الشعراء
حساناً بالجبن، فقد قال الزرقاني:
«إن ابن إسحاق لم ينفرد به، بل جاء بسند متصل حسن كما
علم، فاعتضد حديثه.
وقال ابن السراج:
سكوت الشعراء
عن تعييره بذلك من أعلام النبوة لأنه شاعره «صلى الله عليه وآله»([96]).
ونزيد نحن على ذلك:
أن هجـاءهـم
لحسـان
لا مبرر لـه،
وإنما هم يريدون
هجاء الإسلام، ورسول الإسلام، وجماعة المسلمين، ولا يهمهم حسان كشخص من
قريب ولا من بعيد.
وهذا بالذات هو ما يطغى على شعرهم المتبادل فيما بينهم.
وقد رويت قصة
جبن حسان، وقتل صفية لليهودي في غزوتي أحد والخندق معاً([97]).
وقد تقدمت هذه الرواية في غزوة أحد أيضاً.
ونرجح أنها
كانت في الخندق لأن اليهود إنما غدروا في الخندق([98])،
وهذا هو ما رجحه السمهودي أيضاً استناداً
إلى ذلك،
وإلى
أن الطبراني قد روى بسند رجاله رجال الصحيح عن عروة مرسلاً:
أنها كانت في الخندق، وممن ذكر القصة في الخندق ابن إسحاق أيضاً([99]).
قد ذكرت بعض النصوص المتقدمة:
أن قتل صفية لليهودي قد جعل اليهود يعتقدون: أن النبي
«صلى الله عليه وآله» قد جعل أناساً
لحماية النساء والذرية، وليحفظوا مؤخرة الجيش عن أن تتعرض لأي
عمل حربي، حيث قالت اليهود: إنه لم يك يترك أهله خلوفاً،
ليس معهم أحد.
وذكر في نص سابق:
أن عشرة من اليهود «جعلوا يستترون ويرمون الحصن، ورسول
الله «صلى الله عليه وآله» في نحر العدو، ولا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم
إلينا
إذا أتانا آت».
ولكننا نشك في صحة ذلك:
إذ قد كان ثمة حرس للمدينة يبلغ حوالي خمس مئة مقاتل، وقد كان يكفي لرد
هؤلاء العشرة عشرة مثلهم، فضلاً عن المئات.
ثم إن وصول عشرة من بني قريظة إلى مكان قريب من الجيش
الإسلامي،
وفي قبال ذلك الجيش، مع احتمالهم أن يكون ثمة حرس يعتبر مجازفة منهم،
لا نرى أن اليهود يقدرون عليها.
وقلنا:
إن موضع النساء قريب من جيش المسلمين، لأن النبي «صلى
الله عليه وآله» كما تقدم قد طلب من النساء أن يلمعن بالسيف إذا تعرضن
لأي
مكروه.
فلماذا لم يلمعن بالسيف كما صنعن في قصة أحد بني جحاش،
الذي تم التخلص منه بهذه الطريقة بالذات؟
إلا أن يكون الناس في ذلك الوقت قد شغلتهم الحرب حتى لا
يستطيع أحد منهم، ولا حتى مفرزة صغيرة بمقدار خمسين فارساً:
أن تنجد النساء والأطفال.
ونحن لا نظن:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يحسب حسابه لساعات
كهذه، وترك الأمر يتطور إلى أن يصل إلى هذه الدرجة من الخطورة.
ولهذا فنحن نعتقد:
أن هذه مبادرة من صفية «رحمها الله» لمواجهة رجل تسلل
إلى موضع قريب، وقد نجحت في المهمة التي أحبت أن تبادر لإنجازها، ثم
زاد الآخرون ما شاؤوا على ذلك إكراماً
لولدها الزبير، ولآل
الزبير. ولعل هذه الزيادات لا تبعد كثيراً
عن نشاطات عروة ونظرائه ممن يسيرون في نفس الخط الذي هو
فيه.
ولا ندري كيف يربط السيف على الذراع، ولا ندري أيضاً
كيف يمكن تفسير هذه الاختلافات والتناقضات لنصوص هذه الرواية، فإن ذلك
مما يضعف وثوقنا بها أيضاً.
وقال
أبو سفيان لحيي بن أخطب:
قد نفدت علافتنا فهل عندكم من علف؟!
فقال حيي:
نعم.
فكلم
كعب بن أسد، فقال:
مالنا مالك. فأرسل المشركون إليهم عشرين بعيراً،
فحملوها لهم شعيراً،
وتمراً
وتبناً،
وخرجوا بها إلى قريش، فلما كانوا بصفنة،
وهم يريدون أن يسلكوا العقيق، جاؤوا
جمعاً
من بني عمرو بن عوف، وهم يريدون منازلهم بأنصاف النهار، يطلبونهم،
وهم عشرون رجلاً،
فيهم أبو لبابة، وعويم بن ساعدة ومعن بن عدي، خرجوا لميت مات منهم في
أطمهم ليدفنوه.
فناهضوا الحمولة، وقاتلهم القرشيون ساعة، وكان فيهم
ضرار بن الخطاب، فمنع الحمولة، ثم جُرِحَ
وجَرَحَ،
ثم
أسلموها،
وكثرهم المسلمون، وانصرفوا
بها
يقودونها، حتى أتوا بني عمرو بن عوف، فدفنوا ميتهم، ثم ساروا إلى رسول
الله «صلى الله عليه وآله» بها.
فكان أهل الخندق يأكلون منها، فتوسعوا بذلك، وأكلوه حتى
نفد، ونحروا من تلك الإبل أبعرة في الخندق، وبقي منها ما بقي حتى دخلوا
به المدينة.
فلما رجع ضرار بن الخطاب أخبرهم الخبر، فقال أبو سفيان:
إن حيياً
لمشؤوم، ما أعلمه إلا قطع بنا،
ما نجد ما نتحمل عليه إذا رجعنا([100]).
ولكننا نسجل تحفظاً هنا:
ينطلق من كلام أبي سفيان هذا، فإن
حيياً
لم يقطع بهم. كما أن هذه الغنيمة لم تكن خيلاً ولا إبلاً بل كانت
شعيراً
وتمراً
وتبناً،
وبعض الإبل، فما معنى قوله: ما نجد ما نتحمل عليه إذا رجعنا.
وكان
رجال
يستأذنون أن يطلعوا إلى أهليهم، فيقول «صلى الله عليه
وآله»: إني أخاف عليكم بني قريظة، فإذا
ألحوا
يأمرهم بأخذ السلاح معهم.
«وكان فتى حديث عهد بعرس، فأخذ سلاحه وذهب، فإذا امرأته
قائمة بين البابين، فهيأ لها الرمح ليطعنها، فقالت:
اكفف حتى ترى ما في بيتك، فإذا بحية على فراشه، فركز فيها رمحه،
فاضطربت، وخر الفتى ميتاً.
فما يدري أيهما كان أسرع موتاً.
فقال رسول الله ـ لما أخبر بذلك ـ:
إن بالمدينة جناً
قد
أسلموا،
فإذا رأيتم منهم شيئاً فأذنوه ثلاثة أيام، فإن
بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما
هو شيطان»([101]).
والذي يلفت نظرنا في هذا النص:
ألف:
لماذا يؤاذنونه ثلاثة أيام، لا أقل ولا أكثر؟! فإن الجن
إذا كان مؤمناً، فإنه لا يعتدي على الناس، ولا يأخذ فراش الناس، ويكون
فيه.
ب:
لماذا يبادر إلى طعن زوجته بالرمح إذا رآها بين البابين
ألم يكن بوسعه أن يسألها عن سبب كونها في ذلك المكان؟ وهل وجودها في
هذا المكان دليل خيانة وانحراف؟!
ج:
هل الجن قادر على مواجهة الإنسان بهذه الصورة؟
وهل لم يكن بوسع تلك الحية الجنية أن تتخلص من رمح ذلك
الفتى؟!
وهل إذا مات الجن يبقى جسده ماثلاً
للعيان؟ ويكون من لحم ودم؟!.
إشتباك
مع الإخوة:
وخرجت طليعتان للمسلمين ليلاً، فالتقتا،
ولا يشعر بعضهم ببعض، ولا يظنون إلا أنهم العدو، فكانت بينهم جراحة
وقتل، ثم نادوا بشعار الإسلام: حم، لا ينصرون.
فكف بعضهم عن بعض، وجاؤوا، فقال رسول الله «صلى الله
عليه وآله»: جراحكم في سبيل الله، ومن قتل منكم فإنه شهيد. فكانوا بعد
ذلك إذا دنا المسلمون
بعضهم من
بعض نادوا
بشعارهم([102]).
قال سبط بن الجوزي:
إن الإمام الحسن «عليه السلام» قال لمعاوية: «نظر النبي
«صلى الله عليه وآله» إليك يوم الأحزاب، فرأى أباك على جمل يحرض الناس
على قتاله،
وأخوك يقود الجمل، وأنت تسوقه، فقال: «لعن الله الراكب والقائد
والسائق»([103]).
محمد بن
إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان، وأحمد بن
إدريس،
عن محمد بن عبد الجبار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي
بصير، عن أحدهما «عليهما
السلام»
في قول الله تعالى:
﴿أحِل لكُمْ ليْلةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلى نِسَآئِكُمْ..﴾
الآية([104]).
فقال:
نزلت في خوات بن جبير الأنصاري، وكان مع النبي «صلى
الله عليه وآله» في الخندق وهو صائم، فأمسى وهو على تلك الحال،
وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية
إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والشراب.
فجاء خوات إلى أهله حين أمسى، فقال:
هل عندكم طعام؟!
فقالوا:
لا تنم حتى نصلح لك طعاماً.
فاتكأ فنام، فقالوا له:
قد فعلت؟
قال:
نعم.
فبات على تلك الحال، فأصبح ثم غدا إلى الخندق، فجعل
يغشى عليه، فمر به رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فلما رأى الذي به
أخبره كيف كان أمره،
فأنزل الله عز وجل فيه الآية:
﴿..وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لكُمُ الخَيْطُ
الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ..﴾([105]).
والحديث صحيح السند:
كما هو ظاهر،
لكن صرح في رسالة المحكم والمتشابه بأن ذلك كان حين حفر الخندق في شهر
رمضان المبارك،
وأن
اسم الرجل هو مطعم بن جبير.
ونقول:
1 ـ
الذي نعرفه في رجال الصحابة هو جبير بن مطعم، لا العكس.
2 ـ
قد وصف رواية القمي والسيد المرتضى خوات بن جبير بأنه
كان حينئذٍ شيخاً
كبيراً
ضعيفاً.
مع أنهم يقولون:
إن خوات بن
جبير قد توفي سنة أربعين، أو اثنتين وأربعين وهو ابن أربع وسبعين سنة([106])،
ومعنى ذلك هو أنه كان يوم الخندق في عز شبابه، وغاية نشاطه وقوته.
وقيل:
كان سنه حين
توفي إحدى وسبعين سنة([107])
عن ابن نمير. وإن كان الإستيعاب قد سجل أربعاً
وتسعين سنة([108])،
ولعلها تصحيف سبعين، فإن الاشتباه بينهما كثير.
3 ـ
إن الرواية
تقول: إنها نزلت في خوات، لكن روايات أخرى ذكرت: أنها نزلت في صرمة بن
قيس أو غيره([109]).
4 ـ
الرواية تقول: إن المسلمين كانوا إذا نام أحدهم قبل أن
يفطر حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة ـ وهذا هو المروي
بكثرة عجيبة ـ من طرق غير أهل البيت «عليهم
السلام».
ونقول:
إن هذه كانت
طريقة أهل الكتاب. وقد نزلت الآية لردع المسلمين عنها([110])
فلعل بعض المسلمين بسبب انبهاره قد انساق وراء أهل الكتاب في ذلك فنزلت
الآية لتردعهم عنه، وقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» أيضاً:
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب
أكلة
السحر([111]).
([1])
راجع: السيرة النبوية لابن كثير ج3 ص209.
([2])
راجع: شذرات الذهب ج1 ص11
والتنبيه والإشراف ص216 وراجع سيرة مغلطاي ص56 ومرآة الجنان ج1
ص9 و 10 وإمتاع الأسماع ج1 ص239 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص562
وبه جزم الواقدي، وابن سعد، والبلاذري، والنووي في الروضة
والقطب، وأنساب الأشراف ج1 ص345 وراجع: بهجة المحافل ج1 ص271
والمواهب اللدنية ج1 ص115 وتفسير القمي ج2 ص185 والبحار ج20
ص228 عنه والمغازي للواقدي ج2 ص440 و 491 وتاريخ الخميس ج1
ص492 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص12.
([3])
وفاء الوفاء ج1 ص301 عن ابن عقبة وراجع: فتح الباري ج7 ص301
وتاريخ الخميس ج1 ص484 و 490 و 492 وحبيب السير ج1 ص364 وإمتاع
الأسماع ج1 ص239 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص562 والمغازي للواقدي
ج1 ص419.
([4])
راجع هذا القول في: شذرات الذهب ج1 ص11 وتاريخ ابن الوردي ج1
ص162 وفيه: بضع وعشرون. وكذا في إعلام الورى ص91 وكذا في مناقب
آل أبي طالب ج1 ص198 ومرآة الجنان ج1 ص10 لكن ظاهر عدد منهم:
أنهم يتكلمون عن مدة ما قبل قتل عمرو بن عبد ود وكذا في مجمع
البيان ج8 ص342 والبحار ج20 ص202 و 252 والسيرة النبوية لابن
كثير ج3 ص309.
([5])
التنبيه والإشراف ص216 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 قسم 2
ص30 لكنه قال: ولم تكن حرب وراجع: السيرة النبوية لدحلان ج2
ص12 وزاد المعاد ج2 ص118.
([6])
العبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 قسم 2 ص30 وتاريخ الخميس ج1
ص484 و 492 وراجع: إمتاع الأسماع ج1 ص239 وسبل الهدى والرشاد
ج4 ص562 وحدائق الأنوار ج1 ص52 وج 2 ص587 والكامل في التاريخ
ج2 ص180 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص238 ونهاية الأرب ج17 ص175
وبهجة المحافل ج1 ص271 وجوامع السيرة النبوية ص149 والإكتفاء
للكلاعي ج2 ص165 وراجع سعد السعود ص138.
([7])
البدء والتاريخ ج4 ص217.
([8])
تاريخ الخميس ج1 ص484 و 492.
([9])
سيرة مغلطاي ص56 وراجع: سبل الهدى والرشاد ج4 ص562 والوفاء
ص694 وتاريخ الخميس ج1 ص484 و 492 والسيرة النبوية لدحلان ج2
ص12 وراجع: المواهب اللدنية ج1 ص115 وحبيب السير ج1 ص364.
([10])
راجع: الوفاء ص694 وإمتاع الأسماع ج1 ص235 والبداية والنهاية
ج4 ص104 وكشف الغمة للأربلي ج1 ص202 والكامل في التاريخ ج2
ص180 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص238. وراجع: ومناقب آل أبي طالب
ج1 ص198 والإرشاد للمفيد ص51 وتاريخ مختصر الـدول ص95 وسبل
الهدى والرشاد ج4 ص562 ونهاية الأرب ج17 ص175 والمغـازي
للـواقـدي ج2 ص491 وتاريـخ الخـميس ج1 ص490 = = وأنساب
الأشراف ج1 ص345 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص201 وتاريخ
الإسلام للذهبي (الواقدي) ص238. إلا أن يقال: إن ذلك ناظر إلى
فترة ما قبل المفاوضة على ثلث ثمار المدينة، أو ما قبل قتل
عمرو بن عبد ود كما هو صريح عدد من المصادر الآنفة الذكر. وإن
كان ظاهر الواقدي وغيره خلاف ذلك.
([11])
أحجرناهم: حصرناهم.
([12])
وشهراً كريتاً: تاماً كاملاً.
([13])
راجع: السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص366.
([14])
السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص269 وعيون الأثر ج2 ص66.
([15])
نهاية الأرب ج17 ص171 و 172، وراجع المصادر التالية: عيون
الأثر ج2 ص58 وتاريخ الخميس ج1 ص484 والمغازي للواقدي ج2 ص460
والسيرة= = الحلبية ج2 ص315 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص4 و 5
وإمتاع الأسماع ج1 ص228 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص528.
([16])
إمتاع الأسماع ج1 ص231 والمغازي للواقدي ج2 ص467.
([17])
أنساب الأشراف ج1 ص343.
([18])
نهاية الأرب ج17 ص171 و 172 وعيون الأثر ج2 ص58.
([19])
المغازي للواقدي ج2 ص457.
([20])
المغازي للواقدي ج2 ص474.
([21])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص528.
([22])
إمتاع الأسماع ج1 ص230 وستأتي بقية المصادر حين الحديث عن
القتال، وتناوب المشركين على الخندق.
([23])
راجع: المغازي للواقدي ج2 ص463 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص9
وتاريخ الخميس ج1 ص484 و 485 وراجع: سبل الهدى والرشاد ج4 ص529
والسيرة الحلبية ج2 ص324.
([24])
تاريخ الخميس ج1 ص484 وتقدم حديث عائشة في ذلك.
([25])
المغازي للواقدي ج2 ص464 وإمتاع الأسماع ج1 ص230 وسبل الهدى
والرشاد ج4 ص530 والسيرة الحلبية ج2 ص324.
([26])
عيون الأثر ج2 ص58 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص163 وقد أطلق كلامه
في أن الزبير كان حارس النبي «صلى الله عليه وآله» في الخندق
وكذا في السيرة الحلبية ج3 ص327 والمواهب اللدنية ج1 ص217
والغدير ج7 ص202 عنهما وعن عيون الأثر ج2 ص316 وشرح المواهب
للزرقاني ج3 ص204.
([27])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص529.
([28])
إمتاع الأسماع ج1 ص230 وتقدمت نصوص أخرى أيضاً.
([29])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص529 والمغازي للواقدي ج2 ص465.
([30])
المغازي للواقدي ج2 ص451 و 474 وراجع: إمتاع الأسماع ج1 ص234.
([31])
المغازي للواقدي ج2 ص474.
([32])
وفاء الوفاء ج1 ص301 عن الطبراني، وتاريخ الخميس ج1 ص489.
([33])
غلوة نشابة: مقدار رمية سهم.
([34])
تفسير القمي ج2 ص186 والبحار ج20 ص230 عنه.
([35])
راجع: المغازي للواقدي ج2 ص463 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص9
وتاريخ الخميس ج1 ص484 و 485. وراجع: سبل الهدى والرشاد ج4
ص529 والسيرة الحلبية ج2 ص324 وإمتاع الأسماع ج1 ص229 و 230.
([36])
راجع: المغازي للواقدي ج2 ص465 وإمتاع الأسماع ج1 ص230.
([37])
المغازي للواقدي ج2 ص454 وراجع: سبل الهدى والرشاد ج4 ص518
وإمتاع الأسماع ج1 ص225 والسيرة الحلبية ج2 ص314.
([38])
المغازي للواقدي ج2 ص464.
([39])
شرح الأخبار ج1 ص292 ملخصاً.
([40])
السيرة الحلبية ج2 ص315. وراجع: نهاية الأرب ج17 ص171 و 172
وراجع المصادر التالية: إمتاع الأسماع ج1 ص230 و 231 والسيرة
النبوية لدحلان ج2 ص8 و 5 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص530 والمغاري
للواقدي ج2 ص468 وعيون الأثر ج2 ص58.
والفقرة الأخيرة موجودة أيضاً في المصادر التالية: تاريخ
الخميس ج1 ص486 وحدائق الأنوار ج2 ص590 والإرشاد للشيخ المفيد
ص51 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص198 وكشف الغمة للأربلي ج1 ص202
والكامل في التاريخ ج2 ص180 والسيرة النبوية لابن كثيرة ج3
ص200 و 201 وفتح الباري ج7 ص301 و 307 عن ابن إسحاق.
([41])
حبيب السير ج1 ص363.
([42])
تاريخ الخميس ج1 ص484.
([43])
إمتاع الأسماع ج1 ص231 والمغازي للواقدي ج2 ص468.
([44])
راجع: مرآة الجنان ج1 ص10 وفتح الباري ج7 ص302 وبهجة المحافل
ج1 ص266 وتاريخ ابن الوردي ج1 ص162 وراجع: تاريخ اليعقوبي ج2
ص50.
([45])
إمتاع الأسماع ج1 ص230.
([46])
راجع: المغازي للواقدي ج2 ص465 وإمتاع الأسماع ج1 ص230.
([47])
إمتاع الأسماع ج1 ص230 وراجع: المغازي للواقدي ج2 ص465 السيرة
النبوية لدحلان ج2 ص8.
([48])
السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص226.
([49])
زرق فلاناً: رماي بالمزراق، أي الرمح القصير.
([50])
السيرة الحلبية ج2 ص323.
([51])
تجارب الأمم ج2 ص153.
([52])
سيرة المصطفى ص499.
([53])
المغازي للواقدي ج2 ص468.
([54])
المغازي للواقدي ج2 ص466.
([55])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص514 وكشف الاستار عن مسند البزار ج2
ص332 و 333 ومجمع الزوائد ج6 ص135 وأسد الغابة ج4 ص297 عن أبي
نعيم وأبي موسى والإصابة ج3 ص358 والسيرة الحلبية ج2 ص315
وراجع: الرسول العربي وفن الحرب ص245.
([56])
كشف الأستار عن مسند البزار ج2 ص333.
([57])
مجمع الزوائد ج6 ص135 والإصابة ج3 ص358.
([58])
راجع: الإصابة ج2 ص56 وتهذيب تاريخ دمشق ج6 ص183 ـ 185 وغير
ذلك من كتب التراجم.
([59])
المغازي للواقدي ج2 ص464.
ولا بأس بمراجعة: سبل الهدى والرشاد ج4 ص529 و 530 والسيرة
الحلبية ج2 ص324 وإمتاع الأسماع ج1 ص229 و 230.
([60])
الهيعة: الصوت المفزع.
([61])
راجع: المغازي للواقدي ج2 ص466 و 467 وإمتاع الأسماع ج1 ص230 و
231 وتاريخ الخميس ج1 ص85 4.
([62])
عرق وجهه: أي أغلاه بالماء الحار.
([63])
راجع النص المتقدم في: إمتاع الأسماع ج1 ص231 و 232 والمغازي
للواقدي ج2 ص468 و 469 وراجع قسماً مما تقدم في المصادر
التالية: سبل الهدى والرشاد ج4 ص537 والسيرة النبوية لابن كثير
ج3 ص207 والبداية والنهاية ج4 ص108 والكامل في التاريخ ج2 ص182
وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص240 وراجع ص241 وشرح بهجة المحافل ج1
ص268 والمواهب اللدنية ج1 ص113 وجوامع السيرة النبوية ص151
وإعلام الورى (ط دار المعرفة) ص101 ومجمع البيـان ج8 = = ص344
والسيرة الحلبية ج2 ص321 وبحار الأنوار ج20 ص206 و 207 وتاريخ
الخميس ج1 ص488 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص8 وأنساب الأشراف
ج1 ص347 والإكتفاء للكلاعي ج2 ص170 و 171 ودلائل النبوة ص436
والعبر وديوان المتبدأ والخبر ج2 ق 2 ص30 وعيون الأثر ج2 ص63
والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص238 ودلائل النبوة للبيهقي ج3
ص404 و 441 و 442.
([64])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص537 وراجع: الكامل في التاريخ ج2 ص182
وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص240 والسيرة النبوية لابن هشام ج3
ص238 و 239 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص8 وبحار الأنوار ج20
ص231 و 232 و 207 ومجمع البيان ج8 ص344 وتاريخ الخميس ج1 ص488
ودلائل النبوة ص436 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق 2 ص30
وعيون الأثر ج2 ص63 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص240
والبدء والتاريخ ج4 ص218 وبهجة المحافل وشرحه ج1 ص267 و 268
والمواهب اللدنية ج1 ص113 وجوامع السيرة النبوية ص151
والإكتفاء للكلاعي ج2 ص170 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص207
و 208 وسير أعلام النبلاء ج1 ص281 و 282 وراجع مسند أحمد ج6
ص141 والسيرة الحلبية ج2 ص321 وصحيح البخاري ج3 ص23.
([65])
الكامل في التاريخ ج2 ص182 والبداية والنهاية ج4 ص108 ودلائل
النبوة للبيهقي ج3 ص28 وج 3 ص441.
([66])
هذا العبارة ذكرها الواقدي، والدياربكري، وابن سيد الناس، وابن
هشام، وابن كثير، والكلاعي، وابن إسحاق والبيهقي فراجع الهامش
التالي.
([67])
راجع فيما تقدم ـ وإن اختلفت في بعض الألفاظ ـ المصادر
التالية: سبل الهدى والرشاد ج4 ص525 والمغازي للواقدي ج2 ص469
والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص207.
وراجع: تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص265 و 266 والبداية
والنهاية ج4 ص108 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص240 والروض الأنف
ج2 ص192 ودلائل النبوة للبيهقي ج3 ص440 و 441 والإكتفاء
للكلاعي ج2 ص169 وسير أعلام النبلاء ج1 ص281 وعيون الأثر ج2
ص62 و 63 وتاريخ الخميس ج1 ص488 والسيرة النبوية لابن هشام ج3
ص237.
([68])
البداية والنهاية ج4 ص108.
([69])
إمتاع الأسماع ج1 ص133 والسيرة الحلبية ج2 ص227 و 229 وسبل
الهدى والرشاد (ط دار الكتب العلمية) ج4 ص201.
([70])
عيون الأثر ج2 ص72 والسيرة
النبوية لابن هشام ج3 ص250 وتهذيب سيرة ابن هشام ص200 والسيرة
النبوية لدحلان ج2 ص17 وشرح بهجة المحافل ج1 ص272 عن البغوي
والمواهب اللدنية ج1 ص116 وجوامع السيرة النبوية ص154 والبداية
والنهاية ج4 ص121 ونهاية الأرب ج17 ص191 والسيرة النبوية لابن
كثير ج3 ص233 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص267 وسير أعلام
النبلاء ج1 ص287 والسيرة الحلبية ج2 ص238 وفتح الباري ج7 ص317
وتفسير القمي ج2 ص188 وبحار الأنوار ج20 ص232 والإستيعاب بهامش
الإصابة ج4 ص311 والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج8 ص387
والتراتيب الإدارية ج2 ص113 وج 1 ص462 و 453 و 454 والإصابة ج4
ص302 و 303 عن ابن إسحاق، وعن البخاري في الأدب المفرد. وفي
التاريخ بسند صحيح، والمستغفري، وأبي موسى.
([71])
تاريخ الخميس ج1 ص489 عن مسلم. كذا في المشكاة.
([72])
تاريخ الأمم والملوك ج2 ص241 ودلائل النبوة لأبي نعيم ص435 و
436 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص266 وسير أعلام النبلاء
ج1 ص284 والطبقات الكبرى ج3 قسم 2 ص3 وكنز العمال ج1 ص280 عن
ابن عساكر.
([73])
مستدرك الحاكم ج3 ص31 وتلخيصه للذهبي بهامشه وصححاه ودلائل
النبوة للبيهقي ج3 ص450 و 451 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي)
ص249 و 250.
([74])
سيأتي ذلك في الفصل الأخير من هذا الباب.
([75])
تاريخ الخميس ج1 ص488 عن الترمذي في الشمائل.
([76])
راجع: دلائل النبوة للبيهقي ج3 ص439 و 440 والسيرة النبوية
لابن كثير ج3 ص206 و 207 والبداية والنهاية ج4 ص107 وكنز
العمال ج10 ص286.
([77])
عيون الأثر ج2 ص56 وفتح الباري ج7 ص309 بإسناد صحيح عن
الطبراني.
([78])
عيون الأثر ج2 ص56.
([79])
تاريخ الخميس ج1 ص484.
([80])
راجع المصادر التالية: المغازي للواقدي ج2 ص260 وامتاع الاسماع
ج1 ص228 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص4 و 5 والسيرة الحلبية ج2
ص315 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص528.
([81])
إمتاع الأسماع ج1 ص228 والمغازي للواقدي ج2 ص460 و 461.
([82])
إمتاع الأسماع ج1 ص229 والمغازي للواقدي ج2 ص462.
([83])
تاريخ الخميس ج1 ص489 عن الوفاء عن الطبراني ووفاء الوفاء ج1
ص301 و 302 عن الطبراني وكنز العمال ج10 ص284.
([84])
راجع المصادر التالية: وفاء الوفاء ج1 ص302 عن البزار. وسبل
الهدى والرشاد ج4 ص524 و 525 عن ابن إسحاق، والواقدي، وأبي
يعلى، والبزار بسند حسن عن الزبير، بسند رجاله رجال الصحيح عن
عروة مرسلاً، وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص241 و 242 وكنز العمال
ج10 ص286 وأسد الغابة ج2 ص6 وتاريخ الخميس ج1 ص489 عن الوفاء،
والهيثمي، والسيرة الحلبية ج2 ص317 ومسند أحمد والسيرة النبوية
لابن هشام ج3 ص239 ودلائل النبوة للبيهقي ج3 ص442 و 443 وأمالي
الشيخ الطوسي ص267 و 268 وبحار الأنوار ج20 ص245 والإكتفاء
للكلاعي ج2 ص171 والسيرة النبوية لابن
كثير ج3 ص208 و 209 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص240
والكامل في التاريخ ج2 ص181 والبداية والنهاية ج4 ص109 وأنساب
الأشراف ج1 ص347 ووفاء الوفاء ج1 ص303 وغرر الخصائص الواضحة
ص358.
([85])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص525.
([86])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص524 و 525.
وراجع: المغازي للواقدي ج2 ص462 و 463 وسيرة المصطفى ص505 و
506 وتاريخ الخميس ج1 ص489 ودلائل النبوة للبيهقي ج3 ص442 و
443 والإكتفاء ج2 ص171.
([87])
أنساب الأشراف ج1 ص347 والمغازي للواقدي ج2 ص462 و 463 وفاء
الوفاء ج1 ص302 و 303 وتاريخ الخميس ج1 ص489.
([88])
تاريخ الخميس ج1 ص489 وراجع: شرح النهج للمعتزلي ج15 ص15
وراجع: الروض الأنف ج3 ص281 ووفاء الوفاء ج1 ص302 وسبل الهدى
والرشاد ج4 ص564 وأسد الغابة ج2 ص6.
([89])
السيرة الحلبية ج2 ص317.
([90])
المعارف (ط سنة 1960م) ص312 وغرر الخصائص الواضحة ص358 وأسد
الغابة ج1 ص6.
([91])
كنز العمال ج10 ص286.
([92])
شرح النهج للمعتزلي الشافعي ج13 ص282.
([93])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص564.
([94])
شرح النهج للمعتزلي ج15 ص16 والمغازي للواقدي ج1 ص288.
([95])
راجع: الروض الأنف ج3 ص281 ووفاء الوفاء ج1 ص302 و 303 وتاريخ
الخميس ج1 ص489 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص564.
([96])
هامش السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص240 تحقيق الأبياري،
والسقا، وشلبي.
([97])
وفاء الوفاء ج1 ص302 وراجع: المغازي للواقدي ج2 ص288 وشرح
النهج للمعتزلي ج15 ص15 و 16.
([98])
وفاء الوفاء ج1 ص303 وتاريخ الخميس ج1 ص489.
([99])
المصدران السابقان.
([100])
راجع القصة في: سبل الهدى والرشاد ج4 ص539 و 540 ووفاء الوفاء
ج1 ص304 وتاريخ الخميس ج1 ص492 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص8
والسيرة الحلبية ج2 ص323.
([101])
إمتاع الأسماع ج1 ص234 و 235 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص538
والمغازي ج2 ص475.
([102])
إمتاع الأسماع ج1 ص234 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص537 و 538
والمغازي للواقدي ج2 ص474 والسيرة الحلبية ج2 ص321.
([103])
تذكرة الخواص ص201 والغدير ج10 ص169 عنه.
([104])
الآية 187 من سورة البقرة.
([105])
الكافي ج4 ص99 وتفسير نور الثقلين ج1 ص144 و 145 وتفسير القمي
ج1 ص66 ومن لا يحضره الفقيه (ط مؤسسة النشر الإسلامي) ج2 ص130
و 131 والوسائل ج7 ص80 و 81 ورسالة المحكم والمتشابه ص10
والبحار ج20 ص241 و 242 وتفسير البرهان ج1 ص186 و 187 عن
الكافي والقمي، وعن تفسير العياشي. ومجمع البيان ج1 ص280.
([106])
راجع: الإصابة ج1 ص458 وسير أعلام النبلاء ج2 ص330 وأسد الغابة
ج2 ص126 وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد (ط دار صار) ج3 ص477 و
478 والثقات ج3 ص109 ومشاهير علماء الأمصار ص39 وخلاصة تذهيب
تهـذيب = =
الكمال ص108 والمستدرك للحاكم ج3 ص412 وسير أعلام النبلاء ج2
ص330.
([107])
تهذيب التهذيب ج3 ص171.
([108])
الإستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج1 ص4 44 وكذا في تهذيب
الأسماء ج1 ص179.
([109])
الدر المنثور ج1 ص197 و 198 عن مصادر كثيرة.
([110])
الدر المنثور ج1 ص198 عن عبد بن حميد.
([111])
الدر المنثور ج1 ص198 عن ابن أبي شيبة وأبي داود، والترمذي،
والنسائي.
|