|
كيف انتهت الحرب الخندق؟!
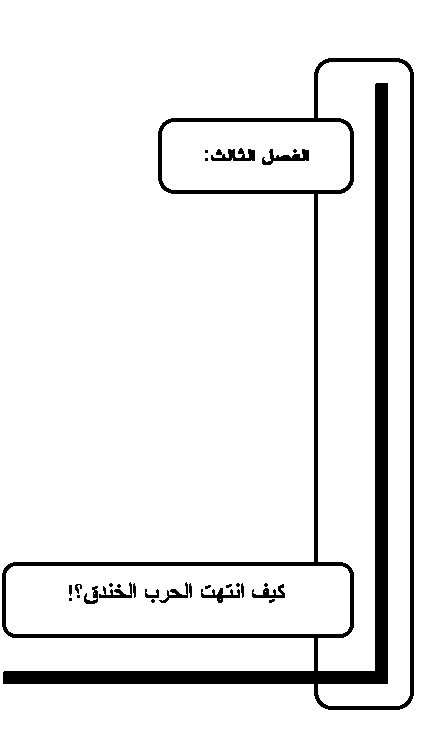
ما فعله نعيم بن مسعود:
لقد حاول المؤرخون
والمحدثون
الذين توجههم التيارات والقوى والتعصبات السياسية، والمذهبية، والأحقاد
ـ حاولوا ـ التعتيم على النصر المؤزر الذي سجله علي أمير المؤمنين
«عليه السلام» في حرب الأحزاب بطريقة أخرى غير طريقة تضخيم الأمور،
وادعاء حصول قتال شغلهم عن صلاة العصر، وغيرها.
فادعوا:
أن نعيم بن مسعود قد قام بدور فاعل وأساس في تخذيل
القوم، وإلقاء
الريب والشك ببعضهم البعض فيما بينهم.
فيدعي المؤرخون:
أن نعيم بن مسعود الغطفاني جاء إلى رسول الله «صلى الله
عليه وآله» مسلماً
ـ وكان من
دواهي العرب ـ فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت، وإن قومي لم يعلموا
بإسلامي، فأمرني بما شئت أنته إليه([1]).
فقال له «صلى الله عليه وآله»:
إنما أنت رجل واحد فينا، وإنما غناؤك أن تخذل عنا ما
استطعت،
وعليك بالخداع، فإن الحرب خدعة.
وحسب نص المقدسي:
أنه «صلى الله عليه وآله» قال له: إن الحرب خدعة، فاحتل
لنا.
فخرج نعيم حتى أتى بني قريظة، وكان
نديماً لهم، فقال:
يا بني قريظة، قد عرفتم ودِّي
إياكم، وخاصة ما بيني وبينكم.
قالوا:
صدقت، لست عندنا بمتهم.
فقال لهم:
إن قريشاً وغطفان ومن التف معهم جاؤوا
لحرب محمد، فإن ظاهرتموهم عليه، فليسوا كهيئتكم،
وذاك أن البلد بلدكم، به أموالكم، وأولادكم، ونسـاؤكم،
لا تقـدرون
أن تتحولـوا
إلى غيره. فـأمـا
قـريش
وغطفان، فإن أموالهم، وأبناءهم، ونساءهم ببلاد غير بلادكم، فإن رأوا
نهبة وغنيمة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم، وخلوا بينكم وبين
الرجل. والرجل ببلادكم لا طاقة لكم به، وإن خلا لكم.
زاد الواقدي:
«وقد كبر عليهم جانب محمد، أجلبوا عليه بالأمس
إلى الليل، فقتل رأسهم عمرو بن
عبد
ود وهربوا منه مجرحين»،
فلا تقاتلوا القوم حتى تأخذوا منهم رهناً
من أشرافهم، يكونون بأيديكم، ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمداً حتى
يناجزوه.
قالوا:
لقد أشرت علينا برأي ونصح.
ثم خرج
حتى
أتى قريشاً.
فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه:
يا معشر قريش،
قد عرفتم ودِّي
إياكم، وفراقي محمداً، وقد بلغني أمر رأيت حقاً
علي أن أبلغكم، نصحاً
لكم، فاكتموا عليَّ.
قالوا:
نفعل.
قال:
اعلموا: أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا بينهم وبين
محمد، وقد أرسلوا ـ وأنا عندهم ـ أن قد ندمنا على ما صنعنا، فهل يرضيك
عنا: أن نأخذ من القبيلتين (مئة رجل، كما عند المقدسي) من قريش وغطفان
رجالاً من أشرافهم، وكبرائهم، ونعطيكهم، فتضرب أعناقهم،
ثم نكون معك على
من
بقي منهم؟
أضافت بعض المصادر:
«وترد جناحنا الذي كسرت إلى ديارهم ـ يعنون بني
النضير»، فإن بعثت إليك يهود، يلتمسون منكم رهناً
من رجالكم فلا تدفعوا إليهم رجلاً واحداً.
فوقع ذلك من القوم.
وخرج حتى أتى غطفان، فقال:
يا معشر غطفان، أنتم أصلي وعشيرتي، وأحب الناس إلي، ولا
أراكم تتهموني.
قالوا:
صدقت.
قال:
فاكتموا عليَّ.
قالوا:
نفعل.
ثم قال لهم مثل ما قال لقريش، وحذرهم مثل ما حذرهم.
فأرسل أبو
سفيان([2])،
ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان،
فقال لهم:
إنا لسنا بدار مقام، وقد هلك الخف والحافر، فاغدوا
للقتال حتى نناجز محمداً، ونفرغ مما بيننا وبينه.
فأرسلوا إليه:
أن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً (وكان قد
أحدث فيه بعض الناس شيئاً فأصابه ما لم يخفَ
عليكم) ومع ذلك فلسنا نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً
من رجالكم (سبعين رجلاً)، يكونون بأيدينا
ثقة حتى نناجز محمداً، فإننا
نخشى ـ إن ضرستكم الحرب، واشتد عليكم القتال ـ أن تشمروا إلى بلادكم،
وتتركونا والرجل في بلدنا، ولا طاقة لنا بذلك من محمد.
وأرسلت غطفان مسعود بن رخيلة في رجال بمثل ما راسلهم به
أبو سفيان..
فلما رجعت الرسل بالذي قالت بنو قريظة قالت قريش
وغطفان: والله، إن الذي حدثكم به نعيم بن مسعود لحق.
فأرسلوا إلى بني قريظة:
إنَّا
والله ما ندفع إليكم رجلاً واحداً، فإن
كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا([3]).
فقالت بنو قريظة حين أدت إليهم
الرسل:
إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق، ما يريد القوم إلا
أن يقاتلوا، فإن
وجدوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم، وخلوا بينكم
وبين الرجل. فأرسلوا إلى القوم: إنا ـ والله ـ لا نقاتل معكم حتى
تعطونا رهناً.
قالوا:
وتكررت رسل قريش وغطفان إلى بني قريظة، وهم يردون عليهم
بما تقدم، فيئس هؤلاء من نصر هؤلاء. وتخاذل القوم، واتهم بعضهم بعضاً.
وذلك في زمن شات، وليال باردة، كثيرة الرياح، تطرح أبنيتهم، وتكفأ
قدورهم الخ..
ولما طالب أبو
سفيان حيي بن أخطب بالأمر، حاول حيي أن يقنع بني قريظة بالعدول عن ذلك،
فلم يفلح([4]).
ورواية القمي:
تختلف عن هذه
الرواية فلتراجع([5]).
ونقول:
كان ما تقدم هو النص الذي يذكره أكثر المؤرخين مطولاً
أو ملخصاً،
لهذه القضية. وتساورنا شكوك حول صحة ذلك،
ونرى
أن ما جرى لم يكن بهذا الشكل، وذلك بالنظر إلى الأمور التالية:
أولاً:
يقول البعض عن
دور نعيم: «يمكن أن يكون في ذلك مبالغة، لأن القصة تروى عن نعيم نفسه،
بواسطة رواة أشجع»([6]).
ثانياً:
بالنسبة لطلب الرهائن تقول رواية نعيم بن مسعود:
إن
ذلك قد كان بعد نقض بني قريظة للعهد مع النبي «صلى الله عليه وآله»،
وبعد أن طال الحصار على قريش،
وبإيحاء من نعيم بن مسعود بالذات.
لكن هناك نص يقول:
إنهم قد طلبوا الرهائن حين كلمهم حيي بن أخطب في نقض
العهد،
فإنهم طلبوا منه: أن يأخذ لهم رهائن من قريش وغطفان تكون عندهم،
تسعين رجلاً من أشرافهم([7])،
وذلك قبل إسلام نعيم.
وقد حاول البعض:
أن يحل هذا
الإشكال، فقال: «قد يحتمل أن تكون قريظة لما يئسوا من انتظام أمرهم مع
قريش وغطفان بعثوا إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» يريدون منه
الصلح على أن يرد بني النضير إلى المدينة»([8]).
وهو حل غير مقبول:
لأنهم بعد أن يئسوا من انتظام أمرهم مع المشركين،
وصيرورتهم في الموقف الأضعف، وأصبحوا يخشون على أنفسهم من مغبة غدرهم،
وعواقب خيانتهم وما جنته أيديهم، لم يكونوا ليجرؤوا على اشتراط إرجاع
بني النضير إلى أراضيهم.
أضف إلى ذلك:
أن هذا الاحتمال الذي ذكره ابن كثير لا يحل
إشكال
أن يكون طلب الرهائن قبل إسلام نعيم. حسبما أوضحناه.
ثالثاً:
إننا لا نكاد نصدق دعوى نعيم: أن قريظة قد أرسلت بحضوره
إلى النبي «صلى الله عليه وآله» تعده بأخذ سبعين، أو تسعين رهينة من
أشراف قريش وغطفان ليقتلهم.
إذ
إن
نعيم بن مسعود نفسه كان من غطفان، فهل يجهر بنو قريظة أمام غطفاني ـ
مهما كانت درجة إخلاصه لهم ـ بأنهم يريدون أخذ أشراف قومه ليسلموهم إلى
القتل؟!.
وهل يمكن أن يصدقه المشركون:
أنه قد سمع ذلك حقاً
من بني قريظة؟!.
رابعاً:
لو صحت قصة نعيم
على
النحو المذكور آنفاً، لكان يجب أن نتوقع من حيي بن أخطب
موقفاً
آخر من بني قريظة. فيتملص من تعهداته لهم، ولا يسلم نفسه إلى القتل
بدخوله معهم في حصنهم بعد رحيل قريش، لأن لديه حجة واضحة، وهي أن الإخلال
وإفشال ما جمعه من كيد إنما من قبل بني قريظة أنفسهم، فإنهم هم الذين
أخلّوا
بتعهداتهم تجاه قريش، وليس العكس.
خامساً:
هناك العديد من الروايات التي تؤكد على أن النبي الأعظم
«صلى الله
عليه
وآله» نفسه هو الذي أفسد العلاقة بين قريش والمشركين من
جهة، وبين بني قريظة من جهة أخرى. وليس نعيم بن مسعود بل كان هو الآخر
غافلاً
عن حقيقة التدبير النبوي في هذا المجال.
والنصوص المشار إليها هي التالية:
1 ـ
قال ابن عقبة: إن نعيم
بن
مسعود كان يذيع ما يسمعه من الحديث،
فاتفق أنه مرّ
بالقرب من رسول الله «صلى الله عليه وآله» ذات يوم عشاء، فأشار إليه
«صلى الله عليه وآله» أن
تعال،
فجاء،
فقال: ما وراءك؟!.
فقال:
إنه قد بعثت قريش وغطفان إلى بني قريظة يطلبون منهم أن
يخرجوا إليهم فيناجزوك.
فقالت قريظة:
نعم، فأرسلوا إلينا بالرهن.
قال:
فقال له رسول الله «صلى الله عليه وآله»: إني مسر إليك
شيئاً فلا تذكره.
قال:
«إنهم قد أرسلوا إلي يدعونني إلى الصلح، وأرد بني
النضير إلى دورهم وأموالهم».
وإنما قال له
«صلى
الله عليه وآله»
ذلك على سبيل الخدعة الجائزة في الحرب.
فخرج نعيم بن مسعود عامداً
إلى غطفان.
وقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
الحرب خدعة. وعسى أن يصنع لنا.
فأتى نعيم غطفان وقريشاً فأعلمهم؛
فبادر القوم وأرسلوا إلى بني قريظة عكرمة وجماعة معه
ـ
فاتفق ذلك ليلة السبت
ـ
يطلبون منهم أن يخرجوا للقتال معهم، فاعتلت اليهود بالسبت. ثم أيضاً
طلبوا الرهن توثقة، فأوقع الله بينهم واختلفوا([9]).
ونعتقد:
أن هذه الرواية هي الأقرب إلى الصواب،
ويشهد لذلك ما يلي:
2 ـ
قال القمي:
إنه لما بلغ النبي «صلى الله عليه وآله» نقض بني قريظة للعهد، قال
«لعناء، نحن أمرناهم بذلك. وذلك أنه كان على عهد رسول الله «صلى الله
عليه وآله» عيون لقريش، يتجسسون خبره»([10]).
3 ـ
عن علي «عليه السلام» قال: الحرب خدعة. إذ حدثتكم عن
رسول الله «صلى الله عليه وآله» حديثاً،
فوالله، لأن
أخرّ
من السماء أو تخطفني الطير أحب إلي من أن أكذب على رسول
الله «صلى الله عليه وآله». وإذ حدثتكم عني، فإن الحرب خدعة.
فإن رسول الله «صلى الله عليه وآله»
بلغه:
أن بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان:
أنكم
إذا التقيتم أنتم ومحمد «صلى الله عليه وآله» أمددناكم وأعنَّاكم.
فقام النبي «صلى الله عليه وآله»،
فخطبنا فقال:
إن بني قريظة بعثوا إلينا: أنَّا إذا التقينا نحن وأبو
سفيان أمددونا وأعانونا.
فبلغ ذلك أبا سفيان، فقال:
غدرت يهود،
فارتحل عنهم([11]).
4 ـ
عن عائشة: كان نعيم رجلاً نموماً،
فدعاه «صلى الله عليه وآله»، فقال: إن يهود قد بعثت
إليّ:
إن كان يرضيك عنا: أن نأخذ رجالاً رهناً
من قريش وغطفان،
من أشرافهم، فندفعهم إليك فتقتلهم،
فخرج من عند رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأتاهم، فأخبرهم بذلك.
فلما ولى نعيم، قال رسول الله «صلى
الله عليه وآله»:
إنما الحرب
خدعة([12]).
5 ـ
ويروي الواقدي عن أبي كعب القرظي: أنه لما جاء حيي بن
أخطب إلى كعب بن أسد يريده على نقض العهد قال له: لا تقاتل حتى تأخذ
سبعين رجلاً من قريش وغطفان
رهاناً
عندكم.
وذلك من حيي خديعة لكعب حتى ينقض العهد. وعرف أنه إذا
نقض العهد لحم الأمر،
ولم يخبر حيي قريشاً بالذي قال لبني قريظة، فلما جاءهم عكرمة يطلب منهم
أن يخرجوا معه البست
(أي يوم السبت)،
قالوا: لا نكسر البست، ولكن يوم الأحد.
ولا نخرج حتى تعطونا الرهان.
فقال عكرمة:
أي رهان؟!
قال كعب:
الذي شرطتم لنا.
قال:
ومن شرطها لكم؟.
قالوا:
حيي بن أخطب.
فأخبر أبا سفيان ذلك، فقال:
يا يهودي، نحن قلنا لك كذا وكذا؟
قال:
لا، والتوراة ما قلت ذلك.
قال أبو سفيان:
بل هو الغدر من حيي.
فجعل حيي يحلف
بالتوراة ما قال ذلك([13]).
وفي نص آخر:
قال كعب: يا حيي، لا نخرج حتى نأخذ من كل أصحابك من كل
بطن سبعين رجلاً رهناً
في أيدينا.
فذكر ذلك حيي لقريش ولغطفان، وقيس. ففعلوا،
وعقدوا بينهم عقداً
بذلك حتى شق كعب الكتاب.
فلما أرسلت إليه قريش تستنصره قال:
الرهن،
فأنكروا ذلك واختلفوا([14]).
6 ـ
قال نص آخر ما ملخصه: حدثني معمر، عن الزهري: أرسلت بنو
قريظة إلى أبي سفيان: أن ائتوا فإنا سنغير على بيضة المسلمين من
ورائهم،
فسمع ذلك نعيم بن مسعود، وكان موادعاً
للنبي «صلى الله عليه وآله» فأقبل إلى النبي «صلى الله عليه وآله»
فأخبره،
فقال «صلى الله عليه وآله»: فلعلنا أمرناهم بذلك.
فقام نعيم بكلمة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وكان
نعيم رجلاً لا يكتم الحديث، فلما ولىَّ
من عند رسول الله «صلى الله عليه وآله» ذاهباً
إلى غطفان،
قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ما هذا الذي قلت؟ إن كان هذا الأمر
من الله تعالى فأمضه، وإن كان هذا رأياً
من قبل نفسك، فإن شأن بني قريظة هو أهون من أن تقول شيئاً يؤثر عنك.
فقال «صلى الله عليه وآله»:
بل هو رأي رأيته، الحرب خدعة. ثم أرسل «صلى الله عليه
وآله» في أثر نعيم فدعاه، فقال «صلى الله عليه وآله» له: أرأيت الذي
سمعتني قلت آنفاً؟ اسكت عنه، فلا تذكره فإنما أغراه.
فانصرف من عند رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى
عيينة ومن معه من غطفان، فقال لهم: هل علمتم محمداً قال شيئاً قط إلا
كان حقاً؟!
قالوا:
لا. قال: فإنه قال لي فيما أرسلت به إليكم بنو قريظة:
«فلعلنا نحن أمرناهم بذلك» ثم نهاني أذكره لكم.
فأخبر عيينة بن حصن أبا سفيان بذلك،
فقال:
إنما نحن في مكر بني قريظة.
فقال أبو سفيان:
نرسل إليهم الآن فنسألهم الرهن، فإن دفعوا الرهن إلينا،
فقد صدقونا، وإن أبوا ذلك فنحن منهم في مكر.
فأرسلوا إليهم يطلبون الرهن ليلة السبت، فامتنعوا من
إعطائه لأجل السبت.
فقال أبو سفيان ورؤوس الأحزاب:
هذا مكر بني قريظة، فارتحلوا فقد طالت
إقامتكم،
فأذنوا
بالرحيل، وبعث الله تعالى عليهم الريح، حتى ما يكاد أحدهم يهتدي لموضع
رحله. فارتحلوا، فولوا منهزمين.
ويقال:
إن حيي بن أخطب قال لأبي سفيان: أنا آخذ لك من بني
قريظة سبعين رجلاً رهناً
عندك حتى يخرجوا فيقاتلوا، فهم أعرف بقتال محمد وأصحابه،
فكان هذا الذي قال: إن أبا سفيان طلب الرهن.
قال ابن واقد:
وأثبت الأشياء
عندنا قول نعيم الأول([15]).
ونقول:
إننا نلاحظ:
أن هذه الرواية، وكذلك رواية جعل ثلث ثمار المدينة
لعيينة بن حصن، تظهر: أن سعد بن
معاذ
وعمر بن الخطاب، يعتقدان أن النبي «صلى الله عليه وآله» يتصرف أحياناً
انطلاقاً
من هدى الوحي، ووفق التدبير والتسديد الإلهي، ويتصرف أحياناً
أخرى إنطلاقاً
من رأيه الشخصي، ووفقاً
لهواه الذي قد يصيب وقد يخطئ. وهذا بالذات هو ما عبر عنه عمر بن الخطاب
هنا.
ثم أظهرت هذه الرواية وتلك:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد اعترف هو نفسه بهذا الأمر
وقرره بصراحة ووضوح.
مع أن نبينا الأكرم أجل من أن يتصرف أو يتكلم بوحي من
الهوى وبغير إذن من الله سبحانه. ولا يخرج من بين شفتيه إلا الحق
والصدق، والهدى، ولا شيء غير ذلك.
وملاحظة أخرى نسجلها على هذه
الرواية وهي:
أن نعيم بن مسعود قد أخبر عيينة بن حصن ومن معه من
غطفان بمقالة الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» بالطريقة التي لا بد
أن يعرفوا منها: أن نعيماً
هو الذي أخبر النبي «صلى الله عليه وآله» بما أرسلت به قريظة إليهم.
وهو ينطوي على مخاطرة واضحة حين يكتشف عيينة وغطفان أن نعيماً
قد
خانهم
وأفشى
سرهم، ولن يسكتوا عن هذا الأمر أبداً.
إلا أن يكون الرواي قد نقل أصل الحدث ذاهلاً
عن الصياغة الحقيقية التي أظهرها نعيم لقومه.
1 ـ
قد يظهر من بعض النصوص المتقدمة: أن نعيم بن مسعود كان
يتجسس للمشركين. وأن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان عارفاً
بأمره، فاختاره «صلى الله عليه وآله» ليلقي إليه قوله ذاك الذي انتهى
بتخذيل الأحزاب، وشكهم ببعضهم البعض.
2 ـ
ثم إن لنا تحفظاً
آخر هنا:
وهو أن تسليم سبعين رهينة من أشراف قريش وغطفان إلى النبي «صلى الله
عليه وآله» ليقتلهم، إنما يعني أن يستقل اليهود من بني قريظة بعداوة
الأحزاب وكل من له بهم صلة أو هوى في المنطقة بأسرها، ولا طاقة لليهود
بهؤلاء جميعاً. بل إن ذلك يحمل معه أخطار إبادتهم عن
بكرة
أبيهم.
فكيف
يمكن أن يصدق المشركون أن يقدم اليهود على أمر كهذا؟!.
وهذا يعني:
أن ما ذكرته النصوص الأخرى المتقدمة أقرب إلى الصواب. وأولى بالاعتبار.
3 ـ
وقد تقدم في الجزء السابق:
أن نعيم بن مسعود وحسان بن ثابت قد أظهرا تعاطفاً
واضحاً
مع بني النضير حينما أجلاهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» فتصدى لهما
أبو عبس ورد عليهم بقوة([16])،
فراجع.
وقد يستفيد البعض من ذلك:
أن نعيم بن مسعود كان حينئذٍ مسلماً.
فما معنى قولهم هنا:
إنه قد
أسلم
في غزوة الخندق؟!.
ويقول البعض:
«كان لوحدة الصف الإسلامي، وانضباط المسلمين ووقوفهم
صفاً
واحداً خلف قائدهم أثر كبير في تطور الموقف ونتائجه،
سيما وأن خصومهم كانوا على نقيض ذلك.
وهذا ما سهل كثيراً
مهمة الدبلوماسية الإسلامية، التي اعتمدت اعتماداً
رئيسياً
على هذه الناحية، فنجحت في تفريق صفوف الأحزاب، وتشتيت شملهم»([17]).
ونقول:
إن هذا الكاتب قد نسي:
المتخاذلين والمنافقين، الذين كانوا يتسللون لواذاً،
ويتركون النبي «صلى الله
عليه وآله»،
ويحتجون لانسحابهم من المعركة بحجج واهية. وكان لهم دور رئيس في تخذيل
الناس، وبث الرعب والخوف في نفوس الكثيرين منهم.
ونسي أيضاً:
تخاذلهم عن عمرو بن عبد ود ورفاقه، وهم أقل عدداً من
أصابع اليد الواحدة.
نعم..
لقد نسي ذلك، وجاء ليدعي أن الصف الإسلامي كان على غاية
من القوة والتماسك خلف قائده. مع أنهم يذكرون ـ كما تقدم وسيأتي إن شاء
الله ـ:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد بقي في ثلاث مئة من أصحابه.
بل ذكرت بعض النصوص:
أنه لم يبق معه سوى اثني عشر رجلاً فقط.
كما أن هذا الكاتب لم يعرف:
أن نعيم بن مسعود لم يكن هو بطل القصة. بل كان المحرك
والمحور الأساس فيها هو رسول الله «صلى الله عليه وآله» نفسه حسبما
أوضحناه آنفاً.
قد روي عن علي «عليه السلام»، أنه
قال:
سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول يوم الخندق:
الحرب خدعة،
ويقول: تكلموا بما أردتم([18]).
وقد اتضح مما تقدم أيضاً:
أنه «صلى الله عليه وآله» كان يعمل على
إيقاع
الشك والريب فيما بين الأحزاب بالطريقة الإعلامية الذكية والواعية، حتى
تحقق له «صلى الله عليه وآله» ما أراد، واستطاع من خلال ذلك أن يفشل كل
مخططاتهم، ويبطل كل ما بذلوه من جهد وكيد.
وقد تجلت لنا من خلال ذلك أهمية الإعلام الحربي الموجه،
وأنه قد يهزم الجيوش، ويثل العروش،
إذا كان هادفاً
وواعياً
وذكياً.
لقد دعا النبي «صلى الله عليه وآله» على الأحزاب،
فاستجاب الله تعالى له.
يقول المؤرخون والمحدثون:
إنه «صلى الله عليه وآله» أتى مسجد الأحزاب يوم الإثنين،
والثلاثاء، والأربعاء؛
فدعا عليهم يوم الأربعاء بين الصلاتين، قال جابر: فعرفنا البشر في
وجهه([19]).
وفي نص آخر:
انتظر «صلى
الله عليه وآله» حتى زالت الشمس، ثم قام في الناس، فقال: يا أيها الناس
لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإن لقيتم العدو فاصبروا،
واعلموا: أن الجنة تحت ظلال السيوف([20]).
ثم قال:
اللهم منزل
الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم، وانصرنا عليهم
وزلزلهم([21]).
وعن ابن المسيب:
أنه «صلى الله
عليه وآله» لما اشتد عليهم الحصار قال: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك،
اللهم إن تشأ لا تعبد»([22]).
وعند الراوندي:
أنه «صلى الله عليه وآله» صعد مسجد الفتح، فصلى ركعتين،
ثم قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد في الأرض بعدها، فبعث الله
ريحاً
قلعت خيم المشركين
الخ..
إلى أن قال:
ثم رجع من مسجد الفتح إلى معسكره، فصاح بحذيفة بن
اليمان، وكان قد ناداه قريباً ثلاثاً
الخ..
ثم ذكر إرساله
لكشف خبرهم([23]).
وقد ذكرت
أدعية أخرى عديدة له «صلى الله عليه وآله» في يوم الأحزاب فلتراجع في
مصادرها([24]).
ولعله «صلى الله عليه وآله» قد دعا بذلك كله في مواقف
مختلفة.
وآخر ما نذكره نحن هنا:
ما عن الخدري قال:
قلنا: يا رسول الله، هل من شيء نقوله، فقد بلغت القلوب
الحناجر.
قال:
نعم، قولوا: اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا.
قال:
فصرف الله
تعالى ذلك([25]).
ونقول:
إن لنا هنا وقفات:
إحداها:
أن
رواية عبد الله بن أبي أوفى المتقدمة موضع ريب وشك، لأن المسلمين لم
يتمنوا لقاء العدو آنئذٍ، بل كان الحال يزداد شدة وصعوبة عليهم يوماً
بعد يوم. وكان الخوف مسيطراً
على الكثيرين، فإن كان النبي «صلى الله عليه وآله» قد قال كلاماً
من هذا النوع، فلا بد أن يكون قد قاله في مناسبة أخرى، غير مناسبة
الخندق.
أضف إلى ذلك:
أننا نستبعد كثيراً:
أن يقول النبي «صلى الله عليه وآله» كلاماً
من هذا النوع، وذلك لما يحمل في طياته من تضعيف وتخذيل
لم يكن النبي «صلى الله عليه وآله» ليقدم عليه في حالات الحرب.
الثانية:
إننا نجد النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» يلتجئ
للصلاة وللدعاء، ويوجه الناس إلى الله سبحانه في هذه الظروف الحرجة،
التي يكون فيها الإنسان أكثر من أي وقت مضى مؤهلاً
للتفاعل مع الحالات الروحية.
يساعد على ذلك أنه في هذه الظروف بالذات تكون نظرته إلى
الأمور واقعية وسليمة، لا تشوبها نوازع نفسية، ولا أهواء ولا غيرها مما
من شأنه أن يضخم الأمور له، أو يمنعه من رؤيتها على حقيقتها.
وذلك لأنه حين تصبح القضية لها مساس بمصيره وبحياته،
فإنه لا بد له من أن يحدق بها، ويكشف كل خباياها وخفاياها، وتتبلور فيه
حساسية خاصة تجاه أية بادرة يلاحظها، إذا كانت تصب في نفس الاتجاه الذي
يسير فيه، أو تؤثر على الواقع الذي يتعامل معه، سلباً
كان ذلك التأثير
أو
إيجاباً.
وإذا كان ثمة ارتباط في هذه الناحية بالذات بالغيب،
وبالله سبحانه على الخصوص، فإن التأثير يصبح أكثر عمقاً
وأصالة وشمولية، لأنه يرتكز على الناحية العقيدية والإيمانية والشعورية
ومداها، قبل أن يدخل في الحسابات المادية وفي نطاقها.
فإذا كانت الناحية الإيمانية تقوم على أساس فكري راسخ
وتستند إلى القناعة من خلال الدليل الصحيح والقاطع، فإنها تستمد حينئذٍ
من اللامحدود، وتستند إلى المطلق، الذي يملك القدرة على استيعاب
المحدود، مهما كانت قوته، ومهما اشتد وتعاظم خطره.
الثالثة:
من الواضح أن التربية الروحية بحاجة إلى القول وإلى العمل،
فإن ذلك يفيد في نيل درجات القرب، ويؤثر أيضاً في التصفية والتزكية،
بما توحي به الكلمة من معان، وتنشره من ظلال روحية، وتثيره من نسمات
إيمانية
أنيسة ودافئة.
كما أن العمل العبادي بما يمثله من تجسيد للحالة
الروحية والنفسية يستطيع أن يرسخ الوعي في المشاعر وفي الخواطر، فتثير
لديه وعياً
جديداً،
وأملاً
وليداً.
قد عرفنا فيما تقدم:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد دعا على الأحزاب،
في مسجد الأحزاب، يوم الإثنين
والثلاثاء والأربعاء، فاستجيب
له يوم الأربعاء.
1 ـ
قالوا: فلما كان ليلة السبت بعث الله الريح على
الأحزاب، حتى ما يكاد أحدهم يهتدي لموضع رحله، ولا يقر لهم قدر ولا
بناء.
وقام رسول الله «صلى الله عليه وآله» يصلي إلى أن ذهب
ثلث الليل. وكذلك فعل ليلة قتل كعب بن الأشرف، وكان إذا حَزَبه
أمر أكثر من الصلاة([26])،
وكان ذلك في
أيام شاتية([27])،
وبرد شديد([28]).
وقال البعض:
أرسل الله تعالى الريح، فهتكت القباب، وكفأت القدور،
ودفنت الرجل، وقطعت الأوتاد،
فانطلقوا لا يلوي أحد على أحد، وأنزل الله
الخ..»([29]).
وكانت الريح التي أرسلها الله سبحانه عليهم هي ريح
الصبا، فأكفأت قدورهم، وطرحت آنيتهم،
ونزعت
فساطيطهم([30]).
وفي نص آخر:
بعث الله عليهم ريحاً
وظلمة، فانصرفوا هاربين لا يلوون على
شيء، حتى ركب أبو سفيان ناقته وهي معقولة. فلما بلغ رسول الله «صلى
الله عليه وآله» ذلك،
قال: عوجل الشيخ([31]).
ويقول نص آخر:
«كان الله عز وجل قبل رحيلهم قد بعث عليهم بالريح بضع
عشرة ليلة، حتى ما خلق الله لهم بيتاً
يقوم، ولا رمحاً،
حتى ما كان في الأرض منزل أشد عليهم ولا أكره إليهم من منزلهم ذلك،
فأقشعوا([32])
والريح أشد ما كانت، معها جنود الله لا ترى،
كما قال الله عز وجل
الخ..([33]).
ولكن هذا النص الأخير:
لا ينسجم
مع
ما تقدم، وما سيأتي في حديث حذيفة أيضاً: من أن إرسال
الريح عليهم إنما كان بعد دعاء النبي «صلى الله عليه وآله» عليهم، وذلك
بعد قتل عمرو بن عبد ود،
وأن ذلك لم يدم إلا مدة يسيرة انتهت بفرارهم. بل لقد أخبرهم النبي «صلى
الله عليه وآله» ليلة الأحزاب بالريح، كما صرحت به النصوص.
كما أننا لا نرى مبرراً
لأن يصمدوا أمام هذه الريح العاتية هذه المدة الطويلة.
والنصوص التاريخية حول ما صنعته الريح بهم كثيرة،
وسيأتي في حديث حذيفة المزيد.
أما بالنسبة:
لإرسال
الملائكة، فإن النصوص فيه أيضاً كثيرة.
ويذكر المفسرون:
أن آية قرآنية قد ذكرت إرسال الريح والملائكة على
الأحزاب، وهي قوله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا
اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَليْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ
فَأَرْسَلنَا عَليْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً﴾([34]).
ويظهر من بعض النصوص:
أن ما فعلته الريح هو نفس ما فعلته الملائكة، وأن حركة
الريح هي حركة الملائكة بالذات، فهو يقول:
وكَثُرَ يومئذٍ تكبير الملائكة في جوانب عسكرهم، وكانوا
ألفاً.
ولم تقاتل يومئذٍ، وسمعوا قعقة السلاح، ولكن قلعت الأوتاد،
وقطعت أطناب الفساطيط، وأطفأت
النيران، وأكفأت القدور، وجالت الخيل بعضها في بعض، وقذف الله في
قلوبهم الرعب، فارتحلوا، وتركوا ما استثقلوه من متاعهم([35]).
1 ـ
وقيل: إن
الملائكة لم يقاتلوا يومئذٍ، بل كانوا يشجعون المؤمنين، ويجبنون
الكافرين([36]).
2 ـ
في رواية: أن الملائكة قطعت أوتاد الخيام، وأطفات
نيرانهم، ورأى الجيش أنه لا خلاص لهم إلا بالفرار([37]).
3 ـ
قال البعض:
وكثر تكبير الملائكة في جوانب عسكرهم حتى كان سيد كل حي يقول: يا بني
فلان هلم، حتى إذا اجتمعوا عنده قال: النجاة النجاة، أتيتم([38])،
لما بعث الله عليهم من الرعب.
4 ـ
قال البلاذري:
«وغشيتهم الملائكة تطمس أبصارهم»([39]).
5 ـ
قيل إنما بعث الله الملائكة تزجر خيل العدو وإبلهم،
فقطعوا مدة ثلاثة أيام في يوم واحد فارين منهزمين([40]).
6 ـ
جاءت الملائكة، فقالت: يا رسول الله، إن الله قد أمرنا
بالطاعة
لك، فمرنا بما شئت.
فقال:
زعزعي المشركين وأرعبيهم،
وكوني (وكونوا)
من ورائهم.. أي فهي قد نفثت الرعب في قلوبهم([41]).
7 ـ
وقالوا:
إن الملائكة لم تقاتل يومئذٍ([42]).
وبعد أن بقي
النبي «صلى الله عليه وآله» في اثني عشر رجلاً([43])
ـ أو في ثلاث مئة رجل ـ كما في روايات أخرى عن حذيفة ـ يحدثنا حذيفة عن
تلك الليلة
التي
قام الرسول
فيها على التل، الذي عليه مسجد الفتح ـ في ليلة ظلماء ذات قرة([44]).
وكان المسلمون صافين قعوداً، والأحزاب فوقهم، وقريظة
أسفل منهم، يخافونهم على ذراريهم. ونحن نلخص كلامه هنا، فقد قال:
ما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة، ولا أشد ريحاً
منها، في أصوات ريحها أمثال الصواعق وهي ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه. فجعل
المنافقون يستأذنون رسول الله، ويقولون:
﴿إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ
وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ﴾([45]).
فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له، فيتسللون، ونحن ثلاث مئة، أو نحو
ذلك.
فطلب النبي «صلى الله عليه وآله» أن يأتيه
أحدهم بخبر القوم، ثلاث مرات، فلم يجبه
أحد من شدة الجوع والقر والخوف، فقال أبو بكر: يا رسول
الله، ابعث حذيفة.
فلما كلم النبي «صلى الله عليه وآله» حذيفة
تقاصر إلى الأرض، كراهية أن يقوم، فأمره «صلى الله عليه وآله» بالقيام،
فقال له «صلى الله عليه وآله»: إنه كائن في القوم خبر، فأتني بخبر
القوم.
وفي نص آخر:
إن الله قد أخبرني: أنه قد أرسل الرياح على قريش
فهزمهم.
فشكى إليه البرد، فقال له «صلى الله
عليه وآله»:
لا بأس عليك من حر ولا برد حتى ترجع إلي.
فذكر له أنه يخاف الأسر والتمثيل به
فقال:
إنك لن تؤسر، فخرج حذيفة، فدعا له النبي «صلى الله عليه
وآله»، فذهب الفزع، والبرد عنه.
قال حذيفة:
فمضيت كأنما
أمشي في حمام([46]).
فلما وليت دعاني، فقال: يا حذيفة، لا تحدثن في شيء
حتى تأتيني.
وفي رواية:
أنه «صلى الله عليه وآله» قال له:
أئت
قريشاً، فقل: يا معشر قريش، إنما يريد الناس إذا كان غداً
أن يقولوا: أين قريش؟ أين قادة الناس؟ أين رؤوس الناس؟
فيقدموكم، فتصلوا القتال، فيكون القتل فيكم.
ثم ائت بني كنانة، فقل:
«وعلمه ما يشبه الكلام السابق لقريش، وكذا الحال
بالنسبة لقيس».
فذهب حذيفة فلما دنا منهم رأى أدهم ضخماً
عند نار توقد، وحوله عصبة، وقد تفرق الأحزاب عنه، وهو يقول: الرحيل
الرحيل.
ولم يكن حذيفة يعرف أبا سفيان قبل ذلك، فانتزع سهماً
ليرميه. فذكر وصية النبي «صلى الله عليه وآله» له،
فأمسك.
قال:
فلما جلست فيهم أحس أبو سفيان أنه قد دخل فيهم غيرهم،
فقال: ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه. فضربت بيدي على يد الذي عن يمني،
فأخذت بيده، فقلت: من أنت؟!
قال:
معاوية بن أبي سفيان. ثم ضربت بيدي على يد الذي عن
شمالي، فقلت: من أنت؟
قال:
عمرو بن العاص.
وفي نص آخر:
سهيل بن عمرو.
وفي آخر:
سبحان الله أما تعرفني؟! أنا فلان بن فلان، فإذا رجل من
هوازن.
وعند الراوندي:
خالد بن الوليد. فعلت ذلك خشية أن يفطن بي، فبدرتهم
بالمسألة.
ثم تلبثت فيهم هنيهة، وأتيت بني كنانة
وقيساً،
وقلت ما أمرني به رسول الله «صلى الله عليه وآله».
ثم دخلت في العسكر، فإذا أدنى الناس مني بنو عامر.
ونادى عامر بن علقمة: يا بني عامر، إن الريح قاتلي وأنا على ظهر،
وأخذتهم ريح شديدة. وصاح بأصحابه.
فلما رأى ذلك أصحابه جعلوا يقولون:
يا بني عامر، الرحيل الرحيل، لا مقام لكم.
وإذا الريح في عسكر المشركين ما تجاوز عسكرهم شبراً،
فوالله إني لأسمع
صوت الحجارة في رحالهم، وفرشهم، والريح تضربها، فلما دنا الصبح نادوا
أين قريش؟ أين رؤوس الناس؟.
فقالوا:
أيهات، هذا الذي أتينا به البارحة.
فقالوا:
أين كنانة؟.
فقالوا:
أيهات هذا الذي أُتينا به البارحة.
أين قيس؟ أين أحلاس الخيل؟.
فقالوا:
أيهات، هذا الذي أتينا به البارحة.
فلما رأى ذلك أبو سفيان، أمرهم بأن يتحملوا،
فتحملوا، وإن الريح لتغلبهم على بعض أمتعتهم. حتى رأيت
أبا سفيان وثب على جمل له معقول فجعل يستحثه ولا يستطيع أن يقوم حتى حل
بعد.
فعاد إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، فلما انتصف به
الطريق التقى بعشرين فارساً،
أو بفارسين فقط، فقالا: أخبر صاحبك:
أن الله تعالى كفاه القوم بالجنود والريح.
فرجع إلى النبي «صلى الله عليه وآله» فوجده يصلي، وعاد
إليه البرد والقر، فسدل عليه فضل شملته فنام، ثم أخبره: أنه تركهم
يرحلون.
وذكر ابن سعد:
أن عمرو بن العاص وخالد بن الواليد أقاما في ماءتي فارس
ساقة للعسكر، وردءاً
لهم، مخافة
الطلب([47]).
إننا نذكر نصاً مختصراً آخر لقضية حذيفة، ثم نحيل
القارئ إلى المصادر التي ذكرت هذه القضية بتفصيل أو بإجمال ليراجعها من
أراد
الاستقصاء والمقارنة.
فنقول:
بعد أن ذكر المؤرخون ما قام به نعيم بن مسعود من كيد
بين قريظة، وقريش وغطفان ـ وإن كنا نحن قد سجلنا
فيما سبق تحفظات قوية عليه ـ قالوا:
«وتخاذل القوم، واتهم بعضهم بعضاً، وذلك في زمن شات،
وليال باردة كثيرة الرياح، تطرح أبنيتهم،
وتكفأ قدورهم. وضاق ذرع القوم، وبلغ رسول الله «صلى الله عليه وآله»
اختلاف القوم، وما هم فيه من الجهد، فدعا حذيفة
بن اليمان فبعثه إليهم، لينظر ما فعل القوم ليلاً.
قال حذيفة:
فذهبت فرأيت من الرياح أمراً هائلاً،
لا يقر لهم ناراً
ولا بناءً.
فقام أبو سفيان بن حرب، فقال:
يا معشر قريش، لينظر امرؤ جليسه.
قال:
فبادرت وأخذت بيد الرجل الذي إلى جانبي، فقلت: من أنت؟!
قال:
أنا فلان بن فلان.
ثم قال أبو سفيان:
إنكم يا قوم ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع
والخف، وأخلفتنا
بنو قريظة، وبلغنا عنهم ما نكره، ولقينا من الجهد والشدة، وهذه الريح
ما ترون، فارتحلوا، فإني مرتحل([48]).
ثم قام
إلى جمله، وقام الناس معه.
في نص آخر:
«قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، ثم ضربه فوثب على
ثلاث قوائم».
وسمعت غطفان بما فعلت قريش، فانصرفوا إلى بلادهم.
وتفرق ذلك الجمع من غير قتال، إلا ما كان من عدة يسيرة،
اتفقوا على الهجوم الخ..
ثم ذكر قتل
علي «عليه السلام» لعمرو.. ثم قال: وانتقض ذلك الجمع والتدبير كله([49]).
وذكرت المصادر:
أنه «صلى الله عليه وآله» نادى حذيفة مرتين، فلم يجبه،
وأجابه في الثالثة.
فقال له:
تسمع صوتي ولا تجيبني؟! فاعتذر عن عدم
إجابته
بالخوف والبرد والجوع([50]).
وثمة نص آخر يقول:
إنه «صلى الله عليه وآله» أراد أن يبعث رجلاً من أصحابه
يعبر الخندق فيعلم ما خبر القوم، فأتى رجلاً فطلب منه ذلك فاعتل، فتركه،
وأتى آخر، فاعتل أيضاً فتركه، وحذيفة يسمع، ولكنه صامت لا يتكلم، فأتاه
«صلى الله عليه وآله» وهو لا يدري من هو، فسأله إن كان قد سمع ما جرى،
فأجاب بالإيجاب،
ثم اعتذر عن عدم مبادرته لإجابة
طلبه «صلى الله عليه وآله» بالجوع والضر. ثم أمره «صلى الله عليه وآله»
بالذهاب الخ..([51]).
ونقول:
إننا لا نستطيع أن نؤكد صحة قضية حذيفة بما لها من
خصوصيات وتفاصيل مذكورة آنفاً، وإن كنا لا نمنع من أن يكون النبي «صلى
الله عليه وآله» قد أرسله لكشف خبر الأحزاب، فعاد إليه
فأخبره بأنهم بدأوا بالرحيل..
وشكنا
فيما عدا ذلك من تفاصيل وأحداث مزعومة، يستند إلى عدة أمور، نذكر منها:
أولاً:
أننا
نجد حذيفة يذكر أنه رأى أبا سفيان في ضوء النار الموقدة، وهو يستدفئ
بها مع أصحابه، وأراد أن يرميه بسهم، لولا أنه ذكر وصية النبي «صلى
الله عليه وآله» له،
وقد رآه رجلاً ضخماً
أدهم.. فكان من الوضوح له أنه استطاع أن يميز لونه، ويعرف أنه أدهم.
ولكنه يأتي ويجلس بين نفس تلك العصبة التي حول أبي
سفيان. ولا يستطيع أن يراه أحد من تلك العصبة، ولا أحس به، رغم وجود
النار والنور. ورغم
إحساس
أبي سفيان بأن رجلاً غريباً
دخل بينهم. وإذا كانت الظلمة شديدة إلى هذا الحد، فكيف استطاع حذيفة أن
يجد مكانه بينهم دون أن يصطدم ولو جزئياً
بواحد منهم؟!.
وكيف استطاع حذيفة أن يرى العصبة وأبا سفيان، ويرى تفرق
الأحزاب عنه، ثم لا يراه أحد، ولا يحس به أي منهم على الإطلاق؟.
ثانياً:
إذا كان أبو سفيان حين ورود حذيفة ينادي: الرحيل
الرحيل، وكذلك كان عامر بن علقمة بن علاثة ينادي الرحيل الرحيل، لا
مقام لكم، فما معنى أن يقوم حذيفة بدوره في تخذيلهم، وفق
ما علمه الرسول إياه؟
ثالثاً:
هناك اختلاف في نصوص الرواية. ونذكر تناقضاً
صريحاً
واحداً هنا وهو واقع في الرواية التي ذكرناها أولاً نفسها، فهي تقول:
إن الريح كانت في عسكر المشركين، ما تجاوز عسكرهم شبراً.
مع أنه قد جاء في بداية الرواية نفسها قوله: «ما أتت علينا ليلة قط أشد
ظلمة، ولا أشد ريحاً
منها، في أصوات ريحها مثل الصواعق،
فجعل المنافقون يستأذنون الخ..».
رابعاً:
تقول الرواية التي ذكرناها أولاً: إن النبي «صلى الله
عليه وآله» قد أمر حذيفة بأن يأتي قريشاً فيقول: يا معشر قريش، إنما
يريد الناس الخ.. ثم يأتي كنانة
فيقول كذا وكذا، ثم يأتي قيساً
فيقول كذا وكذا..
وهذا لا ينسجم مع عنصر السرية الذي كان مطلوباً
لحذيفة في ظروف كهذه. كما لا ينسجم مع ما جرى بينه وبين جليسيه حين طلب
أبو سفيان أن يعرف كل منهم جليسه.
وخامساً:
ألف:
إن بعض المصادر ذكرت: أنه لما سأل حذيفة جليسه عن اسمه.
قال: سبحان الله، أما تعرفني؟! أنا فلان بن فلان، فإذا رجل من هوازن.
فما معنى تعجب هذا الرجل؟ فهل رأى حذيفة وجهه في ذلك
الظلام الدامس ولم يعرفه، فأثار ذلك تعجبه؟!
ب:
كما أننا نعرف أن حذيفة قد حضر حرب أحد، وكان أبو سفيان
قائد جيش المشركين في أحد، فهل لم يكن قد رآه آنئذٍ، ليقول هنا: إنه لم
يكن يعرف أبا سفيان حتى ذلك الوقت؟!.
وحين رآه واقفاً
يوقد النار ويستدفئ بها كيف عرف أنه أبو سفيان؟ فلعله رجل آخر من هذا
الجيش الكثيف.
ج:
تذكر رواية
الراوندي: أن حذيفة قال: «فصرت إلى معسكرهم فلم أجد هناك إلا خيمة أبي
سفيان، وعنده جماعة من وجوه قريش، وبين أيديهم نار تشتعل مرة، وتخبو
أخرى، فانسللت فجلست بينهم»([52]).
والسؤال هو:
لماذا لم يجد إلا خيمة أبي سفيان، فهل استعصت هذه
الخيمة فقط على الريح التي أرسلها الله سبحانه عليهم؟! ودمرت خيام جيش
يعد بالألوف؟!
وسادساً:
إن البعض قد أورد ما يشبه هذه الرواية، لكنه يجعل بطلها
الزبير
بن
العوام، فهو يقول:
قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»
يوم الأحزاب:
من يأتينا بخبر القوم؟!.
فقال الزبير:
أنا.
ثم قال:
من يأتينا بخبر القوم؟!
فقال الزبير:
أنا.
ثم قال:
من يأتينا بخبر القوم؟
فقال الزبير:
أنا.
ثم قال:
إن لكل نبي
حوارياً، وإن حواري الزبير([53]).
ونقول:
إذا كان هذا صحيحاً
فلماذا ترك الزبير، ولم يرسله. وأرسل حذيفة؟!.
فأجاب البعض:
بأن حذيفة إنما
ذهب
ليأتيه بخبر المشركين.
أما الزبير
فقد كشف خبر بني قريظة([54]).
ولكنه كلام لا يصح:
لأن ابن الديبع قد صرح بأن الزبير هو الذي سمع أبا
سفيان ينادي، ويأمرهم بسؤال جلسائهم عن أنفسهم.
قال الزبير:
فبدأت بجليسي
وقلت: من أنت؟([55]).
وقد حاول دحلان أن يجيب
عن
ذلك التساؤل بطريقة أخرى، فقال: «فدعا حذيفة بن اليمان
رضي الله عنهما وأرسله كما سيأتي، ولم يرسل الزبير (رض) مع سؤاله ذلك
ثلاثاً؛
لأن له حدة وشدة، لا يملك معها نفسه أن يحدث بالقوم شيئاً مما نهى عنه
حذيفة فيما يأتي، فاختار
إرسال
حذيفة ذلك. هذا هو التحقيق عند
أئمة
السير. وهو أن المرسل إنما هو حذيفة (رض).
ونسب
بعضهم
الإرسال
إلى الزبير، وهو اشتباه. وإنما إرسال الزبير (رض) في كشف خبر بني قريظة
لما نقضوا العهد»([56])
انتهى.
ونقول:
قد تقدم:
أن
إرسال
الزبير إلى بني قريظة لا يصح أيضاً، فراجع.
وأما أنه «صلى الله عليه وآله» عدل عن الزبير إلى حذيفة
لأجل حدة كانت في الزبير، فإنما هو على فرض تسليم أصل القصة. وهي
مردودة جملة وتفصيلاً؛
لأن حذيفة يصرح بأنه «صلى الله عليه وآله» ناداهم ثلاثاً
فلم يجب منهم أحد، وهذا يكذب أن يكون الزبير قد أجاب ثلاث مرات.
ونعتقد:
أن ما يذكر للزبير هنا إنما هو من مجعولات محبيه، لينال
وساماً
عن غير جدارة ولا استحقاق.
أما حذيفة، فقد يكون النبي «صلى الله عليه وآله» أرسله
لكشف خبر المشركين،
فراقبهم عن بعد، أو عن قرب، وسمع بعض أقوالهم،
ثم
زاد
الرواة على ذلك ما شاؤوا حتى أخرجوا القضية عن حدود المعقول والمقبول.
وكتب أبو سفيان إلى النبي «صلى الله
عليه وآله» رسالة يقول فيها:
لقد سرت إليك في جمعنا. وإنا نريد
ألا
نعود إليك أبداً حتى نستأصلك، فرأيتك قد كرهت لقاءنا وجعلت مضايق
وخنادق، فليت شعري من علمك هذا؟.
فإن نرجع عنكم فلكم منا يوم كيوم أُحد،
تبقر فيه النساء.
وبعث بالكتاب مع أبي أسامة الجشمي؛
فقرأه له أُبي
بن كعب؛
فكتب إليه «صلى الله عليه وآله»:
أما بعد، فقديماً
غرك بالله الغرور، أما ما ذكرت أنك سرت إلينا في جمعكم، وأنك لا تريد
أن تعود حتى تستأصلنا، فذلك أمر الله يحول بينك وبينه، ويجعل لنا
العاقبة حتى لا تذكر اللات والعزى.
وأما قولك:
من علمك الذي صنعنا من الخندق، فإن الله تعالى ألهمني
ذلك لما أراد من غيظك به وغيظ أصحابك،
وليأتين عليك يوم تدافعني بالراح،
وليأتين عليك يوم
أكسر
فيه اللات والعزى، وأساف،
ونائلة، وهبل حتى أذكرك ذلك([57]).
ثمة نص آخر لكتاب كتبه أبو سفيان،
فليراجع([58]).
وذكر الواقدي:
أن أبا سفيان جلس على بعيره وهو معقول، ثم ضربه، فوثب
على ثلاث قوائم، فما أطلق عقاله إلا بعد ما قام.
فناداه عكرمة:
إنك رأس القوم وقائدهم، تقشع؟ وتترك الناس؟.
فاستحيا، فأناخ جمله ونزل عنه، وأخذ بزمامه وهو يقوده،
وقالـوا:
ارحلوا.
قال:
فجعل الناس يرتحلون وهو قائم حتى خف العسكر.
ثم قال لعمرو بن العاص:
يا أبا عبد
الله، لا بد لي ولك أن نقيم في جريدة([59])
من خيل بإزاء
محمد وأصحابه، فإنا لا نأمن أن نُطلب حتى ينفذ العسكر.
فقال عمرو:
أنا أقيم.
وقال لخالد بن الوليد:
ما ترى يا أبا سلمان؟.
فقال:
أنا أيضاً أقيم.
فأقام عمرو وخالد في ماءتي فارس وسار العسكر إلا هذه
الجريدة على متون الخيل.
وأقامت الخيل حتى السحر، ثم مضوا فلحقوا الأثقال
والعسكر مع ارتفاع النهار بملل.
ولما ارتحلت غطفان وقف مسعود بن رخيلة في خيل من
أصحابه، ووقف الحارث بن عوف في خيل من أصحابه،
ووقف
فرسان من بني سليم في أصحابهم، ثم تحملوا في طريق واحدة، وكرهوا أن
يتفرقوا حتى أتوا على المراض (موضع على ستة وثلاثين ميلاً
من المدينة) ثم تفرقوا إلى محالهم([60]).
لكن الراوندي يقول:
إن أبا سفيان قال لخالد:
إما أن تتقدم أنت
فتجمع
إلي الناس، ليلحق بعضهم ببعض، فأكون على الساقة، وإما
أن أتقدم أنا وتكون على الساقة.
قال:
بل أتقدم أنا وتتأخر أنت.
فقاموا جمعياً،
فتقدموا، وتأخر أبو سفيان فخرج من الخيمة، وأنا اختفيت في ظلها، فركب
راحلته وهي معقولة من الدهش الذي كان به، فنزل يحل العقال، فأمكنني
قتله، فلما هممت بذلك تذكرت الخ..([61]).
فالرواية المتقدمة تقول:
إن خالداً
قد بقي هو وعمرو بن العاص في جريدة من مائتي فارس، وهذه تقول: إن خالداً
تقدم على أبي سفيان، وابن
العاص حيث بقي أبو سفيان على ساقة العسكر، وابن العاص في الجريدة، التي
تأخرت.
ومهما يكن من أمر:
فقد روي عن قتادة: أن سيد كل حي كان يقول: يا بني فلان
هلم إلي، حتى إذا اجتمعوا عنده قال: النجاة،
النجاة أتيتم. لما بعث الله عليهم من الرعب، وتركوا ما استثقلوه من
متاعهم([62]).
ويقول البلاذري:
بعد أن ذكر: أن الله سبحانه قد أرسل عليهم ريحاً
صفراء، فملأت
عيونهم فداخلهم الفشل والوهن، وانهزم المشركون وانصرفوا إلى معسكرهم،
ودامت عليهم الريح..
وقالت غطفان وسليم:
«والله، لمحمد
أحب إلينا، وأولى بنا من يهود، فما بالنا نؤذيه وأنفسنا، وكانت تلك
السنة مجدبة، فجهدوا، وأضر مقامهم بكراعهم، فانصرفوا، وانصرف الناس»([63]).
إن ملاحظة معظم المؤخرين تعطينا:
1 ـ
إن ما فعله
نعيم بن مسعود ـ حسب زعمهم ـ من الفتنة بين بني قريظة والمشركين، ثم
إرسال الريح عليهم ـ كان هو السبب في هزيمة الأحزاب([64]).
2 ـ
وبعضهم يرى:
أن السبب هو الريح فقط، أو الريح والجنود([65]).
3 ـ
والبعض يرى:
أن ما فعله نعيم هو السبب([66]).
بل يقول البعض:
إن دور الريح والملائكة كان صورياً.
والسبب الحقيقي هو الفرقة التي بثها رسول الله «صلى الله عليه وآله»
بين صفوف المهاجمين، فأصبح بعضهم لا يأمن بعضاً قبل المعركة، فكيف
يأمنه إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق؟!.
ولذلك ما إن
هبت عليهم الرياح التي أرسلها الله حتى اتخذوها ذريعة للانسحاب من
ميدان القتال يحملون في قلوبهم الضغائن على بعضهم([67]).
وهو كلام عجيب لما فيه من الجرأة والوقاحة على نفي كلام
القرآن، الذي يصرح بالدور القوي للملائكة وللريح في حسم الموقف، كما
تقدم في قوله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا
اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَليْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ
فَأَرْسَلنَا عَليْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً﴾([68]).
فهل يرى هذا الكاتب أن ما أرسله الله سبحانه لم يكن له
أي أثر أو دور إلا أنه اتخذ ذريعة للفرار من قبل المشركين؟!.
وقد ورد أنه «صلى الله عليه وآله»
كان يقول:
«لا إله إلا
الله وحده، أعز جنده، ونصر عبده، وغلب (أو وهزم) الأحزاب وحده، فلا شيء
بعده»([69]).
ونقول:
إن النصوص المختلفة تلمح وتصرح:
بأن هزيمة الأحزاب كانت لأسباب ثلاثة:
الأول:
وهن أمر المشركين بسبب تضعضع ثقتهم ببعضهم البعض، مع
طول الحصار، ثم مع ما واجهوه من مصاعب فيما يرتبط بالناحية المعيشية
لهم ولكراعهم.
وذلك لأن خروجهم إلى حرب النبي بعد انقضاء زمن الحصاد،
وفي سنة مجدبة، قد تسبب بنكسة قوية. وهو يدل على أنهم لم يدرسوا الموقف
من جميع جوانبه، ولعل ذلك لأجل أنهم كانوا مطمئنين إلى أنهم سيحسمون
الموقف لصالحهم في فترة وجيزة ففاجأهم الرسول بخطته الحربية التي كانت
قاصمة
الظهر بالنسبة إليهم.
الثاني:
ما أرسله الله سبحانه عليهم من الريح والجنود التي لا
ترى، فإن الآية وإن لم تصرح بأن هزيمتهم كانت بسبب ذلك إلا أن عدم
التصريح هذا لأن ذلك لم يكن هو تمام السبب في الهزيمة، بل كان من
المؤثرات فيها.
الثالث:
ما قذفه في قلوبهم من الرعب، بسبب قتل فرسانهم وكبش
كتيبتهم، حتى يئسوا من أن يلجوا الخندق مرة أخرى.
قال ابن العبري:
«وبقوا بضعة وعشرين يوماً لم يكن بينهم حرب. ثم جعل
واحد من المشركين يدعو إلى البراز، فسعى نحوه علي بن أبي طالب، فقتله
وقتل بعده صاحباً
له، وكان قتلهما سبب هزيمة الأحزاب، على كثرة عددهم، ووفرة عددهم»([70]).
ب:
وقال المعتزلي: «الذي هزم الأحزاب هو علي بن أبي طالب،
لأنه قتل شجاعهم وفارسهم عمرواً
لما اقتحموا الخندق، فأصبحوا صبيحة تلك هاربين مفلولين، من غير حرب سوى
قتل فارسهم»([71]).
ج:
وقال الشيخ المفيد: «فتوجه العتب إليهم، والتوبيخ
والتقريع، والخطاب. ولم ينج من ذلك أحد بالاتفاق إلا أمير المؤمنين
«عليه السلام»، إذ كان الفتح له، وعلى يديه. وكان قتله عمرواً
ونوفل بن عبد
الله سبب هزيمة المشركين»([72]).
د:
ويقولون أيضاً: «وفر عكرمة، وهبيرة، ومرداس، وضرار، حتى
انتهوا إلى جيشهم، فأخبروهم قتل عمرو ونوفل، فتوهن من ذلك قريش،
وخاف
أبو سفيان. وكادت أن تهرب فزارة، وتفرقت غطفان»([73]).
ه :
تقدم عن علي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن قتله لعمرو
بن عبد ود يوم الأحزاب:
«فهزم الله
قريشاً والعرب بذلك، وبما كان مني فيهم من النكاية»([74]).
و:
ثم هناك ما روي عن ابن مسعود:
من أنه كان يقرأ ـ على سبيل التفسير والبيان طبعاً
ـ
﴿وَكَفَى اللهُ المُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾
بعلي([75]).
فكلمة:
بعلي ليست من القرآن، وإنما هي زيادة تفسيرية للآية،
للتأكيد على نزولها في أمير المؤمنين «عليه السلام».
وما أكثر القراءات التفسيرية هذه،
فراجع كتابنا: «حقائق هامة حول القرآن الكريم».
ز:
عن ابن عباس:
كفاهم الله القتال يوم الخندق، بعلي بن أبي طالب، حين قتل عمرو بن عبد
ود([76]).
وذكر القمي أيضاً:
نزول الآية في
علي فراجع([77]).
وكذا روي عن الإمام الصادق([78]).
ح:
تقدم في الفصل السابق قول الحافظ يحيى بن آدم، أو جابر
بن عبد الله الأنصاري: ما شبهت قتل علي عمرواً
إلا بقوله تعالى:
﴿فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ الله
وَقَتَل دَاوُدُ جَالُوتَ﴾([79]).
ط:
قال الشيخ
المفيد: «وقال رسول الله بعد قتله هؤلاء النفر (يعني: عمرواً وأصحابه):
الآن نغزوهم ولا يغزوننا»([80]).
وعند المعتزلي الشافعي:
أنه «صلى الله
عليه وآله» قال عند قتل عمرو: «ذهبت ريحهم، ولا يغزوننا بعد اليوم،
ونحن نغزوهم إن شاء الله»([81]).
أشجع
الأمة:
قال المحقق التستري:
تدل الآية بناء على قراءة ابن مسعود: «على كون
علي
أشجع من كل الأمة،
وأنه تعالى به «عليه السلام» كفى شر العدو عنهم يوم الأحزاب، فيكون
أفضل منهم،
﴿وَفَضَّلَ اللهُ
المُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً﴾([82])»([83]).
وقال المظفر:
«..فمنه حياة
الإسلام والمسلمين، ولولا أن يكفيهم الله تعالى القتال بعلي لاندرست
معالم الإسلام، لضعف المسلمين ذلك اليوم، وظهور الوهن عليهم الخ..»([84]).
وقد ذكرت إحدى الروايات:
أن هند بنت عمرو بن حزام، حين قتل زوجها عمرو بن الجموح
وأخوها عبد الله، وابنها في حرب أحد، قالت لعائشة:
أما رسول الله «صلى الله عليه وآله» فصالح، وكل مصيبة
بعده جلل. واتخذ الله من المؤمنين شهداء
﴿وَرَدَّ اللهُ الذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لمْ يَنَالُوا
خَيْراً وَكَفَى اللهُ المُؤْمِنِينَ القِتَال وَكَانَ اللهُ قَوِيّاً
عَزِيزاً﴾([85]).
قال المعتزلي:
قلت: هكذا وردت الرواية. وعندي أنها لم تقل كل ذلك.
ولعلها قالت:
﴿وَرَدَّ اللهُ الذِينَ
كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ﴾
لا غير. وإلا فكيف يواطئ كلامها آية من كلام الله تعالى، أنزلت بعد
الخندق. والخندق بعد أحد. هذا من البعيد جداً([86]).
ونقول:
إننا نوافق المعتزلي على ما قاله.
ولكننا نقول له:
كيف صار هذا
من البعيد جداً، ولم تكن موافقات عمر للقرآن([87])
على اختلافها وتنوعها، من البعيد جداً أيضاً؟!.
أم أن عبقرية عمر ليست لغيره من البشر، حتى الأنبياء
وأوصيائهم، فضلاً
عن النساء؟ أم أن حق التأليف القرآني محفوظ لعمر بن الخطاب بالإشتراك
مع العزة الإلهية؟! تعالى الله عما يقول الجاهلون والوضاعون لفضائل عمر
علواً
كبيراً.
الآن
نغزوهم، ولا يغزوننا:
وذكروا:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد قال يوم الأحزاب، حين
أجلاهم الله سبحانه: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم.
أو قال:
لن تغزوكم قريش بعد عامهم (أو عامكم) هذا،
أو نحو ذلك([88]).
فلم
تغز
كفار قريش
المسلمين بعد الخندق([89]).
وقد صرح المفيد والمعتزلي:
بأنه «صلى الله عليه وآله» قد قال ذلك حين قُتل عمرو
وأصحابه. لكن المؤرخين الآخرين يذكرون ذلك بعد جلاء الأحزاب.
والظاهر هو:
أنه لا فرق بين القولين، لأن
جلاء الأحزاب كان في اليوم الثاني، أو الثالث من قتل الفرسان. فلم يكن
هناك فاصل زماني يعتد به. ولا حدثت بعد قتلهم أحداث متميزة ومهمة سوى
ما أرسله الله سبحانه على الأحزاب من الريح.
ولعل البعض:
قد حاول تعمية الأمر هنا، لأجل أن يقلل من أهمية
الإنجاز الكبير الذي حققة علي «عليه السلام»، الذي ابتلي بأناس لا
يزالون يحاولون
إنكار
فضائله، وإطفاء
نور جهاده الرسالي الرائد.
لقد أشاع المشركون بعد حرب أُحد:
أن المسلمين قد هزموا، وتكبدوا خسائر فادحة، رغم أن
نهايات حرب
أحد
كانت كبداياتها قد أرعبت جيش الشرك، وهزمته روحياً
وعسكرياً،
وإن كانت قد حصلت نكسة في أواسط المعركة، تكبد المسلمون بسببها خسارة
كبيرة.
ولكنهم بفضل جهاد علي «عليه السلام»، ثم عودة الخلص من
المسلمين للقتال قد استعادوا زمام المبادرة، وانتهت الحرب بهزيمة
المشركين وكسر عنفوانهم، وتكبدوا هم أيضاً خسائر كبيرة على مستوى
القيادات وغيرها.
ولكن الخسارة التي مني بها المسلمون كانت أكبر ـ كما
قلنا ـ فكان أن أشاع المشركون أنهم قد انتصروا في حرب أحد، كمحاولة
دعائية فارغة لرد الإعتبار.
ثم حزبوا الأحزاب، وجمعوا الجموع، واتفقوا مع يهود بني
قريظة، فانتعشت آمالهم من جديد،
وبدا
واضحاً
لهم: أن أمر المسلمين قد انتهى،
وأصبحت المسألة مسألة وقت لا أكثر ولا أقل.
وقد كانت المشاركة الشاملة للقبائل الفاعلة في المنطقة
تطمئن زعماء قريش، الذين حشدوا كل ما لديهم من قوى بشرية ومادية لحسم
هذا الأمر، والتخلص من هذا الكابوس الجاثم على صدورهم.
ولكن وجود الخندق،
وحسن
إدارة
الرسول «صلى الله عليه وآله» لأمر
الحرب معهم، قد هيأ للمسلمين فرصة للمطاولة في أمر الحرب، حتى مل
الأحزاب طول الحصار، وأصبحوا يواجهون مشكلات على مستوى التموين وغيره.
ثم ظهرت خلافات زعزعت الثقة فيما بين الفرقاء
المؤتلفين، حيث فسد الأمر بينهم وبين بني قريظة وكان الرسول الأعظم
«صلى الله عليه وآله» السبب في ظهورها، حسبما أوضحناه.
ثم كان قتل علي «عليه السلام» لعمرو، فارس الأحزاب وكبش
كتيبتهم، ولمن معه، وفرار الباقين، هو الضربة
القاصمة لهم، والمرعبة لقلوبهم.
وجاءت الريح لتثير في نفوسهم المزيد من الخوف والرهبة،
والإحساس
بالوحشة والوحدة. حيث يجد كل منهم نفسه مسؤولاً
عن حفظ نفسه في مواجهة طغيان هذه الريح. ولا أحد يستطيع مساعدته والدفع
عنه.
فآثروا الفرار على القرار، خوفاً
من أن يبطش بهم سيف الإسلام من جديد، دون أن يتمكنوا من لم شعثهم،
وتسوية صفوفهم. بل وحتى دون أن يتمكنوا من رؤية ما حولهم، لأنهم أصبحوا
في ظلمة شديدة، وحالة مزرية إلى أبعد الحدود.
فكانت الهزيمة، وكان الخزي والعار لهم، دون أن يتمكنوا
من تحقيق أي شيء سوى أنهم قتلوا أفراداً
قليلين، قد لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة وقد خسروا في المقابل
ما يعادل نفس هذا العدد، إلا أن من بينهم فارس قريش والعرب عمرو بن عبد
ود العامري لعنه الله.
فإذا كان هذا
أكبر حشد يمكن لقوى الشرك والكفر في المنطقة كلها أن تقوم به، وقد طار
صيت هذا الحشد في مختلف البلاد، وشدت إليه الأنظار، وانتظر الناس
أخباره في الليل والنهار، وتوقعت القبائل نتائجه في مختلف أرجاء
الجزيرة العربية بفارغ الصبر لا سيما وأن الهدف الذي أعلنوه لهذه
الحرب، هو استئصال محمد ومن معه، حسبما تقدم([90]).
فإن النتائج التي قدمها هذا الحشد كله، قد جاءت بمثابة
زلزال هز المنطقة من الأعماق،
وبث روح الفشل والوهن في كل قلب، وزرع الخوف والرعب في كل بيت.
وحدثت الهزيمة الساحقة والماحقة لكل عنفوان الشرك،
وجبروت الكفر حيث فهم الجميع أن أقصى ما يمكن لهم أن يفعلوه ضد الإسلام
ونبي الإسلام قد فعلته قريش والأحزاب ولم ينته إلى نتيجة.
وكانت النتيجة كذلك هي أن قريشاً قد فقدت الكثير من
نفوذها ومكانتها، ولم تعد الكثير من القبائل تجد نفسها ملزمة بالخط أو
الموقف الذي تريد قريش
إلزامها
به.
ولم يعد بالإمكان
إقناع
الكثير من القبائل بالمخاطرة بمستقبلها، والدخول في حرب جديدة مع
الإسلام ومع المسلمين.
أضف إلى ذلك:
أنه لم يعد بالإمكان تحصيل درجة كافية من الوثوق
بالآخرين، الذين لا بد من ضمان مشاركتهم الفاعلة حتى النهاية. بعدما
أثبتت التجربة مع بني قريظة، بل وفيما بين
فئات المشركين أنفسهم، أن الرهان على ذلك رهان فاشل، بل هو رهان على
يباب وسراب.
وهكذا فإن القبائل التي باتت على يقين من عجزها عن
مواجهة الإسلام تسير باتجاه ترميم علاقاتها، وتحسينها مع التيار
الإسلامي الجديد، الذي لا يزال يتنامى ويتعاظم
في المنطقة بصورة مطردة.
وظهر مصداق قوله «صلى الله عليه
وآله»:
الآن
نغزوهم ولا يغزوننا أو
ما هو قريب من هذا.
وأصبح زمام المبادرة
العسكرية على الخصوص بيد المسلمين، منذ هزيمة الأحزاب واليهود في حرب
الخندق.
﴿..وَكَفَى اللهُ المُؤْمِنِينَ
القِتَال وَكَانَ اللهُ قَوِيّاً عَزِيزاً﴾([91]).
وقد ادَّعى المعتزلي:
أن النبي «انتصر يوم بدر، وانتصر المشركون عليه يوم أُحد
وكان يوم الخندق كفافاً،
خرج هو وهم سواء لا عليه ولا له، لأنهم قتلوا رئيس الأوس، وهو سعد بن
عبادة،
وقتل منهم فارس قريش، وهو عمرو بن
عبد
ود،
وانصرفوا عنه بغير حرب بعد تلك التي كانت»([92]).
وقد اشتبه الأمر على المعتزلي في موضعين:
أحدهما:
قوله:
إن المشركين انتصروا على النبي «صلى الله عليه وآله» يوم أُحد.
وقد بينا في غزوة أُحد:
أن النصر فيها كان
للمسلمين،
وأن المشركين قد فروا من ساحة الحرب، خوفاً
من أن ينال
المسلمون منهم بصورة أشد وأعنف.
نعم..
قد حصلت نكسة للمسلمين في وسط المعركة، ثم تجاوزوها
بفضل جهاد علي، وقتله العديد من قادة كتائب المشركين، فراجع.
الثاني:
دعواه: أنه يوم الأحزاب لم يكن النصر لأحد،
مع أن النصر فيها كان للمسلمين، وذلك أمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان. وقد
أوضحنا ذلك فيما تقدم من نصوص وبحوث.
إلا أن يكون محط نظر المعتزلي هو عدد القتلى الذين
سقطوا من الفريقين في هذه المعارك.
ولكن من الواضح:
أن تعبيره بالنصر والهزيمة ـ والحالة هذه ـ يصبح بلا
مبرر.
1 ـ
الشهداء من المسلمين:
قال مالك:
لم يستشهد يوم
الخندق إلا أربعة، أو خمسة([93]).
وقال أبو زهرة:
خمسة([94]).
وقيل:
كان الشهداء ستة، منهم سعد بن
معاذ.
وزاد الكازروني:
أنهم من
الأنصار([95]).
وقال البعض:
استشهد سعد في
سبعة من الأنصار([96]).
وقال البعض:
قتل من المسلمين ثمانية، مضيفاً
الرجلين اللذين قيل: إنهما كانا طليعة للمسلمين فقتلا([97]).
وقد تقدم عدم صحة ذلك.
وحسب بعض المصادر، فالشهداء هم:
ثلاثة من بني عبد الأشهل:
سعد بن
معاذ،
رمي بسهم، وأنس بن أوس، قتله خالد بن الوليد،
وعبد الله بن سعد،
رماه رجل من بني عويف فقتله.
واثنان من بني جشم، هم:
الطفيل بن النعمان،
قتله وحشي،
وابن
عتمة،
قتله هبيرة بن أبي وهب.
وواحد من بني النجار (أو دينار) هو كعب بن زيد،
أصابه سهم غرب فقتله،
وقيل: قتله ضرار بن الخطاب.
وزاد الدمياطي في الشهداء من
المسلمين:
قيس بن زيد بن عامر، وعبد الله بن أبي خالد، وأبا سنان
بن صيفي بن صخر،
ذكر الحافظ في الكنى: أنه شهد بدراً، واستشهد في الخندق([98]).
وقتل من
المشركين ثمانية([99]).
وقيل:
ثلاثة([100]).
وقيل:
أربعة جميعهم
من قريش([101]).
وقد سمت بعض المصادر القتلى.
والقتلى الثلاثة من المشركين هم:
منبه بن عثمان (أو عثمان بن أمية بن منبه) أصابه سهم
فمات بمكة. ونوفل بن عبد الله،
وعمرو بن عبد ود([102])،
وعبيد بن السباق([103]).
فليتأمل في هذا الأخير وليراجع كلام ابن إسحاق.
وتقدم:
أن حسل بن عمرو بن عبد ود قد قتل هو الآخر
مع أبيه. فراجع الفصل السابق.
وقال ابن شهرآشوب:
إن
علياً «عليه السلام» قتل يوم الأحزاب: عمرو بن عبد ود وولده، ونوفل بن
عبد الله بن المغيرة، ومنبه بن عثمان العبدري، وهبيرة بن أبي هبيرة
المخزومي([104]).
قالوا:
«وأصبح رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالخندق، وليس
بحضرته أحد من عساكر المشركين،
قد هربوا وانقشعوا إلى بلادهم.
فأذن للمسلمين في الانصراف إلى منازلهم. فخرجوا مبادرين
مسرورين بذلك.
فكره رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن تعلم بنو قريظة
حب رجعتهم إلى منازلهم، فأمر بردهـم،
فبعث من ينادي في أثرهم، فما رجع منهم رجل واحد»([105]).
زاد في نص آخر قوله:
«من القر والجوع،
قالا: وكره رسول الله «صلى الله عليه وآله» سرعتهم، وكره أن يكون لقريش
عيون.
قال جابر:
فرجعت إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» فلقيته في
بني حرام منصرفاً،
فأخبرته، فضحك «صلى الله عليه وآله»([106]).
ويقول القمي عن الأحزاب:
«ففروا منهزمين،
فلما أصبح رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال لأصحابه: لا تبرحوا.
فلما طلعت
الشمس دخلوا المدينة، وبقي رسول الله «صلى الله عليه وآله» في نفر
يسير»([107]).
ويقول الراوندي:
«إن النبي «صلى الله عليه وآله» صلى بالناس الفجر،
ونادى مناديه: لا يبرحن أحد مكانه إلى أن تطلع الشمس.
فما أصبح إلا وقد تفرق عنه الجماعة إلا نفراً
يسيراً.
فلما طلعت
الشمس انصرف رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ومن كان معه، فلما دخل
منزله الخ..»([108]).
وكان انصرافه
«صلى الله عليه وآله» من غزوة الخندق لسبع ليال بقين من ذي القعدة([109]).
وكان المنافقون بناحية المدينة يتحدثون بنبي الله «صلى
الله عليه وآله» وأصحابه، ويقولون: ما هلكوا بعد؟!.
ولم يعلموا بذهاب الأحزاب،
وسرهم أن جاءهم الأحزاب، وهم بادون في الأعراب([110]).
وقد روى قطب الدين الراوندي:
قصة المغيرة بن أبي العاص في غزوة الخندق وملخص ما هو
محط نظرنا منها:
أن المغيرة بن أبي العاص ادَّعى:
أنه رمى رسول الله «صلى الله عليه وآله» فكسر رباعيته،
وشق شفتيه
وكذب، وادَّعى
أنه قتل حمزة وكذب.
فلما كان يوم الخندق ضرب الله على أذنيه، فنام ولم
يستيقظ حتى أصبح، فخشي أن يجيء
الطلب فيأخذوه، وجاء إلى منزل عثمان، وتسمى باسم رجل من بني سليم كان
يجلب إلى عثمان الخيل والغنم والسمن؛
فأدخله عثمان منزله، فلما علمت امرأة عثمان ما صنع
بأبيها وعمها صاحت، فأسكتها عثمان.
ثم خرج إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فطلب منه
الأمان
للمغيرة ثلاث مرات، والنبي يحول وجهه عنه حتى آمنه في الثالثة،
وأجله ثلاثاً،
ولعن من أعطاه راحلة، أو رحلاً،
أو قتباً،
أو سقاء، أو قربة، أو إداوة، أو خفاً،
أو نعلاً،
أو زاداً
أو ماء؛
فأعطاه عثمان هذه الأشياء.
ولم يوفق للخروج من محيط المدينة فأعلم جبرئيل
النبي «صلى الله عليه وآله» بمكانه، فأرسل زيد بن حارثة والزبير، فقتله
زيد لأن
النبي «صلى الله عليه وآله» كان قد آخى بين زيد وحمزة.
فرجع عثمان إلى امرأته، واتهمها بأنها كانت قد أخبرت
أباها بمكان عمه، فحلفت له بالله ما فعلت، فضربها بخشبة القتب ضرباً
مبرحاً
كان سبب وفاتها في اليوم الثاني، وقد منع النبي «صلى الله عليه وآلـه»
عثمان ـ الذي كان قد ألم بجاريته ليلة وفاتها ـ من حضور جنازتها([111]).
ولكن قد تقدم بعد غزوة حمراء الأسد:
أن هذه القضية قد حصلت بعد واقعة أحد. وربما تكون رواية
الراوندي أقرب والله هو العالم.
([1])
يقول القمي في تفسيره ج2 ص181 والبحار ج20 ص223 عنه: إن قريظة
قد نقضوا العهد نهاراً، فلما كان في جوف الليل جاء نعيم بن
مسعود إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، وكان قد أسلم قبل قدوم
قريش بثلاثة أيام.
ونقول: لماذا أخَّر نعيم مجيئه إلى النبي «صلى الله عليه وآله»
ليعلن إسلامه هذه المدة الطويلة؟! وآثر البقاء في صفوف أهل
الشرك.
([2])
وذكرت بعض المصادر: أن اليهود هم الذين أرسلوا عزال بن سموأل
يطلبون التواعد على الزحف بشرط اعطائهم رهـائن من أشرافهم
سبعين رجـلاً، فلم = = يرجعوا إليهم بجواب. أضافت بعض
المصادر: أن نعيماً عاد إلى بني قريظة وأخبرهم: أن أبا سفيان
قال بعد أن ولى عزال: لو طلبوا مني عناقاً ما رهنتها، راجع:
سبل الهدى والرشاد ج4 ص543 وإمتاع الأسماع ج1 ص237 والمغازي
للواقدي ج2 ص482 و 485 والسيرة الحليبة ج2 ص325 و 326.
([3])
ويذكر الواقدي: أن الزبير بن باطا قد نصحهم بعدم طلب الرهن من
قريش، لأنهـا لا تعطيهم إيـاه، وهم أكثر عدداً ومعهم كـراع ولا
كـراع مع بني قريظة = = «وهم يقدرون على الهرب ونحن لا نقدر
عليه، وهذه غطفان تطلب إلى محمد أن يعطيها بعض ثمار المدينة،
فأبى أن يعطيهم إلا السيف» فلم يوافق الزبير أحد من قومه، فلما
كان ليلة السبت أرسل أبو سفيان الخ.. راجع: سبل الهدى والرشاد
ج4 ص543 و 544.
([4])
تجارب الأمم ج1 ص150 ـ 152 والمغازي للواقدي ج2 ص481 ـ 484
وسبل الهدى والرشاد ج4 ص541 ـ 545، وتجد هذه القضية بتلخيص أو
بدونه في المصادر التالية: الكامل في التاريخ ج2 ص182 وإمتاع
الأسماع ج1 ص6 23 ـ 238 والبداية والنهاية ج2 ص111 و 112
وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص242 و 243 وتاريخ ابن الوردي ج1 ص162
والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص240 ـ 242 وتفسير القمي ج2 ص181
و 182 و 185 و 186 وبحار الأنوار ج20 ص23 و 224 و 228 و 229 و
207 و 208 ومجمع البيان ج8 ص344 ونهاية الأرب ج17 ص175 ـ 177
وتاريخ الخميس ج1 ص490 = = والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ص2
ص30 و 31 وعيون الأثر ج2 ص64 و 65 وحبيب السير ج1 ص363 وجوامع
السيرة النبوية ص151 و 152 والإكتفاء للكلاعي ج2 ص172 ـ 174
وشرح الأخبار ج1 ص297 ـ 299 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص214
ـ 216 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص241 و 242 والسيرة
الحلبية ج2 ص324 وفتح الباري ج7 ص309 وتهذيب سيرة ابن هشام
ص194 ـ 196 ودلائل النبوة للبيهقي ج3 ص446 ـ 219 و 220 وزاد
المعاد ج2 ص118 وبهجة المحافل وشرحه ج1 ص267 ـ 271.
([5])
راجع: تفسير القمي ج2 ص182 والبحار ج20 ص224 وفيه أن نعيم بن
مسعود حرض أبا سفيان على طلب الرهن من بني قريظة، عشرة رجال من
أشرافهم.
([6])
محمد في المدينة ص139.
([7])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج4 ص527 والبداية والنهاية ج4 ص113 و
3 10 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص199 ودلائل النبوة للبيهقي
ج3 ص401.
([8])
البداية والنهاية ج4 ص113.
([9])
البداية والنهاية ج4 ص113 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص216 و
217 وراجع: الأمالي للشيخ الطوسي ص267 ودلائل النبوة للبيهقي
ج3 ص404 و 405 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص541 والسيرة النبوية
لدحلان ج2 ص10.
([10])
تفسير القمي ج2 ص186 وبحار الأنوار ج20 ص223 عنه.
([11])
راجع: قرب الإسناد ص63 والبحار ج20 ص246 عنه وج100 ص31
والوسائل ج11 ص102 و 103.
([12])
دلائل النبوة للبيهقي ج3 ص447 وفتح الباري ج7 ص309.
([13])
المغازي ج2 ص485 و 486 وذكر ابن عقبة أيضاً ما فعله عكرمة راجع
السيرة النبوية لابن كثير ج3 ص199.
([14])
المغازي ج2 ص6 48 ودلائل النبوة للبيهقي ج3 ص301
([15])
المغازي للواقدي ج2 ص486 و 487 والمصنف ج5 ص368 و 369 وكنز
العمال ج10 ص292 و 293 عن ابن جرير.
([16])
راجع: المغازي للواقدي ج1 ص375.
([17])
الرسول العربي وفن الحرب ص256.
([18])
وسائل الشيعة ج11 ص102 وفي هامشه عن التهذيب ج2 ص53.
([19])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص540 وراجع: تاريخ الخميس ج1 ص490 و 491
وإعلام الورى (ط دار المعرفة) ص100 والكافي (ط دار الاضواء) ج8
ص233 والبحار ج20 ص268 و 269 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص12
والمغازي للواقدي ج2 ص487 والسيرة الحلبية ج2 ص324 وفيه:
«الأحاديث التي جاءت بذم يوم الأربعاء محمولة على آخر أربعاء
في الشهر».
([20])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص540 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص8
والسيرة الحلبية ج2 ص323.
([21])
راجع المصادر التالية: سبل الهدى والرشاد ج4 ص541 والبداية
والنهاية ج4 ص111 عن الصحيحين، وصحيح البخاري ج3 ص22 ومناقب آل
أبي طالب ج1 ص198 والسيرة الحلبية ج2 ص323 ومستدرك الوسائل ج11
ص109 و 110 (ط مؤسسة آل البيت)، والجعفريات ص218 وتيسير
المطالب ص246 = = وبحار الأنوار ج20 ص272 وبهجة المحافل ج1
ص268 وصحيح مسلم ج5 ص143.
وراجع: السيرة النبوية لابن كثير ج3 ص214 والمواهب اللدنية ج1
ص114 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص250 والمغازي للواقدي
ج2 ص487 وتاريخ الخميس ج1 ص490، ودلائل النبوة للبيهقي ج3 ص456
والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص8 و 12 وكنز العمال ج10 ص285.
([22])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص541 وراجع: دلائل النبوة للبيهقي ج3
ص403 و 404 وأنساب الأشراف ج1 ص345 والبداية والنهاية ج4 ص104
والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص200 والمغازي للواقدي ج2 ص477
والمصنف للصنعاني ج5 ص367.
([23])
الخرائج والجرائح ج1 156 والبحار ج20 ص248 وراجع: ص230 وتفسير
القمي ج 2 ص186 وغير ذلك.
([24])
راجع بحار الأنوار ج91 ص212 و 213 ومهج الدعوات ص70 و 71
والوسائل ج10 ص276 و 277.
([25])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص541 والبداية والنهاية ج4 ص111 عن أحمد،
وابن أبي حاتم، وتاريخ الخميس ج1 ص491 والسيرة النبوية لدحلان
ج2 ص8 و 12 والمواهب اللدنية ج1 ص114 والسيرة النبوية لابن
كثير ج3 ص213 والسيرة الحلبية ج2 ص323 وفتح الباري ج7 ص309.
([26])
إمتاع الأسماع ج1 ص238 وراجع: المغازي للواقدي ج2 ص488 والسيرة
النبوية لدحلان ج2 ص8 و 12 وحبيب السير ج1 ص364.
([27])
تاريخ ابن الوردي ج1 ص162 والمختصر في أخبار البشر ج1 ص135.
([28])
الجامع للقيرواني ص281.
([29])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص545 وراجع: السيرة الحلبية ج2 ص326
والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص10 و 12.
([30])
راجع: البحار ج20 ص192 عن مجمع البيان ج8 ص339 وتاريخ ابن
الوردي ج1 ص162 وتاريخ الخميس ج1 ص491 والسيرة النبوية لدحلان
ج2 ص12.
([31])
تاريخ اليعقوبي ج2 ص50 وراجع: الخرائج والجرائح (منشورات
مصطفوي) ص152 والبحار. ج20 ص249.
([33])
دلائل النبوة للبيهقي ج3 ص406.
([34])
الآية 9 من سورة الأحزاب.
([35])
راجع: تاريخ الخميس ج1 ص491 والسيرة الحلبية ج2 ص328 عن ابن
ظفر في الينبوع، والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص10 والمواهب
اللدنية ج1 ص114 وراجع: سعد السعود ص138.
([36])
مجمع البيان ج8 ص339
والبحار ج20 ص192 وتاريخ الخميس ج1 ص491.
([37])
حبيب السير ج1 ص364.
([38])
راجع: بهجة المحافل ج1 ص296 وراجع: سبل الهدى والرشاد ج4 ص546
ولم يذكر الملائكة. والسيرة الحلبية ج2 ص328 وسعد السعود ص138.
([39])
أنساب الأشراف ص345 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص546.
([40])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص546.
([41])
راجع: الخرائج والجرائح ج1 ص156 و 157 والبحار ج20 ص248 وراجع
ص230 وتفسير القمي ج2 ص186 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص10
والسيرة الحليبة ج2 ص10و326.
([42])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص545 عن البيهقي، والسيرة الحلبية ج2
ص326 وراجع السيرة النبوية لدحلان ج2 ص10.
([43])
مستدرك الحاكم ج3 ص31 وتلخيصه للذهبي بهامشه.
([44])
إعلام الورى (ط دار المعرفة) ص101 والكافي ج8 ص278 والبحار ج20
ص268 وراجع ص230 وتفسير القمي ج2 ص186.
([45])
الآية 13 من سورة الأحزاب.
([46])
في تفسير القمي ج2 ص187 والبحار ج20 ص231: أنه بعد أن اجتاز
الخندق شعر كأنه يمشي في حمام. وراجع: الخرائج والجرائح ج1
ص157.
([47])
راجع هذا النص الذي حاولنا تلخيصه في: سبل الهدى والرشاد ج4
ص547 ـ 549 عن الحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي، وأبي نعيم
في دلائلهما، ومسلم، وابن عساكر، وابن إسحاق، وستأتي بقية
المصادر في الهامش الذي بعد التالي، وكنز العمال ج10 ص282 و
283.
([48])
وفي نص آخر أنه قال: «إن كنا نقاتل أهل الأرض فنحن بالقدرة
عليه، وإن كنا نقاتل أهل السماء كما يقول محمد، فلا طاقة لنا
بأهل السماء الخ..» الخرائج والجرائح ص157 والبحار ج2 ص248
عنه.
([49])
تجارب الأمم ج2 ص152 و 153. وحديث حذيفة هذا موجود بإيجاز أو
بتفصيل في المصادر التالية: إمتاع الأسماع ج1 ص239 والكامل في
التاريخ ج2= = ص184 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص244 والبداية
والنهاية ج4 ص113 ـ 155 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص217 ـ
221 وإعلام الورى (ط دار المعرفة) ص101 وعيون الأثر ج2 ص65 و
66 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص243 ومجمع البيان ج8 ص344 و
345 ونهاية الأرب ج17 ص177 و 178 والمغازي للواقدي ج2 ص489 و
490 وتاريخ الخميس ج1 ص491 و 492 والوفاء ج2 ص694 ودلائل
النبوة لأبي نعيم ص433 ـ 435 وتهذيب سيرة ابن هشام ص195 ـ 197
وبحار الأنوار ج20 ص208 و 209 و 268 و 230 و 231 ودلائل النبوة
للبيهقي ج3 ص449 ـ 455 وفتح الباري ج7 ص307 و 308 و 312
والكافي ج8 ص278 و 279 وتفسيره وصححاه، وصحيح مسلم، كتاب
الجهاد باب غزوة الأحزاب، والسيرة الحلبية ج2 ص326 ـ 328
وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص243 و 249 و 250 والسيرة
النبوية لدحلان ج2 ص10 ـ 12 وبهجة المحافل وشرحه ج1 ص270 و 271
والمواهب اللدنية ج1 ص113 والإكتفاء للكلاعي ج2 ص174 و 175
والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص148 و 149 وكنز العمال ج10 ص285.
([50])
راجع: تفسير القمي ج2 ص187 والبحار ج20 ص230 والخرايج والجرائح
ج1 ص157 وراجع: السيرة الحلبية ج2 ص226 والمغازي للواقدي ج2
ص489 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص10 و 11 ولم تصرح المصادر
الثلاثة الأخيرة بأنـه «صلى الله عليه وآله» ناداه باسمه ثلاث
مرات، وكـذا في المصـادر = = التالية: السنن الكبرى للبيهقي ج9
ص148 و 149 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص244 والبداية والنهاية ج4
ص133 و 144 وراجع: مجمع البيان ج8 ص244 و 245 وتاريخ الخميس 1
ص491 والبحار ج20 ص208 و 209 وعيون الأثر ج2 ص65 والإكتفاء
للكلاعي ج2 ص174 و 175 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص242 و
243 و 249 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص217 ـ 219.
([51])
دلائل النبوة للبيهقي ج3 ص406 و 407.
([52])
الخرائج والجرائح ج1 ص157 والبحار ج20 ص248 عنه.
([53])
حدائق الأنوار ج2 ص590 و 591 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص148
وعيون الأثر ج2 ص65 ودلائل النبوة للبيهقي ج3 ص431 وصحيح
البخاري ج3 ص22 والمواهب اللدنية ج1 ص113 وتاريخ الإسلام
للذهبي (المغازي) ص247 والسيرة الحلبية ج2 ص326 والسيرة
النبوية لدحلان ج2 ص10 وبهجة المحافل وشرحه ج1 ص270 عن البخاري
ومسلم، وسنن الترمذي، وابن ماجة، وفي الأخير عن علي.
([54])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص562 و 563 والمواهب اللدنية ج1 ص113
وفتح الباري ج7 ص312.
([55])
حدائق الأنوار ج2 ص590 و 591.
([56])
السيرة النبوية لدحلان ج2 ص10 والسيرة الحلبية ج2 ص328.
([57])
المغازي ج2 ص492 والإمتاع ج1 ص240 وخاتم النبيين ج2 ص942
وراجع: السيرة النبوية لدحلان ج2 ص12 وأنساب الأشراف ج1 ص344
والنزاع والتخاصم ص17 و 18 والغدير ج3 ص252 عنه.
([58])
راجع: المغازي للواقدي ج2 ص493 والسيرة الحلبية ج2 ص331.
([59])
الجريدة: جماعة الخيل.
([60])
المغازي ج2 ص490 وأشار إلى ذلك في عيون الأثر ج2 ص66، وراجع:
السيرة النبوية لدحلان ج2 ص11 و 12 والسيرة الحلبية ج2 ص327
وراجع: إمتاع الأسماع ج1 ص239.
([61])
الخرائج والجرائح ج1 ص157 والبحار ج20 ص248 عنه.
([62])
راجع: بهجة المحافل ج1 ص269 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص546 عن ابن
جرير، وابن أبي حاتم والسيرة الحلبية ج2 ص328 وراجع: السيرة
النبوية لدحلان ج2 ص12.
([63])
أنساب الأشراف ج1 ص345.
([64])
راجع: على سبيل المثال: فتح الباري ج7 ص302.
([65])
راجع: سيرة مغلطاي ص56 والدر المنثور ج5 ص192 عن ابن أبي حاتم
وابن جرير عن السدي وقتادة.
([66])
الدر المنثور ج2 ص195 عن ابن سعد بن المسيب.
([67])
التفسير السياسي للسيرة ص262 و 263.
([68])
الآية 9 من سورة الأحزاب.
([69])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص550 عن البخاري والبداية والنهاية ج4
ص111 و 115 عن الصحيحين ومجمع البيان ج8 ص245 وتاريخ الإسلام
للذهبي (المغازي) ص250 وعن مسلم كتاب الذكر ج8 ص83 والبحار ج20
ص209 ودلائل النبوة للبيهقي ج3 ص456 وصحيح البخاري ج3 ص22
وبهجة المحافل ج1 ص271 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص214 و
221 وعن فتح الباري ج7 ص406.
([70])
تاريخ مختصر الدول ص95.
([71])
شرح نهج البلاغة للمعتزلي الشافعي ج5 ص7.
([72])
الإرشاد ص62 والبحار ج20 ص258.
([73])
تاريخ الخميس ج1 ص487 و 488 عن روضة الأحباب.
([74])
الخصال للشيخ الصدوق ج2 ص369 والبحار ج20 ص244.
([75])
راجع: الدر المنثور ج5 ص192 عن ابن أبي حاتم، وابن مردويه،
وابن عساكر وينابيع المودة ص94 و 96 و 137 عن المناقب وأبي
نعيم وميزان الاعتدال ج2 ص380 ومنـاقب آل طـالب ج3 ص134
والإرشاد للمفيد ص62 وكشف الغمة للأربلي ج1 ص206 وفضائل الخمسة
من الصحاح الستة ج1 ص323 والبحر المحيط ج7 ص224 ورورح المعاني
ج21 ص175 وكفاية الطالب ص234 ومجمع البيان ج8 ص350 و 334
والبحار ج20 ص196 و 205 و 259 وج 41 ص88 وشواهد التنزيل (ط
وزارة الثقافة والإرشاد الايرانية) ص7 و 8 و 9 ج2 ونهج الحق
ص199 وترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق ج2 ص420. وملحقات إحقاق
الحق للمرعشي النجفي ج3 ص376 ـ 380 وج 14 ص327 ـ 329 وج 20 عن
مصادر تقدمت وعن المصادر التالية: معارج النبوة للكاشفي ج1
ص163 ومناقب مرتضوي ص55 ومفتاح النجا للبدخشي (مخطوط) ص41
وتجهيز الجيش ص81 (مخطوط) ودر بحر المناقب (مخطوط) ص85 وأرجح
المطالب ص75 و 186.
([76])
شواهد التنزيل (ط وزراة الثقافة والإرشاد الإيرانية) ج2 ص10
وشرح نهج البلاغة للمعتزلي الشافعي ج13 ص284 عن الإسكافي.
([77])
تفسير القمي ج2 ص189 والبحار ج20 ص233.
([78])
ينابيع المودة ص96 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص134 والبحار ج41
ص88.
([79])
الآية 251 من سورة البقرة.
([80])
الإرشاد ص62 والبحار ج20 ص258.
([81])
شرح النهج للمعتزلي الشافعي ج19 ص62 والبحار ج20 ص273 عنه.
([82])
الآية 95 من سورة النساء.
([83])
إحقاق الحق ج3 ص381.
([84])
دلائل الصدق ج2 ص175.
([85])
الآية 25 من سورة الأحزاب.
([86])
شرح نهج البلاغة للمعتزلي الشافعي ج14 ص262.
([87])
راجع على سبيل المثال: تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص32 ـ
34 والغدير للعلامة الأميني ج5 ص43 ـ 65.
([88])
راجع المصادر التالية: سبل الهدى والرشاد ج4 ص549 عن أحمد،
والبخاري، والبزار، والبيهقي، وأبي نعيم، وفتح الباري ج7 ص312
والمواهب اللدنية ج1 ص115 ودلائل النبوة للبيهقي ج3 ص394، و
457 و 458 والسيرة النبوية= = لابن دحلان ج2 ص12 ووفاء الوفاء
ج1 ص305 وشرح النهج للمعتزلي ج19 ص62 وتاريخ الإسلام للذهبي
(المغازي) ص251 والسيرة الحلبية ج2 ص328 وصحيح البخاري ج3 ص22
والبحار ج20 ص258 و 273 و 209 والإرشاد للمفيد ص62 ونهاية
الأرب ج17 ص178 وعيون الأثر ج2 ص66 وراجع ص76 وحدائق الأنوار
ج2 ص592 والكامل في التاريخ ج2 ص184 والبداية والنهاية ج4 ص115
عن ابن إسحاق ومجمع البيان ج8 ص344 وبهجة المحافل ج1 ص271
والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص221 وتاريخ الخميس ج1 ص492.
([89])
إمتـاع الأسـماع ج1 ص241 والعبر وديـوان المبتـدأ والخـبر ج2 ق
2 ص32 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص549 والبداية والنهاية ج4 ص115
ومجمع البيان ج2 ص345 والبحار ج20 ص209 وتاريخ الخميس ج1 ص492
والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص12 ودلائل النبوة للبيهقي ج3 ص458
والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص266 والسيرة النبوية لابن كثير
ج3 ص221 والمواهب اللدنية ج1 ص115 وتهذيب سيرة ابن هشام ص207
والبحر المحيط ج7 ص224.
([90])
راجع: إمتاع الأسماع ج1 ص241 وخاتم النبيين ج2 ص942 والمغازي
للواقدي ج2 وبقية المصادر ـ وهي كثيرة جداً ـ تجدها في فصل:
الأحزاب إلى المدينة، وفي فصل: غدر بني قريظة.
([91])
الآية 25 من سورة الأحزاب.
([92])
شرح النهج للمعتزلي ج10 ص220.
([93])
الوفاء ج1 ص304 وتاريخ الخميس ج1 ص492 عن الوفاء والجامع
للقيرواني ص281.
([94])
خاتم النبيين ج2 ص938.
([95])
تاريخ اليعقوبي ج2 ص50 وتاريخ ابن الوردي ج1 ص163 وراجع:
البداء والتاريخ ج4 ص220 ومختصر التاريخ ص43 والوفاء ص694
وإمتاع الأسماع ج1 ص240 و 241، ومناقب آل أبي طالب ج1 ص198
وبهجة المحافل وشرحه ج1 ص272 وحبيب السير ج1 ص364 ووفاء الوفاء
ج1 ص304 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص550 و 551 والمغازي للواقدي ج2
ص495 و 496 وعيون الأثر ج2 ص67 والسيرة النبوية لابن هشام ج3
ص264 و 265 والبداية والنهاية ج4 ص115 و 116 والسيرة النبوية
لابن كثير ج3 ص222 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص252
وراجع: تاريخ الأمم والملوك ج2 ونهاية الأرب ج17 ص178 و 179
وتاريخ الخميس ج1 ص492 وتهذيب سيرة ابن هشام ص206 والسيرة
النبوية لدحلان ج2 ص13.
([96])
العبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق 2 ص32.
([97])
الرسول العربي وفن الحرب.
([98])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص551 وعيون الأثر ج2 ص67 و 68 والسيرة
النبوية لدحلان ج2 ص13.
([99])
تاريخ اليعقوبي ج2 ص50.
([100])
راجع المصادر التي تقدمت للقول بأن شهداء المسلمين ستة.
([101])
العبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق 2 ص32 والرسول العربي وفن
الحرب ص254 وروح المعاني ج21 ص175.
([102])
راجع: إمتاع الأسماع ج1 ص240 و 241 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص550
و 551 والمغـازي للواقـدي ج2 ص495 و 496 وعيـون الأثـر ج2 ص67
والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص264 و 265 والبداية والنهاية ج4
ص115 و 116 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص222 وتـاريـخ
الإسـلام للـذهـبي = = (المغازي) ص252 وتاريخ الأمم والملوك ج2
وتاريخ الخميس ج1 ص492 ونهاية الأرب ج17 ص178 و 179 وتهذيب
سيرة ابن هشام ص206 وحبيب السير ج1 ص364 وبهجة المحافل ج1 ص272
والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص13 والبحر المحيط ج7 ص224 وروح
المعاني ج21 ص175.
([103])
البحر المحيط ج7 ص224.
([104])
مناقب آل أبي طالب ج2 ص83.
([105])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص550 والمغازي ج2 ص 491. وفي إمتاع
الأسماع ج1 ص239 اكتفى بالقول: «وأصبح «صلى الله عليه وآله»،
فأذن للمسلمين بالانصراف، فلحقوا بمنازلهم».
([106])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص550 عن الطبراني، والواقدي. والمغازي
للواقدي ج2 ص492.
([107])
تفسير القمي ج2 ص187 والبحار ج20 ص231.
([108])
الخرائج والجرائح ج1 ص158 والبحار ج20 ص248 عنه.
([109])
تاريخ الخميس ج1 ص492 وعيون الأثر ج2 ص66 وراجع: نهاية الأرب
ج17 ص178 والسيرة الحلبية ج2 ص328 والسيرة النبوية لدحلان ج2
ص12 والمواهب اللدنية ج1 ص115 وفتح الباري ج7 ص311.
([110])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص550.
([111])
الخرائج والجرائح ج1 ص94 ـ 96 والبحار ج22 ص158. وقال في هامش
الخرائج: ورواه: بنحو آخر في الكافي ج3 ص251 والتهذيب ج3 ص333
وأخرجه في الوسائل ج2 ص818.
|