|
المسير إلى حصون قريظة
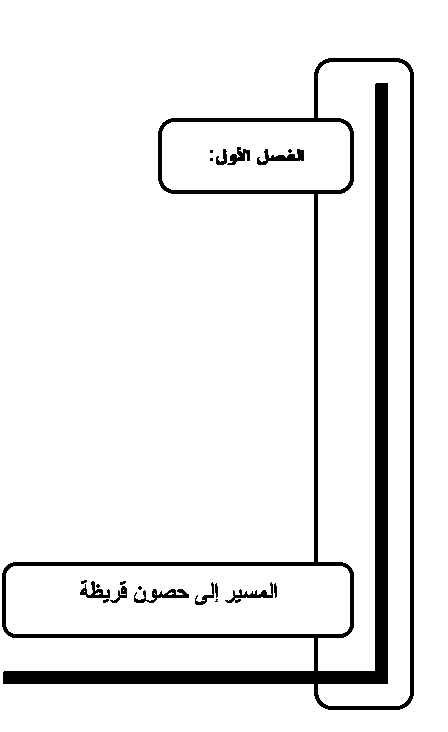
بـدايـة:
لقد انتهت حرب الأحزاب «الخندق»
التي كان المسلمون فيها يعانون من الجوع، والسهر، والخوف، والإشفاق
من مهاجمة ذراريهم ونسائهم من قبل أعدائهم.
وكان من الطبيعي أن يتنفسوا الصعداء حين رأوا عدوهم
يغادر أرضهم خائباً،
خائفاً، خاسئاً،
وكانوا يتمنون
أن يصلوا إلى أهلهم، وذويهم، وبيوتهم، ليرتاحوا من ذلك العناء الطويل.
ولكن هل يمكن لهم أن يطمئنوا على مصيرهم ومستقبلهم وإلى
جوارهم أولئك الذين حزبوا الأحزاب، ورموهم بذلك البلاء العظيم، الذي
كاد أن يقضي على الإسلام والمسلمين ويستأصل شأفتهم؟
ومن جهة ثانية:
ما هو الموقف الذي يمكن أن يتخذه النبي «صلى الله عليه
وآله» من بني قريظة الذين كانوا السبب في كل ما حصل؟
«ولو افترضنا:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» جدد العهد معهم في تلك الفترة فما الذي
يمنعهم من نقضه والخروج عليه مرة ثانية كما فعلوا بالأمس؟ في حين أنهم
لم يجدوا منه إلا الصدق والوفاء كما اعترف بذلك زعيمهم حينما دعاه حيي
بن أخطب للاشتراك مع الغزاة»([1]).
لقد كان منطق الحرب، ومنطق الحذر يدعو إلى مهاجمتهم، لأنهم
العدو القريب، الذي يتربص الدوائر بالإسلام وبالمسلمين وحربهم امتداد
لحرب الأحزاب.. وأحد فصولها، التي لا بد من إنجازها.
ويبقى أن نشير إلى:
أن لا مجال لاحتمال أن يكون النبي «صلى الله عليه وآله»
حين رأى سرعة أصحابه للعودة إلى المدينة، قد فكر في أن يعطيهم فرصة
للراحة فإنه لا مبرر لاحتمال كهذا وفق أي تقييم لما حدث ويحدث، فهذا
الأمر الإلهي قد جاء ليظهر أن الله سبحانه يأبى
أن يمهل الغدرة الفجرة، فربما يجدون أكثر من وسيلة
للتملص والتخلص أو حتى لفرار البعض منهم.. من مواجهة الجزاء العادل لما
اقترفته أيديهم.
وقد كان حيي بن أخطب وكعب بن أسد يتوقعان هذه الحرب وقد
أخذ كعب بن أسد العهد على حيي أن يدخل معهم في حصنهم ويصيبه ما أصابهم
إن رجعت قريش وغطفان. وذلك بعد أن دفع حيي كعباً إلى نقض عهد رسول الله
«صلى الله عليه وآله».
قد تقدم
الحديث
عن تاريخ غزوة قريظة والخندق.
وقد رجحنا أنهما كانتا في السنة الرابعة للهجرة بل قـال
ابن حـزم:
«فكان فتح بني قريظة في آخر ذي القعدة متصلاً
بأول ذي الحجة
في السنة الرابعة من الهجرة»([2]).
ونحن نكتفي بما ذكرناه في ذلك الموضع فليراجعه من أراد.
قريظة:
«فخذ من جذام إخوة النضير.
ويقال:
إن تهودهم كان في أيام عاديا أي السموأل، ثم نزلوا بجبل
يقال له:
«قريظة»،
فنسبوا إليه.
وقد قيل:
إن قريظة اسم
جدهم»([3]).
«وذكر عبد الملك بن يوسف في كتاب الأنواء:
أنهم كانوا يزعمون أنهم من ذرية شعيب نبي الله «عليه
السلام».
وهو بمحتمل (كذا) فإن شعيباً
كان من قبيلة
جذام، القبيلة المشهورة. وهو بعيد جداً»([4]).
ولا يهمنا هنا تحقيق ذلك، ولا تتبع مصادره.
وقد تقدم:
أنه كان بينهم وبين رسول الله «صلى الله عليه وآله» صلح
فنقضوه، ومالوا مع قريش. فوجه إليهم سعد بن معاذ، وآخرين، فذكروهم
العهد، فأساؤوا الإجابة.
ويقول البعض:
إن قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ
عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ
وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الحَرْبِ
فَشَرِّدْ بِهِم مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، وَإِمَّا
تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء
إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الخَائِنِينَ﴾([5])
قد نزل في شأن بني قريظة، كما قاله مجاهد؛
فإنهم كانوا قد عاهدوا النبي «صلى الله عليه وآله» على
أن لا يضروا به، ولا يمالئوا عليه عدواً،
ثم مالؤوا عليه الأحزاب يوم الخندق، وأعانوهم عليه بالسلاح،
«وعاهدوا مرة
بعد أخرى، فنقضوا»([6]).
ولم نجد فيما بأيدينا من نصوص تاريخية ما يدل على تكرر
نقض العهد من بني قريظة،
إلا ما رواه البخاري عن ابن عمر،
قال: «حاربت النضير وقريظة، فأجلى بني النضير، وأقر
قريظة، ومن عليهم،
حتى حاربت قريظة، فقتل رجالهم، وقسم نساءهم، وأموالهم
وأولادهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي «صلى الله عليه وآله»،
فأمنهم وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم: بني قينقاع، وهم رهط عبد
الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي بالمدينة.
ورواه أبو داود بنحوه، إلا أنه قال: حتى حاربت قريظة
بعد ذلك، يعني بعد محاربتهم الأولى وتقريرهم.
ويؤخذ من ذلك:
أن إجلاء من
بقي من طوائف اليهود بالمدينة كان بعد قتل بني قريظة»([7]).
وروي عن الزهري ومجاهد أن قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا
تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء..﴾
قد نزل في بني قريظة([8]).
وروي أيضاً:
أنها نزلت في
بني قينقاع([9]).
ونقول:
إن الآية لا تنطبق على بني قريظة، لأنهم قد نقضوا
العهد، وخانوا بالفعل، والآية إنما تتحدث عن خوف النبي «صلى الله عليه
وآله» من خيانة قومٍ ما.
وأما انطباقها على بني قينقاع فقد يكون له وجه، إذ إن
ما فعلوه لا يصل إلى درجة ما فعله بنو قريظة، ولأجل ذلك جاء عقابهم أخف
من عقاب أولئك.
على أننا نقول:
إن الآية الكريمة وإن كانت قد نزلت في هذه المناسبة إلا
أنها أرادت أن تعطي قاعدة عامة صالحة للانطباق في كل زمان.
وقد روي عن مجاهد:
أن قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ
الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِن أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ
وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ
وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيراً﴾([10])
نزل في بني قريظة([11]).
وكذا روي عن
قتادة([12])
وسعيد بن جبير([13]).
ويؤيد ذلك بل يدل عليه:
أن الضمير في «ظاهروهم» يعود إلى الذين كفروا في الآية
السابقة، الذين هم الأحزاب، والذين ظاهروا الأحزاب، وأنزلهم الله من
صياصيهم، وقتل المسلمون فريقاً منهم وأسروا فريقاً، وهم بنو قريظة
بالذات.
قالوا:
لما انصرف المشركون من الخندق، خافت بنو قريظة خوفاً
شديداً،
وقالوا: محمد يزحف إلينا. وكانت امرأة نباش بن قيس قد رأت([14])
ـ والمسلمون في حصار الخندق ـ الخندق ليس به أحد. وأن الناس تحولوا
إليهم في حصونهم، فذبحوهم ذبح الغنم.
فذكرت ذلك لزوجها، فذكره للزبير بن
باطا، فقال الزبير:
ما لها، لا
نامت عينها؟ تولي قريش، ويحصرنا محمد، والتوراة؟ ولما بعد الحصار أشد
منه([15]).
ونريد أن نسجل هنا:
1 ـ
أن الإنسان يهتم كثيراً بكل ما يمس مصيره
ومستقبله
ويتحرك حتى على أساس التخيل والتوهم لمواجهة أي احتمال
قادم إليه من المجهول. فنجده يلتجئ حتى لقارئة البخت التي يعلم أنها
تكذب عليه، فإذا تكلمت بكلمات عامة وغائمة، تقولها عادة لكل إنسان،
فإنه يتلقفها بلهفة، وبحساسية وشفافية متناهية، ويبدأ بتطبيقها على
حاله وأحواله.
فإذا قالت له مثلاً:
ستأتيك رسالة من صديق، تخيل أن فلاناً
الغائب هو الذي سيرسل إليه تلك الرسالة.
ثم إذا قالت له:
هناك من يحسدك أو يكرهك، وهو أمر قد يحدث لكل إنسان،
فإنه يطبق ذلك على فلان أو فلان،
وتضطرب الانفعالات في نفسه تجاهه،
وهكذا..
أما إذا كان الذي يأتيه من المجهول، ويلامس مستقبله
وحياته ومصيره له درجة من الواقعية مهما كانت هزيلة وضئيلة، فإن إحساسه
بالخطر سوف يتعاظم إلى درجة كبيرة وخطيرة. ولسوف يؤثر على توازنه في
حركته وفي مواقفه،
بل وقد يفقده ثقته بكثير من خططه المستقبلية، ويفسدها
عليه.
ومن الواضح:
أن المنامات والرؤى قد أثبتت لها التجربة درجة من
الواقعية، ولكنها درجة ضعيفة وخفيفة،
ولكن هذا الإنسان يتعامل معها بجدية وباهتمام أكبر
وأكثر مما تفرضه واقعيتها تلك.
والذي يدل على واقعية الرؤيا، وأن لها تعبيراً، ما ذكره
الله تعالى في سورة يوسف، وأن يوسف «عليه السلام» قد عبر الرؤيا لصاحبي
السجن، ثم لملك مصر، وصدقت الرؤيا، وصدق يوسف «عليه السـلام»
هذا بالإضافة إلى رؤيا إبراهيم «عليه السلام» في قضية ذبح ولده إسماعيل
«عليه السلام».
2 ـ
إنه لا شك في أن للأحلام من حيث مناشئها حتى الكاذبة
منها صلة بالواقع، بنحو أو بآخر. فالكاذبة لها صلة بالحالة النفسية
والجسدية للشخص، فقد تنشأ عن تأثير بعض المآكل أو المشاهدات، أو أي شيء
يواجهه الشخص في حال يقظته مما كان له أثر في النفس أو اختزنته ذاكرته،
أو ما إلى ذلك.
وللصادقة صلة من نوع ما بالقوى الظاهرة والخفية
والنواميس الطبيعية المهيمنة التي تؤثر في مسيرة الحياة، إيجاباً
أو سلباً.
وليس بمقدورنا تحديد حقيقة تلك لقوى ولا تحديد نوع تلك النواميس، كما
أننا لا نستطيع تحديد أبعاد، ومدى، وكيفية ذلك التأثير الذي يربط بين
عالم الرؤيا، وعالم الواقع الخارجي الكوني وقواه ونواميسه.
والذي يزيد في حيرتنا هو ما نجده من تأثير حقيقي لتعبير
الرؤيا في الواقع الخارجي، وتوجيهه باتجاه معين، لينتج واقعاً
محسوساً
يختلف عن واقع محسوس آخر،
وأثر تعبير الرؤيا في إبعاد ذاك، ثم في حلول هذا مكانه.
فما هو نوع هذا التأثير، ومداه؟! وما هي مقتضياته؟!
وكيف تم ذلك؟ ولماذا؟!
كل ذلك وسواه لا يزال مجهولاً لدينا، وربما يبقى كذلك
مجهولاً، والمشيئة في ذلك كله إلى الله سبحانه.
3 ـ
وواضح أن رؤيا هذه المرأة القريظية، قد جاءت لتقدم
إنذاراً
لأولئك الذين اعتادوا على نقض العهود والمواثيق،
ولتريهم مصيرهم الذي ينتظرهم. وهي من الرؤى الصادقة، تماماً
كرؤيا عاتكة التي حصلت لها قبل حرب بدر، فإنها هي
الأخرى قد جاءت إنذاراً
لأهل مكة المشركين، وإقامة للحجة عليهم،
بطريقة تلامس الوجدان الإنساني،
وتثير ضميره، وتهزه روحياً من الأعماق.
يقول بعض المستشرقين عن قبيلة
قريظة:
«ظلت هذه القبيلة على الحياد فيما يتعلق بالعمل
العسكري، ولكنها قامت بمفاوضات مع أعداء محمد، ولو أنها وثقت من قريش
وحلفائهم من البدو لانقلبت على محمد.
وقد هاجم محمد قريظة، بعد أن تخلص من أعدائه، ليظهر أن
الدولة الإسلامية الفتية لا تسمح بمثل هذا الموقف المشبوه.
وانسحبت قريظة إلى أطمها، ولم ترد على الهجوم بحماس،
ثم أرسلت تطلب الاستسلام بنفس الشروط التي استسلم بها
بنو النضير، فأجيبت: أن عليها أن تستسلم بدون قيد أو شرط.
فطلب اليهود استشاره أبي لبابة، فلبى نداءهم.
أما ما جرى بينهما، فلا يزال سراً
الخ..»([16]).
ونقول:
إننا نسجل على هذا الكلام النقاط التالية:
1 ـ
إنه يظهر:
أن
هذا الكاتب يريد تخفيف ذنب بني قريظة، وإبهام حقيقة تصرفاتهم، وما صدر
منهم، بهدف إظهار أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد ظلمهم واعتدى
عليهم، وعاقبهم عقوبة لا يستحقونها.
فهو يوحي:
أن قريظة لم تنقلب على محمد، لأنها لم تثق بقريش
وحلفائها!!
وهو يدَّعي:
أنها لم ترد على الهجوم بحماس!! وانسحبت إلى أطمها.
ويدَّعي أيضاً:
أن موقف قريظة لم يزد على أن كان موقفاً
مشبوهاً.
وقد هاجمها
النبي «صلى الله عليه وآله»، ليظهر أن الدولة الإسلامية لا تسمح بمثل
هذا الموقف المشبوه!! وقريظة بزعمه قد عرضت الاستسلام بشروط قبلها
النبي «صلى الله عليه وآله» من بني النضير، لكنه رفضها من بني قريظة!!
بل كان «صلى الله عليه وآله» ـ على حد زعمه ـ يريد أن تستسلم قريظة دون
قيد أو شرط مع ما يتضمنه ذلك من معاني التحدي والعنفوان الإسلامي مع
الإمعان في إذلال قريظة وتحقيرها.
وهو يدَّعي
كذلك سرِّيَة
ما جرى بين أبي لبابة وبني قريظة. ربما ليضفي ـ هذا القائل ـ المزيد من
الغموض على حقيقة ما صدر من يهود قريظة، لأنه لا يصرح بتلاومهم على ما
صدر منهم، ولا يصرح بمعرفتهم بحقيقة الحكم الذي سيصدر في حقهم ـ ليظهر
أنهم قد أخذوا على حين غرة منهم ـ لا ينتج ذلك أنهم قد أخذوا خداعاً
وغدراً.
2 ـ
لقد ادَّعى
ذلك المستشرق: أن ما صدر هو مجرد مفاوضات مع أعداء محمد
«صلى الله عليه وآله»، لم تنته إلى اتفاق، وبقيت قريظة على ولائها، ولم
تنقلب على محمد «صلى الله عليه وآله».
متناسياً حقيقة:
أنهم نقضوا العهد، وأن النبي «صلى الله عليه وآله» أرسل
إليهم سعد بن معاذ، وآخرين ليقنعوهم بالعودة عن موقفهم، فرفضوا العودة
عن نقض العهد، وأسمعوهم ما يكرهون.
وتناسى أيضاً:
أنهم كانوا قد أرسلوا من تحرش بالنساء المسلمات في
أطمهم، وقتلت صفية «رحمها الله» واحداً منهم.
ثم تناسى أنهم أرسلوا إلى قريش بأحمال الطعام، فاستولى
المسلمون على القافلة، وجرى لهم معها قتال، وكان هناك جرحى،
وتناسى وتناسى.. إلى آخر ما هنالك من حقائق دامغة.
3 ـ
قد زعم هذا القائل:
أن قريظة انسحبت إلى أطمها، ولم ترد على الهجوم بحماس،
مع أن بعض النصوص التاريخية تقول: إنهم قد ناجزوا
المسلمين خارج حصونهم وألحقوا بهم بعض الهزائم، كما سيأتي، فما معنى
قوله: أنهم لم يردوا على الهجوم بحماس؟!
إننا لا ندري:
من أين استنتج حقيقة أنهم لم يردوا على الهجوم بحماس؟
وهم قد قاتلوا المسلمين بإصرار خارج حصونهم، ثم تحصنوا
في داخلها مدة طويلة ـ سيأتي أنها استمرت أياماً كثيرة تراوحت الأقوال
فيها ما بين عشرة أيام إلى شهر ـ ولم يفكروا بالاستسلام إلا بعد أن
سمعوا علياً «عليه
السلام»
يقسم على أنه لن يرجع عنهم حتى يفتح الله عليه.
4 ـ
قوله: إن ما جرى بينهم وبين أبي لبابة قد بقي سراً،
غير صحيح فقد ذكرنا موجزاً
عما جرى بينهم وبين أبي لبابة سيأتي في موضعه من هذا
الجزء فراجع.
وتُحَدِّثنا الروايات في مختلف
المصادر التاريخية:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» سار إلى بني قريظة عند
منصرفه من الخندق،
وذلك يوم الأربعاء (كما ذكره الواقدي وغيره) لسبع بقين
من ذي القعدة،
وكانوا على بعد
يوم من المدينة.
وأضاف الواقدي:
أنه انصرف
عنهم لسبع خلون من ذي الحجة([17]).
ولما انصرف «صلى الله عليه وآله» من الخندق، ودخل
المدينة، ووضع السلاح جاءه جبرئيل «عليه
السلام»
بأمر الله سبحانه في شأنهم بعد صلاة الظهر، فأمر «صلى الله عليه وآله»
المسلمين أن لا يصلي أحد منهم العصر إلا في بني قريظة، كما ذكره
البخاري وغيره([18]).
وعن ابن إسحاق:
أنه «صلى الله عليه وآله» أمر بلالاً فأذن في الناس: من
كان سامعاً
مطيعاً
فلا يصلين
العصر إلا في بني قريظة([19]).
لكن ذكر مسلم وآخرون أنه «صلى الله عليه وآله» قال: لا يصلين أحد
الظهر([20]).
ويقولون:
إنه «صلى الله عليه وآله» بعث يومئذٍ منادياً
ينادي: «يا
خيل الله اركبي»([21]).
ولتفصيل القول فيما تقدم نقول:
قد ذكر المؤرخون:
أن جبرئيل جاء إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، وهو في
بيت عائشة فغسل رأسه، واغتسل، ودعا بالمجمرة ليجمر، وقد صلى الظهر،
فأتاه جبرئيل على بغلة..
على ثناياه النقع، فوقف عند موضع الجنائز، فنادى:
عذيرك من محارب.
فخرج «صلى الله عليه وآله» فزعاً.
فقال له جبرئيل:
ألا أراك وضعت اللامة، ولم تضعها الملائكة بعد. لقد
طردناهم إلى حمراء الأسد. إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة، فإني
عامد إليهم فمزلزل بهم حصونهم،
فدعا «صلى الله عليه وآله» علياً «عليه
السلام»
الخ..([22]).
ويقول نص آخر عن عائشة:
سلَّم
علينا رجل، ونحن في البيت، فقام رسول الله «صلى الله عليه وآله» فزعاً.
فقمت في أثره، فإذا بدحية الكلبي.
فقال:
هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة.
قالت:
فكأني برسول الله «صلى الله عليه وآله» يمسح الغبار عن
وجه جبرئيل «عليه
السلام»([23]).
أو قالت:
بينا هو عندي
إذ دق الباب (أو: سمع صوت رجل) فارتاع لذلك رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، ووثب وثبة منكرة، وخرج، وخرجت في أثره، فإذا رجل على دابة،
والنبي «صلى الله عليه وآله» متكي على معرفة الدابة يكلمه فرجعت..
فسألته عن ذلك الرجل، فأخبرها أنه جبرئيل([24]).
ونحن نرتاب في صحة هذه الروايات وأضرابها، وذلك لما
يلي:
أولاً:
هي مضطربة ومتنافرة إلى حد كبيرة ونشير إلى موردين فقط
من موارد التنافر والاختلاف هما:
1 ـ
أن عائشة تذكر: أنها خرجت في أثر رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
فرأته «صلى الله عليه وآله» متكئاً
على معرفة دابة جبريل، فرجعت، فلما دخل النبي «صلى الله
عليه وآله» سألته عنه، فأخبرها.
لكن في رواية أخرى تقول عائشة:
كأني أنظر إلى
جبريل من خلل الباب، قد عصب رأسه العنان (الغبار)([25]).
وفي نص ثالث:
كأني أنظر إلى رسول الله يمسح الغبار عن وجه جبريل،
فقلت: هذا دحية الكلبي يا رسول الله؟!
فقال:
هذا جبرئيل([26]).
2 ـ
كان في بيت عائشة ساعتئذٍ،
وهي تغسل رأسه وقد غسلت شقه، فجاءه جبريل([27]).
مع أن ما تقدم آنفاً يقول:
فغسل رأسه واغتسل، ودعا بالمجمر ليجمر، وقد صلى الظهر،
فأتاه جبرئيل.
وفي نص ثالث:
أنه وضع لامته
واغتسل واستجمر([28]).
ثانياً:
قد ذكرت عائشة: أنها رأت جبرئيل من خلل الباب قد عصب
رأسه العنان.
وسيأتي:
أن كثيرين من الصحابة قد رأوه، وأن النبي «صلى الله
عليه وآله» قد أخبرههم أنه جبرئيل.
ولكن قد روي في المقابل:
أن الذي يرى جبرئيل «عليه
السلام»
يبتلى بالعمى فما رآه أحد إلا طمست عيناه.
فلماذا لم تبتل عائشة، ولا أحد من الصحابة بالعمى بسبب
رؤيتهم جبرئيل؟!
وستأتي الأحاديث
الدالة على ذلك
عن قريب.
ثالثاً:
ذكرت الروايات المتقدمة أنه «صلى الله عليه وآله» كان
حين جاءه جبريل في بيت عائشة، مع أن ثمة روايات أخرى تخالفها في ذلك،
فلاحظ ما يلي:
1 ـ
إنه «صلى الله عليه وآله» كان حين جاءه جبرئيل في بيت
زينب بنت جحش وهي تغسل رأسه.
وفي الدر المنثور:
يغسل رأسه، وقد غسلت شقه إذ جاء جبرئيل فقال:
الخ..([29]).
2 ـ
إنه «صلى الله
عليه وآله» قد كان في بيت أم سلمة([30]).
3 ـ
إنه «صلى الله
عليه وآله» كان حينئذٍ في بيت فاطمة «عليها السلام»، فقد قال
الدياربكري: «وفي رواية في بيت فاطمة»([31]).
قال الزهري وعروة:
«لما دخل
النبي «صلى الله عليه وآله» المدينة، وجعلت فاطمة تغسل رأسه، إذ قال له
جبرئيل: رحمك ربك، وضعت السلاح، ولم يضعه أهل السماء؟ ما زلت أتبعهم
حتى بلغت الروحاء»([32]).
وفي نص آخر:
«فضربت فاطمة ابنته غسولاً،
فهي تغسل رأسه إذ أتاه جبرئيل على بغلة، معتجراً
بعمامة بيضاء،
عليه قطيفة من استبرق، معلق عليها الدر والياقوت، عليه الغبار([33])
ثم يذكر سائر ما تقدم في النص السابق.
ويؤيد هذا القول الأخير:
ما روي من أنه «صلى الله عليه وآله» كان إذا سافر كان
آخر عهده ببيت فاطمة، وإذا عاد من سفر، فإن أول ما يبدأ به هو بيت
فاطمة «عليها
السلام»([34]).
والمفروض:
أن هذا الأمر قد كان فور عودته من حرب الخندق.
إلا أن يقال:
إنه قد مرت فترة كبيرة تكفي لزيارة ابنته فاطمة، ثم
انتقاله إلى بيت إحدى
زوجاته: أم سلمة، أو زينب، أو عائشة. وهذا ما دعانا إلى
اعتبار ذلك القول مؤيداً لا دليلاً..
ونأمل أن لا يخفى على القارئ
الكريم:
أنه قد كان ثمة من يهتم بالتركيز على نقل خصوص ما يرتبط
بعائشة، خصوصاً إذا دخلت روايتها، أو روايتهم سيرة ابن إسحاق، أو ابن
عقبة، أو الواقدي، أو الصحيحين، ثم يأتي الآخرون، ويقتصرون على نقل ما
يجدونه في هذه الكتب، التي تهتم بمنقولات عائشة، وابن أختها عروة بن
الزبير، وأضرابهما.
فيخيل ـ بعد هذا ـ للناظر في كتب التاريخ: أن القضية من
المسلمات التاريخية، وأن ما عداها شاذ، لا يلتفت إليه.
وهذا الأمر:
ينسحب على كثير من القضايا التي حفلت بها كتب التاريخ،
وتناقلتها على أوسع نطاق. فإذا راجعت وقارنت، وتتبعت المصادر، فستجد
أنها تنتهي إلى مصدر واحد تقريباً
في أكثر الأحيان.
ونلاحظ هنا:
أن سياسة القرصنة، وسرقة المواقف، واقتناص الفضائل، كانت هي المهيمنة
على ذهنيات ذلك الفريق، الذي يريد أن يصنع لنفسه ولفريقه تاريخاً، ولو
بقيمة أن يفرغ التاريخ الحقيقي من محتواه، وأن يقلب الكثير من الأمور
رأساً على عقب، لتصب في اتجاه خاص به، رسمه لنفسه، فباع واشترى،
واستولى واستلب، ووهب حسبما رآه ضرورياً ومناسباً لذلك الاتجاه.
وهذا الكتاب قد حفل بنماذج كثيرة لهذا الاتجاه يصعب
إحصاؤها، وما فاته مما لم يدخل في نطاق اهتماماته لأكثر من سبب، أكثر
من ذلك بأضعاف كثيرة.
وقد نشير إن شاء الله في أواخر هذا الكتاب إلى بعض
النماذج التي تتناسب مع ما أشرنا إليه في عنوان هذه الفقرة، التي نحن
بصدد استكمال الحديث فيها، وهو: أن النبي
«صلى الله عليه وآله»
الذي دفن في بيت فاطمة
«عليها
السلام»
قد نقلته رواياتهم
إلى
بيت عائشة، ودفنته هناك.
كما أن السيدة خديجة التي تزوجها رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
بكراً لا يتجاوز عمرها الخمس وعشرين سنة، قد جعلتها رواياتهم زوجة
لأكثر من أعرابي، ونسبوا لها بنات زعموا أنها ولدتهن.
ثم إنهم عمدوا إلى عائشة، التي كانت كبيرة السن وقد
تزوجت قبل النبي
«صلى الله عليه وآله»
وولدت ولداً اسمه عبد الله، فجعلتها رواياتهم بكراً تزوجها النبي
«صلى الله عليه وآله»
في عمر الست سنين.
وفي مورد ثالث:
قلبت رواياتهم الإفك الذي كان على ماريا ونزلت في تبرئتها آيات
مباركات، ليصبح هذا الإفك على عائشة، وتصبح الآيات نازلة في حقها.
وعلى هذه فقس ما سواها.
وسيأتي ذلك في فصول ضمن هذا الكتاب فانتظر.
ويقول
المؤرخون:
إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» خرج إلى بني قريظـة
فلما بلغ الصورين([35])
(هو موضع قرب المدينـة) قال: هل مر بكم أحد.
قالوا:
نعم، مر بنا دحية الكلبي على بغلة بيضاء.
فقال رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»:
ذاك جبرئيل([36]).
وفي نص آخر:
خرج «صلى الله عليه وآله» فمر على مجلس من مجالس
الأنصار في بني غنم، ينتظرون رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقال
لهم: هل مر بكم الفارس آنفاً؟
ثم أخبرهم أنه جبرئيل وليس دحية.
زاد في نص آخر قوله:
أرسل إلى بني
قريظة ليزلزلهم، ويقذف في قلوبهم الرعب([37]).
بل جاء في بعض الروايات ما يلي:
«وتخلف النبي «صلى الله عليه وآله»، ثم لحقهم، فجعل
كلما مر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بأحد، فقال: هل مر بكم
الفارس؟!.
فقالوا:
مر بنا دحية
بن خليفة، وكان جبرئيل يشبه به»([38]).
ويقول نص آخر:
«فخرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» فاستقبله حارثة
بن نعمان.
فقال له:
ما الخبر يا حارثة؟
قال:
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذا دحية الكلبي ينادي في
الناس: ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة.
فقال:
ذاك جبرئيل»([39]).
غير أن نصاً آخر يذكر:
أنه «صلى الله عليه وآله» مر بنفر من بني النجار
بالصورين، فيهم حارثة بن النعمان، قد صفوا عليهم السلاح، فقال: هل مر
بكم أحد؟!
قالوا:
نعم، دحية الكلبي..
إلى أن قال:
فأمرنا بلبس السلاح، فأخذنا سلاحنا وصففنا.
وقال لنا:
هذا رسول الله يطلع عليكم الآن.
قال حارثة بن النعمان:
فكنا صفين.
فقال لنا رسول الله:
ذلك جبريل «بعث إلى بني قريظة ليزلزل بهم حصونهم، ويقذف
الرعب في قلوبهم».
فكان
حارثة بن النعمان يقول:
رأيت جبريل من الدهر مرتين: يوم الصورين، ويوم موضع الجنائز، حين رجعنا
من حنين([40]).
ونقول:
إن الروايات المتقدمة تفيد:
أن الكثير من المسلمين خصوصاً من بني النجار وكذلك
حارثة بن النعمان قد رأوا جبريل، إما وهو ينادي في الناس، يأمرهم
بالمسير إلى بني قريظة، أو حينما مرَّ
على مجالسهم، وطلب منهم أن يلبسوا السلاح لأجل ذلك.
قال ابن حزم:
«رأى
قوم من
المسلمين يومئذٍ جبرئيل في صورة دحية الكلبي، على بغلة عليها قطيفة، ثم
مر عليهم دحية»([41]).
مع أنهم يروون:
أن من يرى جبرئيل يصاب بالعمى، إذا لم يكن نبيَّاً.
ونذكر من هذه الروايات ما يلي:
1 ـ
روي: أنه رأى ابن عباس رجلاً مع النبي «صلى الله عليه وآله»، فلم يعرفه،
فسأل النبي «صلى الله عليه وآله» عنه.
فقال له النبي
«صلى
الله عليه وآله»:
رأيته؟!
قال:
نعم.
قال:
ذلك جبرئيل. أما إنك ستفقد بصرك. فعمي بعد ذلك في آخر عمره([42]).
2 ـ
وروي أيضاً: أن ابن عباس جاء إلى النبي «صلى الله عليه وآله» وعنده رجل،
قال:
فقمت خلفه. فلما قام الرجل التفت إلي، فقال: يا حبيبي،
متى جئت؟.
قلت:
منذ ساعة.
قال:
منذ ساعة؟!
قال:
فرأيت عندي أحداً؟!
قلت:
نعم، الرجل.
قال:
ذاك جبرئيل.
أما إنه ما رآه أحد إلا ذهب بصره، إلا أن يكون نبياً. وأنا أسأل الله
أن يجعل ذلك في آخر عمرك. اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل، واجعله
من أهل الإيمان([43]).
3 ـ
وروي: أن ابن عباس قال في عماه بسبب رؤية جبرئيل، وإخبار النبي «صلى
الله عليه وآله» له بذلك:
إن يـأخـذ الله مـن عينـيَّ
نـورهمــا فـفـي لسـانـي وقـلـبي منهما نور
قـلـبـي ذكـي وعقلي غير ذي دخل وفي فـمي صارم كالسيف مأثور([44])
4 ـ
وفي رواية أخرى: أن العباس أرسل ولده عبد الله إلى النبي «صلى الله
عليه وآله» في حاجة، فوجد عنده رجلاً، فرجع ولم يكلمه، فلقي العباس
رسول الله «صلى الله عليه وآله» بعد ذلك، فذكر ذلك له: فقال «صلى الله
عليه وآله»: يا عم، تدري من ذاك الرجل؟!
قال:
لا.
قال:
ذاك جبريل لقيني. لن يموت ولدك حتى يذهب بصره، ويؤتى
علماً([45]).
إننا أردنا بما تقدم:
تسجيل تحفظ على ما يذكرونه من رؤية الناس لجبرئيل.. لكن
هذا التحفظ لا يعني أن يكون جبرئيل لم يقم بأي عمل في غزوة بني قريظة،
إذ من الجائز أن يكون «عليه
السلام»
قد نادى في الناس، وسمعوا صوته، ويكون النبي «صلى الله عليه وآله» هو
الذي أخبرهم بأن هذا هو صوت جبرئيل، وذلك كما حصل في أُحد
حين نادى:
لا فـــتـــــى إلا عـــــــلـــــي لا ســـيــــف إلا
ذو الـفـقــار
ومهما يكن من أمر:
فإن جبرئيل «عليه
السلام»
قال للنبي «صلى الله عليه وآله» عن الأحزاب: ما زلت أتبعهم حتى بلغت
الروحاء([46]).
أو قال له:
لقد طردناهم
إلى حمراء الأسد([47]).
ثم أمره
بالمسير إلى بني قريظة، وفي بعض النصوص أنه قال له: إن الله يأمرك
بالمسير إلى بني قريظة، فإني عامد إليهم فمزلزل بهم([48]).
وفي نص آخر أنه قال:
والله لأدقنهم
دق البيضة على الصخرة([49]).
أو قال له:
«اخرج وقد أمرت بقتالهم،
وإني غاد بمن معي فنزلزل بهم حصونهم حتى تلحقونا، فأعطى أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب «عليه
السلام»
الراية، وخرج في إثر جبرئيل، وتخلف النبي «صلى الله عليه وآله»، ثم
لحقهم، فجعل كلما مر الخ..»([50]).
ويقول نص آخر:
فجاء جبرئيل ومن معه من الملائكة، فقال: يا رسول الله،
انهض إلى بني قريظة،
فقال:
إن في أصحابي جهداً
(فلو أنظرتهم أياماً).
قال:
إنهض إليهم، لأدخلن
فرسي هذا عليهم في حصونهم، ثم لأضعضعنهم([51]).
قال:
فأدبر جبريل ومن معه من الملائكة حتى سطع
الغبار في
زقاق بني غنم من الأنصار([52])
وهم جيران المسجد([53]).
وفي نص آخر:
أن جبرئيل «عليه
السلام»
قال للنبي «صلى الله عليه وآله»: إني قد قلعت أوتادهم، وفتحت أبوابهم،
وتركتهم في زلزال وبلبال([54]).
النبي
 يندب
الناس إلى بني قريظة: يندب
الناس إلى بني قريظة:
قال الطبرسي:
فدعا رسول الله «صلى الله عليه وآله» علياً، فقال: قدم
راية المهاجرين إلى بني قريظة..
فقام علي «عليه
السلام»،
ومعه المهاجرون، وبنو عبد الأشهل، وبنو النجار كلها، لم يتخلف عنه منهم
أحد. وجعل النبي «صلى الله عليه وآله» يسرب إليه الرجال، فما صلى العصر
إلا بعد العشاء([55]).
وعند ابن شهرآشوب:
«قدم علياً «عليه
السلام»
وقال: سر على بركة الله، فإن الله قد وعدكم أرضهم وديارهم.
ومعه المهاجرون، وبنو النجار، وبنو الأشهل، وجعل يسرب
إليه الرجال.
فلما رأواه قالوا:
أقبل إليكم قاتل عمرو. فقال علي «عليه
السلام»:
الحمد لله الذي أظهر الإسلام، وقمع الشرك»([56]).
وعن عائشة:
أنه «صلى الله عليه وآله» بعث بلالاً، فأذن في الناس:
أن
رسول الله «صلى الله عليه وآله» يأمركم أن لا تصلوا العصر إلا ببني
قريظة.
ولبس رسول الله «صلى الله عليه وآله» السلاح، والمغفر،
والدرع، والبيضة،
وأخذ قناة بيده، وتقلد الترس، وركب فرسه (اللحيف)،
وحف به
أصحابه، وتلبسوا السلاح، وركبوا الخيل([57]).
وفي نص آخر يقول:
لبس «صلى الله
عليه وآله» لامته، وبيضته، وشد السيف في وسطه، وألقى الترس من وراء
كتفه، وأخذ رمحه، وركب فرسه، واسمه لحيف، واجتنب فرسين([58]).
ولم يتخلف عنه من المهاجرين أحد، وأفاء
عامة الأنصار([59]).
واستخلف
على المدينة ابن أم مكتوم([60])
أو أبا رهم الغفاري، كلثوم بن الحصين([61]).
ونحن نشير هنا إلى الأمور التالية:
الأول: قدَّم
راية المهاجرين:
تقدم أن النص المنقول عن الطبرسي
يقول:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» قال لعلي «عليه
السلام»:
قدم راية المهاجرين إلى بني قريظة.
فقام علي «عليه
السلام»
ومعه المهاجرون وبنو عبد الأشهل، وبنو النجار كلها، الخ.. وأن عامة
الأنصار كانوا معه أيضاً.
ونحن نشير هنا إلى ما يلي:
ألف:
قد يدور
بخلد
البعض أن هذا النص يهدف إلى الإيحاء
بأن علياً كان في هذه الغزوة يحمل راية المهاجرين فقط، لا راية الجيش
كله..
ونقول:
إن هذا لا يمنع من أن يكون لواء الجيش كله ورايته مع
علي، بالإضافة إلى راية المهاجرين التي أعطاه رسول الله «صلى الله عليه
وآله» إياها أولاً..
ومما يؤكد ذلك:
أن نفس الطبرسي قد صرح بأن الذين قاموا مع علي حين
أعطاه راية المهاجرين هم المهاجرون، وبنو عبد الأشهل، وبنو النجار
كلها، وجعل رسول الله «صلى الله عليه وآله» يسرب..
وسيأتي ما يؤكد:
أن راية الجيش ولواءه كان في بني قريظة مع علي «عليه
السلام».
ولعل سر تصريح النبي «صلى الله عليه وآله» في بادئ
الأمر براية المهاجرين.. ثم ألحقها «صلى الله عليه وآله» براية الجيش
كله هو ما يلي:
1 ـ
إنه «صلى الله عليه وآله» قد أراد أن يفهم بني قريظة:
أنهم إذا كانوا قد نقضوا عهده من أجل أن ينصروا أهل مكة في صراعهم معه،
فإن هؤلاء أيضاً من أهل مكة،
وقد جاؤوا لحربهم وقتالهم، وعلى رأسهم ابن شيخ الأبطح
علي بن أبي طالب «عليه
السلام».
2 ـ
إنه إذا كان فريق من قبيلة الأوس يشعر بأن لبني قريظة
معه علاقة من نوع ما، ولا بد من التعامل على أساس حفظ هذه العلاقة،
وحفظ ما يترتب عليها من التزامات، فإن النبي «صلى
الله عليه وآله»
سوف لن يواجههم بما يعتبرونه تفريطاً
بالتزاماتهم تلك، أو عدم احترام لها، أو قلة وفاء بها،
إلا بعد أن تتكون لديهم هم أنفسهم القناعة الكاملة، بما يريد لهم أن
يلتزموا بموقف محدد تجاهه.
ولا نبعد كثيراً إذا قلنا:
إن هذا قد كان من أسباب بدئه بالمهاجرين في هذه الغزوة
بإعطاء رايتهم لعلي
«عليه
السلام»،
كما أنه كان أيضاً من أسباب تقديم النبي «صلى الله عليه وآله» أهل بيته
في الحروب، بالإضافة إلى أسباب أخرى ليس هنا محل التعرض لها.
كما أن هذا بالذات هو سبب إرسال سرايا المهاجرين في
بداية الهجرة. حتى اقتنع الأنصار بأن مشاركتهم الحربية ليس فيها أي
مساس بالتزاماتهم، ولا بما عقدوه مع الآخرين من عهود وعقود،
كما أنه يعتبر من صميم التزاماتهم تجاه الإسلام ونبي
الإسلام.
ب:
قد تقدم مبادرة بني عبد الأشهل، وبني النجار كلهم، ثم
لحوق عامة الأنصار بهم، حيث كان النبي «صلى الله عليه وآله» يسربهم إلى
علي «عليه
السلام».
وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على مزيد من الوعي، والإخلاص، والإحساس
بالمسؤولية لدى الأنصار بصورة عامة.
وقد ذكرت بعض النصوص المتقدمة
أيضاً:
أن جبرئيل «عليه
السلام»
قال للنبي «صلى الله عليه وآله»: ما زلت أتبعهم حتى بلغت الروحاء([62]).
ونحن نشك في صحة ذلك:
لأن جبرئيل قد جاء إلى النبي «صلى الله عليه وآله» ظهر
اليوم الذي فر المشركون في ليلته، أو بعد الظهر بقليل. أي بعد فرار
المشركين بنصف يوم أو أكثر بقليل،
ولا يمكن للمشركين أن يقطعوا المسافة التي بين المدينة
وبين الروحاء بهذه المدة القصيرة.
وذلك لأن
الروحاء كانت على بعد ليلتين من المدينة([63])،
بينهما أحد وأربعون أو اثنان وأربعون ميلاً([64]).
وقيل:
ستة وثلاثون([65]).
وقيل:
نحو أربعين([66]).
وقيل:
ثلاثون([67]).
وقيل:
أربعة برد([68]).
فالصحيح هو تلك الرواية التي تقول:
إن الملائكة
طردت المشركين حتى بلغوا حمراء الأسد([69])،
التي تبعد عن المدينة ثمانية أميال([70]).
قد ذكر فيما سبق:
أنه «صلى الله عليه وآله» ركب فرسه، وكان له «صلى الله
عليه وآله» ثلاثة أفراس كانت معه.
مع أنه قد روي عن أبي رافع:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» غدا إلى بني قريظة
على حمارٍ
عري، يقال له: يعفور.
زاد في بعض المصادر قوله:
والناس حوله.
وعند ابن سعد:
والناس يمشون([71]).
وفي شمائل الترمذي:
كان «صلى الله
عليه وآله» يوم قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف ليف([72]).
وقال اليعقوبي:
وركب حماراً
له([73]).
وذكر نص آخر، ذكرناه فيما تقدم
أيضاً:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» بعث بلالاً، فأذن في
الناس أن لا يصلي أحد منهم العصر إلا في بني قريظة.
بينما نجد نصاً آخر يقول:
إن قتادة بن النعمان أخبر النبي «صلى الله عليه وآله»
أن دحية ينادي في الناس: ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة.
فقال
«صلى
الله عليه وآله»:
ذاك جبرئيل، ادع لي علياً.
فجاء علي، فقال له: ناد في الناس ألا لا يصلين أحد
العصر إلا في بني قريظة. فجاء أمير المؤمنين «عليه
السلام»،
فنادى
فيهم، فخرج الناس، فبادروا إلى بني قريظة.
وخرج رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وعلي بن أبي طالب
بين يديه مع الراية العظمى الخ..([74]).
وإذا كنا نعلم:
أن السياسة كانت تتجه إلى إعطاء كل الأدوار إلى الآخرين
وتجاهل، بل وتزوير التاريخ، لإبعاد علي «عليه
السلام»
عن الواجهة إلى درجة تجعل البعض يتخيل أنه لم يكن قد ولد بعد.
فإننا ندرك السبب:
في أنهم يذكرون نصف هذا النص ويرددونه في كتبهم
وصحاحهم، ويتجاهلون النصف الآخر، إلى درجة التجرؤ على استبدال
علي «عليه
السلام»
ببلال. كما تقدم.
فاقرأ واعجب، فما عشت أراك الدهر عجباً.
وعن الزهري، عن ابن المسيب، بعد أن تحدث عن هزيمة
الأحزاب، قال: «فندب النبي «صلى الله عليه وآله» أصحابه في طلبهم.
فطلبوهم حتى بلغوا حمراء الأسد،
قال: فرجعوا، قال: فوضع النبي «صلى الله عليه وآله» لامته،
واغتسل، واستجمر، فنادى
النبي «صلى الله عليه وآله» جبرئيل:
عذيرك من محارب، ألا أراك قد وضعت اللامة، ولم نضعها نحن!!
فقام النبي «صلى الله عليه وآله»
فزعاً، فقال لأصحابه:
عزمت عليكم ألا تصلّوا
العصر حتى تأتوا بني قريظة، فغربت الشمس قبل أن يأتوها الخ..»([75]).
ونقول:
أولاً:
لا ندري لماذا قام النبي «صلى الله عليه وآله» فزعاً.
مع أن المقام مقام طمأنينة مع وجود العنايات الربانية، والتسديد
والتوجيه الإلهي، الذي يظهر جلياً
بمشاركة جبرئيل والملائكة في هذه الحرب؟!.
إلا أن يكون «صلى الله عليه وآله» قد خشي من أن يكون قد
ارتكب شيئاً من التقصير في مطـاردة
أعـداء
الله، والقضـاء
على مصدر الشـر
والانحراف وحاشاه أن يقصر!!
ثانياً:
إن معظم المسلمين حين جلاء الأحزاب قد تنفسوا الصعداء،
وبادروا إلى التوجه نحو المدينة، مخالفين بذلك أمر رسول الله «صلى الله
عليه وآله». كما قدمناه
سابقاً.
فما معنى القول:
إنهم طلبوهم حتى بلغوا حمراء الأسد؟!
ثالثاً:
قد تقدم آنفاً: أن جبرئيل والملائكة «عليهم
السلام»
هم الذين طاردوا المشركين إلى حمراء الأسد والروحاء([76]).
ولعل الأمر قد اشتبه على ابن المسيب بين غزوة الأحزاب وغزوة أحد، فإن
المسلمين إنما طاردوا المشركين إلى حمراء الأسد في غزوة أُحد
لا الأحزاب.
قد ذكرت الروايات المتقدمة:
أن المسلمين
اجتمعوا عند النبي «صلى الله عليه وآله» عشاء، فمنهم من لم يصل حتى جاء
بني قريظة، ومنهم من قد صلى، فذكروا ذلك لرسول الله «صلى الله عليه
وآله»، فما عاب أحداً منهم، وفي بعض النصوص: أن صلاة العصر حانت وهم في
الطريق فذكروا الصلاة، فاحتج الذين لم يصلوا بقول النبي «صلى الله عليه
وآله» لهم: لا يصلين أحد العصر، أو الظهر إلا في بني قريظة([77]).
وقد اختلفت الكلمات في توجيه ذلك، ونحن نجمل أولاً ما
ذكروا، ثم نشير إلى بعض النقاط التي تفيد في تأييد أو تفنيد ذلك،
فنقول:
1 ـ
قد ذكر البعض: أن عدم تعنيفه «صلى الله عليه وآله» لأولئك الذين تركوا
صلاة العصر إنما هو لأنهم أدركوا أن قيام الدولة الإسلامية، والعمل له
ألزم من الصلاة، مع ما لها من مكانة في الإسلام، لأنها إن أقيمت دولة
الإسلام أقيمت الصلاة، وسائر تعاليم الإسلام([78]).
ونقول:
إن هذا الكلام لا يصح، وذلك لما يلي:
أولاً:
إنه حين لم يعب أحداً منهم، فإما
أن يكون الفريقان معاً
على صواب، وهذا غير معقول،
أو يكون أحدهما مصيباً والآخر مخطئاً. فاللازم في هذه
الحالة هو تعليم المخطئ وإرشاده إلى الخطأ الذي وقع فيه.
ثانياً:
لو صح هذا الكلام،
لكان بوسع كل من يسعى لإقامة دولة إسلامية أن يترك
الصلاة ما دام يعمل في هذا السبيل.
بل كان له أن يترك سائر شعائر الإسلام، وأحكامه، إذا
جاز له ترك عمود الدين، للعلم القطعي بعدم
وجود
خصوصيةٍ
للصلاة في هذا المورد..
2 ـ
وذكر البعض توجيها آخر لما ذكروا من عدم تعنيف النبي
«صلى الله عليه وآله» لمن صلى،
ولمن ترك الصلاة.
فادَّعى:
أن من صلى حاز الفضيلتين: امتثال الأمر في الإسراع، وامتثال الأمر في
المحافظة على الوقت، وإنما لم يعنف «صلى الله عليه وآله» الذين أخروها:
لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمر، ولأنهم اجتهدوا فأخروا امتثالاً
للأمر، لكنهم لم يصلوا إلى أن يكونوا في أصوب من اجتهاد الطائفة
الأخرى([79]).
وعبارة البعض هنا تقول:
«إن أدلة الشرع تعارضت عندهم بأن الصلاة مأمور بها في
الوقت، مع أن المفهوم من قول النبي «صلى الله عليه وآله»: لا يصلين أحد
الظهر أو العصر إلا في بني قريظة، المبادرة بالذهاب إليهم، وأن لا
يشتغل عنه بشيء لا أن تأخير الصلاة مقصود في نفسه، من حيث أنه تأخير.
فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظراً
إلى المعنى، لا إلى اللفظ، فصلوا حين خافوا فوت الوقت. وأخذ آخرون
بظاهر اللفظ وحقيقته، فأخروها. ولم يعنف النبي «صلى الله عليه وآله»
واحداً من الفريقين لأنهم مجتهدون([80]).
ونقول تعليقاً على ذلك:
إننا نرى:
أن سبب عدم عيب النبي «صلى الله عليه وآله» من ترك
صلاته ليس هو ما ذكره هؤلاء ولا يمكن استفادة ضابطة ولا تأسيس أي من
القواعد التي استفادوها، وأسسوا وبنوا عليها، استناداً إلى فهمهم
المنقول عنهم آنفاً، لأنه فهم خاطئ،
ولا مبرر
له.
بل السبب:
في أن النبي «صلى الله عليه وآله» ما عاب، ولا عنف، ولا
لام أحداً
منهم على ذلك هو أنه «صلى الله عليه وآله» قد عذرهم
بفهمهم الخاطئ لمرمى كلامه، رغم وضوحه وظهوره.
وذلك إن دل على شيء:
فإنه ليس فقط لا يدل على اجتهادهم المدَّعى،
بل هو يدل على تدنٍ
خطير
في
مستوى تفكيرهم، إلى درجة يلحقهم بالقاصرين، الذين
يعذرون فيما يأتونه ويرتكبونه عن جهل وقصور.
فقد كان من الواضح:
أنه «صلى الله عليه وآله» حين أمرهم بالمسير إلى بني
قريظة على النحو المتقدم، إنما أراد منهم الإسراع في ذلك إلى درجة أن
لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، أي أنه «صلى الله عليه وآله» يريد
منهم أن يصلوا إليها
حينما يحين وقت صلاة العصر، أو قبل ذلك.
وهذا بالذات
هو الذي فهمه الذين صلوا في الطريق، كما ذكره البعض([81]).
لا أنه «صلى الله عليه وآله» أراد أن يسقط عنهم الصلاة في خارج منطقة
بني قريظة.
والذين صلوا في الطريق كانوا ـ فيما يظهر ـ هم الفئة
الأكثر وعياً،
وتفهماً
للكلام في مداليله اللغوية والعرفية.
3 ـ
أما ابن حزم فقد قال: «أما التعنيف، فإنما يقع على
العاصي المتعمد
المعصية، وهو يعلم أنها معصية، وأما من تأول للخير، فهو ـ وإن لم يصادف
الحق ـ غير معنف. وعلم الله أننا لو كنا هناك ما صلينا العصر في ذلك
اليوم إلا في بني قريظة، ولو بعد أيام.
ولا فرق بين
نقله «صلى الله عليه وآله» صلاة في ذلك اليوم إلى موضع بني قريظة، وبين
نقله صلاة المغرب ليلة مزدلفة إلى وقت العشاء، وصلاة العصر من يوم عرفة
إلى وقت الظهر. والطاعة في ذلك واجبة([82]).
ونقول:
لقد غلط ابن حزم هنا غلطاً فاحشاً، وذلك لما يلي:
أولاً:
اعتبر أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد نقل صلاة العصر
إلى بني قريظة، بحيث لو لم يذهبوا إلى بني قريظة إلا بعد أيام لتركوا
صلاة العصر في كل تلك الأيام،
ولو كان ابن حزم معهم لفعل مثل فعلهم أيضاً.
مع أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم ينقل الصلاة، بل
أمرهم بالإسراع في الحضور إلى بني قريظة، بهذا الأسلوب،
بحيث لو تأخر بعضهم عمداً،
أو انصرف عن الذهاب عصياناً،
أو لعذر فإن صلاة العصر لا تسقط عنه، بل تبقى واجبة عليه، وعليه أن
يصليها في مكانه أينما كان. ولو أن ابن حزم فعل غير هذا لكان هو الآخر
مخطئاً،
كما أخطأ ذلك الفريق من الصحابة في تركهم الصلاة في وقتها.
ثانياً:
لقد ناقض ابن حزم نفسه حين أشار إلى أن الذين أخروا
صلاتهم، قد تأولوا قصداً
للخير، وإن لم يصادفوا الحق. ثم اعتبر ـ من جهة أخرى ـ
أن صلاة العصر لم تكن واجبة عليهم إلا في بني قريظة.
ثالثاً:
لماذا التزم ابن حزم باختصاص هذا الحكم بصلاة العصر، أو
الظهر، ولا يتعداها إلى غيرها، مع أن ما ذكره من التعليل بالتأول قصداً
للخير يقتضى تعميم ذلك؟ كما أن تصريحه بنقل الصلاة إلى
بني قريظة يجعل الحكم مختصاً
بصلاة العصر في ذلك اليوم فقط!
رابعاً:
قد ادَّعى:
أن صلاة المغرب قد نقلت ليلة مزدلفة إلى وقت العشاء، وأن صلاة العصر قد
نقلت يوم عرفة إلى وقت الظهر. وأن صلاة العصر قد نقلت يوم بني قريظة
إلى بني قريظة. مع أن وقت المغرب مستمر إلى ما قبل منتصف الليل بقليل،
وتختص هي في أول المغرب بمقدار أدائها، ثم يصير الوقت مشتركاً
بينها وبين العشاء إلى ما قبل منتصف الليل بمقدار أربع
ركعات وهو يختص بالعشاء.
كما أن الظهر تختص في أول الزوال بمقدار أدائها، ثم
يصير الوقت مشتركاً
بينها وبين العصر إلى ما قبل غروب الشمس بمقدار أربع
ركعات التي هي خاصة بالعصر.
غير أن وقت فضيلة الظهر وزيادة المثوبة عليها يمتد إلى
حين يصير ظل كل شاخص مثله، ووقت فضيلة العصر وزيادة المثوبة عليها تمتد
إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه.
ويؤيد ذلك، بل يدل عليه قوله تعالى: ﴿أَقِمِ
الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ
الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾([83]).
فإنه تعالى لم يذكر في كتابه الكريم إلا ثلاثة أوقات
للصلاة، ولا ينطبق ذلك إلا على التقدير الذي ذكرناه آنفاً.
خامساً:
إن كلام ابن حزم لو سلمناه، فإنما يصح لو كانت قد
فاتتهم صلاة العصر فقط، أما لو كان الفائت هو صلاتي
الظهر والعصر معاً،
كما في بعض الروايات وكان النبي «صلى الله عليه وآله» قد قال لهم: لا
يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فلا يستطيع ابن حزم أن يثبت نقل كلا
الصلاتين إلى بني قريظة؛
لأن المذكور في كلامه «صلى الله عليه وآله» هو إحداهما
أما الأخرى وهي العصر، فإنه لم يصرح بنقلها، فكيف تركوها؟
والنصوص التي هي محط نظرنا هي التالية:
في البخاري ـ في جميع الروايات ـ:
لا يصلين أحد العصر، وفي مسلم: الظهر،
مع اتفاقهما
على روايتهما عن شيخ واحد، بإسناد واحد([84]).
ووافق البخاري
أبو نعيم، وأصحاب المغازي، والطبراني، والبيهقي في دلائله([85])
والإسماعيلي.
ووافق مسلماً:
أبو يعلى،
وابن سعد([86])،
وأبو عوانة([87])،
وابن حبان([88])
وقد جمع البعض بينهما باحتمال أن يكون بعضهم كان قد صلى
الظهر قبل الأمر بالذهاب وبعضهم لم يصلها، فقيل لمن لم يصلها: لا يصلين
أحد الظهر، ولمن صلاها: لا يصلين أحد العصر.
أو أن طائفة منهم راحت بعد طائفة،
فقيل للطائفة الأولى:
الظهر،
وللتي بعدها: العصر.
قال ابن حجر:
وكلاهما جمع لا بأس به.
لكن يبعده اتحاد المخرج؛
لأنه عند الشيخين بإسناد واحد، من مبدئه إلى منتهاه،
فيبعد أن يكون كل من رجال
أسناده
قد حدث به على الوجهين، إذ لو كان كذلك لحمله واحد منهم عن بعض رواته
على الوجهين، ولم يوجد ذلك.
وقيل:
في وجه الجمع أيضاً: أن يكون «صلى الله عليه وآله» قال
لأهل القوة، أو لمن كان منزله قريباً:
لا يصلين أحد الظهر.
وقال لغيرهم:
لا يصلين أحد
العصر([89]).
هذا كله:
مع العلم بأن المسافة إلى بني قريظة لم تكن بعيدة،
بل كانت لا تحتاح إلى أكثر من ساعتين من نهار، كما
سنرى.
إستفادات
ودلالات:
قد ذكروا:
أنه يستفاد من هذا التشريع
ـ
أعني جواز ترك الصلاة استناداً إلى اجتهاد أو فهم مشابه
ـ الأمور التالية:
1 ـ
إنه
لا إثم في الخطأ،
كما قال «صلى الله عليه وآله»: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان([90]).
2 ـ
إن هذا يدل
على جواز الجمع بين الصلاتين جمع تأخير([91]).
3 ـ
إن هذا منه «صلى الله عليه وآله» تقرير لمبدأ الاجتهاد
في استنباط الأحكام الشرعية.
4 ـ
إن المتخالفين في الاجتهاد معذوران، ومثابان،
سواء قلنا:
«إن المصيب واحد، أو متعدد»([92]).
5 ـ
إن استئصال الخلاف في مسائل الفروع، التي تنبع من
دلالات ظنية أمر لا يمكن أن يتصور أو يتم.
حكمة ذلك كله:
هو أن تكون الاجتهادات المختلفة وثيقة الصلة بالأدلة
المعتبرة شرعاً،
ليمكن للمسلمين أن يأخذوا بأيها شاؤوا حسب ظروفهم ومصالحهم. وهذا من
مظاهر رحمة الله لهم([93]).
6 ـ
في هذا دليل على أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين
مصيب. وفي حكم داود وسليمان في الحرث أصل لهذا الأصل أيضاً.
ولا يستحيل أن يكون الشيء صواباً في حق إنسان،
وخطأ في حق غيره. فيكون من اجتهد في مسألة، فأداه
اجتهاده إلى التحليل مصيباً
في استحلاله، وآخر اجتهد فأداه اجتهاده ونظره إلى
التحريم
مصيباً
في تحريمه.
وإنما المحال:
أن يحكم في النازلة بحكمين متضادين،
في حق شخص
واحد»([94]).
وقال ابن الديبع:
«وفي ذلك فسحة
للمجتهدين رضي الله عنهم، وأن كل مجتهد مصيب، أي في الفروع، إذا لم يخص
واحداً من الفريقين بصواب ما ذهب إليه»([95]).
7 ـ
«فيه دلالة لمن يقول بالمفهوم.
8 ـ
والقياس.
9 ـ
ومراعاة المعنى.
10 ـ
ولمن يقول
بالظاهر أيضاً»([96]).
11 ـ
وفيه أنه لا
يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده، إذا بذل وسعه في الاجتهاد([97]).
ونقول:
أولاً:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» إنما ترك تعنيف كلا
الطائفتين ومجرد ترك التعنيف لا يدل على جواز الجمع بين الصلاتين.
ولا على التصويب لكلا الفريقين، ولا على كون المجتهد لا
يعنف، وإن
أخطأ، إذا بذل وسعه في الاجتهاد([98]).
كما أنه لا يدل على وجود مجتهدين في البين؟؟
ولا على كون المتخالفين في الاجتهاد معذورين ومثابين.
ولا على القياس أو المفهوم، أو مراعاة المعنى..
ولا، ولا..
بل هو يدل فقط:
على عدم توجه العقاب على كلا الفريقين.
ثانياً:
بالنسبة للتصويب نقول:
ألف:
قد قلنا: إن هذه الحادثة لا تدل على وجود مجتهدين، لا
بين الذين تركوا صلاة العصر، ولا بين الذين صلوها.
ب:
لو سلم وجود مجتهدين، وأن ما جرى قد نشأ عن اجتهاد من
كلا الفريقين، فلا يدل موقف
النبي «صلى الله عليه وآله» على التصويب، بل على مجرد
المعذورية في صورة الخطأ،
أي أنه «صلى الله عليه وآله» قد عذرهم بفهمهم الخاطئ،
وليس المورد من موارد الاجتهاد، فضلاً
عن كونه صواباً أو خطأً.
ج:
إن نظرية التصويب باطلة عقلاً،
فلا بد من التأمل في صحة أو في دلالة ما ظاهره ذلك، إذ لا يمكن أن
يخالف الشرع العقل في أحكامه الصريحة.
د:
قد عبر البعض عن هذا التصويب، بأن يتمكن المسلمون أن
يأخذوا بأيهما شاؤوا، تبعاً
لحاجاتهم، وظروفهم ومصالحهم.
وهذا يعني:
أن تكون الأحكام تابعة لأهواء الناس ومصالحهم،
وهل هذا إلا تشريع التلاعب بالدين وأحكامه؟ والقضاء على
رموزه وأعلامه؟!
ثالثاً:
بالنسبة لجواز الجمع بين الصلاتين جمع تأخير نقول:
ألف:
إن هذا الكلام لم يظهر له معنى، إذا كان التأخير عن
خطأ، كما صرح به هذا القائل نفسه، فإن المخطئ معذور في خطئه إن كان عن
قصور، لا أنه يثبت له حكم شرعي في المورد الذي أخطأ فيه هو الجواز، أو
غيره من الأحكام.
ب:
لا ندري ما معنى جواز التأخير بنية الأداء، بعد فوت
الوقت. فإن الفوات قد تحقق بعد غروب الشمس، فما معنى نية الأداء لصلاة
العصر في خارج وقتها؟!
رابعاً:
إن إثبات الاجتهاد لجميع أولئك الناس، الذين كان فيهم
العالم والجاهل والكبير والصغير، ولو في أوائل بلوغه، والعالم والفلاح
والخ.. دونه خرط القتاد.
خامساً:
إن المسافة بين المدينة وبين بني قريظة قريبة جداً، لا
تحتاج إلى أكثر من ساعة أو ساعتين على أبعد تقدير لقطعها.
والمفروض:
أن أمر النبي «صلى الله عليه وآله» للمسلمين بالمسير قد
كان قبل صلاة العصر، بل وربما قبل الظهر، فتأخر البعض في الوصول إلى
بني قريظة إلى ما بعد العشاء الآخرة ليس له ما يبرره إلا تباطؤ هذا
البعض في تنفيذ أمر النبي «صلى الله عليه وآله».
ويؤكد هذا:
أن قسماً
من الناس قد صلوا العصر في بني قريظة،
ولم يقع منهم أي تأخير. وعدم صلاة ذلك الفريق الآخر ـ
حتى لو سلمنا أنهم قد فهموا الحكم الشرعي بصورة خاطئة، أو أنهم لم
يفهموا حقيقة مغزى
كلامه «صلى الله عليه وآله»
ـ.
نعم،
إن عدم صلاتهم لا مبرر له إلا التباطؤ وعدم الاهتمام
بتنفيذ مراداته «صلى الله عليه وآله» وتحقيق مقاصده..
أحدهما:
أننا
نرجح رواية: لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة، على رواية العصر. وذلك
لعدة أسباب..
الثاني:
بيان المسافة بين المدينة وقريظة، وأنها لا تستغرق أكثر
من ساعتين على أبعد تقدير، وقد تباطأوا أو تواطأوا على التسويف في
تنفيذ أمر النبي «صلى الله عليه وآله».
ونحن نوضح هذين الأمرين، بالمقدار الذي يسمح لنا به
المجال، فنقول:
أما بالنسبة لترجيح رواية:
لا تصلوا الظهر، فقد تقدم منا: أن جبرئيل قد جاء إلى
النبي «صلى الله عليه وآله»، وإن على ثناياه لنقع الغبار، وأخبره: أن
الملائكة لم يضعوا السلاح، بل ما زالوا يتعقبون المشركين إلى حمراء
الأسد التي كانت تبعد عن المدينة ثمانية أميال فقط، ولا يحتاج الوصول
إليها والرجوع منها إلى أكثر من ساعات قليلة لا تصل إلى ربع أو ثلث
يوم.
مع أنه:
كان قد مضى على انهزام الأحزاب حوالي نصف يوم.
وإذا كان النبي «صلى الله عليه وآله» قد بادر إلى أمر
الناس بالمسير إلى بني قريظة بمجرد سماعه ذلك من جبرئيل، فإن معنى ذلك
هو أنه قد طلب ذلك من الناس في وقت الضحى، وقبل صلاة الظهر بساعات يمكن
فيها الوصول إلى بني قريظة قبل حلول وقت الظهر. وذلك واضح.
وأما بالنسبة إلى الأمر الثاني:
وهو أن الوصول إلى بني قريظة لا يحتاج إلى وقت طويل
نقول:
إن ذلك يتضح إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما يلي:
إن
منازل بني قريظة كانت بالعالية (عالية المدينة) على وادي مهزور([99])
حيث يقع مسجد بني قريظة الذي هو بالعوالي على باب حديقة تعرف بحاجزة ـ
شرقي مسجد الشمس ـ (أعني مسجد الفضيخ)، الذي يقع هو الآخر شرقي مسجد
قباء([100])
في الحرة الشرقية المعروفة بحرة واقم، وتسمى حرة بني قريظة أيضاً،
لأنهم كانوا بطرفها القبلي([101]).
قد وردت روايات تفيد:
أن الذهاب إلى العوالي لا يستغرق وقتاً
كبيراً.
فقد ذكرت نصوص:
أن البعض كان يسير من مسجد المدينة بعد صلاة العصر،
فيصل إلى العوالي، والشمس بيضاء حية، نقية، مرتفعة.
وقد حددت نفس هذه النصوص المسافة التي كان يقطعها
بميلين، وثلاثة، وأربعة، وستة. وسيأتي تفسير هذا الاختلاف، والنصوص هي
التالية:
1 ـ
روي: أن رسول
الله «صلى الله عليه وآله» كان يصلي العصر، والشمس (بيضاء) مرتفعة حية،
فيذهب الذاهب إلى العوالي، فيأتيها، والشمس مرتفعة([102]).
وفي البخاري:
أن النبي «صلى
الله عليه وآله» نفسه كان يذهب بعد صلاة العصر إلى العوالي فيأتيها
والشمس مرتفعة([103]).
وبعض المصادر ذكرت النص المتقدم،
ولم تذكر عبارة:
فيأتي
العوالي، أو فيأتيها([104]).
وعدم ذكر ذلك لا يضر في المقصود، لأنه إنما يتحدث عن التبكير في صلاة
العصر،
ولا يتم ذلك إلا إذا قدر الوصول إليها قبل المغرب، كما
هو ظاهر.
2 ـ
عن أنس: كان أبعد رجلين من الأنصار من رسول الله «صلى الله عليه وآله»
دار أبو لبابة بن عبد المنذر، وأهله بقباء، وأبو عبيس بن خير، ومسكنه
في بني حارثة، فكانا يصليان مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» العصر،
ثم يأتيان قومهما، وما صلوا لتعجيل رسول الله «صلى الله عليه وآله» بها([105]).
ويلاحظ:
أن أبا لبابة
إنما كان يسكن في منطقة بني قريظة، الذين كانت منازلهم بالقرب من قباء
وقباء من العوالي([106]).
ولم يكن يسكن في قباء نفسها، كما يظهر من الرواية الآنفة الذكر.
ويدل على ذلك:
ما سيأتي من
أنه تعهد بأن يهجر دار قومه التي أصاب فيها الذنب ودار قومه هي دار بني
قريظة([107])،
«لأن ماله وولده، وعياله كانت في بني قريظة»([108]).
وقد ذكر المؤرخون:
أن أبا لبابة كان مناصحاً
لهم.
ومهما يكن من أمر:
فإن هذا يدل على أن بني قريظة كانوا يسكنون
في أدنى العالية، أي قرب منازل بني عمرو بن عوف.
ولسوف يأتي تحديد العالية، قرباً
وبعداً،
بعد قليل.
3 ـ
روي أن النبي
«صلى الله عليه وآله» كان يصلي العصر، والشمس بيضاء، نقية مرتفعة، يسير
الرجل حين ينصرف منها إلى ذي الحليفة، ستة أميال، قبل غروب الشمس([109]).
4 ـ
سأل ثابت بن عبيد أنساً
عن وقت العصر،
فقال: وقتها أن تسير ستة أميال إلى أن تغرب الشمس([110]).
5 ـ
عن أبي أروى: كنت أصلي مع النبي «صلى الله عليه وآله»
صلاة بالمدينة، ثم آتي ذا الحليفة، قبل أن تغيب الشمس، وهي على قدر
فرسخين
وفي نص آخر:
ستة أميال([111]).
والفرسخان عبارة عن ستة أميال، لأن الميل ثلث فرسخ([112]).
قال
الطحاوي:
«قد يجوز أن يكون ذلك سيراً
على الأقدام،
وقد يجوز أن يكون سيراً
على الإبل والدواب،
فنظرنا في ذلك، فإذا..
قال حدثنا أبو
أروى،
قال:
كنت أصلي العصر مع النبي «صلى الله عليه وآله»، ثم أمشي إلى ذي
الحليفة، فآتيهم
قبل أن تغيب الشمس، ففي هذا الحديث: أنه كان يأتيها ماشياً»([113]).
قد تقدم:
التعبير بكون الشمس حية.
وحياتها:
أن تجد حرها
كما عن خيثمة والخطابي([114]).
وقيل:
حياتها وجود
ضوئها، وصفاء لونها، قبل أن يصفر ويتغير([115]).
وقال الزين ابن المنير:
حياتها: قوة أثرها: حرارة، ولوناً،
وشعاعاً،
وإنارة،
وذلك لا يكون
بعد مصير الظل مثلي الشيء([116]).
وحين ذكر الحديث:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يصلي العصر، ثم يذهب
هو أو غيره إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة،
ألحَقَ
في نهاية هذا الحديث نفسه تحديداً
لبعد العوالي عن المسجد النبوي،
فقال:
والعوالي من
المدينة على ستة أميال([117]).
وفي
نص آخـر:
وبعض (وبُعْدُ)
العوالي من المـدينة
على أربعة أميـال
ونحوه([118]).
وعند السمهودي:
«المعروف:
أن
ما كان في جهة القبلة فأكثر من المسجد النبوي فهو عالية».
ويدل على ذلك:
أن السنح، وهو
منازل بني الحارث بن الخزرج بعوالي المدينة، وبينه وبين مسجد النبي
«صلى الله عليه وآله» ميل([119]).
وبعض المصادر تقول:
والعوالي على
ميلين، أو ثلاثة من المدينة، وأحسبه قال: أو أربعة([120]).
وفي بعضها:
على ميلين أو
ثلاثة([121]).
أو:
على أربعة
أميال، أو ثلاثة([122]).
قال عياض:
هذا حد
أدناها، وأبعدها ثمانية أميال، وبه جزم ابن عبد البر، وصاحب النهاية([123]).
وفي العتيبة، أو المدونة، عن مالك:
أقصى العالية
ثلاثة أميال، يعني من المسجد النبوي([124]).
قال
عياض:
كأنه أراد معظم عمارتها، وإلا، فأبعدها ثمانية أميال([125])،
أو عشرة([126]).
أما السمهودي فقال:
«طريق الجمع:
إن أدنى العوالي من المدينة على ميل، أو ميلين. وأقصاها عمارة على
ثلاثة أو أربعة أميال، وأقصاها مطلقاً ثمانية أميال»([127]).
واعتبر البعض:
أن أقرب
العوالي ميلان، وأبعدها ستة([128]).
وعند النووي والشوكاني:
«العوالي هي
القرى حول المدينة، أبعدها على ثمانية أميال من المدينة، وأقربها
ميلان، وبعضها ثلاثة أميال»([129]).
وقيل:
أقرب العوالي
من المدينة ميلان أو ثلاثة([130])،
ومنها مايكون
على ثمانية أميال أو عشرة([131]).
ومن الغريب والعجيب ـ وما عشت أراك الدهر عجباً ـ قول
العسقلاني هنا:
«أما من احتج لمن أخر بأن الصلاة حنيئذ كانت تؤخر كما
في الخندق، وكان ذلك قبل صلاة الخوف فليس بواضح؛
لاحتمال أن يكون التأخير في الخندق كان عن نسيان، وذلك
بيِّن
في قوله «صلى الله عليه وآله» لعمر، لما قال له: ما كدت أصلي
العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال: والله ما صليتها،
لأنه لو كان ذاكراً
لها لبادر
إليها كما صنع عمر، انتهى»([132]).
وهكذا، فإن نتيجة كلام العسقلاني
هي:
أن عمر كان أذكر للصلاة من رسول الله «صلى الله عليه
وآله»!! وأكثر اهتماماً
بشأنها. ولم ينسها عمر (رغم انشغاله الشديد بأمر الحرب
في الخندق حتى لقد حقق أعظم الإنتصارات
فيها!! وقتل أعظم فرسانها!! وهزم الأحزاب، وفرق جمعهم بسبب ضربته
الكبرى، التي تعدل عبادة الثقلين([133])،
أو انشغاله بالهزيمة والاختباء في الحديقة هو وطلحة
وآخرون، حتى فضحت أمرهم عائشة).
أما النبي «صلى الله عليه وآله»
الذي لم يقم بأي شيء من ذلك:
فقد نسي صلاته وذلك يعني ـ كما يريد هؤلاء أن يقولوا ـ:
أن الصلاة كانت لا تمثل لدى هذا النبي «صلى الله عليه
وآله» شيئاً ذا أهمية رغم كونه نبي هذه الأمة وهو الأسوة والقدوة.
نعم..
هذا ما يوحي به كلام العسقلاني الذي لم يعجبه نسبة
تأخير الصلاة عمداً
لبعض الصحابة، الذي قد يظهر أن بعضهم لا يجوز ـ بنظره ـ
نسبة أي قصور أو تقصير إليه، بل لا بد من الاهتمام به والحفاظ عليه
أكثر من النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله»، وحتى على حساب عصمته ونبوَّته.
والملفت هنا:
أن مسلماً
يروي في صحيحه هذه القضية بصورة ليس فيها ذلك، فيقول:
«عن عبد الله قال: حبس المشركون رسول الله «صلى الله
عليه وآله» عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله
«صلى الله عليه وآله»: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله
أجوافهم وقبورهم ناراً
الخ..»([134]).
([2])
جوامع السيرة النبوية ص156.
([3])
تاريخ اليعقوبي ج2 ص52 وراجع: سبل الهدى والرشاد ج5 ص33.
([4])
فتح الباري ج7 ص313 ووفاء الوفاء ج1 ص162.
([5])
الآيات 56 ـ 58 من سورة الأنفال.
([6])
مجمع البيان ج4 ص552 والبحار ج20 ص191 وراجع: الدر المنثور ج3
ص191 عن ابن أبي شيبة وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ
عن مجاهد باستثناء العبارة الأخيرة.
([7])
وفاء الوفاء ج1 ص309.
([8])
الدر المنثور ج3 ص191 عن أبي الشيخ عن الزهري، وعن ابن المنذر،
وابن أبي حاتم عن مجاهد. وأنساب الأشراف ج1 ص348 وراجع ص309 عن
الزهري.
([9])
أنساب الأشراف ج1 ص348 وراجع ص309.
([10])
الآيتان 26 و 27 من سورة الأحزاب.
([11])
الدر المنثور ج5 ص192 عن الفريابي، وابن أبي شيبة، وابن
المنذر، وابن أبي حاتم وأنساب الأشراف ج1 ص348.
([12])
الدر المنثور ج5 ص193 عن ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن
المنذر، وابن أبي حاتم.
([13])
الدر المنثور ج5 ص193 عن ابن سعد.
([15])
راجع: المغازي للواقدي ج2 ص496 ـ 497.
([16])
محمد في المدينة، لمونتجمري وات ص326.
([17])
راجع المصادر التـاليـة: التنبيه والإشراف ص217 والمغـازي
للواقـدي ج2 ص496 ومناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء) ج1 ص251
وعمدة القاري ج17 ص188.
([18])
راجع: العبر وديوان
المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص31 ووفاء الوفاء ص695 وتاريخ ابن الوردي
ج1 ص162 والثقات ج1 ص274 وجوامع السيرة النبوية ص152 والسيرة
النبوية لابن هشام ج3 ص244 و 245 والكامل في التاريخ ج2 ص185
وبهجة المحافل ج1 ص272 ونهاية الأرب ج17 ص187 ووفاء الوفاء ج1
ص305 والإكتفاء ج2 ص176 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص245 والسيرة
النبوية لابن كثير ج3 ص224، والمغازي للذهبي ص253 والسيرة
النبوية لدحلان ج2 ص13 والسيرة الحلبية ج2 ص331 ودلائل النبوة
للبيهقي ج4 ص6 و 7.
([19])
فتح الباري ج7 ص314 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص9.
([20])
راجع في ذلك: إرشاد الساري ج6 ص328 و 329 وعمدة القاري ج17
ص189 و 190 وفتح الباري ج7 ص313 و 314 والمواهب اللدنية ج1
ص115 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص34 و 35 والسيرة النبوية لدحلان
ج2 ص13 وشرح النووي على صحيح مسلم ج12 ص98 والسيرة الحلبية ج2
ص332 ودلائل النبوة للبيهقي ج4 ص8 وإمتاع الأسماع ج1 ص242.
([21])
عيون الأثر ج2 ص68 والمواهب اللدنية ج1 ص115 وإمتاع الأسماع ج1
ص242 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص9 وتاريخ الخميس ج1 ص493 والسيرة
الحلبية ج2 ص332 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص13.
([22])
المغازي للواقدي ج2 ص497 وراجع: طبقات ابن سعد (ط دار الأضواء)
ج2 ص74 وإمتاع الأسماع ج1 ص241 و 242 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص8
و 9 و 10 وراجع: تاريخ الخميس ج1 ص493 والسيرة النبوية لدحلان
ج2 ص13 والسيرة الحلبية ج2 ص331 و 332 و 333.
([23])
راجع: عمدة القاري ج17 ص192 وفتح الباري ج7 ص318 وسبل الهدى
والرشاد ج5 ص8 وتاريخ الإسلام (المغازي ص254).
([24])
راجع: عيون الأثر ج2 ص68 والبداية والنهاية ج4 ص117 عن البيهقي
ودلائل النبوة للأصبهاني ص437 ومجمع الزوائد ج6 ص141 عن
الطبراني في الأوسط، وسبل الهدى والرشاد ج5 ص8 وراجع: تاريخ
الخميس ج1 ص493 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص13 والسيرة الحلبية
ج2 ص333 ودلائل النبوة للبيهقي ج2 ص8 و 10 والسيرة النبوية
لابن كثير ج3 ص225 و 226.
([25])
الوفا ص694 و 697 والبداية والنهاية ج4 ص117 و 118 و 123
والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص13 وفتح الباري ج7 ص318 وراجع:
مسند أبي عوانة ج4 ص171 وأنساب الأشراف ج1 ص347.
([26])
سيرة ابن إسحاق ص397.
([27])
تاريخ الخميس ج1 ص493 وراجع: ابن سعد ج2 ص75 و 76 وفيه: أنه
نادى في الناس: أن ائتوا حصن بني قريظة، ثم اغتسل فأتاهم عند
الحصن.
([28])
المصنف للصنعاني ج5 ص369 ودلائل النبوة لأبي نعيم ص438 ومجمع
الزوائد ج6 ص145 عن الطبراني وسبل الهدي والرشاد ج5 ص8 و 9.
([29])
تاريخ الخميس ج1 ص493 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص13 والسيرة
الحلبية ج2 ص331 والدر المنثور ج5 ص193 عن ابن أبي شيبة، وابن
جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن قتادة.
([30])
راجع: زاد المعاد لابن القيم 2 ص119.
([31])
راجع: تاريخ الخميس ج1 ص493.
([32])
مناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء) ج1 ص251.
([33])
إعلام الورى (ط سنة 1390 ه.ق) ص93 والبحار ج20 ص272 و 273
عنه.
([34])
إحقاق الحق ج10 ص229 و 238 وج 19 ص105 و 107 عن الإستيعاب
ومصادر كثيرة أخرى، ومستدرك الحاكم ج1 ص448 وج 3 ص155 و 156
وحلية الأولياء ج2 ص30 وج 6 ص123 ومقتل الحسين للخوارزمي ص63 و
56 وذخائر العقبى ص37 والجامع الصغير ج2 ص294 وينابيع المودة
ص198 وإسعاف الراغبين (بهامش نور الأبصار) ص189 و 190 ووفـاء
الوفـاء ج1 = = ص331 وأعلام النساء ج3 ص1217 وسنن البيهقي ج1
ص26 ونظم درر السمطين ص177 وتلخيص المستدرك للذهبي ج3 ص156
وكشف الغمة للشعراني ج1 ص145 ومسند أحمد ج5 ص275 ومختصر سنن
أبي داود ج6 ص108 وأهل البيت لتوفيق أبي علم ص120. وعن مصادر
كثيرة أخرى فلتراجع. وراجع: عوالم العلوم ج11 ص313 والبحار ج43
ص83 وج 88 ص93.
([35])
قال الشامي: الصوران: اسم للنخل المجتمع الصغار. موضع في أقصى
بقيع الغرقد مما يلي بني قريظة. سبل الهدى والرشاد ج5 ص38.
([36])
الثقات ج1 ص274 وراجع: السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص245 وعيون
الأثر ج2 ص69. وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص247.
([37])
راجع: دلائل النبوة للبيهقي ج4 ص14 و 9 و 11 ومجمع البيان ج8
ص351 والبحـار ج20 ص210 عنه ومنـاقـب آل أبي طـالب (ط دار
الأضـواء) ج1 = = ص251 والبداية والنهاية ج4 ص118 والمصنف
للصنعاني ج5 ص370 والسيرة الحلبية 2 ص332 وراجع: مجمع الزوائد
ج6 ص137 والإكتفاء ج2 ص177 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص237
و 226 و 227 و 228 وتاريخ الإسلام (المغازي) ص254 ـ 255.
([38])
تفسير فرات (ط سنة 1460 ه. ق) 174 والبحار ج20 ص266 عنه.
([39])
تفسير القمي ج2 ص189 و 190 والبحار ج20 ص233 و 234.
([40])
راجع: المغازي للواقدي ج2 ص498 و 499 وراجع: إمتاع الأسماع ج1
ص242 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص8 و 9 و 11 ولم يذكر قول حارثة
الأخير، وكذا في المصادر التالية: تاريخ الخميس ج1 ص493
والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص14 والسيرة الحلبية ج2 ص333.
([41])
جوامع السيرة النبوية ص152 وراجع: البداية والنهاية ج4 ص123.
([42])
الإستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج2 ص356 وقاموس الرجال ج6 ص50
عنه وراجع: المعجم الكبير 10 ص292 ومجمع الزوائد ج9 ص276 عنه
وسير أعلام النبلاء ج3 ص340 ومختصر تاريخ دمشق ج12 ص299.
([43])
تاريخ بغداد ج14 ص435 وقاموس الرجال ج6 ص50 عنه.
([44])
الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج2 ص356 وقاموس الرجال ج6 ص50 عنه.
([45])
سير أعلام النبلاء ج3 ص340 ومجمع الزوائد ج9 ص277 وقال: رواه
الطبراني بأسانيد ورجاله ثقات.
([46])
مناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء) ج1 ص251 وإعلام الورى ص93
(ط سنة 1390) والبحار ج20 ص272 ـ 273 وتاريخ الخميس ج1 ص492.
([47])
المغازي للواقدي ج2 ص497 وإمتاع الأسماع ج1 ص241 وتاريخ
الإسلام للذهبي (المغازي) ص254 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص4 و 9
والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص13 والسيرة الحلبية ج2 ص332 وتفسير
فرات (ط سنة 1410 ه. ق) ص174 والبحار ج20 ص266.
([48])
سيرة مغلطاي ص56 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص224 و 228 و
235 و 237 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص13 ودلائل النبوة
للبيهقي ج4 ص12 والبداية والنهاية ج4 ص16 وراجع: ص123 والوفا
ص694.
وراجع: مرآة الجنان ج1 ص10 وتاريخ ابن الوردي ج1 ص162 والسيرة
الحلبية ج2 ص331 ـ 333 والإكتفاء ج2 ص176 والمواهب اللدنية ج1
ص115 ومسند أحمد ج6 ص141 و 142 ونهاية الأرب ج17 ص187 والكامل
في التاريخ ج2 ص185 ومجمع الزوائد ج6 ص136 وتاريخ الإسلام
(المغازي) ص255 ووفاء الوفاء ج1 ص305 و 306 وحدائق الأنوار ج2
ص594 وتاريخ الخميس ج1 ص493 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص244
وعيون الأثر ج2 ص68 وصحيح البخاري ج3 ص22 و 23 وإمتاع الأسماع
ج1 ص241 و 242 وطبقات ابن سعد (ط دار صادر) ج2 ص74 والمغازي
للواقدي ج2 ص497 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص8 و 9 و 10.
([49])
إعلام الورى ص93 (ط سنة 1390 ه.ق) والبحار ج20 ص272 و 273.
([50])
تفسير فرات (ط سنة 1410 ه. ق) ص174 والبحار ج20 ص266 عنه.
([51])
راجع: طبقات ابن سعد (ط دار صادر) ج2 ص77 وفتح الباري ج7 ص313
والسيرة الحلبية ج2 ص332 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص8 و 9 وراجع:
تاريخ الخميس ج1 ص493 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص13.
([52])
راجع المصادر المتقدمة في الهامش السابق، وراجع: صحيح البخاري
ج3 ص22 وطبقات ابن سعد ج2 ص56 وبهجة المحافل ج1 ص272 وفاء
الوفاء ج1 ص306 ودلائل النبوة لأبي نعيم ص437 والبداية
والنهاية ج4 ص117 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص253 ودلائل
النبوة للبيهقي ج4 ص6 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص224.
([53])
مجمع الزوائد ج6 ص137 وراجع: البداية والنهاية ج4 ص123.
([54])
تاريخ الخميس ج1 ص493.
([55])
إعلام الورى (ط سنة 1390 ه.ق) ص93 وبحار الأنوار ج20 ص272 و
273 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص52.
([56])
مناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء) ج1 ص251.
([57])
المغازي للواقدي ج2 ص497 و 498 و 499. وراجع: سبل الهدى
والرشاد ج5 ص8 ـ 11 وطبقات ابن سعد (ط دار صادر) ج2 ص74 وإمتاع
الأسماع ج1 ص241 و 242 وراجع أيضاً: تاريخ الخميس ج1 ص493
والسيرة الحلبية ج2 ص332 و 333 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص3.
([58])
تاريخ الخميس ج1 ص493 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص13 وراجع:
إمتاع الأسماع ج1 ص242.
([59])
تاريخ اليعقوبي ج2 ص52.
([60])
الوفا ص695 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق ص31 ونور اليقين
ص166 وجوامع السيرة النبوية ص153 والسيرة النبوية لابن هشام ج3
ص245 وعيون الأثر ج2 ص68 عنه وطبقات ابن سعد (ط دار صادر) ج2
ص74 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص224 والبداية والنهاية ج4
ص116 وأنساب الأشراف ج1 ص347 والمواهب اللدنية ج1 ص115 وإمتاع
الأسماع ج1 ص241 وتاريخ الخميس ج1 ص493 ونهاية الأرب ج17 ص187
والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص13 والسيرة الحلبية ج2 ص333.
([61])
التنبيه والإشراف ص217.
([62])
مناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء) ج1 ص251 وإعلام الورى (ط
سنة 1390هـ) ص93 والبحار ج20 ص272 و 273.
([63])
وفاء الوفاء ج4 ص1222.
([64])
وفاء الوفاء ج4 ص1222.
([65])
راجع: معجم البلدان ج3 ص87 وفيه: يوماً، وهو خطأ، والصحيح
ميلاً. ومراصد الإطلاع ج2 ص637 ووفاء الوفاء ج4 ص1222 وعن صحيح
البخاري كتاب البيوع، باب 111 وعن صحيح مسلم كتاب الصلاة ح 15.
([66])
مراصد الإطلاع ج2 ص637 ووفاء الوفاء ج4 ص1222 ومعجم البلدان ج3
ص87 (ط دار الكتب العلمية) وفيه: يوماً وهو خطأ، والصحيح:
ميلاً.
([68])
وفاء الوفاء ج4 ص1222.
([69])
المغازي للواقدي ج2 ص497 وإمتاع الأسماع ج1 ص24 وسبل الهدى
والرشاد ج5 ص9 وتفسير فرات (ط سنة 1410 ه. ق) ص174 وبحار
الأنوار ج20 ص266 والسيرة الحلبية ج2 ص332 والسيرة النبوية
لدحلان ج2 ص13 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص254.
([70])
معجم البلدان ج2 ص346 ووفاء الوفاء ج4 ص1196 ومراصد الإطلاع ج1
ص424.
([71])
مجمع الزوائد ج6 ص141 عن الطبراني في الأوسط، وإمتاع الأسماع
ج1 ص242 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص11 وطبقات ابن سعد (ط دار
صادر) ج2 ص76 وراجع: السيرة الحلبية ج2 ص333.
([72])
تاريخ الخميس ج1 ص493.
([73])
تاريخ اليعقوبي ج2 ص52.
([74])
تفسير القمي ج2 ص189 و 190 والبحار ج20 ص233 و 234.
([75])
المصنف للصنعاني ج5 ص369 وراجع: دلائل النبوة لأبي نعيم ص438
وأشار إليه في مجمع الزوائد ج6 ص140 عن الطبراني.
([76])
راجع الهوامش التي تقدمت تحت عنوان: جبرئيل والنبي، وتحت
عنوان: في بيت عائشة أم في بيت فاطمة؟!، وتحت عنوان: حمراء
الأسد أو الروحاء؟!
([77])
راجع فيما تقدم: المغازي للواقدي ج2 ص500 وجوامع السيرة
النبوية ص152 والكامل في التاريخ ج2 ص185 والمواهب اللدنية ج1
ص115 و 114 وإمتاع الأسماع ج1 ص243 وتاريخ الأمم والملوك ج2
ص245 وص 246 وطبقات ابن سعد ج2 ص76 والسيرة النبوية لدحلان ج2
ص13 و 14 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص246 و 245 وصحيح
البخاري ج3 ص22 والسيرة الحلبية ج2 ص334 ومجمع البيان ج8 ص351
والبحار ج20 ص210 عنه، والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص225 ـ
228 والبداية والنهاية ج4 ص117 و 119 والروض الأنف ج3 ص281
وحدائق الأنوار ج2 ص594 والمصنف للصنعاني ج5 ص370 ومجمع
الزوائد ج6 ص140 وبهجة المحافل ج1 ص272 و 273 وتاريخ الخميس ج1
ص494 وتاريخ الإسلام (المغازي) ص253 و 254 وسبل الهدى والرشاد
ج5 ص8 و 10 و 33 ـ 35 ومسند أبي عوانة ج4 ص173 وصحيح مسلم ج5
ص162 ودلائل النبوة للبيهقي ج4 ص6 ـ 8 و 12 والإكتفاء ج2 ص177
ونهاية الأرب ج17 ص187 والثقات ج1 ص274 وعيون الأثر ج2 ص69
وفتح الباري ج7 ص314.
([78])
التفسير السياسي للسيرة ص279 و 280.
([79])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص35 والسيرة الحلبية ج2 ص334 وتاريخ
الخميس ج1 ص494.
([80])
شرح النووي على صحيح مسلم ج12 ص98.
([81])
راجع: البداية والنهاية ج4 ص118 والسيرة النبوية لابن كثير ج3
ص227 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص14 وتاريخ الخميس ج1 ص494
وسبل الهدى والرشاد ج5 ص35 و 34 وشرح النووي على صحيح مسلم ج12
ص98 وفتح الباري ج7 ص315 وأول ص316.
([82])
جوامع السيرة النبوية ص152 و 153 وراجع: البداية والنهاية ج4
ص118 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص118.
([83])
الآية 78 من سورة الإسراء.
([84])
راجع: هامش كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج4 ص321.
([85])
راجع: كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج4 ص8.
([86])
الطبقات الكبرى ج2 ص76.
([87])
مسند أبي عوانة ج4 ص173.
([88])
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج4 ص320 و 321.
([89])
راجع المصادر التالية: إرشاد الساري ج6 ص328 و 329 وعمدة
القاري ج17 ص189 و 190 وفتح الباري ج7 ص313 و 314 والمواهب
اللدنية ج1 ص115 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص33 و 34 والسيرة
النبوية لدحلان ج2 ص13 وشرح النووي على صحيح مسلم ج12 ص98
والسيرة الحلبية ج2 ص332.
([90])
خاتم النبيين ج2 ص951 وفتح الباري ج7 ص315 وراجع: سبل الهدى
والرشاد ج5 ص34.
([91])
خاتم النبيين ج2 ص351.
([92])
فقه السيرة للبوطي ص307 و 308.
([94])
الروض الأنف ج3 ص281 وفتح الباري ج7 ص315 وراجع السيرة الحلبية
ج2 ص334.
([95])
حدائق الأنوار ج2 ص595 وراجع: شرح النووي على صحيح مسلم ج12
ص98.
([96])
النووي على صحيح مسلم ج12 ص98.
([97])
شرح النووي على صحيح مسلم ج12 ص98 وراجع: فتح الباري ج7 ص315.
([98])
راجع: شرح النووي على صحيح مسلم ج2 ص98 وفتح الباري ج7 ص315.
([99])
وفاء الوفاء ج1 ص161 وج 3 ص1076 وراجع: معجم البلدان (ط دار
الكتب العلمية) ج1 ص346 وج 5 ص234 والعبر وديوان المبتدأ
والخبر ج2 ق1 ص287.
([100])
راجع: وفاء الوفاء ج3 ص823 و 824 و 821 ومرآة الحرمين ج1 ص419.
([101])
راجع: وفاء الوفاء ج4 ص1188.
([102])
راجع: صحيح مسلم ج2 ص109 وسنن الدارقطني ج1 ص253 وصحيح البخاري
ج1 ص69 وج 4 ص170 وسنن الدارمي ج1 ص274 والسنن الكبرى ج1 ص440
وتحفة الأحوذي ج1 ص493 و 496.
([103])
صحيح البخاري ج4 ص170.
([104])
سنن أبي داود ج1 ص111
ومختصر سنن أبي داود للمنذري ج1 ص239 ومسند أحمد ج3 ص161 و 217
وسنن النسائي ج1 ص253 ومسند أبي عوانة ج1 ص351 وسنن ابن ماجة
ج1 ص223 والمصنف للصنعاني ج1 ص547 وكنز العمال ج8 ص27 عنه وعن
ابن أبي شيبة. والسنن الكبرى ج1 ص440 ونصب الراية ج1 ص246 وشرح
معاني الآثار ج1 ص190 والتمهيد ج6 ص179.
([105])
سنن الدارقطني ج1 ص254 وشرح معاني الآثار ج1 ص189 و 190 وشرح
الموطأ للزرقاني ج1 ص35.
([106])
راجع: إرشاد الساري ج1 ص494 وشرح الموطأ للزرقاني ج1 ص35.
([107])
عيون الأثر ج2 ص70 و 71 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق 2
ص31 والإكتفاء للكلاعي ج2 ص179 والمغازي للواقدي ج2 ص509
والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص16 والسيرة الحلبية ج2 ص246 وشرح
بهجة المحافل ج1 ص273 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص18 و 19 وراجع:
تاريخ الخميس ج1 ص495 وراجع: قاموس الرجال ج2 ص211.
([108])
السيرة الحلبية ج2 ص336 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص15 وتاريخ
الخميس ج1 ص495.
([109])
سنن الدارقطني ج1 ص252 والسنن الكبرى ج1 ص441.
([111])
راجع: تحفة الأحوذي ج1 ص493 عن البزار، وأحمد، والطبراني في
الكبير، والتمهيد ج6 ص181 وشرح معاني الآثار ج1 ص191.
([112])
عمدة القاري ج25 ص57 و 37 وإرشاد الساري ج10 ص333.
([113])
راجع: شرح معاني الآثار ج1 ص191.
([114])
راجع: سنن أبي داود ج1 ص111 ومختصر سنن أبي داود للمنذري ج1
ص239 والتمهيد ج1 ص300 وفتح الباري ج2 ص22 ونيل الأوطار ج1
ص391 والتعليق المغني على سنن الدارقطني ج1 ص253 والسنن الكبرى
ج1 ص441 وشرح النووي على صحيح مسلم ج5 ص122.
([115])
زهر الربى على المجتبى ج1 ص253 و 254 وعون المعبود ج2 ص77 وشرح
النووي على صحيح مسلم ج5 ص122 وإرشاد الساري ج1 ص493.
([116])
راجع: فتح الباري ج2 ص22.
([117])
سنن الدارقطني ج1 ص253 وإرشاد الساري ج1 ص493 عنه، وكذا في
عمدة القاري ج5 ص37 وفتح الباري ج2 ص23.
([118])
صحيح البخاري ج1 ص69 والسنن الكبرى ج1 ص440 وتحفة الأحوذي ص493
و 496 ووفاء الوفاء ج4 ص1261 ونيل الأوطار ج1 ص391 والمنتقى
لابن تيمية ج1 ص210.
([119])
راجع: وفاء الوفاء ج4 ص1261.
([120])
سنن أبي داود ج1 ص111 ومختصر سنن أبي داود للمنذري ج1 ص239
ومسند أحمد ج3 ص161 والمصنف للصنعاني ج5 ص547 ووفاء الوفاء ج4
ص1261 والسنن الكبرى ج1 ص440 وشرح معـاني الآثـار ج1 ص190 ونصب
الراية ج1 ص246.
([121])
عمدة القاري ج5 ص37 وشرح الموطأ للزرقاني ج1 ص35 وفتح الباري
ج2 ص23.
([122])
السنن الكبرى ج1 ص440 وعمدة القاري ج5 ص37 عنه وصحيح البخاري
ج4 ص170 وفتح الباري ج2 ص23 ووفاء الوفاء ج1261.
([123])
إرشاد الساري ج1 ص493.
([124])
راجع: وفاء الوفـاء ج4 ص1261 وقال: وذكره ابن حزم أيضاً، ونقله
الحافظ ابن حجر عن أبي عبيد، وعمدة القاري ج5 ص37 وفتح الباري
ج2 ص23.
([125])
إرشاد الساري ج1 ص493 وعمدة القاري ج5 ص37 وفتح الباري ج2 ص23
ووفاء الوفاء ج4 ص1261.
([126])
شرح الموطأ للزرقاني ج1 ص35.
([127])
وفاء الوفاء ج4 ص1262.
([128])
إرشاد الساري ج1 ص493.
([129])
شرح النووي على صحيح مسلم ج5 ص122 ونيل الأوطـار ج1 ص391
وراجع: الإستذكار ج1 ص344.
([130])
الجوهر النقي (مطبوع بهامش سنن البيهقي) ج1 ص441 والتمهيد ج6
ص178 وراجع: شرح الموطأ للزرقاني ج1 ص35 ووفاء الوفاء ج4 ص1261
وقال: ذكره ابن حزم أيضاً ونقله ابن حجر عن أبي عبيد.
([131])
التمهيد ج6 ص178 وشرح الموطأ للزرقاني ج1 ص35.
([132])
فتح الباري ج7 ص316.
([133])
هذا الكلام قد جاء على سبيل التعجب والحقيقة هي أن علياً
«عليه
السلام»
هو الذي فعل ذلك كله.
([134])
صحيح مسلم ج2 ص122 ومسند أبي عوانة ج1 ص356 والمنتقى لابن
تيمية ج1 ص213 عن أحمد ومسلم وابن ماجة.
|