|
الـقـتـلــى والـشـهــداء
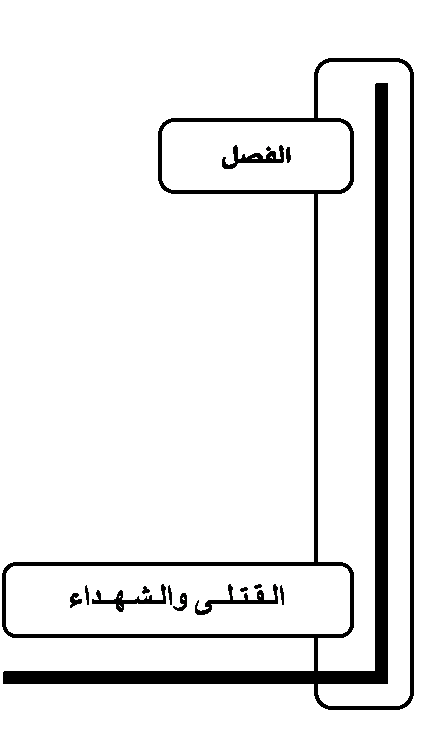
حكم سعد بن معاذ في طريقه إلى التنفيذ:
وقد تقدم قولهم:
إن سعداً حكم على بني قريظة بقتل الرجال، وسبي النساء، وغنيمة الأموال.
لكن الظاهر أنه حكم
عليهم:
«أن يقتل كل من حزَّب
عليه، وتغنم المواشي، وتسبى
النساء والذراري، وتقسم الأموال.
فقال رسول الله «صلى
الله عليه وآله»:
لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»([1]).
فكلمة حزَّب
عليه، أصبحت بعد تصحيفها وإضافة كلمة واحدة إليها للتوضيح هكذا:
جرت عليه الموسى([2]).
ويؤيد:
أنه «صلى الله عليه وآله» قتل من حزَّب
عليه ما سيأتي من الاختلاف الفاحش في عدد المقتولين.
ويصرح ابن شهرآشوب:
أن عدد بني قريظة كان سبع مئة، لكن المقتولين منهم
كانوا أربع مئة وخمسين([3]).
وهو المناسب أيضاً لقوله تعالى: ﴿فَرِيقاً
تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً﴾([4]).
قال القمي:
أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بأخدود، فحفرت
بالبقيع([5]).
وقال آخرون:
إنه «صلى الله عليه وآله» حفر لهم خنادق في سوق
المدينة، فضرب أعناقهم فيها([6]).
وقالت بعض المصادر:
«قتلوا عند دار أبي جهل (جهم) بالبلاط،
ولم تكن يومئذٍ بلاط،
فزعموا: أن دماءهم بلغت أحجار الزيت بالسوق»([7]).
وعند الواقدي:
«فأمر بخدود فخدت
في السوق، ما بين موضع دار أبي جهم العدوي إلى أحجار الزيت بالسوق»([8]).
وجلس «صلى الله عليه وآله»
ومعه علية أصحابه، ودعا برجال بني قريظة، فكانوا يخرجون رسلاً،
رسلاً،
تضرب أعناقهم.
ثم يذكرون كيف أنهم كان يلوم بعضهم بعضاً.
وكان اللذين يليان قتلهم علي والزبير([9]).
وفي بعض المصادر:
أنهم كانوا يخرجونهم أرسالاً.
وحسب نص اليعقوبي: عشرة عشرة، ويلي قتلهم علي
والزبير، ورسول الله «صلى الله عليه وآله» جالس
هناك([10]).
وفي نص آخر:
«تمادى القتل فيهم إلى الليل. فقتلوا على شعل
السعف»([11]).
قال محمد بن كعب القرظي:
قتلوا إلى أن غاب الشفق، ثم رد عليهم التراب في
الخندق([12]).
و«عند قتلهم صاحت نساؤهم، وشقت جيوبها، ونشرت
شعورها، وضربت خدودها وملأت المدينة بالنوح والعويل»([13]).
ونقول:
إننا نشير هنا إلى الأمور التالية:
1 ـ
قولهم: إنهم كانوا يخرجونهم أرسالاً،
أو عشرة عشرة،
يقابله قول البعض: «فلما أمسى أمر بإخراج رجل رجل،
فكان يضرب عنقه»([14]).
ولا بد من ملاحظة
التناقض بين قولهم:
تمادى القتل فيهم إلى الليل، فقتلوا على شعل السعف، أو إلى أن غاب
الشفق. وبين قولهم: فلما أمسى أمر بإخراجهم رجلاً رجلا ليضرب أعناقهم.
ثم ملاحظة التناقض بين
قولهم:
إنهم قتلوا ورسول الله «صلى الله عليه وآله» جالس، ومعه أصحابه، وبين
ما سيأتي من أن النبي قد حضر قتل أربعة منهم فقط.
2 ـ
وعن ذكر الزبير إلى جانب علي «عليه السلام»، وأن هذا كان يقتل عشرة،
وذاك عشرة.
نقول: إنه موضع شك وريب، وذلك لما يلي:
أ:
يقول نص آخر: «وخرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى موضع السوق
اليوم، وحضر معه المسلمون، وأمر أن يخرجوا وتقدم إلى أمير المؤمنين
«عليه السلام» بضرب أعناقهم في الخندق، فأخرجوا أرسالاً»([15]).
ب:
تذكر رواية أخرى، أنه لما قُتل حيي بن أخطب، ونباش بن قيس، وغزال بن
سموأل، وكعب بن أسد، قام «صلى الله عليه وآله» وقال لسعد بن معاذ: عليك
بمن بقي، فكان يخرجهم رسلاً
رسلاً
يقتلهم([16]).
فهذا النص لم يذكر علياً ولا غيره، بل نسب القضية برمتها إلى سعد بن
معاذ.
ج:
يقول نص آخر: «فقتل علي عشرة، وقتل الزبير عشرة. وقلَّ
رجل من الصحابة إلا قتل رجلاً أو رجلين»([17]).
وهذا النص يحاول أن يعطي للزبير ـ دون غيره ـ دوراً
يضارع دور علي «عليه السلام» ثم أعطى بقية الصحابة نصيباً
في هذا الأمر أيضاً.
د:
وقد جاءت رواية أخرى لتقدم مبرراً
لإشراك الأوس من الصحابة في قتل بني قريظة، فهي تقول:
جاء سعد بن عبادة
والحباب بن المنذر، فقالا:
يا رسول الله، إن الأوس كرهت قتل بني قريظة لمكان حلفهم.
فقال سعد بن معاذ:
يا رسول الله، ما كرهه من الأوس من فيه خير، فمن كرهه من الأوس لا
أرضاه الله.
ثم اقترح أسيد بن حضير ـ كما يزعمون ـ أن يرسل
النبي «صلى الله عليه وآله» إلى كل دار (وفي نص آخر: قبيلة أو حي)
ليقتلوهم، فقبل «صلى الله عليه وآله» بالاقتراح، وأرسل إلى كل دار
(قبيلة) من الأوس باثنين اثنين، فقتلوهم([18]).
ولست أدري لماذا جاء إلى النبي «صلى الله عليه وآله» هذان الخزرجيان اللذان
كانا من المناوئين لأبي بكر في السقيفة، وهما سعد بن عبادة، والحباب بن
المنذر؟ ثم جاء الحل الذي يقبله النبي «صلى الله عليه وآله» ويعمل به
من قبل ذلك القريب والنصير لأبي بكر في السقيفة أيضاً، وأحد المهاجمين
لبيت الزهراء، بعد وفاة أبيها «صلى الله عليه وآله»، وأعني به أسيد بن
حضير؟!!
ولست أدري أيضاً:
كيف أصبح اقتراح ابن حضير هو
الحل
الأمثل، والعلاج للمشكة؟ مع أن ابن معاذ قد قرر: أن الكارهين لقتل بني
قريظة هم فئة قليلة لا خير فيها، وتستحق البراءة منها، والدعاء عليها.
ثم أليس يعدُّ
قسوة منه «صلى الله عليه وآله» أن يأمر الحليف بقتل حليفه! والنبي «صلى
الله عليه وآله» ـ كما نطق به القرآن ـ
:
﴿..
بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾.
إلا أن يكون «صلى الله
عليه وآله»:
قد أراد بذلك أن يختبر مدى رضوخهم لحكم الله ورفضهم لأحكام الجاهلية
وأحلافها.
وثمة نقطة أخرى لا بد من
إثارتها هنا، وهي:
أنه إذا صحت مشاركة الأوس أنفسهم في تنفيذ حكم سيدهم سعد فإنما كانت
مشاركة طوعية منهم، وذلك هو المأمول بهم. فإذا كانت هذه المشاركة
مستوعبة وشاملة، كما تقدم، فإن هذا الأمر سيمنع من حدوث أي تململ في
صفوف هؤلاء الحلفاء، وسد الطريق على ذوي النوايا المشبوهة فلم يعد
بإمكانهم تحريك النعرات، والتلاعب بالعواطف، وإثارة البلبلة لخلخلة
الوضع من الداخل، وخلق عقدة لدى هذا الفريق، أو ذاك.
وأصبحت المشاركة الأوسية في قتل بني قريظة من مفاخرهم ومنجزاتهم التي
يعتزون بها،
ولا يمكن لأحد أن يغمز من قناتهم، ولا أن يتهمهم بالميل إلى الدفاع عن
حلفائهم.
قالوا:
وكان علي «عليه السلام» هو الذي ضرب في بني قريظة
«أعناق اليهود، مثل حيي بن أخطب، وكعب بن الأشرف»([19]).
والصحيح:
كعب بن أسد، لأن ابن الأشرف كان قد قتل قبل ذلك بزمان،
مضافاً
إلى أن ابن الأشرف كان من بني النضير، لا من بني قريظة.
إلا أن يكون مراده:
أن علياً «عليه
السلام»
هو الذي قتل ابن الأشرف أيضاً، ثم زور المزورون للتاريخ هذه الحقيقة،
فنسبوا قتله إلى غير علي «عليه السلام»، حسداً
منهم، وحقداً،
وبغياً
عليه.
وقالوا:
إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد أمر بقتل كل
من أنبت من بني قريظة([20])،
وكان من شك في بلوغه نظر إلى مؤتزره، فإن كان أنبت
قُتل، وإلا طُرح في السبي([21]).
قال محمد بن كعب القرظي:
فكنت في من لم ينبت([22]).
وكان مسلم بن بجرة الأنصاري هو الذي تولى كشف عوراتهم. واستدل به
الفقهاء على جواز كشف العورة للحاجة([23]).
لكن أسلم الأنصاري يقول:
جعلني رسول الله «صلى الله عليه وآله» على أسرى
قريظة، فكنت أنظر إلى فرج الغلام، فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه،
وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المسلمين([24]).
ونقول:
ههنا مواقع للنظر، وهي التالية:
1 ـ
قولهم: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد أمر بقتل كل من أنبت من
بني قريظة، يقابله نص آخر يقول: إن سعداً هو الذي أمرهم بالنظر إلى
مؤتزر من شكُّوا
في بلوغه فصوبه النبي «صلى الله عليه وآله»([25]).
2 ـ
قولهم: إنه «صلى الله عليه وآله» قد أمر بقتل كل من أنبت لا يستقيم مع
ما قدمناه وسيأتي أيضاً:
من أنه «صلى الله عليه وآله» إنما قتل خصوص من حزَّب
عليه منهم. والباقون لم يقتلوا. فإن كان قد كشف عن مؤتزر أحد، فإنما
ذلك في خصوص هذا الفريق من الخونة والأشرار.
3 ـ
أما المتولي لكشف عوراتهم، فلعل أسلم الأنصاري هو نفس مسلم بن بجرة
الأنصاري، أو أن مسلماً
هو ابن أسلم([26])،
وقد صحَّف
الراوي، أو أسقط أحدهما.
4 ـ
بقي أن نشير إلى أن بعض النصوص المتقدمة قد ذكرت محمد بن كعب القرظي
على أنه هو الذي وجدوه لم ينبت فأطلقوا سراحه.
مع أن محمد بن كعب إنما ولد في سنة أربعين للهجرة،
ولا يصح أنه ولد في حياة النبي «صلى الله عليه وآله»([27]).
والصحيح:
أن أباه كعباً
هو الذي نجا يوم بني قريظة([28]).
5 ـ
قال ابن حزم: «واستحيا عطية القرظي، وله صحبة»([29]).
عن عطية قال:
كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد أمر أن يقتل من بني قريظة كل من
أنبت منهم. وكنت غلاماً،
فوجدوني لم أنبت، فخلوا سبيلي([30]).
قال السهيلي:
«ففي هذا: أن الإنبات أصل في معرفة البلوغ، إذا
جهل الاحتلام، ولم تعرف سنوه»([31]).
أما القول بأن عطية هذا هو جد محمد بن كعب القرظي([32])،
فلا نراه صحيحاً،
بل عطية هذا رجل آخر.
والصحيح هو:
ما تقدم عن تاريخ البخاري،
فراجع.
وليس تحقيق هذا الأمر مما يهمنا كثيراً لكونه ليس مما يترتب عليه أثر
ذو بال.
وحين جيء
بنباش بن قيس ليقتل، جابذ الذي جاء به حتى قاتله، فدق الذي جاء به أنفه
فأرعفه. فسأل النبي «صلى الله عليه وآله» الذي جاء به عن السبب، فذكره
له،
فقال نباش: كذب ـ والتوراة ـ يا أبا القاسم، ولو خلاني ما تأخرت عن
موطن قتل فيه قومي حتى أكون كأحدهم.
ثم قال رسول الله «صلى
الله عليه وآله»:
«أحسنوا إسارهم، وقيلوهم، واسقوهم حتى يبردوا، فتقتلوا من بقي. لا
تجمعوا عليهم حر الشمس، وحر السلاح، وكان يوماً صائفاً.
فقيَّلوهم،
وسقوهم، وأطعموهم، فلما
أبردوا
راح رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقتل من بقي»([33]).
ونقول:
قد تقدم في الفصل السابق، بعض وصاياه «صلى الله عليه وآله» بأسرى بني
قريظة. وإنما أعدنا بعضه هنا لاقتضاء المناسبة له، وهو قصة نباش بن
قيس.
ونسجل هنا ما يلي:
1 ـ
إننا لا نكاد نصدق قوله: ولو خلاني ما تأخرت عن موطن قتل فيه قومي
الخ.. حيث إننا نلحظ مزيداً
من الاهتمام بإضفاء صفة الشجاعة والبطولة والعنفوان لدى
هؤلاء الخونة. كما سنرى.
2 ـ
إننا قد أشرنا إلى وجود بعض الريب في أن تكون غزوة بني قريظة قد حصلت
في الصيف، فراجع ما ذكرناه في غزوة الخندق في الجزء العاشر
من هذا الكتاب.
3 ـ
إن وصايا الرسول «صلى الله عليه وآله» بالأسرى هنا،
وقوله في مورد آخر عن بني قريظة، الذين خانوا عهده ومالأوا عدوه:
«اسقوهم العذب، وأطعموهم الطيب، وأحسنوا
أسارهم»([34])،
إن هذه الوصايا لا تتناقض أبداً مع قتل بني قريظة، فالقتل هو حكم شرعي
إلهي لا بد من إطاعته وتنفيذه
في حقهم. أما إساءة المعاملة للأسير، فتعتبر تعدياً
على الأسير، وعلى شخصيته. ويعتبر الإحسان إليه هو الواجب الخلقي، الذي
لا بد من القيام به، حتى بالنسبة للمحكومين بحكم يصل إلى هذه الدرجة.
إذن..
هناك حكمان
لهما
حيثيتان فرضتهما حالتان موجودتان في موردهما
فللأسير حقه كإنسان، وعليه العقاب بحسب نوع الجريمة التي ارتكبها،
فإنها هي التي تفرض نوع العقاب.
وأُتيَ «صلى الله عليه وآله» بكعب بن أسد، مجموعة يداه إلى عنقه ـ وكان
حسن الوجه ـ فقال «صلى الله عليه وآله»: كعب بن أسد؟!
قال كعب:
نعم يا أبا القاسم.
قال:
أما انتفعتم بنصح ابن خراش (جواس)، وكان مصدقاً
بي؟ أما أمركم باتباعي؟ وإن رأيتموني أن تقرئوني منه السلام؟!
قال:
بلى ـ والتوراة ـ يا أبا القاسم،
ولولا أن تعيرني اليهود بالجزع من السيف لاتبعتك،
ولكني على دين اليهود.
قال «صلى الله عليه
وآله»:
قدمه، فاضرب عنقه، فقدمه، فضرب عنقه([35]).
وسيأتي لنا كلام حول موقف كعب هذا.
ويقول المؤرخون:
ثم أُتي بحيي بن أخطب، مجموعة يداه إلى عنقه، فقال له رسول الله حين
طلع. ألم يمكن الله منك يا عدو الله؟!
قال:
بلى والله ما لمت نفسي في عداوتك. وقد التمست
العزَّ
في مكانه، وأبى
الله إلا أن يمكنك مني. ولقد قلقلت كل مقلقل (أي ذهبت في كل وجه) ولكنه
من يَخذل
الله يُخذل.
ثم أقبل على الناس،
فقال:
أيها الناس، لا بأس بأمر الله، قدر وكتاب،
ملحمة كتبت على بني إسرائيل.
ثم أمر به فضربت عنقه([36]).
زاد في بعض المصادر
قوله:
ثم أقيم بين يدي أمير المؤمنين، وهو يقول: قتلة شريفة بيد شريف.
فقال له علي «عليه
السلام»:
إن الأخيار يقتلون الأشرار، والأشرار يقتلون الأخيار، فويل لمن قتله
الأخيار، وطوبى لمن قتله الأشرار والكفار.
فقال:
صدقت لا تسلبني حلتي.
قال:
هي أهون علي من ذاك.
قال:
سترتني، سترك الله،
ومد عنقه، فضربها علي، ولم يسلبه من بينهم([37]).
هذا، وقد قال جبل بن جوال الثعلبي في هذه المناسبة:
لعـمـرك مـا لام ابـن أخطب نفسه
ولـكـنـه مـن يخـذل الله يـذخــل
فـجـاهـد حتى أبلغ النفس عذرها وقـلـقـل يبغي العز كل مقلقل([38])
زاد في بعض المصادر:
أن أمير المؤمنين «عليه السلام» قال في ذلك:
لـقـد كـان ذا جـد وجـد بـكفــره
فـقـيـد إلـيـنـا بـالمـجـامـع يقتل
فـقـلـدتـه بـالسيـف ضربـة محفظ فـصـار إلى قـعـر الجحيم يـكبـل
فـذاك مـآب الـكـافـرين ومن يطع لأمـر إلـه الخـلق في الخلد
ينزل([39])
ولنا على ما تقدم ملاحظات، هي التالية:
الأولى:
بالنسبة للشعر المنسوب إلى علي أمير المؤمنين «عليه السلام» نقول:
إنه ليس في المستوى الذي يؤهله لأن ينسب إلى أمير المؤمنين «عليه
السلام»،
وذلك واضح بأدنى تأمل.
الثانية:
إن التجاء حيي بن أخطب إلى القدر والقضاء لتبرير ما يتعرض له هو وبنو
قريظة ليس له ما يبرره، إلا محاولة التبرير والتزوير للحقيقة. ومحاولة
التنصل من المسؤولية، بإلقاء اللوم على الله سبحانه، الذي لم يأمره بأن
يتآمر، وينقض العهود والمواثيق، ولا طلب منه ومنهم أن يواجهوا نبيهم
بالحرب، وهم يعرفون صدقه، وصحة نبوته كما يعرفون أبناءهم، ويجدونه
مكتوباً
عندهم في التوراة والإنجيل.
وإذا كان لكلام حيي هذا أساس من الصحة، فصحته تكمن في أنه يبين أن الله
سبحانه قد قدَّر
على الباغي، والناكث، والمكذب للصادقين، وقتلة الأنبياء: أن يُقْتَلوا
جزاء ذلك البغي والنكث والتكذيب.
الثالثة:
إننا نرجح أن يكون حيي بن أخطب نفسه هو الذي قال:
لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه ولكنه الخ.. كما ذكر
البعض([40]).
بل ذكرت بعض النصوص:
أن علياً «عليه السلام» سأل الذي جاء بحيي للقتل: ما كان يقول وهو يقاد
إلى الموت؟
فقال:
كان يقول:
لـعـمرك ما لام ابن أخطب نفسـه
ولكنه مـن يَخــــذل الله يُخـــذل
فجاهـد حتى أبلغ النفس جهدهـا وحـاول يـبـغي العز كل مقلقل([41])
وهي بحيي أنسب منها بجبل بن جوال خصوصاً إذا كان جبل قد أسلم قبل قتل
حيي وبني قريظة، إذ لا مجال له بعد أن أسلم ليرثي حيي بن أخطب بهذه
الأبيات.
وإن كان قد أسلم بعد ذلك، فيمكن
أن يكون قد رثاه بها. لكن ما حكي من سؤال أمير المؤمنين «عليه السلام»
للذي جاء بحيي عما كان يقول حيي يرجح نسبتها لحيي، حيث أراد أن يترجم
ما أجاب به النبي «صلى الله عليه وآله» شعراً
يتداوله الناس بعده.
الرابعة:
إننا نلمح في هذه الروايات، كما هو في غيرها، قدراً
من الاهتمام بإظهار مزيد من القوة والثبات لدى اليهود، والصبر على
مواجهة المصاب الكارثة، ثم المزيد من التأكيد على أنهم قد اختاروا
الموت كراماً
على الخضوع لما يخالف قناعاتهم..
وقد يكون ما ينسب لحيي هنا، وكذلك ما ينسب لنباش بن قيس، وكعب بن أسد،
وحتى ما ينسب لنسائهم،
كنباتة النضيرية، قد صُنِع
من أجل تحقيق هذا الهدف بالذات،
ولعله أيضاً بهدف التخفيف، أو فقل: التعتيم على ما لحقهم من عار النكث
والخيانة.
مع أن النصوص التاريخية
تؤكد:
ذلهم، وخنوعهم، وجزعهم الشديد حين ذهب إليهم أبو لبابة، فكيف تحول ذلك
الذل والخنوع والجزع إلى قوة وعزة وشهامة، وبطولة؟
لا ندري ولعل الفطن الذكي يدري.
ويقال:
إنه كان ثمة امرأة من بني النضير، يقال لها:
نباتة،
تحت رجل قريظي،
(قال السهيلي: هو الحاكم القرظي) يحبها، وتحبه،
وكانت في حصن الزبير بن باطا. فخاف زوجها أن تسبى بعده، فأحب أن تقتل
بجرمها،
فطلب منها فدلت على المسلمين رحى من فوق الحصن، وكان المسلمون ربما
جلسوا تحته، يستظلون في فيئه،
وكان ذلك بعد اشتداد الحصار على بني قريظة.
فلما أطلعت الرحى،
رآها القوم فانفضوا، فأصابت خلاد بن سويد، فشدخت رأسه.
فلما كان في اليوم الذي أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن يقتلوا
دخلت هذه المرأة على عائشة، فجعلت تضحك ظهراً
لبطن، وهي تقول: سراة بني قريظة، يقتلون، فسمعت قول قائل: يا نباتة.
فقالت:
أنا والله التي أدعي.
قالت:
ولم؟
قالت:
قتلني زوجي.
فسألتها عائشة عن ذلك، فذكرت لها أمر الرحى،
وأنها قتلت خلاد بن سويد، فأمر «صلى الله عليه وآله» بها فقتلت بخلاد
بن سويد.
قالت عائشة:
لا أنسى طيب نفس نباتة، وكثرة ضحكها، وقد عرفت أنها تقتل؛
فكانت عائشة تقول: قُتلت بنو قريظة يومهم، حتى
قُتلوا بالليل على شعل السعف([42]).
وذكرت بعض المصادر:
أن زوجها قال لها: «غلب علينا محمد، سيقتل الرجال،
ويسبي النساء والذراري»([43]).
وقسم من المصادر التي
ذكرناها في الهامش ذكر:
أن اسمها: بنانة،
وقد يكون ذلك تصحيف نباتة، أو العكس.
وسمتها بعض المصادر:
بيانة.
وقيل:
مزنة،
ولعل مزنة هي أرفة الآتي ذكرها.
ونقول:
إننا نسجل هنا الأمور التالية:
إن مما يلفت نظرنا هنا ما نجده من محاولات جادة
لإظهار شجاعة بني قريظة، وثباتهم وقوتهم، وصبرهم في مواجهة الموت
التزاماً
ووفاءً
لقناعاتهم، وانسجاماً
مع أنفسهم في مواصلة الأخطار والكواراث،
دونما رهبة أو وجل.
وقد تجلى ذلك حتى في نسائهم، اللواتي يفترض فيهن أن يظهرن المزيد من
الجزع والضعف والهلع في مواجهة الموت.
ويكتسب اليهود عن طريق
هذا التزوير للتاريخ:
صفات الشهامة، والعزة والكرامة، والإباء والشمم، وهي الصفات التي لم
نزل نعرف عنهم اتصافهم بما يناقضها وينافيها.
أما النبي والمسلمون فيصبحون في موقع الناس القساة، الذين لا تظهر منهم
بادرة رأفة ولا رحمة. بل هم أناس مجرمون، يحبون سفك الدماء، دونما شفقة
أو وازع من ضمير.
ويلفت نظرنا في قصة نباتة الأمور التالية:
أولاً:
كيف دخلت هذه المرأة على عائشة مع أن سبايا بني قريظة، قد جعلوا جميعاً
في دار رملة بنت الحارث، كما تقدم، ودار أسامة([44])
ولم يكن يسمح لأي منهن بالتجول، ودخول المنازل،
لا سيما قبل
تنفيذ الحكم في رجالهن، وقبل تحديد مصير السبايا أيضاً.
بل لقد ذكروا:
أن دخول نباتة على عائشة قد كان والنبي مشغول بقتل بني قريظة، كما ذكره
دحلان وصاحب السيرة الحلبية.
ثانياً:
قال الشيخ المفيد: «قتل من نسائهم امرأة واحدة، كانت أرسلت عليه (أي
على النبي «صلى الله عليه وآله») حجراً،
وقد جاء النبي «صلى الله عليه وآله» باليهود يناظرهم قبل مباينتهم له،
فسلمه الله من ذلك الحجر»([45]).
ثالثاً:
قد تكرر ما يشبه هذه القصة، فذكر نظيرها في بني النضير،
وفي
خيبر، فلماذا لم يتعلم المسلمون مما سبق لهم؟!
رابعاً:
هل يعقل أن يجلس المسلمون في أصل الحصن للاستظلال به، مع وجود احتمالات
إرسال الحجارة أو غيرها عليهم، وهم في حالة حرب مع عدوهم، ولا سيما مع
اشتداد الحصار عليهم، كما صرحت به الرواية نفسها؟! إن ذلك بعيد، ولا
يفعله من له أدنى خبرة في مجال التعامل في أثناء الحرب، ومع إحساس
العدو بالخطر الماحق، وبالدمار الساحق.
خامساً:
من أين علم زوجها: أنهم سيقتلون وتسبى ذراريهم ونساؤهم ولماذا لم يفكر
بحل المشكل بطريقة أخرى؟!
ولماذا طاوعته زوجته على القيام بما طلبه منها، وقد كان من الطبيعي أن
تعترض عليه بأن
عليه
هو أن يلقي
تلك الرحى؟!
وأيضاً لماذا التفت المسلمون إلى فعلها، وهم لا يرونها، بحسب العادة،
وبحسب موقعهم في جلوسهم بأصل الحصن.
قال السهيلي:
«وفي قتلها دليل لمن قال: تقتل المرتدة من النساء أخذاً
بعموم قوله «عليه السلام»: من بدل دينه فاضربوا عنقه. وفيه مع العموم
قوة أخرى، وهي تعليق الحكم بالردة والتبديل، ولا حجة مع هذا لمن زعم من
أهل العراق بأن لا تقتل المرتدة لنهيه «عليه السلام» عن قتل النساء
والولدان.
قلت:
هما عامَّان
تعارضا، وكل من الفريقين يخص أحد الحديثين بالآخر، فالعراقيون يخصون
حديث: من بدل دينه فاقتلوه بحديث النهي عن قتل النساء والصبيان،
وغيرهم يخالفهم، وتخصيص المخالف أولى لوجه ليس هنا موضع ذكره.
وأما استدلاله بهذا الحديث على قتل المرتدة، ولم
تكن هذه مرتدة قط، فعجيب، بل هي قاتلة قتلت خلاد بن سويد، ومقاتلة
بتعاطيها ذلك، وناقضة للعهد. فالعراقي موافق لغيره في قتل هذه. وفي
انفرادها بالقتل عن نساء بني قريظة ما يشعر بأنه لما انفردت به عنهن من
قتل خلاد. فليس هذا من حكم المرتدة في ورد ولا صدر»([46]).
وأما حديث تخصيص أحد الحديثين بالآخر، ففيه مواضع للنظر ليس هنا موضع
التعرض لها.
قال ابن الأثير:
«وقتلت أرفة بنت عارضة منهم»([47]).
وقد تكون أرفة هي مزنة([48])،
كما تقدمت الإشارة إليه فيما سبق.
وكان نساء بني قريظة
يقلن:
عسى أن يمن على رجالنا، أو يقبل منهم فدية، فلما أصبحن وعلمن بقتل
رجالهن صحن، وشققن الجيوب، ونشرن الشعور، وضربن الخدود، فملأن المدينة.
قال: يقول الزبير بن
باطا:
«اسكتن، فأنتم أول من سبي من نساء بني إسرائيل منذ
كانت الدنيا، ولا يرفع السبي عنهم حتى نلتقي نحن وأنتن. وإن كان في
رجالكن خير فدوكن، فالزمن دين اليهودية فعليه نموت، وعليه نحيا»([49]).
ونقول:
نحن نشك في هذا النص، لأن الزبير هذا، كان قد قتل فيمن قتل من رجال بني
قريظة؛
فأين
رآهن الزبير حتى قال لهن هذا القول؟! وقد كن محبوسات في مكان آخر منفصل
عن حبس الرجال.
كما أن النص المذكور يكاد يكون متناقضاً في نفسه، فإن صدره يقول: إنهن
علمن بقتل رجالهن فصحن، وشققن الجيوب الخ..
وذيل النص يقول على لسان
ابن باطا:
وإن كان في رجالكن خير فدوكن الخ..
فكيف يمكن لرجالهن فديتهن وهم محبوسون للقتل أو أنهم قد قتلوا بالفعل.
ووهب «صلى الله عليه وآله» لثابت بن قيس بن الشماس ولد الزبير بن باطا،
فاستحيا منهم عبد الرحمن بن الزبير (كانت له صحبة)
لكن الزبير نفسه أبى
إلا أن يقتل مع قومه قبحه الله([50]).
وتفصيل ذلك وفقاً لما
ذكره الواقدي:
أن الزبير
بن باطا الذي كان أعمى([51])
كان قد مَنَّ على ثابت بن قيس يوم بعاث، وجز ناصيته. فلما كان يوم
قريظة استوهبه من رسول الله، وذلك بموافقة الزبير نفسه، فوهبه له.
فرجع إلى الزبير، فأخبره، ثم رغب الزبير باستيهاب أهله،
وولده، وماله، فوهب له رسول الله «صلى الله عليه وآله» أهله، وماله،
وولده.
فقال الزبير لثابت:
أما أنت فقد كافأتني، وقضيت بالذي عليك يا ثابت، ما فعل الذي كأن وجهه
مرآة صينية، تتراءى
عذارى
الحي في وجهه ـ كعب بن أسد؟
قال:
قتل.
قال:
فما فعل سيد الحاضر والبادي، سيد الحيين كليهما، يحملهم في الحرب،
ويطعمهم في المحل حيي بن أخطب؟
قال:
قتل.
قال:
فما فعل أول غادية اليهود إذا حملوا، وحاميتهم إذا ولوا ـ غزال بن
سموأل؟
قال:
قتل.
قال:
فما فعل الحُوَّل القُلَّب الذي لا يؤم جماعة إلا فضَّها،
ولا عقدة إلا حلَّها
ـ نباش بن قيس؟
قال:
قتل.
قال:
فما فعل لواء اليهود في الزحف ـ وهب بن زيد؟
قال:
قتل.
قال:
فما فعل والي رفادة اليهود، وأبو الأيتام والأرامل من اليهود ـ عقبة بن
زيد؟!
قال:
قتل.
قال:
فما فعل العمران اللذان
كانا يلتقيان بدراسة التوراة؟!
قال:
قتلا.
قال:
يا ثابت، فما خير العيش بعد هؤلاء؟!.
ثم طلب منه، وأصر عليه أن يقتله بسيفه، فقدمه إلى الزبير بن العوام،
فضرب عنقه.
وفي نص آخر:
يذكر فيه نحو ما تقدم، لكنه حين يصل إلى غزال بن سموأل يقول بعده: فما
فعل المجلسان؟ يعني بني كعب بن قريظة، وبني عمرو بن قريظة.
قال:
ذهبوا، قتلوا، فطلب منه أن يقتله، ففعل([52]).
وهذا النص كغيره من النصوص العديدة التي مرت معنا في هذه الغزوة وغيرها
صريح في ما تكررت إشارتنا إليه، ولم نزل نؤكد عليه، من أن المقصود هو:
إظهار مزيد شهامة، ورجولة وإباء لدى اليهود، وتسطير المآثر لهم،
ليعوضوهم بذلك عن الخزي الذي لحق بهم بسبب نقضهم العهود، وخيانتهم
للمواثيق.
ثم تكون نتيجة ذلك أيضاً:
أن يكون النبي «صلى الله عليه وآله» والمسلمون هم الذين ارتكبوا جريمة،
ولا أبشع منها في حق هؤلاء الكرام البررة!!
وليس ثمة ما يبرر ذلك سوى حب التشفي، وإلا القسوة، وحب سفك دماء
الأبرياء.
نعم..
هكذا يريدون أن يصوروا لنا الحال، وما آلت إليه الأحوال.
والأمر والأدهى من ذلك:
أن نرى بعض الكتاب المسلمين ينخدعون بهذه المرويات، حتى ليقول بعضهم:
«الحق أن هؤلاء اليهود قد أظهروا من الشجاعة
النادرة، والصبر المدهش على هذه المحنة والجلد أمام القتل، ما يحسدون
عليه»([53]).
وليت هذا الكاتب أشار أيضاً إلى ما أظهره هذا النص من تسامح، وعفو وكرم
من قبل رسول الله «صلى الله عليه وآله». ثم ما ظهر من خسة وانحطاط خلقي،
ومن صلف وقلة مبالاة بالقيم بإصرار هذا اليهودي على موقفه الخياني
الأثيم،
وانسياقه وراء تسويلات شيطانية رخيصة. ويا ليته أشار أيضاً إلى بكاء
اليهود بين يدي أبي لبابة ضعفاً
وخوراً
وجبناً..
ونظر رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى سلمى بنت قيس ـ وكانت إحدى
خالاته ـ وكان رفاعة بن سموأل له انقطاع إليها وإلى أخيها سليط، وأهل
الدار.
وكان حين حُبس أرسل إليها يطلب منها أن تكلم النبي «صلى الله عليه
وآله» في تركه، لأنها إحدى أمهاته.
فقال «صلى الله عليه
وآله»:
ما لك يا أم المنذر؟
فطلبت منه أن يهب لها رفاعة، وقد رآه «صلى الله عليه وآله» يلوذ بها،
فوهبه «صلى الله عليه وآله» لها.
ثم قالت:
يا رسول الله، إنه سيصلي، ويأكل لحم الجمل.
فتبسم «صلى الله عليه
وآله»، ثم قال:
إن يصلِّ
فهو خير له، وإن يثبت على دينه فهو شر له.
قالت:
فأسلم، فكان يقال له: مولى أم المنذر، فشق ذلك عليه، واجتنب الدار،
فأرسلت إليه: إنه والله ما أنا لك بمولاة، ولكنني كلمت رسول الله «صلى
الله عليه وآله» فوهبك لي، فحقنت دمك، وأنت على نسبك.
فكان بعد يغشاها، وعاد إلى الدار([54]).
لكن ابن حزم قال:
«وهب رفاعة بن شمويل القرظي لأم المنذر سلمى بنت قيس من بني النجار ـ
وكانت قد صلَّت
القبلتين ـ فأسلم رفاعة، وكان له صحبة، وكان ممن لم ينبت»([55]).
فإذا كان لم ينبت، فما معنى شفاعة أم المنذر فيه؟ فإنه لم يكن والحالة
هذه في معرض القتل، إلا أن تكون الشفاعة ناظرة إلى إطلاق سراحه من
السبي.
وقد ذكروا أرقاماً
متفاوتة جداً في عدد المقتولين من بني قريظة الأمر الذي يثير لدينا
شكوكاً
في أن ثمة من يريد أن يستفيد من هذا الأمر ويوظفه إعلامياً
لمقاصد سياسية، أو دينية، أو غيرها.
والأقوال هي التالية:
1 ـ
إن عدد المقتولين كان ألف إنسان، قال المعتزلي: «حصد من بني قريظة في
يوم واحد رقاب ألف إنسان صبراً،
في مقام واحد، لما علم في ذلك من إعزار الدين، وإذلال المشركين»([56]).
2 ـ
كانوا تسع مئة([57]).
3 ـ
المكثر لهم يقول: كانوا بين الثمان مئة والتسع
مئة»([58]).
4 ـ
كانوا سبع مئة وخمسين([59]).
5 ـ
ما بين سبع مئة وثمان مئة([60]).
6 ـ
ما بين ست مئة إلى تسع مئة([61]).
7 ـ
كانوا سبع مئة أو نحو سبع مئة([62]).
8 ـ
ما بين ست مئة إلى سبع مئة([63]).
9 ـ
كانوا ست مئة([64]).
10 ـ
كانوا أربع مئة وخمسين.
وحسب نص ابن شهرآشوب:
أنهم كانوا سبع مئة لكن المقتولين منهم كانوا أربع
مئة وخمسين([65]).
11 ـ
كانوا أربع مئة رجل([66]).
12 ـ
كانوا ثلاثة مئة فقط([67]).
ونشير هنا إلى أمور ثلاثة لها ارتباط بما تقدم هي:
الأول:
إن ما تقدم من الأقوال في عدد المقتولين، قد يكون ناظراً
إلى خصوص الذين قتلوا استناداً إلى حكم سعد بن معاذ فيهم.
أما من قتلوا في المعركة وأثناء الحصار، فقد لا يكون محط النظر في هذه
الأقوال.
ونجد بعض النصوص يصرح:
بأن الذين قتلهم علي «عليه السلام» وحده في بني
قريظة كانوا عشرة([68]).
ثم إنهم يصرحون:
بأن علياً والزبير قد توليا قتلهم وهم يعدون بالمئات. إلا إذا
صححنا رواية توزيعهم على بيوت الأوس حسبما تقدم.
الثاني:
قد ذكر ابن شهرآشوب:
أن عدة بني قريظة كانت سبع مئة، لكن المقتولين منهم كانوا أربع مئة
وخمسين([69])،
وعند غيره: أربع مئة، أو ثلاث مئة،
وقد يكون هذا هو الأقرب إلى الواقع والحقيقة انسجاماً
مع ظاهر قوله تعالى: ﴿فَرِيقاً
تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً﴾([70]).
وقد فسر البعض قوله تعالى: ﴿وَتَأْسِرُونَ
فَرِيقاً﴾
بالسبايا والذراري. وهو تفسير غير مقبول فإن الأسر هنا إنما يناسب
المقاتلين أما النساء والذراري فالأنسب التعبير عنهم بالسبايا.
ومما يؤيد ما نقوله في
عدد بني قريظة، قولهم:
إن عدد الذراري والنساء كان سبع مئة وخمسين، أو تسع مئة أو ألفاً على
أبعد التقادير، مع أن السبي لا بد أن يكون أضعاف عدد المقاتلين، وهذا
يؤيد أن يكون عدد المقاتلين ما بين المئة إلى المئتين على أبعد تقدير.
الثالث:
قد ظهر من الأقوال الآنفة الذكر مدى التفاوت والاختلاف في عدد قتلى بني
قريظة، فقد تراوحت الأقوال ما بين الثلاث مئة إلى الألف، حتى لقد بلغت
الأقوال إلى اثني عشر قولاً.
وكثرة الأقوال إلى هذا الحد تدل على أنه لم يكن ثمة من يملك معلومات
دقيقة عن هذا الموضوع.
ويبدو أنهـا
تقديـرات
تبرعية، تأثرت بريـاح
الأهـواء
السيـاسية،
أو العصبيات الدينية، بهدف إظهار قسوة الإسلام ونبي الإسلام على أعدائه
وخصوصاً اليهود.
ومن الغريب:
أن نجد معاوية الحاكم الأموي قد أفصح عن دخيلة نفسه فيما يرتبط بقتل
كعب بن الأشرف اليهودي الغادر، حين اعتبر قتله نوعاً
من الغدر والخيانة.
وقد تقدم ذلك:
في بعض فصول هذا الكتاب([71]).
ولا ندري، فلعل لهؤلاء الحكام بعض التأثير في هذه الأرقام الخيالية في
قتلى بني قريظة.
أما من قتل من المسلين في غزوة بني قريظة فهم كما يذكره المؤرخون:
1 ـ
خلاد بن سويد،
الذي استشهد يوم بني قريظة حيث طرحت نباتة
النضيرية عليه رحى فقتلته([72])،
وكان قد دنا ليكلمهم([73]).
فقال رسول الله «صلى
الله عليه وآله»:
إن له لأجر شهيدين([74]).
فقالوا:
ولم يا رسول الله؟
قال:
لأن أهل الكتاب قتلوه([75]).
قال بعضهم:
«قلت: فيؤخذ منه: أن مقتول أهل الكتاب له أجر
شهيدين، والله أعلم بالحكمة في ذلك. وأخرجه أبو داود من رواية ثابت بن
قيس بن شماس»([76]).
2 ـ
منذر بن محمد([77])
أخو بني جحجبا([78]).
3 ـ
أبو سنان بن محصن، مات في الحصار فدفنه رسول الله
«صلى الله عليه وآله» في مقبرة بني قريظة، التي يدفن فيها المسلمون لما
سكنوها اليوم، وإليه دفنوا أمواتهم في الإسلام. كذا قاله ابن إسحاق([79]).
ونقول:
إن ذلك كله مشكوك فيه. وذلك لما يلي:
ألف:
بالنسبة لخلاد بن سويد نقول: لقد قال بعضهم: إنه
لم يقتل([80]).
ونقول أيضاً:
لماذا اختص بأجر شهيدين، دون غيره من سائر الشهداء؟ وهل ثمة فرق بين من
يقتله أهل الكتاب وبين من يقتله غيرهم؟
ولماذا لما ينل من يقتله المشركون أجر شهيدين أيضاً؟! أم أن جهاد أهل
الكتاب أصعب من جهاد غيرهم؟ أو أن سيوفهم أحدّ
من سيوف من عداهم. والآلام التي يواجهها المجاهدون معهم أشد من الآلام
مع غيرهم؟!
ولنا أن نحتمل هنا:
أن الهدف هو تقديم خدمة جليلة للسائب بن خلاد بن
سويد الذي ولي لمعاوية اليمن([81]).
فلعلهم أرادوا تعظيم شأن من هو من حزبهم، ومكافأته على إخلاصه لهم،
فاخترعوا لأبيه هذه الأوسمة: وسام الشهادة، ووسام أجر شهيدين.
ب:
أما بالنسبة لمنذر بن محمد، فشهادته أيضاً في بني قريظة موضع شك وريب.
وذلك لما يلي:
1 ـ
قال ابن شهرآشوب:
«لم يقتل فيه من المسلمين غير خلاد»([82]).
2 ـ
قال ابن حزم عن خلاد بن سويد وأبي سنان بن محصن:
«ولم يصب غير هذين»([83]).
ج:
أما بالنسبة لموت أبي سنان بن محصن، فهو أيضاً
مشكوك فيه، إذ إن منهم من قال: «بقي إلى أن بايع تحت الشجرة»([84]).
وتقدم قولهم:
لم يقتل من المسلمين غير خلاد..
فاتضح مما ذكرناه:
أنه لم يثبت استشهاد أي من هؤلاء الثلاثة في بني قريظة..
الشهداء
أشخاص آخرون:
وبعد ما تقدم نقول:
إننا نجد في شعر حسان بن ثابت ما يشير إلى وجود قتلى غير هؤلاء، قد
استشهدوا في هذه الغزوة،
فهو يقول في رثاء سعد بن معاذ، وجماعة ممن استشهد يوم بني قريظة:
صـبـابـة
وجــد
ذكَّـرتـنـي
إخــوة
وقـتـلى
مـضـى
فيهـا
طفيل ورافع
وسعد فأضحوا
في الجنان وأوحشت
منازلهم فـالأرض
مـنـهم
بلاقع([85])
أما قول البعض:
إن الـذين
قتلوا من المسلمين في قريظة كانوا ثلاثة نفر، وفي الخندق ستة([86])
فلعله ناظر إلى أولئك الثلاثة الذين تقدمت أسماؤهم، وذكرنا ما يوجب
الشك في صحة ذلك،
أو هو ناظر إلى الذين ذكرهم حسان.
ويزعم البعض:
أن مجموع شهداء الخندق وقريظة، كان ستة نفر([87]).
لكن قد تقدم في الجزء
العاشر:
ذكر عدد من استشهد من المسلمين في الخندق. وقد تراوحت الأقوال ما بين
أربعة إلى ثمانية شهداء.. والأقوال في شهداء بني قريظة قد ذكرناها
آنفاً..
فما ذكره صاحب البدء
والتاريخ، هنا:
لعله جاء نتيجة جمعه بين القولين وهما: الأربعة في الخندق، والاثنان في
قريظة،
أو خمسة في الخندق، وواحد في قريظة. وقد ظهر الحال مما ذكرناه فلا حاجة
للإعادة.. لأنها ستكون خالية عن الإفادة.
([2])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص21.
([3])
مناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء) ج1 ص252.
([4])
الآية 26 من سورة الأحزاب.
([5])
تفسير القمي ج2 ص191 والبحار ج20 ص236.
([6])
السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص251 و 252 وراجع: كشف الغمة ج1
ص208 و 209 والكامل في التاريخ ج2 ص186 وج4 ص124 وعيون الأثر
ج2 ص73 والإرشاد للمفيد ص64 و 65 والبحار ج20 ص262 و 263
ومناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء) ج1 ص252 والبداية والنهاية
ج4 ص124 وبهجة المحافل ج1 ص274 وتاريخ الخميس ج1 ص497 ونهاية
الأرب ج17 ص192 ووفاء الوفاء ج1 ص307 و 308 والإكتفاء ج2 ص182
وتاريخ الإسلام (المغازي) ص261 والسيرة النبوية لابن كثير ج3
ص239 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص17 والسيرة الحلبية ج2 ص240
ودلائل النبوة للبيهقي ج4 ص22 و 23 وإمتاع الأسماع ج1 ص247
وراجع عن ضرب أعناقهم في الخنادق: تاريخ ابن الوردي ج1 ص163
والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ص32.
([7])
دلائل النبوة للبيهقي ج4 ص20 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي)
ص260.
([8])
المغازي للواقدي ج2 ص512 و 513 سبل الهدى والرشاد ج5 ص22.
([9])
راجع المصادر في الهوامش السابقة.
([10])
راجع: تاريخ اليعقوبي ج2 ص52 ونهاية الأرب ج17 ص193 وشرح بهجة
المحافل ج1 ص275. والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص18 وتاريخ الخميس
ج1 ص498 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص254 والسيرة الحلبية ج2 ص240
والمغازي للواقدي ج2 ص513 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص22.
([11])
راجع: إمتاع الأسماع ج1 ص249 والسيرة الحلبية ج2 ص340 والمغازي
للواقدي ج2 ص517.
([12])
راجع: المصادر الثلاثة المتقدمة في الهامش السابق.
([13])
السيرة النبوية لدحلان ج2 ص17 وإمتاع الأسماع ج1 ص249 والسيرة
الحلبية ج2 ص340.
([14])
تفسير القمي ج2 ص191 والبحار ج20 ص236.
([15])
كشف الغمة ج1 ص208 و 209 والإرشاد للمفيد ص64 و 65 والبحار ج20
ص262 و 263 وكشف اليقين ص135.
([16])
المغازي للواقدي ج2 ص516.
([17])
مناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء) ج1 ص252 وراجع: إعلام الورى
ص93 و 94.
([18])
راجع: المغازي للواقدي ج2 ص515 و 516 وإمتاع الأسماع ج1 ص247
ومجمع الزوائد ج6 ص140 عن الطبراني والسيرة النبوية لدحلان ج2
ص18 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص23 والسيرة الحلبية ج2 ص340 و 341.
([19])
مناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء) ج2 ص97.
([20])
راجع: وفاء الوفاء ج1 ص308 والإكتفاء ج2 ص189 وتاريخ الأمم
والملوك ج2 ص252 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص17 والبحار ج20
ص246 ودلائل النبوة للبيهقي ج4 ص24 والسيرة الحلبية ج2 ص340
وقرب الإسناد ص63 وإمتاع الأسماع ج1 ص249 وتاريخ الخميس ج1
ص498 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص24 ومسند أبي عوانة ج4 ص55 ـ 57
ونهاية الأرب ج17 ص195 وجوامع السيرة النبوية ص155 وطبقات ابن
سعد (ط دار صادر) ج2 ص56 و 57 والبداية والنهاية ج4 ص125 وبهجة
المحافل ج1 ص275 عن ابن حبان، والحاكم، والترمذي والسيرة
النبوية لابن هشام ج3 ص255 وتهذيب الأحكام للطوسي ج6 ص173 و
339 والبحار ج100 ص35 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج1 ص44.
([21])
المغازي للواقدي ج2 ص517 راجع: إمتاع الأسماع ج1 ص249.
([22])
طبقات ابن سعد ج2 ص56 و 57 والبداية والنهاية ج4 ص125 وبهجة
المحافل ج1 ص275 عن ابن حبان والحاكم والترمذي.
([23])
شرح بهجة المحافل ج1 ص275 عن ابن شاهين.
([24])
مجمع الزوائد ج6 ص141 عن الطبراني في الكبير والأوسط، وسبل
الهدى والرشاد ج5 ص24 و 25.
([25])
عوالي اللآلي ج1 ص221 ومستدرك الوسائل ج1 ص86.
([26])
راجع: الإصابة ج3 ص414.
([27])
راجع: الإصابة ج3 ص517 وتهذيب التهذيب ج9 ص421 و 422.
([28])
الإصابة ج3 ص517 عن البخاري في تاريخه وتهذيب الكمال ج26 ص340
و 341 و 343 والتاريخ الكبير للبخاري ج1 الترجمة رقم 479
ومختصر تاريخ دمشق ج23 ص181 وتهذيب التهذيب ج9 ص420 و 421 و
422.
([29])
جوامع السيرة النبوية ص155.
([30])
السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص255 وعيون الأثر ج2 ص75 والروض
الأنف ج3 ص284 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص24 وتاريخ الخميس ج1
ص498 ومسند أبي عوانة ج4 ص55 و 56 والإكتفاء ج2 ص185 وتاريخ
الإسلام (المغازي) ص259 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص19 والسيرة
الحلبية ج2 ص343 والأمالي للطوسي ص403 والبحار ج20 ص246 عنه
ودلائل النبوة للبيهقي ج4 ص25 والسيرة النبوية لابن كثير ج3
ص241 والبداية والنهاية ج4 ص125 و 126 وأسد الغابة ج3 ص413
وتهذيب الكمال ج20 ص157 و 158 وفي هامشه عن: سنن أبي داود 4404
وابن ماجة رقم 2541 والترمذي رقم 1584 والنسائي ج6 ص155.
([31])
الروض الأنف ج3 ص284.
([32])
الروض الأنف ج3 ص284.
([33])
المغازي للواقدي ج2 ص514 وإمتاع الأسماع ج1 ص248 وسبل الهدى ج5
ص24.
([34])
تفسير القمي ج2 ص192 والبحار ج20 ص238.
([35])
المغازي ج2 ص516 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص24 والسيرة النبوية
لدحلان ج2 ص17 و 18 والسيرة الحلبية ج2 ص340 وكمال الدين ج1
ص198 والبحار ج20 ص247 عنه وفي ص236 و 237 وتفسير القمي ج2
ص191.
([36])
راجع المصادر التالية: المغازي للواقدي ج2 ص513 و 514 وإمتاع
الأسماع ج1 ص247 و 248 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص23 و 24 والسيرة
الحلبية ج2 ص340. وراجع أيضاً: السيرة النبوية لابن هشام ج3
ص252 وكشف الغمة للأربلي ج1 ص309 ودلائل النبوة للبيهقي ج4 ص23
وراجع ص20 ومجمع البيان ج8 ص352 وبهجة المحافل وشرحه (أي متناً
وهامشاً) ج1 ص275 وبحار الأنوار ج20 ص212 و 263 والسيرة
النبوية لابن كثير ج3 ص239 وعيون الأثر ج2 ص73 والروض الأنف ج3
ص284 والمصنف للصنعاني ج5 ص371 و 372 والسيرة النبوية لدحلان
ج2 ص17 والإكتفاء للكلاعي ج2 ص183 وتاريخ الإسلام (المغازي)
ص260 و 262 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص250 والكامل في التاريخ
ج2 ص186 والبداية والنهاية ج4 ص124 و 125 وتاريخ الخميس ج1
ص497 والإرشاد للمفيد ص65 والبداية والنهاية ج1 ص124 و 125
ونهاية الأرب ج17 ص192 و 193.
([37])
كشف الغمة ج1 ص209 والإرشاد للمفيد ص65 والبحار ج20 ص263.
([38])
السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص252 ونهاية الأرب ج17 ص193
والإكتفاء للكلاعي ج2 ص183 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص250
ودلائل النبوة للبيهقي ج4 ص23 والسيرة النبوية لابن كثير ج3
ص239 وراجع: الإصابة ج1 ص222.
([39])
الإرشاد للمفيد ص65 والبحار ج20 ص263 و 264.
([40])
تفسير القمي ج2 ص191 و 192 والبحار ج20 ص237 وفي دلائل النبوة
للبيهقي ج4 ص23 قال:
«وبعض
الناس يقول: حيي بن أخطب قالها»
وكذا في الإصابة ج1 ص222.
([41])
البحار ج20 ص263 وكشف الغمة ج1 ص209 والإرشاد للمفيد ص265.
([42])
المغازي للواقدي ج2 ص516 و 517 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص26 و 27
وإمتاع الأسماع ج1 ص249 وفي السيرة الحلبية ج2 ص341 والسيرة
النبوية لدحلان ج2 ص18 أن اسمها: بيانة. وقيل: مزنة. ودخولها
على عائشة وهي تضحـك ظهـراً لبطن في السيرة النبويـة لابن
هشـام ج3 ص253 والإكتفـاء = = للكلاعي ج2 ص184. وراجع: عيون
الأثر ج2 ص73 و 78 والبداية والنهاية
ج4 ص126 وتاريخ الخميس ج1
ص497 و 498 ونهاية الأرب ج17 ص193 وتاريخ الإسلام (المغازي)
ص262 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص250 و 251 و 254 والسيرة
النبوية لابن كثير ج3 ص242. وراجع: شرح بهجة المحافل ج1 ص276
وجوامع السيرة النبوية ص155 ومناقب آل أبي طالب (ط دار
الأضواء) ج1 ص252 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق 2 ص32.
([43])
تاريخ الخميس ج1 ص498.
([44])
المغازي للواقدي ج2 ص518 وراجع ص512.
([45])
الإرشاد للشيخ المفيد ص65 و 66 وبحار الأنوار ج20 ص264.
([46])
عيون الأثر ج2 ص78 وكلام السهيلي في الروض الأنف ج3 ص284.
([47])
الكامل في التاريخ ج2 ص186.
([48])
السيرة النبوية لدحلان ج2 ص18 والسيرة الحلبية ج2 ص341.
([49])
المغازي للواقدي ج2 ص518.
([50])
العبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق 2 ص32 وجوامع السيرة النبوية
ص155.
([51])
مجمع الزوائد ج6 ص141 عن الطبراني في الأوسط ودلائل النبوة
للبيهقي ج4 ص20 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص240 وتاريخ
الإسلام (المغازي) ص260.
([52])
راجع فيما تقدم، باختصار أو بتفصيل المصادر التالية: المغازي
للواقدي ج2 ص518 ـ 520 ومجمع الزوائد ج6 ص141 و 142 عن
الطبراني في الأوسط والبداية والنهاية ج4 ص125 والسيرة النبوية
لابن كثير ج3 ص240 والبحار ج20 ص277 وشرح بهجة المحافل ج1 ص275
و 276 وتاريخ الخميس ج1 ص498 ونهاية الأرب ج17 ص193 ـ 195
والإكتفاء ج2 ص184 و 185 وتاريخ الأمم والملـوك ج2 ص251 ودلائل
النبوة للبيهقي ج4 ص20 ـ 24 = = وسبل الهدى والرشاد ج5 ص26 و
27 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص18 والسيرة الحلبية ج2 ص241 و
242 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص253 و 254 وعيون الأثر ج2
ص74 و 75 وتاريخ الإسلام (المغازي) ص260 و 261 وراجع إمتاع
الأسماع ج1 ص249 ووفاء الوفاء ج1 ص308.
([53])
محمد رسول الله سيرته وأثره في الحضارة ص249.
([54])
المغازي للواقدي ج2 ص514 و 515. وأشار إلى ذلك أو ذكره تفصيلاً
في المصادر التالية: إمتاع الأسماع ج1 ص248 والسيرة النبوية
لابن هشام ج3 ص255 وعيون الأثر ج2 ص75 والبداية والنهاية ح 4
ص126 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص25 ونهاية الأرب ج17 ص195 وتاريخ
الأمم والملوك ج2 ص252 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص241
والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص32 وتاريخ الخميس ج1 ص498
والإكتفاء ج2 ص185 و 186 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص19.
والسيرة الحلبية ج2 ص343.
([55])
جوامع السيرة النبوية ص155.
([56])
شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج16 ص291.
([57])
كشف الغمة للأربلي ج1 ص208
والإرشاد للمفيد ص64 وذكره بلفظ قيل في حدائق الأنوار ج2 ص598
وكذا في عمدة القاري ج17 ص192 وفتح الباري ج7 ص319 وسبل الهدى
والرشاد ج5 ص36 والبحار ج20 ص262 وكشف اليقين ص135.
([58])
راجع المصادر التالية: السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص252 وعيون
الأثر ج2 ص73 والبداية والنهاية ج4 ص124 والسيرة النبوية لابن
كثير ج3 ص239 وبهجة المحافل ج1 ص275 والمواهب اللدنية ج1 ص117
وسبل الهدى والرشاد ج5 ص36 ونهاية الأرب ج17 ص192 والإكتفاء ج2
ص183 وتاريخ الإسلام (المغازي) 261 وتاريخ الأمم والملوك ج2
ص250 ودلائل النبوة للبيهقي ج4 ص23 وفتح الباري ج7 ص319 عن
الروض الأنف، ومحمد رسول الله، سيرته وأثره في الحضارة ص249
والتفسير السياسي للسيرة ص285.
([59])
تاريخ اليعقوبي: ج2 ص52 والتنبية والإشراف ص217 وراجع: إمتاع
الأسماع ج1 ص249 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص16 والسيرة
الحلبية ج2 ص338 والمغازي للواقدي ج2 ص518 عن ابن عباس.
([60])
راجع: الكامل في التاريخ ج2 ص186 وتاريخ الخميس ج1 ص497. ووفاء
ج1 ص308 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص16 والسيرة الحلبية ج2
ص338.
([61])
الثقات ج1 ص278 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق 1 ص293.
([62])
البدء والتاريخ ج4 ص220 وراجع المصادر التالية: فتح الباري ج7
ص319 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص36 وتاريخ ابن الوردي ج1 ص163
ووفاء الوفاء ج1 ص308 وتاريخ الخميس ج1 ص497 عن بن عائذ، وعمدة
القاري ج17 ص192 كما في مرسل قتادة. وتاريخ الإسلام السياسي ج1
ص121 وحدائق الأنوار ج2 ص598 وتفسير القمي ج2 ص190 والبحار ج20
ص234 عنه.
([63])
راجع: المغازي للواقدي 2 ص518 وراجع: التفسير السياسي للسيرة
ص283 ومحمد رسول الله، سيرته وأثره في الحضارة ص249 وطبقات ابن
سعد ج2 ص75 وجوامع السيرة النبوية ص155 والبداية والنهاية ج2
ص186 وبهجة المحافل ج1 ص275 والمواهب اللدنية ج1 ص117 وتاريخ
الإسلام (المغازي) ص261 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص250 والسيرة
النبوية لدحلان ج2 ص18 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص239.
([64])
راجع المصادر التالية: البحار ج2 ص212. المغازي للواقدي ج2
ص517 ومختصر التاريخ ص43 وتاريخ الخميس ج1 ص497 والسيرة
النبوية لدحلان ج2 ص16 وإرشـاد السـاري ج6 ص330 وعمـدة القـاري
ج17 ص192 = = وفتح الباري ج7 ص319 عن ابن إسحاق، وبه جزم أبو
عمر، وسبل الهدى والرشاد ج5 ص36 وإمتاع الأسماع ج1 ص249 وتاريخ
الإسلام (المغازي) ص260 والسيرة الحلبية ج2 ص338 ودلائل النبوة
للبيهقي ج4 ص20 ومجمع البيان ج8 ص352.
([65])
راجع: مناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء) ج1 ص252 وراجع: مجمع
البيان ج8 ص352 والبحار ج20 ص212.
([66])
راجع: إرشاد الساري ج6 ص330 عن الترمذي والنسائي، وابن حبان
بإسناد صحيح. والبداية والنهاية ج4 ص122 و 124 ومحمد رسول
الله: سيرته وأثره في الحضارة ص249 وعمدة القاري ج17 ص192 وفتح
الباري ج7 ص319 والمواهب اللدنية ج1 ص117 وسبل الهدى ج5 ص36
ووفاء الوفاء ج1 ص308 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص16 ودلائل
النبوة للبيهقي ج4 ص28 وتاريخ الخميس ج1 ص497 وتاريخ الإسلام
للذهبي (المغازي) ص264 والسيرة الحلبية ج2 ص338 والسيرة
النبوية لابن كثير ج3 ص234.
([67])
حياة محمد ورسالته، لمولانا محمد علي ص175.
([68])
مناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء) ج3 ص171.
([69])
مناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء) ج1 ص252.
([70])
الآية 26 من سورة الأحزاب.
([71])
راجع: الجزء السابع ص19.
([72])
راجع: الإكتفاء ج2 ص190 وأنساب الأشراف ج1 ص348 و 244 والسيرة
النبوية لدحلان ج2 ص18 والسيرة الحلبية ج2 ص341 والسيرة
النبوية لابن كثير ج3 ص243 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص30 والمغازي
للواقدي ج2 ص529 و 530 وجوامع السيرة النبوية ص157 والسيرة
النبوية لابن هشام ج3 ص265 وعيون الأثر ج2 ص76 وتاريخ الخميس
ج1 ص498 وتاريخ الإسلام (المغازي) ص271 وتاريخ الأمم والملوك
ج2 ص253 ومناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء) ج1 ص252 والبداية
والنهاية ج4 ص126 ونهاية الأرب ج17 ص196 وشرح بهجة المحافل ج1
ص276.
([73])
أنساب الأشراف ج1 ص348.
([74])
راجع المصادر المتقدمة في الهامش ما قبل الأخير.
([75])
شرح بهجة المحافل ج1 ص276.
([77])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص30 وعيون الأثر ج2 ص76 عن ابن عائذ.
([78])
عيون الأثر ج2 ص76.
([79])
تاريخ الخميس ج1 ص498 وراجع المصادر التالية: وفاء الوفاء ج1
ص307 وتاريخ الإسلام (المغازي) ص273 والمغازي للواقدي ج2 ص529
و 530 وجوامع السيرة النبوية ص157 والسيرة النبوية لابن هشام
ج3 ص265 وراجع: عيون الأثر ج2 ص76 ومناقب آل أبي طالب (ط دار
الأضواء) ج1 ص252 والبداية والنهاية ج4 ص126 ونهاية الأرب ج17
ص196 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص253 والسيرة النبوية لابن كثير
ج3 ص243.
([80])
أنساب الأشراف ج1 ص344 و 345.
([82])
مناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء) ج1 ص252 وراجع: البداية
والنهاية ج4 ص126 ونهاية الأرب ج17 ص196.
([83])
جوامع السيرة النبوية ص157.
([84])
تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص273.
([85])
البداية والنهاية ج4 ص136 وسيأتي هذا الشعر مع بقية مصادره.
([86])
الكامل في التاريخ ج2 ص187.
([87])
البدء والتاريخ ج4 ص220.
|