|
حكم الله من فوق سبعة أرقعة
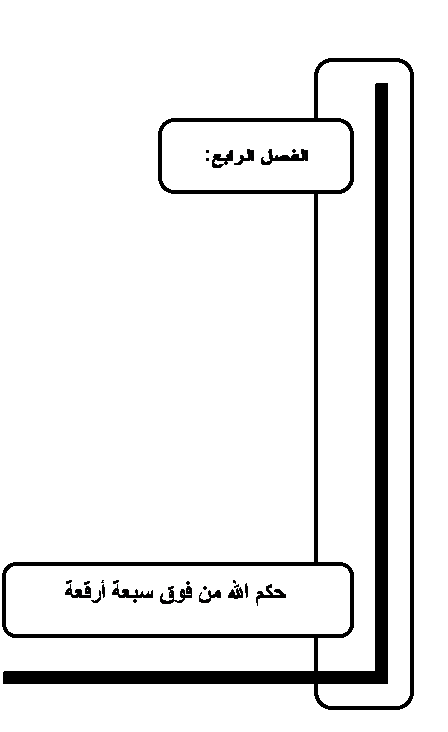
نتائج الحرب، والأسرى:
وبعد أن جهدهم
الحصار، واستنزلهم أمير المؤمنين «عليه السلام» على حكم رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، أمر «صلى الله عليه
وآله» ـ كما يقول المؤرخون ـ بأسراهم، فكتفوا رباطاً،
وجعل على كتافهم محمد بن مسلمة، ونحُّوا
ناحية، وجعلوا النساء والذرية ناحية، وكانوا ألفاً،
وجعل عليهم
عبد الله بن سلام([1]).
ثم رجع «صلى الله عليه وآله» إلى المدينة، «يوم الخميس
لتسع (لسبع) ليال ـ كما ذكر محمد بن عمر، وابن سعد، وجزم إبن الدمياطي
ـ وقيل: لخمس ـ كما جزم به في الإشارة ـ خلون من ذي الحجة».
وعبارة البعض:
فرغ منهم يوم الخميس لسبع أو لخمس خلون الخ..([2]).
وحين رجع «صلى
الله عليه وآله» إلى المدينة حبس بني قريظة في بعض دور الأنصار وهي دار
بنت الحارث بن كرز بن حبيب بن عبد شمس([3]).
واسمها نسيبة([4])،
أو زينب([5])،
أو قلابة([6])
أو كبشة بنت كريز([7])،
أو كيسة([8]).
ولعل كيسة تصحيف كبشة، أو العكس، أو رملة([9]).
وفي بعض النصوص:
حبسهم في دار
أسامة بن زيد([10]).
وجمع البعض بينهما فقال:
أمر «صلى الله عليه وآله» بالسبي فسيقوا إلى دار أسامة
بن زيد،
والنساء
والذرية إلى دار ابنة الحارث([11]).
وكان «صلى الله عليه وآله» كان قد أمر بهم فكُتِّفوا([12]).
«ثم أمر النبي «صلى الله عليه وآله» حتى ذهبوا برجال بني قريظة إلى
المدينة مقرنين في الأصفاد، حتى يرى ضعفاء الإسلام قوة الدين، وعزة ملة
سيد المرسلين»([13]).
ويقول نص آخر:
أمر «صلى الله عليه وآله» بأسلحتهم فجعلت في بيت (في
بعض المصادر: في قبته) وأمر بهم فكتفوا الخ..([14]).
ولعل الصحيح:
(في بيت)، وذلك لقول الواقدي: «وأمر «صلى الله عليه
وآله» بالسلاح والأثاث، والمتاع والثياب، فحمل إلى دار بنت الحارث،
وأمر بالإبل والغنم، فتركت هناك ترعى
في الشجر»([15]).
قال الواقدي:
«وجعلوا ليلتهم يدرسون التوراة، وأمر بعضهم بعضاً
بالثبات على
دينه، ولزوم التوراة»([16]).
ونكاد نطمئن إلى أن التجاءهم للتوراة لم يكن بالنسبة
لعلمائهم وزعمائهم إلا محاولة لخداع السذج منهم بها، لأنهم كانوا
يعرفون هذا النبي كما يعرفون أبناءهم، ويجدونه مكتوباً
عندهم في التوراة، وما زالوا يتوعدون به عرب الحجاز إلى
أن بُعث
«صلى الله عليه وآله».
وكان «صلى الله عليه وآلـه» يقول:
«أسقوهم
العذب، وأطعموهم
الطيب، وأحسنوا إسارهم»([17]).
وقال:
أحسنوا إسارهم، وقيِّلوهم،
واسقوهم حتى يبردوا، فتقتلوا من بقي، لا تجمعوا عليهم حر الشمس، وحر
السلاح»([18]).
وقد قال «صلى الله عليه وآله» هذا بعد حكم سعد بن معاذ
بقتل من حزَّب
عليه منهم. «وأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بأحمال التمر، فنثرت
عليهم، فباتوا يكدمونها كدم الحمر»([19]).
قال الواقدي وغيره ما ملخصه:
إنهم حين جاؤوا بالأسرى، تنحى رسول الله «صلى الله عليه
وآله» فجلس، ودنت الأوس إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وطلبوا
منه أن يهب لهم حلفاءهم من بني قريظة، كما وهب لابن أُبي
ثلاث مئة حاسر، وأربع مئة دارع من بني قينقاع.
ورسول الله «صلى الله عليه وآله» ساكت لا يتكلم، حتى
أكثروا عليه وألحوا، ونطقت الأوس كلها.
فقال
«صلى الله عليه وآله»:
أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم؟!
قالوا:
بلى!
قال:
فذلك إلى سعد بن معاذ.
وكان سعد في خيمة رفيدة، أو كعيبة بنت سعد بن عتبة، في
المسجد. وكانت كعيبة تداوي الجرحى،
وتلم الشعث، وتقوم على الضائع، والذي لا أحد له.
فجاءت الأوس إلى سعد، فحملوه على حمار، وطلبوا منه أن
يحسن في مواليه، كما صنع ابن أُبي
في حلفائه.
والضحاك بن خليفة يقول:
يا أبا عمرو، مواليك! مواليك! قد منعوك في المواطن
كلها، واختاروك على من سواك، ورجوا عياذك، ولهم جمال وعدد.
وقال سلمة بن سلام بن وقش:
يا أبا عمرو، أحسن في مواليك وحلفائك. إن رسول الله
«صلى الله عليه وآله» يحب البقية. نصروك يوم البعاث والحدائق والمواطن،
ولا تكن شراً
من ابن أبي. وسعد لا يتكلم.
فلما أكثروا عليه، قال:
قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم.
فقال الضحاك بن خليفة:
وا قوماه.
وقال معتب بن قشير:
وا سوء صباحاه.
وقال حاطب بن أمية الظفري:
ذهب قومي آخر الدهر.
فلما أقبل سعد إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
والناس جلوس حوله، قال «صلى الله عليه وآله»: قوموا إلى سيدكم.
فكان رجال من بني عبد الأشهل
يقولون:
فقمنا على أرجلنا صفين، يحييه كل رجل منا حتى انتهى إلى
رسول الله «صلى الله عليه وآله».
وطلبت الأوس الذين بقوا عند رسول الله «صلى الله عليه وآله»:
من سعد أن يحسن في بني قريظة، ويذكر بلاءهم عنده.
وقالوا له: إنما ولاك لتحسن فيهم.
ثم قال سعد:
عليكم عهد الله وميثاقه: أن الحكم فيكم ما حكمت؟
قالوا:
نعم.
فقال سعد للناحية الأخرى، التي فيها
رسول الله، وهو معرض عنها، إجلالاً
لرسول الله «صلى الله عليه وآله»: وعلى من ها هنا مثل
ذلك؟!
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، ومن معه:
نعم.
قال سعد:
فإني أحكم فيهم: أن يقتل من جرت عليه الموسى، وتسبى
النساء والذرية، وتقسم الأموال.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
لقد حكمت بحكم الله عز وجل من فوق سبعة أرقعة، أو بحكم
الملك.
وكان سعد قد
سأل الله في الليلة التي نزلت فيها قريظة على حكم رسول الله: أن يقر
عينه من بني قريظة، فأقر الله عينه منهم([20]).
وذكروا أيضاً:
أن سعداً قد حكم بأن تكون الديار للمهاجرين دون الأنصار.
قال:
فقالت الأنصار: إخواننا، كنا معهم!!
فقال:
إني أحببت أن
يستغنوا عنكم([21]).
وفي مجمع البيان:
قال للأنصار: إنكم ذوو عقار، وليس للمهاجرين عقار. فكبر
رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وقال لسعد الخ..([22]).
ويذكر البعض:
أن بني قريظة أبوا أن ينزلوا على حكم النبي، ونزلوا على
حكم سعد فأقبلوا بهم، وسعد أسيراً
(لعل الصحيح: يسير) على أتان حتى انتهوا إلى رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، فأخذت قريظة تذكره بحلفهم، وطفق سعد بن معاذ ينفلت إلى رسول
الله «صلى الله عليه وآله» مستأمراً،
ينتظره فيما يريد أن يحكم به، فيجيب به رسول الله «صلى الله عليه وآله»
يريد أن يقول: أتقر بما أنا حاكم؟!
وطفق رسول الله «صلى الله عليه
وآله» يقول:
نعم.
قال سعد:
فإني أحكم
الخ..([23]).
ويبدو أن سعداً قد أبى أولاً أن يحكم فيهم، لأنه يعلم
أنه لا يحق له ذلك مع وجود النبي «صلى الله عليه وآله».
ففي حديث جابر، عن ابن عائذ:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال: احكم فيهم يا سعد.
قال:
الله ورسوله أحق بالحكم.
قال:
قد أمرك الله
تعالى أن تحكم فيهم([24]).
وعند البعض:
أنه «صلى الله عليه وآله» أرسل لسعد بعد نزول بني قريظة
على حكم رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأتي به محمولاً
على حمار، وهو مضنى من جرحه فقال له: أشر علي في هؤلاء.
فقال:
إني أعلم أن الله قد أمَّرك
فيهم بأمر أنت فاعله.
قال:
أجل، ولكن أشر علي فيهم.
فقال:
لو وليت أمرهم لقتلت مقاتلتهم، وسبيت ذراريهم، وقسمت
أموالهم.
فقال:
والذي نفسي
بيده، لقد أشرت فيهم بالذي أمرني الله به([25]).
ونقول:
إننا هنا نسجل الأمور التالية:
ونحن
وإن كنا نجد المؤرخين يذكرون:
أن سعداً قد حكم بقتل الرجال، وسبي من عداهم، إلا أننا
نشك في شمولية ذلك للجميع، لا سيما ونحن نجد ابن الجوزي يقول: «فحكم
فيهم: أن يقتل كل من حزَّب
عليه، وتغنم المواشي الخ..»([26]).
ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿..فَرِيقاً
تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً﴾([27]).
وسيأتي حين الكلام حول عدد المقتولين منهم، بعض ما يفيد في توضيح هذا
الأمر، إن شاء الله تعالى.
وبذلك يتضح:
أنه يُشك
كثيراً في صحة ما يذكرونه، من أنهم كانوا يتأكدون من بلوغ البالغ منهم
بالنظر إلى مؤتزره، فإن كان قد أنبت قُتل وإلا تُرك.
إلا أن يقال:
إن ذلك لا ينافي قول ابن الجوزي الآنف الذكر، لأن ذلك
قد كان منهم بالنسبة إلى خصوص من حزَّب
على المسلمين.
يفهم من كلام البخاري وغيره:
أن حكم سعد بن معاذ
إنما كان في مسجد النبي «صلى الله عليه وآله»، حيث قال: فلما دنا من
المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم، وخيركم.
فقال:
هؤلاء نزلوا على حكمك.
قال:
تقتل مقاتلتهم، وتسبي ذراريهم.
قال:
قضيت بحكم الله،
وربما قال:
بحكم الملك([28]).
ونقول:
إننا نسجل على هذا النص:
أولاً:
إننا
نجد الآخرين بعد ذكرهم حكم سعد، وقول النبي «صلى الله عليه وآله» له
تلك العبارة، يقولون: «ثم رجع إلى المدينة»([29]).
وهذا يعني:
أن حكم سعد فيهم كان خارج المدينة ولعله كان في المسجد
المعروف بمسجد بني قريظة.
ثانياً:
إن
خيمة رفيدة التي كان سعد يداوى فيها إنما كانت في المسجد النبوي نفسه،
كما تقدم في النص السابق لقضية تحكيم سعد..
إذن..
فما معنى أن يؤتى بسعد على حمار، وطأوا له عليه بوسادة
إلى آخر ما تقدم؟
ثالثاً:
لماذا خصص قول النبي «صلى الله عليه وآله»: قوموا إلى
سيدكم وخيركم بالأنصار؟!
مع أن الأنصار يقولون: إنه «صلى الله عليه وآله» قد عم
بهذه الكلمة!! إلا أن يكون قد صعب على هؤلاء أن يكون سعد خيراً
منهم، أو سيداً
لهم بما فيهم بعض الصحابة الذين يحبونهم، ويتولونهم.
قد ذكرت النصوص المتقدمة وغيرها:
أن اليهود هم
الذين اقترحوا تحكيم سعد بن معاذ([30])
وأن النبي «صلى الله عليه وآله» قال لسعد: هؤلاء نزلوا على حكمك([31]).
وفي نص آخر:
نزلوا على حكم
سعد بن معاذ([32])
وأبوا أن ينزلوا على حكم النبي «صلى الله عليه وآله» فنزلوا على داء([33]).
لكن نصوصاً أخرى تفيد:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» هو الذي حكَّم
سعداً
فيهم، وأن هذا كان قراراً
مباشراً
منه «صلى الله عليه وآله».
وقد تقدم في النص المذكور آنفاً:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد قال للأوس: أما ترضون
أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم؟
قالوا:
بلى.
قال:
فذلك إلى سعد بن معاذ.
ومعنى هذا:
أنه «صلى الله عليه وآله» كان هو المبادر لتحكيم سعد..
ويدل على ذلك أيضاً:
ما رواه مسلم، قال: فقاتلهم رسول الله «صلى الله عليه
وآله». فنزلوا على حكم رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فرد رسول الله
«صلى الله عليه وآله» الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ.
قال:
فإني أحكم فيهم
أن
الخ..([34]).
ويقول نص آخر:
فحصرهم حتى نزلوا على حكمه «صلى الله عليه وآله»([35]).
ونرجح:
أن يكون النبي
«صلى الله عليه وآله» قد قبل منهم أن يختاروا من أصحابه من شاؤوا
فاختاروا سعد بن معاذ سيد الأوس. فقبل رسول الله «صلى الله عليه وآله»
ذلك منهم([36]).
وكان سبب
امتناعهم عن قبول حكم رسول الله «صلى الله عليه وآله» هو مشورة أبي
لبابة([37])
كما تقدم.
فجاء التعبير تارة بنزولهم على حكم رسول الله وأخرى على
حكم سعد، لأنهم إنما نزلوا على حكم سعد برضى
من رسول الله «صلى الله عليه وآله».
وأما خطاب النبي «صلى الله عليه وآله» للأوس،
فلعله كان قبل أن يعرفوا بنتيجة المفاوضة مع بني قريظة.
وقد
ذكر النص المتقدم:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال: قوموا إلى سيدكم.
وزاد في بعض المصادر([38])
قوله:
«فأنزلوه».
قال ابن الديبع:
فقام
المهاجرون([39]).
لكن غيره يقول:
«أما
المهاجرون من قريش فيقولون: إنما أراد رسول الله «صلى الله عليه وآله»
الأنصار، والأنصار يقولون: قد عم بها المسلمين»([40]).
وهذا النص يعطينا صورة عن رفض مهاجري قريش وإبائهم عن
أن يكون هذا الرجل الأنصاري العظيم له امتياز عليهم. ولا أقل من أنه
يشير إلى حالة من الاستعلاء الخفي عن أن يكون للأنصار ما يعتزون به في
مقابل المهاجرين.
كما أن أولئك الذين يريدون تعزيز موقف بعض المهاجرين
الذين يمثلون لهم رموزاً
دينية أو غيرها قد ادعوا ما هو أبعد من ذلك، فقالوا:
إنما أمَّر
رسول الله «صلى الله عليه وآله» الأنصار بل خصوص الأوس بذلك([41]).
ونرى أن الأنصار كانوا في هذه القضية بالذات أكثر
إنصافاً،
وأقرب إلى الحق فيما يرتبط بفهم مداليل الكلام ومراميه، أو هكذا يخيل
لنا الآن.
لا سيما إذا عرفنا أن مهاجري قريش بالذات، دون غيرهم من
سائر المهاجرين، هم الذين يهتمون أكثر من غيرهم برفض هذا الأمر.
الأمر الذي يعطينا:
أنهم يشعرون أنه يعنيهم أكثر من غيرهم.
كما أن هذا:
قد يشير إلى أن غيرهم لا يشاركهم الرأي فيما يرتبط بفهم
المدلول الحقيقي لأمر الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله».
على أننا نريد أن نلفت النظر هنا:
إلى التضحيات الجسام، التي قدمها الأنصار للمهاجرين. بل
وحتى في هذه الغزوة بالذات، فإن سعد بن معاذ الشهيد نفسه قد حكم بأن
تكون دور بني قريظة للمهاجرين دون الأنصار.
هذا..
ولا نجد مبرراً
لرفض المهاجرين سيادة سعد بن معاذ عليهم سوى الحسد، والإحساس
بالتفوق والتميز عن الآخرين على أساس غير إسلامي، ولا إنساني مقبول،
لأن المهاجرين يعتبرون أنفسهم عدنانيين، وأهل يثرب قحطانيون، وكان معظم
المهاجرين من قريش، وهم سدنة للكعبة، ومن أهل مكة، وهم أيضاً قوم
وعشيرة رسول الله «صلى الله عليه وآله».
وبذلك يتضح السبب:
في رفضهم قبول أي امتياز لزعيم الأنصار عليهم. وهو منطق
مرفوض من وجهة نظر إسلامية وإنسانية وإيمانية وكانت كلمات النبي واضحة
الشمول لهم فإننا لم نجد في خطابه «صلى الله عليه وآله» ما يبرر هذا
الاختلاف.
فقد خاطب الحاضرين عنده، والجالسين معه بخطاب واحد عام،
ليس فيه أية دلالة على التخصيص بفريق دون فريق. إذ لو وجدت هذه الدلالة
لم يكن ثمة اختلاف، أو تردد في المقصود.
وهذا يعني:
أن مبررات هذا الاختلاف خارجة عن دلالة اللفظ، وهي محض
اجتهاد تمليه أجواء معينة لدى هذا الفريق أو ذاك.
ملاحظة:
إن سيادة سعد هذه لا تشمل أولئك الذين أخبر الله ورسوله
عن مقامهم وسيادتهم ووجوب طاعتهم على الناس كلهم، مثل علي «عليه
السلام».
فإن خروجهم عن دائرة رسول الله «صلى الله عليه وآله» مفروغ عنه ومعروف
للناس الذين حضروا وسمعوا.
وقد
حاول البعض:
أن يجد في نفس الكلام قرينة أو دلالة يقوي بها رأي
المهاجرين، فقال: «قوموا: الخطاب للأنصار، وقيل: للحاضرين
منهم ومن المهاجرين، إلى سيدكم: هذا يقوي القول الأول، لأنه كان سيد
الأنصار»([42]).
ولكنها محاولة فاشلة:
فإنها لو صحت، فإن المناسب حينئذٍ أن يكون الخطاب لخصوص
الأوس،
لأنه سيدهم دون الخزرج أيضاً.
وقد
قلنا:
إن نفس الاختلاف في المراد يشير إلى أنه حين تكلم «صلى
الله عليه وآله» بهذه الكلمة لم يكن يمكن استفادة التخصيص من أية إشارة
أو لفتة منه.
ولو كان ثمة اختلاف في الفهم في تلك اللحظة لاستفهموا
منه «صلى الله عليه وآله». ولو أن أحداً تخلف عن القيام، وسكت النبي
«صلى الله عليه وآله» عنه، لاحتج المتخلف بسكوته «صلى الله عليه وآله»
عنه.
ومن الغريب حقاً:
أن نجد البعض يحاول أن يقف إلى جانب مهاجري قريش، ويقوي
من حجتهم بطريقة تبدو وكأنها علمية منصفة، مع أنها أبعد ما تكون عن
الإنصاف.
يقول:
«هذا القيام ليس للتعظيم، لما صح عن النبي عليه الصلاة
والسلام قال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضهم بعضاً، بل كان
على سبيل الإعانة على النزول لكونه وجعاً.
ولو كان المراد منه قيام التوقير لقال: قوموا لسيدكم»([43]).
وهو استدلال لا يصح:
لأن المراد من قوله: «قوموا إلى سيدكم» هو القيام لأجل
تلقيه، إكراماً
له وإجلالاً.
وهذا هو مراد الشيخ أبي حامد بقوله:
القيام مكروه
على سبيل الإعظام، لا على سبيل الإكرام، وفي لفظ سيدكم إشعار لتكريمه([44]).
وقال الطيبي:
«لا يلزم من كونه ليس للتعظيم أن لا يكون للإكرام،
وما اعتل به من الفرق بين إلى واللام ضعيف، لأن إلى في هذا المقام أفخم
من اللام، كأنه قيل: قوموا وامشوا إليه، تلقياً
وإكراماً.
وهذا مأخوذ من ترتيب الحكم على الوصف المناسب، المشعر
بالعلية، فإن قوله: «سيدكم» علة للقيام. وذلك لكونه شريفاً،
عالي
القدر»([45]).
وهو كلام جيد ومقبول.
وقد حاول البعض أن يرد على مزعمة:
أنه «صلى الله
عليه وآله» أمرهم بالقيام لسعد من أجل أن يعينوه على النزول، بأنه لو
كان هذا القيام للإعانة لأمر بقيام واحد أو اثنين([46]).
ولكنه رد غير مقبول:
إذ يمكن أن يكون «صلى الله عليه وآله» قد خاطبهم بصيغة
الجمع: «قوموا» وأراد قيام واحد، أو اثنين، فإن ذلك جائز في الاستعمال.
وقد أضافت بعض المصادر المتقدمة كلمة:
«فأنزلوه»([47])
إلى قوله: «قوموا إلى سيدكم». وهي وإن كان ظاهرها: أن القيام للإعانة
على النزول، لكن العلماء
حيث لم يلتفتوا إلى هذه الزيادة، ولا احتجوا بها، فإننا نفهم من ذلك:
أنهم اعتبروها
دخيلة على النص ومقحمة فيه.
هذا بالإضافة إلى:
أن هذه الكلمة لو صحت،
فلا
معنى للاختلاف بين المهاجرين والأنصار في من توجه إليهم
الخطاب حسبما تقدم.
وفي محاولة للتزوير الذكي والخفي، بهدف إفراغ هذه
الكلمة الجليلة في حق سعد من محتواها التكريمي، وليفقد امتيازه بها على
من يحبون ويودون، ادَّعوا: أن القيام لسعد، إنما كان «توقيراً
له بحضرة
المحكوم عليهم، ليكون أبلغ في نفوذ حكمه»([48]).
فاقرأ
واعجب، فما عشت أراك الدهر عجباً، إذ لو صح ذلك لم يكن
بحاجة إلى إعطائه وسام السيادة عليهم.
في مسند أحمد من حديث عائشة:
فلما طلع ـ يعني سعد ـ قال النبي «صلى الله عليه وآله»:
قوموا إلى سيدكم فأنزلوه.
فقال عمر:
السيد الله.
أو قال:
سيدنا الله([49]).
قال العيني:
معناه هو الذي
تحق له السيادة، كأنه كره أن يحمد في وجهه، وأحب التواضع([50]).
ونقول:
لا ندري كيف نفسر هذا الموقف من الخليفة الثاني، فهل هو
اعتراض على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وتخطئة له، لكونه قد فعل
خلاف الأولى، حين مدح ذلك الرجل في وجهه؟ وهل كان عمر أتقى لله سبحانه،
وأكثر مراعاة لأصول التربية الإلهية للناس؟!
أم هو اعتراض على إثباته «صلى الله عليه وآله» السيادة
لغير الله، فيكون «صلى الله عليه وآله» قد ارتكب خطأ عقائدياً
صححه له الخليفة الثاني، على سبيل الإرشاد والتعليم؟!
أما أنه حسد سعداً على هذه الكرامة التي أكرمه الله
تعالى بها، فأظهر ذلك بطريقة غير مباشرة. ونفى عن سعد هذا الوسام بذكاء
ودهاء؟!
إننا نعترف بعجزنا عن معرفة حقيقة القضية، وواقع الأمر.
قال الإمام الحسن «عليه السلام» حين خاض الناس في
أمر
الحكمين، بعد صفين: «وإنما الحكومة فرض الله، وقد حكَّم
رسول الله «صلى الله عليه وآله» سعداً في بني قريظة، فحكم فيهم بحكم
الله لا شك فيه، فنفذ رسول الله حكمه،
ولو خالف ذلك
لم يجزه»([51]).
فالإمام الحسن «عليه السلام» قد ركز على أمرين:
أحدهما:
مشروعية التحكيم، ولكن لا من باب أن الأصل هو الجواز
فيما لم يرد فيه نص، بل من باب النص على المشروعية، وصدور الحكم الإلهي
بذلك فالحكومة ـ كما قال «عليه السلام» ـ فرض الله.
الثاني:
إن تنفيذ الحكم الصادر منوط بأن لا يخالف حكم الله عز
وجل، فالتحكيم ما هو إلا امتداد للحكم الإلهي، ومن مظاهر ومراحل
تنفيذه، وليس في قبال الحكم الإلهي، كما يدعيه الخوارج.
قال النووي:
«فيه جواز التحكيم في أمور المسلمين في أمورهم العظام.
وقد أجمع العلماء عليه، ولم يخالف فيه إلا الخوارج؛
فإنهم
أنكروا
على علي التحكيم، وأقام الحجة عليهم.
وفيه جواز
مصالحة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل، صالح للحكم، أمين على
هذا الأمر. وعليه الحكم بما فيه مصلحة للمسلمين. وإذا حكم بشيء لزم
حكمه ولا يجوز للإمام ولا لهم الرجوع عنه، ولهم الرجوع قبل الحكم»([52]).
ومهما يكن من أمر:
فقد تحدث الشعراء عن هذا التحكيم، وعن مشروعيته،
ونتائجه، فقال القاضي التنوخي في جواب ابن المعتز:
وعـبـت عـليـاً في الحـكـومـة
بينـه وبين ابن حرب في الطغام الأشايب
وقـد حـكـم المـبـعوث يـوم قريظة ولا عيب في فعل الرسول لعايب([53])
وقال السيد الحميري:
قـال الجــوار مـن الـكريـم بمنزل
يجـري لـديــه كـنـسـبـة المتنسب
فـقـضـى بـما رضـي الإلـه لهم بـه بـالحـرب والـقـتـل الملح
المخرب
قـتـل الـكهول وكـل أمـرد منـهم
وسـبـى عـقـائـل بـدنـاً كالربرب
وقـضـى عـقـارهـم لـكـل مهاجر
دون الأُلـى نـصـروا ولم يتهيـب([54])
ويقولون:
إن تحكيم سعد بن معاذ يشير إلى الأمور التالية:
1 ـ
يدل على أن
التعظيم بالقيام جائز لمن يستحق الإكرام، كالعلماء والصلحاء([55]).
قال النووي:
«احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام. قال القاضي:
وليس هذا من القيام المنهي عنه، وإنما ذلك في من يقومون عليه وهو جالس،
ويمثلون قياماً
طول جلوسه.
قلت:
القيام للقادم من أهل الفضل مستحب،
وقد جاء فيه أحاديث،
ولم يصح في النهي عنه شيء صريح. وقد جمعت كل ذلك مع
كلام العلماء في جزء،
وأجبت فيه عما
توهم النهي عنه»([56]).
2 ـ
وفي هذه القضية أيضاً: جواز تحكيم الأفضل
ممن
هو مفضول([57]).
3 ـ
وجواز الاجتهاد مقابل النص،
قالوا:
«وفيها جواز الاجتهاد في زمن النبي «صلى الله عليه وآله». وهي خلافية
في أصول الفقه. والمختار الجواز، سواء كان بحضور النبي «صلى الله عليه
وآله» أم لا.
وإنما استبعد المانع وقوع الاعتماد على الظن مع إمكان
القطع. ولا يضر ذلك، لأنه بالتقرير يصير قطعياً.
وقد ثبت وقوع ذلك بحضرته «صلى الله عليه وآله»، كما في هذه القصة
الخ..»([58]).
ونقول: هذا الكلام لا يصح.
أولاً:
لأن حكم ناقضي العهد، والمحاربين، الذين لهم حالة بني
قريظة ليس ظنياً،
بل هو قطعي، يعرفه كل أحد. وكان سعد يعرفه، كما كان معتب بن قشير،
وحاطب بن أمية، والضحاك بن خليفة يعرفونه.
ولأجل ذلك:
نجد هؤلاء الثلاثة قد صرحوا:
بأن نهاية بني قريظة هي القتل بمجرد أن قال لهم سعد:
إنه سوف يحكم فيهم بحكم الله، ولن تأخذه في الله لومة لائم.
فالحكم الشرعي في هذه المسألة كان معروفاً
لدى الجميع، وليس من قبيل الاجتهاد الظني، كما يزعم
هؤلاء.
ثانياً:
لو سلمنا أن هذه المسألة
إجتهادية،
فالإجتهاد
إنما هو في تحديد موضوع الحكم المعلوم. لا في استنباط الحكم نفسه، فهو
من قبيل حكم السرقة المعلوم لكل أحد. لكن القاضي يبحث عن كون هذا
السارق مستجمعاً
لشرائط قطع اليد في السرقة، التي هي عشرة شرائط،
أم
ليس مستجمعاً
لها.
ومن يراجع المبررات التي استند إليها الأوس الذين طلبوا
الرفق ببني قريظة، يجدها ترتكز على أمور أنشأتها الروح القبلية،
وصنعتها وغذتها مفاهيم الجاهلية، وتعاملت بها وعلى أساسها.
فهم يبررون طلبهم ذاك بالحلف الذي كان بين الأوس وقريظة
ضد الآخرين، وهو حلف لا يأبى
الظلم والتعدي، ويهدف إلى تسجيل النصر في كل من ظروف
الدفاع والتعدي على حد سواء، ولا يبتعد عن أجواء العنجهية
والابتزاز، والدعوة الجاهلية.
مع أن الأوس أنفسهم قد رأوا بأم أعينهم كيف نقض بنو
قريظة عقدهم وعهدهم مع رسول الله «صلى الله عليه وآله». وكان ذلك في
مواجهة سعد بن معاذ الأوسي نفسه قبل أيام. مع ما رافق ذلك من إهانات
لسعد سيدهم، وللنبي، وللمسلمين. كما تقدم توضيحه في غزوة الخندق.
والغريب في الأمور:
أنهم اعتبروا ندم قريظة على ما فرط منهم من نقض العهد
كافياً
لاستحقاقهم الإحسان إليهم..
مع أن هذا الندم لم يأت من خلال قناعات نشأت عندهم بقبح
ما فعلوه، بل هو ندم نشأ عن خوف البوار والدمار، وحين رأوا البأس.
أما حين كان ثمة أمل لديهم بأن تدور الدائرة على النبي
والمسلمين، وذلك حين كان الأحزاب يحاصرونهم، فلم نجد لدى بني قريظة هذا
الندم، ولا لاحظنا أي تردد منهم في أمر إبادة المسلمين، واستئصال
شأفتهم، وخضد شوكتهم.
أما بالنسبة لقول الأوس ـ والمقصود هو بعضهم ـ لرسول
الله «صلى الله عليه وآله»، عن بني قريظة: يا رسول الله، حلفاؤنا دون
الخزرج، فهو يعطينا:
أن قبول النبي «صلى الله عليه وآله» هذا المنطق منهم
معناه:
الإقرار منه «صلى الله عليه وآله» بالتعامل على أساس
المنطق القبلي، وتكريس حالة الانقسام فيما بين الحيين: الأوس، والخزرج،
الذين لم يزل النبي «صلى الله عليه وآله» يعمل على إزالة الحساسيات من
بينهم، بل وصهرهم في بوتقة واحدة هي الإسلام. ثم إن ذلك معناه الفصل
بين قضايا الدين، وقضية القبيلة والفئة.
فالاستجابة لهم على أساس قبول منطق الأوس السابق يعتبر
هدماً
لما بناه، وتخلياً
عن الأسس التي لم يزل ينطلق منها لبناء المجتمع
الإسلامي الناشئ.
وإذا كان سعد قد اعتبر المعترضين على حكمه مجموعة من
المنافقين، فكيف يمكن أن نتوقع من النبي أن يوافقهم على ما يريدون،
ويحقق لهم ما يشتهون؟
وقد أشار البعض أيضاً:
إلى هذه النقطة بالذات، فقال: «يبدو أن الأوس الذين
طلبوا التسامح مع بني قريظة اعتبروها
غير وفية لمحمد، وليس للأوس.
وهذا يعني:
أن أنصار الشفقة كانوا يعتبرون أنفسهم قبل كل شيء أفراد
الأوس وليس أفراد الأمة الإسلامية».
إلى أن قال:
«لقد أدرك رجل بعيد النظر كسعد: أن السماح للعصبية
القبلية بالتغلب على الولاء للإسلام يؤدي للعودة
إلى الحروب الأخوية التي كانت تأمل المدينة بالتخلص منها بمجيء
محمد»([59]).
ومن الأمور التي تؤيد سعداً في اتهامه للمعارضين لحكمه
ـ
بأنهم لا خير فيهم حتى ولو كانوا من الأوس ـ
:
أن هؤلاء الناس قد اتخذوا ابن أبي أمثولة لهم، واعتبروا
أن الحكم على
بني قريظة بما يسوءهم لا يعدو أن يكون عملاً
شريراً
وسيئاً.
ومن الواضح:
أن هذا يشير إلى أن المعارضين للحكم كانوا عدداً
يسيراً
معلوم الحال، لا يوجب اتهامهم بذلك أي خلل في كيان
الأوس، ولا في تماسكهم، ولا يحط من قدر الأوسيين، ولا يُذهب شرف جهادهم
وكفاحهم من أجل هذا الدين.
وقد كان يمكن لنشاط هؤلاء القلة القليلة أن يكون مؤثراً
في إثارة جو من التشكيك والبلبلة لولا حكمة رسول الله
«صلى الله عليه وآله» في معالجة الموقف، حيث إنه «صلى الله عليه وآله»
قد أحرجهم، وتخلص من إلحاحهم، وأبعد شبح الخلاف والاختلاف، وأفقدهم
إمكانية التأثير على السذج والبسطاء حين جعل الحكم إلى رجل أوسي،
وبالذات إلى سعد بن معاذ، الرجل الحكيم والفذ، والسيد المطاع فيهم.
وقد أكد «صلى الله عليه وآله» على سيادة سعد، وعلى
موقعه ومكانته حين قال لهم: قوموا إلى سيدكم.
ويلفت نظرنا هنا قولهم لسعد:
إن رسول الله قد ولاك أمر مواليك لتحسن فيهم.. مع أن
النبي لم يوله أمرهم لذلك، وإنما ليحكم فيهم بالحق.
ويستوقفنا أيضاً قول حاطب بن أمية،
حين أحس من سعد:
أنه ينوي أن يحكم فيهم بحكم الله: ذهب قومي
آخر
الدهر.
وصاح الضحاك:
وا قوماه.
فهم إذن يعتبرون هؤلاء اليهود قومهم وعشيرتهم.
ولعل ابن معاذ قد قصد هؤلاء بالذات، حين قال عن
الكارهين قتل بني قريظة: ما كرهه من الأوس من فيه خير.
ويقول البعض:
«لما رأى
بنو قريظة جيش المسلمين خارت قواهم وأيقنوا بالهلاك
فتبرموا مما ارتكبوه من الغدر، وسألوا الرسول العفو، فأبى
ذلك عليهم،
وشدد الحصار عليهم خمسة وعشرين يوماً حتى نزلوا على حكمه، وسألوا
حلفاءهم الأوس أن يتوسطوا في إطلاقهم الخ..»([60]).
ونقول:
قوله:
إنهم سألوا الرسول العفو، غير دقيق، إذ إنهم قد أبوا في
البداية أن ينزلوا على حكم رسول الله «صلى الله عليه وآله»، الأمر الذي
يشير إلى تشكيكهم في عدالة حكمه ونزاهته. ثم إنه ليس للغادر المحارب أن
يشترط لاستسلامه أي شرط كان. إلا أن باستطاعته أن يلتمس العفو وتخفيف
العقوبة. أو يقدم المبررات لخيانته ولحربه، إن كان يرى أنها تكفي
للإقناع.
إذن..
فلم يسألوا الرسول «صلى الله عليه وآله» العفو، فأبى
ذلك عليهم،
كما يدَّعي
هذا الكاتب.
ومن جهة ثانية:
فإن قوله أخيراً: إنهم نزلوا على حكمه «صلى الله عليه
وآله» ليس دقيقاً،
بل نزلوا على حكم سعد بن معاذ، ورفضوا النزول على حكم رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، الأمر الذي يستبطن إعلاناً
بعدم الثقة بحكمه بالعدل والحق.
فلو أن هذا الكاتب كان أكثر دقة لسلم كلامه من مغبة الإيحاء
بأن الرسول إنسان قاس، لا يعفو عن طالب العفو منه، بل يصر على أن
يقتله، ويسبي النساء والأطفال ويصادر الأموال.
ويبقى هنا سؤال:
أليس هذا الحكم في حق بني قريظة قد جاء قاسياً
وقوياً
إلى درجة ملفتة؟!
ألم يكن من المناسب أن يستفيد بنو قريظة من عفو الإسلام
وصفح النبي الكريم، كما استفاد إخوانهم بنو النضير، وبنو قينقاع من قبل؛
فيكتفي بإجلائهم، وتقسيم أموالهم وأراضيهم؟!
وقد طلبوا هم أنفسهم أن يعاملهم «صلى الله عليه وآله»
بنفس ما عامل به بني النضير من قبل، فرفض طلبهم، وأصر أن ينزلوا على
حكمه.
لقد «انتقد
بعض الكتاب الأوروبيين هذا الحكم ووصفوه بأنه وحشي، وغير إنساني»([61]).
ونحن في مقام التوضيح نلمح إلى الأمور التالية:
أولاً:
إن بني قريظة أنفسهم قد رفضوا النزول على حكم رسول الله
«صلى الله عليه وآله» وقبلوا بالنزول على حكم حليفهم سيد الأوس، سعد بن
معاذ، الأمر الذي يشير إلى أنهم كانوا يسيئون الظن فيما يرتبط بحكم
رسول الله عليهم، ولا يثقون به.
أو فقل:
لا يعتمدون على كرمه وحلمه وسماحته، وإمكانية صفحه
عنهم، رغم أننا لا نستبعد صفحه
«صلى الله عليه وآله» لو أنهم قبلوا بالنزول على حكمه.
ويرون أن سعد بن معاذ وهو من الأوس
ـ
حلفائهم في الجاهلية
ـ
أقرب إلى أن يعاملهم بالصفح والعفو والكرم. وذلك حسب
منطقهم الجاهلي، الجاهل بحقيقة الإسلام، وبما أحدثه في عقلية الناس
ونفوسهم من تغيرات.
ثانياً:
إن جريمة بني قريظة تختلف في حجمها وفي خطورتها على
الإسلام والمسلمين ولا تقاس بجريمة بني النضير وقينقاع.
فقد تحرك بنو قريظة في خط الخيانة، وتوغلوا فيها إلى
درجة أصبح معها أساس الإسلام في خطر أكيد، وشديد، لا سيما وأن ما بنوا
عليه كل مواقفهم هو استئصال شأفة الإسلام وإبادة الوجود الإسلامي بصورة
تامة وحاسمة. ولم يكن بنو النضير ولا بنو قينقاع قد توغلوا في أمر
الخيانة إلى هذا الحد.
مع الإشارة إلى:
أن هدف بني قريظة كان في مستوى الحسابات العملية التي
اعتمدوا عليها قريب المنال، وقد خطوا خطوات عملية لإنجاز هذا المهم،
وللوصول إلى ذلك الهدف، حتى على مستوى التحرك العسكري، الذي يستهدف
تمكين الأحزاب وهم معهم من اجتياح الوجود الإسلامي، وسحقه، وإبادة
المسلمين، خصوصاً النبي وبني هاشم.
أما نقض بني النضير للعهد، فقد بقي في حدود الإصرار على
إظهار التمرد، والغطرسة، والطغيان. فلا يمكن أن تتساوى عقوبة بني قريظة
مع عقوبة بني النضير، وقد طلب القريظيون أن يعاملهم كبني النضير، فرفض
إلا أن ينزلوا على حكمه.
ثالثاً:
لا ريب في أن سكوت النبي على الغطرسة اليهودية، ثم
القبول بترميم العلاقات مع اليهود ولو جزئياً،
لا يبقي مصداقية للعهود والمواثيق، لما يتركه نقضها من سلبيات خطيرة في
هذا المجال، حيث يضعف تأثيرها في ضبط الأمور، وحفظ الكيان العام،
وسيزيد من الاعتماد على القوة المسلحة في حسم الأمور على مستوى
العلاقات فيما بين القوى المتجاورة، وتقل فرص التعايش السلمي بين
الفئات المختلفة في داخل الدولة الواحدة، وحتى على مستوى العلاقات بين
الدول والقوى المختلفة.
أضف إلى ذلك:
أن التساهل في مواجهة الأعمال الخيانية، التي بهذا
الحجم، لسوف يُسَهِّل
على الآخرين خيانات قد تكون أشد خطراً،
وأعظم أثراً
في التدمير، على قاعدة: إن كان ثمة نجاح فهو غاية
المنى، وإن فشلت المحاولة، فلن تكون النتيجة في غاية السوء، وإن كانت
سيئة إلى حد ما، لكنها تسمح بانتظار فرص أكبر، وحظ أوفر.
رابعاً:
إن حكم سعد بن معاذ قد جاء وفق ما يحكم به اليهود
أنفسهم على الآخرين، في حالات هي أدنى من حيث المبررات الموضوعية من
الحالة التي توغل فيها بنو قريظة.
فاليهود هم
الذين كتبوا في توراتهم المحرفة عن المدينة التي يدخلونها عنوة: «وإذا
دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء،
والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة، كل غنيمتها، فتغتنمها لنفسك.
وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك»([62]).
وثمة نصوص أخرى:
أكثر عنفاً
وقسوة في هذا
المجال فراجع هذا الكتاب([63])
فإنها تأمر بإحراق المدينة بكل ما فيها مع بهائمها، وقتل جميع سكانها
بحد السيف، ثم إحراق المدينة بالنار فتكون تلاً
إلى الأبد([64]).
خامساً:
ما الذي يضمن أن لا يعود بنو قريظة إلى نقض العهد،
وتسديد الضربة
القاصمة والقاضية، حين تسنح لهم الفرصة لذلك.
فإن ظروفاً
طارئة خارجة عن حدود اختيارهم أوجبت فشلهم في تنفيذ
خطتهم الجريئة،
وذلك بسبب الخندق، ثم ضربة علي «عليه السلام» القاصمة لقيادة جيش
الشرك، ثم التدخل الإلهي، بإرسال الريح والجنود.
بالإضافة إلى الخلافات التي نشأت بينهم وبين الأحزاب،
ثم ارتحال الأحزاب وغير ذلك من أمور تقدمت.
ولولا ذلك لتحققت أهدافهم الشريرة، وكان الإسلام
والمسلمون في خبر كان.
ولو كان «صلى الله عليه وآله» تركهم، ثم عادوا إلى
الخيانة، فإن استئصالهم والحالة هذه قد يكون أصعب، بل قد يصبح متعذراً،
بعد أن تلقى الناس صفحه عنهم في المرة الأولى بالقبول.
وقد يفهم الكثيرون:
أنه قد جاء عن استحقاق منهم للعفو، وأنه لا يحق له أن
يتخذ في حقهم أي إجراء
آخر.
والذي لا بد من الوقوف عنده هنا، هو حكم سعد بن معاذ
فيهم، الذي جاء موافقاً
للحكم الشرعي الإلهي، ومنسجماً
معه، وذلك هو حكم العقل والفطرة، والضمير الحي،
والوجدان الرضي. وقد ارتضوا هم أنفسهم بحكم سعد مسبقاً،
بل هم الذين اختاروه للحكم.
سادساً:
قال الدكتور إسرائيل ولفنسون:
«وأما المنافقون فقد خفت صوتهم بعد يوم قريظة، ولم نعد
نسمع لهم أعمالاً
وأقوالاً
تناقض إرادة
النبي وأصحابه، كما يفهم ذلك من قبل»([65]).
وبعد..
فهذه هي جريمة القيادات المنحرفة التي تدمر كل شيء، ولا
تشكر النعمة الإلهية على حد قوله تعالى: ﴿أَلَمْ
تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ الله كُفْراً وَأَحَلُّواْ
قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ
الْقَرَارُ﴾([66]).
والغريب في الأمر:
أن نجد بني
قريظة يلجأون إلى سعد بن معاذ نفسه لينقذهم من ورطتهم، وذلك استناداً
إلى الحلف الذي كان بينهم وبين الأوس. مع أنهم هم أنفسهم قد نقضوا
حلفهم مع محمد «صلى الله عليه وآله» وأعلنوا بذلك صراحة لسعد بن معاذ
نفسه، وقالوا له: أكلت (كذا)([67])
أبيك. فهذا النقض للحلف، الذي جرهم لهذا المصير الأسود، قد كان سعد
الطرف الرئيس فيه، وقد حاول معالجته لصالحهم، فلم يفلح، وأظهروا من
الخبث ما جعله يعرفهم على حقيقتهم، ويطمئن لما هم فيه من سوء نية، وخبث
طوية. وها هم اليوم يطالبون سعداً بترميم ما نقضوه من عهد استناداً إلى
عهد آخر.
لكن الفرق بين العهدين كالنار على المنار، وكالشمس في
رابعة النهار، وكان سعد مدركاً
لذلك بلا ريب، فإن عهدهم مع الأوس قد فرضته ظروفهم
الجاهلية، التي لا تتبنى
العدل وقضايا الإنسان والإنسانية أساساً
لما تبرمه من عهود أو تقوم به من تحالفات.
أما عهدهم مع النبي والمسلمين، فقد فرضته قضية الإنسان،
وضرورات الحياة الكريمة، والفاضلة، والحرص على إنسانية الإنسان، وبهدف
إسعاده، وإبعاد الشرور والآفات عنه.
ولا ننسى هنا:
أن تحكيم سعد بن معاذ بالذات له دلالته الهامة، فإن ذلك
من التوفيقات والألطاف الإلهية بالمسلمين،
وذلك من أكثر من جهة.
1 ـ
فمن جهة كان سعد رئيس الأوس ـ بل كان سيد الأوس وغيرهم،
كما أشار إليه النبي «صلى الله عليه وآله» بقوله للصحابة: قوموا إلى
سيدكم.
ونود أن نمعن النظر جيداً
في تأكيد النبي على سيادة سعد هنا، ثم أمره الصحابة بأن
يقوموا لسيدهم.
وإذا حكم الرئيس، فإن الجميع يرى حكمه ملزماً
ونافذاً،
ويراه صادراً
وفق مصلحة مرؤوسيه، ومن خلال حسابات دقيقة، وعن إشراف
تام على مختلف الحيثيات التي ينبغي ملاحظتها في حكم خطير كهذا. فليس
ثمة أية رعونة في اتخاذ القرار، ولا يعاني القرار من جهل في الحيثيات
الموضوعية والاجتماعية والسياسية التي لا بد من أخذها بنظر الاعتبار في
إصدار أي حكم.
2 ـ
ومن جهة ثانية: فإن هذا الحكم من سعد كما أنه أحرق كل
خيوط الأمل لبني قريظة، فإنه أيضاً قد أحرق قلوبهم، لأنه جاء من أولئك
الذين يرون أنهم يهتمون بالحفاظ على حياتهم أكثر من الآخرين.
وإذ بهم يهتمون بالقضاء عليهم ويصرون على ذلك فيحكمون
عليهم بالموت، ثم يشاركون ـ عملاً
ـ في تنفيذ ذلك الحكم الصادر.
فأي فجيعة لهم، أكثر من تلك الفجيعة، التي زادها ألماً
وضرماً،
ما يرونه من رسوخ الدعوة المحمدية، وعلو نجمها، واشتداد شوكتها، واتساع
نفوذها يوماً بعد يوم، بل وساعة بعد ساعة
وأما فيما يرتبط بقبول النبي «صلى الله عليه وآله»
بتحكيم سعد بن معاذ فقد تجلت فيه مرونة وانعطاف جديران بأن يبطلا كل
المبررات التي قد يستفيد منها أولئك الأوسيـون
المتعـاطفون
مـع
حلفـائهم،
لإثـارة
أجـواء
مسمومة حول صوابية القرار النبوي في حق بني قريظة، أو تصويره على أنه
قاس، أو مجحف، أو ما إلى ذلك. ثم هو يسقط الذرائع التي كانوا يتذرعون
بها لممارسة ضغوط على النبي «صلى الله عليه وآله» لمنعه من تنفيذ حكم
الله فيهم.
ثم هو قد ألجم بني قريظة أنفسهم، ووضع حداً
لمحاولاتهم تأليب الرأي العام ضد القرار النبوي،
والاستفادة من سذاجة بعض المسلمين، ومن سوء سريرة البعض الآخر منهم،
خصوصاً أولئك الذين اتهمهم ابن معاذ بعدم الإخلاص في نواياهم، وحتى في
دينهم.
([1])
راجع: المغازي للواقدي ج2 ص509 و 510 وسبل الهدى والرشاد ج5
ص19 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ص32 وإمتاع الأسماع ج1
ص245 وعيون الأثر ج2 ص73 و 74 وطبقات ابن سعد (ط دار صادر) ج2
ص75 والسيرة الحلبية ج2 ص339 و 338 والسيرة النبوية لدحلان ج2
ص16 و 17 والوفا ص695.
([2])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج5 ص22 وتاريخ الخميس ج1 ص497 ونهاية=
= الأرب ص192 والمواهب
اللدنية ج1 ص117 وسيرة مغلطاي ص57 والجامع للقيرواني ص280
وإمتاع الأسماع ج1 ص247.
([3])
السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص251 وراجع: كشف الغمة ج1 ص208 و
209 وعيون الأثر ج2 ص73 والكامل في التاريخ ج2 ص186 والبداية
والنهاية ج4 ص124 وبهجة المحافل ج1 ص274 والمغازي للواقدي ج2
ص512 و 513 وتاريخ الخميس ج1 ص497 ونهاية الأرب ج17 ص192 ووفاء
الوفاء ج1 ص307 و 308 والإكتفاء ج2 ص182 وتاريخ الإسلام (المغازي)
ص261 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص239 وتاريخ الأمم والملوك
ج2 ص250 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص17 والسيرة الحلبية ج2
ص240 والإرشاد للمفيد ص64 و 65 والبحار ج20 ص262 و 263 ومناقب
آل أبي طالب ج1 ص252 وعمدة القاري ج17 ص192 وفتح الباري ج7
ص319.
([4])
السيرة النبوية لابن كثير ج3 ص238 والبداية والنهاية ج4 ص124.
([5])
قالوا: إنها كانت تحت مسيلمة الكذاب، ثم خلف عليها عبد الله بن
عامر بن كريز. دلائل النبوة للبيهقي ج4 ص22 و 23.
([6])
تاريخ الخميس ج1 ص497.
([7])
بهجة المحافل ج1 ص274.
([8])
إمتاع الأسماع ج1 ص247.
([9])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص22.
([10])
راجع: مجمع الزوائد ج6 ص138 عن الطبراني. وراجع: سبل الهدى
والرشاد ج5 ص20 وتاريخ الإسلام (المغازي) ص259 والسيرة الحلبية
ج2 ص338 ومجمع البيان ج2 ص352 والبحار ج20 ص211 ودلائل النبوة
للبيهقي ج4 ص19 وعمدة القاري ج17 ص192 وفتح الباري ج7 ص319.
([11])
المغازي للواقدي ج2 ص512 و 513 وإمتاع الأسماع ج1 ص247 وسبل
الهدى والرشاد ج5 ص22 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص17 وعمدة
القاري ج17 ص192 وفتح الباري ج7 ص319 والسيرة الحلبية ج2 ص340
وراجع: تاريخ الخميس ج1 ص497.
([12])
راجع الهامش ما قبل السابق.
([13])
تاريخ الخميس ج1 ص497.
([14])
مجمع الزوائد ج6 ص138 عن الطبراني وراجع: تاريخ الإسلام
(المغازي) ص259 والسيرة الحلبية ج2 ص338 ومجمع البيان ج2 ص352
والبحار ج20 ص211 ودلائل النبوة ج4 ص19.
([15])
المغازي للواقدي ج2 ص512 و 513 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص22
وراجع: إمتاع الأسماع ج1 ص247.
([16])
المغازي للواقدي ج2 ص512 و 513.
([17])
البحار ج20 ص238 وتفسير القمي ج2 ص192.
([18])
المغازي ج2 ص514 وسبل
الهدى والرشاد ج5 ص24 وإمتاع الأسماع ج1 ص248.
([19])
المغازي للواقدي ج2 ص512 و 513 وإمتاع الأسماع ج1 ص247 وسبل
الهدى والرشاد ج5 ص22 و 23.
([20])
راجع النص المتقدم في: المغازي للواقدي ج2 ص510 ـ 512 وإمتاع
الأسماع ج1 ص246. وتجد هذه النصوص إجمالا أو تفصيلاً في
المصادر التالية: عيون الأثر ج2 ص72 و 73 وسبل الهدى والرشاد
ج5 ص19 ـ 21 والسيرة الحلبية ج2 ص339 و 338 والسيرة النبوية
لدحلان ج2 ص16 و 17 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص249 و 259 ووفاء
الوفاء ج1 ص307 وطبقات ابن سعد (ط دار صادر) ج2 ص75 ـ 77
ونهاية الأرب ج17 ص190 و 191 والإكتفاء ج2 ص181 و 182 وتاريخ
الإسلام (المغازي) ص259 و 260 و 266 والجامع للقيرواني ص280
وتاريخ ابن الوردي ج1 ص162 و 163 والوفا ص695 وحدائق الأنوار
ج2 ص597. وتاريخ الخميس ج1 ص496 و 497 وشرح بهجة المحافل ج1
ص274 والكامل في التاريخ ج2 ص186. وسيرة مغلطاي ص57 والمواهب
اللدنية ج1 ص117 والتنبيه والإشراف ص217 ومناقب آل أبي طالب (ط
دار الأضواء) ج1 ص251 و 252 ومجمع الزوائد ج6 ص137 ـ 139
والبداية والنهاية ج4 ص121 و 122 والسيرة النبوية لابن هشام ج3
ص250 و 251 و 249 وجوامع السيرة النبوية ص154 و 155 والثقات ج1
ص277 و 276 وتفسير القمي ج2 ص190 والبحار ج20 ص234 و 235
ودلائل النبوة للبيهقي ج4 ص18 ـ 22 والسيرة النبوية لابن كثير
ج3 ص233 وتاريخ
اليعقوبي ج2 ص52 وإعلام الوري ص93 و 94. وراجع = = في قوله
«صلى
الله عليه وآله»:
قوموا إلى سيدكم بالإضافة إلى ما تقدم: البداية والنهاية،
والسيرة النبوية لابن كثير، والحلبية، وتاريخ الخميس، وجوامع
السيرة النبوية، والسيرة النبوية لدحلان، وراجع: مرآة الجنان
ج1 ص10 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص31 وصحيح البخاري
ج3 ص23 وج2 ص200 وج4 كتاب الاستئذان، باب قول النبي
«صلى
الله عليه وآله»:
قوموا إلى سيدكم، وشرح النووي على صحيح مسلم ج12 ص93 ومسند أبي
عوانة ج4 ص172.
([21])
راجع: عيون الأثر ج2 ص72 وتاريخ الخميس ج1 ص497 والسيرة
الحلبية ج2 ص339 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص17 وطبقات ابن سعد
ج2 ص78 وفتح الباري ج7 ص319 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص21 ووفاء
الوفاء ج308 وراجع: تاريخ اليعقوبي ج2 ص52 ولم يذكر اعتراض
الأنصار. والبحار ج20 ص212 ومجمع البيان ج8 ص352.
([22])
مجمع البيان ج8 ص352 وبحار الأنوار ج20 ص212.
([23])
المصنف للصنعاني ج5 ص370 و 371 ودلائل النبوة لأبي نعيم ص438.
وليس فيه: أنهم أبوا النزول على حكم رسول الله
«صلى
الله عليه وآله».
([24])
فتح الباري 7 ص317 والمواهب اللدنية ج1 ص117 وسبل الهدى
والرشاد ج5 ص21 وتاريخ الخميس ج1 ص497 والسيرة الحلبية ج2 ص339
والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص17.
([25])
تاريخ الإسلام (المغازي) ص266.
([27])
الآية 26 من سورة الأحزاب.
([28])
صحيح البخاري ج3 ص23 وج 2 ص200 وراجع: صحيح مسلم ج5 ص160
وتاريخ الإسلام (المغازي) ص258 و 259.
([29])
تاريخ ابن الوردي ج1 ص163 وغير ذلك من مصادر.
([30])
راجع النص السابق، والهوامش المذكورة لبيان مصادره.
([31])
صحيح البخاري ج3 ص23 وج 2 ص200 وصحيح مسلم ج5 ص160 وتاريخ
الإسلام للذهبي (المغازي) ص258 و 259.
([32])
راجع: البداية والنهاية ج4 ص122 و 127 وفتح الباري ج7 ص318
ونهاية الأرب ج17 ص192 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص52.
([33])
المصنف للصنعاني ج5 ص370 و 371.
([34])
صحيح مسلم ج5 ص161 ومجمع الزوائد ج6 ص139 والسيرة النبوية لابن
كثير ج3 ص244 و 235.
وراجع: مسند أبي عوانة ج4 ص167 و 169 و 171 ودلائل النبوة
للبيهقي ج4 ص26 والبداية والنهاية ج4 ص122 وفتح الباري ج7 ص318
و 319 وأنساب الأشراف ج1 ص347.
([35])
أنساب الأشراف ج1 ص347 وتاريخ ابن الوردي ج1 ص162 وراجع: تاريخ
الإسلام (المغازي) ص266 والوفا ص695 وسبل الهدى والرشاد ج5
ص19.
([36])
راجع: السيرة النبوية لابن كثير ج3 ص244 والسيرة النبوية
لدحلان ج2 ص16 والسيرة الحلبية ج2 ص338 .
وراجع: دلائل النبوة للبيهقي ج4 ص19 و 22 ومجمع الزوائد ج6
ص138 عن الطبراني، وسبل الهدى والرشاد ج5 ص20 وتاريخ الإسلام
(المغازي) ص259 ومجمع البيان ج2 ص352 والبحار ج20 ص211.
([37])
فتح الباري ج7 ص318 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص246 والبداية
والنهاية ج4 ص124 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص244.
([38])
البداية والنهاية ج4 ص124 ومجمع الزوائد ج6 ص138 وسبل الهدى ج5
ص20 عن أحمد وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص249 والسيرة الحلبية ج2
ص338 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص237.
([39])
حدائق الأنوار ج2 ص597.
([40])
راجع: تاريخ ابن الوردي ج1
ص162 و 163 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص249 ـ 251. وتاريخ
الخميس ج1 ص496 و 497 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص20 و 21
والإكتفاء ج2 ص182 ونهاية الأرب ج17 ص191 والمواهب اللدنية ج1
ص116 و 117 وحدائق الأنوار ج2 ص597 والبداية والنهاية ج4 = =
ص121 و 122. وراجع: السيرة الحلبية ج2 ص338 و 339 وراجع بهجة
المحافل ج1 ص274 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص233.
([41])
راجع: فتح الباري ج11 ص43 وراجع: هامش صحيح مسلم ج5 ص160.
([42])
هامش صحيح مسلم ج5 ص160.
([43])
راجع: هامش صحيح مسلم ج5 ص160 وراجع: فتح الباري ج11 ص44 وعمدة
القاري ج22 ص252 وإرشاد الساري ج9 ص153 وأشار إلى ذلك في
البداية والنهاية ج4 ص127 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص244.
([44])
هامش صحيح مسلم ج5 ص160 وراجع: فتح الباري ج11 ص41 و 44.
([45])
فتح الباري ج11 ص44 وعمدة القاري ج22 ص252 وإرشاد الساري ج9
ص153.
([46])
هامش صحيح مسلم ج5 ص160 وراجع: فتح الباري ج11 ص41 و 46.
([47])
راجع: البداية والنهاية ج4 ص124 ومجمع الزوائد ج6 ص138 وسبل
الهدى والرشاد ج5 ص20 عن أحمد، وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص249
والسيرة الحلبية ج2 ص338 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص237.
([48])
السيرة النبوية لابن كثير ج3 ص244 والبداية والنهاية ج4 ص127.
([49])
عمدة القاري ج17 ص191 ومسند أحمد ج6 ص142 وفتح الباري ج7 ص317
ومجمع الزوائد ج6 ص138 والبداية والنهاية ج4 ص124 والسيرة
الحلبية ج2 ص338 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص237 وقال: هذا
الحديث إسناده جيد، وله شواهد من وجوه كثيرة.
([50])
عمدة القاري ج17 ص191.
([51])
مناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء) ج3 ص223.
([52])
شرح النووي على صحيح مسلم ج12 ص92.
([53])
مناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء) ج1 ص330.
([54])
ديوان السيد الحميري ص110
ومناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء) ج1 ص252.
([55])
هامش صحيح مسلم ج5 ص160 وراجع: فتح الباري ج11 ص41 و 46 وشرح
النووي على صحيح مسلم ج12 ص93 وشرح بهجة المحافل ج1 ص274.
([56])
شرح النووي على صحيح مسلم ج12 ص93 وفتح الباري ج11 ص41 و 46.
([57])
المواهب اللدنية ج1 ص117 وتاريخ الخميس ج1 ص497.
([58])
المواهب اللدنية ج1 ص117
وراجع: تاريخ الخميس ج1 ص497 إلى قوله: أم لا.
([59])
محمد في المدينة ص328.
([60])
تاريخ الإسلام السياسي ج1 ص120.
([61])
محمد في المدينة ص327.
([62])
سفر التثنية، الإصحاح العشرون، الفقرة رقم 13 و 14.
([63])
الجزء الرابع ص317 الطبعة الرابعة، وفي الجزء الخامس ص208 من
هذه الطبعة.
([64])
وراجع أيضاً سفر العدد. الإصلاح 31 الفقرة 7 ـ 10 و 13 ـ 16.
([65])
السيرة النبوية للندوي ص300 عن: اليهود في بلاد العرب ص155.
([66])
الآيتان 28 و 29 من سورة إبراهيم.
([67])
كلمة فاحشة يقبح التصريح بها، تراجع في المصادر.
|