|
أحداث غزوة المريسيع
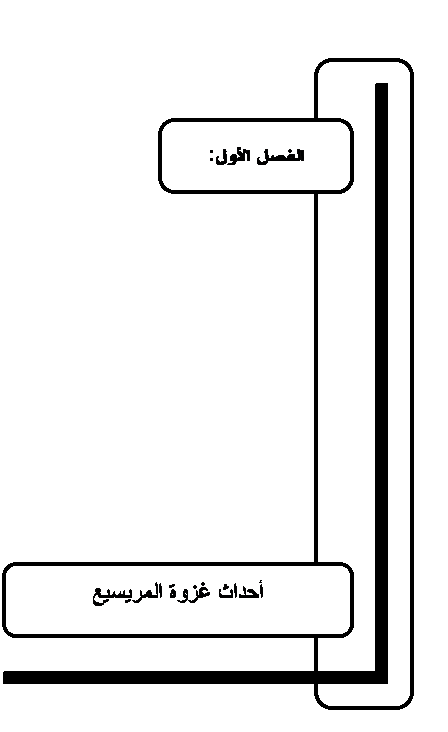
تاريخ
غزوة المريسيع:
يقول عدد من
المؤرخين:
إن غزوة
المريسيع كانت لليلتين خلتا من شعبان سنة خمس للهجرة([1]).
وقيل:
إنها كانت في
السنة السادسة وقيل: إن عليه أكثر المحدثين([2]).
وعن ابن عقبة:
كانت في السنة
الرابعة، كما في البخاري، وعليه جرى النووي في الروضة([3]).
لكن في مغازي ابن عقبة:
سنة خمس([4]).
ونقول:
إننا نرى:
أن غزوة المريسيع قد كانت بعد الخندق،
وقد تحدثنا عن هذا الأمر في كتابنا حديث الإفك الطبعة
الأولى ص 96 ـ 106،
ونحن نورد هنا بعض ما ذكرناه هناك مع بعض التقليم
والتطعيم.
فنقول:
قلنا: في الجزء السابق:
إن الصحيح هو أن غزوة الخندق كانت سنة أربع. ولا ريب في
تأخر المريسيع عنها، وذلك لما يلي:
أولاً:
إن فرض الحجاب
ـ كما ذكره المؤرخون الأثبات ـ قد كان في سنة خمس في ذي القعدة([5])
وغزوة المريسيع كانت في شعبان. وفيها كان حديث الإفك
الذي كان بعد فرض الحجاب فلا بد أن يكون هو شعبان الذي بعد الحجاب في
السنة السادسة،
لأن النبي
«صلى الله عليه وآله» قد تزوج بزينب بنت جحش، التي هي سبب الحجاب بعد
بني قريظة([6]).
وقد تقدم في حديث عائشة، وأم سلمة ما يدل صراحة:
على أن الحجاب
لم يكن فرض يوم الخندق، وبني قريظة([7]).
ثانياً:
قد ثبت أن ابن عمر قد شهد المريسيع، ومن المعلوم: أن
أول مشاهده
الخندق كما تقدم في
الجزء
الحادي
عشر
من هذا الكتاب، فهذا يعني: أن المريسيع كانت بعد
الخندق.
ومحاولة العسقلاني دعوى:
أن من الممكن أن يكون قد حضرها دون أن يشترك في القتال،
كما ثبت عن جابر: أنه كان يمنح أصحابه الماء في بدر، مع
الاتفاق على عدم شهوده بدراً([8])،
هذه المحاولة فاشلة، إذ إن التعبير بشهد غزوة كذا، أو أول مشاهده
غزوة كـذا
إنما يعني شهود قتال، لا مجرد
الحضور، فإرادة معنى آخر لهـذا
التعبير يحتاج إلى قرينة ودلالة، وهي مفقودة هنا.
ويقولون:
إن المريسيع
ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع يومان (وعند ابن سعد نحو يوم) وبين
الفرع والمدينة ثمانية برد([9]).
وقيل:
إن المريسيع
تقع على ستة مراحل من المدينة أو سبعة، مما يلي مكة من ناحية الجحفة([10]).
ويقال لها:
غزوة محارب،
وقيل: محارب غيرها([11]).
وتسمى هذه
الغزوة أيضاً بغزوة بني المصطلق، وهم بطن من خزاعة([12]).
وسبب هذه الغزوة أن بني المصطلق كانوا ينزلون على بئر
يقال لها:
المريسيع، من ناحية قديد إلى الساحل،
وكان سيدهم الحارث بن أبي ضرار دعا قومه ومن قدر عليه
من العرب إلى حرب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأجابوه، وتجمعوا،
وابتاعوا خيلاً
وسلاحاً،
وتهيأوا للحرب، والمسير معه.
فبلغ رسول الله «صلى الله عليه وآله» الخبر، فأرسل
بريدة بن الحصيب الأسلمي ليتحقق ذلك،
فأتاهم، ولقي الحارث، وكلمه،
مظهراً
أنه منهم، وقد سمع بجمعهم، ويريد الانضمام بقومه، ومن
أطاعه إليهم، وعرف منهم صدق ما بلغهم عنهم. فرجع إلى رسول الله فأخبره
بأنهم يريدون الحرب.
وفي الحلبية:
أن بريدة استأذن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن
يقول ما يتخلص به من شرهم، فأذن له.
فلما أخبر بريدة النبي «صلى الله عليه وآله» بصحة ما
بلغه دعا «صلى الله عليه وآله» الناس فأسرعوا الخروج، فخرج معه سبع
مئة، ومعهم ثلاثون فرساً
منها عشرة للمهاجرين وعشرون للأنصار وقد عد منهم
الواقدي في مغازيه جماعة الفرسان على النحو التالي:
«كان علي «عليه السلام» فارساً،
وأبو بكر، وعمر، وعثمان والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد
الله، والمقداد بن عمرو.
وفي الأنصار:
سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وأبو عيسى بن جبر، وقتادة
بن النعمان، وعويم بن ساعدة، ومعن بن عدي، وسعد بن زيد الأشهلي،
والحارث بن حزمة، ومعاذ بن جبل، وأبو قتادة، وأبي بن كعب، والحباب بن
المنذر، وزيادة بن لبيد، وفروة بن عمرو، ومعاذ بن رفاعة. انتهى.
وخرج لليلتين من شعبان،
وخرجت معهم عائشة، وأم سلمة.
وكان معه «صلى الله عليه وآله» فرسان، هما:
لزاز،
وظرب.
واستخلف على
المدينة زيد بن حارثة([13]).
وجعل عمر بن
الخطاب على مقدمة الجيش([14]).
هكذا زعموا.
وزاد في بعض المصادر قوله:
وخرج بشر كثير لم يخرجوا في غزاة قبلها.
وعبارة ابن سعد:
«خرج معه بشر كثير من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قط
مثلها»([15]).
قال الواقدي:
ليس بهم رغبة
في الجهاد، إلا أن يصيبوا من عرض الدنيا، وقرب عليهم السفر([16]).
وسار رسول الله «صلى الله عليه وآله» باتجاه بني
المصطلق، وأصاب عيناً
للمشركين كان وجهه الحارث ليأتيه بخبر رسول الله؛
فسأله «صلى الله عليه وآله» عنهم، فلم يذكر من أمرهم
شيئاً،
فعرض «صلى الله عليه وآله» عليه الإسلام فأبى،
فأمر عمر بن الخطاب بضرب عنقه، فضرب عنقه([17]).
وبلغ الحارث مسير رسول الله «صلى الله عليه وآله»
إليهم، وبلغه أيضاً قتل عينه، الذي كان يأتيه بخبر رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، فسيء
بذلك هو ومن معه. وخافوا خوفاً
شديداً،
وتفرق الأعراب الذين كانوا معه فما بقي أحد سواهم.
وانتهى رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى المريسيع،
وضرب عليه
قبة من أدم، وتهيأوا للقتال، وصفَّ
رسول الله «صلى الله عليه وآله» أصحابه.
قال الحلبي والذهبي:
«وأمر «صلى
الله عليه وآله» عمر بن الخطاب أن يقول لهم: قولوا: لا إله إلا الله
تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم فأبوا»([18]).
ودفع راية المهاجرين إلى أبي بكر، وراية الأنصار إلى
سعد بن عبادة، وقال الواقدي وخواند أمير: كان لواء المشركين مع صفوان
الشامي.
وكان شعار المسلمين يومئذٍ:
يا منصور أمت أمت.
قال الذهبي والواقدي:
«فكان أول من رمى رجل منهم بسهم»،
فتراموا بالنبل ساعة،
ثم أمر النبي «صلى الله عليه وآله» أصحابه فحملوا على
الكفار حملة واحدة، فقتل منهم عشرة، وأسر الباقون، ولم يفلت منهم أحد،
وسبوا الرجال والنساء والذراري، وأخذوا الشاء والنعم،
وكانت الإبل ألفي بعير، والشاء خمسة آلاف والسبي مائتي
أهل بيت.
قال الحلبي:
واستعمل على الغنائم شقران ولم يقتل من المسلمين إلا
رجل واحد وبعث «صلى الله عليه وآله» أبا نضلة (أو أبا ثعلبة) (أو أبا
نملة) الطائي بشيراً
إلى المدينة بفتح المريسيع.
ولما رجع المسلمون بالسبي قدم أهاليهم فافتدوهم. كذا ذكـره
ابن إسحاق([19]).
السبي
والغنائم:
قالوا:
«وأمر بالأسارى
فكتفوا، واستعمل عليهم بريدة بن الحصيب، وأمر بالغنائم
فجمعت، واستعمل عليها شقران مولاه.
وجمع الذرية ناحية، واستعمل على مقسم الخمس وسهمان
المسلمين محمية بن جزء.
واقتسم السبي وفرق، وصار في أيدي الرجال وقسم النعم
والشاء، فعدلت الجزور بعشر من الغنم، وبيعت الرثة في من يزيد.
وأسهم للفرس سهمين، ولصاحبه سهماً، وللراجل سهماً.
وكانت الإبل ألفي بعير، والشاء خمسة آلاف شاة.
وكان السبي ماءتي أهل بيت،
وصارت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في سهم ثابت بن
قيس بن شماس، وابن عم له؛
فكاتباها على تسع أواق من ذهب،
فسألت رسول الله «صلى الله عليه وآله» في كتابتها،
وأداها عنها، وتزوجها،
وكانت جارية حلوة.
ويقال:
جعل صداقها عتق كل أسير من بني المصطلق.
ويقال:
جعل صداقها عتق أسير من بني المصطلق.
ويقال:
جعل صداقها عتق أربعين من قومها.
وكان السبي منهم من منَّ
عليه رسول الله «صلى الله عليه وآله» بغير فداء، ومنهم
من افتدي،
فافتديت المرأة والذرية بست فرائض.
وقدموا المدينة ببعض السبي، فقدم عليهم أهلوهم فافتدوهم،
فلم تبق امرأة
من بني المصطلق إلا رجعت إلى قومها. وهو الثبت عندنا»([20]).
وقال الواقدي:
أخرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» الخمس من جميع
المغنم،
وجعل على خمس المسلمين محمية بن جزء الزبيدي. «وكان
يجمع الأخماس،
وكانت الصدقات على حدتها، أهل الفيء
بمعزل عن الصدقة،
وأهل الصدقة بمعزل عن الفيء.
وكان يعطي الصدقة اليتيم، والمسكين، والضعيف، فإذا
احتلم اليتيم نقل إلى الفيء،
وأخرج من الصدقة، ووجب عليه الجهاد، فإن كره الجهاد وأباه لم يعط من
الصدقة شيئاً، وخلوا بينه وبين أن يكتسب لنفسه.
وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا يمنع سائلاً،
فأتاه رجلان يسألانه من الخمس، فقال: إن شئتما أعطيتكما منه، ولا حظ فيها
لغني، ولا لقوي مكتسب الخ..»([21]).
وقال البلاذري:
«وقسم رسول الله «صلى الله عليه وآله» الغنائم،
وأخذ صفيه قبل القسم،
ثم جزَّأ
الغنائم خمسة أجزاء، ثم أقرع عليها، ولم يتخير، فأخرج الخمس، وأخذ سهمه
مع المسلمين لنفسه، وفرسه، وكان له «صلى الله عليه وآله» صفي من
المغنم، حضر أو غاب، قبل الخمس: عبد، أو أمة، أو سيف، أو درع»([22]).
قالوا:
وكانت غيبته
«صلى الله عليه وآله» في هذه الغزوة ثمانية وعشرين يوماً([23])،
وقدم المدينة
لهلال شهر رمضان المبارك([24]).
وقبل أن نواصل الحديث عن سيرة الرسول الأكرم «صلى الله
عليه وآله»، نتوقف قليلاً
لنسجل بعض ما نرى ضرورة لتسجيله هنا، فنقول:
وإذا كانت غزوة المريسيع قد أسفرت عن نتائج حاسمة إلى
هذا الحد، فإن ذلك يعتبر ضربة موفقة لنفوذ وكبرياء قريش لأنها قد جاءت
في منطقة كانت إلى الأمس القريب تقع في نطاق النفوذ المكي إن صح
التعبير، ولا أقل من أنها من المواقع المتقدمة في خط الدفاع عن طاغوت
الشرك المتمثل في قريش ومن تبعها، وتحالف معها، في مكة وغيرها، مما قرب
منها أو بعد عنها.
ومن جهة ثانية:
فإن الطريقة التي تمت بها هذه الضربة القاسية، والنتائج
التي أسفرت عنها، لا بد أن تقنع الكثيرين بأن الوقوف في وجه هذا المد
العارم يكاد يلحق بالممتنعات.
وحتى قريش ومكة عموماً
فإنها قد باتت مقتنعة تماماً
أنها وحدها غير قادرة على تحقيق نصر حاسم.
وقضية أُحد
هي الشاهد الحي على ذلك، خصوصاً،
وأن أحداً قد أظهرت وجود بعض الثغرات في الصف الإسلامي، وتهيأت الفرصة
لتسديد ضربة موجعة،
ولكنها رغم ذلك أيضاً قد عجزت عن تحقيق أي شيء، بل هي
قد خسرت بالإضافة إلى معنوياتها وروحياتها خسرت سمعتها وكثيراً
من تحالفاتها.
وتأتي هذه الضربات المتلاحقة هنا وهناك، فتزيد من قوة
الإسلام والمسلمين، وتمعن في إضعاف شوكة الشرك والمشركين:
فكان لا بد من استباق الأمور، والتحرك بسرعة قبل أن
يبلغ السيل الزبى،
وقبل أن يستكمل المسلمون قضم أطراف مكة، وحتى أطراف الجزيرة، أو ما هو
أبعد من ذلك ثم تصل النوبة إلى مكة نفسها، فيبتلعها التيار العارم،
ويضربها الزلزال الهادم، حيث تتهاوى صروح الشرك والفساد ويعم السلام
والهدى جميع العباد في مختلف الأصقاع والبلاد.
وكان قرار مكة هو أنه لا بد أن يشاركها الآخرون في مهمة
القضاء على الإسلام والمسلمين.
وعمدت إلى حشد أكبر عدد ممكن من الناس من القبائل التي
كان لها تحالفات معها،
أو ممن شاركوها في التآمر والبغي. ومن شأن الكثرة أن
تقوي الضعيف، وتشجع الجبان، وتؤمن الخائف.
فكان أن تحزبت الأحزاب مع قريش، وقصدوا محمداً
والمسلمين في عقر ديارهم، ليجتثوهم من الجذور، ويقتلعوا منهم الآثار،
ويخلوا منهم الديار.
فكانت غزوة الأحزاب «الخندق»،
والتي انتهت هي الأخرى بالفشل الذريع. وطاشت السهام،
وخابت الآمال،
وانقلب السحر على الساحر.
وكان فشل قريش في هذه المرة فشلاً
ذريعاً،
ومنيت بهزيمة لا تشبه سائر الهزائم فقد كانت هزيمة مرة وحقيقية وأبدية
أيضاً.
وهذا بالذات هو ما يميِّز
غزوة الخندق عما سواها، حتى قال النبي «صلى
الله عليه وآله»
بعدها: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا». كما سنرى.
ذكر فيما تقدم:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد استخلف على المدينة
زيد بن حارثة «رحمه الله».
ويمكن المناقشة في ذلك بما يلي:
أولاً:
سيأتي إن شاء
الله: أن البعض يقول: إن زيد بن حارثة كان على الميمنة في المريسيع([25])،
فكيف يكون خليفة له «صلى الله عليه وآله» على المدينة؟
ثانياً:
إن ابن هشام يقول: إنه «صلى الله عليه وآله» قد استخلف
على المدينة أبا ذر الغفاري.
ويقول آخرون:
استخلف عليها
نميلة بن عبد الله الليثي([26]).
وقيل:
أبا رهم
الغفاري([27]).
إلا أن تكون كلمة أبي رهم تصحيف لكلمة أبي ذر. ولم نجد أبا رهم الغفاري
في جملة الصحابة المترجم لهم.
وهذا الذي ذكر من تولية أبي ذر على المدينة في غياب
رسول الله «صلى الله عليه وآله»:
لا يتلاءم مع ما رووه عن النبي «صلى الله عليه وآله»،
أنه قال لأبي ذر: إني أراك ضعيفاً،
فلا تأمرن على اثنين([28]).
إلا أن يقال:
إنه
«صلى الله عليه وآله» إنما قال له ذلك بعد أن اختبره، وعرف أمره..
على أن هذا الحديث:
تفوح منه رائحة الكيد السياسي لأبي ذر، الذي كان الشوكة
الجارحة في أعين الذين يمسكون بزمام السلطة وقد جعلوا مال الله دولاً،
واتخذوا عباد الله خولاً،
وقد كان له معهم مواقف جريئة فضحتهم، وأظهرت زيفهم للأجيال كلها.
وتقدم أن الواقفي:
قد ذكر سعد بن معاذ في جملة من كان معه فرس في حرب
المريسيع، مع أننا قدمنا ما يثبت أن المريسيع كانت بعد بني قريظة، التي
مات فيها سعد بن معاذ.
ولا ندري هل نصدق أم نكذّب
ما زعمه الدياربكري:
من أن عمر بن الخطاب كان على مقدمة الجيش.
إذ من الواضح:
أن من يكون على المقدمة يكون هو رمز صمود الجيش، ولا بد
أن يكون من الفرسان المعروفين الذين يرهب جانبهم، ولم يكن عمر بن
الخطاب ذلك الرجل الذي له هذه الخصوصية، بل هو في ما يناقضها أذكر
وأشهر. وقد أكد هو نفسه هذه الحقيقة بفراره المتعاقب في حرب أُحد،
والأحزاب، وربما في قريظة أيضاً، مع عدم ظهور أي تميز له في حرب بدر،
بل لعل الذين كانوا إذا حمي الوطيس يلوذون برسول الله «صلى الله عليه
وآله» في بدر ـ كما قال علي «عليه السلام» ـ هم:
هذا الرجل وأمثاله.
وعدا عن ذلك كله:
فإنه لم يظهر منه ولم يؤثر عنه إلى حين موت رسول الله
«صلى الله عليه وآله» أية مواقف حربية شجاعة، بل عُرف
عنه الفرار في كل مواطن الشدة والحرج في الحروب كلها. وليس ما جرى في
خيبر وحنين عن أسماعنا ببعيد.
وكلمة أخيرة نقولها هنا وهي:
إنه
إذا كان المقصود من جعله على المقدمة هو جعله أميراً
على الجيش كله، فذلك مما لا ريب في كونه كذباً،
بعد أن قدمنا ما يدل بصورة قاطعة على أن علياً أمير المؤمنين «عليه
السلام»
كان صاحب لواء وراية رسول الله «صلى الله عليه وآله» في المواطن كلها،
باستثناء غزوة تبوك، فراجع أوائل غزوة أحد، من هذا الكتاب.
وقد تقدم أيضاً:
أن راية المهاجرين كانت مع أبي بكر، ونحن نشك في ذلك،
لما يلي:
1 ـ
قال خواند أمير: إنه «صلى الله عليه وآله» أعطى راية
المهاجرين لعلي «عليه
السلام»،
وراية الأنصار لسعد بن عبادة، وعمر على المقدمة، وعلى الميمنة زيد بن
حارثة، وعلى الميسرة عكاشة بن محصن([29]).
لكن قد تقدم:
أن البعض
يقول: إنه «صلى الله عليه وآله» استخلف زيد بن حارثة على المدينة في
هذه الغزوة([30]).
2 ـ
ذكر البعض: أن
راية المهاجرين كانت مع عمار بن ياسر([31]).
أما لواء الجيش ورايته فقد كانتا مع علي أمير المؤمنين،
حسبما أثبتناه في غزوتي بدر وأحد.
وأما عن المقتولين من بني المصطلق، فقد:
قالوا:
إن علياً «عليه السلام» قتل منهم رجلين: مالكاً،
وابنه([32]).
وقتل أبو قتادة:
صاحب لواء المشركين،
وكان الفتح([33]).
ونحن لا نستطيع تأكيد ذلك أو نفيه، فالمغرضون يهمهم
التلاعب في بعض الأمور، وقد يكون هذا منها.
أما بالنسبة لعدد الأسرى والسبايا فقد تقدم أنهم مئتا
أهل بيت.
وبعضهم يقول:
إنهم كانوا
سبع مئة([34]).
وقيل:
إنهم كانوا
أكثر من سبع مئة، وكانت برة بنت الحارث سيد بني المصطلق في السبي([35]).
وليس ثمة تناف بين هذه النصوص فإن مئتي أهل بيت قد يكون
عددهم سبع مئة، أو أكثر من ذلك.
ويقولون:
«كان رجل منهم ممن أسلم وحسن إسلامه يقول: لقد كنا نرى
رجالاً
بيضاً
على خيل بلق،
ما كنا نراهم قبل ولا بعد»([36]).
ولكننا لا نكاد نطمئن لصحة هذه المقولة، التي لم ينقلها
إلا رجل مجهول الهوية منهم، رغم كثرة من أسلم منهم: فكيف تفرد ذلك
الرجل بنقل هذا الأمر الغريب الذي تتوفر الدواعي على نقله من كل من
يراه؟! حتى ولو كان لم يتشرف بدين الإسلام أصلاً؟!
وبعد..
فما هو وجه الحاجة لقتال الملائكة هنا، مع أنه لم يكن
ثمة داع إلى ذلك. حيث لم يتعرض المسلمون لخطر يستدعي التدخل الإلهي،
بواسطة الإمداد
بالملائكة؟!
إلا أن يقال:
إن ذلك يجعل المشركين يندفعون إلى الإسلام، ولا يشتدون
في حربهم ضد المسلمين.
وقد تقدم:
أنه لم يقتل من المسلمين سوى رجل واحد.
والظاهر:
أنه هشام بن صبابة (ضبابة)، الذي قاتل مع المسلمين في
المريسيع حتى أمعن. وكان قد أسلم، وقد قتله أنصاري اسمه أوس، من بني
عمرو بن عوف، كما يقوله الواقدي بطريق الخطأ، قتله وهو يرى أنه من
العدو،
وكان هشام قد
خرج في طلب العدو، فرجع في ريح شديدة وعجاج([37]).
ثم قدم أخوه مقيس في سنة خمس من مكة، متظاهراً
بالإسلام، وطلب دية أخيه هشام، فأقام عند رسول الله غير
كثير، ثم عدا على قاتل أخيه، فقتله، ثم رجع إلى مكة مرتداً([38])
فأهدر
النبي «صلى الله عليه وآله» دمه فقتل يوم فتح مكة([39]).
وهو متعلق بأستار الكعبة.
ونزل فيه قوله تعالى: ﴿وَمَن
يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ﴾([40])
الآية([41]).
ونقول:
1 ـ
قولهم: إن قدوم مقيس بن ضبابة كان سنة خمس، لا ينسجم مع
ما قدمناه من أن غزوة المريسيع كانت سنة ست، وبعدها كان قدوم مقيس، إذا
فرض أن أخاه الذي جاء لأخذ ثأره وديته قد قتل بعد المريسيع.
2 ـ
يقول النص الآنف الذكر: أن آية سورة النساء: ﴿وَمَن
يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً﴾،
قد نزلت في مقيس هذا.
مع أنهم يقولون:
إن هذه الآية
قد نزلت بعد المريسيع بعدة سنوات، فقد روي عن ابن عباس: أنها في آخر ما
نزل، ولم ينسخها شيء حتى قبض رسول الله «صلى الله عليه وآله»([42])؛
فكيف تأخر نزولها عن الحدث الذي نزلت من أجله؟
3 ـ
قد ذكر النص المتقدم أن أنصارياً
اسمه أوس وهو من بني عمرو بن عوف قد قتل هشاماً،
لكونه خرج في طلب العدو، فرجع في ريح شديدة وعجاج، فقتله مقيس بأخيه،
مع أن نصاً آخر يقول: إن النبي «صلى الله عليه وآله» بعث مقيساً
ومعه رجل من بني فهر في حاجة للنبي «صلى الله عليه
وآله»، فاحتمل مقيس الفهري فضرب به الأرض، ورضخ رأسه بين حجرين.
وأوضح نص آخر ذلك فقال:
إن الفهري كان
رجلاً من قريش، أرسله النبي «صلى الله عليه وآله» معه إلى بني النجار
بقباء([43]).
4 ـ
وهذا النص يقول: إن رجلاً اسمه أوس قد قتل هشاماً،
فقدم أخوه من مكة مطالباً
بديته.
مع أن نصاً آخر يقول:
إن هذين الأخوين قد أسلما وكانا بالمدينة، فوجد مقيس
أخاه قتيلاً
في بني النجار، فانطلق إلى النبي «صلى الله عليه وآله»
فأخبره بذلك.
فأرسل رسول الله «صلى الله عليه وآله» معه رجلاً من بني
فهر من قريش، إلى بني النجار بقباء، أن ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن
علمتم ذلك، وإلا فادفعوا إليه الدية.
فقالوا:
إنهم لا يعلمون له قاتلاً،
وأعطوه ديته مئة من الإبل.
فرجع هو
والفهري
من قباء، فوسوس إليه الشيطان بأن يقتل الفهري، فتغفله، فرماه بصخرة
فشدخه، وارتد عن الإسلام، وركب بعيراً،
وساق بقيتها إلى مكة،
وقال في ذلك شعراً([44]).
ولعل هذه الرواية هي الأرجح بملاحظة ما ذكرناه آنفاً في
تاريخ نزول آية سورة النساء.
قد تقدم قولهم:
إنه «صلى الله عليه وآله» أعطى من الغنائم للفرس سهمين
ولصاحبه سهماً،
فيصير المجموع ثلاثة أسهم،
وأعطى للراجل سهماً
واحداً.
وقد تحدثنا في غنائم بني قريظة:
أن هذا لا يصح، وأن الصحيح هو أنه «صلى الله عليه وآله»
كان يعطي للفارس سهمين، أحدهما له والآخر لفرسه،
فراجع ما ذكرناه هناك إن شئت.
وفي الصحيحين وغيرهما، عن ابن عمر:
أن النبي «صلى
الله عليه وآله» أغار على بني المصطلق، وهم غارون، وأنعامهم تسقى على
الماء، فقتل مقاتلهم، وسبى ذراريهم وهم على الماء([46])،
وكان ابن عمر في الجيش كما ذكره البلاذري.
قالوا:
والأول أثبت([47])
أي أنه لم يغر عليهم وهم غارون.
ولعل سبب كونه هو الأثبت هو عدم صحة ما ذكر من قتل
مقاتلهم، لأن بني المصطلق قد بقوا بعد ذلك على كثرتهم، وانتشارهم، وقتل
مقاتلهم معناه أن لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك.
قد تقدم:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أمر بالأسارى،
فكتفوا، واستعمل عليهم بريدة (رض)، ثم فرق «صلى الله عليه وآله» السبي؛
فصار في أيدي
الناس([48]).
قال الحلبي:
«وفي هذا دليل لقول إمامنا الشافعي (رض) في الجديد:
يجوز استرقاق العرب،
لأن بني المصطلق عرب من خزاعة.
خلافاً لقوله في القديم:
إنهم لا يسترقون لشرفهم،
وقد قال في
الأم: لو أنا نأثم بالتمني لتمنينا أن يكون هكذا، أي عدم استرقاقهم. أي
لا يجوز الرق على عربي»([49]).
ونقول:
إن الشافعي وإن كان قد أصاب حين قال بجواز استرقاق
العرب، خلافاً
لقوله القديم: إلا أنه في كتابه
الأم يعود ليستسلم لمشاعره في التمييز العنصري، الذي
كرسه عمر بن الخطاب في أقواله وتشريعاته حين تمنى عدم استرقاق العرب،
وعدم جواز الرق على عربي، وكأنه لا يعجبه الحكم الإلهي الصائب، ويجد في
نفسه حرجاً
مما قضى الله ورسوله.
قد تقدم:
أنهم يقولون: إن أهالي الأسرى قدموا فافتدوهم، وإن
المرأة والذرية افتدوا بست فرائض، وقدموا المدينة ببعض السبي، فقدم
عليهم أهلوهم فافتدوهم. فلم تبق امرأة من بني المصطلق إلا رجعت إلى
قومها.
مع أنهم يذكرون:
أن جميع بني المصطلق قد أسروا، ولم يفلت منهم أحد حسبما
تقدم.
ونكاد نلمح من خلال تأكيداتهم على إطلاق سراحهم فوراً:
أن البعض لا يرتاح لأسر بني المصطلق الذين هم عرب.
ويزعجه جداً أن تسبى نساؤهم. ولعل
الفقرة الأخيرة المتقدمة:
فلم تبق امرأة من بني المصطلق إلا رجعت إلى قومها، تشير
إلى ذلك الانزعاج، وإلى الحرص على إبعاد شبح استرقاق العرب.
ونعتقد:
أن السبب في ذلك هو سياسـات
الخليفة الثاني تجـاه
العرب، وهـو
القائـل:
ليس على عربي ملـك([50]).
وكـره
أن يصير السبي سنة على العرب([51]).
وقد أعتق سبي اليمن وهن حبالى، وفرق بينهن وبين من اشتراهن([52]).
وأعتق كل مصلٍّ
من سبي العرب،
وأوصى بعتق كل عربي([53]).
وسياسات عمر هذه معروفة عنه.
وقد فصلنا القول فيها في كتابنا:
«سلمان الفارسي في مواجهة التحدي» فليراجعه من أراد.
([1])
قد ذكر هذا القول مستنداً إليه، أو بلفظ قيل، في المصادر
التالية: سيرة مغلطاي ص55 وفتح الباري ج7 ص332 والبدء والتاريخ
ج4 ص214 والسيرة الحلبية ج2 ص278 والجامع للقيرواني ص281
وأنساب الأشراف ج1 ص341 والثقات ج1 ص263 وحبيب السير ج1 ص357
وزاد المعاد ج2 ص112 وطبقات ابن سعد ج2 ص63 وبه جزم الذهبي في
تاريخ الإسلام (المغازي) ص214 والمغازي للواقدي ج1 ص404 ونهاية
الأرب ج17 ص164 والمواهب اللدنية ج1 ص108. وراجع: السيرة
النبوية لابن كثير ج3 ص297 والبداية والنهاية ج4 ص156 والسيرة
النبوية لدحلان ج1 ص266 ودلائل النبوة للبيهقي ج4 ص44 و 45
والإستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج4 ص258 و 260 والإصابة ج4
ص465.
([2])
راجع هذا القول في المصادر التالية: تاريخ مختصر الدول ص95
والسيرة الحلبية ج2 ص279 والجامع للقيرواني ص283 وسيرة مغلطاي
ص55 عن البخاري، والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق 2 ص33 وفتح
الباري ج7 ص332 وبهجة= = المحافل ج1 ص241 عن ابن إسحاق، وقال:
«الخندق
على الأصح سنة أربع»
وشذرات الذهب ج1 ص11 والكامل في التاريخ ج2 ص192 وتاريخ الأمم
والملوك ج2 ص260 وتاريخ ابن الوردي ج1 ص164 والسيرة النبوية
لابن هشام ج3 ص302 ونهاية الأرب ج17 ص164 عن ابن إسحاق
والمواهب اللدنية ج1 ص108 مثله والسيرة النبوية لابن كثير ج3
ص297 والبداية والنهاية ج4 ص156 عن ابن إسحاق أيضاً وكذا في
دلائل النبوة للبيهقي ج4 ص46 والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج4
ص258 والإصابة ج4 ص265.
([3])
راجع: السيرة الحلبية ج2 ص279 وراجع: سيرة مغلطاي ص55 والمواهب
اللدنية ج1 ص108 عن ابن عقبة، وصحيح البخاري ج3 ص24 عنه أيضاً،
والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص197 والبداية والنهاية ج4 ص156
كلاهما عن ابن عقبة، وفتح الباري ج7 ص332.
([4])
السيرة الحلبية ج2 ص279 والمواهب اللدنية ج1 ص108 وبهجة
المحافل ج1 ص241.
([5])
تاريخ الأمم والملوك ج2 ص231 والكامل في التاريخ ج2 ص177
والتنبيه والأشرف ص217 ومروج الذهب ج2 ص289 وطبقات ابن سعد (ط
ليدن) ج2 ق1 ص81 وج 8 ص125 و 126 و 157 وصفة الصفوة ج2 ص46
ووفاء الوفاء ج1 ص310 وفتح الباري ج8 ص351 عن الواقدي وتاريخ
الخميس ج1 ص500 و 501 و 267 ونقله أيضاً عن أسد الغابة
والمنتقى والبداية والنهاية ج4 ص145 عن قتادة، والواقدي، وبعض
أهل المدينة والبيهقي، والسيرة الحلبية ج2 ص293 عن إمتاع
الأسماع عن بعض أهل الأخبار. ثم أشكل عليه بما ورد في حديث
الإفك وسيأتي عدم صحة ذلك.
([6])
البداية والنهاية ج4 ص145.
([7])
حديث عائشة مع مصادره في الجزء الحادي عشر من هذا الكتاب ص83
وحديث أم سلمة تقدم في هذا الجزء في الحديث عن توبة أبي لبابة.
([8])
راجع: فتح الباري ج8 ص360.
([9])
تاريخ الخميس ج1 ص470 وسيرة مغلطاي ص55 والتنبيه والإشراف ص215
وطبقات ابن سعد ج2 ص63.
([10])
الجامع للقيرواني ص283.
([11])
السيرة الحلبية ج2 ص278.
([12])
تاريخ الخميس ج1 ص470.
([13])
راجع ما تقدم في المصادر التالية، وبعض ما فيها يكمل البعض
الآخر: طبقات ابن سعد ج2 ص63 والسيرة النبوية لابن هشام ج3
ص302 303 وتاريخ الخميس ج1 ص470 والسيرة الحلبية ج2 ص278 و 279
وسيرة مغلطاي ص55 ونهاية الأرب ج17 ص164 والمواهب اللدنية ج1
ص108 و 109 والبداية والنهاية ج4 ص156 والسيرة النبوية لابن
كثير ج3 ص297 والكامل في التاريخ ج2 ص192 وتاريخ الأمم والملوك
ج2 ص260 وأنساب الأشراف ج1 ص341 و 342 وحبيب السير ج1 ص357
وزاد المعاد ج2 ص112 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص214 و
215 والمغازي للواقدي ج1 ص404 و 405 والسيرة النبوية لدحلان ج1
ص266 ودلائل النبوة للبيهقي ج4 ص46 و 47 وبهجة المحافل ج1
ص241.
([14])
تاريخ الخميس ج1 ص270.
([15])
زاد المعاد ج2 ص112 والمغازي للواقدي ج2 ص405 والسيرة النبوية
لدحلان ج1 ص266 وطبقات ابن سعد ج2 ص63.
([16])
المغازي للواقدي ج2 ص405.
([17])
السيرة الحلبية ج2 ص279 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص266 وزاد
المعاد ج2 ص112 وفي المغازي للواقدي ج1 ص506 أن عمر هو الذي
قال: «يا
رسول الله، اضرب عنقه. فقدمه فضرب عنقه».
([18])
السيرة الحلبية ج2 ص279 وتاريخ الإسلام (المغازي) ص215.
([19])
النص المتقدم يوجد في: تاريخ الخميس ج1 ص470 ويوجد أيضاً
باختصار أو بتفصيل في المصادر التالية: السيرة الحلبية ج2 ص279
والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق 2 ص33 وتاريخ الأمم والملوك
ج2 ص260 والكامل في التاريخ ج2 ص192 والوفا ص692 وتاريخ ابن
الوردي ج1 ص164 وراجع: أنساب الأشراف ج1 ص341 والثقات ج1 ص263
و 264 والتنبيه والإشراف ص215 وحبيب السير ج1 ص357 وزاد المعاد
ج2 ص112 و 113 وفتح الباري ج7 ص333 ودلائل النبوة للبيهقي ج4
ص46 ـ 48 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص302 و 303 وتاريخ
الإسلام للذهبي (المغازي) ص214 و 215 والمغـازي للواقـدي ج1
ص406 و 407 ونهاية الأرب ج17 ص164 = = و 165 والمواهب اللدنية
ج1 ص109 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص297 و 298 والبداية
والنهاية ج4 ص156 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص266 وبهجة
المحافل ج1 ص241.
([20])
راجع: طبقات ابن سعد ج2 ص64 وراجع: المغازي للواقدي ج1 ص410 و
411 و 412 وفي نهاية الأرب ج17 ص165 ملخص عنه.
([21])
راجع: المغازي للواقدي ج1 ص410 و 411 و 412.
([22])
أنساب الأشراف للبلاذري ج1 ص341 و 342
([23])
تاريخ الخميس ج1 ص473 والسيرة الحلبية ج2 ص291 وسيرة مغلطاي
ص55 والتنبيه والإشراف ص215 وطبقات ابن سعد (ط دار صادر) ج2
ص65 ونهاية الأرب ج17 ص165 والمواهب اللدنية ج1 ص110.
([24])
تاريخ الخميس ج1 ص473 والسيرة الحلبية ج2 ص291 وطبقات ابن سعد
ج2 ص65.
([25])
حبيب السير ج1 ص357.
([26])
راجع: البداية والنهاية ج4 ص156 والسيرة النبوية لابن كثير ج3
ص297 وراجع: السيرة النبوية لدحلان ج1 ص266 والسيرة الحلبية ج2
ص279 وزاد المعاد ج2 ص112 والسيرة النبويـة لابن هشـام ج3 ص302
ونهايـة الأرب = = ج17 ص164 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق
2 ص33 ويظهر منه أنه يرجح ولاية أبي ذر، لكونه ذكر نميلة بلفظ
قيل.
([27])
الجامع للقيرواني ص283.
([28])
أمالي الطوسي (ط سنة 1414 نشر دار الثقافة ـ قم إيران) ص384
المجلس الثالث عشر وصحيح مسلم ج6 ص6 و 7 وسنن النسائي ج6 ص255
وسنن أبي داود، كتاب الوصايا ح 4.
([29])
حبيب السير ج1 ص357.
([30])
أنساب الأشراف ج1 ص342 وثمة مصادر أخرى.
([31])
السيرة الحلبية ج2 ص279 والمغازي للواقدي ج1 ص407 والسيرة
النبوية لابن كثير ج3 ص297 والبداية والنهاية ج4 ص92 وراجع:
السيرة النبوية لدحلان ج1 ص266 ودلائل النبوة للبيهقي ج4 ص48.
([32])
تاريخ الأمم والملوك ج2 ص263 وحبيب السير ج1 ص358 والمغازي
للواقدي ج1 ص407 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص306 والبداية
والنهاية ج4 ص158 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص302 ودلائل
النبوة للبيهقي ج4 ص48.
([33])
حبيب السير ج1 ص358 والمغازي للواقدي ج1 ص407 ودلائل النبوة
للبيهقي ج4 ص48.
([34])
راجع: السيرة النبوية لدحلان ج1 ص266.
([35])
السيرة الحلبية ج2 ص279.
([36])
السيرة الحلبية ج2 ص285 وراجع: حبيب السير ج1 ص358 وتاريخ
الإسلام (المغازي) ص215 والمغازي للواقدي ج2 ص409 ودلائل
النبوة للبيهقي ج4 ص47.
([37])
راجع المصادر التالية: المغازي للواقدي ج1 ص407 و 408 تاريخ
الخميس ج1 ص470 و 471 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص266 والكامل
في التاريخ ج2 ص192 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق 2 ص33
والبداية والنهاية ج4 ص156 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص298
وراجع: الإصابة ج3 ص603.
([38])
تاريخ الخميس ج1 ص473 والسيرة الحلبية ج2 ص285 والكامل في
التاريخ ج2 ص194 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص263 وتاريخ ابن
الوردي ج1 ص164 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص305 و 306
والبداية والنهاية ج4 ص156 و 157 والسيرة النبوية لابن كثير ج3
ص298 والمغازي للواقدي ج1 ص408 وبهجة المحافل ج1 ص241 و 242.
([39])
السيرة الحلبية ج2 ص285 وراجع: تاريخ ابن الوردي ج1 ص164
والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص298 والبداية والنهاية ج4 ص156.
([40])
الآية 93 من سورة النساء.
([41])
بهجة المحافل ج1 ص242 والدر المنثور ج2 ص195.
([42])
الدر المنثور ج2 ص196 عن أحمد، وسعيد بن منصور، والنسائي، وابن
ماجة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم،
والطبراني، والنحاس في ناسخه. وحديث آخر عن ابن عباس أيضاً في
الدر المنثور ج2 ص196 عن عبد بن حميد، والبخاري، وابن جرير.
([43])
راجع: الدر المنثور ج2 ص195 عن ابن جرير، وابن المنذر، وعن ابن
أبي حاتم، والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس، وعن سعيد بن
جبير، وراجع: الإصابة ج3 ص603 وشرح بهجة المحافل ج1 ص242 عن
تفسير البغوي.
([44])
راجع: الدر المنثور ج2 ص195 و 196 عن ابن أبي حاتم، وعن
البيهقي في شعب الإيمان، وراجع: الإصابة ج3 ص603 وشرح بهجة
المحافل ج1 ص242 عن تفسير البغوي.
([45])
غار الرجل: نام في نصف النهار.
([46])
راجع: تاريخ الخميس ج1 ص470 و 471 والمغازي للواقدي ج1 ص407 و
408 والسيرة الحلبية ج2 ص285 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2
ق 2 ص33 والكامل في التاريخ ج2 ص192 وطبقات ابن سعد ج2 ص64
وتاريخ الإسلام (المغازي) ص215 والمواهب اللدنية ج1 ص109
والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص298 والبداية والنهاية ج4 ص156
وفتح الباري ج5 ص23 وصحيح البخاري ج2 ص54 وصحيح مسلم ج5 ص139
وشرح النووي على صحيح مسلم ج12 ص36 وأنساب الأشراف ج1 ص342.
([47])
طبقات ابن سعد ج2 ص64 والمغازي للواقدي ج1 ص407 وراجع: دلائل
النبوة للبيهقي ج4 ص48 وفتح الباري ج7 ص333.
([48])
وراجع أيضاً: السيرة الحلبية ج2 ص280.
([49])
السيرة الحلبية ج2 ص280.
([50])
الأموال ص197 و 198 و 199
والإيضاح ص249 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص549 وسنن البيهقي ج9
ص73 و 74 ونيل الأوطار ج8 ص150 والمسترشد في إمامة علي
«عليه
السلام»
ص115 وقضاء أمير المؤمنين
«عليه
السلام»
ص264 والمصنف للصنعاني ج10 ص103 و 105 وج 7 ص278 و 279 والنظم
الإسلامية ص463.
([51])
تاريخ اليعقوبي ج2 ص139.
([53])
راجع: المصنف للصنعاني ج8 ص380 و 381 وج 9 ص168 وراجع:
المسترشد في إمامة علي
«عليه
السلام»
ص115.
|