بـعـوث وسـرايـــا قـبـل
خــيـبــر
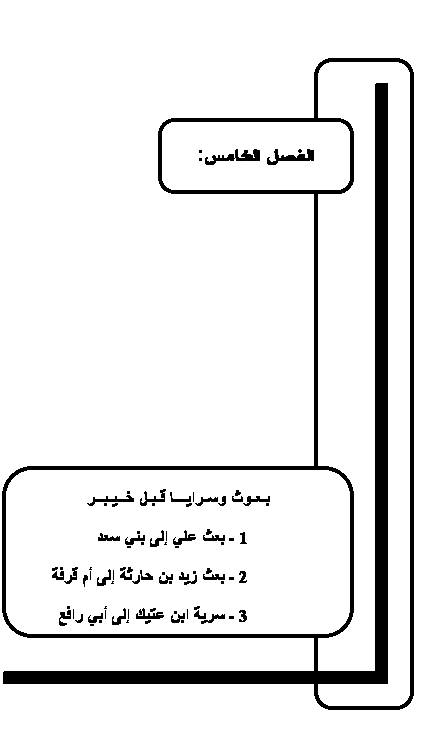
1 ـ بعث
علي  إلى
بني سعد: إلى
بني سعد:
وفي شعبان سنة ست، بعث النبي «صلى الله عليه وآله» علي
بن أبي طالب «عليه السلام» في مائة رجل إلى بني سعد بن بكر بفدك التي
كان بينها وبين المدينة ست ليال، وفي لفظ: ثلاث مراحل.
وسببه:
أنه بلغ رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «أن لهم
جمعاً، يريدون أن يمدوا يهود خيبر، وأن يجعلوا لهم تمر خيبر، فسار
«عليه السلام» إليهم، وفي الطريق أخذوا رجلاً هناك فسألوه، فأقر أنه
عين لبني سعد، وأنه مرسل من قبلهم إلى خيبر، يعرض على يهودها نصرهم
مقابل التمر.. ثم دلهم على موضع تجمعهم.
فسار علي «عليه السلام» بمن معه، فأغاروا عليهم، وهم
غارون بين فـدك وخيبر. فأخـذوا خمس مـائة بعير، وألفي شـاة، وهربت بنو
سعـد بالظعن.
وعزل علي طائفة من الإبل الجياد، صفيّ المغنم لرسول
الله «صلى الله عليه وآله»، وفيها ناقة حلوب قريبة عهد بنتاج، تدعى
الحفيدة، أو الحفدة لسرعة سيرها.
ثم عزل الخمس، وقسم الباقي على السرية.
وقدم بمن معه المدينة، ولم يلقوا كيداً»([1]).
وفي نص آخر:
أنه قبل أن يصل إليهم نزل «عليه السلام» بمن معه محلاً بين خيبر وفدك،
فوجدوا به رجلاً، فسألوه عن القوم، فقال: لا علم لي، فشدوا عليه، فأقر
أنه عين لهم. وقال: أخبركم على أن تؤمنوني، فأمنوه، فدلهم([2]).
ويفهم من النص:
أن أهل خيبر كانوا يتوقعون الحرب فيما بينهم وبين
المسلمين، فكانوا يسعون لإقامة تحالفات مع من يحيط بهم، لضمان أن
يكونوا إلى جانبهم وتقوية لموقعهم ضد المسلمين..
ولكن الحقيقة هي أكثر من ذلك، فإنهم كانوا يجمعون
الرجال استعداداً لمهاجمة المدينة.
إذ يلاحظ:
أن النص يقول: إن لهم جمعاً يريدون أن يمدوا يهود خيبر، فإن هذا معناه:
أنهم يجمعون الرجال للانضمام إلى اليهود، وليكونوا معهم في عملية حربية
مُتَوَقَّعَة كان اليهود يخططون لها..
ولا شك في أن تسديد هذه الضربات لمن يدبرون للحرب من
شأنه أن يفقدهـم قوتهم الاقتصادية، وأن يهزمهم نفسيـاً، ويضعف من درجة
إصرارهم على الحرب، حين يدب اليأس وتثور أمامهم شكوك قوية في قدرتهم
على النيل من هذه القدرة الضاربة، بل قد لا يحصلون إلا على الهزائم،
ولا يحصدون إلا الخيبة، والبوار والخسران.. الأمر الذي لا بد أن يثير
أمامهم ضرورة التفكير في السعي إلى تجنب هذه الحرب التي تتنامى
احتمالات خسرانهم فيها..
وفي شهر رمضان من سنة ست، بعث «صلى الله عليه وآله» زيد
بن حارثة إلى أم قرفة، فاطمة بنت ربيعة بن زيد الفزاري، بناحية وادي
القرى، على سبع ليالٍ من المدينة.
وكان سببها:
أن زيد بن حارثة خرج في تجارة إلى الشام، ومعه بضائع لأصحاب النبي «صلى
الله عليه وآله»، فلما كانوا بوادي القرى لقيه أناس من فزارة، من بني
بدر، فضربوه، وضربوا أصحابه، وظنوا: أنهم قُتلوا، وأخذوا ما كان معهم.
فقدم على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأخبره، ونذر
زيد أن لا يغسل رأسه من جنابة حتى يغزو بني فزارة. فلما برئ من جراحته،
بعثه رسول الله «صلى الله عليه وآله» إليهم، وأمره بأن يكمن بأصحابه
بالنهار، ويسير بهم بالليل، ففعل، وكان معه دليل من بني فزارة.
فعلم
بنو فزارة بالأمر، فراقبوا الطريق. ولكن
الدليل ـ
حين لم
يبق لهم
إلى بني فزارة
سوى مسيرة ليلة ـ ضل الطريق الذي كان بنو فزارة
يرصدونه، بواسطة ناظرٍ لهم، ينظر لهم من رأس جبل مشرف مسيرة يوم في
الصباح، ويقول لهم: اسرحوا، فلا بأس عليكم. وينظر لهم مسيرة ليلة
مساءً، ويقول لهم: ناموا، فلا بأس عليكم. فحين ضل الدليل عن الطريق من
مسيرة ليلة، أوصلهم إلى مقصدهم من طريق آخر.
فحمدوا خطأهم الذي وقعوا فيه، وكمن زيد لهم تلك الليلة.
ثم صبحهم هو وأصحابه، فكبروا، وأحاطوا بالحاضر، وأخذوا أم قرفة، وكانت
ملكة ورئيسة.
وفي المثل يقال:
أمنع وأعز من أم قرفة؛ لأنه كان يعلق في بيتها خمسون
سيفاً لخمسين رجلاً، كلهم لها محرم. وهي زوجة مالك بن حذيفة بن بدر.
وأخذوا ابنتها جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر.
وعمد قيس بن المحسر إلى أم قرفة، وهي عجوز كبيرة،
فقتلها قتلاً عنيفاً، حيث ربط برجليها حبلين، ثم ربطهما بين بعيرين، ثم
زجرهما، فذهبا بها، فقطَّعاها.
وقدم زيد بن حارثة من وجهه ذلك، فقرع باب النبي «صلى
الله عليه وآله»، فقام إليه عرياناً ـ كما يزعمون ـ يجر ثوبه حتى
اعتنقه، وقبَّله، وسأله، فأخبره بما ظفره الله به([3]).
ولقي رسول الله «صلى الله عليه وآله» سلمة بن الأكوع،
فطلب منه الفتاة المذكورة، فأعطاه إياها، فأهداها «صلى الله عليه وآله»
إلى خاله، الذي كان في مكة.
وهناك العديد من النقاط التي لا بد
لنا من الوقوف عندها، للتصحيح تارة، وللتوضيح أخرى، وذلك على النحو
التالي:
ورد في صحيح مسلم وغيره، عن سلمة بن
الأكوع:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» بعث أبا بكر ليشن الغارة
على بني فزارة في وادي القرى.
قال سلمة:
«وخرجت معه، حتى إذا صلينا الصبح، أمرنا، فشنينا
الغارة، فوردنا الماء، فقتل أبو بكر ـ أي جيشه ـ من قَتَل. ورأيت طائفة
فيهم، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فأدركتهم، ورميت بسهم بينهم وبين
الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، وفيهم امرأة ـ أي وهي أم قرفة ـ عليها
قشع من أدم ـ أي فروة ـ خلقة، معها ابنتها من أحسن العرب.
فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر، فنفلني أبو بكر (رض)
ابنتها، فلم أكشف لها ثوباً، فقدمنا المدينة، فلقيني رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، فقال: يا سلمة، هب لي المرأة لله أبوك (أي كان قد وصف
لرسول الله «صلى الله عليه وآله» جمالها).
فقلت:
هي لك يا رسول الله، فبعث بها رسول الله «صلى الله عليه
وآله» إلى مكة، ففدى بها أسرى من المسلمين كانوا في أيدي المشركين»([4]).
ونقول:
إن الكلام مشكوك فيه، فإن ابن إسحاق، وابن سعد، وغيرهما
يقولون: إن أمير السرية التي أخذت فيها أم قرفة، وابنتها، هو زيد بن
حارثة..
واحتمل البعض ـ جمعاً بين الأمرين
ـ:
أن يكون هناك سريتان، اتفق فيهما لسلمة بن الأكوع أن أصاب في كل واحدة
منهما بنتاً لأم قرفة، فأخذهما منه رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
فوهب إحداهما لخاله المكي، وهي السرية التي كان أميرها زيد بن حارثة،
وفدى بالأخرى أسرى المسلمين في مكة، وهي السرية التي كان أبو بكر
أميرها..
ونقول:
إن هذا الوجه وإن كان يحل مشكلة بنت أم قرفة ولكنه لا
يحل مشكلة أم قرفة نفسها، فإنها لا يمكن أن تؤسر وتقتل في كلتا
السريتين.
ولأجل استبعاد التوافق في جميع
الخصوصيات لم يرتض الحلبي ذلك:
إذ من البعيد أن تتعدد أم قرفة، وأن يكون لكل واحدة بنتاً من أحسن
العرب، وأن يأسرهما معاً ابن الأكوع، ثم يطلبهما رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، ويرسلهما أيضاً إلى مكة.
والغريب في الأمر:
أن يترك ابن الأكوع هذه الوليدة، التي هي من أجمل نساء
العرب، فلا يكشف لها ثوباً حتى يرجع بها إلى المدينة، ويطلبها منه
الرسول «صلى الله عليه وآله» مرتين أو ثلاثاً حين لقيه في السوق في
يومين، فهل كان هذا نتيجة ورع من ابن الأكوع؟!
أم أنه كان لا إرب له في النساء؟
أم أن الله صرفه عن ذلك؟!
ولماذا يصرفه الله عن امرأة ستصبح لأحد مشركي مكة؟!..
وذكروا:
أن زيد بن حارثة أمر بقتل أم قرفة، لأنها كانت تسب رسول
الله «صلى الله عليه وآله»([5]).
وذكروا في كيفية قتلها ما تقدم:
من أنهم ربطوا حبلين برجليها، وربطوهما إلى بعيرين، وزجروهما فشقاها
نصفين..
ولكننا لا يمكن أن نصدق ذلك، فقد
ذكروا:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» نهى عن المثلة، إما في غزوة أحد ـ حسبما
تقدم في الحديث عنها ـ وإما في قضية أصحاب اللقاح، حسبما تقدم في سرية
كرز بن جابر..
ولا نرى أن زيداً يرضى بمخالفة رسول الله «صلى الله
عليه وآله» مخالفة صريحة، ولو أنه رضي بذلك فسيجد في جيشه من يعترض
عليه، ويشتكيه إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»..
ولا بد أن يصدر منه «صلى الله عليه وآله» ما يدل على
عدم رضاه بهذا الأمر، إن لم يصل الأمر إلى تأنيب الفاعلين، وتقبيح ما
صدر منهم.
وقد زعم ابن الأكوع:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» طلب منه بنت أم قرفة فوهبها له..
فأرسلها إلى مكة ففدى بها جماعة من المسلمين..
مع أن رواية أخرى تقول:
إنه فدى بها مسلماً واحداً([6]).
ونص آخر يقول:
إنه أرسلها هدية إلى خاله، حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بمكة([7]).
مع أن سلمة قد قال للنبي «صلى الله عليه وآله»
حينما طلب منه الجارية: «رجوت أن أفدي بها امرأة منا في بني فزارة،
فأعاد رسول الله «صلى الله عليه وآله» الكلام في مرتين، أو ثلاثاً،
فعرف أنه «صلى الله عليه وآله» يريدها، فوهبها له..».
وفي نص آخر:
«لقيني رسول الله «صلى الله عليه وآله» في السوق، فقال:
يا سلمة، هب لي المرأة.
فقلت:
يا رسول الله، قد أعجبتني، وما كشفت لها ثوباً.
فسكت، حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله «صلى الله
عليه وآله» في السوق، ولم أكشف لها ثوباً، فقال: يا سلمة هب لي المرأة
لله أبوك.
فقلت:
هي لك يا رسول الله الخ..»([8]).
فما هذا الإصرار من النبي «صلى الله عليه وآله» على
استيهاب جارية يريد صاحبها أن يفدي بها أسيرة من أقاربه؟!
ولماذا يعيد «صلى الله عليه وآله» الكلام مرتين أو
ثلاثاً؟! مع أن فداء الأسير من الأقارب ـ خصوصاً إذا كانت امرأة ـ أولى
من الهدية إلى الخال المقيم على الشرك في مكة.. خصوصاً، وأنه قد كان
بالإمكان أن يهيئ له هدية أخرى تكون من مال نفس المهدي، لا من مال رجل
آخر لم يتنازل عن جاريته إلا بعد الإصرار وربما حياءً وخجلاً من رسول
الله!!
ولا ندري، لماذا أصر «صلى الله عليه وآله» على
الاستيهاب ولم يعرض عليه أن يبيعها له!! ألم يكن هو الأولى والأنسب
بمقامه «صلى الله عليه وآله»؟!
قالوا:
ولما قدم زيد بن
حارثة المدينة جاء إلى بيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» وقرع الباب،
فخرج إليه رسول الله «صلى الله عليه وآله» عرياناً، يجر ثوبه، واعتنقه،
وقبله وسأله، فأخبره بما ظفَّره الله تعالى به([9]).
ونقول:
1 ـ
إنه ليس هناك أي داع لخروج رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى زيد على
هذه الحالة، إذ ليس ثمة ما يشير إلى وجود أمر مستعجل، أو غير عادي
يمنعه من تناول ثوبه، ووضعه على عاتقه في ثوان قليلة.
2 ـ
هل كان «صلى الله عليه وآله» يستقبل، ويقبل ويعانق كل
عائد من الغزو، وخصوصاً بهذه الحرارة؟ وبهذه العجلة؟!
أم أنه كان يعانق ويقبل خصوص المنتصر الذي جاء بالغنائم
والأسرى؟
أم أن هذه خصوصية لزيد بن حارثة دون كل من عداه، حتى
علي بن أبي طالب «عليه السلام»؟! الذي لم يجد هذه المعاملة حينما عاد
من فتح خيبر، أو حينما عاد من قتل عمرو بن عبد ود العامري.. أو في فتح
حنين، أو في حرب بدر، وأحد.. وغير ذلك.
أم أن لهذه الغزوة ـ غزوة أم قرفة ـ خصوصية عنده «صلى
الله عليه وآله»؟ وما هي تلك الخصوصية؟!
3 ـ
إذا كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» أشد حياءً من العذراء في
خدرها، فكيف يخرج إلى زيد بن حارثة عرياناً يجر ثوبه، ثم يعانقه
ويقبِّله..
4 ـ
لماذا كان النبي «صلى الله عليه وآله» عرياناً؟ هل كان يغتسل؟ أو كان
يمارس حقه الطبيعي مع زوجته؟! أو كان بصدد تبديل ملابسه؟!
إن ذلك كله مما يأنف الناس من الإيحاء به للآخرين، أو
أن يسوقهم إلى أن يتصوروه عنهم، فكيف برسول الله «صلى الله عليه
وآله»؟!
وفي شهر رمضان من سنة ست، كانت سرية عبد الله بن عتيك،
لقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي بخيبر.
وقيل:
كان ذلك في ذي الحجة سنة خمس.
وقيل:
في جمادى الآخرة سنة ثلاث.
وكان أبو رافع ممن حزَّب الأحزاب يوم الخندق.
وأرسل «صلى الله عليه وآله» مع ابن عتيك أربعة رجال هم:
عبد الله بن أنيس، وأبو قتادة، وخزاعي بن الأسود، ومسعود بن سنان.
وأمرهم بقتله، فقتلوه([10]).
وقد تقدم
الحديث عن هذه السرية في أوائل الجزء السابع،
فراجع.
قالوا:
وفي شوال من سنة ست، كانت سرية عبد الله بن رواحة إلى
أسير (أو اليسير) بن رزام (أو رازم) اليهودي بخيبر.
وسببها:
أنه لما قَتَل أبو رافع ابنَ أبي الحقيق، أمَّرت يهود
عليها أسيراً هذا، فسار في غطفان وغيرهم يجمع لحرب النبي «صلى الله
عليه وآله»، ليغزوه في عقر داره بزعمه، فبلغ النبي «صلى الله عليه
وآله» ذلك؛ فوجه ابن رواحة في ثلاثة نفر، في شهر رمضان سراً، فسأل عن
خبره، وعربه، ثم رجع، فأخبر النبي «صلى الله عليه وآله» بذلك..
فندب «صلى الله عليه وآله» الناس، فانتدب مع ابن رواحة
ثلاثون رجلاً، فساروا إلى أسير، فقالوا له: إن رسول الله «صلى الله
عليه وآله» بعثنا إليك لتخرج إليه، يستعملك على خيبر، ويحسن إليك،
فاستشار اليهودَ، فأشاروا عليه بعدم الذهاب، وقالوا: ما كان محمد
ليستعمل رجلاً من بني إسرائيل.
قال:
بلى قد ملَّ الحرب.
فخرج معهم في ثلاثين رجلاً من اليهود، مع كل رجل من
المسلمين رديفه من اليهود، فلما كانوا بقرقرة ضربه عبد الله بن أنيس
بالسيف، فسقط عن بعيره، ومالوا على أصحابه فقتلوهم غير رجل،
ولم يصب من المسلمين أحد.
ثم قدموا على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقال: قد
نجاكم الله من القوم الظالمين([11]).
وفي نص آخر:
أن ابن أنيس حمل اليسير على بعيره، فلما صاروا بقرقرة، على ستة أميال
من خيبر، ندم اليسير على مسيره إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
ففطن به ابن أنيس، وهو يريد السيف، فاقتحم به، فضربه بالسيف، فقطع
رجله، وضربه اليسير بمخرش في يده، فأمَّه..
ثم قتلوه مع أصحابه غير رجل واحد أعجزهم هرباً.
فلـما قدم ابن أنيس على رسول الله «صلى الله عليه
وآلـه» تفل على شجته، فلم تقح، ولم تؤذه([12]).
قال:
وقطع لي قطعة من عصاه، فقال: امسك هذه معك، علامة بيني
وبينك يوم القيامة، أعرفك بها، فإنك تأتي يوم القيامة متخصراً.
فلما دفن عبد الله بن أنيس، جعلت معه على جلده، دون
ثيابه([13]).
ونقول:
إننا نسجل هنا النقاط التالية:
إن النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» حين سمع بسعي
أسير بن رزام لجمع غطفان لحربه «صلى الله عليه وآله» لم يبادر إلى
اتخاذ القرار بمهاجمته، بل أرسل من يتثبت له من هذا الأمر.
فلما تأكد له صحته، بادر لتسديد ضربته الوقائية، التي
اقتصرت على تدمير موقع الخطر دون سواه، فعمل على التخلص من خصوص الساعي
في تأليب الناس وجمعهم لحرب المسلمين، وهو ابن رزام نفسه، أما قومه،
فلم يردهم رسول الله «صلى الله عليه وآله».. لاحتمال أن يكون لهم عذرهم
في الانقياد لأسير، والانخداع بما كان يقدمه لهم من مبررات..
وهذا في الحقيقة:
إحسان من النبي «صلى الله عليه وآله» إليهم، وإعطاء الفرصة لهم لإعادة
النظر في الأمور بروية وتعقل.
وهذا يدلنا:
على أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يكن همه إرسال
عصابات القتل، والسلب، والنهب في كل اتجاه، كما ربما يراد الإيحاء به،
أو التسويق له، بل كان يريد دفع شر الأعداء عن أهل الإسلام، حينما يتضح
له بصورة قاطعة أنهم بصدد تسديد ضربتهم للإسلام والمسلمين.
وما ذكروه لأسير بن رزام:
من أن النبي «صلى الله عليه وآله» يريد أن يستعمله على
خيبر، غير ظاهر الوجه، لأن المفروض: أن هذه السرية كانت سنة ست، أي قبل
فتح حصون خيبر بمدة طويلة، إلا إذا كان المقصود هو استعماله على حصون
خيبر، التي كانت بيد اليهود،
وهم لم يكونوا
تحت سيطرة رسول الله
«صلى الله عليه وآله»..
بل كان جعله على خيبر يكون من قبيل تحصيل الحاصل، لأن
المفروض
حسب زعم الرواية:
أن يهود خيبر
قد
أمَّروا أسير بن رزام عليهم بعد قتل ابن أبي الحقيق، فما معنى هذا
العرض؟!
فلعل الصحيح:
هو أن هذه السرية قد كانت بعد فتح خيبر، ويكون اليهود الذين تفرقوا في
البلاد، أو أبقاهم النبي «صلى الله عليه وآله» ليعملوا في أرض خيبر قد
جعلوا عليهم ابن رزام، فسعى لنقض العهد، وجمع الجموع لحرب رسول الله
«صلى الله عليه وآله».. فجاءه ابن رواحة في ثلاثين رجلاً، وكان ما كان،
من تطميعه بالولاية على خيبر من قبل رسول الله «صلى الله عليه وآله»..
ثم انتهى الأمر بقتله، وقتل من معه..
وأبقى «صلى الله عليه وآله» اليهود على أعمالهم في
خيبر؛ لأنهم لم يشاركوا ابن رزام في مساعيه..
ولعل هذا أولى بالقبول من القول:
بأن القضية قد حصلت قبل خيبر، وأن المقصود: أنه «صلى الله عليه وآله»
أراد أن يجعله على غطفان، وغيرها من القبائل الساكنة في تلك المناطق.
أو أنهم أرادوا طمأنته إلى أن النبي «صلى الله عليه
وآله» لا يأبى من أن يكون أميراً على خيبر، بل هو يعطيه أيضاً تفويضاً
بذلك، ويستعمله عليها، فقبل ابن رزام، المتوجس خيفة من الحرب ذلك منهم،
لأنه رأى أنه قد ضمن السلام والسلامة، وأبعد عن مخيلته شبح الحرب،
وكابوسها المخيف والمرعب الذي رأى بعض فصوله في حروب المسلمين مع بني
قينقاع، والنضير، ومع المشركين في بدر وفي أحد.
وقد يهوِّن عليه تصديق هذه المقولة:
ما دخل في وهمه من أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد
ملَّ الحرب([14]).
ولكن في نص آخر قال أسير بن رزام:
«بلى قد مللنا الحرب»([15]).
وهذا يؤيد:
أنه كان يريد أن يتخلص من شبح الحرب، التي ملها الناس
من حوله.
وفي جميع الأحوال نقول:
إن الأرجح هو أن تكون هذه السرية قد حصلت بعد فتح خيبر حسبما أوضحناه.
وذكروا:
أنهم حين ساروا برفقة أسير بن رزام «حمل عبد الله بن أنيس أسير بن رزام
على بعيره، قال عبد الله بن أنيس: فسرنا حتى إذا كنا بقرقرة ثبار, وندم
أسير, وأهوى بيده إلى سيفي, ففطنت له, ودفعت بعيري, وقلت: أغدراً أي
عدو الله؟!
فدنوت منه لأنظر ما يصنع, فتناول سيفي، فغمزت بعيري,
وقلت: هل من رجل ينزل يسوق بنا؟!
فلم ينزل أحد.
فنزلت عن بعيري, فسقت بالقوم, حتى انفرد لي أسير,
فضربته بالسيف, فقطعت مؤخرة الرجل, واندرت عامة فخذه وساقه, وسقط عن
بعيره, وفي يده مخرش الخ..»([16]).
ونقول:
إن هذا النص وأمثاله على درجة كبيرة من الغموض بل هو
موضع شك وريب أيضاً.. فإنه إذا كان ابن أنيس قد فطن لغدر ابن رزام,
وصرح فعله عن غدره هذا, فمن المتوقع أن يحتاط أسير لنفسه,
ويتباعد
عن مرافقه، ويفر منه, وأن يعلن عزمه على العودة من
مسيره
ذاك.
ومن جهة ثانية، نقول:
قد روي
أن قتل أسير كان على يد عبد الله بن رواحة فراجع([17]).
ومن جهة ثالثة، نقول:
كيف لم يسمع أحد من المرافقين, وهم ما يقرب من ستين
رجلاً ما قاله ابن أنيس لرفيقه؟..
وكيف لم يروا ما دار بينهما من تجاذب للسيف؟! وثمة
أسئلة أخرى تحتاج إلى الإجابة هنا، وهي التالية:
كيف صار اليهود ردفاء للمسلمين؟! ألم يكن لدى ذلك
الرئيس المطاع أعني أسير بن رزام ولدى سائر من معه، خيل، أو إبل
يركبونها, حتى احتاجوا إلى الارتداف خلف أناس, كانوا إلى ما قبل ساعة
يسعون لجمع الناس لحربهم؟!.
وهل فكر أولئك اليهود الرؤساء بكيفية رجوعهم من مسيرهم
ذاك؟
وهل سوف يرجعون
سيراً على الأقدام؟ أم
على الخيل؟
أم
على الإبل؟!
وعلى أية خيل أو إبل سيعودون إلى بلادهم؟.
وإذا لم يكن هناك ارتداف وكان كل واحد منهم يركب بعيره
الخاص به, فكيف وصلت يد أسير
بن رزام إلى سيف ابن أنيس؟.
وهل جاء ابن رواحة ومن معه في مهمتهم تلك على الخيل؟ أم
على الإبل؟
فإن كانوا جاؤوا على الخيل، فمن أين جاءت الإبل؟ وإن
كانوا جاؤوا على الإبل, فهل الإبل هي المراكب المناسبة لمهمات كهذه؟.
وعن قصة قتل ابن أبي الحقيق نقول:
قد تقدم:
أن ابن عتيك هو الذي قتله، وقد أصيب ابن عتيك، وبانت
يده فمسح النبي «صلى الله عليه وآله» عليها فلم تكن تعرف من اليد
الأخرى([18]).
د ـ ابن
أنيس
وقصة العصا:
وعن قصة العصا التي أعطاها النبي «صلى الله عليه وآله»
لابن أنيس، نقول:
أولاً:
إن نفس هذه الدعوى قد ادَّعاها ابن أنيس لنفسه في قضية
قتل سفيان بن خالد, حيث زعم:
أنه هو الذي أنجز هذه المهمة، وأعطاه النبي «صلى الله عليه وآله» العصا
ليعرفه بها، ثم جعلها بين كفنه وجلده..
فهل تكررت هذه الواقعة كما يحلو للبعض أن يتخيل؟!
فإن كان الأمر كذلك، فإن نفس الحلبي الشافعي ربما تتشوق
للسؤال عن حكمة تكرير ذلك له, وتخصيصه بهذه المنقبة دون بقية الصحابة.
ثانياً:
لا ندري لماذا يحتاج ابن أنيس إلى علامة تعرّف النبي «صلى الله عليه
وآله» به!! فهل يحتاج النبي حقاً في معرفته لابن أنيس إلى علامة؟!
ولماذا لا يعرفه إذا رآه، من حيث إنه يحفظ صورة وجهه في
ذاكرته؟!
أم أن ذاكرته «صلى الله عليه وآله» سوف تضعف حين يدخله
الله الجنة؟!
وإذا كان الأمر كذلك، فما هي العلامات التي كان «صلى
الله عليه وآله» يعرف بها نساء أصحابه .
إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة التي تحتاج إلى جواب..
قالوا:
وبعث رسول الله «صلى الله عليه وآله» زيد بن حارثة إلى
مدين، فأصاب سبياً من أهل ميناء، وهي السواحل، فبيعوا، ففرقوا بين
الأمهات وأولادهن. فخرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» وهم يبكون،
فقال: ما لهم؟!
فأُخبر خبرهم.
فقال:
لا تبيعوا إلا جميعاً([19]).
ونقول:
إن لنا تحفظاً على هذه السرية، يتلخص في أن «مدين»
هي قرية شعيب، وقد سميت باسم مدين بن إبراهيم، وكان بينها وبين مصر
ثمان مراحل([20]).
ولكنها لم تكن في سلطة فرعون.
وفي معجم ما استعجم:
أنها بلد بالشام، معلوم، تلقاء غزة. وهو منزل جذام،
وشعيب النبي المبعوث إلى أهل مدين أحد بني وائل، من جذام([21]).
والسؤال هو:
كيف استطاع زيد أن يخترق كل تلك التجمعات السكانية،
وكانت كلها معادية له ولدينه، ويقطع هذه المئات من الأميال، ولا يعارضه
أحد من أهل الشرك والكفر، الذين كانوا في تلك المفاوز والقفار النائية،
والتي قد يكون لقيصر الروم حساسية خاصة تجاه غزوها، كما ظهر في قضية
غزوة مؤتة؟
ثم هو يحارب أهل مدين، ويأسر النساء والأطفال من أهل
ميناء، ثم لا ينجد هؤلاء المنكوبين أحد من أهل نحلتهم، ومن هم على
دينهم..
إننا، وإن كنا لا نستطيع أن نعتبر هذه التساؤلات دليلاً
قاطعاً على النفي، ولكنها ترشد إلى لزوم التريث في الحكم القاطع بصحة
هذه النقولات.
إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أمر بعدم التفريق بين
الأم وولدها في البيع. والذي نريد أن نوجه النظر إليه هو:
أن هناك اختلافاً في النظرة إلى هذا الكائن الإنساني،
وفي مبررات تكريمه، أو إهانته، ينشأ عنها اختلاف في التعامل معه في هذا
الاتجاه أو ذاك أيضاً.
فقد تعطى القيمة للإنسان على أساس العصبيات العرقية أو
القومية، وقد تبنى العلاقة بالإنسان على أساس المنفعة والمصلحة، أو
اللذة العاجلة. وما إلى ذلك..
وهناك من يعطي القيمة للإنسان استناداً إلى مجرد كونه
كائناً بشرياً وحسب.
ولكن القيمة في الإسلام تستند إلى عنصرين أساسيين:
أحدهما:
كونه بشراً ونظيراً لك في الخلق.
والثاني:
كونه أخاً لك في الدين.
وفَقْدُ أحد هذين العنصرين لا يلغي الحق الثابت له من
خلال توفر العنصر الآخر.. وإن اختلفت طبيعة هذا الحق الثابت، بالنسبة
إلى كل واحد منهما..
وعلى هذا الأساس نقول:
إنه إذا فقد الالتزام الديني لدى الإنسان، واتجه نحو
ممارسة العدوان، فإن ذلك، وإن كان يسلبه الحق الذي ينشأ عن الالتزام
الديني، ولكنه لا يستطيع أن يسقط الحق الثابت له بالاستناد إلى بشريته،
وإلى نوع خلقته وتكوينه.
فمن يؤسَرُ أو يُسْبى، نتيجة ظروف الصراع معه، من أجل
امتلاك حرية التدين التي يسعى لسلبها منك، وإن كان يحرم الحقوق التي
تثبتها الأخوة الدينية، ولكن الحقوق التي يثبتها له كونه نظيراً في
الخلق، لا يمكن إسقاطها..
ولذلك نهى النبي «صلى الله عليه وآله» عن التفريق بين
الأم وولدها، وفرض أن لا يباعا إلا جميعاً، حسبما تقدم.
ولهذا نقول:
إن نهي النبي «صلى الله عليه وآله» عن هذا التفريق ليس
مجرد قرار شخصي، أو نتيجة توهج عاطفي، بل هو حكم إلهي مستند إلى
مبرراته الموضوعية، وينطلق من طبيعة النظرة إلى الحقوق، وإلى مناشئها..
([1])
تاريخ الخميس ج2 ص12 والسيرة الحلبية ج3 ص182 و 183 وسبل الهدى
والرشاد ج6 ص97 والبحار ج20 ص293 و 376 والطبقات الكبرى ج2
ص90.
([2])
السيرة الحلبية ج3 ص183 والطبقات الكبرى ج2 ص90 وعن عيون الأثر
ج2 ص107 وموسوعة التاريخ الإسلامي ج2 ص573 وراجع: سبل الهدى
والرشاد ج6 ص97.
([3])
تاريخ الخميس ج2 ص12 والسيرة الحلبية ج3 ص179 ـ 181 وسبل الهدى
والرشاد ج6 ص92 و 99 و 100 والطبقات الكبرى ج2 ص91 وعن عيون
الأثر ج2 ص108.
([4])
السيرة الحلبية ج3 ص179 و 180 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص92 و 100
والطبقات الكبرى ج2 ص118 عن عيون الأثر ج2 ص154 ومسند أحمد ج4
ص46 وصحيح مسلم ج5 ص151 وعن سنن أبي داود ج1 ص611 والسنن
الكبرى للبيهقي ج9 ص129 وشرح صحيح مسلم ج12 ص68 وسنن النسائي
ج5 ص202 وصحيح ابن حبان ج11 ص200 والمعجم الكبير للطبراني ج7
ص15 ونصب الراية ج4 ص259 وتاريخ مدينة دمشق ج22 ص92 والبداية
والنهاية ج4 ص251 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص417 وسير
أعلام النبلاء ج1 ص226 وعن تاريخ الأمم والملوك للطبري ج2
ص288.
([5])
السيرة الحلبية ج3 ص180 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص99 وتاريخ
الأمم والملوك ج2 ص287 والبداية والنهاية ج5 ص237 والسيرة
النبوية لابن هشام ج4 ص1035 وعن عيون الأثر ج2 ص103والسيرة
النبوية لابن كثير ج4 ص434.
([6])
السيرة الحلبية ج3 ص180.
([7])
السيرة الحلبية ج3 ص180 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص100 وعن
الإصابة ج4 ص197 و 251 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص71 وعن تاريخ الأمم
والملوك للطبري ج2 ص287 والبـدايـة والنهايـة ج5 ص237 والسيرة
النبـوية لابن = = هشام ج4 ص1035 وعن عيون الأثر ج2
ص104والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص434.
([8])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص92 و 100 ومسند أحمد ج4 ص46 و 51 وصحيح
مسلم ج5 ص151 وسنن أبي داود ج1 ص611 والسنن الكبرى للبيهقي ج9
ص129 وشرح صحيح مسلم ج12 ص68 وسنن النسائي ج5 ص202 وصحيح ابن
حبان ج11 ص200 والمعجم الكبير ج7 ص15 ونصب الراية ج4 ص259
والطبقات الكبرى ج2 ص118 وتاريخ مدينة دمشق ج22 ص92 والبداية
والنهاية ج4 ص251 وعن عيون الأثر ج2 ص154 والسيرة النبوية لابن
كثير ج3 ص417.
([9])
السيرة الحلبية ج3 ص 181 والجامع الصحيح ج4 ص174 وتحفة الأحوذي
ج7 ص434 ونصب الراية ج6 ص154 وكنز العمال ج10 ص569 والجامع
لأحكام القرآن ج15 ص361 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص99 و 427 وعيون
الأثر ص108 والطبقات الكبرى ج2 ص91 وتاريخ مدينة دمشق ج19 ص366
وعن فتح الباري ج11 ص51.
([10])
تاريخ الخميس ج2 ص12 وراجع: مناقب آل أبي طالب ج1 ص173 والبحار
ج20 ص13 و 203 وعن صحيح البخاري ج4 ص23 وج5 ص26 و 28 والسنن
الكبرى للبيهقي ج3 ص222 وج9 ص80 وعن مقدمة فتح الباري ص288 وعن
فتح الباري ج7 ص262 و 263 والمصنف للصنعاني ج5 ص408 ومسند أبي
يعلى ج2 ص204 و 205 ودلائل النبوة ص125 والثقات ج1 ص247 وأسد
الغابة ج1 ص81 و 83 وج4 ص358 وعن الإصابة ج1 ص223 وتاريخ
المدينة ج2 ص465 و 467 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص78 وعن تاريخ الأمم
والملوك للطبري ج2 ص184 والبداية والنهاية ج4 ص156 و 158
وموسوعة التاريخ الإسلامي ج2 ص541 وعن السيرة النبوية لابن
هشام ج3 ص746 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص102 و 104.
([11])
تاريخ الخميس ج2 ص15 والسيرة الحلبية ج3 ص183 وسبل الهدى
والرشاد ج6 ص111 و 112 والطبقات الكبرى ج2 ص92 وموسوعة التاريخ
الإسلامي ج2 ص596 وعن عيون الأثر ج2 ص109.
([12])
تاريخ الخميس ج2 ص15 والسيرة الحلبية ج3 ص183 وسبل الهدى
والرشاد ج6 ص111 و 112 وعن تاريخ الأمم والملوك للطبري ج2 ص406
والبداية والنهاية ج5 ص238 وعن السيرة النبوية لابن هشام ج4
ص1036 وعن عيون الأثر ج2 ص110.
([13])
السيرة الحلبية ج3 ص183 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص112.
([14])
السيرة الحلبية ج3 ص183.
([15])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص111 وموسوعة التاريخ الإسلامي ج2 ص596.
([16])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص112 وج10 ص24 والبحار ج20 ص41 وإعلام
الورى ج1 ص211.
([17])
البداية والنهاية ج4 ص252 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص418.
([18])
البحار ج10 ص46 وج17 ص294 وج20 ص303 وراجع أيضاً: مسند أبي
يعلى ج2 ص206 من له رواية في مسند أحمد ص241 وغير ذلك.
([19])
تاريخ الخميس ج2 ص15 والسيرة الحلبية ج3 ص183 وسبل الهدى
والرشاد ج6 ص96 ودعائم الإسلام ج2 ص60 وعن السيرة النبوية لابن
هشام ج4 ص1051 وعن عيون الأثر ج2 ص106.
([20])
تاريخ الخميس ج2 ص15 عن أنوار التنزيل.
([21])
تاريخ الخميس ج2 ص15عن معجم ما استعجم.
|