|
كتاب النبي
 إلى
قيصر
إلى
قيصر
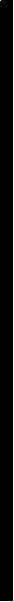 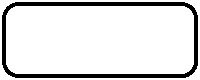 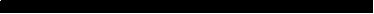 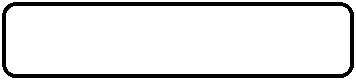
كتاب النبي
’
إلى قيصر:
هذا وقد كتب
«صلى الله عليه وآله»
أيضاً إلى قيصر كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام، ونص الكتاب هو التالي:
«بسم
الله الرحمن الرحيم: من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام
على من اتبع الهدى.
أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك
الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين و ﴿تَعَالَوْاْ
إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ
اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً
أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾»([1]).
وبالمراجعة والمقارنة بين كتاب النبي
«صلى الله عليه وآله»
لكسرى، وكتابه لقيصر، يتضح مدى التوافق بين الكتابين، باستثناء
اختلافات يسيرة فيما بينهما، سوف نحاول الإلماح إلى بعض ما تمس الحاجة
إليه، فنقول:
ورد في الكتاب قوله «صلى الله عليه
وآله»:
«يؤتك
الله أجرك مرتين»
وهذا يتضمن إشارات لأمور عديدة، منها:
أولاً:
لقد ذكر له
«إيتاء
الأجر»
لا إعطاءه، والإيتاء يتضمن معنى الجزاء بل قد فسر به([2]).
وهو أيضاً يشير إلى:
أن ما يصل إليه إنما هو أحد طرفي معاملة أو فقل مبادلة
من طرفين، فهو نظير آسى وآكل أي أن الإيتاء إعطاء على سبيل المقابلة
بشيء قد أوجب ذلك، ودعا إليه.. وقد يستبطن ذلك معنى السهولة واليسر
أيضاً.
ثانياً:
إن هذا الإيتاء الذي جاء على سبيل المقابلة والجزاء على
فعل الإسلام، إنما هو من الله تعالى، فلا منة فيه لأحد عليه، ولا يطلب
منه شكر ومكافأة لمخلوق مثله..
ثالثاً:
إن هذا العطاء داخل في مقولة الأجر والمثوبة التي
أوجبها إيمان؛ يعتبر عند الله عملاً محترماً، ومحفوظاً لعامله الذي قام
به باختياره، وليس استجابة لعملية ابتزاز، وقهر، وإخضاع مذل. بل هو أمر
فرضه على العامل معرفته بواقع كونه مربوباً، لا بد أن يؤدي فروضه
وواجباته بأمانة وصدق وإخلاص.
رابعاً:
لعل إيتاء الأجر مرتين، إنما كان لأجل إيمانه نفسه.
أو ربما يكون الأجر مرتين هو أجر الدنيا وأجر الآخرة..
أو ربما لأجل إيمانه نفسه وايمان قومه.
وربما يكون ذلك جارياً وفق السنة في أهل الكتاب، فقد
قال تعالى: ﴿الَّذِينَ
آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ، وَإِذَا
يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الحَقُّ مِن
رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، أُوْلَئِكَ
يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ
بِالحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾([3]).
وروي عن رسول الله «صلى الله عليه
وآله» أنه قال:
«من
أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين»([4]).
وذلك لأن أهل الكتاب ينالون أجرهم مرة بصبرهم على أذى
الطواغيت، وأذى المنحرفين عن الحق، وذلك في المرحلة السابقة على ظهور
نبينا الأكرم «صلى الله عليه وآله»، وينالون أيضاً أجراً آخر من أجل
إيمانهم بمحمد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وتحملهم الأذى في جنب
الله تعالى.
وقد جاء في الكتاب إلى هرقل:
«فإن توليت، فإنما عليك إثم الأريسيِّين».
وقد ذكر العلامة الأحمدي «رحمه
الله»:
اختلافات الناقلين في هذه الكلمة أو الفقرة([5])،
ولا نرى حاجة للتعرض لها ههنا..
غير أن علينا أن نشير إلى المراد بهذه الكلمة، فنقول:
قد تقدم بعض الحديث عن المراد بها، حين الكلام عن كتابه
«صلى
الله عليه وآله»
إلى ملك الفرس، ونضيف إلى ذلك هنا: أن أقرب الوجوه في معناها هو:
أن المراد بالأريسيِّين:
أتباع آريوس أسقف الإسكندرية، الذين كانوا يقولون
بالتوحيد الخالص، وأنكروا التثليث، واعتبروا المسيح عبداً من عباد الله
المخلَصين.
وكانوا قد كثروا وانتشرت دعوتهم، فأخاف ذلك الإمبرطور
الروماني قسطنطين، الذي كان وثنياً وتنصر، فجمع عدداً كبيراً من
الأساقفة، بلغ (318) أسقفاً.. وبعد مناقشات حامية وفي ظل الترهيب
والتخويف سيطر أنصار التثليث على أتباع آريوس، وفرضوا عقيدة التثليث،
وحوصر أتباع آريوس بقرار الكنيسة بمنع تداول عقائدهم([6]).
وقال أبو عبيد:
إن الأريسيِّين هم الخدم والخول([7])،
الذين يصدهم أربابهم عن الدين والحق.
وقيل:
هم الأكَّارون، لأنهم كانوا عندهم من الفرس، وهم عبدة
النار، فجعل عليهم إثمهم؛ إذ كانوا سبباً في عدم إيمانهم.
وقيل:
أتباع عبد الله بن أريس ـ رجل كان في الزمن الأول ـ
قتلوا نبياً بعثه الله إليهم.
وقيل:
الأريسيُّون: الملوك، واحدهم إِ رِّيس، فالملك هو
إِرِّيسهم الذي يجيبون دعوته ويطيعون أمره.
وقيل:
هم العشَّارون([8]).
ونحن نذكر هنا:
ما جرى عند ملك الروم، ونختار النص الذي أورده العلامة
الأحمدي
«رحمه
الله»،
وهو التالي:
«وكتب
مع دحية إلى قيصر كتاباً، يدعوه إلى الله تعالى ودين الإسلام، وأمره أن
يدفعه إلى قيصر، فلما وصل دحية إلى الحارث ملك غسان، أرسل معه عدي بن
حاتم ليوصله إلى قيصر.
فلما ذهب به إليه، قال قومه لدحية:
إذا رأيت الملك فاسجد له، ثم لا ترفع رأسك أبداً حتى يأذن لك.
قال دحية:
لا أفعل هذا أبداً، ولا أسجد لغير الله.
قالوا:
إذاً لا يؤخذ كتابك.
فقال له رجل منهم:
أنا أدلك على أمر يؤخذ فيه كتابك ولا تسجد له.
فقال دحية:
وما هو؟
قال:
إنه له على كل عتبة منبراً يجلس عليه، فضع صحيفتك تجاه
المنبر حتى يأخذها هو ثم يدعو صاحبها، ففعل.
فلما أخذ قيصر الكتاب وجد عليه
عنوان كتاب العرب، وقال:
إن هذا كتاب لم أره بعد سليمان:
بسم الله الرحمن الرحيم
فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية
ثم قال:
أنظروا لنا من قومه أحداً نسأله عنه».
وروي عن ابن عباس، عن أبي سفيان،
أنه قال:
«في
الهدنة التي كانت بيني وبين رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
خرجت للتجارة إلى الشام، فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
إلى هرقل، فأرسل هرقل إليه في ركب من قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم
في مجلسه، وعلى رأسه تاج، وحوله عظماء الروم، ودعا بترجمانه، فقال:
أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟
فقال أبو سفيان:
أنا أقربهم نسباً.
فقال:
أدنوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال:
إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فقال: حدثني عن هذا الذي
خرج بأرضكم ما هو؟
قلت:
شاب.
قال :
كيف نسبه فيكم؟
قلت:
هو فينا ذو نسب.
قال:
فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟
قلت:
لا.
قال:
فهل كان من آبائه ملك؟
قلت:
لا.
قال:
فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟
قلت:
بل ضعفاؤهم.
قال:
أيزيدون أم ينقصون؟
قلت:
لا، بل يزيدون.
قال:
فهل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له؟
قلت:
لا.
قال:
فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟
قلت:
لا.
قال:
فهل يغدر؟
قلت:
لا.
قال:
فهل قاتلتموه؟
قلت:
نعم.
قال:
فكيف كان قتالكم إياه؟
قلت:
الحرب بيننا وبينه سجال.
قال:
كيف عقله ورأيه؟
قلت:
لم نعب له عقلاً ولا رأياً قط.
قال:
كيف حسبه فيكم؟
قلت:
هو فينا ذو حسب.
قال لترجمانه:
قل له: فما يأمركم به؟
قلت:
يأمرنا بالصلاة، والزكاة، والصدق، والعفاف، والصلة، وأن
نعبد الله وحده لا شريك له، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا
بالوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، والطهارة.
فقال لترجمانه:
قل له: إني سألتك عن حسبه، فزعمت أنه فيكم ذو حسب،
وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها.
وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا.
فقلت:
لو كان من آبائه ملك قلت: رجل يطلب ملك آبائه.
وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم.
فقلت:
بل ضعفاؤهم. وهم أتباع الرسل.
وسألتك هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن
لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليدَّعي الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على
الله.
وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له،
فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب.
وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، فزعمت:
أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم.
وسألتك هل قاتلتموه، فزعمت:
أنكم قد قاتلتموه، فيكون الحرب بينكم وبينه سجالاً، ينال منكم وتنالون
منه، وكذلك الرسل تبتلى، ثم تكون لهم العاقبة.
وسألتك هل يغدر، فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا
تغدر.
وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله، فزعمت أن لا.
فقلت:
لو قال هذا القول أحد قبله، قلت: رجل ائتم بقول قيل
قبله.
قال ثم قال:
إن يكن ما تقول حقاً فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج،
ولم أكن أظنه منكم، ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده
لغسلت قدميه، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي.
قال:
ثم دعا بكتاب رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
فقرأه».
وذكر أن ابن أخي قيصر أظهر الغيظ
الشديد، وقال لعمه:
قد ابتدأ بنفسه وسماك صاحب الروم.
فقال:
والله إنك لضعيف الرأي، أترى أرمي بكتاب رجل يأتيه
الناموس الأكبر، وهو أحق أن يبدأ بنفسه؟ ولقد صدق أنا صاحب الروم،
والله مالكي ومالكه.
وفي نقل آخر:
إن هذا الرجل أخوه.
قال أبو سفيان:
فلما فرغ من قراءة الكتاب إرتفعت الأصوات عنده، وكثر
اللغط، فأمر بنا فأخرجنا.
قال:
قلت لأصحابي: لقد أمِرَ أمرُ ابن أبي كبشة، إنه ليخافه
ملك بني الأصفر.
قال:
فما زلت موقناً بأمر رسول الله
«صلى الله عليه وآله».
ثم أمر الملك بإنزال دحية وإكرامه،
وأمر منادياً ينادي:
ألا إن هرقل قد ترك النصرانية، واتبع دين محمد
«صلى الله عليه وآله»،
فأقبل جنده قد تسلحوا حتى أطافوا بقصره.
فأمر مناديه فنادى:
ألا إن قيصر إنما أراد أن يجرِّبكم، كيف صبركم على
دينكم، فارجعوا قد رضي عنكم.
ثم قال للرسول:
إني أخاف على ملكي، إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسل، والذي
كنا ننتظره ونجده في كتابنا، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك
لاتبعته، فاذهب إلى ضغاطر الأسقف، فاذكر له أمر صاحبكم، فهو أعظم في
الروم مني، وأجوز قولاً مني عندهم، صاحبك والله نبي مرسل.
فجاء دحية فأخبره بما جاء به من عند رسول الله
«صلى الله عليه وآله».
فقال ضغاطر:
صاحبك والله نبي مرسل، نعرفه في صفته، ونجده في كتابنا
باسمه، ثم ألقى ثياباً كانت عليه سوداء، ولبس ثياباً بيضاء، ثم أخذ
عصاه، ثم خرج على الروم وهم في الكنيسة.
فقال:
يا معشر الروم: إنه قد جاءنا كتاب أحمد يدعونا فيه إلى
الله، وإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن أحمد رسول الله، فوثبوا
عليه وثبة رجل واحد فضربوه فقتلوه، فرجع دحية إلى هرقل فأخبره الخبر.
فقال:
قد قلت لك: إنا نخافهم على أنفسنا، وضغاطر كان والله
أعظم عندهم مني.
ويظهر من بعض الألفاظ (كما يظهر من الإصابة عن بعض
الرواة): أن ضغاطر اجتمع مع ملك الروم، فأقرأه الكتاب، فقال: هذا النبي
الذي كنا ننتظره.
قال:
فما تأمرني؟
قال:
أما إني فمصدقه ومشيعه.
قال قيصر:
أما إن فعلت يذهب ملكي([9]).
وبعد، فإننا نلاحظ على ما تقدم ما يلي:
إنه قد ورد في كتابه
«صلى الله عليه وآله»
إلى ملك الروم قوله تعالى: ﴿قُلْ
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ ولا نشرَك به شَيْئاً وَلاَ
يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ الله فَإِن
تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾([10]).
وقد تقدم:
أن بعض النصوص صرحت: بأن كتاب رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
إلى الكفار هو: ﴿تَعَالَوْاْ
إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ..﴾
الآية([11]).
وعن الزهري:
كانت كتب النبي «صلى الله عليه وآله»
إليهم واحدة، كلها فيها هذه الآية([12]).
وقد تقدم:
أنه
«صلى الله عليه وآله»
قد كتب هذه الآية إلى كسرى([13]).
وسيأتي:
أنه كتب بها إلى المقوقس وإلى النجاشي أيضاً.
وقال أبو عبيد:
«كتب
رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
إلى كسرى، وقيصر، والنجاشي كتاباً واحداً:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
من محمد رسول الله، إلى كسرى، وقيصر، والنجاشي.
أما بعد،
﴿تَعَالَوْاْ
إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ..﴾الآية»([14]).
وهذه الآية قد جاءت في سورة آل عمران.
وقد ذكروا أيضاً:
أنه
«صلى الله عليه وآله»
قد ذكر هذه الآية لأهل نجران، حين جاؤوا إلى المدينة([15]).
وقالوا:
إن النبي
«صلى الله عليه وآله»
قد كتبها.
وقيل:
نزلت لأنها نزلت سنة تسع، وهي سنة قدوم النجرانيين([16]).
وقيل:
بل بعد نزولها؛ لأن نزولها كان في أول الهجرة في شأن
اليهود([17]).
ونقول:
إن قراءة النبي
«صلى الله عليه وآله»
للآية على النجرانيين، والطلب إليهم العمل بمضمونها لا يدل على نزول
الآية في ذلك الحين، فإن مضمونها عام صالح للاستفادة منه في كل حين،
وقد دلت الروايات على نزولها قبل ذلك حين كان يحتج على يهود المدينة.
كما أن من الجائز أن يكون أهل نجران قد جاؤوا إلى
المدينة في سنة ست.
وربما يتوهم بعضهم، أو يتعمد القول:
بأن مفاد الآية هو دعوة أهل الكتاب إلى الالتزام
بالقواسم المشتركة بيننا وبينهم، وهي عبادة الله، وتوحيده، ويبقى ما
عداها خاضعاً للبحث والحوار..
إنه كلام غير صحيح، بل إن الآية تريد أن تلزم أهل
الكتاب بالتوحيد، وأن تفرض عليهم التخلي عن الشرك، وعبادة غير الله،
وأن لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله.
وهو أمر لا يرضاه أهل الكتاب، وقد صرح القرآن بأنهم: ﴿اتَّخَذُواْ
أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللهِ..﴾([18]).
وصرح أيضاً بشركهم، وبعبادتهم لغير الله عز وجل، حيث
قال: ﴿لَقَدْ
كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ هُوَ المَسِيحُ ابْنُ
مَرْيَمَ..﴾([19]).
وقال: ﴿لَّقَدْ
كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ
إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا
يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ، أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللهُ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ، مَّا المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ
خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا
يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ
انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ، قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا
لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً واللهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ
غَيْرَ الحَقِّ..﴾([20]).
وقال تعالى: ﴿قُلْ
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا
بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا..﴾([21]).
وقال سبحانه: ﴿وَإِذْ
قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ
اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللهِ..﴾([22]).
وقال تبارك وتعالى: ﴿وَقَالَتِ
الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ
ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ
الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ،
اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِن دُونِ اللهِ
وَالمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ
إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا
يُشْرِكُونَ، يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ
وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُونَ﴾([23]).
كما أن آية الجزية صريحة:
في أن من أهل الكتاب، من لايؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يدين دين
الحق([24]).
فهذه الآيات كلها تدل:
على أن أهل الكتاب لا يعبدون الله وحده لا شريك له، كما
يريد أن يدَّعيه هذا البعض. بل إن قوله تعالى:
﴿تَعَالَوْاْ
إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ..﴾
الآية، يدل: على أنهم بعيدون عن كلمة السواء، ولا يلتزمون بها تماماً
كاتخاذهم أحبارهم أرباباً من دون الله.
فإن الآية قد دعتهم إلى الالتزام بهذين الأمرين بصيغة
واحدة، وسياق واحد، وذلك يدل على عدم التزامهم بهما معاً، كما قلنا..
ويؤيد ذلك:
ما روي من أن النبي «صلى الله عليه
وآله» كلم النضر بن الحارث حتى أفحمه، ثم قال: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ..﴾ الآية، فلما خرج
النبي «صلى الله عليه وآله» قال ابن الزبعرى: أما والله لو وجدته في
المجلس لخصمته، فاسألوا محمداً أكلُّ ما يُعبد من دون الله في جهنم مع
من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيراً، والنصارى تعبد
عيسى.
فأُخبر النبي «صلى الله عليه وآله»،
فقال:
يا ويل أمه، أما علم أن
«ما»
لما لا يعقل، و
«من»
لمن يعقل؟
فنزلت:
﴿إِنَّ
الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّا..﴾
الآية([25]).
وإذا كان
«صلى الله عليه وآله»
قد كتب بآية
«كلمة
السواء»
إلى ملك الفرس بالإضافة إلى النجاشي، وقيصر، والمقوقس، فإن ذلك يعني:
أن المجوس أيضاً من أهل الكتاب.
وقد ورد في الأحاديث:
أنه كان لهم كتاب فضيعوه، أو أحرقوه([26]).
فتضييعهم له، لم يخرجهم عن أحكامه، ولا أوجب معاملتهم معاملة أهل
الشرك.
ويقول المؤرخون أيضاً:
إن قيصر قد رد دحية بن خليفة الكلبي مكرماً، وأهدى إلى
رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
هدية، وكتب إليه:
«..
إلى أحمد رسول الله، الذي بشر به عيسى، من قيصر ملك الروم:
إني جاءني كتابك مع رسولك، وإني أشهد أنك رسول الله،
نجدك عندنا في الإنجيل، بشرنا بك عيسى بن مريم.
وإني دعوت الروم إلى أن يؤمنوا بك، فأبوا، ولو أطاعوني
لكان خيراً لهم. ولوددت أني عندك، فأخدمك، وأغسل قدميك»([27]).
وجعل كتاب رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
في الديباج والحرير، وجعله في سفط([28]).
فلما وصل كتابه إلى رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، قال:
«يبقى
ملكهم ما بقي كتابي عندهم»([29]).
ونقل الحلبي أنه «صلى الله عليه
وآله» قال:
«كذب
عدو الله، إنه ليس بمسلم»([30]).
وقد ذكر السهيلي:
أن هرقل وضع كتاب رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
الذي كتب إليه في قصبة من ذهب، تعظيماً له، وأنهم لم يزالوا يتوارثونه
كابراً عن كابر، في أرفع صوان، وأعز مكان، حتى كان عند
«أذفونش»
الذي تغلب على طليطلة، وما أخذ أخذها من بلاد الأندلس، ثم كان عند ابن
بنته، المعروف بـ
«السليطين».
حدثني بعض أصحابنا:
أنه حدثه من سأله رؤيته من قواد أجناد المسلمين، كان
يعرف بعبد الملك بن سعيد، قال: فأخرجه إلي، فاستعبرته، وأردت تقبيله،
وأخذه بيدي، فمنعني من ذلك، صيانة له، وضناً به عليَّ.
ولا نريد التعليق على المحاورة التي جرت بين قيصر وأبي
سفيان، بل نكتفي بالقول: إن أبا سفيان لم يكن سعيداً حين كان يجيب على
أسئلة قيصر، وذلك من جهتين:
إحداهما:
أنه يرى: أعدى أعدائه قد أصبح يشكل قضية كبيرة لقيصر،
ولكسرى، ولغيرهما من ملوك الأرض، وأن هؤلاء الملوك الأقوياء جداً لم
يستهينوا بأمر هذا النبي
«صلى الله عليه وآله»،
بل تلقوا أمره، وقرأوا كتبه لهم باهتمام بالغ، وبجدية ظاهرة، وكان
موقفهم منه يتسم بكثير من التروي، والحرص على عدم ظهور أية بادرة عداء
من قبلهم تجاهه، سوى ما ظهر من كسرى..
وقد أسلم بعض هؤلاء الملوك، أو أسلم كبار من أعوانهم
ورجالاتهم، ومن لم يعلن إسلامه، فإنه اتخذ جانب المداراة، والتودد له،
وأرسل له الهدايا، وخصه بالعبارات الرضية، والرقيقة..
وهذا أمر لا بد أن يزعج أبا سفيان جداً، إلى حد الصدمة،
ويجعله أكثر يأساً من الوصول إلى مبتغاه، ألا وهو القضاء على دعوته،
والتخلص من الدين الذي جاء به بيسر وسهولة..
الثانية:
إنه وجد نفسه مضطراً للصدق في أجوبته على أسئلة قيصر،
ليحفظ لنفسه موطئ قدم لديه. ولا بد أن يكون ذلك صعباً عليه؛ لأنه يدرك
أن كلماته سوف تترك انطباعاً إيجابياً لدى قيصر عن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
وهو أمر كان أبو سفيان يخشى عواقبه وتبعاته كل الخشية، ولا يرضاه في
حال من الأحوال.
ويثير الانتباه هنا:
قول قيصر لأبي سفيان: إنه يعرف: أنه نبي، وأنه خارج لا
محالة، ولكنه لم يكن يظن أنه من العرب..
غير أننا نقول:
هل كان سوء حال العرب، واستغراقهم في جهالاتهم
وضلالاتهم هو الذي صرف ذهن قيصر عن تداول احتمال أن يكون الرسول
الموعود منهم؟! وإلا فإن واقع الحال يشير إلى أنه برغم كل هذا التحريف
للحقائق الذي ظهر في كتبهم التي يعتقدون بها، فقد حفلت تلك الكتب نفسها
بإمارات ودلالات كثيرة جداً، تؤكد على أن هذا النبي هو من العرب، ومن
مكة المكرمة بالتحديد. ونذكر مثالين على ذلك، وهما:
1 ـ
ورد في الأصل العبراني من سفر التكوين ما ترجمته:
«ولإسماعيل
سمعته (إبراهيم) ها أنا أباركه كثيراً، وأنمِّيه، وأثمِّره كثيراً،
وأرفع مقامه كثيراً بمحمد، واثني عشر إماماً يلدهم إسماعيل، وأجعله أمة
كبيرة»([31]).
2 ـ
«هذه
شهادة يوحنا إذ أرسل إليه اليهود من أورشليم الكهنة واللاويين،
يسألونه: من أنت؟!
اعترف ولم ينكر، واعترف:
لست المسيح.
فسألوه: من أنت
إذن؟! أأنت إيليا؟!
قال:
لست إياه.
أأنت النبي؟!
أجاب:
لا.
فقالوا له:
من أنت فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا الخ..»
([32]).
وهناك العديد من المؤلفات التي أوردت بشارات العهدين
برسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
فيمكن الرجوع إليها والوقوف على بعض من ذلك.. ويكفي أن نشير إلى أن
الله تعالى يقول: ﴿يَعْرِفُونَهُ
كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ﴾([33]).
ويقول: ﴿النَّبِيَّ
الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ
وَالإِنْجِيلِ﴾([34]).
ومعرفة قيصر بظهور نبي في آخر الزمان يدل على أن ذلك ـ
كما أشار إليه القرآن ـ كان معروفاً عندهم. وهناك شواهد كثيرة على هذا
الأمر لسنا بصدد تتبعها.
وقد تقدم أن قيصر قد أعلن:
بأن ملك هذا النبي ـ الذي كان عالماً بأنه سيظهر ـ سوف
يبلغ إلى تحت قدميه.. والمتوقع في حالات كهذه أحد أمرين:
أولهما:
أن يؤمن ويسلم، ويستسلم للأمر الواقع، ويُرْجِع الأمر
إلى النبي
«صلى الله عليه وآله»
نفسه..
الثاني:
أن يثور، وأن يزمجر، ويتهدد، ويتوعد، ويباشر العمل في
تجهيز الجيوش، لإنزال الضربة الحاسمة بهذا الذي يخشاه على ملكه..
ولكن قيصر لم يفعل لا هذا ولا ذاك.. بل عامل النبي
«صلى الله عليه وآله»
بالمداراة والرفق.. ولكنه لم يدخل في الإسلام.
تقدم وسيأتي أنه قد ادَّعى الإسلام فكذَّبه رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
وهذا يدل على أنه قد نافق، وماكر، وكذب على الرسول
«صلى الله عليه وآله»،
وسعى لدفعه برفق وأناة؛ لأنه يريد التصدي لإنسان يعرف أنه نبي مرسل،
ويدرك أن إعلان الحرب عليه معناه إعلان الحرب على الله سبحانه، وهو
يعرف أنه قد يعجز عن مواجهة بشر مثله، فهل يقدر على أن يواجه الله
تعالى، ويعلن الحرب عليه؟!
وقد أظهر استجواب قيصر لأبي سفيان:
أن هذا الرجل كان على جانب كبير من الحنكة والمعرفة
بالأمور، وبمناشئها، ودوافعها، كما أنه كان مطلعاً على شيء من تاريخ
دعوات الأنبياء «عليهم السلام»، وخصوصياتهم، بالإضافة إلى قدر كبير من
الدراية والبصر بأحوال الناس، وبأخلاقهم، وطبيعة نظرتهم للأمور، ويتضح
لك فيما يلي:
وإذا ألقينا نظرة على أسئلة قيصر لأبي سفيان، فإننا سوف
نخرج بنتيجة مفادها: أنها قد اختيرت بعناية فائقة، حيث عرف من خلالها
كل الأمور والمزايا والخصوصيات التي تحتم نجاح مهمة رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
وأنه لا قدرة لأحد على الوقوف في وجه دعوة لها هذه الميزات،
والخصوصيات.
ونذكر من ذلك على سبيل المثال:
1 ـ
أن قيصر لم يسأل أبا سفيان عن معجزة رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، وعن السبب في عدم انصياعهم لمعجزته.
بل اتخذ الحوار بينهما منحى آخر يصب في اتجاه التعرف على ما يفيد في
وضع خطة لمواجهة هذه الدعوة التي يخشاها كل الخشية ويريد أن يتجنب
الصدام معها.
2 ـ
أنه سأل أبا سفيان عن نسب وحسب رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
فأخبره: أنه ذو نسب وحسب.. وله مكانة مرموقة فيما بين قومه.. وبديهي:
أن الناس العاديين يعظمون ذوي الأحساب، ويحبون التقرب منهم، ولا يرضيهم
إلحاق الأذى بهم، ولا يؤنسهم التطاول عليهم.. ومعرفة قيصر بهذا الأمر
بالنسبة لرسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
سوف تزعجه، وتزيد من هواجسه..
3 ـ
حين لم يجد قيصر في آباء رسول الله
«صلى الله عليه وآلـه»
ملكاً، فإنه فقد المبرر لاتهامه
«صلى الله عليه وآله»
بأنه يريد أمراً لنفسه، وأنه طالب جاه ومقام ضاع منه..
4 ـ
وإذا كان ضعفاء الناس هم أتباع رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
فإن ذلك يعني: أن الشرفاء والرؤساء ـ وهم قليلون ـ يفقدون سيطرتهم على
أولئك الضعفاء، الذين هم الكثرة الكاثرة، والذين يعيشون حالة من
التلاحم، والتعاضد،
ويعطف
بعضهم على البعض الآخر، ويحن إليه، وتتلاقى مشاعرهم
بالمظلومية والقهر، وتتشارك أمانيهم في التعلق بمن يأتي لينجيهم مما هم
فيه، من ظلم وعسف أولئك الأسياد، ويهديهم إلى طريق الخلاص من متاعبهم،
وآلامهم..
5 ـ
ومن الواضح: أن الوثوق بصدق القائد والرئيس أمر مهم
جداً في حصول الاطمينان لدى الناس بأقواله وأفعاله، وفي سكون نفوسهم
إليه.. وهو يقلل أيضاً من فرص التشكيك في صدقيته، وفي خلوصه، وإخلاصه..
وهو من موجبات احترام الناس وإكبارهم له.
كما أن ذلك يؤكد لهم صحة ما جاء به، ويزيد تقديسهم له..
6 ـ
وإن عدم ارتداد أحد ممن يدخل في دينه
«صلى الله عليه وآله»،
يشير إلى أن باطن هذا الدين لا يخالف ظاهره، وأن شعاراته متوافقة مع
حقائقه، وأنه منسجم مع الفطرة والحقيقة الإنسانية، مؤيد بالمنطق
القويم، والعقل السليم، وأنه صالح لكل المستويات، ومتوافق مع عقول
الناس من مختلف الفئات، وجميع المجتمعات..
كما أن ذلك يدل على أن من يؤمن بهذا الدين يجد فيه
مبتغاه، وأنه حتى لو كان قد دخل فيه لألف سبب وسبب، فإن هذا الدين قادر
على تحويل العلقة الظاهرية، إلى علقة إيمانية حقيقية وواقعية..
7 ـ
يضاف إلى ذلك: أن أهل الإيمان في ازدياد مستمر، وأن هذا
الدين لا يتراجع ولا ينحسر، وأن ذلك ينسحب على جميع القوميات،
والطبقات، والفئات.
وهذا يعطي:
أنه لا خصوصية لبلاد العرب ولا لأحوالهم في ذلك، بل
الخصوصية هي للتكوين الإنساني نفسه، حيث إنه إذا وجد ما يسانخه،
ويتلاءم معه، فإنه يتلاحم معه، ويندمج فيه.
8 ـ
ولأجل ذلك سأل قيصر أخيراً عن التعاليم التي جاء بها،
فلما أخبره ببعضها أدرك أنها تعاليم إنسانية إلهية خالصة، وهي التي
تبحث الفطرة عنها، لتتكامل بها ومعها. وهي التي تأنس بها النفس، وتهفو
إليها الروح، ويرشد إليها عقل الإنسان ويرضاها وجدانه، وضميره..
وفي هذا الحوار نقاط كثيرة أخرى، كلها تصب في اتجاه
واحد، وهو: أن قيصر أراد أن يكتشف ثغرة في دعوة رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
تفسح المجال لتسديد الضربة القاصمة له، ليتخلص منه، فلم يجد..
ولأجل ذلك عقب بقوله:
«وليبلغن
ملكه ما تحت قدمي».
بل وجد أن أي صدام مع هذا النبي سوف يؤدي إلى غرس شجرة
الإسلام في بلاده، وهي شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، لا مجال
للتخلص منها، في أي حال، بل يكون السعي في هذا الاتجاه من موجبات
قوتها، وتجذرها، وانتشار أغصانها في كل اتجاه..
فآثر العمل على تجنب ذلك، ومارس المكر والحيلة، ولا
يحيق المكر السيئ إلا بأهله، ولتعلمن نبأه بعد حين.
ولو أنه كان راغباً في الإسلام، فقد كان باستطاعته وهو
الرجل المجرب، والحصيف أن يفعل ذلك، وأن يمهد السبل لإسلام أهل مملكته
وفق ما يأمره به نبي الله
«صلى الله عليه وآله».
تقدم:
أن ملك الروم بعدما قرأ كتاب رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
واطلع من أبي سفيان على ما أحب أن يطلع عليه..
«أمر
منادياً ينادي: ألا إن هرقل قد آمن بمحمد واتبعه.
فدخلت الأجناد في سلاحها، وأطافت بقصره، تريد قتله،
فأرسل إليهم: أني أردت أن أختبر صلابتكم في دينكم، فقد رضيت عنكم.
فرضوا عنه.
ثم كتب إلى رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
أنه مسلم، ولكنه مغلوب على أمره..
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
كذب عدو الله، ليس بمسلم، بل هو على نصرانيته.. أو نحو
ذلك»([35]).
ونقول:
إن التأمل في هذا الذي جرى يدل دلالة واضحة على مكر هذا
الرجل، وعلى سوء سريرته، حيث اختار هذه الطريقة التحريضية المثيرة،
التي من شأنها أن تلهب مشاعر الناس، وتعجل باتخاذهم قرار الرفض، تحت
وطأة الشعور بالخوف والوجل من أمر مجهول لهم، لم يطلعوا على أي شيء منه
يفيد في طمأنتهم إلى مصيرهم ومستقبلهم معه..
وقد كان بإمكانه أن يفعل كما فعل باذان، وملك الحبشة،
وغيرهما من الملوك الذين أسلموا، ولم يثيروا الناس من حولهم، بل هم قد
يسروا لهم سبيل الإيمان والهداية، وأفسحوا لهم المجال في هذا الأمر،
بعيداً عن أجواء التشنج والإثارة والتحدي.. فأنار الله قلوبهم بالحق،
وفتح أعينهم على الخير، وأسلموا لله رب العالمين..
نعم، إن ما فعله قيصر قد أوجب صدود الناس عن التفكير في
حقيقة ما يعرضه رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
عليهم، وأصبحوا يتعاملون بانفعال، وبعصبية بالغة، وبتحفظ شديد. وبذلك
يكون قد أوصد أبواب الهداية إلى الله تعالى، وحرمهم من بركاتها..
وقد أكد هذا الصدود لديهم والإصرار على الممانعة منهم،
حين لوَّح لهم بأن هذا النبي هو من قوم لم يكن يظن أن يكون منهم، فأثار
في نفوس أتباعه مشاعر الاستكبار، والتعالي، وساقهم إلى رفض الانصياع
لنبي يخرج من قوم ليس لهم شأن، ولا مقام، ولا بد أن يعتبروا الانصياع
لنبي من قوم لهم هذه الصفة نقيصة وعاراً، ولا يليق صدوره من أهل الشرف
والشهامة، والرياسة، والزعامة.
ولعل الذي دعاه إلى ذلك:
خوفه من أن يكون انتشار الإسلام في رعيته سبباً في
تعاظم نفوذ كلمة رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
فيهم، إلى حد يؤثر على نفوذه، ويضعف مكانته عندهم، مع إدراكه أن
الانقياد للدين ولرموزه يكون هو الأشد؛ لأنه انقياد نابع من ضمير
الإنسان، ومن أعماق روحه، وشغاف قلبه، لا خوفاً من عصاً، ولا طمعاً
بشيء من حطام الدنيا. فابتكر هذه الطريقة من أجل حسم الأمر لصالحه،
وهكذا كان.
وأما إعلان الحرب من قِبَله على رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
فهو غير سديد؛ لأنه سوف ينتهي إلى ما انتهت إليه قريش في حربها معه..
كما سيأتي توضيحه حين الكلام عن موقف المقوقس.
وبذلك يكون قيصر قد باء بإثم الأريسيِّين، أو القبط،
الذين كان يستطيع أن يهديهم إلى الحق، ويأخذ بأيديهم إلى النجاة فساقهم
إلى الكفر، وأوردهم موارد السوء والبوار والهلاك..
هذا وبمراجعة المصادر التاريخية
يتضح:
أنه
«صلى الله عليه وآله»
قد أرسل كتباً أخرى إلى قيصر، أحدها حينما كان راجعاً من تبوك، وقد طلب
منه أن يعطي الجزية، فإن أبى، فعليه أن يواجه الحرب، إلا أن يلتزم بأن
لا يحول بين الفلاحين، وبين الإسلام([36]).
وغزوة تبوك كانت في سنة تسع، فإرسال هذا الكتاب إلى
قيصر في هذه السنة يدل على أنه لم يقبل منه ادعاءه للإسلام، بعد أن
ظهرت دلائل كذبه، ومكره في دعواه هذه، فهدده في هذا الكتاب بالحرب،
أو إعطاء الجزية.
وسوف نتعرض مرة أخرى لهذا الكتاب حين الحديث عن غزوة
تبوك فيما يأتي إن شاء الله تعالى.
وقد ذكرنا فيما تقدم:
أنه
«صلى الله عليه وآله»
كان لا يقبل هدية مشرك، أو كافر. فقد يقال: إن هذا لا يتلاءم مع ما
ذكرته الروايات من قبوله
«صلى الله عليه وآله»
هدية قيصر، إذا كان كافراً؟!
ويمكن أن يجاب عن ذلك بعدة أجوبة:
أحدها:
أنه
«صلى الله عليه وآله»
كان لا يقبل هدية المشركين. أما هدية أهل الكتاب، مثل: النصراني،
واليهودي، فلم يكن يردها كما دلت عليه بعض الروايات([37]).
وقد كان قيصر نصرانياً، وكان كسرى مجوسياً، ويعد المجوس
من أهل الكتاب أيضاً.
وأما ما روي من أنه «صلى الله عليه
وآله» كان يقول:
«اللهم
لا تجعل لفاجر ولا فاسق عندي نعمة»([38])..
فربما يقال:
إن المراد به: من كان محارباً من الفساق والفجار..
الثاني:
قد يقال: إن المقصود بما سبق هو: أنه
«صلى الله عليه وآله»
كان يرد هدية المشرك المحارب، أما غيره، فكان يقبل هديته، حتى لو كان
مشركاً([39])،
فضلاً عن أن يكون يهودياً أو نصرانياً.
ونقول:
أولاً:
إن هذا الكلام غير ظاهر الوجه، فإن المشرك إذا كان
محارباً، فهو لا يهدي لرسول الله
«صلى الله عليه وآله»
شيئاً..
ثانياً:
إن الحديث غير مقيد بالمحارب ولا بغيره. فراجع النصوص
المنقولة في ذلك، حين الحديث عن إيمان أبي طالب رضوان الله تعالى عليه،
فإن مفادها: أن نفس شركهم هو السبب في عدم قبول الهدية منهم.
ثالثاً:
قد ادَّعى البعض: أنه
«صلى الله عليه وآله»
قد قبل هدية قيصر؛ لأنها فيء للمسلمين ولذلك قسمها عليهم. ولو أنها
كانت هدية خاصة، بحيث تكون لشخصه
«صلى الله عليه وآله»،
ولا يستفيد منها سواه، أو أهل بيته الذين هم تحت تكفله، فإنها تكون له
خالصة، كما كانت هدية المقوقس خالصة له، وقد قبلها منه؛ لأنه لم يكن
محارباً للإسلام..
ونقول:
إن هذا الكلام غير دقيق:
أولاً:
إن قيصر لا يختلف في موقفه عن المقوقس من حيث إنه يداري
رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
دون أن يدخل في دينه.
ثانياً:
إن قيصر قد أظهر في رسالته التي بعثها لرسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
أنه قد أسلم، غاية الأمر: أن الرسول
«صلى الله عليه وآله»
قد أخبر عنه أنه غير صادق فيما يقول، وأنه قد اتبع سبيل النفاق والمكر
في هذا الأمر.
وقد كان
«صلى الله عليه وآله»
يعامل المنافقين كما يعامل المسلمين. وكان عارفاً بهم، وقد أخبر حذيفة
بأسمائهم، ولم يُؤثر عنه
«صلى الله عليه وآله»:
أنه عاملهم كما يعامل أهل الكفر أو الشرك.
ثالثاً:
إنه لا دليل على أن النبي
«صلى الله عليه وآله»
قد اعتبر ذلك فيئاً للمسلمين، إذ لماذا لا يكون
«صلى الله عليه وآله»
قد ترك لأصحابه أمراً هو له، ترفعاً منه
«صلى الله عليه وآله»،
وتنزهاً، أو إظهاراً للشمم والنبل، أو إيثاراً منه لأصحابه، ليتعلم منه
الناس ذلك، ولتصل أخباره إلى من أرسل تلك الهدية، والذي كان يظن أن
هديته سوف يكون لها وقعها الخاص لدى المرسل إليه، بسبب ندرتها،
وقيمتها، وأهميتها من الناحية المادية..
رابعاً:
إن الفيء ملك خالص لرسول الله
«صلى الله عليه وآله»
وليس لأحد فيه نصيب، فإن هؤلاء لم يأخذوه في ساحة الحرب، ليكون غنيمة
لهم.
([1])
لقد كفانا العلامة الأحمدي مؤونة تتبع مصادر هذا الكتاب، حيث
أشار في كتابه القيم: مكاتيب الرسول ج2 ص391 و 392 إلى المصادر
التالية، وفقاً للطبعات المتوفرة لديه: السيرة الحلبية ج3 ص275
وزيني دحلان ج3 ص61 ورسالات نبوية ص311 ومسند أحمد ج1 ص263
وتهذيب تأريخ ابن عساكر ج1 ص141 و ج6 ص392 و 390 وج5 ص22
واليعقوبي ج2 ص67 وصبح الأعشى ج6 ص363 و 364 والأموال لابن
زنجويه ج1 ص120 وج2 ص584 و 585 والمنتظم ج3 ص278 و 279 وكنز
العمال ج2 ص275 = = وفي (ط أخرى) ج4 ص237 (1942) (عن أحمد
والبيهقي والنسائي) و ج10 ص385 و 417 و 419 و 411 والدر
المنثور ج2 ص 40 (عن عبد الرزاق، والبخاري، ومسلم، والنسائي،
وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه) وج4 ص30 ومشكل الآثار للطحاوي
ج2 ص397 و 398 ودلائل النبوة لأبي نعيم ص290 والمعجم الكبير
للطبراني ج4 ص 266 وج8 ص 17 ـ 27 بطرق متعددة وج25 ص236 وج12
ص242 ونصب الراية للزيلعي ج4 ص418 وسنن أبي داود ج4 ص335
والأموال لأبي عبيد ص32 و 362 وأعيان الشيعة ج1 ص244 وصحيح
البخاري ج1 ص7 و 83 وح4 ص54 و 55 و 57 وج6 ص45 وج9 ص193 وج8
ص72 وصحيح مسلم ج3 ص1396 والكامل لابن الأثير ج2 ص81 وفي (ط
أخرى) ص 212 والطبري ج2 ص291 وفي (ط
أخرى) ص649 والبداية والنهاية ج4 ص264 وجمهرة رسائل العرب ج1
ص33 والأغاني ج6 ص93 والمواهب اللدنية للقسطلاني ج3 ص384
وإعلام السائلين ص10 ـ 19 وناسخ التواريخ في سيرة رسول الله
«صلى الله عليه وآله» ص 274 والتراتيب الإدارية ج1 ص142 وثقات
ابن حبان ج2 ص5 وج1 ص1 ومآثر الإنافة ج3 ص247 وفقه السيرة ص371
والتأريخ لابن خلدون ج2 ق2 ص36 وتأريخ الخميس ج2 ص33 والفائق
للزمخشري ج1 ص 36 و 14 وحياة الصحابة ج1 ص110 وتفسير القرطبي
ج4 ص105 وتفسير المنار ج3 ص328 وزاد المعاد لابن القيم ج3 ص60
ودلائل النبوة للبيهقي ج4 ص379 و 380 و 384 وعبد الرزاق ج5
ص346 والوثائق ص107/26 وقال: قابل مسند أحمد ج3 ص133 وج4 ص74 و
75 وأشار إلى المجلات العصرية المتعرضة للكتاب ونقله أيضاً عن
جمع ممن تقدم (وعن تفسير النسائي ج3 ص441 والمنتقى لأبي نعيم
ورقة 132 وصبح الأعشى ج6 ص376 ومفيد العلوم ومبيد الهموم
للقزويني ص17 ووسيلة = = المتعبدين ص8 مخطوطة بانكى پور في
الهند ورقة 27 والإمتاع للمقريزي (خطية كوپر لو) ص1012 والمبعث
والمغازي للتيمي خطية ورقة 12 والوفاء لابن الجوزي ص724)
وراجع: مدينة البلاغة ج2 ص247 ومرقاة المصابيح ج4 ص221 ومشكاة
المصابيح بهامش المرقاة ص221 وحياة محمد لهيكل ص352 والمصباح
المضيء ج2 ص77 ونشأة الدولة الإسلامية ص 299 و 300.
وأشار
إلى الكتاب: الترمذي ج5 ص68 والبحار ج21 ص286 وج17 ص207 وج15
ص30 وج4 ص100 وج20 ص386 والجامع للقيرواني ج1 ص288 والطبقات
الكبرى ج1 ق2 ص16 وج4 ق1 ص18 والتنبيه والإشراف ص226 والسنن
الكبرى للبيهقي ج9 ص177 و ج10 ص130 و 131 ومسند أحمد ج1 ص262
وتفسير گازر ج2 ص65 وتفسير ابن كثير ج1 ص371 وتفسير الثعالبي
ج1 ص275 وابن هشام ج4 ص254 والنهاية لابن الأثير في «دعى» و
«أرس» وكذا في لسان العرب. وراجع: فتح الباري ج13 ص430 وج1 ص35
وج6 ص79 و ج8 ص165 والعمدة ج1 ص79 وج 14 ص210 وج18 ص144 وعون
المعبود ج4 ص498 و 499 ومجمع الزوائد ج5 ص306 والأم للشافعي ج4
ص171.
([2])
راجع: لسان العرب ج1 ص67.
([3])
الآيات 52 ـ 54 من سورة القصص.
([4])
راجع: المعجم الكبير ج8 ص191 وبمعناه في ص212 والسنن الكبرى ج7
ص128 ومشكل الآثار ج2 ص215 و 394 ومسند أحمد ج5 ص259 ومكاتيب
الرسول ج2 ص395 عنهم، ومجمع الزوائد ج1 ص93 والدر المنثور ج5
ص133 وكنز العمال ج1 ص96 وجامع البيان ج27 ص317 وتفسير القرآن
العظيم ج3 ص405.
([5])
مكاتيب الرسول ج2 ص396 و 397.
([6])
راجع: تاريخ الفكر المسيحي (تأليف حنا الخضري) ج1 ص617، ودائرة
المعارف للبستاني، كلمة «أرس».
([7])
الأموال ص33 والنهاية في اللغة ج1 ص38 ولسان العرب ج1 ص117 وعن
فتح الباري ج8 ص167.
([8])
النهاية في غريب الحديث ج1 ص42 ولسان العرب ج6 ص6 وراجع:
السيرة النبوية لدحلان (بهامش السيرة الحلبية) ج3 ص60 والبحار
ج20 ص388 و 396 ومكاتيب الرسول ج2 ص397.
([9])
في مكاتيب الرسول ج2 ص405 قال العلامة الأحمدي: راجع في تفصيل
بعث دحية وقصة أبي سفيان: السيرة الحلبية ج3 ص273 وسيرة دحلان
ج3 ص58 ودلائل أبي نعيم: 287 و 290 والبحار ج20 ص389 ومسند
أحمد ج3 ص263 وتهذيب تأريخ ابن عساكر ج1 ص141 و ج6 ص392 والدر
المنثور ج2 ص40 ومشكل الآثار للطحاوي ج3 ص397 والدلائل للبيهقي
ج4 ص279 ـ 284 والأموال لأبي عبيد ص34 و 362 وأعيان الشيعة ج1
ص244 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص177 و ج10 ص130 وفتح الباري ج1
ص35 و ج6 ص79 و ج8 ص165 وعمدة القاري ج1 ص99 و ج14 ص210 وج18
ص144 وعون المعبود ج4 ص498 والطبقات الكبرى ج1 ق2 ص16 وثقات
ابن حبان ج2 ص5 والبخاري ج1 ص2 ـ 5 وج4 ص57 وتأريخ الخميس ج2
ص32 والبداية والنهاية ج4 ص262 ـ 268 وتاريخ الأمم والملوك ج2
ص646 والكامل لابن الأثير ج2 ص211 والإصابة ج2 ص216 وأسد
الغابة ج3 ص41 ومجمع الزوائد ج8 ص236 و 237 و ج5 ص306 ـ 308
وحياة الصحابة ج1 ص104 وراجع: الطبراني في الكبير ج12 ص442
(13607) وج25 ص 233 ـ 238 وج4 ص266 وج8 ص17 ـ 28 بأسانيد
متعددة والمصنف لعبد الرزاق ج5 ص344 والروض الأنف ج3 ص249
والأموال لابن زنجويه ج2 ص584 و 585 و 589 والمنتظم ج3 ص277 و
278.
([10])
الآية 64 من سورة آل عمران.
([11])
الدر المنثور ج2 ص40 عن الطبراني عن ابن عباس وراجع المصادر
المتقدمة.
([12])
البداية والنهاية ج3 ص83 والمصادر المتقدمة.
([13])
راجع: الأموال ص34 وكنز العمال ج10 ص417 والبحار ج21 ص287 الدر
المنثور ج5 ص107 والمصنف لابن أبي شيبة ج14 ص338 وسنن سعيد بن
منصور ج2 ص189 ومكاتيب الرسول ج2 ص320.
([14])
الأموال ص34 ومكاتيب الرسول ج2 ص320 و 456 والمصنف لابن أبي
شيبة ج8 ص461 وكنز العمال ج10 ص632.
([15])
الدر المنثور ج2 ص40 عن ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير،
وعن السدي.
([16])
السيرة الحلبية ج3 ص244 وراجع: عمدة القاري ج1 ص93.
([17])
الدر المنثور ج2 ص40 عن ابن جرير، وابن أبي حاتم، وعبد بن
حميد، والسيرة الحلبية ج3 ص244 وراجع: عمدة القاري ج1 ص93
وجامع البيان ج3 ص410 و 415 وفتح القدير ج1 ص349.
([18])
الآية 31 من سورة التوبة.
([19])
الآيتان 17 و 72 من سورة المائدة.
([20])
الآيات 73 ـ 77 من سورة المائدة.
([21])
الآية 59 من سورة المائدة.
([22])
الآية 116 من سورة المائدة.
([23])
الآيات 30 ـ 32 من سورة التوبة.
([24])
الآية 29 من سورة التوبة.
([25])
المناقب لابن شهرآشوب ج1 ص49 والكنى والألقاب ج1 ص294 والبحار
ج18 ص200 والقواعد الفقهية ج5 ص338 عن الكاشف ج3 ص136 وعن
أسباب النزول للواحدي ص175 وعن الدر المنثور ج5 ص679.
وراجع: البداية والنهاية ج3 ص111 والسيرة النبوية لابن هشام ج1
ص241 والسيرة النبوية لابن كثير ج2 ص53 وسبل الهدى والرشاد ج2
ص465 وجامع البيان ج17 ص128والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج16
ص103 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج3 ص208.
([26])
فقه القرآن ج1 ص342 و 344 وميزان الحكمة ج4 ص3183 والكافي ج3
ص568 ومن لا يحضره الفقيه ج2 ص54 وتهذيب الأحكام ج4 ص113 وج6
ص159 و 175 والوسائل (ط دار الإسلامية) ج11 ص96 و 97 والفصول
المهمة ج2 ص212 والبحار ج14 ص463 ومكاتيب الرسول ج2 ص413
والتفسير الصافي ج2 ص334 ونور الثقلين ج2 ص202 وقصص الأنبياء
للجزائري ص514 وعن فتح الباري ج9 ص343.
([27])
تاريخ اليعقوبي ج2 ص67 و 68 وراجع: السيرة الحلبية ج3 ص246
والسيرة النبوية لدحلان (مطبوع مع الحلبية) ج3 ص63 والروض
الأنف ج4 ص196 ومكاتيب الرسول ج2 ص410.
([28])
دلائل النبوة لأبي نعيم ص 291 وراجع: الروض الأنف ج4 ص197
ومكاتيب الرسول ج2 ص410 وسبل الهدى والرشاد ج11 ص354.
([29])
تاريخ اليعقوبي ج2 ص68 وراجع: مسند أحمد ج3 ص442 وج4 ص74
والبحار ج20 ص386 ومكاتيب الرسول ج2 ص410 و 416 ومجمع الزوائد
ج8 ص235 وعن فتح الباري ج1 ص42 وكنز العمال ج1 ص268 والبداية
والنهاية ج5 ص20 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص28 وسبل الهدى
والرشاد ج5 ص458 وج11 ص355.
([30])
السيرة الحلبية ج3 ص246 والسيرة النبوية لدحلان (مطبوع مع
الحلبية) ج3 ص63 وموارد الظمآن ص393.
([31])
سفر التكوين 17: 20.
([32])
إنجيل يوحنا 1/19 فما بعدها.
([33])
الآية 146 من سورة البقرة، والآية 20 من سورة الأنعام.
([34])
الآية 157 من سورة الأعراف.
([35])
الروض الأنف ج4 ص196 وراجع: حياة الصحابة ج1 ص106 و 107
والبداية والنهاية ج4 ص267 و 268 وج5 ص15 وتهذيب تاريخ دمشق ج1
ص114 وعن فتح الباري ج1 ص35 والسيرة الحلبية ج3 ص246 والسيرة
النبوية لدحلان (بهامش الحلبية) ج3 ص63 وسائر المصادر التي
ذكرناها سابقاً، حين أوردنا ما جرى بين هرقل وأبي سفيان،
وموارد الظمآن ص393 وصحيح ابن حبان ج10 ص358.
([36])
مكاتيب الرسول ج2 ص410 و 411 عن المصادر التالية: الأموال ص22
وفي (طبعة أخرى) ص32، ورسالات نبوية ص313 ـ 117 ومدينة البلاغة
ج2 ص247 عن جمهرة رسائل العرب والوثائق: 110/27 عن (الأموال
وصبح = = الأعشى ج6 ص363 و 377 وسنن سعيد بن منصور ج2 ص187
والمطالب العالية ج4 ص2231 و 2479 وراجع 4342 عن الحارث بن
أسامة وقال: انظر مجلة المعارف شهر يونيو 1935م: 416 ـ 430،
وراجع: نشأة الدولة الإسلامية ص299 و 300 (عن أبي عبيد،
والقلقشندي، ومحمد حميد الله)، وراجع أيضاً ص713. وأوعز إليه
الحلبي في السيرة ج2 ص377 والبداية والنهاية ج5 ص15 وابن عساكر
ج1 ص113 و 114 ودحلان هامش الحلبية ج2 ص374 وسعيد بن منصور في
سننه ج2 ص187.
([37])
إختيار معرفة الرجال (ط جامعة طهران) ص160 و (ط مؤسسة آل
البيت) ج2 ص268 والبحار ج16 ص374 وج50 ص107 والوسائل (ط دار
الإسلامية) ج12 ص217 وعون المعبود ج8 ص215 وسبل الهدى والرشاد
ج9 ص31 وجامع الرواة ج1 ص300 ومعجم رجال الحديث ج8 ص89.
([38])
النصائح الكافية ص156 وراجع: من لا يحضره الفقيه ج3 ص299 (ط
مؤسسة النشر الإسلامي) وكنز العمال ج2 ص111 و 211 والجامع
لأحكام القرآن ج17 ص108 و 308 (ط مؤسسة الرسالة)، وأبو طالب
مؤمن قريش للخنيزي وتذكرة الموضوعات ص68 وكشف الخفاء ج1 ص89 و
331 وج2 ص321 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص353 والدر المنثور ج6
ص186 و 187.
([39])
الروض الأنف ج4 ص196.
|