|
حديث العترة
هو القصص الحق
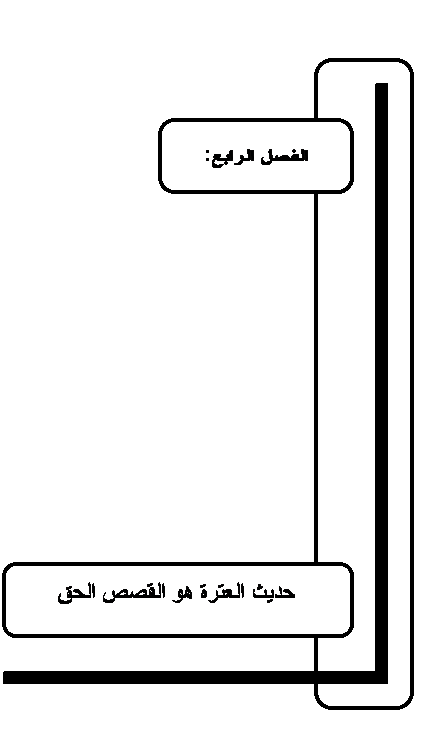
ونريد أن نعرض هنا نصوصاً هامة.. ثم نلحقها ببعض ما
يفيد في جلاء الحقيقة، وفي إعطاء الإنطباع السليم عن بعض ما ترمي إليه
مواقف الرسول «صلى الله عليه وآله»، وبياناته، وغير ذلك من أمور هامة
ومفيدة، والنصوص هي التالية:
ذكر ابن شهرآشوب قضية إغارة خالد على حي أبي زاهر
الأسدي، فجاء سياقها موافقاً ـ تقريباً ـ لسياق قضية بني جذيمة، فقال:
«في
رواية الطبري:
أنه أمر بكتفهم، ثم عرضهم على السيف، فقتل منهم من قتل.
فأتوا بالكتاب الذي أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله»
أماناً له ولقومه إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، وقالوا جميعاً: إن
النبي «صلى الله عليه وآله» قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد.
وفي رواية الخدري:
اللهم إني أبرأ إليك من خالد ثلاثاً.
ثم قال:
«أما متاعكم فقد ذهب، فاقتسمه المسلمون، ولكنني أرد
عليكم مثل متاعكم».
ثم إنه قدم على رسول الله «صلى الله عليه وآله» ثلاث
رزم من متاع اليمن، فقال: يا علي، فاقض ذمة الله، وذمة رسوله. ودفع
إليه الرزم الثلاث.
فأمر علي «عليه السلام» بنسخة ما أصيب لهم.
فكتبوا، فقال:
خذوا هذه الرزمة، فقوّموها بما أصيب لكم.
فقالوا:
سبحان الله هذا أكبر مما أصيب لنا!
فقال:
خذوا هذه الثانية، فاكسوا عيالكم وخدمكم، ليفرحوا بقدر
ما حزنوا، وخذوا الثالثة بما علمتم وما لم تعلموا، لترضوا عن رسول الله
«صلى الله عليه وآله».
فلما قدم علي «عليه السلام» على رسول الله «صلى الله
عليه وآله» أخبره بالذي كان منه، فضحك رسول الله «صلى الله عليه وآله»
حتى بدت نواجذه، وقال: أدى الله عن ذمتك كما أديت عن ذمتي.
ونحو ذلك روي أيضاً في بني جذيمة([1]).
حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد «رحمه الله»، قال:
حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن
علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر الباقر «عليه السلام»، قال:
بعث رسول الله «صلى الله عليه وآله» خالد بن الوليد إلى
حي يقال لهم: بنو المصطلق من بني جذيمة. وكان بينهم وبين بني مخزوم
إحنة في الجاهلية.
فلما ورد عليهم كانوا قد أطاعوا رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، وأخذوا منه كتاباً، فلما ورد عليهم خالد أمر منادياً فنادى
بالصلاة، فصلى وصلوا. فلما كانت صلاة الفجر أمر مناديه فنادى، فصلى
وصلوا. ثم أمر الخيل، فشنوا فيهم الغارة، فقتل، وأصاب.
فطلبوا كتابهم فوجدوه، فأتوا به النبي «صلى الله عليه
وآله»، وحدثوه بما صنع خالد بن الوليد.
فاستقبل القبلة، ثم قال:
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد .
قال:
ثم قدم على رسول الله تبر ومتاع، فقال لعلي «عليه
السلام»: يا علي، إئت بني جذيمة من بني المصطلق، فأرضهم مما صنع خالد.
ثم رفع «صلى الله عليه وآله» قدميه،
فقال:
يا علي، اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك.
فأتاهم علي «عليه السلام»، فلما انتهى إليهم حكم فيهم
بحكم الله.
فلما رجع إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، قال:
يا علي، أخبرني بما صنعت.
فقال:
يا رسول الله، عمدت، فأعطيت لكل دم دية، ولكل جنين غرة،
ولكل مال مالاً.
وفضلت معي فضلة، فأعطيتهم لميلغة كلابهم، وحبلة رعاتهم.
وفضلت معي فضلة، فأعطيتهم لروعة نسائهم، وفزع صبيانهم.
وفضلت معي فضلة، فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون.
وفضلت معي فضلة، فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله.
فقال «صلى الله عليه وآله»:
يا علي، أعطيتهم ليرضوا عني؟! رضي
الله عنك، يا علي، إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي
بعدي([2]).
وفي حديث آخر:
أنه «صلى الله عليه وآله» بعث خالداً والياً على صدقات
بني المصطلق حي من خزاعة.
ثم ساق الحديث نحو ما تقدم، ولكنه «صلى الله عليه وآله»
قال لعلي في آخره: «أرضيتني، رضي الله عنك، يا علي، أنت هادي أمتي. ألا
إن السعيد كل السعيد من أحبك، وأخذ بطريقتك. ألا إن الشقي كل الشقي من
خالفك، ورغب عن طريقتك إلى يوم القيامة»([3]).
وفي حديث المناشدة يوم الشورى، قال
«عليه السلام»:
«نشدتكم بالله، هل علمتم أن رسول الله «صلى الله عليه
وآله» بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، ففعل ما فعل، فصعد رسول الله
«صلى الله عليه وآله» المنبر، فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد
بن الوليد» ثلاث مرات.
ثم قال:
«اذهب يا علي».
فذهبت، فوديتهم، ثم ناشدتهم بالله هل بقي شيء؟
فقالوا:
إذا نشدتنا بالله، فميلغة كلابنا، وعقال بعيرنا.
فأعطيتهم لهما([4]).
وبقي معي ذهب كثير، فأعطيتهم إياه، وقلت: وهذا لذمة رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، ولما تعلمون، ولما لا تعلمون، ولروعات النساء
والصبيان.
ثم جئت إلى رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، فأخبرته، فقال:
«والله، ما يسرني يا علي أن لي بما صنعت حمر النعم».
قالوا:
اللهم نعم([5]).
ونقول:
قد صرحوا:
بأن بني المصطلق بطن من خزاعة، وهو بنو جذيمة، وجذيمة
هو المصطلق([6]).
وكان «صلى الله عليه وآله» قد غزا بني المصطلق في سنة
أربع، أو خمس، أو ست، فأسر وسبى، وتزوج منهم جويرية، فأعتق المسلمون كل
من كان بأيديهم من الأسرى منهم، وقالوا: أصهار رسول الله «صلى الله
عليه وآله».
فآمنوا، وأخذوا من رسول الله «صلى الله عليه وآله»
كتاباً بإسلامهم([7]).
والذي يبدو لنا:
أن إيقاع خالد ببني جذيمة كان لعدة أسباب:
أولها:
ما أشارت إليه الروايات: من أنه أراد أن ينتقم لعمه
الفاكه بن المغيرة، إنفاذاً لوصية أبيه له ولإخوته بذلك([8]).
ثانيها:
أن خزاعة كانت مكروهة من قبل قريش، لأنها كانت عيبة نصح
لرسول الله «صلى الله عليه وآله». فلابد أن يوقع بكل من ينتسب إلى
خزاعة، التي حالفت من لا تحبه قريش، ومن تسعى لإبطال دعوته، وكسر
شوكته، ومن لم يزل أمرها معه يسير من وهن إلى وهن، حتى اضطرت إلى
الاستسلام.
ثالثها:
أن نفس طبيعة خالد تميل إلى العدوان، وقهر الناس،
وإذلالهم بقسوة وشراسة، ولو عن طريق الغدر والخديعة، ونقض العهود،
والمواثيق.. بل ولو استلزم ذلك الكذب على رسول الله «صلى الله عليه
وآله» حين كان خالد يحاول إسكات الأصوات المرتفعة بالنكير عليه، حيث
زعم لعبد الرحمن بن عوف: أنه إنما قتلهم امتثالاً لأمر النبي «صلى الله
عليه وآله» الصادر إليه فيهم.. فكذبه عبد الرحمن في هذه الدعوى، وظهر
كذبه فيها أيضاً من إعلان رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالقول ـ
ثلاث مرات ـ اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد..
وقد جاء في حديث إغارة خالد على حي
أبي زاهر الأسدي:
أن علياً «عليه السلام»أمر بنسخ ما أصيب لهم، فكتبوا.
ثم أعطاهم المال.
قال ابن شهرآشوب في آخر قصة أبي
زاهر:
«ونحو ذلك روي أيضاً في بني جذيمة»([9]).
ونقول:
إن لكتابة الخسائر العديد من الأهداف والمقاصد، نذكر
منها:
1 ـ
أن ذلك يمثل ضمانة لحفظ حقوق الناس.
2 ـ
إنه يبعد عملية معالجة هذا الأمر عن أجواء الفوضى.
3 ـ
إنه يمنع من تحايل البعض للحصول على ما لا حق لهم به.
4 ـ
يمثل درساً عملياً في نظم الأعمال وضبطها.
5 ـ
إنه إذا أعطاهم بصورةعشوائية فذلك يفسح المجال أمام ذوي
الأغراض السيئة، لإشاعة الإتهام له «عليه السلام» بعدم رعاية العدل
والإنصاف، وقد يزعزع ذلك الثقة لدى بعض الضعفاء ممن لا يملكون الوعي
الكافي، وتخدعهم أو تؤثر عليهم الشائعات.
6 ـ
قد يهيء ذلك أجواء غير سليمة بين بني جذيمة أنفسهم، حيث
قد يتهم بعضهم بعضاً في أمر الأموال، ويصير بعضهم يرصد حركة البعض
الآخر، ويشيع سوء الظن، والتحاسد فيما بينهم.
7 ـ
والأهم من ذلك كله وسواه: ما رواه سليمان بن جعفر
الجعفري، عن الإمام الرضا «عليه السلام» حين رأى غلمانه وهم يعملون
بالطين أواري الدواب([10])،
وغير ذلك، وإذا معهم أسود ليس منهم، فسألهم عنه فقالوا: يعمل معنا،
ونعطيه شيأً.
قال:
قاطعتموه على أجرته؟!
فقالوا:
لا، هو يرضى منا بما نعطيه.
فأقبل عليهم يضربهم بالسوط، وغضب لذلك غضباً شديداً.
فقلت:
جعلت فداك، لم تدخل على نفسك.
فقال:
إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة، أن يعمل معهم أحد
حتى يقاطعوه أجرته.
واعلم:
أنه ما من أحد يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة، ثم زدته لذلك
الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصته أجرته.
وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته، حمدك على الوفاء، فإن
زدته حبة عرف ذلك لك، ورأى أنك قد زدته([11]).
فهذا التوجيه الكريم هام جداً، ويتعين الالتزام به في
قضية بني جذيمة، التي يراد فيها القضاء عن ذمة الله ورسوله، ومعالجة
آثار كارثة تتجاوز في نتائجها وتبعاتها حدود الخسائر المادية، لتنال
الأنفس البريئة، وقتل الأجنة.
هذا بالإضافة إلى روعات النساء، وفزع الصبيان.. وغير
ذلك من أمور لا بد من معالجتها، وسل سخيمة أولئك الناس الذين وقعوا
ضحية قضاء الجاهلية، وأحقادها، وإحنها، وعصبياتها البغيضة.
كل ذلك من أجل حفظ إيمان الناس، من أن يتعرض لأي كدورة
أو اختلال.. ومن أجل إقامة صرح العدل، وإعطاء كل ذي حق حقه..
وقد يسأل أحدهم:
إنه إذا كان بنو جذيمة بأسفل مكة، على ليلة منها نحو
يلملم([12]).
إلى جهة اليمن، فكيف يمكن أن يغزوهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» في
السنة الرابعة، أو الخامسة، أو السادسة.. في حين أن الهيمنة على
المنطقة كانت لقريش، وكانت لها تحالفات وارتباطات مع مختلف القبائل
فيها..
ونحن.. وإن كنا نرى:
أن سراياه التي كان «صلى الله عليه وآله» يرسلها في كل
اتجاه، قد أضعفت علاقة تلك القبائل بقريش، وزعزعت تحالفها معها،
وحولتها في العديد من الموارد إلى تحالفات مع المسلمين، ولكن ذلك لا
يصلح جواباً على السؤال عن الوسيلة التي مكنت النبي «صلى الله عليه
وآله» من الوصول إلى هذه المنطقة التي تقع مكة على طريقها، فإن ذلك لا
بد أن يكون محفوفاً بالمخاطر الكبيرة، إلا إذا كان «صلى الله عليه
وآله» قد سلك إليهم طرقاً غير مألوفة، مكنته من أن يتحاشى المرور من
المناطق المأهولة.
ولعل مما يسهل عليه هذا الأمر:
أنه «صلى الله عليه وآله» لم يكن بحاجة إلى استنفار
الناس في المنطقة، ولا كان يريد جمع أعداد كبيرة من المقاتلين، بل كان
يكتفي ببضع عشرات، أو مئات، يقدرون على إنجاز المهمات الموكلة إليهم
بسرعة، وبمزيد من التكتم والإنضباط.
على أن من الجائز أن يكون هؤلاء القوم كانوا أولاً على
ماء المريسيع، قرب قديد، على الساحل بالقرب من مكة.. حيث هاجمهم حين
علم بجمعهم في المرة الأولى، وأعلنوا له آنئذٍ إسلامهم، وأعطاهم بذلك
كتاباً.. ثم انتقلوا من موضعهم ذاك إلى ماء الغميصاء، بين مكة ويلملم،
حيث جرى عليهم من خالد بعد ذلك ما جرى، فإن العرب كانوا ينتقلون من
مكان إلى آخر طلباً للماء والكلأ، بحسب ما يقتضيه الحال.
هذا.. وقد ذكرت الروايات:
الأسباب التي دعت علياً «عليه السلام» إلى إعطاء المال
لبني جذيمة، ونحن نعرضها وفق ما أشارت إليه النصوص، كما يلي:
1 ـ
أعطى لكل دم دية.
2 ـ
رد مثل متاعهم عليهم، وأما نفس المتاع، فقد ذهب،
فاقتسمه المسلمون، فلا سبيل إلى رده عينه (وقد ورد ذلك في حديث إغارة
خالد على حي أبي زاهر الأسدي، حيث قال ابن شهرآشوب: إنه قد روي نحو ذلك
في بني جذيمة).
3 ـ
أعطاهم إحتياطاً لرسول الله «صلى الله عليه وآله» مما
يعلمون، ومما لا يعلمون.
4 ـ
وفي نص آخر: أعطاهم على أن يحلوا رسول الله «صلى الله
عليه وآله» مما علم، ومما لا يعلم.
5 ـ
ليرضوا عن رسول الله «صلى الله عليه وآله».
6 ـ
لروعة نسائهم، وفزع صبيانهم.
7 ـ
قضاء، لذمة الله، وذمة رسوله.
8 ـ
أعطاهم كسوة عيالهم، وخدمهم، ليفرحوا بقدر ما حزنوا
(كما ورد في حديث إغارة خالد على حي أبي زاهر الأسدي، حيث قال ابن
شهرآشوب: ونحو ذلك روي أيضاً في بني جذيمة).
9 ـ
لكل جنين غرة.
10 ـ
لكل مال مالاً.
11 ـ
لميلغة كلبهم، وحبلة رعاتهم.
وما نريد أن نقوله هنا هو:
أن مجموع هذه النصوص يشير إلى أمور عديدة، كلها على
جانب كبير من الأهمية، فلاحظ ما يلي:
ألف:
إن ذلك يدل على: أن الذين قتلوا لم يكونوا جميعاً من
الكبار والبالغين، بل كان فيهم أجنة أيضاً، ولذلك أعطى علي «عليه
السلام» لكل جنين غرة. والغُرَّة ـ بالضم ـ عبد أو أمة.
ومنه:
قضى رسول الله «صلى الله عليه وآله» في الجنين بغرة.
وقال الفقهاء:
الغرة من العبد الذي ثمنه عشر الدية([13]).
وزعم بعضهم:
أن الغرة من العبيد الذي يكون ثمنه
نصف عشر الدية([14]).
وفي هذا التعبير ـ أعني قوله:
«لكل جنين غرة» ـ: إشارة ضمنية إلى تعدد، أو كثرة
القتلى من الأجنة، حتى ذكرهم أمير المؤمنين «عليه السلام» إلى جانب
ديات البالغين..
ثم إنه لم يتضح إن كان هناك قتلى من النساء أو لم يكن..
ولكن روعاتهن كانت واضحة.
ب:
إن علياً «عليه السلام» قد أعطى مالاً لروعات النساء،
وعوضاً عما أصابهن من الحزن، وصرح: بأن المطلوب هو: أن يفرحوا بقدر ما
حزنوا.
وهذا تأصيل لمعنى جديد لا بد من مراعاته في مجالات
التعامل مع الناس، ولم يكن هذا المعنى معروفاً، ولا مألوفاً قبل هذه
الحادثة.. كما أننا لم نجد أحداً قد راعى هذا المعنى في معالجته لآثار
العدوان على الآخرين.
ولعل قول النبي «صلى الله عليه وآله» لعلي «عليه
السلام»: «يا علي، اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك».
يشير إلى هذا المعنى، ولا يختص ذلك بموضوع مقادير
الديات، أو ما يرتبط بالثأر من غير القاتل الحقيقي.
بل إن الفقهاء وعلى مدى كل هذا التاريخ الطويل لم
يشيروا في فتاواهم، ولو إلى رجحان التعرض لمعالجة هذا النوع من الآثار،
ولا رسموا له حدوداً، ولا بينوا له أحكاماً، ولا حددواً له شروطاً!!
فهل هذه غفلة كانت منهم؟!
أم أنهم فهموا:
أن ذلك مما يختص بالمعصوم، من نبي وإمام؟! أم ماذا؟!
ج:
يلاحظ: أن علياً «عليه السلام»، قد بذل لبني جذيمة
أموالاً من أجل أن يفرحوا بقدر ما حزنوا.
أي أنه «عليه السلام» قد لاحظ مقدار الحزن، ومقدار
الفرح، وأراد أن يكون هذا بقدر ذاك، ولذلك لم يقل : «ليفرحوا بعد ما
حزنوا». بل قال: «ليفرحوا بقدر ما حزنوا ».
د:
إن سرد ما اعطاه علي «عليه السلام» لبني جذيمة يصلح أن
يكون هو الوصف الدقيق لحقيقة ما جرى على هؤلاء الناس من قتل وسلب وخوف.
فهم قد سلبوهم كل شيء. حتى حبلة الرعاة، وميلغة الكلب، ولم يتركوا لهم
حتى كسوة العيال والخدم.. وأخذوا منهم ما يعلمون، وما لا يعلمون.
بالإضافة إلى قتل الرجال، وإسقاط الأجنة، وروعة النساء،
وفزع الصبيان، وحزن العيال والخدم.
هـ:
وقد صرحت الكلمات الواردة في الروايات: بأن علياً «عليه
السلام» يريد أن يقضي عن ذمة الله ورسوله. أي أن الذين قتلهم خالد، قد
كانوا في ضمان ذمة الله، وذمة الرسول «صلى الله عليه وآله».
ولعل هذا يؤيد صحة القول:
بأنه كان لديهم كتاب من رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، يضمن لهم سلامتهم، وأمنهم، ويعتبرهم في ذمة الله ورسوله.
وعدوان خالد عليهم يعتبر إخلالاً بهذه الذمة، وهذا يحتم
الوفاء بها، وإعادة الأمور إلى نصابها.
بل قد يقال:
إن هذا التعبير يدل على: أنه لو أن أحداً من غير
المسلمين اعتدى على بني جذيمة لوجب نصرهم، وتحمل مسؤولية التعويض عليهم
كل نقص يعرض لهم، في الأموال والأنفس على حد سواء..
و:
قد ذكرت النصوص المتقدمة: أنه «عليه السلام» أعطاهم
مقداراً من المال، ليرضوا عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، مع
العلم: بأن السخط على الرسول «صلى الله عليه وآله» من موجبات الكفر
والخروج من الدين.
ومع أن السخط والرضا لا يشترى ولا يعطى بالمال، فكيف
نفهم هذا الإجراء منه «عليه السلام»؟!
ولعل من المفيد أن نقول في الإجابة عن ذلك:
إن المراد بالرضا هنا ليس ما يقابل السخط، بل المراد
به:
الشعور بالرضا، بعد الشعور بالحاجة إلى الإنصاف،
وبضرورة إيصال حقهم إليهم..
فإذا رأوا علياً «عليه السلام» قد اعطاهم فوق ما لهم من
حق، فلابد أن يتكون لديهم شعور باستعادة كامل حقوقهم، وبما فوق مستوى
الإنصاف والعدل الذي يتوقعونه أو ينتظرونه..
وهذا معناه:
أنه «عليه السلام» لم يشتر رضاهم بالمال.. بل هو قد
وفاهم حقهم، حتى تكوَّن لديهم الشعور بالرضا بهذا الوفاء.
ز:
إن تخصيص جزء من المال لما يعلمون، وما لا يعلمون. قد
يكون من أهم الأمور التي تبلِّغهم درجات ذلك الرضا بأكمل وجوهه،
وأتمها، فإن هناك أموراً قد يفقدها الإنسان، ولكنها تكون من الصغر،
والتفاهة إلى حد يرى أن مطالبته بها تنقص من قدره، وتحط من مقامه،
فيعرض عنها.
ولكنه حتى حين يغض النظر عنها قد يبقى لديه شعور
بالانتقاص من حقه، أو فقل بعدم بلوغه درجة الإشباع.
فإذا رضخ علي «عليه السلام» له مالاً في مقابل تلك
الأمور أيضاً، فإنه لا يبقى مجال لأي خاطر يعكر صفو الشعور بالإرتواء
التام..
فإذا زاد على ذلك:
أن أعطاه أموالاً في مقابل ما ربما يكون قد عجز عن
استحضاره في ذهنه، فإنه سينتقل إلى مرحلة الشعور بالامتنان. والإحساس
بمزيد من اللطف به، والتفضل عليه، والنظر إليه، والشعور معه..
حكم علي
 حكم الله تعالى:
حكم الله تعالى:
وقد صرحت الروايات المتقدمة:
بأن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أمر علياً «عليه
السلام» بأن يضع قضاء الجاهلية تحت قدميه.. أي أنه «صلى الله عليه
وآله» يعلن أن خالداً قد قضى في بني جذيمة بحكم الجاهلية..
وذلك يكذب ما زعمه خالد:
من أنه قد نفذ أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله»
فيهم.. حسبما تقدم. كما كذَّبه قبل ذلك حين أعلن ثلاث مرات براءته مما
صنع خالد.
ويكذِّب أيضاً رواية محبي خالد:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان راضياً، ولم يعترض
على فعله، ولم تسقط منزلته عنده.. فإن النبي الأعظم والأكرم «صلى الله
عليه وآله» لا يمكن أن يرضى بما يكون من قضاء الجاهلية، ولا يمكن أن
يرضى بما يعلن أنه بري إلى الله منه..
وفي المقابل نجد علياً «عليه السلام» كما يصرح به
الإمام الباقر «عليه السلام»: لما انتهى إلى بني جذيمة «حكم فيهم بحكم
الله».
وهذا صريح:
بأن جميع ما فعله علي «عليه السلام» إنما هو إجراء لحكم
الله تعالى، وليس مجرد تبرعات منه «عليه السلام»، تستند إلى الاستحسان،
أو إلى تفاعل أو اندفاع عاطفي آني، أو رغبة أذكتها العصبية للقربى، أو
محبة أكدتها علاقة المودة والإلف بينه وبين ابن عمه نبي الله «صلى الله
عليه وآله».. بل ما فعله كان ـ كما قلنا ـ إجراء وتنفيذاً لحكم الله
تبارك وتعالى، من دون تأثر بهوى، أو ميل مع عصبية أو عاطفة..
ويؤكد هذا المعنى:
أن المال الذي حمله «عليه السلام» معه إليهم، سواء أكان
مُلْكاً شخصياً للنبي «صلى الله عليه وآله»، أو كان من بيت مال
المسلمين، لا يجوز له الإسراف والتبذير فيه، فضلاً عن تمزيقه وتفريقه
وفق ما يقود إليه الهوى، وما يرجحه الذوق والاستنساب، وتدعو إليه
العاطفة والإنفعالات الشخصية.
وقد قال رجل من بني جذيمة:
جزى
الله عنا مدلجاً حيث أصبحت جزاءة بؤسى حيث سارت وحلت
أقاموا على أقضاضنـا يقسمونهـا وقـد نهـلـت فينـا الرماح
وعلت
فــوالله لــولا ديـن آل محــمــد لقـد هربـت منهم خيول فشلت([15])
ونقول:
إننا نسجل هنا:
1 ـ
إن هذا القائل قد بيَّن أن تمسك بني جذيمة بدين الإسلام
هو الذي منعهم من مهاجمة خالد ومن معه، وهو الذي دعاهم إلى إلقاء
السلاح، ثم القبول بأن يكتف بعضهم بعضاً.. ولولا ذلك لكانت لهم صولات
توقع الهزيمة الحتمية على الذين قتلوهم.
2 ـ
إن هذا الشعر قد تضمن تصريحاً بأن هؤلاء القوم كانوا
يلتزمون بدين آل محمد..
وهذا معناه:
أن آل محمد كانوا جزءاً من هذا الدين، وكانوا أعلامه،
وقادته ورواده، وعنهم تؤخذ معالم الدين ومفاهيمه، وشرائعه. وأن ذلك كان
معروفاً منذ ذلك الزمن. ولا ندري إن كان «صلى الله عليه وآله» قد سجل
عليهم في الكتاب الذي أعطاهم إياه، فقد وجدنا لهذا نظائر في تاريخ
الإسلام، فإنه «صلى الله عليه وآله» كتب لأهل مقنا: «وليس عليكم أميرٌ
إلا من أنفسكم، أو من آل بيت رسول الله..»([16]).
3 ـ
إن هذه الأبيات قد نسبت دين الإسلام كله إلى آل محمد،
فإن الشاعر لم يقل: لولا محمد.
بل قال:
لولا دين آل محمد.
وفي ذلك دلالة ظاهرة على ما قلناه..
وفي مقابل ذلك:
لم نجد أحداً يقول: لولا دين أبي بكر وعمر لكان كذا..
لا في زمن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولا بعده.
1 ـ
إن من أهم الأوسمة التي أعلن عنها رسول الله «صلى الله
عليه وآله» فيما يرتبط بما جرى لبني جذيمة، هو قوله «صلى الله عليه
وآله» لعلي «عليه السلام»، حسبما روي عن الإمام الباقر «عليه السلام»:
« أنت مني بمزلة هارون من موسى»([17]).
وهي كلمة قالها رسول الله «صلى الله عليه وآله» لأمير
المؤمنين «عليه السلام» في أكثر من مناسبة، أشهرها: حين تجهز «صلى الله
عليه وآله» لغزو تبوك، وتخلف عنه جمع من المنافقين في المدينة انتظاراً
للفرصة، وأملاً بإنجاز مؤامرتهم الشريرة، وسعياً لتحقيق نواياهم
المشؤومة.
فإنه «صلى الله عليه وآله» قرر:
أن يبقي علياً «عليه السلام» على المدينة مدة غيبته.
فتضايق المتآمرون من المنافقين، وتضايق معهم من لف
لفهم، ممن كان عازماً على المسير أيضاً، لكي يبقوا على مقربة من
المستجدات والتحولات، وليمكنهم التدخل في الوقت المناسب في مسار
الأحداث، وانتهاز الفرص واقتناصها، إن أمكن. أو دفع ما يرون فيه خطراً
على مشاريعهم التآمرية التي يعدون لها العدة. كما أظهرته الوقائع
اللاحقة.
وكان إبقاء علي «عليه السلام» في المدينة مخيفاً لهم،
فحاولوا أن يطلقوا شائعات حول القرار بإبقاء علي «عليه السلام»، من
شأنها أن تمس الكرامة، وتؤذي العنفوان، من قبيل قولهم: إنه «صلى الله
عليه وآله» خلَّف علياً «عليه السلام» استثقالاً له([18]).
أو قولهم:
خلفه في النساء والصبيان([19]).
أو:
كره صحبته([20]).
أو:
مله وكره صحبته([21]).
أو:
استثقله وكره صحبته([22]).
أو:
سئمه وكره صحبته([23]).
وجاء الرد الإلهي الحاسم والحازم ليقول رسول الله «صلى
الله عليه وآله» لعلي «عليه السلام»: أنت مني بمنزلة هارون من موسى.
2 ـ
وعن منزلة هارون من موسى نقول:
ألف:
إن منزلة هارون من موسى، كما أشارت إليه آيات القرآن
الكريم: هي أنه وزيره. وذلك بجعل من الله سبحانه، فإن الله جعل هارون
وزيراً لموسى:
{..وَجَعَلْنَا
مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيراً}
([24]).
أنه شد أزر النبي، وشد عضده.
أنه شريكه في أمر الدين، ونشره، وإبلاغه، وحفظه وفي كل
شيء سوى النبوة.
أنه من أهله، فقد قال تعالى على لسان موسى «عليه
السلام»:
{وَاجْعَل
لِّي وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي
وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي}
([25]).
وقال تعالى:
{قَالَ
سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ..
}
([26]).
أنه ردءٌ للنبي.
أنه يصدق النبي، فقد قال تعالى حكاية عن موسى:
{فَأَرْسِلْهُ
مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ}
([27]).
أنه خليفته في قومه..
أن مهمته هي الإصلاح في أولئك القوم..
قال تعالى حكاية عن لسان موسى «عليه السلام»:
{اخْلُفْنِي
فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ المُفْسِدِينَ}
([28]).
ب:
قال العلامة الطباطائي «رحمه الله»
عن نبي الله هارون «عليه السلام»: «أشركه الله تعالى مع موسى «عليهما
السلام» في سورة الصافات: في المنّ، وإيتاء الكتاب، والهداية إلى
الصراط المستقيم، وفي التسليم، وأنه من المحسنين، ومن عباده المؤمنين
[الصافات: 114 ـ 122] وعده مرسلاً [طه: 47]، ونبياً [مريم: 53]، وأنه
ممن أنعم عليهم [مريم: 58]، وأشركه مع من عدهم من الأنبياء في سورة
الأنعام في صفاتهم الجميلة، من الإحسان، والصلاح، والفضل، والإجتباء،
والهداية [الأنعام: 84 ـ 88]» انتهى([29]).
ج:
ليس المراد بإشراكه في حفظ الدين، ونشره، وتبليغه، ما
هو على حد شراكة المؤمنين معه في ذلك من حيث إن وجوب التبليغ والإرشاد
والدعوة إلى الله، والدفاع عن الحق والدين وتعليم الأحكام يعم الجميع،
فيجب على الناس العاديين وعلى الأولياء والأنبياء أيضاً.. بل هي شراكة
خاصة في كل أمره «صلى الله عليه وآله» باستثناء نزول الوحي عليه، ونيل
درجة النبوة بصورة فعلية.
وتظهر آثار هذه الشراكة في وجوب طاعته «عليه السلام»،
وفي حجية قوله، وفي كل ما أعطاه الله إياه من علم خاص، ومن عرض أعمال
العباد عليه، ومن طاعة الجمادات له، ومن التصرفات والقدرات الخاصة، مثل
طي الأرض، ورؤيته من خلفه، وكونه تنام عيناه ولا ينام قلبه، والإسراء
والمعراج إلى السماوات لرؤية آيات الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك.
د:
إنه «عليه السلام» من أهل النبي «صلى الله عليه وآله»
والأهل يعيشون مع بعضهم بعفوية وشفافية ووضوح، فأهل النبي يشاهدون
أحواله، ويطَّلعون على أسراره، فإذا كان وزيره، وشريكه منهم، فإن
معرفته بكل هذه الأمور المعنوية تكون منطلقة من معرفته الواقعية بكل
حالاته وخفاياه، وباطنه وظاهره.. ولابد أن يدخل إلى ضمير هذا الوزير
والشريك وإلى خلجات نفسه، وحنايا روحه، ويلامس شغاف قلبه بصفته نبياً
مقدساً وطاهراً بكل ما لهذه الكلمة من معنى، ولا يريد لنفسه ردءاً
وشريكاً ووزيراً بعيداً عنه، قد يفرض غموضه احترامه عليه، أو يخشى
ويحذر ما يجهله منه..
إن هذا الإشراف المباشر على حالات هذا النبي، والعيش
معه بعفوية الأهل والأحبة ومن دون أن يكون هناك أي داع لتحفظه معهم، أو
للتحفظ معه.. يعطي للإنسان السكينة والطمأنينة إلى صحة الرؤية، وسلامة
المعرفة، وواقعيتها، فيترسخ الإيمان بصحة نبوته في العقل، ويتبلور
صفاؤه في الوجدان، ويتجذر طهره في أعماق النفس، وينساب هداه في الروح
والضمير إنسياب الدم في العروق..
وهذه خصوصية لا يمكن أن توجد إلا لدى الأنبياء «عليهم
السلام»، ومن هم في خطهم من الأولياء، والخلّص من المؤمنين..
أما من عداهم من أهل الدنيا.. فلا يمكن أن تستقيم لهم
الأمور إلا بوضع الحجب، وإنشاء السدود والحواجز أمام الناس، حتى أقرب
الناس إليهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم فضلاً عن غيرهم.. ومنعهم من
المعرفة بحقيقة سلوكهم، وبواقع نواياهم، وبما تكنّه ضمائرهم.. لأن
معرفة الناس بذلك سوف تجر لهم الداء الدوي، والبلاء الظاهر والخفي..
هـ:
وأما الأخوّة التي ينشدها النبي في الوزير: فقد تعني
فيما تعنيه الأمور التالية:
أولاً:
المساواة.. والإشتراك.. والمماثلة في الميزات.. والشبه
في الصفات..
ولذلك نلاحظ:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» كما ذكر المؤرخون كان
يؤاخي بين كل ونظيره، ممن هو أقرب الناس إليه في الخُلُق، وفي السيرة،
وفي الطموح، وفي المستوى الفكري والعقلي، وسائر الصفات.
مع العلم:
بأننا لا نجد ملكاً يعترف لأي مخلوق، سواء أكان وزيراً
أو قريباً أو حتى ولداً بالمساواة معه في الصفات والأخلاق، وسائر
الميزات. بل هو يعطي لنفسه مقاماً متميزاً عن الناس كلهم، ويسعى لتعمية
الأمر على الناس، ويتوسل إلى ذلك بأساليب شتى من الإبهام والإيهام،
والإدّعاءات الزائفة، والمظاهر الخادعة.
ثانياً:
إن هذا التشابه أو التقارب في الميزات من شأنه: أن يفرض
تساوياً في الحقوق لكل منهما بالنسبة لأخيه الآخر.. وهذا مرفوض أيضاً
في منطق أهل الدنيا، فإن الرؤساء والملوك فيها، إن لم يجدوا لأنفسهم
خصوصية، فلابد من انتحالها، والتظاهر بما يوهم الخصوصية. كما ألمحنا
إليه..
فكيف يمكن أن يرضوا بالمساواة مع غيرهم في الحقوق
والمزايا؟!
و:
إن استثناء النبوة في كلام رسول الله «صلى الله عليه
وآله» عن وزارة علي «عليه السلام» يفيد: أن المراد بمنزلة هارون من
موسى: هو سائر مراتبها، ومختلف متعلقاتها. أي أن هذا الإستثناء يفيد
عموم المنزلة وشمولها لكل الأمور والجهات والمراتب، فهو بمنزلته في
لزوم الطاعة، وفي حجية قوله، وفي حاكميته، وفي القضاء، والعطاء،
والسلم، والحرب والسفر، والحضر، وفي الحياة، وبعد الممات.. وفي كل
شيء..
وتقدم:
أنه «صلى الله عليه وآله» قال لعلي «عليه السلام» في
هذه المناسبة: «أنت هادي أمتي. ألا إن السعيد كل السعيد من أحبك، وأخذ
بطريقتك. ألا إن الشقي كل الشقي من خالفك، ورغب عن طريقك إلى يوم
القيامة»([30]).
ونقول:
إن هذه الكلمة قد تضمنت ثلاثة أمور هامة وأساسية.. وهي:
1 ـ علي
 هادي أمة محمد
هادي أمة محمد
 : :
إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد
قرر في هذه المناسبة:
أن علياً «عليه السلام» هادي أمته.
وهذا يدل على:
أن ما أجراه «عليه السلام» في بني جذيمة ليس مجرد إيصال
بعض مال استحقه أولئك الناس عوضاً عن متاع سلب منهم، أو ديات لقتلى
سقطوا في عدوان تعرضوا له. بل هو أمر يرتبط بالهداية إلى الحق، وتعريف
الناس بما يرضي الله تبارك وتعالى..
فكيف يمكن فهم هذا الأمر من الوقائع التي جرت له «عليه
السلام» في مهمته تلك؟
إن الإجابة على هذا السؤال قد تكون من خلال ملاحظة
تنوّع العطاءات، وتنوّع أسبابها، حيث أظهرت: أن لروعات النساء، وفزع
الصبيان قيمة، وأنه لا بد من أن تودى الأجنة إذا أسقطت في مثل هذه
الحالات، وأنه لا بد من بذل الأموال لإبراء ذمة الله ورسوله، ولأجل ما
يعلمون، وما لا يعلمون.. وغير ذلك مما تقدم.. وتقدمت بعض الإشارات إلى
وجوهه وأسبابه..
وهي أمور لم تكن واضحة للناس، بل هي قد لا تخطر لأحد
منهم على بال..
وهي تدل على:
أنه «عليه السلام» هو الذي يدرك أسرار الشريعة،
ودقائقها، وكوامنها، ويعرف أهدافها، ومؤدياتها..
ولعل
مما يوضح ذلك:
أنه «عليه السلام» قد أعطى مالاً أيضاً من أجل أن يرضوا عن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، ليحفظ بذلك دينهم، ويصون إيمانهم.
وقد بيّن «صلى الله عليه وآله»
للناس:
أن حقيقة السعادة تُنال بأمرين:
أحدهما:
حب علي «عليه السلام».
والمقصود هو:
حبه «عليه السلام» كما هو، وعلى ما هو عليه، وهو الذي
يرضيه ما يرضي الله، ويغضبه ما يغضبه، فالسعيد هو من أحب علياً «عليه
السلام» حتى وهو يجري عليه وعلى أهله وولده أحكام الله تعالى، ويقيم
عليه وعليهم حدوده، ولا تؤثر إقامته لها عليه وعليهم في محبته وفي
إخلاصه وطاعته له، فهو يحبه حتى وهو يجلده، وحتى وهو يقتص من ولده
القاتل. أو يقطع يد ولده السارق.
أما حب علي «عليه السلام» لأنه شجاع مثلاً، فهو ليس
حباً لعلي «عليه السلام»، بل هو حب للشجاعة فقط، فهو يحبها حتى لو ظهرت
لدى أعداء الله ورسوله. وأعداء الإنسانية.. فهذا الحب لا ينفع صاحبه
ولا يسعده برضا الله تبارك وتعالى.
الثاني:
الأخذ بطريقة علي «عليه السلام».. أي أن العمل الجوارحي
يجب أن ينسجم مع المشاعر، ويستجيب لدعوتها أيضاً.. فالحب لعلي «عليه
السلام» يدعو إلى التأسي والإقتداء وبدون ذلك، فإن الحب يبقى عقيماً،
ليس له أي امتداد أو قيمة، أو ما يوجب له البقاء.
غير أن الملاحظ هنا:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد تحدث عن الأخذ بطريقة علي
«عليه السلام»، ولم يأمر بأن يعمل نفس عمل علي «عليه السلام» بحيث يكون
للعمل نفس قيمة وخصوصيات عمل علي «عليه السلام»، ونفس درجته في
الإخلاص، والخلوص، والمثوبة، وسائر الآثار، بل المطلوب هو: أن يتبع
المؤمن سبيله، وطريقته «عليه السلام»، وإن لم تتحقق المماثلة لها في
سائر الخصوصيات والآثار.
ولذلك نلاحظ:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد رتب الشقاء على مخالفة
طريقة علي «عليه السلام»، لا على فقدان الأعمال لخصوصيات وآثار وقيمة،
وخصائص عمل علي «عليه السلام».
وذلك لطف آخر من الله ورسوله بالعباد، ولهذا البحث مجال
آخر.
([1])
مناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء سنة 1412 هـ) ج1 ص150 و 151
و (ط المكتبة الحيدرية) ج1 ص395 والبحار ج38 ص73.
([2])
الأمالي للشيخ الصدوق (ط سنة 1389 هـ) ص152 و 153 و (ط مؤسسة
البعثة) ص238 والبحار ج21 ص142 و ج101 ص423 و 424 ومستدرك
الوسائل ج18 ص366 و 367 وعلل الشرائع (ط سنة 1385 هـ) ج2 ص473
و 474 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص486 وموسوعة أحاديث أهل البيت
«عليهم السلام» ج11 ص80 وغاية المرام ج2 ص76.
([3])
الأمالي للشيخ الطوسي (ط سنة 1414 هـ) ص498 والبحار ج21 ص143
وموسوعة أحاديث أهل البيت «عليهم السلام» ج11 ص219.
([4])
أي أنه أعطى بني جذيمة مالاً لأجل ميلغة الكلب، وعقال البعير.
([5])
الخصال ج2 ص562 والبحار ج1 ص141 و 327.
([6])
راجع: مكاتيب الرسول ج1 ص228 عن السيرة الحلبية ج2 ص293 و (ط
دار المعرفة) ص583 ومعجم قبائل العرب، ونهاية الإرب، والروض
الأنف ج2 ص17. والمنمق ص127 و 200 و 230 ولب اللباب في تحرير
الأنساب ص246.
([7])
راجع: مكاتيب الرسول ج1 ص228 وأشار في هامشه إلى: تاريخ الأمم
والملوك ج2 ص204 والسيرة الحلبية ج2 ص293 وصحيح البخاري ج5
ص147 وإلى الكامل في التاريخ ج2 ص192 والبداية والنهاية ج4
ص156 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص192 والروض الأنف ج2 ص17
وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ج2 ص96 وراجع: المجموع للنووي
ج19ص306 ووتكملة حاشية رد المحتار ج1 ص266 ونيل الأوطار
للشوكاني ج8 ص150 وفقه السنة ج2 ص687 والغارات للثقفي ج2 ص817
والبحار ج20 ص290 و 296 وميزان الحكمة ج4 ص3240 ومسند أحمد ج6
ص277 وسنن أبي داود ج2 ص235 و 236 والمستدرك للحاكم ج4 ص26 و
27 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص75 ومسند ابن راهويه ج2 ص217 وج4
ص37 وصحيح ابن حبان ج9 ص362 ونصب الراية ج6 ص550 وموارد الظمآن
ج4 ص125 والطبقات الكبرى لابن سعد ج8 ص117 والثقات لابن حبان
ج1 ص289 والإصابة ج8 ص73 والمنتخب من ذيل المذيل ص101 وتاريخ
الأمم والملوك ج2 ص264 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص33
وإمتاع الأسماع ج13 ص314 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص263 .
([8])
المنمق لابن حبيب ص226 و 246.
([9])
مناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء سنة 1412 هـ) ج1 ص151 و (ط
المكتبة الحيدرية) ص395 والبحار ج38 ص73 ومكاتيب الرسول ج1
ص244.
([10])
الأواري: جمع آري، وهو محبس الدابة، ويطلق أيضاً على معلف
الدابة أنه آري.
([11])
الكافي ج5 ص288 و 289 والبحار ج49 ص106 والحدائق الناضرة ج21
ص577 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج19 ص104 و (ط دار
الإسلامية) ج13 ص245 وتهذيب الأحكام ج7 ص212 وجامع أحاديث
الشيعة ج19 ص15 ودرر الأخبار ص368 ومسند الإمام الرضا «عليه
السلام» ج2 ص301 و 302 وتذكرة الفقهاء (ط ق) ج2 ص301.
([12])
التنبيه والإشراف ص234.
([13])
راجع: مجمع البحرين ج3
ص422 و (مكتب نشر الثقافة الإسلامية) ج3 ص302.
([14])
أقرب الموارد ج2 ص867 وراجع: عمدة القاري ج24 ص67 وتحفة
الأحوذي ج4 ص554 ومرقاة المفاتيح ج7 ص40 والنهاية في غريب
الأثر ج3 ص353 وكتاب الكليات ج1 ص670 والتعريفات للجرجاني ج1
ص208.
([15])
السيرة النبوية لابن هشام ج4 ص77 و (ط مكتبة محمد علي صبيح)
ص887.
([16])
راجع: مكاتيب الرسول ج3 ص103 و 106والطبقات الكبرى لابن سعد ج1
ص277 وفتوح البلدان للبلاذري (ط سنة 138 هـ) ص67 و (ط مكتبة
النهضة المصرية) ج1 ص72.
([17])
الهداية للشيخ الصدوق ص157 و 158 و 160 و 162 والمقنعة للشيخ
المفيد ص18 ورسائل الشريف المرتضى ج1 ص333 وج4 ص76 والإقتصاد
للشيخ الطوسي ص222 و 225 والرسائل العشر للشيخ الطوسي ص114
وإشارة السبق لأبي المجد الحلبي ص53 والحدائق الناضرة ج8 ص 512
ونخبة الأزهار للسبحاني ص160 والخلل في الصلاة للسيد مصطفى
الخميني ص130 وكتاب الطهارة للسيد الخميني ج2 ص128 والمحاسن
للبرقى ج1 ص159 والكافي ج8 ص107 وعلل الشرائع ج1 ص222 وج2 ص474
وعيون أخبار الرضا «عليه السلام» ج1 ص208 وج2 ص210 والخصال
ص211 و 311 و 554 و 572 والأمالي للشيخ الصدوق ص238 و 402 و
491 و 618 وكمال الدين وتمام النعمة ص278 ومعاني الأخبار للشيخ
الصدوق ص74 و 75 و 77 و 78 و 79 وتحف العقول ص430 و 459 وتهذيب
الأحكام ج1 ص27 وج10 ص41 وروضة الواعظين للفتال النيسابوري ص89
وشرح أصول الكافي ج5 ص199 وج6 ص110 وج9 ص122 وج12 ص39 و 41
والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج11 ص32 و (ط دار الإسلامية) ج8
ص21 ومستدرك الوسـائل ج18 ص367 وكتـاب سليم بن قيـس (تحقيق = =
محمد باقر الأنصاري) ص167 و 195 و 201 و 204 و 299 و 305 و
314 و 322 و 400 و 408 و 414 و 422 و 458 والغارات للثقفي ج1
ص62 وج2 ص745 و 767 ومناقب أمير المؤمنين «عليه السلام» لمحمد
بن سليمان الكوفي ج1 ص224 و 301 و 317 و 459 و 499 و 501 و 502
و 503 و 508 و 510 و 511 و 512 و 519 و 520 و 522 و 523 و 524
و 527 و 529 و 534 و 539 و 540 و 541 وج2 ص516 المسترشد للطبري
ص67 و 335 و 440 و 441 و 446 و 454 و 459 و 460 و 621 ودلائل
الإمامة للطبري ص124 وشرح الأخبار ج1 ص97 و 319 وج2 ص177 و 186
و 250 و 477 وج3 ص202 ومائة منقبة لمحمد بن أحمد القمي ص92 و
160 والفصول المختارة للشيخ المفيد ص28 و 252 والإفصاح للشيخ
المفيد ص33 والنكت الإعتقادية للشيخ المفيد ص38 و 42 والنكت في
مقدمات الأصول للشيخ المفيد ص47 و 47 والإرشاد للشيخ المفيد ج1
ص8 والأمالي للشيخ المفيد ص19 والأمالي للسيد المرتضى ج4 ص186
وكنزالفوائد ص274 و 275 ـ 283 والأمالي للشيخ الطوسي ص227 و
253 و 333 و 351 و 548 و 555 و 560 والإحتجاج للطبرسي ج1 ص155
و 162 و 163 و 197 و 216 و 218 و 233 و 247 و 278 وج2 ص8
ومناقب آل أبي طالب ج1 ص3 و 4 و 190 وج2 ص37 و 219 و 302 وج3
ص44 و 46 و 60 والعمدة لابن البطريق ص13 و 97 و 126 ـ 137 و
144 و 183 و 214 و 258 و 337 والمزار لمحمد بن المشهدي ص576
والفضائل لشاذان بن جبرئيل القمي ص152 وسعد السعود لابن طاووس
ص43 وإقبال الأعمال ج1 ص506 واليقين لابن طاووس ص208 و 448
والطرائف لابن طاووس ص51 ـ 54 و 63 و 151 و 277 و 414 و 521
والصراط المستقيم ج1 ص61 و 101 و 207 ـ 323 وج2 ص47 و 64 و 87
وج3 ص78 = = والمحتضر لحسن بن سليمان الحلي ص96 ووصول الأخيار
إلى أصول الأخبار لوالد البهائي العاملي ص54 وكتاب الأربعين
للشيرازي ص98 ـ103 و 190 و 222 وحلية الأبرار للسيد هاشم
البحراني ص80 و 327 و 338 و 424 ومدينة المعاجز ج2 ص420
والبحار ج5 ص69 وج8 ص1 وج16 ص412 و413 وج21 ص142 وج25 ص224
وج26 ص3 وج28 ص45 و 55 و 222 و 350 وج29 ص83 و 606 وج31 ص316 و
333 و 351 و 362 و 368 و 371 و 376 و 414 و 417 و 429 و 433
وج32 ص487 و 617 وج33 و 149 و 154 و 176 و 183 وج35 و 58 و 275
وج36 ص331 و 418 وج37 ص254 ـ و305 وج38 ص123 و 240 و 246 و 247
و 331 و 334 ـ 338 و 341 و 342 وج39 ص20 و 21 و 28 و 59 و 62 و
85 وج40 ص2 و 9 و 10 و 43 و 78 و 88 و 95 وج42 ص155 وج44 ص23 و
35 و 63 وج49 ص200 و 209 و 229 وج64 ص148 و 194 وج68 ص65 وج69
ص146 و 155 وج72 و 445 وج82 ص265 وج97 ص362 وج99 ص106 وج101
ص424 وكتاب الأربعين للشيخ الماحوزي ص79 و 81 و 82 و 137 و 146
و 236 و 239 و 342 و 435 و 443 ومناقب أهل البيت «عليه السلام»
للشيرواني ص106 و 133 ـ 135 و 201 و 216 و 220 و 446 وخلاصة
عبقات الأنوار للنقوي ج1 ص52 و 55 و 61 و 72 و 85 و 86 و 92 و
97 وج2 ص213 وج7 ص58 و 75 و 87 و 121 و 179 و 188 و 233 وج8
ص263 وج9 ص106 و 269 و 314 ونهاية الدراية للسيد حسن الصدر
ص131 و 133 والنص والإجتهاد ص491 و 564 والمراجعات ص200 و 204
و 209 و 210 و 283 و 310 و 389 وسبيل النجاة في تتمة المراجعات
لحسين الراضي ص117 و 213 و 276 ومقام الإمام علي «عليه السلام»
لنجم الدين العسكري ص13 و 18 و = = 19 و 30 و 33 والغدير ج1
ص39 و 197 و 198 و 208 و 212 و 213 و 297 و 396 وج2 ص108 وج3
ص115 و 201 و 228 وج4 ص63 و 65 وج5 ص295 وج6 ص333 وج10 ص104 و
258 و 259 وفدك في التاريخ للسيد محمد باقر الصدر ص27 ومستدرك
سفينة البحار ج7 ص229 وج8 ص231 وج10 ص29 و 30 و 31 و 55 ونهج
السعادة ج1 ص124 و 160 و 363 وج7 ص471 والإمام علي «عليه
السلام» لحمد الرحماني الهمداني ص253 و 282 و 307 و 586 وكلمات
الإمام الحسين «عليه السلام» للشيخ الشريفي ص272 ومسند الإمام
الرضا «عليه السلام» للعطاردي ج1 ص128 وج2 ص116 وأضواء على
الصحيحين للنجمي ص329 و 344 ومعالم المدرستين للعسكري ج1 ص296
و 316 وأحاديث أم المؤمنين عائشة للعسكري ج1 ص245 ومكاتيب
الرسول ج1 ص43 و 564 ومواقف الشيعة ج1 ص102 و 305 و 315 و 440
و 454 وج2 ص402 وج3 ص269 و 302 والمناظرات في الإمامة للشيخ
عبدالله الحسن ص5
و
101
و
109
و
112
و
116
و
165
و
166
و
169
و
213
و
215
و
237
و
238
و
259
و
332
و
475.
وفضائل الصحابة ص13 و 14 وصحيح مسلم ج7 ص120 وسنن الترمذي ج5
ص304 وشرح مسلم للنووي ج15 ص174 ومجمع الزوائد ج9 ص109 ـ 111
والديباج على مسلم للسيوطي ج5 ص386 وتحفة الأحوذي ج10 ص161
ومسند أبي داود ص29 والمعيار والموازنة للإسكافي ص219 و 220
والمصنف لابن أبي شيبة ج7 ص496 ومسند سعد بن أبي وقاص للدورقي
ص176 وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص13 والآحاد والمثاني ج5
ص172 وكتاب السنة لابن أبي عاصم ص551 و 586 ـ 588 و 595 و 596
ومجلسان من إملاء النسائي ص83 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص44 و
45 و 120 ـ 125 وخصـائص أمير = = المؤمنين «عليه السلام»
للنسائي ص77 ـ 79 و 84 و 85 و 89 ومسند أبي يعلى ج2 ص87 و 99
وجزء الحميري ص28 و 34 وأمالي المحاملي ص209 وحديث خيثمة بن
سليمان الأطرابلسي ص199 وصحيح ابن حبان ج15 ص369 والمعجم
الصغير ج2 ص22 و 54 والمعجم الأوسط ج3 ص139 وج5 ص287 وج6 ص77 و
83 وج7 ص311 والمعجم الكبير ج1 ص146 و 148 وج2 ص247 وج4 ص17 و
184 وج11 ص61 وج24 ص146 و 147 ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص252
وفوائد العراقيين للنقاش ص94 وشرح النهج للمعتزلي ج2 ص59 و 264
وج5 ص248 وج6 ص169 وج9 ص305 وج10 ص222 وج13 ص211 وج17 ص174
وج18 ص24 ودرر السمط في خبر السبط ص79 ونظم درر السمطين ص24 و
134 وكنز العمال وج5 ص724 وج9 ص167 و 170 وج11 ص599 و 607 وج13
ص106 و 123 و 124 و 151 و 163 و 192 وج16 ص186 وتذكرة
الموضوعات للفتني ص8 وكشف الخفاء للعجلوني ج2 ص384 و 420 ونظم
المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص195 وفتح الملك العلى
لأحمد بن الصديق المغربي ص109 و 154 وإرغام المبتدع الغبي لحسن
بن علي للسقاف ص59 وقاموس شتائم للسقاف ص198 ودفع الإرتياب عن
حديث الباب للعلوي ص33 وتفسير الإمام العسكري «عليه السلام»
ص250 وخصائص الوحى المبين لابن البطريق ص186 و 243 و 245
وتفسير نور الثقلين ج2 ص314 وتفسير القرطبي ج1 ص266 و 267 وعدة
الأصول (ط.ق) ج1 ص170 ورجال النجاشي ص94 و 233 و 401 والفهرست
لللطوسي ص74 ونقد الرجال للتفرشي ج3 ص176 والفوائد الرجالية
لبحر العلوم ج4 ص113 وطرائف المقال للبروجردي ج2 ص487 و 569
ومعجم رجال الحديث للسيد الخـوئي ج3 ص64 و 65 وج11 ص96 وج18
ص215 وتهـذيب المقـال = = للأبطحى ج3 ص489 وج5 ص432 والتاريخ
الكبير للبخاري ج1 ص115 ومعرفة الثقات للعجلي ج2 ص184 و 457
وضعفاء العقيلي ج2 ص47 والكامل لابن عدي ج2 ص142 و 315 وج3
ص207 وج6 ص68 و 216 وج7 ص39 وطبقات المحدثين بأصبهان لابن حبان
ج4 ص264 وعلل الدارقطني ج4 ص313 و 381 وتاريخ بغداد ج1 ص342
وج4 ص176 و 291 وج5 ص147 وج8 ص52 و 262 وج9 ص370 وج10 ص45 وج12
ص320 وتاريخ مدينة دمشق ج12 ص349 وج13 ص150 و 151 وج18 ص138
وج20 ص360 وج21 ص415 وج30 ص359 وج38 ص7 وج39 ص201 وج41 ص18
وج42 ص53 و 116 و 143 و 146 ـ 148 و 150 و 153 ـ و157 و 162 ـ
175 و 177 و 179 و 180 و 182 ـ 185 وج54 ص226 وج59 ص74 وج70
ص35 و 36 وأسد الغابة ج4 ص27 وج5 ص8 وذيل تاريخ بغداد لابن
النجار البغدادي ج4 ص209 وتهذيب الكمال للمزي ج5 ص577 وج8 ص443
وج14 ص407 وج20 ص483 وج32 ص482 وج35 ص263 وتذكرة الحفاظ ج1 ص10
و 217 وج2 ص523 وسير أعلام النبلاء ج7 ص362 وج13 ص341 وج14
ص210 وتهذيب التهذيب ج2 ص209 وج5 ص160 ج7 ص296 ولسان الميزان
ج2 ص414 والإصابة ج4 ص467 وأنساب الاشراف ص96 و 106 والجوهرة
في نسب الإمام علي وآله للبري ص14 و 15 وذكر أخبار إصبهان ج1
ص80 وج2 ص281 و 328 والبداية والنهاية ج7 ص376 و 378 وج8 ص84
ووقعة صفين للمنقري ص315 وبشارة المصطفى للطبري ص352 و 374 و
409 وإعلام الورى للطبرسي ج1 ص326 و 331 والمناقب للخوارزمي
ص55 و 61 و 129 و 133 و 140 و 158 و 301 وكشف الغمة ج1 ص63 و
79 و 123 و 292 و 342 وج2 ص24 ونهج الإيـمان = = لابن جبر ص68
و 119 و 379 ـ 405 و 531 و 616 و 658 والعدد القوية ص51 و 247
وكشف اليقين ص279 و 425 و 459 و 466 والنزاع والتخاصم للمقريزي
ص101 وجواهر المطالب في مناقب الإمام علي «عليه السلام» لابن
الدمشقي ج1 ص37 و 197 و 296 وسبل الهدى والرشاد ج11 ص292
وينابيع المودة للقندوزي ج1 ص137 و 156 و 157 و 158 و 162 و
240 و 309 و 404 و 431 و 434 وج2 ص86 و 146 و 153 و 302 و 303
و 386 وج3 ص208 و 211 و 278 و 369 و 403 واللمعة البيضاء
للتبريزي ص67 والنصائح الكافية لمحمد بن عقيل ص96 و 117 و 183
والأنوار العلوية للشيخ جعفر النقدي ص23 و 328 و 336 ولمحات
للشيخ لطف الله الصافى ص43 ومجموعة الرسائل للشيخ لطف الله
الصافي ج1 ص174 وج2 ص329 وحياة الإمام الحسين «عليه السلام»
للقرشي ج1 ص255 وحياة الإمام الرضا «عليه السلام» للقرشي ج1
ص169 وج2 ص266 و 318 .
([18])
المسترشد ص129 و 444 والإرشاد ج1 ص156 وذخائر العقبى ص63
والمستجاد من الإرشاد ص95 و 96 والصراط المستقيم ج1 ص316
والبحار ج21 ص208 و 245 وج37 ص267 والغدير ج3 ص198 والمناظرات
في الإمامة ص214 والثقات ج2 ص93 وتاريخ مدينة دمشق ج2 ص31 وعن
تاريخ الأمم والملوك ج2 ص368 وعن البداية والنهاية ج5 ص11 وعن
السيرة النبوية لابن هشام ج4 ص946 وكشف الغمة ج1 ص227 وعن عيون
الأثر ج2 ص254 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص12 وسبل الهدى
والرشاد ج5 ص441 ونشأة التشيع والشيعة ص109 وكتاب السنة ص586
وإعلام
الورى ج1 ص244
وقصص
الأنبياء للراوندي ص349 وشرح
الأخبار ج2 ص195 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص183 وتفسير نور
الثقلين ج3 ص378 والثقات ج2 ص93 وكشف اليقين للعلامة الحلي
ص145.
([19])
مختصر تاريخ دمشق ج17 ص332 والإعتقاد على مذهب السلف لأحمد بن
الحسين البيهقي ص205 ومسند أبي يعلى ج1 ص286 ومعارج القبول ج2
ص471 ومسند فاطمة للسيوطي ص62 والمعجم لابن المثنى التميمي
ص230 وتحفة الأحـوذي ج10 ص229 وتلخيص المتشـابه في الرسـم ج2
ص644 وتاريـخ = =
الإسلام للذهبي ج3 ص627 وتاريخ الأحمدي ص99 وفضائل الصحابة
للنسائي ص14 والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( ط بيروت) ج9 ص41
والحدائق لابن الجوزي ج1 ص387 عن البخاري، ومسلم، والبداية
والنهاية ج5 ص7.
([20])
المسترشد ص445 وشرح الأخبار ج1 ص97 ومسند ابن الجعد ص301
والطبقات الكبرى ج3 ص24 وتاريخ مدينة دمشق ج42 ص175 وأنساب
الأشراف ص94.
([21])
مناقب أمير المؤمنين «عليه السلام» ج1 ص531 و 532 وفضائل
الصحابة ص13 ومسند سعد بن أبي وقاص ص174 والسنن الكبرى للنسائي
ج5 ص44 و 120 و 240 وخصائص أمير المؤمنين «عليه السلام»
للنسائي ص76 ومسند أبي يعلى ج2 ص86 والكامل ج2 ص417 وعن تاريخ
مدينة دمشق ج42 ص151 و 152 ومختصر تاريخ دمشق ج17 ص344.
([22])
مقام الإمام علي «عليه السلام» ص36 ومكاتيب الرسول هامش ج1
ص595 وعن تاريخ مدينة دمشق ج42 ص117.
([23])
الإحتجاج ج1 ص59 ومدينة المعاجز ج1 ص288 والبحار ج21 ص223
وتفسير الإمام العسكري «عليه السلام» ص380 وبشارة المصطفى
للطبري ص316 .
([24])
الآية 35 من سورة الفرقان.
([25])
الآيتات 29 ـ 32 من سورة طه.
([26])
الآية 35 من سورة القصص.
([27])
الآية 34 من سورة القصص.
([28])
الآية 142 من سورة الأعراف.
([29])
الميزان (تفسير) ج16 ص44.
([30])
الأمالي للطوسي (ط سنة 1414 هـ) ص498 والبحار ج21 ص143 وموسوعة
أحاديث أهل البيت «عليهم السلام» ج11 ص219.
|