إستعداد
العدو.. واستطلاع النبي

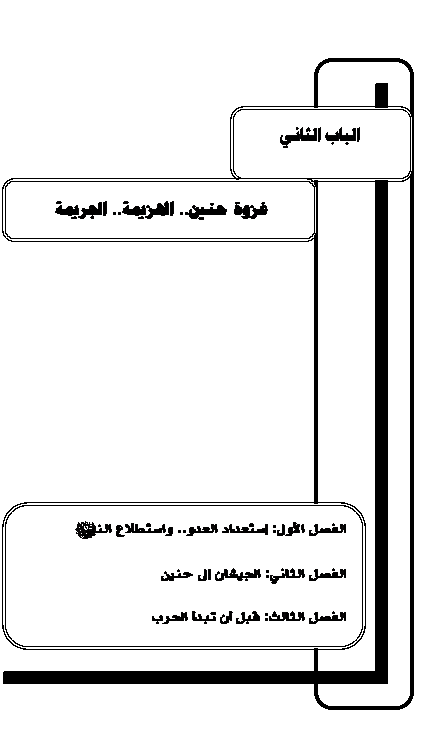
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد
وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين..
وبعد..
نتابع فيه حديثنا عن هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ
الإسلام، والتي انتهت بسقوط عنفوان الشرك، في المنطقة بأسرها..
لتكون الهيمنة المطلقة للإسلام وللمسلمين، باعتراف صريح من رموز
الشرك، وعتاته، وفراعنته، وجباريه.
وتتمثل نهايات هذه المرحلة بحسم الأمر بالنسبة
لقبيلة هوازن في حنين وأوطاس.. وسقوط ثقيف وخثعم في الطائف..
ثم تبع هذه المرحلة تداعيات طبيعية، تمثلت بانثيال
وفود قبائل العرب على المدينة، ليعلنوا ولاءهم، وتأييدهم، وقبولهم
بالإسلام ديناً، واعترافهم بمحمد نبياً..
والذي يعنينا الحديث عنه في هذا الباب وفصوله هو
عرض ما جرى في حنين، وأوطاس، والطائف..
وأما الحديث عن الوفود، وعن سائر الأحداث الهامة،
فنأمل أن نوفق للتعرض له فيما سوى ذلك من أبواب إن شاء الله
تعالى..
فنقول.. ونتوكل على خير مأمول
ومسؤول:
بـدايـة:
إن النصوص التاريخية تؤكد على:
أن قبيلة هوازن هي التي بادرت إلى جمع الجموع وتحركت من
أماكن سكناها باتجاه المسلمين، لتورد ضربتها الحاسمة فيهم، فلما سمع
رسول الله «صلى الله عليه وآله» بجمعها، وبتحركها، سار إليها.
وسنحاول في هذا الفصل متابعة أحداث هذا التحرك،
والأجواء المهيمنة على هذا المسير، فإلى ما يلي من عناوين ومطالب، ومن
الله نستمد العون والقوة، ونبتهل إليه أن يمنحنا التوفيق والتسديد، إنه
ولي قدير وبالإجابة حري جدير..
قال المؤرخون، والمؤلفون:
[وتسمى أيضاً غزوة هوازن، لأنهم الذين أتوا لقتال رسول
الله «صلى الله عليه وآله». عن أبي الزناد: أقامت هوازن سنة تجمع
الجموع وتسير رؤساؤهم في العرب، تجمعهم]([1]).
قال أئمة المغازي:
لما فتح رسول الله «صلى الله عليه وآله» مكة مشت أشراف هوازن، وثقيف
بعضها إلى بعض، (وكان أهلها عتاة، مردة، مبارزين)([2])
وأشفقوا أن يغزوهم رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وقالوا: قد فرغ لنا
فلا ناهية له دوننا، والرأي أن نغزوه.
فحشدوا، وبغوا، وقالوا:
والله، إن محمداً لاقى قوماً لا يحسنون القتال، فأجمعوا أمركم، فسيروا
في الناس، وسيروا إليه قبل أن يسير إليكم.
فأجمعت هوازن أمرها، وجمعها مالك بن عوف بن سعد بن
ربيعة النصري، وهو ـ يوم حنين ـ ابن ثلاثين سنة، فاجتمع إليه مع هوازن
ثقيف كلها، ونصر، وجشم كلها، وسعد بن بكر، وناس من بني هلال، وهم قليل.
قال محمد بن عمر:
لا يبلغون مائة، ولم يشهدها من قيس عيلان. إلا هؤلاء، ولم يحضرها من
هوازن كعب ولا كلاب، مشى فيها ابن أبي براء فنهاها عن الحضور، وقال:
والله، لو ناوأوا محمداً من بين المشرق والمغرب لظهر عليهم([3]).
وكان في جشم دريد بن الصمة وهو يومئذ ابن ستين ومائة.
ويقال:
عشرين ومائة سنة، وقيل: مائة وخمسون سنة. وقيل: مائة
وسبعون سنة([4]).
(وذكر السيد محسن الأمين: المكثر يقول بلغ المائتين والمقل المائة
والعشرين)([5])
وهو شيخ كبير قد عمي، ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه، ومعرفته بالحرب،
وكان شيخاً مجرباً قد ذكر بالشجاعة والفروسية وله عشرون سنة([6]).
فلما عزمت هوازن على حرب رسول الله «صلى الله عليه
وآله» سألت دريداً الرياسة عليها، فقال: وما ذاك؟! وقد عمي بصري، وما
استمسك على ظهر الفرس؟ ولكن أحضر معكم لأن أشير عليكم برأيي على أن لا
أخالَف، فإن كنتم تظنون أني أخالف أقمت ولم أخرج.
قالوا:
لا نخالفك.
وجاءه مالك بن عوف، وكان جماع أمر الناس إليه، فقالوا
له: لا نخالفك في أمر تراه.
فقال له دريد:
يا مالك، إنك تقاتل رجلاً كريماً، قد أوطأ العرب،
وخافته العجم ومن بالشام، وأجلى يهود الحجاز، إما قتلاً وإما خروجاً
على ذل وصغار، ويومك هذا الذي تلقى فيه محمداً له ما بعده.
قال مالك:
إني لأطمع أن ترى غداً ما يسرك.
قال دريد:
منزلي حيث ترى، فإذا جمعت الناس صرت إليك، فلما خرج من
عنده طوى عنه أنه يسير بالظعن والأموال مع الناس([7]).
وكان قائد ثقيف ورئيسهم كنانة بن
عبد ليل، وقيل قارب بن الأسود([8]).
وكان جملة من اجتمع من بني سعد وثقيف أربعة آلاف،
وانضمت إليهم أعداد من سائر العرب، جموع كثيرة، كان مجموعهم كلهم
ثلاثين ألفاً، وجعلوا أمر الجميع إلى مالك بن عوف([9]).
فلما أجمع مالك المسير بالناس إلى رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، أمر الناس، فخرجوا معهم أموالهم، ونساؤهم، وأبناؤهم. ثم
انتهى إلى أوطاس، فعسكر به، وجعلت الأمداد تأتي من كل جهة، وأقبل دريد
بن الصمة في شجار له يقاد به من الكبر، فلما نزل الشيخ لمس الأرض بيده،
وقال: بأي واد أنتم؟
قالوا:
بأوطاس.
قال:
نعم مجال الخيل، لا حَزْنٌ ضرسٌ، ولا سهل دَهِس. مالي
أسمع بكاء الصغير، ورغاء البعير، ونهاق الحمير، وبعار الشاء، وخوار
البقر؟
قالوا:
ساق مالك مع الناس أبناءهم، ونساءهم، وأموالهم.
فقال دريد:
قد شرط لي ألا يخالفني، فقد خالفني، فأنا أرجع إلى أهلي
وتارك ما هنا.
قيل:
أفتلقى مالكاً فتكلمه؟
فدُعي له مالك، فقال:
يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له
ما بعده من الأيام. مالي أسمع بكاء الصغير، ورغاء البعير، ونهاق
الحمير، وبعار الشاء، وخوار البقر؟!
قال:
قد سقت مع الناس أبناءهم، ونساءهم، وأموالهم.
قال:
ولم؟
قال:
أردت أن أجعل خلف كل إنسان أهله وماله يقاتل عنهم.
فأنقض به دريد، وقال:
راعي ضأن والله، ما له وللحرب. وصفق دريد بإحدى يديه
على الأخرى تعجباً، وقال: هل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم
ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك، يا
مالك، إنك لم تصنع بتقديم البيضة، بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاً،
فارفع الأموال، والنساء، والذراري إلى عليَا قومهم، وممتنع بلادهم، ثم
القَ القوم على متون الخيل، والرجال بين أصفاف الخيل، أو متقدمة دريَّة
أمام الخيل، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك الفاك ذلك،
وقد أحرزت أهلك ومالك.
فقال مالك بن عوف:
والله، لا أفعل، ولا أغيّر أمراً صنعته، إنك قد كبرت
وكبر علمك، أو قال عقلك. وجعل يضحك مما يشير به دريد.
فغضب دريد وقال:
هذا أيضاً يا معشر هوازن، والله ما هذا لكم برأي، إن
هذا فاضحكم في عورتكم، وممكّن منكم عدوكم، ولاحق بحصن ثقيف وتارككم،
فانصرفوا واتركوه.
فسل مالك سيفه، ثم نكسه، ثم قال:
يا معشر هوازن!! والله، لتطيعنّني، أو لأتكئن على هذا
السيف حتى يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي.
فمشى بعضهم إلى بعض، وقالوا:
والله، لئن عصينا مالكاً ليقتلن نفسه وهو شاب، ونبقى مع دريد وهو شيخ
كبير لا قتال معه، فأجمعوا رأيكم مع مالك، فلما رأى دريد أنهم قد
خالفوه، قال:
يا لـيـتـني فـيـهـــا جــــذع
أخــب فــيــهـــا وأضـــــــع
أقـــــود وطــفـــاء الـزمـع كــــأنهـــــا شـــاة
صـــــدع([10])
ثم قال دريد:
يا معشر هوازن، ما فعلت كعب وكلاب؟
قالوا:
ما شهدها منهم أحد.
قال:
غاب الحد والجد، لو كان يوم علاء ورفعة. وفي لفظ: لو كان ذكراً وشرفاً
ما تخلفوا عنه، يا معشر هوازن، ارجعوا، وافعلوا ما فعل هؤلاء.
فأبوا عليه.
قال:
فمن شهدها منكم؟
قالوا:
عمرو بن عامر، وعوف بن عامر.
قال:
ذانك الجذعان من بني عامر لا ينفعان ولا يضران.
قال مالك لدريد:
هل من رأي غير هذا فيما قد حضر من أمر القوم؟
قال دريد:
نعم، تجعل كميناً، يكونون لك عوناً، إن حمل القوم عليك
جاءهم الكمين من خلفهم، وكررت أنت بمن معك، وإن كانت الحملة لك لم يفلت
من القوم أحد، فذلك حين أمر مالك أصحابه أن يكونوا كميناً في الشعاب،
وبطون الأودية، فحملوا الحملة الأولى التي انهزم فيها رسول الله «صلى
الله عليه وآله».
قال دريد:
من مقدمة أصحاب محمد؟
قالوا:
بني سليم.
قال:
هذه عادة لهم غير مستنكرة، فليت بعيري ينحّى من سنن
خيلهم، فنُحي بعيره مولياً من حيث جاء([11]).
ونقول:
إن لنا هنا ملاحظات، ووقفات عديدة، نشير إليها ضمن
العناوين التالية:
حنين واد إلى جنب وادي ذي المجاز، قريب من الطائف، بينه
وبين مكة بضعة عشر ميلاً([12]).
وقيل:
حنين: اسم لما بين مكة والطائف([13]).
وقال بعضهم:
اسم موضع قريب من الطائف([14]).
وقيل:
بينه وبين مكة ثلاث ليال، قرب الطائف([15]).
تقدم
أنهم يزعمون:
أن سبب هذه الغزوة هو: أنه بعد فتح مكة مشت أشراف هوازن، وثقيف،
وقالوا: قد فرغ لنا فلا ناهية له دوننا، والرأي أن نغزوه.
ولكنّ نصاً آخر يقول:
إن سببها هو: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لما خرج
لفتح مكة أظهر أنه يريد هوازن، فبلغ الخبر إليهم، فتهيأوا، وجمعوا
الجموع والسلاح، واجتمع رؤساء هوازن إلى مالك بن عوف، فرأسوه عليهم
وخرجوا الخ..([16]).
ونقول:
أولاً:
إن ثمة خللاً في هذا النص الأخير، فإن ما بلغ هوازن قد
كان قبل فتح مكة، وبعد فتحها وبقاء النبي «صلى الله عليه وآله» فيها
هذه المدة التي قد يقال: إنها قاربت العشرين يوماً، لا بد أن يتوقع أن
هوازن قد اقتنعت بأن مكة كانت هي المقصودة بذلك الجيش.. فلا معنى لأن
تقرر هوازن أن تجمع هذه الجموع وتسير لحرب رسول الله «صلى الله عليه
وآله».
ثانياً:
إن هوازن قد بقيت سنة تجمع الجموع، وتحث القبائل على
مشاركتها في حربها مع رسول الله «صلى الله عليه وآله»([17]).
وصرحت بعض الروايات:
بأنهم قبل فتح مكة كانوا يريدون قتاله «صلى الله عليه
وآله»([18])،
فلا معنى لقولهم: إنها قد تهيأت للحرب حين بلغها مسير رسول الله «صلى
الله عليه وآله» إليها، أو أنها قد قررت جمع الجموع والحرب بعد فتح
مكة..
فلعل الصحيح هو:
أنها قد بدأت بالتهيؤ للحرب قبل سنة، ثم زادت وتيرة هذا
الاستعداد بعدما بلغها مسير النبي «صلى الله عليه وآله» إليها.. ثم
جددت خيار المبادرة والدخول في الحرب بصورة فعلية بعد فتح مكة.
لقد بات واضحاً:
أن هوازن لم تكن تريد بحربها لرسول الله «صلى الله عليه
وآله» وللمسلمين أن تحقّ حقاً، أو تبطل باطلاً، كما أنها لم تكن تريد
الدفاع عن نفس أو عرض، أو مال، أو أرض، ولا الدفاع عن حرية أو كرامة،
ولا عن جاه وزعامة، ولا دفاعاً عن قيم إنسانية، أو عن حقائق إيمانية،
أو ثأراً لعدوان سابق عليهم. وإنما كانت حرب العصاة البغاة، والمعتدين
الطغاة، وحرب الأجلاف الجفاة، والعتاة القساة.
إنهم يخوضون حرباً يقرر زعماؤهم، وأصحاب الرياسة فيهم
زجّهم فيها، ويفرضونها عليهم، وحملهم على مواجهة ويلاتها، وتحمل
تبعاتها..
ولو أنهم تركوا الأمور تسير على طبيعتها، فإن غاية ما
كان سيفعله معهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» هو: أن يعرض عليهم ما
يدعو إليه، ويقدم لهم الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة عليه، ويبقى
خيار القبول أو الرفض عائداً إليهم، وفقاً للشعار الذي طرحه الإسلام في
قوله تعالى:
{لاَ
إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}([19]).
و
{إِنْ
أَنَا إِلاَ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ}([20]).
و
{إِنَّمَا
أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ}
([21]).
و
{مَنْ
شَاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاء فَلْيَكْفُرْ}([22]).
إلى عشرات من الآيات الأخرى المصرحة بهذا المعنى..
فلماذا إذن تبادر هوازن إلى جمع الجموع، والاستعداد
طيلة سنة كاملة لحرب رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟! ولماذا تريد
منعه من إبلاغ رسالات ربه، بأساليب القهر، والظلم والتعدي، الذي يبلغ
حد شن حرب، تأكل الأخضر واليابس؟!
وقد قرأنا في النصوص المتقدمة ولم نزل نقرأ أمثال هذه
المزاعم في مواقف كثيرة أخرى مشابهة لأهل الكفر، مثل يهود خيبر وغيرهم:
«أن محمداً «صلى الله عليه وآله» والمسلمين إنما كانوا ينتصرون في
حروبهم المتلاحقة، لأنهم كانوا يلاقون قوماً لا يحسنون القتال.. ثم
يزعمون أنهم هم أهل الجد والجلد، وأهل العدة والعدد، والعارفون بفنون
الحرب، والذين يملكون خبرات عالية بأساليب الطعن والضرب»..
ولكن هؤلاء القوم وكذلك غيرهم من اهل اللجاج والعناد
يرون المعجزات الباهرة، التي لا تبقي مجالاً للشك بحتمية الرعاية
الربانية لهذا الدين وأهله. وقد كانوا يرون بأم أعينهم المعجزات
القاهرة للعقول، أو الكرامات الظاهرة الآسرة للوجدان، الموقظة للضمير.
فما معنى:
أن يتعامى أولئك الناس عن كل مظاهر هذه العناية
الإلهية، والرعاية الربانية، ويتجهون نحو تزوير الحقائق، وإخفاء أمرها،
وتدنيس طهرها..
فهل يرجع هذا إلى ضعف في بصيرتهم، أو إلى خذلان رباني
لهم، حجبهم عن الحقائق، أو حجبها عنهم، على قاعدة:
{فَلَمَّا
زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ}([23])،
و
{وَالَّذِينَ
اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ}([24]).
إن الإجابة الصحيحة والصريحة عن ذلك، هي:
صحة ووقوع كلا
هذين الأمرين، نعوذ بالله من الخذلان،
ومن سوء العاقبة وعذاب الخزي في الدنيا والآخرة..
إن كلام دريد بن الصمة مع مالك بن عوف فيما يرتبط برسول
الله «صلى الله عليه وآله»، وبموقعه، وبما حققه من إنجازات يشير إلى
معرفته التامة بما يجري في المنطقة، وبما آلت إليه الأمور بعد تلك
الحروب الطويلة، التي خاضها المسلمون مع أعدائهم من مختلف الأديان
والأجناس، وفي جميع المواقع..
كما أنه قد أظهر خبرة غير عادية بحالات القبائل،
وسياسات الناس وأحوالهم.. وتنبأ بما تكون عليه الحال، لو التقى الناس
في ساحات القتال، وتنبأ بأن مالكاً سيترك أصحابه، ويلجأ إلى حصن
الطائف، وهذا ما حصل فعلاً.
فإذا كان هذا الرجل يملك هذه الخبرة العالية، ويعرف:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» رجل كريم، فلماذا يستجيز
لنفسه قتال الرجل الكريم، من دون ذنب أتاه إليه، ولا إلى غيره، سوى أنه
يدعوه إلى الحق والخير والهدى؟!
وإذا كان يعرف أيضاً:
أن هذا النبي قد أوطأ العرب، وخافته العجم، وخافه من في
الشام.
ويعرف:
أنه أجلى يهود الحجاز: إما قتلاً، أو خروجاً على ذل
وصغار.
ويعرف:
أن الحرب مع محمد «صلى الله عليه وآله» ليست مجرد عبث
يتلاشى وينتهي، بل هي عمل تبقى آثاره ونتائجه إلى الأعقاب، عبر
الأحقاب..
فلماذا يرضى من يعرف ذلك كله:
بأن يكون المدبر لهذه الحرب الظالمة، والعدوانية، على
رجل كريم، قد حقق كل هذه الإنجازات الهائلة التي لم تعرف لها المنطقة
العربية مثيلاً في كل تاريخها الطويل؟!
فهل هذه حكمة ودراية، أم رعونة وغواية؟!
ومما لفت نظرنا هنا أيضاً:
أن مالك بن عوف لا يرضى بما أشار به دريد بن الصمة،
ويسعى إلى فرض رأيه على قومه بأسلوب أرعن وساقط، حيث إنه يأخذ سيفاً،
ويهددهم بأنه سوف يقتل به نفسه إن خالفوه..
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعفه الشديد، وإفلاسه
الأكيد، من أي منطق صحيح وسليم.
ولو كان يملك حجة ومنطقاً صحيحاً، فهو يكفي لإلزامهم
بالأخذ برأيه، ويفرض عليهم البخوع لحجته..
والأشد غرابة هنا:
أن لا نجد في تلك القبيلة الكبيرة بأسرها، والتي هي
بصدد اتخاذ قرار مصيري وحاسم، يؤثر على مستقبلها ووجودها ـ لا نجد فيها
ـ من يقول له: إن تهديدك بقتل نفسك لا يدل على صحة قراراتك، إن لم يكن
دليلاً على ضعف حجتك، وبوار منطقك..
وإذا كان قرارك خاطئاً فسينتج المصائب والبلايا،
والكوارث والرزايا، على مئات أو ألوف من البشر، لا يحق لك أن تتصرف
بمصيرهم من دون روية، وتدبر، وحكمة وتبصر.
بل إنهم جميعاً خضعوا لإرادته،
وأطاعوه حباً بالحفاظ على حياته،
ولم يفكروا بما يحفظ لهم حياتهم.. مع أن هذا الرجل هو مجرد شاب طامح،
لا يملك الكثير من الخبرة، أو التجربة، والحنكة،
ولا يشعر بالمسؤولية بالمستوى الذي يؤهله لإصدار قرارات بهذا القدر من
الحساسية،
وبهذا المستوى من الخطورة. بل هو يستجيب لأحاسيسه، وينقاد لمشاعره،
وأهوائه.
والأغرب من ذلك:
أن هؤلاء الناس قد سمعوا حجة دريد بن الصمة على مالك بن
عوف.. وكانت حجة قوية، ومرضية، وسمعوا أيضاً جواب مالك عليها، الذي كان
مجرد إصرار على رأي ظهر خطؤه، وقد صاحب إصراره هذا الضحك الإزدرائي
وحفنة من الشتائم، حيث اعتبره إنساناً قد كبر، وكبر علمه، فأصبح هرم
الجسم والعلم والعقل.. فهو يتكلم بما ربما يصنف في دائرة الخرف
والإختلال، أو التدني في مستوى الإدراك والوعي للأمور..
الإستطلاع..
والتثبت:
عن جابر بن عبد الله، وعمرو بن شعيب، وعبد الله بن أبي
بكر بن عمرو بن حزم: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لما سمع بخبر
هوازن بعث عبد الله بن أبي حدرد، فأمره أن يدخل في القوم فيقيم فيهم،
وقال: «إعلم لنا علمهم».
فأتاهم، فدخل فيهم، فأقام فيهم يوماً وليلة، أو يومين،
حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا عليه من حرب رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، وسمع من مالك، وأمر هوازن، وما هم عليه([25]).
وعند محمد بن عمر:
أنه انتهى إلى خباء مالك بن عوف، فيجد عنده رؤساء هوزان،
فسمعه يقول لأصحابه: إن محمداً لم يقاتل قوماً قط قبل هذه المرة، وإنما
كان يلقى قوماً أغماراً لا علم لهم بالحرب، فيظهر عليهم، فإذا كان
السحر فصُفُّوا مواشيكم ونساءكم من ورائكم، ثم صفوا، ثم تكون الحملة
منكم، واكسروا جفون سيوفكم، فتلقونه بعشرين ألف سيف مكسورة الجفون،
واحملوا حملة رجل واحد، واعلموا أن الغلبة لمن حمل أولاً. انتهى([26]).
ثم أقبل حتى أتى رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
فأخبره الخبر، فقال: رسول الله «صلى الله عليه وآله» لعمر بن الخطاب:
«ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد»؟
فقال عمر:
كذب.
فقال ابن أبي حدرد:
والله لئن كذبتني يا عمر لربما كذبت بالحق.
فقال عمر:
ألا تسمع يا رسول الله ما يقول ابن أبي حدرد؟
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
قد «كنت ضالاً فهداك الله»([27]).
(زاد الطبرسي قوله: وابن أبي حدرد صادق)([28]).
1 ـ
إننا لسنا بحاجة للتذكير بأهمية الإستخبارات في إنجاح
أي عمل عسكري ضد العدو، ولذلك رأينا: أنه حين علم «صلى الله عليه وآله»
بأمر هوازن كان أول عمل قام به هو إرسال العيون لمعرفة نواياهم
الحقيقية في أمر الحرب والسلم من جهة، ثم معرفة الخطة التي سيعتمدونها
في حربهم، فيما لو كان قرارهم هو إثارة الحرب ضد المسلمين من جهة أخرى.
2 ـ
ثم إن هذا التروّي، وعدم التسرع في اتخاذ القرار بجرد
وصول الخبر عن جمع هوازن، يدخل في دائرة الإنصاف للآخرين، والشعور
بالمسؤولية، وتحاشي القيام بأي عمل حربي ضدهم، أو أي عمل إيذائي مهما
كان نوعه قبل التأكد من صحة الأخبار الواصلة..
3 ـ
ويثير الإنتباه هنا: التعبير الذي اختاره «صلى الله
عليه وآله» وهو يصدر أمره لابن أبي حدرد، حيث قال له «صلى الله عليه
وآله»: «إعلم لنا علمهم».
فالمهمة إذن هي:
أن ينوب عن النبي «صلى الله عليه وآله» في تحصيل العلم
بالمطلوب.
4 ـ
ومتعلق العلم الذي يريده «صلى الله عليه وآله» من ابن
أبي حدرد هو أيضاً نفس علمهم، أي أنه يريد منه أن لا يكتفي بالحدسيات،
وبالإمارات والقرائن، ولا بالظنون مهما بلغت قوتها.. ولا بالاستنتاجات
المستندة إلى الإجتهاد، بل المطلوب هو: أن يصبح علمه بما عزموا عليه هو
نفس علمهم. وكأنه ينقل إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» نفس علمهم.
وهذا غاية في الإحتياط، ومنتهى في الدقة.
ولا ندري السبب في هذا الموقف الغريب والعجيب، الذي
اتخذه عمر بن الخطاب من ابن أبي حدرد!! فإن هذه القضية قد حملت معها
الكثير من الدلالات اللافتة والمثيرة.. ونستطيع أن نشير هنا إلى الأمور
التالية:
فقد لاحظنا:
أنه «صلى الله عليه وآله» بعد أن سمع ما نقله ابن أبي
حدرد عن مالك بن عوف، قال لعمر: ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد؟
وقد يكون التفسير الطبيعي لهذا
السؤال هو:
أنه «صلى الله عليه وآله» أراد توجيه عمر إلى خطة مالك
بن عوف، التي رسمها لأصحابه لمهاجمة أهل الإسلام.
غير أنه يمكن أن يفسر ذلك بطريقة
أخرى، وهي:
أنه «صلى الله عليه وآله» أراد استدراج عمر، ليفصح عن
دخيلة نفسه. وهذا ما حصل فعلاً.
ثم جاءت إجابة عمر نشازاً، وهجينة في مضامينها، حين
اتهم ابن ابي حدرد بالكذب. مع أن الله تعالى لم يطلعه على غيبه، كما
أنه لم يكن يملك أي دليل يشير إلى كذب هذا الرجل.
إلا أن يكون لعمر بن الخطاب عيون قد حضروا نفس المجلس
الذي حضره ابن أبي حدرد، ونقلوا له ما يدل على عدم صحة ما جاء به إلى
النبي «صلى الله عليه وآله».
ولا نظن أن أحداً يرتضي حتى إبداء هذا الإحتمال، إلا في
صورة واحدة، وهي أن يكون على علم بسوء سريرة عمر بن الخطاب، ويرى أنه
يخطط، ويعمل بصورة مستقلة، ولحساب فريق آخر غير رسول الله «صلى الله
عليه وآله» وجماعة المسلمين.
أو أنه يتهم عمر بأنه يمالئ مشركي هوازن، ويتصل بهم،
وينسق معهم، ويريد بموقفه هذا تعمية الأمور على النبي «صلى الله عليه
وآله»، والتستر عليهم عنده، لتمكينهم من إيراد ضربتهم بأهل الإسلام. أو
حفظهم، ودفع الأخطار عنهم، ما وجد إلى ذلك سبيلاً.
وهذه احتمالات خطيرة، ولا يمكن البخوع لها والتسليم بها،
إذا لم تدعمها الأدلة الدامغة، والشواهد الواضحة.
وأما جواب ابن ابي حدرد لعمر بقوله:
لربما كذبت بالحق. ثم تفسير النبي «صلى الله عليه وآله»
لذلك: بأنه قد كان ضالاً فهداه الله.. فهو غير ظاهر الوجه، ويصعب
الإطمئنان إلى عدم عروض التحريف له.. لأن ابن أبي حدرد يريد أن يرد
الاتهام بمثله، والتكذيب بالحق أيام الضلال مما لا يختص بعمر، بل هو
حال عامة الناس آنئذٍ.
وعمر إنما نسب إلى ابن أبي حدرد الكذب في نفس مقامه،
وعين كلامه، فالمناسب أن يكون رد ابن أبي حدرد عليه هو نسبة الكذب إليه
بنفس المستوى، وفي نفس ذلك المقام.
بل إن المناسب هو:
أن يستبدل كلمة «لربما» بكلمة «لطالما» كما هو المتوقع
في أمثال هذه المواقف.. ولعل محبي عمر استبدلوا هذه بتلك للإبقاء على
مقام عمر وهيبته
غير أن بالإمكان دفع هذه الإحتمالات بأن مقصود ابن أبي
حدرد بكلامه هذا هو: أن حكم عمر بكذب ابن أبي حدرد في هذا المورد ربما
يكون تكذيباً بالحق..
ولكن يرد على هذا:
أنه يخالف التوجيه الذي نسبوه إلى رسول الله «صلى الله
عليه وآله» في جوابه لعمر، وهو قوله: «قد كنت ضالاً فهداك الله»..
كما أن ذلك لا يصحح اعتراض عمر، واستنجاده برسول الله
«صلى الله عليه وآله».
ولا يبرر نجدة رسول الله «صلى الله عليه وآله» له بهذا
الكلام المنسوب إليه «صلى الله عليه وآله».
ولو كان هذا مقصود ابن أبي حدرد لكان عمر قد فهم كلام
ابن أبي حدرد، ولم يكن معنى لأن يتوجه عمر بشكواه إلى رسول الله «صلى
الله عليه وآله» من الأساس ولا أن يظهر كأنه يدعو النبي «صلى الله عليه
وآله» للإنتصار له.
وليس ثمة ما يبرر الشكوى أو الاستنصار.
كما أنه لم يكن هناك ضرورة للتفسير من قبل النبي «صلى
الله عليه وآله»..
وقد انتهى الأمر بإعلان النبي «صلى الله عليه وآله» صدق
ابن أبي حدرد في أقواله.
حيث أضاف «صلى الله عليه وآله»
قوله:
«وابن أبي حدرد صادق».
وهذا في حد ذاته يعتبر إدانة لعمر، وتكذيباً له، بل هو
تأييد لقول ابن أبي حدرد: على رواية «لربما كذبت بالحق» إذا كان
مقصوده: أن تكذيبك لي في هذا المورد ربما يكون تكذيباً بالحق.. والنبي
الأعظم «صلى الله عليه وآله» قد أكد صحة ذلك..
فإذا كان صادقاً، فلماذا لم يبادر النبي «صلى الله عليه
وآله» إلى تأنيب عمر على نسبته إلى الكذب؟! فإن هذا هو المتوقع من
النبي الكريم «صلى الله عليه وآله» في مثل هذه الحالات، إلا إذا فرض:
أن ثمة ما يمنع من الزيادة على هذا، والله هو العالم بالحقائق.
وقد لاحظنا:
أن أكثر نقلة هذه القضية يقتصرون على بعض فقراتها،
ويحذفون سائرها.. خصوصاً حينما يصل الأمر إلى عمر وموقفه، وما جرى، مع
أنهم يلاحقون الواو والفاء، والباء، والتاء حين يكون هناك ما يحتملون
فيه أدنى تأييد له.. فراجع على سبيل المثال السيرة الحلبية، والإصابة،
وأسد الغابة.. وغير ذلك من مصادر..
أليس هذا من أجلى مصاديق القول
المعروف:
«حبك الشيء يعمى ويصم»؟!.
أعاذنا الله من الزلل والخطل في الفكر، وفي القول، وفي
العمل، إنه ولي قدير، وبالإجابة جدير..
([1])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص310 وراجع: البداية والنهاية ج4 هامش
ص368.
([2])
تاريخ الخميس ج2 ص99 والسيرة الحلبية ج3 ص105 و (ط دار
المعرفة) ص61 وأعيان الشيعة ج1 ص278.
([3])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص310 وتاريخ الخميس ج2 ص99 والسيرة
الحلبية ج3 ص105 و 106 والسيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة)
ج2 ص107 وراجع: البحار ج21 ص148 وتفسير القمي ج1 ص285 والبداية
والنهاية ج4 ص369 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص45
والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص611.
([4])
السيرة الحلبية ج3 ص106 والسيرة النبوية لدحلان (ط دار
المعرفة) ج2 ص107 وراجع: تاريخ مدينة دمشق ج17 ص240 ومختصر
المزني ص272 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص92 ومعرفة السنن
والآثار ج7 ص27.
([5])
أعيان الشيعة ج1 ص278.
([6])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص310 وراجع: البحار ج21 ص148 وتفسير
القمي ج1 ص285 والسيرة الحلبية ج3 ص106 والسيرة النبوية لدحلان
(ط دار المعرفة) ج2 ص107.
([7])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص310 والسيرة الحلبية ج3 ص106 والسيرة
النبوية لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص107.
([8])
السيرة الحلبية ج3 ص106 والسيرة النبوية لدحلان (ط دار
المعرفة) ج2 ص107.
([9])
السيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص107.
([10])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص311 والبحار ج21 ص148 و 149 و 164 و 165
وراجع: السيرة الحلبية ج3 ص106 و 107 والسيرة النبوية لدحلان
(ط دار المعرفة) ج2 ص107 و 108 والفايق في غريب الحديث ج1 ص123
وتفسير القمي ج1 ص286 وتفسير نور الثقلين ج2 ص 199وتاريخ مدينة
دمشق ج17 ص239 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص345 وعن البداية
والنهاية ج4 ص370 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص890 وعن عيون
الأثر ج2 ص214 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص612 وغريب الحديث
ج1 ص320 وإعلام الورى ص120 و 121 وتاريخ الخميس ج2 ص99 و 100.
([11])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص312.
([12])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص 351 وتاريخ الخميس ج2 ص99 وعون المعبود
ج7 ص229 وراجع ج6 ص134 وراجع: عمدة القاري ج14 ص157 وج17 ص277
و 294 ومعجم ما استعجم ج2 ص471 ومعجم البلدان ج2 ص313 وفتح
الباري (المقدمة) ص106 وج8 ص21.
([13])
السيرة الحلبية ج3 ص105 و (ط دار المعرفة) ص61 والسيرة النبوية
لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص107.
([14])
السيرة الحلبية ج3 ص105 و (ط دار المعرفة) ص61.
([15])
تاريخ الخميس ج2 ص99 وعمدة القاري ج14 ص157 والطبقات الكبرى
لابن سعد ج2 ص149 ومعجم البلدان ج2 ص313 وراجع: التنبيه
والإشراف ص234 وإمتاع الأسماع ج2 ص8 وج8 ص388 وأعيان الشيعة ج1
ص278.
([16])
البحار ج21 ص148 و 149 وتفسير القمي ج1 ص285 وتفسير مجمع
البيان ج5 ص33 والتفسير الصافي ج2 ص330 وتفسير نور الثقلين ج2
ص197 وتفسير الميزان ج9 ص 230 وتاريخ مدينة دمشق ج17 ص240
والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص45.
([17])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص310 والسيرة النبوية لدحلان (ط دار
المعرفة) ج2 ص107 وراجع: البداية والنهاية ج4 هامش ص368.
([18])
السيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص107 وراجع: معجم
قبائل العرب ج1 ص150 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص344 .
([19])
الآية 256 من سورة البقرة.
([20])
الآية 188 من سورة الأعراف.
([21])
الآية 7 من سورة الرعد.
([22])
الآية 29 من سورة الكهف.
([23])
الآية 5 من سورة الصف.
([24])
الآية 17 من سورة محمد.
([25])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص313 عن ابن إسحاق، والبداية والنهاية ج4
ص370 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص891 والسيرة النبوية لابن
كثير ج3 ص613 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص346 وعن عيون الأثر ج2
ص214 و 215 وتاريخ الخميس ج2 ص100 والسيرة الحلبية ج3 ص107
والسيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص108 وتاريخ
الإسلام للذهبي ج2 ص572 والمستدرك للحاكم ج3 ص48 و 49 ومعجم
قبائل العرب ج2 ص833.
([26])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص313 عن الواقدي، وراجع: البحار ج21 ص149
و 164 ـ 165وتفسير القمي ج1 ص286 ـ 287 وراجع: إعلام الورى
ص120 والمغازي للواقدي ج3 ص893 والسيرة النبوية لدحلان (ط دار
المعرفة) ج2 ص107.
([27])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص313 وإعلام الورى ص120 والبحار ج21 ص165
والمغازي للواقدي ج3 ص893 وراجع: السيرة النبوية لابن هشام ج4
ص86 و 82 و (ط مكتبة محمد علي صبيح) ص891 والطبقات الكبرى ج2
ص150 والمواهب اللدنية ج1 ص161 وعن السيرة الحلبية ج3 ص107
وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص475 و (ط دار الكتاب العربي)
ج2 ص572 وأسد الغابة ج3 ص141 وشرح المواهب اللدنية ج3 ص2
والبداية= = والنهاية ج4 ص371 وتاريخ الخميس ج2 ص100 والتراتيب
الإدارية ج1 ص362 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص613 و 614
وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص346 .
([28])
إعلام الورى ص120 و (ط مؤسسة آل البيت لإحياء التراث) ج1 ص229
والبحار ج21 ص165.
|