النبي
 يعالج الموقف
يعالج الموقف
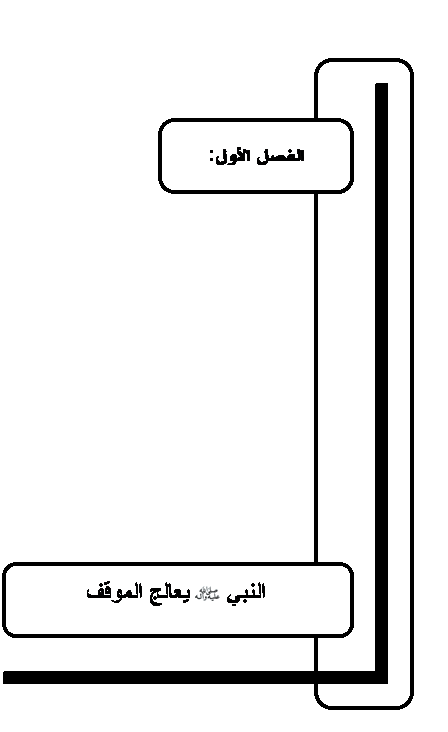
النداء
والدعاء:
قال الشيخ المفيد:
«ولما رأى رسول الله «صلى الله عليه وآله» هزيمة
القوم عنه، قال للعباس ـ وكان رجلاً جهورياً صيّتاً ـ: «نادِ في
القوم وذكرهم العهد»، فنادى العباس بأعلى صوته: يا أهل بيعة
الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة، إلى أين تفرون؟ اذكروا العهد الذي
عاهدتم عليه رسول الله «صلى الله عليه وآله».
والقوم على وجوههم قد ولّوا مدبرين.
وكانت ليلة ظلماء، ورسول الله في الوادي، والمشركون
قد خرجوا عليه من شعاب الوادي، وجنباته، ومضايقه، مصلتين سيوفهم،
وعمدهم، وقسيهم.
قال:
فنظر رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى الناس
ببعض وجهه في الظلماء، فأضاء كأنه القمر ليلة البدر. ثم نادى
المسلمين: «أين ما عاهدتم الله عليه»؟
فأسمع أولهم وآخرهم، فلم يسمعها رجل إلا رمى بنفسه
إلى الأرض، فانحدروا إلى حيث كانوا من الوادي، حتى لحقوا بالعدو
فقاتلوه»([1]).
ونص آخر يقول:
«فلما رأى رسول الله «صلى الله عليه وآله» الهزيمة
ركض نحو عليٍّ بغلته، فرآه قد شهر سيفه، فقال: يا عباس، إصعد هذا
الظرب([2])،
وناد: يا أصحاب البقرة، ويا أصحاب الشجرة، إلى أين تفرون؟ هذا رسول
الله.
ثم رفع رسول الله «صلى الله
عليه وآله» يده، فقال:
«اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان».
فنزل جبرئيل، فقال:
يا رسول الله، دعوت بما دعا به موسى حيث فلق له
البحر، ونجاه من فرعون.
ثم قال رسول الله «صلى الله
عليه وآله» لأبي سفيان بن الحارث:
ناولني كفاً من حصى، فناوله، فرماه في وجوه
المشركين، ثم قال: «شاهت الوجوه».
ثم رفع رأسه إلى السماء، وقال:
«اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد، وإن شئت أن لا
تعبد لا تعبد».
فلما سمعت الأنصار نداء العباس، عطفوا، وكسروا جفون
سيوفهم الخ..» ([3]).
وما ذكر آنفاً من دعائه «صلى الله عليه وآله» بما
دعا به موسى حين فلق البحر، رواه الواقدي وغيره، وقالوا: إنه دعا
به لما انكشف عنه الناس، ولم يبق معه إلا المائة الصابرة([4]).
ورووا عن أنس أيضاً:
انه «صلى الله عليه وآله» قال: «اللهم إنك إن تشأ
لا تعبد بعد اليوم»([5]).
روى ابن إسحاق، وأحمد، عن جابر بن عبد الله، وابن
إسحاق، وعبد الرزاق، ومسلم عن العباس، عم رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، قال العباس: شهدت مع رسول الله «صلى الله عليه وآله»: يوم
حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، فلم نفارقه، ورسول الله «صلى الله عليه وآله» على بغلة له
شهباء.
قال:
فلما التقى المسلمون والكفار ولَّى المسلمون
مدبرين.
فطفق رسول الله «صلى الله عليه وآله» يركض بغلته
قِبَل الكفار، وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله «صلى الله عليه
وآله».
وفي رواية:
أكفها أن لا تسرع، وهو لا يألو ما أسرع نحو
المشركين ([6]).
(وهو يقول:
أنــــا الــنــبــي لا كــــذب
أنــــا ابــن عبـــد المـطــلـب).
وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركاب رسول الله «صلى
الله عليه وآله»([7]).
وفي رواية:
بغرزه (بغرز (النبي) رسول الله «صلى الله عليه
وآله»)([8]).
وفي رواية:
بثفره (بثفر بغلته)([9]).
فالتفت رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى أبي
سفيان بن الحارث، وهو مقنَّع في الحديد، فقال: «من هذا»؟
فقال:
ابن عمك يا رسول الله([10]).
وفي حديث البراء:
وأبو سفيان ابن عمه يقود به([11]).
قال ابن عقبة:
وقام رسول الله «صلى الله عليه وآله» في الركابين،
وهو على البغلة، فرفع يديه إلى الله يدعو، يقول: «اللهم إني أنشدك
ما وعدتني.. اللهم لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا»([12])
انتهى.
وفي نص آخر قال العباس:
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «يا عباس!!
نادِ يا معشر الأنصار، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة».
قال العباس:
وكنت رجلاً صيتاً، فقلت بأعلى صوتي: أين الأنصار؟
أين أصحاب السمرة؟ أين أصحاب سورة البقرة؟
قال:
والله لكأنما عطفتهم حين سمعوا
صوتي عطفة البقر على أولادها([13]).
وقالوا أيضاً:
فلما سمعت الأنصار نداء العباس عطفوا، وكسروا جفون
سيوفهم، وهم يقولون: لبيك، ومروا برسول الله «صلى الله عليه وآله»،
واستحيوا أن يرجعوا إليه، ولحقوا بالراية، فقال رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، للعباس: من هؤلاء يا أبا الفضل؟
فقال:
يا رسول الله، هؤلاء الأنصار.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
الآن حمي الوطيس.
ونزل النصر من السماء، وانهزمت هوازن([14]).
وعند الطبرسي:
«فلما سمع المسلمون صوت العباس، تراجعوا، وقالوا:
لبيك، لبيك. وتبادر الأنصار خاصة، وقاتلوا المشركين حتى قال رسول
الله «صلى الله عليه وآله»: الآن حمي الوطيس.
أنــــا الــنــبــي لا كــــذب
أنــــا ابــن عبـــد المــــطــلـب
ونزل النصر من عند الله تعالى، وانهزمت هوازن هزيمة
قبيحة، فمروا في كل وجه، ولم يزل المسلمون في آثارهم. ومر مالك بن
عوف، فدخل حصن الطائف»([15]).
وفي حديث عثمان بن شيبة:
أنه «صلى الله عليه وآله» قال: «يا عباس، إصرخ
بالمهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة، وبالأنصار الذين آووا ونصروا».
قال:
فما شبهت عطفة الأنصار على رسول الله «صلى الله
عليه وآله» إلا عطفة الإبل على أولادها (أو عطفة البقر على
أولادها، أو عطفة النحل على يعسوبها) حتى ترك رسول الله «صلى الله
عليه وآله» كأنه في حرجة، فلرماح الأنصار كانت أخوف عندي على رسول
الله «صلى الله عليه وآله» من رماح الكفار([16]).
انتهى.
فقالوا:
يا لبيك، يا لبيك، يا لبيك.
قال:
فيذهب الرجل يثني بعيره، ولا يقدر على ذلك، أي
لكثرة الأعراب المنهزمين ـ كما ذكره أبو عمر بن عبد البر ـ فيأخذ
درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه، ويقتحم عن بعيره، فيخلي
سبيله، فيؤم الصوت، حتى ينتهي إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله».
حتى إذا اجتمع منهم مائة، استقبلوا الناس، فاقتتلوا
هم والكفار. والدعوة في الأنصار: يا معشر الأنصار، ثم قصرت الدعوة
على بني الحارث بن الخزرج، وكانوا صُبَّراً عند الحرب.
وأشرف رسول الله «صلى الله عليه وآله» في ركابيه،
فنظر إلى مجتلدهم، وهم يجتلدون، وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى
قتالهم، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «هذا حين حمي
الوطيس» أو (الآن حمي الوطيس).
ثم أخذ رسول الله «صلى الله عليه وآله» حصيات فرمى
بهن وجوه الكفار، ثم قال: «انهزموا، ورب محمد».
فذهبت أنظر، فإذا القتال على
هيئته فيما أرى، فوالله، ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى
حدَّهم كليلاً، وأمرهم مدبراً، فوالله ما رجع الناس (أو فوالله ما
رجعت راجعة الناس من هزيمتهم، حتى وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول
الله «صلى الله عليه وآله») إلا وهم أسارى عند رسول الله «صلى الله
عليه وآله» مكتفون، قتل الله تعالى منهم من قتل، وانهزم منهم من
انهزم، وأفاء الله تعالى على رسوله أموالهم، ونساءهم، وأبناءهم([17]).
وروي برجال ثقات، عن ابن مسعود
قال:
كنت مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوم حنين،
فولى الناس عنه، وبقيت معه في ثمانين رجلاً من المهاجرين والأنصار،
فقمنا على أقدامنا ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله تعالى
عليهم السكينة، ورسول الله «صلى الله عليه وآله» على بغلته لم يمض
قدماً، فحادت به بغلته، فمال عن السرج، فقلت له: ارتفع رفعك الله.
فقال:
«ناولني كفاً من تراب»، فناولته، فضرب وجوههم،
فامتلأت أعينهم تراباً، ثم قال: «أين المهاجرون والأنصار»؟
قلت:
هم أولاء.
قال:
«اهتف بهم». فهتفت بهم، فجاؤوا وسيوفهم بأيمانهم
كأنها الشهب، وولى المشركون أدبارهم([18]).
وعن أنس قال:
جاءت هوازن يوم حنين بالنساء، والصبيان، والإبل،
والغنم، فجعلوهم صفوفاً، ليكثروا على رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، فالتقى المسلمون والمشركون، فولى المسلمون مدبرين، كما قال
الله تعالى، وبقي رسول الله «صلى الله عليه وآله» وحده، فقال رسول
الله «صلى الله عليه وآله»: «يا عباد الله، أنا عبد الله ورسوله».
ونادى رسول الله «صلى الله عليه وآله» نداءين لم
يخلط بينهما كلاماً، فالتفت عن يمينه، فقال: «يا معشر الأنصار، أنا
عبد الله ورسوله».
فقالوا:
«لبيك يا رسول الله، نحن معك».
ثم التفت عن يساره، فقال:
يا معشر الأنصار، أنا عبد الله ورسوله.
فقالوا:
لبيك يا رسول الله، نحن معك.
فهزم الله تعالى المشركين، ولم يضرب بسيف، ولم يطعن
برمح([19]).
ويقول أبو بشير المازني:
إنه حين رأى المقدمة قد انهزمت، وصار الناس ينهزمون
معها: «وأكرّ في وجوه المنهزمين، ليس لي همة إلا النظر إلى سلامة
رسول الله «صلى الله عليه وآله»، حتى صرت إلى رسول الله «صلى الله
عليه وآله» وهو يصيح: «يا للأنصار».
فدنوت من دابته، والتفت من ورائها، وإذا الأنصار قد
كروا كرة رجل واحد، ورسول الله «صلى الله عليه وآله» واقف على
دابته في وجوه العدو.
ومضت الأنصار أمام رسول الله «صلى الله عليه وآله»
يقاتلون، ورسول الله «صلى الله عليه وآله» سائر معهم يفرجون العدو
عنه، حتى طردناهم فرسخاً، وتفرقوا في الشعاب، حتى فلوا من بين
أيدينا.
فرجع رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى منزله
وقبته، وقد ضربت له، والأسرى مكتفون حوله، وإذا نفر حول قبته. وفي
قبته زوجاته: أم سلمة وميمونة، حولها النفر الذين يحرسون رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، وهم: عباد بن بشر، وأبو نائلة، ومحمد بن
مسلمة([20]).
وفي نص آخر:
أنه «صلى الله عليه وآله» نادى أصحابه، وذمرهم: «يا
أصحاب البيعة يوم الحديبية، الله، الله الكرة على نبيكم».
وقيل:
إنه قال: «يا أنصار الله وأنصار رسوله، يا بني
الخزرج»، وأمر العباس بن عبد المطلب فنادى في القوم بذلك، فأقبل
إليه أصحابه سراعاً يبتدرون([21]).
ونقول:
قد تضمنت النصوص المتقدمة أموراً نشير إلى طائفة
منها، كما يلي:
ويذكرون في تبرير هزيمتهم:
أن المشركين اختبأوا في مضايق
الوادي، وشعابه، وأجنابه، وتهيأوا، قالوا: «فما راعنا إلا كتائب
الرجال بأيديها السيوف، والعمد، والقنا، فشدوا علينا شدة رجل واحد،
فانهزم الناس راجعين..»([22]).
ولكن الشيخ المفيد يقول:
إنه بعد أن فرَّ المسلمون،
وبعد نداء العباس: «وكانت ليلة ظلماء، ورسول الله «صلى الله عليه
وآله» في الوادي، والمشركون قد خرجوا عليه من شعاب الوادي، وجنباته،
ومضايقه، مصلتين سيوفهم، وعمدهم وقسيهم»([23]).
ولعل شدة المشركين على المسلمين شدة رجل واحد، قد
أرعبت المسلمين، فهربوا، ثم خرج باقي المشركين على النبي «صلى الله
عليه وآله» من المضائق والشعاب، بأيديهم العمد، والسيوف، والقسي.
عن سيابة بن عاصم السلمي:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال يوم حنين:
«أنا ابن العواتك»([24]).
أو:
«أنا ابن العواتك من قريش»([25]).
أو:
«أنا ابن العواتك من سليم»([26]).
ونقول:
العواتك من سليم ثلاث نساء من جدات رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، وهن:
1 ـ
عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان. أم عبد مناف بن
قصي.
2 ـ
عاتكة بنت مرة بن هلال، بن فالج بن ذكوان. أم هاشم
بن عبد مناف.
3 ـ
عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان.
أم وهب بن عبد مناف بن زهرة، جد النبي «صلى الله عليه وآله»..
فالأولى عمة الثانية، والثانية
عمة الثالثة، وبنو سليم تفخر بهذه الولادة([27]).
والعواتك من جداته «صلى الله
عليه وآله» اثنتا عشرة:
ثلاث منهن من بني سليم،
واثنتان من قريش، وكنانية، وأسدية، وهذلية، وقضاعية، وأزدية([28]).
وقال اليعقوبي:
«واللاتي ولدنه من العواتك
اثنتا عشرة عاتكة: عشر منهن مضريات، وقحطانية، وقضاعية. والمضريات:
ثلاث من قريش، وثلاث من سليم، وعدوانيتان، وهذلية، وأسدية..»([29]).
وذكر ابن عساكر في تاريخه عن
أبي عبد الله العدوي:
أن العواتك أربع عشرة وأن السلميات أربع([30])
ومن أراد التوسع في البحث فليراجع.
غير أننا نقول:
لعل كلمة «من سليم» أو «من قريش» قد أضيفت إلى كلمة
رسول الله «صلى الله عليه وآله».. حيث إن المناسب هو: أن يكون
مقصوده «صلى الله عليه وآله» جميع العواتك الاثني عشر.
إذ قد تقدم:
أن الهزيمة التي جرت على المسلمين كان سببها قبيلة
سليم، ومن معها من أهل مكة في مقدمة الجيش.
بل صرحت بعض الروايات:
بأن المسؤول عن ذلك هو خصوص سليم دون سواها..
فهل يريد «صلى الله عليه وآله»:
أن يكافئ سليماً على فعلتها الشنعاء تلك؟!..
من أجل ذلك نقول:
لعله «صلى الله عليه وآله» كان يقصد بكلمته هذه: أن
يقول للناس:
أولاً:
إن خطأ من حضر من سليم في هذه الحرب، لا يعني أن
يلحق العار بالأبرياء من هذه القبيلة أيضاً.
ثانياً:
إن هذا الخطأ يجب أن لا يكون سبباً في استمرار سير
هذه القبيلة باتجاه واحد، هو سبيل الإنحراف والغي، فالذي يخطئ
وينحرف يمكنه أن يرجع عن سبيل الغي إلى سبيل الخير والصلاح ولو بعد
حين..
وقد كان في بني سليم أناس صالحون في السابق، إلى حد
أن ثلاث جدات لرسول الله «صلى الله عليه وآله» كنّ منها، وقد نشأن
في بيوت عز وخير.. فما المانع من أن تعود سليم إلى انتهاج طريق
الهدى، والفلاح والنجاح؟!..
ثالثاً:
إنه لا بد لرسول الله «صلى الله عليه وآله» من
العمل على ترميم سمعة القبائل التي تبتلى بخطأ بعينه، حتى لا تسقط
في مهاوي الخزي والعار، فإن ذلك من شأنه أن يحدث خللاً في البنية
الإجتماعية، وأن تنشأ عنه تداعيات كبيرة وخطيرة..
لذلك نلاحظ:
أنه ينسب نفسه إلى العواتك، ويقول للناس: إن عليهم
أن لا يتمادوا في الطعن في هذه القبيلة أو تلك، ما دام أن له «صلى
الله عليه وآله» رحماً فيها، وفي كثير من تلك القبائل، مثل: سليم،
وكنانة، وأسد، وهذيل، وقضاعة، والأزد.
ونضيف نحن هنا أمراً رابعاً:
وهو أن راوي هذه الرواية وهو سيابة بن عاصم. كان من
بني سليم، فقد يكون ذلك من أسباب الشبهة في صحة هذه الإضافة، وهي
كلمة «من بني سليم»، من حيث إن من الممكن أن يكون قد أراد بروايته
هذه جرّ النار إلى قرصه، ودفع العار عن بني جنسه.. فلا بأس بالبحث
عن طريق آخر لهذه الرواية لا يكون فيه تهمة من هذا القبيل.
وعن المراد بقوله «صلى الله
عليه وآله»:
يا أصحاب سورة البقرة، نقول:
إن هذه السورة هي أول سورة نزلت في المدينة، فلعل هذا
النداء يرمي إلى تذكيرهم ببعض آياتها التي تقول:
{وَأَوْفُواْ
بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ}
([31])،
وتقول:
{كَم
مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ الله}
([32]).
وتقول:
{وَمِنَ
النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ
رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ}
([33]).
كما أن هذه السورة تضمنت أيضاً:
حديثاً عن المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، ويوقنون
بالآخرة، وسائر العقائد، وحديث المنافقين، وعن مختلف قضايا التشريع،
وحقائق الدين.
غير أننا نقول:
لعل القول بأن المراد التذكير بقوله تعالى:
{وَأَوْفُواْ
بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ}
هو الأنسب بقوله: يا أهل بيعة الشجرة، و يا أصحاب
السمرة.
وبقوله:
ذكِّرهم بالعهد.
وقوله:
إلى أين تفرون؟ أذكروا العهد الذي عاهدتم.
وقوله:
يا أصحاب البيعة يوم الحديبية.. ونحو ذلك..
فإن مثل هذا كله يدل على:
أن المقصود هو: إلزامهم بعهدهم، ليكون ذلك حافزاً لهم
على العودة إلى ساحات الجهاد.
كما أنه يتضمن قدراً من التهديد بأن الله تعالى سوف
يعاملهم بالمثل، وهذا ما لا يمكنهم تحمله والرضا به لأنفسهم.
وحين نادى النبي «صلى الله عليه
وآله» الفارين:
أين ما عاهدتم الله عليه؟! أسمع أولهم وآخرهم، ليقيم
الله عليهم الحجة بذلك. لأنها معجزة تثبت صدق هذا النبيّ العظيم «صلى
الله عليه وآله» من جهة. وتذكرهم بما يحفزهم للثبات والتصدي من جهة
أخرى، فلم يعد يمكن لأي منهم أن يقول: إن الخوف أنساني كل شيء، ولو
أنني التفت لهذه الأمور في تلك اللحظات لكان لي موقف آخر.
والذي يراجع النص الذي أورده الشيخ
المفيد «رحمه الله»، يلاحظ:
أنه «صلى الله عليه وآله» لم يقل: اذكروا العهد الذي
عاهدتموني عليه، بل قال: اذكروا العهد الذي عاهدتم عليه رسول الله..
فيكون بذلك قد تجنب الإيحاء بأن الأمر يرتبط به كشخص، وأثار في الأذهان
صورة عن ارتباط الموضوع بالله تعالى، حين ذكروا: أن العهد كان معه بما
أنه رسول الله، لا بما له من صفة شخصية.
ولكنه حين ظهرت معجزته لهم، ورأوا شاهد نبوته عياناً،
حيث رأوا وجهه في الظلمات، فأضاء كأنه القمر ليلة البدر، عاد فذكَّرهم
بالعهد، ولكنه ربطه بالله مباشرة، ولم يعد ثمة من حاجة إلى تحديد دوره
في هذا الأمر. فإن المعجزة قد حددت ذلك، وعرفتهم برسوليته «صلى الله
عليه وآله»، ولابد أن ينتهي كل شيء إليه تبارك وتعالى..
وعن دعاء النبي «صلى الله عليه وآله» بعد فرار أصحابه
عنه نقول:
إنه «صلى الله عليه وآله» ذكر فقرات ثلاثاً، هي:
1 ـ
اللهم لك الحمد.
2 ـ
وإليك المشتكى.
3 ـ
وأنت المستعان.
وفي سياق بيان ذلك نقول:
ألف:
إنه «صلى الله عليه وآله» يريد أن يعرِّف كل أحد انه
حتى حين يفر عنه جميع من معه، ويبقى وحده في مواجهة عشرات الألوف من
أعدائه، الساعين إلى سفك دمه، فإن ذلك لا ينقص من نعم الله عليه، بل
ذلك يؤكد أن لا أحد يستحق الحمد سواه تبارك وتعالى؛ لأنه وحده المنعم
المتفضل..
بل إن فرارهم عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا بد
أن يفهم على أنهنه بمثابة التفريط
بنعمة الله تعالى عليهم، لا أنه إضرار برسول الله «صلى الله عليه
وآله»، أو إنقاص من النعم الواصلة إليه، ولذلك قال «صلى الله عليه
وآله»: اللهم لك الحمد.
ب:
وإذا فرط هؤلاء الناس بنعم الله، وتخلوا عن واجبهم
الإلهي، واستحقوا الإبعاد عن ساحة رحمته، ولطفه جل وعلا.
وإذا كان الله تعالى ـ وحده ـ هو المنعم الواهب،
والمتفضل.. فإن أحداً لا يستطيع أن ينفعهم بشيء. ولا أن يصلح ما
أفسدوه، ويبني ما هدموه إلا هو تبارك وتعالى..
وهذا يعني:
أن الشكوى لغير الله لا تثمر شيئاً، بل هي ليست بشكوى،
لأن غير الله لا يستطيع أن يدفع، ولا أن يمنع.. والإنسان العاقل لا
يعبث ولا يلعب. بل إن الشكوى لغير الله ـ والحالة هذه ـ تمثل نكراناً
لفضله تبارك وتعالى، وهذه خطيئة لا يمكن أن تصدر من المعصوم. ولذلك قال
«صلى الله عليه وآله»: وإليك المشتكى.
ج:
وإذا كان الله تعالى وحده هو القادر، والقاهر، والحكيم،
والعليم، والرؤوف الرحيم، والمعطي والمانع. وإذا كانت المخلوقات كلها
تستمد منه، وتفتقر إليه. فلا معنى للإستعانة بسواه. لأن ذلك من السفه
الذي لا يصدر عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أيضاً. ولذلك قال
«صلى الله عليه وآله»: وأنت المستعان.
د:
وإذا كانت هذه هي العقيدة الراسخة بالله تبارك وتعالى،
وهي خلاصة نظرة الإنسان إلى الكون وما فيه، وإلى الحياة بكل مظاهرها..
وإذا تمحض في الإخلاص والصدق في هذا الدعاء المرتكز إلى
ذلك الإيمان الراسخ، فسوف يتحقق بعمق وصدق مفهوم قوله تعالى:
{ادْعُونِي}.
ويكون لا بد من الإستجابة لمن يدعوه تعالى ولا يدعو غيره.. ويرجوه ولا
يرجو غيره..
ولابد بعد هذا أن ننتظر تحقق المعجزات، وقد تحققت في
حنين فعلاً، كما تحققت لموسى «عليه السلام» من قبل، وشاهد تحقق
المعجزات في حنين: أن الله تعالى قد هزم عشرات الألوف بسيف علي «عليه
السلام» وحده. بعد أن أمد الله رسوله «صلى الله عليه وآله» والمؤمنين
بجنود لم يروها، تماماً كما حصل في حرب بدر العظمى..
وكما جرى في حرب بدر جرى في حرب حنين، فقد قال «صلى
الله عليه وآله» في كلتا الواقعتين: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا
تعبد، وإن شئت أن لا تعبد، لا تعبد.
ونقول:
أولاً:
لا شك في أن المقصود بـ «هذه العصابة» هو عصابة أهل
الإيمان، الذين يدافعون عن دينهم وعن نبيهم، وعلي «عليه السلام» أولهم،
وعلى رأسهم..
وأما شمولها للذين ولوا الأدبار، ولم يفوا بعهدهم، بما
فيهم المشركون. وقد صرحوا: بأنهم ثمانون رجلاً، بما فيهم المنافقون وما
أكثرهم. يضم إليهم أصحاب المطامع والأهواء.. نعم.. أما شمول هؤلاء فذلك
غير ظاهر.. فإن الإسلام إنما كان يقوم على النبي «صلى الله عليه وآله»
وعلي «عليه السلام»، فإن هلكا فلا إسلام بعد ذلك، ولا عبادة لله تعالى.
وأما المنهزمون، فإن فرارهم الذي هو بمثابة هلاك وبوار
دورهم، وانعدام تأثيرهم ـ فلم يمنع من استمرار عبادة الله تبارك
وتعالى.
ثانياً:
إنه «صلى الله عليه وآله» قد علق استمرار عبادة الله
تعالى على مشيئة الله تبارك وتعالى.
ومن الواضح:
أن وجوب شكر المنعم، وعبادة الله، والطاعة له حكم عقلي،
لا مجال للتخلف عنه. وهذا معناه: أن المقصود بكلامه هذا «صلى الله عليه
وآله»، ليس هو إسقاط هذا الوجوب، بل المراد: أن تزول عبادة الله تعالى
بزوال المؤمنين، وهلاكهم.
وتحاول بعض النصوص:
أن تلطف العبارات، وتخفف من حدة قبح الهزيمة، بطريقة
ذكية، حين تنسب الهزيمة إلى الأعراب، لكي يفهم الناس أن قريشاً، وأهل
مكة، والمهاجرين لم يكونوا مع المنهزمين.. وإن كان معهم منهم أحد،
فإنما هم أفراد قليلون، جرفهم السيل البشري للأعراب ربما من غير اختيار
منهم.
وهذا ولا شك خيانة للحق والحقيقة، لما يستبطنه من تزوير
وتضليل، ولا نريد أن نقول أكثر من ذلك.
تقدم:
أن المسلمين انهزموا عن النبي «صلى الله عليه وآله» في
ليلة ظلماء، وأن وجهه «صلى الله عليه وآله» أضاء للناس كالقمر ليلة
البدر.
ولكن قد يقال:
إن ذلك مما يصعب القبول به، إذا أخذنا بالرواية التي
تقول: فلما تراءت الفئتان حمل المشركون على المسلمين حملة رجل واحد،
فانهزموا.. لأن ترائي الفئتين يكون في النهار عادة..
ويمكن أن يجاب عن ذلك:
بأن المقصود بترائي الفئتين: هو مواجهة كل منهما
للأخرى، ولو بوصول طلائع الفريقين إلى موقع ترى فيه طرفاً من الفريق
الآخر. وهذا يحصل ليلاً كما يحصل نهاراً.
وليس المقصود:
الرؤية المباشرة نهاراً..
ويؤيد ما نقول:
قولهم أيضاً في نصوص أخرى سبقت: إنه «صلى الله عليه
وآله» صار يسأل عن أبي سفيان بن الحارث، وسأل أيضاً عن الأنصار الذين
حضروا بعد الهزيمة إلى ساحة القتال.. إذ لعله «صلى الله عليه وآله»
احتاج إلى السؤال عنهم بسبب حيلولة الظلام بينه وبينهم، فلا يراهم..
ويمكن الرد على ذلك:
بأنه ربما يكون قد سأل عنهم لأنه يريد تعريف الناس بهم،
والجهر باسمهم، وبيان حالهم.. حتى وإن كان قد عرفهم بالرؤية المباشرة،
أو بالعلم الخاص، الذي اختصه الله تعالى به.
قد ظهر من سياق رواية المفيد:
أن الناس لم يصغوا إلى نداء العباس، بل مروا على وجوههم
في هزيمتهم.
فلما ناداهم النبي «صلى الله عليه
وآله»:
«أين ما عاهدتم الله عليه»؟ لم يسمعها رجل إلا رمى
بنفسه إلى الأرض، فانحدروا إلى حيث كانوا من الوادي، حتى لحقوا بالعدو،
فقاتلوه([34]).
فلا يصح قولهم ـ حسبما تقدم وما
سيأتي ـ:
إن عودة الأنصار كانت لسماعهم نداء العباس([35]).
غير أن لنا تحفظاً على قوله «لحقوا بالعدو فقاتلوه» إذ
إن الدلائل والشواهد تشير إلى أنهم لم يقاتلوهم، كما سيأتي.
قد صرحت رواية عثمان بن شيبة:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» طلب من العباس: أن ينادي
المهاجرين والأنصار.
ولكن الغريب في الأمر:
أن المهاجرين لم يستجيبوا للنداء أبداً، وإنما استجاب
الأنصار فقط، كما ذكرته رواية القمي وغيره([36])،
ورواية عثمان بن أبي شيبة نفسها، بل لقد صرحت رواية الطبرسي بالقول:
«تبادرت الأنصار خاصة»([37]).
ونص آخر يذكر:
أنه «صلى الله عليه وآله» طلب منه أن ينادي خصوص
الأنصار.
بل لقد ذكرت رواية أبي بشير المازني:
أنه «صلى الله عليه وآله» كان يصيح: يا للأنصار، وإذ
بهم كروا كرة رجل واحد، ومضت الأنصار أمامه «صلى الله عليه وآله»
يقاتلون حتى طردوا العدو، فلماذا خص نداءه بالأنصار، ولم يذكر
المهاجرين؟
أليس لأنه كان قد يئس من نصرهم؟!
وتقدم عن أنس:
أنه لما بقي النبي «صلى الله عليه وآله» وحده، نادى
«صلى الله عليه وآله» نداءين لم يخلط بينهما كلاماً، فالتفت عن يمينه،
وقال: يا معشر الأنصار، أنا عبد الله ورسوله، فقالوا: لبيك يا رسول
الله، نحن معك، فهزم الله تعالى المشركين الخ..
وعن سعيد بن جبير:
فيومئذٍ سمى الله تعالى الأنصار مؤمنين، قال:
{ثُمَّ
أَنَزلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ}([38])»([39]).
بل صرحت رواية عثمان بن شيبة([40]):
بأنه لما اجتمع حول النبي «صلى الله عليه وآله» مائة، وكانت الدعوة في
الأنصار: يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج.
بل روي:
أنه «صلى الله عليه وآله» قال: يا أنصار رسول الله! يا
بني الخزرج!!
وذلك يدل على عدم صحة ما ذكرته رواية ابن مسعود، من أنه
بعد أن ضرب وجوه المشركين بكف من تراب، أمره بأن يهتف: يا للمهاجرين
والأنصار، فهتف بهم، فجاؤوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب.
فإن الصحيح هو:
أن الذين جاؤوا ولبوا النداء هم خصوص الأنصار ولاسيما
الخزرج. بل الخزرج منهم فقط.
ويتجلى حب الأنصار لرسول الله «صلى الله عليه وآله» في
تعبيرات الروايات، كقول العباس: «والله، لكأنما عطفتهم حين سمعوا صوتي
عطفة البقرة على أولادها»([41]).
وقولهم:
«ما شبهت عطفة الأنصار على رسول الله «صلى الله عليه
وآله» إلا عطفة الإبل على أولادها»([42]).
وفي نص آخر:
فثابوا من كل ناحية، كأنهم النحل تأوي إلى يعسوبها([43]).
وحين يكون المحارب محباً لقائده، فإنه وإن فرَّ حين
تفاجئه هجمة قوية، ولكن محبته تبقيه على مقربة ممن يحب، وتدفعه لأن
يبذل محاولة لمعرفة ما جرى عليه، ثم العودة إليه بمجرد أن تلوح له
بارقة أمل عن حياته ونجاته..
وأما غير المحب، فلا يرده عن هزيمته شيء، ولا يفكر
بأحد.
ولعل هذا كان شأن المهاجرين وكان ذاك شأن الأنصار،
وخصوصاً الخزرج منهم، ولذلك نادى النبي
«صلى الله عليه وآله»
الأنصار، فكانوا هم الذين استجابوا، وعادوا إليه.
وقد ذكرت رواية الإرشاد المتقدمة:
أنه لما انهزم المسلمون عن النبي «صلى الله عليه وآله»
التفت إليهم ببعض وجهه، فأضاء لهم كأنه القمر ليلة البدر.
ونقول:
إن هذا النور المتدفق من وجه الرسول «صلى الله عليه
وآله» بحيث يراه الناس، والمفروض: أن هذا الأمر يحصل في الليل.. لا بد
أن يعطي الدلالة لأهل الإيمان على أن عليهم أن يكونوا أعمق إيماناً،
وأشد يقيناً مما هم عليه..
ولابد أن يدفعهم ذلك إلى إعادة النظر في فرارهم المزري
هذا، ويؤكد لهم أن ذلك معناه: خسران الدنيا والآخرة، إذ لا يمكن أن
يوفقهم الله لحياة سعيدة في الدنيا، بعد أن تركوا نبيهم لتتناهبه سيوف
أعدائه، وأعدائهم..
بل المتوقع لهم هو:
الخذلان الدائم، والعار، والخزي المقيم.. وفي الآخرة
ينتظرهم عذاب أليم.
كما أن الحجة تتم على الأعداء، الذين أظهر الله لهم نور
النبوة، في الليلة الظلماء، فلماذا، وعلام يحاربون الأنبياء، ويسعون
لقتلهم، وإسقاط دعوتهم؟ وما هو المبرر لطاعة ساداتهم وكبرائهم في أمر
خطير كهذا؟!
وهل يمكن لأولئك السادات
أن يحموهم من غضب الله تعالى، أو أن يكونوا بديلاً لهم عن عونه ولطفه
ورعايته؟!
ثم إن ذلك يحدد مركز الرسول
«صلى الله عليه وآله»
للأعداء، فإذا منعهم الله من الوصول إليه رغم كثرتهم وقوتهم، فذلك
معجزة أخرى لهم، تيسر لهم الإيمان، وتقودهم إلى التسليم والبخوع لنبوته
«صلى الله عليه وآله»،
حين تتهيأ الظروف لإسلامهم، بعد أن تضع الحرب أوزارها، ولا يكون
إسلامهم ـ والحالة هذه ـ قهراً وجبراً، وبلا حجة ودليل..
كما أن المنهزمين لا يمكن أن يعتذروا عن إمعانهم في
هزيمتهم: بأنهم لم يعرفوا مصير النبي
«صلى الله عليه وآله»،
فلا معنى للمخاطرة بالعودة إلى ساحة القتال، لأن ذلك إلقاء للنفس إلى
التهلكة بلا وجه ظاهر..
ثم إنهم حين يترقبون سؤالاً يحرجهم،
وهو:
لماذا كان الخزرج هم السبَّاقون لإجابة نداء الرسول
«صلى الله عليه وآله»،
والعودة إلى ساحة القتال دون الأوس، ودون سائر المهاجرين؟!
ولماذا خص النبي «صلى الله عليه وآله» الخزرج بندائه،
وخصهم الأنصار أنفسهم بالدعوة أيضاً؟!
نعم..
إنهم يترقبون سؤالاً من هذا القبيل يبادرون إلى الإجابة
بطريقة ضمنية، ويوردون الكلام بعفوية طبيعية، ويرسلونه إرسال المسلمات،
فيقولون: إن الخزرج صبَّر عند اللقاء.
ونقول:
1 ـ
ولا ندري كيف، ولماذا كان الخزرج كذلك دون إخوانهم من
الأوس، فضلاً عن غيرهم من قبائل المنطقة؟! مع أنهم كانوا في الجاهلية
يتصاولون مع الأوس تصاول الفحلين.
ولم يظهر لنا:
أنهم قد عرفوا بهذه الخصوصية قبل حرب حنين..
2 ـ
ولو كانت هذه صفتهم، فلماذا هربوا قبل لحظات ولم يصبروا
كما صبر علي
«عليه
السلام»،
ونفر من بني هاشم؟!
إن الحقيقة هي:
أن
الخزرج كانوا ـ بصورة عامة ـ أكثر إيماناً، والتزاماً،
وطاعة لرسول الله
«صلى الله عليه وآله»
من غيرهم، وقد عرف فيهم النبي
«صلى الله عليه وآله»
ذلك فخصهم بالنداء.. وعمّ الأنصار.. فكانوا أسرع استجابة، فصاروا
ينادون يا للأنصار، على أمل أن يلتحق بهم غيرهم من سائر القبائل، فلما
لم يبادر أحد إلى ذلك صاروا يقولون: يا للخزرج ـ حسبما تظهره النصوص
التي ذكرناها فيما سبق..
وقد ذكرت رواية ابن مسعود المتقدمة:
أنه
«صلى الله عليه وآله»،
«لم
يمض قُدُماً».
أي أنهم يريدون القول: بأنه «صلى الله عليه وآله» قد ثبت في موضعه، ولم
يتقدم للقتال، مكتفياً بالدفاع عن نفسه، وحفظ موقعه بانتظار عودة
المنهزمين لمهاجمة الكافرين، ليكون تحقيق النصر على المشركين على
أيديهم.. مع ان ذلك غير صحيح.
والظاهر:
أن هذا من أخطاء النساخ.
والصحيح هو:
أن يقال:
«لم
يزل يمضي قدماً»
وعلي «عليه السلام» يهد المشركين هداً بعد ان قتل صاحب لوائهم. وتحقق
النصر.
وقد صرحت الروايات المتقدمة نفسها، بالقول:
«فطفق رسول الله «صلى الله عليه وآله» يركض بغلته
قِبَلَ الكفار، وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله «صلى الله عليه
وآله»..».
وفي رواية:
«أكفها
أن لا تسرع، وهو لا يألو ما أسرع نحو المشركين»([44]).
ركض
 بغلته
نحو علي بغلته
نحو علي  : :
وقد تقدم في حديث الشيخ المفيد:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» لما رأى الهزيمة ركض نحو
عليٍّ بغلته، فرآه قد شهر سيفه الخ..
([45]).
ولم تفصح الروايات:
عن سبب ذلك منه «صلى الله عليه وآله»، فهو يعرف: أن
علياً «عليه السلام» لا يمكن أن يفرَّ من ساحة المعركة.. فلعله أراد ان
يطمئن على سلامته من أي سوء، وأن يؤكد موقعه «عليه السلام» في ساحة
الجهاد، لكي لا يحاول المغرضون نسبة الأباطيل إليه «عليه السلام»،
وخداع البسطاء من الناس بها.
ولعل هذه الرواية قد حُرِّفت وحذفت منها كلمة «نحو علي»
ووضع مكانها «نحو المشركين» أو «قبل الكفار» كما ورد في روايات
الآخرين، من الذين يحاولون مساواة علي «عليه السلام» بغيره.
وفي بعض هذه الروايات:
«..كان النبي «صلى الله عليه وآله» يركض ناحية هوازن
(الكفار) ويقول:
أنــــا الــنــبــي لا
كــــذب أنــــا ابــن عبـــد المـطــلب»([46]).
مع ملاحظة:
أن تعبيرهم أيضاً ليس فيه شيء من الكذب، لأن علياً
«عليه السلام» كان يغوص في أوساط المشركين، ويقتل منهم من حضرت منيته،
ومن بلغ إليه سيفه.
النبي
 يطالب
المهاجرين بعهدهم: يطالب
المهاجرين بعهدهم:
ويستفاد من النصوص المتقدمة:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» حين قال للعباس: نادِ
بالقوم، وذكرهم العهد، إنما قصد بذلك خصوص المهاجرين.
ويدل على ذلك:
ما ورد في حديث عثمان بن شيبة المتقدم، حيث قال «صلى
الله عليه وآله»: «يا
عباس، إصرخ بالمهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة، وبالأنصار الذين آووا
ونصروا».
فإن الأنصار والمهاجرين معاً قد بايعوا النبي «صلى الله
عليه وآله» تحت الشجرة، فما معنى تخصيص المهاجرين بهذا الوصف، وتوصيف
الأنصار بالذين آووا ونصروا؟!
ألا يؤكد هذا:
على أن المقصود هو تسجيل إدانة للمهاجرين، من حيث إنهم
لم يفوا بعهدهم، ومن حيث أن وازعهم للعودة هو وفاؤهم بالعهود التي
يعطونها، وهو ما يلتزم به حتى الإنسان الجاهلي.
وأما الأنصار، فإنهم وإن أسرعوا في الفرار في بادئ
الأمر، إلا أن إيواءهم ونصرتهم تكفي حافزاً لهم على سرعة العودة إلى
رسول الله «صلى الله عليه وآله» لكي يحفظوه، ويطيعوه، وليحفظوا جهدهم،
ولا يبطلوا جهادهم، وذلك هو ما يفرض عليهم الإلتزام والطاعة.
وهذا يشير إلى اختلاف أساسي بين النظرتين، وبين
الفريقين..
ويدل على نوع الوعي، ودرجة الإيمان، وحوافز الإلتزام
لدى هؤلاء، وأولئك، ولا نريد أن نقول أكثر من ذلك.
وقد تقدم في حديث القمي:
أن الأنصار حين عادوا إلى القتال، استحيوا من أن يرجعوا
إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، ولحقوا بالراية في ساحة المعركة
مباشرة.
وهذا يشير إلى:
أن ثمة معاني إنسانية، وقيماً أخلاقية تهيمن على
الأنصار، وتؤثر في سلوكهم وحركتهم.. وعلى قاعدة: الحياء من الإيمان.
يكون ذلك دليلاً على بعض نفحات الإيمان فيهم أيضاً.
وسأل رسول الله «صلى الله عليه وآله» العباس بن عبد
المطلب عن أولئك الناس الذين كانوا يرجعون إلى ساحات القتال، فيقول: من
هؤلاء يا أبا الفضل؟!
فيقول:
يا رسول الله، هؤلاء الأنصار.
فهل كان العباس «رحمه الله» أعرف بهم من رسول الله «صلى
الله عليه وآله»؟! ولماذا خفي أمرهم على النبي «صلى الله عليه وآله»،
وظهر لغيره؟!
إن الجواب الأقرب إلى الإعتبار هنا هو:
أنه «صلى الله عليه وآله» كان يريد من العباس أن يعلن
هوية الراجعين على الملأ، ليعرف الناس الفضل لأهل الفضل، ولكي يقطع
الطريق على المترصدين من سارقي الفضائل، ومنتحلي المواقف كذباً وزوراً.
حتى لا يحرموا الأنصار من حقهم، وفضلهم بالسطو على هذه الفضيلة ايضاً
في جملة ما يسطون عليه.
وهكذا يقال أيضاً:
حين رأى «صلى الله عليه وآله» أبا سفيان بن الحارث وهو
مقنع بالحديد، فسأل عنه، فأجابه أبو سفيان: ابن عمك يا رسول الله..
وقد يلاحظ القارئ الكريم:
أن ثمة تناقضات فيما بين الروايات..
فمن ذلك:
اختلاف الروايات في الذي ناول النبي «صلى الله عليه
وآله» الحصى، أو التراب، أو أن النبي «صلى الله عليه وآله» تناوله
بنفسه.. وهل نزل عن البغلة من أجل ذلك؟ أم أنها هي التي انخفضت به؟ وقد
تقدم ذلك.. وتقدم أن من الممكن دفع التناقض المتوهم.
ومنه أيضاً:
أن عودة الأنصار هل كانت لسماعهم نداء العباس، أو لسماع
نداء الرسول «صلى الله عليه وآله» نفسه؟!
ويمكن حل هذا التناقض:
بأن من الممكن أن يعود فريق لسماعه صوت النبي «صلى الله
عليه وآله»، ويعود فريق آخر لسماعه صوت العباس.
ومنه:
الإختلاف في موقع العباس، وأبي سفيان بن الحارث من رسول
الله «صلى الله عليه وآله» بعد فرار المسلمين.
فهل كان أبو سفيان آخذاً بركاب النبي «صلى الله عليه
وآله»؟ أم بغرزه؟ أم بثفر السرج؟
وهل كان الآخذ بعنان البغلة هو العباس؟ أم أبو سفيان بن
الحارث؟
وهل كان العباس أمامه «صلى الله عليه وآله»؟ أم كان
آخذاً بلجام البغلة؟ أم كان عن يمينه؟
ويمكن أن يدفع هذا التناقض:
بأن الحالات قد اختلفت، فتارة كان هذا يأخذ بعنان
البغلة، وأخرى ذاك. وتارة يكون أمامه، وأخرى يكون خلفه، وغير ذلك.
ومنه:
الإختلاف في نداء النبي «صلى الله عليه وآله» والعباس.
هل كان للأنصار فقط؟ أم كان للأنصار والمهاجرين معاً؟
وقد تقدم ذلك.
ويمكن دفع التناقض:
بأنه «صلى الله عليه وآله» ناداهم جميعاً أولاً، ثم خص
الأنصار بالنداء، حين رأى أن المهاجرين لا يلوون على شيء.
ومنه:
الإختلاف في عدد من ثبت مع النبي «صلى الله عليه وآله»
كما سيأتي إن شاء الله تعالى..
ومنه:
الإختلاف في أنهم بعد عودتهم من فرارهم إلى ساحة
المعركة هل قاتلوا أم لا؟
ومنه:
الإختلاف في الذين نزلت عليهم السكينة. وقد أوضحنا ذلك
فيما سبق، وربما نعود إلى التوضيح.
ومنه:
اختلاف الروايات في أن هوازن خرجت من الشعاب على النبي
«صلى الله عليه وآله»، فثبت لهم. أم خرجت على المسلمين، فانهزموا؟ كما
سنرى.
النبي
 يركب
بغلة: يركب
بغلة:
إنه لا شك في أنه كانت لدى النبي «صلى الله عليه وآله»
خيول معروفة بأسمائها وأعيانها، مثل الظرب، ولزاز.
ولكننا نقرأ في النصوص المتقدمة:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يركب شيئاً من الخيل
في حنين، بل كان يركب البغلة الشهباء، أو تلك المسماة بدلدل.
ولعل ذكر الفرس في حديث عبد الرحمن الفهري، حيث قال:
إنه «صلى الله عليه وآله» اقتحم عن فرسه، فأخذ كفاً من
تراب، قد ورد سهواً من الراوي، وإذ قد ظهر ذلك، فإن السؤال الذي يطرح
نفسه هنا هو:.
لماذا لم يركب «صلى الله عليه وآله» فرساً، فإنها أقدر
على التحرك السريع في ساحات القتال؟!
ويؤكد ضرورة اختيار الخيل هنا:
أنه «صلى الله عليه وآله» كان هو المستهدف الأول لكل
تلك الجيوش والكتائب، وستكون همتها مصروفة للوصول إليه.. وسيكون ركوبه
البغلة من دواعي الحرص على استهدافه بالهجمات، حيث يترجح لدى أعدائه
احتمال تمكنهم من إلحاق الأذى به «صلى الله عليه وآله».
ونقول في الجواب:
لعل السبب في هذا الإختيار هو:
1 ـ
أن ذلك يدل على: أن ثمة شجاعة نادرة، وثباتاً لا مثيل
له لدى رسول الله «صلى الله عليه وآله». «لأن ركوب الفحولة مظنة
الإستعداد للفرار والتولي. وإذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه على عدم
الفرار، والأخذ بأسباب ذلك كان أدعى لاتباعه»([47]).
2 ـ
إن النبي «صلى الله عليه وآله» كان قد وعد المسلمين
النصر، وأن يجعل الله ما جاؤوا به من أموال، وأنعام وسواها، غنائم
للمسلمين. فإذا كان النبي «صلى الله عليه وآله» يركب بغلة، وليس فرساً،
وقد فر عنه جميع من كان معه وهم اثنا عشر ألفاً، أو أكثر، أو أقل، وقد
أصبح هو وابن عمه علي «عليه السلام»، وربما بضعة أشخاص آخرين من بني
هاشم وحيدين في بلاد الأعداء النائية، وإذا كان اعداؤه الذين يهاجمونه
هم أهل البلاد، العارفون بمسالكها، وفجاجها، ومضايقها، وهم على درجة
كبيرة من الكثرة، ووفرة العدد، وحسن العدة، حتى إن عددهم قد يصل إلى
عشرين ألف سيف، أو أزيد من ذلك.
وإذا كان قد تفرق عنه جيشه في تلك البلاد وتاه في
أرجائها، حتى لم يعد يمكن جمعه، ولا الإعتماد عليه في تحقيق أي شيء
يؤثر على مصير الحرب..
فإذا كان الأمر على هذا الحال.. فإن المتوقع هو أن يغير
النبي «صلى الله عليه وآله» من مسير حركته، وان يدخل تغييرات أساسية
على أوضاعه الأمنية، والقتالية، ليتمكن من تجاوز هذه المحنة بسلام.
ولكن هذا النبي «صلى الله عليه وآله» العظيم والكريم لم
يتخذ أي إجراء احتياطي حتى في هذه الحال الشديدة، فلم يبحث عن مركوب
يستطيع بحركته السريعة أن يمكِّن من يمتطيه، ليس من الخروج من ساحة
القتال، وإنما من حفظ نفسه ـ ولو من خلال المراوغة السريعة ـ من هجمات
أعدائه المتتابعة.
بل بقي في موقع التحدي والتصدي ليحقق النصر، الذي كان
قد وعد الناس به، فكان له ما أراد، على يد أحب الخلق إلى الله تعالى،
وإليه، وهو علي بن أبي طالب «عليه السلام».
وليكون ذلك دليلاً آخر على صدقه، وعلى نبوته «صلى الله
عليه وآله»، وعلى أنه متصل بالغيب، ومؤيد بالله، ومسدد بألطافه، ومحاط
بعناياته الظاهرة والخفية.
3 ـ
والذي زاد من وضوح هذه المعجزة الظاهرة، وسطوع هذه
الكرامة الباهرة: أنه «صلى الله عليه وآله» يعلن للناس عن نفسه، ويصرح
لهم باسمه الشريف، ليسمعه الأعداء منهم والأصدقاء على حد سواء.
ومضمون هذا الإعلان هو:
إخبارهم بأنه سينتصر، كما أخبرهم، مضيفاً إلى ذلك أنه
قد جعل نفس النبوة رهينة بهذا النصر.. ويكون هذا منه في الوقت الذي يرى
كل أحد أنه لا يملك شيئاً، يمكن أن يعطي أية فرصة مهما كانت ضئيلة لذرة
من خيال لاحتمال نجاة له من عشرين ألف سيف يحيطون به، بعد أن فرَّ عنه
جميع أنصاره، وتركوه في بلاد عدوه وحيداً فريداًو
توهم لاحتمال .
وقيل:
إن جيش الكفار كان ضعفي المسلمين
في العدد، وأكثر من ذلك. «ولذا جزم في النور: بأن هوازن كانوا أضعاف
الذين كانوا معه «صلى الله عليه وآله»..»([48]).
وتقدم القول:
بأن بعض جيش المشركين كان ثلاثين ألفاً.
وذكر الثعالبي:
أنهم كانوا ثلاثين ألفاً([49]).
والدليل على أنه «صلى الله عليه وآله» قد جعل نفس نبوته
رهينة بهذا النصر: أنه «صلى الله عليه وآله» كان يعرِّف الناس بموقعه
وبمكانه، ويتحدث عن نفسه لهم، بعنوان: أنه الذي يحمل صفة النبوة، التي
«يستحيل معها الكذب. ويقول:
أنــــا الــنــبــي لا
كــــذب أنــــا ابــن عبـــد المـطــلــب
([50])
وكأنه «صلى الله عليه وآله» قال:
لأنني أنا النبي. والنبي لا يكذب، فلست بكاذب فيما أقول
حتى أنهزم، وأنا متيقن من أن الذي وعدني به الله من النصر حق.
«وقيل
معنى قوله:
لا كذب. أي أنا النبي حقاً لا كَذبَ في ذلك»([51]).
ونظير هذا الموقف رواه لنا محمد بن سنان عن الإمام
الرضا «عليه السلام»، فإنه قال له في أيام هارون: إنك قد شهرت نفسك
بهذا الأمر، وجلست مجلس أبيك، وسيف هارون يقطر بالدم؟!.
قال:
جرأني على هذا، ما قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»:
إن أخذ أبو جهل من رأسي شعرة، فاشهدوا أني لست بنبي.
وأنا أقول لكم:
إن أخذ هارون من رأسي شعرة، فاشهدوا أني لست بإمام([52]).
4 ـ
ثم إنه «صلى الله عليه وآله» قد نسب نفسه إلى عبد
المطلب، لشهرة أمر عبد المطلب في البلاد والعباد، لما رزقه من نباهة
الذكر، وطول العمر.. ولم يكن لعبد الله والد النبي «صلى الله عليه
وآله» شهرته.
5 ـ
والأهم من ذلك كله: أنه «صلى الله عليه وآله» ـ كما ذكر
في الروايات المتقدمة ـ قد نزل عن بغلته حين غشيه الأعداء، وذلك مبالغة
منه في إظهار الإصرار على الثبات والصبر مهما كانت النتيجة، فإن توهم
أحد أن للبغلة أي أثر في حفظ نفسه الشريفة «صلى الله عليه وآله»، أو
التسريع في خروجه من دائرة الخطر، فإن نزوله عنها يبدد هذا الوهم،
ويمحو أثره من الوجود..
يضاف إلى ذلك:
أن ذلك يتضمن مواساةً منه «صلى الله عليه وآله» لمن ثبت
وجاهد، وعرَّض نفسه للخطر، أو لاحتمالاته، أو احتمالات الضرر، فإنه
«صلى الله عليه وآله» لا يرغب بنفسه عن أنفسهم.
6 ـ
ثم إن هناك تصعيداً آخر في موقفه الحازم والصارم هذا،
وهو: أن الروايات قد ذكرت: أنه «صلى الله عليه وآله» قد تجاوز موضوع
اختيار البغلة كمركوب له في ساحات الخطر..
ثم النزول عنها ليصبح راجلاً.
ثم تعريف الناس بمكانه، وبصوته، وأنه ما زال على قيد
الحياة.
نعم..
لقد تقدم خطوة أخرى باتجاه الخطر الهائل الذي يتحاشاه
أعظم الناس بطولة وبسالة، وأشدهم إقداماً، وشجاعة.. وهو أنه حين غشوه،
وأصبح راجلاً، صار يتقدم باتجاه أعدائه..
ولا شك في أن هذا سيفاجئ الأعداء، ويصدمهم، ويثير
أمامهم احتمالات تزلزلهم، وتشوش الموقف أمام أعينهم، وستختلط عليهم
الأمور، وتتناقض المشاعر، وسيفهمون ذلك على أنه كرامة، بل معجزة، لا
يجوز لهم متابعة التحدي لها، لأن ذلك سيعرضهم لأخطار لم يحسبوا لها
حساباً، ولم تخطر لهم على بال، ولا مرت لهم في خيال..
وتتبلور تلك الصدمة الكبرى برؤيتهم علياً «عليه
السلام»، وهو يحصدهم حصداً، بسيف يتوالى لمعانه لهم كأنه شعلة نار،
يتجلى فيها غضب الجبار، وهي تجري فيهم حكم الواحد القهار.
7 ـ
كما أن المهزومين من المسلمين، سوف يصعقون لهذه
المفاجأة، وستتأكد لديهم المعجزة، والرعاية الإلهية، والحفظ الرباني
لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، وتأييده بنصره، وسيثير ذلك مشاعر
الندم لدى طائفة كبيرة منهم، ويعطيهم القوة والعزيمة، ويدعوهم إلى
تدارك ما بدر منهم، والعودة إلى ساحة الحرب، والشدة في الطعن والضرب.
نعم..
إن ذلك لا بد أن يعطي الكثير منهم القوة في الإيمان،
والنفاذ في البصيرة، والصدق في العزيمة، والحماس للتضحية، والرغبة في
مثوبة الله تبارك وتعالى.
وقد تقدم:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد قال حين فرَّ عنه الناس:
أنــــا الــنــبــي لا كــــذب
أنــــا ابــن عبـــد المـطــلـــب
وهذا الكلام له وزن الشعر، فهل يعتبر قائله شاعراً؟!
وكيف نوفق بين ذلك، وبين القول:
بأن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يكن شاعراً؟!..
ونجيب:
أولاً:
إن الكلام العادي، قد يأتي على وزن الشعر في بعض
الأحيان، ولكنه لا يعد شعراً إلا إذا قصد ذلك منه.
والشاهد على ذلك:
أنه قد ورد في القرآن بعض من ذلك، ولم يقل أحد: إن
القرآن قد تضمن شعراً.
فقد قال تعالى:
{وَقُرْآناً
فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ
تَنْزِيلاً}([53]).
وقال:
{وَأَخْرَجَتِ
الأرْضُ أَثْقَالَهَا}([54]).
وقال سبحانه:
{إِنَّا
أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ}([55]).
ولكن ذلك لا يصحح القول:
بأن القرآن قد تضمن بيتاً من الشعر، أو شطر بيت، ولم
يقل ذلك أحد من المشركين، والذين اتهموا النبي «صلى الله عليه وآله»،
بأنه شاعر لم يستطيعوا أن يتخذوا من هذه الآيات شاهداً على مزاعمهم، بل
إن الناس كذبوهم في مزاعمهم هذه..
ولم يستطيعوا أن يردوا قوله تعالى:
{وَمَا
عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَ ذِكْرٌ
وَقُرْآنٌ مُبِينٌ}([56]).
ولا قوله عز وجل:
{وَمَا
هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ}([57]).
بادِّعاء:
أن الآيات التي ذكرناها آنفاً تدل على خلاف ما دلت عليه
هاتان الآيتان.
ثانياً:
إن الآيات حين نفت عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»
أن يكون شاعراً، فإنما أرادت أن تقول أمرين:
الأول:
أن الشعر مما لا يليق بالأنبياء «عليهم السلام»، وقد
نزه الله تعالى عنه نبيه الكريم «صلى الله عليه وآله»، رفعاً لدرجته،
وتنزيهاً لساحته عن أن يكون ممن يزين المعاني الشعرية بالتخييلات
الكاذبة، والأوهام الباطلة.
الثاني:
أن هذا القرآن لم يعتمد الطريقة الشعرية في بيان
مقاصده. لكن ذلك لا يعني أن لا يصدر عن النبي «صلى الله عليه وآله»
كلام يتوافق مع وزن بيت، أو شطر بيت من الشعر.
بيان ذلك:
أن الشعر يقوم على أمرين:
أحدهما:
اعتماد الأمور الخيالية، والأوهام، والتزيينات اللفظية
والبديعية، في عرضه للمعاني على القلوب والنفوس، ودفعها للقبول بها.
الثاني:
التزام الوزن بما له من موسيقى مثيرة، وإيقاع مؤثر كأسلوب آخر من
أساليب التسويق للمقاصد والمعاني، التي يراد إبعادها عن مجال التأمل
والتحليل العقلي، فتُلقى إلى القلوب والنفوس عبر المشاعر والإنفعالات
فتتلقفها، وتتفاعل معها من دون فكر وروية، وبلا تدبر في الأبعاد،
والأسباب، أو في الأهداف والنتائج.
أما إذا جاء الكلام موزوناً، ولكن من دون أن يكون
للإيقاع والوزن أي تأثير في التسويق للمعنى، ومن دون أن يعطل دور العقل
في التأمل والتفكر، والتحليل، والتدبر، ومن دون أن تمازج تلك المعاني
خيالات أو أوهام. فإن هذا الكلام لا يكون مشمولاً لما نزه الله نبيه
عنه تجليةً منه وتكريماً له، وتنزيهاً عنه.
وهذا هو السبب في أن وجود فقرة أو فقرات يتوافق وزنها
مع وزن بعض الشعر لم يجعل هذه الفقرات من الشعر، ولا يكون نقضاً
للقاعدة التي أطلقها القرآن حول الشعر والشعراء، وحول القرآن،
والأنبياء. إدانة ورفضاً، وحلاً ونقضاً.
النبي
 يركض
البغلة، والعباس يكفها: يركض
البغلة، والعباس يكفها:
ونقرأ في الروايات المتقدمة:
كيف أن النبي كان يركض البغلة نحو الكفار، وكان العباس
يكفها، بعد أن ولى المسلمون مدبرين.
ومن الواضح:
أن هذا الهجوم على الأعداء من رسول الله «صلى الله عليه
وآله» من شأنه أن يرعبهم، لاسيما وهم يرون أنه راكب على بغلة، تقصر به
عن بلوغ مراده في ساحة الحرب، فاندفاعه الواثق والقوي هذا يجعل
المشركين يحسبون ألف حساب لما يمكن أن يكون معتمده، وما يريد أن يحققه.
ولابد أن يمنعهم ذلك من الإقدام والمغامرة، أو هو على الأقل يوجب قدراً
من التردد لديهم في ذلك..
أما العباس فهو يكف البغلة عن الإسراع باتجاه العدو،
لأنه يرى أن من واجبه أن يحتاط للأمر، ويحفظ حياته وحياة رسول الله
«صلى الله عليه وآله». وهو لا يلام في ذلك، لأنه لا يقصد مخالفة
الرسول، ولا يريد إبطال تدبيره..
على أن هذا الاندفاع من رسول الله «صلى الله عليه وآله»
كان لأجل أن يكون بالقرب من أخيه علي «عليه السلام»، الذي كان قد غاص
في أوساط الأعداء، حتى افتقده العباس، وظن أنه تخلى عن موقعه، وعن
دوره، فأطلق كلمات تبرُّم وشك، فدلوه على موقعه فيما بين تلك الكتائب
المتكالبة على قتله، وقتل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ومن معهما
من المؤمنين.
([1])
البحار ج21 ص167 وراجع ص156 و 157 والإرشاد ج1 ص142 وأعيان
الشيعة ج1 ص279 وكشف الغمة ج1 ص222 وكشف اليقين ص144.
([2])
الظرب: ما نشأ من حجر، وحدّ رأسه. والرابية الصغيرة.
([3])
البحار ج21 ص150 و 151 والتفسير الصافي ج2 ص331 و 332 والتفسير
الأصفى ج1 ص459 و 460 وتفسير الميزان ج9 ص234 وتفسير نور
الثقلين ج2 ص199 و 200 وتفسير القمي ج1 ص287 و 288 وراجع:
تاريخ الخميس ج2 ص104 والسيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة)
ج2 ص111.
([4])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص327 عن الواقدي، وفي هامشه عن: المعجم
الصغير ج1 ص122 ومجمع الزوائد ج10 ص183 والترغيب والترهيب ج2
ص618 تاريخ الخميس ج2 ص104 وراجع: تفسير النسفي ج2 ص84 البحار
ج21 ص150 وتفسير القمي ج1 ص287 والتفسير الصافي ج2 ص331 و 332
والتفسير الأصفى ج1 ص459 و 460 وتفسير الميزان ج9 ص234 وتفسير
نور الثقلين ج2 ص200 وتفسير القمي ج1 ص287 و 288.
([5])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص326 و 327 عن ابن أبي شيبة، وأحمد برجال
الصحيح، وقال في هامشه: عن أحمد ج5 ص152 وعن ابن أبي شيبة ج10
ص351 وج14 ص522 وعن مسلم ج3 ص1363 (23/1743) وابن سعد ج2 ق1
ص52 والسيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص111 وراجع:
المصنف لابن أبي شيبة ج6 ص75 و (ط دار الفكر) ج7 ص95 وج8 ص550
وكنز العمال ج10 ص548 والبداية والنهاية ج4 ص375 والسيرة
النبوية لابن كثير ج3 ص621 وميزان الحكمة ج3 ص2251 عن البحار
ج21 ص180 ح16.
([6])
راجع: تاريخ الخميس ج2 ص103 ومسند أحمد ج1 ص207 والمصنف
للصنعاني ج5 ص379 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص194 وكنز العمال
ج10 ص546 وتفسير القرآن للصنعاني ج2 ص269 وجامع البيان ج10
ص131 والدر المنثور ج3 ص224 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص155
وتاريخ مدينة دمشق ج4 ص18 وتهذيب الكمال ج24 ص134 وسبل الهدى
والرشاد ج5 ص322.
([7])
راجع: صحيح مسلم ج5 ص167 والمستدرك للحاكم ج3 ص328 وفتح الباري
ج6 ص93 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص197 ورياض الصالحين للنووي
ص715 والجامع لأحكام القرآن ج8 ص98 والطبقات الكبرى لابن سعد
ج4 ص18 وتاريخ مدينة دمشق ج4 ص17 والبداية والنهاية ج4 ص378
وإمتاع الأسماع ج5 ص67 وج7 ص217 والسيرة النبوية لابن كثير ج3
ص627 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص322 وج11 ص102.
([8])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج5 ص322 وج7 ص47 وذخائر العقبى ص198
ومسند أحمد ج1 ص207 ومسند أبي يعلى ج12 ص67 وصحيح ابن حبان = =
ج15 ص524 وتفسير القرآن للصنعاني ج2 ص269 والدر المنثور ج3
ص224 وتاريخ مدينة دمشق ج4 ص19 وتهذيب الكمال للمزي ج24 ص134
والدر المنثور ج4 ص160 وجامع البيان ج10 ص131 والسنن الكبرى
للنسائي ج5 ص124 و 194 ومسند أبي يعلى ج12 ص67 ومشاهير علماء
الأمصار لابن حبان ص44 والطبقات الكبرى ج2 ص155 ومسند أبي
عوانة ج4 ص277 والمصنف للصنعاني ج5 ص380 وفضائل الصحابة ج2
ص927 وطبقات الشافعية الكبرى ج1 ص259.
([9])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج5 ص322 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص349
والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص896 والبداية والنهاية ج4 ص374
والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص619.
([10])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج5 ص322 وكتاب التوابين لابن قدامة
ص116.
([11])
راجع: السنن الكبرى ج5 ص188 وج6 ص155 وكنز العمال ج10 ص540
وجامع البيان ج10 ص132 وتفسير البحر المحيط ج5 ص26 وتاريخ
الأمم والملوك ج2 ص348 وإمتاع الأسماع ج7 ص218 وسبل الهدى
والرشاد ج5 ص322 و 349.
([12])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص322 وقال في هامشه: أخرجه الطبراني في
الكبير ج10 ص188 وانظر المجمع ج6 ص82 وج8 ص619 والبيهقي في
الدلائل ج5 ص31 وعبد الرزاق في المصنف (9741) والحميدي (459)
وابن سعد ج2 ق1 ص112 وأحمد ج1 ص207 وراجع: إعلام الورى ص122
والبحار ج21 ص167 وتاريخ الخميس ج2 ص102 و 103 وشجرة طوبى ج2
ص310 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص578 والبداية والنهاية ج4
ص378 وإمتاع الأسماع ج5 ص66 وإعلام الورى ج1 ص232 والسيرة
النبوية لابن كثير ج3 ص626.
([13])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص322 و 323 وراجع: تاريخ الخميس ج2 ص103
وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص580 والبداية والنهاية ج4 ص378
ودلائل النبوة للبيهقي ج5 ص138 والسيرة النبوية لابن كثير ج3
ص627 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص62 و 63 والسيرة النبوية لدحلان (ط
دار المعرفة) ج2 ص110 و 111.
([14])
تفسير القمي ج1 ص287 و 288 والبحار ج21 ص151 وشجرة طوبى ج2
ص309 والتفسير الأصفى ج1 ص460 والتفسير الصافي ج2 ص332 وتفسير
نور الثقلين ج2 ص200 وتفسير الميزان ج9 ص234.
([15])
مجمع البيان ج5 ص17 و 18 و (ط مؤسسة الأعلمي) ص35 والبحار ج21
ص147 و 181 وتفسير الميزان ج9 ص231.
([16])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج5 ص323 والمعجم الكبير للطبراني ج7
ص299 وتاريخ مدينة دمشق ج33 ص257 والسيرة الحلبية (ط دار
المعرفة) ج3 ص66 ومجمع الزوائد ج6 ص184.
([17])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج5 ص323 عن أبي القاسم البغوي،
والبيهقي، وفي هامشه عن: الطبراني في الكبير ج7 ص358 وابن
عساكر كما في التهذيب 6 ص351 وراجع: تاريخ الخميس ج2 ص103
والسيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص110 و 111 والسيرة
الحلبية ج3 ص111 وراجع ص108 و 109 وراجع: مسند أحمد ج1 ص207
وصحيح مسلم ج5 ص167 وشرح مسلم للنووي ج12 ص115 وفتح الباري ج8
ص25 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص197 ومسند أبي يعلى ج12 ص67
وتفسير البغوي ج2 ص278 والطبقات الكبرى لابن سعد ج4 ص18 وتاريخ
مدينة دمشق ج4 ص19 والجمع بين الصحيحين لمحمد بن فتوح الحميدي
ج3 ص327 ومشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ج8 ص1649 وتهذيب
الكمال ج24 ص134 وسيرة النبي المختار ج1 ص355 والمنتظم في
تاريخ الملوك والأمم ج3 ص334.
([18])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص325 عن أحمد، والطبراني، والحاكم، وأبي
نعيم، والبيهقي، وقال في هامشه: أخرجه أحمد ج1 ص453 والطبراني
في الكبير ج10 ص209 وانظر المجمع ج6 ص84 و 183 والحاكم ج2
ص117 وتاريخ الخميس ج2 ص104 عن أحمد، والحاكم، والسيرة النبوية
لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص110 و 111 وراجع: مسند أحمد ج1
ص454 ومجمع الزوائد ج6 ص180 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص359
وتاريخ مدينة دمشق ج33 ص79 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص582
وإمتاع الأسماع ج5 ص70 ومسند البزار ج5 ص368. وراجع: والسيرة
الحلبية ج3 ص110.
([19])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص325 عن ابن أبي شيبة، وأحمد، والحاكم،
وابن مردويه، والبيهقي، وقال في هامشه: أخرجه أحمد ج3 ص190 و
279 و ج5 ص286 وابن سعد ج2 ق1 ص113 وابن أبي شيبة ج14 ص530 و
531 والبيهقي في الدلائل ج5 ص141 وفي السنن ج6 ص306 والدولابي
في الكنز ج1 ص42 وانظر الدر المنثور ج3 ص224 وراجع: السيرة
النبوية لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص111 والسيرة الحلبية ج3
ص108 و 109 والمصنف ج8 ص551 وكنز العمال ج10 ص550 وصحيح
البخاري ج4 ص1567 و (ط دار الفكر) ج5 ص106 وصحيح مسلم ج2 ص735
و (ط دار الفكر) ج3 ص106 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج3
ص123 وصحيح ابن حبان ج11 ص88 والجمع بين الصحيحين ج2 ص494
والمصنف لابن أبي شيبة ج7 ص416 ومسند أحمد ج3 ص280 وعمدة
القاري ج17 ص311 والبداية والنهاية ج4 ص357 و (ط دار إحياء
التراث العربي) ص409 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص675.
([20])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص319 و 320 عن الواقدي.
([21])
الإرشاد ج1 ص142 والبحار ج21 ص167 وراجع ص156 و 157 والبداية
والنهاية ج4 ص378 وإعلام الورى ج1 ص232 والسيرة النبوية لابن
كثير ج3 ص626 وراجع: دلائل النبوة للبيهقي ج5 ص131 والإكتفاء
ج2 ص244 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص66 وتاريخ
الإسلام ج2 ص578.
([22])
إعلام الورى ص121 و (ط مؤسسة آل البيت) ج1 ص230 والبحار ج21
ص166 وقصص الأنبياء للراوندي ص347 وراجع: مناقب آل أبي طالب ج1
ص181 وشجرة طوبى ج2 ص309 والدر النظيم لابن حاتم العاملي ص182.
([23])
الإرشاد ج1 ص142 والمستجاد من الإرشاد (المجموعة) ص84 والبحار
ج21 ص156 و 157 وشجرة طوبى ج2 ص308 وأعيان الشيعة ج1 ص279.
([24])
سبل الهدى والرشاد ج1 ص323 وج5 ص336 عن الطبراني، وفي هامشه
عن: الطبراني في الكبير ج7 ص201، وانظر مجمع الزوائد ج8 ص219
والبيهقي في الدلائل ج5 ص135 وسعيد بن منصور (2840 و 2841)
وابن عساكر كما في التهذيب ج1 ص289 وراجع: عمدة القاري ج14
ص287 والمعجم الكبير (ط دار إحياء التراث) ج7 ص169والإستيعاب
(ط دار الجيل) ج2 ص691 شرح النهج للمعتزلي ج14 ص267 عن
الواقدي، وكنز العمال ج11 ص443 وج12 ص438 وطبقات خليفة بن خياط
ص101 والجرح والتعديل ج4 ص321 والثقات ج1 ص29 وتاريخ مدينة
دمشق ج3 ص107 و 110 وأسد الغابة ج2 ص382 وج4 ص184 وتذكرة
الحفاظ ج3 ص1067 والإصابة ج3 ص194 وج5 ص304 وتاريخ اليعقوبي ج2
ص120 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص580 والوافي بالوفيات للصفدي
ج16 ص36 والبداية والنهاية ج4 ص375 و 376 وإمتاع الأسماع ج1
ص164 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص622 و 623 والسيرة الحلبية
(ط دار المعرفة) ج1 ص67 وج2 ص505 وتاج العروس ج2 ص91 والتاج
والإكليل ج3 ص392 والمراسيل لابن أبي حاتم ج1 ص69 ومعجم
الصحابة ج1 ص302.
([25])
الكافي ج5 ص51 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج19 ص250 و (ط دار
الإسلامية) ج13 ص346 والبحار ج19 ص171 والحدائق الناضرة ج22
ص357 وجواهر الكلام ج28 ص222 وجامع أحاديث الشيعة ج19 ص157
ومستدرك سفينة البحار ج7 ص81 وموسوعة أحاديث أهل البيت «عليهم
السلام» ج5 ص33 ومستدركات علم رجال الحديث ج8 ص585 ومجمع
البحرين ج3 ص118.
([26])
البحار ج19 ص171 و 172 والإستيعاب (ط دار الجيل) ج2 ص691
والفايق في غريب الحديث ج2 ص330 والجامع الصغير ج1 ص411 وكنز
العمال ج11 ص402 و 443 وج12 ص434 وغوامض الأسماء المبهمة ج2
ص779 والصحاح للجوهري ج4 ص1598 والنهاية في غريب الحديث ج3
ص179 وتاريخ واسط ج1 ص43 وغوامض الأسماء المبهمة ج2 ص780 ولسان
العرب ج10ص 464 وفيض القدير ج3 ص50 وتاج العروس ج13 ص610
وإكمال الكمال لابن ماكولا ج5 ص14 وتاريخ مدينة دمشق ج3
ص107والأعلام للزركلي ج3 ص242 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص120
والفردوس بمأثور الخطاب ج1 ص46 والفائق ج2 ص390 والروض الأنف
ج1 ص207 ومنح الجليل ص3 ص240 والوافي بالوفيات للصفدي ج16 ص36
والدر النظيم ص34 وسبل الهدى والرشاد ج1 ص323 والسيرة الحلبية
(ط دار المعرفة) ج1 ص67 و 144 وتهذيب اللغة ج1 ص197 .
([27])
راجع: لسان العرب ج10ص 464 والأعلام للزركلي ج3 ص242 والبحار
ج19 ص172 ومستدرك سفينة البحار ج7 ص81 وفيض القدير ج3 ص50
والنهاية في غريب الحديث ج3 ص180 وغوامض الأسماء المبهمة ج2
ص780 والحدائق الناضرة ج22 ص357 ومستدركات علم الرجال ج8 ص585
وسبل الهدى والرشاد ج1 ص323 وراجع: الروض الأنف ج1 ص206.
([28])
لسان العرب ج10ص 464 وراجع: كتاب المحبر للبغدادي ص47 والكامل
في التاريخ ج1 ص556 و (ط دار صادر) ج2 ص34 وراجع: تاج العروس
ج26 ص266.
([29])
تاريخ اليعقوبي ج2 ص120.
([30])
تاريخ مدينة دمشق ج3 ص110 وكنز العمال ج12 ص435.
([31])
الآية 40 من سورة البقرة.
([32])
الآية 249 من سورة البقرة.
([33])
الآية 208 من سورة البقرة.
([34])
البحار ج21 ص167 وراجع ص156 و 157 والإرشاد ج1 ص142 وأعيان
الشيعة ج1 ص279 وكشف الغمة ج1 ص222 وكشف اليقين ص144
([35])
راجع على سبيل المثال: سبل الهدى والرشاد ج5 ص323 ومجمع البيان
ج5 ص17 و 18 والمعجم الكبير للطبراني ج7 ص299 والثقات ج2 ص69
وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص348 وعيون الأثر ج2 ص218 وزاد المعاد
ج3 ص471 والإكتفاء ج2 ص243 والدرر لابن عبد البر ص226 والسيرة
النبوية لابن هشام (ط دار الجيـل) ج5 ص113 وكتـاب التـوابين
لابـن قدامة ج1 = = ص114 وتاريخ مدينة دمشق ج23 ص257 والسيرة
الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص65 و 66 والبحار ج21 ص147 و 151
وتفسير القمي ج1 وغير ذلك كثير جداً.
([36])
تفسير القمي ج1 ص287 و 288 والبحار ج21 ص151 وسبل الهدى
والرشاد ج5 ص331 والمغازي للواقدي ج3 ص904 وراجع المصادر في
الهامش السابق.
([37])
مجمع البيان ج5 ص17 و 18 والبحار ج21 ص147.
([38])
الآية 26 من سورة التوبة.
([39])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص327 عن ابن أبي حاتم، وفي هامشه عن الدر
المنثور ج3 ص223 وراجع: الدر المنثور ج4 ص162 و (ط دار
المعرفة) ج3 ص225 وجمع البيان ج10 ص103 و (ط دار الفكر) ص133
وتفسير ابن أبي حاتم ج3 ص752 وج6 ص1774 وفتح القدير ج2 ص349 .
([40])
راجع: تاريخ الخميس ج2 ص105.
([41])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص323 و 350 وج11 ص102 والسيرة النبوية
لدحلان (ط دار المعرفة) ج3 ص111 والسيرة الحلبية ج3 ص109 و (ط
دار المعرفة) ص66 وذخائر العقبى ص198 ومسند أحمد ج1 ص207 وصحيح
مسلم ج5 ص167 والمستدرك للحاكم ج3 ص328 وشرح مسلم للنووي ج12
ص115 وفتح الباري ج8 ص25 والمصنف للصنعاني ج5 ص380 ومسند
الحميدي ج1 ص219 والآحاد والمثاني ج1 ص273 والسنن الكبرى
للبيهقي ج5 ص197 وصحيح ابن حبان ج15 ص524 والمعجم الكبير
للطبراني ج7 ص299 وكتاب التوابين لابن قدامة ص115 ورياض
الصالحين للنووي ص715 وتفسير ابن أبي حاتم ج6 ص1773 وتفسير
الثعلبي ج5 ص23 وتفسير البغوي ج2 ص278 وتفسير القرطبي ج8 ص98
والدر المنثور ج3 ص224 وتاريخ مدينة دمشق ج4 ص17 و 19 وتهذيب
الكمال ج24 ص134 وتاريخ الإسلام ج2 ص580 والبداية والنهاية ج4
ص378 وإمتاع الأسماع ج5 ص67 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص327
ومجمع الزوائد ج6 ص184.
([42])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص323 عن البيهقي، وأبي القاسم البغوي،
وفي هامشه عن المعجم الكبير للطبراني ج7 ص358 وتهذيب تاريخ
دمشق ج6 ص351 وتاريخ الخميس ج2 ص103 والسيرة النبوية لدحلان (ط
دار المعرفة) ج3 ص111 والسيرة الحلبية ج3 ص109 و (ط دار
المعرفة) ص66 وفتوح الشام للواقدي ج1 ص206 وتاريخ مدينة دمشق
ج23 ص257 والخصائص الكبرى للسيوطي (ط دار الكتب العلمية) ج1
ص449.
([43])
راجع: تاريخ الخميس ج2 ص105 وراجع: الإكتفاء ج3 ص58 وسبل الهدى
والرشاد ج3 ص58.
([44])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص322 والدر المنثور ج4 ص160 و (ط دار
المعرفة) ج3 ص224 وتاريخ مدينة دمشق ج4 ص18 ومسند أحمد ج1
ص207 وراجع: المصنف للصنعاني ج5 ص379 والسنن الكـبرى للنسـائي
ج5 ص194 وكنز = = العمال ج10 ص546 وتفسير القرآن للصنعاني ج2
ص269 وجامع البيان (ط دار الفكر) ج10 ص131 وتهذيب الكمال ج24
ص134 ومسند أبي عوانة ج4 ص277 وفضائل الصحابة ج2 ص924 و 927
والمنتظم ج3 ص334.
([45])
البحار ج21 ص150 و 151 والتفسير الصافي ج2 ص331 و 332 والتفسير
الأصفى ج1 ص459 و 460 وتفسير الميزان ج9 ص234 وتفسير نور
الثقلين ج2 ص199 و 200 وتفسير القمي ج1 ص287 و 288 وراجع:
تاريخ الخميس ج2 ص104 والسيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة)
ج2 ص111.
([46])
السيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص110 وراجع: تفسير
القرآن العظيم ج3 ص580 وتفسير السعدي ج1 ص333 وتفسير أبي
السعود ج4 ص56 وتيسير الكريم الرحمن في كلام المنان ص333
والبداية والنهاية ج6 ص67 والتفسير الكبير ج16 ص18 ومناهل
العرفان ج2 ص269 وشرح الزرقاني على الموطأ ج3 ص27 وراجع: تفسير
الثعلبي ج5 ص23 وإمتاع الأسماع ج7 ص217 وروح المعاني ج10 ص74
وفتح الباري ج8 ص31 وعمدة القاري ج14 ص157.
([47])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج5 ص349 وفتح الباري ج8 ص 26 .
([48])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص351.
([49])
راجع: تفسير الثعالبي ج3 ص172 وراجع: السيرة النبوية لدحلان (ط
دار المعرفة) ج2 ص107 والسيرة الحلبية ج3 ص109 و (ط دار
المعرفة) ص66. وأعيان الشيعة ج1 ص282.
([50])
مصادر هذه الفقرات كثيرة، فراجع على سبيل المثال: إعلام الورى
ص122 والبحار ج21 ص167 والإرشاد ج1 ص143 وأمالي الطوسي ص574
ومناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج1 ص181 وسنن الترمذي ج3 ص117
والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص243 وتاريخ الخميس ج2 ص103 ومسند
أحمد ج4 ص281 و 289 وصحيح البخاري ج3 ص218 و 220 وج4 ص24وصحيح
مسلم ج5 ص168.
([51])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج5 ص349 وراجع: فتح الباري ج8 ص25
وتحفة الأحوذي ج5 ص274 وراجع: فيض القدير ج3 ص49 ومجمع البحرين
ج4 ص28 والتيسير بشرح الجامع الصغير ج1 ص374.
([52])
راجع: الكافي ج8 ص257 و 285 وشرح أصول الكافي ج12 ص356 ومناقب
آل أبي طالب ج3 ص451 والبحار ج49 ص59 و 115 والأنوار البهية ص
217 ومدينة المعاجز ج7 ص227 ومستدرك سفينة البحار ج7 ص395 و
مسند الإمام الرضا للعُطاردي ج1 ص165 وراجع: حياة الإمام الرضا
«عليه السلام» للقرشي ج1 ص41 وج2 ص227 وعن أعيان الشيعة ج4 ق2
ص97 والحياة السياسية للإمام الرضا «عليه السلام» ص324.
([53])
الآية 106 من سورة الإسراء.
([54])
الآية 1 من سورة الكوثر.
([55])
الآية 2 من سورة الزلزلة.
([56])
الآية 69 من سورة يس.
([57])
الآية 41 من سورة الحاقة.
|