نهايات حرب حنين
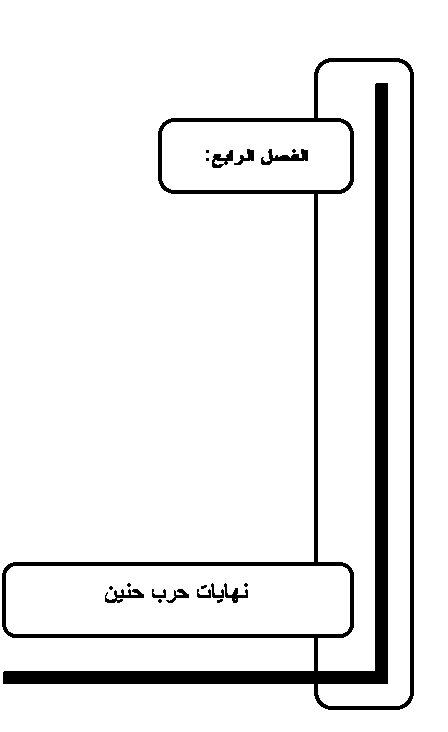
ولا بأس بأن نشير هنا إلى أنهم ينسبون إلى عباس بن
مرداس قوله:
فـإن سراة الحي إن كنـت سـائـلاً
سليـم وفيهـم منـهـم مـن تسـلـما
وجند من الأنصـار لا يخـذلـونـه أطـاعـوا فــما
يـعـصونـه ما تكلما
فإن تك قد أمرت في القوم خالداً وقــدمــتــه فـإنـه
قـد تـقــدمـا
بـجـنـد هـداه الله أنـت أمـــيره تـصـيـب به في الحق من كان
أظلما
حـلـفـت يـمـيـنـاً بـرة لمـحمد فـأكـمـلتـهـا ألفاً من
الخيل ملجما
وقـال نـبـي المـؤمـنـين تقدمـوا وحـب إلـيـنـا أن تـكـون
المقـدما
وبـتـنـا بنهـي المستديـر ولم تكن بـنـا الخـوف إلا
رغـبــة وتحـزمـا
أطعناك حتى أسلم الناس كلهم وحتى صبحنا الجمع أهـل يلملـما
يضل الحصان الأبلق الورد وسطه ولا يـطـمـئـن الشيخ حتى
يسوما
لـدن غـدوة حتـى تركنـا عشية حـنـيـنـاً وقـد سـالت دوامعه
دما
سمونا لهم ورد القطازفة ضحى وكـل تـراه عـن أخـيـه قد
احجما
إذا شـئـت من كل رأيت طمرة وفـارسهـا يهـوي ورمحــا محـطـما
وقـد أحرزت منا هوازن سربها وحب إليها أن نخـيـب
ونحـرما([1])
ونقول:
إن من يراجع كتب السيرة والتاريخ سيرى أمامه العديد من
القصائد، والمقطوعات الشعرية، المتضمنة للإفتخار بدور بني سليم في حرب
حنين، وأكثرها منسوب إلى أحد رؤساء هذه القبيلة، وهو العباس بن مرداس
السلمي..
هذا بالإضافة إلى الثناء على خالد، وتحسين تأميره على
المقدمة في حرب حنين..
غير أنه قد تقدم منا في بعض الفصول:
أن خالداً لم يكن ناجحاً في قيادته، وخصوصاً في حرب
حنين، وكان في المنهزمين الأوائل في ساحة القتال([2]).
وهكذا الحال بالنسبة لقبيلة سليم ـ التي كانت تفخر بأن
ألفاً منها قد حضروا في حنين([3])
ـ فإنها إما تبعت أهل مكة في الهزيمة، وقد كانوا معاً في المقدمة. وإما
أنها كانت هي المبادرة للفرار، وتبعها الناس في ذلك لا يلوون على شيء([4]).
وبقي علي أمير المؤمنين «عليه السلام» وحيداً في ساحة القتال، بالإضافة
إلى نفر من بني هاشم احتوشوا رسول الله «صلى الله عليه وآله»، لكي
يمنعوا المشركين من الوصول إليه، وإلحاق الأذى به..
من أجل ذلك كله نقول:
إن الأشعار المنسوبة للعباس بن مرداس إنما تهدف إلى
تزوير الحقيقة، وتبييض صفحة بني سليم، وخالد، ولو عن طريق إشاعة
الأباطيل والأكاذيب. ولا شيء أكثر من هذا.. وبطلان هذه الإدعاءات
كالنار على المنار، وكالشمس في رابعة النهار.. وقد خاب من افترى.
النبي
 يدافع عن
ذراري المشركين: يدافع عن
ذراري المشركين:
ولا ندري كيف يمكن تفسير ما ورد في
بعض الروايات المتقدمة:
من أن المسلمين حنقوا على المشركين، فقتلوهم حتى أسرع
القتل في ذراري المشركين، حتى اضطر رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
إلى النداء:
«ألا
لا تقتل الذرية، ألا لا تقتل الذرية» ثلاثاً
([5]).
غير أننا نكتفي هنا بالإلماح إلى ما يلي:
أولاً:
إن المشركين كانوا يعدون بالألوف، إن لم نقل بعشرات
الألوف.. ومجموع من قتل منهم كان حوالي مائة، كما تقدم، وسيأتي.. وأكثر
قتلى المشركين قتلوا على يد علي
«عليه
السلام»،
فإنه
«عليه
السلام»
بعد قتل أبي جرول قتل أربعين رجلاً، ولا ندري كم قتل قبل ذلك.. وقد كان
قتل أبي جرول ـ حسبما تقدم ـ هو السبب في كسر شوكة المشركين، وفي
هزيمتهم.
ولو أردنا تصديق ما زعموه:
من أن أبا طلحة قتل عشرين رجلاً من المشركين، وحصل على
سلبهم، وأضفنا إلى ذلك الأسير الذي قتله عمر بن الخطاب، والأسير الذي
قتلته أم عمارة والرجل الذي زعموا: أن النبي «صلى الله عليه وآله»
قتله.. وأضفنا إلى ذلك المرأة التي قتلها خالد، والذراري الذين قتلوا
من دون مبرر، فلا يبقى سوى قلة قليلة جداً لا تستحق هذه المبالغات،
التي يتخيل سامعها أن المسلمين قد حصدوا مئات من المشركين في فورة
حنقهم..
وفي جميع الأحوال يبقى السؤال
قائماً:
أين أمعن المسلمون في قتل رجال المشركين؟! وما هي حصيلة
هذا الإمعان سوى ما ذكرناه؟!.
ثانياً:
إذا كان المسلمون عشرة آلاف، أو اثنا عشر ألفاً،
ويقابلهم ضعف أو أضعاف عددهم من المشركين، قيل: أربعة وعشرون، بل
ثلاثون ألفاً، فلا بد أن نتوقع سقوط عدد من القتلى يتناسب مع عدد
الجيشين، ولو بأن يقتل واحد من كل عشرة من المشركين، وواحد من كل مائة
من المسلمين..
وهذا معناه:
أن تكون الحصيلة النهائية تعد بالمئات بل بالألوف.
ولاسيما مع الحنق والهيجان المنسوب للمسلمين، ومع الإسراع في القتل
المنسوب إليهم في المشركين، حتى تجاوز الرجال إلى الذرية..
ثالثاً:
إن المسلمين قد حاربوا أعداءهم طيلة ثماني سنوات في
عشرات الحروب، فما معنى أن يجهل أسيد بن حضير، وهو الرجل الذي يعظمونه
وينسبون إليه المقامات والفضائل، وهو ينافس على زعامة قبائل الأوس كلها
في المدينة. كيف وما معنى أن يجهل أنه لا يحق لأحد أن يقتل ذرية، ولا
عسيفاً، ولا امرأة، ولا شيخاً؟!
وهذه هي وصية رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
لكل بعوثه، وفيها يقول: «لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا صبياً، ولا امرأة»([6]).
بل إنه «صلى الله عليه وآله» قد
أرسل إلى خالد يقول له:
«لا
تقتل ذرية ولا عسيفاً»([7]).
وهم وإن لم يصرحوا باسم الغزوة التي أرسل إليه فيها هذا الأمر، لكنها
إما حنين، وإما الفتح بلا شك، لأن الرواية صرحت: بأنه قتلها بعد ما جرى
على المقدمة التي كانت بقيادته ما جرى.
ومن المعلوم:
أنه «صلى الله عليه وآله» لم يجعله على مقدمته بعد
حنين.
فما معنى أن يسأل أسيد بن حضير هذا السؤال إلا إذا كان
يرى أن في أوامر النبي
«صلى الله عليه وآله»،
ما يكون خطأً وغير معقول؟!
ولنترك أسيد بن حضير، لنسأل عن غيره من المسلمين
الحانقين الذين فتكوا بالذرية، فنسأل أيضاً: لماذا عصوا أوامر رسول
الله
«صلى الله عليه وآله»
وتوجيهاته لهم، وهي لم تزل تتلى على مسامعهم، عند إرسال كل سرية أو
بعث؟!
رابعاً:
إن الإسراع في قتل الذرية معناه: أنهم قد انتقلوا من
ساحة المعركة، إلى موضع وجودها، إذ إن الذرية لا تكون في ساحة القتال،
بل تجعل مع النساء بعيداً عن موضع الخطر، لكي لا ينالها مكروه في حالات
الكر والفر..
وهذا يشير إلى أنهم إنما فعلوا بالذرية ذلك في حال لم
تكن هوازن قادرة على التفكير بهم، والدفع عنهم. وليس ذلك إلا حال
فرارها من سيف علي «عليه السلام»، ومن جند الله تعالى، فشغلها ذلك عن
التفكير بأي شيء آخر، فاغتنم المسلمون الفارّون الفرصة للفتك بذرية
المشركين في نفس هذه اللحظات..
وهذه رذيلة، وليست فضيلة، وهي تدل على منتهى العجز
والخوار، وليست دليل بسالة وشجاعة.
خامساً:
إن ما نسبوه إلى رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
من أنه قال لأسيد بن حضير:
«أليس
خياركم أولاد المشركين»،
يبقى هو الآخر موضع ريب وشك.
ولعل الصحيح، هو:
أنه قال له: أليس تقولون (أو أليس تزعمون) أن خياركم
الخ..
أو لا بد من حمل كلامه على أنه أجراه وفق ما يعتقده ابن
حضير، ومن تابعه حيث يوهمون أنفسهم بأنهم خيار الناس، فهو سؤال تقريري
أجراه على ظاهر الحال منه..
وإلا، فالحقيقة هي:
أن خيار الناس هم أولاد الموحدين وهم النبي «صلى الله
عليه وآله» وأهل بيته الطاهرون.. ثم يأتي الناس بعدهم على مراتبهم.
وأخيراً نقول:
أولاً:
قد اتضح: أن ظواهر الأمور تعطي: بأن بعض الناس،
العاجزين، وغير الملتزمين بأوامر النبي «صلى الله عليه وآله»
وتوجيهاته، قد بادروا إلى قتل الذرية، فنهاهم رسول الله «صلى الله عليه
وآله»..
ويدل على ذلك:
نفس قول رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
«ما
بال أقوام بلغ بهم القتل حتى بلغ الذرية»؟!..
ثانياً:
إن نفس كلمات النبي
«صلى الله عليه وآله»
أيضاً تشير إلى أن ما يفعله هؤلاء في الذرية كان بدافع الحقد وشهوة
القتل، ولذلك قال
«صلى الله عليه وآله»
لهم:
«بلغ
بهم القتل حتى بلغ الذرية..»
أي إن حب وشهوة القتل نفسه قد ساقهم إلى هذا الحد غير المعقول ولا
المقبول..
وهذا في حد نفسه رذيلة لا بد من التنزه عنها، بل هو مرض
لا بد من علاجه، وتخليص النفوس منه..
وأما الحديث عن نذر قتل ذلك الرجل الذي تاب إلى الله،
وعدم قبول النبي «صلى الله عليه وآله» البيعة منه حتى يفي ذلك الناذر
بنذره، فهو غير مقبول، بل غير معقول..
أولاً:
لأن ذلك الرجل إذا كان قد أقلع عما كان عليه، وتاب إلى
الله، فكيف يسمح النبي
«صلى الله عليه وآله» بقتله،
وهل يحق له أن يفرط فيه بعد توبته.. أولم يصرح القرآن بأن الله تعالى
{هُوَ
الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ}([8])،
وقال تعالى:
{وَإِنِّي
لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ}([9]).
ثانياً:
هل يصح الإمساك عن مبايعة رجل جاء تائباً إلى الله
تعالى، واخذه بما سلف منه؟!
ثالثاً:
هل يصح نذر ذلك الرجل في أمر كهذا؟!. وهل يجب عليه أن
يفي به، بعد أن كان أمر الأسرى لا يعود إليه، بل هو بيد رسول الله
«صلى الله عليه وآله»؟!
والمفروض:
أن ذلك قد نذر قتله بعد أسره لا قبله. وليس لأحد أن
ينذر في حق الأسرى، أي شيء من دون إذنه
«صلى الله عليه وآله»
بعد أن أصبحوا في عهدة النبي، وصار أمرهم إليه «صلى
الله عليه وآله».
وهل هذا إلا مثل أن ينذر أحد أن يتصدق بمال غيره، أو أن
يعتق عبد جاره، أو أن يطلق زوجة أخيه؟!. وما إلى ذلك..
وزعموا:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» أمر المسلمين بقتل من
قدروا عليه من المشركين، وأنه قال لهم: اجزروهم جزراً، وأومأ بيده إلى
الحلق([10]).
وهو كلام مكذوب على رسول الله «صلى الله عليه وآله» بلا
ريب، فإن المطلوب إذا كان ذلك، فلماذا لم يقتلهم حين قدر عليهم،
وأسرهم؟!
يضاف إلى ذلك:
أنه «صلى الله عليه وآله» إنما يريد بحربه لهم دفع
شرهم، وإبطال كيدهم، وإيقافهم عند حدهم، ثم هدايتهم إلى الحق. ولا يريد
أن يتشفى منهم، لأنه لم يكن يحقد عليهم؛ بل كانت نفسه «صلى الله عليه
وآله» تذهب
حسرات على الضالين والمشركين، وقد خاطبه الله تعالى
بقوله:
{فَلَا
تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ}([11])،
وقوله:
{فَلَعَلَّكَ
بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا
الْحَدِيثِ أَسَفاً}([12])،
وكان «صلى الله عليه وآله» يقول: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»([13]).
حتى وهم يقاتلونه، ويحاولون سفك دمه.
وقد صرحت الروايات المتقدمة:
بأن نتائج حرب حنين، قد دعت الكثيرين من المكيين إلى
الدخول في الإسلام. قالوا:
«وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة، حين رأوا نصر الله
تعالى رسوله، وإعزاز دينه»([14]).
ولسنا بحاجة إلى بذل أي جهد في
توضيح حقيقة:
أن إسلام هؤلاء الناس من أهل مكة، لم يكن لأجل انصياعهم
لما تحكم به عقولهم، وتقودهم إليه فطرتهم، ولا كان ذلك حباً بالحق،
والتذاذاً بالهدى، وبخوعاً وانقياداً لما تفرضه المعجزة القاهرة،
والبراهين الظاهرة.
ولكن إسلامهم كان انصياعاً للقوة واستجابة لإغراءاتها،
وتأثراً باقتضاءاتها، فقد رأوا نصر الله رسوله، وإعزازه دينه، ويعتبرون
أن أمراً من هذا القبيل يعنيهم، ولابد لهم من البحث عنه، والحصول عليه،
لأنه يمثل مظهراً من مظاهر الحياة الدنيا، وربما يكون من أقوى السبل
إليها، والحياة الدنيا هي محط أنظارهم، ومهوى أفئدتهم..
فالإنتصار، والإعزاز كانا السبب الأقوى لإظهارهم
الإسلام، وهذه هي نظرة الضعفاء قليل الحظ في العلم والثقافة والمعرفة،
والمفلسين من القيم والمثل، والبعيدين عن التفاعل الروحي مع الأحداث،
والفاقدين لتوهج المشاعر، ولحياة العواطف.. فانحسر دور هذه المؤثرات،
لتتفرد الأهواء والغرائز بمسار الإنسان، وبمصيره، دونما وازع من ضمير،
أو رادع من وجدان.
قالوا:
لما هزم الله تعالى هوازن، أتوا للطائف، ومعهم مالك بن
عوف، وعسكر بعضهم بأوطاس، وتوجه بعضهم نحو نخلة، بنو عيرة من ثقيف.
فبعث رسول الله «صلى الله عليه وآله» خيلاً تتبع من سلك
نخلة ولم تتبع من سلك الثنايا.
وأدرك ربيعة بن رفيع بن أهبان بن ثعلبة، من بني سليم،
دريد بن الصمة، فأخذ بخطام جمله، وهو يظن أنه امرأة، وذلك أنه في شجار
له، فإذا هو رجل، فأناخ به وهو شيخ كبير، ابن ستين ومائة سنة، فإذا هو
دريد، ولا يعرفه الغلام.
فقال له دريد:
ما تريد؟
قال:
أقتلك.
قال:
وما تريد إلى المرتعش الكبير الفاني؟
قال الفتى:
ما أريد إلا ذاك.
قال له دريد:
من أنت؟
قال:
أنا ربيعة بن رفيع السلمي.
قال:
فضربه، فلم يغن شيئاً.
فقال دريد:
بئس ما سلحتك أمك، خذ سيفي من وراء الرحل في الشجار،
فاضرب به، وارفع عن العظم، واخفض عن الدماغ، فإني كذلك كنت أقتل
الرجال، ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة، فربّ يوم قد
منعت فيه نساءك.
فزعمت بنو سليم:
أن ربيعة لما ضربه فوقع، تكشف للموت، فإذا عجانه وبطون
فخذيه مثل القرطاس من ركوب الخيل.
فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها
بقتله إياه، قالت:
والله لقد أعتق أمهات لك ثلاثاً في غداة واحدة، وجز
ناصية أبيك.
فقال الفتى:
لم أشعر([15]).
وقالوا أيضاً:
ووقف مالك بن عوف على ثنية من الثنايا، وشبان أصحابه،
فقال: قفوا حتى يمضي ضعفاؤكم، وتلتئم إخوانكم. فبصر بهم الزبير بن
العوام، فحمل عليهم حتى أهبطهم من الثنية، وهرب مالك بن عوف، فتحصن في
قصر بلية. ويقال: دخل حصن ثقيف([16]).
ونقول:
إننا نلاحظ على ما تقدم:
1 ـ
قال اليعقوبي: «وقتل دريد بن الصمة، فأعظم الناس ذلك.
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: إلى النار وبئس المصير، إمام من
أئمة الكفر، إن لم يكن يعين بيده، فإنه يعين برأيه، قتله رجل من بني
سليم»([17]).
وهذا دليل واضح على أن قتل دريد بن الصمة كان عملاً
صائباً، ومحموداً، فإن هذا الشيخ مع كبر سنه قد حرص على إطفاء نور
الله، وأصرّ على محاربة الأنبياء، وخذلان الحق، ونصرة الباطل، فهل هناك
من هو أسوأ من هذا..
فلو أنه بعد أن بلغ من الكبر عتياً.. ندم على ما فرط
منه طيلة حياته الحافلة بالظلم والعدوان وقتل الناس.. كما اعترف به
آنفاً، واعتزل في بيته على أقل تقدير، ونصح من يأخذ عنه، ويسمع منه
بالعمل بما يحفظ لهم كرامتهم، ويؤكد المعاني الإنسانية النبيلة فيهم،
لكان خيراً له ولهم..
ولكنه بالرغم من ظهور عدم طاعة مالك له، أصر على البقاء
الذليل معه في ذلك الجمع. آملاً أن يتمكن من عمل أي شيء ضد رسول الله
«صلى الله عليه وآله» ومن معه من المؤمنين. مع اعترافه لرسول الله «صلى
الله عليه وآله»، بأنه ليس كسائر الناس شمماًَ وكرماً..
ومع اعترافه أيضاً:
أنه قد أظهر لمالك بن عوف ولغيره بأنه على معرفة تامة
بما كان يجري في المنطقة من تحولات.. مما يعني: أنه يفعل ما يفعل عن
سابق علم وتصميم، وهذا يزيد في وضوح سوء نيته، وخبث طويته، وهو لا
يستحق أي نوع من أنواع الرأفة والتسامح.
3 ـ
لقد أحسن هذا الشاب فيما أجاب به أمه حين عتبت عليه
لعدم تكرّمه على ابن الصمة بالعفو عنه، حيث أوضح لها: أنه لم يكن
ليتكرم بما يوجب غضب الله ورسوله.. فقد قال لها: ما كنت لأتكرم عن رضا
الله ورسوله([18]).
وهذا يدل:
على أنه قد قتله عن معرفة تامة باستحقاقه للقتل، ولم
يكن ذلك عن رغبة في سفك دماء الناس، كما ربما توحي به رواية قتله التي
ذكرها الصالحي الشامي وغيره..
4 ـ
قيل: إن قاتل دريد هو: الزبير بن
العوام، وقيل: هو عبد الله بن قنيع (أو قبيع)([19]).
والحديث المتقدم لا مجال لتطبيقه على الزبير، كما هو ظاهر..
5 ـ
إن سياق حديث قتل ابن الصمة قد يوحي: بأن دريداً كانت
له أعمال صالحة تشير إلى أنه كان يملك درجة من النبل، وكرم الطباع،
وصالح السجايا، من حيث إنه كان يعتق النساء، ويطلق الأسرى، بعد أن يجز
ناصيتهم..
ولكن الحقيقة هي:
أن ذلك لا يكفي لإثبات أن عتقه للنساء، وإطلاقه للأسارى
قد كان بدافع إنساني، يستحق معه بعض التكريم، والتعظيم، أو يوجب
التعامل معه بشيء من التسامح.. إذ لعله كان يفعل ذلك للحصول على ما هو
أفضل من ذلك، في الموقع المناسب.. أو لأجل الحصول على السمعة في
الدنيا.. أو ما إلى ذلك.
ويؤيد ما نقول:
أنه كان يهتم بسفك دماء الناس، وله شهرة واسعة في ذلك..
فمن كان كذلك، كيف نتوقع أن يكون عتقه للنساء بدافع إنساني يستحق معه
العفو؟
ولو فرض أنه يستحق العفو لإطلاق سراح النساء، فهل يستحق
العفو بالنسبة للأبرياء الذين قتلهم في كل تاريخه الطويل؟!
6 ـ
وأما الحديث عن عجانه وبطون فخذيه وأنها كانت كالقرطاس
من ركوب الخيل، فهو كلام فارغ، لا يعدو كونه مبالغات دأب عليها الناس
في مثل هذه الأحوال، رغبة منهم في تهجين الأمور. وإلا، فإن الإنسان لو
ركب الخيل عشرات السنين، فلا يتحول عجانه وباطن فخذيه إلى هذه الحالة.
نعم، ربما يكون كبر سنه وضعف بدنه قد أوجد حالة من
الترهل والإسترخاء.. وذلك يحصل لكل من طعن في السن، فكيف إذا بلغ مائة
وعشرين، أو مائة وستين، أو حوالي مائتي سنة؟!
قالوا:
وخرج مالك بن عوف عند الهزيمة، فوقف في فوارس من قومه
على ثنية من الطريق، وقال لأصحابه: قفوا حتى تمضي ضعفاؤكم، وتلحق
أخراكم، فوقف هنالك حتى مرّ من كان لحق بهم من منهزمة الناس.
قال ابن هشام:
وبلغني: أن خيلاً طلعت ومالك وأصحابه على الثنية، فقال
لأصحابه: ماذا ترون؟
قالوا:
نرى أقواماً عارضي رماحهم، أغفالاً على خيلهم.
قال:
هؤلاء الأوس والخزرج، فلا بأس عليكم منهم، فلما انتهوا
إلى أصل الثنية، سلكوا طريق بني سليم.
فقال لأصحابه:
ماذا ترون؟
قالوا:
نرى قوماً واضعي رماحهم بين آذان خيلهم، طويلة بوادّهم.
قال:
هؤلاء بنو سليم، ولا بأس عليكم منهم، فلما سلموا سلكوا
بطن الوادي.
ثم اطلع فارس، فقال لأصحابه:
ماذا ترون؟
قالوا:
نرى فارساً طويل البادّ، واضعاً رمحه على عاتقه، عاصباً
رأسه بملاءة حمراء.
قال:
هذا الزبير بن العوام، وأحلف باللآت والعزى ليخالطنكم
فاثنوا له.
فلما انتهى الزبير إلى أصل الثنية
أبصر القوم، فصمد لهم فلم يزل يطاعنهم حتى أزاحهم عنها([20]).
ونقول:
إننا نشك في صحة هذه الأقاويل..
أولاً:
لأن النصوص قد صرحت: بأن مالك بن عوف حين فرّ في حنين،
قد بلغ في فراره إلى حصن الطائف، وكان الذعر قد بلغ بالمشركين
المنهزمين حداً جعلهم يشعرون وكأن عدوهم يدخل على أثرهم إلى حصن الطائف([21]).
ولم يكن المنهزمون قادرين على انتظار أحد من الناس، لا
من ضعفتهم، ولا من غيرهم حتى يلحق بهم، ولا ليجرؤا على الوقوف على
ثنية، ويراقبوا كتائب المسلمين وهي تلاحقهم، ويميزوا بين هذه وتلك..
وكان «صلى الله عليه وآله» قد أرسل الخيل لتلاحقهم كما
يقولون، فلم يكونوا ليجدوا الفرصة ليصعدوا على ثنية ولا على غيرها([22]).
ثانياً:
إن المسلمين كما تقدم: لم يعودوا إلى القتال، بل عادوا
فوجدوا أسرى المشركين مكتفين عند رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فهم
لم يلاحقوا المنهزمين..
أو على الأقل:
إن النصوص غير قادره على إثبات ذلك..
ثالثاً:
هل كان الزبير وحده في تلك البيداء؟! ولماذا كان وحده؟!
وإذا كانت لديه هذه الشجاعة، والروحية، والمقدرة، فلماذا هرب مع
الهاربين.. واستحق العقاب الإلهي، مع من عوقب وطولب، وليم وأنّب؟!
كما أننا لا بد أن نسأل:
كيف انتهت المناوشات بينه وبين الذين على الثنية، فهل
قتلهم أم قتلوه، أو هزمهم أو هزموه، أو انصرف عنهم، وانصرفوا عنه؟!
وهل لحق به أحد فعاونه عليهم، أم بقي وحده بينهم؟! أم
أن مقصوده هو مجرد إزاحتهم عن الثنية ثم لا شغل له بهم؟!
رابعاً:
إن عرض الرماح على الخيل معناه: الإعراض عن الحرب، أو
الإستهتار بالعدو، لأن معنى عرضها هو: وضعها على العرض، قال الشاعر:
جــاء
شـقـيـق عـارضـاً رمحــه إن بـنـي عـمــك فـيـهـم رمــاح
فلماذا يعرض الأوس والخزرج رماحهم، فإن كان ذلك
استهتاراً بالعدو، فلماذا هربوا منه قبل قليل؟!. وإن كان إعراضاً عن
الحرب، فالمفروض: أنهم يطاردون المنهزمين في كل اتجاه، ولابد أنهم
يستعملون تلك الرماح في تلك المطاردة.
خامساً:
ما معنى تسليم سليم على الواقفين على الثنية، هل عرفوا:
أن الذين على الثنية هم مالك بن عوف، وأصحابه؟! فلماذا سلموا عليهم،
وتركوهم، ولم يناجزوهم القتال؟!
وإن كانوا قد ظنوا أنهم من أصحابهم، فلماذا تركوهم
أيضاً لم يدعوهم إلى النزول إلى ساحات القتال؟!
أو على الأقل:
لماذا لم يسألوهم عن حالهم، وعن سبب وقوفهم على
الثنية؟!
فإن حال هؤلاء الواقفين مريب على جميع الأحوال..
قال اليعقوبي:
«وكان جميع من استشهد أربعة نفر»([23]).
ذكروا:
أن الذين استشهدوا من المسلمين في حرب حنين كانوا خمسة
رجال فقط، وهم:
1 ـ
أيمن بن عبيد الله بن زيد الخزرجي، وابن أم أيمن.
2 ـ
وسُراقة بن الحارث الأنصاري.
3 ـ
ورقيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن لوذان.
4 ـ
وأبو عامر الأشعري أصيب بأوطاس، كما سيأتي.
5 ـ
ويزيد بن زمعة بن الأسود، جمح به فرس يقال له: الجناح،
فقتل.
واستحر القتل من ثقيف في بني مالك، فقتل منهم سبعون
رجلاً تحت رايتهم، فيهم عثمان بن عبد الله بن الحارث.
وكانت رايتهم مع ذي الخمار، فلما قتل أخذها عثمان بن
عبد الله، فقاتل حتى قتل. ولما بلغ رسول الله «صلى الله عليه وآله»
قتله، قال: «أبعده الله، فإنه كان يبغض قريشاً»([24]).
قال دحلان:
«قتل من المشركين وقت الحرب أكثر من سبعين. قيل: وفي
الإنهزام أكثر من ثلاثمائة»([25]).
ونقول:
لو صح هذا لوجب أن تكون الهزيمة قد وقعت أولاً على
المشركين، فلماذا انهزم المسلمون إذن..
ومن جهة أخرى:
فقد روي عن عبد الله بن الحارث، عن أبيه قال: قتل من
أهل الطائف يوم حنين مثل من قتل يوم بدر([26]).
وتقدم:
أن علياً «عليه السلام» قد قتل بعد أبي جرول أربعين
رجلاً([27])،
أما من قتلهم «عليه السلام» قبل ذلك، فالله أعلم بعدتهم. كما أن مجموع
من قتلهم علي «عليه السلام» في حنين، لم يذكره لنا التاريخ، ولا تحدثت
عنه الروايات.
وكان مجموع من قتل من المشركين مائة رجل([28]).
وبعد أن انهزمت هوازن استمر القتل في ثقيف في بني مالك
منهم، فقتل منهم سبعون رجلاً تحت رايتهم، التي كانت أولاً مع ذي
الخمار، فقتل. فأخذها عثمان بن عبد الله بن ربيعة، فقتل أيضاً.
بالنسبة لقول رسول الله «صلى الله
عليه وآله»:
أبعده الله، فإنه كان يبغض قريشاً([29])،
نقول:
إن اليعقوبي يذكر:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد قال هذه الكلمة بعد
قتل ذي الخمار([30]).
إن بغض قريش الموجب للدعاء بالسوء لا بد أن يكون لجهة
مبغوضة لله تعالى. أما بغضها لأجل شركها مثلاً، فلا يستوجب هذا الدعاء،
بل هو من موجبات الحمد والثناء.
وأما بغض القبائل لبعضها البعض لأجل إحنٍ جاهلية،
وثارات قبلية، فلا يختص بقريش، وهو من الأمور التي عمل الإسلام على
اقتلاعها من جميع فئات المجتمع. حتى من قريش في بغضها للقبائل الأخرى
إذا كان من أجل ذلك..
عن رباح بن ربيع:
أنه خرج مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» في غزوة
غزاها، وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمر رباح وأصحاب رسول الله «صلى
الله عليه وآله» على امراة مقتولة مما أصابت المقدمة، فوقفوا ينظرون
إليها، يعني: ويعجبون من خلقها، حتى لحقهم رسول الله «صلى الله عليه
وآله» على راحلته، فانفرجوا عنها.
فوقف عليها رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، فقال:
«ما كانت هذه لتقاتل».
فقال لأحدهم:
«الحق خالداً وقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفاً»([31]).
ونقول:
1 ـ
إن هذه الرواية وإن لم تصرح: بأن ذلك كان في غزوة حنين،
لكن عبارة «مرَّ على امرأة مقتولة مما جرى على المقدمة» تدل على: أن
قتل هذه المرأة كان في حنين، لأنها هي الغزوة الوحيدة التي انهزمت
المقدمة فيها بهذا الشكل القبيح، والمهين، والمشين.
2 ـ
إن الكلمة الموجزة للنبي «صلى الله عليه وآله» قد تكفلت
بحسم الأمر بصورة تامة من جميع جهاته، لأنها أشارت إلى:
ألف:
إدانة قتل النساء في الحروب، لأن المقصود بكلمة «هذه»
ليس هو شخص تلك المرأة، بل جنسها ولاسيما مع ملاحظة كلمة «ما كانت
هذه»..
ب:
إنها دلت على: أن التوجيه النبوي لجيشه كان هو المنع عن
قتل النساء، ولذلك أجرى الكلام وكأنه مفروغ عنه، ليفيد: أن الذي يُقتل
هو خصوص من يقاتل..
ج:
إنه «صلى الله عليه وآله» إنما أشار إلى أن طبيعة وشأن،
وظاهر حال النساء هو أنهن لا يتصدين للقتال.. فما معنى أن يقتل من هذا
حاله.. فلا بد من اعتبار قتل هذه المرأة حالة شاذة، وغير مقبولة..
3 ـ
إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد عرف بمجرد رؤية تلك
المرأة أن خالد بن الوليد هو المطالب بقتلها، فسارع إلى إعادة تأكيد
أوامره له بأن لا يرتكب أمثال هذه المخالفات.
وأما كيف عرف «صلى الله عليه وآله» ذلك.
فأولاً:
هو «صلى الله عليه وآله» نبي متصل بالله، وهو يخبره بكل
ما يجب، و يحب.
ثانياً:
لعله علم ذلك، من حيث إن الذين مروا في ذلك المكان هم
خالد ومن معه. دون سواهم. بالإضافة إلى قرائن ودلالات أخرى. لعلها
توفرت له.
ثالثاً:
قد صرح بعضهم: بأنه «صلى الله عليه وآله» سألهم عن تلك
المرأة، فقالوا: قد قتلها خالد بن الوليد»([32]).
4 ـ
إنه «صلى الله عليه وآله» كان كلما أراد ان يرسل بعثاً
أو سرية يجلسهم بين يديه، ويوصيهم بوصايا جامعة، ومنها قوله «صلى الله
عليه وآله»:
«لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا صبياً، ولا امرأة»([33])
فما معنى أن يخالف خالد، ومن معه أوامر رسول الله «صلى الله عليه
وآله»؟!
5 ـ
إن النص المذكور آنفاً قد اقتصر على ذكر العسيف،
والذرية في الأمر الصادر لخالد من رسول الله «صلى الله عليه وآله»..
فلماذا لم يذكر المرأة؟ مع أنها هي الحدث المقتضي
لتجديد التأكيد على الأوامر الصادرة.
فالجواب هو:
أن ثمة إسقاطاً من الرواية، ولا ندري إن كان متعمداً..
ويدل على ذلك:
تصريحهم بأنه لما وقف النبي «صلى الله عليه وآله» على
تلك المرأة، وأخبروه بأن خالداً قتلها «بعث إلى خالد، ونهاه عن قتل
المرأة، والطفل، والأجير»([34]).
وذكر للنبي «صلى الله عليه وآله»:
أن رجلاً كان بحنين قاتل قتالاً شديداً، حتى اشتدت به
الجراح، فقال: «إنه من أهل النار».
فارتاب بعض الناس من ذلك، ووقع في قلوب بعضهم ما الله
تعالى به أعلم.
فلما آذته جراحته، أخذ مشقصاً من كنانته فانتحر به.
فأمر رسول الله «صلى الله عليه
وآله» بلالاً أن ينادي:
ألا لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله تعالى يؤيد هذا
الدين بالرجل الفاجر»([35]).
ونقول:
1 ـ
في هذه الرواية دلالات مختلفة نقتصر منها على الإشارة
إلى هذا الضعف الظاهر في إيمان كثيرين ممن عاشوا مع رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، ورأوا الآيات والمعجزات ليس في الحروب وحسب، وإنما في
مختلف شؤون الحياة.
وقد بلغ بهم ضعف الإيمان هذا:
أن قضية جزئية، يخبر فيها النبي «صلى الله عليه وآله»
عن مصير واحد من الناس قد أنستهم كل ما رأوه من معجزات، وعاينوه من
دلالات، ويتلاعب بهم الشيطان، ويشككهم بدينهم وبنبيهم من أجلها..
فليت شعري، متى صلُب هذا الإيمان فيهم، حتى استعصى على
الهزات، وخلص من الشوائب، والتشكيكات؟!
ومن يضمن لنا:
أن لا تستمر ببعضهم حالات الريب والشك، ويكتمها عنا،
وعن غيرنا إلى ما بعد موته؟!
وعلينا أن لا ننسى لفت نظر القارئ إلى أن النبي «صلى
الله عليه وآله» كان يتعمد إلقاء أمثال هذه الأخبار لأصحابه لسببين:
أحدهما:
أنه يريد أن يعمق الإيمان في قلوبهم بصورة عملية،
بتكرار أمثال هذه الحوادث، ليوصلهم إلى اليقين الراسخ، والقناعة
التامة..
الثاني:
أنه يريد: أن يعرّف الأجيال اللاحقة بحقيقة معاناته،
وبواقع هؤلاء الناس، الذي سيأتي من ينسب إليهم ثبات القدم في الدين،
وشدة اليقين فيه، وحقيقة الوعي لحقائقه ومبانيه، بل سوف يدَّعون لهم
مقام الإجتهاد، والرشاد والسداد، إلى درجة العصمة، ويصرون على براءة
ساحتهم، من كل تهمة أو وصمة.
عن عبد الله بن الأزهر، قال:
كان خالد بن الوليد جرح يوم حنين، وكان على خيل رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، فجرح يومئذٍ، فلقد رأيت رسول الله «صلى
الله عليه وآله» بعد ما هزم الله تعالى الكفار، ورجع المسلمون إلى
رحالهم يمشي في المسلمين ويقول: «من يدلني على رحل خالد بن الوليد»؟
فأتي بشارب، فأمر من عنده فضربوه بما كان في أيديهم،
وحثا عليه التراب([36]).
قال عبد الرحمن:
فمشيت ـ أو قال: سعيت ـ بين يدي رسول الله «صلى الله
عليه وآله» وأنا غلام محتلم، أقول: من يدل على رحل خالد، حتى دللنا
عليه، فإذا خالد مستند إلى موخرة رحله، فأتاه رسول الله «صلى الله عليه
وآله» فنظر إلى جرحه، فتفل فيه فبرئ([37]).
عن عائذ بن عمرو قال:
أصابتني رمية يوم حنين في جبهتي، فسال الدم على وجهي
وصدري، فَسَلَتَ النبي «صلى الله عليه وآله» الدم بيده عن وجهي وصدري
إلى ثندؤتي، ثم دعا لي.
قال حشرج والد عبد الله:
فرأينا أثر يد رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى
منتهى ما مسح من صدره، فإذا غرة سابلة كغرة الفرس([38]).
ونقول:
أولاً:
إننا لا نستطيع أن نؤكد صحة هذه الروايات، غير أننا
نعلم: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لا يميز أحداً على أحد في تعامله.
فهل كان يسأل عن المجروحين الآخرين، ويذهب في الطرقات يسأل عن رحالهم؟!
ويأتيهم، ويشفيهم، كما فعل بخالد؟!
بل قد زعمت رواية نسبت إلى أنس:
أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعلياً «عليه السلام» قد ضرب
كل منهم بضعة عشر ضربة([39]).
فإذا كان هؤلاء يصدِّقون هذه
الرواية، فالسؤال هو:
إن هؤلاء الأربعة عند هؤلاء أفضل من خالد بن الوليد،
فلماذا لم يزرهم في رحالهم، ويهتم بشفائهم كما فعل بخالد؟!
وإن كان قد فعل ذلك، لكن التاريخ أهمل ذكره، فلا بد أن
نسأل أيضاً عن سبب هذا الإهمال، فإننا لا نرى أي مبرر. بل قد تعودنا
الإحتفاظ بأبسط الأمور إذا كانت تتعلق بهؤلاء، فكيف إذا كان الأمر بهذه
الخطورة؟!
ثانياً:
ما معنى أن يمشي رسول الله «صلى الله عليه وآله» في
المسلمين، وهو يسأل عن رحل خالد، ثم يستخدم مراهقاً لهذه الغاية، ليسعى
بين يديه «صلى الله عليه وآله»، وهو يقول: من يدل على رحل خالد، فإن
هذا الأمر غير متوقع، ولا مألوف منه «صلى الله عليه وآله»..
بل إن ما نتوقعه هو أن نجد المسلمين يتبادرون،
ويتسابقون ليدلوا النبي «صلى الله عليه وآله» على ما يطلب دلالتهم
عليه، ولا تصل النوبة إلى أن يمشي هو فيهم يطلب منهم ذلك، فضلاً عن ان
يستخدم مراهقاً لهذا الغرض.
ثم ألا ترى معي:
أن الهدف من ادِّعاء أن خالداً جرح، ثم تحرك النبي «صلى
الله عليه وآله» في الجيش لزيارته في رحله على ذلك النحو الفاقع.. يراد
منه: إعادة الإعتبار لخالد بهذا التكريم المزعوم..
ثم التماس عذر له في الهزيمة، وانه لم يقصر في القيام
بواجبه، لكن جراحاته هي التي قصرت به.
ولنا أن نحتمل:
أن يكون هذا البرء العاجل لجرح خالد، إنما هو لمنع بحث
الناس عن هذا الأمر، حتى لا يظهر أن جراحاته المزعومة كانت ضرباً من
الخيال..
كما أن ذلك يسد الطريق على من يريد
أن يقول:
إنه كان حاضراً، ولم ير خالداً يعاني، لا من جراحة، ولا
من غيرها.
قالوا:
لما انهزم القوم أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله»
بالغنائم أن تجمع، ونادى مناديه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
يغل.
وأمر «صلى الله عليه وآله» بالذراري، والأموال أن تحضر
إلى الجعرانة، فوقف بها هناك إلى أن انصرف رسول الله «صلى الله عليه
وآله» من حصار الطائف([40]).
وجعل الناس غنائمهم في موضع، حيث استعمل عليها رسول
الله «صلى الله عليه وآله» مسعود بن عمرو الغفاري([41]).
وأما
السبي، فعن سعيد بن المسيب:
أنه جعل عليهم أبا سفيان بن حرب([42]).
وقال البلاذري:
جعل عليهم بديل بن ورقاء الخزاعي([43]).
قال الصالحي الشامي:
قال في زاد المعاد:
كان الله تعالى قد دعا رسول الله «صلى الله عليه وآله»
وهو الصادق الوعد: أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دينه أفواجاً، ودانت
له العرب بأسرها، فلما تم له الفتح المبين، اقتضت حكمة الله تعالى أن
أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام وأن يتجمعوا ويتأهبوا لحرب رسول
الله «صلى الله عليه وآله» والمسلمين، ليظهر أمر الله سبحانه وتعالى
وتمام إعزازه لرسوله الله «صلى الله عليه وآله» ونصره لدينه، ولتكون
غنائمهم شكراً لأهل الفتح، ليظهر الله ورسوله وعباده قهره لهذه الشوكة
العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلها، فلا يقاومهم بعد أحد من العرب.
ويتبين ذلك:
من الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين.
واقتضت حكمته تعالى:
أن أذاق المسلمين أولاً مرارة الهزيمة والكبوة، مع كثرة
عَدَدِهم وعُدَدهم وقوة شوكتهم، ليطأ من رؤوس رفعت بالفتح، ولم تدخل
بلده وحرمه كما دخله رسول الله «صلى الله عليه وآله» واضعاً رأسه،
منحنياً على فرسه، حتى إن ذقنه تكاد أن تمس سرجه، تواضعاً لربه تبارك
وتعالى، وخضوعاً لعظمته، واستكانة لعزته أن أحل له حرمة بلده، ولم يحله
لأحد قبله، ولا لأحد بعده.
وليبين عز وجل لمن قال:
لن نغلب اليوم من قلة: أن النصر إنما هو من عنده، وأنه:
من ينصره فلا غالب له، ومن يخذله فلا ناصر له غيره، وأنه تعالى هو الذي
تولى نصر رسوله ودينه لا كثرتكم التي أعجبتكم، فإنها لم تغن عنكم شيئاً
فوليتم مدبرين.
فلما انكسرت قلوبهم أرسلت إليها خلع الجبر مع مزيد
{ثُمَّ
أَنَزلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ
وَأَنزَلَ جُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ
وَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ}([44]).
وقد اقتضت حكمته تبارك وتعالى:
أن خلع النصر وجوائزه إنما تفضى على أهل الإنكسار
{وَنُرِيدُ
أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ
لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا
مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ}([45]).
إلى أن قال:
وبهاتين الغزاتين طفئت جمرة العرب لغزو رسول الله «صلى
الله عليه وآله» والمسلمين.
فالأولى خوَّفتهم وكسرت من حدتهم.
والثانية:
استفرغت قواهم، واستنفدت سهامهم، وأذلت جمعهم، حتى لم
يجدوا بداً من الدخول في دين الله تعالى.
وجبر الله تبارك وتعالى أهل مكة بهذه الغزوة، وفرّحهم
بما نالوا من النصر والمغنم، فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم.
وإن كان عين جبرهم وقهرهم تمام نعمته عليهم، بما صرفه
عنهم من شر من كان يجاورهم من أشراف العرب، من هوازن وثقيف، بما أوقع
بهم من الكسرة، وبما قيّض لهم من دخولهم في الإسلام، ولولا ذلك ما كان
أهل مكة يطيقون مقاومة تلك القبائل مع شدتها.
ومن تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله
سبحانه وتعالى لمسبباتها قدراً وشرعاً، فإن رسول الله «صلى الله عليه
وآله» أكمل الخلق توكلاً، فقد دخل مكة والبيضة على رأسه، ولبس يوم حنين
درعين، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى:
{وَاللهُ
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}([46]).
وكثير ممن لا تحقيق عنده يستشكل هذا ويتكايس في الجواب، تارة: بأن هذا
فعله «صلى الله عليه وآله» تعليماً لأمته، وتارة: بأن هذا كان قبل نزول
الآية!!
لو تأمل:
أن ضمان الله سبحانه وتعالى له العصمة لا ينافي تعاطيه
لأسبابها، فإن هذا الضمان له من ربه تبارك وتعالى لا ينافي احتراسه من
الناس ولا ينافيه، كما أن إخبار الله عز وجل له بأنه يظهره على الدين
كله ويعليه، لا يناقض أمره بالقتال، وإعداد العدة والقوة، ورباط الخيل،
والأخذ بالجد والحذر، والإحتراس من عدوه، ومحاربته بأنواع الحرب،
والتورية، فكان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها، وذلك لأنه إخبار من الله
تعالى عن عاقبة حاله ومآله، فيما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله
تعالى بحكمته موجبة لما وعده به من النصر والظفر، وإظهار دينه، وغلبته
على عدوه انتهى([47]).
ونقول:
إن مبنى هذا الكلام غير مقبول، بل غير معقول، لأنه مبني
على نظرية باطلة جملة وتفصيلاً، وهي نظرية الجبر الإلهي..
حيث نلاحظ:
أنه اعتبر أن الله تعالى هو الذي أمسك قلوب هوازن،
ومنعهم من الإيمان والإسلام، الأمر الذي
أدى الى تلك الحرب الشعواء، التي أزهقت فيها نفوس،
ويتمت بها أطفال..
وذكر أيضاً:
أنه تعالى هو الذي أذاق المسلمين أولاً مرارة الهزيمة،
لأجل بعض الحكم والمصالح.
ومنطق الجبر هذا ينتهي إلى نسبة الظلم إلى الله تبارك
وتعالى، فإن إمساكه قلوب هوازن ومن تبعها، عن الإسلام بزعمهم يعرضها
للعذاب الذي لا تستحقه ولم ترده، وهذا ظلم لا يصدر عن العزة الإلهية..
كما أن ذلك ينتهي إلى بطلان الثواب والعقاب، فلا يصح
عقاب هوازن ومن معها، لأنهم كانوا مكرهين على البقاء في دائرة الشرك،
لأن الله أمسك قلوبهم عن الإسلام، كما أن اجتماعهم وتأهبهم لحرب الرسول
«صلى الله عليه وآله» والمسلمين قد اقتضته حكمة الله تعالى لكي يظهر
الله أمره، ولإتمام إعزازه لدينه، ونصره لرسوله، ولتكون غنائمهم شكراً
لأهل الفتح الخ..
ولا يصح عقاب المسلمين الذين ولوا أدبارهم، لأن الله هو
الذي أذاقهم مرارة الهزيمة والكبوة، ليطأ الرؤوس التي رفعت في الفتح،
ولم تفعل كما فعل النبي «صلى الله عليه وآله» حين دخل مكة، مطأطئاً
رأسه، منحنياً على فرسه..
فلماذا إذن يغضب الله تعالى على الذين يولون الأدبار،
ويقول:
{وَمَن
يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ
مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ
وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المَصِيرُ}([48]).
ولا يصح أيضاً إثابة المجاهدين الذين نصروا الله
ورسوله، لأن الله سبحانه هو الذي تولى فعل ذلك دونهم، لأن حكمته اقتضت
أن يفعله، وان يحركهم في تلك الحال حركات لا معنى ولا أثر لها على
الإطلاق..
على أن هذا الجبر المزعوم لا بد أن يصادر الحجة التي
يحتج بها أهل الحق على أهل الباطل.. إذ لا يصح لهم أن يعترضوا عليهم
لأجل شركهم، لأنهم معذرون فيه، فهو مفروض عليهم جبراً وقهراً.. ولم تعد
لله الحجة البالغة على أحد من المشركين والمجرمين، لأن عذرهم معهم. بل
تصبح لهم هم الحجة على الله، لأنهم لا بد أن يقولوا له تعالى: «أنت
الذي تفعل ذلك بنا، فكيف ولماذا تعذبنا على ما تفعله أنت»؟!
2 ـ
إنه زعم: أن السكينة قد أنزلت على الذين ولوا مدبرين..
مع أن الآية لم تقل لهم: أنزل الله سكينته عليكم. بل غيرت السياق إلى
الغيبة وقالت:
{عَلَى
المُؤْمِنِينَ}..
وقد ذكرنا فيما سبق:
أن نزول السكينة على المنهزمين والعاصين لله لا يصح. بل
نزلت على من جاهد وصبر، وواجه عشرات الألوف من الأعداء، فهو الذي يستحق
هذه الكرامة الإلهية، والهبة الربانية دون سواه.
3 ـ
زعم هذا القائل: أن السكينة نزلت على المنهزمين،
مستشهداً بآية:
{وَنُرِيدُ
أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ
لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا
مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ}([49]).
وهو كلام غير دقيق ولا مجال لقبوله، فإن الذين تتحدث
عنهم الآية المباركة هم أناس قهرهم بغي فرعون وهامان وجنودهما،
واستضعفوهم، وأذلوهم من دون أن يقصِّر أولئك المقهورون، والمستضعفون في
أداء واجبهم.
أما المنهزمون في حنين، فلم يكن لهم عذر في هزيمتهم،
وقد تخلفوا عن أداء واجبهم، بل ارتكبوا ما استحقوا به غضب الله تبارك
وتعالى.. وقد قرّعهم الله سبحانه في قرآنه الكريم بما هو معروف وواضح
في مقاصده ودلالاته، فما معنى قياس هؤلاء على أولئك، وما المبرر
لاستفادة المساواة في جريان سنة الله تعالى التي أجراها الله في الذين
استضعفهم فرعون، في التاركين لواجبهم الشرعي والعاصين لله تعالى في قصة
حنين؟!
4 ـ
وأما جبر([50])
أهل مكة بغزوة حنين، وتفريحهم بما نالوا من النصر والمغنم، فلا يمكن
قبوله أيضاً، لأن هذا النصر لم يفرح أهل مكة. بل لعلهم كانوا أكثر
الناس انزعاجاً منه، وتبرماً به.
يضاف إلى ذلك:
أنه لم يكن لأهل مكة في صنع هذا النصر أي دور، بل اقتصر
دورهم على صنع الهزيمة، لأنهم هم الذين كانوا في المقدمة، وقد انهزموا
وانهزم الجيش تبعاً لهم. وذلك قبل أن يحصل أي احتكاك بينهم وبين
المشركين. حسبما اتضح فيما سبق.
ولكن زعماء أهل مكة قد فرحوا بالغنائم التي سيقت إليهم،
ودقت أبوابهم، ودخلت بيوتهم تلقائياً، ومن دون أن يبذلوا في سبيلها أي
جهد.
5 ـ
على أن ما ذكره: من أن كسر شوكة هوازن وثقيف قد أراح
أهل مكة، وصرف عنهم شر هؤلاء الجيران الأقوياء، لا يعدو كونه مبالغات
لا مبرر لها، فإن أهل مكة لم يكونوا منزعجين من شرك هوازن، كما أنهم هم
أنفسهم لم يكونوا ـ في بادئ الأمر على الأقل ـ مخلصين لإسلامهم. بل إن
قسماً كبيراً منهم ما كانوا قد أعلنوا إسلامهم بعد، وقد حضروا مع النبي
«صلى الله عليه وآله» إلى حنين، وهم بعد على شركهم. فلا يرون أن ثمة أي
مباينة فيما بينهم وبين جيرانهم من هوازن وثقيف..
6 ـ
وعن نزول آية :
{وَاللهُ
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}([51])
بعد، أو قبل غزوة حنين، نقول:
إن ظاهر سياق كلام صاحب هذه المزاعم يعطي أنه لا يعترض
على القول بنزولها بعد حنين، بل لعل الصحيح أن نقول: إنه لم يقدر على
رد القول: بأن آية العصمة من الناس قد نزلت بعد حنين، لأن سورة المائدة
كما رواه محمد بن كعب القرظي([52])،
والربيع بن أنس([53])،
قد نزلت في حجة الوداع. وسورة المائدة قد نزلت دفعة واحدة كما هو معلوم([54]).
7 ـ
قد تقدم: أن مظاهرة النبي «صلى الله عليه وآله» بدرعين
لا مجال لإثباتها. بل الشواهد تشير إلى ضد ذلك.. فلا يصغى إلى قولهم:
إنه «صلى الله عليه وآله» قد فعل ذلك تعليماً لأمته.
أو قولهم:
إن ضمان العصمة للنبي «صلى الله عليه وآله» من الله
تعالى لا ينافي احتراسه «صلى الله عليه وآله»، مثلما أن وعد الله لنبيه
بإظهار دينه لا ينافي الأمر بالقتال، وإعداد العدة، ورباط الخيل.. لأن
وعده بالنصر، إنما هو وعد له بأمر يحصل له من خلال ما يتعاطاه من
أسباب.. وليس مطلقاً.
8 ـ
على أن قولهم هذا الأخير، لا يتلاءم مع ما زعمه قبل
ذلك: من أن الله سبحانه يتدخل في الأمور، ويجريها على الناس بصورة
قهرية وجبرية.. لأن الجبر والقهر يجعل من التوسل بالأسباب الظاهرية
لغواً، وبلا مبرر، لأن وجودها يكون كعدمها، لأنها مع هذا الجبر الإلهي
تكون فاقدة لأي تأثير البتة..
فالإعتراف بأن إرادة إجراء الأمور مرهونة بها، ينقض
القول: بأن الله هو الذي يقهر، ويجبر. وذلك ظاهر.
([1])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص347 وتاريخ مدينة دمشق ج26 ص424 و 425
والبداية والنهاية ج4 ص394 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص913
والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص651 .
([2])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص317 عن الواقدي، وتاريخ الخميس ج2 ص101
وراجع: تفسير البغوي ج2 ص278
([3])
راجع: تفسير القمي ج1 ص287 والبحار ج21 ص149 عنه، وشجرة طوبى
ج2 ص307 والتفسير الأصفى ج1 ص459 وتفسير مجمع البيان ج5 ص34
والتفسير الصافي ج2 ص331 وتفسير نور الثقلين ج2 ص199 وتفسير
الميزان ج9 ص231.
([4])
راجع على سبيل المثال: البحار ج21 ص150 وتفسير القمي ج1 ص287
وغير ذلك مما تقدم.
([5])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص331 عن الواقدي، والمغازي ج3 ص905
والآحاد والمثاني ج2 ص375 وراجع: المعجم الكبير ج1 ص284 وإمتاع
الأسماع ج2 ص15 و 16 وجزء أبي الطاهر ج1 ص26 .
([6])
تذكرة
الفقهاء (ط ج) ج9 ص63 و 65
وتذكرة
الفقهاء (ط ق) ج1 ص412
ومنتهى
المطلب (ط ق) ج2 ص908 و 911 و 912
والتحفة
السنية (مخطوط) ص199
ورياض
المسائل ج7 ص502 و 507
وجواهر
الكلام ج21 ص66 و 73
والمغني
لابن
قدامه ج10 ص542
والشرح
الكبير
لابن
قدامه ج10 ص399
والمحلى
لابن
حزم ج7 ص297
وبداية
المجتهد ونهاية المقتصد
لابن
رشد الحفيد ج1 ص308
ونيل
الأوطار ج8 ص72 و 73
وفقه
السنة ج2 ص641
والمحاسن
للبرقي
ج2 ص355
والكافي
ج5 ص27 و 30
وتهذيب
الأحكام ج6 ص138 والوسائل
(ط
مؤسسة
آل
البيت) ج15 ص58 و (ط
دار
الإسلامية) ج11 ص43
والبحار
ج19 ص177
وج97
ص25
وجامع
أحاديث الشيعة ج13 ص117 و 148
ومستدرك
سفينة البحار ج5 ص32
ومستدرك
سفينة البحار ج10 ص345
وميزان
الحكمة ج1 ص565 و 566
وسنن
أبي داود ج1 ص588
وعمدة
القاري ج14 ص261
وعـون
المعبـود = = ج7 ص196 و 237
والمصنف
لابن
أبي شيبة ج7 ص654
ومعرفة
السنن والآثار ج7 ص31
والإستذكار
لابن
عبد البر ج5 ص32 و 33
والتمهيد
لابن
عبد البر ج24 ص233
ونصب
الراية
للزيلعي
ج4 ص235
والدراية
في تخريج أحاديث الهداية
لابن
حجر ج2 ص116
وكنز
العمال ج4 ص382
وفيض
القدير ج2 ص76
وتفسير
نور الثقلين ج2 ص188
والدر
المنثور ج1 ص205
وتهذيب
الكمال
للمزي
ج8 ص151
وسبل
الهدى والرشاد ج6 ص7
والسيرة
الحلبية ج3
ص135.
([7])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص335 عن أحمد، وأبي داود، وفي هامشه عن
أحمد ج3 ص488 و (ط دار صادر) ج4 ص178 وعن أبي داود في الجهاد
ج2 ص50 وعن المعجم الكبير للطبراني ج5 ص70 و (ط دار إحياء
التراث العربي) ج4 ص11 ومعاني الآثار ج3 ص222 وسنن ابن ماجة
(42 28) ومستدرك الحاكم ج2 ص122 وراجع: سبل السلام ج4 ص49 وفتح
الباري ج6 ص103 والمصنف للصنعاني ج5 ص201 وج6 ص132 والسنن
الكبرى للنسائي ج5 ص187 وصحيح ابن حبان ج11 ص112 والتمهيد لابن
عبد البر ج16 ص141 وكنز العمال ج4 ص433 و 482 ولسان الميزان ج4
ص202 والنهاية في غريب الحديث ج2 ص157 ولسان العرب ج4 ص304
وج14 ص286 وتاج العروس ج6 ص436.
([8])
الآية 25 من سورة الشورى.
([9])
الآية 82 من سورة طه.
([10])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج5 ص332 عن ابن إسحاق، والبزار، وفي
هامشه عن: مجمع الزوائد ج6 ص182.
([11])
الآية 8 من سورة فاطر.
([12])
الآية 6 من سورة الكهف.
([13])
البحار ج11 ص298 وج20 ص21 و 96 و 117 وج21 ص119 وج35 ص177
وشجرة طوبى ج2 ص204 وسنن النبي «صلى الله عليه وآله»
للطباطبائي ص413 والخرائج والجرائح ج1 ص164 والتحفة السنية
(مخطوط) ص52 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص166 واثنا عشر رسالة
للمحقق الداماد ج8 ص26 وتأويل مختلف الحديث ص150 وتفسير مجمع
البيان ج4 ص279 وتفسير الميزان ج6 ص60 وجامع البيان ج22 ص192
ومعاني القرآن ج5 ص487 وزاد المسير ج6 ص 268 وتفسير القرآن
العظيم ج3 ص575 والدر المنثور ج2 ص 298 وج3 ص 94 وتفسير
الثعالبي ج2 = = ص104 وفتح القدير ج2 ص61 وتاريخ مدينة دمشق
ج62 ص247 وموسوعة التاريخ الإسلامي ج2 ص301 ص683 والشفا بتعريف
حقوق المصطفى ج1 ص105 وإعلام الورى بأعلام الهدى ج1 ص179 وعصمة
الأنبياء ص78 وعيون الأثر ج2 ص421 وسبل الهدى والرشاد ج1 ص481
وج7 ص21 و 22 وقصص الأنبياء للجزائري ص83 .
([14])
سبل
الهدى والرشاد ج5 ص332 وإعلام الورى ص122 و 123 والبحار ج21
ص67 وعن البداية والنهاية ج4 ص378 وعن السيرة النبوية ج3 ص627
وتاريخ الخميس ج2 ص105 والسيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة)
ج2 ص112 والسيرة الحلبية ج3 ص114 وراجع المصادر المتقدمة.
([15])
سبل
الهدى والرشاد ج5 ص333 و 334 عن ابن إسحاق، والواقدي، وغيرهما.
والمغازي للواقدي ج3 ص914 و 915 والسيرة الحلبية ج3 ص112 و (ط
دار المعرفة) ص72 وتاريخ الخميس ج2 ص107 والسيرة النبوية
لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص112 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص351
والإستيعاب ج2 ص491 وتاريخ مدينة دمشق ج17 ص237 و 238 و 242
والكامل في التاريخ ج2 ص264 والبدايـة والنهايـة ج4 ص386
وأعيـان الشيعـة ج1 = = ص280 والسيرة النبوية لابن كثير ج3
ص640 وأسد الغابة ج2 ص167 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص589
والوافي بالوفيات ج14 ص9 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص901
والإكتفاء ج2 ص246 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص92 .
([16])
راجع: تاريخ مدينة دمشق ج56 ص486 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص334
والإكتفاء ج2 ص248 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص152 وعيون
الأثر ج2 ص219 .
([17])
تاريخ
اليعقوبي ج2 ص63.
([18])
السيرة الحلبية ج3 ص112 و (ط دار المعرفة) ص72 والسيرة النبوية
لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص112 والإصابة ج2 ص464 و (ط دار
الكتب العلمية) ص387.
([19])
السيرة الحلبية ج3 ص112 و (ط دار المعرفة) ص72 وتاريخ الخميس
ج2 ص107 وراجع: والسيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة) ج2
ص112 والدرر لابن عبد البر ص227 والسيرة النبوية لابن هشام ج4
ص902 وفتح الباري ج8 ص34 وعمدة القاري ج17 ص302 وأسد الغابة ج3
ص244 والإصابة ج4 ص21 .
([20])
تاريخ الخميس ج2 ص108 والمغازي للواقدي ج3 ص916 و 917
والإكتفاء ج2 ص248 والبداية والنهايةج4 ص385 والسيرة النبوية
لابن هشام ج4 ص904 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص638.
([21])
راجع: المغازي للواقدي ج3 ص908 و 906 وغير ذلك مما تقدم.
([22])
المغازي للواقدي ج3 ص914.
([23])
تاريخ اليعقوبي ج2 ص63 والسيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة)
ج2 ص112.
([24])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص334 وفي هامشه عن المصادر التالية: عبد
الرزاق (19904) وابن أبي عاصم ج2 ص638 وابن سعد ج5 ص380، وابن
أبي شيبة ج12 ص173 والعقيلي في الضعفاء ج4 ص350 وراجع: ج2
ص350 والبداية والنهاية ج4 ص383 والسيرة النبوية لابن هشام ج4
ص899 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص635.
([25])
السيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص112.
([26])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص334 عن البيهقي، وراجع: المستدرك للحاكم
ج2 ص121 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص582 والبداية والنهاية ج4
ص380 وإمتاع الأسماع ج5 ص70 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص630
والتاريخ الكبير ج7 ص19 ونعجيل المنفعة ج1 ص325 ودلائل النبوة
للبيهقي ج5 ص142.
([27])
الإرشاد ج1 ص142 ـ 144 والبحار ج41 ص94 عن مناقب آل أبي طالب
ج1 ص604 ـ 606.
([28])
البحار ج21 ص181 ومجمع البيان ج5 ص18 ـ 20.
([29])
تاريخ الخميس ج2 ص106 عن الإكتفاء، وراجع المصادر المتقدمة.
([30])
تاريخ اليعقوب ج2 ص63.
([31])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص335 عن أحمد وأبي داود، وراجع المصادر
المتقدمة.
([32])
تاريخ الخميس ج2 ص106 والنص والإجتهاد ص324 وبغية الباحث ص207
والبداية والنهاية ج4 ص385 وإمتاع الأسماع ج2 ص18 والسيرة
النبوية لابن هشام ج4 ص905 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص638
والمطالب العالية ج9 ص456.
([33])
البحار ج19 ص177 والكافي ج5 ص27 ومصادر أخرى تقدمت عن قريب.
([34])
تاريخ الخميس ج2 ص106 وراجع المصادر المتقدمة.
([35])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص334 عن الواقدي، والمعجم الأوسط ج3 ص357
وإمتاع الأسماع ج13 ص344 والمتواري على أبواب البخاري لابن
المنير الإسكندري ج1 ص180 ومصادر أخرى كثيرة.
([36])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص334 و 335 عن عبد الرزاق، وابن عساكر،
وفي هامشه عن: مسند أحمد ج4 ص88 و 350 و 351 والحميدي ص897 وعن
دلائل النبوة للبيهقي ج5 ص140.
وراجع: السيرة الحلبية ج3 ص114 والسيرة النبوية لدحلان (ط دار
المعرفة) ج2 ص112 والسنن الكبرى للبيهقي ج3 ص251 والسنن الكبرى
للبيهقي ج8 ص320 وج9 ص103 والمصنف لابن ابي شيبة ج8 ص542
وتاريخ مدينة دمشق ج68 ص50 والمستدرك للحاكم ج4 ص375 والمجموع
للنووي ج19 ص339 وسنن أبي داود ج2 ص362 وشرح معاني الآثار ج3
ص156 وسنن الدارقطني ج3 ص112 وكنز العمال ج5 ص492 والجامع
لأحكام القرآن ج12 ص165 والأحكام لابن حزم ج7 ص1014.
([37])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص335 وج10 ص25 والسيرة الحلبية ج3 ص114
والسيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص112 ومسند أحمد ج4
ص351 والمصنف للصنعاني ج5 ص381 .
([38])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص335 عن الحاكم، وأبي نعيم، وابن عساكر،
وتاريخ الخميس ج2 ص106 والسيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة)
ج2 ص112 والسيرة الحلبية ج3 ص114 والخصائص الكبرى ج1 ص450
والأحاديث المختارة ج8 ص238 والآحاد والمثاني ج2 ص329 والمعجم
الكبير ج18 ص20 ومسند الروياني ج2 ص33 ومجمع الزوائد ج9 ص412.
([39])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص329 و 330 عن البزار.
([40])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص338 و 339 وعن مجمع الزوائد ج6 ص189 عن
البزار، والطبراني في الكبير والأوسط، وإعلام الورى ص123 ومجمع
البيان ج5 ص18 ـ 20 و (ط مؤسسة الأعلمي) ص35 والبحار ج21 ص168
و 181 وتفسير الميزان ج9 ص232 وراجع: إمتاع الأسماع ج9 ص296
ودلائل النبوة للبيهقي ج5 ص155 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص253
وأعيان الشيعة ج1 ص280 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص906.
([41])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص339 عن ابن إسحاق، وإمتاع الأسماع ج9
ص297 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص252 والسيرة النبوية لابن هشام
ج4 ص906 ودلائل النبوة للبيهقي ج5 ص155.
([42])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص339 عن عبد الرزاق، والنكت على مقدمة
ابن الصلاح ج1 ص298 وكنز العمال ج10 ص245 و (ط مؤسسة الرسالة)
ص547 وتاريخ مدينة دمشق ج23 ص460 وإمتاع الأسماع ج2 ص21
والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص76.
([43])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص339 والبحار ج21 ص181 ومجمع البيان ج5
ص18 و 19 و (ط مؤسسة الأعلمي) ص35 والسيرة الحلبية (ط دار
المعرفة) ج3 ص76 والبحار ج21 ص181 وتفسير الميزان ج9 ص232
وإمتاع الأسماع ج9 ص296.
([44])
الآية 26 من سورة التوبة.
([45])
الآيتان 5 و 6 من سورة القصص.
([46])
الآية 67من سورة المائدة.
([47])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص347 و 348.
([48])
الآية 16 من سورة الأنفال.
([49])
الآيتان 5 و 6 من سورة القصص.
([50])
المقصود: جبر النقص الوارد عليهم.
([51])
الآية 67من سورة المائدة.
([52])
الدر المنثور ج2 ص252 عن ابن عبيد، وعمدة القاري ج18 ص196
والغدير ج1 ص227 وج6 ص256 والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج1
ص60 وشرح إحقاق الحق ج3 ص335 وفتح القدير ج2 ص3 والبحار ج37
ص248.
([53])
الدر المنثور ج2 ص252 عن ابن جرير، وجامع البيان ج6 ص112 ومجمع
البيان ج3 ص274 والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج2 ص155
والتبيان ج3 ص426.
([54])
الدر المنثور ج2 ص252 عن أحمد، وعبد بن حميد، وابن جرير، ومحمد
بن نصر في الصلاة، والطبراني، والبيهقي في شعب الإيمان ودلائل
النبوة، وابن أبي شيبة في مسنده، وأبي نعيم في دلائل النبوة،
والبغوي في معجمه، وابن مردويه، وأبي عبيد عن أم عمرو بن عميس،
عن عمها. وعن عبد الله بن عمر، وعن أسماء بنت يزيد، ومحمد بن
كعب القرظي، والربيع بن أنس، وراجع: كشف اللثام (ط ج) ج7 ص78
والجواهر ج30 ص31 و 32 والبحار ج18 ص271 وج89 ص274 والغدير ج6
ص256 وج8 ص193 ومستدرك سفينة البحار ج8 ص484 و 485 وج9 ص504
وفتح الباري ج5 ص309 و 310 وتفسير العياشي ج1 ص288 وتفسير مجمع
البيان ج3 ص257 والتفسير الأصفى ج1 ص308 والتفسير الصافي ج2
ص104 وتفسير نور الثقلين ج1 ص582 وج5 ص448 والبيان في تفسير
القرآن للسيد الخوئي ص341 وتفسير الميزان ج20 ص72 والبرهان
للزركشي ج1 ص194 والصراط المستقيم ج3 ص284 وعوالي اللآلي ج2 ص6
و 95 والفتح السماوي للمناوي ج2 ص552 وراجع: تفسير الثعلبي ج4
ص5 والجامع لأحكام القـرآن ج3 ص68 وج6 ص31 = = وأضواء البيان
للشنقطي ج5 ص254 وأحكام القرآن للجصاص ج4 ص161 و (ط دار الكتب
العلمية) ج2 ص615 والكشاف ج1 ص637 والبحار ج77 ص253 وتحفة
الأحوذي ج8 ص326 وعون المعبود ج10 ص15 وتخريج الأحاديث والآثار
ج1 ص377 .
|