صنم طيء.. وآل حاتم
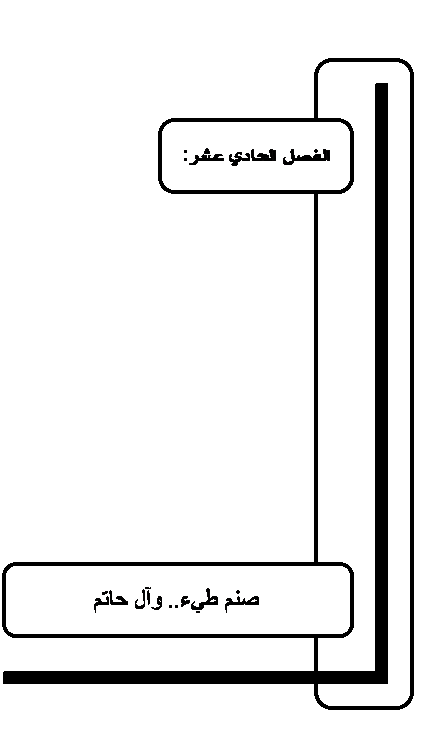
قالوا:
وفي شهر ربيع الآخر من سنة تسع بعث رسول الله «صلى الله
عليه وآله» علي بن أبي طالب «عليه السلام» في خمسين ومائة رجل ـ أو
مائتين كما ذكره ابن سعد ـ من الأنصار على مائة بعير وخمسين فرساً،
ومعه راية سوداء، ولواء أبيض إلى الفلس، ليهدمه.
فأغاروا على أحياء من العرب، وشنوا الغارة على محلة آل
حاتم مع الفجر، فهدموا الفلس وخربوه، وملأوا أيديهم من السبي، والنعم،
والشاء.
وكان في السبي سفانة أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى
الشام.
ووجد في خزانة الفلس ثلاثة أسياف:
رسوب، والمخذم ـ كان الحارث بن أبي شمر قلده إياهما ـ
وسيف يقال له: اليماني، وثلاثة أدرع.
واستعمل علي «عليه السلام» على السبي أبا قتادة،
واستعمل على الماشية والرثة عبد الله بن عتيك.
فلما نزلوا ركك اقتسموا الغنائم وعزلوا للنبي «صلى الله
عليه وآله» صفياً رسوباً والمخذم، ثم صار له بعد السيف الآخر، وعزل
الخمس.
وعزل آل حاتم، فلم يقسمهم حتى قدم بهم المدينة.
ومرَّ النبي «صلى الله عليه وآله» بأخت عدي بن حاتم،
فقامت إليه وكلمته: أن يمن عليها.
فمنّ عليها، فأسلمت وخرجت إلى أخيها، فأشارت عليه
بالقدوم على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقدم عليه([1]).
وذكر ابن سعد في الوفود:
أن الذي أغار، وسبى ابنة حاتم هو خالد بن الوليد([2]).
والفُلْس ـ بضم الفاء، وسكون اللام
ـ:
صنم لطيء ومن يليها([3]).
وفي نص آخر ذكره الواقدي:
أن علياً «عليه السلام» دفع رايته إلى سهل بن حنيف،
ولواءه إلى جبار بن صخر السلمي، وخرج بدليل من بني أسد يقال له: حريث،
فسلك بهم على طريق فيد (جبل)، فلما انتهى بهم إلى موضعٍ قال: بينكم
وبين الحيّ الذي تريدون يوم تام، وإن سرناه بالنهار وطئنا أطرافهم
ورعاءهم، فأنذروا الحيّ، فتفرقوا، فلم تصيبوا منهم حاجتكم، ولكن نقيم
يومنا هذا في موضعنا حتى نمسي، ثم نسري ليلتنا على متون الخيل، فنجعلها
غارة حتى نصبحهم في عماية الصبح.
قالوا:
هذا الرأي!
فعسكروا وسرحوا الإبل واصطنعوا، وبعثوا نفراً منهم
يتقصّون ما حولهم، فبعثوا أبا قتادة، والحباب بن المنذر، وأبا نائلة،
فخرجوا على متون خيل لهم يطوفون حول المعسكر، فأصابوا غلاماً أسود،
فقالوا: ما أنت؟
قال:
أطلب بغيتي.
فأتوا به علياً «عليه السلام»،
فقال:
ما أنت؟
قال:
باغ.
قال:
فشدوا عليه.
فقال:
أنا غلام لرجل من طيء من بني نبهان، أمروني بهذا الموضع
وقالوا: إن رأيت خيل محمد فطر إلينا فأخبرنا، وأنا لا أدرك أسراً، فلما
رأيتكم أردت الذهاب إليهم، ثم قلت: لا أعجل حتى آتي أصحابي بخبر بيِّن،
من عددكم وعدد خيلكم، ورقابكم، ولا أخشى ما أصابني، فلكأني كنت مقيداً
حتى أخذتني طلائعكم.
قال علي «عليه السلام»:
أصدقنا ما وراءك.
قال:
أوائل الحيّ على مسيرة ليلة طرادة، تصبحهم الخيل
ومغارها حين غدوا.
قال علي «عليه السلام» لأصحابه:
ما ترون؟
قال جبار بن صخر:
نرى أن ننطلق على متون الخيل ليلتنا حتى نصبح القوم وهم
غارون، فنغير عليهم ونخرج بالعبد الأسود ليلاً، ونخلف حريثاً مع العسكر
حتى يلحقوا إن شاء الله.
قال علي «عليه السلام»:
هذا الرأي.
فخرجوا بالعبد الأسود، والخيل تعادا، وهو ردف بعضهم
عقبة (نوبة)، ثم ينزل فيردف آخر عقبة، وهو مكتوف، فلما انهار الليل كذب
العبد، وقال: قد أخطأت الطريق وتركتها ورائي.
قال علي «عليه السلام»:
فارجع إلى حيث أخطأت.
فرجع ميلا أو أكثر، ثم قال:
أنا على خطأ.
فقال علي «عليه السلام»:
إنَّا منك على خدعة، ما تريد إلا أن تثنينا عن الحيّ،
قدموه، لتصدقنا، أو لنضربن عنقك.
قال:
فقدم وسل السيف على رأسه، فلما رأى الشر قال: أرأيت إن
صدقتكم أينفعني؟
قالوا:
نعم.
قال:
فإني صنعت ما رأيتم، إنه أدركني ما يدرك الناس من
الحياء، فقلت: أقبلت بالقوم أدلهم على الحيّ من غير محنة ولاحق فآمنهم،
فلما رأيت منكم ما رأيت وخفت أن تقتلوني كان لي عذر، فأنا أحملكم على
الطريق.
قالوا:
أصدقنا.
قال:
الحيّ منكم قريب.
فخرج معهم حتى انتهى إلى أدنى الحيّ، فسمعوا نباح
الكلاب وحركة النعم في المراح والشاء.
فقال:
هذه الأصرام (الجماعات) وهي على فرسخ، فينظر بعضهم إلى بعض.
فقالوا:
فأين آل حاتم؟
قال:
هم متوسطو الأصرام.
قال القوم بعضهم لبعض:
إن أفزعنا الحيّ تصايحوا وأفزعوا بعضهم بعضاً، فتغيب
عنا أحزابهم في سواد الليل، ولكن نمهل القوم حتى يطلع الفجر معترضاً،
فقد قرب طلوعه فنغير، فإن أنذر بعضهم بعضاً لم يخفَ علينا أين يأخذون،
وليس عند القوم خيل يهربون عليها، ونحن على متون الخيل.
قالوا:
الرأي ما أشرت به.
قال:
فلما اعترضوا الفجر أغاروا عليها، فقتلوا من قتلوا،
وأسروا من أسروا، واستاقوا الذرية والنساء، وجمعوا النعم والشاء، ولم
يخف عليهم أحد تغيب فملأوا أيديهم.
قال:
تقول جارية من الحي وهي ترى العبد الأسود ـ وكان اسمه
أسلم ـ وهو موثق: ما له هبل، هذا عمل رسولكم أسلم، لا سلم، وهو جلبهم
عليكم، ودلهم على عورتكم!
قال يقول الأسود:
أقصري يا ابنة الأكارم، ما دللتهم حتى قدّمت ليضرب
عنقي.
قال:
فعسكر القوم، وعزلوا الأسرى وهم ناحية نفير، وعزلوا
الذرية وأصابوا من آل حاتم أخت عدي ونسيات معها، فعزلوهن على حدة.
فقال أسلم لعلي «عليه السلام»:
ما تنتظر بإطلاقي؟
فقال:
تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.
قال:
أنا على دين قومي هؤلاء الأسرى، ما صنعوا صنعت.
قال:
ألا تراهم موثقين، فنجعلك معهم في رباطك؟
قال:
نعم، أنا مع هؤلاء موثقاً أحب إلي من أن أكون مع غيرهم
مطلقاً، يصيبني ما أصابهم، فضحك أهل السرية منه، فأوثق وطرح مع الأسرى.
وقال:
أنا معهم حتى ترون منهم ما أنتم راؤن.
فقائل يقول له من الأسرى:
لا مرحباً بك، أنت جئتنا بهم!
وقائل يقول:
مرحباً بك وأهلاً، ما كان عليك أكثر مما صنعت، لو
أصابنا الذي أصابك لفعلنا الذي فعلت وأشد منه، ثم آسيت بنفسك.
وجاء العسكر واجتمعوا، فقربوا الأسرى، فعرضوا عليهم
الإسلام، فقال: والله، إن الجزع من السيف للؤم، وما من خلود.
قال:
يقول رجل من الحي ممن أسلم: يا عجباً منك، ألا كان هذا
حيث أخذت، فلما قتل من قتل، وسبي منا من سبي، وأسلم منا من أسلم،
راغباً في الإسلام تقول ما تقول؟! ويحك أسلم واتبع دين محمد.
قال:
فإني أسلم وأتبع دين محمد. فأسلم وترك، وكان يعد فلا
يفي حتى كانت الردة، فشهد مع خالد بن الوليد اليمامة، فأبلى بلاء
حسناً.
قال:
وسار علي «عليه السلام» إلى الفلس، فهدمه وخربه، ووجد
في بيته ثلاثة أسياف: رسوب، والمخذم، وسيفاً يقال له: اليماني، وثلاثة
أدراع، وكان عليه ثياب يلبسونه إياها.
وجمعوا السبي، فاستُعمل عليهم أبو قتادة، واستعمل عبد
الله ابن عتيك السلمي على الماشية والرثة.
ثم ساروا حتى نزلوا ركك (أحد جبال طيء) فاقتسموا السبي،
والغنائم، وعزل للنبي «صلى الله عليه وآله» صفياً: رسوباً والمخذم، ثم
صار له بعد السيف الآخر، وعزل الخمس، وعزل آل حاتم، فلم يقسمهم حتى قدم
المدينة.
قال الواقدي:
فحدثت هذا الحديث عبد الله بن جعفر الزهري، فقال: حدثني
ابن أبي عون قال: كان في السبي أخت عدي بن حاتم لم تقسم، فأنزلت دار
رملة بنت الحارث، وكان عدي بن حاتم قد هرب حين سمع بحركة علي «عليه
السلام»، وكان له عين بالمدينة، فحذره فخرج إلى الشام.
وكانت أخت عدي إذا مر النبي «صلى
الله عليه وآله» تقول:
يا رسول الله، هلك الوالد، وغاب الوافد، فامنن علينا
منّ الله عليك.
كل ذلك يسألها رسول الله «عليه
السلام»:
من وافدك؟
فتقول:
عدي بن حاتم.
فيقول:
الفار من الله ورسوله؟ حتى يئست.
فلما كان يوم الرابع مرّ النبي «صلى الله عليه وآله»،
فلم تتكلم، فأشار إليها رجل: قومي فكلميه.
فكلمته، فأذن لها ووصلها، وسألت عن الرجل الذي أشار
إليها، فقيل: علي، وهو الذي سباكم، أما تعرفينه؟
فقالت:
لا والله، ما زلت مُدْنِيَةً طرف ثوبي على وجهي، وطرف
ردائي على بُرقعي من يوم أُسرت حتى دخلتُ هذه الدار، ولا رأيت وجهه ولا
وجه أحد من أصحابه([4]).
وفي نص آخر:
أنه «صلى الله عليه وآله» مضى حتى مرَّ ثلاثاً.
قالت:
فأشار إليَّ رجل من خلفه: أن قومي فكلميه.
قالت:
فقلت: يا رسول الله، هلك الوالد، وغاب الوافد، فامنن
عليّ، منّ الله عليك.
قال:
قد فعلت، فلا تعجلي، حتى تجدي ثقة يبلغك بلادك، ثم
آذنيني.
فسألت عن الرجل الذي أشار إليّ،
فقيل:
علي بن أبي طالب.
وقدم ركب من بلى، فأتيت رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، فقلت:
قدم رهط من قومي.
قالت:
وكساني رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وحملني،
وأعطاني نفقة، فخرجت حتى قدمت على أخي، فقال: ما ترين في هذا الرجل؟!
فقلت:
أرى أن نلحق به([5]).
وفي نص آخر، قالت:
يا محمد، أرأيت أن تخلي عنا ولا تشمت بنا أحياء العرب؟!
فإني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الذمار، ويفك العاني، ويشبع
الجائع، ويكسو العاري، ويقري الضعيف، ويطعم الطعام، ويفشي السلام، ولم
يرد طالب حاجة قط. أنا ابنة حاتم طيء.
فقال لها النبي «صلى الله عليه
وآله»:
يا جارية، هذه صفة المؤمنين حقاً، ولو كان أبوك مسلماً
لترحمنا عليه، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق([6]).
ونقول:
إن لنا مع النصوص المتقدمة وقفات، نجملها فيما يلي من
مطالب:
قد عرفت:
أن الذي جاء بسفانة بنت حاتم هو علي «عليه السلام».
ولكن ابن سعد يذكر:
أن الذي سباها هو خالد بن الوليد، ولا يمكن الجمع
بينهما: بأن خالداً كان في جيش علي «عليه السلام»، لأن جيش علي «عليه
السلام» كانوا كلهم من الأنصار([7]).
لقد كانت المهمة التي أنيطت بأمير المؤمنين «عليه
السلام» هي هدم صنم طيئ.. وهذا يمثل تحدياً كبيراً لتلك القبيلة ولكل
من كان في تلك المنطقة، فإنهم كانوا يلزمون أنفسهم بعبادته، ويصورونه
على أنه قادر على أن يضرهم وينفعهم.
وخير وسيلة لإسقاط هذا الإعتقاد، وإظهار خرافيته وزيفه
هو:
التعرض لذلك الصنم بالهدم، وهو الحد الأقصى للتحدي،
بحيث يقصر عنه كل ما عداه.. ويكون هذا الذي يجري على الصنم أبلغ من كل
قول، وأدلّ من أية حجة، وأوفى من كل بيان..
وذلك لأن هذا الصنم كان هو الوسيلة للتضليل، والخداع،
وهو السبب في صدّ الناس عن الهدى، وأصبح التحدي منحصراً به، فلا بد أن
لا تبقى له أية حرمة، ولا يمثل التعرض له بالهدم تحدياً للذين يتخذونه
وسيلة ضلال وإضلال، فعليهم أن يرضوا بأن يكون هو المحك والمحل لإختيار
الصحة والبطلان.. ويكون من حق كل أحد أن يجعله في موضع الإختيار لإظهار
زيف ما يدّعونه له من قدرات، أو تصرفات، لكي يرى الناس بأم أعينهم: أنه
يفقد ما يدّعونه له، وتتجلى لهم حقيقته، وكيف أنه لا يضر، ولا ينفع،
ولا يبصر ولا يسمع، ولا يضع ولا يرفع، ولا يمنع ولا يدفع..
فإذا نصب هؤلاء الناس العداء لمن يريد أن يبطل حجتهم،
وإظهار بطلان ما يزعمونه لذلك الصنم، وأرادوا أن يواجهوه بالحرب، فذلك
يعني: أنهم مصرون على قهر الآخرين، والتسلط عليهم في دينهم وفي
اعتقاداتهم من دون مبرر.
وهذا ظلم فاحش منهم لابد من العمل على إسقاطه، وإفساح
المجال للآخرين، لممارسة حريتهم في الفكر، وفي الإعتقاد وفي الممارسة..
من أجل ذلك نقول:
إن لعلي «عليه السلام» كل الحق في أن يبادر إلى هدم
الفُلْس ـ صنم طيء ـ ليكشف للناس عجزه، وضعفه، وبطلان ما يزعمونه له من
قدرات وتأثيرات، لكي يتحرر الناس من الخرافة، وليفلتوا من أيدي
المستغلين والظالمين لهم، والمعتدين على كرامتهم الإنسانية، حين رضوا
بأن يستخفوا بهم، وأن يدخلوهم في أنفاق مظلمة من الخداع والتضليل،
والضياع..
وقد كان «عليه السلام» يعلم أن قبيلة طيء لابد أن تمنع
أياً كان من ممارسة هذا الحق الطبيعي في إبطال حجتهم، وتحطيم وسيلة
الخداع والظلم التي في حوزتهم، فاحتاط للأمر وقدم معه عدد قادر على
الدفاع، وصد العدوان. وكسر شوكة المعتدي، فجاء بمائة وخمسين، أو مائتي
مقاتل..
هذا..
ولا مجال للإصغاء إلى ما زعمته الروايات المشبوهة، من
أنهم قد «أغاروا على أحياء من العرب، وشنوا الغارة على محلة آل حاتم
الخ..»، فإنها تريد أن توحي: بأن مهمة علي «عليه السلام» كانت هي
الإغارة على الآمنين، والحصول على الأسرى والسبايا والغنائم، مع أن
النبي «صلى الله عليه وآله» كان يأمر سراياه بأن لا يقاتلوا أحداً إلا
بعد دعوته إلى الإسلام، وإقامة الحجة عليه، فإذا لم يستجب، واتخذ موقف
المعادي، وبادأهم بالعدوان، وواجههم بالحرب، كان عليهم ردّ عدوانه،
وحفظ أنفسهم من سوء ما يواجههم به.
والشواهد على هذا الأمر كثيرة.. ويوجد في ثنايا هذا
الكتاب عدد وافر منها، ولا حاجة إلى تكرار ذلك..
بل إن النصوص التاريخية تشير إلى:
أن آل حاتم كانوا مع المسلمين في حالة حرب.
فقد ذكروا:
أن جواسيسهم كانت تراقب تحركات المسلمين، وأن أولئك
الجواسيس قد وصلوا إلى المدينة نفسها. وقد عرف عدي بن حاتم رئيس قبيلة
طي بمسير المسلمين لهدم صنم عشيرته من جاسوس كان لهم بالمدينة، فغادر
المنطقة وترك عشيرته، وذهب إلى الشام.
كما أن علياً «عليه السلام» حين سار إليهم وجد عيناً
لهم على مسيرة يوم من محالهم، وكانت مهمته هي رصد خيل محمد، حتى إذا
رآها طار إليهم، وأخبرهم ليأخذوا حذرهم..
وإذا كانوا مع المسلمين في حالة حرب، فللمسلمين أن
يحاولوا أخذهم على حين غرة ليوفروا على أنفسهم خسائر قد تكون جسيمة في
الأرواح، وفي المعنويات.
وليس للمحارب:
أن ينام، ويقول: يجب على عدوي إذا وجدني أن يقف إلى
جانبي وينتظرني حتى أستفيق من غفوتي، وأغسل وجهي، وآخذ سيفي، وأركب
فرسي، وأحركها نحوه في اللحظة التي أحب..
علي
 لا يقسم آل حاتم:
لا يقسم آل حاتم:
ولقد لفت انتباهنا:
أن علياً «عليه السلام» قد عزل خمس غنائم الحرب، ثم
قسمها بين المقاتلين، ولكنه لم يقسم آل حاتم.
وهذا يدل على:
أنه «عليه السلام» أراد حفظ كرامة أهل الكرامة، ولم يكن
يريد إذلال أحد. لأن هذه هي مهمة الإسلام، وعنوان رسالة السماء،
ومضمونها العميق، وهو الأمر الذي لم يزل علي «عليه السلام» يجاهد ويضحي
في سبيلها.
وقد أشرنا أكثر من مرة إلى أن راية النبي «صلى الله
عليه وآله» في حربه لأهل الكفر والشرك كانت سوداء، حتى لقد قال الكميت
الأسدي «رحمه الله»:
وإلا فـارفـعـوا
الـرايـات
سـوداً
عـلى
أهـل
الـضـلالـة
والتعـدي([8])
وقد كانت راية علي «عليه السلام» سوداء، وراية رسول
الله «صلى الله عليه وآله» يوم فتح مكة كانت سوداء أيضاً.
وقد كان عدي بن حاتم سيد القبيلة
ورئيسها. فما معنى:
أن يهرب إلى الشام بمجرد أن عرف بتحرك علي «عليه
السلام» نحو بلاد طيء، ولماذا لا يبقى في بلده ليواسي عشيرته بنفسه؟!
ألا يدلنا ذلك على:
أنه كان يعرف مسبقاً بالنتائج، فهو قد عرف وسمع بما جرى
على يد علي «عليه السلام» في خيبر، وأُحد، والخندق، وقريظة، وحنين،
ويوم فتح مكة، وذات السلاسل، وما إلى ذلك..
وهو يعرف قدرات طيء، ولاسيما بعد أن لم يعد هناك من
يؤمل نصره.
كما أن ذلك يشير إلى إدراكه سخافة عبادة الأصنام، وعدم
معقولية الدفاع عنها، وتعريض النفس والأهل والمال والولد للأخطار من
أجلها وفي سبيلها..
ولأجل ذلك اختار دين النصرانية، الذي يزعم أهله أنه
سماوي، ورأى أنه أقرب وأولى بالاعتبار من الشرك، وعبادة الأحجار.
ولعله هرب إلى الشام أملاً في أن يجد لدى القياصرة ـ
وهم نصارى ـ ما يمكن أن يعتمد عليه في محاربة الإسلام وأهله..
1 ـ
تقدم: أن علياً «عليه السلام» اصطفى ثلاثة سيوف لرسول
الله «صلى الله عليه وآله»، وذكر ابن هشام عن بعض أهل العلم: أنه «صلى
الله عليه وآله» قد وهب رسوباً، والمخذم لعلي «عليه السلام». قال: وهما
سيفا علي رضي الله عنه([9]).
2 ـ
إنه «عليه السلام» قد اختار السيوف لتكون هي التحفة
التي يخص بها رسول الله «صلى الله عليه وآله» لأنه يعلم أنه «صلى الله
عليه وآله» سيد المجاهدين، الباذلين أنفسهم في سبيل الله وقائدهم. حيث
إنه لا يفكر بالمال ولا بالمغانم، ولا يريد جاهاً، ولا مقاماً دنيوياً،
ولا يسعى للحصول على متعة بشيء من حطام الدنيا، وإنما يفكر بسعادة
الناس في الدنيا والآخرة، وبهدايتهم إلى طريق الحق والخير، وبكل ما
يعينه على ذلك في ميادين الجهاد والتضحيات، مهما عظمت وجلت..
وبعد أن ظهر:
أن ذلك الجاسوس قد حاول أن يخدع المسلمين، تهدده أمير
المؤمنين «عليه السلام»، وهذا يدل على: جواز إجبار الأسير على الإقرار
بأمر يُعْلَم بكتمانه له، إضراراً منه بالمسلمين..
وليس فيه دلالة على صحة إجباره على ما يظن أو يحتمل أنه
يكتمه.
وقد أظهرت الرواية السابقة:
أن المسلمين كانوا يحرصون على مواجهة الرجال المقاتلين
من آل حاتم بالحرب، وبهدف استئصال الروح القتالية ضد المسلمين فيهم،
لأن ذلك يمنعهم من التفكير بجمع الجموع والعودة إلى الحرب، ويوفر على
المسلمين متاعب، وربما خسائر قد تكون كبيرة أو كثيرة، وكما أن ذلك قد
يسهل دخول هؤلاء الناس في الإسلام لكي يسعدوا به.. وهذا هو المطلوب.
ثم إن هؤلاء الأسرى الذين حاربوا الإسلام والمسلمين،
وأرادوا أن أن يطفئوا نور الله بالقول، وبالفعل المسلح، ويريدون منع
الناس من قبول الهداية الإلهية بعد أن أقيمت الحجة عليهم، ولم يبق لهم
أي عذر، وقد أسفر الصبح لذي عينين، لا يستحقون الحياة.
ولو تُركوا فلن يكون لهم دور إلا الفساد الإفساد،
والتآمر، والتهيئة لمزيد من الحروب والكوارث.
ولكن الإسلام قد تكرم عليهم حين منحهم فرصة أخيرة، فعرض
عليهم الإسلام، فإذا أبوه، فلا بد من تخليص الناس من شرهم. وفق ما
يمليه الواجب، وتحكم به جميع الشرايع والأعراف.
لم يجبها
 إلا في المرة الرابعة:
إلا في المرة الرابعة:
لقد لاحظنا:
أن النبي
«صلى الله عليه وآله» لم يستجب لطلب سفَّانة
بنت حاتم بأن يمن عليها بعد أن غاب وافدها.. وكان في كل
مرة يقول لها: من وافدك؟!
فتقول:
عدي بن حاتم.
فيقول «صلى الله عليه وآله»:
الفارُّ من الله ورسوله؟
وكانت يئست من استجابته، فسكتت في الرابعة، فحرضها علي
«عليه السلام»، على معاودة الطلب، ففعلت، فاستجاب لها..
فما هي الحكمة من تأجيله «صلى الله عليه وآله»
الإستجابة لطلبها إلى المرة الرابعة؟!
ويمكن أن يجاب:
بأنه «صلى الله عليه وآله» أراد أن يجعل من ذلك ذريعة
للتأكيد على رعونة موقف أخيها عدي بن حاتم، مع التصريح التعليمي لها،
ولكل من تبلغه كلماته بالدليل على فساد هذا التصرف من عدي؛ وخروجه عن
حدود المعقول والمقبول. فإن الهروب المنسجم مع موازين العقل والعدل هو
ما كان إلى الله ورسوله، لا الهروب منهما، لأن الهروب إذا كان منهما،
فهو طيش ورعونة وافتتان، وإذا كان إليهما فهو حكمة، وروية، واتزان.
والمتوقع من أمثال عدي، والمناسب
لحاله هو:
أن يكون أكثر تعقلاً، وأفضل روية، إذ لا يمكن أن يجهل
عاقل بحقيقة أنه تبارك وتعالى مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ
المستصرخين، موضع حاجات الطالبين.
ولا نريد أن نقول أكثر من ذلك.
ولعل مما يؤكد صحة ذلك:
أنه «صلى الله عليه وآله» كان في كل مرة يسألها: من
وافدك؟ مع أن مما لا شك فيه: أنه قد عرف وافدها منذ الفترة الأولى.
ولكنه كان يريد أن تعود إلى التصريح باسمه ليعاود التأكيد على قوله
هذا.
وجهها علي
 وحرص
عليها النبي وحرص
عليها النبي
 : :
ويبقى أن نشير هنا إلى أمرين:
أحدهما:
أن علياً «عليه السلام» الذي أسرها، هو الذي حرضها على
معاودة طلب المنّ عليها من رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وفي ذلك
دلالة واضحة على مدى حرصه «عليه السلام» على أن يبلغها ما تريد. ويحفظ
لها بذلك عزتها وكرامتها، ربما لما كان يتوسمه فيها من ـ كونها امرأة
حازمة تعرف بسداد الرأي وحسن الإختيار، وذلك سيؤدي بها إلى اختيار
الإسلام، ثم تكون سبباً في هداية أخيها عدي، كما صدقته الوقائع بعد
ذلك، حيث إن أخاها أخذ برأيها، واختار الإسلام، ثم القدوم على رسول
الله «صلى الله عليه وآله».
وقد كان علي «عليه السلام» قد قسَّم الغنائم، وعزل
السبي، فلم يقسمهم، بل أرسلهم إلى المدينة، كما تقدم.
الثاني:
إن تأخير النبي الأعظم والأكرم «صلى الله عليه وآله»
إلى اليوم الرابع، لا يعني: أن استجابته المتأخرة تختزن الرغبة في أن
يعاملها بقسوة، فإنه أجابها بقوله: قد فعلت، فلا تعجلي حتى تجدي ثقة
يبلغك بلادك، ثم آذنيني.
فلما علم أنها وجدت ذلك كساها وحملها، وأعطاها نفقة..
وهذا الموقف يشير إلى مدى حرصه «صلى الله عليه وآله»
على حفظ هذه المرأة، وعلى رغبته في إكرامها، وعلى راحتها، وسعادتها..
وقد تقدم:
أنها ذكرت أباها للنبي «صلى الله عليه وآله» ووصفته
بالكرم. وبغير ذلك من أمور جميلة، فقال لها «صلى الله عليه وآله»: لو
كان أبوك مسلماً لترحمنا عليه..
وهذه هي الكلمة الصادقة والمناسبة لمقتضى الحال، لأنها
في حين لم تتضمن إشادة منه «صلى الله عليه وآله» بإبيها الذي مات على
الشرك، فإنها أيضاً لم تجرح عاطفة سفَّانة، لأنها لم تتضمن جَرحاً
صريحاً: بل اكتفت بالإشارة إلى أن شرك حاتم يمنعه «صلى الله عليه وآله»
من الترحم عليه فـ {إِنَّ
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}([10])
كما قال تبارك وتعالى..
ونريد لفت النظر هنا إلى:
أن الروايات قد اختلفت في الصيغة التي وردت على لسان
رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فبعضها يقتصر على كلمة: «لو كان أبوك
مسلماً لترحمنا عليه».
وبعضها يضيف إلى ذلك قوله «صلى الله
عليه وآله»:
يا جارية، هذه صفة المؤمنين حقاً..
أو أنه «صلى الله عليه وآله» قال:
خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق..
وليس لدينا ما يؤكد صحة صدور هذه العبارات عنه «صلى
الله عليه وآله»..
بل إن الرواية التي ذكرت هذه الفقرات قد تضمنت ما يدل
على أن ثمة تصرفاً مشيناً في تلك الرواية، حيث زعمت: أن علياً «عليه
السلام» قد وصف بنت حاتم بما لا يعقل صدوره منه.
وأنه «عليه السلام» لما رآها عند النبي «صلى الله عليه
وآله» أعجب بها، وصمم على أن يطلب من رسول الله «صلى الله عليه وآله»
أن يجعلها في فيئه([11])،
مع أنه هو الذي سباها، وجاء بها من بلادها إلى المدينة.
ويذكرون هنا أيضاً:
أن سفَّانة قد أسلمت وحسن إسلامها، وغادرت المدينة إلى
الشام.
قال عدي:
«فوالله إني لقاعد في أهلي، إذ نظرت إلى ظعينة تصوب إلي
تؤمنا.
قال:
فقلت: ابنة حاتم، فإذا هي هي.
فلما وقفت علي قالت:
أنت القاطع الظالم، ارتحلت بأهلك وولدك، وتركت بقية
والدك: أختك وعورتك؟!
قال:
قلت: يا خية، لا تقولي إلا خيراً، فوالله ما لي من عذر،
ولقد صنعت ما ذكرت.
قال:
ثم نزلت، فأقامت عندي.
قال:
فقلت لها، وكانت امرأة حازمة: ماذا ترين في أمر هذا
الرجل؟
قالت:
أرى والله أن نلحق به سريعاً، فإن يكن الرجل نبياً،
فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكاً فلن نذل في عز اليمن، وأنت أنت.
قال:
قلت: والله إن هذا الرأي.
قال:
فخرجت حتى أقدم على رسول الله «صلى الله عليه وآله»
المدينة، فدخلت عليه وهو في مسجده، (وعنده امرأة وصبيان، أو وصبي، وذكر
قربهم من رسول الله «صلى الله عليه وآله».
قال:
فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر)، فسلمت عليه، فقال:
من الرجل؟!
قال:
قلت: عدي بن حاتم.
قال أبو عامر في حديثه:
فرحب به النبي «صلى الله عليه وآله» وقربه. وكان يتألف
شريف القوم ليتألف به قومه.
قال ابن إسحاق في حديثه:
فقام رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فانطلق به إلى
بيته.
قال:
فوالله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة كبيرة ضعيفة،
فاستوقفته، فوقف لها طويلاً تكلمه في حاجتها.
قال:
قلت في نفسي والله، ما هذا بملك.
قال: ثم مضى حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوة
ليفاً، فقدمها إلي، فقال: اجلس على هذه.
قلت:
بل أنت فاجلس.
قال:
فقال: بل أنت فاجلس عليها.
قال:
فجلست عليها، وجلس رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالأرض.
قال:
قلت: في نفسي ما هذا بأمر ملك.
قال أبو عامر في حديثه:
فدخل الإسلام في قلبي، وأحببت رسول الله «صلى الله عليه وآله» حباً لم
أحبه شيئاً قط.
قال:
ولم يكن في البيت إلا خصاف ووسادة أديم، وقال في حديثه: فلم يجلس عليها
ولم أجلس عليها، ثم أقبل علي، فقال:
هيه يا عدي بن حاتم، أفررت أن توحد الله؟ وهل من أحد
غير الله؟
هيه يا عدي بن حاتم، أفررت أن تكبر الله؟ ومن أكبر من
الله؟
هيه يا عدي بن حاتم، أفررت أن تعظم الله؟ ومن أعظم من
الله؟
هيه يا عدي بن حاتم، أفررت أن تشهد أن لا إله إلا الله؟
وهل من إله غير الله؟
هيه يا عدي بن حاتم، أفررت أن تشهد أن محمداً رسول
الله؟
قال:
فجعل رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول نحو هذا وأنا أبكي.
قال:
ثم أسلمت.
قال ابن إسحاق في حديثه:
ثم قال: إيه يا عدي بن حاتم، ألم تك ركوسياً([12]).
قال:
قلت بلى.
قال:
فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك.
قال:
قلت: أجل والله، وعرفت أنه نبي مرسل، يعلم ما يجهل.
وفي نص آخر:
فقال: «يا عد ي، أخبرك ألا إله إلا الله، فهل من إله
إلا الله؟ وأخبرك أن الله تعالى أكبر، فهل من شيء هو أكبر من الله عز
وجل»؟
ثم قال:
«يا عدي أسلم تسلم».
فقلت:
إني على ديني.
فقال:
«أنا أعلم منك بدينك».
فقلت:
أنت أعلم مني بديني؟
قال:
«نعم» يقولها ثلاثاً. «ألست ركوسياً»
فقلت:
بلى.
قال:
«ألست ترأس قومك»؟
قلت:
بلى.
قال:
«أولم تكن تسير في قومك بالمرباع»؟
قلت:
بلى والله، وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل.
قال:
«فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك».
قال:
ثم قال: لعله يا عدي بن حاتم إنما يمنعك من دخول في هذا
الدين ما ترى من حاجتهم، فوالله لأوشك أن يفيض فيهم ـ يعني المال ـ حتى
لا يوجد من يأخذه.
ولعله أن يمنعك من ذلك ما ترى من كثرة عدوهم وقلة
عددهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى
تزور البيت لا تخاف.
ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك
والسلطان في غيرهم، وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور من أرض بابل
البيض قد فتحت عليهم.
قال:
فأسلمت، فكان عدي يقول: مضت
اثنتان، وبقيت الثالثة، ووالله لتكونن. لقد رأيت القصور البيض من أرض
بابل وقد فتحت عليهم، ورأيت المرأة تخرج على بعيرها لا تخاف إلا الله
حتى تحج هذا البيت من القادسية، وأيم الله لتكونن الثالثة، ليفيضن
المال حتى لا يوجد من يأخذه»([13]).
في رواية قال:
«هل رأيت الحيرة»؟
قلت:
لم أرها وقد علمت مكانها.
قال:
«فإن الظعينة سترحل من الحيرة تطوف بالبيت في غير جوار
لا تخاف أحداً إلا الله عز وجل والذئب على غنمها».
قال:
فقلت في نفسي: فأين ذعار طيء الذين سعروا البلاد؟
قال:
«فلعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى الملك والسلطان
في غيرهم والله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت
عليهم».
وفي رواية:
«لتفتحن عليهم كنوز كسرى بن هرمز».
قلت:
كنوز كسرى بن هرمز.
قال:
«كنوز كسرى بن هرمز».
وفي رواية:
«ولئن طالت بك حياة، لترين الرجل يخرج بملء كفه من ذهب
أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحداً يقبله منه، وليلقين الله أحدكم
يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم،
وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم
تجدوا شق تمرة فبكلمة طيبة»([14]).
قال عدي:
فأسلمت، فرأيت وجه رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد
استبشر، فقد رأيت الظعينة ترحل من الكوفة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا
الله عز وجل، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة
سترون ما قال أبو القاسم «صلى الله عليه وآله»([15]).
([1])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج6 ص218 والمغازي للواقدي ج3 ص984 و
985 والسيرة الحلبية ج3 ص205 وراجع: المواهب اللدنية وشرحه
للزرقاني ج4 ص48 و 49 و 50 وتاريخ الخميس ج2 ص120 و 121
والإصابة ج4 ص329 وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج69 ص194 ـ 203
وإحقاق الحق (الملحقات) ج23 ص234 ـ 237 وراجع: الطبقات الكبرى
لابن سعد ج2 ص164 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص624 وإمتاع
الأسماع ج2 ص45.
([2])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج6 ص218 والطبقات الكبرى لابن سعد ج1
ص322 وراجع: تاريخ مدينة دمشق ج69 ص193.
([3])
شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج4 ص48. وراجع: معجم البلدان ج4
ص273 وج5 ص205
([4])
المغازي للواقدي ج3 ص985 ـ 989. وراجع: تاريخ مدينة دمشق ج69
ص194 ـ 198 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج23 ص234 ـ 238.
([5])
الإصابة ج4 ص329 و (ط دار الكتب العلمية) ج8 ص180 عن ابن
إسحاق، وابن الأثير، وأبي نعيم، والطبراني، والخرائطي في مكارم
الأخلاق، وراجع: السيرة الحلبية ج3 ص205 وراجع: شرح المواهب
اللدنية للزرقاني ج4 ص49 و50 وأسد الغابة ج5 ص475.
([6])
السيرة الحلبية ج3 ص205 و (ط دار المعرفة) ج3 ص224 والبداية
والنهاية ج2 ص271 وج5 ص80 والسيرة النبوية لابن كثير ج1 ص109
وج4 ص132 وتاريخ مدينة دمشق ج11 ص359 وج36 ص446 وج69 ص202 و
203 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص376 ومستدرك الوسائل ج11 ص194
وجامع أحاديث الشيعة ج14 ص210 وموسوعة أحاديث أهل البيت «عليهم
السلام» ج10 ص398 ونهج السعادة للمحمودي ج7 ص362 وكنز العمال
ج3 ص664 والدرجات الرفيعة ص355.
([7])
شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج4 ص50.
([8])
تاريخ الأمم والملوك ج5 ص432.
([9])
شرح المواهب اللدنية ج4 ص49.
([10])
الآية 13 من سورة لقمان.
([11])
تاريخ مدينة دمشق ج11 ص359 وج36 ص445 وج69 ص202 و203 وجامع
أحاديث الشيعة ج14 ص210 ونهج السعادة ج7 ص361 وكنز العمال ج3
ص664 والبداية والنهاية ج2 ص271 وج5 ص80 والسيرة النبوية لابن
كثير ج1 ص109 وج4 ص131 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص376.
([12])
الركوسية: طائفة من النصارى والصابئين. أقرب الموارد ج1 ص428.
([13])
تاريخ مدينة دمشق (ط دار الفكر) ج69 ص200 و 201 عن السيرة
النبوية لابن هشام ج4 ص225 فما بعدها و (نشر مكتبة محمد علي
صبيح) ج4 ص1001 و 1002 وراجع: سبل الهدى والرشاد ج6 ص276 ـ 278
عن أحمد، والبيهقي، والطبراني. وراجع: الدرجات الرفيعة في
طبقات الشيعة ص353 ـ 354 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص376 ـ 377
والبداية والنهاية ج5 ص75 ـ 77 وعيون الأثر ج2 ص287 و 288
والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص124 ـ 126.
([14])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص378 وفتح الباري ج13 ص72 والبداية
والنهاية ج5 ص79 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص130.
([15])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص378 عن البيهقي، وأحمد، والطبراني.
وراجع: صحيح البخاري ج4 ص176 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص226
ودلائل النبوة للأصبهاني ج3 ص825 والبداية والنهاية ج5 ص79 وج6
ص209 وإمتاع الأسماع ج14 ص59 والسيرة النبوية لابن كثير ج4
ص130.
|