ست وفادات شخصية
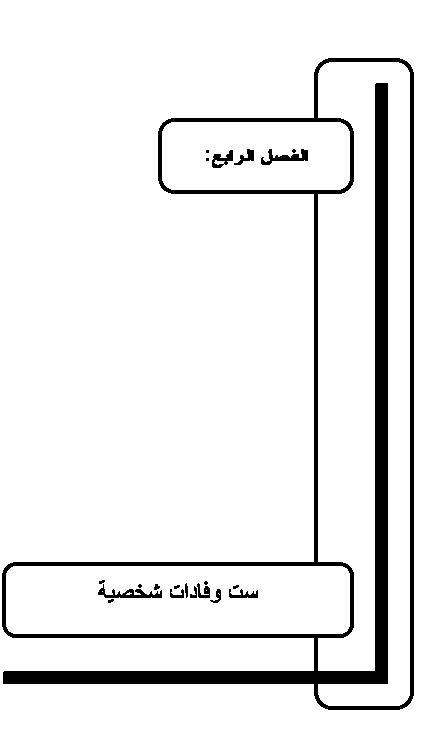
عن لقيط بن عامر قال:
خرجت أنا وصاحبي نهيك بن عاصم [بن مالك بن المنتفق]
(لانسلاخ رجب)([1])
حتى قدمنا على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فوافيناه حين انصرف
من صلاة الغداة، فقام في الناس خطيباً، فقال: «يا أيها الناس، ألا
إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام لتسمعوا الآن، ألا فهل من
امرئ قد بعثه قومه فقالوا: اعلم لنا ما يقول رسول الله «صلى الله
عليه وآله»؟ ألا ثمّ رجل لعلَّه أن يلهيه حديث نفسه، أو حديث
صاحبه، أو يلهيه ضال؟! ألا وإني مسؤول هل بلغت؟ ألا اسمعوا تعيشوا،
ألا اجلسوا».
فجلس الناس، وقمت أنا وصاحبي، حتى إذا فرغ لنا
فؤاده وبصره قلت: يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟
فضحك، فقال:
«لعمر الله» وهز رأسه، وعلم أني أبتغي سقطه، فقال:
«ضنَّ ربك عز وجل بمفاتيح خمسة من الغيب لا يعلمها إلا الله».
وأشار بيده.
فقلت:
وما هي يا رسول الله؟
فقال:
«علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه،
وعلم ما في غد وما أنت طاعم غداً ولا تعلمه، وعلم المني حين يكون
في الرحم قد علمه ولا تعلمونه، وعلم الغيث يشرف عليكم آزلين
مسنتين، فيظل يضحك قد علم أن غوثكم قريب».
قال لقيط:
قلت: لن نعدم من رب يضحك خيراً يا رسول الله.
قال:
«وعلم يوم الساعة».
قلت:
يا رسول الله، إني سائلك عن حاجتي فلا تعجلني.
قال:
«سل عما شئت».
قال:
قلت يا رسول الله: علّمنا مما لا يعلم الناس، ومما
تعلم، فإنَّا من قبيلٍ لا يصدقون تصديقنا أحداً، من مذحج التي تدنو
إلينا، وخثعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها.
قال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«ثم تلبثون ما لبثتم، يتوفى نبيكم ثم تبعث الصائحة،
فلعمرو إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات، والملائكة الذين مع
ربك، فيصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض قد خلت عليه البلاد، فيرسل
ربك السماء تهضب من عند العرش، فلعمرو إلهك ما تدع على ظهرها من
مصرع قتيل، ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من قبل رأسه،
فيستوي جالساً.
فيقول ربك:
مهيم ـ لما كان فيه.
فيقول:
يا رب، أمس اليوم، ولعهده بالحياة يحسبه حديث عهد
بأهله».
فقلت:
يا رسول الله، فكيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح،
والبلى، والسباع؟
فقال:
«أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، أشرقت على الأرض وهي
مدرة بالية.
فقلت:
لا تحيا هذه أبداً، ثم أرسل ربك عليها، فلم تلبث
إلا أياماً حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة، ولعمرو إلهك لهو أقدر
على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، فتخرجون من
الأصواء، ومن مصارعكم، فتنظرون إليه وينظر إليكم».
قال:
قلت: يا رسول الله، كيف ونحن ملء الأرض، وهو عز وجل
شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟
قال:
«أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل: الشمس والقمر
آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعة واحدة، [ولعمرو إلهك أقدر على
أن يراكم وترونه من أن ترونهما ويريانكم] لا تضارون ـ وفي لفظ: لا
تضامون ـ في رؤيتهما».
قلت:
يا رسول الله، فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟
قال:
«تعرضون عليه بادية له صفحاتكم، لا تخفى عليه منكم
خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم،
فلعمرو إلهك ما تخطئ وجه أحد منكم قطرة، فأما المسلم فتدع وجهه مثل
الريطة البيضاء.
وأما الكافر فتنضحه، أو قال:
فتحطمه بمثل الحمم الأسود.
ثم ينصرف نبيكم، ويتفرق على أثره الصالحون، فتسلكون
جسراً من النار، فيطأ أحدكم الجمر، فيقول: حس.
فيقول ربك عز وجل:
أوإنه! ألا فتطلعون على حوض نبيكم، لا يظمأ والله
ناهله قط، فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده الا وقع عليها قدح
يطهره من الطوف والبول والأذى، وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما
واحداً».
قال:
قلت يا رسول الله، فبم نبصر يومئذ؟
قال:
«بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك مع طلوع الشمس في يوم
أشرقته الأرض، وواجهته الجبال».
قال:
قلت: يا رسول الله، فبم نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟
قال:
«الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بمثلها إلا أن
يعفو».
قال:
قلت: يا رسول الله، فما الجنة وما النار؟
قال:
«لعمرو إلهك إن النار لها سبعة أبواب، ما منها
بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاماً، وإن للجنة ثمانية
أبواب، ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاماً».
قال:
قلت: يا رسول الله، فعلام نطلع من الجنة؟
قال:
«على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر ما بها من
صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وماء غير آسن،
وفاكهة، ولعمرو إلهك ما تعلمون، وخير من مثله معه أزواج مطهرة».
قال:
قلت: يا رسول الله، أولنا فيها أزواج؟! أَوَمنهنّ
صالحات؟
قال:
«المصلحات للصالحين».
وفي لفظ:
«الصالحات للصالحين، تلذّون بهن مثل لذاتكم في
الدنيا، ويلذذن بكم غير أن لا توالد».
قال لقيط:
قلت: يا رسول الله، أقصى ما نحن بالغون ومنتهون
إليه؟
فلم يجبه النبي «صلى الله عليه وآله».
قال:
قلت: يا رسول الله، علام أبايعك؟
قال:
فبسط رسول الله «صلى الله عليه وآله» يده وقال:
«على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وزيال الشرك، فلا تشرك بالله
إلهاً غيره».
قال:
فقلت: يا رسول الله، وإن لنا ما بين المشرق
والمغرب؟
فقبض النبي «صلى الله عليه وآله» يده وظن أني أشترط
عليه شيئاً لا يعطينيه.
قال:
قلت: نحل منها حيث شئنا، ولا يجني على امرئ إلا
نفسه؟
فبسط إليَّ يده وقال:
«ذلك لك، تحل حيث شئت ولا يجزي عنك إلا نفسك».
قال:
فانصرفنا عنه. فقال: «ها إنّ ذين، ها إنّ ذين، من
أتقى الناس في الأولى والآخرة».
فقال له كعب بن الخدارية، أحد
بني بكر بن كلاب:
من هم يا رسول الله؟
قال:
«بنو المنتفق أهل ذلك منهم».
قال:
فانصرفنا وأقبلت عليه، فقلت: يا رسول الله، هل لأحد
ممن مضى من خير في جاهليتهم؟
فقال رجل من عرض قريش:
والله إن أباك المنتفق لفي النار.
قال:
فلكأنَّه وقع حَرٌّ بين جلدة وجهي ولحمي مما قال
لأبي، على رؤوس الناس، فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ ثم إذا
الأخرى أجمل، فقلت: يا رسول الله، وأهلك؟
قال:
«وأهلي لعمرو الله، حيث ما أتيت على قبر عامري أو
قُرشي أو دَوسي قل أرسلني إليك محمد، فأبشر بما يسوؤك تجر على وجهك
وبطنك في النار».
قال:
قلت: يا رسول الله، وما فعل بهم ذلك؟ وقد كانوا على
عمل لا يحسنون إلا أياه، وكانوا يحسبون أنهم مصلحون.
قال «صلى الله عليه وآله»:
«ذلك بأن الله تعالى بعث في آخر كل سبع أمم نبياً،
فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين».
قال الصالحي الشامي:
رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند،
والطبراني.
وقال الحافظ أبو الحسن الهيثمي:
أسنادها متصلة ورجالها ثقات. وإسناد الطبراني مرسل،
عن عاصم بن لقيط.
وقال في زاد المعاد:
«هذا حديث كبير جليل، تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه خرج من
مشكاة النبوة، رواه أئمة السنة في كتبهم، وتلقوه بالقبول، وقابلوه
بالتسليم والإنقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته».
وسرد «ابن القيم» من رواه من
الأئمة، منهم البيهقي في كتاب البعث([2]).
ونقول:
قد تضمن الحديث المتقدم مواضع مكذوبة على رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، ونحن نكتفي هنا بالإشارة إلى بعضها، وهي
التالية:
قد زعمت الرواية المتقدمة:
أن الله عز وجل: «يظل يضحك قد علم أن غوثكم قريب.
قال لقيط:
قلت: لن نعدم من رب يضحك خيراً».
وقالت:
«فيصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض قد خلت عليه
البلاد».
وقالت:
«..فتخرجون من الأصواء، ومن مصارعكم، فتنظرون إليه،
وينظر إليكم».
قال:
قلت: «يا رسول الله، كيف ونحن ملء الأرض، وهو عز
وجل شخص واحد، ينظر إلينا، وننظر إليه؟!
قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء
الله عز وجل:
الشمس والقمر آية منه صغيرة، ترونهما ويريانكم ساعة
واحدة، ولعمرو إلهك أقدر على أن يراكم وترونه من أن ترونهما
ويريانكم»
وقالت الرواية أيضاً:
«فيأخذ ربكم عز وجل بيده غرفة من الماء، فينضح
قبلكم».
وقد حاول هؤلاء:
أن يبعدوا هذا النوع من الروايات عن دائرة التجسيم،
فزعموا ـ كما قال في زاد المعاد في قوله «صلى الله عليه وآله»:
«فيظل يضحك»، هذا من صفات أفعاله سبحانه وتعالى التي لا يشبهه فيها
شيء من مخلوقاته كصفات ذاته، وقد وردت هذه القصة في أحاديث كثيرة
لا سبيل إلى ردها، كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفها، وكذلك قوله:
«فأصبح ربك يطوف في الأرض»، هو من صفات أفعاله، كقوله تعالى:
{وَجَاء
رَبُّكَ وَالمَلَكُ صَفّاً
صَفّاً}([3])،
وقوله تعالى: {هَلْ
يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ المَلآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ
رَبُّكَ}([4]).
وينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا [ويدنو عشية عرفة، فيباهي
بأهل الموقف الملائكة]، والكلام في الجميع صراط واحد مستقيم، إثبات
بلا تمثيل، وتشبيه وتنزيه بلا تحريف وتعطيل([5]).
ومن الواضح:
أن هذا كله من قبيل الضحك على اللحى، ونحن نوضح هنا
هذا الأمر بعض التوضيح بقدر ما تسمح لنا به المناسبة، فنقول:
إن الحنابلة قد أثبتوا لله صفات وجدت الفرق الأخرى
أنها قد أدت بالقائلين بها إلى إثبات صفة الجسمية له تعالى..
ويسمون أنفسهم صفاتية.
فأثبتوا لله تبارك وتعالى يداً، وإصبعاً، وساقين،
وقدمين، وعينين، ونفساً، ونواجذ وما إلى ذلك مما وردت به
أحاديثهم.. وقد أثبتوها له بما لها من معان حقيقية.
وقالوا:
إنه تعالى فوق عرشه في السماوات، وينزل إلى الأرض.
وقد جمع ابن خزيمة في كتابه:
التوحيد وإثبات صفات الرب مئات من هذه الأحاديث، ثم
اختار منها البيهقي الصحاح والحسان، وحاول تأويلها في كتابه:
«الأسماء والصفات» بكثير من التكلف والتعسف. ولو أنه أقر بكذبها
لكان أراح واستراح.
ويشير إلى كثرة أحاديث التجسيم، التي يسمونها
أحاديث الصفات قول ابن تيمية: «وقد جمع علماء الحديث من المنقول في
الإثبات، ما لا يحصي عدده إلا رب السماوات»([6]).
وقد بلغ بهم تشددهم في هذه العقيدة، حداً جعلهم ينكرون المجاز،
وأطلقوا عليه أنه طاغوت([7]).
ولعل أصدق كلمة في التعبير عن واقع ومنحى هذه
الأحاديث هو ما وصف به الفخر الرازي كتاب ابن خزيمة، فقد قال وهو
يتحدث عن آية: {لَيْسَ
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}([8]):
«واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا بهذه الآية
في الكتاب الذي سماه: بـ «التوحيد»، وهو في الحقيقة كتاب الشرك،
واعترض عليها، وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف التطويلات، لأنه كان
رجلاً مضطرب الكلام، قليل الفهم، ناقص العقل»([9]).
ولعل مما سهَّل تقبل الناس
لعقيدة التجسيم:
أنها كانت منسجمة مع عبادة الأصنام التي كانت شائعة
في العرب، فهم وإن كانوا قد اصبحوا يعبدون الله، ولكنهم أعطوه نفس
صفات أصنامهم.
يضاف إلى ذلك:
أن هذه العقيدة كانت موجودة
لدى أهل الكتاب. فالنصارى شبهوا المسيح بالله، وجعلوه الابن،
وقالوا: إنه الأقنوم الثالث في الذات الإلهية. وكان في العرب
نصارى، وفي الحيرة وفي الشام، وفي نجران([10]).
واليهود الذين كانوا أكثر إغراقاً في التجسيم
الإلهي، كانوا يقيمون في المدينة المنورة، أو قريباً منها مثل
خيبر، وكان لهم وجود قوي في تيماء، وفي وادي القرى. وفي اليمن كان
لهم ملوك. وكان العرب مبهورين بهم، خاضعين لهم ثقافياً، وكان لكعب
الأحبار، ووهب بن منبه، وعبد الله بن سلام، وأضرابهم تأثير في
إشاعة ثقافة اليهود بواسطة فريق من الناس كانوا يأخذون منهم من دون
أي تحفظ، مثل أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومقاتل
وغيرهم..
وإذا استثنينا علياً وأهل البيت «عليهم السلام»،
وكذلك شيعتهم، فسنجد أن الحكام بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله»
قد ساعدوا على ذلك، وكذلك الأمويون والعباسيون.
وأما علي «عليه السلام» «فخطبه في بيان نفي التشبيه
(أي التجسيم) وفي إثبات العدل أكثر من أن تحصى»([11]).
وعنه أخذ المعتزلة القول بالتنزيه.
وقد ذكرنا بعض ما يرتبط بهذا الأمر في الجزء الأول
من هذا الكتاب.
وقد حاول الأشاعرة أن ينأوا بأنفسهم عن عقيدة
الصفات (أعني إثبات الأعضاء والحركات) التي التزم بها أهل الحديث
بزعامة أحمد بن حنبل، وقبله وبعده.. ولكنهم عادوا ليلتزموا بطرف
منه، ووقعوا فيما هربوا منه، حين اثبتوا رؤية الله تعالى في
الآخرة..
يبقى أن نشير إلى:
أن ما زعمه ابن القيم من التفريق بين الأعضاء، وبين
الحركات والأفعال، فقال: إن التجسيم إنما هو فيما كان من قبيل
الأول، أما الثاني، فليس منه، ما هو إلا محاولة فاشلة:
أولاً:
لأنهم إنما يثبتون له تعالى حركة تلازم صفة الجسمية
من حيث كونها حركة له، ولأجل ذلك قال ابن تيمية: إنه تعالى ينزل
إلى السماء الدنيا كما ينزل هو عن المنبر، ثم نزل ابن تيمية عن
منبره([12]).
أو أنه تعالى بعد نفخ الصور يطوف في الأرض، قد خلت عليه البلاد([13]).
ثانياً:
إن الرواية قد تضمنت رؤية الناس لربهم ورؤيته لهم
حين يخرجون من مصارعهم حين ينفخ في الصور.
ومن الواضح:
أن نظرهم إلى ربهم لابد أن يكون على نحو الحقيقة،
كنظره تعالى إليهم، وذلك لا يكون إلا إذا كان في مكانٍ وجهة
بعينها، وكان جسماً أيضاً، تماماً كما هو الحال بالنسبة لإشراق
الشمس والقمر علينا، ورؤيتنا لهما. حسبما أوضحته الرواية نفسها.
كما أنها قد تضمنت:
أن الله سبحانه وتعالى يأخذ بيده غرفة من الماء،
فينضح بها قبلكم، ثم هي قد تحدثت عن ضحك الله عز وجل..
وهما حركتان جسمانيتان بالدرجة الأولى، ولا مجال
لدفع ظهور الكلام في ذلك إلا بالإلتزام بالمجازات البعيدة،
والتأويلات السخيفة الأخرى لكلمة «اليد»، و «غرفة الماء»، و
«الضحك» وما إلى ذلك..
وقال الصالحي الشامي، تعليقاً على
قول النبي «صلى الله عليه وآله»:
«فلعمرو إلهك»، هو قسم بحياة الله تعالى، وفيه دليل على
جواز الإقسام بصفاته، وانعقاد اليمين بها، وأنها قديمة، وأنه يطلق عليه
منها أسماء المصادر، ويوصف بها، وذلك قدر زائد على مجرد الأسماء، وأن
الأسماء الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها([14]).
ونقول:
إننا لانريد أن نناقش في صحة جميع الفقرات التي أوردها،
غير أننا نكتفي بالقول: إن ما زعمه من قدم صفاته تعالى، إذا انضم إلى
ما يزعمونه من أن الصفات زائدة على ذاته تعالى. ثم ما يحتمه ذلك عليهم
من الإلتزام بتعدد القديم ـ إن ذلك ـ يجعلنا نستذكر قول الفخر الرازي:
«النصارى كفروا لأنهم أثبتوا ثلاثة قدماء، وأصحابنا قد أثبتوا تسعة»([15]).
وبعد.. فقد تضمنت الرواية الآنفة
الذكر:
أن بني المنتفق من أتقى الناس في الأولى، والآخرة..
ونقول:
أولاً:
لا ندري لماذا صار بنو المنتفق من أتقى الناس في الأولى
والآخرة، ولم يكن بنو هاشم أو أية قبيلة أخرى بهذا المستوى؟!
على أننا لم نجد في هذه القبيلة من هو في مستوى سلمان،
أو أبي ذر، أو المقداد، أو عمار، أو أبي الهيثم بن التيهان، أو قيس بن
سعد، وغيرهم؟!..
كما أنه لم يشتهر أحد من بني المنتفق بهذه الخصوصية ـ
أعني خصوصية التقوى ـ حتى بعد وفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
بحيث يكون متميزاً على من عداه فيها؟!
ثانياً:
لم نفهم المقصود بالأولى والآخرة في قوله «صلى الله
عليه وآله»: «من اتقى الناس في الأولى والآخرة..».
فإن كان المقصود بالأولى:
الدنيا.. وبالآخرة: الحياة الباقية يوم القيامة.. فما
معنى أن يصفهم بالتقوى في الآخرة، مع أنه لا تكليف فيها، لتتحقق فيها
الطاعة تارة، والمعصية أخرى؟!
وإن
كان المقصود بالأولى:
الجاهلية.. وبالآخرة: الإسلام..
فلماذا يكون هؤلاء المشركون من أتقى الناس، ولا يكون بنو هاشم هم
الأتقى من كل أحد، فإن بني هاشم كانوا على دين الحنفية، بل كان فيهم
الأنبياء والأوصياء، وفقاً للحديث: ما زال الله ينقله من نبي إلى نبي
حتى أخرجه من صلب أبيه عبد الله([16]).
والحديث في أن عبد المطلب يحشر وعليه سيماء الأنبياء
وهيبة الملوك([17])،
وأنه كان حجة، وأنه من أوصياء إبراهيم «عليه السلام»([18])،
والحديث عن أن أبا طالب كان من الأوصياء، وأن وصايا عيسى «عليه السلام»
قد تناهت إليه([19])،
وغير ذلك كثير.
ولا نعرف لبني المنتفق شيئاً من ذلك..
ثالثاً:
إذا كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقرر أن بني
المنتفق من أتقى الناس.. فلا يجوز إيذاؤهم بذكر أمواتهم، ولا السكوت عن
هذا الإيذاء، فما معنى أن يقول ذلك القرشي: إن المنتفق في النار؟!..
حيث لم يعترض عليه رسول الله «صلى الله عليه وآله» بأنه ليس له أن يقول
هذا، لأن ذلك يؤذي الأحياء، وقد نهى «صلى الله عليه وآله» عن مثله..
حسبما قدمناه في الجزء الثاني من هذا الكتاب..
قال أبو عبيدة معمر بن المثنى:
قدم الجارود العبدي على رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، ومعه سلمة بن عياض الأسدي، وكان حليفاً له في الجاهلية. وذلك أن
الجارود قال لسلمة: إن خارجاً خرج بتهامة يزعم أنه نبي، فهل لك أن نخرج
إليه؟ فإن رأينا خيراً دخلنا فيه، فإنه إن كان نبياً فللسابق إليه
فضيلة، وأنا أرجو أن يكون النبي الذي بشَّر به عيسى بن مريم.
وكان الجارود نصرانياً قد قرأ الكتب.
ثم قال لسلمة:
«ليضمر كل واحد منا ثلاث مسائل يسأله عنها، لا يخبر بها
صاحبه، فلعمري لئن أخبر بها إنه لنبي يوحى إليه».
ففعلا. فلما قدما على رسول الله «صلى الله عليه وآله»
قال له الجارود: بم بعثك ربك يا محمد؟
قال:
«بشهادة ألا إله إلا الله، وأني عبد الله ورسوله،
والبراءة من كل ند أو وثن يعبد من دون الله تعالى، وإقام الصلاة
لوقتها، وإيتاء الزكاة بحقها، وصوم شهر رمضان، وحج البيت،
{مَنْ
عَمِلَ صَالِحاً
فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ
لِّلْعَبِيدِ}([20]).
قال الجارود:
إن كنت يا محمد نبياً فأخبرنا عما أضمرنا عليه.
فخفق رسول الله «صلى الله عليه وآله» كأنها سنة ثم رفع
رأسه، وتحدر العرق عنه، فقال: «أما أنت يا جارود فإنك أضمرت على أن
تسألني عن دماء الجاهلية، وعن حلف الجاهلية، وعن المنيحة، ألا وإن دم
الجاهلية موضوع، وحلفها مشدود. ولم يزدها الإسلام إلا شدة، ولا حلف في
الإسلام، ألا وإن الفضل الصدقة أن تمنح أخاك ظهر دابة أو لبن شاة،
فإنها تغدو برفد، وتروح بمثله.
وأما أنت يا سلمة، فإنك أضمرت على أن تسألني عن عبادة
الأصنام، وعن يوم السباسب، وعن عقل الهجين، فأما عبادة الأصنام فإن
الله تعالى يقول: {إِنَّكُمْ
وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا
وَارِدُونَ}([21]).
وأما يوم السباسب، فقد أعقب الله تعالى منه ليلة بلجة
سمحة، لا ريح فيها، تطلع الشمس في صبيحتها، لا شعاع لها.
وأما عقل الهجين، فإن المؤمنين إخوة تتكافأ دماؤهم،
يجير أقصاهم على أ دناهم، أكرمهم عند الله أتقاهم».
فقالا:
نشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك عبد الله
ورسوله.
وعند ابن إسحاق، عمن لا يتهم، عن
الحسن:
أن الجارود لما انتهى إلى رسول الله «صلى الله عليه
وآله» كلمه، فعرض عليه رسول الله «صلى الله عليه وآله» الإسلام،
ورغَّبه فيه.
فقال:
يا محمد، إني كنت على دين، وإني تارك ديني لدينك،
أفتضمن لي ديني؟
فقال له رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«نعم أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه».
فأسلم وأسلم أصحابه.
ثم سأل رسول الله «صلى الله عليه
وآله» الحملان، فقال:
«والله ما عندي ما أحملكم عليه».
فقال:
يا رسول الله، فإن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال
الناس ـ وفي لفظ المسلمين ـ أفنتبلغ عليها إلى بلادنا؟
قال:
«لا، إياك و إياها، فإنما تلك حرق النار»..
زاد في نص آخر:
فقال: «يا رسول الله، ادع لنا أن يجمع الله قومنا».
فقال:
«اللهم اجمع لهم أُلفة قومهم، وبارك لهم في برهم
وبحرهم».
فقال الجارود:
يا رسول الله، أي المال أتَّخِذ ببلادي؟
قال:
«وما بلادك»؟
قال:
مأواها وعاء، ونبتها شفا، وريحها صبا، ونخلها غواد.
قال:
«عليك بالإبل، فإنها حمولة، والحمل يكون عدداً. والناقة
ذوداً».
قال سلمة:
يا رسول الله، أي المال أتَّخِذ ببلادي؟
قال:
«وما بلادك»؟
قال:
مأوا ها سباح، ونخلها صراح، وتلاعها فياح.
قال:
«عليكم بالغنم، فإن ألبانها سجل، وأصوافها أثاث،
وأولادها بركة، ولك الأكيلة والربا».
فانصرفا إلى قومهما مسلمين.
وعند ابن إسحاق:
فخرج من عنده الجارود راجعاً إلى قومه، وكان حسن
الإسلام، صليباً على دينه حتى مات، ولما رجع من قومه من كان أسلم منهم
إلى دينه الأول مع الغرور بن المنذر بن النعمان بن المنذر، قام الجارود
فشهد شهادة الحق، ودعا إلى الإسلام، فقال: أيها الناس، إني أشهد ألا
إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأُكَفِّر من
لم يشهد.
وقال الجارود:
شـهـدت بأن الله حـق (وإنــــما)
بنـات فـؤادي بالشهـادة والنهض
فأبـلـغ رسـول الله عني رسالـــة بأني حنيف حيث كنت من
الأرض
وأنـت أمـين الله في كـل خـلقــه على الوحي من بين القضيضة
والقض
فـإن لم تكـن داري بيثرب فيكـم فـإني لكـم عنـد الإقـامة
والخفض
أصالح من صالحت من ذي عداوة وأبغض من أمس على بغضكم بغضي
وأدني الـذي والـيـتـه وأحـبــــه وإن كان في فيه العـلاقم من
بغض
أذب بـسـيـفي عنـكـم وأحبكم إذا ما عدوكم في الرفاق وفي
النقض
واجـعـل نـفـسي دون كـل ملمة لكم جُنَّة من دون عرضكم عرضي
وقال سلمة بن عياض الأسدي:
رأيـتـك يـا خـير الـبريـة
كلهــا نشـرت كتـابـاً جـاء بالحـق معلما
شرعت لنا فيه الهدى بعد جورنا عـن الحـق لمـا أصبـح
الامر مظلما
فـنورت بالقرآن ظلمات حندس وأطـفـأت نـار الكـفر لمـا
تضرمـا
تـعـالى عـلـو الله فــوق سـمائـه وكـان مـكـان الله
أعـلى وأكـرمـا
وعن عبد الله بن عباس:
أن الجارود أنشد رسول الله «صلى الله عليه وآله» حين
قدم عليه في قومه:
يـا
نبي الهـدى أتـتـك رجـــال قـطـعـت فـــدفــــداً وآلاً
فــآلا
وطوت نحوك الصحاصح طراً لا تخــــال الـكـــلال فيـه كـلالا
كل دهناء يقصر الطـرف عنهـا أرقـلـتـهـــا قـلاصـنـــاً
إرقــالا
وطوتهـــا الجيـاد تجمح فـيـهـا بـكــماة كــأنــجـــم
تــتــــلالا
تبتغي دفـع بُـؤس يـوم عبـوس أوجـل الـقـلـب ذكـره ثـم هالا([22])
وقع في العيون:
الجارود بن بشر بن المعلى. قال في النور: والصواب: حذف
[ابن] يبقى الجارود بشر بن المعلى([23]).
والذي نريد لفت النظر إليه في هذه
القصة هو:
أن المعجزة الخالدة لنبينا الأكرم «صلى الله عليه وآله»
هي القرآن الكريم.
كما أن من المعلوم:
أنه «صلى الله عليه وآله» بتوجيه من الله تعالى، لم يكن
يستجيب لمطالب المشركين التعجيزية. وقد صرح القرآن بذلك، مستدلاً على
صحة هذا الموقف بأنه «صلى الله عليه وآله» بشر رسول..
قال تعالى:
{أَوْ
تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ
خِلالَهَا تَفْجِيراً
أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً
أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالمَلآئِكَةِ قَبِيلاً أَوْ يَكُونَ لَكَ
بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاء وَلَن نُّؤْمِنَ
لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً
نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَراً
رَّسُولاً}([24]).
ولكننا نراه «صلى الله عليه وآله» يستجيب هنا لما يطلبه
الجارود العبدي، وسلمة بن عياض من إخبارهما بما نوياه. فلماذا يستجيب
هنا، ويكون لابد من رفض الإستجابة هناك، وفقاً للتوجيه الإلهي؟!
ويمكن أن يجاب:
بأن طلبات المشركين التي تحدثت الآيات عنها كانت تهدف
إلى الإستفادة من تلبيتها في تضليل الناس، لأن المشركين سيضعونها في
سياق إثبات ما يدَّعونه من ضرورة أن يكون الأنبياء من سنخ آخر غير سنخ
البشر، وأن البشرية لا تتلاءم مع النبوة، أو في سياق اتهامه «صلى الله
عليه وآله» بالسحر والكهانة.
وهذا يوضح لنا سبب أمر الله تعالى نبيه «صلى الله عليه
وآله» بأن يقول لهم:
{..قُلْ سُبْحَانَ
رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَراً
رَّسُولاً}؟!
ويؤيد ذلك أيضاً قوله تعالى:
{وَلَوْ
نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً
فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ
إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ}([25]).
ويلاحظ:
أنه «صلى الله عليه وآله» حين لا يستجيب لطلبهم هذا
يوضح للناس: أن هدفهم هو مجرد التعجيز، وليس لديهم نية الإنصياع
لمقتضاه لو استجيب لهم، لأن المطلوب إن كان هو رؤية المعجزة، فإن نفس
هذا القرآن متضمن لها، فقد قال تعالى:
{لَقَدْ
أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً
فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ}([26]).
أي أنهم لو رجعوا إلى عقولهم لوجدوا في هذا القرآن ما
يدفع عنهم أية شبهة، ويزيل كل ريب ولزالت جميع المبررات لطلباتهم
التعجيزية، لو كانوا يريدون أن يجدوا ما يحتم عليهم الإيمان، ويدعوهم
إلى البخوع للحق.. كما أنه «صلى الله عليه وآله» قد أظهر لهم من
المعجزات ما لا يقل عما يطلبونه منه، فلماذا لم يؤمنوا؟
والخلاصة:
أنه لا مجال لأن يستجيب لطلبهم حين تسهم استجابته هذه
في تكريس مفهوم خاطئ عن طبيعة النبي والنبوة، أو إذا كان يمكِّنهم من
التأثير السلبي على بعض السذج أو الغافلين الذين قد لا يتيسر إخراجهم
من غفلتهم بسبب عدم إمكان الوصول إليهم، أو لأي سبب آخر، فتستحكم
الشبهة لديهم، ويؤدي بهم ذلك إلى الإغراق في الضلال، أو الخروج عن
دائرة الإستقامة على طريق الحق والهدى بالكلية.
والأهم من ذلك هو:
أن الطلب الذي رُفض، قد تضمن أموراً كان رسول الله «صلى
الله عليه وآله» قد فعلها، وتحدث القرآن عن بعضها، مثل قضية المعراج
إلى السماوات.. كما أنه «صلى الله عليه وآله» وكذلك الأئمة الطاهرون
«عليهم السلام» قد فجروا الينابيع، وشق الله القمر لهم نصفين، وردَّ
الشمس لعلي «عليه السلام» إلى غير ذلك مما صنعه «صلى الله عليه وآله»،
وكذلك صنعه للأنبياء «عليهم السلام» من قبله..
ولكن ما صنعه «صلى الله عليه وآله» من معجزات، منه ما
كان بمبادرة منه «صلى الله عليه وآله» لمصلحة اقتضت ذلك، ولم يقترحه
الناس عليه، ومنه ما كان استجابة لطلب بعض الناس، بهدف تحصيل اليقين
بالنبوة..
وربما يكون قد ظهر للنبي «صلى الله
عليه وآله»:
أن طالب المعجزة كان غير قادر على إدراك إعجاز المعجزة
الكبرى الخالدة، وهي القرآن لسبب أو لآخر..
وربما يكون قد ساعد على ذلك طبيعة المطلوب، وحجمه
ومداه، فإنهم إنما طلبوا منه أن يخبرهم بما أضمروه لا أكثر.. ولو أنهم
كانوا بصدد الجحود والكيد له، لادَّعوا أنهم قد أضمروا غير ما أخبرهم
به.
وقد تقدم:
أن حلف الجاهلية مشدود، وأنه لا حلف في الإسلام، ولعلنا
قد أشرنا في ثنايا هذا الكتاب إلى أن حلف الجاهلية المشدود هو الحلف
القائم على دفع الظلم، وعلى التناصر في الحق، ومواجهة وصد من يريد
التعدي، ويسعى في الفساد والإفساد..
ولا يصح أن يتحالف المسلم مع مسلم آخر ضد مسلم ثالث..
لأن الإسلام يمنع من الظلم، و
{يَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاء وَالمُنكَرِ وَالْبَغْيِ}([27])،
لأن هذه الآية توجب التناصر ضد الظلم، فيرتفع بذلك موضوع التحالف، إذا
كان المراد به التحالف على ظلم الآخرين، والعدوان والبغي عليهم.
وقد وصفت الرواية المتقدمة ليلة
القدر بأنها:
«ليلة بلجة سمحة، لا ريح فيها، تطلع الشمس في صبيحتها،
لا شعاع لها..».
غير أن هذا الوصف لا يتتطابق مع المروي عن الأئمة
الطاهرين من أهل البيت «عليهم السلام»، فقد روى محمد بن مسلم عن أحدهما
ـ الباقر أو الصادق «عليهما السلام» ـ قال: «علامتها أن يطيب ريحها،
وإن كانت في بردٍ دفئت، وإن كانت في حرٍ بردت، فطابت الخ..»([28]).
فإن مفاد هذه الرواية: أن في ليلة القدر ريحاً، ولكنه
طيب.
وأما أنها بلجة أو سمحة أو أن الشمس تطلع في صبيحتها لا
شعاع لها، فلم نجده فيما بين أيدينا من روايات عن أهل البيت «عليهم
السلام»..
يضاف إلى ذلك:
أن المشاهدة المستمرة عبر السنين المتطاولة لليالي شهر
رمضان لا تؤيد هذه الأوصاف، ولا سيما فيما يرتبط بالشمس وشعاعها، فإنها
لا تكون ذات شعاع في مختلف الأيام التي تكون ليلتها في محتملات ليلة
القدر..
فضلاً عن يوم السابع والعشرين من شهر رمضان، فإنه أيضاً
لا يختلف عن سائر الأيام في ذلك..
وإنه لمن الأمور الهامة جداً أن
نقرأ عن الجارود العبدي:
أنه يرضى بترك دينه، والدخول في دين آخر اعتماداً على
ضمان رسول الله «صلى الله عليه وآله» نفسه..
والأهم من ذلك:
أنه انتقل إلى دينٍ يدعو إليه نفس الشخص الضامن، ويقدم
نفسه للناس على أنه النبي له مع العلم بأن الجارود العبدي لم يكن
إنساناً مغفلاً، ولا طائشاً، فإنه كان سيد قبيلة عبد القيس([29])،
وسادة القبائل يكونون عادة أكثر وعياً ونباهة من غيرهم..
وهذه القضية إن دلت على شيء فهي تدل على مدى قبول الناس
لشخص رسول «صلى الله عليه وآله» من خلال ما عرفوه عنه، وما لمسوه فيه
من ميزات إنسانية، ومن صدق والتزام واستقامة على طريق الحق والخير.
وتبقى استفادات أخرى من النص المتقدم نصرف النظر عن
ذكرها، فقد تقدم منا بعض ما يشير إليها. ومن ذلك ما نلاحظه من أن
الجارود يسأل النبي «صلى الله عليه وآله» عن أي مال يتخذه ببلاده، أي
أنه يرى أن المفروض بالنبي «صلى الله عليه وآله» أن يكون عالماً بمثل
هذه الأمور أيضاً، ويستجيب «صلى الله عليه وآله» له على النحو المذكور،
ولم يقل له: إن ذلك ليس من اختصاصي.. فراجع.
عن الحارث بن حسان البكري قال:
خرجت أشكو العلاء الحضرمي إلى رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، فمررت بالربذة، فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت: يا عبد
الله، إن لي إلى رسول الله حاجة، فهل أنت مبلغي إليه؟
قال:
فحملتها، فأتيت المدينة، فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا
راية سوداء تخفق، وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، فقلت: ما شأن الناس؟
قالوا:
يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاً.
قال:
فجلست، فدخل منزله، فاستأذنت عليه، فأذن لي. فدخلت
فسلمت، فقال: «هل كان بينكم وبين تميم شيء»؟
قلت:
نعم، وكانت الدائرة عليهم، ومررت بعجوز من بني تميم
منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك، وها هي بالباب.
فأذن لها فدخلت.
فقلت:
يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزاً،
فاجعل الدهناء.
فحميت العجوز واستوفزت، وقالت:
يا رسول الله، أين يضطر مضرك؟
قال الحارث:
قلت: إن مثلي ما قال الأول: معزى حملت حتفها، حملت هذه
ولا أشعر أنها كانت لي خصماً، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد.
قالت هي:
وما وافد عاد؟ وهي أعلم بالحديث منه، ولكن تستطعمه.
قلت:
إن عاداً قحطوا فبعثوا وافدا لهم. فمر بمعاوية بن بكر.
فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر، وتغنيه جاريتان يقال لهما: الجرادتان.
فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة
فقال:
اللهم إنك تعلم (أني) لم أجئ إلى مريض فأداويه، ولا إلى
أسير فأفاديه، اللهم اسق ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود، فنودي
منها: اختر، فأومأ إلى سحابة منها سوداء، فنودي منها: خذها رماداً
رمدداً، لا تبق من عاد أحداً.
قال:
فما بلغني أنه أرسل عليهم من ريح إلا بقدر ما يجري في
خاتمي هذا حتى هلكوا.
قال أبو وائل:
وكانت المرأة أو الرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: لا
يكن كوافد عاد([30]).
ونقول:
قد أظهر هذا النص:
كيف أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد فتح أمام الناس
أبواب الشكوى من عماله. وهذا أمر هام وحساس للغاية، لأنه مما تقتضيه
سنة الإنصاف والعدل، وتوجبه مسؤولية حفظ وصيانة الشأن العام من أي تعدٍ
وإفساد، لأن الفساد آفة الدول، ومن موجبات وهنها وسقوطها..
وأما استياء العمال من الشاكين، فهو لا يضر مادام أنه
بلا مبرر، وغاية ما يحدثه من أثر هو إفساد علاقتهم ببعض الأفراد،
ويقابل ذلك منافع عظمى تبدأ بحفظ أولئك العمال أنفسهم من الإساءة
والخطأ، وتنتهي بحفظ الدولة والرعية من الظلم والفساد..
إن الراية التي رآها الحارث بن حسان
كانت سوداء، وقد ذكرنا:
أن الراية السوداء كانت ترفع حين تكون الحرب مع
الكافرين والمشركين..
إنه «صلى الله عليه وآله» لم يمهل الحارث حتى يفصح له
عن حاجته، بل هو قد بادره بالسؤال عن حالهم مع بني تميم، إن كان قد حصل
شيء بين الفريقين، وهذا يفصح عن شدة اهتمام رسول الله «صلى الله عليه
وآله» بمتابعة ما يجري بين الفئات المختلفة، وهو يعرِّف الناس: أنه
معنيٌّ جداً بما جرى..
ويلاحظ:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يتدخل بين تلك
التميمية وبين الحارث بن حسان.. بل اكتفى بالسماع.. ربما لأنه رأى أن
ثمة تكافؤاً في الحوار فيما بينهما.. وأن العجوز لم تظلم الحارث حين
اعترضت عليه، لأنها رأت أن جعل الدهناء هي الحاجز بين الفريقين مضر
بحال قومها، ربما لأنه يمنعهم من الوصول إلى مواضع يحتاجون إلى الوصول
إليها..
ولعلها قد لاحظت أيضاً:
أنه بصدد التشفي بقومها حين أضاف بلا مبرر ظاهر قوله:
«وكانت الدائرة عليهم»، حيث لم يسأله النبي «صلى الله عليه وآله» عن
نتيجة ما جرى، بل سأله عن أصل حدوث شيء..
كما أنه «صلى الله عليه وآله» لم
يلاحظ:
أن لدى الحارث نوايا سيئة وراء طلبه هذا، فهو إنما أراد
أن يحجز بين الفريقين ليحقن الدماء، ولم يكن يقصد الإضرار بتميم فيما
يرتبط بمعاشها، أو في حريتها بالتنقل والتقلب في البلاد المختلفة
للتجارة أو لسواها..
عن أبي عبد الرحمن المدنيّ قال:
لما قدم النبي «صلى الله عليه وآله» المدينة وفد إليه
عبد العُزَّى بن بدر الجُهَنِيّ، من بني الرَّبعة بن زيدان بن قيس بن
جهينة، ومعه أخوه لأمه أبو روعة، وهو ابن عمِّ له. فقال رسول الله «صلى
الله عليه وآله» لعبد العُزَّى: «أنت عبد الله».
ولأبي روعة:
«أنت رُعْت العدو إن شاء الله».
وقال:
«من أنتم»؟.
قالوا:
«بنو غيّان».
قال:
«أنتم بنو رشدان». وكان اسم واديهم غَوى، فسمَّاه رسول
الله «صلى الله عليه وآله» ـ رُشداً ـ وقال لجبلي جهينة: «الأشعر
والأجرد: هما من جبال الجنة، لا تطؤهما فتنة». وأعطى اللواء يوم الفتح
عبد الله بن بدر، وخط لهم مسجدهم، وهو أول مسجد خط بالمدينة([31]).
وقال عمرو بن مرة الجهني:
كان لنا صنم وكنا نعظمه وكنت سادنه، فلما سمعت برسول
الله «صلى الله عليه وآله» كسرته وخرجت حتى أقدم المدينة على النبي
«صلى الله عليه وآله»، فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وآمنت بما جاء به من
حلال وحرام، فذلك حين أقول:
شـهـدت بـأن الله حـق وأنـنـــي
لآلهــة الأحـجـار أول تــــــارك
وشمرت عن ساق الأزار مهاجراً إليك أجوب الوعث بعد
الدكادك
لأصحب خير الناس نفساً ووالداً رسول مليك الناس فوق
الحبـائك
قال:
ثم بعثه رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى قومه
يدعوهم إلى الإسلام، فأجابوه إلا رجلاً واحداً، رد عليه قوله، فدعا
عليه عمرو بن مرة فسقط فوه فما كان يقدر على الكلام، وعمي، واحتاج([32]).
وعن عمران بن حصين قال:
سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: «جهينة مني
وأنا منهم، غضبوا لغضبي ورضوا لرضائي، أغضب لغضبهم. من أغضبهم فقد
أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله»([33]).
ونقول:
قد تكلمنا في أكثر من مرة عن موضوع تغيير الأسماء،
وأشرنا إلى تأثيراتها على الروح والنفس، فلا حاجة إلى الإعادة، غير
أننا نشير هنا إلى الأمور التالية:
إذا صح أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد قال عن جبلي
جهينة الأشعر والأجرد: «إنهما من جبال الجنة»، فالمفروض أن يصبحا
مزاراً للناس للتبرك بهما، أو رؤيتهما، والتقرب إلى الله بالصلاة
والدعاء عليهما، تماماً كما كانوا يقصدون ما بين قبره «صلى الله عليه
وآله» ومنبره لأجل ذلك، لأن النبي «صلى الله عليه وآله» قال: «ما بين
قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة»([34]).
مع أن هذين الجبلين لا يعرفان، ويضطرب الناس في تحديد موقعهما..
أما دعوى:
أن وفادة جهينة على النبي «صلى الله عليه وآله» كانت في
أول الهجرة، وأن النبي «صلى الله عليه وآله» قد خط لهم مسجدهم، فكان
أول مسجد خط في المدينة([35]).
فلا نكاد نطمئن لها، لأننا نستبعد وفادة أيٍ من القبائل في هذا الوقت
المبكر جداً.
ولأننا لا ندري إن كانت جهينة تسكن في داخل المدينة،
لتحتاج إلى مسجد، يخطه لها رسول الله «صلى الله عليه وآله»، أم أنها
كانت بالقرب منها هي ومزينة، وأسلم وغفار.
أما إن كان المقصود:
أنه «صلى الله عليه وآله» اختط لهم مسجداً في منطقتهم
خارج المدينة، فلا يكون مسجدهم أول مسجد اختطه رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، لأن مسجد قباء كان هو الأسبق في ذلك.
تقدم ثناء النبي «صلى الله عليه وآله» على جهينة بقوله:
«جهينة مني وأنا منهم، غضبوا لغضبي ورضوا لرضائي، أغضب
لغضبهم. من أغضبهم فقد أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله».
وتقدم أيضاً:
ثناؤه «صلى الله عليه وآله» على جبلي جهينة: الأشعر
والأجرد، وأنهما من جبال الجنة، لا تطؤهما فتنة..
ونقول:
إننا لا نرتاب في أن ذلك مكذوب على رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، وذلك لما يلي:
أولاً:
إن جهينة ـ كما صرح به عكرمة ـ كانت من قبائل النفاق
التي تسكن بالقرب من المدينة، كما قال عكرمة في تفسير قوله تعالى:
{وَمِمَّنْ
حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ
مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ
سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيم}([36]).
قال: هم جهينة ومزينة، وأسلم وغفار([37]).
ثانياً:
إن هذا الحديث يدل على عصمة جهينة، لأن من يغضب الله
ورسوله لغضبهم، يجب أن يكونوا معصومين في جميع أحوالهم، لأن من يفعل
المنكر ويترك المعروف، لا بد أن ينهاه الآخرون عن المنكر، وأن يأمروه
بالمعروف، حتى لو غضب من ذلك، ومن يكون كذلك فلا يغضب الله لغضبه، إلا
أن يكون الله سبحانه يرضى بفعل المنكر وترك المعروف، تعالى الله عن ذلك
علواً كبيراً..
ثالثاً:
إن ظاهر قوله: «غضبوا لغضبي»: أن جهينة قد غضبت لغضب
النبي «صلى الله عليه وآله»، ورضوا لرضاه، وهذا خبر عن أمر حصل،
فالسؤال هو: متى غضبت جهينة لغضبه، ورضيت لرضاه «صلى الله عليه وآله»؟
وفي أية قضية كان ذلك؟! وما هي وقائع تلك القضية؟! فإنها لابد أن تكون
على درجة كبيرة من الخطورة.
وهل لم يغضب أحد من المسلمين فيها لرسول الله «صلى الله
عليه وآله» سوى جهينة؟! فان كان الجواب بالإيجاب، فلماذا لم يذكر في
هذا السياق سوى جهينة؟! وإن كان الجواب بالسلب، فلماذا أحجموا عن نصرة
نبيهم؟!
والذي أراه هو:
أن هذا المفتري على الله وعلى رسوله، إما أنه كان على
درجة من الغباء، أو أن الله سبحانه قد أعمى قلبه، وطمس على بصيرته، على
قاعدة {خَتَمَ
اللهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ
غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ}([38]).
فإن من يريد أن يفتري ويختلق، لابد أن لا يكون ما
يختلقه ظاهر الخطل والبطلان.. فلا يصح أن يدعي مثلاً: أن المسك سيء
الرائحة، ولا أن يقول: إن الذهب خشب، والتفاحة دجاجة، وما إلى ذلك..
فإن فعل ذلك، فقد سعى إلى حتفه بظلفه، وفضح نفسه بنفسه، وإنما على
نفسها جنت براقش([39]).
والأمر في هذا الحديث المفترى قد جاء على نفس السياق،
إذ لا يمكن أن يكون له معنى في هذا المورد، إذ لا يمكن أن يكون النبي
«صلى الله عليه وآله» من جهينة، كما لا يمكن أن تكون جهينة منه «صلى
الله عليه وآله»..
فإن النبي «صلى الله عليه وآله» ليس من جهينة، لا
حقيقية ولا مجازاً، فهو «صلى الله عليه وآله» ليس منها نسباً، وذلك
ظاهر. وليس منها بما يمثله من دين ورسالة، لأنها ليس لها أثر يذكر في
نشر الإسلام، أو في الدفاع عنه، بل قد تقدم: أن عكرمة يصرح بأنها كانت
إحدى القبائل الأربع التي عناها الله تعالى بقوله:
{وَمِمَّنْ
حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ}.
ومهما يكن من أمر، فإن أحداً لا
يجهل أن عبارة:
«من أغضبها فقد أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله»، قد
قالها النبي «صلى الله عليه وآله» في حق الزهراء «عليها السلام»، وهذا
ما أوجب ما يوجب الطعن على من أغضبها بأنه قد أغضب الله ورسوله، بأنه
لا يمكن أن يكون أهلاً لأن يكون في مقام خلافة النبوة؟!
كما أن أحداً لا يجهل:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد قال في حق الحسين «عليه
السلام»، الذي يَبعث النبي «صلى الله عليه وآله» ويُحييه، بإحياء دينه،
وإسقاط أطروحة عدوه، وفضحه باستشهاده «عليه السلام»، حيث قال فيه:
«حسين مني وأنا من حسين»، فهو من النبي «صلى الله عليه وآله» بكل
المعاني، والنبي بما له من صفة النبوة والرسولية من الحسين «عليه
السلام».
5 ـ
قدوم وائل بن حجر:
عن وائل بن حجر قال:
بلغنا ظهور رسول الله «صلى الله عليه وآله» وأنا في بلد
عظيم، ورفاهة عظيمة فرفضت ذلك، ورغبت إلى الله عز وجل، وإلى رسول الله
«صلى الله عليه وآله». فلما قدمت عليه أخبرني أصحابه أنه بشَّر بمقدمي
عليهم قبل أن أقدم بثلاث ليال.
قال الطبراني:
فلما قدمت على رسول الله «صلى الله عليه وآله» سلمت
عليه فرد علي، وبسط لي رداءه، وأجلسني عليه، ثم صعد منبره وأقعدني معه،
ورفع يديه، وحمد الله تعالى، وأثنى عليه، وصلى على النبي «صلى الله
عليه وآله»، واجتمع الناس إليه فقال لهم: «يا أيها الناس، هذا وائل بن
حجر قد أتاكم من أرض بعيدة، من حضرموت، طائعاً غير مكره، راغباً في
الله وفي رسوله، وفي دين بيته، بقية أبناء الملوك».
فقلت:
يا رسول الله، ما هو إلا أن بلغنا ظهورك، ونحن في ملك
عظيم وطاعة، وأتيتك راغباً في دين الله.
فقال:
«صدقت»([40]).
وعن وائل بن حجر قال:
جئت رسول الله «صلى الله عليه وآله» فقال: «هذا وائل بن
حجر جاء حباً لله ورسوله»، وبسط يده، وأجلسه، وضمه إليه، وأصعده
المنبر، وخطب الناس فقال: «ارفقوا به، فإنه حديث عهد بالملك».
فقلت:
إن أهلي غلبوني على الذي لي.
فقال:
«أنا أعطيكه وأعطيك ضعفه».
وقالوا:
إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أصعده إليه على
المنبر، ودعا له، ومسح رأسه وقال: «اللهم بارك في وائل وولد ولده»([41]).
ونودي:
الصلاة جامعة، ليجتمع الناس سروراً بقدوم وائل بن حجر
إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأمر رسول الله «صلى الله عليه
وآله» معاوية بن أبي سفيان أن ينزله منزلاً بالحرة، فمشى معه، ووائل
راكب، فقال له معاوية: أردفني خلفك [وشكا إليه حر الرمضاء].
قال:
لست من أرداف الملوك.
قال:
فألق إلي نعليك.
قال:
لا، إني لم أكن لألبسهما وقد لبستهما.
قال:
إن الرمضاء قد أحرقت قدمي.
قال:
امش في ظل ناقتي، كفاك به شرفاً.
(وقال
معاوية:
فأتيت النبي «صلى الله عليه وآله» فأنبأته بقوله، فقال:
إن فيه لعيبة من عيبة الجاهلية).
فلما أراد الشخوص إلى بلاده كتب له رسول الله «صلى الله
عليه وآله» كتاباً([42]).
ونقول:
تضمنت النصوص المتقدمة:
أوسمة عديدة لوائل بن حجر، مع أننا لا نرى مبرراً لشيء
منها، فإننا حين نراجع ما بلغنا عن حياة هذا الرجل لا نجد فيها شيئاً
يستحق الذكر، سوى أنه كان قبل أن يسلم من أقيال حضرموت، ووفد إلى رسول
الله «صلى الله عليه وآله» بعد أن عزَّ الإسلام، ونصر الله نبيه على
الشرك والكفر في المنطقة بأسرها. ثم إنه أسلم، ولم يسهم في شيء في
تأييد هذا الدين أو في نصره ونشره. كما أنه لم يكن معروفاً بشيء يميزه،
لا في علمه ولا في تقواه، ولا في أي شيء آخر..
ونحن نعلم أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يكن يوزع
الأوسمة على الراغبين والخاملين بصورة مجانية، بل هو يمنح الوسام
لمستحقيه، باعتباره جزءاً من الواجب، وثمناً لجهد، وسياسة إلهية لاطراد
المسيرة الإيمانية بصورة أكثر قوة، وأشد ثباتاً.
بل إن هذه الأوسمة لوائل إذا لم يكن وائل مستحقاً لها،
تكون من موجبات التغرير بالناس، في أمره، ولم يكن وائل أهلاً لشيء من
ذلك كما سنرى..
وقد ذكرت الروايات المتقدمة:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» صعد منبره، وأقعده معه..
والسؤال هو:
هل كان المنبر في مسجد الرسول «صلى الله عليه وآله»
يتسع لشخصين؟!
وهل كان وائل هذا من الخطباء، ويريد «صلى الله عليه
وآله» أن يعرِّف الناس بخصوصيته هذه؟!
وإذا صح هذا، فما هي الخطبة التي أوردها على الناس من
على ذلك المنبر؟! وهل كان «صلى الله عليه وآله» يعرف الناس بخصوصيات
زائريه بهذه الوسائل؟!
أم أنه أراد أن يجعل له الأمر من
بعده ويقول للناس:
إنه يجلس في مجلسه، ويقوم على منبره؟!
أم أن الأرض ضاقت بالجالسين، فلم يجد مكاناً يجلس فيه
مع ضيفه إلا المنبر؟!
إلى غير ذلك من الأسئلة التي لن تجد لها جواباً مقبولاً
ولا معقولاً، إلا إذا اعترف أهل الإنصاف بوضع هذه المفتريات، لألف سبب
وسبب..
وقد زعم وائل نفسه ـ وهو يجر النار
إلى قرصه ـ:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد بشَّر الناس قبل
ثلاثة أيام بمقدمه..
ولسنا ندري ما هي الفائدة والعائدة من هذه البشارة!!
فهل كان وائل سوف يزيل الغمة بمقدمه عن هذه الأمة؟! أو أنه سوف يغني
عنهم في شيء من المهمات التي كانت تنتظرهم؟! أو أنه سيكون له دور حاسم
في نشر العلم والتقوى بينهم، أو في أي منطقة أخرى تحتاج إلى شيء من
ذلك؟!
إننا لا نجد شيئاً من ذلمك يبرر هذه البشارة المزعومة
بمقدم وائل هذا..
ثم إن وائلاً هو الذي استفاد من
الإسلام حين دخل فيه، حيث قال:
يا رسول الله، اكتب لي بأرضي التي كانت لي في الجاهلية،
وشهد له أقيال حمير، وأقيال حضرموت، فكتب له.
قالوا:
وكان الأشعث وغيره من كندة: نازعوا وائل بن حجر في واد
بحضرموت، فادَّعوه عند رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فكتب به رسول
الله «صلى الله عليه وآله» لوائل([43]).
وإذا كانت وفادة وائل على رسول الله «صلى الله عليه
وآله» قد جاءت متأخرة أكثر من عشرين سنة على بعثة رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، وقد شاعت أخبار النبي «صلى الله عليه وآله»، وذاعت، ولا
سيما بعد أن هاجر إلى المدينة، وبدأت الحروب ضده من قبل المشركين
واليهود، بل هو قد واجه ملك الروم في مؤتة، وانتشرت سراياه وبعوثه،
ودعاته في مختلف البلاد، فما معنى أن يزعم وائل: أنه بمجرد أن بلغه
ظهور النبي «صلى الله عليه وآله»، ترك ملكه العظيم وطاعة قومه، وجاءه
راغباً في الإسلام..
على أن وائلاً لم يكن ملكاً كما زعم، بل كان من بقية
أبناء الملوك كما صرحت به نفس الرواية التي ذكرت الفقرة السابقة.. وهذا
تناقض آخر في هذه الرواية المزعومة.
ونص آخر يقول:
إنه حديث عهد بالملك، وهذا معناه أنه كان ملكاً، وقد
فقده لتوه، فهو حديث عهد به.
ثم إنه يقول:
إن أهله غلبوه على الذي له، فكيف نوفق بين هذا كله،
وبين قوله: إنه لما سمع بظهور النبي «صلى الله عليه وآله» ترك ملكه
وقدم على النبي «صلى الله عليه وآله» راغباً في دين الله؟!
وعلى كل حال،
فإن وائلاً قد أظهر في نفس مقدمه ذاك أنه لا يستحق أي
وسام، وليس جديراً بأي ثناء كما دل عليه سلوكه غير الإنساني مع معاوية،
حيث لم يرض بإردافه ولا بإعطائه نعله ليتقي بها الرمضاء.. وإنما سمح له
بأن يمشي في ظل ناقته وحسب، فلما بلغ النبي «صلى الله عليه وآله» ذلك
قال: «إن فيه لعيبة من عيبة الجاهلية».
ومعاوية وإن كان هو الأسوأ أثراً في الإسلام، ولكن ذلك
لا يبرر هذا التصرف من وائل تجاهه، وهو ينم عن خلال مقيتةٍ وسيئة فيه..
حيث دل على مدى ما يحمله في داخل نفسه من غطرسة وكبر، ومن قسوة، وحب
للدنيا..
ولكن مهما صدر عن وائل من سيئات مع معاوية وغيره، فإنه
يبقى محبوباً ومنصوراً، وذنبه مغفوراً، وفي جميع أحواله مصيباً
ومأجوراً. لأنه ـ كما يقولون ـ كان عند علي «عليه السلام» بالكوفة،
وكان يرى رأي عثمان، فقال لعلي «عليه السلام»: إن رأيت أن تأذن لي
بالخروج إلى بلادي، وأصلح مالي هناك، ثم لا ألبث إلا قليلاً إن شاء
الله حتى أرجع إليك، فأذن له علي «عليه السلام».
فخرج إلى بلاد قومه، وكان قبلاً من أقيالهم، عظيم الشأن
فيهم، وكان يرى رأي عثمان، فدخل بسر صنعاء، فطلبه وائل وكتب إليه،
فأقبل بسر إلى حضرموت بمن معه، فاستقبله وائل وأعطاه عشرة آلاف، وأشار
عليه بقتل عبد الله بن ثوابة([44]).
ثم كان هو الذي حمل حجر بن عدي إلى معاوية بأمر زياد بن
أبيه، فكان شريكاً أيضاً في دم هذا العبد الصالح، وبقية الستة الذين
استشهدوا معه على يد معاوية بالذات([45]).
6 ـ
وفود أبي صفرة:
عن محمد بن غالب بن عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب بن
أبي صفرة قال: حدثني أبي عن آبائه: أن أبا صفرة قدم على رسول الله «صلى
الله عليه وآله» على أن يبايعه، وعليه حلة صفراء، وله طول ومنظر وجمال،
وفصاحة لسان، [فلما رآه أعجبه ما رأى من جماله] فقال له: «من أنت»؟
قال:
أنا قاطع بن سارق بن ظالم بن عمر بن شهاب بن مرة بن
الهقام بن الجلند بن المستكبر، الذي كان يأخذ كل سفينة غصباً، أنا ملك
ابن ملك.
فقال له النبي «صلى الله عليه
وآله»:
«أنت أبو صفرة، دع عنك سارقاً وظالماً».
فقال:
أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أنك عبده ورسوله حقاً
حقاً يا رسول الله، وإن لي ثمانية عشر ذكراً وقد رزقت بأخرة بنتاً
سميتها صفرة.
فقال له رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«فأنت أبو صفرة»([46]).
ونقول:
نحب لفت النظر إلى سلسلة الأسماء قاطع، بن سارق، بن
ظالم.. وابن مرة، وابن المستكبر الذي كان يأخذ كل سفينة غصباً..
فإنها سلسلة لا يصح التباهي بها، وليست هذه الأسماء من
أسماء الملوك، بل إن السوقة من الناس، والسراق أنفسهم لا يرضون بأن
يناديهم أحد باسم سارق ويرونه عيباً وعاراً، فكيف يتباهى به هؤلاء؟! ثم
يعتبرون أنفسهم ملوكاً..
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عقلية وذهنية، وأجواء
وطموحات وقيم أولئك الناس الذين تعامل معهم رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، وسرعان ما جعل منهم أمة رائدة في كل المجالات العلمية
والأخلاقية، والحضارية، بهرت الأمم بقيمها، وبسموّ أهدافها، وبنهجها
الإلهي العظيم..
وأين هذا من نسب أهل بيت الطهارة، والعصمة، الذين كان
كل منهم طهراً طاهراً مطهراً، من طهر طاهر مطهر..
إنه لا شك في أن هذا النسب الذي ذكره وافتخر به لا يمكن
أن يصل إلى زمن موسى «عليه السلام»، الذي كان يعيش في زمن ذلك الملك
الذي كان يأخذ كل سفينة غصباً، كما أشارت إليه آيات القرآن الكريم وهي
تعرض ما جرى بين موسى والعبد الصالح «عليهما السلام»..
وبذلك يتضح:
أن أبا صفرة يقصد شخصاً آخر كان يأخذ كل سفينة غصباً،
ولا بد أنه كان يعيش قبل ظهور نبينا «صلى الله عليه وآله» بحوالي قرنين
من الزمن.
وقد صرح هذا الرجل:
بأن له ثمانية عشر ولداً ذكراً، وأنه قد رزق آخر الأمر
ببنتٍ أسماها صفرة، وإذ بالنبي «صلى الله عليه وآله» يكنيه بأبي صفرة!!
فلماذا اختار «صلى الله عليه وآله» أن يكنيه باسم
ابنته، وترك تكنيته باسم أي واحد من أولاده الذكور؟!
قد يكون سبب ذلك:
أن العرب
كانوا يحتقرون البنت ويمقتونها، ويظلمونها إلى حد أن الرجل منهم كان
يدفن ابنته وهي حية حتى لا تشاركه في طعامه، أو خوفاً من أن يلحقه عار
بسببها.. وقد تحدث الله تبارك وتعالى عن نظرتهم لها، وعن جرائمهم هذه
في أكثر من آية، ومنها قوله تعالى: {وَإِذَا
الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ}([47]).
وقال سبحانه:
{وَإِذَا
بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً
وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ
أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء
مَا يَحْكُمُونَ}([48]).
وقال عز وجل:
{أَلَكُمُ
الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذاً
قِسْمَةٌ ضِيزَى}([49]).
وقال جل وعلا:
{إِنَّ الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ
الْأُنثَى}([50]).
وقال سبحانه:
{أَفَأَصْفَاكُمْ
رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ المَلآئِكَةِ إِنَاثاً
إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً}([51]).
وقال عز من قائل:
{فَاسْتَفْتِهِمْ
أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ}([52]).
وقال تعالى:
{أَمِ
اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا
بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً
ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً
وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي
الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا المَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ
عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً
أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ}([53]).
فإذا كانت هذه هي نظرة العرب، ومنهم هذا الرجل إلى
المرأة، وإذا كان قد ولد لهذا الرجل ثمانية عشر ولداً ذكراً، فمن
الطبيعي أن يعيش حالة لا تطاق من الزهو والكبر، والعنجهية والغرور..
وقد دل على ذلك اعتزازه حتى بما يعد رذيلة، لو لم يكن
قد وافق الإسم المسمى «سارق ـ ظالم ـ قاطع ـ مستكبر ـ يأخذ كل سفينة
غصباً..».
علماً بأن للأسماء إيحاءاتها، وآثارها على النفوس حين
يصل الأمر إلى حد الأنس بالإسم، وتتفاعل معه بصورة إيجابية..
فكان لابد من ترويض هذه النفوس، ومواجهتها بالقيم
الإلهية، المنسجمة مع الفطرة، وأحكام العقل، وإفهامهم: أن للأنثى
قيمتها عند الله تبارك وتعالى، وأنها تكون أولى بالتقدير، والإحترام من
عشرات الرجال إذا كانت تسير في خط الإستقامة دونهم، وأن التقوى هي
معيار الكرامة عند الله،
{..إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَهِ أَتْقَاكُمْ..}([54]).
ولأجل ذلك نلاحظ:
أن أبا صفرة لم يعترض، ولم يناقش، ولم يستفهم عن طبيعة
أو قيمة هذه المعادلة الجديدة التي واجهه رسول الله «صلى الله عليه
وآله» بآثارها ومقتضياتها بصورة عملية..
([1])
الإصابة ج3 ص579 و 330، ومسند أحمد ج4 ص13، والمستدرك
للنيسابوري ج4 ص560، ومجمع الزوائد ج10 ص338، وما روي في الحوض
والكوثر للقرطبي ص153، و كتاب السنة لابن أبي عاصم ص286،
والمعجم الكبير للطبراني ج19 ص211، وجزء بقي بن مخلد لابن
بشكوال ص153، وأسد الغابة ج5 ص44، والإصابة ج6 ص376.
([2])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص404 و 406 والمواهب اللدنية وشرحه
للزرقاني ج5 ص230 ـ 233 عن أحمد، وابن معين، وخلق، والنسائي،
وابن صاعد، = = وأبي عوانة، والطبراني، وآخرين. وراجع: الإصابة
ج3 ص330 وأشار إليه في ص579 عن زوائد المسند، وابن شاهين،
والطبراني.
([3])
الآية 22 من سورة الحجر.
([4])
الآية 158 من سورة الأنعام.
([5])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص233 وفي (ط دار الكتب العلمية) ج6 ص405.
([6])
مجموعة الرسائل ج1 ص198.
([7])
الرسائل السبعة (الضميمة الثالثة للإبانة) ص36.
([8])
الآية 11 من سورة الشورى.
([9])
تفسير الفخر الرازي ج27 ص50.
([11])
فضل الإعتزال ص163.
([12])
راجع: رحلة ابن بطوطة ص90 و (ط أخرى) ج1 ص57 وأبو هريرة للسيد
شرف الدين ص64 وأعيان الشيعة ج1 ص23 و 42 و 57 عن ابن بطوطة،
والقول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع للأصبهاني ص143 وكشف
الإرتياب في أتباع محمد بن عبد الوهـاب للسيد محـسن الأمـين
ص382 وصفـات الله عنـد = = المسلمين لحسين العايش ص31 عن علاقة
الإثبات والتفويض ص86 و 87 وابن تيمية في صورته الحقيقية لصائب
عبد الحميد ص18 عن رحلة ابن بطوطة ص95 والدرر الكامنة ج1 ص154.
([13])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج6 ص404 والفايق في غريب الحديث
للزمخشري ج3 ص401 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص157 والدر
المنثور ج6 ص293 والبداية والنهاية ج5 ص95 وكتاب السنة لابن
عاصم ص287 وتفسير الآلوسي ج15 ص142 وغريب الحديث لابن قتيبة ج1
ص228.
([14])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص407.
([15])
نهج الحق (مطبوع ضمن دلائل الصدق) ج1 ص162، وشرح إحقاق الحق
للسيد المرعشي ج1 ص 232 نقلاً عن فخر الدين الرازي.
([16])
راجع: الخصال للصدوق ص483 ومعاني الأخبار ص308 ومصباح البلاغة
(مستدرك نهج البلاغة) للميرجهاني ج3 ص93 والبحار ج15 ص5 وشجرة
طوبى ج2 ص210 وتفسير نور الثقلين ج1 ص68، وراجع: فتوح الشام
للواقدي ج2 ص23.
([17])
راجع: الكافي ج1 ص447 وشرح أصول الكافي ج7 ص171 والبحار ج15
ص157 وج35 ص156 وج108 ص205 وموسوعة أحاديث أهل البيت «عليهم
السلام» للشيخ هادي النجفي ج12 ص92 وشرح النهج لابن أبي الحديد
ج14 ص68 والحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب لفخار بن معد
الموسوي ص56 وموسوعة التاريخ الإسلامي لليوسفي ج1 ص242 والدر
النظيم لابن حاتم العاملي ص40 و 797 عن كتاب مدينة العلم.
([18])
راجع: الإعتقادات في دين الإمامية للصدوق (طبع المطبعة
العلمية، قم سنة 1412هـ) ص85 و (ط دار المفيد) ص110 والبحار
ج15 ص117 وج17 ص142 وج35 ص138 والخصائص الفاطمية للكجوري ج2
ص62 ومكيال المكارم ج1 ص369، والغدير ج7 ص385.
([19])
راجع: المحاسن للبرقي ج1 ص235 والبحار ج17 ص142 والغدير ج7
ص385 ونفس الرحمن للطبرسي ص51 وإيمان أبي طالب للأميني ص76.
([20])
الآية 46 من سورة فصلت.
([21])
الآية 98 من سورة الأنبياء.
([22])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج6 ص303 ـ 305 وراجع: الإصابة ج1 ص216
و 217، والبحار ج18 ص294 وج26 ص299.
([23])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص305.
([24])
الآيات 91 ـ 93 من سورة الإسراء.
([25])
الآية 7 من سورة الأنعام.
([26])
الآية 10 من سورة الأنبياء.
([27])
الآية 90 من سورة النحل.
([28])
الوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج10 ص350 و (ط دار الإسلامية) ج7
ص256، والكافي ج4 ص157 ومن لا يحضره الفقيه ج2 ص102، ومنتهى
المطلب (ط.ق) للعلامة الحلي ج2 ص626، ومشارق الشموس (ط.ق)
للمحقق الخوانساري ج2 ص446، والحدائق الناضرة للبحراني ج13
ص440، ودعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي ج1 ص281، ومن لا
يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج2 ص159، ومستدرك الوسائل ج7 ص468،
وإقبال الأعمال للسيد ابن طاووس ج1 ص152، والبحار ج94 ص9،
والتفسير الصافي للفيض الكاشاني ج5 ص352 وج7 ص521، و تفسير نور
الثقلين ج5 ص623، ومنتقى الجمان لصاحب المعالم ج2 ص570.
([29])
الإصابة ج1 ص216، وإكمال الكمال لابن ماكولا ج6 ص134، وتهذيب
التهذيب ج2 ص47، وتاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص238.
([30])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص318 و 319 عن أحمد، والترمذي، والنسائي،
وابن ماجة، والبداية والنهاية لابن كثير ج5 ص99.
([31])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص316 عن ابن سعد، والطبقات الكبرى ج1
ص333.
([32])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص316 عن ابن سعد، والطبقات الكبرى لابن
سعد ج1 ص333 و 334، وتاريخ مدينة دمشق ج46 ص343، والبداية
والنهاية ج2 في حاشيةص392.
([33])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص316 وفي هامشه عن: المعجم الكبير
للطبراني ج18 ص108 وج19 ص317، ومجمع الزوائد ج8 ص48، ومجمع
الزوائد ج10 ص48، والآحاد والمثاني للضحاك ج5 ص30، وكنز العمال
ج12 ص63.
([34])
معاني الأخبار ص267 ومن لا يحضره الفقيه ج2 ص568 والوسائل (ط
مؤسسة آل البيت) ج14 ص345 و 369 و (ط دار الإسلامية) ج10 ص270
و 288 و 289 والمزار لابن المشهدي ص76 والبحار ج97 ص192 وجامع
أحاديث الشيعة ج12 ص243 و 255 و 261 وقاموس الرجال للتستري ج12
ص333 وشفاء السقام للسبكي ص288 وتطهير الفؤاد لمحمد بخيت
المطيعي ص3 و 132 وفي عمدة القاري ج7 ص262 و 263 نزعة من نزع
الجنة، وراجع: مسند أحمد ج2 ص412 و 534 ومجمع الزوائد ج4 ص9
وتأويل مختلف الحديث ص113 ومسند أبي يعلى ج1 ص109 وج3 ص320 و
462 التمهيد لابن عبد البر ج17 ص179 وكنز العمال ج12 ص260 و
261 وإمتاع الأسماع ج14 ص619.
([35])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص316 والطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص333
ومحاضرة الأوائل ص94 عن أوائل السيوطي.
([36])
الآية 101 من سورة التوبة.
([37])
الدر المنثور ج3 ص271 عن ابن المنذر.
([38])
الآية 7 من سورة البقرة.
([39])
فإن قوماً غزاهم عدوهم ليلاً، فلم يجدهم، فعزم على الرجوع، وإذ
بكلبة لهم اسمها براقش تنبح، فعرف مكانهم، فأوقع بهم، وقتلت
تلك الكلبة أيضاً، فقيلت هذه الكلمة في ذلك.
([40])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص431 عن البخاري في تاريخه، والبزار،
والطبراني، والبيهقي، وفي هامشه عن: مجمع الزوائد ج9 ص378 عن
الطبراني في الصغير والكبير، وقصص الأنبياء للراوندي ص294،
وراجع: الإستيعاب (بهامش الإصابة)، والخرائج والجرائح ج1 ص60،
والبحار ج18 ص108 وج22 ص112، ومجمع الزوائد ج9 ص374، وعون
المعبود ج2 ص293، والتاريخ الكبير للبخاري ج8 ص175، ومشاهير
علماء الأمصار لابن حبان ص77، و تاريخ مدينة دمشق ج62 ص391،
والسيرة الحلبية ج1 ص333.
([41])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص431 عن الطبراني، وأبي نعيم، وفي هامشه
عن: البداية والنهاية ج5 ص79، والخرائج والجرائح ج1 ص60،
والبحار ج18 ص108 وج22 ص112، ومستدرك سفينة البحار ج1 ص335،
والإستيعاب ج4 ص1562، وشرح مسند أبي حنيفة للملا علي القاري
ص492، والتاريخ الكبير للبخاري ج8 ص175، وضعفاء العقيلي ج4
ص59، والثقات لابن حبان ج3 ص425، ومشاهير علماء الأمصار لابن
حبان ص77، وتاريخ مدينة دمشق ج62 ص391، وأسد الغابة ج5 ص81،
والأعلام للزركلي ج8 ص106، والأنساب للسمعاني ج2 ص230، والوافي
بالوفيات ج27 ص250، وتاريخ ابن خلدون ج7 ص380، وقصص الأنبياء
للراوندي ص294، والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص154، والسيرة
الحلبية ج1 ص333.
([42])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص431 و 432 وأشار في مكاتيب الرسول ج3
ص361 إلى المصادر التالية: شرح النهج لابن أبي الحديد ج19 ص352
والعبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون ج2 ص835 والمعجم
الكبير ج22 ص47 والمعجم الصغير ج2 ص144 والأموال لابن زنجويه
ج2 ص619 وأسد الغابة ج5 ص81 والإصابة ج3 ص628 والإستيعاب
(بهامش الإصابة) ج3 ص642 والمحاسن للبيهقي ص268 والبحار ج18
ص108 والبداية والنهاية ج5 ص79 و 80 والطبقات الكبرى لابن سعد
ج1 ق2 ص79 و 80 ورسالات نبوية ص286 ومجمع الزوائد ج9 ص373
ومعجم البلدان ج5 ص454 ونشأة الدولة الإسلامية ص243 وما بعدها،
وربيع الأبرار ج3 ص414.
([43])
مكاتيب الرسول ج3 ص360، والطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص287.
([44])
الغارات للثقفي ج2 ص629 ـ 631 وراجع: البحار (ط كمباني) ج8
ص671 و (ط سنة 1413 هـ) ج34 ص16 وسفينة البحار ج8 ص403 ومستدرك
سفينة البحار ج10 ص228 وشرح النهج للمعتزلي ج4 ص94 وموسوعة
الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» في الكتاب والسنة
والتاريخ للريشهري ج7 ص49، ومكاتيب الرسول ج3 ص362.
([45])
أسد الغابة ج1 ص386 والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج1 ص356
والكامل في التاريخ ج3 ص472 وتاريخ الأمم والملوك ج4 ص200 ـ
204 والغدير ج11 ص47 ـ 50 ومواقف الشيعة ج2 ص458 وتاريخ الكوفة
للسيد البراقي ص319 ومستدرك سفينة البحار ج10 ص232.
([46])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص352 عن ابن مندة، وابن عساكر، والديلمي،
وفي هامشه عن كنز العمال (37573)، والإصابة ج7 ص185.
([47])
الآيتان 8 و 9 من سورة التكوير.
([48])
الآيتان 57 و 58 من سورة النحل.
([49])
الآيتان 21 و 22 من سورة النجم.
([50])
الآية 27 من سورة النجم.
([51])
الآية 40 من سورة الإسراء.
([52])
الآية 149 من سورة الصافات.
([53])
الآيات 16 ـ 19 من سورة الزخرف.
([54])
الآية 13 من سورة الحجرات.
|