جيش الإسلام في تبوك
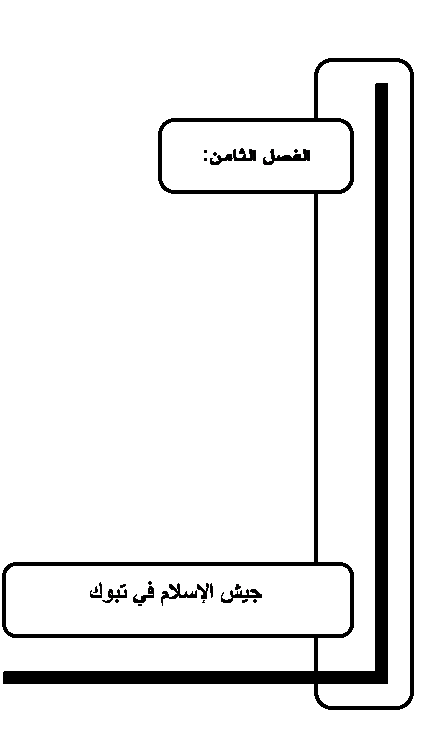
عن حذيفة، ومعاذ بن جبل، قال:
إنه خرج مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» عام تبوك.
قال:
فكان يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، قال:
فأخر الصلاة يوماً، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل فصلى
المغرب والعشاء جميعاً، ثم قال: «إنكم ستأتون غداً إن شاء الله تعالى
عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من
مائها شيئاً حتى آتي».
وفي حديث حذيفة:
«بلغ رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن في الماء قلة،
فأمر منادياً ينادي في الناس: أن لا يسبقني إلى الماء أحد».
قال:
فجئناها وقد سبق إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض
بشيء من مائها، فسألهما رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «هل مسستما من
مائها شيئاً».
قالا:
نعم.
فسبهما، وقال لهما ما شاء الله أن يقول.
ثم غرفوا من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شن، ثم
غسل رسول الله «صلى الله عليه وآله» فيه وجهه ويديه، ومضمض، ثم أعاده
فيها، فجرت العين بماء كثير.
ولفظ ابن إسحاق:
فانخرق الماء حتى كان يقول من سمعه: إن له حساً كحس
الصواعق، وذلك الماء فوارة تبوك. انتهى.
فاستسقى الناس، ثم قال رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
«يا معاذ، يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا مليء
جناناً»([1]).
وعن عروة:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» حين نزل تبوك وكان في
زمان قلّ ماؤها فيه، فاغترف غرفة بيده من ماء فمضمض بها فاه، ثم بصقه
فيها، ففارت عينها حتى امتلأت. فهي كذلك حتى الساعة([2]).
وعن جابر قال:
انتهى رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى تبوك، وعينها
تبض بماء يسير مثل الشراك، فشكونا العطش، فأمرهم فجعلوا فيها ما دفعها
إليهم، فجاشت بالماء، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» لمعاذ:
«يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جناناً»([3]).
ونقول:
النبي
 لا يسب
أحداً: لا يسب
أحداً:
قد تقدم بعض هذا الحديث فيما سبق حين الكلام عن سبب
تسمية عين تبوك، وذلك أول هذا الجزء من الكتاب، وقد قلنا: إنه لا يصح
قولهم: إن النبي
«صلى الله عليه وآله»
قد سب أحداً من الناس، وهو الذي نهى الناس عن السباب..
وقد تضمن النص المتقدم:
أن النبي
«صلى الله عليه وآله»
قد جمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وهذا لا إشكال
فيه، إذ الجمع بين الصلاتين جائز في فقه أهل البيت
«عليهم
السلام»
مطلقاً، أي سواء أكان ذلك في السفر أو في الحضر، مع عذر من مطر أو غيره
وبدونه..
ولكن غير الشيعة يلزمون أنفسهم بالتفريق في الحضر،
ويجيزون الجمع في السفر، وفي حال وجود عذر من مطر أو غيره..
وقد بدأ الشيعة بالتفريق وبالجمع بين صلاتي الظهر
والعصر، وبين المغرب والعشاء، من عهد الرسول
«صلى الله عليه وآله»،
وذلك اقتداءً منهم بهذا النبي الكريم والعظيم صلوات الله وسلامه عليه
وعلى آله الطاهرين، حيث صرحت الروايات الكثيرة المروية عند السنة
والشيعة، بأسانيد صحيحة: أن النبي
«صلى الله عليه وآله»
قد جمع بين الصلوات من دون عذر من سفر، ولا مطر، ولا غير ذلك([4]).
علماً بأن الشيعة لا يرون الجمع واجباً، كما لا يرون
التفريق حتماً لازماً..
يضاف إلى ذلك:
أن القرآن نفسه لم يحدد سوى ثلاثة أوقات للصلاة
اليومية، حيث قال:
{أَقِمِ
الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ
الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً}([5]).
وقد دلت روايات أهل البيت «عليهم
السلام» أيضاً:
على صحة الجمع والتفريق، فقد روي: أنه إذا زالت الشمس
فقد دخل وقت الصلاتين، إلا أن هذه قبل هذه([6]).
وهذا معناه:
أن وقت فضيلة الظهرين يكون قد بدأ بمجرد الزوال، مع
حتمية تقديم صلاة الظهر، ثم يستمر وقت فضيلتهما معاً إلى حين صيرورة ظل
كل شيء مثله كما دلت عليه روايات أخرى، فينتهي حينئذٍ وقت فضيلة الظهر،
ويستمر وقت فضيلة العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه.. فينتهي هذا
الفضل.
فمن صلى الظهر بعد صيرورة ظل الشيء مثله، إلى آخر
الوقت، فإنه يكون قد صلاها في غير وقت فضيلتها.
ومن يصلي العصر بعد صيرورة ظل كل شيء مثليه إلى الغروب،
فإنه يكون قد صلاها في غير وقت فضيلتها.
ثم إن علينا أن لا ننسى أن الجمع بين الصلاتين حتى في
السفر، أو المطر، أو غير ذلك دليل على أن أوقات الصلاة اليومية ثلاثة،
لأنها لو كانت خمسة لكان الجمع بين الصلاتين يقتضي أن تكون إحدى
الصلاتين قد وقعت في خارج وقتها، أو الإلتزام بسقوط شرطية الوقت في
الصلوات الأربع من الأساس، لأن الجمع بين الصلاتين قد يكون بتقديم
العصر إلى وقت الظهر، وقد يكون بتأخير الظهر إلى وقت العصر، كما أنه قد
يكون بتقديم العشاء إلى وقت المغرب، وقد يكون بتأخير المغرب إلى وقت
العشاء..
وأما ما ذكرته الرواية المتقدمة عن تأخير النبي
«صلى الله عليه وآله»
لصلاته، فلا بد أن يكون المقصود به هو التأخير مع البقاء في داخل وقت
الفضيلة، وبدون ذلك، فإن الحديث يكون مكذوباً لأن النبي
«صلى الله عليه وآله»
لا يختار من الأعمال إلا ما هو أفضل وأتم..
وقالوا:
خطب رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
عام تبوك وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال: «ألا أخبركم بخير الناس وشر
الناس إن من خير الناس رجلاً يحمل في سبيل الله على ظهر فرسه، أو على
ظهر بعيره، أو على قدميه حتى يأتيه الموت. وإن من شر الناس رجلاً
فاجراً جريئاً، يقرأ كتاب الله، لا يرعوي إلى شيء منه([7]).
وعن عقبة بن عامر:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لما أصبح بتبوك حمد
الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال:
«أيها الناس، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله،
وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة
محمد، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص القرآن.
هذا وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن
الهدى هدى الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأعمى العمى الضلالة بعد
الهدى، وخير الأعمال ما نفع وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من
اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وشر المعذرة حين يحضر
الموت، وشر الندامة يوم القيامة.
ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبراً، ومنهم من لا
يذكر الله إلا هجراً.
ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب، وخير الغنى غنى النفس،
وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل، وخير ما وقر في
القلوب اليقين، والإرتياب من الكفر، والنياحة من أعمال الجاهلية،
والغلول من جثى جهنم، والسكركة([8])
من النار، والشعر من إبليس، والخمر جماع الإثم، والنساء حبالة الشيطان،
والشباب شعبة من الجنون، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المأكل مال
اليتيم، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه، وإنما يصير
أحدكم إلى موضع أربعة أذرع، والأمر إلى الآخرة، وملاك العمل خواتمه،
وشر الرؤيا رؤيا الكذب، وكل ما هو آت قريب، وسباب المؤمن فسوق، وقتال
المؤمن كفر، وأكل لحمه من معصية الله عز وجل، وحرمة ماله كحرمة دمه،
ومن يتألَّ على الله يكذبه، ومن يَغفر يُغفر له، ومن يَعف يعفِ الله
عنه، ومن يكظم الغيظ يأجره الله، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله، ومن
يبتغ السمعة يسمع الله به، ومن يصبر يضعف الله له، ومن يعص الله يعذبه
الله.
اللهم اغفر لي ولأمتي ـ قالها ثلاثاً ـ استغفر الله لي
ولكم([9]).
ومن الواضح:
أن الإرتياب الذي هو من الكفر هو ذلك الذي يكون في الله
عز وجل.. أو في نبوة نبيه
«صلى الله عليه وآله»،
أو في البعث، أو في القرآن، وغير ذلك، وكذلك الحال إذا كان الريب في
صفات الله، كأن يرتاب في علمه تعالى، أو في عدله.. أو في قدرته وما إلى
ذلك..
والنياحة التي هي من أعمال الجاهلية هي النّياحة
بالباطل، أو تلك التي تصاحبها بعض الأمور المحرمة..
والشعر الذي هو من إبليس هو الذي تحدث الله تعالى عنه
بقوله:
{وَالشُّعَرَاءُ
يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ
يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا
الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَهَ
كَثِيراً وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ
الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ}([10]).
وهو الشعر الذي يراد به إشاعة الباطل، أو العدوان على
الناس، أو ما إلى ذلك.
وعن قوله:
«الشقي من شقي في بطن أمه» نقول:
قد يتخيل البعض
أن هذه الفقرة تؤيد مقولة الجبر الإلهي للعباد على أفعالهم..
وهو تخيل باطل، فإن الآيات الكثيرة وكذلك الروايات
المتوافرة قد دلت على أن الإنسان هو الذي يختار طريق السعادة، أو طريق
الشقاء..
وعِلْمُ الله تعالى بما يختاره لا يؤثر في ذلك الإختيار
شيئاً، ولا يجعله مقهوراً أو مجبوراً على فعله، بل يكون مثل علمنا بأن
فلاناً سوف يأكل أو سوف يشرب، وأن الشمس ستطلع في صباح اليوم التالي،
وأن الأرض سوف تنبت نباتها وزرعها.. وما إلى ذلك..
كما أن وجود الدوافع القوية نحو الشر في داخل الإنسان
لا تجعله مجبراً على اختيار طريق الشر، مهما كانت تلك الدوافع والنوازع
قوية، وعاصفة، وحتى لو كانت قد ولدت معه..
فقد ورد أن محمد بن أبي عمير، قال:
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر «عليهما السلام» عن معنى
قول رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد
من سعد في بطن أمه».
فقال:
الشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال
الأشقياء، والسعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال
السعداء.
قلت له:
فما معنى قوله «صلى الله عليه وآله»: «اعملوا فكل ميسر
لما خلق له»؟
فقال:
إن الله عز
وجل خلق الجن والإنس ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه، وذلك قوله عز وجل:
{وَمَا
خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}([11]).
فيسر كلاً لما خلق له، فالويل لمن استحب العمى على الهدى([12]).
ولهذا البحث محل آخر، وقد تقدم بعض منه أكثر من مرة في
هذا الكتاب فراجع..
وقد استعمل رسول الله «صلى الله عليه وآله» على حرسه
بتبوك من يوم قدم إليها، إلى أن رحل منها عباد بن بشر، فكان عباد يطوف
في أصحابه على العسكر، فغدا على رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوماً،
فقال: يا رسول الله، ما زلنا نسمع صوت تكبير من ورائنا حتى أصبحنا،
فولَّيتَ أحدنا يطوف على الحرس؟!
قال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«ما فعلت، ولكن عسى أن يكون بعض المسلمين انتدب».
فقال سِلْكان بن سلامة:
يا رسول الله، خرجت في عشرة من المسلمين على خيلنا،
فكنا نحرس الحرس.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«رحم الله حرس الحرس في سبيل الله، ولكم قيراط من الأجر
على كل من حرستم من الناس جميعاً أو دابة»([13]).
ونقول:
إن هذا النص ملتبس بدرجة كبيرة، وذلك من عدة جهات.
الأولى:
في أن سلكان بن سلامة وتسعة معه كانوا يحرسون الحرس،
وهذه سابقة غير معهودة، فإن الناس إنما ينتدبون لحراسة الجيش الذي يخلد
إلى الراحة، خوفاً من أن يفاجئه عدو متربص، ويوقع به.. أما حراسة
الحرس، فلم نسمع بها في التدابير المألوفة في مسير الجيوش، وفي حلها
وارتحالها..
الثانية:
ما معنى أن يسمع الحرس ذلك التكبير بالقرب منهم، ولا
يتحرون مصدره، ولا يسعون لكشف حقيقته، فلعلها مكيدة لهم ولعله عدو
متربص بهم، ولعل.. ولعل..
الثالثة:
هل الذي يتصدى للحرس يعلن بالتكبير حتى يسمعه
الآخرون؟!. فلو فرض أن جماعة تفكر في الإيقاع أو الإغارة على بعض أطراف
الجيش، ألا يكون صوت الحرس في جوف الليل، من موجبات تحديد موقعهم، وذلك
بالتالي يعطي القدرة للعدو على تجنب المرور على مواضع تمركز ذلك الحرس،
ويبحث عن ثغرات أخرى يستطيع التسلل والنفوذ منها؟!.
الرابعة:
هل كان الحرس متمركزين في موقع بعينه، حتى استطاع عشرة
أشخاص فقط أن يقوموا بمهة حفظهم وحراستهم في ذلك الموقع علماً بأن ذلك
الجيش الذي يتولون حراسته كان يعد بثلاثين، أو أربعين أو سبعين ألفاً،
وتحتاج حراسة موقع نزول هذا العدد، بما معه من دواب ومراكب إلى أعداد
كبيرة، قد تصل إلى المئات، لأن المساحة التي يحتاجونها ستكون كبيرة..
الخامسة:
إذا كان النبي «صلى الله عليه وآله» قد دعا لهم لأنهم
قد حرسوا الحرس، فما معنى أن يتحدث عن الأجر على حراسة الدواب أيضاً..
فإن المفروض: أنهم لم يحرسوها.
وما معنى قوله:
«جميعاً أو دابة».
السادسة:
لماذا انتظر عباد بن بشر إلى الصباح ليعلم النبي «صلى
الله عليه وآله» بأمر ذلك التكبير الذي سمعه؟!. ألم يكن الأحرى به،
والأصوب له أن يخبره «صلى الله عليه وآله» بالأمر فور سماعه لذلك
التكبير؟!
السابعة:
ما معنى أن تقتصر حراسة عباد على الطواف بأصحابه على
العسكر؟! ألم يكن ذلك من شأنه أن يهييء الفرصة للعدو ليورد ضربته حين
يصبح الحرس المتجولون بعيدين عن النقطة التي يريد الهجوم منها..
قالوا:
لما انتهى رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى تبوك وضع
حجراً قبلة مسجد تبوك، وأومأ بيده إلى الحجر وما يليه، ثم صلى بالناس
الظهر، ثم أقبل عليهم فقال: «ما ها هنا شام، وما ها هنا يمن»([14]).
ونلاحظ هنا ما يلي:
إن تحديد الجهات للناس الذين يدخلون بلاداً لم يعرفوها
ضروري جداً، ليعرفوا قبل كل شيء موقعهم، والجهة التي يتربص بهم عدوهم
فيها، أو يأتيهم الخطر من جهتها، كما أنه يحدد لهم الجهة التي يشعرون
بالأمن والسكينة فيها، وتحن قلوبهم إليها أو يرجون الخير فيها..
ثم إن أول شيء صنعه «صلى الله عليه وآله» في تبوك هو
تحديد المسجد والصلاة فيه، وتعيين قبلته بواسطة وضع حجر فيها، ليعرف
الناس موضع صلاتهم، ويكون المسجد هو نقطة الإرتكاز في تحركهم في تلك
المنطقة ثم أشار إلى الحجر، وإلى الجهة كلها لتصبح جهة القبلة معلومة
للجميع.
وإنما أشار إلى ما يلي الحجر، حتى لا يدخل في وهم أحد
أن للحجر نفسه خصوصية كما هو الحال بالنسبة لعبادة الأصنام.. بل
الخصوصية للجهة، من حيث إنها جهة القبلة، فيتوجه الناس إليها، لا إلى
الحجر بما هو حجر..
وقوله «صلى الله عليه وآله»:
«ما هاهنا شام، وما هاهنا يمن». يؤيد ما ذكرناه في موضع
سابق من هذا الكتاب، من أن اليمن يطلق حتى على أهل مكة، بل وعلى أهل
المدينة أيضاً.
بل إن هذه العبارة المذكورة هنا تفيد أن كل ما بعد تبوك
إلى جهة اليمن، هو يمن.. وأن كل ما قبل تبوك إلى جهة الشام فهو شام..
فتبوك هي الحد الفاصل بين هاتين المنطقتين..
واللافت هنا:
أنه قد عبر عن ذلك بالاسم الموصول، وهو كلمة «ما»
بالنسبة لليمن والشام على حد سواء، فدل ذلك على أنه يريد إطلاق كلمة
يمن وشام على كل أرض بعد تبوك لتكون يُمناً، وكل أرض قبلها، فهي شام..
النبي
 في تبوك
يصلي على ميت في المدينة: في تبوك
يصلي على ميت في المدينة:
عن معاوية بن أبي سفيان، وعن أنس
قالوا:
كنا مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» بتبوك، قال أنس:
فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت بمثلهم فيما مضى، فأتى
جبريل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»: «يا جبريل ما لي أرى الشمس اليوم طلعت بضياء وشعاع ونور لم أرها
طلعت بمثلهم فيما مضى»؟!
قال:
«ذلك معاوية بن معاوية المزني مات بالمدينة اليوم، فبعث
الله تعالى سبعين ألف ملك يصلون عليه، فهل لك في الصلاة عليه؟
قال:
«نعم».
فخرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» يمشي، فقال جبريل
بيده هكذا يفرج له عن الجبال والآكام، ومع جبريل سبعون ألف ملك، فصلى
رسول الله «صلى الله عليه وآله» وصف الملائكة خلفه صفين، فلما فرغ رسول
الله «صلى الله عليه وآله» قال لجبريل: «بم بلغ هذه المنزلة».
قال:
«بحبه
{قُلْ
هُوَ اللهُ أَحَدٌ}([15])
يقرؤها قائماً أو قاعداً، أو راكباً أو ماشياً وعلى كل حال([16]).
«قال
الحافظ في لسان الميزان في ترجمة محبوب بن هلال:
هذا الحديث علم من أعلام النبوة، وله طرق يقوى بعضها
ببعض.
وقال في فتح الباري، في باب الصفوف
على الجنازة:
إنه خبر قوي بالنظر إلى مجموع طرقه.
وقال في اللسان في ترجمة نوح بن
عمر:
طريقه أقوى طرق الحديث. انتهى.
وأورد الحديث النووي في الأذكار في
باب:
«الذكر في الطريق».
فعلم من ذلك رد قول من يقول:
إن الحديث موضوع لا أصل له»([17]).
ونقول:
1 ـ
لقد مات سلمان الفارسي، وأبو ذر، وعمار بن ياسر، بل لقد
استشهد أو مات الكثيرون من الأنبياء، والأوصياء، والأولياء، ولم نرَ
الشمس قد طلعت بضياء وشعاع ونور فريد، لم تطلع بمثله. باستثناء حالات
خاصة أريد بها إفهام الأمة معنى، وإيقافها على حقيقة تحتاج إلى معرفتها
في دينها ويقينها. كما هو الحال بالنسبة لاستشهاد الإمام الحسين «عليه
السلام» في كربلاء.
2 ـ
لم توضح الرواية تلك الخصوصية التي ظهرت في نور الشمس
وشعاعها، ونورها، هل هي الحمرة؟ أم الحدة؟ أم تمازج الألوان؟ أم ماذا؟
3 ـ
ما الفرق بين ضياء الشمس ونورها، وكيف اختلف حالهما
فيما بينهما، ثم اختلف الحال بينهما وبين الشعاع.
4 ـ
حين خرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» يمشي، وكان
جبريل يزيح الجبال والآكام من أمامه.. إلى أين كان يقصد؟! وإلى أين
بلغ؟! ولماذا احتاج إلى قطع هذه المسافات؟! ألم يكن يمكنه «صلى الله
عليه وآله» أن يَصُفَّ الناس، ويصلي على ذلك الميت، وهو في موضعه؟!
5 ـ
لم يذكر النص الآنف الذكر ما يدل على خروج أحد من
المسلمين مع النبي «صلى الله عليه وآله» إلى تلك الصلاة، بل يذكر ـ فقط
ـ أن سبعين ألف ملك اصطفوا خلف النبي «صلى الله عليه وآله»، وصلوا
بصلاته.
6 ـ
هل يمكن القبول بافتراض أن لا يكون النبي «صلى الله
عليه وآله» عارفاً بأثر قراءة
{قُلْ
هُوَ اللهُ أَحَدٌ}
في هذه الأحوال، أو أنه قد عرف ذلك لكنه لم يعلم حتى الخلَّص من أصحابه
به، حتى فاتتهم هذه المنزلة والكرامة؟
قد يدَّعى:
أن سؤال النبي «صلى الله عليه وآله» لجبرئيل عن سبب
بلوغ هذه المنزلة يدل على صحة الإحتمال الأول، وهو أن هذه الرواية
المزعومة تريد أن تدَّعي: أنه لم يكن عالماً بذلك. نعوذ بالله من الزلل
والخطل في الإعتقاد وفي القول وفي العمل..
7 ـ
وأخيراً لو صح هذا الحديث ـ ودون إثبات صحته خرط القتاد
ـ فهو لا يدل على مشروعية صلاة الغائب، لاحتمال أن يكون ما صنعه جبرئيل
قد جاء لإكرام رسول الله «صلى الله عليه وآله» بخفض كل رفع، ورفع كل
خفض له، حتى أصبحت جنازة ذلك الرجل أمامه، فصلى عليه النبي «صلى الله
عليه وآله» صلاة الحاضر لا الغائب، تماماً كما كان الحال بالنسبة
للنجاشي ملك الحبشة حسبما تقدم في بعض فصول هذا الكتاب..
عن يزيد بن نِمْرَان قال:
رأيت رجلاً بتبوك مقعداً، فقال: مررت بين يدي رسول الله
«صلى الله عليه وآله» وأنا على حمار، وهو يصلي، فقال: «اللهم اقطع
أثره»، فما مشيت عليها بعدها.
وعن سعيد بن غزوان عن أبيه:
أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا رجل مقعد فسأله عن أمره،
فقال: سأحدثك حديثاً فلا تحدث به ما سمعت أنِّي حي، إن رسول الله «صلى
الله عليه وآله» نزل بتبوك إلى نخلة فقال: «هذه قبلتنا»، ثم صلى إليها.
فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت
بينه وبينها، فقال:
«قطع صلاتنا قطع الله أثره». فما قمت عليها إلى يومي
هذا([18]).
ونقول:
إننا لا نشك في كذب هذه الرواية.
فأولاً:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» لا يدعو بقطع الأثر على
غلام لا يحسن تقدير الأمور، ولم يبلغ سن التكليف، كما أن الله تعالى لا
يستجيب دعاءً على بريء، ولا يشارك في ظلم أحد..
ثانياً:
حتى لو كان هذا الغلام قد بلغ سن التكليف، ثم مر في حال
الغفلة أمام المصلي، فإنه معذور، ولا يستحق أن يدعو عليه رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، بل لا يجوز له ذلك..
ثالثاً:
من الذي قال: إن ذلك الغلام كان يعرف أن المرور بين يدي
المصلي حرام؟!
رابعاً:
إن قول النبي «صلى الله عليه وآله» في دعائه على ذلك
الشخص: «قطع الله أثره» ليس معناه أن لا يقف على رجليه.. بل هو شيء آخر
يختلف عن مضمون تلك الدعوة تماماً..
فما معنى جعل عدم قدرته على الوقوف على رجليه استجابة
لتلك الدعوى؟!..
خامساً:
روي عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله «صلى
الله عليه وآله» يصلي، وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة.
وقد روي هذا بوجوه مختلفة.
وقالت في بعضها:
وأنا حائض.
وفي بعضها:
أنه «صلى الله عليه وآله» كان يغمز رجليها فتقبضهما،
فإذا رفع رأسه بسطتهما([19]).
فإذا كان اعتراض المرأة خصوصاً الحائض بين المصلي، وبين
القبلة لا يقطع الصلاة، فالمرور من بين يدي المصلي بطريق أولى([20]).
وعن عائشة وهي ترد على قولهم:
لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة قالت:
أعدلتمونا بالكلب والحمار؟! لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء النبي
«صلى الله عليه وآله»، فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنِّحه (أي أن
تستقبله ببدنها في صلاته)، فأنسل من قبل السرير، حتى انسل من لحافي([21]).
قال العيني:
«وفيه دلالة على أن مرور المرأة بين يد المصلي لا يقطع
صلاته، لأن انسلالها من لحافها كالمرور بين يدي المصلي»([22]).
وقال الطحاوي:
«دل حديث عائشة على أن مرور بني آدم بين يدي المصلي لا
يقطع الصلاة»([23]).
ونضيف هنا:
أن نفس أن يبادر النبي «صلى الله عليه وآله» للصلاة في
موضع يكون هناك إنسان معترض في قبلته فيدفعه ذلك إلى الإنسلال من أمامه
يدل على عدم قادحية وجود أو مرور إنسان أمام المصلي..
سادساً:
إن الروايات عن أهل البيت «عليهم السلام» وهم أعرف بما
فيه تدل عدم حرمة المرور بين يدي المصلي([24]).
سابعاً:
إن ظاهر رواية غزوان عن المقعد الذي رآه في تبوك: أنه
لم تكن لغزوان معرفة بذلك الرجل المقعد، فلماذا وكيف وثق ذلك المقعد
به، حتى باح له بسره، وأوصاه ألا يحدِّث به ما سمع أنه حي؟! مع العلم:
بان غزوان إنما نزل بتبوك، وهو حاج، فكيف يسمع بحياة ذلك المقعد وهو في
بلده البعيد عن تبوك مئات الأميال.. فهل كان ذكر ذلك الرجل المقعد
واسمه يطبق الآفاق؟! لكي يسمع به غزوان..
قال رجل من بني سعد هُذَيم:
جئت رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وهو جالس بتبوك في
نفر، فقال: «يا بلال أطعمنا».
فبسط بلال نطعاً ثم جعل يخرج من حميتٍ له، فأخرج خرجات
بيده من تمر معجون بسمن وأقط، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»:
«كلوا».
فأكلنا حتى شبعنا، فقلت:
يا رسول الله، إن كنت لآكل هذا وحدي.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معاء
واحد».
ثم جئت في الغد متحيناً لغدائه لأزداد في الإسلام
يقيناً، فإذا عشرة نفر حوله، فقال: «هات أطعمنا يا بلال».
فجعل يخرج من جراب تمراً بكفه قبضة
قبضة، فقال:
«أخرج، ولا تخش من ذي العرش إقلالاً».
فجاء بالجراب ونشره، فقال:
فحزرته مُدَّين، فوضع رسول الله «صلى الله عليه وآله»
يده على التمر وقال: «كلوا باسم الله».
فأكل القوم وأكلت معهم، وأكلت حتى ما أجد له مسلكاً.
قال:
وبقي على النطع مثل الذي جاء به بلال، كأنا لم نأكل منه
تمرة واحدة.
قال:
ثم غدوت من الغد، وعاد نفر فكانوا عشرة أو يزيدون رجلاً
أو رجلين، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «يا بلال أطعمنا».
فجاء بلال بذلك الجراب بعينه، أعرفه، فنثره، ووضع رسول
الله «صلى الله عليه وآله» يده عليه وقال: «كلوا باسم الله».
فأكلنا حتى نهلنا، ثم رجع مثل الذي صب، ففعل ذلك ثلاثة
أيام([25]).
عن عرباض بن سارية قال:
كنت ألزم باب رسول الله «صلى الله عليه وآله» في الحضر
والسفر، فرأيتنا ليلة ونحن بتبوك، وذهبنا لحاجة، فرجعنا إلى منزل رسول
الله «صلى الله عليه وآله» وقد تعشى ومن معه من أضيافه، ورسول الله
«صلى الله عليه وآله» يريد أن يدخل قبته ـ ومعه زوجته أم سلمة ـ فلما
طلعت عليه قال: أين كنت منذ الليلة؟
فأخبرته، فطلع جعال بن سراقة وعبد الله بن مغفل المزني،
فكنا ثلاثة كلنا جائع، إنما نغشى باب رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
فدخل رسول الله «صلى الله عليه وآله» البيت، فطلب شيئاً نأكله، فلم
يجده، فخرج إلينا فنادى: «يا بلال هل من عشاء لهؤلاء النفر».
فقال:
والذي بعثك بالحق لقد نفضنا جربنا وحمتنا.
قال:
«انظر عسى أن تجد شيئاً».
فأخذ الجرب ينفضها جراباً جراباً، فتقع التمرة
والتمرتان، حتى رأيت في يده سبع تمرات، ثم دعا بصحفة فوضع التمر فيها،
ثم وضع يده على التمرات، وسمى الله تعالى، فقال: «كلوا باسم الله».
فأكلنا، فحصيت أربعاً وخمسين تمرة، أعدها عداً، ونواها
في يدي الأخرى، وصاحباي يصنعان مثل ما أصنع، وشبعنا، فأكل كل واحد منا
خمسين تمرة، ورفعنا أيدينا فإذا التمرات السبع كما هي. فقال: «يا بلال
ارفعها، فإنه لا يأكل منها أحد إلا نهل شبعاً».
فلما أصبح رسول الله «صلى الله عليه وآله» صلى صلاة
الصبح ثم انصرف إلى فناء قبته، فجلس وجلسنا حوله، فقرأ من «المؤمنون»
عشراً، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «هل لكم في الغداء»؟
قال عرباض:
فجعلت أقول في نفسي أي غداء، فدعا بلالاً بالتمرات،
فوضع يده عليهن في الصحفة، ثم قال: «كلوا بسم الله».
فأكلنا، فوالذي بعثه بالحق، حتى شبعنا وإنا لعشرة، ثم
رفعوا أيديهم منها شبعاً، وإذا التمرات كما هي، فقال رسول الله «صلى
الله عليه وآله»: «لولا أني أستحي من ربي لأكلنا من هذا التمر حتى نرد
المدينة عن آخرنا».
وطلع عليهم غلام من أهل البدو، فأخذ رسول الله «صلى
الله عليه وآله» التمرات فدفعها إليه، فولى الغلام يلوكهن([26]).
ونقول بالنسبة لما تقدم، من أن الكافر يأكل بسبعة
أمعاء، والمؤمن يأكل في معاء واحد([27])
نقول:
قد ذكرنا أن هذا الحديث إن ثبت، فلا بد أن يكون المراد
منه المعنى المجازي، وهو:
أولاً:
أن المؤمن لا يأكل رزقه إلا من باب واحد وهو باب
الحلال، أما الكافر فلا يبالي من أي باب أكل، ومن أين أكل، فأي باب فتح
له أكل منه.. فمآكل الكافر كثيرة، وذكر السبعة إنما هو لإفادة الكثرة،
كقوله تعالى:
{وَالْبَحْرُ
يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ}([28]).
ثانياً:
أو يقال: إن المؤمن يأكل ليعيش، أي أنه لا يهتم إلا بما
يمسك به الرمق، ويقيم الأود، ولا يعيش ليأكل، فيكون كالدابة المربوطة
همها علفها، وشغلها تقممها. فكأن المؤمن لشدة قناعته يأكل بمعاء واحد،
وكأن الكافر لشدة شرهه، واستقصائه في البحث عن اللذة له سبعة أمعاء..
ثالثاً:
أو يقال: إن هذا كناية عن طمع الكافر وجشعه، وحبه
للدنيا، واستغراقه في طلبها، واتساع رغبته بها، فهو يأكل كل ما يحصل
عليه، يأكل الدينار، ويأكل القنطار، ويأكل البلاد والعباد..
وأما أن يكون المراد:
أن الكافر يأكل سبعة أضعاف ما يأكله المؤمن، فلا مجال
لقبوله، لأن المشاهد خلاف ذلك، وأنه لا فرق بين المؤمن والكافر في
مقدار الطعام الذي يتناوله كل واحد منهما.
رابعاً:
يفهم من بعض النصوص: أن النبي «صلى الله عليه وآله»
قال: ستكون من بعدي سنة، يأكل المؤمن في معاء واحد، ويأكل الكافر في
سبعة أمعاء([29])..
فإن كان المراد هو الإخبار عن سنة من الزمان يكون فيها
ذلك، فالأمر واضح، وإن كان المراد بها ـ كما احتمله العلامة المجلسي ـ
السُّنَّة([30])
ـ بالضم والتشديد ـ فالحديث يشير إلى أمر سيحصل، ولا نعرف متى سيكون
ذلك.
ونحن نعتقد:
أن حديث الجراب الذي يرويه ذلك الرجل، الذي لم نعرف
اسمه، وإن كان ممكناً في حد نفسه، وأن له نظائر كثيرة جداً في حياة
رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأن صدور أمثال هذه المعجزات
والكرامات منه «صلى الله عليه وآله» وعنه يعد بالعشرات، إن لم يكن
بأكثر من ذلك..
إلا أن اللافت هنا:
أن نقل هذه الحادثة قد اقتصر على رجل مجهول من بني سعد
هذيم..
مع أن هذا الحدث قد تكرر أمام جماعة من الناس.. وتكرر
مع بلال حامل الجراب ثلاث مرات، فهل زهد المسلمون بنقل هذه الحوادث
لكثرتها؟!
على أن لنا أن نسأل:
لماذا لم يأت هذا الرجل نفسه في اليوم الرابع أيضاً؟!
لكي يأكل من جراب رابع وخامس.
ويلاحظ هنا:
أن رقم عشرة تكرر في اليومين الأخيرين، مع الإشارة إلى
أن العشرة الأخيرة كانت هي نفس العشرة التي جاءت في اليوم السابق.
وعن رواية عرباض بن سارية نقول:
إن دعواه أنه كان ملازماً لباب
رسول الله «صلى الله عليه وآله» في السفر والحضر.. لا نجد ما يؤيدها،
بل المعروف خلافه، إلا إن كان يقصد أنه كان ملازماً للمسجد مع أهل
الصفة، الذين كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يهتم بأمرهم، ويقوم
بإعالتهم، لكونهم من الفقراء، وكان عرباض منهم([31])..
على أننا لا ندري سبب إظهار هذه الكرامة لعرباض، وجعال،
وابن مغفل، فإن كان السبب هو جوع هؤلاء، فإن غيرهم أيضاً كان يعاني من
نفس المشكلة، فلماذا آثر هؤلاء وحرم أولئك؟!. فليظهر هذه الكرامة لكل
جائع.
وإن كان السبب هو أن هؤلاء كانوا يحتاجون إلى إظهار
المعجزة، لترسيخ يقينهم، وإزالة الريب من نفوسهم، فذلك يعني أن شائبة
النفاق كانت ماثلة فيهم، أو في بعضهم.
وتستمر هذه الشبهة حولهم إلى ما بعد وفاة النبي «صلى
الله عليه وآله».
ولعل مما يؤكد هذا الأمر بالنسبة
لبعضهم:
أنهم يقولون: إن إبليس تصور بصورة مغفل بن سراقة يوم
أحد([32])..
وحين نقرأ قوله «صلى الله عليه
وآله»:
«لولا أني أستحي من ربي، لأكلنا من هذا التمر حتى نرد
المدينة عن آخرنا».. قد يراودنا خاطر يزعج اليقين لدينا بصحة هذا القول،
من حيث تضمنه جرأة على مقام العزة الإلهية، لأنه يعطي: أن النبي «صلى
الله عليه وآله» كان أكرم من الله على عباد الله، وأرفق بهم منه.. وهذا
المنطق مرفوض ومدان جملة وتفصيلاً.. لأنه يؤدي إلى الخروج من الدين.
فلا بد أن يكون المقصود:
أنه «صلى الله عليه وآله» يستحي من الله لأن هذا الطلب
يؤدي إلى نقض الغرض من المعجزة أو الكرامة.. لأن أولئك الناس قد
ينتزعون منه فكرة خاطئة، أو يزينها الشيطان لهم، وهو أن هذا العطاء،
وهذه الكرامة.. قد منحهم الله إياها عن استحقاق منهم لها.
أو لربما يدخل في وهمهم:
أن هذا العطاء هو السنة الإلهية التي لو لم يجرها الله
تعالى فيهم لكان ظالماً لهم، ولكان لهم الحق في أن يطالبوه بها..
أو غير ذلك من الأوهام الشيطانية التي تؤدي إلى أن يصبح
حالهم مع النبي «صلى الله عليه وآله» حال بني إسرائيل مع موسى «على
نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام»..
أو لأن المقصود هو ـ كما ذكره بعض
الإخوةـ:
أنه لا ينبعي للنبي «صلى الله عليه وآله» أن يعتمد، ولا
يغري المؤمنين بالإعتماد على المنح الإلهية التي حباه الله تعالى بها
في تحصيل الأرزاق، فإن ذلك يؤدي إلى قعود الناس عن طلب الرزق، وإلى غير
ذلك من أمور..
إن ثمة سؤالاً يحتاج إلى إجابة، وهو أنه إذا كان الطعام
قد فقد، وكانوا قد نفضوا جُرُبَهم و.. و.. حتى احتاجوا إلى التصرف
النبوي، والإستجابة الإلهية.. فماذا كانوا سيأكلون، وينفقون في الأيام
التالية، وإلى حين رجوعهم إلى المدينة؟! والحال أن البلاد ليست بلادهم،
وليس لهم فيها زراعة ولا تجارة، ولا غير ذلك!!.
إلا أن يكون المقصود:
أن الطعام الذي كان عند رسول الله «صلى الله عليه وآله»
قد استنفد، أما الآخرون فكان لديهم طعام، ولعلهم لا يتركون رسول الله
«صلى الله عليه وآله» في الأيام التالية..
أو يقال:
إن نفاد الطعام لا يعني نفاد المال الذي يشتري به في
اليوم التالي حيث يبيعه المسلمون أو غيرهم من سكان تلك المنطقة.
وقالوا:
كان رجل من بني عذرة يقال له: عدي يقول: جئت رسول الله
«صلى الله عليه وآله» بتبوك، فرأيته على ناقة حمراء يطوف على الناس،
يقول:
«يا أيها الناس، يد الله فوق يد المعطي، ويد المعطي
الوسطى، ويد المعطى السفلى، أيها الناس، فتغنوا ولو بحزم الحطب، اللهم
هل بلغت» ثلاثاً.
فقلت:
يا رسول الله، إن امرأتيَّ اقتتلتا، فرميت إحداهما،
فَرُمي في رميتي ـ يريد أنها ماتت ـ فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»: «تعقلها ولا ترثها».
فجلس رسول الله «صلى الله عليه وآله» في موضع مسجده
بتبوك، فنظر نحو اليمين، ورفع يده يشير إلى أهل اليمن، فقال: «الإيمان
يمان».
ونظر نحو الشرق، فأشار بيده فقال:
إن الجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر، من نحو
المشرق، حيث يطلع الشيطان قرنيه([33]).
ونقول:
إن لنا مع هذا النص وقفات، نقتصر منها على ما يلي:
هناك حكم شرعي يقول:
لا يرث القاتل من المقتول إذا قتله عمداً، وإذا كان
القتل شبيهاً بالعمد، كأن يكون قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول غير
قاصد للقتل، وكان الفعل مما لا يترتب عليه القتل في العادة، فقد اختلفت
كلمات الفقهاء فيه، تبعاً لاختلاف ما استفادوه من النصوص..
أما قتل الخطأ فلا يمنع من التوارث..
فقد يقال:
إن قتل هذا الرجل لزوجته لم يكن متعمداً، بل هو شبيه
بالعمد.. وقد حكم النبي «صلى الله عليه وآله» بعدم إرثه منها.. فهذا
يؤيد قول من قال: بعدم الإرث في شبه العمد.
ونجيب:
بأن هذا المورد ليس من موارد شبه العمد، لأن الآلة التي
استعملت، والفعل الذي حصل هو بحسب الظاهر مما يترتب عليه القتل عادة،
لأن الظاهر من كلامه أنه رماها بسهم، والسهم يقتل عادة، أو هو من آلات
القتل والقتال.
إن قلت:
لكن رواية الضحاك تقول: «فرميت إحداهما بحجر»([34]).
قلنا:
إن الحجر يمكن أن يكون كبيراً بحيث يقتل عادة، أو يكون
رماه بحيث يصيب منها مقتلاً في العادة بحسب جلستها أو نومتها أو حالها،
وعلى كل حال، فمع مثل هذه الإحتمالات لا يثبت أنه شبه العمد، لأنه على
بعض الوجوه عمد كرميها بسهم أو نحوه.
وقد ادعت الرواية المتقدمة:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» أشار إلى الشرق، وقال:
إن الجفاء، وغلظة القلوب في الفدادين أهل الوبر، من نحو الشرق، حيث
يطلع قرن الشيطان..
ونقول:
إن الحديث المعروف والثابت
والمتداول هو ذلك الذي رواه البخاري عن نافع، عن ابن عمر قال: قام
النبي «صلى الله عليه وآله» خطيباً، فأشار إلى مسكن عائشة، وقال: ها
هنا الفتنة ـ ثلاثاً ـ من حيث يطلع قرن الشيطان([35]).
وفي البخاري أيضاً قال:
خرج النبي «صلى الله عليه وآله» من بيت عائشة، فقال:
رأس الكفر من ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان([36]).
وحين صدمتهم دلالة هذا الحديث حاولوا إيجاد مخارج له..
فتمخض الجبل فولد فأرة حين زعموا: أن حجرة عائشة كانت إلى جهة الشرق.
وباقي الأحاديث تقول:
إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أشار إلى الشرق، وقد
فسره «صلى الله عليه وآله» بقوله: «حيث يطلع قرن الشيطان»، أي من جانب
الشرق..
قالوا:
ولو كان المراد حجرة عائشة، فكيف يصح أن يقول: إن
الشيطان يطلع من حجرته المقدسة؟!.
والحال أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» يطلع من
الحجرة؟!([37]).
ونقول:
أولاً:
إن ظاهر الكلام يمنع من إرادة جهة الشرق، بل المقصود هو
مسكن عائشة، الذي يزعمون أنه يقع في جهة الشرق، ولذلك صرح البخاري:
بأنه أشار إلى مسكن عائشة، وأورده في باب ما جاء في بيوت أزواج النبي
«صلى الله عليه وآله»، فإن كان قد ذكر جهة الشرق حقاً، فلأن مسكن عائشة
كان يقع في تلك الجهة حسب زعمهم.. أي أن المطلق، وهو جهة الشرق يحمل
على القيد، وهذا هو طبع الكلام في الموارد المختلفة..
ثانياً:
إن مسكن عائشة كان إلى جانبه بيوت كثيرة، ولم يكن وحده
في تلك الجهة، فلماذا خص الراوي مسكنها بالذكر؟!.
ثالثاً:
لماذا قال «صلى الله عليه وآله»: «من ها هنا» (الذي هو
للإشارة للقريب)، ولم يقل: من هناك الذي يشار به للبعيد؟!.
في حين أنه قد استعمل لفظ: «هناك» في الحديث الذي أشار
به إلى نجد فقال: هناك الزلازل والفتن([38]).
رابعاً:
إنه «صلى الله عليه وآله» لم يرد أن كل من يطلع من تلك
الحجرة فهو قرن شيطان، لكي يشمل نفسه بهذا الكلام ـ كما زعموا ـ بل
أراد التكنية عن شخص بعينه، يكون منه ما لا يرضاه الله تعالى. كما
أظهرته الوقائع بعد استشهاد النبي «صلى الله عليه وآله»..
خامساً:
إننا نقول: إن الروايات التي تتحدث عن الشرق ربما تكون
مجعولة، من أجل تخفيف وطأة حديث البخاري، ويكون ذلك مخرجاً له..
إذ إن بيت عائشة لم يكن إلى جهة الشرق، بل كان في جهة
القبلة في مسجد رسول الله «صلى الله عليه وآله». فلاحظ ما يلي:
1 ـ
قالوا: «والمعروف عند الناس أن البيت الذي على يمين
الخارج من خوخة آل عمر المذكورة هو بيت عائشة»([39])..
وخوخة آل عمر كانت قبلي المسجد
الشريف، وهي اليوم، «يتوصل إليها من الطابق الذي بالرواق الثاني من
أروقة القبلة. وهو الرواق الذي يقف الناس فيه للزيارة أمام الوجه
الشريف، بالقرب من الطابق المذكور»([40])..
وكان دار حفصة قبلي المسجد([41])،
ملاصقاً لبيت عائشة من جهة القبلة([42]).
2 ـ
وقال محمد بن هلال عن بيت عائشة: كان بابه من جهة الشام([43]).
وقال ابن عساكر:
«وباب البيت شامي»([44])..
ومن المعلوم:
أن الجهة الشامية التي للمسجد هي الجهة الشمالية، فإذا
كان باب بيت عائشة يقابل الجهة الشمالية، فإنه لا يكون لجهة الشرق..
سادساً:
وأخيراً نقول:
إنه لا مانع من أن يطلع قرن الشيطان
من موضعين أحدهما:
جهة المشرق..
وثانيهما:
مسكن عائشة، الذي لم يكن في تلك الجهة، وليس ثمة ما
يحتم أن تكون الروايات مسوقة لبيان أمر واحد، إذ لعل هناك حالتين لا بد
من أن يخبر النبي «صلى الله عليه وآله» عنهما جميعاً..
وعن قوله «صلى الله عليه وآله»: «الإيمان يمان»، نقول:
قد تحدثنا عن هذا الموضوع قبل بضعة
صفحات تحت عنوان:
«3 ـ ما ها هنا يمن». وفي فصل:
«خمسة وفود بلا تاريخ».
تحت عنوان: «وفد الأشعريين». فراجع..
غير أننا نحب أن نشير إلى أنه إذا كان المقصود باليمن
واليمان هو ما يشمل الحجاز كله، واليمن أيضاً، فلا ضير في ذلك ما دام
أصل الإيمان المتمثل بالنبي «صلى الله عليه وآله» وأهل بيته «عليهم
السلام»، قد ظهر في هذه المنطقة، وتبعهم أولئك الذين تربوا على أيديهم،
ونهلوا من معين علمهم..
فإن أريد معارضة هذا الحديث بحديث:
لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من فارس([45]).
فيجاب عن ذلك: بأننا لا نمنع من أن ينال رجال من فارس الدين والعلم،
ولكن أصله الأصيل، وحقيقته الظاهرة المتمثلة بصفوة الخلق كله، إنما كان
في منطقة الحجاز اليمانية..
قد ذكرت الرواية المتقدمة:
أن الجفاء، وغلظ القلوب، في الفدادين أهل الوبر، من نحو
المشرق الخ..
والفداد:
هو الشديد الصوت.
والفدادون:
هم الرعيان، والبقارون، والجمالون،
والفلاحون وسواهم. وهم أهل الوبر، لغلظ أصواتهم، وجفائهم. ولعله لأجل
رفع أصواتهم في حروثهم ومواشيهم، وهم أصحاب الإبل الكثير الذين يملك
أحدهم المائتين من الإبل إلى الألف، وهم مع ذلك جفاة وأهل خيلاء([46]).
ونقول:
1 ـ
إنه لا دليل على أن رفع الصوت للراعي، والبقار،
والجمال، والفلاح، يوجب الجفاء وغلظ القلب، إلا إذا كان الدليل هو هذه
الرواية وأمثالها، ثم أخذ المصنفون في اللغة تفاسيرهم من هذه الأحاديث.
ومجتمع أهل الإيمان لا يشير إلى وجود أي فرق في أخلاق
الناس الذين يشتغلون بهذه الأمور مع غيرهم من سائر الناس..
2 ـ
لو كان الرعي أو الفلاحة، أو اقتناء الإبل، من موجبات
الجفاء والخيلاء، فإن ذلك يفرض انحسار الإهتمام بهذه الأمور في مجتمع
أهل الإيمان، ولكن هذه الأمور قد بقيت كما كانت عليه قبل الإسلام،
واستمرت على نفس الوتيرة عبر العصور والدهور..
3 ـ
إننا لم نجد فرقاً بين الفدادين من أهل المشرق
والفدادين في المناطق الأخرى، ولم نجد الشيطان يطلع قرنيه في مشرق
جزيرة العرب، أكثر مما كان ولا يزال يطلعه في سائر المناطق، مثل بلاد
الشام ونجد، فضلاً عن سائر البلاد التي لا تدين بالإسلام، فإن الشيطان
يطلع قرنيه في كل موقع لا يهيمن فيه دين الله تبارك وتعالى..
فلماذا اختص الفدادون المشرقيون بهذا التوصيف الحاد؟!.
4ـ
إن من الأنبياء من كان يرعى الأغنام، وبعضهم كان يحرث
الأرض ويزرعها، فهل هذا الوصف يشملهم؟!
قالوا:
وهاجت ريح شديدة بتبوك، فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»: هذا لموت منافق عظيم النفاق.
فقدموا المدينة، فوجدوا منافقاً عظيم النفاق قد مات([47])..
ونقول:
قد تقدم حين الحديث عما جرى في الحجر، ومنع النبي «صلى
الله عليه وآله» الناس من الإستفادة من مائها، وإكفائه القدور الخ..:
أنه «صلى الله عليه وآله» أخبر الناس هناك بأنه ستهب في تلك الليلة ريح
شديدة، وأن سبب ذلك هو موت عظيم من المنافقين.. وقد حصل ذلك فعلاً.
وقد تكرر ذكر هذه القضية هنا، غير أن الروايات لم تذكر
اسم هذا العظيم النفاق في الموضعين، مع أنهم يهتمون بتسمية من هو أقل
شأناً وخطراً بمراتب، ولو من دون مناسبة.
فهل كان هذا الرجل العظيم النفاق من أقارب بعض من
يرغبون في تفخيمه وتعظيمه، ولا يريدون التلميح، فكيف بالتصريح بأدنى
شيء يشير إليه أو إلى أحد من أقاربه، إذا كان مما يشين؟!.
وهل كانت الريح تهب كلما مات منافق عظيم النفاق؟! وهل
هبت الريح عند موت عبد الله بن أُبي، الذي يحبون أن يصفوه بأنه رئيس
المنافقين في المدينة؟!.
وأما الرواية التي تصرح باسم رفاعة بن تابوب، أو رافع
بن تابوت فيرد عليها: أن هذا العظيم لم يعرف له ذكر أو دور ذو بال في
تاريخ الإسلام، ولا أشار إلى أسباب عظمته في شيء، بخلاف عبد الله بن
أبي، الذي زعموا أنه كان ينظم له الخرز ليتوج قبيل قدوم النبي «صلى
الله عليه وآله»إلى المدينة..
قالوا:
قدم على رسول الله «صلى الله عليه وآله» نفر من سعد
هذيم، فقالوا: يا رسول الله، إنا قدمنا إليك، وتركنا أهلنا على بئر لنا
قليل ماؤها، وهذا القيظ، ونحن نخاف إن تفرقنا أن نُقْتَطَع، لأن
الإسلام لم يفشُ حولنا بعد، فادع الله تعالى لنا في مائها، فإنا إن
روينا به فلا قوم أعز منا، لا يعبر بنا أحد مخالف لديننا.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«ابغوا لي حصيات».
فتناول بعضهم ثلاث حصيات، فدفعهن إلى رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، ففركهن بيده، ثم قال: «اذهبوا بهذه الحصيات إلى
بئركم، فاطرحوها واحدة واحدة، وسَمُّوا الله تعالى».
فانصرف القوم من عند رسول الله «صلى الله عليه وآله»
ففعلوا ذلك، فجاشت بئرهم بالرواء، ونفوا من قاربهم من أهل الشرك
ووطئوهم، فما انصرف رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى المدينة حتى
أوطئوا من حولهم غلبة، ودانوا عليه بالإسلام.
ونحن لا نريد أن نرهق القارئ بالأسئلة عن مدى صحة أن
يكون هؤلاء قد وطأوا جميعاً من حولهم غلبة، ودانوا عليه بالإسلام في
غضون أيام يسيرة ـ فإن ذلك مما لا يغفل عنه القارئ الكريم إن شاء الله
تعالى.
عن عبد الله بن عمر قال:
كنا مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» بتبوك، فقام من
الليل يصلي، وهو كثير التهجد بالليل، ولا يقوم إلا استاك، فقام ليلة
فلما فرغ أقبل على من كان عنده فقال: «أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن
أحد قبلي: بعثت إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه. وجعلت لي
الأرض مسجداً وطهوراً، أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت، وكان من قبلي
لم يعطوا ذلك، وكانوا لا يصلون إلا في الكنائس والبيع، وأحلت لي
الغنائم آكلها، وكان من قبلي يحرمونها، والخامسة هي ما هي، هي ما هي،
هي ما هي» ثلاثاً.
قالوا:
يا رسول الله، وما هي؟
قال:
«قيل لي سل، فكل نبي قد سأل، فهي لكم، ولمن شهد أن لا
إله إلا الله».
ونقول:
إن لنا مع هذه الرواية عدة وقفات نذكر منها:
جاء في الرواية المتقدمة:
أن الله تعالى بعث محمداً «صلى الله عليه وآله» إلى
الناس كافة في غزوة تبوك.
ونقول:
أولاً:
إن الله تعالى
يقول في سورة التكوير:
{إِنْ
هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ}([48]).
وسورة التكوير نزلت في مكة قبل الهجرة.. وقال تعالى في
سورة الفرقان:
{تَبَارَكَ
الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ
نَذِيراً}([49]).
والجمهور على أن سورة الفرقان مكية.
وقال الضحاك:
مدنية([50]).
ثانياً:
قال تعالى:
{وَمَا
أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}([51]).
وهي مكية أيضاً.
رابعاً:
إن رسائله إلى ملوك الأرض في سنة ست دليل على أنه مبعوث
إلى الناس جميعاً.
وقد صرحوا:
بأن آية التيمم قد نزلت في غزوة المريسيع، وغزوة
المريسيع قد سبقت غزوة تبوك بعدة سنوات، وقد قدمنا طائفة من المصادر
الدالة على ذلك في فصل: «ما عشت أراك الدهر عجباً»، في فقرة: «ضياع
العقد مرة أخرى».
فكيف تقول الرواية الآنفة الذكر:
إن الله تعالى أعطاه التيمم في غزوة تبوك؟!
ولا ندري مدى صحة ما أطلقته
الرواية:
من أن الأنبياء قبل النبي «صلى الله عليه وآله» كانوا
لا يصلون إلا في الكنائس والبيع.. فإن ذلك لم نجده إلا في هذه الرواية
التي تعاورت عليها العلل والأسقام، وهل كان الانبياء، وغيرهم من
المؤمنين لا يصلون في أسفارهم وفي حضرهم إذا لم يكن ثمة بيعة أو كنيسة
قريبة منهم؟! وكذلك الحال بالنسبة لتحريم الغنائم من قبل من سبقه من
الأنبياء..
أو أنهم كانوا كلما أرادوا الصلاة في أسفارهم بنوا بيعة
أو كنيسة لأجل ذلك.
إننا لم نفهم ماذا عناه بقوله
ثلاثاً:
هي! ما هي؟!..
هل القصد أن يطرحها عليهم كأحجية، يطلب منهم حلها؟!..
أم أنه هو نفسه قد نسي الخامسة، ثم هو يحاول أن يتذكرها؟!.
واللافت هنا:
أن الرواية تذكر: أنه «صلى الله عليه وآله» قد نقض أول
كلامه بآخره، فإنه قد قرر أولاً: أن الله تعالى قد أعطاه أولاً خمساً
لم يعطها أحداً قبله.. ثم عاد أخيراً فنقض ذلك وقال: إن كل نبي قد سأل،
وأنه هو أيضاً له الحق في أن يسأل كما سأل من سبقه، فلم تكن الخامسة
مما اختصه الله تعالى به.. وبذلك تكون الخمسة قد نقصت واحدة، لم تكن
مختصة به «صلى الله عليه وآله»، دون من سبقه..
عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال:
خرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى غزوة تبوك،
وكنت على خدمته، فنظرت إلى نِحي السمن قد قل ما فيه، وهيأت للنبي «صلى
الله عليه وآله» طعاماً فوضعت النحي في الشمس، ونمت فانتبهت بخرير
النحي، فقمت فأخذت رأسه بيدي.
فقال
رسول الله «صلى الله عليه وآله» ورآني:
«لو تركته لسال الوادي سمناً»([52]).
([1])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص450 و 451 عن مالك، وابن إسحاق، ومسلم،
وأحمد. والبداية والنهاية ج5 ص17 وج6 ص110 والسيرة النبوية
لابن كثير ج4 ص23 والسيرة الحلبية ج3 ص110 و 120. وراجع:
البحار ج21 ص250 وعمدة القاري ج18 ص45 والمصنف للصنعاني ج2
ص546 وصحيح ابن خزيمة ج2 ص82 وج4 ص469 وج14 ص475 والمعجم
الكبير ج20 ص57 وكنز العمال ج12 ص378 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2
ص636 وإمتاع الأسماع ج2 ص58.
([2])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص451 و 452 و 453 عن أبي نعيم، وعن
البيهقي في الدلائل، وعن ابن عائذ. وعيون الأثر ج2 ص 258
والسيرة الحلبية ج3 ص110 وإمتاع الأسماع ج5 ص113.
([3])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص451 عن مالك وعن الخطيب في كتاب الرواة،
وقال في هامشه: أخرجه مسلم ج4 ص1784 ـ 1785 حديث (10/706)
وأحمد ج5 ص238 وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (549)،
والبيهقي في الدلائل ج5 ص236 وابن خزيمة (968) ومالك في الموطأ
144وانظر كنز العمال (35398). وراجع: صحيح ابن خزيمة ج2 ص82
وصحيح ابن حبان ج4 ص470 والمعجم الأوسط ج7 ص76 والمعجم الكبير
ج20 ص57 و والتمهيد ج12 ص194 والإستذكار لابن عبد البر ج2 ص205
وتاريخ مدينة دمشق ج2 ص38 وج61 ص275 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2
ص637 ومصادر كثيرة أخرى.
([4])
سنن الترمذي ج5 ص392 وراجع: مسند أحمد ج1 ص223 و354، وصحيح
مسلم ج2 ص152 وسنن أبي داود ج1 ص272 وسنن النسائي ج1 ص290
والسنن الكبرى ج3 ص167 وج1 ص491 وتحفة الأحوذي ج1 ص478 والموطأ
(ط دار إحياء التراث العربي) ج1 ص144.
([5])
الآية 78 من سورة الإسراء.
([6])
الوسائل (ط دار الإسلامية) ج3 ص95 والكافي ج3 ص276 وراجع: من
لا يحضره الفقيه ج1 ص215 والإستبصار للطوسي ج1 ص246 وتهذيب
الأحكام للطوسي ج2 ص26 وفقه الرضا لابن بابويه ص74 والهداية
للصدوق ص127 وتذكرة الفقهاء (ط.ج) للحلي ج2 ص308 ومنتهى المطلب
(ط.ج) للحلي ج4 ص94 وجواهر الكلام ج7 ص78 والبحار ج80 ص32 و
46.
([7])
سبل الهدى والرشاد ج9 ص273 وج5 ص452 عن أحمد وقال في هامشه:
أخرجه أحمد في المسند ج3 ص37 و 58 و 414 والحاكم ج2 ص67 وسنن
النسائي ج6 ص12، والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص160 والجهاد لابن
المبارك ص158 والمصنف لابن أبي شيبة ج4 ص592 ومنتخب مسند عبد
بن حميد ص305 والسنن الكبرى للنسائي ج3 ص9 والجامع الصغير
للسيوطي ج1 ص439 وكنز العمال ج15 ص771 والبداية والنهاية ج5
ص17 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص23 وراجع: الجامع لأحكام
القرآن ج1 ص437.
([8])
السكركة: خمر الحبشة، وهو من الذرة، وتسمى الغبيراء أيضاً.
([9])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص452 عن البيهقي، وقال في هامشه البيهقي
ج5 ص241 قال الحافظ ابن كثير في البداية ج5 ص13و 14 هذا حديث
غريب، وفيه نكارة، وفي إسناده ضعيف. وراجع: كنز العمال ج15
ص930.
([10])
الآيات 224 ـ 227 من سورة الشعراء.
([11])
الآية 56 من سورة الذاريات.
([12])
التوحيد للصدوق ص356 والبحار ج5 ص157 ونور البراهين للجزائري
ج2 ص285 ومستدرك سفينة البحار ج10 ص590 وميزان الحكمة ج2 ص1479
وراجع: نور الثقلين ج2 ص396 .
([13])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص453 عن الواقدي، وراجع: إمتاع الأسماع
ج2 ص68.
([14])
سبل الهدى والرشاد ج ص451 عن الواقدي.
([15])
الآية 1 من سورة الإخلاص.
([16])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص456 و 457 عن الطبراني في الكبير
والأوسط، وابن سعد، والبيهقي، وأبي يعلى، وعن البداية والنهاية
ج4 ص14 وراجع: السنن الكبرى للبيهقي ج4 ص51 ومجمع الزوائد ج3
ص37 ومسند أبي يعلى ج7 ص258 والمعجم الكبير ج19 ص429
والإستيعاب (ط دار الجيل) ج3 ص1423 وأسد الغابة ج4 ص389 وتاريخ
الإسلام للذهبي ج2 ص640.
([17])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص457.
([18])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص453 عن أحمد وأبي داود، وقال في هامشه:
أخرجه أبو داود (701) و (705)، وأحمد ج4 ص64، والبيهقي في
السنن ج2 ص234 والبداية والنهاية ج5 ص14 والبخاري في التاريخ
ج8 ص366، وراجع: عمدة القاري ج4 ص279 والمغني لابن قدامه ج2
ص75 ومسند الشاميين ج3 ص195 والتاريخ الكبير للبخاري ج8 ص366
وتاريخ مدينة دمشق ج21 ص336.
([19])
عمدة القاري ج4 ص272 عن البخاري، ومسلم وص297 وراجع: صحيح
البخاري باب التطوع خلف المرأة، وباب من قال: لا يقطع الصلاة
شيء، وباب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود؟ وصحيح (ط دار
الفكر) ج1 ص101 و 130 وصحيح مسلم ج2 ص61 وراجع: وسائل الشيعة
(ط دار الإسلامية) ج3 ص426 والسنن الكبرى للبيهقي ج1 ص128 وج2
ص264 و 276 والسنن الكبرى للنسائي ج1 ص98 وصحيح ابن حبان ج6
ص110 ومعرفة السنن والآثار ج2 ص121 والإستذكار ج2 ص85 والتمهيد
لابن عبد البر ج21 ص166 و 170 ونصب الراية للزيلعي ج1 ص127
وعمدة القاري ج4 ص297 والمصنف للصنعاني ج2 ص32 وسنن النسائي ج1
ص102 والموطأ (صلاة الليل) ومسند أحمد ج6 ص44 و 55 و 142 و 225
و 255 و 182 = = وفي (ط دار الحديث) ما ورد برقم: 24510 و
25308 و 24021 و 24443 و 25513 و 25523 و 25818 و 24118 و
25572 و 25475 و 26059 و (ط دار صادر) ج6 ص148 و 225.
([20])
عمدة القاري ج4 ص279.
([21])
صحيح البخاري (كتاب الصلاة) باب الصلاة إلى السرير، وباب
استقبال الرجل وهو يصلي، وباب من قال: لا يقطع الصلاة شيء و (ط
دار الفكر) ج1 ص128 والسنن الكبرى للبيهقي ج2 ص276 وصحيح مسلم
ج2 ص60 والسنن الكبرى للبيهقي ج2 ص276 ومسند ابن راهويه ج3
ص835.
([22])
عمدة القاري ج4 ص288.
([23])
عمدة القاري ج4 ص299.
([24])
الوسائل (ط دار الإسلامية) ج3 ص434 ـ 436 و 426 عن كتاب
التوحيد للصدوق ص171 و 177 وعن تهذيب الحكام ج1 ص228 وعن
الإستبصار ج1 ص204 وعن الكافي ج3 ص82 وقرب الإسناد ص54 وعن من
لا يحضره الفقيه ج1 ص80.
([25])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص454 والمغازي للواقدي ج3 ص1017 وإمتاع
الأسماع ج2 ص61.
([26])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص454 و 455 عن الواقدي، وأبي نعيم، وابن
عساكر، والمغازي للواقدي ج3 ص1017 وراجع: كنز العمال ج12 ص432
وتاريخ مدينة دمشق ج40 ص189 وإمتاع الأسماع ج2 ص70 وج14 ص52.
([27])
راجع: البحار ج63 ص325 و 337 والخصال ص351 والمحاسن ص447
ومصباح الشريعة ص27 و 28.
([28])
الآية 77 من سورة لقمان.
([29])
المحاسن ص447 والبحار ج63 ص337 والكافي ج6 ص268 والوسائل (ط
مؤسسة آل البيت) ج24 ص240 و (ط دار الإسلامية) ج16 ص406.
([31])
الإصابة ج2 ص473 و (ط دار الكتب العلمية) ج4 ص398 وتاريخ مدينة
دمشق ج40 ص176 و 177 وج40 ص187 وتهذيب الكمال ج19 ص549 وتقريب
التهذيب ج1 ص669 وتهذيب التهذيب ج7 ص157.
([32])
الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج1 ص260 و (ط دار الجيل) ج1 ص274.
([33])
المغازي للواقدي ج3 ص1017 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص455 عنه،
وتاريخ مدينة دمشق ج37 ص213 وإمتاع الأسماع ج2 ص60 ومسند
الحميدي ج2 ص452 والمصنف لابن أبي شيبة ج7 ص552 وراجع: مسند
أحمد ج4 ص118 وج5 ص273 وصحيح البخاري ج4 ص97 و 154 وج5 ص122
وج6 ص178 وصحيح مسلم ج1 ص51 وفتح الباري ج6 ص250 وعمدة القاري
ج15 ص191 وج18 ص31 وج20 ص293 والمعجم الكبير ج17 ص209.
([34])
الآحاد والمثاني ج5 ص302 و (ط دار الدراية للطباعة) ج5 ص308.
([35])
صحيح البخاري (ط دار الفكر) ج4 ص46. والعمدة لابن البطريق ص456
والطرائف لابن طاووس ص297 والصراط المستقيم ج3 ص237 ووصول
الأخيار إلى أصول الأخبار ص83 والجمل لابن شدقم ص47 والبحار
ج31 ص639 وج32 ص287 و مناقب أهل البيت للشيرواني ص471 و مسند
أحمد ج2 ص1.
([36])
مسند أحمد ج2 ص23 و 26 وصحيح مسلم ج8 ص181 والمصنف لابن أبي
شيبة ج7 ص552 وكنز العمال ج11 ص119.
([37])
دلائل الصدق ج3 ق2 ص157 عن فضل بن روزبهان، والخصائص الفاطمية
للكجوري ج1 ص504 والبحار ج2 ص87 ح241 وإحقاق الحق (الأصل) ص308
وكشف الغطاء (ط.ق) ج1 ص19 ووصول الأخيار إلى أصول الأخبار
لوالد البهائي العاملي ص83 عن صحيح البخاري عن ابن عمر.
([38])
الإستذكار لابن عبد البر ج8 ص221 وصحيح البخاري ج2 ص23 وج8 ص95
وفتح الباري ج2 ص433 وج13 ص39 وعمدة القاري ج7 ص58 وج24 ص200
وسير أعلام النبلاء للذهبي ج12 ص524 وج15 ص356 وعوالي اللآلي
ج1 ص154 وجامع أحاديث الشيعة ج12 ص277 والتمهيد لابن عبد البر
ج1 ص279 وج21 ص267 والعهود المحمدية للشعراني ص513 وكنز العمال
ج12 ص300 والدر المنثور ج3 ص113 وتاريخ مدينة دمشق ج1 ص133 و
134 وتذكرة الحفاظ للذهبي ج3 ص836 .
([39])
وفاء الوفاء ج2 ص719.
([40])
وفاء الوفاء ج2 ص706.
([41])
رحلة ابن بطوطة ص72.
([42])
وفاء الوفاء ج2 ص543.
([43])
وفاء الوفاء ج2 ص542 و 459 و 460.
([44])
وفاء الوفاء ج2 ص542 و 459 و 460.
([45])
المعجم الكبير ج18 ص353 والإستيعاب (ط دار الجيل) ج2 ص636 وكنز
العمال ج12 ص91 وتفسير السمعاني ج5 ص187 والتفسير الكبير
للرازي ج28 ص76 وتفسير أبي السعود ج1 ص56 وذكر أخبار إصبهان ج1
ص5 و 8 و 9 وفضل آل البيت للمقريزي ص92 وسبل الهدى والرشاد ج10
ص116 والبحار ج22 ص52 وج64 ص61 ومجمع البيان 9 ص108 والإختصاص
= = ص143 والتاج الجامع للأصول 3 ص423 وج4 ص235 وفقه القرآن
للراوندي ج1 ص371 .
([46])
لسان العرب (ط سنة 1416 هـ) ج10 ص201.
([47])
مسند أحمد ج3 ص341 و 347 وإمتاع الأسماع ج2 ص62 وسبل الهدى
والرشاد ج5 ص455 عن الواقدي، وراجع: البحار ج18 ص131 وج21 ص251
.
([48])
الآية 27 من سورة التكوير.
([49])
الآية 1 من سورة الفرقان.
([50])
الإتقان في علوم القرآن (ط سنة 1422 هـ) 26 و (ط دار الفكر) ج1
ص43 والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج4 ص199 والجامع لأحكام القرآن ج13
ص1 وتفسير السمعاني ج4 ص5 وتفسير الآلوسي ج18 ص230.
([51])
الآية 107من سورة الأنبياء.
([52])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص460 عن أبي نعيم، والطبراني، ودلائل
النبوة لأبي نعيم (1550) وراجع: السيرة الحلبية (ط دار
المعرفة) ج3 ص117.
|