رسـائـل.. وأجـوبـتـهــــا
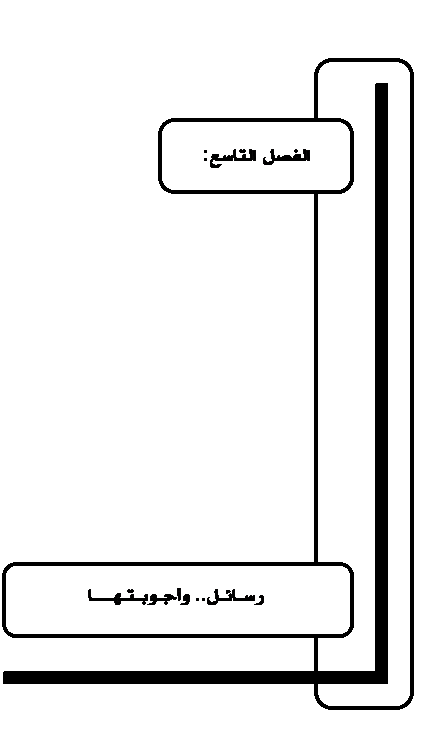
قالوا:
لما وصل رسول الله «صلى الله عليه وآله» تبوك كان هرقل
بحمص ـ وقيل: بدمشق ـ ولم يكن يهمُّ بالذي بلغ رسول الله «صلى الله
عليه وآله» عنه من جمعه، ولا حدثته نفسه بذلك..
وعن أبي بكر بن عبد الله المزني
قال:
قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «من يذهب بهذا
الكتاب إلى قيصر وله الجنة»؟
فقال رجل:
وإن لم يقبل؟.
قال:
وإن لم يقبل.
فانطلق الرجل فأتاه بالكتاب([1]).
ونص كتاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» لقيصر هو
التالي:
من محمد رسول الله إلى صاحب الروم:
إني أدعوك إلى الإسلام، فإن أسلمت فلك ما للمسلمين،
وعليك ما عليهم، فإن لم تدخل في الإسلام فأعط الجزية، فإن الله تبارك
وتعالى يقول:
{قَاتِلُوا
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا
يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ
الحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}([2])
.
وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه،
وأن يعطوا الجزية([3]).
فقرأه فقال:
اذهب إلى نبيكم، فأخبره أني متَّبعه، ولكن لا أريد أن
أدع ملكي.
وبعث معه بدنانير إلى رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، فرجع، فأخبره، فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»: «كذب»، وقسم الدنانير([4]).
وعن سعيد بن أبي راشد قال:
لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله «صلى الله عليه
وآله» بحمص، وكان جاراً لي شيخاً كبيراً قد بلغ المائة أو قَرُبَ،
فقلت: ألا تحدثني عن رسالة رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى هرقل؟
فقال:
بلى، قدم رسول الله «صلى الله عليه وآله» تبوك، فبعث
دحية الكلبي إلى هرقل، فلما أن جاء كتاب رسول رسول الله «صلى الله عليه
وآله» دعا قسيسي الروم وبطارقتها، ثم أغلق عليه وعليهم الدار.
فقال:
قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم، وقد أرسل يدعوني إلى ثلاث
خصال: أن أتبعه على دينه، أو أن أعطيه مالنا على أرضنا، والأرض أرضنا،
أو نلقي إليه الحرب. والله لقد عرفتم فيما تقرأون من الكتب ليأخذن
أرضنا، فهلم فلنتبعه على دينه، أو نعطه مالنا على أرضنا.
فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من
برانسهم وقالوا:
تدعونا أن نذر النصرانية، أو نكون عبيداً لأعرابي جاء
من الحجاز؟
فلما ظن أنهم إذا خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم
رقاهم ولم يكد، وقال: إنما قلت ذلك لأعلم صلابتكم على أمركم([5]).
ثم دعا رجلاً من عرب تجيب كان على
نصارى العرب، قال:
ادع لي رجلاً حافظاً للحديث، عربي اللسان، أبعثه إلى
هذا الرجل بجواب كتابه.
فجاءني، فدفع إلي هرقل كتاباً، فقال:
اذهب بكتابي هذا إلى هذا الرجل، فما سمعته من حديثه،
فاحفظ لي منه ثلاث خصال: هل يذكر صحيفته التي كتب إلي بشيء؟
وانظر إذا قرأ كتابي هذا هل يذكر الليل؟
وانظر في ظهره هل فيه شيء يريبك؟
قال:
فانطلقت بكتابه حتى جئت تبوكاً، فإذا هو جالس بين
ظهراني أصحابه محتبياً على الماء، فقلت: أين صاحبكم؟
قيل:
ها هو ذا.
قال:
فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه، فناولته كتابي، فوضعه
في حجره، ثم قال: «ممن أنت»؟
فقلت:
أنا أخو (أحد) تنوخ.
فقال:
«هل لك في الإسلام، الحنيفية، ملة أبيك إبراهيم»؟
فقلت:
إني رسول قوم، وعلى دين قوم، [لا أرجع عنه] حتى أرجع
إليهم.
فضحك، وقال:
{إِنَّكَ
لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ}([6]).
يا أخا تنوخ، إني كتبت بكتاب إلى كسرى فمزقه، والله
ممزقه وممزق ملكه، وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فمزقها، والله ممزقه وممزق
ملكه.
وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها، فلن يزال الناس يجدون
منه بأساً ما دام في العيش خير.
قلت:
هذه إحدى الثلاث، التي أوصاني بها صاحبي، فأخذت سهماً
من جعبتي، فكتبتها في جفن سيفي.
ثم ناول الصحيفة رجلاً عن يساره،
قلت:
من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم؟
قالوا:
معاوية.
فإذا في كتاب صاحبي:
تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين،
فأين النار؟
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«سبحان الله أين النهار إذا جاء الليل».
قال:
فأخذت سهماً من جعبتي فكتبته في جفن سيفي، فلما فرغ من
قراءة كتابي قال: «إن لك حقاً، وإنك لرسول، فلو وجدت عندنا جائزة
جوزناك بها، إنا سفر مرملون».
قال قتادة:
فناداه رجل من طائفة الناس قال: أنا أجوزه، ففتح رحله،
فإذا هو بحلة صفورية، فوضعها في حجري.
قلت:
من صاحب الجائزة؟
قيل لي:
عثمان.
ثم قال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«أيكم ينزل هذا الرجل»؟
فقال فتى من الأنصار:
أنا.
فقام الأنصاري وقمت معه، حتى إذا خرجت من طائفة المجلس
ناداني رسول الله «صلى الله عليه وآله» فقال: «تعال يا أخا تنوخ».
فأقبلت أهوي حتى كنت قائماً في مجلسي الذي كنت بين
يديه، فحل حبوته عن ظهره وقال: «ها هنا امض لما أمرت له».
فجلت في ظهره فإذا أنا بخاتم النبوة في موضع غضروف
الكتف، مثل المحجمة الضخمة
([7]).
قال محمد بن عمر:
فانصرف الرجل إلى هرقل، فذكر ذلك له.
فدعا قومه إلى التصديق بالنبي «صلى الله عليه وآله»،
فأبوا حتى خافهم على ملكه، وهو في موضعه بحمص لم يتحرك ولم يزحف، وكان
الذي خبر النبي «صلى الله عليه وآله» من تعبئة أصحابه، ودنوه إلى وادي
الشام لم يرد ذلك ولا هم به([8]).
وذكر السهيلي:
أن هرقل أهدى لرسول الله «صلى الله عليه وآله» هدية
فقبل رسول الله «صلى الله عليه وآله» هديته، وفرقها على المسلمين
([9]).
ثم إن هرقل أمر منادياً ينادي:
ألا إن هرقل قد آمن بمحمد واتبعه، فدخلت الأجناد في
سلاحها وطافت بقصره تريد قتله، فأرسل إليهم: إني أردت أن أختبر صلابتكم
في دينكم، فقد رضيت عنكم، فرضوا عنه.
ثم كتب إلى رسول الله «صلى الله
عليه وآله» كتاباً مع دحية يقول فيه:
إني معكم، ولكني مغلوب على أمري، فلما قرأ رسول الله
«صلى الله عليه وآله» كتابه قال: «كذب عدو الله، وليس بمسلم بل هو على
نصرانيته».
ونقول:
إن لنا مع ما تقدم وقفات:
قد روى الراوندي:
هذا الحديث باختلاف ظاهر عما ذكرناه آنفاً، ففيه: أن
رسول قيصر كان رجلاً من غسان، وأن الثلاث التي أمره أن يحفظها هي: من
الذي يجلس على يمين النبي «صلى الله عليه وآله»، وعلى أي شيء يجلس،
وخاتم النبوة.
فوجد الغساني رسول الله «صلى الله عليه وآله» جالساً
على الأرض، وكان علي «عليه السلام» عى يمينه، ونسي الغساني الثالثة،
فقال له «صلى الله عليه وآله»: تعال، فانظر إلى ما أمرك به صاحبك، فنظر
إلى خاتم النبوة..
فعاد الغساني إلى هرقل، فأخبره بما
رأى وجرى، فقال:
«هذا الذي بشر به عيسى بن مريم، أنه يركب البعير،
فاتبعوه، وصدقوه».
ثم قال للرسول:
أخرج إلى أخي، فاعرض عليه، فإنه شريكي في الملك..
فقلت له:
فما طاب نفسه عن ذهاب ملكه([10]).
وليس في الرواية:
أن ذلك قد حصل في تبوك، بل فيها ما يدل على خلاف ذلك،
فإن ذكر أمير المؤمنين «عليه السلام» يدل على أن ذلك كان في المدينة،
لأنه «عليه السلام» لم يكن مع النبي «صلى الله عليه وآله» في تبوك،
لأنه خلفه في المدينة..
ولعل الرواة قد خلطوا بين ما حصل في تبوك من مراسلات،
وبين ما حصل في المدينة قبل ذلك، حين راسل «صلى الله عليه وآله» الملوك
ومنهم قيصر الروم.
على أن لنا أن نحتمل:
أن يكون النبي «صلى الله عليه وآله» قد كتب إلى ملك
الروم، ثم جاء جوابه مع دحية إلى تبوك، ثم جاء رسوله الآخر، وهو ذلك
الرجل التنوخي إلى المدينة، ولكن الرواة قد تعمدوا أو اجتهدوا، فذكروا
تبوك دون المدينة..
وقد ضمن النبي «صلى الله عليه وآله» الجنة لمن حمل
رسالته إلى ملك الروم.. ولعل هذا يشير إلى أن الناس كانوا يشعرون بخطر
عظيم من التوغل في بلاد الروم، ويرون أن من الصعب جداً وصول الرسول إلى
هرقل حياً. وحتى لو وصل إليه، فإن خطر أن يأمر ذلك الطاغية الغاضب
والحانق بقتل الرسول قائم، وجدي، لا سيما وأن مرسل الرسالة هو قائد هذا
الجيش العظيم الذي يقف عل مشارف بلاده، ويخشى أن ينقض عليها، وينقض ملك
ذلك الجبار، وربما ينتهي الأمر بقتله، والتعجيل بروحه إلى النار..
فلأجل ذلك كان ثمن الدخول في هذا الخطر العظيم والجسيم
هو الجنة، إذ لا شيء سواها يمكن أن يطمع به من يعرض نفسه للقتل..
غير أن لسائل أن يسأل هنا فيقول:
إذا كان الله يطلع نبيه على الغيب فلماذا لم يسترشد
النبي «صلى الله عليه وآله» من ربه سبحانه، ويستأذنه بإعلام هذا الرسول
بنجاته من شر هرقل، ومن شر الروم كلهم.. ويدفع بذلك الخوف عنه، ويكون
من ثم أكثر ثباتاً وإقداماً؟!.
ولنا أن نجيب:
بأنه «صلى الله عليه وآله» لا يريد أن يعوِّد أصحابه
على هذه الطريقة في التعامل مع الأمور، ومواجهة قضاياهم.. أي أنه لا
يريد لهم أن يتكلوا على الغيب إلى هذا الحد، فإن سلبيات هذه الطريقة
كثيرة وخطيرة، إذ هي تؤدي:
أولاً:
إلى حرمانهم من ثواب الجهاد في سبيل الله، وقصد القربة،
وثواب الخوف والتغرب، وحمل النفس وتوطينها على مواجهة الضرر والخطر..
ثانياً:
إن ذلك يجعلهم إتكاليين في مواجهاتهم، ويسلب منهم روح
الإبداع والخلاقية، ويمنعهم من التدبر في الأمور ومن التدبير الصحيح
والسليم..
ثالثاً:
إنه إذا مست الحاجة إلى ارتكاب المخاطر حتى الاستشهاد،
وكان العمل بالإستناد إلى الغيب، الذي يحتم تعريف الناس بمآل الأمور،
فقد لا نجد أحداً يقدم على ذلك باختياره، وسيظهر الفشل، وتحل الكارثة،
إما بسقوط الهكيل على رؤوس الجميع، وإما بالخسران في الآخرة.
رابعاً:
إن ذلك قد يختزن في داخله نزاعات، واعتراضات،
وانقسامات، وعداوات، وتشكيكات في المعصوم، تخرج الناس من الدين، وتؤدي
بهم إلى الردة، وإلى تركه ليواجه وحده المحنة والشدة.
بقي أن نشير إلى أن ذلك الذي تبرع بحمل الرسالة طمعاً
بالجنة، كأنه تخيل أنه لا يكون له ما وعد به رسول الله «صلى الله عليه
وآله» إلا إذا استجاب هرقل إلى دعوة النبي «صلى الله عليه وآله» وقبل
الإسلام..
فجاءه الجواب:
أن المطلوب منه هو مجرد إيصال الرسالة، وأن ذلك يكفي
لاستحقاق ما وعده به رسول الله «صلى الله عليه وآله».
وقد أجاب «صلى الله عليه وآله» على
السؤال عن مكان النار بقوله:
إذا جاء الليل فأين يكون النهار؟!
وهو كلام في غاية الدقة والأهمية، حيث إنه يتضمن حقيقة
علمية لم تكتشفها الأمم إلا في العصور المتأخرة، حيث أشار «صلى الله
عليه وآله» إلى كروية الأرض، لأن الليل إذا كان من جهة الأرض، فإن
الجانب الآخر يكون هو المقابل للشمس، ويكون النهار في ذلك الجانب..
بل هو يترقى إلى ما هو أهم من ذلك،
حيث يقرر أيضاً:
أن هذه المجرة السابحة، أو حتى منظومة المجرات نفسها
السابحة في الكون ربما تكون جميعها ككومة من حبات عنب، منظومة في عنقود
أو بدونه، إن هذه المجرات التي ربما تكون في حالة اتساع مستمر على
قاعدة:
{وَالسَّمَاءَ
بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ}([11]).
فإن الجنة إذا كانت في جهة من هذه المجرة، أو منظومة المجرات، فلتكن
النار في الجهة الأخرى، فإن ما يسبح في الفضاء أي جهة من جهاته توازي
الجهة الأخرى، وتقابلها تماماً كما يكون الليل في جهة من الأرض السابحة
في الفضاء والنهار في الجهة الأخرى.
إن الألفاظ إنما وضعت لمعانٍ يدركها الإنسان وهي
بالدرجة الأولى المعاني المحسوسة، بالبصر أو السمع أو اللمس.. ثم
المعاني القريبة من الحس، كالكرم، والشجاعة، والعدالة والغضب وغير ذلك
مما يرى دلائله، ويحس بآثاره. ثم هو يركِّب من هذه وتلك معانيَ جديدة،
ويستفيد منها في الإنتقال إلى ما هو أدق وأغرب.
ولكن القرآن يريد أن يوصل للإنسان معاني أسمى وأعظم مما
يخطر على باله، أو يمر في خياله.
وقد احتاج إلى أن يضعها في قوالب لفظية، كانت قد وضعت
لمعان مبتذلة وعادية، وقريبة ومحدودة؛ فكان عليه أن يتوسل لإيصال
الإنسان إلى تلك المعاني العالية بالمجازات والكنايات، والإستعارات،
واستعمال تراكيب مختلفة، وإشارات وتلميحات، ومختلف أنواع الدلالات.
فحين أراد مثلاً بيان حجم الكون..
قال أولاً:
هناك سماء وأرض، والسماء مأخوذة من السمو، وهو العلو..
ثم قال:
هناك سماء دنيا، وهي القريبة الدانية، وهناك سماوات
عُلى.
ثم ذكر:
أن السماوات سبع.
ثم قال:
إن جميع ما نراه من نجوم يسطع نورها، فإنما هو في
السماء الدنيا، فقال تعالى:
{وَزَيَّنَّا
السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ}([12]).
وحيث إنه قد يفهم من ذلك:
أن هذا يختص بالنجوم التي تظهر في الليل، لأن المصابيح
تكون في الظلمة، عاد فذكر في آية ثانية ما يفيد التعميم لكل كوكب حتى
للشمس التي تطلع في النهار، فقال:
{إِنَّا
زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ}([13]).
أو لعل كلمة «المَصَابِيحَ» توهم الاختصاص بما يكون
نوره نابعاً من ذاته، كما هو الحال في المصباح، فلا يشمل ما كان نوره
مكتسباً من غيره، فجاءت الآية الثانية لتفيد الشمول إلى كل ما يضيء،
سواء أكان في الليل أم في النهار، حيث عبرت بكلمة «الْكَوَاكِبِ» ثم
جاء التعبير بـ «الزينة» ليشير إلى أن هناك رؤية وتلذذاً، وإدراكاً
لهذه الحالة الجمالية «الزينة».
وإذا رجعنا إلى ما لدينا من
معلومات، فسنجد: أنهم يقولون:
إن هناك كواكب لم يصل نورها حتى الآن إلينا. وإن هناك
كواكب يحتاج نورها إلى ملايين السنين الضوئية ليصل إلينا، ثم هم
يقولون: إن الضوء يقطع ما يقارب الثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية.
فإذا ضممنا ذلك كله بعضه إلى بعض،
وعلمنا:
أنه كله في السماء الدنيا، فسندرك: أن حجم هذه السماء
لا يمكن أن يناله وهم أو خيال..
فكيف إذا جاء الحديث ليقول لنا:
إن السماء الدنيا بالنسبة للثانية كحلقة ملقاة في فلاة.
وإن السماء الثانية بالنسبة للثالثة كذلك.. وهكذا السماوات السبع في
الكرسي كذلك، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك..
كما أن الله تعالى قد قال:
{الَّذِي
خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً}([14]).
وقال
تعالى:
{أَلَمْ
تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً}([15]).
وصرح أيضاً بقوله:
{تَعْرُجُ
المَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ}([16]).
وقال تعالى:
{وَالسَّمَاء
بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ}([17]).
وذلك كله يظهر لنا:
أن القمر الذي يبعد عن الأرض أقل من ثانية ونصف بحسب
مسيرة الضوء، لا يعد بعيداً، بل هو أقرب من قريب.. وكذلك سائر الكواكب
التي يفكر الإنسان بالوصول إليها كالمريخ والزهرة ونحوها، ولا يعد هذا
البعد شيئاً ذا بال في حساب مسافات السماء الدنيا، فضلاً عن السماوات
العلى..
هذا وقد ذكرت الآية الشريفة:
{يَا
مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا
مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ
إِلَّا بِسُلْطَانٍ}([18])،
أن الإنسان قادر على اختراق أقطار السماوات والأرض كلها، والخروج من
دائرتها إلى عالم جديد، لأنه تعالى قد حدد للإنسان طبيعة المانع، وسماه
له، وأخبره أنه إن تغلَّب عليه فسيتمكن من الخروج من جميع جهات
السماوات والأرض، لا من جهة واحدة وحسب، ولذلك قال «مِنْ أَقْطَارِ».
فمن وصل إلى القمر لا يكون قد خرج من دائرة السماوات،
أو اخترقها من أقطارها وجوانبها المختلفة، بل يكون في بداية انطلاقته
إلى مسافات تحتاج إلى مليارات المليارات التي لا تنتهي من السنين
الضوئية، ليقترب حتى من بعض الكواكب البعيدة نسبياً في السماء الدنيا،
فضلاً عن غيرها من السماوات..
وبعد كل هذا الذي ذكرناه من حقائق مثيرة وعظيمة وهائلة
نقول:
لا شك في أن الأرض واقعة في محيط السماء الدنيا، في هذه
المجرة، ولكن أين هي السماوات السبع، والكرسي، والعرش، وسدرة المنتهى؟!
وكيف يكون موقعها بالقياس إلى الأرض؟!
هل تكون مثل طبقات البصلة التي يحيط بعضها ببعض؟!
أم هي منظومات هائلة من المجرات المختلفة.. يقع بعضها
إلى جانب البعض الآخر، على نحو الاستطالة، أو الاجتماع المنتظم في صعيد
واحد.. أو التفرق
غير
المنتظم؟!..
إن تحديد ذلك كله لا يدخل في نطاق قدراتي شخصياً، ولا
أدري إن كان ثمة من يستطيع أن يعطي تصوراً حاسماً في هذا المجال، سوى
الإمام المهدي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين
الطاهرين..
غير أن من المقطوع به:
أن السماء الدنيا محيطة بالأرض، وبكل ما يقع في
داخلها.. ولكن إحاطتها لا تعني استدارتها
في مجموع تكوينها.. كما أن موقعها بالنسبة إلى سائر السماوات لا يمكن
تحديده كم أسلفنا.
وقد ظهر من جميع ما تقدم:
أن مجموع السماوات والأرض وكل ما تحويه من مجرات إن هي
إلا سابحة في الفضاء، وهو محيط بها من كل جانب.
تقدم:
قولهم إن هرقل لم يكن يهمُّ بالذي بلغ النبي «صلى الله
عليه وآله» عنه، ولا حدثته نفسه بذلك..
ونقول:
إننا قد نقبل من هؤلاء أن يقولوا:
إن فلاناً لم يفعل الشيء الفلاني، لأن المعرفة بصدور
ذلك منه أو عدم صدوره قد تكون متيسرة في كثير من الأحيان، ولا سيما إذا
كان ذلك الأمر جمع الجيوش، والتهيؤ للحرب، وغير ذلك من الأمور التي لا
تخفى عادة.
ولكننا لا نقبل من أحد أن يقول لنا:
إن فلاناً لم يهم بالأمر الفلاني، لأن الهمَّ بالشيء
فعل قلبي قد تصاحبه بعض الحركات باتجاه ما يهم به، وقد يخلو عنها.
وأما أن يقول قائل لنا:
إن فلاناً لم تحدثه نفسه بالشيء الفلاني، فذلك ما
لايمكن قبوله من أحد إلا من نبي، أو وصي نبي، لأنه قول يستبطن العبث
بنا، والإستخفاف بعقولنا، وهذا ما لا نرضاه لأنفسنا، لأنه من إنسان لم
يطلعه الله على غيبه، ولا أوقفه على ما يكنه ضمائر عباده.
وقد عرفنا فيما سبق حين الكلام حول مراسلات النبي «صلى
الله عليه وآله» لملوك الأرض في سنة ست: أنه «صلى الله عليه وآله» كتب
إلى ملك الروم بعنوان: «إلى عظيم الروم» وكتب إليه في تبوك بعنوان:
«صاحب الروم».
ولا ندري هل هذا هو نفس الملك السابق، أم أن ذاك قد مات
أو عزل، وحل محله ملك آخر احتاج النبي «صلى الله عليه وآله» إلى
الكتابة إليه، كما كان الحال بالنسبة للنبي «صلى الله عليه وآله» مع
ملك الحبشة؟
غير أن ما رأيناه في الحالتين:
أنه «صلى الله عليه وآله» لم يخاطبه بصفة «ملك»، ربما
لكي لا يتوهم أحد أن ذلك يمثل إقراراً من نبي لا ينطق عن الهوى بالملك
له، ثم يشيعون: أن هذا يثبت له حقاً منحه الله تعالى إياه، ويتخذ ذلك
ذريعة لخداع السذَّج والبسطاء من الناس.
ولا شك في أن رسالة النبي «صلى الله عليه وآله» إلى
هرقل كانت في غاية الدقة. وهي رسالة هادئة وحازمة، وقد راعت أهداف
الإسلام، من دون أن تعطي ذلك الطاغية أية ذريعة للتمرد، أو اللامبالاة،
كما أنها لم تخلَّ بشرط الإختيار، والحرية لطاغية الروم، فقد خيره بين
أمور لم يذكر له الحرب، ولا إبرام العهد..
ولكن هرقل تخلص أولاً من دحية الكلبي بكذبة كان يعرف
أنها لا تنفع مع النبي «صلى الله عليه وآله»، حين زعم له أنه قد أسلم.
ثم هيأ رسولاً آخر، يستطيع أن يأتيه بالمعلومات التي
يحتاج إليها، ولكنه على ما يظهر أراد أن يطمئن إلى ولاء قومه، وطاعتهم
له.. فعقد جلسة مع قسيسي الروم وبطارقتها وأخبرهم بالخيارات التي كتب
بها إليه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وقد بهرج الكلام بحيث أثار
حفيظتهم، وأيقظ عنجهيتهم الدينية أولاً، حين وضعهم وهم بطارقة وقسيسون
أمام خيار قبول الإسلام، والحال أنهم يرون أن كل ما لديهم هو نتيجة
الإلتزام بالنصرانية، والتسويق لها، فالتخلي عنها معناه الخسارة لكل
شيء.
فلم يبق أمامهم إلا خيار قبول الجزية أو والسيف، وقد
عرض عليهم إعطاء الجزية بصورة تحريضية على الرفض، من خلال ما يثيره
فيهم من شعور بالمظلومية.. حيث قال لهم: «أو أن أعطيه مالنا، والأرض
أرضنا».
ثم إنه قد صعَّد من لهجته التحريضية، التي تسوقهم إلى
المقاومة بشراسة وبقسوة حين قال لهم مرة أخرى: «ليأخذن أرضنا».
ثم قال لهم ثالثة:
«فلنتبعه على دينه، أو نعطه مالنا على أرضنا»..
ويذكرنا هذا الأسلوب بما فعله فرعون «لعنه الله» في
مواجهة موسى «عليه السلام»، وذلك حين كان الحوار يجري بينهما لإبطال
ادِّعاء فرعون للألوهية، فأظهر الله تعالى المعجزة على يد موسى «عليه
وعلى نبينا وآله السلام»، بانقلاب العصا إلى ثعبان، وظهور يده البيضاء،
لكن فرعون
{قَالَ
لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ: إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ
يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ..}([19]).
ثم أكد لهم ذلك بإعلانه خروجه عن دائرة الصراع، وإيكال
أمر اتخاذ القرار في حق موسى «عليه السلام» إليهم، لأن الأمر يعنيهم،
والقضية قضيتهم، وهو إنما كان يساعدهم على درء الخطر فقال لهم:
{فَمَاذَا
تَأْمُرُونَ}؟([20]).
وقد جاءت النتائج وفق ما خطط له قيصر، فقد «نخروا نخرة
رجل واحد، حتى خرجوا من برانسهم، وقالوا: تدعونا أن نذر النصرانية، أو
نكون عبيداً لأعرابي جاء من الحجاز»؟
فلما اطمأن إلى أنه قد نال ما أراد بادر إلى استيعابهم
من جديد، فطمأنهم إلى أنه إنما أراد أن يختبرهم، ويقف على مدى صلابتهم.
قد يعترض على النصوص المتقدمة بأنها
تقول:
إنه «صلى الله عليه وآله» قال لرسول ملك الروم: «وكتبت
إلى النجاشي بصحيفة فمزقها، والله ممزقه وممزق ملكه».
مع أن الروايات تقول:
إن النجاشي أسلم على يد جعفر بن أبي طالب، وإنه قد مات
في حياة النبي «صلى الله عليه وآله». فصلى عليه النبي «صلى الله عليه
وآله»، بعد أن رفع الله له كل خفض، وخفض له كل رفع، حتى رأى جنازته
أمامه..
والجواب:
أن هذا الذي مات اسمه أصحمة، وليس هو المقصود بكلام
رسول الله «صلى الله عليه وآله»، بل المقصود هو الذي تولى بعده، ويقال
له «النجاشي» أيضاً، لأن هذه الكلمة هي لقب ملك تلك البلاد كما يقال:
كسرى وقيصر لِمَلَكَيْ الروم والفرس..
ونعتقد:
أن ما جرى في مؤتة على يد القادة الثلاثة الذين
استشهدوا كان له أكبر الأثر في قرارات هرقل، وكل بطارقته وأعوانه، فقد
رأيناه مذبذباً يسعى إلى التملص، والتخلص من المواجهة، فيزعم للنبي
«صلى الله عليه وآله» في بادئ الأمر أنه على
دينه، ويرسل إليه هدية..
ثم يرسل له رسالة أخرى، يحاول فيها أن يطرح بعض
الأسئلة، ربما بهدف تسويف الوقت، وعدم إفساح المجال لإلزامه بشيء..
ولكن ما لا بد من الوقوف عنده ملياً
هو:
أن قيصر كان لا يزال يعيش نشوة النصر على كسرى قبل نحو
سنتين، ويرى نفسه أنه يملك نصف الدنيا، وكانت حتى بلاد الشام، وفلسطين
والأردن، وسواها من بلاد العرب خاضعة لسلطانه، وتدين بالولاء له.
وكان يستطيع أن يزحف بمئات الألوف من الجيوش المجهزة
بأفضل الأسلحة، ليواجه بها عربياً يعيش في صحراء الحجاز، لا يملك من
المال ما يهيء به نعالاً لجيشه الذي يريد أن يخترق به تلك الصحراء
الشاسعة ليتقي بها ذلك الجيش حر الرمضاء، فيضطر الكثيرون منه إلى قطع
تلك المسافات مشاة وحفاةً.
إن هرقل هذا لا يجرؤ على التفوه بكلمة «لا» أمام دعوة
رسول الله «صلى الله عليه وآله» له، رغم أنه يدعوه وقومه إلى إعطاء
الجزية عن يد وهم صاغرون..
ولم يحدث في تاريخ طواغيت الأرض وعتاتها أن تأتي عساكر
أعدائهم لتقف على تخوم بلادهم، وهي ثلة قليلة العدد ضعيفة العدة، ثم
يسكتون ولا يحركون ساكناً، وكأن شيئاً لم يكن، مع قدرتهم على تجنيد
عشرة أضعاف ذلك العدو بأفضل عدة، وأتم وأوفى عدد!!
بل تراه يتحايل على ذلك العدو، ويرسل له بالهدايا،
وبالكلمات المعسولة، حتى إنه ليدَّعي ـ كاذباً ـ الإنقياد له، والقبول
به، والتبعية والطاعة لكل ما يأمر به وينهى عنه.
ثم يتبع ذلك بما يشير إلى أنه بصدد التأكد من أمر
النبوة، وأنه يبحث عن الحقيقة، لكي يسلب منه القدرة على التصميم على
مهاجمته، وليحرجه في قرار المضي بالحرب معه، أو في التوغل في بلاده، لو
أنه فكر في ذلك، لأنه كان يعلم أنه لا يمكن للنبي «صلى الله عليه
وآله»أن يتخذ قراراً كهذا في حق من يظهر أنه يبحث عن الحق، ويتلمس
دلائله..
والذي يبدو لنا:
هو أن سبب هذا الإستخذاء من هرقل، ومن أصحاب القرار في
مملكة الروم هو ما جرى في مؤتة..
فهي قد عرَّفت قيصر، ومن معه:
أن الأمر في أية مواجهة مع هذا النبي الكريم «صلى الله
عليه وآله»، سيكون بالغ الخطورة، إن لم نقل: إنهم كانوا على يقين من
أنه لن يأتي لهم بغير الخزي والعار، والذل والصَّغار، والهزيمة
النكراء، والفضيحة الصلعاء..
إذ إن مئات الأولوف التي جاء بها قيصر إلى حرب مؤتة قد
واجهت ثلاثة آلاف فقط من المسلمين، وكان من المتوقع: أن يسقط أكثر
المسلمين صرعى في أول ساعة بل في الدقائق الأولى من المعركة، حيث لا بد
أن تتناهبهم سيوف ورماح مئات الألوف من الرجال، إن لم نقل: إن الحجارة
كانت تكفيهم، لتبيد جميع أعدائهم وتفنيهم..
ولكن ما حصل كان نقيض ذلك، فإن الحرب لم تنته في
اللحظات الأولى، بل طالت ربما لأيام، ولم يسقط فيها من الشهداء سوى عدد
ضئيل جداً، لا يتجاوز السبعة أشخاص، كان القادة الثلاثة منهم، ولولا
الهزيمة التي فرضها عليهم خالد بن الوليد، فلربما بلغ السيل الزبى،
والحزام الطبيين.. والذين قتلوا من غير القادة لعلهم قتلوا بعد فرار
خالد بالمسلمين، أو على الأقل لا يمكن تأكيد قتلهم في ساحة المعركة قبل
ذلك.. وقد كان هذا، والحال أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يكن
معهم.. فلو كان «صلى الله عليه وآله» معهم، فكيف ستكون عليه الحال
والمآل..
ولعل قيصر وأهل الروم قد سمعوا بمعاقبة النبي «صلى الله
عليه وآله» والمسلمين للعائدين من مؤتة، حتى لقد حثوا في وجوههم
التراب، واستقبلوهم بما يكرهون، وقد قاطعهم وعاداهم أهلهم وذووهم
وإخوانهم، وحتى نساؤهم ومحبوهم.. ولم يقل لهم أحد: «الحمد لله على
سلامتكم»..
وها هو قيصر يرى عشرة أضعاف الثلاثة آلاف، ومعهم
قائدهم، ورائدهم وسيدهم الذي يقدسونه، ويفدونه بأنفسهم، فأي جيش يمكن
أن يواجه هؤلاء وينتصر عليهم، ولذلك اتخذ قرار الخداع دون الإنصياع،
والمخاتلة والمماطلة، بديلاً عن المواجهة والمقابلة..
ولا يبعد أن حصول هرقل على أخبار إلهية من كتب سماوية
وصلت إليه تتحدث عن شأن النبي «صلى الله عليه وآله» هو الذي اضطره
لاتخاذ الإجراءات التي اتخذها، أو كان عاملاً مؤثراً في ذلك.
وإن أقبح أنواع الإستكبار هو ذلك الذي ينضح بالغباء
البغيض المهلك، ويضج بالسماجة المقيتة والمميتة، ولعل استكبار أولئك
الأساقفة والبطارقة، والذي وافقهم عليه ملكهم أوضح مثال على ما نقول..
إذ لا معنى لأن يستكبر هؤلاء على نبي يجدونه مكتوباً عندهم في إنجيلهم
وتوراتهم، وعلى رجل لا يريد أن يستعبدهم، بل يريد أن يحررهم من عبادة
الشيطان، ومن العبودية للأكاسرة والقياصرة، والطواغيت والجبابرة.. ومن
أسر الشهوات، وحب الدنيا، وينطلق بهم نحو الله، ليكونوا أحراراً في
دنياهم، سعداء في آخرتهم..
ويا ليتهم يقدمون التبرير المقبول
والمعقول لذلك، بل ذكروا:
أن سبب رفضهم للإنقياد له هو كونه قد جاءهم من الحجاز،
معتبريه أعرابياً، والحال أنهم لم يروه، ولم يسمعوا كلامه، ولا شاهدوا
معجزته.. وذلك هو الإستكبار السمج والغبي بكل تأكيد، وأغبى منهم من قبل
منهم، ورضي عنهم، وانقاد لمشورتهم، مع علمه ببوار حجتهم، وفيال رأيهم..
وهو قيصر بالذات لأن هذا الرجل قد أعلمهم مسبقاً أن هذا الحجازي هو
الذي أخبرتهم به كتبهم، وعرفتهم أنه سوف ينتصر عليهم، إن عاجلاً، وإن
آجلاً، فما هذه المكابرة، ولماذا المخاطرة؟!. إذن..
وقد أتم الله الحجة على قيصر، وأظهر الله تعالى كذبه
وخداعه، وأنه يماطل ويخاتل حين أرسل ذلك التنوخي برسالته إلى النبي
«صلى الله عليه وآله»، لأنها قد دلت على أنه قد كذب فيما قاله لدحية من
أنه متبع للنبي «صلى الله عليه وآله»، ولكن لا يريد أن يدع ملكه، وقد
تمت الحجة عليه بما عرفه من كتبهم التي أخبرتهم عن رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، وبما بلغه عنه «صلى الله عليه وآله» من معجزات وكرامات
وحالات، ثم بما عاينه من صنع الله لنبيه «صلى الله عليه وآله» في غزوة
تبوك.. ثم بما عاينه مبعوثه، وأخبره به، حيث وجد ذلك المبعوث صحة كل ما
أوصاه باستكناهه، وكشف حقيقته، بدءاً من:
1 ـ
ذكره «صلى الله عليه وآله» لصحيفته، وإخباره بما يجري
على كسرى، والنجاشي، وبما يؤول إليه أمر قيصر.. وصولاً إلى:
2 ـ
إجابته «صلى الله عليه وآله» على سؤاله عن مكان النار
والجنة، وانتهاءً بـ:
3 ـ
مشاهدة مبعوثه خاتمَ النبوة، بعد أن ذكَّره النبي «صلى
الله عليه وآله» به، إذ قد يظهر أنه كان قد نسيه..
وقد صرح النبي «صلى الله عليه
وآله»:
بأن قيصراً يكذب فيما يدعيه، فقد قال حين أخبره دحية
بما قاله له: «كذب».
ولما قرأ كتابه أيضاً قال:
«كذب» «عدو الله» «وليس بمسلم» «بل هو على نصرانيته»..
ورغم ذلك كله، تجد أن المؤرخين يوردون قضية هرقل في
سياق يظهر نفس ما كان يريد هرقل أن يخدع به رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، وتصوير أنه مغلوب على أمره، وأنه.. وأنه.. فهل هذا غباء؟!. أم
أنهم ممن أضلهم الله تعالى على علم؟!. أم الإثنان معاً؟!
وقد تقدم:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» دعا ذلك التنوخي
للإسلام، فلم يقبل بحجة أنه رسول قوم، وعلى دينهم، ولا يرجع عن دينه
حتى يرجع إليهم..
وهي حجة واهية، وغير منطقية، فإن كونه رسولاً لا يمنع
من قبول الحق، والإلتزام بالهدى الإلهي، ولا سيما بعد أن رأى البينات
بأم عينيه، فقد رأى خاتم النبوة، وسمع إخباره عما فعله قيصر بالصحيفة
التي أرسلها إليه، وعما يجري للنجاشي، وكسرى، وسمع وسجل إجابته على
السؤال حيث طابقت تلك الإجابة ما أخبره به قيصر الذي أرسله..
وعاين سلوك النبي «صلى الله عليه وآله» وأخلاقه مع
الناس عن قرب، حتى إنه لم يستطع أن يميزه من بينهم، حتى احتاج للسؤال
عنه، فقال: أين صاحبكم؟ ولم يقل: من هو صاحبكم؟ وكأنه قد ظن أنه غائب،
مع أنه يأتي من قبل أحد الملوك، ويعرف كيف يعامل الملوك رعاياهم، وما
هي حقيقة تعامل رعاياهم معهم ..
وقد ورد في كتاب النبي «صلى الله
عليه وآله» قوله لهرقل:
«..وإلا..»، أي إن لم تدخل في الإسلام، ولم تعط الجزية،
«فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه، أو يعطوا
الجزية..».
قال أبو عبيد:
«لم يرد الفلاحين خاصة، ولكنه أراد أهل مملكته جميعاً،
وذلك أن العجم عند العرب كلهم فلاحون، لأنهم أهل حرث وزرع، لأن كل من
كان يزرع، فهو عند العرب فلاح، إن ولي ذلك بنفسه، أو وليه له غيره»([21]).
فهذا الشرط من جهةٍ يتيح للنبي «صلى الله عليه وآله» أن
يتعامل مع الناس مباشرة، من دون تدخل من قبل هرقل.
ومن جهة أخرى فإن النبي «صلى الله عليه وآله» في مقابل
ذلك يعفي هرقل من الجزية، ومن الحرب..
وذلك من شأنه:
أن يمكن النبي الكريم والعظيم «صلى الله عليه وآله» من
مخاطبة الناس، وعرض دعوته عليهم، ويكونون هم الذين يقررون الدخول في
دينه، أو إعطاء الجزية. إذ إن خيار الحرب ليس هو الخيار المفضل عند
رسول الله «صلى الله عليه وآله»، بل هو خيار يأتي على قاعدة: آخر
الدواء الكي، والأمر الأهم بالنسبة لرسول الله «صلى الله عليه وآله» هو
استعادة حرمة الناس، وكرامتهم، وخياراتهم من سالبيها، حيث إنهم يمنعون
الناس حتى من أن يفكروا، ومن أن يعتقدوا، ومن أن يخاطبوا هذا الفريق أو
ذاك.
فإذا أراد هرقل أن يميز نفسه عنهم، ويرفض أن يختار
لنفسه ما يختارونه لأنفسهم، فذلك شأنه، فإذا كف عن ظلمهم المتمثل
بمنعهم من ممارسة حريتهم الفكرية والإعتقادية، فإنه وإن كان الكف عن
الظلم واجباً عليه، ولكن النبي «صلى الله عليه وآله» أراد أن يزيد في
إحسانه له بالسكوت عن مطالبته بالجزية، والإمتناع عن مواجهته بالحرب..
فظهر مما ذكرناه:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أظهر أنه سيكون
رفيقاً بقيصر محسناً إليه، إذا كف قيصر عن ممارسة القهر والظلم لشعبه،
وتخلى عن مصادرة حرياتهم..
وقد كان الملوك ولا يزالون يميزون أنفسهم عن رعاياهم،
ويرون أنه يحق لهم ما لا يحق لغيرهم.. ولكن حكم الإسلام هو أنه لا فضل
لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ولا فرق بينهم في العبادات، ولا في
المعاملات، ولا في الحقوق، ولا في الحدود..
وعلى هذا الأساس جاء قول رسول الله «صلى الله عليه
وآله» في رسالته إلى هرقل: «فإن أسلمت فلك ما للمسلمين، وعليك ما
عليهم»، ولم يقل له: إن أسلمت فلك كذا وكذا من المال، أو أنني أجعلك
وزيراً لي، أو أوليك على البلد الفلاني، أو ما شاكل ذلك..
واللافت في هذه الرسالة، وسائر
رسائله إلى الملوك:
أنه «صلى الله عليه وآله» يخاطب أولئك الملوك بما هم
أفراد، فيميزهم بذلك عن غيرهم من الناس، فهو لم يكتب لقيصر مثلاً
عبارة: أسلموا تسلموا، أو إن أسلمتم فلكم كذا، وإن امتنعتم، فعليكم
كذا، بل قال له هو: أسلم تسلم، وقال: فإن أسلمت الخ..
وذلك أولاً:
لأنه لا يريد أن يعترف له بأنه يمثل أحداً من الناس،
حتى لو كانوا قومه، ومن يعتبرهم هرقل رعية له.
وثانياً:
لأنه إن أسلم، فسيلتزم بتعاليم الشريعة التي منها ترك
الحرية للناس في أن يختاروا دينهم، وسيتعامل معهم وفق ما يختارونه،
وسيطبق عليهم أحكام الله، لأن الإيمان والإلتزام به، والعمل بمقتضاه،
والكفر والجحود هو فعل ومسؤولية الأشخاص، وهم الذين يواجهون آثار
وتبعات ما يختارونه من ذلك..
ولكن الملوك يمثلون ـ في العادة ـ العقبة الكأداء أمام
ممارسة الناس لحقهم، فيحتاج الأمر إلى مخاطبتهم أولاً، من دون أن يكون
لهذا الخطاب أي تأثير على حق الرعية.. حسبما أوضحناه..
وكان أهل أيلة يهوداً، فلما بعث رسول الله «صلى الله
عليه وآله» خالد بن الوليد إلى أكيدر بدومة ـ كما بيناه في السرايا ـ
أشفق ملك أيلة، يحنة بن رؤبة أن يبعث إليه رسول الله «صلى الله عليه
وآله» كما بعث إلى أكيدر، فقدم على النبي «صلى الله عليه وآله»، وقدم
معه أهل جربا وأذرح ومقنا، وأهدى لرسول الله «صلى الله عليه وآله» بغلة([22]).
وعرض عليه «صلى الله عليه وآله» الإسلام، فلم يسلم([23]).
قال أبو حميد الساعدي:
قدم على رسول الله «صلى الله عليه وآله» ابن العلماء،
صاحب أيلة بكتاب، فأهدى إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» بغلة
بيضاء، وكساه رسول الله «صلى الله عليه وآله» برداً، وكتب له رسول الله
«صلى الله عليه وآله» ببحرهم
([24]).
وعن الواقدي قال:
رأيت يُحَنَّة بن رؤبة يوم أُتي به رسول الله «صلى الله
عليه وآله» وعليه صليب من ذهب، وهو معقود الناصية، فلما رأى رسول الله
«صلى الله عليه وآله» كفَّر (أي وضع إحدى يديه على الأخرى)، وأومأ
برأسه، فأومأ إليه رسول الله «صلى الله عليه وآله» بيده أن ارفع رأسك.
وصالح النبي «صلى الله عليه وآله» يُحنة يومئذ، وكساه
برداً يمنية، فاشتراه بعد ذلك أبو العباس عبد الله بن محمد بثلاثمائة
دينار، وأمر له بمنزل عند بلال انتهى([25]).
كتابه
 ليُحَنَّة:
ليُحَنَّة:
قالوا:
وقطع رسول الله «صلى الله عليه وآله» الجزية، جزية
معلومة، ثلاثمائة دينار كل سنة، وكانوا ثلاثمائة رجل، وكتب لهم بذلك
كتاباً فيه:
«بسم الله الرحمن الرحيم:
هذا كتاب أمنة من الله تعالى، ومحمد النبي رسول الله
ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة، لسفنهم وسائرهم، السارح في البر والبحر، لهم
ذمة الله وذمة رسوله «صلى الله عليه وآله»، ولمن كان معهم من أهل
الشام، وأهل اليمن، وأهل البحر. ومن أحدث حدثاً فإنه لا يحول ماله دون
نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه،
ولا طريقاً يردونه من بر أو بحر».
هذا كتاب جهيم بن الصلت، وشرحبيل بن حسنة، بإذن رسول
الله «صلى الله عليه وآله»([26])..
كتابه
 لأهل
أذرح وجربا: لأهل
أذرح وجربا:
وكتب رسول الله «صلى الله عليه وآله» لأهل أذرح كتاباً،
وكانوا يهوداً أيضاً، وقد أعطاهم الأمان فيه، وفرض عليهم الجزية، وفيما
يلي نص الكتاب:
«بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كتاب محمد النبي «صلى الله عليه وآله» لأهل أذرح
وجربا، إنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد، وأن عليهم مائة دينار في كل
رجب وافية طيبة، والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان إلى المسلمين، ومن
لجأ من المسلمين من المخافة والتعزير، إذا خشوا على المسلمين فهم
آمنون، حتى يحدث إليهم محمد «صلى الله عليه وآله» قبل خروجه».
قالوا:
وأتى أهل جربا وأذرح بجزيتهم بتبوك فأخذها»([27]).
كتابه
 لأهل
مقنا: لأهل
مقنا:
وصالح رسول الله «صلى الله عليه وآله» أيضاً أهل مقنا
على ربع ثمارهم، وربع غزولهم. وكانوا قد وفدوا إليه مع يُحنّة عظيم
إيلة، وكنا قد أشرنا إلى كتابه في أوائل كتابنا هذا، حيث تحدثنا عن:
أعمال تأسيسية في مطلع الهجرة، حيث بحثنا موضوع وضع التاريخ الهجري..
وقد ذكرنا هناك:
أن الظاهر هو: أنه «صلى الله عليه وآله» قد كتب لهم هذا
الكتاب في المدينة، ولعلهم وفدوا إليه مرة أخرى بعد عودته إليها، لأن
كاتب الكتاب هو علي بن أبي طالب «صلوات الله وسلامه عليه»، وهو لم يكن
في غزوة تبوك..
ونص الكتاب هو التالي:
«بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد رسول الله إلى بني حبيبة وأهل مقنا:
سلم أنتم، فإنه أنزل علي أنكم راجعون إلى قريتكم، فإذا
جاءكم كتابي هذا فإنكم آمنون، ولكم ذمة الله وذمة رسوله، وإن رسول الله
قد غفر لكم ذنوبكم، وكل دم اتبعتم به، لا شريك لكم في قريتكم إلا رسول
الله، أو رسول رسول الله، وإنه لا ظلم عليكم ولا عدوان، وإن رسول الله
«صلى الله عليه وآله» يجيركم مما يجير منه نفسه، فإن لرسول الله بزتكم
ورقيقكم، والكراع والحلقة إلا ما عفا عنه رسول الله أو رسول رسول الله،
وإن عليكم بعد ذلك ربع ما أخرجت نخيلكم، وربع ما صادت عرككم، وربع ما
اغتزلت»([28]).
وقالوا أيضاً:
لما خرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» سنة تسع إلى
تبوك، حين سمع باجتماع طوائف من الروم، وعاملة، ولخم، وجذام لحربه، سمع
بذلك مالك بن أحمر الجذامي، فوفد إليه، فقبل «صلى الله عليه وآله»
إسلامه، وسأله مالك أن يكتب له كتاباً يدعو قومه به إلى الإسلام، فكتب
في رقعة أدم عرضها أربعة أصابع، وطولها قدر شبر([29])..
ونص الكتاب:
«بسم الله الرحمن الرحيم:
هذا كتاب من محمد رسول الله لمالك بن أحمر، ولمن تبعه
من المسلمين أماناً لهم ما أقاموا الصلاة، وآتو الزكاة، واتبعوا
المسلمين، وجانبوا المشركين، وأدوا الخمس من المغنم، وسهم الغارمين،
وسهم كذا وكذا، فهم آمنون بأمان الله عز وجل، وأمان محمد رسول الله([30])..
ونقول:
إن لنا مع ما تقدم الوقفات التالية:
والظاهر:
أن لجذام وفدين إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»:
أحدهما:
حيث كان «صلى الله عليه وآله» في تبوك، فجاءه مالك بن
أحمر وقومه من بني عوف من جذام، فكتب له الكتاب المتقدم.
الثاني:
وفد رفاعة بن زيد الجذامي، فقد وفد على رسول الله «صلى
الله عليه وآله» إلى المدينة مع رهط من بني صبيبة من جذام.
ويلاحظ هنا:
أن من جملة بركات مسير تبوك هو: أن الله تعالى قد ألقى
الرعب في قلوب أعداء الله، فبادروا إلى إعلان إسلامهم أو استسلامهم،
فكانت هذه المعاهدات مع الفئات المختلفة، هي النتيجة الطبيعية لذلك،
ووفد إليه أهل مقنا، وإيلة، وجربا، وأذرح، ومالك بن أحمر وقومه يطلبون
العهد والأمان، وفتح الله دومة الجندل، وما إلى ذلك..
يضاف إلى ذلك كله،
رعب الروم وعمالهم، وسائر القبائل المعادية، مثل عاملة،
ولخم، وجذام، وسائر الذين جمعوا الجموع، وأرادوا مهاجمة المسلمين..
وقد صرحت الروايات:
بأن الكتاب الذي طلبه مالك بن أحمر، قد أراد أن يدعو
قومه به..
ويلاحظ:
أن ما كتبه رسول الله «صلى الله عليه وآله» لهم، هو نفس
ما كتبه لغيرهم، وهو: أن يلتزموا بأحكام الدين، وأن يكونوا مع
المسلمين، ويتركوا المشركين..
وهذا يدل على:
أن هذا الدين لا يحتاج إلى أي جهد لإقناع الناس به، بل
إن مجرد عرض نفس حقائقه وأحكامه يكفي للرغبة فيه والتعلق به، والزهد
بغيره إلى حد النفور..
والأمان الذي جعله رسول الله «صلى الله عليه وآله»
لمالك بن أحمر وقومه هو أمان الله تعالى أولاً. الذي يكفي في الحصول
عليه أن يلتزموا بأحكام الدين، كما أن أمان رسول الله «صلى الله عليه
وآله» لا يحتاج إلى أكثر من ذلك.. فهو إذن لم يطلب لنفسه شيئاً، بل ما
طلبه يعود نفعه إليهم..
وحين كفَّر رؤبة (أي وضع إحدى يديه على الأخرى) أمام
النبي «صلى الله عليه وآله» وأومأ برأسه، لم يوافق فعله هذا رضى من
رسول الله، لأنه «صلى الله عليه وآله» يريد أن يكون الإحترام والتعظيم
من منطلق الوعي للقيمة الأخلاقية والإنسانية التي تعطي القيمة للإنسان
الذي يعيش إنسانيته، والإرتباط بالله تبارك وتعالى بصدق، وبإخلاص.
أما إذا كان الإحترام للإنسان، لأنه غني، أو قوي أو ذو
جاه وشوكة، وسلطان، فالإحترام ليس لإنسانيته، وإنما لماله، ولقوته،
وخوفاً من سلطانه وهيبة لموقعه وجاهه.. وما إلى ذلك..
كما أنه «صلى الله عليه وآله» يرى أن الخضوع والخشوع،
لا بد أن يكون لله تبارك وتعالى لا لسواه.. وأن الجميع سواسية أمامه
سبحانه، وأن هذه الطاعة له سبحانه تغني عن كل ما عداها.. فكل ما يكون
لغيره فلا بد أن ينتهي إليه، ويكون من خلاله تعالى، وإلا فهو باطل
وزائف، لأن قطع الصلة بين أي شيء وبين الله تعالى، سوف يفقده قيمته،
ويسقط معناه..
إنهم يقولون:
إن أهل أيلة، وجربا وأذرح، وسواها، كانوا يهوداً فما
معنى أن يكون على يُحَنَّة صليب من ذهب، والحال أن النصارى هم الذين
يعتمدون الصليب؟!
هذا.. وقد تضمن كتابه «صلى الله عليه وآله» ليحنة وأهل
إيلة الأمان لهم ولأنفسهم، وأموالهم وقوافلهم، وسفنهم، بشرط أن لا
يحدثوا حدثاً يوجب نقض العهد، فإن من ينقض العهد لا حرمة لماله ولا
لدمه، ولا تقبل منهم الفدية لو بذلوها في هذه الحال..
والحدث الموجب لنقض العهد هو الإمتناع عن إعطاء الجزية،
وإظهار التمرد والعصيان..
وقد تضمن كتابهم التنصيص على حرية تحركهم، وقد أباح لهم
أن يردوا أي ماء شاؤا، وأن يسلكوا أي طريق أرادوا..
إن نص كتاب أهل مقنا يفيد:
أنهم كانوا قد ارتكبوا من السيئات والذنوب تجاه
الإسلام، وآذوا المسلمين ما جعلهم يستحقون معه العقوبة دون سائر الناس،
ولكن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، قد غفر ذلك لهم.. بل هو قد أحسن
إليهم بأن أجارهم «صلى الله عليه وآله»، حتى أنه ليدفع عنهم كل ما
يدفعه عن نفسه..
وهذا غاية الرفق بهم، والإحسان إليهم.
ولكنه شدد عليهم من جهة أخرى، فأجرى فيهم حكم التوراة،
ربما لكي لا يستسهلوا العودة إلى الجريمة، حين يرون أن العفو، والحماية
بانتظارهم، وأن ثم من يدفع عنهم.
ثم إنه «صلى الله عليه وآله» قد أخذ منهم متاعهم
ورقيقهم، وآلة الحرب وما يتقوَّون به على العدوان، إلا ما عفا عنه لهم.
مما لا بد لهم منه للدفع عن أنفسهم..
وقد شرط لهم:
أن لا أمير عليهم إلا من أنفسهم، أو من أهل رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، فهل المقصود من هذا القرار النبوي تعريف الناس:
أن أهل رسول الله «صلى الله عليه وآله» هم الذين يعاملونهم بالرفق،
ويهتمون بما يصلحهم، ولا يبغون لهم إلا الصلاح والخير، فهم يحرصون على
مصلحتهم بمستوى حرص أحدهم على مصلحة نفسه وأهله؟.
أما غير أهل النبي «صلى الله عليه وآله»، فقد يجرون
النار إلى قرصهم، ويتخذون الدين ذريعة للدنيا، ويتخذون مال الله دولاً
وعباد الله خولاً، وهذا ما أظهرته الوقائع اللاحقة..
كما أن أهل رسول الله «صلى الله عليه وآله» أعرف من كل
أحد بأحكام الدين، وهم الواقفون على سياسات ومناهج وأخلاق وأهداف رسول
الله «صلى الله عليه وآله».. وهم الأولى من كل أحد بتولي شأن الناس من
بعده..
وقد أورد بعضهم نصاً لكتاب النبي «صلى الله عليه وآله»
لأهل مقنا، وهو باللغة العربية لكنه مكتوب بالخط العبراني.
وهو يختلف عن النص المتقدم ويزيد عليه في أمور كثيرة([31])،
ولكن بعض الباحثين قد حكموا عليه بأنه مزور ومكذوب. ومستندهم في ذلك
الأمور التالية:
1 ـ
أن الكتاب المذكور قد أرخ بسنة خمس للهجرة، مع أن ثمة
اتفاقاً على أنه «صلى الله عليه وآله» قد عاهد أهل مقنا سنة تسع..
2 ـ
قد ورد ذكر صفية زوجة رسول الله «صلى الله عليه وآله»
في الكتاب، مع أن النبي «صلى الله عليه وآله» إنما تزوجها سنة سبع بعد
غزوة خيبر..
3 ـ
إنه «صلى الله عليه وآله» قد كتب إلى ملوك الدنيا بالخط
العربي، فلماذا كتب ليهود مقنا بالعبرانية، وهم عرب؟!..
4 ـ
إن خيبر قد فتحت بعد سنة خمس بالإتفاق.. والكتاب مؤرخ
بسنة خمس.
ونضيف إلى ما تقدم:
أن نفوذ المسلمين لم يكن بهذا الإتساع، كما أن عساكر
الإسلام لم تكن قد وصلت إلى تلك المناطق، ولم يكن أهلها يخافون من
حملات المسلمين على بلادهم، خصوصاً قبل سقوط خيبر وقبل فتح مكة حيث كان
المشركون في مكة يضغطون على المسلمين، ويشنون عليهم الحملات..
5 ـ
إن الجزية ـ حسب زعمهم ـ قد وضعت سنة تسع، فهي في سنة
خمس لم تكن قد وضعت بعد..
6 ـ
بعض الشروط التي أعطاهم إياها، أو أعفاهم منها لم تكن
تجري حتى في حق المسلمين. إذا ما معنى أن لا يحجبوا عن ولاة
المسلمين؟!.
7 ـ
ما معنى أن لا يمنع أحد من اليهود من دخول المساجد؟!.
8 ـ
لماذا لا يعدُّ زواج النبي «صلى الله عليه وآله» بمن
كانت قبل إسلامها على الشرك إكراماً للمشركين أيضاً؟
ولماذا لا يعدُّ زواجه «صلى الله عليه وآله» من مارية
القبطية إكراماً للنصارى؟!
قالوا:
كان عبد الله ذو البجادين([32])
من مزينة، مات أبوه وهو صغير، فلم يورثه شيئاً، وكان عمه مليّاً،
فأخذه، فكفله حتى كان قد أيسر، وكانت له إبل وغنم ورقيق، فلما قدم رسول
الله «صلى الله عليه وآله» المدينة جعلت نفسه تتوق إلى الإسلام ولا
يقدر عليه من عمه، حتى مضت السنون والمشاهد كلها.
فانصرف رسول الله «صلى الله عليه وآله» من فتح مكة
راجعاً إلى المدينة، فقال عبد الله ذو البجادين لعمه: يا عم قد انتظرت
إسلامك فلا أراك تريد محمداً، فائذن لي في الإسلام.
فقال:
والله لئن اتبعت محمداً لا تركت بيدك شيئاً كنت أعطيتكه
إلا انتزعته منك حتى ثوبيك.
فقال:
وأنا والله متبع محمداً ومسلم، وتارك عبادة الحجر
والوثن، وهذا ما بيدي فخذه، فأخذ كل ما أعطاه حتى جرده من إزاره.
فجاء أمه فقطعت بجاداً لها باثنين، فائتزر بواحد وارتدى
بالآخر.
ثم أقبل إلى المدينة، فاضطجع في المسجد، ثم صلى مع رسول
الله «صلى الله عليه وآله» الصبح، وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله»
يتصفح الناس إذا انصرف من الصبح، فنظر إليه فأنكره.
فقال:
«من أنت»؟
فانتسب له، فقال:
«أنت عبد الله ذو البجادين».
ثم قال:
«انزل مني قريباً».
فكان يكون في أضيافه، ويعلمه القرآن، حتى قرأ قرآناً
كثيراً، وكان رجلاً صيتاً فكان يقوم في المسجد، فيرفع صوته في القراءة،
فقال عمر: يا رسول الله، ألا تسمع هذا الأعرابي يرفع صوته بالقرآن، حتى
قد منع الناس القراءة؟
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«دعه يا عمر، فإنه قد خرج مهاجراً إلى الله تعالى وإلى
رسوله».
فلما خرج رسول الله «صلى الله عليه
وآله» إلى تبوك، قال:
يا رسول الله. ادع الله تعالى لي بالشهادة.
فقال:
«أبلغني بلحاء سمرة». (أي ائتني بها).
فأبلغه بلحاء سمرة، فربطها رسول الله «صلى الله عليه
وآله» على عضده، وقال: «اللهم إني أحرم دمه على الكفار».
فقال:
يا رسول الله، ليس هذا أردت.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«إنك إذا خرجت غازياً في سبيل الله فأخذتك الحمى فقتلتك
فأنت شهيد. وإذا وقصتك دابتك فأنت شهيد، لا تبالي بأية كان».
فلما نزلوا تبوك أقاموا بها أياماً، ثم توفي عبد الله
ذو البجادين، فكان بلال بن الحارث المزني يقول: حضرت رسول الله «صلى
الله عليه وآله» ومع بلال المؤذن شعلة من نار عند القبر واقفاً بها،
وإذا رسول الله «صلى الله عليه وآله» في القبر، وإذا أبو بكر وعمر
يدليانه إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» وهو يقول: «أدنيا لي
أخاكما».
فلما هيأه لشقه في اللحد قال: «اللهم إني قد أمسيت عنه
راضياً، فارض عنه».
فقال ابن مسعود:
يا ليتني كنت صاحب اللحد([33]).
ونقول:
في هذه القضية أمور كثيرة تحتاج إلى بيان، غير أننا سوف
نقتصر منها على نقطتين فقط، فلاحظ ما يلي:
ذكرت الرواية المتقدمة:
أن عمر بن الخطاب قد اشتكى على ذي البجادين إلى رسول
الله «صلى الله عليه وآله» أنه يرفع صوته بالقرآن، ثم هو يصفه بوصف
يريد أن يشينه به، وهو أنه أعرابي، وكأنه يريد إن يطبق عليه قوله
تعالى:
{الْأَعْرَابُ
أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا
أَنْزَلَ اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}([34])،
وغيرها من الآيات..
مع أنه يعلم ويرى:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» معهم في المسجد، ويسمع
قراءة ذي البجادين كما يسمعون، فلو أنه كان في قراءته ما يحتاج إلى
تدخل، وتحديد لكان «صلى الله عليه وآله» بادر إلى ذلك من دون حاجة إلى
تذكير عمر..
كما أن ذا البجادين لم يسئ إلى عمر، لكي يتخذ عمر ذلك
ذريعة لتوجيه الإهانة له..
يضاف إلى ذلك:
أنه لم يظهر من فعل ذي البجادين أنه يتعمد إزعاج
المسلمين بقراءته..
فلماذا إذن يوجه له عمر بن الخطاب هذه الكلمات اللاذعة
والمهينة؟!.
ولعل السبب في أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يدع
بالشهادة لذي البجادين: أن الله تعالى كان قد أعلمه بأن غزوة تبوك سوف
تنتهي من دون حرب، والذي طلبه ذو البجادين ـ فيما يبدو ـ هو الشهادة في
تبوك بالذات، فإذا دعا له النبي «صلى الله عليه وآله» بالشهادة، ثم حضر
أجل ذلك الرجل، الذي يرى أن دعاء رسول الله «صلى الله عليه وآله»
مستجاب، فسيعتقد أنه لم يكن أهلاً لكرامة الله تبارك وتعالى، ولربما
يصاب باليأس الذي قد يؤي به إلى الهلاك. هذا إن لم يرتب في استجابة
الله دعاء رسوله، ثم ينتقل إليه هنا إلى معانٍ ومفردات أخرى، يتجاوز
بها الحدود.
فما فعله النبي «صلى الله عليه وآله» مع هذا الرجل،
إنما كان يهدف إلى حفظ إيمانه وصحة يقينه..
هذا.. ويلاحظ:
أن الرسول «صلى الله عليه وآله» قد عوضه عن المفاجأة
التي أصيب بها للوهلة الأولى، حين رأى النبي «صلى الله عليه وآله» يحرم
دمه على الكفار أن يسفكوه، بأن فتح له أبواباً أخرى تلتقي مع معنى
الشهادة في أجرها، وفي مقامها، فأخبره بأن خروجه للغزو، ثم إدراك الموت
له ولو بالحمَّى، يجعله في مصافِّ الشهداء..
ويقولون:
إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» شاور أصحابه في
التقدم، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إن كنت أُمرت بالمسير فسر.
فقال «صلى الله عليه وآله»:
«لو أمرت بالمسير لما استشرتكم فيه».
فقال:
يا رسول الله، إن للروم جموعاً كثيرة، وليس بها أحد من
أهل الإسلام، وقد دنونا منهم، وقد أفزعهم دنوك، فلو رجعنا هذه السنة
حتى ترى أو يحدث الله لك أمراً([35]).
ونقول:
إننا في الوقت الذي لا نريد فيه أن نتجنى على أحد، لا
نريد أيضاً أن نورد الأحداث مجتزأةً، أو مبهمة، فإن للقارئ علينا حقاً،
لا بد أن نؤديه إليه ولا نخونه فيه، ألا وهو أن نكون أمينين فيما ننقله
له، معتمدين الصراحة والوضوح، ومحاولة استيفاء العناصر الأساسية التي
توضح له مرامي النص الذي نعرضه.
من أجل ذلك، نقول:
1 ـ
إن ثمة أمراً لافتاً للنظر، وهو أنه «صلى الله عليه
وآله» حين استشار أصحابه في أمر الحرب في بدر، كانت مشورتهم عليه تقضي
بتجنب الدخول فيها، مع إسهاب ظاهر في التعظيم والتهويل..
وبقريش وجبروتها في حرب حنين نراهم يعتزون بكثرة عددهم،
ثم يهربون بصورة مذلة ومهينة.
ثم جاءت تبوك، فكانت مشورتهم عليه «صلى الله عليه وآله»
هي هذا الذي قرأناه آنفاً من أقوال عمر بن الخطاب.. المتضمن للتخويف من
جموع الروم الكثيرة، وعدم وجود أحد في تلك البلاد من أهل الإسلام، وأن
الإكتفاء بهذا الدنو منهم الذي أفزعهم، والرجوع من هناك إلى المدينة هو
الأولى والأصوب..
فلماذا هذا التحاشي لأي صدام مع أعداء الله من النصارى،
ومن المشركين؟ هل هو الجبن والخور؟ أم ماذا؟!
2 ـ
قد تحدثنا عن سبب استشارة النبي «صلى الله عليه وآله»
لأصحابه في أمر الحرب، وذلك حين الحديث عن غزوة أحد، فراجع.
وروى عكرمة عن أبيه أو عن عمه عن جده:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله»
قال في غزوة تبوك:
«إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا
كنتم بغيرها فلا تقدموا عليها»([36]).
قال في بذل الطاعون:
يشبه ـ والله أعلم ـ أن يكون السبب في ذلك أن الشام
كانت في قديم الزمان ولم تزل معروفة بكثرة الطواعين، فلما قدم النبي
«صلى الله عليه وآله» تبوك غازياً الشام لعله بلغه أن الطاعون في الجهة
التي كان يقصدها، فكان ذلك من أسباب رجوعه من غير قتال ـ والله أعلم.
انتهى.
قال الصالحي الشامي:
قلت:
قد ذكر جماعة: أن طاعون شيرويه أحد ملوك الفرس، كان في
أيام النبي «صلى الله عليه وآله»، وأنه كان بالمدائن([37]).
ونقول:
1 ـ
إن طاعون شيرويه، إذا كان في المدائن، فهو في العراق،
لأن المدائن تقع قرب بغداد، وكانت عاصمة لمملكة الفرس، ولا يزال إيوان
كسرى فيها ماثلاً للعيان حتى اليوم..
فأين المدائن عن تبوك، وعن الشام وبلادها، وما معنى أن
يساق الحديث إليه هنا؟!.
2 ـ
قد تقدم: أن السبب في رجوعه «صلى الله عليه وآله» عن
بلاد الروم، هو ما أظهره قيصر من مقاربة لدين الإسلام، حيث لم يعد
سائغاً الدخول في حرب معه قبل أن تستقر الأمور بالإتجاه الذي يفرض
ذلك..
3 ـ
إننا لم نسمع عن وجود طاعون في الشام في زمن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، سواء في الجهة التي كان «صلى الله عليه وآله»
يقصدها أو في غيرها..
4 ـ
بالنسبة للكلمة المنقولة عن النبي «صلى الله عليه وآله»
آنفاً فيما يرتبط بالدخول أو الخروج من البلاد التي يكون فيها الطاعون
نقول:
إنها قد أسست لمبدأ الحجر الصحي للأمان من العدوى، وإن
كان بعض الناس قد فهمها بصورة خاطئة، كما أوضحته الروايات الواردة عن
أهل البيت «عليهم السلام»:
1 ـ
فعن علي بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبد الله «عليه
السلام»: القوم يكونون في البلد يقع فيها الموت، ألهم أن يتحولوا عنها
إلى غيرها؟!.
قال:
نعم.
قلت:
بلغنا أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» عاب قوماً
بذلك.
فقال:
أولئك كانوا رتبة بإزاء العدو، فأمرهم رسول الله «صلى
الله عليه وآله» أن يثبتوا في موضعهم، ولا يتحولوا منه إلى غيره، فلما
وقع فيها الموت تحولوا من ذلك المكان إلى غيره. فكان تحولهم من ذلك
المكان إلى غيره كالفرار من الزحف([38]).
2 ـ
وعن أبان الأحمر قال: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن «عليه
السلام» عن الطاعون يقع في بلدة وأنا فيها، أتحول عنها؟
قال:
نعم.
قال:
ففي القرية وأنا فيها أتحول عنها؟
قال:
نعم.
قال:
ففي الدار وأنا فيها أتحول عنها؟
قال:
نعم.
قلت:
فإنا نتحدث أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال:
الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف؟!.
قال:
إن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، إنما قال هذا في
قوم كانوا يكونون في الثغور في نحر العدو، فيقع الطاعون، فيخلون
أماكنهم ويفرون منها، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» ذلك فيهم([39])..
3 ـ
وروي: أنه إذا وقع الطاعون في أهل مسجد، فليس لهم أن
يفروا منه إلى غيره([40])..
4 ـ
وعن علي بن جعفر: أنه سأل أخاه موسى الكاظم «عليه
السلام»: عن الوباء، يقع في الأرض، هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟!.
قال:
يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه، فإذا وقع
في مسجده الذي يصلي فيه، فلا يصلح الهرب منه([41]).
5 ـ
وعن الإمام الصادق «عليه السلام»: أن النبي «صلى الله
عليه وآله» كره أن يكلم الرجل مجذوماً إلا أن يكون بينه وبينه قدر
ذراع، وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد([42]).
6 ـ
وعنه «صلى الله عليه وآله»: خمسة يجتنبون على كل حال:
المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي([43]).
7 ـ
وعنه «صلى الله عليه وآله»: لا يورد ذو عاهة على مُصح([44]).
8 ـ
وروي: أنه «صلى الله عليه وآله» أتاه مجذوم ليبايعه،
فلم يمد يده إليه، بل قال: أمسك يدك فقد بايعتك([45]).
9 ـ
وروي عنه «صلى الله عليه وآله» أنه قال: لا تديموا
النظر إلى المجذومين
([46]).
ونستطيع أن نستخلص مما تقدم ما يلي:
1 ـ
إن التحرز من المجذوم والمصاب بالطاعون مطلوب.
2 ـ
إنه لا يورد ذو عاهة على مصح.
3 ـ
إن ما شاع من أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد عاب
الذين فروا من الطاعون: إنما هو لفرارهم من مواقعهم الدفاعية المتقدمة
في ثغورهم..
4 ـ
يجوز لمن يكون في منطقة الطاعون أن يتحول عنها، إلى
غيرها ما دام سليماً..
5 ـ
إذا بلغ الطاعون إلى أهل مسجد، فليس لهم أن يفروا منه
إلى غيره، (ربما لأن ذلك يقرِّب احتمال أن يكونوا مصابين بالمرض، وإن
لم تظهر عليهم أعراضه، فيوجب ذلك انتقال المرض إلى مناطق أخرى)..
وهذا لا ينافي جواز التحول من البلد التي وقع فيها
الطاعون.. فإن وقوع الطاعون في بعض أحيائها لا يبرر منع سائر الناس من
التحول عنها، فإن احتمال ابتلائهم بالمرض يبدو ضعيفاً، بخلاف ما لو وصل
المرض إلى بعض من في المسجد الواحد، فإن احتمال ابتلاء سائر من فيه به
يكون قوياً، زيزجب الإحتياط..
روي:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» لما غزا تبوك استخلف
علياً «عليه السلام» على المدينة، فلما نصر الله رسوله «صلى الله عليه
وآله»، وأغنم المسلمين أموال المشركين ورقابهم، جلس رسول الله «صلى
الله عليه وآله» في المسجد، وجعل يقسم السهام على المسلمين، فدفع إلى
كل رجل سهماً سهماً، ودفع إلى علي سهمين.
فقام زائدة بن الأكوع فقال:
يا رسول الله، أوحي نزل من السماء أو أمر من نفسك؟ تدفع
إلى المسلمين سهماً سهماً، وتدفع إلى علي سهمين.
فقال
النبي «صلى الله عليه وآله»:
أنشدكم الله، هل رأيتم في ميمنة عسكركم صاحب الفرس
الأغر المحجل، والعمامة الخضراء، لها ذؤابتان مرخاتان على كتفه، بيده
حربة، وحمل على الميمنة فأزالها، وحمل على القلب فأزاله؟
قالوا:
نعم يا رسول الله لقد رأينا ذلك.
قال:
ذلك جبريل، وإنه أمرني أن أدفع سهمه إلى علي بن أبي
طالب.
قال:
فجلس زائدة مع أصحابه وقال قائلهم شعراً:
علي حوى سهمين من غـير أن
غزا غـزاة تبـوك حبـذا سهـم مسهم([47])
ونقول:
قد دلت هذه الرواية على أنه قد جرى في تبوك قتال، وحصل
المسلمون على غنائم، قسمها رسول الله «صلى الله عليه وآله» بين
المسلمين، ويؤيد ذلك حديث مناشدة علي «عليه السلام» لأهل الشورى، حيث
قال لهم: «أفيكم أحد كان له سهم في الحاضر، وسهم في الغائب»؟.
قالوا:
لا([48]).
وقال ابن العرندس المتوفى في حدود سنة 840هـ:
وتبـوك نـازل شوسهـا
فـأبـادهم ضـربـاً بصـارم عـزمـة لن يفللا([49])
ولكن المؤرخين لا يعترفون بحدوث قتال في تبوك، فكيف
نوفق بين هذا، وذاك؟َ!.
ويمكن أن يجاب:
1 ـ
بأن من الجائز أن تكون غنائم دومة الجندل، التي أخذت في
تبوك، بقيت إلى حين عودة النبي «صلى الله عليه وآله» إلى المدينة،
فقسمها رسول الله «صلى الله عليه وآله» في المسجد، وأعطى أمير المؤمنين
«عليه السلام» منها..
2 ـ
لا ندري، فلعل بعض جماعات أهل الشرك قد احتكت بالمسلمين
في غزوة تبوك، فنصر الله المسلمين عليها، وغنّمهم أموالها..
ثم إن المؤرخين أغمضوا النظر عن ذكر ذلك، لما فيه من
التنويه بأمير المؤمنين «عليه السلام»، وإشاعة لفضائله، فأراحوا
أنفسهم، ومن هم على شاكلتهم من عناء التماس المخارج، والتأويلات، حين
يواجههم شيعة أمير المؤمنين «عليه السلام» بالحقيقة..
والله هو العالم بالحقائق..
([1])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص457 عن الحارث بن أسامة، والمعجم الكبير
للطبراني ج12 ص442 ومجمع الزوائد ج5 ص306 وبغية الباحث عن
زوائد مسند الحارث ص202 وصحيح ابن حبان ج10 ص357 وموارد الظمآن
ج5 ص218.
([2])
الآية 29 من سورة التوبة.
([3])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص457 عن الحارث بن أبي أسامة والمعجم
الكبير للطبراني ج12 ص442 ومجمع الزوائد ج5 ص306 وراجع: مكاتيب
الرسول ج2 ص410 و 411 وأشار إلى المصادر التالية: الأموال لأبي
عبيد ص22 وفي (ط أخرى) ص32 رواه بإسناده عن عبد الله بن شداد،
ورسالات نبوية ص313/117 ومدينة البلاغة ج2 ص247 عن جمهرة رسائل
العرب، ومجموعة الوثائق السياسية ص110/27 عن الأموال، وسنن
سعيد بن منصور ج2 ص187 وصبح الأعشى ج6 ص363 و 377 والمطالب
العالية ج4 ص2231/2479 عن الحارث بن أبي أسامة، وقال: انظر
مجلة المعارف شهر يونيو 1935 م ص416 ـ 430) وراجع نشأة الدولة
الإسلامية ص299 و 300 (عن أبي عبيد والقلقشندي ومحمد حميد
الله) وراجع أيضاً: ص713. وأوعز إليه الحلبي في السيرة ج2 ص377
والبداية والنهاية ج5 ص15 وابن عساكر ج1 ص113 و 114 ودحلان
(هامش الحلبية) ج2 ص374 . ومجمع الزوائد ج5 ص307 وقال: «رواه
الطبراني ورجاله صحيح».
([4])
صحيح ابن حبان ج10 ص358 وموارد الظمآن ج5 ص218 وسبل الهدى
والرشاد ج5 ص457 وبغية الباحث عن مسند الحارث ص202 وراجع:
مكاتيب الرسول ج2 ص410 و 411 وأشار في هامشه إلى المصادر
التالية: تاريخ اليعقوبي ج2 ص62 وفي (ط أخرى) ص67 وأشار إليه
الحلبي ج3 ص277 والسيرة النبوية لدحلان ج3 ص67 والدلائل
للأصبهاني ص292 والبحار ج20 ص379 و 395 ومجموعة الوثائق
السياسية ص111/28 عن اليعقوبي، وعن منشآت السلاطين لفريدون بك
ج1 ص30 وقال: قابل السهيلي ج2 ص320 ومسند أحمد ج3 ص442 وج4 ص74
ودلائل النبوة للبيهقي ج1 ص166. والطبقات الكبرى ج1 ق2 ص16 وفي
فتح الباري ج1 ص42 «ذكر السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب
في قصبة من ذهب تعظيماً له وأنهم لم يزالوا يتوارثونه..» وراجع
الأموال ص362.
([5])
حياة الصحابة ج1 ص106 و 107 عن عبد الله بن أحمد، وأبي يعلى،
وراجع: تاريخ الأمم والملوك للطبري ج2 ص651 والبداية والنهاية
ج4 ص267 و 268 وج5 ص15 و (ط دار إحياء التراث العربي) ج5 ص20
وتهذيب تاريخ ابن عساكر ج1 ص114 وفتح الباري ج1 ص41 ومجموعة
الوثائق السياسية ص112/28 ـ ألف ب. وموارد الظمآن إلى زوائد
ابن حبان ص392 ومجمع الزوائد ج8 ص235. وراجع: مسند أحمد ج3
ص442 و السيرة النبوية لابن كثير ج4 ص27 وسبل الهدى والرشاد ج5
ص458.
([6])
الآية 56 من سورة القصص.
([7])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص458 عن أحمد وأبي يعلى، وقال في هامشه:
قال الحافظ ابن كثير ج5 ص16: هذا حديث غريب، وإسناده لا بأس
به، تفرد به = = الإمام
أحمد. ومكاتيب الرسول ج2 ص415 و 416 وأشار في هامشه إلى
المصادر التالية: السيرة الحلبية ج3 ص280 والسيرة النبوية
لزيني دحلان (بهامش الحلبية) ج3 ص70 وإعلام السائلين ص19
ورسالات نبوية ص278 وأعيان الشيعة ج2 ص142 وفي (ط أخرى) ج2
ص244 وجمهرة رسائل العرب، والخطط للمقريزي ج1 ص29 وحسن
المحاضرة ج1 ص42 والمواهب اللدنية للقسطلاني ج1 ص292 وج3 ص397،
ونشأة الدولة الإسلامية ص304 عن فتوح مصر (ط ليدن) ص46، ومجلة
الهلال أكتوبر سنة 1904 م، وصبح الأعشى ج6 ص358 ـ 366 و 378
وزاد المعاد لابن القيم ج3 ص61 ونصب الراية للزيلعي ج4 ص421
وراجع: الإصابة ج3 ص531 ودائرة المعارف لوجدي ج9 ص317 وشرح
المواهب للزرقاني ج3 ص347 وتأريخ الخميس ج2 ص37 ولغت نامه
دهخدا ج43 ص955 وصبح الأعشى ج6 ص364 والمصباح المضيء ج2 ص129
ومجموعة الوثائق السياسية ص105/49 ورسالات نبوية، وإعلام
السائلين، ومفيد العلوم للقزويني، وحسن المحاضرة للسيوطي، ونصب
الراية للزيلعي، وصبح الأعشى، والبيهقي، والمنفلوطي، ومنشئات
السلاطين لفريدون بك، وشرح المواهب للزرقاني، والحلبي وغيره.
([8])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص459 عن الواقدي، والبحار ج21 ص251
وتاريخ مدينة دمشق ج2 ص37 وإمتاع الأسماع ج2 ص61 ج9 ص264.
([9])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص459 وج11 ص356.
([10])
الخرائج والجرائح ج1 ص104 والبحار ج20 ص378 ومستدرك سفينة
البحار ج10 ص532.
([11])
الآية 47 من سورة الذاريات.
([12])
الآية 12 من سورة فصلت والآية 5 من سورة الملك.
([13])
الآية 6سورة الصافات.
([14])
الآية 3 من سورة الملك.
([15])
الآية 15 من سورة نوح.
([16])
الآية 4 من سورة المعارج.
([17])
الآية 47 من سورة الذاريات.
([18])
الآية 33 من سورة الرحمن.
([19])
الآيتان 34 و 35 من سورة الشعراء.
([20])
الآية 35 من سورة الشعراء.
([21])
الأموال لأبي عبيد ص32.
([22])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص460.
([23])
المغازي للواقدي ج3 ص1031 ومكاتيب الرسول ج2 ص480 عنه.
([24])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص460 و 461 عن البخاري، وابن أبي شيبة،
وأحمد، ومسلم، وقال في هامشه: أخرجه مسلم ج3 ص1011 (503/1392).
وراجع: المغازي للواقدي ج3 ص1031 ومكاتيب الرسول ج3 ص114 عنه،
وراجع: صحيح البخاري ج2 ص132 وج3 ص141 وج4 ص64 وعمدة القاري ج9
ص64 وج13 ص168 وج13 ص170 وج15 ص85 وتحفة الأحوذي ج5 ص165.
([25])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص460 و 461 عن الواقدي ومكاتيب الرسول ج3
ص114 عن المصادر التالية: البداية والنهاية ج5 ص16 و 17
(واللفظ له) والطبقات الكبرى ج1 ص290 وفي (ط أخرى) ج1 ق2 ص37
والسيرة الحلبية ج3 ص160 وزيني دحلان (بهامش الحلبية) ج2 ص375
ورسالات نبوية ص89 وجمهرة رسائل العرب ج1 ص49 عن شرح الزرقاني
للمواهب اللدنية ج3 ص413 ومدينة البلاغة ج2 ص349. ومجموعة
الوثائق السياسية ص118/32 عن جمع ممن تقدم، وعن إمتاع الأسماع
للمقريزي ج1 ص468= = و 469 وأخرى في القسم الغير المطبوع (خطية
كوپرلو) ص1040 والمواهب اللدنية ج1 ص297 ومنشئات السلاطين ج1
ص34 وشرح الزرقاني ج3 ص360 ودلائل النبوة للبيهقي (خطية
كوپرولو) ج1 ورقة 23 ـ ب. ثم قال: قابل الطبقات ج1 ق2 ص37 و 38
وشرح السيرة لإبراهيم الحلبي ورقة 115 ـ ب، وفتوح البلدان ص59
والخراج لقدامة ورقة 124، مخطوطة باريس، ولسان العرب، والمواهب
اللدنية ج3 ص160 والتنبيه والإشراف ص282 والنهاية لابن الأثير
مادة جرب، وانظر مجلة تحقيقات علمية في مراجع المكتوب ص26
(كايتاني) ج9 ص239 التعليقة الثانية و (اشپرنكر) ج3 ص422 و 424
و (اشپربر) ص44 و 45 .
([26])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص461 والمغازي للواقدي ج3 ص1032 ونقله
العلامة الأحمدي «رحمه الله» في مكاتيب الرسول ج3 ص97 وراجع ج2
ص480 عن المصادر التالية: الطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص289 وفي
(ط أخرى) ج1 ق1 ص37 واللفظ له، وتهذيب تأريخ ابن عساكر ج1 ص115
والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص181 وفي (ط أخرى) ص169 والسيرة
الحلبية ج3 ص160 والبداية والنهاية ج5 ص16 والسيرة النبوية
لدحلان (بهامش الحلبية) ج2 ص374 والثقات ابن حبان ج2 ص94 و 95
والأموال لأبي عبيد ص200 وفي (ط أخرى) ص287 ورسالات نبوية ص317
والجمهرة ج1 ص48 ومدينة البلاغة ج2 ص327 وتأريخ الخميس ج2 ص127
ونشأة الدولة الإسلامية ص310 ومنشآت السلاطين ج1 ص33 وإمتاع
الأسماع للمقريزي ج1 ص468 وراجع: البحار ج21 ص245 (بهامشه) عن
ابن هشام، والمقريزي، وشرح الزرقاني ج3 ص359 وفتح الباري ج3
ص273 و ج5 ص169 وج6 ص191 وعمدة القاري ج9 ص64 ـ 70 وج13 ص168 ـ
170 وج15 ص76 و 85 وعون المعبود ج3 ص144 وإرشاد الساري ج3 ص68
و 69 وزاد المعاد ج3 ص5 والأموال لابن زنجويه ج2 ص463 ودلائل
النبوة للبيهقي ج5 ص247 وسيرة النبي «صلى الله عليه وآله»
لإسحاق بن محمد. ومسند أحمد ج5 ص425 وسنن الدارمي ج2 ص233 وابن
أبي شيبة ج14 ص540 وإعلام الورى ص133 وفي (ط أخرى) ص75
والتنبيه والإشراف ص236 وفتوح البلدان للبلاذري ص80 واليعقوبي
ج2 ص57 ومعجم البلدان ج1 ص292 في «إيلة» وأعيان الشيعة ج1 ص283
والكامل ج2 ص280 والطبري ج3 ص108 والمفصل ج7 ص348 وج6 ص601
وتأريخ ابن خلـدون ج2 ق2 ص50 والنهـايـة في = = مادة: بحر،
وسيرة ابن كثير ج4 ص29 والتأريخ المختصر لأبي الفداء ج1 ص142
ومجموعة الوثائق السياسية ص117 والمطالب العالية لابن حجر
ص2631، وانظر كايتاني ج9 ص38 (التعليقة الأولى) و (اشپربر) ص41
و (اشپرنكر) ج2 ص422) وراجع: البخاري ج2 ص155 وج3 ص213 وج4
ص119 وسنن أبي داود ج3 ص 179 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص215
وصحيح مسلم ج4 ص1785 وكنز العمال ج10 ص415 وفي (ط أخرى) ج5
ص325 وشرح النووي لمسلم ج15 ص42 والبخاري شرح الكرماني ج8 ص27
وتذكرة الفقهاء ج1 ص441.
([27])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص461 عن الواقدي ومكاتيب الرسول ج3 ص113
و 114 عن المصادر التالية: البدايـة والنهايـة ج5 ص16 و 17
(واللفظ لـه) = = والطبقات الكبرى ج1 ص290 وفي (ط أخرى) ج1 ق2
ص37 والسيرة الحلبية ج3 ص160 وزيني دحلان (بهامش الحلبية) ج2
ص375 ورسالات نبوية ص89 وجمهرة رسائل العرب ج1 ص49 ومدينة
البلاغة ج2 ص349. ومجموعة الوثائق السياسية ص118/32 عن جمع ممن
تقدم، وعن إمتاع الأسماع للمقريزي ج1 ص468 و 469 وأخرى في
القسم الغير المطبوع (خطية كوپرلو) ص1040 ومنشآت السلاطين ج1
ص34 وشرح الزرقاني ج3 ص360 ودلائل النبوة للبيهقي (خطية
كوپرولو) ج1 ورقة 23 ـ ب. وشرح السيرة لإبراهيم الحلبي ورقة
115 ـ ب، وفتوح البلدان ص59 والخراج لقدامة ورقة 124، مخطوطة
باريس، ولسان العرب، والمواهب اللدنية ج3 ص160 والتنبيه
والإشراف ص282 والنهاية لابن الأثير مادة جرب، وانظر مجلة
تحقيقات علمية في مراجع المكتوب ص26 (كايتاني) ج9 ص239
التعليقة الثانية و (اشپرنكر) ج3 ص422 و 424 و (اشپربر) ص44 و
45.
([28])
مكاتيب الرسول ج3 ص100 و101 و 105 عن المصادر التالية: الطبقات
الكبرى ج1 ص277 وفي (ط أخرى) ج1 ق2 ص28 وفتوح البلدان للبلاذري
ص71 وفي (ط أخرى) ص80 (واللفظ للأول) ورسالات نبوية ص115 (عن
المصباح المضيء عن ابن سعد) ونشأة الدولة الإسلامية ص311
والمصباح المضيء ج2 ص380 ومجموعة الوثائق السياسية ص119/33 عن
المصادر المذكورة وعن الخراج لقدامة ورقة 124 وإمتاع الأسماع
للمقريزي ج1 ص439 ومرة أخرى في القسم الغير المطبوع (خطية
كوپرولو) ص1040 وانظر مجلة تحقيقات علمية المقالة المذكورة في
مراجع المكتوب ص26 وكايتاني ج9 ص40 و (اشپرنكر) ج3 ص419 ـ 421
و (اشپربر) ص45 و 46 وراجع: الطبقات ج1 ق2 ص38 والمغازي
للواقدي ج3 ص1032 والسيرة = = الحلبية ج3 ص160 ودحلان (بهامش
الحلبية) ج2 ص375 ومدينة البلاغة ج2 ص325 و 326 ومعجم البلدان
في «مقنا»، والكامل لابن الأثير ج2 ص280 والفائق ج2 ص411
والنهاية لابن الأثير، واللسان في «عرك» و «غزل».
([29])
الإصابة ج3 ص338 والإستيعاب ج3 ص381 وأسد الغابة ج4 ص271.
([30])
مكاتيب الرسول ج3 ص249 و 250 عن المصادر التالية: أسد الغابة
ج4 ص271 (واللفظ له) والإصابة ج3 ص338 (عن البغوي وابن شاهين)
ورسالات نبوية ص253 (عن جامع أزهر عن الطبراني في الأوسط، وابن
الأثير وابن حجر) ولسان الميزان ج3 ص20 (نقله لمبارك بن أحمر
ولعلـه سهو من = = قلمه، لأنه لم يذكر مبارك بن أحمر في
الإصابة ولا ابن الأثير في أسد الغابة) ونشأة الدولة الإسلامية
ص336 ومدينة البلاغة ج2 ص344 والمعجم الأوسط للطبراني ج7 ص419
وأوعز إليه في الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج3 ص381 والتراتيب
الإدارية ج1 ص122 ومجموعة الوثائق السياسية ص279/174 (عن أسد
الغابة والإصابة ومعجم الصحابة لابن قانع (خطية) ورقة 165 ـ ب
166 ـ ألف، وميزان الإعتدال للذهبي ج2 ص15 ثم قال: قابل الجرح
والتعديل لأبي حاتم الرازي ج4 ص1 وراجع: اللباب ج1 ص265: وجذام
هو الصدف بن أسلم بن زيد بن مالك بن زيد بن حضرموت، وكذا في
الأنساب للسمعاني ج2 ص33 وفيه أيضاً: جذام هو الصدف بن شوال بن
عمرو بن دعمى بن زيد، ولكن المشهور هو ما ذكرنا، ولعل هؤلاء
طائفة أخرى كما في هامش الأنساب للسمعاني.
([31])
مكاتيب الرسول ج3 ص110 ـ 112 ومجموعة من الوثائق السياسية
ص121.
([32])
البجاد: كساء مخطط من أكيسة الأعراب، يشتملون به.
([33])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص459 و 460 عن ابن إسحاق، وابن مندة،
والواقدي، والمغازي للواقدي ج3 ص1014 وإمتاع الأسماع ج14 ص54.
([34])
الآية 97 من سورة التوبة.
([35])
سبل الهدى والرشاد 5 ص461 و 462 عن الواقدي، وتاريخ مدينة دمشق
ج2 ص37 وإمتاع الأسماع ج2 ص62 وج9 ص264 و السيرة الحلبية (ط
دار المعرفة) ج3 ص119.
([36])
سبل الهدى والرشاد ص462 عن أحمد والطبراني، وفي هامشه عن: أحمد
ج1 ص175 وج3 ص416 وج5 ص373، والطبراني في الكبير ج1 ص90، وانظر
المجمع ج2 ص315 والدولابي في الكنى ج1 ص100، والطحاوي في
المعاني ج4 ص306 ونيل الأوطار ج7 ص374 وصحيح مسلم ج7 ص27 وسنن
الترمذي ج2 ص264 وتحفة الأحوذي ج4 ص148 والسنن الكبرى للبيهقي
ج3 ص376 ومسند أبي داود الطيالسي ص28 و 87 ومسند سعد بن أبي
وقاص ص138 و 144 و 145 و 186 و منتخب مسند عبد بن حميد ص81
والآحاد والمثاني ج2 ص52 والسنن الكبرى لنسائي ج4 ص362 والمعجم
الكبير ج1 ص166 وج4 ص91 وج18 ص15 والإستذكار لابن عبد البرج8
ص254.
([37])
سبل الهدى والرشاد ج ص462.
([38])
البحار ج78 ص121 عن علل الشرائع ص176 و (منشورات المكتبة
الحيدرية) ج2 ص520. وراجع: التحفة السنية (مخطوط) ص339
والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج2 ص430 و (ط دار الإسلامية) ج2
ص645 وجامع أحاديث الشيعة ج13 ص171.
([39])
البحار ج78 ص121 و 122 وج108 ص82 عن معاني الأخبار ص74 و (ط
مؤسسة النشر الإسلامي) ص254 وجامع أحاديث الشيعة ج13 ص171.
([40])
البحار ج6 ص122 وج78 ص122 عن معاني الأخبار ص74 و و (ط مؤسسة
النشر الإسلامي) ص255 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج2 ص431 و
(ط دار الإسلامية) ج2 ص646 وجامع أحاديث الشيعة ج13 ص171.
([41])
البحار ج6 ص122 وج10 ص255 ومسائل علي بن جعفر ص117 والوسائل (ط
مؤسسة آل البيت) ج2 ص431 و (ط دار الإسلامية) ج2 ص646 .
([42])
البحار ج72 ص14 وج62 ص82 وج73 ص338 وج74 ص50 والأمالي للصدوق
ص181 و (ط مؤسسة البعثة) ص378 والخصـال ج2 ص102 = = و (ط
منشورات جماعة المدرسين) ص520 ومن لا يحضره الفقيه ج4 ص258 و
(منشورات جماعة المدرسين) ج3 ص557 وج4 ص257 والوسائل (ط مؤسسة
آل البيت) ج12 ص49 وج15 ص345 و (ط دار الإسلامية) ج8 ص431 وج11
ص274 ومكارم الأخلاق للطبرسي ص235 و 436.
([43])
البحار ج72 ص15 والخصال ص287 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج12
ص50 و (ط دار الإسلامية) ج8 ص432.
([44])
البحار ج27 ص277 وج61 ص85 وج62 ص82 والأمالي ج2 ص44 والطب
النبوي لابن القيم ص118 و 119.
([45])
البحار ج62 ص82 وراجع: مسند ابن الجعد ص311 وتأويل مختلف
الحديث لابن قتيبة ص96 والطب النبوي لابن القيم ص118.
([46])
التاريخ الصغير للبخاري ج2 ص76 ـ 77، وسنن ابن ماجة ج2
ص1172ح3543، والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص218، ومجمع الزوائد ج5
ص101، وفتح الباري ج10 ص133و 134و 136، ومسند أبي داود
الطيـالسي ص339، والمصنف لابن أبي شيـبـة ج5 ص569 وج6 ص226، =
= والذرية الطاهرة النبوية ص129، والمعجم الأوسط ج9 ص107،
وناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص517 ح526، والجامع الصغير ج2
ص731 ح9754 وص732 ح9763، وكنز العمال ج10 ص54 ح28330 وص55
ح28339، وفيض القدير ج6 ص508 ح9754 وص511 ح9763، والكامل لابن
عدي ج6 ص218، وتاريخ مدينة دمشق ج53 ص380، وإمتاع الأسماع ج8
ص27، وسبل الهدى والرشاد ج12 ص171، والسيرة الحلبية (ط دار
المعرفة) ج3 ص242، والنهاية في غريب الحديث ج1 ص252، والطب
النبوي لابن القيم ص116، ولسان العرب ج12 ص88. وفي متون بعضها:
لا تحدُّوا..
([47])
راجع المصادر التالية: السيرة الحلبية ج3 ص142 عن الزمخشري في
فضائل العشرة، وشرح إحقاق الحق ج23 ص282 عن غاية المرام (نسخة
جستربيتي) ص73 وج31 ص565، وتفسير آية المودة للحنفي المصري ص74
عنه، وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج23 ص281، وعمدة القاري ج16
ص215 وجواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب «عليه
السلام» لابن الدمشقي ج1 ص78 وقال محقق الكتاب: والحديث رواه
الحلواني في الباب الثالث من كتاب المقصد الراغب، كما رواه
أيضا الخفاجي في الثالثة عشرة من خصائص علي «عليه السلام» من
خاتمة تفسير آية المودة الورق 74 /ب/. ورواه قبلهم جميعاً
الحافظ السروي في عنوان: «محبة الملائكة إياه» من كتابه مناقب
آل أبي طالب (ط بيروت) ج2 ص238.
([48])
ترجمة الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» من تاريخ مدينة
دمشق ج3 ص93، واللآلي المصنوعة ج1 ص362 والضعفاء الكبير
للعقيلي ج1 ص211 و 212 وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج42 ص435،
ومناقب علي بن أبي طالب «عليه السلام» وما نزل من القرآن في
علي «عليه السلام» لأبي بكر أحمد بن موسى ابن مردويه الأصفهاني
ص131 وفيه بدل (الحاضر) و (الغائب): = = (الخاص) و(العام)،
وكنز العمال ج5 ص725، والموضوعات لابن الجوزي ج1 ص379، ومسند
فاطمة «عليها السلام» للسيوطي ص21 عنه، وشرح إحقاق الحق
(الملحقات) ج31 ص323، والمناقب للخوارزمي ص315.
([49])
الغدير ج7 ص8 وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» في
الكتاب والسنة والتاريخ لمحمد الريشهري ج9 ص76.
|