في ظلال حديث الغدير
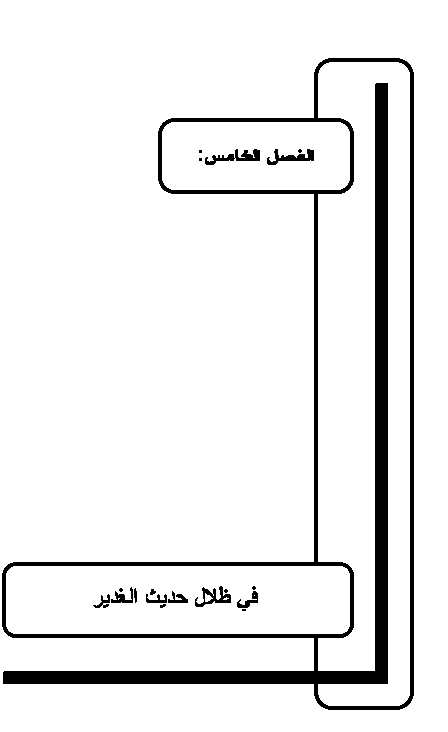
بـدايـة:
كان حديثنا في الفصل يهدف إلى إعطاء لمحة عن الحدث
الخالد الذي جرى في غدير خم، ولمحة أخرى عن تواتر أسانيده، وثبوته
بصورة قاطعة لكل عذر، بعيدة عن أي ريب.
ونريد هنا أن نعمق فهمنا لمرامي الأقوال والتوجيهات،
والتحركات، والإجراءات في المواقف المختلفة، لنستفيد الفكرة الهادية،
والعبرة الصادقة، والوعي الصحيح، والعميق لسياسة الإسلام، القائمة على
الحق والعدل، والهدى الإلهي، فنقول:
إن من جملة ما لا بد أن يثير انتباه الناس، ليتبلور
لديهم أكثر من سؤال هو إسراعه «صلى الله عليه وآله» في الخروج من مكة،
حتى إنه «صلى الله عليه وآله» لم يطف بالبيت، بل هو لم يدخل إلى المسجد
الحرام أصلاً، ولو لإلقاء نظرة الوداع على بيت الله تبارك وتعالى..
ولا أحد من الناس يجهل مدى علاقة النبي «صلى الله عليه
وآله» ببيت الله، وحبه له، فلا بد أن يتساءلوا عن أسباب هذه السرعة في
المغادرة، وأن يربطوا بين الخروج على هذا النحو وبين ما جرى في مكة وفي
منى، حيث واجهته قريش، ومن يدور في فلكها بالأذى والخذلان.. وبين ما
يجري في غدير خم.
وإذا اتصل بهذا الإجراء إجراء آخر يتمثل في أنه «صلى
الله عليه وآله»، حين وصل إلى غدير خم، وقف حتى لحقه من تأخر بعده،
وأمر برد من كان تقدم، فإنهم سيعرفون أن ثمة أمراً سيحدث، وأنه سيكون
بالغ الأهمية أيضاً، وسيتوقعون أن يكون اتصاله بما جرى في منى وعرفات
قوياً، وسيفتحون آذانهم، وتتعلق قلوبهم بكل حركة تصدر عنه، أو كلمة
يتفوه بها..
ويتأكد هذا الأمر لديهم حين منعهم من النزول تحت
الشجرات، الخمس دوحات المتقاربات العظام، اللواتي أمر بإزالة الشوك،
وتمهيد المكان عندها، حتى إذا نودي بالصلاة عمد إليهن فصلى بالناس
تحتهن، ثم نصَّب لهم علياً «عليه السلام»([1]).
ثم إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد اتبع أساليب بالغة
الدقة في واقعة الغدير، بهدف رفع مستوى الإطمينان إلى دقة وشمولية
المعرفة بما يجري، واتساع نطاقها إلى أبعد مدى، حتى ليكاد الباحث يجزم
بأن كل فرد فرد من المسلمين قد وقف على ما يراد إيقافه عليه، وعرف
حدوده وتفاصيله، ودقائقه، وحقائقه، بل لقد صرحت بعض الروايات بهذه
الشمولية، بالقول:
«وأخذ بيد علي فرفعها حتى عرفه القوم أجمعون، ثم قال:
اللهم وال من والاه الخ..»([2]).
وفي نص آخر عن زيد بن أرقم:
فقلت لزيد: سمعته من رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟
فقال:
وإنه ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينيه، وسمعه
بأذنيه([3]).
ويؤكد ذلك سائر الإجراءات التي اتخذت، والبيانات التي
قيلت، كما ربما يتضح جانب منه إن شاء الله تعالى.
إن حبس المتقدمين وإرجاعهم، وانتظار وصول واجتماع
المتأخرين منهم، سيثير لدى أولئك الناس أكثر من سؤال، وسيجعلهم أشد
انتباهاً ويقظة، وسعياً لفهم مغزى هذا الإجراء النبوي، ولن تؤثر سائر
الصوارف على تشويش الفكرة التي يراد إيصالها إليهم..
وزاد من شعورهم بخطورة ما يريد «صلى الله عليه وآله» أن
ينتهي بهم إليه أن هذه الإجراءات كلها إنما تتم في حر الهاجرة الذي
يصرح بعض هؤلاء بأنه كان بالغ الشدة إلى حد أن زيد بن أرقم يقول: ما
أتى علينا يوم كان أشد حراً منه([4]).
فخطب خطبته هناك، وبدأت إجراءات البيعة والتهنئة لعلي «عليه السلام».
ويبدو أنه «صلى الله عليه وآله» قد خطب في ذلك المكان
أكثر من مرة، فإن النصوص تشير تارة إلى أن ذلك قد كان ظهراً في حر
الهاجرة، وبعضها قال: إنه فعل ذلك عشية بعد الصلاة([5]).
فإذا لاحظنا اختلاف نص الخطب المنقولة، فسوف يترجح
لدينا احتمال تعدد الخطبة في أيام الثلاثة..
وبعض نصوص الغدير تقول:
«ينادي رسول الله بأعلى صوته»([6]).
وقد استهل «صلى الله عليه وآله» خطبته يوم الغدير
بالحديث عن الضلال والهدى، وكل الناس يحبون ويعتزُّون بأن يعدوا أو أن
يوصفوا بالهداية، ويربأون بأنفسهم عن الاتصاف بالضلال والغواية.
وهذا مغروس في طبائعهم، ومستقر في نفوسهم، وكل منهم يحب
أن يعرف موقعه بالنسبة لطريقي الهدى والضلال.. ولا سيما إذا جاء هذا من
قبل نبي يبلغهم عن الله، ومتصل بالغيب، ومطَّلع عليه.
وقد أظهرت بداية كلامه «صلى الله عليه وآله» أنه يريد
أن يبين لهم أمراً يرتبط بهذا الأمر بالذات، الذي يعني كل شخص مباشرة،
ولا يستطيع أن يتجاهله، ويمضي عنه.
ثم ساق «صلى الله عليه وآله» الكلام في اتجاه مثير
لمشاعر الخوف من المجهول، والرهبة من فقدان ما يرون فيه الضمان،
ويشعرون معه بالسكينة والأمان، حين قال: يوشك أن أدعى فأجيب، موضحاً
لهم: أن هذا الأمر الذي يريد بيانه، يفيد في هدايتهم وحفظهم في خصوص
تلك المرحلة المخيفة، وهي مرحلة ما بعد موته «صلى الله عليه وآله».
ثم قد أكد «صلى الله عليه وآله» حساسية هذا الأمر الذي
يريد أن يثيره أمامهم حين قال لهم: إني مسؤول، وأنتم مسؤولون.. فما
أنتم قائلون؟!
مما يعني:
أن تملصهم من المسؤولية في الدنيا لا يجديهم، لأن
الحساب سيكون أمامهم في الآخرة، فلا منجا ولا مهرب منه، ولا مفر ولا
محيص عنه.
بل قرر أنه هو «صلى الله عليه وآله» أيضاً مسؤول
ومحاسب. وسيرى الخلائق في الآخرة كما هو الحال في الدنيا أنه قد أبلغهم
ما أمره الله بإبلاغه إياهم على أتم وجه.
ولذلك قالوا:
نشهد أنك قد بلغت، ونصحت، وجهدت..
ثم ذكرهم «صلى الله عليه وآله» بالركائز العقائدية
الصحيحة، التي تضع كل إنسان أمام مسؤولياته.. كما أنها تمثل الحافز
القوي للالتزام بأوامر الله الواحد الأحد، والإنتهاء بنواهيه المتمثلة
بالشريعة والأحكام، والإلتزام بالحقائق الإيمانية، وكل ما جاءهم به
رسول الله «صلى الله عليه وآله» عن الله تبارك وتعالى..
ثم بين لهم سبل الرشاد والهداية إلى ذلك كله وهو
الالتزام بالثقلين، وهما كتاب الله والعترة.
ثم تأتي بعد ذلك الأسئلة التقريرية، التي واجههم بها
التي فرضت عليهم التنبه التام، وأن تنشد القلوب والعقول إلى النتيجة
التي يريد أن ينتهي إليها. وليكون الجميع قد استنفروا كل قواهم لتلقي
كل كلمة، واستنطاق كل حرف يتفوه به، لتقوم بذلك الحجة عليهم، وليأخذوا
الأمر بجدية تامة، من دون أن يفسح المجال لأي تأويل أو اجتهاد يرمي إلى
تمييع القضية، والإنتقاص من حيويتها، ومن الشعور بخطورتها وأهميتها.
أما مضمون الأسئلة فكان هو الأهم، والأجدر بالتأثير،
حيث إنه بعد سؤاله عن أولويته بالمؤمنين ـ بما هم جماعة([7])
ـ من أنفسهم، سألهم عن أولويته بكل فرد فرد من نفسه.. فأعطاهم الإنطباع
بأن الأمر يعني كل فردٍ فردٍ منهم، بشخصه، وبلحمه ودمه، وكل وجوده.
ثم هو يسألهم عن حدود سلطتهم على أنفسهم، ويريد أن يسمع
إقرارهم له بأن سلطته وولايته عليهم، وموقعه منهم فوق سلطة وموقعية
وولاية أمهاتهم وآبائهم، وحتى أنفسهم على أنفسهم.
وهذا يؤكد لهم:
أن القرار الذي يريد أن يتخذه يعنيهم في صميم وجودهم،
وينالهم في أخص شؤونهم وحالاتهم، ولا بد أن يزيد هذا الأمر من اهتمامهم
بمعرفة هذا الأمر الخطير، والتعامل معه بإيجابية متناهية.
ثم إنه «صلى الله عليه وآله» لم يكتف بسؤالهم عن ذلك
لمرة واحدة، بل كرر السؤال عن نفس الأمور الأساسية والحساسة عليهم ثلاث
مرات على سبيل التعميم أولاً، ثم على سبيل التحديد والتشخيص بفرد بعينه
أخرى، فقد روي أنه «صلى الله عليه وآله» قال: أيها الناس، من أولى
الناس بالمؤمنين.
قالوا:
الله ورسوله أعلم.
قال:
أولى الناس بالمؤمنين أهل بيتي. يقول ذلك ثلاث مرات.
ثم قال في الرابعة، وأخذ بيد علي:
اللهم من كنت مولاه، فعلي مولاه، اللهم وال من والاه
وعاد من عاداه ـ يقولها ثلاث مرات ـ ألا فليبلغ الشاهد الغائب([8]).
وفي نص آخر:
كرر ذلك أربع مرات([9]).
وعن البراء بن عازب:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» نزل بعد حجته في بعض
الطريق، وأمر بالصلاة جامعه، فأخذ بيد علي، فقال: ألست أولى بالمؤمنين
من أنفسهم؟!
قالوا:
بلى.
قال:
ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟!
قالوا:
بلى.
قال:
فهذا ولي من أنا مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من
عاداه([10]).
وفي نص آخر عن البراء:
خرجنا مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» حتى نزلنا
غدير خم، بعث منادياً ينادي. فلما اجتمعنا قال: ألست أولى بكم من
أنفسكم؟
قلنا:
بلى يا رسول الله.
قال:
ألست أولى بكم من أمهاتكم؟
قلنا:
بلى يا رسول الله.
قال:
ألست أولى بكم من آبائكم؟
قلنا:
بلى يا رسول الله.
قال:
ألست؟ ألست؟ ألست؟
قلنا:
بلى يا رسول الله.
قال:
>من
كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه<.
فقال عمر بن الخطاب:
هنيئاً لك يا بن أبي طالب، أصبحت اليوم ولي كل مؤمن([11]).
ثم إنه «صلى الله عليه وآله» لم يتكل على ما يعرفه من
رغبة الناس بنقل ما يصادفونه في أسفارهم، إلى زوارهم بعد عودتهم، فلعل
أحداً يكتفي بذكر ذلك فور عودته، ثم لا يعود لديه دافع إلى ذكره في
الفترات اللاحقة، فجاء أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» لهم ليلزمهم
بإبلاغ كل من غاب عن هذا المشهد، مهما تطاول الزمن، وجعل ذلك مسؤولية
شرعية في أعناقهم.
وبذلك يكون قد سد باب التعلل من أي كان من الناس بادعاء
أن أحداً لم يبلغه هذا الأمر، وأنه إنما كان قضية في واقعة، وقد لا
ينشط الكثيرون لذكرها، إن لم يكن ثمة ما يلزمهم بذلك.. ولعلهم قد كانت
لديهم اهتمامات أخرى شغلتهم عنها..
قال الزبيدي:
«ومن المجاز: عُمِّمَ ـ بالضم ـ أي سُوِّد، لأن تيجان
العرب العمائم، فكلما قيل في العجم: توج، من التاج قيل في العرب: عمم..
وكانوا إذا سودوا رجلاً عمموه عمامة حمراء، وكانت الفُرْسُ تتوج
ملوكها، فيقال له: المتوج..»
([12]).
وقال:
«والعرب تسمي العمائم التاج، وفي الحديث: «العمائم
تيجان العرب» جمع تاج، وهو ما يصاغ للملوك من الذهب والجوهر، أراد أن
العمائم للعرب بمنزلة التيجان للملوك؛ لأنهم أكثر ما يكونون في البوادي
مكشوفي الرؤوس أو بالقلانس، والعمائم فيهم قليلة.. والأكاليل: تيجان
ملوك العجم. وتوّجه: أي سوّده، وعممه»([13]).
وعن رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«العمائم تيجان العرب»([14]).
وعن علي «عليه السلام» قوله:
عممني رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوم غدير خم
بعمامة، فسدلها خلفي (أو فسدل طرفها على منكبي)، ثم قال: «إن الله
أمدَّني (أيدني) يوم بدر وحنين بملائكة يعتمّون هذه العمة».
وقال:
«إن العمامة حاجزة بين الكفر والإيمان»([15]).
وعن ابن شاذان في مشيخته عن علي
«عليه السلام»:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» عممه بيده، فذنب العمامة
من ورائه ومن بين يديه، ثم قال له النبي «صلى الله عليه وآله»: أدبر.
فأدبر.
ثم قال له:
أقبل.
فأقبل.
وأقبل على أصحابه، فقال النبي «صلى
الله عليه وآله»:
هكذا تكون تيجان الملائكة([16]).
والعمامة التي عممه بها تسمى السحاب([17]).
وقد قال ابن الأثير:
«كان اسم عمامة النبي «صلى الله عليه وآله» السحاب»([18]).
قال الملطي:
«قولهم ـ يعني الروافض ـ: علي في السحاب. فإنما ذلك قول
النبي «صلى الله عليه وآله» لعلي: أقبل، وهو معتم بعمامة للنبي «صلى
الله عليه وآله» كانت تدعى «السحاب»، فقال «صلى الله عليه وآله»: قد
أقبل علي في السحاب، يعني في تلك العمامة التي تسمى «السحاب»، فتأولوه
هؤلاء على غير تأويله»([19]).
وقال الغزالي والحلبي والشعراني:
«وكانت له عمامة تسمى السحاب، فوهبها من علي، فربما طلع
علي فيها، فيقول «صلى الله عليه وآله»: طلع علي في السحاب»([20]).
ونقول:
إن لنا مع النصوص المتقدمة وقفات هي
التالية:
إننا نلاحظ:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد مازج بين واقع ما يجري،
وبين الرمز المشير، الذي يجعل الإنسان يعيش الشعور التمثلي الرابط بين
الرمز وبين حركة الواقع.
1 ـ
فيرى كيف يسبغ النبي «صلى الله عليه وآله» على علي
«عليه السلام» مقام الرئاسة والسيادة، وذلك حين يعممه بيده. ولا يأمره
بلبس العمامة، وكأنه يريد أن يحسس الناس بأنه يريد أن يجعل من هذه
الحركة الرمزية وسيلة لإنشاء مقام الحاكمية له..
2 ـ
ثم إنه «صلى الله عليه وآله» يختار أن تكون العمامة
التي يتوِّجه بها هي نفس العمامة التي عرف الناس أنها له، حتى بما لها
من اسم ومن خصوصية مميزة.. ليشير بذلك إلى أنه إنما يعطيه الموقع الذي
هو له، أو انه يريده أن يكون امتداداً له فيما يمثله، وفيما يوكل إليه
من مهام..
3 ـ
ثم هو يتجاوز الفعل إلى القول، فيعلن: أنه يقصد بفعله
هذا تكريس معنى السيادة والحاكمية فيه من خلال هذا التتويج، ما دام أن
العمائم تيجان العرب.
4 ـ
ثم تجاوز ذلك إلى إعطاء هذا التصرف المقصود مضموناً
دينياً عميقاً، ومثيراً، حين أعلن أن ما فعله بعلي «عليه السلام» لا
يشبه لبس الآخرين من الأسياد والحاكمين لعمائم سيادتهم، بل هي سيادة
خاصة تمتد قداستها، بعمقها الروحي، وبمضمونها الإيماني المرتبط
بالسماء، ما دام أن الملائكة فقط هم الذين يعتمون هذه العمة.
5 ـ
ولم يكن فعل الملائكة هذا مجرد ممارسة لأمر يخصهم، ولا
كان يريد لعلي «عليه السلام» أن يتشبه بهم فيه، أو أن يكون له شبه
بهم.. بل هو فعل له ارتباطاته الواقعية والعملية، بنفس حركة علي «عليه
السلام» الجهادية والإيمانية، حيث قرر: أن الملائكة إنما تعتم بهذه
العمامة في خصوص بدر وحنين.. وهما الواقعتان المتشابهتان جداً في كثير
من خصوصياتهما، والمتميزتان بأن علياً «عليه السلام» جاء بالنصر فيهما،
ولم يكن لأي من مناوئي علي «عليه السلام» أي دور أو أثر إلا الفرار من
الزحف، وربما الممالأة لأهل الشرك على أهل الإيمان..
في حين أن الإسلام كله كان رهن النصر الذي أحرزه سيف
علي «عليه السلام» دون سواه.
6 ـ
ثم جاء التصريح بعد التلميح ليؤكد على أن هذه العمامة
بما لها من دلالات وخصوصيات ترمز إلى أمر أهم من ذلك كله، وهو: أنها
الحد الفاصل بين الإيمان الخالص وبين دنس الشرك، بمختلف مظاهره وحالاته
وحتى لو بمستوى أن يراود خاطر أي من الطامحين والطامعين، أو تلوث
وجدانه استجابة لأي طمع بالحياة الدنيا.
7 ـ
أما ما نسبه الملطي للروافض، من أنهم قد تأولوا قول
النبي «صلى الله عليه وآله»: «طلع علي في السحاب»، فلعله لا يقصد
بالروافض الإمامية الاثني عشرية أعزهم الله تعالى.. فإننا لا نشعر أن
لديهم أي تأويل يعاني من أية شائبة تذكر..
أما غيرهم، فإن كان الملطي صادقاً فيما يقول، فلسنا
مسؤولين عن أفعال وأقوال أهل الزيغ، بل سنكون مع من يناوئهم، ويدفع
كيدهم، ويسقط أباطيلهم.
ثم إن الإنسان قد لا يجد في نفسه دافعاً نحو ارتكاب بعض
الأمور إلا إذا كان هناك تزيين شيطاني، ووسوسة، وسعي لقلب الحقائق،
وجعل القبيح حسناً، والحسن قبيحاً، ولو بربطه بأمور أخرى تكون ظاهرة
الحسن أو القبح، أو الإيهام بأن هذا مصداق لها، وفي جملة منطبقاتها،
ولو عن طريق الإدعاء والتخييل.
وهذا ما يعبر عنه بالتزيين الشيطاني الذي يظهر القبح
بصورة الحسن، قال تعالى:
{زُيِّنَ
لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ}([21]).
{أَفَمَنْ
كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ
عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ}([22]).
{زُيِّنَ
لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ}([23]).
{وَكَذَلِكَ
زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ}([24]).
{وَكَذَلِكَ
زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ المُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ
شُرَكَاؤُهُمْ}([25])
وآيات كثيرة أخرى.
وهناك أمور لا يحتاج الإنسان للاندفاع إليها إلى تزيين
شيطاني، بل تكون هي بنفسها تملك زينة ظاهرة، تلائم نوازع النفس
الأمارة، فيتلهى الإنسان بزينتها تلك عن التدبر في واقعها السيء، الذي
قد يكون بمثابة السم المهلك.
وربما يكون الأمر من قبيل الدواء الذي يشفي المريض، لكن
النفس الأمارة حين تتلاءم مع بعض حالات ذلك الدواء، كما لو كان له طعم
العسل مثلاً، تخرج فيه عن المقدار المفيد، وتتناوله على غير الوصف الذي
حُدِّد له، فيفقد تأثيره من أجل ذلك، أو يصبح مضراً، وربما يؤدي إلى
الهلاك في بعض الأحيان..
والإمارة والسلطان هي من الأمور التي تتلاءم في بعض
جوانبها مع نوازع النفس الأمارة، فتندفع إليها، ولا تهتم بواقعها السيء،
المتمثل في كونها ظلماً وعدواناً على الناس، واغتصاباً لحق الغير.. بل
هي حين تفقد شرعيتها تمرد على الله، وتعدٍ على حاكميته المطلقة، وتجاوز
لحدوده..
ولأجل ذلك نلاحظ:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد بدأ خطبته بالإستعاذة
بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، التي هي الأكثر فعالية، والأشد
تأثيراً في الإندفاع إلى التعدي على حدود الله، وغصب الحاكمية من
صاحبها الشرعي، والتعدي على حقوق الناس وظلمهم.
ثم إنه «صلى الله عليه وآله» بعد أن استعاذ بالله من
شرور الأنفس، وسيئات الأعمال، لكي لا يستسلم الناس لدواعي الغفلة،
عرفهم أن الله الذي يعيذهم هو المالك الحقيقي للتصرف، وأن لجوءهم إليه،
إذا كانوا صادقين فيه، سوف يجعلهم في حصنٍ حصين، وسيعني هذا اللجوء
أنهم يستحقون أن يعود عليهم بالفضل، ويفتح أمامهم أبواب الرحمة.
ولن تستطيع أية قوة أن توصد تلك الأبواب، بل لا بد أن
يبقوا في ذلك الحصن الحصين، والمكان الأمين ما شاؤوا.. وما استقاموا
على طريق الحق.
وحين يتسبب العبد بأن توصد أمامه أبواب الرحمة والهداية،
فلن يستطيع أحد أن يفتح تلك الأبواب أمامه، إلا إذا أصلح ذلك العبد ما
أفسده، واستحق أن يعود الله عليه بالرحمة، فإن الله تعالى وحده دون
سواه هو الذي يفتح أمامه تلك الأبواب من جديد، على قاعدة:
{مَا
يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا
يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الحَكِيمُ}([26]).
وهذا البيان يفسر لنا قوله «صلى الله عليه وآله»: لا هادي لمن أضل
الخ..
ثم إنه «صلى الله عليه وآله» بادر إلى الشهادة لله
بالوحدانية، والإقرار على نفسه بالعبودية لله، ولها بالرسولية، توطئة
لتقرير ذلك الحشد بمثل ذلك، وتسهيلاً للإقرار به عليهم، ورفعاً
لاستهجانهم، وإبعاداً لأي ظن أو احتمال قد يراود أذهانهم فيما يرتبط
بمستوى الثقة، واليقين بصدق إيمانهم. فإن ذلك أدعى لإلزامهم فيما
يلزمون به أنفسهم، وأقوى في تعظيم أمر النكث وتهجينه، واستقباح صدوره
منهم، إن لم يكن تديناً وخوفاً من العقوبة في الآخرة، فالتزاماً
بالإعتبارات التي ألزموا بها أنفسهم في الحياة الدنيا.
فهو يستعين بكل ما لا مانع شرعاً من الإستعانة به لدفع
الفساد، والإفساد، وتضييق الخناق على الباطل، وتأكيد وضوح الحق، فهو
نظير قول أمير المؤمنين «عليه السلام» لأصحابه: أما تستحيون؟! أما
تغارون؟! نساؤكم يزاحمن العلوج في الأسواق؟!([27]).
فإنه «عليه السلام» يريد أن يحرك فيهم معنى الحياء
والغيرة، لكي يبادروا إلى منع ما قد ينشأ عنه الفساد، ولو في أدنى
مستوياته.
وهكذا فعل رسول الله «صلى الله عليه وآله» فإنه ذكرهم
بأصل التوحيد، فشهدوا لله تعالى بالوحدانية، وبأصل النبوة، فشهدوا له
«صلى الله عليه وآله» بأنه رسول من الله إليهم، مما يعني أن ما يأتيهم
به هو من عند الله.
وذكَّرهم بالنار التي يعاقب بها المتمردون على الله،
المخالفون لرسوله، وبالجنة التي يثاب بها المطيعون لهما، وبأن الموت
حق، والبعث والحساب حق، فلماذا يتعلقون بالدنيا، ويفسدون آخرتهم من
أجلها..
ثم ذكَّرهم بالإمامة، وبما يحفظ من الهداية والضلال،
وبميزان الأعمال من خلال التأكيد على حديث الثقلين.
كل ذلك توطئة لنصب أمير المؤمنين «عليه الصلاة السلام»
ولياً وهادياً، ومرجعاً وإماماً.
وربما يسعى بعض الناس إلى إشاعة
المفهوم القائل:
إن أمر الحب والبغض ليس اختيارياً، وذلك ليتسنى لهم
التملص من تبعات حبهم لمن يبغضهم الله، وبغضهم لمن يحبهم الله تبارك
وتعالى.
باعتبار أن الإنسان لا يحاسب على الحب والبغض إلا إذا
ظهرت آثارهما في مقام العمل، فالحساب إنما يكون عليه، لا عليهما.
ولكن ما ورد في كلام الرسول «صلى الله عليه وآله» يوم
غدير خم يدل على خلاف ذلك، حيث دعى «صلى الله عليه وآله» لمحب علي
«عليه السلام»، ودعا على مبغضه، فقال: «اللهم وال من والاه، وعاد من
عاداه، وأحب من أحبه، وابغض من أبغضه».
ولأجل ذلك،
أوجب تعالى حب أهل الإيمان وبغض أهل الضلال والكفر
والطغيان. وعاتب وعاقب من يخالف ذلك.. وتجد في الآيات والروايات ما
يؤكد هذا الأمر، فراجع.
وقد ضمَّن النبي «صلى الله عليه وآله» دعاءه لعلي «عليه
السلام» يوم الغدير قوله: «وأدر الحق معه حيث دار»، فدل ذلك على أن
المولوية التي جعلها له «عليه السلام» تختزن معنى الحق والمسؤولية عنه،
علماً أو عملاً، أو كلاهما. إذ لولا ذلك لم يحتج إلى هذا الدعاء.
وهذه المسؤولية عن الحق هي التي فرضت أن يقرن «صلى الله
عليه وآله» بين القرآن والعترة لحفظ الأمة من الضلال، وجعل استمرار هذا
الاقتران بينهما من مسؤولية الأمة أيضاً.
ولا بد أن يكون اقتراناً متناسباً مع شمولية القرآن،
ومع ما تضمنه من حقائق، وما يتوخى من موقف للأمة تجاهه.. ومع مسؤولية
العترة تجاه القرآن في مجال العلم والعمل، والتربية، وما يترتب على ذلك
من لزوم الطاعة والنصرة، وما إلى ذلك.. ولا يكون ذلك إلا بالتمسك به،
وبالعترة في العلم وفي العمل والممارسة.. سواء في الأحكام أو في القضاء
بين الناس، أو في السياسات، أو في الإعتقادات، أو في الأخلاق، و في كل
ما عدا ذلك من حقائق، لهج وصرح بها القرآن الكريم، وهذا يختزن معنى
الإمامة بكل أبعادها وشؤونها..
ويؤكد هذا المعنى، ويزيده رسوخاً
قوله «صلى الله عليه وآله»:
«وانصر من نصره، واخذل من خذله..»، فإن إيجاب النصر له
على الناس، وتحريم الخذلان إنما هو في صورة التعرض للتحدي، والمواجهة
بالمكروه، من أي نوع كان، ومن أي جهة صدرت.
وذلك يشير إلى:
أنه «عليه السلام» هو المحق في كل نزاع يحاول الآخرون
أن يفرضوه عليه، وأن على الأمة نصره، بردع المعتدي، فإن لم تستطع، فلا
أقل من أن لا تنصر أعداءه، وأن تعتقد بأن غيره ظالم له، معتد عليه،
مبطل في ما يدَّعيه.
وقد جاءت هذه الإشارات اللائحة، والدلالات الواضحة قبل
وفاته «صلى الله عليه وآله» بيسير، وقد واجه علي «عليه السلام» المحنة
التي فرضها عليه نفس هؤلاء الذين خاطبهم رسول الله «صلى الله عليه
وآله» بهذا الخطاب!! واستنطقهم، وقررهم، وردوا عليه الجواب. وهم الذين
هنأوا علياً «عليه السلام»، وبخبخوا له، وبايعوه، حتى قال ابن عباس:
وجبت ـ والله ـ في أعناق القوم.
وقد تقدم:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد أمر أمهات المؤمنين بأن
يسرن إلى علي «عليه السلام» ويهنئنه، ففعلن، وما ذلك إلا لأنه يريد أن
يقطع العذر لمن تريد منهن أن تشن عليه حرباً ضروساً، يقتل فيها المئات
والألوف، فلا تدَّعي أنها لم تعرف شيئاً مما جرى في يوم الغدير، لأنها
كانت معزولة في خدرها عن الحدث، رهينة الحجاب المفروض عليها.
أو أن تدّعي:
أن ما عرفته من أفواه الناس من أقاربها كان لا يقيم
حجة، ولا يقطع عذراً، أما النساء فإنهن وإن أبلغنها بشيء مما كان يجري،
لكن حالهن حالها، وربما يبلغها ما لا يبلغهن، أو أن ما يبلغها قد يكون
أكثر دقة مما يتناهى إلى مسامعهن، بعد أن تعبث به الأهواء، ويختلط مع
التفسيرات والتأويلات، والإجتهادات وما إلى ذلك..
وإن نفس الطلب إلى نساء النبي «صلى الله عليه وآله» بأن
يقمن بهذا الأمر، لا بد أن يفسح المجال لسؤالهن عن سبب هذه التهنئة،
وعن حقيقة ما جرى. لا سيما إذا كانت هذه أول مرة يطلب فيها من أمهات
المؤمنين أن يشاركن في تهنئة أحد، فإن هذا أمر له ارتباط بالرجال غير
رسول الله «صلى الله عليه وآله».. وقد جاء الأمر بذلك عاماً وشاملاً
لهن من دون استثناء، فلا مجال للتأويل والتحليل، أو لاحتمال أن ذلك كان
لخصوصية اقتضت طلب ذلك من امرأة بعينها..
قال السيد المرتضى «رحمه الله»:
إن أولى بمعنى مولى، كما قاله أئمة اللغة في تفسير
الآية([28]).
أما سائر معاني كلمة مولى فهي إما بديهية الثبوت لعلي،
فيكون ذكرها في يوم الغدير عبثاً.. مثل: «ابن العم، والناصر» التي ذكر
أنها من معاني «المولى».
وإما واضحة الإنتفاء، ولا يصح
إرادتها. مثل:
«معنى المعتِق والمعتَق، فلا يصح إرادتهما في مناسبة
الغدير، لأن ذلك يستلزم الكذب فيهما.. وذلك لا يصدر من رسول الله «صلى
الله عليه وآله»..».
فأجاب الرازي بما ملخصه:
إنه لو كان مولى وأولى بمعنى واحد لصح استعمال كل منهما
مكان الآخر، فكان يجب أن يصح أن يقال: هذا مولى من فلان.. ويصح أن
يقال: هذا أولى من فلان([29]).
وقد أجاب علماؤنا على كلام الرازي بما يلي:
أولاً:
إن الترادف إنما يكون في حاصل المعنى، دون الخصوصيات
التي تنشأ من اختلاف الصيغ، والإشتقاقات، أو أنحاء الإستعمال.. فكلمة
«أفضل» تضاف إلى صيغة التثنيه بدون كلمة «من»، فيقال: زيد أفضل
الرجلين، لكن حين تضاف إلى المفرد، فلا بد من كلمة من، فلا يقال: زيد
أفضل عمرو، بل يقال: زيد أفضل من عمرو.
ثانياً:
لنأخذ معنى الناصر في كلمة «مولى».. فإنه يصح أن يقال:
فلان ناصر دين الله، ولكن لا يصح أن يقال: فلان مولى دين الله.
وقال عيسى:
{مَنْ
أَنْصَارِي إِلَى اللهِ}([30]).
ولا يقال: من مواليّ إلى الله..
ويقال:
الله ولي المؤمنين ومولاهم.. ويقال: فلان ولي الله، ولا
يقال: مولى الله، كما ذكره الراغب([31]).
ويقال:
إنك عالم. ولا يقال: إنَّ أنت عالم.
فالمولى اسم للمتولي، والمالك للأمر، والأولى بالتصرف.
وليس صفة ولا هو من صيغ أفعل التفضيل بمنزلة الأولى، لكي يقال: إنه لا
يأخذ أحكام كلمة «أولى» التي هي صفة..
ثالثاً:
لو كان المراد بالمولى المحب والناصر، فقوله «صلى الله
عليه وآله»: «من كنت مولاه فعلي مولاه». إن كان المراد به: الإخبار
بوجوب حبه «عليه السلام» على المؤمنين، أو إنشاء وجوب حبه عليهم، فذلك
يكون من باب تحصيل الحاصل، لأن كل مؤمن يجب حبه على أخيه المؤمن، فما
معنى أن يجمع عشرات الألوف في ذلك المكان؟! ليقول لهم: يجب أن تحبوا
أخاكم علياً؟!
ولماذا يكون ذلك موازياً لتبليغ الرسالة
{وَإِنْ
لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ}؟!([32]).
ولماذا يكمل به الدين، وتتم به النعمة؟!.
ولماذا يهنئه عمر وأبو بكر بهذا
الأمر، ويقولان له:
أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، وكأنه لم يكن كذلك.
قبل هذا الوقت باعتقادهما.
ألم يكن الله تعالى قد أوجب على المؤمنين أن يحب بعضهم
بعضاً؟!
ألم يكن الله قد اعتبر المؤمنين بمثابة الإخوة؟!
يضاف إلى ما تقدم:
أن وجوب النصرة والمحبة لا يختص بعلي «عليه السلام»، بل
يشمل جميع المؤمنين.
وإن كان المقصود هو إيجاب نصرة مخصوصة تزيد على ما
أوجبه الله على المؤمنين تجاه بعضهم، فهو المطلوب، لأن هذا هو معنى
الإمامة، ولا سيما مع الإستدلال على هذه النصرة الخاصة بمولوية النبي
«صلى الله عليه وآله» لهم..
وإن كان المراد الإخبار بأنه يجب على علي «عليه السلام»
أن يحبهم وأن ينصرهم.. فلا يحتاج هذا إلى جمع الناس يوم الغدير، ولا
إلى نزول الآيات، وما إلى ذلك.. إذ كان يكفي أن يخبر علياً بأنه يجب
عليه ذلك..
وعلى كل حال، فإن قوله «صلى الله عليه وآله»:
«ألست أولى بكم من أنفسكم» يفيد أنها ولاية نصرة ومحبة
ناشئة عن هذه الأولوية منهم بأنفسهم.. كما أن جعل وجوب نصرة علي «عليه
السلام» كوجوب نصرة النبي «صلى الله عليه وآله» لهم يؤكد ذلك..
فإن نصرة النبي «صلى الله عليه وآله» لهم إنما هي من
حيث نبوته، وملكه لأمورهم، وزعامته عليهم.. وليست كوجوب نصرتهم أو
محبتهم لبعضهم بعضاً.
وأما القول بأن المراد بالمولى
المالك والمعتق، فيرد عليه:
أنه لم يكن هناك مالكية حقيقية، ولا عتق، ولا انعتاق.
وإن كان المراد بكلمة مولى:
السيد، فهو يقترب من معنى الأولى، لأن السيد هو المتقدم
على غيره. وهذا التقدم ليس بالقهر والظلم، لأن النبي «صلى الله عليه
وآله» قرن سيادة علي «عليه السلام» بسيادة نفسه، فلا بد أن يكون التقدم
بالإستحقاق، من خلال ما يملك من مزايا ترجحه عليهم، وبديهي: أن أية
مزية شخصية لا توجب تقدماً، ولا تجعل له حقاً عليهم، يجعله أولى بهم من
أنفسهم، إلا إذا كانت هذه المزية قد أوجبت أن يجعل من بيده منح الحق
ومنعه لصاحب هذه المزية مقام الأولوية بهذا المستوى الذي هو من شؤون
النبوة والإمامة. وليس لأحد الحق في منح هذا المقام إلا لله تبارك
وتعالى..
وكذلك الحال لو كان المراد بكلمة المولى، المتصرف
والمتولي للأمر، فإن حق التصرف إنما يثبت له بجعل من له الحق في الجعل،
وهو الله سبحانه وفق ما ذكرنا آنفاً..
وقد ذكر العلامة الأميني وغيره:
أن الذي يجمع تلك المعاني كلها هو الأولى بالشيء، فإنه
مأخوذ من جميع تلك المعاني بنوع من العناية، فـ «المعتِق» أولى. لأن له
حقاً على «المعتَق»، وهو أولى به لتفضله عليه.
والمالك أولى بالمملوك، والسيد أولى بمن هم تحت سيادته،
والابن أولى بالأب، والأخ أولى بأخيه، والتابع أولى بمتبوعه، والصاحب
أولى بصاحبه الخ..
فالمعاني التي تذكر لكلمة مولى ليست معاني لها على سبيل
الإشتراك اللفظي، بل هي خصوصيات في موارد استعمال كلمة مولى، وليس لها
دخل في معناها وهو «الأولى». وقد اشتبه عندهم المفهوم بخصوصية المصداق.
وقوله «صلى الله عليه وآله»:
«ألست أولى بكم من أنفسكم» يدل على ما نقول..
ويدل عليه أيضاً:
ما ورد في بعض نصوص الحديث، من أنه «صلى الله عليه
وآله» سأل الناس، فقال: فمن وليكم؟!
قالوا:
الله ورسوله مولانا.
وقوله «صلى الله عليه وآله» في نص
آخر:
«تمام نبوتي، وتمام دين الله في ولاية علي بعدي..» فإن
ما يتم به الدين هو الولاية بمعنى الإمامة.
وفي
بعض النصوص أنه «صلى الله عليه وآله» قال في تلك المناسبة:
هنئوني، هنئوني، إن الله تعالى خصني بالنبوة، وخص أهل بيتي بالإمامة..
يضاف إلى ذلك قوله «صلى الله عليه
وآله»:
الله أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضا الرب
برسالتي، والولاية لعلي من بعدي.
ويؤيد ذلك أيضاً، بل يدل عليه:
بيعتهم لعلي «عليه السلام» في تلك المناسبة، وقد استمرت
ثلاثة أيام.
وكذلك قوله «صلى الله عليه وآله»:
«إني راجعت ربي خشية طعن أهل النفاق ومكذبيهم، فأوعدني
لأبلغها أو ليعذبني» أو ما هو قريب من هذه المعاني، فإن طعن أهل
النفاق، وخوف النبي «صلى الله عليه وآله» من الإبلاغ إنما هو لأمر جليل
كأمر الإمامة، ولا ينسجم ذلك مع إرادة المحب أو الناصر من كلمة المولى.
يضاف إلى ذلك، التعبير بكلمة:
«نصب علياً»، أو «أمر الله تعالى نبيه أن ينصبني»، أو
«نصبني» أو نحو ذلك.
وعبارة ابن عباس:
وجبت والله في رقاب (أو في أعناق) القوم.
ونزول قوله تعالى:
{وَالله
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}([33]).
وثمة مؤيدات وقرائن أخرى ذكرها كلها العلامة الأميني في
كتابه الغدير، فراجع الجزء الأول منه، فصل «القرائن المعيّنة لمعنى
الحديث». وراجع الأحاديث الأخرى المفسرة لمعناه أيضاً في كتاب الغدير
ج1 ص385 ـ 390.
([1])
الفصول المهمة لابن الصباغ ص241 والغدير ج1 ص10 و 26 و 27 عن
مصادر كثيرة أخرى، والبداية والنهاية ج5 ص209 وج7 ص348 وتاريخ
مدينة دمشق ج12 ص226 والصواعق المحرقة ص43. وراجع: كتاب
الأربعين للماحوزي ص139 وخلاصة عبقات الأنوار ج7 ص155 و 156
وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج6 ص342.
([2])
جامع أحاديث الشيعة ج1 ص33 وكتاب الولاية لابن عقدة الكوفي
ص233 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج 6 ص 344 وج21 ص79 والغدير
ج1 ص25 و 47 عن جواهر العقدين للسمهودي، وينابيع المودة ص38 و
39 و (دار الأسوة للطباعة) ج1 ص120.
([3])
الخصائص للنسائي ص21 والغدير ج1 ص30 و 34 والسنن الكبرى
للبيهقي ج5 ص130 وإكمال الدين ص235 و 238 ومناقب الإمام أمير
المؤمنين «عليه السلام» للكوفي ج2 ص435 والبحار ج37 ص137 ومجمع
الزوائد ج9 ص164 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص130 و (مكتبة نينوى
الحديثة) ص93 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص416 والمناقب
للخوارزمي ص154 والبداية والنهاية ج5 ص228 وأنساب الأشراف
للبلاذري ص111 وتفسير = = الآلوسي ج6 ص194 وكنز العمال ج13
ص104 وخلاصة عبقات الأنوار ج1 ص134 و 138 و 145 و 174 و 193 و
231 وج7 ص11 و 256 و 292 وج8 ص116 و 118 و 120 و 126
والمراجعات للسيد شرف الدين ص262 وشرح إحقاق الحق (الملحقات)
ج4 ص440 وج6 ص374 وج15 ص648 وج16 ص566 وج20 ص354 وج21 ص46 وج22
ص119 و 127 و 129 وج24 ص217 وج30 ص403.
([4])
المستدرك للحاكم ج3 ص533 وخلاصة عبقات الأنوار ج7 ص248 وج9 ص83
والغدير ج1 ص32 والمعجم الكبير ج5 ص171 وشرح إحقاق الحق= = ج4
ص438 وج18 ص271 ومناقب الإمام أمير المؤمنين «عليه السلام»
للكوفي ج2 ص440.
([5])
المستدرك على الصحيحين ج3 ص109 وشرح إحقاق الحق ج4 ص437 وج9
ص321 وج18 ص272 وج21 ص41 وخلاصة عبقات الأنوار ج1 ص153 وج7
ص105 و 261 و 339 وجامع أحاديث الشيعة ج1 ص24 والغدير ج1 ص31
والإكمال في أسماء الرجال ص119.
([6])
المناقب للخوارزمي ص94 والغدير ج1 ص277 وشرح إحقاق الحق
(الملحقات) ج6 ص235.
([7])
وقد قال تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ
أَنْفُسِهِمْ﴾ الآية 6 من سورة الأحزاب.
([8])
الفصول المهمة لابن الصباغ ج1 ص238 وكتاب الأربعين للماحوزي
ص144 وكشف الغمة ج1 ص49 ـ 50 عن الزهري، وخلاصة عبقات الأنوار
ج1 ص258 وج7 ص229 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج6 ص234 و 301
وج21 ص93 والروضة في فضائل أمير المؤمنين ص118 وسعد السعود
لابن= = طاووس ص71 والبحار ج42 ص156 والغدير ج1 ص11 و 33 و 176
وراجع: الإصابة لابن حجر (ط دار الكتب العلمية) ج1 ص34
([9])
مشكاة المصابيح ج3 ص360 وتذكرة الخواص ص29 وفضائل الصحابة
لأحمد بن حنبل ج2 ص586 وعن مسند أحمد ج5 ص494 وكفاية الطالب
ص285 وعن ابن عقدة، والغدير ج1 ص11.
([10])
الطرائف ص149 وكتاب الأربعين للشيرازي ص116 والعمدة لابن
البطريق ص96 و 100 والمناقب لابن شهرآشوب ج2 ص236 والبحار ج37
ص159 ومسند أحمد ج4 ص281 وسنن ابن ماجة ج1 ص43 ومناقب الإمام
أمير المؤمنين «عليه السلام» للكوفي ج1 ص442 وج2 ص370 وخلاصة
عبقات الأنوار ج7 ص80 و 86 و 115 و 122 و 147 و 294 و 301 و
335 وج8 ص117 و 218 و 247 وج9 ص261 والغدير ج1 ص220 و 272 و
274 و 277 و 279 ونظم درر السمطين ص109 وخصائص الوحي المبين
لابن البطريق ص89 وتفسير الثعلبي ج4 ص92 وتاريخ مدينة دمشق ج42
ص221 وتاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص632 وبشارة المصطفى لطبري ص284
والمنـاقب للخوارزمي = = ص155 ونهج الإيمان لابن جبر ص120
وينابيع المودة ج1 ص102 وج2 ص284 وشرح إحقاق الحق (الملحقات)
ج6 ص235 و 238 وج14 ص34 وج20 ص173 و 357 وج21 ص34 و 38 و 39
وج23 ص325 و 554 وج30 ص418 و 419.
([11])
مناقب الإمام أمير المؤمنين «عليه السلام» للكوفي ج2 ص368 و
441 وخلاصة عبقات الأنوار ج7 ص29 و 146 وج9 ص93 والبداية
والنهاية ج7 ص386 وتـاريـخ مدينـة دمشق ج42 ص220 وشرح إحقـاق
الحق (الملحقات) ج6 = = ص361 و 376 والغدير (ط مركز الغدير
للدراسات الإسلامية) ج1 ص50 ـ 53 و (ط دار الكتاب العربي) ج1
ص19 و 20 متناً وهامشاً عن مصادر كثيرة جداً.
([12])
تاج العروس ج8 ص410 و (ط دار الفكر) ج17 ص506 والغدير ج1 ص290
وراجع: لسان العرب ج17 ص506.
([13])
تاج العروس ج2 ص12 و (ط دار الفكر) ج3 ص305 والغدير ج1 ص290
ولسان العرب ج2 ص219.
([14])
راجع بالإضافة إلى تاج العروس ج2 ص12: الجامع الصغير ج2 ص193
والنهاية في غريب الحديث ج1 ص199 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت)
ج5 ص56 و 57 و (ط دار الإسلامية) ج3 ص378 ومكارم الأخلاق
للطبرسي ص119 وأدب الإملاء والإستملاء للسمعاني ص39 ومسند
الشهاب لابن سلامة ج1 ص75 والغدير ج1 ص290 وجامع أحاديث الشيعة
ج16 ص746 ونور الأبصار ص58 والفردوس للديلمي ج3 ص87 حديث رقم
4246.
([15])
مسند أبي داود الطيالسي ص23 وكنز العمال ج15 ص306 و 482 و 483
والسمط المجيد ص99 ومناقب الإمام أمير المؤمنين «عليه السلام»
للكوفي ج2 ص42 وفرائد السمطين ج1 ص75 و 76 وعن ابن أبي شيبة،
ومعرفة الصحـابـة لأبي نعيـم ج1 ص301 والسنن الكـبرى للبيهقي
ج10 ص14 = = والرياض النضرة ج3 ص170 والغدير ج1 ص291 وخلاصة
عبقات الأنوار ج9 ص234 وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ج5 ص10
والفصول المهمة لابن الصباغ ص41 وعن الصراط السوي.
([16])
الغدير ج1 ص291 وفرائد السمطين ج1 ص76 ونظم درر السمطين ص112
وكنز العمال ج15 ص484 وراجع: الوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج5
ص56 و (ط دار الإسلامية) ج3 ص377 وكشف اللثام (ط.ج) ج3 ص263
والحدائق الناضرة ج7 ص127 والكافي ج6 ص461 وجواهر الكلام ج8
ص247 وغنائم الأيام ج2 ص353 والبحار ج42 ص69 وج80 ص198 وجامع
أحاديث الشيعة ج16 ص747 ومكارم الأخلاق للطبرسي ص120 ورياض
المسائل ج3 ص213.
([17])
الفردوس ج3 ص87 وفرائد السمطين ج1 ص76 وخلاصة عبقات الأنوار ج9
ص236 والغدير ج1 ص290 و 291.
([18])
النهاية في اللغة ج2 ص345 وراجع: البحار ج10 ص5 وج16 ص97 و 121
و 126 وج30 ص94 وشرح السير الكبير للسرخسي ج1 ص71 ونهج الإيمان
لابن جبر ص497 وسبل الهدى والرشاد ج7 ص271 ولسان العرب ج1 ص461
وتاج العروس ج2 ص68.
([19])
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص19 والغدير ج1 ص292.
([20])
إحياء علوم الدين ج2 ص345 والبحر الزخار ج1 ص215 وعن السيرة
الحلبية ج3 ص341 والغدير ج1 ص292 وشرح إحقاق الحق (الملحقات)
ج6 ص563 والإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» ص 283.
([21])
الآية 37 من سورة التوبة.
([22])
الآية 14 من سورة محمد.
([23])
الآية 8 من سورة فاطر
([24])
الآية 37 من سورة غافر.
([25])
الآية 137 من سورة الأنعام.
([26])
الآية 2 من سورة فاطر.
([27])
الكافي ج5 ص537 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج20 ص236 و (ط دار
الإسلامية) ج14 ص174 والشرح الكبير لابن قدامه ج8 ص144 وكنز
العمال ج3 ص780 ومسند أحمد ج1 ص133 ومشكاة الأنوار ص417 وراجع:
البحار ج76 ص115 وجامع أحاديث الشيعة ج20 ص271 ومستدرك سفينة
البحار ج8 ص96 موسوعة أحاديث أهل البيت «عليهم السلام» ج8 ص243
والمغني لابن قدامه ج8 ص137 والحدائق الناضرة ج23 ص153 وجامع
أحاديث الشيعة ج20 ص271 وجامع السعادات ج1 ص239.
([28])
راجع: رسائل المرتضى ج3 ص253 وج4 ص131 والشافي في الإمامة
للشريف المرتضى ج2 ص261 وراجع: العمدة لابن البطريق ص116
والبحار ج37 ص238 وج37 ص240 وتفسير مجمع البيان ج8 ص125 ونهج
الإيمان لابن جبر ص124 والصراط المستقيم ج1 ص308 والرسائل
العشر للشيخ الطوسي ص135 وراجع: كنز الفوائد ص229 وقد ذكر
العلامة الأميني طائفة كبيرة من أقوال العرب وأهل اللغة، فراجع
كتاب الغدير ج1 ص345 ـ 348.
([29])
راجع: التفسير الكبير ج29 ص227 والغدير ج1 ص350 و 351 عنه، وعن
نهاية العقول، تفسير الآلوسي ج27 ص178.
([30])
الآية 52 من سورة آل عمران.
([31])
مفردات الراغب ص533.
([32])
الآية 67 من سورة المائدة.
([33])
الآية 67 من سورة المائدة.
|