شبهات.. وأجوبتها
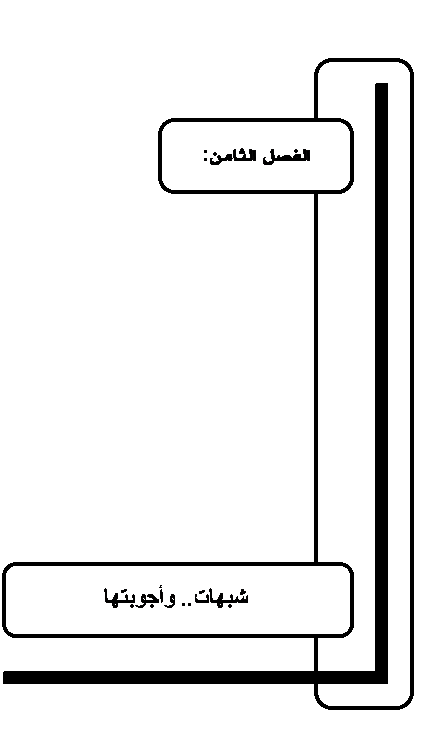
وقد تقدم قولهم:
إن يوم الغدير كان يوم الخميس في الثامن عشر من ذي
الحجة..
ولكن هذا يناقض إجماع أهل السنة على أن يوم عرفة في حجة
الوداع كان يوم الجمعة، لأن هذا يحتم أن يكون يوم الأحد، لأنه يكون هو
الثامن عشر من ذي الحجة..
ويؤكد هذا الإشكال:
أنهم يقولون: إن أول ذي الحجة كان يوم الخميس([1]).
والذي نراه:
أن هذا الإجماع السُنِّي الذي أشار إليه العلامة
الأميني، إنما يستند إلى رواية البخاري ومسلم، التي صرح فيها عمر وبعض
آخر: بأن يوم عرفة في حجة الوداع كان يوم الجمعة، فإن ظهر خطأ الرواية
في ذلك، فإن على المجمعين أن يغيروا رأيهم تبعاً لما ظهر.
وقد ظهر:
أن ما صرحوا به في تحديد يوم الغدير بيوم الخميس يقتضي
أن يكون يوم عرفة يوم الثلاثاء..
وقد صرحت رواية رواها ابن جرير
وغيره:
بأن يوم عرفة الذي هو يوم نزول سورة المائدة
{الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}([2])
هو يوم الإثنين([3]).
ولعل الأمر اشتبه على الراوي بين الإثنين والثلاثاء.
وهذه الرواية وإن حكم عليها بعضهم بضعف السند. لكن ضعف
السند لا يعني كذب المضمون. فإذا أيدت الشواهد أنه أقرب إلى الصحة، أخذ
به، وأهمل ما عداه، لقوة احتمال السهو أو الغلط، أو تعمد الكذب فيه،
وذلك ظاهر لا يخفى.
وقد يروق للبعض أن يسجل اعتراضاً على قول الشيعة من
دلالة حديث الغدير على الإمامة؛ فيقول: إن الحديث وإن كان ثابتاً
ومتواتراً من حيث السند، ولكنه لو كان دالاً على الإمامة والخلافة بعد
رسول الله «صلى الله عليه وآله» لاحتج به علي «عليه السلام» على
مناوئيه، وغاصبي حقه بعد وفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله» مباشرة،
ولو فعل ذلك لحسم الأمر، ولأعيدت الأمور إلى نصابها.
ولا يصح التسويف في هذا الأمر، إذ لا عطر بدون عروس.
ونقول في الجواب:
أولاً:
إنكم قد ذكرتم بأن جمهور علماء السنة ـ إلا من شذ ـ لا
ينكرون صدور هذا الحديث.
فإذا كان الحديث ثابتاً ومعلوماً لدى كل أحد، وكان
النبي «صلى الله عليه وآله» قد أورده أمام عشرات الألوف من الناس، كما
ذكرت الروايات، فلا تبقى حاجة إلى الإحتجاج به؟! فإن من يعرف حرمة
الكذب، ويقرأ الآيات في ذلك، ويسمع تأكيدات الرسول «صلى الله عليه
وآله»، على حرمته.
ومن يعرف حرمة السرقة، ويقرأ آيات تحريمها صباح مساء.
ومن يعرف وجوب الصلاة، ويقرأ ويسمع آيات القرآن، وكلمات
الرسول «صلى الله عليه وآله» في الحث عليها، والدعوة إليها.. فإنه حين
يمارس الكذب، ويقدم على السرقة، وعلى ترك الصلاة جهاراً نهاراً، فسيكون
الاحتجاج عليه بالآيات والروايات عبثاً، وبلا فائدة أو عائدة.
وهكذا الحال بالنسبة لحديث الغدير، فإن من يأتي بالآلاف
من حملة السلاح من بني أسلم، ويستقوي بهم، ويهاجم بيت فاطمة «عليها
السلام»، ويضربها ويسقط جنينها، ويأخذ علياً أمير المؤمنين «عليه
السلام» بالقوة للبيعة.
ومن يقول:
إن النبي ليهجر ـ وهو على فراش المرض ـ ليمنعه من كتابة
كتاب لا تضل الأمة بعده.. وهو يفعل ذلك كله ـ قبل أن ينبس علي «عليه
السلام» ولا غيره ببنت شفة حول الخلافة.
مع أنه قد حضر قبل سبعين يوماً فقط يوم الغدير، وسمع
أقوال رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وبايع علياً «عليه السلام»، في
ذلك اليوم وهنأه بالولاية..
إن من يفعل ذلك، فإن الاحتجاج لا ينفع معه لأنه يكون
ظاهر الجحود، في نفسه.. ولن يزيد ذلك الناس معرفة بالحق.. لأن الناس
كلهم لم ينسوا يوم الغدير وسواه من المواقف الحاسمة، كما لا ينسون
صلاتهم وصيامهم..
ثانياً:
لو سلمنا جدلاً أن التاريخ لم ينقل لنا شيئاً من
احتجاجات علي والزهراء «عليهما السلام»، فهو لا يدل على عدم حصوله منه
ومنها «عليهما السلام»، لا سيما مع الحرص الظاهر على محاربة علي، وطمس
كل شيء يؤيد حقه «عليه السلام» بالأمر، والتخلص من كل ما يدين خصومه
فيما أقدموا عليه..
وعدم نقل أهل السنة ذلك، يعد أمراً طبيعياً، لأن نقلهم
له إنما يعني تسجيل إدانة لأناس يريدون تبرئتهم من كل شيء، بل يريدون
ادِّعاء العصمة لهم، وإظهار أهليتهم للإمامة، والخلافة والزعامة. كما
أنه سوف يحدث خللاً اعتقادياً لو أراد الناس الالتزام بلوازمه.. ولا
أحب أن أقول أكثر من هذا..
ثالثاً:
إنه ليس ثمة ما يدل على انحصار الحجية بما نقله محدثو
ومؤرخو، وعلماء أهل السنة، بحيث يبطل ذلك أقوال، ونقولات غيرهم.. ومن
يدّعي هذا الانحصار يحتاج إلى دليل..
بل ربما يكون دليل مخالفيهم هو الأقوى.. لأن هذا
التوثيق، وذاك الرفض يتوقف على حسم الأمر في مسألة الإمامة وفقاً
للأدلة الشرعية المتوفرة، فلا معنى لفرض اتجاه معين في الأخذ بمصادر
ومراجع بعينها، قبل حسم الأمر في تلك المسألة، لأن هناك من يقول: إن
الأدلة القاطعة تدل على أن قضايا الدين لا بد أن تؤخذ من القرآن، ومن
خصوص عترة الرسول «صلى الله عليه وآله» المعصومين، والمنصوص عليهم، فمن
خالفهم في شيء، فإنه يردّ عليه..
رابعاً:
إننا نجد في مصادر أهل السنة والشيعة العديد من الموارد
التي أشير فيها إلى أن علياً كان يحتج بحديث الغدير، ويسعى لحمل الذين
حضروا واقعة الغدير على أن يعلنوا للناس بما رأوا وبما سمعوا في ذلك
اليوم الأغرّ، وقد أثمرت هذه المناشدات والإحتجاجات شهادات بصحة هذا
الحديث، وتأكيدات على وقوعه، واعترافات من المناوئين الذين كانوا يسعون
لقلب الأمور رأساً على عقب.
ونحن نذكر من ذلك الشواهد التالية:
إن النصوص قد ذكرت:
1 ـ
إحتجاج علي «عليه السلام» بحديث الغدير يوم البيعة لأبي
بكر، فإنه «عليه السلام» قد احتج على أبي بكر ومؤيديه، حينما جيء به
إلى البيعة، فقال: «يا أبا بكر، ما أسرع ما توثبتم على رسول الله! بأي
حق، وبأي منزلة دعوت الناس إلى بيعتك؟ ألم تبايعني بالأمس بأمر الله
وأمر رسوله»؟([4]).
ثم لما هددوه بالقتل إن لم يبايع،
أقبل عليهم علي «عليه السلام»، فقال:
«يا معشر المسلمين والمهاجرين والأنصار، أنشدكم الله،
أسمعتم رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول يوم غدير خم كذا وكذا؟ وفي
غزوة تبوك كذا وكذا»؟ فلم يدع «عليه السلام» شيئاً قاله فيه رسول الله
«صلى الله عليه وآله» علانية للعامة إلا ذكَّرهم إياه.
قالوا:
اللهم نعم.
فلما تخوف أبو بكر أن ينصره الناس،
وأن يمنعوه بادرهم فقال له:
كل ما قلت حق، قد سمعناه بآذاننا وعرفناه، ووعته
قلوبنا، ولكن قد سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول بعد هذا:
«إنا أهل بيت اصطفانا الله وأكرمنا، واختار لنا الآخرة على الدنيا. وإن
الله لم يكن ليجمع لنا أهل البيت النبوة والخلافة».
فقال علي «عليه السلام»:
هل أحد من أصحاب رسول الله شهد هذا معك؟ الخ..
([5]).
وهو استدلال عجيب وغريب من أبي بكر، فإنه يفضي إلى
القول بأن الله ورسوله كانا يعبثان بالناس طيلة ثلاث وعشرين سنة، حيث
كان «صلى الله عليه وآله» بأمر من الله يؤكد الولاية لعلي «عليه
السلام»، ويجمع الناس في منى وعرفات، وفي غدير خم، ويذكر لهم خلافة علي
«عليه السلام» وإمامته، وولايته عليهم من بعده. ويأخذ البيعة له في يوم
الغدير.. و.. و.. الخ.. ثم يتبين أن الله ـ والعياذ بالله ـ كان مخطئاً
حين كان يوجه رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى القيام بهذه الأعمال،
وإطلاق هذه الأقوال كلها.
هذا.. وقد قال «عليه السلام» لرسول أبي بكر، الذي قال
له:
أجب خليفة رسول الله: «سبحان الله، ما أسرع ما كذبتم
على رسول الله، إنه ليعلم ويعلم الذين حوله أن الله ورسوله لم يستخلف
غيري».
وحين أرسل إليه:
أجب أمير المؤمنين قال: «فوالله إنه ليعلم أن هذا الاسم
لا يصلح إلا لي، ولقد أمره رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وهو سابع
سبعة، فسلموا علي بإمرة المؤمنين».
فاستفهم هو وصاحبه عمر من بين السبعة، فقالا:
أحق من الله ورسوله؟
فقال لهما رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
نعم، حقاً، حقاً الخ..([6]).
2 ـ
احتجاجه «عليه السلام»، بحديث الغدير في يوم الشورى،
حيث قال «عليه السلام»: ولأحتجن عليكم بما لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم
تغيير ذلك، ثم قال: أنشدكم الله، أيها النفر جميعاً: أفيكم أحد وحّد
الله قبلي؟
قالوا:
لا..
إلى أن قال:
فأنشدكم الله، هل فيكم أحد قال له رسول الله «صلى الله
عليه وآله»: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من
عاداه، وانصر من نصره. ليبلغ الشاهد الغايب، غيري؟
قالوا:
اللهم لا.. الخ..([7]).
وعلى كل حال:
فقد ذكروا حديث المناشدة عن الدارقطني وابن مردويه،
وأبي يعلى وغيرهم.
ولنفترض:
أن بعض رجال أسناد هذا الحديث ضعاف، فإن ذلك لا يعني
كذب الرواية من الأساس كما هو معلوم. لاسيما مع أن مصلحة الرواة هي في
خلاف مضمون ما يروونه..
3 ـ
واحتج علي «عليه السلام»، بهذا الحديث في خلافة عثمان
أيضاً.. وذلك في المسجد، في حلقة كان فيها أكثر من ماءتي رجل([8])،
فقال: «أفتقرون أن رسول الله دعاني يوم غدير خم، فنادى لي بالولاية، ثم
قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب»؟.
قالوا:
اللهم نعم([9]).
4 ـ
لما بلغه وهو في الكوفة أن الناس يتهمونه فيما يرويه من
تقديم رسول الله «صلى الله عليه وآله» إياه على غيره، حضر في مجتمع من
الناس، وناشد من سمع رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوم الغدير أن
يشهد، فشهد له قوم، وأمسك زيد بن أرقم، فدعا عليه علي «عليه السلام»
بذهاب البصر فعمي.
وقيل:
إن الذين لم يشهدوا ثلاثة. وقيل: إنهم قوم.
وقيل:
فقام أناس كثير فشهدوا.
وفي نص آخر:
شهد له بضعة عشر رجلاً، أو اثنا عشر رجلاً، أو ثلاثة
عشر رجلاً (أو بدرياً). أو ستة عشر رجلاً، أو خمسة، أو ستة، أو ثلاثون،
أو سبعة عشر رجلاً، أو ثمانية عشر([10]).
ونشير هنا إلى أمرين:
الأول:
لماذا لم يشهد أكثر من هذا العدد؟!:
ذكر العلامة الأميني أسماء أربعة وعشرين رجلاً، شهدوا
لأمير المؤمنين «عليه السلام» بحديث الغدير في رحبة الكوفة([11])،
فراجع.
وقد أشار العلامة الأميني:
إلى أن رواية أبي الطفيل قد ذكرت: أن علياً «عليه
السلام» لما قدم الكوفة نشد الناس بحديث الغدير.
وإنما قدم «عليه السلام» الكوفة سنة 35 للهجرة، وبعد
خمسة وعشرين عاماً من استشهاد رسول الله «صلى الله عليه وآله». وكان
كثير من الذين حضروا يوم الغدير قد ماتوا، وكثير منهم كانوا مبثوثين في
مختلف البلاد، وقد فتح العراق بعد استشهاد رسول الله «صلى الله عليه
وآله» بسنوات، وإنما دخل العراق شراذم من الصحابة بعد ذلك..
كما أن هذا الإستشهاد قد جاء على سبيل الإتفاق، ولم
يُهيَّأ له الناس، ولا طُلِبَ من الصحابة الحضور للشهادة، لكي تكثر
الشهود، وتحضر الرواة، وكان في الحاضرين من يخفي شهادته حنقاً أو
سفهاً.
قد ظهر مما تقدم أن ثمة اختلافاً في عدد من شهد. فهل
سبب ذلك هو أنهم أرادوا عدّ خصوص من كان بدرياً. أو أنصارياً، أو على
جانبي المنبر.. أو ان بعضهم أراد تقليل العدد لحاجة في نفسه قضاها؟! كل
ذلك محتمل.
وثمة احتمال آخر، أشير إليه في هامش كتاب الغدير([12])
وقد لهجت بصحته النصوص نفسها، وهو: أن هناك مناشدتين:
إحداهما:
جرت داخل
المسجد، ومن على منبره بالذات، فقام ستة شهود من كل جانب من جانبي
المنبر.. أو قامت جماعة كان منهم اثنا عشر بدرياً([13]).
وأخرى:
في خارج المسجد في الرحبة التي أمامه.. فقام ناس كثير،
أو ثلاثون رجلاً([14]).
وهناك احتمال ثالث، وهو:
أن تكون هذه المناشدات في مسجد الكوفة وفي رحبته قد جرت
عدة مرات.. ويدل على ذلك حديث الركبان التالي:
5 ـ
مناشدة علي «عليه السلام» حين خروجه من القصر، حيث استقبله ركبان
متقلدون السيوف، فقالوا له: السلام عليكم يا مولانا ورحمة الله وبركاته.
فقال «عليه السلام»:
مَنْ ها هنا من أصحاب النبي «صلى الله عليه وآله»؟
فقام ثلاثة عشر (أو اثنا عشر) رجلاً، فشهدوا أنهم سمعوا
النبي «صلى الله عليه وآله» يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه([15]).
وذكرت نصوص أخرى:
أن ركباناً أتوه فشهدوا له بحديث الغدير، وهو في رحبة
الكوفة، فيهم أبو أيوب الأنصاري([16])،
فيحتمل تعدد الواقعة.
وتذكر النصوص هنا أيضاً:
أن بعض من لم يشهد أصيب ببلاء أيضاً، وهم ستة أشخاص([17]).
6 ـ
إحتج «عليه
السلام» على طلحة بحديث الغدير في حرب الجمل([18]).
7 ـ
ناشدهم «عليه السلام» بحديث الغدير أيضاً في صفين، فشهد
له اثنا عشر بدرياً([19]).
8 ـ
واحتجت فاطمة الزهراء «عليها السلام» على غاصبي حقوقها
بحديث الغدير أيضاً([20]).
9 ـ
احتج به الإمام الحسن «عليه السلام» المجتبى في خطبته
حين فرضت عليه الهدنة مع معاوية([21]).
10 ـ
خطب الإمام الحسين «عليه السلام» بمنى في أكثر من سبع
مائة رجل عامتهم من التابعين، ونحو مائتي رجل من أصحاب النبي «صلى الله
عليه وآله»، فكان مما قال: «أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله نصبه
يوم غدير خم، فنادى له بالولاية، وقال: ليبلغ الشاهد الغائب»؟
قالوا:
اللهم نعم([22]).
ونضيف إلى ما تقدم:
11 ـ
إحتجاج عبد الله بن جعفر على معاوية بحديث الغدير([23]).
12 ـ
واحتج رجل همداني اسمه برد على عمرو بن العاص بحديث
الغدير([24]).
13 ـ
واحتج به عمرو بن العاص على معاوية([25]).
14 ـ
واحتج به عمار بن ياسر على عمرو بن العاص([26]).
15 ـ
واحتج به أصبغ بن نباتة في مجلس معاوية أيضاً([27]).
16 ـ
وناشد شاب أبا هريرة بحديث الغدير في مسجد الكوفة([28]).
17 ـ
ناشد رجل زيد بن أرقم بحديث الغدير([29]).
18 ـ
ناشد عراقي جابر الأنصاري بحديث الغدير([30]).
قال الذهبي:
هذا حديث حسن عال جداً، ومتنه متواتر([31]).
19 ـ
واحتج به قيس بن سعد على معاوية([32]).
20 ـ
واحتجت به دارمية الحجونية على معاوية([33]).
21 ـ
احتج به عمرو الأودي على قوم كانوا ينالون من أمير
المؤمنين «عليه السلام»([34]).
22 ـ
استشهد عمر بن عبد العزيز بحديث الغدير أيضاً([35]).
23 ـ
استشهد زريق مولى علي بن أبي طالب على عمر بن عبد
العزيز بحديث الغدير([36]).
24 ـ
احتج المأمون بحديث الغدير على الفقهاء، وفيهم إسحاق بن
إبراهيم، ويحيى بن أكثم([37]).
قال المعتزلي:
«وروى سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عمر
بن عبد الغفار: أن أبا هريرة لما قدم الكوفة مع معاوية، كان يجلس
بالعشيات بباب كندة، ويجلس الناس إليه، فجاء شاب من الكوفة، فجلس إليه،
فقال: يا أبا هريرة، أنشدك الله، أسمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله»
يقول لعلي بن أبي طالب: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»!
فقال:
اللهم نعم.
قال:
فأشهد بالله، لقد واليت عدوه، وعاديت وليه! ثم قام عنه»([38]).
ثم يواصل كلامه عن أبي هريرة، وأنه كان يؤاكل الصبيان
في الطريق، ويلعب معهم. ويخطب الناس بالمدينة.. ثم يقول:
«قلت:
قد ذكر ابن قتيبة هذا كله في كتاب، المعارف، في ترجمة
أبي هريرة، وقوله فيه حجة، لأنه غير متهم عليه».
قال الأميني «رحمه الله»:
«هذا كله قد أسقطته عن كتاب المعارف (ط مصر سنة
1353هـ)
يد التحريف اللاعبة به، وكم فعلت هذه اليد الأمينة لدة هذه في عدة
موارد منه، كما أنها أدخلت فيه ما ليس منه، وقد مر الإيعاز إليه ص192»([39]).
ويبدو أن هناك طبعات أخرى قد أهملت ذلك أيضاً، فراجع
طبعة سنة 1390 هـ.
وقد ذكرنا:
أن هذا الكتاب قد حرف في موارد أخرى، منها ما يرتبط
بإسقاط الزهراء «عليها السلام» لجنينها المحسن بضرب عمر بن الخطاب
لها..
قال اليعقوبي في تاريخه ج2 ص37 (ط النجف الأشرف سنة
1358): «وقد قيل: إن آخر ما نزل عليه:
{الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً}([40]).
وهي الرواية الصحيحة، الثابتة الصريحة. وكان نزولها يوم
النص على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، بغدير خم».
لكن تاريخ اليعقوبي المطبوع في بيروت سنة (مطبوع في دار
صادر ـ بيروت سنة 1379 هـ ـ و1960م ) ج2 ص43 قد جاء محرفاً كما يلي:
«وكان نزولها يوم النفر على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله
عليه بعد ترحم».
وقد ذكرنا طائفة أخرى من الكتب
المحرفة في كتابنا:
«دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام» فراجع.
وعلى كل حال، فليس هذا بالغريب على هؤلاء، وإنما هي «شنشنة
أعرفها من أخزم».
روى شمس الدين أبو الخير الجزري الدمشقي المقري الشافعي
في كتابه أسنى المطالب في مناقب سيدنا علي بن أبي طالب ص49 ـ 51 قال عن
حديث الغدير:
فألطف طريق وقع بهذا الحديث وأغربه ما حدثنا به شيخنا
خاتمة الحفاظ، أبو بكر محمد بن عبد الله بن المحب المقدسي مشافهة:
أخبرتنا الشيخة أم محمد زينب ابنة أحمد عبد الرحيم المقدسية، عن أبي
المظفر محمد بن فتيان بن المثنى، أخبرنا أبو موسى محمد بن أبي بكر
الحافظ، أخبرنا ابن عمة والدي القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن
عبد الواحد المدني بقراءتي عليه، أخبرنا ظفر بن داعي العلوي باستراباد،
أخبرنا والدي وأبو أحمد ابن مطرف المطرفي قالا: حدثنا أبو سعيد
الإدريسي إجازة فيما أخرجه في تاريخ استراباد، حدثني محمد بن محمد بن
الحسن أبو العباس الرشيدي من ولد هارون الرشيد بسمرقند وما كتبناه إلا
عنه، حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الحلواني، حدثنا علي بن محمد بن
جعفر الأهوازي مولى الرشيد، حدثنا بكر بن أحمد القسري.
حدثتنا فاطمة وزينب وأم كلثوم بنات موسى بن جعفر «عليه
السلام»، قلن حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق، حدثتني فاطمة بنت
محمد بن علي، حدثتني فاطمة بنت علي بن الحسين، حدثتني فاطمة وسكينة
ابنتا الحسين بن علي عن أم كلثوم بنت فاطمة عن فاطمة بنت النبي، رسول
الله «صلى الله عليه وآله» ورضي عنها، قالت:
أنسيتم قول رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوم غدير خم،
من كنت مولاه فعلي مولاه؟
وقوله «صلى الله عليه وآله»:
أنت مني بمنزلة هارون من موسى «عليهما السلام»؟
وهكذا أخرجه الحافظ أبو موسى المديني في كتابه المسلسل
بالأسماء، وقال:
هذا الحديث مسلسل من وجه، وهو أن كل واحدة من الفواطم
تروي عن عمة لها، فهو رواية خمس بنات أخ كل واحدة منهن عن عمتها([41]).
ومن الأسئلة التي تطرح هنا السؤال التالي:
هل جملة:
«من كنت مولاه فهذا علي مولاه» خبرية محضة، أو أنها
خبرية يراد بها الإنشاء؟!.
ويجاب بما يلي:
إنه سواء أكانت جملة «من كنت مولاه فهذا علي مولاه»
خبرية محضة، أم خبرية يراد بها الإنشاء، فإن النتيجة واحدة، ولا
يُلْحِقُ ذلك أي ضرر في الاستدلال بها على ولاية أمير المؤمنين «عليه
السلام»..
غير أننا نقول:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» كان قد أخبرهم وبيَّن
لهم طيلة أكثر من عشرين سنة أن علياً «عليه السلام» هو الإمام من بعده،
وكان ذلك منه «صلى الله عليه وآله» بأمر من الله سبحانه..
وقد يعترض على ذلك:
بأنه إذا كانت ولاية أمير المؤمنين «عليه السلام» ثابتة
من أول بعثة النبي «صلى الله عليه وآله»، فما معنى إعادة إنشائها في
يوم الغدير؟ فإن إنشاء الولاية فيه معناه: أنها لم تكن ثابتة قبل ذلك،
وأنها إنما توجد بهذا الإنشاء..
وهذه شبهة في دلالة حديث الغدير، من شأنها أن تجعل
الناس كلهم معذورين في عدم الإلتزام بولايته «عليه السلام»..
والجواب:
إنه لا مانع من إنشاء الولاية مرة بعد أخرى، فيأتي
اللاحق ليؤكد السابق، خصوصاً إذا كان هناك من يفكر في الإنقلاب على
الأعقاب، ويسعى للتشكيك في جدية الأوامر الصادرة، أو في الإلتفاف عليها
بطريقة أو بأخرى، أو تجاهلها. وهذا نظير تأكيدات رسول الله «صلى الله
عليه وآله» على الناس مرة بعد أخرى بأن جهزوا جيش أسامة.
وتتأكد صحة هذا المعنى إذا كان في الحشد المجتمع يوم
الغدير من لم تبلغه الإنشاءات السابقة، أو أنه قد طرحت عليه بعض
الشبهات، والتشكيكات، من قبل الطامعين، والطامحين..
وقد يقول بعضهم:
لو سلم دلالة الحديث على إمامة علي «عليه السلام»، فلا
نسلم دلالته على كونها بعد النبي «صلى الله عليه وآله» بلا فصل، لكي
تنتفي إمامة الثلاثة: أبي بكر، وعمر، وعثمان.
ويرد عليه:
أولاً:
كيف يترك النبي «صلى الله عليه وآله» في حال تصديه لنصب
إمام المسلمين من بعده، حذراً من حضور أجله ـ كيف يترك ـ ذكر ثلاثة من
خلفائه، وينص على الرابع منهم، والذي سيكون إماماً بعد خمس وعشرين سنة
من وفاته «صلى الله عليه وآله»؟!.
ولو جاز ذلك، لكان جميع ولاة العهد محل كلام، إذ لا
يقول السلطان عادة: هذا ولي عهدي بلا فصل.
ثانياً:
لو أخذنا هؤلاء، فإنه حتى لو قال «صلى الله عليه وآله»:
من كنت مولاه فعلي مولاه بعدي، لقالوا: لا منافاة بين البعدية وبين
الفصل بغيره، كما صنع القوشجي في قوله: أنت وصيي وخليفتي من بعدي.
بل لو قال:
فعلي مولاه بعدي بلا فصل، لقالوا: يحتمل أن يكون المعنى
بلا فصل من غير الثلاثة!!([42]).
ثالثاً:
إن حديث الغدير يدل على جعل الولاية لعلي «عليه السلام»
فعلاً. ومن حين صدور الكلام.. لا أنه يجعلها له بعد وفاته «صلى الله
عليه وآله».
رابعاً:
إن الخلفاء الثلاثة لم يجعل لهم النبي «صلى الله عليه
وآله» ولاية، بل هم الذين استأثروا بالأمر لأنفسهم، فتبقى الولاية
المجعولة له بحديث الغدير بلا مزاحم.
ويحاول بعض الناس أن يزعم:
أن الإمامة تدخل في نطاق إكمال البرنامج العملي، الذي
لم يكمله النبي «صلى الله عليه وآله»، فاحتاج إلى من يكمله بعده.
وعلى أساس ذلك تم التفتيش بين المسلمين عن هذه الشخصية
التي تستطيع ملء الفراغ بعد النبي «صلى الله عليه وآله»، فلم يكن غير
الإمام علي «عليه السلام».
ونقول في الجواب:
إنه لا ريب في أن ولاية أمير المؤمنين «عليه السلام»
التي أمر الله سبحانه نبيه «صلى الله عليه وآله» بأن يبلغها في يوم
الغدير وغيره، جزء من دين الإسلام الحنيف، وقد دلت نفس الآيات القرآنية
التي نزلت في مناسبة الغدير على ذلك.. فلاحظ:
1 ـ
قوله تعالى لنبيه «صلى الله عليه وآله»:
{يَا
أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ
لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ
النَّاسِ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}([43]).
حيث يستفاد من هذه الآية:
أولاً:
إن عدم تبليغ ولاية أمير المؤمنين علي «عليه السلام»
يوازي عدم تبليغ الدين كله. فلو كانت الحاجة إلى الإمام علي «عليه
السلام» هي مجرد حاجة إلى مساعد في إكمال البرنامج العملي، فإن ذلك يتم
عبر الاستعانة به، وتمهيد الأمور له ليمسك بزمامها، ولا يحتاج ذلك إلى
نص عليه من الله، وتسجيل ذلك في آيات قرآنية تتلى إلى يوم القيامة، ولا
إلى تبليغ ما أنزل إليه من الله تعالى، ولا يكون ترك ذلك التبليغ
بمثابة ترك تبليغ الرسالة كلها..
إذ إن الحديث في الآية إنما هو عن قيمة مجرد الإبلاغ،
وليس الحديث عن نفس الاستعانة بالإمام علي «عليه السلام» في إكمال
البرنامج العملي، في حركة الرسالة في الواقع!!
ثانياً:
إنه تعالى قد جعل الآخرين الذين لا يرضون بولاية الإمام
علي «عليه السلام» من القوم الكافرين، وهم إنما يكفرون بإنكار حقائق
الدين، لا بمجرد الاعتراض على أن يكون الإمام علي «عليه السلام» هو
المكمل للبرنامج العملي، إذا كان ذلك ناشئاً عن حسد، أو هوى، لا عن
تكذيب للرسول «صلى الله عليه وآله»، وإنكار لصدقه فيما يبلغهم إياه..
ثالثاً:
إن الظاهر هو أن السبب في اعتبار عدم إبلاغ ولايته
«عليه السلام» مساوياً لعدم إبلاغ الرسالة كلها، هو أن أعمال العباد لا
تقبل بدون ولاية الإمام علي «عليه السلام»، فلو أن أحداً قام ليله،
وصام نهاره، وحج دهره، ولم يأت بولاية الإمام علي «عليه السلام» لم
بنفعه ذلك كله شيئاً..
كما أن ولايته صلوات الله وسلامه عليه شرط لاكتمال
التوحيد، وفقاً لما روي عن الإمام الرضا «عليه السلام»، عن آبائه
«عليهم السلام»، عن جبرئيل «عليه السلام»، عن الله سبحانه وتعالى:
«كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي».
ثم قال الإمام الرضا «عليه السلام»:
«بشروطها، وأنا من شروطها»([44]).
وفي نص آخر:
«ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من
عذابي».
ومعنى ذلك أنه لا فرق بينهما لجهة:
أن كلاً منهما ـ أي التوحيد، وولاية الإمام علي «عليه
السلام» ـ حصن الله سبحانه.
فقوله تعالى:
{وَإِنْ
لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ}([45])
يعطينا: أن حقائق الإسلام وشرائعه وأحكامه بمثابة الجسد، المكتمل في
تكوينه، والجامع لكل الميزات، والحائز على جميع الإمكانات والطاقات..
ولكنه يبقى خامداً هامداً، لا فائدة فيه إلا إذا نفخت فيه الروح، فتبدأ
اليد بالحركة، وتدب فيها القوة، وتصبح العين قادرة على الرؤية، والأذن
متمكنة من السمع، وتعطيه اليقظة في العقل وفي المشاعر والأحاسيس و..
و.. الخ..
فولاية الإمام علي «عليه السلام» إذن بمثابة هذه الروح
التي تجعل كل أحكام الدين وشرائعه، وحقائقه وقضاياه مؤثرة في الغايات
المتوخاة منها، موصلة إلى الله تعالى، هادية إليه..
فإذا لم يبلِّغ الرسول «صلى الله عليه وآله» هذه
الولاية، فإنه لم يبلغ أي شيء من رسالة الله سبحانه.. لأن جميع ما بلغه
يكون ناقصاً، وبلا فائدة ولا عائدة، إذ ليس فيه روح وحركة وحياة، ولا
يثمر ثمرة، ولا يؤدي إلى نتيجة..
2 ـ
الآية الثانية: وهي قوله تعالى:
{الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً}([46])..
أفادت بملاحظة نزولها بمناسبة تبليغ ولاية الإمام علي «عليه السلام»
يوم الغدير:
أولاً:
إن ولاية الإمام علي «عليه السلام» جزء من الدين، ولا
يكمل الدين إلا بها..
ثانياً:
إن الإسلام كله لا يكون ديناً مرضياً لله سبحانه بدون
هذه الولاية.. فلو كانت الحاجة إلى الإمام علي «عليه السلام» هي لمجرد
المساعدة في إكمال البرنامج العملي في حركة الرسالة في الواقع، فلا
معنى لربط رضا الله لدينه بها، فإن الدين إذا اكتمل، فإنه يصبح مرضياً،
سواء طبّقه الناس، أم عصوا الله فيه..
أضف إلى ذلك أن الكل يعلم:
أن الإمام علياً «عليه السلام» قد أقصي عن مركزه الذي
جعله الله تعالى له.. فهل بقي هذا الرضا الإلهي لدين الإسلام، أم أنه
قد ذهب وزال بسبب ذلك الإقصاء أيضاً.. فإذا كنا لا نشك في أن رضاه تعلى
للإسلام قد بقي، فذلك يعني أن نفس إبلاغ الولاية هو الذي يكمل به
الدين، وليس لطاعة الناس ومعصيتهم أثر في ذلك..
ثالثاً:
إن رضاه تعالى للإسلام ديناً قد حصل بمجرد حصول ذلك
الإبلاغ. وقد نزلت الآية الدالة على ذلك بمجرد حصول ذلك الإبلاغ، ولم
يكن البرنامج العملي قد أكمل بعد. وذلك يعني أن الذي حصل بالإبلاغ هو
إكمال الدين به فقط.. وذلك ظاهر لا يخفى.
وبذلك يتضح:
أن ما ذكره ذلك البعض من أن آية
{الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}
قد نزلت قبل نصب علي «عليه السلام» يوم الغدير وأن رسول الله «صلى الله
عليه وآله» قد بلغ الرسالة للناس([47])،
ينافي الآيتين المتقدمتين منافاة ظاهرة، ولا أقل من أنه ينافي صريح
الآية الثانية..
على أن مقتضى كلامه هو أن الإمام علياً «عليه السلام»
لم يكن هو الإنسان الذي اصطفاه الله قبل خلق الخلق، إذ مقتضاه: أن
الأمر لا ينحصر بالإمام علي «عليه السلام»، فأي إنسان سواه كان يمكنه
أن يساعد في إكمال البرنامج العملي، يمكن الاستعانة به، وقد يكون هناك
اثنان أو أكثر كان بإمكانهم ـ لو اجتمعوا ـ أن يقوموا مقام الإمام علي
«عليه السلام» في ذلك..
ويشير إلى ذلك قول ذلك البعض نفسه:
«فلا بد أن يتم التفتيش بين المسلمين عن الشخصية التي
تستطيع ملء الفراغ بعد رسول الله الخ..»([48]).
وهذا يخالف ما عليه مذهب شيعة أهل البيت «عليهم
السلام»، وما هو الثابت لهم بالأدلة القاطعة، والبراهين الساطعة من
القرآن ومن السنة الشريفة..
ويبقى أن نشير إلى أن ما ورد في السؤال من طلب معرفة
الفرق بين الدين، وبين البرنامج العملي..
فنقول:
إن ذلك من أوضح الواضحات، وأبده البديهيات، فإن الدين
هو مجموعة الأحكام والشرائع، والحقائق الإيمانية، الثابتة، التي يطلب
من الناس الإيمان والعمل بها، إلى يوم القيامة..
وأما البرنامج العملي، فهو ما يطلب من خلاله تهيئة
الظروف والمناخات لحمل الناس على قبول تلك الحقائق والإيمان بها، وعلى
الالتزام العملي بتلك الشرائع والأحكام..
وهذا الأمر لا يحتاج إلى جعل، ولا إلى تشريع، بل هو
نتيجة جهد بشري، سواء في مجال التخطيط، أو في مجال التنفيذ. والتدخل
الإلهي في هذه الصورة إن كان، فهو إنما يأتي على سبيل المعونة
والتسديد، وليس على سبيل الجعل والتشريع..
وأين هذا من الدين الذي لا بد من الرجوع فيه إلى الله
سبحانه، والانتهاء إليه فيه..
وعلى كل حال نقول:
لو كانت القضية قضية إكمال برنامج عملي لرسول الله «صلى
الله عليه وآله»، يرتبط بتعميق الإسلام لدى أناس كانوا حديثي عهد
بالجاهلية.. لم يكن الناس في الأجيال اللاحقة بحاجة إلى ولاية الإمام
علي «عليه السلام»، لا من حيث الاعتقاد، ولا في دائرة العمل
والممارسة.. ولكانت قضية ولايته محصورة بذلك الجيل من الناس دون
سواهم..
وجاء في حديث احتجاج المأمون على الفقهاء، وفيهم إسحاق
بن إبراهيم قول المأمون لإسحاق: يا إسحاق، هل تروي حديث الولاية؟
قلت:
نعم يا أمير المؤمنين.
قال:
إروه.
ففعلت.
قال:
يا إسحاق، أرأيت هذا الحديث، هل أوجب على أبي بكر وعمر
ما لم يوجب لهما عليه؟
قلت:
إن الناس ذكروا: أن الحديث إنما كان بسبب زيد بن حارثة،
لشيء جرى بينه وبين علي، وأنكر ولاء علي، فقال رسول الله «صلى الله
عليه وآله»: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من
عاداه.
قال:
في أي موضع قال هذا؟ أليس بعد منصرفه من حجة الوداع؟
قلت:
أجل.
قال:
فإن قتل زيد بن حارثة قبل الغدير!
كيف رضيت لنفسك بهذا؟
أخبرني لو رأيت ابناً لك قد أتت
عليه خمسة عشر سنة يقول:
مولاي مولى ابن عمي أيها الناس؟ فاعلموا ذلك. أكنت
منكراً ذلك عليه تعريفه الناس ما لا ينكرون ولا يجهلون؟
فقلت:
اللهم نعم.
قال:
يا إسحاق أفتنزه ابنك عما لا تنزه عنه رسول الله «صلى
الله عليه وآله»؟
ويحكم لا تجعلوا فقهاءكم أربابكم إن الله جل ذكره قال
في كتابه:
{اتَّخَذُوا
أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ}([49]).
ولم يصلُّوا لهم، ولا صاموا، ولا زعموا أنهم أرباب، ولكن أمروهم
فأطاعوا أمرهم([50]).
والظاهر:
أن إشكال المأمون هذا قد آتى ثماره، حيث جاء المصلحون
بعد ذلك ليقولوا: إن هذه الحادثة قد جرت بين أسامة بن زيد بن حارثة
وبين علي.. وقد كان أسامة حياً آنئذٍ، والذي قتل في مؤتة هو أبوه..
فذكروا: أن أسامة قال لعلي «عليه السلام»: لست مولاي، إنما مولاي رسول
الله.
فقال «صلى الله عليه وآله»:
«من كنت مولاه فعلي مولاه»([51]).
ومن الواضح:
أن إشكال المأمون باستشهاد زيد في مؤتة يدل على أن
إقحام اسم أسامة قد جاء متأخراً بهدف حل هذا الإشكال.
لكن لو سلمنا باستبدال زيد بأسامة، فإن إشكال المأمون
بعدم معقولية أن يقول الرجل: مولاي مولى ابن عمي.. يبقى على حاله..
يضاف إلى ذلك:
أنه لو صحت رواياتهم، فلا معنى لأن يوقف النبي «صلى
الله عليه وآله» عشرات الآلاف في حر الرمضاء، ولا معنى لأخذ البيعة
له.. ولا معنى لقول عمر: أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.. ولا معنى
لأن يحتاج إلى العصمة من الناس.. ولا معنى لإكمال الدين وإتمام النعمة،
ولا معنى.. ولا معنى.. إذا كان ينحصر بهذا الخلاف البسيط بين أسامة
وبين علي «عليه السلام».
علي
 كان
باليمن: كان
باليمن:
وذكر ياقوت الحموي:
أن محمد بن جرير الطبري «له كتاب فضائل علي بن أبي طالب
«عليه السلام»، تكلم في أوله بصحة الأخبار الواردة في غدير خم، ثم تلاه
بالفضائل، ولم يتم»([52]).
وقال:
«وكان إذا عرف من إنسان بدعة أبعده واطَّرحه. وكان قد
قال بعض الشيوخ ببغداد بتكذيب غدير خم، وقال: إن علي بن أبي طالب كان
باليمن في الوقت الذي كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» بغدير خم.
وقال هذا الانسان في قصيدة مزدوجة، يصف فيها بلداً
بلداً ومنزلاً منزلاً، أبياتاً يُلَوِّحُ فيها إلى معنى حديث غدير خم،
فقال:
ثــم مــررنـــا بـغـديـر خـــم
كـم قــائــــل فـيـه بـزور جـــم
عــلى عــلي والـنـبـي الأمــــي
وبلغ أبا جعفر ذلك، فابتدأ بالكلام في فضائل علي بن أبي
طالب، وذكر طرق حديث غدير خم، فكثر الناس لاستماع ذلك الخ..»([53]).
وقال الطحاوي:
«فدفع دافع هذا الحديث، وزعم أنه مستحيل، وذكر أن علياً
لم يكن مع النبي «صلى الله عليه وآله» في خروجه إلى الحج من المدينة،
الذي مرَّ في طريقه بغدير خم بالجحفة..»([54]).
ونقول:
إن علياً «عليه السلام» لم يكن باليمن آنئذٍ، لأنه عاد
منها في أيام الحج، وشارك في حجة الوداع، وأشركه النبي «صلى الله عليه
وآله» معه في الهدي، وبعد انتهاء حجة الوداع توجه النبي «صلى الله عليه
وآله» ومعه علي «عليه السلام» إلى المدينة، وجرت قصة الغدير في طريق
العودة([55]).
ويفهم من كلام الذهبي:
أن الذي تكلَّم في حديث الغدير ودفعه وردِّه بهذا الزعم
الباطل، هو ابن أبي داود، فبلغ ذلك محمد بن جرير، فعمل كتاب الفضائل،
ثم قال: قلت: رأيت مجلداً من طرق الحديث لابن جرير، فاندهشت له، ولكثرة
تلك الطرق([56]).
وذكر ابن طاووس:
أن ابن جرير سمى كتابه المشار إليه: «كتاب الرد على
الحرقوصية»([57]).
نسبة إلى حرقوص، أحد زعماء الخوارج، كأنه يشير إلى أن الذي شكك في حديث
الغدير كان من هذه الفرقة الخبيثة.
ورد في رواية جرير بن عبد الله
البجلي لواقعة الغدير:
أنه «صلى الله عليه وآله» أخذ بذراع علي «عليه السلام»
وقال:
«من يكن الله ورسوله مولاه، فإن هذا مولاه، اللهم وال
من والاه، وعاد من عاداه. اللهم من أحبّه من الناس فكن له حبيباً، ومن
أبغضه فكن له مبغضاً. اللهم إنّي لا أجد أحداً استودعه في الأرض بعد
العبدين الصالحين([58])
غيرك([59])،
فاقض له بالحسنى.
قال بشر (الراوي عن جرير) قلت:
من هذان العبدان الصالحان؟
قال:
لا أدري([60]).
و لم يرضوا بتفسير العبدين الصالحين بأنهما الخضر
وإلياس، وقالوا:
لا بدّ من أن
يحدّدهما نصّ المعصوم، وهو غير موجود([61]).
وقد حدث الزهري بحديث الغدير، فقيل له:
لا تحدث بهذا بالشّام وأنت تسمع ملء أذنيك سب علي.
فقال:
و الله، إن عندي من فضائل علي «عليه السلام» ما لو
تحدّثت بها لقتلت([62]).
و هذا يعطي:
أنّ هذا الرجل كان يكتم من فضائل علي «عليه السلام» ما
هو أهم من حديث الغدير.. وذلك خوفاً من القتل، فما بالك بما كان يكتمه
الآخرون من فضائله صلوات الله و سلامه عليه!!
وإذا تأملنا في نص خطبة الغدير، وما جرى في التهنئة به،
الذي رواه محمد بن جرير الطبري، صاحب التاريخ المعروف، والتفسير
الموصوف، ورواه الطبرسي في الإحتجاج وآخرون، ثم راجعنا النصوص المختلفة
الأخرى، فسنخرج بنتيجة حاسمة هي: أنه نص جدير بالتأمل، لأن النصوص
الأخرى تؤيده، والأحداث والوقائع تسدده، وتشيده وتؤكده..
وإذا كانت البيعة في يوم الغدير قد
استمرت مدة طويلة، قيل:
ثلاثة أيام، وقيل: غير ذلك، فلماذا لا يكون «صلى الله
عليه وآله» قد خطب الناس مرة بعد أخرى في تلك الأيام، لكي يقيم الحجة
على أبلغ وجه وأتمه، وليسمعهم المزيد مما ربما يكون أكثر المجتمعين لم
يسمعوه منه. إذ لعل معظمهم لم يكن قد رأى النبي «صلى الله عليه وآله»
قبل ذلك، ولن يراه أكثرهم بعد ذلك.
أما شرح مضامين هذه الخطبة، والإلمام بدلالات سائر ما
جرى فلا بد لنا من الإعتذار عنه، لأنه يحتاج إلى توفر تام، وجهد مستقل.
لا بد من ذكر الواقعة التي نوقشت ها هنا، وهي في كتاب
الغدير الجزء الأول.
ونقول:
لعل عمر بن الخطاب قد بهره جمال ذلك الشاب الذي كان إلى
جانبه، حيث لم يعهد في أقرانه، ونظرائه الذين يعرفهم شيئاً يذكر من
الجمال، باسثناء بني هاشم، فأثار ذلك عجبه، ولم يتهيأ له أن يسأل ذلك
الشاب عن نفسه، فروى ما رأى للنبي «صلى الله عليه وآله» عله يعرف منه
شيئاً عنه.
أو لعله أراد من النبي «صلى الله عليه وآله» أن يأتي
بذلك الشاب ويؤنبه، على ما فرط منه، حين اتهم من يسعى في حل هذا العقد
بأنه منافق.
أو أنه أراد أن يسمع من النبي «صلى
الله عليه وآله» كلمة مفادها:
أن الأمر لا يبلغ إلى هذا الحد. وأن الشاب قد أخطأ في
تقديره..
وحينئذٍ فقط يمكنه أن يروي هذه الواقعة للآخرين.
ولكن عمر قد فوجئ بما لم يكن يخطر له على بال، فقد
أخبره النبي «صلى الله عليه وآله» بأن ذلك الشاب هو جبرئيل، وكم كانت
جميلة تلك اللحظات التي حلم عمر فيها أن يتمكن من رواية ما يسمعه
للآخرين على سبيل التفاخر والمباهاة، باعتبار أن رؤية جبرئيل حدث
متميز، ربما يشير إلى خصوصية غيرعادية في من يوفق لرؤية هذا الملاك
العظيم.
ولكن الذي يصده عن ذلك، كان أعظم وأخطر، فإن ذلك الشاب
الجميل الصورة، قد حكم على من يسعى في حل هذا العقد بالنفاق..
وقد صدَّق النبي «صلى الله عليه وآله» قوله، مبيناً أن
قائل هذا القول هو جبرئيل «عليه السلام».
وإذا عرف الناس ذلك، فسيكون سبباً في زيادة تعقيد
الأمور أمام الساعين في حل هذا العقد، وعمر بن الخطاب منهم، بل هو
العنصر الأبرز والأقوى، والأشد صلابة فيه.
إن ذلك يمثل تأكيداً على أن الله هو الذي أبرم هذا
العقد، وأن أي سعي في الإتجاه الآخر سيكون تمرداً على الله مباشرة.
وليس بالإمكان لمن يعترف بأن جبريل هو الذي حكم بنفاق من يحل العقد أن
يدَّعي للناس: أن من الممكن أن يكون هذا التدبير من ابتكارات رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، حباً بصهره وابن عمه..
([1])
راجع: البحار ج22 ص534 عن كتاب التنوير ذو النسبين بين دحية
والحسين، وفتح الباري ج3 ص323 وعمدة القاري ج16 ص99 وج18 ص60
والبداية والنهاية ج5 ص184 وج5 ص276 وكشف الغمة ج1 ص20 والسيرة
النبوية لابن كثير ج4 ص333 وج4 ص509 وسبل الهدى والرشاد ج12
ص306 وراجع: الغدير ج1 هامش ص42.
([2])
الآية 3 من سورة المائدة.
([3])
جامع البيان ج6 ص54 والدر المنثور ج2 ص258 و 259 عنه. وراجع:
مجمع الزوائد ج1 ص196والمعجم الكبير ج12 ص183 وكنز العمال ج12
ص445 والتبيان للطوسي ج3 ص436 وجامع البيان ج6 ص112 و تفسير
القرآن العظيم ج2 ص15 وتاريخ مدينة دمشق ج3 ص67 و 69 وتاريخ
الإسلام للذهبي ج1 ص26 والبداية والنهاية ج2 ص319 وإمتاع
الأسماع ج14 ص542 والسيرة النبوية لابن كثير ج1 ص198 وسبل
الهدى والرشاد ج1 ص333 و السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3
ص28.
([4])
كتاب سليم بن قيس ج2 ص588 و 589 و (بتحقيق الأنصاري) ص152 و
388 وراجع: ج3 ص965 و 966 والبحار ج28 ص270 و ومجمع النورين
ص99 وشرح النهج للمعتزلي ج18 ص372.
([5])
كتاب سليم بن قيس ج2 ص588 و 589 و (بتحقيق الأنصاري) ص154
وراجع: ج3 ص965 و 966 فهناك مصادر أخرى للحديث، والبحار ج28
ص270 ـ 274 و 300 ومجمع النورين ص99 والمحتضر للحلي ص110.
([6])
كتاب سليم بن قيس ج2 ص583 و و (بتحقيق الأنصاري) ص148 و 268
وراجع مصاد أخرى لهذا الحديث في ج3 ص965 و 966 واليقين لابن
طاووس ص28 والعقد النضيد والدر الفريد لمحمد بن الحسن القمي
ص111 و 113.
([7])
راجع: الغدير ج1 ص159 فما بعدها عن المناقب للخوارزمي الحنفي
ص217 وأخرجه الحمويني الشافعي في فرائد السمطين الباب58 ج1
ص319 وفي الدر النضيد لابن حاتم الشامي، قال: أنشدكم بالله،
أمنكم من نصّبه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، يوم غدير خم
للولاية غيري؟ قالوا: اللهم لا..
وراجع أيضاً: شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج6 ص167 وراجع: الغدير
ج1 ص161
ومصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) للميرجهاني ج3 ص216 وشرح
الأخبار ج2 ص191 وكنز الفوائد ص227 والأمالي للطوسي ص333 و 555
والإحتجاج للطبرسي ج1 ص196والروضة في فضائل أمير المؤمنين
لشاذان = = بن جبرئيل القمي ص118 والبحار ج31 ص332 و 351 و 361
و 368 وتفسير أبي حمزة الثمالي ص152 وتمهيد الأوائل وتلخيص
الدلائل للباقلاني ص514 وبشارة المصطفى للطبري ص374 وكشف
اليقين ص423.
([8])
راجع: إكمال الدين للصدوق ص274 والإحتجاج للطبرسي ج1 ص211
الغدير ج1 ص163 ـ 165 وفرائد السمطين ج1 ص312 وكتاب سليم بن
قيس (بتحقيق الأنصاري) ص71 والتحصين لابن طاووس ص631 والبحار
ج31 ص408 وكتاب الأربعين للماحوزي ص439.
([9])
راجع: كتاب سليم بن قيس ج2 ص641 و 644 و 645 و 646 و (بتحقيق
الأنصاري) ص193 ـ 195 وراجع: المصادر في الهامش السابق.
([10])
راجع فيما تقدم: مناقب أهل البيت «عليه السلام» للشيرواني ص128
وشرح النهج للمعتزلي ج2 ص289 وج4 ص74 وخلاصة عبقات الأنوار ج7
ص39 و 62 و 63 و 86 و 98 و 109 و 129 و 135 و 138 و 186 و 209
و 243 و 251 و 262 و 270 و 272 و 286 و 312 و 324 و 341 و 361
وج9 ص15 و 17 و 18 و 20 و 24 و 26 وقاموس الرجال ج10 ص333 وج11
ص145 و 449 والمعجم الصغير ج1 ص64 وأسد الغابة ج2 ص233 وج3 ص93
و 307 وج4 ص28 وج5 ص6 وكتاب الولاية لابن عقدة ص226 و 229 و
235 و 237 ومسند أحمد ج1 ص88 و 119 والسنن الكبرى للنسائي ج5
ص136 و 155 وذكر أخبار إصبهان ج2 ص228 وكنز العمال ج13 ص155 و
170 وتاريخ بغداد ج14 ص240 والمعجم الأوسط ج7 ص70 والمعجم
الكبير ج5 ص175 وجزء الحميري ص33 وذخائر العقبى للطبري ص68
ومجمع الزوائد ج9 ص105 و 106 و 108 وأمالي المحاملي ص162 ومسند
أبي يعلى ج1 ص429 وخصائص أمير المؤمنين «عليه السلام» للنسائي
ص96 و 103 والبداية والنهاية ج7 ص383 وتـاريـخ مديـنـة دمشـق
ج42 ص206 و 207 و 209 و 212 = = و 214 وتهذيب الكمال للمزي ج22
ص397 والسيرة الحلبية (الملحقات) ج3 ص337 وشرح إحقاق الحق
(الملحقات) ج6 ص305 و 307 و 316 و 323 و 328 و 338 و 378 وج21
ص114 و 119 وج22 ص125 وج23 ص12 و 413 و 416 وج30 ص389 و 404
وينابيع المودة ج2 ص159 وكشف الغمة ج1 ص287 والخرائج والجرائح
ج1 ص208 والإرشاد للمفيد ج1 ص352 والطرائف ص148 وكتاب الأربعين
للماحوزي ص146 والعمدة لابن البطريق ص109 والبحار ج34 ص341
وج37 ص186 و 196 و 197 و 199 و 200 وج41 ص205 وج42 ص148
ومستدرك سفينة البحار ج10 ص469 والمراجعات للسيد شرف الدين
ص268 و 270 و 388. وراجع: الغدير ج1 ص166 ـ 184 عن مصادر كثيرة.
([11])
راجع: الغدير ج1 ص184 ـ 185.
([12])
راجع الغدير (ط مركز الغدير للدراسات) ج1 ص378.
([13])
راجع: مسند أحمد ج4 ص370 وفضائل الصحابة ص1167والبداية
والنهاية ج5 ص211 و (ط دار إحياء التراث العربي) ج7 ص384. وعن
الضياء في المختارة، وينابيع المودة ج2 ص159 والبحار ج3 ص18
وج37 ص196 وج41 ص205 وج42 ص148 والخرائج والجرائح ج1 ص208 و
الإرشاد للمفيد ج1 ص352 والعمدة لابن البطريق ص106 و 110 وكتاب
الأربعين للشيرازي ص114 وخلاصة عبقات الأنوار ج3 ص261 وج9 ص25
وشرح إحقاق الحق ج6 ص318 وج16 ص579 إضافة إلى مصادر أخرى تقدمت.
([14])
مسند أحمد ج1 ص88 و 119 وأمالي المحاملي ص162 والبداية
والنهاية ج7 ص348 وأسد الغابة ج4 ص28 ومجمع الزوائد ج9 ص105
ومسند أبي يعلى ج1 ص429 وكنز العمال ج13 ص170 وتاريخ مدينة
دمشق ج42 ص206 و 207 وذكر أخبار إصبهان ج2 ص228 وتاريخ بغداد
ج14 ص240 والمراجعات للسيد شرف الدين ص268 و 270و 388 وخلاصة
عبقات الأنوار ج7 ص83 و 62 و 86 و 129 و 186 و 207 و 341 و 361
و ج9 ص17 و 20 وج37 ص125 و 148 و 188 و 200 وكتاب الأربعين
للماحوزي ص146 ومناقب الإمام أمير المؤمنين «عليه السلام»
للكوفي ج2 ص367 و 408 و 437 و 444 و 445 والأمالي ص255 وكتاب
الأربعين للشيرازي ص118 والطرائف لابن طاووس ص151 والعمدة لابن
البطريق ص93 بالإضافة على مصادر أخرى تقدمت.
([15])
راجع: الغدير ج1 ص189 و 190 وشرح الأخبار للقاضي النعمان ج1
ص109 وأسد الغابة ج1 ص368 والبحار ج41 ص213 وخلاصة عبقات
الأنوار ج3 ص261 و ج7 ص199
وج9 ص25 وكتـاب الولايـة لابن عقدة = =
ص241 واختيار معرفة الرجال ج1 ص246 وموسوعة الإمام علي بن أبي
طالب «عليه السلام» في الكتاب والسنة والتاريخ ج2 ص216 و 326 و
331 وكتاب الولاية لابن عقدة ص241 ونقد الرجال ج1 ص265 ومعجم
رجال الحديث ج4 ص185 وأعيان الشيعة ج3 ص551 وج4 ص539 والمناشدة
والإحتجاج بحديث الغدير ص59 و 60 و 61 وشرح إحقاق الحق ج6 ص334.
([16])
راجع: الغدير ج1 ص187 و 188 و 380 ومسند أحمد ج5 ص419 والمعجم
الكبير ج4 ص173 والبداية والنهاية ج5 ص231 وج7 ص384 وأعيان
الشيعة ج6 ص287ونهج الإيمان لابن جبر ص116 والعدد القوية ص184
والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص422 وجواهر المطالب ج1 ص83
وينابيع المودة ج1 ص107 وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب «عليه
السلام» في الكتاب والسنة والتاريخ ج2 ص215 وشرح النهج
للمعتزلي ج3 ص208 وغاية المرام ج1 ص269 و 282 و 300 وكشف المهم
في طريق خبر غدير خم ص101 و 148 والمناشدة والإحتجاج بحديث
الغدير ص57 و 58 وشرح الأخبار للقاضي النعمان ج1 ص108 ومعجم
الرجال والحديث لمحمد حياة الأنصاري ج1 ص37 و 50 و 62 و 268
وتاريخ مدينة دمشق ج42 ص211 والدرجات الرفيعة ص315 و 453
والعمدة ص94 و 109 والإكمال في أسماء الرجال ص15 والبحار ج37
ص148 ومناقب أهل البيت «عليهم السلام» للشيرواني ص128 وخلاصة
عبقات الأنوار ج1 ص49 و ج3 ص261 وج7 ص40 و 70 و 94 و 136 و 166
و 169 و 235 وج9 ص135 و 136 و 137 والمراجعات ص273 وموسوعة
أحاديث أهل البيت «عليهم السلام» ج7 ص342 وشرح إحقاق الحق ج6
ص251 و 326 وج16 ص565 وج21 ص59 و 60 وج23 ص7 ص636 وج30 ص422 و
425.
([17])
راجع: الإرشاد للمفيد ج1 ص352 وكشف الغمة ج1 ص287 وشرح النهج
للمعتزلي ج4 ص74 وكتاب الولاية لابن عقدة ص246 وأسد الغابة ج3
ص321 وتاريخ مدينة دمشق ج42 ص208 ومجمع الزوائد ج9 ص106 وقاموس
الرجال ج11 ص116 والمعجم الكبير ج5 ص171 و 175 والإكمال في
أسماء الرجال ص72 وخلاصة عبقات الأنوار ج3 ص262 وج7 ص116 وج9
ص23 و 24 و 25 و 26 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج6 ص308 و 318
و 320 وج8 ص743 و 745 وج16 ص567 وج30 ص397 والبحار ج37 ص200
والغدير ج1 ص192.
([18])
راجع: تخريج الأحاديث والآثار ج2 ص235 وكنز العمال ج11 ص332
وتاريخ مدينة دمشق ج25 ص108 والغدير ج10 ص127 وشرح إحقاق الحق
(الملحقات) ج6 ص249 و 336 وج16 ص568 وج23 ص15 وج23 ص631
والمستدرك للحاكم ج3 ص371 والإكمال في أسماء الرجال ص115.
([19])
راجع: كتاب سليم بن قيس (بتحقيق الأنصاري) ص295 والبحار ج33
ص146 والغدير ج1 ص195.
([20])
راجع: خلاصة عبقات الأنـوار ج7 ص188 وج9 ص103 و 105 و 106 = =
وقاموس الرجال ج12 ص334 والغدير ج1 ص197 وشرح إحقاق الحق ج21
ص27.
([21])
راجع: الأمالي للطوسي ص561 والبحار ج10 ص138 وج69 ص151 والغدير
ج1 ص197 وينابيع المودة ج3 ص366 وكتاب الولاية لابن عقدة ص182
وشرح إحقاق الحق ج5 ص58 وعن حلية الأبرار ج1 ص253 وتفسير
البرهان ج3 ص315 ح26.
([22])
راجع: كتاب سليم بن قيس (تحقيق الأنصاري) ص320 والبحار ج33
ص183 والغدير ج1 ص198 وراجع: الإحتجاج للطبرسي ج2 ص19 وصلح
الحسن «عليه السلام» للسيد شرف الدين ص324.
([23])
راجع: كتاب سليم بن قيس (بتحقيق الأنصاري) ص362 والبحار ج33
ص265 والغدير ج1 ص199.
([24])
راجع: الامامة والسياسة (بتحقيق الزيني) ج1 ص97 و (بتحقيق
الشيري) ج1 ص129 والحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب للسيد
فخار بن معد ص232 وخلاصة عبقات الأنوار ج7 ص82 والغدير ج1 ص201
وج9 ص137 وشرح إحقاق الحق ج6 ص285 وج31 ص382 وج32 ص382.
([25])
راجع: المناقب للخوارزمي ص199 وكشف الغمة ج1 ص258 والبحار ج33
ص52 والعقد النضيد والدر الفريد لمحمد بن الحسن القمي ص و88
وخلاصة عبقات الأنوار ج7 ص148 والغدير ج1 ص201 وشرح إحقاق الحق
(الملحقات) ج5 ص51.
([26])
راجع: كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي ج3 ص77 وشرح النهج
للمعتزلي ج8 ص21 ووقعة صفين للمنقري ص338 والبحار ج33 ص30
وكتاب الأربعين للشيرازي ص630 والغدير ج1 ص202 وج2 ص145.
([27])
راجع: المناقب للخوارزمي ص205 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج6
ص257 والغدير ج1 ص202.
([28])
راجع: الإيضاح لابن شاذان ص535 والغارات للثقفي ج2 ص658 ومناقب
الإمام أمير المؤمنين «عليه السلام» للكوفي ج2 ص394 والسيرة
النبوية ج4 ص425 والبداية والنهاية ج5 ص232 وتاريخ مدينة دمشق
ج42 ص232 ومسند أبي يعلى ج11 ص306 والمصنف لابن أبي شيبة ج7
ص499 ومجمع = = الزوائد ج9 ص105 والبحار ج34 ص325 وخلاصة عبقات
الأنوار ج7 ص185 و 237 و 315 والغدير ج1 ص203 وشرح إحقاق الحق
ج6 ص258 وج21 ص62 و 63.
([29])
راجع: المعجم الكبير ج5 ص194 وينابيع المودة ج2 ص283 وتاريخ
مدينة دمشق ج42 ص216 وخلاصة عبقات الأنوار ج7 ص111 و 178
والغدير ج1 ص204 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج6 ص232 وج21 ص43.
([30])
راجع: سير أعلام النبلاء ج8 ص334 وقال في هامشه: حديث صحيح،
أخرجه ابن ماجة (121) من حديث سعد بن أبي وقاص، وأخرجه أحمد ج4
ص368 والترمذي (713) من حديث زيد بن أرقم، وأخرجه أحمد ج1 ص84
و 118 و 119 و 152 من حديث علي، و 331 من حديث ابن عباس، وج4
ص281 من حديث البراء، وج4 ص368 و 370 و 372 من حديث زيد بن
أرقم، وج5 ص347 من حديث بريدة، و 419 من حديث أبي أيوب
الأنصاري.
وراجع: تاريخ مدينة دمشق ج42 ص225 وخلاصة عبقات الأنوار ج7
ص260 والغدير ج1 ص205 وشرح إحقاق الحق ج6 ص254 وج21 ص67 وج30
ص410 و 411 والجوهرة في نسب الإمام علي وآله للبري التلمساني
ص67.
([31])
راجع: سير أعلام النبلاء ج8 ص334.
([32])
راجع: البحار ج33 ص173 ـ 175 والغدير ج1 ص106 ـ 108 وكتاب سليم
بن قيس ج2 ص777 ح26 و (بتحقيق الأنصاري) ص311.
([33])
راجع: بلاغات النساء لابن طيفور ص72 والطرائف ص27 عن العقد
الفريد (ط مصر 1316هـ) ج1 ص115 والبحار ج33 ص260 والغدير ج1
ص208 و 344 ومستدرك سفينة البحار ج3 ص273 والإمام علي بن أبي
طالب «عليه السلام» للرحماني ص767 ومستدركات علم رجال الحديث
ج8 ص573 وقاموس الرجال ج12 ص254.
([34])
راجع: الأمالي للطوسي ص558 والبحار ج40 ص69 والغدير ج1 ص209.
([35])
راجع: بشارة المصطفى ص378 وخلاصة عبقات الأنوار ج7 ص177
والإمام علي «عليه السلام» في آراء الخلفاء للشيخ مهدي فقيه
إيماني ص173 وفي هامشه عن: حلية الأولياء ج5 ص364 وأسد الغابة
ج5 ص383 ترجمة عمر بن عبد العزيز، وتاريخ مدينة دمشق ج5 ص320
[و (ط دار الفكر) ج65 ص324] رواية زريق القرشي المدني، وفرائد
السمطين ج1 ص66 باب (10) ح32 ونظم درر السمطين ص112. وراجع:
شرح إحقاق الحق (الملحقات) ج6 ص285 وج21 ص92 وج22 ص118.
([36])
راجع: تاريخ مدينة دمشق ج18 ص138 وشرح إحقاق الحق (الملحقات)
ج21 ص51.
([37])
راجع: قاموس الرجال ج12 ص155 والغدير ج1 ص210 والإمام علي
«عليه السلام» في آراء الخلفاء للشيخ مهدي فقيه إيماني ص182 ـ
197 وفي هامشه عن: العقد الفريد ج5 ص92 ـ 101 وعيون أخبار
الرضا للصدوق ج2 ص185 ـ 200 باختلاف يسير.
([38])
شرح النهج للمعتزلي ج4 ص68 الخطبة رقم 56 وكشف الأستار عن مسند
البزار الحديث رقم 2531 والمصنف لابن أبي شيبة حديث رقم 12141
والمطالب العالية حديث 3958 وراجع: أضواء على السنة المحمدية
ص217 وشيخ المضيرة أبا هريرة لأبي رية ص237 والنص والإجتهاد
ص515 وخلاصة عبقات الأنوار ج7 ص230 والغدير ج1 ص204 ومناقب
الإمام أمير المؤمنين «عليه السلام» للكوفي ج2 ص403 والإمام
علي بن أبي طالب «عليه السلام» لأحمد الرحماني ص562 والبحار
ج37 ص199 ومواقف الشيعة ج2 ص311 وموسوعة الإمام علي بن أبي
طالب «عليه السلام» في الكتـاب = = والسنة والتاريخ ج11 ص351
وغاية المرام ج1 ص300 وكشف المهم في طريق خبر غدير خم ص150
والمناشدة والإحتجاج بحديث الغدير ص83 وراجع: مناقب الإمام
أمير المؤمنين «عليه السلام» للكوفي ج2 ص403.
([40])
الآية 3 من سورة المائدة.
([41])
راجع الغدير ج1 ص197.
([42])
راجع: دلائل الصدق ج2 ص62 و63.
([43])
الآية 67 سورة المائدة.
([44])
راجع: نقله في مجلة مدينة العلم، (السنة الأولى) ص415 عن صاحب
تاريخ نيسابور، وعن المناوي في شرح الجامع الصغير، وهي أيضاً
في الصواعق المحرقة ص 122، وحلية الأولياء 3 ص 192، وعيون
أخبار الرضا ج2 ص135و (ط مؤسسة الأعلمي) ج1 ص145 وأمالي الصدوق
ص208، وينابيع المودة ص 364 و 385 وقد ذكر قوله «عليه السلام»:
وأنا من شروطها، في الموضع الثاني فقط. والبحار ج49 ص123 و 126
و 127 ج3 ص7 عن ثواب الأعمال، ومعاني الأخبار، وعيون أخبار
الرضا «عليه السلام»، والتوحيد، والفصول المهمة لابن الصباغ
ص240 ونور الأبصار ص141 ونقلها في مسند الإمام الرضا ج1 ص43 و
44 عن التوحيد، ومعاني الأخبار، وكشف الغمة ج3 ص98. وهي موجودة
في مراجع كثيرة أخرى. لكن يلاحظ: أن بعض هؤلاء قد حذف قوله
«عليه السلام»: «بشروطها، وأنا من شروطها»، ولا يخفى السبب في
ذلك.
وراجع: التوحيد ص25 وثواب الأعمال للصدوق ص7 ومعاني الأخبار
للصدوق = = ص371 وروضة الواعظين للفتال النيسابوري ص42
والمناقب لابن شهرآشوب ج2 ص296 وعوالي اللآلي ج4 ص94 ونور
البراهين للجزائري ج1 ص76 ومستدرك سفينة البحار ج2 ص235 ومسند
الإمام الرضا «عليه السلام» للعطاردي ج1 ص44 وراجع: ينابيع
المودة ج3 ص123.
([45])
الآية 67 من سورة المائدة.
([46])
الآية 3 من سورة المائدة.
([47])
نظرة إسلامية حول الغدير ص16 من 18.
([48])
المصدر السابق ص19.
([49])
الآية 31 من سورة التوبة.
([50])
قاموس الرجال ج12 ص155 والغدير ج1 ص211 ـ 212 والإمام علي
«عليه السلام» في آراء الخلفاء للشيخ مهدي فقيه إيماني ص182 ـ
197 وفي هامشه عن: العقد الفريد ج5 ص92 ـ 101 و (ط أخرى) ج5
ص56 ـ 61 وعيون أخبار الرضا للصدوق ج2 ص185 ـ 200 باختلاف
يسير.
([51])
تحفة الأحوذي ج10 ص148 والنهاية لابن الأثير ج5 ص228 وعن
السيرة الحلبية ج3 ص277 وفيض القدير شرح الجامع الصغير ج6 ص282
ومعاني القرآن للنحاس ج6 ص411 وكتاب الأربعين للماحوزي ص164
وخلاصة عبقات الأنوار ج7 ص42 والغدير ج1 ص383 ولسان العرب ج15
ص410 وشرح إحقاق الحق ج6 ص244 و 291.
([52])
معجم الأدباء ج18 ص80 وقاموس الرجال ج9 ص152.
([53])
معجم الأدباء ج18 ص84 والغدير ج1 ص152.
([54])
تذكرة الحفاظ ج2 ص713 رقم 728 والغدير ج1 ص314 و 294.
([55])
إقبال الأعمال ص453 وأشار إلى كتاب ابن جرير في البداية
والنهاية ج11 ص146 وتهذيب التهذيب ج7 ص339 والفهرست للطوسي
ص150.
([56])
تذكرة الحفاظ ج2 ص713 ومشكل الآثار ج2 ص308 والصواعق المحرقة
ص42 و 43 والمعتصر من المختصر ج2 ص301 والمرقاة في شرح المشكاة
ج10 ص476 والمسترشد للطبري (الشيعي) ص43 وخلاصة عبقات الأنوار
ج7 ص219 والغدير ج1 ص152 و 307 والإمام علي بن أبي طالب «عليه
السلام» لأحمد للرحماني ص808 وفتح الملك العلي لابن الصديق
المغربي ص15.
([57])
راجع: مشكل الآثار ج2 ص308 والصواعق المحرقة ص42 و 43 والمعتصر
من المختصر ج2 ص301 والمرقاة في شرح المشكاة ج10 ص476 وشرح
الأخبار ج1 ص81 والمسترشد للطبري (الشيعي) ص35 وإقبال الأعمال
لابن طاووس ج2 ص239 والبحار ج37 ص126 والغدير ج1 ص153 ورجال
النجاشي ص322 وقاموس الرجال ج9 ص151 و 154 و 193.
([58])
الغدير (تحقيق مركز الغدير للدراسات) ج1 ص621 عن مجمع الزوائد
ج9 ص106 والمعجم الكبير ج2 ص357 وهداية العقول ص31 وقال في
الغدير: في تعليق هداية العقول (ص 31): لعله أراد بالعبدين
الصالحين أبا بكر وعمر، وقيل: الخضر وإلياس، وقيل: حمزة وجعفر
رضي الله عنهما، لأن علياً «عليه السلام» كان يقول عند اشتداد
الحرب: وا حمزتاه ولا حمزة لي؟ وا جعفراه ولا جعفر لي؟
أقول:
هذا رجم بالغيب، إذ لا مجال للنظر في تفسير العبدين الصالحين
بمن ذكر إلا أن يعثر على نص، والظاهر: عدم ذلك لما ذكره سيدي
العلامة بدر الدين محمد بن = = إبراهيم بن المفضل «رحمه الله»
لما سأله بعضهم عن تفسير الحديث، فأجاب بما لفظه: لم أعثر عليه
في شيء من كتب الحديث إلا أن في رواية مجمع الزوائد ما يدل على
عدم معرفة الراوي أيضاً بالمراد بالرجلين لأن فيه قال بشر أي
الراوي عن جرير: قلت: من هذان العبدان الصالحان؟
قال:
لا أدري.
قال
«رحمه الله»: ومثل هذا إن لم يرد به نقل فلا طريق إلى تفسيره
بالنظر أ ه.
وقال
في كتاب على ضفاف الغدير: وأخرجه عنه أحمد بن عيسى المقدسي في
الجزء الثاني من فضائل جرير بن عبد الله البجلي الموجود في
المجموع 93 في المكتبة الظاهرية. أخرجه في الورقة 240.
وأخرجه ابن عساكر في تاريخه: رقم 587، وابن منظور في مختصر
تاريخ دمشق ص17 ص358، والقرافي في نفحات العبير الساري: ق76/ب،
والسيوطي في جمع الجوامع ص1 ص831، وفي قطف الأزهار المتناثرة
في الأحاديث المتواترة ص277 ح102، والزبيدي في لقط اللآلئ
المتناثرة في الأحاديث المتواترة ص206، والشوكاني في در
السحابة ص210، والكتاني في نظم المتناثر في الحديث المتواتر
ص194 وإسحاق بن يوسف الصنعاني في تفريج الكروب في حرف الميم.
([59])
راجع: الغدير ج1 هامش ص62.
([60])
أسد الغابة ج1 ص308 وقال: أخرجه الثلاثة. يريد: ابن عبد البر،
وابن منة، وأبا نعيم.
([61])
راجع الهامش الذي في الصفحة قبل السابقة.
([62])
أسد الغابة ج1 ص308 وقاموس الرجال ج12 ص38 وخلاصة عبقات
الأنوار ج7 ص228 والغدير ج1 ص24 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج6
ص274 و 376.
|