الغدير في ظل التهديدات الإلهية
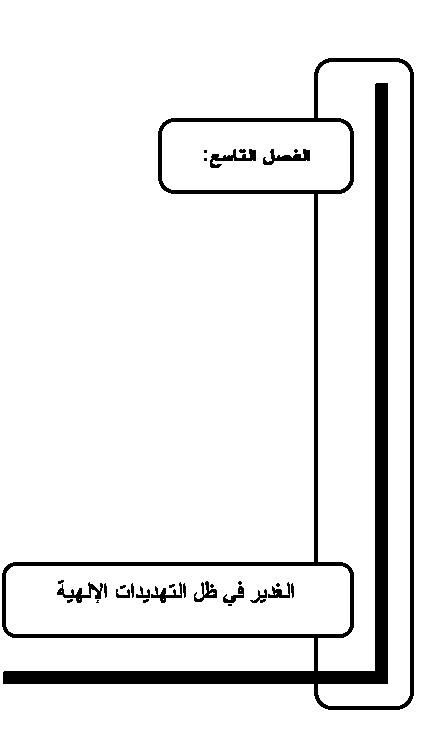
قد عرفنا في الفصل السابق:
أن قريشاً، ومن هم على رأيها هم الذين كانوا يخططون
لصرف الأمر عن بني هاشم، وبالذات عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
«عليه
الصلاة والسلام»،
وكانوا يتصدون لملاحقة هذا الأمر ومتابعته في جميع تفاصيله وجزئياته،
دون كلل أو ملل، ولو عن طريق إثارة الشكوك والشبهات، واختلاق الشائعات،
وحياكة المؤامرات، وتوجيه الإتهامات إلى حد اتهام النبي «صلى الله عليه
وآله» بنزاهته، وفي عدله، وحتى في عقله. حتى قالوا عنه: إنه يهجر..
وكانت قريش تتحدى، وتمانع بالقول، وبالفعل، حتى منعت النبي «صلى الله
عليه وآله» من إعلان هذا الأمر في عرفات، ثم في منى. فراجع.
وقد رأوا:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان في مختلف
المواقع والمواضع لا يزال يهتف باسمه، ويؤكد على إمامته، لكن الأصعب
والأمر عليهم أن يعلن إمامته «عليه السلام» أمام تلك الجموع الغفيرة،
التي جاءت للحج من جميع الأقطار والأمصار، ولأجل ذلك بادروا إلى
التشويش والإخلال بالنظام. وحين غلبوا على أمرهم، وأعلن «صلى الله عليه
وآله» أن الأئمة اثنا عشر كانت قريش بالذات هي التي قصدت النبي «صلى
الله عليه وآله» في منزله بعد هذا الموقف مباشرة، لتستوضح منه ماذا
يكون بعد هؤلاء الأئمة، لترى إن كان لها نصيب في هذا الأمر ولو بعد
حين.
فكان الجواب:
ثم يكون الهرج.
وفي نص آخر:
(الفرج)،
كما رواه الخزاز([1]).
والظاهر:
أن هذا هو الصحيح..
وقد رأى النبي «صلى الله عليه
وآله»:
أن مجرد التلميح لهذا الأمر، قد دفعهم إلى هذا المستوى
من الإسفاف والإسراف في التحدي لإرادة الله سبحانه. ولشخص النبي «صلى
الله عليه وآله»، دون أن يمنعهم من ذلك شرف المكان، ولا خصوصية الزمان،
ولا قداسة المتكلم، وشأنه وكرامته. حسبما أشار إليه «صلى الله عليه
وآله» في تقريره لهم حين سألهم عن أي شهر أعظم حرمة، وأي بلد أعظم
حرمة، وأي يوم أعظم حرمة([2]).
فكيف لو صرح «صلى الله عليه وآله» بذلك، وجهر باسمه
«عليه
الصلاة والسلام»
في ذلك الموقف، فقد يصدر منهم ما هو أمر وأدهى،
وأشر
وأقبح،
وأشد
خطراً على الإسلام
وأهله.
وقد فضح الله بذلك أمر هؤلاء المتظاهرين بغير حقيقتهم،
أمام فئات من الناس، جاءت للحج من كل حدب وصوب، وسيرجع الناس بذكريات
مرة عنهم، ليحدثوا بها أهلهم، وأصدقاءهم، وزوارهم.. في زمان كان الرجوع
من سفر كهذا، والنجاة من أخطاره ومشقاته، بمثابة ولادة جديدة..
ثم جاء التهديد الإلهي لهم، فحسم الموقف، وأبرم الأمر،
وظهر لهم أنهم عاجزون عن الوقوف في وجه إرادة الله، القاضية بلزوم
إقامة الحجة على الناس كافة، وفق ما يريده الله ويرتضيه.
وأدركوا: أن استمرارهم في المواجهة السافرة قد يؤدي بهم إلى حرب حقيقية،
مع
الله ورسوله، وبصورة علنية ومكشوفة.
فلم يكن لهم بد من الرضوخ، والانصياع، لا سيما بعد أن
أفهمهم
الله سبحانه: أنه يعتبر عدم إبلاغ هذا الأمر بمثابة عدم إبلاغ أصل
الدين، وأساس الرسالة،
وأن معارضتهم لهذا الإبلاغ، تجعلهم في جملة أهل الكفر، المحاربين،
الذين يحتاج الرسول إلى العصمة الإلهية منهم.
وهذه الأمور الثلاثة قد تضمنتها الآية الكريمة التي
حددت السياسة الإلهية تجاههم، فهي تقول:
{وَإِن
لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ واللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ
النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ}([3]).
والتركيز على هذه الأمور الثلاثة
معناه:
أن القرار الإلهي هو أنه تعالى سوف يعتبر عدم تبليغ هذا الأمر للناس
بصورة علنية بمثابة العودة إلى نقطة الصفر، وخوض حروب في مستوى بدر،
وأحد والخندق، وحنين وسواها من الحروب التي خاضها المسلمون ضد
المشركين، من أجل تثبيت أساس الدين وإبلاغه.
ومن الواضح لهم:
أن ذلك سوف ينتهي بهزيمتهم وفضيحتهم، وضياع كل الفرص،
وتلاشي جميع الآمال في حصولهم على امتياز يذكر، أو بدونه، حيث تكون
الكارثة بانتظارهم، حيث البلاء المبرم، والهلاك والفناء المحتّم.
فآثروا الرضوخ
ـ مؤقتاً ـ
إلى الأمر الواقع، والانحناء أمام العاصفة، في سياسة
غادرة وماكرة.. ولزمتهم الحجة، بالبيعة التي أخذت منهم له «عليه
السلام» في يوم الغدير. وقامت الحجة بذلك على الأمة بأسرها أيضاً. ولم
يكن المطلوب أكثر من ذلك.
وكان ذلك قبل استشهاده «صلى الله عليه وآله» بسبعين
يوماً..
ولكن ذلك لم يكن ليمنعهم من ادعاء التوبة عما صدر عنهم،
والندم على ما بدر منهم، وادعاء أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد رضي
عليهم وسامحهم، وأنه قد استجدت أمور دعت النبي إلى العدول عن ذلك كله،
فصرف النظر عن تولي الإمام علي «عليه السلام» للأمور بعده.. ربما لأنه
رأى أن العرب لن ترضى بهذا الأمر، لأن علياً «عليه السلام» وترها، وقتل
رجالها.. أو لغير ذلك من أسباب..
1 ـ
فكانت قضية تجهيز جيش أسامة، وظهور عدم انصياعهم لأوامر
النبي «صلى الله عليه وآله» وانسحابهم من منظومة ذلك الجيش، وسعيهم في
تعطيل مسيره، رغم إصرار النبي «صلى الله عليه وآله» عليهم في ذلك، حتى
لقد لعن «صلى الله عليه وآله» من تخلف عن جيش أسامة..
كانت هذه القضية هي الدليل الآخر على أنهم لا يزالون
على سياساتهم تجاه النبي «صلى الله عليه وآله»، وأنهم كانوا دائماً
بصدد عصيان أوامره، رغم شدة غضبه «صلى الله عليه وآله»، منهم، ومن
موقفهم..
وقد يعتذرون عن ذلك بأن حبهم للنبي «صلى الله عليه
وآله»، وخوفهم من أن يحدث له أمر في غيبتهم، هو الذي دعاهم إلى هذا
العصيان، فليس هو عصيان تمرد ولا هو عن سوء نية، بل هو يدل على أنهم في
غاية درجات الحسن والصلاح..
ثم إنهم قد يقولون للناس ـ وقد
قالوا ذلك بالفعل ـ:
إن لعن النبي لهم هو من أسباب زيادة درجات الصلاح فيهم،
حيث روى الرواة عنه «صلى الله عليه وآله» زوراً وبهتاناً، أنه قال:
«والله إني بشر، أرضى وأغضب، كما يغضب البشر، اللهم من
سببته، أو لعنته، فاجعل ذلك زكاة له ورحمة».
أو نحو ذلك من الألفاظ([4]).
2 ـ
فجاءت قضية صلاة أبي بكر بالناس، في مرض موته «صلى الله
عليه وآله»، وعزل النبي «صلى الله عليه وآله» له عنها، لتفسد عليهم أي
ادعاء لأن يكونوا أهلاً لما هو أدنى من مقام إمامة الأمة، وخلافة
النبوة، فإن عدم الأهلية حتى للإمامة في الصلاة، التي لا تحتاج إلا إلى
صحة القراءة «والعدالة»([5])،
يكشف عن عدم الصلاحية لمقام الإمامة الذي يحتاج إلى العلم الغزير، وإلى
العدالة، وإلى الشجاعة، وإلى غير ذلك من صفات..
ولكنهم قد يعتذرون عن ذلك أيضاً بالتشكيك في اشتراط
العدالة، ويروون عن النبي «صلى الله عليه وآله» زوراً وبهتاناً أيضاً
أنه قال: «صلوا
خلف كل بر وفاجر»..
ثم يفتي فقهاؤهم بذلك، أو يدّعون أن النبي هو الذي صلى خلف أبي بكر،
كما صلى ـ بزعمهم الفاسد ورأيهم الكاسد ـ خلف عبد الرحمن بن عوف..
ويدّعون.. ويدّعون..
3 ـ
فجاءت قضية كتابة النبي «صلى الله عليه وآله» الكتاب
الذي لن يضلوا بعده أبداً، لتظهر كيف أنهم لا يتورعون حتى عن اتهام
النبي «صلى الله عليه وآله» في عقله، حتى ليقول قائلهم:
«إن النبي ليهجر»!!
أو قال كلمة معناها:
«غلبه الوجع».
رغم أنه «صلى الله عليه وآله»
لم يصرح لهم بأنه يريد أن يعين الخليفة من بعده، بل قال:
«أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدي أبداً»..
فواجهوه بهذا الأمر العظيم، فكيف لو زاد على ذلك ما هو أوضح وأصرح؟!
ألا يحتمل أن يبادروا حتى إلى قتله؟!
وقد يعتذرون عن ذلك أيضاً بأن الذي تجرأ على النبي «صلى
الله عليه وآله» وواجهه بهذا القول، هو عمر بن الخطاب قد ندم وتاب، وقد
يدعون أنه اعتذر إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، وأنه «صلى الله عليه
وآله» قد عذره وصفح عنه وسامحه.
بل لقد قالوا:
إن ما صنعه عمر، من منع النبي «صلى الله عليه وآله» من
كتب الكتاب كان هو الأصح والأصلح، وأنه لو كتب ذلك الكتاب لاختلف
المسلمون، ولكانت المصيبة أعظم. وسيأتي بيان ذلك
4 ـ
فجاء ما جرى على السيدة الزهراء «عليها السلام» ليؤكد
إصرارهم على مناوأة النبي «صلى الله عليه وآله» في أهدافه، وعلى أنهم
لا يتورعون حتى عن الاعتداء على البنت الوحيدة لرسول الله «صلى الله
عليه وآله».. إلى حد إسقاط الجنين، وكسر الضلع، وضربها إلى حد التسبب
باستشهادها.. وذلك بعد أن جمعوا الألوف من المقاتلين، خصوصاً من قبيلة
بني أسلم. التي كانت تعيش أعرابيتها بالقرب من المدينة، وقد قال تعالى:
{وَمِمَّنْ
حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَابِ مُنَافِقُونَ}([6]).
وقد يعتذرون عن ذلك ويقولون للناس
أيضاً:
لعن الله الشيطان لقد كانت ساعة غضب وعجلة، ولم نكن نحب
أن نسيء إلى بنت رسول الله «صلى الله عليه وآله».. وقد ندمنا أعظم
الندم على ما صدر وبدر منا ـ رغم أن لنا، أسوة برسول الله «صلى الله
عليه وآله»، فإنه إذا كان النبي قد يبدر منه حين الغضب ما لا يناسب
مقامه، وفقاً لحديث: إني بشر أرضى وأغضب كما يغضب البشر، اللهم من
سببته أو لعنته الخ.. فكيف يمكن تنزيه غيره «صلى الله عليه وآله» عن
مثل ذلك؟!
وهذا معناه:
أن ما صدر منهم لا يعني بالضرورة أنهم لا يصلحون لمقام
الإمامة والخلافة، خصوصاً وأن ما صدر منهم تجاه السيدة الزهراء
«عليهاالسلام» كان في ساعات حرجة، مشوبة بالكثير من الإنفعال والتوتر،
وهم يزعمون: أنهم يسعون فيها إلى حفظ الإسلام، قبل انتشار الأمر، وفساد
التدبير..
5 ـ
فجاءت قضية فدك لتبين أن هؤلاء غير صادقين فيما
يدَّعونه، وأنهم يفقدون أدنى المواصفات لمقام خلافة النبوة، فهم:
غير مأمونين على دماء الناس، كما أظهره فعلهم بالسيدة
الزهراء «عليها السلام».
وغير مأمونين على أعراضهم، كما أوضحه هتكهم لحرمة
بيتها، وهي التي تقول: خير للمرأة أن لا ترى رجلاً ولا يراها رجل.
وغير مأمونين على أموال الناس كما أوضحه ما صنعوه في
فدك..
فإذا كانوا لا يحفظون أموال ودماء وعرض رسول الله، فهل
يحفظون دماء وأعراض وأموال الضعفاء من الناس العاديين؟!
وإذا كانوا يجهلون حكم الإرث، فقد علمتهم إياه السيدة
الزهراء «عليها السلام».
وبعد التعليم، والتذكير، فإن الإصرار يدل على فقدانهم
لأدنى درجات الأمانة والعدالة.
فهل يمكنهم بعد ذلك كله ادعاء أنهم يريدون إقامة العدل،
وحفظ الدماء، والأعراض، والأموال، وتعليم الناس دينهم، وتربيتهم، وبث
فضائل الأخلاق فيهم، وغير ذلك..
والنتيجة من ذلك هي:
أن هؤلاء القوم قد أصروا على صرف هذا الأمر عن الإمام
علي «عليه السلام»، ونكثوا بيعته، وأجبروا الناس على البيعة لهم..
وقد توسلوا للوصول إلى أهدافهم بقوة السلاح، فجهزوا
ألوفاً من المقاتلين من قبيلة بني أسلم، وفرضوا على الناس البيعة،
وأهانوهم من أجلها، وسحبوهم إلى البيعة من بيوتهم سحباً، وحملوهم عليها
قهراً، وجبراً، كما صرحت به النصوص التاريخية.
وكان هناك من يدلهم على البيوت التي اختبأ فيها أفراد
لا يريدون البيعة لأبي بكر، فكانوا يستخرجون الرجلين والثلاثة، ويأتون
بهم ملببين، مهانين إلى المسجد ليبايعوا أبا بكر..
وبعد أن تضايقت سكك المدينة بالرجال المسلحين من بني
أسلم وغيرهم، فإنه إن كان هناك أفراد يحبون نصرة الإمام علي «عليه
السلام»، فكيف يمكنهم الوصول إليه؟! وقد أخذ الرجال عليهم أقطار الأرض،
وآفاق السماء؟!!
لقد كان ما جرى إنقلاباً مسلحاً بكل معنى الكلمة، قام
به أناس بعد وفاة النبي «صلى الله عليه وآله»، وبعد إحساسهم بالأمن،
وبالقوة.
{فَمَن
نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ}([7]).
{وَلَيَحْمِلُنَّ
أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ}([8]).
وقد يدور بخلد بعض الناس السؤال
التالي:
إنه كيف يمكن أن نصدق أن يقدم عشرات الألوف من الصحابة
على مخالفة ما رسمه النبي «صلى الله عليه وآله» لهم في أمر الخلافة
والإمامة. وهم أصحابه الذين رباهم على الورع والتقوى، وقد مدحهم الله
عز وجل في كتابه العزيز، وذكر فضلهم، وهم الذين ضحوا في سبيل هذا
الدين، وجاهدوا فيه بأموالهم وأنفسهم؟!
ونقول في الجواب:
إن ما يذكرونه حول الصحابة أمر مبالغ فيه. وذلك لأن
الصحابة الذين حجوا مع النبي «صلى الله عليه وآله» قبيل وفاته، وإن
كانوا يعدون بعشرات الألوف.. ولكن لم يكن هؤلاء جميعاً من سكان
المدينة، ولا عاشوا مع النبي «صلى الله عليه وآله» فترات طويلة، تسمح
له بتربيتهم وتزكيتهم،
وتعليمهم وتعريفهم بأحكام الإسلام، ومفاهيمه.
بل كان أكثرهم من بلاد أخرى، بعيدة عن المدينة أو قريبة
منها، وقد فازوا برؤية النبي «صلى الله عليه وآله» هذه المرة، ولعل
بعضهم كان قد رآه قبلها أو بعدها بصورة عابرة أيضاً،
ولعله لم يكن قد رآه.
ولعل معظمهم ـ بل ذلك هو المؤكد ـ قد أسلم بعد فتح مكة،
وفي عام الوفود،
سنة تسع من الهجرة: فلم يعرف من الإسلام إلا اسمه، ومن الدين إلا رسمه،
مما هو في حدود بعض الطقوس الظاهرية والقليلة.
وقد تفرق هؤلاء بعد واقعة الغدير مباشرة، وذهب كل منهم
إلى أهله وبلاده.
ولم يبق مع رسول الله بعد حادثة الغدير، الا أقل القليل،
ربما بضعة مئات
من الناس،
ممن كان يسكن المدينة.
وربما
كان فيهم العديد
من الخدم والعبيد، والأتباع، بالإضافة إلى المنافقين الذين هم
ممن حولهم من الأعراب ومن
أهل المدينة، مردوا على النفاق، ولم يكن رسول الله «صلى الله عليه
وآله» يعلمهم بصورة تفصيلية، وكان الله سبحانه هو الذي يعلمهم([9]).
قال تعالى:
{وَمِمَّنْ
حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ
مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ}([10]).
هذا إلى جانب فئات من الناس، من أهل المدينة نفسها،
كانوا لا يملكون درجة كافية من الوعي للدين، وأحكامه ومفاهيمه،
وسياساته، بل كانوا مشغولين
بزراعاتهم، وبأنفسهم،
وتجاراتهم، وملذاتهم،
فإذا رأوا تجارة أو لهواً،
انفضوا إليها،
وتركوا النبي «صلى الله عليه وآله» قائماً.
وقد تعرض كثير من الناس منهم لتهديدات النبي «صلى الله
عليه وآله» بحرق بيوتهم، لأنهم كانوا يقاطعون صلاة الجماعة التي كان
يقيمها رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالذات، كما أنه قد كان ثمة
جماعة اتخذت لنفسها مسجداً تجتمع فيه، وتركت الحضور في جماعة المسلمين،
وهو ما عرف بمسجد الضرار، وقد هدمه «صلى الله عليه وآله»، كما هو
معروف.
وتكون النتيجة هي
أن من كان
في ساحة الصراع والعمل السياسي
في المدينة، هم
أهل الطموحات، وأصحاب النفوذ من قريش، صاحبة الطول والحول في المنطقة
العربية بأسرها. بالإضافة إلى
أفراد
معدودين من غير قريش أيضاً.
فكان هؤلاء هم الذين يدبرون الأمور،
ويوجهونها بالإتجاه الذي يصب في مصلحتهم، ويؤكد هيمنتهم، ويحركون
الجماهير بأساليب
متنوعة، اتقنوا الاستفادة منها بما لديهم من خبرات سياسية طويلة.
فكانوا يستفيدون من نقاط الضعف الكثيرة لدى السذَّج
والبسطاء، أو لدى غيرهم ممن لم يستحكم الإيمان في قلوبهم بعد، ممن كانت
تسيِّرهم الروح القبلية، وتهيمن على عقلياتهم وروحياتهم المفاهيم
والرواسب الجاهلية.
وكان أولئك
الذين وترهم الإسلام ـ أو قضى على الإمتيازات التي لا يستحقونها، وقد
استأثروا بها لأنفسهم ظلماً وعلوا ـ كانوا
ـ
يسارعون إلى الاستجابة إلى أي عمل يتوافق مع
أحقادهم،
وينسجم مع مشاعرهم وأحاسيسهم الثائرة ضد كل ما هو حق وخير، ودين
وإسلام.
وهذا هو ما عبر عنه رسول الله «صلى
الله عليه وآله» حينما ذكر:
أن تأخيره إبلاغ أمر الإمامة بسبب أنه كان يخشى قومه،
لأنهم قريبو عهد بجاهلية، بغيضة ومقيتة، لا يزال كثيرون منهم يعيشون
بعض مفاهيمها، وتهيمن عليهم بعض
أعرافها.
وهكذا يتضح:
أن الأخيار الواعين من الصحابة، كانوا قلة قليلة. وحتى
لو كثر عددهم، فإن الآخرين هم الذين كانوا يقودون التيار، بما تهيأ لهم
من عوامل وظروف، في المدينة التي كانت بمثابة قرية صغيرة، لا يصل عدد
سكانها إلى بضعة ألوف من الناس، لا تصل إلى عدد أصابع اليد الواحدة، قد
عرفنا بعض حالاتهم، فكان أن تمكنوا من صرف أمر الخلافة بعد رسول الله
«صلى الله عليه وآله» عن أصحابها الشرعيين، إلى غيرهم، حسبما هو مذكور
ومسطور في كتب الحديث والتاريخ.
هذا.. وقد تقدم:
أن بعض النصوص يقول: إن التنفير برسول الله «صلى الله
عليه وآله» ليلة العقبة، ليسقط في ذلك الوادي السحيق قد كان بعد حجة
الوداع، وبعد البيعة لعلي «عليه السلام» في يوم الغدير([11]).
ولعله يمكن ترجيح هذا القول لكثير من الإعتبارات التي
اتضح جانب كبير منها.
وبعد ما تقدم، فإنه يصبح واضحاً أن الرسول الأكرم «صلى
الله عليه وآله» كان يواجه عاصفة من التحدي، والإصرار على إفشال الخطط
الإلهية، بأي ثمن كان، وبأي وسيلة كانت!
وأن التدخل الإلهي،
والتهديد القرآني
إنما هو موجه إلى العناصر
التي
أثارت
تلك العاصفة،
لإفهامهم:
أن إصرارهم على التحدي، يوازي في خطورته وفي زيف نتائجه، وقوفهم في وجه
الدعوة الإلهية من الأساس.
وقد حَسَم
هذا التدخل الموقف، ولجم التيار، لاسيما بعد أن صرح القرآن بكفر من
يتصدى، ويتحدى، وتعهد بالحماية والعصمة له «صلى الله عليه وآله»:
{وَإِن
لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ
النَّاسِ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}([12]).
وإذا كان الله سبحانه هو الذي سيتصدى لكل معاند وجاحد،
فمن الواضح: أنه ليس بمقدور أحد أن يقف في وجه الإرادة الإلهية، فما
عليهم إلا أن ينسحبوا من ساحة التحدي، من أجل أن يقيم الله حجته، ويبلغ
الرسول «صلى الله عليه وآله» دينه ورسالته.
وليبوؤوا بإثم المكر والبغي، وليحملوا وزر النكث
والخيانة..
([1])
راجع: كفاية الأثر ص52 ويقارن ذلك مع ما في إحقاق الحق
(الملحقات) وغيبة النعماني وغيرهما. فإنهم صرحوا بان قريشاً هي
التي أتته.
([2])
راجع هذه الفقرات: في خطبة النبي «صلى الله عليه وآله» في حجة
الوداع في المصادر التالية: مسند أحمد ج3 ص313 و 371 وكنز
العمال ج5 ص286 و 287 والمصنف لابن أبي شيبة ج8 ص600 والكافي
ج7 ص273 و 275 ودعائم الإسلام ج2 ص484 والمجموع للنووي ج8 ص466
وج14 ص231 والمحلى لابن حزم ج7 ص288 والوسائل (ط مؤسسة آل
البيت) ج29 ص10 و (ط دار الإسلامية) ج19 ص3 والتفسير الصافي ج2
ص67 وتفسير نـور الثقلين ج1 ص655 وتفسير القمي ج1 ص171
ومستـدرك = = الوسائل ج17 ص87 والبحار ج37 ص113 وإمتاع
الأسماع ج10 ص343 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص391 والبداية
والنهاية ج5 ص215 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص100 ومستدرك سفينة
البحار ج7 ص170 إضافة إلى مصادر أخرى تقدمت.
([3])
الآية 67 من سورة المائدة.
([4])
راجع: مسند أحمد ج2 ص243 و 493 وج6 ص52 وصحيح مسلم ج8 ص26 و 27
وشرح مسلم للنووي ج16 ص151 ومجمع الزوائد ج8 ص267 وفتح الباري
ج11 ص147 وأبو هريرة لشرف الدين ص43 ص91 وقاموس الرجال ج10
ص125 والتاريخ الكبير للبخاري ج4 ص109 وتاريخ مدينة دمشق ج67
ص326 وأسد الغابة ج4 ص386 والبداية والنهاية ج8 ص113 وإمتاع
الأسماع ج1 ص267 وج2 ص251 و 252 وسبل الهدى والرشاد ج10 ص434
وعمدة القاري ج22 ص310 وعون المعبود ج12 ص270 و 271 ومسند ابن
راهويه ج1 ص275 وج2 ص543 والآحاد والمثاني ج2 ص200 وصحيح ابن
حبان ج14 ص444 والإستذكار ج2 ص75 وتخريج الأحاديث والآثار ج2
ص261 واللمع في أسباب ورود الحديث ص82 وكنز العمال ج3 ص609 و
611 و 613 والفتح السماوي ج2 ص768 وتفسير السمعاني ج2 ص369 وج3
ص223 وأحكام القرآن ج3 ص431 وتفسير الرازي ج22 ص231 والجامع
لأحكام القرآن ج10 ص227 وتفسير الآلوسي ج15 ص24 و 25 ومكاتيب
الرسول ج1 ص587 و 589 و 617 والغدير ج8 ص251 و 252.
([5])
وفق مذهب أهل البيت «عليهم السلام» فقط.
([6])
الآية 101 من سورة التوبة.
([7])
الآية 10 من سورة الفتح.
([8])
الآية 13 من سورة العنكبوت.
([9])
الظاهر: أنه لا يعلمهم في مقام الظاهر، وفقاً لوسائل العلم
العادية، أما بعلم الشاهدية، فإنه كان «صلى الله عليه وآله»
يرى أعمال الخلائق..
([10])
الآية 101 من سورة التوبة.
([11])
البحار ج28 ص99 وإرشاد القلوب للديلمي ص331 وكتاب سليم بن قيس
(بتحقيق الأنصاري) ص272 والعقد النضيد والدر الفريد لمحمد بن
الحسن القمي ص114 والمحتضر ص109 والبحار ج28 ص128.
([12])
الآية 67 من سورة المائدة.
|