تمحلات بالية وأعذار واهية
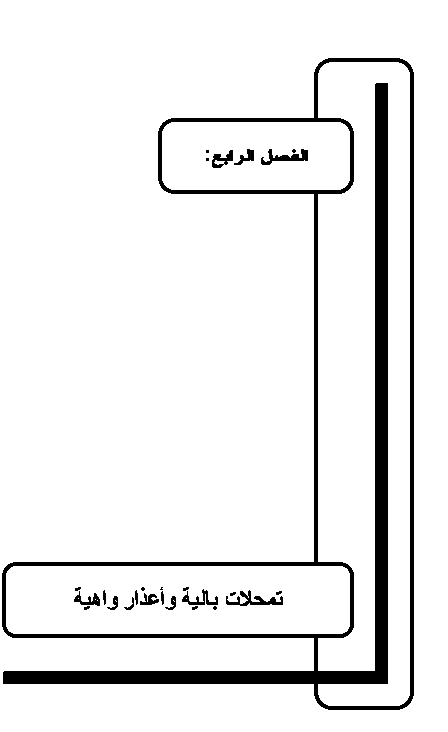
قال البيهقي والذهبي:
وإنما أراد عمر التخفيف عن رسول الله «صلى الله عليه
وآله» حين رآه شديد الوجع، لعلمه أن الله تبارك وتعالى قد أكمل ديننا،
ولو كان ذلك الكتاب وحياً لكتبه النبي «صلى الله عليه وآله»، ولما أخل
به لاختلافهم ولغطهم، لقول الله تعالى:
{بَلِّغْ
مَا أنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ}([1]).
كما لم يترك تبليغ غيره لمخالفة من خالفه، ومعاداة من
عاداه، وإنما أراد ما حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله، أن يكتب
استخلاف أبي بكر، ثم ترك كتابته اعتماداً على ما علم من تقدير الله
تعالى، كما هَمَّ به في ابتداء مرضه حين قال: «وا رأساه».
ثم بدا له أن لا يكتب، ثم قال:
«يأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر».
ثم نبه أمته على خلافته باستخلافه إياه في الصلاة حين
عجز عن حضورها.
ويتابع البيهقي، فيقول:
«وإن كان المراد به رفع الخلاف في الدين، فإن عمر بن
الخطاب علم أن الله تعالى قد أكمل دينه بقوله:
{الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}([2])،
وعلم أنه لا تحدث واقعة إلى يوم القيامة، إلا في كتاب الله تعالى وسنة
رسوله «صلى الله عليه وآله» بيانها، نصاً أو دلالة.
وفي نص رسول الله «صلى الله عليه وآله» على جميع ذلك في
مرض موته، مع شدة وعكه، ما يشق عليه، فرأى عمر بن الخطاب الإقتصار على
ما سبق بيانه نصاً، أو دلالة، تخفيفاً على رسول الله «صلى الله عليه
وآله».
ولكي لا تزول فضيلة أهل العلم بالإجتهاد في الإستنباط،
وإلحاق الفروع بالأصول، بما دل الكتاب والسنة عليه.
وفيما سبق من قوله «صلى الله عليه
وآله»:
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ،
فله أجر واحد» دليل على أنه وكل بيان بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء،
وأنه أحرز من أصاب منهم الأجرين الموعودين، أحدهما: بالإجتهاد، والآخر:
بإصابة العين المطلوبة بما عليها من الدلالة في الكتاب أو السنة.
وأنه أحرز من اجتهد فأخطأ أجراً واحداً باجتهاده، ورفع
إثم الخطأ عنه، وذلك في أحكام الشريعة التي لم يأت بيانها نصاً، وإنما
ورد خفياً.
فأما مسائل الأصول، فقد ورد بيانها جلياً، فلا عذر لمن
خالف بيانه لما فيه من فضيلة العلماء بالإجتهاد، وإلحاق الفروع
بالأصول، بالدلالة، مع طلب التخفيف على صاحب الشريعة، وفي ترك رسول
الله «صلى الله عليه وآله» الإنكار عليه فيما قال واضح على استصوابه
رأيه، وبالله التوفيق».
وقال المازري:
إنما جاز للصحابة الإختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره
بذلك، لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه
قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم بل على الإختيار، فاختلف
اجتهادهم، وصمم عمر على الإمتناع لما قام عنده من القرائن بأنه «صلى
الله عليه وآله» قال ذلك عن غير قصد جازم.
[وعزمه «صلى الله عليه وآله» كان إما بالوحي وإما
بالاجتهاد، وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي، وإلا فبالاجتهاد أيضاً].
وقال النووي:
اتفق العلماء على أن قول عمر «حسبنا كتاب الله» من قوة
فقهه، ودقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب أموراً ربما عجزوا عنها، فيستحقوا
العقوبة لكونها منصوصة.
وأراد أن لا يسد باب الإجتهاد من العلماء.
وفي تركه «صلى الله عليه وآله» الإنكار على عمر الإشارة
إلى تصويبه. وأشار بقوله: «حسبنا كتاب الله» إلى قوله تعالى:
{مَا
فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ
يُحْشَرُونَ}([3]).
ولا يعارض ذلك قول ابن عباس:
إن الرزية الخ.. لأن عمر كان أفقه منه قطعاً.
ولا يقال:
إن ابن عباس لم يكتف بالقرآن مع أنه حبر القرآن، وأعلم
الناس بتفسيره، ولكنه أسف على ما فاته من البيان، وبالتنصيص عليه لكونه
أولى من الإستنباط([4]).
و نقول:
إن ما ذكر آنفاً لا يحتاج إلى بذل أي جهد لإظهار بطلانه
وفساده، حيث إن سقوطه وخطله ظاهر للعيان، ولا يحتاج إلى بيان، ولا إلى
إقامة برهان..
ولكننا نكرر على مسامع القارئ الكريم بعض اللمحات
والإشارات إلى بعض الشبهات والمغالطات والأباطيل من دون تطويل لثقتنا
بحسن تقديره، وبسلامة وصحة تفكيره، فنقول:
إن ما زعموه:
من أن عمر أراد التخفيف عن رسول الله «صلى الله عليه
وآله» حين رآه شديد الوجع.. يضحك الثكلى، فهل التخفيف على النبي «صلى
الله عليه وآله» يستدعي اتهامه بالهذيان؟!
وهل التخفيف يكون بإيذائه بقوارع القول، وقواذع الكلم؟!
وهل التخفيف عنه بعصيان أوامره، أم بطاعته «صلى الله
عليه وآله»، والمبادرة إلى فعل ما يرضيه، ويطمئنه؟!
ألا يدل قوله «صلى الله عليه وآله»:
«أكتب كتاباً لكم لن تضلوا بعده»، أو نحو ذلك على أنه
«صلى الله عليه وآله» كان يخشى عليهم من الضلال عن الصراط المستقيم،
والوقوع في الفتن والمهالك، والإبتلاء بالضلالات؟!
وهل مجرد كمال الدين يمنع من الضلال؟! ويحصن من
الإختلاف؟!
ومن الذي قال:
إنه «صلى الله عليه وآله» يريد أن يأتي بتشريع جديد
يضيفه إلى الدين، فلعله أراد إلزامهم بالعمل ببعض ما بلغهم إياه، وهو
الوفاء ببيعتهم يوم الغدير، وتوثيق ذلك بالكتاب حتى لا يدّعي مدعٍ: أن
ولاية علي لم تكن بوحي من الله، بل هي اجتهاد من الرسول، وقد غيَّر
النبي «صلى الله عليه وآله» رأيه واجتهاده؟!
ومما يضحك الثكلى أيضاً الإستدلال بآية:
{بَلِّغْ
مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ}
وآية إكمال الدين، على صحة فعل عمر.. فقد تقدم حين البحث في قضية
الغدير، أنهم يقولون: إن هناك أحكاماً قد بلغها النبي «صلى الله عليه
وآله» بعد نزول هذه الآية، مثل آية الكلالة، وآيات الربا، وأمره بإخراج
المشركين من جزيرة العرب.. بالإضافة إلى أمور أخرى ذكروها..
وبالنسبة لقولهم:
لو كان الكتاب وحياً من الله لكتبه النبي «صلى الله
عليه وآله»، ولم يحفل بلغطهم.. نقول:
إن عدم كتابته للكتاب بعد اتهامه بالجنون والهذيان لا
يدل على أن الله لم يأمره بكتابته..
أولاً:
لأن الله تعالى يقول:
{وَأَطِيعُوا
اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}،
وهو أمر مطلق، ولم يقل: أطيعوه في بعض أوامره، واعصوه في بعضها الآخر..
ثانياً:
إن كل ما يأمرهم به رسول الله «صلى الله عليه وآله» هو
بوحي من الله، لقوله تعالى:
{وَمَا
يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}([5]).
ثالثاً:
إنه قد يكون الأمر بالكتابة مشروطاً بعدم صدور اتهام من أحد للنبي «صلى
الله عليه وآله» بالهذيان، أو ما بمعناه، لأن ذلك يبطل مفعول الكتاب،
ويقلب الأمور رأساً على عقب.. إذ لو كتب الكتاب مع وجود هذه التهمة،
لأوجبت كتابته الخلاف والفتنة، بدل أن يكون سبباً للمصونية من الضلال..
وقد ظهرت هذه الأحوال في نفس ذلك المجلس، حيث اختلف
الحاضرون وتنازعوا، فمنهم يقول: قدموا لرسول الله «صلى الله عليه وآله»
ما طلب ليكتب لكم.. ومنهم من يقول: القول ما قال عمر..
فهل إذا ارتحل النبي «صلى الله عليه وآله» إلى الرفيق
الأعلى، سوف يتفق المسلمون، أم سوف يبقى هناك من يقول: القول ما قال
عمر؟!
بل من الذي يضمن لنا تسيلم عمر نفسه بمضمون ذلك
الكتاب؟!
وإذا كانوا يعصون رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
ويخالفون أمر الله له بأن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوته «صلى الله عليه
وآله»، وبأن لا يتنازعوا عنده، بل يردون الأمر الذي يتنازعون فيه إليه
«صلى الله عليه وآله» لكي يبينه لهم إذا كانوا يفعلون ذلك كله تحت سمع
رسول الله «صلى الله عليه وآله» وبصره، فهل سيكون موته سبباً لاتفاقهم،
وحل نزاعاتهم؟! في حين أن الله تعالى يقول:
{أَفَإِنْ
مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ
يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَهَ شَيْئاً
وَسَيَجْزِي اللَهُ الشَّاكِرِينَ}([6]).
إن وجود النبي «صلى الله عليه وآله» بينهم كان رحمة
لهم، فهل أصبح وجوده نقمة، وموته رحمة لهم، ومن موجبات دفع تنازعهم
وانتظام أمورهم؟! إن من يذهب إلى هذه المقالة، لا يمكن أن يكون من أهل
الإيمان، ولا من الموصوفين بالإسلام..
رابعاً:
لنفترض جدلاً: أن كتابة الكتاب كانت اجتهاداً من رسول
الله «صلى الله عليه وآله».. فلماذا يصر هؤلاء على تخطئة النبي «صلى
الله عليه وآله» في اجتهاده، وتصويب اجتهاد عمر بن الخطاب؟! مع أنهم
يصرحون في سائر الموارد: بأن اجتهاد النبي «صلى الله عليه وآله» صواب،
وكل اجتهاد يخالفه فهو خطأ..
ولو كان الأمر كما يحلو لهم، فلماذا لم يرسل الله عمر
نبياً لهذه الأمة؟!
وهل يمكن أن يكون الله قد آثر الأخذ بمقالة المعتزلة،
فقدم المفضول وهو رسول الله «صلى الله عليه وآله» على عمر الذي كان هو
الأفضل؟!
ألا يعد ذلك من سفه القول، ومن سوء التفكير، ومن
الوسوسات الشيطانية الخبيثة؟!
ولا يكاد ينقضي تعجب من يملك أدنى ذرة من العقل
والإنصاف، من القول المنسوب إلى أهل العلم (!!) عند هؤلاء: أنه «صلى
الله عليه وآله» أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر. اعتماداً على ما علم من
تقدير الله الخ..
فقد تقدم:
أنه كلام باطل من أساسه.. إذ لم يكن ما فعله «صلى الله
عليه وآله» في يوم الغدير ـ والعياذ بالله ـ سفهاً، ولا كانت أقواله
التي تؤكد على إمامة علي «عليه السلام» بلا معنى، ولم يكن قول عمر: إن
النبي ليهجر صحيحاً، ولا كان «صلى الله عليه وآله» يهذي منذ بعثه الله
رسولاً، ومن يوم إنذاره لعشيرته الأقربين، حيث جعل علياً «عليه السلام»
أخاه، ووصيه، وخليفته من بعده منذ ئذٍ..
كما أن الله سبحانه لم يكن قد غلبه الوجع حين أنزل:
{إِنَّمَا
وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ
يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}([7]).
ولا كان كذلك حين أنزل آية:
{بَلِّغْ
مَا أنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ}([8]).
وآية:
{الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}([9]).
وأي نبي هذا الذي يتردد في أعماله؟! ويتراجع عن
أقواله.. فيريد أن يكتب كتاباً يوقع به التنازع بين أصحابه، ثم يظهر له
أن الأصوب هو أن يترك ذلك، لأن الله والمؤمنين يأبون إلا أبا بكر؟! ألم
يكن يعرف ذلك من أول الأمر؟!
إن نسبة ذلك إلى الله وإلى رسوله خروج عن الدين، بلا
ريب.. ولا نريد أن نقول أكثر من ذلك.
وأما ما زعمه البيهقي:
من أن الله تعالى قد أكمل دينه، وأنه لا تحدث واقعة إلى
يوم القيامة، إلا وفي كتاب الله تعالى وسنة رسوله بيانها نصاً أو
دلالة.. فيكذبه قول عمر نفسه: «حسبنا كتاب الله»، حيث إنه استبعد بنفس
هذه الكلمة سنة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأسقطها عن أي اعتبار.
إن قول عمر:
«حسبنا كتاب الله» يدل على أنه قد عرف: أن ما يريد أن
يقوله النبي «صلى الله عليه وآله» يهدف إلى الحفظ من الضلال في تعاليم
شريعة أكملها الله تعالى.. ولا يريد أن يضيف حكماً جديداً إليها لكي
يقال: إن الأحكام موجودة في الكتاب والسنة، أو في الكتاب فقط ويمكن
استفادتها نصاً أو دلالة.. فإن الحافظ للشيء لا يجب أن يكون جزءاً منه،
بل قد يكون خارجاً عنه حافظاً له..
ولم يكن النبي «صلى الله عليه وآله» بصدد كتابة السنة
نفسها ولا شيئاً يوجب الإرهاق والمشقة على النبي «صلى الله عليه وآله»،
لكي يقول هؤلاء: «وفي نص رسول الله «صلى الله عليه وآله» على جميع ذلك
في مرض موته، مع شدة وعكه، مما يشق عليه، فرأى عمر بن الخطاب الإقتصار
على ما سبق بيانه، نصاً، أو دلالة تخفيفاً على رسول الله».
فإن قولهم هذا يدل على أنهم يريدون
الإيحاء لنا:
بأن النبي «صلى الله عليه وآله» أراد أن يكتب الفقه كله
أو جله في ذلك الكتاب. وهو على تلك الحال من المرض الشديد..
مع أن الأمر ليس كذلك، بل هو يريد أن ينص على الحافظ
للكتاب والسنة، والمانع من الضلال، ولعل ذلك لا يتجاوز الثلاث كلمات،
فيكتب مثلاً: «علي إمامكم (أو وليكم) بعدي»..
وبذلك يظهر عدم صحة قولهم:
إن عمر أراد حفظ فضيلة العلم، والإجتهاد في الإستنباط،
وإلحاق الفروع بالأصول.
يضاف إلى ذلك:
أن اجتهاد المجتهدين، الذين قد يخطئون، وقد يصيبون، ليس
من غايات الشريعة المقدسة، ولا هو مما يهتم له النبي الأكرم «صلى الله
عليه وآله»، غاية النبي «صلى الله عليه وآله» وكل همه هو إيصال الأحكام
الشرعية، وحقائق الدين بعيداً عن الإجمال والإبهام. وأن تكون في منتهى
الوضوح، بلا حاجة إلى اجتهاد، ولا إلى مجتهدين.
وإنما احتاج الناس إلى هذا الأمر، حين تمردوا على الله
ورسوله، ومنعوا الإمام الحافظ للدين، والمبين لأحكامه من أداء المهمات
التي أوكلها الله إليه، بعد أن نكثوا بيعتهم له، ومنعوا النبي «صلى
الله عليه وآله» من معاودة التأكيد عليهم في شأنه.. ثم إنهم أقصوه،
ونابذوه وحاربوه، واضطهدوه، هو وكل من يتشيع له، أو يدين بإمامته التي
جعلها الله ورسوله له..
أما ما ادَّعاه المازري:
من أن أمر النبي «صلى الله عليه وآله» للصحابة بإحضار
الكتف قد قارنه ما نقله عن الوجوب إلى غيره.
فنقول
فيه:
أولاً:
لنفترض صحة ما ذكره المازري، لكن القرينة على عدم
الوجوب، لا تنفي ثبوت رجحان تنفيذ مراد رسول الله «صلى الله عليه
وآله».
ثانياً:
إن القرينة على عدم الوجوب لا تعني أن يُغْضِبُوا رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، ولا أن يتهموه بالهذيان، ولو على مستوى
التعريض والإشارة.
ثالثاً:
لو كانت هناك قرينة على الترخيص، لكان المفروض أن لا
يحصل تنازع بين الحاضرين، فيقول فريق: قربوا للنبي ما طلب، ويقول فريق
آخر: القول ما قال عمر، ولكان ينبغي أن يفهم الجميع هذه القرينة، أو أن
يحتج بها عمر ومناصروه لإسكات الآخرين..
رابعاً:
لو كانت هناك قرينة، فلا معنى لغضب النبي «صلى الله
عليه وآله» منهم، حتى قال لهم: «أنتم لا أحلام لكم». ولا معنى لأن يقول
لهم: «قوموا عني»، ولا أن يغضب منهم كما صرح به عدد من النصوص..
خامساً:
إنه لا مجال للترديد في عزم النبي «صلى الله عليه وآله»
بأنه إما أن يكون بالوحي أو بالإجتهاد، وكذلك تركه.. فإن النبي «صلى
الله عليه وآله»
{مَا
يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}([10])..
ولو سلم فإن الله قد أمر بطاعته
{أَطِيعُواْ
اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ}([11])
ولم يستثن من وجوب الطاعة ما إذا كان أمره عن اجتهاد.
وأما ما ادِّعاء النووي:
من أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد يكتب ما يعجزون
عنه، فيستحقون العقوبة فمنع عمر له من ذلك كان من قوة فقهه، ودقيق
نظره.. فهو أوضح فساداً، وأقبح استناداً، وذلك لما يلي:
أولاً:
إن هذا الكلام يدل على أن عمر بن الخطاب كان أصوب
رأياً، وأصح نظراً للأمور من رسول الله «صلى الله عليه وآله».. وأن عمر
قد أدرك بثاقب فكره، ودقيق نظره ما لم يدركه رسول الله «صلى الله عليه
وآله».. فكيف جاز صرف النبوة عن صائب الرأي، قوي الفقه، دقيق النظر،
إلى من يفقد هذه الصفات، أو يضعف عنه فيها؟!
ثانياً:
هل يظن برسول الله الذي وصفه الله بأنه
{عَزِيزٌ
عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ
رَحِيمٌ}([12])
بأنه يمكن أن يكتب أموراً يعجز المسلمون والمؤمنون عنها؟!
بل هل يظن بعاقل أن يكلف أحداً بما يعجز عنه؟!
وهل تقبل العقول بالتكليف بغير المقدور؟!
ثالثاً:
لو سلمنا بأنه «صلى الله عليه وآله» قد كلفهم بما
يعجزون عنه، فهل يجوز على الله أن يعاقبهم على أمر منعهم العجز عن
القيام به؟! وهل العاجز يستحق العقاب؟!
ط: النبي
 يصوب عمر
فيما قال: يصوب عمر
فيما قال:
والأكثر مرارة هنا قولهم:
إن ترك النبي «صلى الله عليه وآله» الإنكار على عمر
يتضمن الإشارة إلى تصويبه.. فهل يريد هؤلاء من النبي «صلى الله عليه
وآله» أن يقابل الشتيمة بالشتيمة؟!
وماذا يمكن أن يقول النبي «صلى الله عليه وآله» لمن
يقول له: إنك مجنون؟!
وقد قالت قريش عنه: إنه كاهن، وساحر، ومجنون، و.. و..
ولم يجبهم «صلى الله عليه وآله»، فهل كان سكوته عنهم تصويباً لهم؟! أو
إشارة إلى ذلك؟!
ألم يقل النبي «صلى الله عليه وآله» لهم: أنتم لا أحلام
لكم؟!
ألم يطردهم من محضره؟!
ألم يغضب من قولهم؟!
أليس هذا كله من تخطئة النبي «صلى الله عليه وآله»
لهم؟!
وبعد أن كتبت ما تقدم وجدت العلامة آية الله السيد عبد
الحسين شرف الدين «رحمه الله» قد أورد نصاً عن الشيخ سليم البشري، شيخ
الأزهر في زمانه، يحاول فيه أن يجد مخرجاً لما صدر من عمر بن الخطاب في
حق رسول الله «صلى الله عليه وآله».. مستفيداً من تلك التمحلات نفسها،
التي ذكرناها عنهم، وناقشناها فيما سبق، فلما وجد نفسه في مأزق لا
يستطيع الخروج منه بادر إلى الإعتراف بالعجز تبرئة ساحة المتجرئين.
ثم إن السيد شرف الدين قد علق على هذه التمحلات بما لاح
له من وجوه الضعف فيها.
فرأيت من المناسب نقل كلام هذين العلمين بعينه، وفقاً
لما جاء في كتاب النص والإجتهاد، فأقول:
قال الشيخ البشري حسبما أورده عنه السيد شرف الدين في
النص والإجتهاد ما يلي:
لعل النبي «عليه السلام» حين أمرهم بإحضار الدواة
والبياض لم يكن قاصداً لكتابة شيء من الأشياء، وإنما أراد بكلامه مجرد
اختبارهم لا غير، فهدى الله عمر الفاروق لذلك دون غيره من الصحابة،
فمنعهم من إحضارهما، فيجب ـ على هذا ـ عد تلك الممانعة في جملة
موافقاته لربه تعالى، وتكون من كراماته رضي الله عنه.
قال «رحمه الله»:
هكذا أجاب بعض الأعلام (ثم قال): لكن الإنصاف أن قوله «عليه السلام»:
لا تضلوا بعده يأبى ذلك، لأنه جواب ثان للأمر، فمعناه: أنكم إن أتيتم
بالدواة والبياض، وكتبت لكم ذلك الكتاب لا تضلوا بعده، ولا يخفى أن
الإخبار بمثل هذا الخبر لمجرد الإختبار إنما هو من نوع الكذب الواضح،
الذي يجب تنزيه كلام الأنبياء عنه، ولا سيما في موضع يكون ترك إحضار
الدواة والبياض أولى من إحضارهما.
(قال):
على أن في هذا الجواب نظراً من جهات أخر، فلا بد هنا من اعتذار آخر.
قال:
وحاصل ما يمكن أن يقال: أن الأمر لم يكن أمر عزيمة
وإيجاب، حتى لا تجوز مراجعته، ويصير المراجع عاصياً، بل كان أمر مشورة،
وكانوا يراجعونه «عليه السلام» في بعض تلك الأوامر، ولا سيما عمر، فإنه
كان يعلم من نفسه أنه موفق للصواب في إدراك المصالح، وكان صاحب إلهام
من الله تعالى.
وقد أراد التخفيف عن النبي «صلى الله عليه وآله»
إشفاقاً عليه من التعب الذي يلحقه بسبب إملاء الكتاب في حال المرض
والوجع، وقد رأى رضي الله عنه أن ترك إحضار الدواة والبياض أولى.
وربما خشي أن يكتب النبي «عليه السلام» أموراً يعجز
عنها الناس، فيستحقون العقوبة بسبب ذلك، لأنها تكون منصوصة لا سبيل إلى
الإجتهاد فيها. ولعله خاف من المنافقين أن يقدحوا في صحة ذلك الكتاب.
لكونه في حال المرض، فيصير سبباً للفتنة، فقال: حسبنا كتاب الله لقوله
تعالى:
{مَا
فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}([13]).
وقوله:
{الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}([14])،
وكأنه رضي الله عنه أمن من ضلال الأمة، حيث أكمل الله لها الدين، وأتم
عليها النعمة.
قال «رحمه الله»:
هذا جوابهم وهو كما ترى، لأن قوله «عليه السلام»: لا
تضلوا، يفيد: أن الأمر أمر عزيمة وإيجاب، لأن السعي فيما يوجب الأمن من
الضلال واجب مع القدرة بلا ارتياب، واستياؤه «صلى الله عليه وآله»
منهم.
وقوله لهم:
قوموا حين لم يمتثلوا أمره، دليل آخر على أن الأمر إنما
كان للإيجاب لا للمشورة.
قال:
[فإن قلت:] لو كان واجباً ما تركه النبي «عليه السلام»
بمجرد مخالفتهم، كما أنه لم يترك التبليغ بسبب مخالفة الكافرين.
فالجواب:
أن هذا الكلام لو تم فإنما يفيد كون كتابة ذلك الكتاب
لم تكن واجبة على النبي بعد معارضتهم له «عليه السلام»، وهذا لا ينافي
وجوب الإتيان بالدواة والبياض عليهم حين أمرهم النبي به، وبين لهم أن
فائدته الأمن من الضلال، إذ الأصل في الأمر إنما هو الوجوب على المأمور
لا على الأمر، ولا سيما إذا كانت فائدته عائدة إلى المأمور خاصة،
والوجوب عليهم هو محل الكلام، لا الوجوب عليه.
قال:
على أنه يمكن أن يكون واجباً عليه أيضاً، ثم سقط الوجوب
عنه بعدم امتثالهم، وبقولهم: «هجر»، حيث لم يبق لذلك الكتاب أثر سوى
الفتنة كما قلت حرسك الله.
قال «رحمه الله»:
وربما اعتذر بعضهم: بأن عمر رضي الله عنه ومن قالوا
يومئذ بقوله لم يفهموا من الحديث أن ذلك الكتاب سيكون سبباً لحفظ كل
فرد من أفراد الأمة من الضلال على سبيل الإستقصاء، بحيث لا يضل بعده
منهم أحد أصلاً، وإنما فهموا من قوله: لا تضلوا، أنكم لا تجتمعون على
الضلال بقضكم وقضيضكم، ولا تتسرى الضلالة بعد كتابة الكتاب إلى كل فرد
من أفرادكم.
وكانوا رضي الله عنهم يعلمون أن اجتماعهم بأسرهم على
الضلال مما لا يكون أبداً وبسبب ذلك لم يجدوا أثراً لكتابته، وظنوا أن
مراد النبي ليس إلا زيادة الإحتياط في الأمر لما جبل عليه من وفور
الرحمة، فعارضوه تلك المعارضة، بناء منهم أن الأمر ليس للإيجاب، وأنه
إنما هو أمر عطف ومرحمة ليس إلا، فأرادوا التخفيف عن النبي بتركه.
إشفاقاً منهم عليه «صلى الله عليه وآله».
قال:
هذا كل ما قيل في الإعتذار عن هذه البادرة، لكن من أمعن
النظر فيه جزم ببعده عن الصواب، لأن قوله «عليه السلام»: لا تضلوا،
يفيد: أن الأمر للإيجاب كما ذكرنا، واستياؤه منهم دليل على أنهم تركوا
أمراً من الواجبات عليهم، وأمره إياهم بالقيام مع سعة ذرعه وعظيم
تحمله، دليل على أنهم إنما تركوا من الواجبات ما هو أوجبها وأشدها
نفعاً، كما هو معلوم من خلقه العظيم.
قال:
فالأولى أن يقال في الجواب: هذه قضية في واقعة كانت
منهم على خلاف سيرتهم كفرطة سبقت، وفلتة ندرت، لا نعرف وجه الصحة فيها
على سبيل التفصيل، والله الهادي إلى سواء السبيل.
ثم عقب آية الله السيد شرف الدين
«رحمه
الله»
عليه بما يلي:
«قالوا
في الجواب الأول:
لعله «صلى الله عليه وآله» حين أمرهم بإحضار الدواة لم
يكن قاصداً لكتابة شيء من الأشياء، وإنما أراد مجرد اختبارهم لا غير.
فنقول ـ مضافا إلى ما أفدتم ـ:
إن هذه الواقعة إنما كانت حال احتضاره ـ بأبي وأمي ـ
كما هو صريح الحديث، فالوقت لم يكن وقت اختبار، وإنما كان وقت إعذار
وإنذار، ونصح تام للأمة، والمحتضر بعيد عن الهزل والمفاكهة، مشغول
بنفسه ومهماته ومهمات ذويه، ولا سيما إذا كان نبياً.
وإذا كانت صحته مدة حياته كلها لم تسع اختبارهم، فكيف
يسعها وقت احتضاره؟
على أن قوله «صلى الله عليه وآله» ـ حين أكثروا اللغو
واللغط والاختلاف عنده ـ: «قوموا» ظاهر في استيائه منهم، ولو كان
الممانعون مصيبين لاستحسن ممانعتهم، وأظهر الإرتياح إليها.
ومن ألمّ بأطراف هذا الحديث، ولا
سيما قولهم:
«هجر رسول الله» يقطع بأنهم كانوا عالمين أنه إنما يريد
أمراً يكرهونه، ولذا فاجؤوه بتلك الكلمة، وأكثروا عنده اللغو واللغط،
والإختلاف، كما لا يخفى.
وبكاء ابن عباس بعد ذلك لهذه الحادثة وعدّها رزية، دليل
على بطلان هذا الجواب.
قال المعتذرون:
إن عمر كان موفقاً للصواب في إدراك المصالح، وكان صاحب
إلهام من الله تعالى. وهذا مما لا يصغى إليه في مقامنا هذا، لأنه يرمي
إلى أن الصواب في هذه الواقعة إنما كان في جانبه، لا في جانب النبي،
وأن إلهامه يومئذٍ كان أصدق من الوحي الذي نطق عنه الصادق الأمين «صلى
الله عليه وآله».
وقالوا:
بأنه أراد التخفيف عنه «صلى الله عليه وآله» إشفاقاً
عليه من التعب الذي يلحقه بسبب إملاء الكتاب في حال المرض، وأنت تعلم:
أن في كتابة ذلك الكتاب راحة قلب النبي، وبرد فؤاده، وقرة عينه، وأمنه
على أمته «صلى الله عليه وآله» من الضلال.
على أن الأمر المطاع، والإرادة المقدسة مع وجوده الشريف
إنما هما له، وقد أراد ـ بأبي وأمي ـ إحضار الدواة والبياض، وأمر به،
فليس لأحد أن يرد أمره، أو يخالف إرادته
{وَمَا
كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَهُ وَرَسُولُهُ
أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ
يَعْصِ اللَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً}([15]).
على أن مخالفتهم لأمره في تلك المهمة العظيمة، ولغوهم
ولغطهم واختلافهم عنده كان أثقل عليه وأشق من إملاء ذلك الكتاب الذي
يحفظ أمته من الضلال، وإذا كان خائفاً من المنافقين أن يقدحوا في صحة
ذلك الكتاب، فلماذا بذر لهم بذرة القدح، حيث عارض ومانع وقال: «هجر»؟!
وأما قولهم في تفسير قوله:
«حسبنا كتاب الله»: إنه تعالى قال:
{مَا
فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}([16])،
وقال عز من قائل:
{الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}([17])
فغير صحيح، لأن الآيتين لا تفيدان الأمن من الضلال، ولا تضمنان الهداية
للناس، فكيف يجوز ترك السعي في ذلك الكتاب اعتماداً عليهما؟ ولو كان
وجود القرآن العزيز موجباً للأمن من الضلال، لما وقع في هذه الأمة من
الضلال والتفرق ما لا يرجى زواله([18]).
وقالوا في الجواب الأخير:
إن عمر لم يفهم من الحديث أن ذلك الكتاب سيكون سبباً
لحفظ كل فرد من أمته من الضلال، وإنما فهم أنه سيكون سبباً لعدم
اجتماعهم ـ بعد كتابته ـ على الضلال.
(قالوا):
وقد علم رضي الله عنه أن اجتماعهم على الضلال مما لا
يكون أبداً، كتب ذلك الكتاب أو لم يكتب، ولهذا عارض يومئذٍ تلك
المعارضة.
وفيه مضافاً إلى ما أشرتم إليه:
أن عمر لم يكن بهذا المقدار من البعد عن الفهم، وما كان
ليخفى عليه من هذا الحديث ما ظهر لجميع الناس، لأن القروي والبدوي إنما
فهما منه أن ذلك الكتاب لو كتب، لكان علة تامة في حفظ كل فرد من
الضلال، وهذا المعنى هو المتبادر من الحديث إلى أفهام الناس.
وعمر كان يعلم أن الرسول «صلى الله عليه وآله» لم يكن
خائفاً على أمته أن تجتمع على الضلال، إذ كان يسمع قوله «صلى الله عليه
وآله»: لا تجتمع أمتي على الضلال، ولا تجتمع على الخطأ، وقوله: لا تزال
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق.
وقوله تعالى:
{وَعَـدَ
اللَهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَـاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي
لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً}([19])
إلى كثير من نصوص الكتاب والسنة الصريحة بأن الأمة لا تجتمع بأسرها على
الضلال، فلا يعقل مع هذا أن يسنح في خاطر عمر أو غيره أن النبي «صلى
الله عليه وآله» حين طلب الدواة والبياض كان خائفاً من اجتماع أمته على
الضلال.
والذي يليق بعمر:
أن يفهم من الحديث ما يتبادر منه الأذهان، لا ما تنفيه
صحاح السنة، ومحكمات القرآن.
على أن استياء النبي «صلى الله عليه
وآله» منهم المستفاد من قوله:
«قوموا» دليل على أن الذي تركوه كان من الواجب عليهم.
ولو كانت معارضة عمر عن اشتباه منه في فهم الحديث كما
زعموا، لأزال النبي «صلى الله عليه وآله» شبهته. وأبان لهم مراده منه.
بل لو كان في وسع النبي أن يقنعهم بما أمرهم به لما آثر
إخراجهم عنه.
وبكاء ابن عباس وجزعه من أكبر الأدلة على ما نقول.
والإنصاف:
أن هذه الرزية لمما يضيق عنها نطاق العذر، ولو كانت ـ
كما ذكرتم ـ قضية في واقعة، كفلتة سبقت، وفرطة ندرت، لهان الأمر، وإن
كانت بمجردها بائقة الدهر، وفاقرة الظهر.
والحق أن المعارضين إنما كانوا ممن يرون جواز الإجتهاد
في مقابل النص، فهم في هذه المعارضة وأمثالها إذاً مجتهدون، فلهم
رأيهم، ولله تعالى رأيه؟([20]).
([1])
الآية 67 سورة المائدة.
([2])
الآية 3 من سورة المائدة.
([3])
الآية 38 من سورة الأنعام.
([4])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص248 و 249 وفتح الباري ج8 ص102.
([5])
الآيتان 3 و 4 من سورة النجم.
([6])
الآية 144 من سورة آل عمران.
([7])
الآية 55 من سورة المائدة.
([8])
الآية 67 سورة المائدة.
([9])
الآية 3 من سورة المائدة.
([10])
الآيتان 3 و 4 من سورة النجم.
([11])
الآية 59 من سورة النساء.
([12])
الآية 128 من سورة التوبة.
([13])
الآية 38 من سورة الأنعام.
([14])
الآية 3 من سورة المائدة.
([15])
الآية 3 من سورة المائدة.
([16])
الآية 38 من سورة الأنعام.
([17])
الآية 3 من سورة المائدة.
([18])
وأنت تعلم أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يقل: أن مرادي أن
أكتب الأحكام، حتى يقال في جوابه: حسبنا في فهمها كتاب الله
تعالى.
ولو
فرض أن مراده كان كتابة الأحكام، فلعل النص عليها منه كان
سبباً للأمن من الضلال، فلا وجه لترك السعي في ذلك النص اكتفاء
بالقرآن.
بل لو
لم يكن لذلك الكتاب إلا الأمن من الضلال بمجرده، لما صح تركه
والإعراض عنه، اعتماداً على أن كتاب الله جامع لكل شيء.
وأنت
تعلم اضطرار الأمة إلى السنة المقدسة وعدم استغنائها عنها
بكتاب الله، وإن كان جامعاً مانعاً، لأن الإستنباط منه غير
مقدور لكل أحد، ولو كان الكتاب مغنياً عن بيان الرسول «صلى
الله عليه وآله» لما أمر الله تعالى ببيانه للناس، إذ قال عز
من قائل: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (منه قدس).
([19])
الآية 55 من سورة النور.
([20])
النص والإجتهاد للسيد شرف الدين ص 156 ـ 163.
|